لتحميل الموسوعة أو تصفحها بصيغة PDF إضغط هنا
دائرة المعارف الإسلامية الشيعية
حسن الأمين
المجلد الأول
الطبعة السادسة
1422هـ/2001م

المؤرخ .السيد حسن الأمين
بسم الله الرحمن الرحيم
بين يدي الكتاب
نصدر دائرة المعارف الإسلامية الشيعية في طبعتها السادسة محاولة أن تؤدي دورها في بعث الماضي الإسلامي المجيد بكل ما في حضارته من فكر وعلم وأدب وفلسفة، ليكون عبرة للأجيال الحاضرة مقتبسة مما انطبع عليها أسلافها من إيمان وصبر على الشدائد ونزوع إلى التقدم والانطلاق في الميادين الإنسانية الرحبة.
ونحن حين ننطلق من اسم (الإسلامية الشيعية) لا ننطلق من تقوقع مذهبي أو نزعة نحلية، فذلك أبعد ما يكون عن بواعثنا ومطامحنا، وإنما ننطلق من الحقيقة وحدها، هذه الحقيقة التي غابت عن الكثير مما كتبه المستشرقون فيما أسموه (دائرة المعارف الإسلامية) وأصدروها بلغاتهم، ثم ترجمت إلى العربية([1]) وغابت كذلك عما دونه بعض المسلمين أنفسهم.
ولسنا هنا في معرض تبيان العوامل التي أدت إلى هذا الغياب، وكل ما نقوله أننا فيما ندون هنا، إنما ندون صفحات مجيدة من الفكر الإسلامي: فقهاً وتاريخاً وجغرافية وفلسفة وأدباً وما إلى ذلك، كان يجب أن تدون – ولم تدون – ونحن حين ندونها فإننا بذلك نساهم في تمجيد الإسلام وإعلاء شأنه ورفعة أمره. وهذا هو هدفنا في الحياة.
ونذكّر القارئ بأن هذا المجلد هو في الحقيقة مقدمة للمجلدات القادمة التي بها تبدأ موضوعات الدائرة،. هذه الموضوعات التي ستخلو من ذكر الأشخاص وهو ما تكفلت به موسوعة (أعيان الشيعة) التي اختصت بذكر الأشخاص. وكل ما نذكره نحن منهم هو من ارتبط اسمه بكتاب ذكرناه، أو شعر نقلناه.
وهنا لا بد لنا من القول أن سيادة السيد محمد الخاتمي الذي هو اليوم رجل الدولة والسياسة والحزم، والذي هو قبل اليوم وبعد اليوم رجل العلم والفكر والقلم، نظر لدائرة المعارف هذه نظرة العلم ونظرة الحزم فشق لها بعلمه وحزمه السبيل القويم.
إنني أكتب هذا الكلام وأنا في الثالثة والتسعين من العمر، وليس لمن بلغ هذه السن أن يحسب ما بقي له من العمر بالسنين، بل بالشهور والأسابيع والأيام. وإذا كان طموحي أن تبلغ (دائرة المعارف الإسلامية الشيعية) عشرات المجلدات، فإنني أودع تحقيق هذا الحلم لمن يقدر لهم أن يتولوه بعدي، فقد وضعت لهم النواة، وبنيت الأساس فعليهم أن يكملوا ما بدأت، وينجزوا ما أعددت. وما التوفيق إلا من الله.
بيروت 17 ربيع الآخر سنة 1422 ﮬ – 8 تموز سنة 2001م.
حسن الأمين
الشيعة
في اللغة والتاريخ
أولاً: تمهيد
من الموضوعات التي أهملها الباحثون في تاريخ الاسلام دراسة الجوانب اللغوية والتاريخية والفنية لكثير من المصطلحات التي دارت على الألسنة والأقلام على مدى العصور([2]) ومن ذلك كلمة «شيعة» التي تعُمّ كثيراً من المسلمين في طول العالم الاسلامي وعرضه زماناً ومكاناً.
وقبل البدء في هذا تنبغي الإشارة إلى أمر مهم جداً، ذلك أن ظهور مصطلح ما قد لا يعني ظهور العقيدة التي هو عنوانها، بل يجوز أن يتأخر المصطلح عن العقيدة أو أن يطلق أصحاب فكرة دينية على أنفسهم مصطلحاً معيّناً ويثبت عليهم مصطلح آخر؛ ومثال ذلك الخوارج، فمع تمسكهم بأنّهم: «مِحكّمة» و«شُراة» سار فيهم المصطلح المعروف دون أن يستطيعوا منه فكاكاً، فاضطروا إلى تسويغه وجمع الأسانيد على إيجابيته وخدمته للغرض الذي ترمي إليه الفرقة. والمعتزلة أنفسهم لم يطلقوا على أصحاب عقيدتهم هذا المصطلح، بل اختاروا لهم «أهل العدل والتوحيد». لكن اللفظ الأول ثبت ولم يعش الثاني إلا في كتب المعتزلة أنفسهم. ومن ظواهر الحركات الدينية في العصر الحديث بروز الوهابية نسبة إلى مؤسس العقيدة محمد بن عبد الوهاب، ومع حرص أتباعها على الاستظلال براية التوحيد وإطلاق لفظ «الموحدين» على أنفسهم أبت عليهم الظروف ذلك، وألصقت بهم الاسم المعروف([3]).
وفي مجال التشيّع نلاحظ هذا التداعي بين العقيدة والمصطلح؛ فقد تأخر الأخير عن الأولى واستغرقتها ألفاظ كثيرة أطلقها عليهم الخصوم ومنها: السبئية والترابية والخشبية والكيسانية والرافضة وغيرها حتى استقر مصطلح الشيعة في النهاية في الوقت الذي سيتحدد في أثناء هذا الفصل. ومع هذا، لم يكن هذا الاستقرار نهائياً، وإنما ازدوج المصطلح الذي أطلق على حملة هذه العقيدة: ففي بيئاتهم وبيئات إخوانهم من المعتدلين في خصومتهم يطلق عليهم وصف الشيعة، وعند خصومهم ذوي اللدد يطلق عليهم وصف الرافضة وغيره من مصطلحات تقترن بأسماء قادتهم في مختلف العصور، وقد تداولت الكتب من ذلك أسماء: الجعفرية والإسماعيلية والزيدية إلى غيرها من فرق الغلاة كالخطابية، والإسحاقية وغيرها. وفوق هذا ربما يتشعب من الفرقة شعب وكتل وطوائف تقترن بأسماء مؤسسيها. كالجارودية والصالحية والبترية من الزيدية. وكالشيخية والأصولية والإخبارية من الإثنا عشرية. والبهرة والإغاخانية من الإسماعيلية، إلى غير ذلك مما قد يشتت التركيز المقصود بهذا الفصل.
هذه كلمة أريد بها أن تمهد لبحث التشيع لغةً ومصطلحاً وعقيدةً ولتعدّ ذهن القارئ لهذا التمييز قبل أن يسبق إليه ما لا يراد له.
ثانياً: اشتقاق لفظة «شيعة»
يتصل هذا الاسم بالفعل شاع يشيع كما هو واضح، وربما بالفعل شاع يشوع أيضاً في رأي ابن منظور (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري 630-711هـ/ 1232-1310م) الذي دلّل على ذلك بالاتصال الوثيق بين معنى الانتشار الذي يفهم من شاع يشيع، وبين الشوع الذي يعني «انتشار الشعر وتفرّقه كأنه شوك»([4]) ومنه أشوع وشوعاء للمشعر من ذكر وأنثى([5]) وكذا الفعل نشوّع بمعنى نُغير في جماعة، وذلك في قول الأعشى (ميمون بن قيس بن جندل 7هـ/ 629م) نشوع عوناً ونجتابها([6]).
وكذا بملاحظة أن «الشوع من الليل والشواع: بمعنى الساعة»([7]) وإن لم يُخْفِ- فيما يتصل بعبارة: شيعة الرجل – بأن «الأكثر أن تكون عين الشيعة ياء»([8]). وعاد ابن منظور إلى ملاحظة أن كلمتي «عيد» و«أعياد» منقلبتا الياء من أصل واوي لاتصالهما بالفعل: عاد، يعود([9]). وكانت النتيجة أن مَزَجَ بين الأصلين ولم يميّز بينهما، فقال في وصف الأخوين اللذين لم يرد بينهما غيرهما «هذا شَوْع هذا وشَيْع بعده»([10]).
واذا لاحظنا أن الاصل «شعّ» يشترك مع شاع يشيع وشاع يشوع في الدلالة على الانتشار إلى حدّ أن الفيروزآبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب 729-817هـ/ 1329-1415م) قد عرّف الشعاع بأنه «الذي تراه من الحبال مقبلة عليك اذا نظرت اليها الشمس» أو الذي ينتشر من ضوئها، أوالذي تراه ممتداً كالرماح بُعَيْدَ الطلوع وما أشبهه([11])…» تبين لنا الاتصال الوثيق بين تعريف الشوع في العبارة السابقة وتعريف الشعاع في العبارة التالية وبالتالي اشتراك الافعال: يشيع ويشوع ويشعّ في معنى الانتشار، وكأنّ الجذر الأساسي لها جميعاً حرفا الشين والعين اللذين يدل اجتماعهما بفاصل يائيّ أو واويّ وبالتضعيف على معان متشابهة. واذا لاحظنا أن العشّ يعني تجميع القش وما اليه ليؤوي فراخ الطير، وضحت فكرة الاصل الثنائي لكلمة «شيعة» التي تعني فيما تعني أيضاً فكرة التجميع، كما يأتي، صدوراً من دلالة الشين والعين اذا اجتمعا في إسم او فعل.
واذا اتضح هذا؛ ساغ العود إلى لفظ «شيعة» للتعرّف إلى دلالته اللغوية.
ذكر ابن فارس (أبو الحسين أحمد، ت 395هـ/ 1005م) الذي انفرد من بين المعجميين العرب بالاهتمام بالأصول اللغوية من حيث الدلالة على الاساس التي تتفرع منها المعاني المختلفة، بأن الشين والياء والعين جذر له «أصلان يدل أحدهما على معاضدة ومساعدة، والاخر على بثِّ واشادة»([12]). وهو تأصيل مستمد من مراجعة الدلالات المختلفة التي يجمعها جذر الشين والياء والعين، في رأيه. وهذا المعنى قد خطر جزئياً للراغب الاصفهاني (أبي القاسم الحسن بن محمد، ت565هـ/ 1169-1170م) فذكر أن أصل شاع من «الانتشار والتقوية»([13]). وخاض مجد الدين ابن الأثير الجزري (أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني، ت606هـ/ 1209-1210م) هذا المعترك، فتبين له أن أصل الشيعة من «المشايعة، وهي المتابعة والمطاوعة»([14]). أما الشيعة فلم يتركوا هذا الميدان، وقد أنعم الطبرسي منهم (وهو أبو علي الفضل ابن الحسن، ت548هـ/1153م) النظر في هذا الامر، فبدا له أن أصل الشيعة من «الظهور»([15]) الذي يعني الانتشار لا الوضوح. وهو أول معنى يفهم من الفعل شاع بالذات، وليس فيه كبير تعمّق.
ولنا – بعد هذه التمهيدات ذات النظرات العامة الاجمالية – أن نستعرض بأنفسنا الاستعمالات المتفرعة من الاصل شاع لنرتب ما يترسب منها ويثبت. ويصادفنا في هذا المجال قول الأحوص (عبد الله بن محمد بن عبد الله الانصاري، ت105هـ/ 723م):
| الا يا نخلةً من ذات عِرْقٍ | برود الظل، شاعكم السلام([16]) |
ويفهم من «شاعكم السلام» هنا: «عمّكم وتوجّه إلى واحد واحد منكم» وهذا يعني الانتشار والعموم. ويقترن بهذا الاستعمال قولهم: «هذا سهم مُشاع أو شائع. أي:غير مقسوم»([17]) ويعني الحصّة في الدار([18]) التي لا يعرف حدها لاتصال ملكيتها بالجماعة كلها دون الأفراد، ومن هنا توصف عملية إعطاء كل ذي حقّ حقه منها- في العراق على الخصوص- بعبارة «إزالة الشيوع».
ثم يرد قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي (23-93هـ/644-712م):
| قال الخليط: غداً تصدعنا | أو شَيْعَه، أفلا تودّعنا؟([19]) |
ويفهم من عبارة «شيعة» التسلسل والترابط بين اليوم والغد، والتوالي الذي يصلهما في آصرة الزمن المغذّ السير. ومن هذه النقطة قيل في الأخوين اللذين لم يولد بينهما غيرهما «هذا شَوْع هذا وشيع هذا»([20]) أي تاليه([21]) والآتي بعده دون فاصل. ومن هذا المنطلق جاءت كلمة «شاعة»([22]) التي تعني الزوجة لانها تشايع زوجها أي تتبعه.
وتبدأ دلالة التجميع في قولهم: «شيّع الراعي بإبله أو شايع بها»([23]) إذا صاح بها أودعاها متى تأخر بعضها([24]) ومن هنا لا يستغرب اطلاق لفظ «الشياع» على مزمار الراعي في قول قيس بن ذريح (ت68هـ/ 688م):
| إذا ما تذكرين يحنّ قلبي | حنين النيب تطرب للشياع([25]) |
لأنّ المزمار يجمع مسنات الإبل، ويبث فيها شعوراً واحداً ويجعل منها كتلة واحدة. واستكمالاً لهذه الالتفاتة أطلقوا لفظ «المشيعة» على الشاة أو النعجة «التي لا تزال تتبع الغنم عجفاً أي لا تلحقها»([26]). وهكذا تتضح المشايعة، ويتبين ما فيها من المخالطة والمشاركة في الأمر وغيره([27])، وكذا المعاضدة والمساعفة التي أشار اليها ابن فارس في أول هذا الفصل.
وتنتهي هذه السلسلة في وضوح تام إلى «الشيعة» بمعنى الفرقة([28]) و«الشيع» جمعها و«الأشياع» جمع الجمع([29]) على اعتبار أن الأول: يتمثل في أن «بعضهم يتبع بعضاً»([30]) والثاني في أن «الشيعة من يتقوى بهم الانسان وينتشرون عنه ومنه»([31]) وأخيراً لدلالتها على «المشايعة والموالاة والمناصرة»([32]) وفي النهاية باعتبار الشيعة «الأولياء والأنصار والأصحاب والأحزاب»([33]).
بقي شيء ينبغي أن يناقش في هذه اللمعة، ذلك أن لفظ «شيعة» من حيث تركيبه الصرفي – في رأي ابن نشوان – جمع شاعٍ بمعنى شائع كما يقال: سائر وسار، ومثله كمثل حيرة جمع حار([34])، فكأنّه مشتق من الفعل «شعى» توأم «شاع» وكأنهما بمعنى كنحو الفعلين «سار» و«سرى» اللذين خرج منهما إسما الفاعل: سائر وسار. ويبدو رأي ابن نشوان لاوّل وهلة قلقاً متهافتاً، إذ من الواضح أن «شيعة» على وزن «فعلة» كفرقة، والياء فيها عين الكلمة. من هنا ينبغي أن يكون فعلها أجوف، أي أنه «شاع» لا «شعى». لكن الأمر ليس على هذا النحو، ذلك أن ابن نشوان ردّد رأياً قديماً بحثه اللغويون وحلّلوه حتى استقروا على هذه النتيجة ناظرين إلى قول ربيعة بن مقروم بن قيس، الشاعر المخضرم (ت بعد 16هـ/ 637م) واصفاً فصيل الناقة الحديث الولادة:
| فلهّف أمه وانصاع يهوي ء |
له رهج من التقريب شاعٌ([35]) |
أي أسرع إلى أمّه على ضعفه يقوم مرة ويقع أخرى والغبار منتشر من حوله، و«شاع» هنا بمعنى «منتشر» في رأي ابن الأنباري (القاسم بن محمد بن بشار، ت304هـ/917م) «شائع» في الاصل، فطرأت عليها أحوال ونقلٌ في حروفها خرجت بها من أصلها ذاك إلى صورة أخرى هي «شاعٌ». ذلك أن الشاعر «أخّر الياء فجعلها بعد العين فصارت: شاعي، ثم أسقط الياء وجعله اسماً (أي ما بقي من شاعٍ بعد إسقاط الياء). فإذا تأخرت الياء فينبغي أن يكون لفظَ «شاعي» اسماً منقوصاً يكتب عند التنوين في حالي الرفع والجرّ على صورة «شاعٍ» لا «شاعٌ» كما هو شأن المنقوصات. لكن اللغويين البصريين لم يقفوا عند هذه النقطة وقالوا في هذه الظاهرة: «كان أصله شائعاً، وأسقطنا الهمزة (في شائع) وهي عين الكلمة، فصار شاعٌ»([36]). وانساق ابن دريد مع هذا الرأي دون توقف، فأيده بمثال آخر يتمثل في كلمة «سائر» بمعنى «كلّ» التي تحولت إلى صورة «سارٌ» في قول ذي الرمّة (غيلان بن عقبة العدوي، 77-117هـ/ 696-735م) «وهي أدماء سارها»([37]) بمعنى «سائرها»([38])، وواضح أن الأساس في هذا كله إنما هي ضرورة الشعر وتصرف الشعراء الأولين في اللغة الشعرية بمقتضى متعارفات عصرهم التي صارت عند تدوين اللغة وما يتصل بها مصادر للمعرفة ومراجع لاستنباط القوانين الصرفية. وهكذا يبدو أن «شيعة» جمع مفرده «شاعٌ» المعدول بها عن «شائع» بمعنى منتشر وما يتصل به.
و«شيعة» إلى هذا قد عادت من حال جمعها إلى كلمة مفردة لها جمع هو «شيع» وجمع جمع هو «أشياع» وحارٌ التي مرّت قد عدل بها عن حائر، وجمعت فكانت حيرة كشيعة. وحال هذه الأخيرة في الوزن كحال فرقة، وفي الجمع بـ شِيَع كحال فرق.
ويذكر لكلمة «شيعة» انها – بحكم سريانها على الطائفة والولاء الديني ولأسباب أخر- اكتسبت مرونة لم تكتسبها كلمة أخرى في العربية يعرفها كاتب هذه السطور، اللهم إلّا «عدوّ» التي تضادها وربما «حزب» التي تقف نداً لها؛ فكلمة «شيعة» تنفرد عن سائر الاسماء التي تطلق على الجماعات الدينية والسياسية بأنها تصدق على المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، فكلهم شيعة([39]) إلى جوار «شيعي» التي ولدت منها لتصف المفرد إشباعاً لحاجة لغوية وإجتماعية عرضت فيما بعد.
بعد هذه الفذلكة اللغوية، يبدو واضحاً أن ألفاظ «شيعة» و«فرقة» و«حزب» تصدق على الجماعة المتكتلة؛ لكن الأول اتخذ سبيل الوصل والرصّ والجمع، واتبع الثاني جادة الفصل والفرز والنفي والمنع، وانصب الثالث على التجمع في الشدائد حين «يحزب» أمر. وهذا يعني أن لفظ فرقة أدلّ على التمييز وإسباغ الطابع الخاص من اختيها لصدورها عن التفريق والتمييز والمنع، ولفظ «الشيعة» يغلب عليه جمع المتشابهات دون مراعاة المنع ووضع الحدود الفاصلة([40]) وهذه الملاحظة لا تقلل من قيمة لفظ «شيعة» لا فنياً ولا منطقياً، بل تبين أصالته في الدلالة على خصيصة الأقوام الذين دانوا بهذا المذهب وعلى طابعهم المزجي الذي يتمثل في التقائهم في نقطة البدء التي جمعتهم، من القول بفضل عليّ، واستقلالهم في ما عدا ذلك من الشجون في الأصول والفروع. وقد أرسل الأزهري في كلمة «شيعة» عبارة جامعة لعله لم يلتفت إلى عمقها وذلك في قوله: «والشيعة الذين يتّبع بعضهم بعضاً، والشيع الفرق التي كل فرقة منها يتّبع بعضهم بعضاً، وليس كلهم متفقين..» ومن عجب أن هذا الوصف الذي عيّنت به دلالة الكلمة لغوياً قد لحقت المعنى الاصطلاحي في رأي الشيعة أنفسهم([41]). والحق أن رسوخ كلمة «شيعة» في الدلالة على حملة هذه العقيدة ليعدّ نموذجاً من عبقرية الظروف التي فرضت هذا اللفظ وحده ليعبر عن حاق الأمر فعلاً.
وأما لفظ «حزب» فنسوق عليه ملاحظة لأبي حاتم الرازي (أحمد بن حمدان، ت322هـ/ 934م) صاحب كتاب الزينة التي يقول فيها: «فالشيعة تكون معرفة ونكرة، يقال هؤلاء الشيعة إذا أردت به شيعة علي. ويقال أيضاً: هؤلاء شيعة فلان، لمن أردت من الناس فيعرف بالإضافة. فأما الحزب فأنه لا يجيء إلا نكرة؛ لا يقال هؤلاء الحزب حتى تعرّفه بالإضافة فتقول: حزب فلان»([42]). ومن ناحية أخرى ذكر أبو حاتم أن لفظ: «الأحزاب قد يجيء معرفة ونكرة، قال الله عز وجل: ﴿ولما رءا المؤمنون الاحزاب﴾ [الاحزاب: 22] فجاء به على المعرفة. والشيع – اذا جمعته – لا يجئ إلا نكرة ولا يكون معرفة؛ قال الله عز وجل: ﴿شيع الأولين﴾ [الحجر:10] فعرّف بالإضافة، لا يقال: هؤلاء الشيع كما يقال: هؤلاء الاحزاب.. ([43]).
وختاماً لهذه الفقرات وجمعاً لنتائجها وتنبيهاً إلى رأي مصنف قديم خبير بأعماق الإسلام والقرآن نسوق عبارة معبرة للحكيم الترمذي (أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر، ت بعد 318هـ/ 930م) ضمّنها كتابه «تحصيل نظائر القرآن» الذي حققه وضبطه حسن نصر زيدان بمصر سنة 1389هـ/ 1969م في تعليقه على كلمة «شيعاً» في قوله تعالى: «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيئاً» ([44]) وغيره.
قال الحكيم الترمذي: «وأمّا قوله: شيعاً على كذا وجه، فالشيعة: واحدة وجماعتها شيعاً (شِيَع)، فالشيعة كل فرقة شايع بعضهم بعضاً، أي شاع قول كل واحد منهم في قول الآخر، فصاروا مختلطين قولاً وفعلاً، فهم شيعة بالاختلاط. ولذلك يقال للشيء بين شركاء: شائع غير مقسوم، ويقال: شاع هذا الأمر في الناس، لتفرّقه واختلاط الخبر باسماعهم وقلوبهم». وفي الختام ذكر الحكيم الترمذي أن للشيعة نظيرين في الدلالة القرآنية هما: «الفرق» و«أهل الدين»([45]).
ثالثاً: لفظ «شيعة» في الاستعمال اللغوي
لا بد أن يكون لكلمة «شيعة» التي أصابت هذه الشهرة في التاريخ والتداول على الألسنة والأقلام تاريخ لغوي حافل منذ القديم، ونحاول في هذه الفقرة تجميع هذه الاستعمالات فيما يلي:
أ – لم يرد هذا اللفظ في الشعر الجاهلي نصاً – فيما نعلم – إلا في قصيدة لكعب بن زهير الشاعر المخضرم صاحب البردة المشهورة (ت 26هـ/ 647م) لعله قالها في الفترة السابقة على الإسلام، ومنها بيتان في وصف الذئب حين سأله حيان بن عوف: «يا كعب ويحك، لَمِ لا تشتري الغنما؟» يقول فيهما:
| أخشى عليهم كسوباً غير مدّخر | عاري الأشاجع لا يشوي إذا ضغما | |
| إن يَغد في شيعة لا يثنه نهر | وإن غدا واحداً لا يتّقي الظلما([46]) |
وورد لفظ «الشيع» في قول الأعشى:
| وبلدةٍ يرهب الجوّاب دلجتها | حتى تراه عليها يبتغي الشيعا([47]) |
وورد لفظ «الاشياع» في قوله أيضاً:
| أبو مالك خير أشياعنا | إذا عَدّتْ النفس أقتارها([48]) |
وإذا تساهلنا في لفظ «مشايع» واعتبرناه مرادفاً لكلمة «شيعة» فإن على ذلك يرد قول عنترة:
| ذُلُل ركابي حيث شئتُ، مشايعي | لبّى وأحفزه بأمر مبرم([49]) |
ب – وفي القرآن، ورد لفظ «شيعة» وجمعاه «شيع» و«أشياع» في دلالة واضحة على الجماعة ذات الرأي حسناً كان أو شيئاً.
فجاء لفظ «شيعة» في الآية: ﴿وإن من شيعته، لإبراهيم (83) إذ جاء ربه بقلب سليم﴾ [الصافات: 83- 84] وفي الآية ﴿وجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه… ﴾ [القصص: 15] والآية: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً﴾ [مريم: 69].
وجاء لفظ «شيعة» في قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين﴾ [الحجر: 10] وفي قوله تعالى:﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض﴾ [الأنعام: 65] وفي قوله تعالى: ﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا منهم شيعاً لست منهم من شيء﴾ [الأنعام: 159] وقوله تعالى: ﴿إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً﴾ [القصص: 4].
وجاء لفظ «أشياع» في قوله تعالى: ﴿ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدَّكر﴾ [القمر: 51] وفي قوله تعالى: ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب﴾ [سبأ: 54].
جـ – وفي الحديث وردت كلمة «شيعة» دائرة حول أنصار عليّ وكتلته من المسلمين الأولين من نحو قوله (ص) في عليّ: «إن هذا وشيعته لهم الفائزون»([50]) وغيره مما لا داعي للتعلّل به لإحاطة الشكّ بدلالته الاصطلاحية في هذا الوقت المبكّر، ولورود غيره نافياً عنه الصفة الفنية، وجانحاً به إلى الجانب اللغوي بروايات عن علي وإخوانه الصحابة أنفسهم. ومع هذا فإنّ من المفيد أن ندرج هنا بعض هذه الأحاديث.
ففي كتاب الصحاح والسنن لم يرد هذا اللفظ كثيراً وأغلب ما جاء منه تضمنه مسند ابن حنبل. ومنه أحاديث وردت في سنن النسائي (أحمد بن علي، الحافظ، ت 303هـ/ 915م) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل: 181- 255هـ/ 797 – 869م).
ويقتضينا التدقيق أن نستعرض الاحاديث التي تضمنت هذه الكلمة لتتخذ مكانها المناسب في موكب استعمالاتها المختلفة.
فمن ذلك حديث صفوان «إني لأرى موضع الشهادة، لو تشايعني نفسي» اي تتابعني([51])، ومنه حديث الأحنف: «وإن حسكة كان رجلاً مشيّعاً» أراد به ها هنا العجول.. ([52]) ومنه حديث علي «أمرنا بكسر الكوبة والكنّارة والشياع»([53]) وهو بمعنى المزمار كما مرّ، ومنه أيضاً: «الشياع حرام»([54]). وورد عنه (ص) في حديث الضحايا أنه «نهى عن المشيِّعة»([55]) وهي التي «لا تزال تتبع الغنم عجفاً اي لا تلحقها»([56]). وواضح أن هذه كلها استعمالات لغوية تتناول فروع الجذر الذي جاءت منه كلمة «شيعة».
ووردت مجموعة من الأحاديث في التعليق على الآية ﴿أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض… ﴾ الماضية، ومنها عبارته (ص): «هاتان أهون؛ الشيع: الفرق أي يجعلكم فرقاً مختلفين»([57]) وقوله (ص): «وسألت ربي ألا يلبسنا شيعاً»([58]) و«ألا يلبسهم شيعاً»([59]) و «اتخذوا دينهم شيعاً»([60]).
ووردت مجموعة ثالثة من الأحاديث حوت كلمة «شيعة» بالذات، بمعنى الأتباع، موجهة إلى الدجال ومنها الحديث: «فإنه سيكون له شيعة»([61])، والحديث: «وهم شيعة الدجال»([62]) وقوله (ص) في حروب الدجال وملاحمه وفتنه: «.. فيقتتلون ويقتلون شيعته»([63])، ثم ما ينسب إليه (ص) أنه قال: «القدرية شيعة الدجال» ([64]). وكل هذا يتصل بالجانب اللغوي كما مرّ واتضح.
حتى أحاديث الشيعة التي تستمد هذا التسمية من الرسول الكريم وصفاً لأتباع علي ومؤيديه في الإسلام الأول لا تتجاوز الجانب اللغوي من هذه الاستعمالات، ومن ذلك ما ورد من أنه (ص) قال: «شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة»([65]) ومن قوله الذي سجلنا آنفاً: «إن هذا وشيعته لهم الفائزون».
رابعاً: كلمة «شيعة» في الشعر والنصوص الإسلامية
من المفيد جداً استعراض كلمة «شيعة» في الشعر والنصوص الإسلامية الأخرى من تواريخ وآثار لنتبين تاريخها ودلالتها في الفترة الإسلامية توطئة لتبيّن ما فيها من جديد يفيد في إغناء دراستنا هذه. وتنظيماً لهذه المعلومات وتنسيقاً لها أفردنا فقرة بكل شكل من اشكال التعبير على نسق تاريخي.
أ – كلمة «شيعة» في الشعر العربي الإسلامي:
1 – أقدم نص شعري إسلامي ينطوي على كلمة «شيعة» قول حسَان بن ثابت الأنصاري (ت 54ﻫ / 674م):
| أكرم بقوم رسول الله شيعتهم | إذا تفرقت الأهواء والشيع([66]) |
2 – ومن الأشعار الإسلامية في هذا المجال قول عمير بن الأهلب الضبي – الذي حارب مع جيش عائشة يوم الجمل وجرح فيه – يصف نفسه وقومه بأنهم من عائشة «شيعتها»:
| لقد أوردتنا حومة الموت أمّنا | فلم ننصرف إلا ونحن رواء | |
| لقد كان عن نصر ابن ضبة أمه | وشيعتها مندوحة وغناء([67]) |
3 – ومنها قول عامر بن واثلة الكناني (أبي الطفيل الشاعر، 3 – 100ﻫ/ 625 – 718م) يدعو إلى مؤازرة محمد بن الحنفية (ت 81ﻫ / 700م) وتأييده:
| يا إخوتي، يا شيعتي، لا تبعدوا | ووازروا المهدي كيما تهتدوا | |
| محمد الخيرات يا محمد | أنت الإمام الطاهر المسدد | |
| لا ابن الزبير السامري الملحد | ولا الذي نحن إليه نقصد([68]) |
4 – ومنها قول الكميت بن زيد الأسدي (60- 126ﻫ / 680 – 744م):
| وما لي إلا آل أحمد شيعة | وما لي إلا مشعب الحق مشعب | |
| ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعة | ومن بعدهم؟ لا من اجل وأرحب؟!([69]) |
وقوله في القصيدة نفسها:
| فلا زلت فيهم حيث يتهمونني | ولا زلـــــت في اشيــاعهم أتقلب([70]) |
5 – ومنها قول حمّاد الراوية (ابن ميسرة أو سابور، مولى بني شيبان، 95 – 155ﻫ / 714- 772م) يصف أصحاب أبي منصور العجلي الغالي (ت 121ﻫ / 739م):
| إذا سرت في عجل، فسر في صحابة | وكندة فاحذرها حذارك للخسف | |
| وفي شيعة الأعمى زيار وغيلة | وقشب وإعجال لجندلة القذف([71]) |
6 – ومنها قول محمد بن سابق يقرن هذه الكلمة بعمر بن الخطاب، وهي من نوادر الشواهد على الاستعمال اللغوي لكلمة شيعة:
| إني رضيت علياً للهدى علما | كما رضيت عتيقاً صاحب الغار | |
| وقد رضيت ابا حفص وشيعته | وما رضيت بقتل الشيخ في الدار | |
| كل الصحابة عندي قدوة علم | فهل عليَّ بهذا القول من عار؟!([72]) |
7 – وجاءت في شعر للوأواء الدمشقي (أبي الفرج محمد بن أحمد الغسّاني، ت نحو370هـ/ 980 – 981م) قال فيه:
| يا شيعة اللهو هبّوا | إلى اللذائذ هبّوا | |
| فالناي يبدي أنينا | يشجي وللعود ضرب | |
| وأعين الغيث تجري | لها انهمال وسكب | |
| وما علينا جناح | فيما فعلنا وعتب([73]) |
8 – وجاءت كلمة «شِيَع» في شعر لمحمد بن يسير الرياشي البصري (المعاصر لأحمد بن يوسف الكاتب، ت 213ﻫ/ 828م) وصف فيه متكلمين «من أهل الجدل يتصايحون في المقالات والحجج فيها» وقال فيه([74]):
| يا سائلي عن مقالة الشيع | وعن صنوف الأهواء والبدع | |
| دع من يقود الكلام ناحية | فما يقود الكلام ذو ورع |
وواضح أن هذه الشواهد كلها بعيدة عن معالجة المعنى الاصطلاحي لكلمة شيعة ابتداء من حسان بن ثابت حتى الوأواء الدمشقي في قصيدته العابثة الماضية. ومن الطبيعي أن ما رويناه ليس كل ميراثنا من الشعر في هذه النقطة. ومن الطريف أن نشير إلى أن الكميت اعتبر الأئمة شيعة له على خلاف ما نألفه من معنى الكلمة وتوجّهها إلى الأتباع لا المتبوعين، وهذا من خفايا هذه الكلمة المتعددة الجوانب.
خامساً: كلمة «شيعة» في الأخبار والنصوص
وكان من الطبيعي أن ترد كلمة «شيعة» في الأخبار والتواريخ والنصوص والإشارات المختلفة، ومن المفيد تضمينها هذا الموضع.
1 – وردت هذه الكلمة في كلام لعمر بن الخطاب وصف بها حاشية الهرمزان – وزير يزدجرد – لما أُتي به المدينة أسيراً مع اثني عشر من رجاله. في هذه الواقعة، نظر عمر الى الهرمزان، وعليه الديباج ومناطق وأسورة الذهب، فقال: «أعوذ بالله من النار. ثم قال: الحمد لله الذي أذلّ هذا وشيعته بالإسلام»([75]).
2 – ووردت على لسان علي بن أبي طالب بعد عودته من حرب الجمل لما سأله رجل ممن تخلف عنه: «يا أمير المؤمنين، أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحة، بِمَ قتلوا؟».
فكان الجواب: «قتلوا شيعتي وعمّالي… وفي أعناقهم بيعتي ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي؛ فقتلتهم بهم…»([76]).
3 – وفي هذه الاثناء، كان معاوية بن ابي سفيان (ت 58ﻫ/ 677 – 678م) ينتظر دوره في إفساد الأمر على عليّ. ولما أنتصر الخليفة المنتخب على قادة المؤامرة الأولى، وولّى على مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري (ت 60 هـ/ 680م) الذي سيطر على الموقف هناك، خشي معاوية (أن يُقبل عليه عليٌ في أهل العراق، ويقبل إليه قيس بن سعد في أهل مصر، فيقع معاوية بينهما»([77]) فكان مما قاله:
«قلت لأهل الشام: لا تسبّوا قيس بن سعد، ولا تدعوا إلى غزوه، فإنه لنا شيعة، يأتينا كيّس نصيحته سراً…». وقال معاوية أيضاً: «وهممت أن أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق، فيسمع بذلك جواسيس علي عندي وبالعراق».
وبذلك راجت هذه الإشاعة، ودبّ الشك في قلوب أنصار عليّ تجاه قيس بن سعد، وكان في مصر وغيرها ما كان.
4 – وتكرّر استعمال كلمة «شيعة» في صكّ التحكيم بصفّين خمس مرات، وذلك سنة (37هـ/ 657م) وقد بدأت هذه الوثيقة بالعبارات التالية:
«هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهمنا فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنّة نبيّه (ص) قضيّة علي في أهل العراق ومن كان من شيعته من شاهد وغائب، وقضية معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعته من شاهد وغائب…» ([78]).
5 – وفي وقعة صفّين هذه وصف أبو أيوب الأنصاري الصحابي القديم (خالد بن يزيد بن كليب، ت 52 هـ/672م) بكونه «من شيعة علي»([79]).
6 – وبعد ذلك، لما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية وصف أنصار الأثنين في وثيقة التنازل بالشيعة أيضاً، كما فعل في صكّ التحكيم وكان ذلك سنة (50 هـ/670م).
7 – وحين خالف زياد بن أبيه (1-53هـ/ 622-673م) نصوص هذا الاتفاق باضطهاده أنصار الحسن، شكاه الحسن إلى معاوية، فأخذت زياداً العزّة بالإثم وكتب إلى الحسن يقول: «من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن (!).
أما بعد، فإنه أتاني كتابك في فاسق تؤويه الفسّاق من شيعتك وشيعة أبيك. وأيم الله، لأطلبنّه بين جلدك ولحمك. وإن أحبّ الناس إليّ لحماً أن آكله، للحم أنت منه، والسلام»([80]).
8 – وعقب قتل الحسين (61 هـ/680م) نازعت عبد الله بن الزبير نفسه للخلافة، وذلك في حياة يزيد بن معاوية (25-64هـ/645- 683م) فعيَّن هذا عمرو بن الزبير – أخا عبد الله وعدوّه اللدود – على شرطة المدينة. ولما كان عمرو يعرف أسرار الحركة «ضرب ناساً كثيراً من قريش والأنصار بالسياط، وقال: هؤلاء شيعة عبد الله بن الزبير»([81]).
9 – وفي سنة (65هـ/ 684-685م) وبعد موت يزيد بن معاوية، ثم ابنه معاوية الثاني، وتركه الأمر شورى للمسلمين، كاد عبد الله بن الزبير أن يصل إلى الحكم، وكاد أنصاره يسيطرون على دمشق نفسها. وفي هذه الأثناء نظمت حركة أموية في الأردن لاستعادة السلطان، وكان قائلهم يقول:
«… لئن كان دين يزيد بن معاوية وهو حيّ حقاً يومئذ، إنه اليوم وشيعته على حق. وإن كان ابن الزبير يومئذ وشيعته على باطل، إنه اليوم على باطل وشيعته…» ([82]).
10 – وفي هذا الصراع الدامي بين عبد الله بن الزبير من ناحية، ومروان بن الحكم، ثم عبد الملك بن مروان من ناحية أخرى، ذكر أن المختار ابن أبي عبيد – القائد الكيساني المشهور (ت67هـ/ 692م)- كان «مع عبد الله بن الزبير في حصره الأوّل أشد الناس معه، ويريه أنّه شيعة له…» ([83]).
11 – ولما قدم المختار العراق مندوباً من قبل عبد الله بن الزبير «اختلف إلى عبد الله بن مطيع (ت 73هـ/692م) وهو والي الكوفة يومئذ لعبد الله بن الزبير وأظهر مناصحة ابن الزبير، وعابه في السرّ، ودعا إلى ابن الحنفية وحرّض الناس على ابن مطيع واتّخذ شيعة: يركب في خيل عظيمة. فلمّا رأى ذلك ابن مطيع خافة فهرب..» ([84]).
12 – وفي مقابل تشيّع المختار لعبد الله بن الزببير ثم لمحمد بن الحنفية، وُصِف الحارث بن خالد – الذي ولاّه الحجاج بن يوسف الثقفي (40- 95هـ/ 660-714م) بأنه:
كان شيعة للحجاج… فجعل ينادي: من دخل منى إلى الحارث بن خالد فهو آمن، ومن دخل دار شيبة الحاجب فهو آمن…» ([85]).
13 – وفي اثناء الحركة السرّية العباسية التي أسقطت الدولة الأموية كان الدعاة ينتمون إلى الشيعة، دون تعيين لجهة معيّنة، مخادعة للناس وللعلويين، واستغلالاً لعطف الناس على أبناء عليّ، وحنقهم على الأمويين. ومع هذا فقد ذكرت عبارة «شيعة بني العباس» في أخبار سنة 125هـ/742 – 743 م التي توفيَ فيها محمد بن علي بن عبد الله بن العباس قائد هذه الحركة، وذلك حين قصد أحد النقباء إلى خراسان و «قد مرو، وجمع النقباء، فنعى لهم الإمام، ودعاهم إلى ابنه إبراهيم الإمام، فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة: شيعة بني العباس»([86]).
14 – ولما سقطت الدولة الأموية في المشرق وقامت في المغرب على يد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك (113-172هـ/ 731-788م) المنصور: «… إن معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان، وذلّلا له صعبه، وعبد الملك ببيعة تقدّم له عقدها، وأمير المؤمنين (يعني السفاح) بطلب عشيرته واجتماع شيعته، وعبد الرحمن منفرد بنفسه، مؤيّد برأيه، مستصحب لعزمه»([87]).
15 – ومن أطرف النصوص دلالة، فيما يتصل بكلمة «شيعة» أن الحسن بن عمرو بن الجهم (ت 288هـ/ 901م) وكان من الرواة عن الصوفية، عرف بأبي الحسين الشيعي، لا نسبة إلى شيعة علي بن ابي طالب(ع) كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما إلى «شيعة المنصور»([88]) وكذا كان اسماعيل بن يونس([89]).
16 – وفوق دخل لفظ «شيعة» عالم الفلسفة بالمعنى اللغوي، واستعمل للتعبير عن المدرسة الفلسفية والتلامذة. ومن هنا وصف ثابت بن قرّة الحرّاني (221- 288هـ/836-901م) نيقوما الجاراسيني، صاحب كتاب «المدخل إلى علم العدد» بأنه «من شيعة فيثاغورس»([90]).
17 – ولم يقتصر الأمر على التراجمة الذين ينقلون الكلمات من لغة إلى أخرى حرفاً بحرف، وإنما وجدنا عبد الحق ابن سبعين (أبا محمد المرسي، ت 669 هـ/ 1270م) الصوفي الوجودي، يردد كلمة «شيعة» ترديد ثابت بن قرة؛ فأرسل عبارة تضمنتها مرتين، هجّن فيها الفلسفة اليونانية، وحذّر من الوقوع في شَرَكها وقال:
«ولا تلتفت إلى ما تخبط فيه شيعة أرسطو، وكونهم يقولون: الحق – عز وجلّ – هوالمحرك لجرم الأقصى بذاته… وكذلك مذهب أهل الرواق وشيعة فيثاغورس ومن قال بالمثل المعلّقة والحياة السارية في الموجودات…».
وواضح، بعد هذا، أن كلمة «شيعة» لم تكن من اختراع حملة هذا المذهب، وإنما كانت كلمة عربية متداولة على الألسنة، رائجة في الأخبار والأشعار، استعملها الجاهلي في جاهليته، واستعملها المسلم عند إسلامه وبعده. وميزة كلمة «شيعة» أنها لبست لبوس الكلمات الشرعية التي نقلها الإسلام من الإستعمال اللغوي إلى الشرعي، من نحو صلاة وزكاة ووضوء وأذان وجهاد، دون أن تكون منها، وإنّما ثبتت بقوتها الذاتيّة إلى جانب الكلمتين الإسلاميتين: «المهاجرين» و«الأنصار». بل عاشت عمراً أطول منهما، إذ انتقلت هاتان إلى المعاجم لتحنّط فيها، واستمرت كلمة «شيعة» تتدفق حياة حتى الآن، وستظل إلى ما شاء الله دون أن تستمد بقاء من عَلَمٍ تقترن به، أو تتحول إلى كلمة منسوبة إلى علَم معين كمصطلحات: الأشاعرة أو الإسماعيلية أو الوهابية أوغيرها. وظاهر من استقراء النصوص التي أدرجناها فيما مرّ أن حركات التكتل السياسي والتنافس على الحكم قد ولّدت تصوّراً اجتماعياً أحوج إلى مصطلح يعبر عن هذه الظاهرة، فما أسرع ما أشبعت كلمة «شيعة» هذه الحاجة فدارت حول أنصار علي ومعاوية وعائشة والحسن بن علي ويزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير والحجاج وأبي العباس وأبي جعفر المنصور، فوق إطلاقها على حاشية الهرمزان ومدرستي فيثاغوراس وارسطو الفلسفيّتين، وأية نحلة دينيّة تنسب إلى رجل بعينه، وفوق صلاحها لوصف أية جماعة يؤلف بينها مزاج موقت كشيعة اللهو التي وردت في شعر الوأواء الدمشقي، وكشيعة السياسة والمسرح والرياضة كما يستطيع غيره أن يديرها على لسانه أو يسيلها من قلمه.
لكن كلمة «شيعة» بمعناها الطائفي المعروف لها تاريخها الذي انتقلت عنده، واتجهت وجهتها الخاصة بدلالتها على المنتسبين لعلي في حياته، والمتّبعين لأبنائه بعد موته، الجامعين لكلماتهم وآرائهم وسيرهم على سبيل التقليد لها والتقيّد بها باعتبارها أسساً لمذهب عقلي واتجاه ديني وتطبيق فقهي للإسلام في صورته المثالية المتكاملة.
تحول كلمة «شيعة» إلى الاصطلاح
إذا كانت كلمة «شيعة» قد انتقلت فعلاً بنفسها للدلالة على من تعنيهم دون حاجة إلى اسم آخر يكمل معناها فهذه نتيجة حاضرة لا يحتاج الوصول إلى مقدّمتها الّا إلى تتبّع تاريخي يصل إلى أقدم نص تتحقق فيه الأبانة عن هذا الاستقلال. وهذا يعني أن المنطق يقضي بقيام سلسلة من التداول التاريخي لكلمة «شيعة» في البيئات الشيعية القديمة التي سبقت هذا الحدث. ولكي نكون على بيّنة من هذا الأمر يحسن أن نعود إلى أوّل جماعة عمّها لفظ «الشيعة» في رأي حملة هذا المذهب، لنرى أي طريق سلك. في هذ المجال ذكر أبو حاتم الرازي (أحمد بن حمدان، ت322هـ/934م) في كتابه المخطوط «الزينة» أن «الشيعة لقب قوم كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – صلوات الله عليه – في حياة رسول الله (ص) وعرفوا به، مثل: سلمان الفارسي وابي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وغيرهم وكانوا يقال لهم: شيعة علي، وأصحاب علي…»([91]) ثم ذكر في موضوع قريب من هذا انه «كان الذين سمّوا: شيعة علي، لأنّهم الفرقة الذين بايعته وعاونته وكانت معه…» ([92]). وذكر أبو نعيم الأصفهاني (احمد بن عبد الله، ت430هـ/1039م) حديثاً رفعه إلى سلمة بن كهيل (121هـ/739م) عن مجاهد (بن جبر المكي، ت نحو10 هـ/ 632م) نصه: «شيعة عليّ الحلماء، العلماء، الذبل الشفاه، الأخيار الذين يعرفون بالرهبانية من اثر العبادة»([93]).
وأخرج ابن عساكر (جار الله ابوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، ت 571هـ/1175- 1176م) قول النبي (ص): «والذي نفسي بيده، إنّ هذا (يعني علياً) وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»([94]) وروى ابن الاثير محاورة بين علي بن أبي طالب ومولاه قنبر «قتله الحجاج سنة 28هـ/701-702م) مؤدّاها أن «علياً نظر إلى قوم ببابه، فقال لقنبر مولاه: من هؤلاء؟: شيعتك يا أمير المؤمنين. قال: وما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ فقال: وما سيماهم؟ قال: خُمص البطون من الطَّوى، يُبس الشفاه من الظمأ، عمش العيون من البكاء!»([95]).
ومهما قيل في هذه النصوص فإن شيئاً جوهرياً مشتركاً يجمعهما لخدمة غرض لنا هو أن كلمة «شيعة» في استعمالاتها المبكرة، في مجالي ذكر المناقب وتحديد صفة الطائفة، لم تخرج عن الطابع اللغوي البحث شأن استعمالاتها العامة الأخرى في المجالات المختلفة التي مرّت بنا فيما مضى.
وإذا كان الأمر على هذه الصورة، فمتى استقل الاصطلاح من ناحيته الفنية المذهبية على العموم؟ لقد كان من حظّنا الوصول إلى اجتهاد في هذا الشأن، قلنا فيه: «على أننا نرى أن التشيّع السياسي، وإن كان ظهر في الفترة التي افترضها الباحثون السابقون، إلا أن دلالة الاصطلاح «شيعة» على الكتلة التي ندرسها من المسلمين وانصرافه إليهم دون غيرهم قد بدأ بحركة التوّابين التي ظهرت سنة (61هـ/681م) وانتهت بالفشل سنة (65هـ/684 – 685م) وكان قائد الحركة يلقب بشيخ الشيعة دون أن تحدّد الجهة التي تضاف إليها هذه الجماعة؛ فلم يقل «شيعة علي» ولا «شيعة الحسين» وإنما استقل هذا اللفظ لوضوح مدلوله، ورسوخه في الميدان السياسي»([96]). وقد ساعدنا على إصدار هذا الحكم نصّ في الجزء الخامس من كتاب أنساب الأشراف للبلاذري (أبي جعفر أحمد يحيى البغدادي، ت 279هـ/892م) (ط. القدس 1936م، ص 206) وأفصحنا عن المقصود بشيخ الشيعة هنا في كتابنا: «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية في مطلع القرن الثاني عشر الهجري» (بغداد 1966م، ص16) فقلنا هناك «وسمّي قائدهم سليمان بن صرد الخزاعي بشيخ الشيعة، واستمر هذا الاصطلاح دالا على هذا المعنى إلى النهاية». وقد أخذ بهذا الرأي أيضاً الدكتور علي سامي النشار فضمّنه الجزء الثاني من كتابه الواسع «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» في سنة 1964م (انظر ط 3، دار المعارف 1966م، 521) نقلا عن مروج الذهب للمسعودي (أبي الحسن علي بن الحسين الشافعي ت 345هـ/955م، مصر 1346هـ/1927م، 2/110) وكذا أخذت به بعد ذلك الآنسة نبيلة عبد المنعم في كتابها: «نشأة الشيعة الاثنا عشرية»، وكان رسالة ماجستير. وصدر في بغداد سنة 1970م كتاب للدكتور عبد الله الفياض من كلية الآداب جامعة بغداد باسم «تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» فأخذ بهذا الرأي أيضاً، بعد استعراض واسع للآراء والنصوص، نقلا عن الطبري (ط. القاهرة 1357هـ، 4/426) وكذا عن أنساب الأشراف الذي أشرنا إليه. وهكذا يبدوأن هذه الفكرة تجد لها مستقرا بين الباحثين في هذا الموضوع؛ ولهذا يحسن أن نردد نص البلاذري باعتباره اقدم من تعرّض لهذه الواقعة من المؤرخين:
قال البلاذري في أخبار التوّابين الذين أرّقهم قتل الحسين سنة 61هـ/680م دون أن ينصروه:
«ولما دخل عبيد الله بن زياد من معسكره بالنخيلة إلى الكوفة، تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندّم؛ ففزعوا إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة وهم: سليمان بن صرد الخزاعي – وكانت له صحبة – والمسيب بن نجبة الفزاري – وكان من خيار أصحاب عليّ – وعبد الله بن نفيل الأزدي، وعبد الله بن وال التميمي، ورفاعه بن شدّاد البجلي ثم الفتياني. فاجتمع هؤلاء النفر في منزل سليمان بن صرد ومعهم ناس من وجوه الشيعة»([97]) وبعد مناقشات ومداولات، قام رفاعة بن شدّاد فقال مخاطبا المسيّب ابن نجبة والحاضرين فقال: «وإن رأيت، ورأى أصحابنا، وليّنا هذا الأمر شيخ الشيعة وصاحب رسول الله (ص)… سليمان بن صرد…»([98]). ولما قدم المختار إلى الكوفة في سنة 65هـ/686م، كان «إذا دعا الشيعة إلى نفسه وإلى الطلب بدم الحسين قالوا: هذا سليمان بن صرد شيخ الشيعة. وقد أطاعته الشيعة وانقادت له وولّته أمرها» وهكذا تكررت كلمة «شيعة» ست مرات في هذا الحيّز الضيق دون أن تضاف مرة واحدة إلى علم يحدد جهة التشيع ومناط الولاء، وفي هذا دليل واضح على استقرار الدلالة وشهرة الكلمة، وانصرافها إلى حاق معناها مباشرة. وليست هذه الظاهرة غريبة في التاريخ، ولا بد أنّ عليها أمثلة كثيرة ضمن نطاق الإسلام وخارجه.
فقبل ذلك سميت يثرب بمدينة الرسول، ثم استقلت بدلالتها وحدها وعرفت بالمدينة. وكذلك كانت الحال مع القاهرة التي عرفت في البدء بالقاهرة المعزّية.
د. كامل مصطفى الشيبي
التشيع
جرى بعض الباحثين المحدثين على دراسة التشيع بوصفه ظاهرة طارئة في المجتمع الإسلامي. والنظر إلى القطاع الشيعي في جسم الأمة الإسلامية بوصفه قطاعاً تكوَّن على مر الزمن نتيجة لأحداث وتطورات اجتماعية معينةً أدَّت إلى تكوين فكري ومذهبي خاص بجزء من ذلك الجسم الكبير٬ ثم اتسع الجزء بالتدريج.
وهؤلاء الباحثون بعد أن يفترضوا ذلك يختلفون في تلك الأحداث والتطورات التي أدت إلى نشوء تلك الظاهرة وولادة ذلك الجزء.
فمنهم من يفترض أن عبد الله بن سبأ ونشاطه السياسي المزعوم هو الأساس لذلك التكتل الشيعي.
ومنهم من يرد ظاهرة التشيع إلى عهد خلافة الإمام علي (ع)، وما هيأه ذلك العهد من مقام سياسي واجتماعي على مسرح الأحداث.
ومنهم من يزعم أن ظهور الشيعة يكمن في أحداث متأخرة عن ذلك في التسلسل التاريخي للمجتمع الإسلامي.
والذي دعا فيما أظن كثيراً من هؤلاء الباحثين إلى هذا الافتراض والاعتقاد: بأن التشيع ظاهرة طارئة في المجتمع الإسلامي٬ هو أن الشيعة لم يكونوا يمثلون في صدر الإسلام إلاَّ جزءاً ضئيلاً من مجموع الأمة الإسلامية. فقد أوحت هذه الحقيقة شعوراً بأن اللاتشيع كان هو القاعدة في المجتمع الإسلامي، وأن التشيع هو الاستثناء والظاهرة الطارئة التي يجب اكتشاف أسبابها من خلال تطورات المعارضة للوضع السائد.
ولكن اتخاذ الكثرة العديدة والضآلة النسبية أساساً لتمييز القاعدة والاستثناء أو الأصل والانشقاق ليس شيئاً منطقياً، فمن الخطأ إعطاء الإسلام اللاشيعي صفة من الأصالة على أساس الكثرة العددية، وإعطاء الإسلام الشيعي صفة الظاهرة الطارئة ومفهوم الانشقاق، فإن هذا لا يتفق مع طبيعة الانقسامات العقائدية.
إننا كثيراً ما نلاحظ انقساماً عقائدياً في إطار رسالة واحدة تقوم على أساس بعض الاختلاف في تحديد معالم تلك الرسالة، وقد لا يكون القسمان العقائديان متكافئين من الناحية العددية.
ولكنهما متكافئان في أصالتهما، ومعبران بدرجة واحدة عن الرسالة المختلف بشأنها. ولا يجوز بحال من الأحوال أن نبني تصوراتنا عن الأنقسام العقائدي داخل إطار الرسالة الإسلامية إلى شيعة وغيرهم على الناحية العددية.
كما لا يجوز أيضاً أن نقرن ولادة الأطروحة الشيعية في إطار الرسالة الإسلامية بولادة كلمة «الشيعة» أو«التشيّع) كمصطلح واسم خاص لفرقة محددة من المسلمين، لأن ولادة الأسماء والمصطلحات شيء ونشوء المحتوى أوالأطروحة شيء آخر. فإذا كنا لا نجد كلمة «الشيعة» في اللغة السائدة في حياة الرسول (ص) أو بعد وفاته، فلا يعني هذا أن الأطروحة والاتجاه الشيعي لم يكونا موجودين. فبهذه الروح يجب أن نعالج قضية التشيع والشيعة.
كيف ولد التشيع؟
أما فيما يتعلق بالسؤال الأول «كيف ولد التشيع؟» فنحن نستطيع أن نعتبر التشيع نتيجة طبيعية للإسلام، وممثلاً لأطروحة كان من المفروض للدعوة الإسلامية أن تتوصل إليها حفاظاً على نموها السليم.
ويمكننا أن نستنتج هذه الأطروحة استنتاجاً منطقياً من الدعوة التي كان الرسول الأعظم (ص) يتزعم قيادتها بحكم طبيعة تكوينها والظروف التي عاشتها، فإن النبي كان يباشر قيادة دعوة انقلابية، ويمارس عملية تغيير شاملة للمجتمع وأعرافه وأنظمته ومفاهيمه. ولم يكن الطريق قصيراً أمام عملية التغيير هذه، بل كان طريقاً طويلاً وممتداً بامتداد الفواصل المعنوية الضخمة بين الجاهلية والإسلام، فكان على الدعوة التي يمارسها النبي أن تبدأ بإنسان الجاهلية فتنشؤه إنشاءاً جديداً، وتجعل منه الإنسان الإسلامي الذي يحمل النور الجديد وتجتث منه كل جذور الجاهلية ورواسبها.
وقد خطأ القائد الأعظم (ص) بعملية التغيير خطوات مدهشة في برهة قصيرة، وكان على عملية التغيير أن تواصل طريقها الطويل حتى بعد وفاة النبي (ص) الذي أدرك منذ فترة قبل وفاته أن أجله قد دنا، وأعلن ذلك بوضوح في حجة الوداع ولم يفاجئه الموت مفاجأة.
وهذا يعني أنه كان يملك فرصة كافية للتفكير في مستقبل الدعوة بعده، حتى إذا لم نُدخل في الموقف عامل الاتصال الغيبي والرعاية الإلهية للرسالة عن طريق الوحي. وفي هذا الضوء يمكننا أن نلاحظ أن النبي (ص) كان أمامه ثلاثة طرق بالإمكان انتهاجها تجاه مستقبل الدعوة:
الطريق الأول:
أن يقف من مستقبل الدعوة موقفا سلبياً، ويكتفي بممارسة دوره في قيادة الدعوة وتوجيهها فترة حياته ويتركها في مستقبلها للظروف والصدف.
وهذه السلبية لا يمكن افتراضها في النبي (ص)، لأنها إنما تنشأ من أحد أمرين كلاهما لا ينطبقان عليه:
– الأمر الأول: الاعتقاد بأن هذه السلبية والإهمال لا يؤثران على مستقبل الدعوة.
وهذا الاعتقاد لا مبرر له من الواقع اطلاقاً، بل إن طبيعة الأشياء كانت تدل على خلافه، لأن الدعوة بحكم كونها عملاً تغييرياً انقلابياً في بدايته، يستهدف بناء أمة واستئصال كل الجذور الجاهلية منها، تتعرض لأكبر الأخطار إذا خلت الساحة من قائدها وتركها دون تخطيط، فهنالك الأخطار التي تنبع عن طبيعة مواجهة الفراغ دون أي تخطيط سابق، وعن الضرورة الآنية لاتخاذ موقف مرتجل في ظل الصدمة العظيمة بفقد النبي (ص). فإن الرسول إذا ترك الساحة دون تخطيط لمصير الدعوة فسوف تواجه الأمة – ولأول مرة – مسؤولية بدون قائدها تجاه أخطر مشاكل الدعوة، وهي لا تملك أي مفهوم مسبق بهذا الصدد، وسوف يتطلب منها الموقف تصرفاً سريعاً آنياً، بالرغم من خطورة المشكلة لأن الفراغ لا يمكن أن يستمر، وسوف يكون هذا التصرف السريع في لحظة الصدمة التي تمنى بها الأمة، وهي تشعر بفقدها لقائدها الكبير. هذه الصدمة التي تزعزع بطبيعتها سير التفكير وتبعث على الاضطراب، حتى أنها جعلت صحابياً معروفاً – يعلن الصدمة – أن النبي (ص) لم يمت ولن يموت.
وهناك الأخطار التي تنجم عن التناقضات الكامنة التي كانت ولا تزال تعيش في زوايا نفوس المسلمين على أساس الانقسام إلى مهاجرين وأنصار، أو قريش وسائر العرب، أو مكة والمدينة.
وهناك الأخطار التي تنشأ نتيجة لوجود القطاع المستتر بالإسلام والذي كان يكيد له في حياة النبي (ص) باستمرار، وهوالقطاع الذي كان يسمّيه القرآن ﺑ «المنافقين».
وإذا أضفنا إليهم عدداً كبيراً ممن أسلم بعد الفتح استسلاماً للأمر الواقع، لا انفتاحاً على الحقيقة، نستطيع أن نقدر الخطر الذي يمكن لهذه العناصر أن تولده، وهي تجد فجأة فرصة لنشاط واسع في فراغ كبير، مع خلو الساحة من رعاية القائد.
فلم تكن إذن خطورة الموقف بعد وفاة النبي (ص) شيئاً يمكن أن يخفى على اي قائد مارس العمل العقائدي، فضلاً عن خاتم الأنبياء.
وإذا كان أبو بكر لم يشأ أن يترك الساحة دون أن يتدخل تدخلاً إيجابياً في ضمان مستقبل الحكم بحجة الاحتياط للأمر..
وإذا كان الناس قد هرعوا إلى عمر حين ضرب قائلين «يا أمير المؤمنين لوعهدت عهداً»([99]) خوفاً من الفراغ الذي يخلفه الخليفة، بالرغم من التركز السياسي والاجتماعي الذي كانت الدعوة قد بلغته بعد عقد من وفاة الرسول (ص)..
وإذا كان عمر قد أوصى إلى ستة تجاوباً مع شعور الآخرين بالخطر.
وإذا كان عمر يدرك بعمق خطورة الموقف في يوم السقيفة، وما كان بالإمكان أن تؤدي إليه خلافة أبي بكر بشكلها المرتجل من مضاعفات إذ يقول «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة غير أن الله وقى شرها»([100])…
وإذا كان أبو بكر نفسه يعتذر عن تسرعه إلى قبول الحكم وتحمل المسؤولية الكبيرة بأنه شعر بخطورة الموقف وضرورة الإقدام السريع على حلها، إذ يقول – وقد عوتب على قبول السلطة – «وإن رسول الله قبض والناس حديثوعهد بالجاهلية فخشيت أن يفتتنوا وأن أصحابي حملونيها»([101]).
إذا كان كل ذلك صحيحاً، فمن البديهي أيضاً أن يكون رائد الدعوة ونبيها أكثر شعورا بخطر السلبية، وأكبر إدراكاً وأعمق فهما لطبيعة الموقف ومتطلبات العمل التغييري الذي يمارسه في أمة حديثة عهد بالجاهلية على حد تعبير أبي بكر.
– الأمر الثاني: الذي يمكن أن يفسر سلبية القائد تجاه مستقبل الدعوة ومصيرها بعد وفاته: أنه بالرغم من شعوره بخطر هذه السلبية لا يحاول تحصين الدعوة ضد ذلك الخطر لأنه ينظر إلى الدعوة نظرة مصلحية، فلا يهمه إلا أن يحافظ عليها ما دام حيا ليستفيد منها ويستمتع بمكاسبها، ولا يعنى بحماية مستقبلها بعد وفاته.
وهذا التفسير لا يمكن أن يصدق على النبي (ص)، حتى إذا لم نلاحظ بوصفه نبياً ومرتبطاً بالله سبحانه وتعالى في كل ما يرتبط بالرسالة، وافترضناه قائداً رسالياً كقادة الرسالات الأخرى. لأن تاريخ القادة الرساليين لا يملك نظيراً للقائد الرسول في إخلاصه لدعوته وتفانيه فيها وتضحيته من اجلها إلى آخر لحظة من حياته، وكل تاريخه يبرهن على ذلك. وقد كان (ص) على فراش الموت وقد ثقل مرضه وهو يحمل هم معركة كان قد خطط لها وجهز جيش أُسامة لخوضها، فكان يقول «جهزوا جيش أسامة، انفروا جيش أسامة، أرسلوا بعث أسامة» ويكرر ذلك ويغمى عليه بين الحين والحين([102]).
فإن اهتمام الرسول (ص) بقضية من قضايا الدعوة العسكرية يبلغ إلى هذه الدرجة وهو يجود بنفسه على فراش الموت ولايمنعه علمه بأنه سيموت قبل أن يقطف ثمار تلك المعركة عن تنبيه لها، وأن يكون همه الشاغل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.. فكيف يمكن أن نتصور أن النبي (ص) لا يعيش هموم مستقبل الدعوة، ولا يخطط لسلامتها بعد وفاته من الأخطار المترقبة.
وأخيراً، فإن سلوك الرسول في مرضه الأخير رقماً واحداً يكفي لنفي الطريق الأول وللتدليل على أن القائد الأعظم كان أبعد ما يكون عن فرضية الموقف السلبي تجاه مستقبل الدعوة وعدم الشعور بالخطر أوعدم الاهتمام بشأنه. وهذا الرقم أجمعت صحاح المسلمين جميعاً سنَّةً وشيعة على نقله، وهو أن الرسول لما حضرته الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: «ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابداً»([103]).
فإن هذه المحاولة من القائد الكريم المتفق على نقلها وصحتها، تدل بكل وضوح على أنه كان يفكر في أخطار المستقبل، ويدرك بعمق ضرورة التخطيط لتحصين الأمة من الانحراف، وحماية الدعوة من التميّع والانهيار، فليس من الممكن افتراض الموقف السلبي بحال من الأحوال.
الطريق الثاني:
أن يخطط الرسول القائد (ص) لمستقبل الدعوة بعد وفاته ويتخذ موقفاً إيجابياً، فيجعل القيمومة على الدعوة وقيادة التجربة للأمة الممثلة على اساس نظام الشورى في جيلها العقائدي الأول الذي يضم مجموع المهاجرين والأنصار، فهذا الجيل الممثل للأمة هو الذي سيكون قاعدة للحكم ومحور قيادة الدعوة في خط نموها.
وهنا يلاخظ أن طبيعة الأشياء والوضع العام الثابت عن الرسول (ص) والدعوة والدعاة يدحض هذه الفرضية، وينفي أن يكون النبي قد انتهج هذا الطريق، واتجه إلى ربط قيادة الدعوة بعده مباشرة بالأمة، ممثلة في جيلها الطليعي من المهاجرين والأنصار على أساس نظام الشورى.
وفيما يلي بعض النقاط التي توضح ذلك:
1 – لو كان النبي (ص) قد اتّخذ من مستقبل الدعوة بعده موقفاً إيجابياً يستهدف وضع نظام الشورى موضع التطبيق بعد وفاته مباشرة وإسناد زعامة الدعوة إلى القيادة التي تنبثق عن هذا النظام، لكان من أبده الأشياء التي يتطلبها هذا الموقف الإيجابي أن يقوم الرسول القائد (ص) بعملية توعية للأمة والدعاة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله وإعطائه طابعاً دينياً مقدساً، وإعداد المجتمع الإسلامي إعداداً فكرياً وروحياً لتقبل هذا النظام، وهومجتمع نشأ من مجموعة من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الإسلام وضعاً سياسياً على أساس الشورى، وإنما كانت تعيش في الغالب وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكم فيها القوة والثروة وعامل الوراثة إلى حد كبير.
ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النبي (ص) لم يمارس عملية التوعية في نظام الشورى وتفاصيله التشريعية أومفاهميه الفكرية، لأن هذه العملية لوكانت قد أنجزت لكان من الطبيعي أن تنعكس وتتجسد في الأحاديث المأثورة عن النبي (ص) أو في ذهنية الأمة، أوعلى أقل تقدير في ذهنية الجيل الطليعي منها الذي يضم المهاجرين والأنصار بوصفه هوالمكلف بتطبيق نظام الشورى، مع أننا لا نجد في الأحاديث المأثورة عن النبي (ص) أي صورة تشريعية محددة لنظام الشورى.
وأما ذهنية الأمة أو ذهنية الجيل الطليعي منها، فلا نجد فيها أي ملامح أوانعكاسات محددة لتوعية من ذاك القبيل.
وللتأكد من ذلك نلاحظ بهذا الصدد أن أبا بكر حينما اشتدَّت به العلة عهد إلى عمر بن الخطاب، فأمر عثمان أن يكتب عهده، فكتب:
«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله إلى المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم إني أحمد إليكم الله، أما بعد، فإني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا».
ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال: كيف أصبحت يا خليفة رسول الله؟ فقال: أصبحت مولياً وقد زدتموني على ما بي، ورأيتموني استعملت رجلاً منكم. فكلكم قد اصبح ورماً أنفه، وكل قد أصبح يطلبها لنفسه([104]).
وواضح من هذا الاستخلاف وهذا الاستنكار للمعارضة أن الخليفة لم يكن يفكر بعقلية نظام الشورى وأنه كان يرى من حقه تعيين الخليفة، وأن هذا التعيين يفرض على المسلمين الطاعة، ولهذا أمرهم بالسمع والطاعة، فليس هو مجرد ترشيح أو تنبيه، بل هو إلزام ونصب.
ونلاحظ أيضاً أن عمر رأى هوالآخر أن من حقه فرض الخليفة على المسلمين، ففرضه في نطاق ستة أشخاص، وأوكل أمر التعيين إلى الستة أنفسهم دون أن يجعل لسائر المسلمين أي دور حقيقي في الانتخاب([105]).
إن عقلية نظام الشورى لم تتمثل في طريقة الاستخلاف التي انتهجها عمر، كما لم تتمثل في الطريقة التي سلكها الخليفة الأول، وقد قال عمر حين طلب منه الناس الاستخلاف: «لوأدركني أحد رجلين لجعلت هذا الأمر إليه سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة الجراح، ولوكان سالم حيا ما جعلتها شورى»([106]).
وقال أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف وهو يناجيه على فراش الموت «وددت أني كنت سألت رسول الله (ص) لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد»([107]).
وحينما تجمع أنصار السقيفة لتأمير سعد بن عبادة قال منهم قائل: إن أبت مهاجرة قريش؟ فقالوا: نحن المهاجرون ونحن عشيرته وأولياؤه. قالت طائفة منهم: إذا نقول منّا أمير ومنكم أمير لن نرضى بدون هذا أبداً.
وحينما خطب أبوبكر فيهم قال: «كنا معاشر المسلمين والمهاجرين أول الناس إسلاماً، والناس في ذلك تبّع، ونحن عشيرة رسول الله وأوسط العرب أنساباً».
وحينما اقترح الأنصار أن تكون الخلافة دورية بين المهاجرين والأنصار، ردّ أبو بكر قائلاً: إن رسول الله (ص) لما بعث، عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم، فخالفوه وشاقوه، وخصّ الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه، فهم أول من عبد الله في الأرض، وهم أولياؤه وعترته وأحقّ الناس بالأمر بعده، ولا ينازعهم فيه إلا ظالم.
وقال الحباب بن المنذر وهو يشجع الأنصار على التمسك: أملكوا عليكم أيديكم، إنما الناس في فيئكم وظلكم، فإن أبى هؤلاء فمنَّا أمير ومنهم أمير.
فردَّ عليه عمر قائلاً: هيهات لا يجتمع سيفان في غمد، من ذا يخاصمنا في سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشريته ألا مدلٍ بباطل أو متجانف لأثم أومتورط في هلكة([108]).
إن الطريقة التي مارسها الخليفة الأول والخليفة الثاني للاستخلاف وعدم استنكار تلك الطريقة، والروح العامة التي سادت على الجناحين المتنافسين من الجيل الطليعي: المهاجرين والأنصار يوم السقيفة، والاتجاه الواضح الذي بدل لدى المهاجرين نحو تقرير مبدأ انحصار السلطة بهم وعدم مشاركة الأنصار في الحكم، والتأكيد على المبررات الوراثية التي تجعل من عشيرة النبي (ص) أولى العرب بميراثه، واستعداد كثير من الأنصار لتقبل فكرة أميرين أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، وإعلان أبي بكر الذي فاز بالخلافة في ذلك اليوم عن أسفه لعدم السؤال من النبي عن صاحب الأمر بعده..
كل ذلك يوضح بدرجة لا تقبل الشك أن هذا الجيل الطليعي من الأمة الإسلامية – بما فيه القطاع الذي تسلّم الحكم بعد وفاة النبي – لم يكن يفكر بذهنيه الشورى، ولم يكن لديه فكرة محددة عن هذا النظام، فكيف يمكن أن نتصور أن النبي مارس عملية توعية على نظام الشورى تشريعياً وفكرياً، وأعدَّ جيل المهاجرين والأنصار لتسلم قيادة الدعوة بعده على أساس هذا النظام، ثم لا نجد لدى هذا الجيل تطبيقاً واقعياً لهذا النظام أو مفهوماً محدداً عنه؟!!
كما أننا لا يمكن أن نتصور من ناحية أخرى: أن الرسول القائد (ص) وضع هذا النظام وحده تشريعياً ومفهومياً، ثم لا يقوم بتوعية المسلمين عليه وتثقيفهم به..
2 – إن النبي (ص) لوكان قد قرَّر أن يجعل من الجيل الإسلامي الرائد الذي ضمَّ المهاجرين والأنصار من صحابته قيماً على الدعوة بعده ومسؤولاً عن مواصلة عملية التغيير لحتم على الرسول القائد (ص) أن يعبئ هذا الجيل تعبئة رسالية واسعة يستطيع أن يمسك بالنظرية بعمق، ويمارس التطبيق على ضوئها بوعي، ويضع للمشاكل التي تواجهها الدعوة باستمرار الحلول النابعة من الرسالة، خصوصا إذا لاحظنا أن النبي (ص) كان – وهوالذي بشر بسقوط كسرى وقيصر – يعلم بأن الدعوة مقبلة على فتوح عظيمة، وأن الأمة الإسلامية سوف تنضم إليها في غد قريب شعوب جديدة ومساحة كبيرة، وتواجه مسؤولية توعية تلك الشعوب على الإسلام، وتحصين الأمة من خطر هذا الانفتاح، وتطبيق أحكام الشريعة على الأرض المفتوحة وأهل الأرض.
وبالرغم من أن الجيل الرائد من المسلمين كان أنظف الأجيال التي توارثت الدعوة وأكثرها استعداداً للتضحية، لا نجد فيه ملامح ذلك الاعداد الخاص للقيمومة على الدعوة، والتثقيف الواسع العميق على مفاهيمها، والأرقام التي تبرر هذا النفي كثيرة لا يمكن استيعابها في هذا المجال.
ويمكننا أن نلاحظ بهذا الصدد: أن مجموع ما نقله الصحابة من نصوص عن النبي (ص) في مجال التشريع لا يتجاوز بضع مئات من الأحاديث، بينما كان عدد الصحابة يناهز اثني عشر ألفاً على ما أحصته كتب التاريخ. وكان النبي (ص) يعيش مع الآلاف من هؤلاء في بلد واحد وفي مسجد واحد صباحاً ومساءاً، فهل يمكن أن نجد في هذه الأرقام ملامح الإعداد الخاص؟
والمعروف عن الصحابة أنهم كانوا يتحاشون من ابتداء النبي (ص) بالسؤال: حتى إن أحدهم كان ينتظر فرصة مجيء أعرابي من خارج المدينة يسأل ليسمع الجواب، وكانوا يرون أن من الترفع السؤال عن حكم قضايا لم تقع بعد.
ومن أجل ذلك قال عمر على المنبر: «أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن النبي قد بيَّن ما هو كائن»([109]).
وقال: «لا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن، إن الله قد قضى فيما هو كائن».
وجاء رجل يوما إلى ابن عمر يسأله عن شيء، فقال له ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن، فإن سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عمّا لم يكن([110]).
وسأل رجل أبي بن كعب عن مسألة، قال أبي: يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ قال: لا.. قال: أما لا فأجلني حتى يكون([111]).
وقرأ عمر يوما القرآن فانتهى إلى قوله تعالى: ﴿فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا * وفاكهة وأبا﴾. فقال: كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم قال: هذا لعمر الله هوالتكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه.
وهكذا نلاحظ اتجاهاً لدى الصحابة إلى العزوف عن السؤال إلاّ في حدود المشاكل المحددة الواقعة، وهذا الاتجاه هو الذي أدّى إلى ضآلة النصوص التشريعية التي نقلوها عن الرسول (ص)، وهوالذي أدَّى بعد ذلك إلى الاحتياج إلى مصادر أخرى غير الكتاب والسنَّة، كالاستحسان والقياس وغيرهما من ألوان الاجتهاد التي تمثل فيها العنصر الذاتي للمجتهد، الأمر الذي أدَّى إلى تسرب شخصية الإنسان بذوقه وتصوراته الخاصة إلى التشريع.
وهذا الاتجاه أبعد ما يكون عن عملية الإعداد الرسالي الخاص التي كانت تتطلب تثقيفا واسعا لذلك الجيل وتوعية له على حدود الشريعة للمشاكل التي سوف يواجهها عبر قيادته.
وقد أثبتت الأحداث بعد وفاة النبي (ص) أن جيل المهاجرين والأنصار لم يكن يملك أي تعليمات محددة عن كثير من المشاكل الكبيرة التي كان من المفروض أن تواجهها الدعوة بعد النبي (ص) حتى إن مساحة هائلة من الأرض التي امتدَّ إليها الفتح الإسلامي لم يكن لدى الخليفة والوسط الذي يسنده أي تصور محدد عن حكمها الشرعي، وعمّا إذا كانت تقسم بين المقاتلين أم تجعل وقفا على المسلمين عموماً. فهل يمكننا أن نتصور أن النبي (ص) يؤكد للمسلمين أنهم سوف يفتحون أرض كسرى وقيصر ويجعل من جيل المهاجرين والأنصار القيم على الدعوة والمسؤول عن هذا الفتح ثم لا يخبره بالحكم الشرعي الذي يجب أن يطبق على تلك المساحة الهائلة من الدنيا التي سوف يمتد إليها الإسلام؟!
بل إننا نلاحظ أكثر من ذلك: أن الجيل المعاصر للرسول (ص) لم يكن يملك تصورات واضحة محددة حتى في مجال القضايا الدينية التي كان النبي يمارسها مئات المرات وعلى مرأى ومسمع من الصحابة.
ونذكر على سبيل المثال لذلك الصلاة على الميت، فإنها عبادة كان النبي (ص) قد مارسها علانية مئات المرّات. وأدّاها في مشهد عام في المشيعين والمصلين، وبالرغم من ذلك يبدو أن الصحابة كانوا لا يجدون ضرورة لضبط صورة هذا العبادة ما دام النبي يؤديها وما داموا يتابعون فيها النبي فصلا بعد فصل، ولهذا وقع الاختلاف بينهم بعد وفاة النبي في عدد التكبيرات في صلاة الميت. فقد أخرج الطحاوي عن إبراهيم قال: قبض رسول الله والناس مختلفون في التكبير على الجنازة لا تشاء أن تسمع رجلاً يقول سمعت رسول الله يكبر سبعاً، وآخر سمعت رسول الله يكبّر خمساً، وآخر يقول سمعت رسول الله يكبّر أربعاً، فما اختلفوا في ذلك حتى قبض أبوبكر، فلما ولي عمر رأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا، فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله (ص) فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا ما تجتمعون عليه، فكأنما أيقظهم. فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين([112]).
وهكذ نجد أن الصحابة كانوا في حياة النبي (ص) يتكلون غالباً على شخص النبي، ولا يشعرون بضرورة الاستيعاب المباشر للأحكام والمفاهيم ما داموا في كنف النبي (ص).
وكل ما تقدم يدلّ على أن التوعية التي مارسها النبي على المستوى العام في المهاجرين والأنصار لم تكن بالدرجة التي يتطلبها إعداد القيادة الواعية الفكرية والسياسية لمستقبل الدعوة وعملية التغيير، وإنما كانت توعية بالدرجة التي تبني القاعدة الشعبية الواعية التي تلتف حول قيادة الدعوة في الحاضر والمستقبل وأي افتراض يتجه إلى القول بأن النبي (ص) كان يخطط لإسناد قيادة التجربة والقيمومة على الدعوة بعده مباشرة إلى جيل المهاجرين والأنصار، يحتوي ضمنا اتهام – أكبر وأبصر قائد رسالي في تاريخ العمليات التغيرية – بعدم القدرة على التمييز بين الوعي المطلوب على مستوى القاعدة الشعبية للدعوة والوعي المطلوب على مستوى قيادة الدعوة وإمامتها الفكرية والسياسية.
3 – إن الدعوة عملية تغيير ومنهج حياة جديدة، وهي تكلف بناء أمة من جديد، واقتلاع كل جذور الجاهلية ورواسبها من وجودها.
والأمة الإسلامية – ككل – لم تكن قد عاشت في ظل عملية التغيير هذه إلا عقداً واحداً من الزمن على أكثر من تقدير، وهذا الزمن لا يكفي عادة في منطق الرسالات العقائدية والدعوات التغييرية لارتفاع الجيل الذي عاش في كنف الدعوة عشر سنوات فقط إلى درجة من الوعي والموضوعية والتحرر من رواسب الماضي والاستيعاب لمعطيات الدعوة الجديدة، تؤهله للقيمومة على الرسالة وتحمل مسؤوليات الدعوة ومواصلة عملية التغيير بدون قائد.
بل إن منطق الرسالات العقائدية يفرض أن تمر الأمة بوصاية عقائدية فترة أطول في الزمن، تهيؤها للارتفاع إلى مستوى تلك القيمومة وليس شيئاً نستنتجه استنتاجاً فحسب، وإنما يعبر أيضاً عن الحقيقة التي برهنت عليها الأحداث بعد وفاة القائد الرسول (ص) وتجلَّت بعد نصف قرن أو اقلَّ من خلال ممارسة جيل المهاجرين والانصار لإمامة الدعوة والقيمومة عليها إذ لم يمض على هذه القيمومة ربع قرن حتى بدأت الخلافة الراشدة والتجربة الرسالية – التي تولى جيل المهاجرين والأنصار قيادتها – تنهار تحت وقع الضربات الشديدة التي وجهها اعداء الإسلام القدامى، ولكن من داخل إطار التجربة الإسلامية لا من خارجها، فاستطاعوا أن يتسللوا إلى مراكز النفوذ في التجربة بالتدريج، ويستغلوا القيادة غير الواعية، ثم صادروا – بكل وقاحة وعنف – تلك القيادة، واجبروا الأمة وجيلها الطليعي الرائد على التنازل عن شخصية قيادته، وتحولت الزعامة إلى ملك موروث يستهتر بالكرامات ويقتل الابرياء ويبعثر الأموال ويعطل الحدود ويجمد الأحكام ويتلاعب بمقدرات الناس، واصبح الفيء والسواد بستاناً لقريش، والخلافة كرة يتلاعب بها صبيان بني أمية.
فواقع التجربة بعد النبي (ص) وما تمخض عنه بعد ربع قرن من نتائج يدعم الاستنتاج المتقدم الذي يؤكد أن إسناد القيادة والامامة الفكرية والسياسية لجيل المهاجرين والأنصار عقيب وفاة النبي (ص) مباشرة إجراء مبكر وقبل وقته الطبيعي، ولهذا ليس من المعقول أن يكون النبي (ص) قد اتخذ إجراء من هذا القبيل.
الطريق الثالث:
وهوالطريق الوحيد الذي بقي منسجماً مع طبيعة الأشياء ومعقولاً على ضوء ظروف الدعوة والدعاة وسلوك النبي (ص) هو أن يقف النبي من مستقبل الدعوة بعد وفاته موقفاً ايجابياً، فيختار شخصاً يرشحه عمق وجوده في كيان الدعوة، فيعده إعداداً رسالياً وقيادياً خاصاً لتتمثل فيه المرجعية الفكرية والزعامة السياسية للتجربة وليواصل بعده – وبمساندة القاعدة الشعبية الواعية من المهاجرين والأنصار – قيادة الأمة وبنائها عقائدياً وتقويتها باستمرار نحو المستوى الذي يؤهلها لتحمل المسؤوليات القيادية.
وهكذا نجد بأن هذا هو الطريق الوحيد، الذي كان بالإمكان أن يضمن سلامة مستقبل الدعوة وصيانة التجربة من الانحراف في خط نموها، وهكذا كان.
وليس ما تواتر عن النبي (ص) من النصوص التي تدل على أنه كان يمارس إعداداً رسالياً وتثقيفياً عقائدياً خاصاً لبعض الدعاة على مستوى يهيئه للمرجعية الفكرية والسيايسة، وأنه (ص) قد عهد اليه بمستقبل الدعوة وزعامة الامة من بعده فكرياً وسياسياً، ليس هذا إلاَّ تعبيراً عن سلوك القائد الرسول الطريق الثالث الذي كانت تفرضه، وتدل عليه قبل ذلك طبيعة الاشياء كما عرفنا.
ولم يكن هذا الشخص الداعي المرشح للإعداد الرسالي القيادي والمنصوب لتسلم مستقبل الدعوة وتزعمها فكريا وسياسياً إلا علي أبي طالب (ع) الذي رشَّحه لذلك عمق وجوده في كيان الدعوة، وأنه المسلم الأول والمجاهد الأول في سبيلها عبر كفاحها المرير ضد كل أعدائها، وعمق وجوده في حياة القائد الرسول (ص) وأنه ربيبه الذي فتح عينيه في حجره ونشأ في كنفه وتهيأت له من فرص التفاعل معه والاندماج بخطه ما لم يتوفر لأي إنسان آخر.
والشواهد من حياة النبي (ص) والإمام (ع) على أن النبي كان يعد الإمام إعداداً رسالياً خاصاً كثيرة جداً، فقد كان النبي (ص) يخصه بكثير من مفاهيم الدعوة وحقائقها، ويبدؤه بالعطاء الفكري والتثقيف أذا استنفذ الإمام أسئلته ويختلي به الساعات الطوال في الليل والنهار، يفتح عينيه على مفاهيم الرسالة ومشاكل الطريق ومناهج العمل إلى آخر يوم من حياته الشريفة.
روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي إسحاق سألت القاسم بن العباس: كيف ورث علي رسول الله؟ قال: لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً.
وفي حلية الأولياء عن ابن عباس أنه قال: كنَّا نتحدث أن النبي (ص) عهد إلى عليّ سبعين عهداً لم يعهده إلى غيره.
وروى النسائي عن ابن عباس عن علي أنه يقول: كانت لي منزلة من رسول الله (ص) لم تكن لأحد من الخلائق، كنت أدخل على نبي الله كل ليلة، فإن كان يصلي سبَّح فدخلت، وإن لم يكن يصلي أذن لي فدخلت.
وروى أيضاً عن الإمام (ع) قوله: «كان لي مع النبي (ص) مدخلان: مدخل بالليل، ومدخل بالنهار».
وروى النسائي عن الإمام أيضاً انه كان يقول: «كنت إذا سألت رسول الله (ص) أعطيت، وإذا سكت ابتدأني». ورواه الحاكم في المستدرك أيضاً، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وروى النسائي عن ام سلمة أنها كانت تقول: والذي تحلف به أم سلمة أن أقرب الناس عهدا برسول الله (ص) علي. وقالت: لما كانت غداة قبض رسول الله (ص) فأرسل اليَّ رسول الله، وأظنّه كان بعثه في حاجة، فجعل يقول «جاء علي؟» ثلاث مرات، فجاء قبل طلوع الشمس، فلمَّا أن جاء عرفنا ان له إليه حاجة، فخرجنا من البيت، وكنَّا عند رسول الله (ص) يومئذٍ في بيت عائشة، وكنت في آخر من خرج من البيت، ثم جلست من وراء الباب، فكنت أدناهم إلى الباب، فأكبَّ عليه علي، فكان آخر الناس به عهداً، فجعل يسارّه ويناجيه.
وقال أمير المؤمنين في خطبته القاصعة الشهيرة وهو يصف ارتباطه الفريد بالرسول القائد وعناية النبي (ص) بإعداده وتربيته: وقد علمتم موضعي من رسول الله والقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره، ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، وقد كنت أتبعه اتباع الفصيل لأثر أُمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقة علماً ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاورني كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الاسلام غير رسول الله (ص) وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة».
إن هذه الشواهد وشواهد أخرى كثيرة تقدم لنا صورة عن ذلك الاعداد الرسالي الذي كان النبي (ص) يمارسه في سبيل توعية الامام على المستوى القيادي للدعوة، كما أن في حياة الامام علي (ع) بعد وفاة القائد الرسول أرقاماً كثيرة جداً تكشف عن ذلك الاعداد العقائدي الخاص للامام علي من قبل النبي، بما تعكسه من آثار ذلك الاعداد الخاص ونتائجه: فقد كان الامام هوالمفزع والمرجع لحل أي مشكلة يستعصي حلها على القيادة الحاكمة وقتئذٍ، ولا نعرف في تاريخ التجربة الإسلامية على عهد الخلفاء الاربعة، واقعة واحدة رجع فيها الامام إلى غيره لكي يتعرف على رأي الاسلام وطريقة علاجه للموقف، بينما في التاريخ عشرات الوقائع التي احسَّت القيادة الإسلامية الحاكمة فيها يضرورة الرجوع إلى الامام بالرغم من تحفظاتها في الموضوع.
وإذا كانت الشواهد كثيرة على ان النبي (ص) كان يعد الإمام إعداداً خاصاً لمواصلة قيادة الدعوة من بعده، فالشواهد على إعلان الرسول القائد على تخطيطه هذا واسناد زعامة الدعوة الفكرية والسياسية رسمياً إلى الامام علي (ع) لا تقل عنها كثرة، كما نلاحظ ذلك في حديث الثقلين وحديث المنزلة وحديث الغدير، وعشرات النصوص النبوية الأخرى.
وهكذا وجد التشيع في إطار الدعوة الإسلامية متمثلاً في الاطروحة النبوية التي وضعها النبي (ص) للحفاظ على مستقبل الدعوة.
وهكذا وجد التشيع لا كظاهرة طارئة على مسرح الاحداث، بل كنتيجة ضرورية لطبيعة تكوّن الدعوة وحاجاتها وظروفها الأصيلة التي كانت تفرض على الاسلام أن يلد التشيع. وبمعنى آخر كانت تفرض على القائد الاول للتجربة ان يعد للتجربة قائدها الثاني الذي تواصل على يده ويد خلفائه نموها الثوري، وتقترب نحو اكتمال هدفها التغييري في اجتثاث كل رواسب الماضي الجاهلي وجذوره، وبناء أمة جديرة على مستوى متطلبات الدعوة ومسؤولياتها.
وأودّ أن أشير قبل ختام الحديث إلى نقطة، وأعتبر توضيحها على درجة كبيرة من الأهمية، فإن بعض الباحثين يحاول التمييز بين نحوين من التشيّع: أحدهما التشيع الروحي، والآخر التشيع السياسي. ويعتقد أن التشيع الروحي أقدم عهداً من التشيع السياسي، وأن أئمة الشيعة الإمامية من أبناء الحسين (ع) قد اعتزلوا بعد مذبحة كربلاء السياسة وانصرفوا إلى الإرشاد والعبادة والانقطاع عن الدنيا.
والحقيقة أن التشيع لم يكن في يوم من الأيام منذ ولادته مجرد اتجاه روحي بحت، وإنما ولد التشيع في أحضان الإسلام بوصفه أطروحة مواصلة الإمام بعد النبي (ص) للقيادة الفكرية والقيادة السياسية للدعوة على السواء، كما أوضحنا سابقاً عند استعراض الظروف التي أدَّت إلى ولادة التشيّع.
ولم يكن بالإمكان – بحكم هذه الظروف التي استعرضناها – أن يفصل الجانب الروحي عن الجانب السياسي في أطروحة التشيع، تبعاً لعدم انفصال أحدهما عن الآخر في الإسلام نفسه.
فالتشيع إذن لا يمكن أن يتجزأ إلاّ إذا فقد معناه كأطروحة لحماية مستقبل الدعوة بعد النبي (ص) وهو مستقبل بحاجة إلى المرجعية الفكرية والزعامة السياسية للتجربة الإسلامية معاً.
وقد كان هناك ولاء واسع النطاق للإمام علي (ع) في صفوف المسلمين باعتباره الشخص الجدير بمواصلة دور الخلفاء الثلاثة في الحكم، وهذا الولاء هو الذي جاء به إلى السلطة عقيب قتل عثمان، وهذا الولاء ليس تشيعاً روحياً ولا سياسياً، وإنما التشيع الروحي والسياسي داخل إطاره، فلا يمكن أن نعتبره مثالاً على التشيع المجزأ.
كما أن الإمام (ع) كان يتمتع بولاء روحي وفكري من عدد من كبار الصحابة في عهد أبي بكر وعمر، من أمثال: سلمان وأبي ذر وعمار وغيرهم، ولكن هذا لا يعني أيضاً تشيعاً روحياً منفصلاً عن الجانب السياسي، بل إنه تعبير عن إيمان أولئك الصحابة بقيادة الإمام علي (ع) للدعوة بعد وفاة النبي (ص) فكرياً وسياسياً، وقد انعكس إيمانهم بالجانب الفكري من هذه القيادة بالولاء الروحي المتقدم.
ولم تنشأ في الواقع النظرة التجزيئية للتشيع الروحي بصورة منفصلة عن التشيع السياسي، ولم تولد في ذهن الإنسان الشيعي إلاَّ بعد أن استسلم للواقع، وانطفأت جذوة التشيع في نفسه كصفة محدودة لمواصلة القيادة الإسلامية في بناء الأمة وإنجاز عملية التغيير الكبيرة التي بدأها الرسول الكبير (ص) وتحولت إلى مجرد عقيدة يطوي الإنسان عليها قلبه أن يستمد منها سلوته وأمله.
وهنا نصل إلى ما يقال من أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من أبناء الحسين (ع) اعتزلوا السياسة وانقطعوا عن الدنيا، فنلاحظ أن التشيع بعد أن فهمناه كصيغة لمواصلة القيادة الإسلامية، والقيادة الإسلامية لا تعني إلاَّ ممارسة عملية التغيير التي بدأها الرسول الكريم (ص) لتكميل بناء الأمة على أساس الإسلام. فليس من الممكن أن نتصور تنازل الأئمة (عليهم السلام) عن الجانب السياسي إلاَّ إذا تنازلوا عن التشيع.
غير أن الذي ساعد على تصور اعتزال الأئمة (عليهم السلام) وتخليهم عن الجانب السياسي من قيادتهم، ما بدا من عدم إقدامهم على عمل مسلَّح ضد الوضع القائم من إعطاء الجانب السياسي من السياسة معنى ضيقاً لا ينطبق إلاَّ على عمل مسلَّح من هذا القبيل.
ولدينا نصوص عديدة عن الأئمة (عليهم السلام) توضح أن إمام الوقت دائماً كان مستعداً لخوض عمل مسلَّح إذا وجدت لديه القناعة بوجود الأنصار والقدرة على تحقيق الأهداف الإسلامية من وراء ذلك العمل المسلَّح.
ونحن إذا تتبعنا سير الحركة الشيعية نلاحظ أن القيادة الشيعية المتملثة في أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كانت تؤمن بأن تسلَّم السلطة وحده لا يكفي ولا يمكّن من تحقيق عملية التغيير إسلامياً، ما لم تكن هذه السلطة مدعّمة بقواعد شعبية واعية تعي أهداف تلك السلطة وتؤمن بنظريتها في الحكم، وتعمل في سبيل حمايتها وتفسير مواقفها للجماهير، وتصمد في وجه الأعاصير.
وفي نصف القرن الأول بعد وفاة النبي (ص) كانت القيادة الشيعية – بعد إقصائها عن الحكم – تحاول باستمرار استرجاع الحكم بالطرق التي تؤمن بها، لأنها كانت تؤمن بوجود قواعد شعبية واعية – أو في طريق التوعية – من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، ولكن بعد نصف قرن – وبعد أن لم يبق من هذه القواعد الشعبية الشيء المذكور ونشأت أجيال ماتعة في ظل الانحراف – لم يعد تسلُّم الحركة الشيعية للسلطة محققاً للهدف الكبير، لعدم وجود القواعد الشعبية المساندة بوعي وتضحية.
وأمام هذا الواقع كان لا بدَّ من عملين:
أحدهما: العمل من أجل بناء هذه القواعد الشعبية الواعية التي تهيىء أرضيَّة صالحة لتسلم السلطة.
والآخر: تحريك ضمير الأمة الإسلامية وإرادتها، والاحتفاظ بالضمير الإسلامي والإرادة الإسلامية بدرجة من الحياة والصلابة تحصن الأمة ضد التنازل المطلق عن شخصيتها وكرامتها للحكَّام المنحرفين.
والعمل الأول هو الذي مارسه الأئمة بأنفسهم، والعمل الثاني هو الذي مارسه ثائرون علويون كانوا يحاولون بتضحياتهم الباسلة أن يحافظوا على الضمير الإسلامي والإرادة الإسلامية، وكان الأئمة (ع) يسندون المخلصين منهم.
قال الإمام علي بن موسى الرضا (ع) للمأمون وهو يحدثه عن زيد بن علي الشهيد: «إنه كان من علماء آل محمد، غضب لله، فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله»([113]).
وفي رواية أنه ذكر بين يدي الإمام الصادق (ع) من خرج من آل محمد (ص) فقال: «لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجون من آل محمد. ولوددت أن الخارج من آل محمد خرج وعليَّ نفقة عياله»([114]).
إذن فترك الأئمة (ع) العمل المسلَّح بصورة مباشرة ضد المنحرفين لم يكن يعني تخليهم عن الجانب السياسي من قيادتهم وانصرافهم إلى العبادة، وإنما كان يعبر عن اختلاف صيغة العمل السياسي التي تحددها الظروف الموضوعية، وعن إدراك معمق لطبيعة العمل التغييري وأسلوب تحقيقه.
محمد باقر الصدر
الخطوط الكبرى في التشيع
أخرج الباحث المصري الدكتور حسين مؤنس كتاب الحلة السيراء لابن الأبار الأندلسي، وكتب للكتاب مقدمة تعريف بابن الأبار قال فيها عنه ليس بشيعي لأنه لم يترك السنّة، ولكنه طالبي، لأن الشيعي هو الذي يتبع مذهب الشيعة ويميل عن السنَّة.
هذا ما قاله الدكتور حسين مؤنس عن تشيع ابن الأبار. والحقيقة أن ابن الأبار شيعي صريح ككل الشيعة في كل زمان ومكان، ولكن الدكتور حسين مؤنس حين درس ابن الأبار درساً صحيحاً رأى أنه مسلم لا يستطيع أي محقق منصف أن يجد في عقيدته اعوجاجاً ولا في سلوكه انحرافاً، وقارن الدكتور بين هذه العقيدة الصافية ومعلوماته الخاطئة عن الشيعة، فرأى بينهما بوناً شاسعاً، فحار في أمره، ولم يجد إلاَّ هذا الحل الوسط فقال إنه طالبي لا شيعي.
يقول الدكتور مؤنس هذا القول لأنه يجهل حقيقة التشيع ويحسبه شيئاً آخر غير هذا الذي يقول به ابن الأبار، ولا يعلم الدكتور مؤنس أن التشيع ليس هو البعد عن السنَّة، بل هوالتمسك بها والأخذ بكل ما حوته، وأن من مضمون تلك السنَّة أن لا يساء إلى الذين أحبَّهم الرسول وربَّاهم وعلمهم، أن لا يُساء إليهم لا في حياتهم ولا بعد موتهم.
والدكتور مؤنس ليس وحده الذي يجهل حقيقة التشيع ويقلد في الحديث عنه ما كتبته في القديم الأقلام المأجورة للطغاة أو الأقلام التي أعماها التعصب فأضلها عن الحقيقة، بل إن جميع الكُتَّاب المصريين – إلاَّ قلَة قليلة – يجهلون التشيُّع جهلاً تاماً، فيكتبون عنه ما يحسبه القارئ تعصباً وتضليلاً، في حين أن أولئك الكتَّاب أبعد الناس عن التعصب والانغماس فيه، ولكنهم أخذوا في ما كتبوه عن المتعصبين أو الجهلاء أوعبيد الطغاة من أمثال ابن حزم([115]) وابن تيمية ومن سبقهما ومن تأخَّر عنهما.
وأمامنا غير الدكتور مؤنس الدكتور محمد علي مكي في ما كتبه في بحثه النفيس عن التشيع في الأندلس فقد قال مثلاً: «إن التشيع منذ نشأته اتَّخذ صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية» وقال أيضاً: «بين التشيع واليهودية صلة قديمة، وتأثر الشيعة منذ نشأتهم بتعاليم الديانة اليهودية» إلى آخر ما قاله من هذا الكلام المؤسف.
إننا نقول للدكتور مكي: إن التشيع ولد في العرب، ونشأ وتربى على أيديهم، فكانوا أهله وحرَّاسه وحماته ودعاته المعتزين به المضحين في سبيله. أما العصبية للعرب ولغير العرب فالتشيع يطبق فيها قول إمامه جعفر الصادق: «ليس من العصبية أن تحب أخاك، ولكن العصبية هي أن ترى شرار قومك خيراً من خيار غيرهم». فالتشيع حتماً لا يؤمن بالعنصرية الاعتدائية المتجبرة التي مارسها الأمويون، ويحترم حق الشعوب – كل الشعوب – في الحياة والكرامة والعدالة، وهوالذي يفهم القومية محبة وتسامحاً وتعاطفاً، لا كرهاً ومذابح وطغياناً واضطهاداً واحتقاراً كما فهمها المستبدون([116]).
فإذا كان الدكتور يقصد بالصبغة هذه الصبغة، فالتشيع يقرّها ويؤمن بها. وإن كان يقصد غير ذلك فالدكتور مخطئ.
إن التشيع لا يرضى حتماً بالمعاملة التي عامل بها الأمويون الشعوب التي حكموها سواء منها العربية وغير العربية. فالتشيع يستنكر مثلاً معاملة قائد الأمويين بسر بن أبي أرطاة للشعب العربي، وما أوقعه فيه بأمر معاوية من مذابح وفظائع في الحجاز واليمن وغيرهما، ويستنكر مذابح القائد الأموي الآخر مسلم بن عقبة في أهل المدينة وإباحتها لجنوده ثلاثة أيام بأمر يزيد([117]). يستنكر ذلك بنفس القوة التي يستنكر فيها معاملة يزيد بن المهلب – والي الأمويين – لأتراك دهستان وجرجان، ومعاملة قتيبة بن مسلم لنيزك وجماعته ولخام جرد وجماعته، ومعاملة الجرَّاح الحكمي لأتراك بلنجر، ومعاملة ابن أبي العمرطة للأتراك أيضاً.
إن التشيع يستنكر هذا كله وأمثاله مما اصيب به الأتراك والفرس والبربر والهنود وغيرهم، ولا يشفع له عنده أنه صدر من قادة عرب ضد شعوب غير عربية، ويرى أن هذا الظلم والاضطهاد هما اللذان أساءا إلى سمعة الإسلام وأضرَّا بالعرب.
إن التشيع يستنكر أن يجند عشرات الألوف من الموالي ويساقوا إلى ساحات القتال بلا عطاء ولا رزق، مما هو مسطور في كتب التاريخ كلها، كما يستنكر اتخاذ الفتوح وسيلة لنهب الشعوب وسلب أموالها وإبادة رجالها وسبي نسائها. إن التشيع يستنكر هذا كله ويراه مضاداً لرسالة الإسلام ولأخلاق العرب. يستنكر هذا سواء كان فاعلوه عرباً وضحاياه عرباً، أوكان فاعلوه عرباً وضحاياه غير عرب.
فإن كان هذا الاستنكار في رأي الدكتور مكي وغير الدكتور مكي هو: «صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية» فإن التشيع لا يتبرأ من هذه الصبغة أبداً.
إن بلالاً الحبشي الذي كان يعذبه أميَّة بن خلف لأنه آمن برسالة محمد، فيطرحه أمية في الرمضاء على ظهره، ويلقى فوقه الصخور، ولا يترك نوعاً من أنواع العذاب إلاَّ ويبهظه به ليكفر بمحمد (ص) وبلال يتحمل العذاب صابراً ويصرّ على الإيمان، إن هذا العبد الزنجي الحبشي هوالبطل الشريف في رأي التشيع، والزعيم العربي أمية بن خلف هو المجرم النذل. وسلمان الفارسي الذي تخلى عن أهله وبلده وثروته وجاهه لينضم إلى الدعوة المحمدية ويقاتل في سبيلها، والذي أشار على المسلمين بأن يحفروا الخندق ليتقوا به غزو أبي سفيان لهم وهجومه عليهم، إن سلمان الفارسي هذا هو الجدير بالاحترام بنظر التشيع لا أبو سفيان القرشي العبشمي الذي ظلَّ يقاتل محمداً ودعوته ما وسعه القتال، ولم يستسلم إلاَّ بعد أن أعياه الأمر ولم يبق له وسيلة للمقاومة والقتال. وإن أي بربري من أبناء المغرب الأحرار الذين رفضوا الظلم الذي أنزله بهم مثلا والي الأمويين يزيد بن أبي مسلم، والذين أبى لهم إيمانهم وكرامتهم أن يستذلوا لهذا الوالي ولغيره من الولاة الطغاة، والذين لم يجدوا إلاَّ السيف منقذاً لدينهم وشرفهم. إن أي بربري من هؤلاء الأحرار المؤمنين هو موضع الإعجاب والإكبار من التشيع، وإن ذاك الوالي الظالم الخارج على أبسط قواعد الإسلام في العدل، وعلى أبسط أخلاق العرب في المروءة، إن ذاك الوالي من الولاة هو موضع الاحتقار والزراية في نظر التشيع، وعروبته لا تغني عنه شيئاً.
وإننا لنرى أن في قول الدكتور مكي بأن بين التشيع واليهودية صلة قديمة. نرى فيه افتراء وغباء وجهلاً.. ما يسيء إلى علم الدكتور وحصافته([118]).
وهناك أيضاً الدكتور حسن إبراهيم حسن صاحب كتاب تاريخ الدولة الفاطمية الذي هو فضيحة الفضائح في جهل صاحبة فيما كتبه عن الشيعة ومذهبهم([119]).
وهؤلاء الدكاترة وأمثالهم من رجال العلم والبحث لا يحتاجون إلاَّ إلى وضع الحقائق أمامهم ليثوبوا إليها.
التشيع الفكري
لفهم المعاني القرآنية، كان لزاماً أن تبدأ اهتمامات الفكر الإسلامي الشيعي بما يسمونه العلوم النقلية، كاللغة والحديث والتاريخ والأنساب. ولهذا ركزت الدراسات الشيعية الأولى وما زالت تركز على وعي التراث العربي والتفقه العميق بعلوم النحو والصرف والبلاغة. والتمكن من معرفة تاريخ العرب ونظم الحياة القبلية والاجتماعية.
وكان الهدف من وراء ذلك، استخدام هذه المعرفة في البراهين والحجج. ثم انتقل الفكر الشيعي من مرحلة الآداب الإنسانية، إلى العلوم العقلية التي عززت دور التفكير في وعي العلوم الدينية.
ويعطي التراث الشيعي للعلماء دوراً أساسياً في قيادة المجتمع والدولة، على الرغم من وجود الخليفة المعترف به، فضلاً عن الملك والسلطان والوالي ورئيس الجمهورية. ويتردد على شفاه الدارسين الشيعة – منذ مراحلهم الأولى – صدى عدد من الأحاديث المنسوبة إلى النبي محمد (ص) في تكريم العلماء ومبايعتهم قيادة المجتمع، ومنها «الفقهاء أمناء الرسل».. و«افتخر يوم القيامة بعلماء أمتي، فاقول علماء أمتي كسائر الأنبياء من قبلي»… و«العلماء خلفاء الأنبياء»… و«العلماء ورثة الأنبياء، والفقهاء حصون الإسلام، كحصن سور المدينة لها»…
لكن أعظم دور – على مستوى الحياة السياسية – إنما يعطيه الإمام جعفر الصادق (ص) للعلماء. فقد روي أنه قال:
«الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك».
وهذا يفترض أن الفقهاء والمعدمين – وهم معظم طلاب الدراسات الفقهية في المراكز العلمية الشيعية – سيحملون معهم شحنة من الكبرياء العلمي بسبب الدور الذي يمنحه التشيع لهذه الفئة. لكنه ليس افتراضاً مطلقاً، مع أنه يجعل العالم بمنزلة فوق منزلة الملوك والسلاطين. ومن هنا كانت الفرصة مهيأة لتلك المشكلة الدائمة في الصراع، بين فقهاء التشيع وسلاطين الزمان الجائرين، فضلاً عن غيرها من أسباب الصراع. من جانب آخر فإن نظام الاجتهاد الشيعي من شأنه أن يجعل عملية الابداع حيوية ومستمرة ومتطورة. ذلك أن الشيعة لا تجيز التقليد الابتدائي عن المجتهد الميت. والشخص الذي لا يعلم مسألة ما عن طريق الاجتهاد، فإنه وفقا لوظيفته الدينية يجب أن يقلد المجتهد. ولا يستطيع الرجوع إلى فتوى المجتهد المتوفى، ما لم يكن قد قلد في هذه المسألة مجتهداً حياً. وبعد وفاة المرجع والمقلد، بقي على تقليده. وهذه المسألة هي إحدى العوامل المهمة التي تجعل الفقه الإسلامي الشيعي، يمتاز بالحيوية، فيسعى جماعة للحصول على درجة الاجتهاد، والتحقيق في المسائل الفقهية. إن أهمية نظام الاجتهاد الحر في الإبداع الفكري، ستبدوعظيمة للغاية، حين يقرر علماء في المذاهب الإسلامية الأخرى حصر الاجتهاد وكذا التقليد في أئمة المذاهب الأربعة.
وسيبدو دور الفكر الإسلامي الشيعي أساسياً وخطيراً لمنع التدهور في الدراسات الفلسفية الإسلامية في أعقاب فتح السلاجقة الأتراك العراق واحتلالهم بغداد، والذين طاردوا – حتى الإبادة – الفرق الإسلامية. واحتجوا على تلك الحرية التي كان الإسلاميون خارج مذهب الخلافة يتمتعون بها. فوضعوا السيف في الإسماعيلية والإمامية والمعتزلة، ثم انتقلوا إلى الأشاعرة، وهم فرقة من أهل السنة. ولأول مرة في تاريخ بغداد يجري الاحتفال الرسمي – وقبل سقوط بغداد بقرنين – بإحراق كتب الفلاسفة والمناطقة والعلماء ككتاب الشفاء لابن سينا، وكتاب الهيئة لابن الهيثم، ورسائل إخوان الصفا.
ولتكريس فكرة الراي الواحد والمذهب الواحد بدأ السلاجقة الأتراك – ولأول مرة في تاريخ التعليم الإسلامي – بتأسيس مدارس الدولة، فصار الناس يشعرون بصبغة حكومية يراد بها السيطرة على العلماء. وأن لا يكون العلم حراً. فعُدَّ هذا أول تدخل في أمور العلم.
في ذلك الوقت بالذات انتقل فلاسفة الإسلام الشيعي خارج بغداد السلجوقية، ناشدين الحرية على مشارف الصحراء. فتأسست الحوزة العلمية في النجف منتصف القرن الخامس الهجري. لتستقبل طلاب الدراسات الدينية وفقاً لمنهج الاجتهاد المفتوح. وبهذا أنقذ مفكرو التشيع جزءاً من الفكر الإسلامي من أن يسقط في حمأة الجمود.
من جانب آخر، فقد كان أجراء السلاجقة الأتراك بتأسيس المدارس الحكومية، بداية مرعبة لتحول العلماء والفقهاء إلى موظفين ومستخدمين في دوائر الأوقاف. فقد اهتم هؤلاء الحكام من الإسلام بالشكل والرسوم، فشهدت عمارة المؤسسات الدينية في ذلك العصر تطوراً جعل إقامة المساجد والمدارس والتكايا وصيانتها والإنفاق عليها، أمراً عظيماً يتطلب الكثير من الأموال والجهود والنفقات. الأمر الذي حتم اختصاص الدولة بتلك المهام. ثم أوقفت على هذه المؤسسات الأوقاف الواسعة. فكان أن تحول العلماء والفقهاء – مثقفو ذلك العصر – إلى منتفعين بريع الأوقاف. أي إلى موظفين لدى الدولة. ففقدوا الاستقلال الذي كان يعينهم على النقد والاعتراض، فعرف العصر وعاظ السلاطين والأمراء.
وهنا تبدو ميزة خاصة للفقهاء الشيعة إنهم لا يرتبطون مع الدولة برابط المعاش، وإنما يعتمدون على الناس في تمويل مراكز الدرس الفقهي، والإنفاق عليها. مما أكسب المؤسسة العلمية الشيعية استقلالاً عن نفوذ الحكومة وسطوتها. وبهذا فليس غريباً أن تزدهر الدراسات الفلسفية في النجف، في الوقت الذي انهارت فيه العلوم الفلسفية في العهد العثماني «وأهمل أمر المدارس ما بين القرن التاسع الهجري والقرن الثاني عشر. فامتدت أيدي الأطماع إلى أوقافها، وتصرف فيها النظار على خلاف شرط وقفها، وامتنع الصرف على المدرسين والطلبة والخدم. فأخذوا في مفارقتها. وصار ذلك يزيد في كل سنة عما قبلها، حتى انقطع التدريس بالكلية، وبيعت كتبها وانتهبت، وآل بعض تلك المدارس إلى زريبة».
وقد وصف أروع مراكز الإبداع الفكري في العالم الإسلامي، المتمثل في الأزهر الشريف، بأنه أزهر يكتنفه الجمود. وعلماء لا يذهبون في علومهم إلى أبعد من علوم الدين التقليدية. وعامة مأخوذة بالتصوف والمتصوفة والشعوذة والخرافات.
يقول الدكتور علي الوردي يصف النجف: شهدت النجف ابتداء من عام 1821م أعظم عصور ازدهارها العلمي، فشيدت فيها المدارس الدينية الكبيرة. وصار كل طالب علم في إيران، أوفي غيرها من البلاد الشيعية، يطمح أن يهاجر إلى النجف لكي يكمل دروسه العالية فيه. وقد تجاوز عدد طلابها عشرة آلاف طالب. فكان فيهم الإيراني والتركي والهندي والتبتي والأفغاني والبحراني والعاملي والإحسائي علاوة على العراقي. ومن المؤسف أن لا يدخل الباحثون العرب في تاريخ الفكر الإسلامي النجف والدراسات العليا فيها ضمن النشاط الفكري في الفترة المظلمة. دون أن ينتبهوا إلى أن الفكر الإسلامي الشيعي، لم يتأثر كثيراً من عصور الانحطاط([120]). وتكفي الإشارة إلى أن أعظم فلاسفة الإسلام الشيعي كانوا قد ظهروا في الفترة التي رافقت أو أعقبت سقوط بغداد، كالفيلسوف الإسلامي الكبير محمد صدر الدين، الملقب بالملا صدرا، أوصدر المتألهين، الذي استطاع أن يحقق إنجازاً علمياً عبقرياً سابقاً لعصره، بإثبات نظرية الحركة الجوهرية.
وكان معظم فلاسفة الإسلام قد استسلموا لفكرة تدهور العصور. وكان المؤرخون قد سمّوا مجدداً على رأس كل قرن، ثم توقفوا عن المائة العاشرة، أي عند العصر المملوكي، وسيطرة آل عثمان، فلم يذكروا للأجتهاد والتجديد علماً، ولم يشيروا إلى أثر في حياة الأمة الفكرية للتجديد والاجتهاد. إذ ذاك – وهذا هوالجانب المهمل من تاريخ الفلسفة الإسلامية – كانت الدراسات الفقهية في مراكز التشيع لا سيما في النجف، قد قطعت مراحل كبيرة في حقول الإبداع والاجتهاد. على الرغم من أن فريقا من علماء التشيع، قد آثر – هو الآخر – الاستسلام لعلوم السلف، والتوقف حيثما وقفوا، وإغلاق باب الاجتهاد. وهم الأخباريون الذين يعتمدون في أحكامهم الشرعية على الأخبار الواردة عن النبي والأئمة الاثني عشر، دون إخضاعها للفحوص العقلية، وفيما إذا كانت تلك الروايات صحيحة أم لا. وهي المهمة التي نهض بها فريق آخر من العلماء الشيعة الذين أوجبوا على الفقيه أن يبحث في أسانيد الروايات والأخبار، ويقارن بينها مستعينا في ذلك بعلم خاص يسمى (الأصول)([121]).
وقد استمر الخلاف بين الأخباريين السلفيين، والأصوليين العقلانيين، فترة طويلة حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر، حين تزعم المدرسة الأخبارية الميرزا محمد الأخباري، والمدرسة الأصولية الشيخ جعفر الذي وضع كتابا في الرد على الأخباريين بعنوان «كاشف الغطاء عن معائب المرزا محمد الاخباري عدو العلماء» وكان الشيخ جعفر قد انتصر على خصمه الأخباري الذي قتل علم 1817 م في الكاظمية، فضعفت الحركة الأخبارية بمقتل زعيمها. أما الحركة الأصولية فقد سادت وشملت مختلف مراكز الفكر الشيعي في العالم.
وباعتقادنا فإن محاولة الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء المتنورة هي التي هيأت لمدرسة تالية من مدارس التنوير الإسلامي التي قادها جمال الدين الأفغاني، التلميذ القديم في جامعة النجف والمتشبع بالمدرسة الأصولية.
حسن العلوي
التشيع والحمية الإسلامية
يقول عبد الرزاق الهلالي في كتابه «تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني» الصفحة 43 من طبعة 1959م.
«كان الولاة في مختلف الأدوار، تظاهراً منهم بالإخلاص للدين ورجاله، يقومون بتأسيس المدارس ويوقفون لها الأوقاف الخيرية، مستثنين من ذلك أبناء المذهب الشيعي الذي يحتل أتباعه جانباً كبيراً من البلاد. مما اضطرهم لإنشاء المدارس الخاصة بهم بعيداً عن تشجيع الولاة أو مساعدتهم المالية معتمدين في ذلك على الحقوق الشرعية، وما يرد من أموال التركات والأوقاف والتبرعات والهبات، التي كان يقدمها المحسنون لهذه المعاهد».
ويقول كامل الجادرجي في «من أوراق كامل الجادرجي» ص 86 من طبعة بيروت.
«كانت الطائفة الشيعية تعد – في زمن السلطان عبد الحميد، وبالحقيقة في زمن الدولة العثمانية – أقلية تنظر إليها الدولة بعين العداء. فلم تفسح لها مجالات التقدم في أية ناحية من نواحي الحياة العامة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك أنها كانت لا يقبل لها تلميذ في المدرسة الحربية، ولا يقبل منها فرد في وظائف الدولة، إلا ما ندر وعند الضرورة القصوى، وحتى في مدارس الدولة الإعدادية القليلة، كانت توضع العراقيل في طريق دخول أبناء الطائفة فيها».
إن التمييز الطائفي ضد الشيعة في العراق، وحرمانهم من حق التعليم الرسمي، وقيامهم بفتح المدارس الخاصة بهم من أموال المتبرعين، أوجد في العراق نظامين للتعليم. رسمي تابع للدولة العثمانية، يقتصر على مرحلة الدراسة الابتدائية والرشدية، ثم إتمامها في اسطنبول لمن أراد الاستمرار في تحصيله العلمي. وتقليدي يعتبر استمراراً لنظام التعليم في العصر العباسي، وهو التلمذة على الشيخ والدراسة في المراكز الدينية. وتعتمد الدراسة في النظام الرسمي، حيث لا يقبل فيه أبناء الشيعة اللغة التركية لغة وحيدة للدراسات الإنسانية والعلمية للطلاب، قبل أن يتهيأوا لإرسالهم إلى اسطنبول لاستكمال مرحلة التتريك. ومن هؤلاء تشكلت المدرسة التركية لإدارة العراق، والتي تحولت فيما بعد إلى إدارة الدولة العراقية أثناء الاحتلال البريطاني وعند تأسيس الحكم الملكي.
أما الدراسات في مدارس النظام التقليدي في حواضر الشيعة: النجف وكربلاء والكاظمية، حيث أوسع مركز إسلامي للتعليم المستقل عن الدولة والمدار من قبل الهيئة الاجتماعية الدينية، فقد كانت تعتمد العربية لغة العلم والبحث.
وبهذا صار العراق أمام حالتين أو مصدرين للتعليم. رسمي يسعى لتتريك العرب وفرض الثقافة واللغة والتراث التركي على الطلبة، وشعبي يتم فيه التركيز على اللغة العربية، والثقافة الإسلامية، والتراث والتاريخ العربي، لتغذية الطلاب العراقيين، وتعريب الأجانب القادمين إلى هذه المدارس من الصين ومنغوليا وأزبكستان وأفغانستان والهند وتركيا وإيران. وكان هؤلاء الطلاب الأجانب المستعربون يعودون إلى بلادهم وهم علماء نحو وصرف وبلاغة، كما هم علماء دين، وهم يشعرون بشيء غير قليل من الفخر والزهو، لأنهم يعرفون العربية، ويقرأون القرآن، ويفهمون كتب التاريخ العربي بلغتها العربية، وقد ينقلون ذلك لابنائهم في تلك البلدان الاجنبية، كما هي حالة المتعلمين العرب الآن في الجامعات الأوروبية، الذين يعودون إلى بلدانهم وهم يتحدثون الألمانية أو الإنكليزية أو الفرنسية بنفس الزهو، أما الدارسون في المعاهد التركية من أبناء العراق فإنهم يعودون إلى وطنهم وقد تشربوا بالثقافة التركية، وأصبحت التركية لغتهم الأم التي لا يجيدون سواها.
ولعل وقفة قصيرة أمام قادة الدولة القومية في العراق من الرؤساء والوزراء والعسكريين الكبار، تكشف بجلاء عن هذه الحقيقة، فقد كانوا لا يستطيعون الحديث بالعربية، ولم يسبق لأحد منهم أن وقف خطيبا في منتدى عربي، أوكتب مقالا باللغة العربية، أو عقد مؤتمراً صحفياً مع صحفيين عرب. فقد مات عبد المحسن السعدون وترك وصيته – وهو رئيس وزراء العراق – عند انتحاره مكتوبة باللغة التركية لأنه لا يجيد التعبير عن مشاعره باللغة العربية. وكشفت مذكرات طه الهاشمي عن جهله الفاضح بقواعد الكلام العربي.
وكان الحكام العراقيون يلجأون إلى وزير شيعي، على الأغلب لصياغة معظم البيانات الحكومية باللغة العربية. وكان ذلك هو الدور الوحيد الذي يناط عادة بالشيخ علي الشرقي، حيث يسند إليه منصب وزير بلا وزارة. وفي جانب آخر فقد أقصى الأتراك العثمانيون الشيعة العرب في العراق، عن أي مركز إداري في الدولة وأبعدوهم عن التمثيل النيابي، فعندما تريد الدولة تعيين نائب عن مدن الشيعة، تختار أحد أبناء العراق من أهل السنة ممثلاً لكربلاء، أوالعمارة أوالديوانية أوالناصرية. فيما أعطت الدولة العثمانية لليهود وللمسيحيين في العراق حق أختيار أو تعيين مندوب لهم في مجلس المبعوثين (البرلمان العثماني). وعلى الرغم من صدور الدستور العثماني عام 1908 م الذي اعتبر ثورة ديمقراطية ودعوة شاملة للحرية والمساواة بين مواطني الدولة، فقد حرم الشيعة من حق التمثيل عن مدنهم.
إن نواب العراق في سنة 1912 م هم:
عن لواء بغداد: مراد بك سليمان (شقيق حكمت سليمان) وفؤاد أفندي – مدير الأملاك – ومحي الدين الكيلاني وساسون حسقيل.
وعن لواء البصرة: طالب باشا النقيب، وعبد الله الزهير، وعبد الوهاب باشا القرطاس، وأحمد نديم. وعن لواء كربلاء: فؤاد الدفتري (والد محمود صبحي الدفتري)، ونوري بك البغدادي.
وعن لواء الديوانية: إسماعيل حقي بابان.
وعن لواء المنتفك: جميل صدقي الزهاوي، وعبد المجيد الشاوي.
وعن لواء العمارة: عبد الرزاق المير، ومعروف الرصافي.
وباستثناء بغداد والبصرة فسكّان هذه الألوية كلهم من الشيعة. أما بغداد والبصرة ففيهما أكثرية شيعية، ومع ذلك فليس بين هؤلاء النواب أحد من الشيعة.
حركة الجهاد
لم يكن من المستبعد أن يضع المشروع البريطاني لاحتلال العراق أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1914 م في حسابه الاعتماد على المنبوذين والمحرومين من حقوقهم المدنية، كفئات متصالحة أو مؤيدة للحكم البريطاني القادم، وهويرفع شعار تحرير الشعب العراقي من النير التركي. وإحلال عصر تسود فيه مبادئ الحرية والمساواة والعدل. لا سيما أن التجربة السابقة في اعتماد المنبوذين، قد أثمرت في الهند نتائج طيبة لصالح الإنكليز.
ولما كان الشيعة العراقيون هم الذين وقع عليهم بشكل خاص الحرمان والاضطهاد طيلة الحكم العثماني، كان طبيعياً، من خلال هذا المنطق، أن يتعاون الإنكليز والشيعة على طرد الأتراك من العراق، ولا ننسى إن الإنكليز كانوا قد انتصروا للشيعة في بعض الحالات التي كانوا يتعرضون فيها لمذبحة أو لمشكلة مباشرة مع السلطة العثمانية. ففي حرب نجيب باشا عام 1843م ضد أهالي كربلاء، دخل القنصل البريطاني طرفاً لتسوية النزاع. كما تدخل الدبلوماسيون الإنكليز في المشكلة التي تعرّض لها الإمام محمد حسن الشيرازي اثناء إقامته في سامراء، أواخر القرن التاسع عشر لصالح الشيعة هناك. إلا أن الإمام الشيرازي رفض مقابلة القنصل البريطاني، وبعث له من يبلغه بكلمته وهي «نحن مسلمون فلا حاجة لتدخلكم بيننا، فرجع القنصل خائبا»([122])..
وكان بإمكان علماء الشيعة أن يخلدوا إلى صوامعهم، دون أن يوجه إليهم لوم، حينما دخلت الجيوش البريطانية البصرة واصدر شيخ الإسلام في اسطنبول فتوى الجهاد. ولديهم الكثير من الحجج السياسية والفقهية لتبرير موقف القعود عن الجهاد. كعدم ارتباطهم فقهياً بمركز الإفتاء في اسطنبول، وكون مشيخة الإسلام الرسمي في بغداد هي الممثلة الشرعية للمشيخة التركية. وعدم اعتراف الدولة العثمانية بالمذهب الشيعي الجعفري. وتعرض الشيعة خلال الحكم العثماني الطويل إلى الاضطهاد المذهبي، وحرمانهم من أموال الأوقاف، وعدم شمولهم بالمنح السلطانية والإقطاعيات.
لقد أصدر شيخ الإسلام في اليوم السابع من تشرين الثاني عام 1914 م، فتوى أعلن فيها بوصفه الرئيس الروحي، صاحب أرفع منصب ديني في الدولة العثمانية، أن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين في العالم، ومن بينهم الذين يعيشون تحت حكم بريطانيا وفرنسا وروسيا، أن يتحدوا لمقاومة هذه الدول الثلاث عدوة الإسلام، وأن يحاربوها ويحاربوا حلفاءها، وأن يمتنعوا مهما تكن الحال، حتى حينما يكونون معرضين لعقوبة الإعدام، عن مساعدة دول الحلفاء في هجومها على الدولة العثمانية.
وكانت بيانات أخرى قد اكدت أن الجهاد عن الإسلام إنما هو فرض أمر الله به كل مؤمن فلا يجوز التهرب منه. وقد أجازت بعض البيانات الصادرة عن مشيخة الإسلام في اسطنبول للمسلمين استخدام القتل والاغتيال لمنع احتلال أرض الإسلام.
وكانت حملة الدعوة إلى الجهاد، قد حضّت كافة الشعوب الإسلامية، لكنها وجهت إلى العرب بقوة ونشاط لتؤكد لهم الواجب الملقى على عاتق المسلمين جميعا، في الدفاع عن الأماكن المقدسة. وقد تليت هذه الفتوى في جوامع بغداد جميعها في 23 محرم 1333هـ. فما هو رد فعل الفتوى الرسمية لشيخ الإسلام على علماء المشيخة في بغداد والبصرة والموصل؟.
لقد تم التعتيم قدر المستطاع على ردود الفعل، ولم يشر أحد بإدانة مباشرة من بين الحريصين على الإسلام العثماني، إلى علماء الدين المتخلفين عن الجهاد. وسبب هذا التعتيم، أن علماء المؤسسة التركية لم يكتفوا بالقعود عن الجهاد، وإنما بدأوا يتصلون برجال الاحتلال البريطاني عارضين على الإنكليز تأييدهم([123]).
وعلى نطاق العشائر التي اعتمدها السلطان والولاة الأتراك في العراق، كانت ثلاث عشائر تحظى بثقة الباب العالي وتتمتع بامتيازاته، لا سيما في العقود الأخيرة من الحكم العثماني.. وهي شمّر بزعامة الشيخ عجيل الياور.. والدليم بزعامة الشيخ علي السليمان.. وعنزة بزعامة الشيخ فهد الهذال. ولم يتحرك هؤلاء الشيوخ لنجدة حليفهم المسلم في وقت كانت تحت تصرفهم قوى بشرية، واصقاع تمتد من شمال الموصل حتى شمال النجف، وإلى حدود العراق مع الشام والجزيرة العربية. ولوأنها استخدمت في المقاومة الوطنية إلى جانب الجيش العثماني ضد القوات البريطانية الغازية لكانت نتائج الحرب مختلفة حتماً.
لقد ظهر فيما بعد أن هؤلاء الشيوخ كانوا قد اتصلوا بالإنكليز وقدموا لهم خدمات أمنية وعسكرية، مقابل أجور وامتيازات ورواتب قدمت لهم([124]).
أغلب الظن أن المفاجأة أذهلت واضعي المشروع البريطاني لاحتلال العراق وهم يواجهون في ضواحي البصرة التي نزلت إليها القوات البريطانية، ميليشات مقاومة وطنية يقودها علماء مسلمون من الذين يعانون حتى اثناء الحرب من اضطهاد تركي قومي ومذهبي مركب. وبكلمة افصح علماء الشيعة. وهو التعبير الذي يتهرب منه الكتّاب الشيعة كي لا يوصموا بالطائفية، والكتّاب من غير الشيعة لكي لا يعطوا لهؤلاء دوراً بارزاً واساسياً في تاريخ العراق.
ولنا أن نستعرض ما يمكن أن يكون ردوداً غير مباشرة، على طروحات وتصورات طبعت في أذهان المثقفين والبسطاء، حول جدية حركة الجهاد وفاعليتها القتالية وأهميتها الاستراتيجية. إن أعداد المجاهدين الشيعة الذين لبوا دعوة مجتهديهم تفوق في بعض الجبهات أعداد الجنود النظاميين في الجيش العثماني.
فقد كانت القوة النظامية في الشعيبة حوالي (7,600) مقاتل من الأتراك و(18,000) مقاتل من المجاهدين العرب الشيعة بحسب التقارير التركية.
وفي منطقة القرنة عدد المجاهدين بأربعين ألفا، وقد توزع المجاهدون على ثلاث جبهات:
القلب: مركزه القرنة. يقوده العلماء الشيعة: مهدي الحيدري، وشيخ الشريعة، ومصطفى الكاشاني، وعلي الداماد، وعبد الرزاق الحلو في الجانب الآخر من النهر.
الجناح الأيمن: مركزه الشعيبة. يقوده العلماء الشيعة: محمد سعيد الحبوبي، وباقر حيدر، ومحسن الحكيم.
الجناح الأيسر: مركزه الحويزة. يقوده العلماء الشيعة: مهدي الخالصي وولده محمد الخالصي وجعفر الشيخ راضي، وعبد الكريم الجزائري، وعيسى كمال الدين.
وكان السيد عيسى كمال الدين، قد اقترح الجبهة الثالثة (الجناح الأيسر) لحماية ميسرة الجيش في القرنة، بعدما علم بعزم الإنكليز على احتلال العمارة، عن طريق الحويزة والأهواز، بعد أن أعلنوا الجهاد ضد الإنكليز، ولما اعترضهم الشيخ خزعل حاكم عربستان الموالي للإنكليز، أعلنوا الثورة ضد الشيخ خزعل. وقد نجح المجاهدون على هذه الجبهة في نسف أنابيب في الأهواز، التي كانت تغذي القوات البريطانية، الأمر الذي أقلق الإنكليز وسبب لهم متاعب جمة، حتى إنهم أرغموا على إرسال المزيد من القوات العسكرية.
وفي الشعيبة كانت مساهمة المقاومة الوطنية الشيعية لقوات العشائر وللمجاهدين، قد أدت إلى استمرار معركة ضارية، فخسر الإنكليز (1297) رجلاً بين قتيل وجريح. وخسر الجانب الإسلامي في هذه المعركة، ضعفي ما خسره الإنكليز، وطبيعي أن يكون ضعفا الخسارة الإسلامية، من بين المجاهدين الذين اعتادوا القتال في الجبهات الأمامية تنفيذاً للطريقة الإسلامية في الحرب([125]).
واستخدم المجاهدون طريقة حرب العصابات أيضاً في الهجمات المفاجئة على المعسكرات البريطانية ثم الانكفاء. فكانت توقع الرعب في معسكرات الإنكليز وتقتل من الجنود وتستولي على العتاد، كما حدث أثناء تقدم الجيش البريطاني الذي قاده تونزند لاحتلال الكوت. وكانت مجموعة من المقاتلين الشيعة قد أحبطت محاولة بريطانية لتعطيل الخطوط الهاتفية وقطع اتصال قوات المجاهدين مع بغداد. فهاجم المجاهدون ضابط المحاولة وأخذ أسيراً. وكانت القبائل تقدم العون للأتراك، وتشترك معهم في القتال كما يقول ويلسن. فأنزل جيش المجاهدين بمعونة القبائل ضربات كبدت الإنكليز خسائر فادحة بلغت (4490) رجلاً بين قتيل وجريح، ومن مجموع الضباط المشتركين في المعركة التي قادها تونزند، وعددهم (317) فقد الإنكليز (130) ضابطاً بيت قتيل وجريح، ومن مجموع الضباط الهنود البالغ عددهم (235) ضابطا بقي (111) ضابطاً على قيد الحياة. أما خسائر المجاهدين فكانت (9600) رجل بين قتيل وجريح. وحين حوصر الجيش البريطاني في الكوت قرابة (147) يوماً وخسر (500) رجل أثناء انسحابه، شعر «تونزند» بمرارة نفس شديدة، لما لحق به من خسارة في الأرواح والعتاد، من جراء هجمات الفرسان من القبائل العربية (الشيعية) وفي ساعة يأس شديدة كتب يقول، لقد وجدت العرب في أثناء الأعمال العسكرية في العراق جماعة لا تعرف الرحمة، كما أنهم جماعة من الأوغاد الجبناء.. ويحاول التدليل على قوله هذا، بسرد خبر عن عدد من الجنود لا يزيد على الستة، وقعوا في أيدي رجال القبائل، فجردوهم من ملابسهم وقتلوهم.
إن الموضوعية في البحث تفرض علينا أن نذكر ما فعله الإنكليز في أثناء الأعمال العسكرية في خوزستان (على جبهة الحويزة) وعندما احتلوا العمارة، فإنهم أحرقوا قرى وبيوتاً بمن فيها من السكان.
ويقول ويلسن انه لم ينج أحد من سكان الخفاجية، وإذا كان بيت واحد قد سلم من النار، فإن ذلك كان صدفة من الصدف([126]).
وكان قد التحق بالمجاهدين، حين تمركزوا في الكوت بعد تراجع القوات التركية، كل من العلماء: صالح كمال الدين، وجواد الجواهري، وموسى تقي آل زاير، وحسن القطيفي. واستخدمت حرب العصابات ضد الجيش البريطاني المحاصر في الكوت، عن طريق تسلل المجاهدين عبر نهر دجلة. وقد افشلوا محاولة بريطانية لمد جسر على دجلة، ينفذ منه جيشهم المحاصر. وكان القادة العسكريون البريطانيون كثيري الشكوى، ممن يسمونهم «الجواسيس الشيعة» الذين يساندون الجيش التركي. على الرغم من أن الجنرال «تونزند» سجل إعجابه بقوة المجاهدين المرابطين شمالي القرنة بقيادة السيد مهدي الحيدري، واتهم القائد العثماني «حليم بك» بالجبن الفاضح لهزيمته الشنعاء في المعركة التي وقعت في القرنة([127]) وكان عدد من علماء الإسلام الشيعة المشتركين في حركة الجهاد، وقد توفوا إثر الهزيمة، كالشيخ باقر حيدر، والشيخ طاهر فرج الله، والشيخ عيسى مال الله.
أما قائد المجاهدين السيد محمد سعيد الحبوبي فله حديث مستقل.
نماذج عراقية
هذه ثلاث صفحات مطوية من ايام الجهاد: اثنتان للمجاهدين، وواحدة للجانب القاعد عن الجهاد.
1 – السيد محمد سعيد الحبوبي:
كان الحبوبي من زملاء وتلامذة السيد جمال الدين الأفغاني الحسيني([128]) درسوا معا في مدارس النجف التي تعلم الفقه والأدب والمنطق وعلم الكلام.
وكانت للأفغاني الحسيني طموحات أبعد من علوم النجف وآدابها، أثرت في زملائه، أو بعضهم بالأدق فدفعت بهم إلى خوض معامع القرن العشرين الأولى.
بدأ الحبوبي شاعرا. أراد أم يستعيد مجد الموشحات. ونجح في ذلك أبعد النجاح. تقرأ موشحاته فتتذكر ابن سناء الملك، وابن سهل، ولسان الدين الخطيب. كان من القلائل الذين استعادوا فن الموشح بكامل طراوته وألوانه الطبيعية حتى لتكاد تنسى وأنت تقرأه أويتلى عليك أن هذا الشعر قد كتب في النجف أواخر القرن التاسع عشر / أوائل العشرين:
| يا غزال الكرخ واوجدي عليك | كاد سري فيك ينهتكا | |
| هذه الصهباء والكأس لديك | وغرامي في هواك احتنكا | |
| فاسقني كأسا وخذ كاسا إليك | فاذيذ العيش أن نشتركا |
ومضت السنون، والحبوبي يكتب الموشح، ليرسم به أحاسيس نفس شفاقة. تحب الحب والجمال، ولا ترى فيهما عيبا على الشعر. ثم غلبت عليه مهنة الفقيه. فأخذ يقطع صلته بالشعر والموشح. لكن لم يصبح فقيها بالعنى التقليدي ولو أنه استوعب ثقافة النجف التي تتألف من الفقه أولاً، فقد بقي يحب الجمال والناس والأشياء فلم يمارس إلا القليل من الفتوى. وجعله أقرب إلى هموم الناس، علاقته الحميمة بالسيد الأفغاني الحسيني، الذي كان يتحرك في دائرة الإسلام – الحضارة.
وبالتالي، فلم تكن مفاجأة تاريخية، أن يظهر الشاعر الغزلي للناس بعد أن شارف السبعين، ليقودهم في الدفاع عن العراق ضد جيوش الغزوالبريطانية، التي كانت قد نزلت في البصرة. السيد الفقيه محمد سعيد الحبوبي، كان ممن أعلنوا الجهاد، واستجابت له ألوف من المقاتلين من أبناء القبائل الشيعية. وزحف بهم نحو البصرة، وعلى مشارفها التحم شاعر الموشحات وفقيه النجف، بمعركة غير متكافئة مع الغزاة البريطانيين. وكانت قيادة الجبهة لعسكري تركي من بقايا العثمانيين. فلم يصمد حين كان المجاهدون بقيادة الحبوبي يلتحمون مع الإنكليز، وقد أدى ذلك إلى الفت في أعضادهم. وبالطبع لم يكن لهم أن يصمدوا أمام جيش حديث يفوقهم في الخبرة والتنظيم، كما يفوقهم في المدد والامتداد. وأصيب المجاهدون بضربة موجعة تقهقروا بعدها إلى مدينة الناصرية. وهناك أدرك الإعياء وثقل الهزيمة، قائدهم الشيخ، فلم يقو على مواصلة السير باتجاه النجف ليتحصن فيها. ومات في الناصرية شهيداً. بعد أن قاتل الجيش المحتل سبعة شهور، وأوقف زحفه على الناصرية أربعة شهور، فلم تقع الناصرية في أيدي الإنكليز، إلا في 24 تموز 1915م، أي بعد وفاة الحبوبي في 16 حزيران 1915 م.
بدأ شاعراً، وتوسط فقيهاً.. وانتهى قائداً بمعركة تصدي ختمها بالشهادة.
2 – السيد مهدي الحيدري:
في أعمار متقاربة.. عبد الرحمن النقيب، ومهدي الحيدري ومهدي الخالصي. يعيشون في مكان واحد. وفي ولاية واحدة. يفصل بينهما وبينه نهر دجلة. وجميعهم علماء دين، لهم أتباع ومريدون. سوى أن النقيب من إسلام الحاكم وهما من إسلام المحكومين.
وقد يكون لهذا السبب، أن للنقيب إقطاعيات وأوقافاً ورواتب ثابتة ومنحا سلطانية، وليس للخالصي والحيدري شئ من ذلك.
والنقيب، وهو الزعيم الروحي للطريقة القادرية، لا يرى في منصب رئيس البلدية عيباً دينياً([129]) ويرى المهديان غير ذلك. فهما عند قانون آخر أودعه جعفر الصادق.. فإذا كان الملوك حكاماً على الناس فالعلماء حكام على الملوك.. بون شاسع وسحيق أن يكون العالم الفقيه رئيس بلدية، أو أن يكون حاكماً على الملوك. لكن مَنْ مِنَ الملوك سيرضخ لحكم العلماء؟
ومَنْ مِنَ العلماء مَنْ يجرؤ على محاكمة الملوك؟ ربما كان السيد مهدي الحيدري من هذا الصنف من العلماء.
كان السيد مهدي الحيدري، وهوالمثقل بثمانين سنة، ومئات التلامذة، وألوف الكتب، قد تسلم برقية في اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1333هـ (تشرين الثاني 1914م) تقول: الكفار يحيطون بنا، الجميع تحت السلاح، ونخشى على باقي الإسلام، ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع([130]).
لم تكن المعلومات السابقة المتوفرة لدى السيد مهدي الحيدري تكفي للتحرك، لكنه بعد هذه البرقية، لم يعد أمامه سوى أن ينهض فيعلن على حشد من الناس في الصحن الكاظمي([131]) أن بلاد العراق المسلم، تتعرض لغزو أجنبي، وإنني عازم على مواجهة الغزاة. فمن وجد في نفسه القدرة فليلتحق. وأمضى الحيدري أثنتي عشرة ليلة يعد العدة للسفر إلى البصرة، حيث اللقاء المنتظر. وقد بدأ بخاصة أهله.. ثلاثة من أبنائه وهم علماء ومجتهدون، أسد وأحمد وراضي وكان من بين أسرته عالم عرف بالشجاعة فأولاه أهمية خاصة. لم يكن هذا العالم سوى السيد عبد الحسين الحيدري الذي سيكون له حديث في تراجيديا الجهاد.
فقرر السيد مهدي الحيدري أن يخرج الموكب الإسلامي تودعه الناس، ماراً بشوارع بغداد، لبثِّ الحمية وتحريض المسلمين فيها على الجهاد.
ونزل الموكب من شريعة بغداد إلى السفن والمراكب التي سارت به نحو البصرة. وكان كلما وصل إلى إحدى المدن أوالقبائل العربية الشيعية التي تنزل على ضفاف النهر، توقف المركب ونزل الإمام وأصحابه، داعياً أهل المدينة وأبناء العشيرة إلى الجهاد فتلتحق بالقافلة سفن جديدة، حتى وصلوا قرنة البصرة، وكان القائد العسكري التركي قد قرر في ذلك الوقت الانسحاب إلى العمارة، ثم قرر إخلاء العمارة، فرفض السيد مهدي الحيدري قائلاً، انسحبوا أما أنا فلا أتحرك من هذا المكان حتى اقتل أو أنتصر. فعدل القائد التركي عن رأيه في الانسحاب، وأذعن لرأي السيد للبدء بعملية تجنيد واسعة، فاستجاب من أهل العمارة للجهاد، من لم تستطع قيادة الجيش النظامي تغطية حاجاتهم من السلاح، فحملوا العصي والهراوات.
ولإتهام «جاويد باشا» بالتقصير فقد عزل وعين سليمان العسكري مكانه. فبدأ القائد الجديد عمله بلقاء طويل مع السيد مهدي الحيدري، عارضا عليه ما يحتاج من المؤن، فرفض ذلك رفضاً قاطعاً، قائلاً له: إن الجهاد لن يكون جهاداً، إذا لم يستطع المجاهدون أن يتمولوا مما عندهم. ولو تمكنا نحن على مدكم بالمال والطعام لفعلنا. فهوى القائد على يديه وقبلهما، وأدى له التحية العسكرية مودعاً. حتى إذا دخل المعركة، وكان ضابطاً مقداماً، أصابه جرح نازف، فدخل المستشفى في بغداد. وعاده أحد علماء المشيخة الكبار، فرمقه بنظرة احتقار، وأمامه شبح السيد مهدي الحيدري قائلاً أنت ها هنا ترفل بالراحة والطمأنينة، لم تدافع لا عن إسلامك، ولا عن الدولة التي وفرت لك الأرزاق طيلة حياتك، وقد تركت في الحرب عالما يقاتل الكفار بنفسه، على شيخوخته وعظمته، وهوالآن في الصفوف الأولى، مع أنه لم يأخذ من الدولة لا قليلاً ولا كثيراً طيلة حياته؟.
وكان بعض العسكريين يقولون، إنه كلما اشتد الضغط علينا من العدو، هممنا بالانسحاب، وكلما نظرنا إلى خيام السيد قائمة، كنا نستحي من الانسحاب([132]).
لقد انتحر القائد العام سليمان العسكري، بعد انكسار جيشه، وتطورت ظروف الحرب لغير صالح المسلمين، وتقرر انسحاب الجيش والمجاهدين، وتم ذلك في وضح النهار بدلاً من أن يتم ليلاً، كما أراد المجاهدون، وكان الانسحاب عن طريق المراكب النهرية التي كانت تمخر عباب الماء بمشقة بالغة، لسيرها في عكس اتجاه الماء، مما جعلها عرضة لهجمات العدو، فأحرق بعضها، وأغرق بعضها الآخر. وأوشكت قوات الإنكليز أن تدركهم، فرأوا أن يتفرقوا في الباخرة والمراكب، ولا يجتمعوا في مكان واحد. وكان السيد مهدي الحيدري، قد رفض أول الأمر أن يترك الباخرة التي تقله إلى زوارق النجاة، إلا أن السيد عبد الحسين الحيدري ألحّ عليه، وجذبه من منكبه، ووافقه أولاد السيد أيضاً فوافق، ونزل إلى أحد الزوارق مع ابن عمه وأولاده، وقد طرحوا في الزورق أسلحتهم، وبقي العلامة المجتهد عبد الحسين الحيدري مدججاً بالسلاح، تحسباً للطوارئ بملابس الحرب الكاملة. فلما استقر بهم الزورق وهمّ بالسير رمى اثنان من الجنود، وواحد من المجاهدين بأنفسهم إلى ذلك الزورق، لينجوا من الموت، فانقلب الزورق بمن فيه، وغاص الجميع في الماء، حتى السيد، وقد صعب عليه أن يقاوم التيار، لكن أولاده الثلاثة أحاطوا به، والماء ينحدر بهم إلى جهة العدو، فكانوا تارة يرسبون في الماء، وتارة يعومون على وجهه، حتى كاد التعب أن ينهكهم، ويهد قواهم وقد عثروا على خشبة طافية، فوضعوا يدي ابيهم عليها، واستسلم اثنان منهم إلى اليأس بعيدا عن نظره. فيما بقي الثالث يراقب والده. وكان بعض أبناء القبائل قد حضروا إلى النهر، فألقوا بأنفسهم على الإمام واستنقذوه إلى الأرض، وقد سلم الإمام وأولاده الثلاثة أما السيد عبد الحسين فقد اثقله السلاح فلم يظهر له أثر رغم جميع المحاولات التي بذلت في البحث عنه والعثور عليه، فقد أخذه النهر إلى أعماقه، وعلى جسده تنام البندقية.
وإذ خرجوا من الماء قبيل المغرب، ومشوا قليلاً، رأى السيد راضي أحد أبناء الإمام، شيخاً تتقاذفه أمواج النهر، فألقى بنفسه إلى الماء، واستنقذ الشيخ، فكان هو العلامة شيخ الشريعة، الذي كتب له فيما بعد أن يقود ثورة العشرين ضد الإنكليز، بعد رحيل الإمام محمد تقي الشيرازي.
وكان الشيخ يلقب السيد راضي بعد هذه الحادثة بمحيي الشريعة.
لقد أجتمع على البر ثلاثة أقطاب.. السيد الحيدري، وشيخ الشريعة، والسيد مصطفى الكاشاني. فتوجهوا في رحلة شاقة إلى الكوت حيث التحق بهم ألوف المجاهدين([133]).
وبعد رحلة عام تقريباً مع الجهاد، وقد انتصر الإنكليز أخيراً، وسقطت بغداد، بكى الإمام وقال كلمته «كأني بالإسلام قد سقط من السماء إلى الأرض»، ولم يستطع أن يقاوم الكارثة، وبالإنكليز يحكمون بغداد، رغم «أنهم كانوا ينظرون إليه بإكبار، وقد أعجبوا من صلابته في عقيدته، وإخلاصه لأمته، وحبه لوطنه»([134]).
لقد فارق السيد العظيم الحياة بعد آلام الكارثة وفاجعة الهزيمة.
الأتراك والجهاد
باستثناء المشاعر الودية التي غمرت قلة قليلة من الضباط الاتراك إزاء مشاهد المجاهدين المستميتين في القتال، فإن رجال السلطة التركية والجيش التركي تصرفوا مع المجاهدين ومناطق الجهاد بطريقتهم القديمة. وهي مزيج من الاستعلاء والتعصب وحب السلب والرشوة. مما دفع مؤرخين محايدين إلى القول.. إن الدعوة إلى الجهاد نجحت، وإنما عجز الأتراك عن الانتفاع بها، بسبب سوء إدارتهم، وعدم استعدادهم للحرب منذ الهزيمة التي مني بها الأتراك في معركة الشعيبة. ففي النجف وهي المدينة التي شكلت مع مدينة الكاظمية مركز النشاط الشعبي والعسكري المناصر للدولة العثمانية في أزمتها أثناء الحرب، ضاعفت السلطة التركية والجيش التركي من ضغطهما على السكان، واتخذا عدداً من الاجراءات المشددة، وفرض الغرامات المالية، ونهب الموجودات الثمينة، ومصادرة الأطعمة. ولم يسلم من شرّهم أحد حتى حراس مرقد الإمام علي.
وكانت النجف تدار من قبل قائم مقام يدعى بهيج، وكان سيء السيرة، يعامل الناس بخشونة وفظاظة، وبالضغط وابتزاز الأموال والمس بكرامات الناس، بما يبديه النجفيون وعلماؤهم من التجاوب المخلص مع السلطات العثمانية، ونصرتها في ساحة القتال. كان القائم مقام يلاحق الجنود الفارين وهم قلة، لا يسمنون ولا يغنون من جوع، لكنه كان في قرارة نفسه يريد أن يبتز الأموال من أهاليهم. فجرد في مايس عام 1915م حملة من ألف جندي – كان من الممكن أن يرسلوا إلى جبهة القتال – للبحث عن خمسين جندياً فاراً في مدينة هي سندهم الكبير. فدخل الجيش التركي، وبالطريقة التي حدثت قبل مائة عام تقريباً في باب الشيخ ببغداد، لجأ الجنود الأتراك إلى تفتيش النساء وقد طلب من بعضهم خلع عباءاتهن خشية أن يكون الفارون متزيين بزي النساء. وعندها لم يكن أمام الجنود الفاريين، إلا أن يقتحموا بروح فدائية حامية النجف، فانضم الناس إليهم، في معركة انتهت بهزيمة الحامية التركية، وقيام إدارة أهلية مستقلة في النجف. ثم ثارت بعدها كربلاء والهندية والحلة»([135]).
يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي في مذكراته:
«إن القائد التركي حسين رؤوف كان على رأس قوات تركية أثناء الحرب، يهاجم القرى في مناطق الفرات الأوسط، ويقتل الناس، ويسلبهم، فقتل في تلك الغارات بعض طلاب العلم الذين كانوا يدعون الناس للجهاد مع الأتراك، وكان ممن قتل الشيخ جعفر بن الشيخ محمد تقي وسلب منه (1700) ليرة ذهب ربما كانت توزع على المجاهدين([136]).
وفي الحلة التي اشتركت بزخم هائل في حركة الجهاد، قاد «عاكف بك» قوات مدججة بالمدافع، لقصف المحلات الشعبية في المدينة، وتحولت طائرات تركية، من قصف الإنكليز، إلى قصف السكان فيها، فأحدث ذلك رد فعل كبير في معنويات المجاهدين الذين استجابوا لفتوى الجهاد، متناسين مسلسلاً طويلاً من الإرهاب التركي، والتمييز المذهبي والعنصري الذي وقع عليهم. وحين وقف عاكف بيك على مشارف الأحياء الشعبية، ادعى إنما هو يرمي إلى التفاوض السلمي، لحل المشكلات التي حدثت بين أهالي الحلة والإدارة التركية. فاستدعى زعماء الحلة لهذا الغرض، حتى إذا دخلوا إلى مقره، أمر جنوده بوضع السلاسل في أرجلهم وأيديهم، ونصب في المعسكر سبع عشرة مشنقة، وكان ممن شنقوا من زعماء الحلة: صالح المهدي، وعلي الشيخ حسن، والملا إبراهيم، وأمين علوش، وموحي عبد الوهاب، ومحمد الحاج سعيد. وجمع القائد التركي عدداً من النساء وساقهن سبايا إلى الأناضول.
لقد أوجز محمد رضا الشبيبي في قصيدة طويلة معاناة الشيعة مع الأتراك أثناء حكمهم الثقيل، واثناء حركة الجهاد التي انتصر فيها الشيعة للعثمانيين. جاء فيها:
| قَيَّضْتم لحفاظ المُلك طائفة | لغيرها المُلكُ والأجنادُ والدولُ | |
| قومٌ من العُرِب وَخْزُ النحلِ حظهُمُ | وحظ قُوم سوانا الأريُّ والعسلُ | |
| عند المغانم، تنسونا ويفدحنا | من المغارم ثقلٌ ليس يُحتَملُ([137]) |
غزو إيطاليا لليبيا سنة 1911م
وعندما غزت إيطاليا ليبيا سنة 1911م قام الشيعة في العراق يساندون مجاهدي ليبيا، وكان موقف المرجعية الدينية الشيعية في النجف الأشرف موقفاً حازماً في تعضيد المناضلين الليبيين، وصدرت الفتاوى بالجهاد من قبل كبار مراجع التقليد والفتيا في النجف الأشرف، ووزعت في جميع أنحاء العراق، وامتد صداها إلى كل المؤمنين في ايران وروسيا والهند وغيرها من البلاد الإسلامية، فتجاوب لذلك الناس تجاوباً منقطع النظير، فاندفع الناس بحماسة كبيرة للتطوع والتبرع، وراح خطباء المنبر الحسيني ينقلون فتاوى المرجعية إلى الجماهير ويشرحونها، فيزداد الناس حماسة ويتطلعون للجهاد مع إخوتهم في القطر الليبي، وفيها تليت عشرات القصائد الحماسية في تمجيد الفدائيين الليبيين الذين وصلت أنباء تضحياتهم إلى مسامع الشعب، حيث عبَّر الشعراء الشيعة عن انفعالهم الشديد للصور المرعبة التي رسمتها المعركة من اشتباك وقتل وتشريد وهتك الحرمات والأعراض، وكانت كل هذه المساهمات تحت رعاية المرجعية الدينية في النجف وإشرافها المباشر.
وفيما يلي فقرات من (الفتوى التاريخية) التي نُشرت في مجلة (العلم) النجفية (الجزء 6 من المجلد 2 تشرين الثاني سنة 1911م).
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى كافة المسلمين الموحدين وممن جمعتنا وإياهم جامعة الدين والإقرار بمحمد سيد المرسلين، السلام عليكم أيها المحامون عن التوحيد والمدافعون عن الدين والحافظون لبيضة الإسلام. هذه كفرة إيطاليا قد هجموا على طرابلس الغرب التي هي من أعظم الممالك الإسلامية وأهمها، فخربوا عامرها وابادوا أبنيتها وقتلوا رجالها ونساءها وأطفالها. ما لكم تبلغكم دعوة الإسلام فلا تجيبون، وتوافيكم صرخة المسلمين فلا تغيثون، أتنتظرون أن يزحف الكفار إلى بيت الله الحرام، وحرم النبي والأئمة (ص) ويمحوا الديانة الإسلامية عن شرق الأرض وغربها وتكونوا معشر المسلمين أذل من قوم سبأ، فالله الله في التوحيد، الله الله في الرسالة، الله الله في نواميس الدين، وقواعد الشرع المبين، فبادروا إلى ما افترضه الله عليكم من الجهاد في سبيله، واتفقوا ولا تفرقوا، واجمعوا كلمتكم وابذلوا أموالكم وخذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم، لئلا يفوت وقت الدفاع وأنتم غافلون، وينقضي زمن الجهاد وأنتم متثاقلون ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفونَ عن أَمرِهِ أنْ تُصِيبَهُم فِتنَةٌ أَوْ يُصيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
خادم الشريعة المطهرة محمد كاظم الخراساني، الأحقر الجاني عبد الله المازندراني، الأحقر الجاني شيخ الشريعة الأصفهاني، الأقل علي رفيش، أقل خدام الشريعة محمد حسين القمشة، أقل خدام الشريعة الغراء حسن ابن المرحوم صاحب الجواهر، الأحقر الجاني السيد علي التبريزي، الأقل الجاني مصطفى الحسيني الكاشاني، الراجي عفو ربه محمد آل الشيخ صاحب الجواهر، الراجي عفو ربه الغفور محمد جواد الشيخ مشكور، الأحقر جعفر ابن المرحوم الشيخ عبد الحسن، بسم الله النصار المعين أنا وكل مسلم نستعين، الأقل محمد سعيد الحبوبي.
السيد محسن الأمين – الذي كان المرجع الأعلى في سوريا ولبنان – قال عند احتلال الإيطاليين لطرابلس الغرب بعد احتلال الفرنسيين لبلاد مراكش (المغرب) من قصيدة:
| ما لي أرى الإسلام تمحقها | في كل شارقة أيد أثيمات | |
| أودت بمراكش بالأمس وانهملت | على طرابلس منها البليات | |
| ما بالكم يا بني الإسلام قد غمضت | منكم على الذل أجفان قذيات | |
| ما بالكم يا أباة الضيم قد رضيت | بالضيم أنفسكم وهي الأبيات | |
| نمتم وأعداؤكم يقظى تعدّ لكم | منها الغوائل طورا والخديعات | |
| هذي دياركم عاث العدو بها | وفوقها خفقت للظلم رايات | |
| فبادروا قبل فوت الأمر من يدكم | وامضوا سراعا فللتأخير آفات | |
| تبعتم أمة الإفرنج فابتعدت | بكم عن الخير أفعال وعادات | |
| لانت لكم أمة الإفرنج خادعة | كما تلين ثعابين وحيّات | |
| حيى الإله رجالا في طرابلس | لساحة الحرب قادتها الحميات | |
| ترمي بها بين نيرات المدافع في | هول الحروب نفوس مستميتات | |
| شم ّ الأنوف فلا يرضيهم حكم | في الروع إلا السيوف المشرفيات |
وقال الشيخ عبد المحسن الكاظمي من قصيدة:
| هذي طرابلس تدعوكم لنجدتها | فشاطروها الأسى أو تفرج الإزم | |
| هبّوا سراعاً فأنتم في الندى دفع | من الغمام وأنتم في الوغى عصم |
وقال السيد عبد المطلب الحلي من قصيدة:
| قل لإيطاليا التي جهلتنا | بثبات الأقدام هل عرفونا | |
| أرأيتم ضرب المباتر إنّا | بشبا العزم دونه واثقونا | |
| كم لنا بالواحات عندهم ثأر | عليها الضبا دما قد بكينا |
وقال الشيخ محمد حسين الجعفري من قصيدة:
| أفيرجوالإسلام لقيان سلم | بعد حرب الطليان والبلقان | |
| إن بيض الوجوه سود إذا لم | تغدُ حمراً من النجيع القاني | |
| تركوا دينهم لدنيا سواهم | رُبَّ ربح يكون من خسران | |
| واذا القلب كان أعمى عن الرشد | فماذا تفيده العينان | |
| وإذا ما اليدان لا تدفع الضيم | فأولى بالقطع تلك اليدان | |
| ليت من لا يكون ذا حرّ دين | في البرايا يكون ذا وجدان |
وقال الشيخ محمد رضا الشبيبي من قصيدة:
| أو ما أتاك «ببرقة» نبأ التي | رمت البلاد بمبرق، وبموعد | |
| ماذا يُرجَّى من وراء حضارة | عَمِيَ البصير بها وضلَّ المهتدي | |
| وُجدتْ فأعدمتِ النفوس فضائلاً | خُلقتْ لها فكأنها لم تُوجدِ |
وقال الشيخ محمد باقر الشبيبي من قصيدة:
| فيا إيطاليا اعتقدي بأنّا | سننشرها بأجنحة الظليم | |
| ونضرب بالسيوف لكم رقاباً | ونحمي بالدفاع حمى الحريم |
ومن قصيدة الشيخ عبد العزيز الجواهري:
| فتيات رومةَ نظمي درر البكا | سمطاً يزان بلؤلؤ متنثر | |
| وصفي القلائد للرجال مدامعا | وذرى تمائمهم مكان الجوهر | |
| ودعي الخدور لهم فقد نهبتهم | بيض السيوف بكل ليث مخدر |
ومن قصيدة الشيخ علي الشرقي:
| قوم من العرب لم يُبردْ حميتهم | حرّ الظبا وعلى جمر الثرى بردوا | |
| إنْ فوّرت سورةُ العليا دماءهم | لنهضةٍ فبغير السيف ما قصدوا | |
| ترومُ أبناء روما أن تناضلهم | هيهات لا يستوي الطليان والأسدُ | |
| زرعٌ لرومةَ أهدته طرابلساً | فأهزمَ المحل ابناها بما حصدوا | |
| فأوطانكم بعد عزّ الحفاظ | قد اصبحت نهزة الطامعينا | |
| يسوم الصليب أعزّاءها | – ويا لهف نفسي – ذلاً وهونا | |
| وهذي طرابلس لا تزال | تكابد بالجهد حرباً طحونا | |
| وكنتم إلى صلحنا والسيوف | تأبى لنا الصلح والمسلمونا | |
| فإن طرابلس للمسلمين | جميعاً يحامونها أجمعينا | |
| فلا صلح بيننا أو يفوز | أقوى الفريقين عزماً وديناً |
ومن قصيدة الشيخ محمد حسن أبوالمحاسن:
| شربت إيطاليا كأس العطب | في طرابلس بأسياف العرب | |
| حدّثتها كذباً آمالها | إنها تبلغ بالحرب الإرب |
شاعرا الشيعة الأندلسيان يستنجدان للأندلس
من شعراء الشيعة في الأندلس: محمد بن عبد الله القضاعي، المعروف ﺑ(ابن الأبار) الأندلسي، وابو البقاء الرندي.
والأول هو مؤلف كتاب (درر السمط في خبر السبط) وهو كتاب في سيرة الحسين (ع). وقد نقل صاحب كتاب (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) فصولاً من درر السمط، ثم قال: «ولم أورد منه غير ما ذكرته، لأن في الباقي ما تشمّ منه رائحه التشيع !…».
وقد علق في (أعيان الشيعة) على هذا القول بقوله:
«ولا يخفى أن رائحه التشيع العطرية ونفحاته المسكية مشمومة مما أورده أيضاً لظهوره في إخلاصه في حب أهل البيت الطاهر واعترافه بفضلهم الباهر الذي قلما يطيق كثير من الألسن ذكره أو تستطيع نشره. ولا شك أن ما تركه تحرجاً وتأثماً حتى كأنه من الموبقات رائحة التشيع منه فائحة…».
وترد تفاصيل عن ابن الأبار وعن الشاعر الآخر (أبو البقاء الرندي) في بحث: (الأندلس) فلتراجع هناك. ولا نذكر هنا إلا قصيدتيهما:
أنشد ابن الأبار أمام أمير تونس أبي زكريا الحفصي يستصرخه فيها لنصرة الأندلس المهددة من ملك (أراغون) الذي كان قد أحكم الحصار على (بلنسية) سنة 635هـ/ 1238م.
والقصيدة هي:
| أدرك بخيلك خيل الله أندلسا | إن السبيل إلى منجاتها درسا | |
| وهب لها من عزيز النصر ما التمست | فلم يزل منك عزّ النصر ملتمسا | |
| حاش مما تعانيه حشاشتها | فطالما ذاقت البلوى صباح مسا | |
| يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا | للنائبات وأمسى جدّها تعسا | |
| في كل شارقة إلمام بائقة | يعود مأتمها عند العدى عرسا | |
| وكل غاربة إجحاف نائبة | نثني الأمان حذرا والسرور أسا | |
| تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم | إلا عقائلها المحجوبة الأنسا | |
| وفي بالنسية منها وقرطبة | ما يذهب النفس أوما ينزف النفسا | |
| مدائن حلّها الإشراك مبتسماً | جذلان، وارتحل الإيمان مبتئسا | |
| وصيّرتها العوادي العائثات بها | يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا | |
| ما للمساجد عادت للعدى بيعاً | وللنداء يرى أثناها جرسا | |
| لهفا عليها إلى استرجاع فائتها | مدارسا للمثاني أصبحت درسا | |
| وأربعاً غنمت أيدي العدو بها | ما شئت من خلع موشية وكسا | |
| كانت حدائق للأحداق مونقة | فصوّح النضر من أدواحها وعسا | |
| وحال ما حولها من منظر عجب | يستوقف الركب أوستركب الجلسا | |
| سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا | عيث الدبا في مغانيها التي كبسا | |
| وابتزّ بزّتها مما تحيّفها | تحيّف الأسد الضاري لما افترسا | |
| فأين عيش جنيناه بها خضرا | وأين غضن جنيناه بها سلسا | |
| محا محاسنها طاغٍ أتيح لها | ما نام عن هضمها حينا وما نعسا | |
| ورجّ أرجاءها لمّا أحاط بها | فغادر الشمّ من أعلامها خنسا | |
| خلا له الجو وامتدت يداه إلى | إدراك ما لم تنل رجلاه مختلسا | |
| وأكثر الزعم بالتثليث منفردا | ولو رأى راية التوحيد ما نبسا | |
| صل حبلها أيها المولى الرحيم فما | أبقى المراس لها حبلاً ولا مرسا | |
| وأحي ما طمست منها العداة كما | أحييت من دعوة المهدي ما طُمسا | |
| أيام سرت لنصر الحق مستبقا | وبتّ من نور ذاك الهدي مقتبساً | |
| وقمت فيها لأمر الله منتصرا | كالصارم اهتزّ أو كالعارض انبجسا | |
| تمحوالذي كتب التجسيم من ظُلَمٍ | والصبح ماحية أنواره الغلسا | |
| هذي رسائلها تدعوك من كثب | وأنت أفضل مرجوٍ لمن يئسا | |
| وافتك جارية بالنجح راجية | منك الأمير الرضى والسيد الندسا | |
| خاضت خضارة يعلوها ويخفضها | عبابة فتعاني اللين والشرسا | |
| وربما سبحت والريح عاتية | كما طلبت بأقصى الشدة الفرسا | |
| تؤم يحيى بن عبد الواحد بن أبي | حفص مقبّلة من تربه القدسا | |
| ملك تقلّدت الأملاك طاعته | دينا ودنيا، فغشّاها الرضى لبسا | |
| من كل غادٍ على يمناه مستلماً | وكل صادٍ إلى نعماه ملتمسا | |
| مؤيد لو رمى نجماً لأثبته | ولو دعا أفقاً لبّى وما احتبسا | |
| إمارة تحمل المقدار رايتها | ودولة عزّها يستصحب القعسا | |
| يبدي النهار بها من ضوئه شنباً | ويطلع الليل من ظلمائه لعسا | |
| كأنه البدر والعلياء هالته | تحفّ من حوله شهب القنا حرسا | |
| له الثَّرى والثَريا خطّتان فلا | أعز من خطتيه ما سما ورسا | |
| يا ايها الملك المنصور أنت لها | علياء توسع أعداء الهدى تعسا | |
| وقد تواترت الأنباء أنك من | يحيى بقتل ملوك الصفر أندلسا | |
| طهّر بلادك منهم إنهم نجس | ولا طهارة ما لم تغسل النجسا | |
| وأوطئ الفيلق الجرّار أرضهم | حتى يطأطئ رأسا كل من رأسا | |
| وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت | عيونهم أدمعا تهمي زكا وخسا | |
| هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت | داء متى لم تباشر حسمه انتكسا | |
| املأ هنيئاً لك التمكين ساحتها | جرداً سلاهب أوخطية دعسا | |
| وتضرب لها موعداً بالفتح ترقبه | لعلّ يوم الأعادي قد أتى وعسى |
أبو البقاء الرندي راثي الأندلس
ومن كبار رجال الشيعة الأندلسيين: أبوالبقاء الرندي الذي اشتهر بقصيدة رثى بها الأندلس واستنجد لها، أو هو رثى المدن والبلدان والحصون والمناطق التي سقطت لزمانه، في جملة حركة الاستخلاص العارمة، واستنهض الهمم لاستردادها وحرض على القتال والجهاد.
وقد ولد هذا الشاعر في المحرم سنة 601 هـ وفي عام 674هـ.
تشيّع الرندي
كان الرندي شاعراً كاتباً مؤلفاً، ومن مؤلفاته كتاب (روضة الأنس ونزهة النفس) وهومن كتب الثقافة العامة التي شاع التأليف فيها، والتي كان مثالها البارز كتاب ابن قتيبة (عيون الأخبار).
والموجود من الكتاب هوالجزء الأول، وقد اطلع على النسخة المصورة منه الدكتور محمد رضوان الداية عن الأصل الموجود في مكتبة الأستاذ محمد المنوني.
وفي هذا الكتاب يقول أبوالبقاء:
«وقد رثي الحسين قديماً وحديثاً، وممن بكاه فأحزن، ورثاه وأجاد: أبو بحر صفوان بن إدريس الأندلسي رحمه الله.
ثم يقول أبوالبقاء:
وقد ألمعت بطريقة صفوان رحمه الله في رثائه (ع) بجملة حذوت فيها حذوه، فبلغت شأوه بما هو في المعنى أغرب وإلى الحال أنسب. وذلك أني صنعت مخمسة على حروف المعجم مذيلة بأعجاز من قصيدة زهير، فيها:
| أبيت فلا يساعدني عزاء | إذا ذكر الحسين وكربلاء | |
| فخلّ الوجد يفعل ما يشاء | لمثل اليوم يدّخر البكاء | |
| عفا من آل فاطمة الجواء | بعينك يا رسول الله ما بي | |
| دموعي في اهمال وانسكاب | وقلبي في انتهاب والتهاب | |
| على دار مكرّمة الجناب | عفتها الريح بعدك والسماء | |
| بكيت منازل الصبر السؤاة | بمكة والمدينة والفرات | |
| معالم للعلا والمكرمات | عفت آثارها وكذاك يأتي | |
| على آثارها من ذهب العفاء | ||
قصيدة أبي البقاء في رثاء الأندلس
أنشد هذه القصيدة مستنجداً ببني مرين وقبائل المغرب بخاصة، وسامعي النداء من المسلمين وراء بحر الزقاق بعامة ويدعو إلى الجهاد، ويرثي ما ضاع من بلاد الأندلس. وذلك بعد تحالف إسبانيا والبرتغال وأرغون، وتنازل ابن الأحمر عن عدد كبير من المدن والحصون:
| لكلّ شيئ إذا ما تمّ نقصان | فلا يغرّ بطيب العيش إنسان | |
| هي الأمور كما شاهدتها دول | من سره زمن ساءته أزمان | |
| وهذه الدار لا تبقى على أحد | ولا يدوم على حال لها شان | |
| يمزّق الدهر حتماً كل سابغة | إذا نبت مشرفيات وخرصان | |
| وينتضي كل سيف للفناء ولو | كان ابن ذي يزن والغمد غمدان | |
| أين الملوك ذووالتيجان من يمن | وأين منهم أكاليل وتيجان | |
| وأين ما شاده شداد في إرم | وأين ما ساسه في الفرس ساسان | |
| واين ما حازه قارون من ذهب | وأين عاد وشداد وقحطان | |
| أتى على الكل أمر لا مردّ له | حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا | |
| وصار ما كان من ملك ومن ملك | كما حكى عن خيال الطيف وسنان | |
| دار الزمان على دارٍ وقاتله | وأم كسرى فما آواه إيوان | |
| كأنما الصعب لم يسهل له سبب | يوما ولا ملك الدنيا سليمان | |
| لجائع الدهر أنواع منوعة | وللزمان مسرات وأحزان | |
| للحوادث سلوان يهوّنها | وما لما حلّ بالإسلام سلوان | |
| في الجزيرة أمر لا عزاء له | هوى له أحد وانهد ثهلان | |
| بابها العين في الإسلام فارتزئت | حتى خلت منه أقطار وبلدان | |
| فاسأل بلنسية ما شأن مرسية | وأين شاطبة أم أين جيّان | |
| من قرطبة دار العلوم فكم | من عالم قد سما فيها له شان | |
| واين حمص ما تحويه من نزه | ونهرها العذب فيّاض وملآن | |
| قواعد كنّ أركان البلاد فما | عسى البقاء إذا لم تبق أركان | |
| تبكي الحنيفية البيضاء من أسف | كما بكى لفراق الإلف هيمان | |
| على ديار من الإسلام خالية | قد أُسلمت ولها بالكفر عمران | |
| حيث المساجد قد صارت كنائس ما | فيهنّ إلا نواقيس وصلبان | |
| حتى المحاريب تبكي وهي جامدة | حتى المنابر ترثي وهي عيدان | |
| يا غافلاً وله الدهر موعظة | إن كنت في سنة فالدهر يقظان | |
| وماشياً مرحاً يلهيه موطنه | أبعد حمص تغرّ المرء أوطان | |
| تلك المصيبة أنست ما تقدمها | ومالها مع طوال الدهر نسيان | |
| يا ايها الملك البيضاء رايته | ادرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا | |
| يا راكبين عتاق الخيل ضامرة | كأنها في مجال السبق عقبان | |
| وحاملين سيوف الهند مرهفة | كأنها في ظلام النقع نيران | |
| وراتعين وراء البحر في دعة | لهم بأوطانهم عزّ وسلطان | |
| أعندكم نبأ من أهل أندلس | فقد سرى بحديث القوم ركبان | |
| كم يستغيث بنوها المستضعفون وهم | أسرى وقتلى فما يعتزّ إنسان | |
| ماذا التقاطع في الإسلام بينكم | وأنتم يا عباد الله إخوان | |
| ألا نفوس أبيّات لهم همم | أما على الخير أنصار وأعوان | |
| يا من لذلة قوم بعد عزّهم | أحال حالهم كفر وطغيان | |
| بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم | واليوم هم في بلاد الكفر عبدان | |
| فلو تراهم حيارى لا دليل لهم | عليهم من ثياب الذل ألوان | |
| ولو رأيت بكاهم عند بيعهم | لهالك الأمر واستهوتك أحزان | |
| يا ربّ ام وطفل حيل بينهما | كما تفرّق أرواح وابدان | |
| وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت | كأنما هي ياقوت ومرجان | |
| يقودها العلج للمكروه صاغرة | والعين باكية والقلب حيران | |
| لمثل هذا يذوب القلب من كمد | إن كان في القلب إسلام وإيمان |
الإسلام في أبسط مظاهره
سنحدث الدكتور مؤنس والدكتور مكي وغيرهما حديثاً موجزاً عن التشيع يثبت لهم أنه هو الذي كان يأخذ به ابن الأبار وغير ابن الأبار من أعلام الإسلام الذين نيغوا في الشعر والحكمة والأدب والسياسة والجهاد، من أمثال: الفرزدق وأبي تمام والبحتري والمتنبي وابن الرومي وأبي فراس الحمداني والشريف الرضي، وأمثال: ابن سينا والفارابي ومسكويه وأبي العلاء المعري والخليل بن أحمد وجابر بن حيان وأبو علي الفارسي والبيروني والمسعودي وأبو الفرج الأصفهاني، وأمثال: سيف الدولة الحمداني وعضد الدولة البويهي وأسامة بن منقذ، إلى ألوف من أمثال من عددنا ممن لا يقلون عنهم بروزاً وتشيعاً وآخرهم جمال الدين الأفغاني.
ويوم نحكم على التشيع بمثل ما حكم عليه هؤلاء الدكاترة الأفاضل، وندّعي خروج حَمَلَتِهِ عن الطريق السويّ، فهل يظن هؤلاء الأفاضل أنه يكون في ذلك إنصاف لتاريخ الإسلام وتاريخ نخبة من أفذاذ رجاله.
وإذا كان من عددنا وأمثالهم ممن هم أعرق الناس في التشيع والتمسك به ضالين مضلين، يعودون في عقائدهم إلى اليهودية، فحبّذا هذا الضلال الذي أخرج للعالم الإسلامي الرعيل بعد الرعيل من الأعلام.
رأي الشيعة في الخلافة
إن التشيع جوهره وحقيقته شيء بسيط فطري لا تعقيد فيه ولا انحراف، إنه الأخذ بنظرية أن النبي أعظم وأجلّ وأعقل من أن يترك أمر المسلمين من بعده فوضى، فيقعوا فريسة التذابح على من يتولى سلطة الدولة التي أنشأها مع الدين جنباً إلى جنب، وأن أي إنسان ولو لم تكن له رسالة النبي الإلهية وحكمته الإنسانية، لا يمكن أن ينسب إليه هذا الإهمال، فكيف بمن هو رسول الله ويتمتع في نفس الوقت بعبقرية شخصية فذَّة.
إن هذا في رأي الشيعة لا يمكن أن يقع، وإن الشيعة يرون أن الأقوال الثابت عند جميع المسلمين أن النبي قالها، هي نص أوعلى الأقل إشارة إلى أن الذي يتولى الأمر بعده، هوعلي بن أبي طالب.
حديثان نبويّان
ونحن سنذكر هنا حديثين فقط من تلك الأحاديث الكثيرة التي يستند إليها الشيعة، وهذان الحديثان لم يروهما الشيعة وحدهم، بل وردا في المصادر المعتمد عليها عند غير الشيعة والتي هي المأخذ لكل من كتب في التاريخ والدين:
1 – ما رواه مؤرخ الإسلام الأول «الطبري» ورواه معه غيره من المؤرخين والمفسرين والفقهاء من غير الشيعة من أمثال: البغوي والثعلبي في تفسيره، والنسائي في الخصائص، وصاحب السيرة الحلبية وغيرهم.
قال الطبري في تاريخه وتفسيره ما خلاصته: إنه عندما نزلت آية: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ أولم النبي وليمة دعا إليها عشيرته وبينهم علي بن أبي طالب وكان أصغرهم سنا. فقال لهم النبي: «إنني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم» فأحجم القوم إلا علي بن أبي طالب، فقال النبي: «إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم».
ومن الأعاجيب أن الدكتور محمد حسين هيكل حين بدأ بنشر كتابه «حياة محمد» بدأ بذلك أول ما بدأ في جريدته «السياسية الأسبوعية» فنشر هذه القصة كما رواها المؤرخون، فاعترض عليه معترض بأن هذا يؤيد رأي الشيعة، فردّ بأنه ليس هوالذي يقول هذا القول بل التاريخ هوالذي يقوله. وقد قرأنا قول الدكتور هذا مع من قرأه يوم نشره في السياسة الأسبوعية. وحين طبع طبعته الأولى أورد القصة فيه، ثم صدرت الطبعة الثانية فإذا بالقصة مشوّهة تشويها عجيبا، أفسدها كل الإفساد، وأبطل الغاية المقصودة منها. ولما سأل الناس عن السرّ في ذلك وكيف أن الدكتور هيكل قد دافع عن هذه القصة في جريدته وقال إن هذا ما رواه التاريخ، ثم عاد في الطبعة الثانية فشوّهها وتجنّى على التاريخ، لما سأل الناس عرفوا أن وزارة الأوقاف عرضت على الدكتور أن تشتري من الطبعة الثانية ألف نسخة تدفع ثمنها سلفاً خمس مائة جنية، ولكنها اشترطت عليه أن يشوّه القصة هذا التشويه، فلم ير الدكتور حرجا في ذلك، وكان إغراء الخمسمائة الجنية فوق إغراء الدفاع عن التاريخ. ثم تتابعت الطبعات بعد ذلك وكلها مشوهة.
جريدة السياسة الأسبوعية موجودة، والطبعة الأولى موجودة، والطبعات التالية موجودة.
2 – حديث غدير خم. وقد ذكره من غير الشيعة: الواحدي النيسابوري في أسباب النزول، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في المستدرك، والذهبي في تلخيص المستدرك، وابن كثير الشامي في تاريخه، وصاحب السيرة الحلبية. وقال ابن كثير: أعتني بهذا الحديث – أي حديث غدير خم – الطبري في تاريخه وتفسيره فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه، وكذلك الحافظ الكبير أبوالقاسم بن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة – يعني خطبة يوم الغدير – ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهم كثيرون.
وخلاصة حديث غدير خم هي: أن النبي لما رجع من حجة الوداع ووصل إلى المكان المعروف باسم «غدير خم» أمر بالنزول هناك، فنزل ونزل معه المسلمون جميعاً، ثم وقف ومعه علي بن أبي طالب وخطب خطبة قال فيها: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله».
والشيعة يرون في هذين الحديثين فضلاً عن الكثير من أمثالها من الأحاديث نصاً في الخلافة من النبي على علي بن ابي طالب.
فهل في هذا الرأي تأثير مجوسي أو يهودي أوحتى يوناني كما يقول بعضهم الذي زاد على غيره بأن قال في بعض بحوثه بأن التشيع تأثر بالفرس واليونان.
مزايا علي
ثم إن الشيعة يرون في المزايا الشخصية الرائعة التي كان يتحلى بها علي ما يؤيد قولهم، وأن النبي لم يفعل هذا محاباة لعلي بسبب قربه منه، بل إنما فعله لأن علياً أهل أي أهل لذلك.
مغزى جيش اسامة
والشيعة يرون أن هناك تصرفات معينة تصرفها النبي (ص) في أواخر حياته تؤيد رأيهم، وإلاَّ فما هو التفسير لأن يختار النبي شاباً لم يتجاوز العشرين مثل أسامة بن زيد لقيادة أعظم جيش جهَّزه، وأن يكون في عداد هذا الجيش تحت قيادة اسامة أعاظم الصحابة وشيوخهم أمثال أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم([138]) وأن يستثني من ذلك رجلاً واحداً هو الآخر شاب مثل أسامة، وأن لا يضمه إلى ذلك الجيش، ذاك الشاب الآخر هوعلي بن أبي طالب الذي أجمع المؤرخون على أنه الوحيد من الصحابة الذي لم يدخله النبي (ص) في جيش أسامة.
لم يكن ذلك رأي الشيعة عبثاً، فإن النبي (ص) خشي أن يعترض المعترضون بعده على أن علياً هو شاب فكيف يسود غيره من الشيوخ، فأراد النبي (ص) سلفاً أن ينقض ذلك وأن يولي قيادة الصحابة شاباً مهماً كانت مزاياه فهي بلا شك دون مزايا علي بن أبي طالب، فتسقط بذلك حجة المعترضين على شباب علي، وأنه إنما اسثنى علياً من دخول جيش أسامة لأنه كان يعدّه لمهمة أعظم وأخطر، ولأنه أراد أن يفهم الناس أن علياً بما هو معدّ له لا يمكن أن يكون مقاداً كغيره لأسامة. هذا ما يفسر به الشيعة الشكل الذي ألّف به جيش أسامة. وأحسب أنه لو تخلى أي إنسان عن التقليد الأعمى وتجرّد عن الرواسب المتراكمة، فإنه سيجد أن هذا التفسير معقول جداً، وإلاّ فهل عند غير الشيعة لا سيما الدكاترة الأفاضل وأمثالهم ممن هم موجودون وممن سيوجدون تفسير أولى من هذا التفسير؟.
معارضة إرادة النبي
وهناك شيء آخر هو في رأي الشيعة أخطر من كل ذلك أدَى الى إفساد خطط النبي (ص) وترك الأمة بعده للتذابح والتناحر والفتن الأهلية مما جرَّ على الإسلام والمسلمين أسوأ النتائج وأدَى في النهاية إلى أن تصبح الدولة الإسلامية على غير ما أراده النبي (ص) من إنشاء مجتمع صالح لا مكان فيه لغير العدل والحق والخير، إلى أن تصبح امبراطورية قيصرية لا يتقيد حكامها بقانون ولا نظام، وأن يصبح الشعب فيها مأكلة للطغاة الظالمين.
هذا الشيء الآخر الذي هو أكثر خطراً هو ما رواه جميع المؤرخين على اختلاف ميولهم، وإننا نكتفي بما أورده البخاري في صحيحه إذ أنه فضلاً عن قيمته التاريخية، فإن له قيمة دينية مقدّسة عن غير الشيعة، وأخباره تعتبر ذات أهمية خاصة يحتج بها ويعول عليها. قال البخاري في الجزء الرابع من صحيحه في باب قول المريض قوموا عني في بحث المرض والطب: «لما احتضر رسول الله (ص) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي هلمّوا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر: إن النبي قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، وحسبنا كتاب الله، فاختلف الحاضرون، فاختصموا فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبي كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي، قال رسول الله (ص): قوموا.
يعني أن النبي طردهم من مجلسه بنص البخاري. وروى البخاري في مكان آخر أن الرد على طلب النبي كان: «ما شأنه، أهجر؟» وروى البخاري كما روى غيره أن ابن عباس كان يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم([139]).
وخشي القسطلاني صاحب كتاب (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) أن يظل اسم من ردَ على النبي مجهولا، فأكَد من جديد. وكذلك فعل جميع المؤرخين.
رأي الشيعة في ذلك
إن الشيعة يرون أنه لم يكن يصح أن يقال عن النبي في وجهه وهو مريض مثل هذا القول، وأن يتعارك الناس في مجلس النبي المسجًى المشرف على الموت، وأن الصدور التي اتسعت دائما لتلقي التوجيهات المحمدية كان عليها أن تتسع لتلقي هذا التوجيه الأخير، وأنه ليس من الحق أن يحال بين النبي وبين قول ما يريد لأمته في آخر أيام حياته، وأن الشيعة وغير الشيعة مجمعون أن الموضوع كان يتعلق بتنظيم أمر الخلافة بعده بحيث لا تترك الأمة للفتن. وأنهم يرون أن الاعتراض على النبي ومجابهته بمثل ذلك القول هوالذي أفسد ترتيبات النبي، فحيل بينه وبني الكلمة الأخيرة، فكان ما كان.
ولم يجمع المؤرخون على شيء إجماعهم على رواية هذه القصة، ففيما عدا البخاري نكتفي من أسمائهم بذكر من له صفة خاصة تضفي على أقواله قدسية، وتفرض لها تسليما عند غير الشيعة مثل ابن سعد صاحب الطبقات ومثل القسطلاني شارح البخاري ومثل صاحب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. هذا فضلا عن الطبري وأمثاله.
توبة أحمد أمين غير المقصودة
لقد شاء الله أن ينتقم للشيعة من أحمد أمين بأحمد أمين نفسه، فأنطقه في أواخر حياته بالحق، وجعله – من حيث لا يشعر – يؤيد آراء الشيعة ويؤكد أن سبب وقوع الفتن بين المسلمين هو أنهم لم يعملوا برأي الشيعة في الخلافة.
إن أحمد أمين بعد أن ألّف فجر الإسلام وضحى الإسلام عاش إلى سنة 1952 م، أي حوالي عشرين سنة بعد تأليف الكتابين، وفي السنين الأخيرة فقد بصره، فعاش بقية حياته أعمى، ويظهر أن هذا المصير عاد بأحمد أمين إلى صفاء النفس ونقاء الروح، وجرَّده من نعرة التعصب والتقليد، فألَّف وهو في هذا الحالة آخر كتبه وسمَّاه (يوم الإسلام). وقد ذكر في هذا الكتاب نظريات وآراء هي عين نظريات الشيعة وآرائهم. واندفع يدافع بحماسة عن هذه النظريات والآراء، ولقد كان من أعظم ما أخذه على الشيعة في فجر الإسلام وضحى الإسلام وهاجمهم من أجله وتهكّم عليهم فيه أنهم يقولون بأن النبي لا يمكن أن يترك الأمة فوضى وأنه لذلك نصَ بالخلافة بعده على الأمام علي. والآن لنسمع ما يقوله أحمد أمين نفسه عن عقيدة النص في كتابه (يوم الإسلام): «أراد رسول الله في مرضه الذي مات فيه أن يعيّن من يتولى الأمر بعده، ففي الصحيحين (صحيح مسلم وصحيح البخاري) أن رسول الله لما احتضر قال: آتوني بدواة وورق اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» وكان في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب، قال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف القوم واختصموا فمنهم من قال: قربوا إليه يكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من قال: القول ما قاله عمر: فلما أكثروا اللغو والاختلاف عنده طردهم وقال لهم: قوموا. فقاموا، إنَ ترك الأمر مفتوحا لمن شاء جعل المسلمين طوال عصرهم يختلفون على الخلافة (وهل قال الشيعة إلاَ عين هذا القول الذي يقوله أحمد أمين؟)
وقال أحمد أمين أيضاً: «اختلف الصحابة على من يتولى الأمر بعد الرسول، وكان هذا ضعف لياقة منهم، إذا اختلفوا قبل أن يدفن الرسول».
لقد كان علي بن أبي طالب وحده الذي لا يشمله ضعف اللياقة. هذا الذي ذكره أحمد أمين، إذ أنه بينما كان علي مشغولا بتغسيل النبي وتجهيزه كان كبار الصحابة يتآمرون على الخلافة تاركين النبي جثة ملقاة ليس عندها أحد إلاَّ على وأهل بيته، ولم يحترموا موت النبي الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، ولم ينتظروا دفنه، بل ازدحموا على الفوز بتراثه قبل أن يوارى القبر.
وقال أحمد أمين أيضاً: «بايع عمر أبا بكر، ثم بايعه الناس. وكان في هذا مخالفة لركن الشورى، ولذلك قال عمر: إنها غلطة وقى الله المسلمين شرَّها، وكذلك كانت غلطة بيعة أبي بكر لعمر».
وهل يقول الشيعة أكثر من ذلك؟!!
وقال أحمد أمين أيضاً: «كره كثير من الصحابة أن تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد، ولعلمهم بشدة علي في الحق وعدم تساهله».
وقال: «إن قتل عمر وعلي كان حادثة فردية، أما مقتل عثمان فقد كان ثورة شعبية للأقطار الإسلامية».
هذا ما ذكره أحمد أمين في آخر كتابه له، فماذا نستنتج من ذلك؟
إن نتيجة هذه الأقوال هي ما يلي:
1 – إن مبدأ النص على الخليفة لم تخترعه الشيعة ولم تستورده من الأفكار غير الإسلامية، بل إن مصدره الأول هو النبي نفسه، وأن الذين حالوا بينه وبين أن يكتب النص، هم الذين حالوا دون تنفيذ النص غير المكتوب.
2 – إن ترك النص على الخليفة كان السبب في تفريق الأمة وحدوث الفتن فيها، والسبب في ذلك كان من حالوا بين النبي وبين أن يكتب الكتاب، فمنعوا النبي من تنفيذ ما أراده.
3 – إن بيعة الخليفة الأول والخليفة الثاني لم تكن بالنص من النبي ولا بالشورى بين المسلمين، وإنما كانت مجرد غلطة، أما عثمان فقد ثار عليه الشعب في كل مكان ثورة محددة الأهداف والمطالب.
4 – إن الذين حالوا بين علي وبين الخلافة بعد وفاة النبي إنما فعلوا ذلك لسببين: الأول أن علياً شديد في الحق لا يتساهل به أبدا. والثاني الحسد لأهل البيت والتعصب عليهم، حيث كره الحاسدون المتعصبون أن تجتمع في بيت محمد النبوة والخلافة.
هذه الأمور لم نقلها نحن، وإنما قالها أحمد أمين الذي هاجم الشيعة واعتدى عليهم في كتابيه: (فجر الإسلام) و(ضحى الإسلام) وبهذه الأقوال يكون أحمد أمين قد هدم كل ما قاله عن الشيعة، ويكون قد أيَد آراءهم، إذ أن الشيعة لا يقولون أكثر من هذا الذي قاله أحمد أمين.
ولا بدَّ من جملة واحدة نقولها تعليقاً على أقواله: إننا نقول إذا كان الحسد لأهل بيت محمد هو الذي حمل من حمل على التعصب عليهم وحال بين علي والخلافة لئلاَ تجتمع لهم النبوة والخلافة، وإذا كانت شدة علي في الحق وعدم تساهله فيه كانت السبب في محاربته ومنعه من الوصول إلى الخلافة، فهل من الإنصاف أن يلام الشيعة لأنهم أحبُوا أهل بين نبيهم ولم يحسدوهم ولم يتعصبوا عليهم، ولأنهم أحبّوا علي بن أبي طالب وفضَلوه وكرَموه لتمسّكه بالحق وعدم تساهله فيه؟ هذا تعليقنا الوحيد على أقوال أحمد أمين. ونترك للقارئ المنصف أن يستنتج من أقواله ما يشاء.
.. ورشيد رضا أيضاً
وهناك رشيد رضا أيضاً، هذا الذي ملأ المنار شتما للشيعة، يأبى الله إلاَ أن يرغمه على أن يؤيد آراء الشيعة، فقد جاء في الصفحة 955 من الجزء 12 المجلد 12 من مجلة المنار ما يلي: «لقد حوَّل معاوية شكل الحكومة الإسلامية إلى حكومة شخصية استبدادية جعلت مصالح الأمة كالمال يرثه الأقرب فالأقرب إلى المالك وإن كرهت الأمة كلها، فكان هذا أصل جميع مصائب الأمة الإسلامية».
إذاً فباعتراف رشيد رضا أن معاوية هو أصل جميع مصائب الأمة الإسلامية. ويكفينا هذا من رشيد رضا ليهدم هو بنفسه جميع ما قاله عن الشيعة في مجلة المنار.
الإسلام في أبسط مظاهره
التشيع هوالإسلام في أبسط مظاهره وابعدها عن التعقيد، هو الذي لم يعترف بالحكومات المطلقة والملكيات الاستبدادية والدكتاتوريات الغاشمة. والذي يعترف دائماً بالشعب وحقه وحريته وسعادته.
لم يوال التشيع أشخاصاً لمجرد أنهم ينتمون إلى أسرة معينة، وإذا كان قد والى من سمَّاهم القرآن وسمَّاهم النبي «أهل البيت» فلأن القرآن ولأن النبي قد أمرا بذلك، ولأن هؤلاء حملوا في الإسلام راية الصلاح والإصلاح والدعوة إلى الحرية والعدالة واحترام الشعب، وعندما كان قريب لهؤلاء سواء كان ابناً أو أخاً أو حفيداً يتخلى عن هذه الدعوة، كان الشيعة يتخلون عنه ويحاربونه بنفس القوة التي يحاربون بها أشدَّ أعدائهم، ولا تشفع له عندهم قرابته من اهل البيت وكونه من سلالة محمد وعلي. ومواقفهم من بعض العلويين الناقمين على الأمويين والعباسيين حين كان يتبين لهم أن نقمتهم مجرَّد حركة شخصية لا حركة شعبية ذات مطالب تحررية ومبادئ حق وعدل، إن مواقف الشيعة من هؤلاء واستنكارهم لحركاتهم شيء معروف، وتسميتهم لابن الإمام علي الهادي بجعفر الكذَاب – وهوابن إمام وأخو إمام – وحفيد إمام مشهورة أيضاً.
كما أن التشيع لم يقاوم أشخاصاً لمجرد أنهم ينتمون إلى أسرة معينة، وإذا كان قد قاوم الأمويين مثلاً فلأن الأمويين قد انحرفوا بالإسلام إلى ما هو شر من الجاهلية، ولأنهم اعتبروه مجرَّد تحكم وسيطرة واستغلال. ولأنهم مزَّقوا صفوف العرب بأن أثاروا فيهم العصبية القبلية والأحقاد العشائرية التي قضى عليها الإسلام. ولكن عندما كان أحد الأمويين يعود إلى الطريق المستقيم لم تكن أمويته تحول بينهم وبين احترامه والاعتراف بفضله. وموقفهم من عمر بن عبد العزيز معروف مشهور.
إن كون عمر بن عبد العزيز بن مروان أموياً صميماً، بل وكونه حفيد مروان بن الحكم لم يمنع الشيعة من أن يكنوا له أكبر الاحترام والتقدير، وأن يعتبروه من أعظم رجال الإسلام.
هذا موقف الشيعة من الأموي العريق عمر بن عبد العزيز، وهذا موقفهم من العلوي العريق جعفر بن علي الهادي، وهذا موقفهم من غير هذا أو غير ذاك.
النص وإرادة الأمة
ومن أطرف ما يهاجم به الشيعة، الزعم بأن قولهم بالنص في الخلافة هو تعطيل لإرادة الأمة وابتعاد عن الديمقراطية، وأن قول غيرهم بأن الأمر متروك للناس هو الأقرب إلى الديمقراطية والأكثر احتراماً لرأي الأمة.
وهذا – كما قلت – من أطرف الأمور وأدعاها إلى الضحك والسخرية.
1 – إن الشيعة يقولون بأنه سواء كان الأمر متروكاً للناس أوغير متروك، فإنه من غير المعقول أن يهمل النبي (ص) فلا ينصّ على طريقة الاستخلاف ولا يضع قانوناً ملزماً لها يحول بين المسلمين والفتن، وأن هذا ما أراده في كل تصرفاته، ولكن في الساعة الأخيرة أفسدوا عليه تدبيره برفضهم إحضار ما طلبه من القرطاس والقلم.
2 – إذا اسثنينا الطريقة التي اختير بها أبو بكر وما قيل وما يقال فيها وما قاله حتى عمر وحتى أحمد أمين، فأين احترام إرادة الأمة والديمقراطية في اختيار الخلفاء؟ ألم يتولّ عمر الخلافة بنص من أبي بكر؟ ألم يتولّها عثمان بنص من عمر؟ وإذا قلنا بأن النص كان على أكثر من واحد، فهو نص على كل حال. ولكننا نعلم أنه كان في الحقيقة نصاً على عثمان وحده، وإن جاء ذلك مداورة، لأن صلة عبد الرحمن بن عووف بعثمان وقرابته وإيثاره له كان شيئاً معروفاً. أتمنعون النبي (ص) من ان يكون له حق تنظيم أمر الخلافة بعده والنص على من يراه كفؤا، ثم تبيحون ذلك لمن أوجدهم النبي وهداهم؟ وبماذا كان لأبي بكر(رض) حق لا يجوز أن يكون لمحمد؟!
ثم كيف تولى بعد ذلك الخلفاء أجمعون الخلافة، واين كان رأي الأمة منذ معاوية بن أبي سفيان حتى عبد المجيد العثماني؟ !
إنه يحق حتى لمعاوية وحتى ليزيد أن ينصّا على الخليفة بعدهما ولا يجوز ذلك لمحمد بن عبد الله.
ومن العجيب أن الخليفة الوحيد الذي انتخب انتخاباً شعبيا رائعاً كان علي بن أبي طالب، وأنه وحده الذي اختاره ممثلون للأقطار الإسلامية كلها، كانوا مجتمعين في المدينة من أقصى مصر حتى أقصى البصرة. ولم يشذ عن ذلك إلاَ الشام التي كانت تخضع لحكم فردي استبدادي يسيّرها كيف يشاء.
عوامل تكوين المعارضة الشيعية
السفّاحون يحكمون الإسلام
هذا هو التشيع في بساطته وفطرته، ثم ماذا؟ لقد انتهى الإسلام بعد ذلك إلى عبادات محضة في ظل حكم يفوق كل حكم في تعسّفه وكرهه للشعب، وتآمره عليه وإفقاره واستغلاله لخيراته. وانتهت رسالة الإسلام في تكوين حكم مثالي لمجتمع مثالي، وأصبحت كلمة الحاكم هي القانون وأصبحت الأمة خاضعة لنزوات الحكام وشهواتهم، فلا الدم مصون، ولا الكرامة مصونة، ولا المال مصون، ولا الحرية مصونة، واصبح حاكم واحد مثلا هو سمرة بن جندب عامل معاوية على البصرة يقتل بكلمة ثمانية آلاف مسلم. وأصبح مصعب بن الزبير يقتل سبعة آلاف بكلمة واحدة أيضاً. حتى ليقول له عبد الله بن عمر: أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة، والله لو قتلت عدّتهم غنماً من تراث أبيك لكان ذلك سرفاً! واصبح الحجاج يقتل أكثر من مائة ألف بأكثر من كلمة واحدة. وأصبح قتيبة بن مسلم يقتل ستة عشر ألفاً. وأصبح يزيد بن الملهب يقتل أربعين ألفاً. وأصبح من هم أكبر من هؤلاء ومن هم أصغر على نفس الطريقة لا يردعهم رداع ولا يقف بوجههم واقف.
شتم علي بن أبي طالب
وعدا عن ذلك فهناك السنَّة التي سنَّها معاوية بن أبي سفيان بلعن علي بن أبي طالب على المنابر في المساجد، ومن علي؟ إنه ربيب محمد وتلميذه وخرّيجه، إنه الرجل الذي قدَّم لدعوة النبي أقصى ما يمكن أن يقدمه إنسان من رجولة وبسالة وتضحية ونكران ذات.
قال ابن الأثير وهو يتحدث عن خلافة عمر بن عبد العزيز: «كان بنو أمية يسبّون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز فترك ذلك» وقال الطبري وهو يتحدث عن وصية معاوية للمغيرة بن شعبة: «لا تتوان عن شتم علي وذمه».
وقال الجاحظ في رسائله: أن معاوية كان يقول في خطبته يوم الجمعة: «اللهم العن… الذي ألحد في دينك وصدَّ عن سبيلك، فالعنه لعناً وبيلاً، وعذَّبه عذاباً أليماً» وكتب بذلك إلى من في الآفاق بهذه الكلمات تقرأ على المنابر. ويقول الجاحظ أيضاً: إن قوماً من بني أمية قالوا لمعاوية: فلو كففت عن لعن هذا الرجل. فقال لهم: لا والله حتى يربو عليه الصغير، ويهرم عليه الكبير. ولا يذكر ذاكر له فضلاً.
وعن الأشعث بن سوار قال: سبَّ عدي بن أرطأة علياً على المنبر، فبكى الحسن البصري، وقال: سبَّ هذا اليوم رجل إنه لأخو رسول الله في الدنيا والآخرة.
وروى أبو يوسف قال: خطب مروان بن الحكم في المدينة والحسن البصري جالس. فقال الحسن: ويلك يا مروان أهذا الذي تسبّ هو شرُّ الناس!!.
وقال عمر بن عبد العزيز: كنت أجلس تحت منبر المدينة وأبي يخطب وهو حينذاك أمير المدينة، فكنت أسمع أبي يمر في خطبته فتهدر شقاشقه حتى يأتي إلى لعن علي فيجمجم وتعرض له الفهاهة والحصر، فكنت أعجب من ذلك. فقلت يا أبت أنت أفصح الناس وأخطبهم، فما لي أراك أفصح خطيب يوم حفلك حتى إذا مررت بلعن هذا االرجل صرت ألكن عيياً؟ فقال: يا بني إن من ترى تحت منبري لوعلموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لما تبعنا منهم أحد، فوقعت كلمته في صدري، وأعطيت الله عهداً إن كان لي في هذا الأمر نصيب لأغيّرنه. ولما منَ الله عليَ بالخلافة أسقطت ذلك. وذكر المبرد في الكامل أن خالد بن عبد الله القسري كان والياً على العراق في خلافة هشام بن عبد الملك فكان يلعن علياً على المنبر ويقول: اللهم العن… ابن هاشم صهر رسول الله على ابنته وابا الحسن والحسين. وقال ابن الأثير في الجزء الثالث: دعا معاوية المغيرة بن شعبة وهو يريد أن يستعمله على الكوفة، فقال له في كلام:
«وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتماداً على بصرك ولست تاركاً إيصاءك بخصلة واحدة: لا تترك شتم علي وذمّه». وجاء في كتاب (مدينة دمشق عند الجغرافيين والرحالين المسلمين) نقلاً عن ابن الفقيه الهمداني في مختصر كتابه عن البلدان: خرج الوليد حاجاً فمرَّ بمسجد النبي (ص) فدخله فرأى بيتاً ظاعناً في المسجد شارعاً بابه. فقال: ما بال هذا البيت؟ فقيل: هذا بيت علي بن ابي طالب، أقرَّه رسول الله (ص) وردم سائر أبواب أصحابه. فقال: إن رجلا نلعنه على منابرنا في كل جمعة، ثم نقرّ بابه ظاعناً في مسجد رسول الله (ص) من بين الابواب! إهدم يا غلام. وجاء في معجم البلدان وهو يتحدث عن مدينة (سجستان): لعن علي بن أبي طالب على منابر الشرق والغرب، ولم يلعن على منبرها إلاَ مرة، وامتنعوا على بني أمية حتى زادوا في عهدهم: أن لا يلعن على منبرهم أحد. ثم يقول ياقوت: وأي شرف أعظم من امتناعهم عن لعن أخي رسول الله وهو يلعن على منابر الحرمين مكة والمدينة.
وقال المسعودي في مروج الذهب: «كان أهل حران قاتلهم الله حين أزيل لعن أبي تراب – يعني علي بن ابي طالب – عن المنابر يوم الجمعة امتنعوا عن إزالته وقالوا: لا صلاة إلاَ بلعن أبي تراب، وأقاموا على ذلك». وقال أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني في ترجمة (العبيلي) عبد الله بن علي، وهو شاعر أموي النسب «كان أبوعدي الشاعر يكره ما يجري عليه بنو أمية من ذكر علي صلوات الله عليه، وسبه على المنابر ويظهر الإنكار لذلك».
وقال في العقد الفريد فيما حكي عنه: «لما دخل معاوية مكة أراد أن يلعن علياً على المنبر، فأنكر ذلك سعد بن ابي وقاص». وقال الشعبي: «كنت أسمع خطباء بني أمية يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على منابرهم وكأنما يشال بضيعة إلى السماء». وقال المسعودي في مروج الذهب: «جعلوا لعن علي سنَة ينشأ عليها الصغير ويهلك الكبير».
معاملة فاطمة
ثم كان قبل ذلك المعاملة التي عوملت بها فاطمة بنت محمد، وهي معاملة أقل ما يقال فيها أنها لا تليق أن تعامل بها وحيدة النبي الاثيرة لديه الحبيبة إلى قلبه.
مدار الفكرة الشيعية
كان كل ذلك وكان ماهو أكثر منه وما هو مثله، فكان من الطبيعي أن لا ترضي تلك التطورات نخبة من المسلمين يعلمون أن الإسلام ليس هو الحكم الذي تمثله مجازر معاوية ويزيد وسمرة بن جندب وزياد والحجاج وقتيبة وابن المهلب واضرابهم، وأنه ليس لمثل هذا جاءت الرسالة الإسلامية وأن شتم علي بن ابي طالب على المنابر هوشتم ضمني لمحمد الذي كان عليّ اقرب الناس إليه، وأن اسرة محمد الذين سمّاهم القرآن (أهل البيت) يجب أن تحفظ – على الاقل – كرامتهم فضلاً عن حقوقهم ودمائهم.
هذا هو مدار الفكرة الشيعية بعد أمر النص على الخلافة، فماذا في ذلك؟ وهل يرى الدكتور مكي وغيره من الدكاترة في هذا أمراً معيباً أم أمراً مشرفاً؟ وهل هذا مدسوس من وحي مجوسي وفكر يهودي؟
قضية حجر بن عدي
وتطورت الأمور فإن رجلاً مثل الصحابي الجليل حجر بن عدي الكندي أحد أبطال الفتوح في الشام، وأحد المفكرين الأحرار الشجعان القلائل رأى في استمرار شتم علي بن ابي طالب عاراً لا يحتمل، لا سيما إذا كان هذا الشتم من رجل مثل زياد بن أبيه، من أكبر مفاخره أنه سليل وربيب المومس سمية غانية الخمارات، وأن هذا الشتم هو تحدٍ للإسلام الذي كان علي أخلص المنفّذين لتعاليمه، وتحدٍ لمحمد الذي لم يكف عن الثناء على علي في كل مناسبة. ورأى حجر أنه ما دام لا يستطيع أن يمنع ذلك بالقوة، فلا أقلَّ من أن يستنكر ذلك استنكاراً جريئاً، وهكذا فعل هو وعصبة كريمة من إخوانه، فكانت دماؤهم ثمن دفع العار الذي كان يجلل المنابر الإسلامية حين يشتم على أعوادها بطل الإسلام حبيب محمد وربيبه وزوج ابنته فاطمة وأبو سبطية الحسن والحسين، فتحدّوا زياد علانية في المسجد([140]) وأحدثوا الأثر المطلوب، فساقهم زياد إلى معاوية.
بطل
وقبل أن يسوقهم استدعى إليه أحدهم صيفي بن فسيل، فلما صار عنده قال له زياد: يا عدو الله ما تقول في أبي تراب؟ قال صيفي: ما أعرف أبا تراب. قال زياد: ما أعرفك به. قال: ما أعرفه. قال: أما تعرف علي بن أبي طالب؟ قال: بلى. قال: فذاك أبو تراب. قال: كلا. فذاك أبو الحسن والحسين. فقال له صاحب الشرطة: يقول لك الأمير: هو أبو تراب، وتقول أنت: لا؟ قال: وإن كذب الأمير، أتريد أن أكذب واشهد له على باطل كما شهد!؟ قال زياد: وهذا أيضاً من ذنبك. عليَ بالعصا. فأتى بها، فقال زياد: ما قولك في علي؟ قال: أحسن قول أنا قائلة. قال زياد: اضربوا عاتقة بالعصا حتى يلصق بالأرض. فضرب حتى لزم الأرض، ثم قال: أقلعوا عنه، إيه ما قولك في علي؟ قال: والله لو شرّحتني بالمواسي والمدى ما قلت إلاَ ما سمعت مني. قال زياد: لتلعننّه أو لأقتلنك. قال: إذن تقتلني قبل ذلك. قال زياد: إدفعوا في رقبته. ثم قال أوقروه حديداً وألقوه في السجن([141]).
ثم أرسله بعد ذلك مع حجر إلى معاوية، فقتله مع من قتل.
أبطال
وهنا تجلَى حلم معاوية على حقيقته([142]) وأراد أن يفسد الأثر الذي تركته حركة حجر، وحسب أن حجراً الأسير المقيد المهدد بالموت سيضعف أمام شبح القتل، فأرسل إليه وإلى جماعته يطلب مطلباً واحداً لا يكلفهم شيئاً سوى كلمة تلفظها شفاههم، أرسل يقول لهم: تبرؤوا من علي يخل سبيلكم وتعودوا إلى أهلكم، فإن لم تفعلوا فإنه القتل. ولكن حجراً واصحابه أذكى من أن يجهلوا نوايا معاوية، وأشجع من أن يهابوا الموت، رفضوا أن يتبرأوا من علي، وتمسكوا بموقفهم البطولي. لقد كان معاوية يعلم كما كان حجر يعلم أن تبرؤهم من علي هو أكبر نصر تحرزه فكرة شتم علي بن أبي طالب، وأن حجراً حين يفعل ذلك إنما يمهد لدوام فكرة الشتم واستمرارها وموت كل معارضة لها. لذلك رفض هو ورفض من معه أن يتبرأوا من علي، وصمموا على استقبال الموت فقتلوا جميعاً. وهكذا كان تصرف معاوية هذا التصرف مع حجر واصحابه هو أحطّ ما يمكن أن تصل إليه وسائل الحكم وأساليبه.
لقد كان حجر في واد وهم في واد آخر، وكانوا أحقر من ان يصلوا بمثلهم الخسيسة إلى الذروة التي يمكن أن يصل إليها مثل حجر بن عدي الشامخة.
هذه هي الحركات الشيعية، فأي شنار فيها يخجل منه أصحابها، ونحن نعود فنسأل الدكاترة الأفاضل: من أي مصدر مجوسي ومن أي فكرة يهودية استوحى حجر وأصحابه موقفهم الشيعي العظيم هذا؟!
التشيّع تيَّار شعبي تحرري
منذ مقتل حجر وأصحابه أصبح التشيّع تياراً شعبياً يقود حركة تحررية تريد أن تعيد الحكم الإسلامي إلى الطريق السوي الذي شقَه محمد، وعندما ندقّق في أحداث التاريخ نرى أن ذاك التيَار كان موضع عطف الجماهير، وكان هذا يختلف باختلاف الناس، فهو طوراً كتوم وطوراً جهير، طوراً مسالم وطوراً ثائر. إلى أن تولى يزيد بن معاوية الحكم، فكانت الطامَة الكبرى، ورأى الحسين أن التسليم بخلافة يزيد تدهور إسلامي مريع، وأن السكوت عليها سيكسبها شرعية لا يفيد معها أي عمل بعد ذلك. لهذا صمّم على القيام بحركة احتجاج ضخمة تفسد المخطط الأموي في الانحراف بالإسلام انحرافاً كاملاً، وتقدَم هو بنفسه ليضرب المثل لمن يمكن أن يحاولوا ما حاول، وتقدَم معه اقل من مائة رجل كانوا في تفاصيل مواقفهم والتفافهم حول الحسين وصمودهم معه شيئاً عجيباً وفوق التخيّل.
فلهوزن وحركة حجر
تعجب «يوليوس فلهوزن» الألماني في كتابه (الخوارج والشيعة) من عطف الرأي العام الإسلامي على حجر وصحبه واستفظاعه قتلهم، وكأنَّ «فلهوزن» يرى أن قتلهم كان أمراً طبيعياً لا ينافي الإسلام، فلماذا إذن يستفظع المسلمون قتلهم، وراح يتكلَف تعليل ذلك بصورة تدل على جهله بحقائق الإسلام والتاريخ، وجهله بشخصية حجر نفسه، ثم تاريخ تلك الحقبة من حياة المسلمين. لقد علَّل مواقف الراي العام الإسلامي بما معناه أن المسلمين لا يجيزون قتل أحد إلاَ إذا كان قاتلاً. وبما أن حجراً واصحابه لم يقتلوا أحداً فقد استفظع المسلمون قتلهم، مع ان الخروج على السلطة يوجب القتل.
ويبدو أن «فلهوزن» لم يدرس قضية حجر، بل مرَّ بها مروراً عابراً وفاتتة تفاصيلها. فاعتقد أن حجراً خارج على السلطة، وبما أن الخروج على السلطة يوجب القتل فقد قتل فلا موجب إذن للاستنكار والاستفظاع.
ولقد فات «فلهوزن» أن حجراً لم يكن خارجاً على السلطة. وفاته أيضاً أنه حتى الخروج على السلطة كان في تلك الحقبة هو العمل الشرعي في نظر الرأي العام الإسلامي، ولذلك كان يعطف على كل ثورة تقوم ضدَّها.
إن عمل حجر لم يتعدَ ما ندعوه في اصطلاحنا مظاهرة احتجاج على شتم علي بن أبي طالب على منابر المسلمين، وهو نتيجة استفزاز مثير من الحكم الذي يمثله زياد، لم يستطع معه الصحابي الشجاع المؤمن صبراً، ولما طورد رفض أن يقاتل وصاح بمن تجمعوا حوله ليقاتلوا دونه: أن يتفرقوا ثم سلَّم نفسه متحملاً نتيجة عمله مهما كانت النتيجة، وليس في الدنيا قانون يجيز قتل من يفعل فعل حجر.
وإذا كان حجر قد تحدّى زياداً بنفسه علناً دون رهبة، وإذا كان الشعب المتجمع في المسجد قد تجاوب كلَه مع حجر، فلماذا اختير مع حجر هذه المجموعة من الرجال، ولماذا أخذ هؤلاء بالجريرة من دون سائر الناس، وعلى أي اساس تمَّ اختيارهم؟
الحقيقة أنه لم يقل أحد من المؤرخين أن واحداً منهم قام بعمل معيَّن يستحق عليه حتى عقوبة السجن، فضلاً عن عقوبة الموت، ولكن هؤلاء كانوا معروفين بنزعتهم التحررية ومشهورين بأنهم من اخلص أصحاب علي. فقد جاءت الآن الفرصة للقيام بمجزرة جديدة يقضى فيها على كل ذي رأي حرّ يأبى العبودية والإذلال، ولا يرضى بالظلم والفساد. وهكذا رأينا معاوية «الحليم» يفعل بهم ما فعل غير متقيد حتى بما قطعه على نفسه من نسيان الماضي.
وإذا كان «لفهوزن» متأثراً بقواعد نيتشه وكتاب (الأمير) وجذور النازية، فقد كان يجب عليه أن يذكر بأن الإسلام إنما جاء ليضع حداً لأعمال العسف والجور والتصرفات الكيفية في الحكم على الناس وسفك دمائهم.
ومع ذلك فإن كان فعل حجر يوجب له الموت، فقد كان يجب قتله حالاً وعدم معاملته تلك المعاملة اللئيمة المتجردة من كل إنسانية وخلق ونبل. وقد صارحه قاتلوه بأنهم لا يقتلونه لأنه فعل ما فعل، بل لأنه لا يتبرأ من علي. وهل عدم التبرؤ من علي، من أي رجل كان فضلاً عمن هو في منزلة حجر يوجب الحكم بالموت؟!!
الرأي العام الإسلامي وراء الشيعة
وليس ما كتبه «فلهوزن» إلاَّ صدى لما اعتمل في نفسه خطأ من اندهاش لنقمة الرأي العام الإسلامي على الحكم القائم وعطفه على المعارضة الشيعية الباسلة بسالة الاستشهاد في سبيل ما تؤمن أنه الحق، وفي سبيل عدم الانحراف بالإسلام عن حكم مثالي في عدله إلى حكم لا مثيل له في جوره.
وظلَّ الشيعة بعد ذلك يقودون الحركة التحررية الشعبية ممثلين الجماهير الإسلامية في نقمتها وثورتها المكبوتة، وكانت هذه الجماهير تعضد بشتى ضروب التعضيد كل حركة شيعية، وكان كبار الفقهاء في طليعة العاطفين على المعارضة الشيعية المؤيدين لها، فمثلاً نرى أنه عندما لم يجد زيد بن علي بن الحسين بداً من إعلان ثورة مسلَّحة قادها بنفسه على الحكم الأموي، كان أوَّل المؤيدين له أبو حنيفة، فأفتى بوجوب الخروج معه، وكذلك فعل يوم قامت ثورة شيعية أخرى في العهد العباسي بقيادة النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب في الحجاز تعضدها ثورة أخرى في نفس الوقت بقيادة أخيه إبراهيم في العراق، فعضد أبو حنيفة هذه الثورة أيضاً، وحرَّض على الالتحاق بها، وأمدَّها بالمال. وكذلك انضمَّ إلى إبراهيم رجال من غير الشيعة كانوا من أبرز رجال مجتمعهم فقهاً وعلماً ومكانةً، مثل: بشير الرحال، والأعمش، وسليمان بن مهران، والقاضي عباد بن منصور صاحب مسجد عباد في البصرة، والمفضل بن محمد، وسعيد بن الحافظ في عشرات من نظرائهم. وللتدليل على تحمّس أبي حنيفة لتلك الثورة نورد بعض ما قاله أبو الفرج الأصبهاني عن هذا الموضوع بالذات. قال أبو الفرج: إن أبا حنيفة كان يجهر في أمر إبراهيم جهراً شديداً، ويفتي الناس بالخروج معه. وذكر أبو الفرج كذلك أنه كتب إلى إبراهيم يشجّعه. كما روى أبو الفرج أن أبا إسحاق الفزاري جاء إلى أبي حنيفة فقال له: ما أتقيت الله حيث أفتيت أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل؟ فقال له أبو حنيفة: قتل أخيك حيث قتل يعدل قتله لو قتل يوم بدر، وشهادته مع إبراهيم خير له من الحياة. فقال له الفزاري: ما منعك أنت من ذاك؟ قال: ودائع الناس كانت عندي.
وقد ذكر أبو الفرج كما ذكر غيره عدة قصص من هذا القبيل. وهذا كله يشير إلى أن الرأي العام الإسلامي كان يرى في الحركات الشيعية وسيلة نجاته، وأن التشيع قد أصبح التيار الشعبي الذي تتعشقه الجماهير الظامئة إلى الحرية والعدالة.
مظاهر عطف الرأي العام الإسلامي
وليس أدل على ذلك من أنّ موظفي الدولة أنفسهم الذين كان يوكل إليهم الحكام التصدي لذلك التيار، كانوا يحمونه ما استطاعوا ذلك، ففي حركة إبراهيم هذه عندما اضطرَّ إبراهيم للتواري أوَّل الأمر، وكان المنصور قد وضع الجند على الجسور والمعابر فلا يسمحون لأحد باجتيازها إلاَ إذا كان يحمل جوازاً، ليضيق الخناق على إبراهيم فيقبض عليه، احتال سفيان بن حيَّان القمي – أحد كبار رجال إبراهيم – على المنصور، وأظهر له أنه رجع عن الولاء لإبراهيم، وأنه ينوي التفتيش عليه وإحضاره إلى المنصور، وطلب جوازا له ولغلامه، فأعطاه المنصور الجوازين، فلبس إبراهيم ثياب الغلمان، ولما أراد عبور قنطرة المدائن قدّم سفيان الجوازين لصاحب القنطرة. فتركهما وقال لسفيان: ما هذا غلام، هذا إبراهيم، إذهب راشداً.
ولما طورد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن ابي طالب، ولجأ إلى مصر سنة 220 هـ في عهد المعتصم، روى خادمه هذه القصة التي تريك تعلق الشعب بكل طبقاته بالمعارضة الشيعية ورجالها الأبطال. قال الخادم: «ضاقت بالقاسم المسالك واشتدَّ الطلب، ونحن مختفون معه خلف حانوت إسكافي. فنودي نداء يبلغنا صوته: برئت الذمة ممن آوى القاسم بن إبراهيم وممن لا يدل عليه، ومن دلَّ عليه فله ألف دينار، ومن العير كذا وكذا.. والأسكافي مطرق يسمع ويعمل لا يرفع صوته. فلما جاءنا قلنا له: أما ارتعت؟ قال: ما ارتياعي منهم، ولو قرضت بالمقاريض بعد إرضاء رسول الله في وقايتي لولده بنفسي.
فهذا الأسكافي الفقير الذي يمثل رجل الشعب في ذلك الوقت عرّض نفسه لخطر الموت بتستّره على القاسم، ورفض الثروة المعروضة عليه.
هذا في العصر العباسي، أما قبل ذلك في العصر الأموي فمعاملة الجماهيرالإسلامية لزين العابدين علي بن الحسين في الكعبة تريك كيف كان التشيع هو أمل الناس، وكيف كان الناس ينظرون الى الأئمة ممثلي التشيع وقادته، وأن القوة وحدها هي التي كانت تكبت عواطف الناس، وتحول بينهم وبين التعبير عن عواطفهم، حتى إذا وجدوا متنفّساً برزت تلك العواطف أعمالاً وأقوالاً.
لقد التقى زين العابدين وهشام بن عبد الملك – وهو ولي للعهد – في الكعبة معاً، يريد كل منهما أن يستلم الحجر الأسود، فحين تقدم هشام حالت الجماهير بازدحامها بينه وبين الوصول، وفجأة يقبل علي بن الحسين زين العابدين، فما أن تقع أعين الناس عليه حتى يملكها احترامه ويسودها إجلاله، فتفرج له عن طريق الحجر الأسود، فيمضي إليه تحوطه القلوب وترعاه النفوس.
هكذا عامل الناس ممثل السلطة والرجل الثاني في الدولة، وهكذا عاملوا ممثل الشعب والرجل الأول في الشيعة.
وهؤلاء الحجاج المزدحمون حول الكعبة لم يكونوا من بلد واحد أوعشيرة واحدة، بل كانوا مجتمعين من انحاء العالم الإسلامي كله وممثلين لجميع الأقطار. إلاَ أن يقول الدكاترة الأفاضل بأنهم كانوا يهوداً ومجوساً.
ومن هذا الحادث تستطيع أن تدرك أية هوَّة كانت بين الشعب وحكَّامه، وأن هؤلاء الحكَّام لم يكن يربطهم بالشعب إلاَ رباط القوة وحدها. وبالفعل فكثيراً ما عبّر هذا الشعب عن سخطه على الحكام لا بالعواطف والأقوال فحسب، بل بتجريد السلاح والثورة عليهم.
وقعة الحرة
وثورة أهل المدينة، مدينة الرسول على يزيد معروفة وهي أصدق مثال على ذلك، فإن أهل المدينة الذين آووا الرسول وحموه وكانوا أنصاره، والذين شبَّ الإسلام في ديارهم فتشبعوا بروحه، لم يصبروا على الحكم الأموي الممثل بيزيد وأعوانه، فثاروا عليه ثورة عارمة، فأرسل يزيد لإخضاعهم مسلم بن عقبة، وفي صدر يزيد من الحقد عليهم ما لم يستطع إخفاءه، فقد كانت تتمثل له وقعة (بدر) وما لقيه أهله فيها من الهزيمة والذل، وكان يتذكر كيف أن اباه نجا لأنه فرّ ركضاً على قدميه حتى تورمتا، وكان يتصور أهل المدينة وقد أذعنوا لمحمد (ص) ومشوا معه إلى بدر، فأصاب أسرته ما أصابها.
وكان ذلك كله في ذهن يزيد وهو يوصي مسلم بن عقبة بما يفعله بأهل المدينة. لقد صفًى حسابه مع محمد ومع علي فقتل ولدهما الحسين، وقتل معه جمعاً من أحفادهما وابناء عمهما، وحمل رؤوسهم إليه في الشام زيادة في التشفّي، ثم أراد أن ينتقم لجدّته هند بالذات، هند التي قتل علي بن ابي طالب وعمه حمزة – بأمر النبي – اباها وعمهما وأخاها في في معركة بدر، فساق نساء محمد وعلي إليه سبايا.
أجل لقى صفَّى حسابه مع محمد وعلي، وبقي حسابه مع أهل المدينة الذين سمَاهم النبي (ص) الأنصار، والذين كان لهم شرف نصرته في بدر، والذين هزمت سيوفهم جموع أهل يزيد في تلك الوقعة. وقد جاء الآن وقت تصفية حسابه معهم، فما زال يستفزّهم حتى ثاروا، فأرسل إليهم جيشاً كثيفاً بقيادة مسلم بن عقبة، وأمره أن يبيح المدينة لعسكره ثلاثة أيام، وأن يأمر الناس بأن يبايعوه على أنهم عبيد رق ليزيد.
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان وهو يتحدث عن الحرة: ودخل جنده المدينة، فنهبوا الأموال، وسبوا الذرية، واستباحوا الفروج، وحملت منهم ثمانمائة حرَّة وولدن، وكان يقال لأولئك الأولاد: أولاد الحرة. ثم أحضر الأعيان لمبايعة يزيد بن معاوية، فلم يرض إلاّ أن يبايعوه على أنهم عبيد يزيد بن معاوية، حتى ابن تيمية اعترف فقال: وهو يتحدث عن يزيد: «فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوَّابه وأهله، فبعث إليهم جيشاً وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثاً، فصار عسكره في المدينة ثلاثاً يقتلون وينهبون ويفتضّون الفروج المحرَّمة..»
وسار ابن عقبة إلى مدينة الرسول يحمل هذه الأوامر، فعمل على تنفيذها حرفياً، فأباح المدينة ثلاثة أيام لجنوده يهتكون الأعراض، ويقتلون بقايا الصحابة وأبناء الصحابة، ويسلبون الأموال. ثم ساق الناس إليه يبايعونه على أنهم خول عبيد ليزيد بن معاوية، يحكم في دمائهم وأهليهم وأموالهم ما شاء، ومن أبى قتل.
وهكذا رأى أبطال بدر وابناؤهم الذين بايعوا محمداً بيعة الرضوان وبيعة العقبة، رأوا أنفسهم يبايعون اليوم هذه البيعة التي أوردنا نصَّها كاملاً، يبايعونها لحفيد أبي سفيان الذي هزموا حزبه وتغلبوا على أهله تحت لواء محمد (ص) في بدر، فجاء اليوم هذا الحفيد ينتقم لجده واسرته وجاهليته من أنصار محمد.
وهكذا رأوا أنفسهم وقد استحالوا عبيداً لحفيد أبي سفيان عدوهم وعدو نبيهم بالأمس، ورأوا أعراضهم تهتك، وشرفهم يدنس، وأموالهم تسلب، ودماءهم تراق وكرامتهم تداس.
لقد ولد بعد هذه الوقعة في المدينة مئات المواليد لا يعرف لأحد منهم أب، كما أن الرجل كان إذا أراد أن يزوج ابنته لا يضمن بكارتها ويقول: لعلَّها اصابها شيء يوم الحرة. وقد تعمد يزيد أن يختار لاستباحة مدينة الرسول (ص) مسلم بن عقبة بالذات إمعانا منه في الانتقام من محمد (ص) ومن الإسلام. وذلك أن النبي (ص) كان قد وجَّه أسامة بن زيد إلى بني غطفان فهزمهم وأسر منهم، وكان مسلم بن عقبة هذا من بين الأسرى، فعاش في المدينة عبداً إلى أن أعتقته امرأة من الأنصار، فكان اختياره لقيادة الجيش انتقاماً من الإسلام والمسلمين الذين أسروه. (راجع أنساب الأشراف – الجزء الرابع – القسم الثاني – الصفحة 40).
وهكذا صفّى يزيد حسابه مع أنصار محمد، بعد أن صفَّى حسابه من قبل مع محمد نفسه ومع علي، وراح ينشد ابياته المشهورة:
| ليت أشياخي ببدر شهدوا | جزع الخزرج من وقع الأسل | |
| لأهلّوا واستهلّوا فرحا | ثم قالوا يا يزيد لا تشل | |
| قد قتلنا القرم من ساداتهم | وعدلنا ميل (بدر) فاعتدل |
معاوية هو الذي بدأ اضطهاد الأنصار
ومن قبل كان معاوية قد بدأ اضطهاد الأنصار وإهانتهم، وحرَض شاعره على أن يقول فيهم:
| ذهبت قريش بالمفاخر كلها | واللؤم تحت عمائم الأنصار |
ولما جاء وفدهم ليقابله في دمشق، وذهب حاجبه ليقول له إن وفد الأنصار في الباب، تضايق وانزعج من كلمة الأنصار، وقال لحاجبه: قل لهم ليدخل أبناء قيلة وهو الاسم الذي عرفوا به في الجاهلية، وفي ذلك قال شاعرهم:
يـــا سـعد لا تجـــب النــــداء فمـا لنــا لــقب نجـيـب به سوى الأنصــــــــار
لقد كانت كلمة الأنصار تهزّ كيان معاوية، فيتذكرهم يوم بدر وكيف قُتِلَ جده وعمه وخاله وأخوه، وكيف فرَ هو على قدميه حتى تورمتا، ويذكر كيف كان الأنصار يوم ذاك، ويذكر أن محمدا إنما سماهم الأنصار لنصرتهم له في هذه المعارك. لذلك رأيناه يتعمد إهانتهم ويرفض أن يستقبلهم يحملون اسم الأنصار، ويناديهم باسمهم الجاهلي، ورأيناه يطرب لهجائهم ويحمي هاجيهم.
لقد فعل معاوية ذلك وهو يعلم أن محمداً (ص) قال فيهم: «لو سلك الناس شعباً، وسلكت الأنصار شعباً، لسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار».
فلهوزن
وفلهوزن المتقدم ذكره لم يكن سطحيا في التحدث عن حركة حجر وحدها، بل كان أكثر سطحية وهويتحدث عن «الحسين» فقد قال:
(لم يكد يصطدم بأول مقاومة حتى انهار). وقال: (اكتفى بأن ينظر إلى أنصاره وهم يموتون في القتال من أجله وابقى على نفسه حتى اللحظة الأخيرة).
إن فلهوزن لم يستطع أن يفهم كيف كان الحسين آخر قتيل فعبَّرعن ذلك بمثل هذا القول، لم يستطع أن يفهم أن أنصار الحسين وأهل بيته قد صمموا على أن لا يقتل الحسين وهم أحياء، وأنهم قرروا أن يموتوا دونه عن آخرهم، لم يفهم ذلك، ولم يفهم أنها خطة وضعها أنصار الحسين لأنفسهم، وكيف أن الحسين طلب من اصحابه أن يدعوه لأن القوم لا يريدون أحدا سواه فرفضوا، كما أنَه لا يستطيع أن يفهم المعاني التي تشير إليها هذه الخطة. وإذا كان الحسين قد انهار كما يقول فلهوزن فكيف يفسر صموده الصمود العجيب، وإصراره على السير في خطته مهما كانت النهاية؟ والمنهار يفقد كل قواه المعنوية وينشل تفكيره ويصبح شلوا في صورة إنسان، فهل كان باستطاعته فلهوزن أن يدلنا على موقف واحد كان فيه الحسين ضعيفاً، فضلاً عن أن يكون منهاراً. لم يكن أسهل من الحياة للحسين، لو كان لا يبغي إلاَ الحياة المريحة، ولكن الحسين ليس من الرجال الذين يرضون براحة الجسد مع تعب النفس، إنه من الرجال الذين لا يستطيع أمثال فلهوزن سبر أغوارهم والنفوذ إلى أعماقهم. وإذا كان فلهوزن يقول عن الحسين بعد اكثر من ألف وثلاثمائة سنة ما قال، فإن أعداء الحسين الذين شهدوه وأبصروه بعيونهم يخالفون فلهوزن في القول ويرون في الحسين غير ما رأى، فاسمع شهادة عدو من أعداء الحسين خرج لقتاله والقضاء عليه، ولكنه لم يستطع إلاَ أن ينفعل برجولة الحسين فقال يصفه: «فوالله ما رأيت مكثوراً قط قتل ولده وأهل بيته واصحابه أربط جأشاً ولا أمضى جِناناً ولا أجرأ مقدماً منه. والله ما رأيت قبله ولا بعده مثله، وإن كانت الرجالة لتشد عليه، فيشد عليها بسيفه، فتنكشف عن يمينه وعن شماله، ولقد كان يحمل عليهم فينهزمون من بين يديه، ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلَّا بالله».
وأمثال هذا كثير في كتاب فلهوزن. والأغرب من فلهوزن هو معرّب كتابه الدكتور عبد الرحمن بدوي الذي يقول مثلاً في مقدمته عن رأي الشيعة بالأئمة الأثني عشر ما يلي بالنص: «.. وهذا التعليم مصدره الإمام المعصوم وحده، ومن هنا اقترن به السحر والتنجيم والطلسمات والمخاريق، ولا بدّ لهم – أي الشيعة – من أجل ذلك أن ينتحل زعماؤهم صفات النبوة والرسالة، بل وأحياناً الألوهية. ومن أجل تفسير ذلك يقولون مثلاً أن روح القدس هي الله، وصارت في النبي، ثم في علي ثم في الحسن ثم في الحسين إلى آخر الأئمة الاثني عشر». ثم ينهي الدكتور بدوي كلمته بقوله: «فهؤلاء إذن آلهة حلَّت فيهم روح القدس على التناسخ الواحد عقب الآخر» إلى آخر ما قاله من هذا ونحوه.
وجوابنا الوحيد للدكتور بدوي هو ما قلنا مثله لغيره: إن مثل هذا الكلام إن أضرَّ بأحد فإنما يضرّ بسمعة الدكتور العلمية، وإن أساء إلى أحد فإنما يسيء إليه وحده كباحث دارس وإن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن الدكتور بدوي أجهل الناس بهذه البحوث.
الخضرة شعار العلويين
ومن عجيب ما يسير عليه فريق من الناس أن أي حدث ينسب إلى التشيع مهما كان هذا الحدث بسيطاً أوغير بسيط فلا بدَّ له عندهم من التعديلات، فالأستاذ طه الراوي مثلا وهو يكتب عن بغداد ويشير إلى جعل المأمون عليا الرضا وليا لعهده، وأمره باستعمال اللون الأخضر شعاراً لدولته بدل اللون الأسود، إن الأستاذ الراوي لا يمكن أن تفوته هنا التعليلات والتأويلات فهو يضيف إلى ذلك قوله: «فأرجف أعداء المأمون بأن اللون الأخضر يرمز إلى لون النار، وإنما اختاره الفضل بن سهل تقربا إلى المجوسية التي كان يدين بها من قبل». إن الأستاذ الراوي لا ينسب هذا القول إلى نفسه، بل ينسبه إلى أعداء المأمون، ولكنه يورده بشكل يحاول فيه تركيزه في الأذهان، أو على الأقل يترك بذور شك وارتياب.
ولماذا كلّ هذا لأن الخضرة هي شعار العلويين مثلما كان البياض شعار الأمويين والسواد شعار العباسيين، إذن فلا بدّ من إلقاء شبهات على هذا اللون ما دام العلويون قد اتخذوه شعاراً لهم، ولو كانت هذه الشبهاتمن السخافة بمكان أي مكان..
أن يتخذ الأمويون البياض شعاراً فهذا شيء طبيعي، وأن يتخذ العباسيون السواد شعاراً فهذا شيء طبيعي أيضاً، أما أن يكون للعلويين شعار كغيرهم فهذا ما يجب تشويهه وعدم السكوت عليه، وكيف نفعل ذلك؟ وبعد إعمال الفكرة رُئِيَ أن أحسن شيء أن نقول أن الخضرة رمز إلى النار، وأن النار شعار المجوسية، ثم رئي تثبيتاً لذلك أن نقول أن صاحب فكرة اتخاذ الخضرة شعاراً للعلويين هو الفضل بن سهل لا العلويون أنفسهم.
ولكننا نقول لهؤلاء الإخوان بكل بساطة. ما رأيكم فيما ذكره المؤرخون وهم يصفون زحف النبي إلى مكة ويشيرون إلى ما أمر به عمه العباس من «أن يحبس ابا سفيان عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله» وأن العباس نفَّذ أمر النبي فأخذت القبائل تمر فيقول من هؤلاء يا عباس حتى مر رسول الله (ص) في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار.
ما رأيكم بهذه الخضرة التي اتخذها النبي شعارا لكتيبته؟ أهي رمز إلى النار، نار المجوس؟!
ثم ايها الإخوان ما علاقة الخضرة بالنار، والنار تأتي على الأخضر واليابس؟
إن الخضرة هي شعار العلويين من قبل أن يخلق الفضل بن سهل وأبو الفضل بن سهل وحفيد الفضل سهل، وظلَّت شعارهم بعد ابن سهل وحفيد الفضل سهل. وليس هذا كل ما في كلمة الراوي من غمز ولمز، ولكن ذكرنا هذا كشاهد فقط ونذكر معه شاهدا آخر.
بين البويهيين والسلجوقيين
وعندما وصل الأستاذ الراوي إلى ذكر البويهيين كان لا بد له من إنصافهم فقال عنهم: وفي عهد بني بوية وصل العلم والأدب في بغداد إلى القمة العليا، فنشأ أكابر المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين والمؤرخين والكتَّاب والشعراء وأساطين علوم العربية والحذَّاق في المعارف الكونية».
إلى أن قال: «وكان لبعض ملوكهم آثار في العمران وحسنات على أهل الفضل واقمار الأدب، ففي عهدهم تولّى الوزارة في إيران أبو الفضل بن العميد وابنه أبوالفتح والصاحب بن عباد، وفي بغداد أبو محمد المهلبي الذي أفاض على رجالات العلم والأدب سيباً من حسناته وفيضاً من نعمه».
وختم الأستاذ الراوي كلامه بهذا القول: «على أنه لا ينكر أن القوم أيقظوا الفتن المذهبية، ونفخوا في نارها؛ حتى أخذ بعض المسلمين يستحل دم بعض».
أما الذنب الذي اقترفه البويهيون وأدَّى إلى أن يصمهم الأستاذ بما وصمهم به فهو أنهم كانوا شيعة، فلم يشفع لهم عنده كل ما أورده من الصفات. إن كل ما فعله البويهيون هو أنهم حكموا فوجدوا الشيعة مضطهدين محرومين من أبسط حقوق الإنسان في حرية العقيدة والرأي، فأعادو الأمور إلى طبيعتها، وأطلقوا الحرية للناس في أن يختاروا عقيدتهم ومذهبهم، وحالوا بين أحد والاعتداء على غيره، وأباحوا للشيعة أن يحتفلوا بذكرى استشهاد الحسين. ولم يتجاوزوا في تصرفاتهم هذا الحد، فكانوا عند الأستاذ الراوي موقظين للفتن المذهبية نافخين في نارها وبسببهم أخذ بعض المسلمين يستحل دم بعض.
ونحن نسأل الأستاذ الراوي: إذا كان استحلال بعض المسلمين دم البعض الآخر سببه البويهيون، فكيف استحلَّ قادة حرب الجمل دم السبابجة فأمروا بذبحهم، فذبحوا منهم أربعمائة كالغنم، وكيف استحلوا دم الثلاثمائة المسلم من عبد القيس فذبحوهم أيضاً؟
إذن فاستحلال بعض المسلمين دم البعض الآخر ليس سببه البويهيون. هذا ما ذكره الأستاذ الراوي عن البويهيين، فلنر ما ذكره عن السلجوقيين: لقد اكتفى وهو يشير إلى إحراقهم لدور الكتب بقوله عن مكتبة دار سابور بن أردشير: «واحترقت هذه الخزانة في فاتحة استيلاء السلاجقة على بغداد».
أما حقيقة ما فعله السلاجقة فهو الجدير بأن يوصف بأفظع من «إيقاظ الفتن والنفخ في نارها» فإنهم في حال وصول أول ملوكهم طغرل بك إلى بغداد سنة 447 هـ كان أول ما فعله أن نفخ في نار الفتن، ثم زاد النفخ وتأجيج النار حتى أشعل النار الحقيقية لا النار المجازية في مكتبة من أعظم ما شهدته العواصم الإسلامية من مكتبات([143]) لا لشيء إلا لأن منشئ هذه المكتبة لم يكن على مذهبهم.
لقد أنشأ هذه المكتبة أبو نصر سابور وزير بهاء الدولة البويهي، وكانت من دور العلم المهمة في بغداد، بناها هذا الوزير الأديب في محله بين السورين في الكرخ سنة 381 هـ على مثال (بيت الحكمة) وجمع فيها ما تفرَّق من كتب فارس والعراق، واستكتب تآليف أهل الهند والصين والروم، كما قاله محمد كرد علي في خطط الشام([144]). وزادت كتبه على عشرة آلاف من جلائل الآثار ومهام الأسفار، وأكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلفين. قال ياقوت الحموي([145]): لم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها، كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة واصولهم المحررة إلخ.. وكان منها مائة مصحف بخط ابن مقلة على ما ذكره ابن الأثير([146]). وقد كان هذا الوزير سابور من أهل الفضل والأدب، فأخذ العلماء يهدون إليه مؤلفاتهم، فأصبحت مكتبته من أغنى دور الكتب ببغداد. ولما أخذ السلاجقة عند وصولهم إلى بغداد «بإيقاظ الفتن المذهبية والنفخ في نارها» كان من بعض نتائج ذلك أن أحرقت هذه المكتبة العظيمة فيما أحرق من محال الكرخ.
ثم استمرَّ إيقاظ الفتن المذهبية والنفخ في نارها حتى وصل الأمر إلى العالم الكبير أبي جعفر الطوسي وأصحابه فأحرقو كتبه وكرسيَه العلمي الذي كان يجلس عليه للتدريس.
قال ابن الجوزي في حوادث سنة 448 هـ: وهرب أبو جعفر الطوسي، ونهبت داره. ثم قال في حوادث سنة 449 هـ: وفي صفر من هذه السنة كبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ، وأخذ ما وجد من دفاتره وكرسيّ كان يجلس عليه للكلام، واخرج إلى الكرخ، واضيف إليه ثلاثة سناجق بيض كان الزوار من اهل الكرخ قديماً يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة، فأحرق الجميع إلخ([147])..
الدكتور حسين مؤنس أيضاً
بعد كتابة هذا البحث قرأنا للدكتور مؤنس بحثاً في مجلة عربية كبرى شتم فيه الدولة الفاطمية مجرد شتم، ثم ادعى عليها بعض الدعاوى، ولما كتبنا للمجلة نناقش الدكتور مناقشة موضوعية نشرت المجلة شيئاً مهما مما كتبنا وحذفت شيئا أهم. وصدف أن كان الدكتور يقيم في نفس البلد الذي تصدر فيه المجلة فأطلعوه – قبل النشر – على ما كتبناه، فكان له – على الأغلب – أثر في عدم نشر ما لم ينشر من ردّنا، ومع ذلك فقد كان ما نشروه كافياً لدحض دعاوى الدكتور، فكان كل ما أجاب به أن أستشهد بقول واهٍ لرجلين غربيين. وعدنا إلى العدد السابق من المجلة المذكورة – السابق للعدد الذي نشروا فيه استشهاده بالأجنبيين الغربيين – فرأيناه ينعى على من يستشهدون بالأجانب الغربيين عند بحثهم للشؤون الإسلامية والعربية!.
مصير الذين خذلوا التشيع
أعداء محمد كانوا أعداء علي
القول المأثور: «من أعان ظالماً سلَّطه الله عليه» لا ينطبق على الأفراد في علاقاتهم الخاصة بقدر ما ينطبق عليهم في علاقاتهم العامة وارتباط هذه العلاقات بمصالح الأمة وشؤون الدولة.
ولقد رأيت في تاريخنا من هذا القبيل عجباً أي عجب، ففي الوقت الذي انحسر فيه المد التحرري بتولي الخليفة الثالث الخلافة وإطلاق يد أسرته في شؤون العرب والمسلمين تعتبرها نهباً مقسماً بينها، ثم في الوقت الذي عادت فيه حركة الإسلام التقدمية نظاماً رجعياً إقطاعياً استثمارياً بتولي معاوية بن ابي سفيان الحكم، في هذا الحين بالذات وعندما أدرك العرب والمسلمون الأحرار الذين على تضحياتهم قامت ثورة الإسلام العظيمة بقيادة الرسول الأعظم (ص) عندما أدركوا الخطر المهدد لمستقبل الإسلام والعرب من جراء الردة الأموية، تكتّلوا كلهم حول الزعيم الفريد الذي صمَم على حماية مكاسب الثورة الإسلامية وعدم التفريط بها، تكتَلوا كلهم حول علي بن أبي طالب.
تكتلوا كلهم في هذا الصف، فلم تلق فيه إلاَّ كلَّ من عذب وشرد واضطهد وضحى في سبيل الإسلام وحركته العالمية الرائعة تحت لواء محمد (ص) ولم تلق في الصف الآخر إلاَّ كل من سبق له أن قاتل محمداً واعتدى عليه، ولم يُسْلِم إلَّا بعد أن لاحت طلائع النصر الإسلامية. ولم يكن من الصدف أن يكون أبو بكر إلى جانب محمد في معركة بدر، ويكون ابنه عبد الرحمن إلى جانب المشركين يقاتل محمداً وصاحب محمد اباه. ليس من الصدف أن لا يكون عبد الرحمن بن أبي بكر هذا نفسه يوم التقت الفئتان من جديد في جانب علي بل في الجانب الآخر، وأن يجرّد على علي وصاحب علي أخيه محمد بن أبي بكر نفسه السيف الذي جرَّده على محمد وصاحب محمد أبيه أبي بكر في بدر. وليس من الصدف أن يكون قادة الفريق المناوئ لعلي كلهم من قاتل قبل اليوم محمداً هو أو أبوه، إذا كان أبوه قد مات قبل صفين.
أبو الأعور السلمي
ولقد عجبت مرَّة حين رأيت أن أبا الأعور السلمي من قادة الجيش المقاتل لعلي في صفين لم يرد له ذكر في من قاتلوا محمداً في مفتتح الدعوة، ولم يقل مؤرخ أن له يدا في ما نال محمداً واصحابه من أذىً وتعذيب، عجبت أن يخرج على علي من لم يسبق له الخروج على محمد، ولكن عجبي لم يلبث أن زال حين قرأت يوماً أسماء رؤساء الأحزاب الذين حاصروا محمداً (ص) بقيادة أبي سفيان، فأتقى النبي حصارهم بالخندق الذي أشار بحفرة سلمان الفارسي، فإذا بي أجد بين اولئك الرؤساء إسماً هو «سفيان بن عبد شمس السلمي» الذي كان حليفاً لحرب بن أمية والذي كان في وقعة الخندق يقود بني سليم، وقد حرص المؤرخ الذي عدد الأسماء على أن يشير إلى أن هذا هو والد أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية في صفين([148]).
نفس السيوف
وعند ذلك أدركت أن السيوف جميعها التي سُلَّت على محمد في معاركه عادت فسلت من جديد على علي في معاركه، وأنه إذا كان لم يدرك عليا، فإنه قد أورث سيفه لابنه الذي أدرك عليا.
وهكذا فقد كانت المعارك التي خاضوها ضد عليّ امتداداً للمعارك التي خاضوها ضد محمد (ص) ولكن الأخيرة تلبست بلباس الإسلام بعد أن جرّدته من جوهره، وحولته من مجتمع إلى حكم فردي يسوده الاستبداد والظلم والإقطاع والباطل والسلب والنهب والقتل.
سعد بن أبي وقَّاص
قلت إن العرب والمسلمين الأحرار جميعهم تكتَلوا حول علي لحماية التراث الإسلامي والحفاظ على رسالة محمد (ص) ولكن الأمر لم يخل من شذوذ، فإن نفراً قليلاً أخطأهم الصواب، فوقف بعضهم على الحياد يشهد المعركة عنيفة حامية دون أن يساهم في نصرة الحق. والحياد في مثل هذا المقام هو انتصار ضمني للباطل.
هذا الفريق المحايد ويمثله: سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر. مضافاً إلى الفريق الذي إنحاز إلى الباطل من أول ساعة ويمثله: المغيرة بن شعبة. مضافاً كذلك إلى الفريق الذي غدر بالحق وهو في أحرج ساعاته وأدقّ ظروفه فارتد عليه وخانه وخذله، ويمثله: الأشعث بن قيس. هؤلاء الفرقاء جميعاً لم أجد أحداً ينطبق عليه القول المأثور المتقدم: من أعان ظالما سلَطه الله عليه، كما ينطبق عليهم.
انتهى الأمر بالصحابي سعد بن أبي وقاص، جليس محمد ورفيق أبي بكر وعمر وسادس القوم إسلاماً وقائد القادسية، انتهى الأمر به لأن يضطر إلى الوفود على رجل مثل معاوية، إلى الوفود على رجل كان أقصى ما يتمناه ذلك الرجل أن يظفر بنظرة عطف من سعد ومن رفاق سعد، بنظرة عطف تنقذه يوم فتح مكة من الزراية والمهانة إن لم يكن من الموت. اضطرَّ سعد إلى الوفود على معاوية والاستماع إليه يؤنبه ويبكته ويهينه.
وإذا كان سعد قد وقف على الحياد، فإن ابنه عمر بن سعد قد انغمس في الباطل وغرق فيه، وهكذا فإن الأب حايد فلم ينصر الحق، والابن نصر الباطل أيّ نصر. ومات الأب بعد أن أبصر مصيره بعينيه، مصيره وقد عاد شخصاً لا يحفل به ولا يسأل عنه، ملايين الأشخاص الذين يمشون في الصباح والمساء دون أن يشغلوا ذهناً أو يثيروا سؤالاً، شخصاً ناله من تَبْكِيت معاوية وتأنيبه وتحقيره ما يحطم الكبرياء، ويغضّ من الكرامة، وينكّس الرأس، نال كل ذلك بعد الصحبة لمحمد (ص) وبعد القيادة الكاسحة والأمرة الظافرة.
ثم أراحه الموت قبل أن يصير إلى شرّ مما صار إليه، مات دون أن يعلم بما كان مخبَّأ له، ودون أن يدري القصاص الذي أعدَّته المقادير له في الغيب جزاء خذلانه للحق، ونصر ابنه للباطل.
محمد بن سعد بن ابي وقاص
كان لسعد ولد آخر هو محمد بن سعد، وقد عاش هذا الولد حتى أدرك الردَّة الأموية وقد بلغت ذروتها واسفرت عن وجهها إسفاراً كاملاً، لقد عاش حتى رأى رجلاً مثل الحجاج يهينه ويحقره، ثم تناول عوداً وأخذ يضربه على رأسه حتى أدماه. فاستعطفه المسكين ثم قال له: إن رأيت أن تكتب إلى عبد الملك بن مروان فإن جاءك عفو كنت شريكاً في ذلك محموداً، وإن جاء غير ذلك كنت قد أعذرت. فأطرق الحجاج ملياً ثم قال: اضرب عنقه. فضرب عنقه. هذه هي النتيجة الحتمية لمثل الموقف الذي وقفه سعد بن أبي وقاص ثم ابنه عمر. وبسيف سعد نفسه الذي أبى أن يجرّده لنصرة الحق، وبسيف ابنه عمر الذي جرّده لنصرة الباطل أُهين ابنه الآخر محمد وضُرب ثم قُتِل([149]).
عبد الله بن عمر
أبَى عبد الله بن عمر أن يبايع علياً بن أبي طالب، ووقف على الحياد كسعد بن ابي وقاص، ثم عاش إلى أن دخلت جيوش الأمويين إلى المدينة بعد وقعة الحرَّة بقيادة مسلم بن عقبة، فإذا هذا الذي يرفض خلافة علي بن أبي طالب يجبر على أن يبايع مع غيره من الذين أمرهم القائد الأموي بأن يبايعوه على أنهم عبيد أرقَّاء ليزيد بن معاوية، وقد بايع عبد الله بن عمر هذه البيعة لأنه لو لم يبايعها لقتل.
رفض عبد الله بن عمر أن ينصر علياً بن أبي طالب، فيكون في طليعة الأحرار حماة الحق، فألجأه الزمن لأن يسير مرغماً في صفوف العبيد والأرقَّاء، ولأن يعترف على نفسه بأنه ليس من الحرية في شيء، بل هوعبد ذليل. وأكثر من هذا: عاش عبد الله بن عمر حتى أدرك الحجاج، فإذا بالحجاج يهينه ويقول له: اسكت فإنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك. ويهدده بالقتل قائلا: يوشك شيخ أن يؤخذ فتضرب عنقه فيجر.. وبالفعل أرسل إليه من اغتاله، ثم منع من أن يُدفن حيث أوصى. وقد ظلَّ عبد الله بن عمر بعد أن رأى ما صار إليه المسلمون والعرب يظهر ندمه على أن لا يكون قاتل الفئة الباغية مع علي([150]).
وكما أصيب عبد الله بن عمر بما أصيب، فقد أُصيب عبيد الله وسليمان ابنا عاصم بن عمر بن الخطاب، فقتلتهما سيوف الأمويين يوم الحرة في المدينة. وقبل ذلك لما جاء معاوية إلى المدينة ليأخذ البيعة لولده يزيد دخل عليه عبد الله بن عمر، فقال له معاوية: «لا مرحباً بك ولا أهلاً، وسبَّه. فقال عبد الله: إني لست أهلاً لهذه المقالة. فقال معاوية: بلى ما هو شرٌّ منها»([151]).
ولم تكن ذرية عمر بن الخطاب وحدها التي نكبت وأُصيبت، بل شاركتها في المحنة ذرية أبي بكر. أُصيب عبد الرحمن بن أبي بكر فأُهين ورُوِّع وشتمه مروان بن الحكم لأنه اعترض على بيعة يزيد وتناوله بقبيح القول، واضطرت عائشة للدفاع عن أخيها، فشتمت مروان وشتمت أباه([152]) وقال له معاوية: هممت بأن أقتلك. وقال له: لا تظهر لأهل الشام فإني أخشى عليك منهم. فاضطر للاستتار والتواري، ولم يلبث أن مات مقهوراً مهاناً، وربما مسموماً([153]).
كما أصيب أخوه محمد بن أبي بكر فقتل أشنع قتلة. وتوالت المحن على أسرة أبي بكر فأُصيبت ابنته أسماء بالذل، وذبح سبطه ابنها عبد الله بن الزبير بين يديها.
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث
أما الفريق الذي يمثله الأشعث بن قيس وأبناؤه، هذا الفريق الذي تخلَّى عن دعوة الحق بعد أن ماشاها، فلم يكن مصيره في أبنائه بأحسن من مصير الفريق الأول.
فهذا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الذي رأى بعينيه ما أدَّى إليه تخاذل جدّه وخذلانه للحق، ثم تأييد أبيه وعمه للباطل، ومشاركة عبد الرحمن الذي أبصر المصير البشع الذي عاد إليه حكم الإسلام، ورأى أن السيل سيجرفه هو بالذات، اضطرَّ للثورة على الحجاج فكانت نهاية حياته عبرة للمعتبرين. فإنه بعد لجوئه إلى «رتبيل» لم يحفظ فيه رتبيل الذمام، بل باعه هو وإخوته وأقربائه بأرخص ثمن، فأحضره هو وثلاثين من أهل بيته ما بين أخٍ وولد وابن عم وقد أعدَّ لهم الجوامع والقيود، فألقى في عنقه جامعة، وفي عنق أخيه جامعة، وأرسل بهم إلى الحجاج، وكان عبد الرحمن يعلم لؤم الحجاج، فعزَّ عليه أن يصل إليه وهو في هذا الحال، فاغتنم وهو في الطريق فرصة انشغال حرَّاسه فانتحر بإلقاء نفسه من فوق قصر كانوا ينزلونهم فيه، فمات. ولمَّا رأى ذلك الموكلون بهم احتزوا رأسه وقتلوا بقية أهله وأرسلوا رأسه ورؤوسهم وامرأته إلى الحجاج، فبعث بالجميع إلى عبد الملك.
مطرف بن المغيرة بن شعبة
وفي الفريق الثالث الذي آزر الباطل من أول ساعة يبرز لنا: المغيرة بن شعبة، كما يبرز: مسلم بن عمرو الباهلي. وسنكتفي بهما مثلين من عشرات الأمثلة.
فمواقف المغيرة في خذلان الحق ونصرة الباطل شهيرة لقي جزاءها أبناؤه لا سيما منهم: مطرف. وإذا كان المغيرة قد نشأ نشأة جاهلية وكان سبب إسلامه أن قتل قتيلاً ولجأ إلى المسلمين معلناً إسلامه ليتخلَّص من ملاحقة أهل القتيل، إذا كان المغيرة كذلك، فإن أولاده قد نشأوا في ظل الإسلام وشبّوا عليه، وكان فيهم نزوع لنصرة الحق، على عكس ما كان يحسب الحجاج بن يوسف الذي قرَّبهم إليه وولاَّهم الولايات أملاً في أن يكونوا مثل أبيهم أعوان الباطل ونصراء الحجاج على الظلم والرجعية والاستبداد.
لقد خيَّبوا ظنَّ الحجاج بمجرد أن شاركوا في الحكم معه، فإنهم وهم خارج الحكم كانوا بعيدين نوعاً ما عن الصورة البشعة التي كان يحكم بها العرب والمسلمون، فلمَّا شاركوا في الحكم، واطَّلعوا على دخائله، وعرفوا ما يراد منهم إنفاذه في الناس، هاجت فيهم كوامن الخير، فأبت ضمائرهم أن يحملوا تلك الأوزار التي لا يمكن أن يحملها حرٌ كريم.
وقد كان المبرز فيهم بذلك أحدهم «مطرف» الذي ولاَّه الحجاج على المدائن، فلم يطق تنفيذ أوامر الحجاج، ولمس بيده وأبصر بعينيه المصير الذي انتهى إليه حكم العرب والمسلمين.
أبوه وأمثال أبيه من الانتهازيين الرجعيين الوصوليين هم الذين قام عليهم هذا الهيكل الفاسد المجرم، أيعقّ أباه أم يعقّ العرب والمسلمين، أيستمر في التعاون مع هذا الحكم الذي كان أبوه من أقوى دعائم تركيزه، أم ينفض يديه منه، ويجلس في بيته معتزلاً حتى يقضي الله بقضائه، أم يثور عليه؟
إنني أتخيل الصراع النفسي الرهيب الذي كان يعتمل في نفس مطرف بن المغيرة بن شعبة. مهما كان أبوه فهو أبوه، وليس يسيراً على الإنسان أن يعقّ أباه، وأي عقوق؟ عقوق يبرز المغيرة على حقيقته العارية عوناً للظالمين ونصيراً للطغاة وشريكاً للرجعيين.
ولكن هنا شعباً يعاني شرّ أنواع الحكم، وأمه ترزح تحت ضربات الحرمان والاستبداد وسفك الدماء والإبادة الجماعية، ومطرف واحد من هذه الأمة قدِّر له أن يكون ذا ضمير حي ونفس حرَّة وإرادة كريم.
لم يطل أمد الصراع، وانتهى مطرف إلى ما هو مفروض أن ينتهي إليه أمثاله من الأحرار. فاستهتر بالولاية الممنوحة له، واستهان بالسلطة المعطاة إليه، وهزئ بالجاه والنفوذ، وقرَّر أن يكون ثائراً مشرّداً مع الثوار المشرّدين، ورأى أن خير برٍ بأبيه هو أن يكفّر بدمه عن جرائر ذاك الأب، وهكذا فقد قاد ثورة يائسة لا تطمع بنصر، ولكنها تطمع بتنبيه الناس وبعث الآمال في صدورهم ليظلوا دائماً نزَّاعين إلى الحرية.
تخلى عن ولايته طائعاً، وخاطب الشعب بمثل قوله: إني أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظلمة العاصين على أحداثهم التي أحدثوا. أو بمثل قوله: ما زلت لأعمال هؤلاء الظلمة كارهاً أنكرها بقلبي وأغيّرها ما استطعت بفعلي وأمري. أو بمثل قوله: إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى قتال الظلمة. أو بمثل قوله: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى جهاد من عَنَدَ عن الحق واستأثر بالفيء.
ثم مضى ثائراً مع عصبة من الأحرار يقارع بهم ما استطاع القراع، حتى سقط قتيلاً، فأسرع جنود الطغاة كعادتهم البشعة، فاحتزّوا رأسه، وأرسلوه إلى أسيادهم. إن المغيرة بن شعبة لقي في أولاده جزاء ما جنته يداه في حياته.
قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي
كان مسلم بن عمرو الباهلي من أعوان الباطل المندفعين في نصرته، المتفانين في تأييده، وكان نذلاً لئيماً لا مروءة فيه ولا ذرة من الشهامة. ولن نشير إلاَّ إلى موقف واحد من مواقفه، وذلك حين وقع مسلم بن عقيل في الأسر في الكوفة بعد معركة مضنية أُثخن فيها بالجراح، فلما وصلوا به إلى قصر ابن زياد، وقد جفَّ حلقه ويبس لسانه عطشاً، رأى على الباب قلة فيها ماء بارد، فقال: اسقوني من هذا الماء.
وكان مسلم بن عمرو الباهلي حاضراً فقال له: أتراها ما أبردها، لا والله لا تذوق منها قطرة. ومنعهم أن يسقوه، فقال له ابن عقيل: ما أجفاك وأفظَّك وأقسى قلبك.
وانتصر مسلم بن عمرو الباهلي، وقتل مسلم بن عقيل بن أبي طالب ظامئاً، وأرسل رأسه إلى الملك الأموي يزيد بن معاوية في دمشق. ونجحت دعوة الباطل بأمثال مسلم الباهلي، وأصبح ابنه قتيبة والياً على خراسان زمن الحجاج طاغية الأمويين. وهنا يطل علينا القول المأثور: من أعان ظالماً سلَّطه الله عليه.
فإن قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي، ابن الرجل الذي رفض أن يسقي الظامئ المقبل على الموت، ومنع عنه قلة الماء البارد، ابن هذا الرجل وجد نفسه فجأة وقد وصل إليه أذى الباطل الذي نصره أبوه ونصره هو نفسه، ورأى أن الظلم الذي أعاناه وكانا من أركانه قد وقف يتحداه ويتحفز للوثوب عليه، وإذا به وهو في عنفوان قوته وأوج سلطته يشعر بأن الأرض بدأت تهتز تحته، وأن الذين كان يدهم قد أصبح هدف انتقامهم. ورأى نفسه مضطراً لأن يتملق الشعب الذي طالما نفّذ فيه أوامر البطش والغدر والحرمان والتشريد والترويع، وإذا به يقف في جموع العراقيين النازلين خراسان فيقول لهم مستنصراً بهم: انسبوني تجدوني عراقي الأم، عراقي الأب، عراقي المولد، عراقي الهوى والرأي والدين.
يريد بذلك أن يثير إقليميتهم على أهل الشام الحاكمين وعلى الأمويين المتربعين على عرش دمشق المهددين له اليوم بالموت، ويسترسل في القول: إن الشام أب مبرور، والعراق أب مكفور، حتى متى يتبطح أهل الشام بإفنيتكم وظلال دياركم([154]).
اليوم أصبح العراق في نظر ابن مسلم الباهلي أباً مكفوراً، أما يوم كان أبوه يحول بين الظامئ وبين الماء فلم يكن العراق أباً مكفوراً، ويوم كان أبوه يتبطح بأفنية العراقيين وظلال ديارهم، وكان هو إلى جانبه ينتظر الولايات والأحكام فقد كان يرضيه أن يكون الشام أباً مبروراً، وعلى من يريد هذا الباهلي أن يدجل وأن يقول أنه عراقي الهوى والرأي والدين؟ أعلى العراقيين الذين أذاقهم هو وأبوه وأسياده وأسياد أبيه ما لا يمكن أن يذيق أقسى منه حاكم لشعبه؟ وأين كان العراقيون يوم كان هو وأبوه صنيعتي الطغاة ومنفذي أوامرهم والمتطوعين لمنع الماء عن الجرحى العطاشى.
ولم يفد الباهلي تملقه، ولا أجداه إثارة النعرة الإقليمية، فانتهى الأمر به إلى حمل رأسه إلى دمشق نفسها التي حمل إليها رأس مسلم بن عقيل من قبل، إلى سليمان بن عبد الملك حمل رأس ابن مسلم بن عمرو الباهلي.
والفرق الوحيد بين الموقفين هو أنه لو استقى قتيبة وهو جريح عطشان لما قال له أحد مثل قول أبيه: أتراها ما أبردها لا والله لا تذوق منها قطرة، بل لأسرع إليه أي واحد بالماء البارد.
لم يكن رأس قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي وحده الذي فصل عن جسده، بل كان معه رؤوس خمسة من أبناء مسلم بن عمرو الباهلي هم: عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحصين وعبد الكريم. وكان معهم أيضاً رؤوس خمسة من أبنائهم.
أحد عشر رأساً من صلب مسلم بن عمرو الباهلي دفعها ثمناً لتأييده للباطل.
وأكثر من ذلك فإن مسلم بن عمرو الباهلي نفسه ذهب ضحية الباطل الذي أيَّده، فإن سيوف الأمويين بقيادة عبد الملك بن مروان قتلته هو بالذات وسقت دمه أرض العراق فيمن سقت من دماء الألوف([155]).
محمد بن مسلمة حليف بني عبد الأشهل
كان محمد هذا ممن امتنعوا عن مبايعة علي بن أبي طالب، قال في الإمامة والسياسة عن وقعة الحرة: وأول دور انتهبت والحرب قائمة دور بني عبد الأشهل، فما تركوا في المنازل من أثاث ولا حلي ولا فراش إلاَّ نقض صوفه حتى الحمام والدجاج كانوا يذبحونها، فدخلوا دار محمد بن مسلمة فصاح النساء، فأقبل زيد بن محمد بن مسلمة إلى الصوت فوجد عشرة ينهبونها، فقاتلهم ومعه رجلان من أهله حتى قُتِل الشاميون جميعاً، وخلصوا منهم ما أخذ منهم، فألقوا متاعهم في بئر لا ماء فيه، وألقي عليها التراب. ثم أقبل نفر من أهل الشام، فقاتلوهم أيضاً حتى قتل زيد بن محمد أربعة عشر رجلاً، فضربوه بالسيف، منهم أربعة في وجهه.
واعتقد أن الذي بعث القوة في نفس زيد بن محمد بن مسلمة فجعله يستميت هذه الاستماتة لا نهب الأموال، بل الدفاع عن أخواته وبناته وقريباته، فإن تعليمات يزيد لمسلم بن عقبة كانت أن يبيح المدينة لجنوده ثلاثة أيام. فكانت الإباحة إباحة عامة شاملة لم تقتصر على النهب والسلب، بل وصلت إلى هتك الأعراض، فقد كان الرجل بعد وقعة الحرة إذا أراد أن يزوج ابنته لا يضمن بكارتها، بل يقول: لعلَّه أصابها شيء يوم الحرة.
ويقول ياقوت الحموي في (معجم البلدان) عن مسلم بن عقبة: «ودخل جنده المدينة، فنهبوا الأموال وسبوا الذرية، واستباحوا الفروج، وحملت منهم ثمانمائة حُرة وولدن، وكان يقال لأولئك الأولاد: أولاد الحرة ….».
إن استماتة زيد بن محمد بن مسلمة لم تكن لنهب منزله، ولكنه سمع صيحة النساء: أخواته وبناته. فاستمات دفاعاً عن شرفهنّ. والله وحده يعلم ما إذا كنَّ بين الثمانمائة اللواتي تحدث عنهنّ ياقوت الحموي، فلم يكن ليتركهنّ جنود يزيد سالمات بعد أن قتل رجلهنّ زيد من قتل منهم.
إن محمد بن مسلمة رفض أن يبايع علي بن أبي طالب وخذله مع الخاذلين، فذاق نتيجة ما جنت يداه في بناته وحفيداته … وفي ابنه.
وأبو جهم بن حذيفة العدوي ابن عم عمر بن الخطاب جيئ به بعد وقعة الحرة إلى مسلم بن عقبة، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا أبو جهم بن حذيفة العدوي. قال: أوتتكنى علي، وتقول أبو جهم بن حذيفة؟ بايع الآن يزيد بن معاوية على أنك عبد من عبيده. فقال أبو جهم: يا سبحان الله، كيف أكون عبداً ليزيد وأنا رجل من قريش معروف الحسب والنسب! فقال مسلم بن عقبة: اضربوا عنقه! فقال: أنا أبايع على ما تأمرني به. فقال: لا والله لا أقيلك. ثم قدِّم فضرب عنقه.
النبي محمد (ص)
أكثر المؤرخين متفقون على أن النبي (ص) ولد عام الفيل (570م) ومات أبوه عبد الله قبل ولادته. كما ماتت أمه وهو لا يزال طفلاً، فعاش في رعاية جده عبد المطلب، ثم عمه أبي طالب. وتزوج خديجة وهو في الخامسة والعشرين، ورزق منها ولديه القاسم وعبد الله الطيب والطاهر اللذين ماتا طفلين كما رزق منها ابنته فاطمة.
هل كان له بنات غير فاطمة؟
ذكر المؤرخون أن للنبي (ص) أربع بنات، هنّ بحسب تسلسل ولادتهنّ:
زينب ـ رقية ـ أم كلثوم ـ فاطمة([156]).
ولدى التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلاً على ثبوت بنوة غير الزهراء عليها السلام منهن، بل الظاهر أن البنات الأخريات كنَّ بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد (ص).
ونورد فيما يلي خلاصة بالقرائن التاريخية المُشْعِرة بصحة ما ذهبنا إليه:
1 ـ زينب:
ولدت زينب ـ باتفاق المؤرخين ـ في سنة ثلاثين من مولد النبي (ص) ([157]) وتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وهو ابن خالتها، قبل أن يبعث النبي (ص) بالإسلام([158]) و«ولدت له علياً مات صغيراً، وأُمامة»([159]).
وعندما بُعث النبي (ص) بالرسالة أسلمت زينب حين أسلمت أمها خديجة، وبايعت رسول الله (ص) هي وأخواتها([160]).
«وكان الإسلام قد فرَّق بين زينب … حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع، إلا أن رسول الله (ص) كان لا يقدر على أن يفرّق بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه»([161]).
2 ـ رقية:
ولدت رقية، ورسول الله (ص) ابن ثلاث وثلاثين سنة([162]). و«تزوجها عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب قبل النبوة»([163]). «وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد، وبايعت رسول الله (ص) هي وأخواتها»([164]).
ولما بُعث رسول الله (ص) «أمر أبو لهب ابنه بطلاقها، فتزوّجها عثمان»([165]) وكان ذلك قبل الهجرة الأولى إلى الحبشة، لأن عثمان عندما هاجر كانت رقية بصحبته([166]).
3 ـ أم كلثوم:
ولدت بعد أختيها زينب ورقية من دون أن يعيّن المؤرخون عام ولادتها. و«تزوجها عتيبة بن أبي لهب بن عبد المطلب قبل النبوة. وأسلمت حين أسلمت أمها»([167]) وفارقت زوجها في نفس الوقت الذي فارقت به رقية زوجها عتبة.
الخلاصة:
إن أول بنت للنبي (ص) ـ كما ادعوا ـ قد ولدت وللنبي (ص) من العمر ثلاثون، فمتى زوجت من أبي العاص ومتى ولدت له علياً ـ إن لم نقل: وأُمامة ـ وكم كان عمرها حين زواجها، علماً بأن الإسلام قد فرق بينهما ـ زوجياً ـ ولزينب عشر سنوات حسب الادعاء؟
وكذلك الأمر في رقية ولدت وللنبي (ص) من العمر ثلاث وثلاثون، فمتى زوجت للمرة الأولى، ومتى طلقت، ومتى زوجت للمرة الثانية من عثمان، وكم كان عمرها حين زواجها؟ علماً بأن عتبة زوجها الأول قد طلقها ولرقية من العمر سبع سنوات؟
وأم كلثوم التي ولدت بعد أختيها متى زوجت؟ وكم كان عمرها حين زواجها، علماً بأن عتيبة قد طلَّقها ولها من العمر ست سنوات في أكثر الفروض([168]).
البعثة
وفي الأربعين من عمره بُعث بالنبوة سنة 610م وأول من آمن به خديجة وعلي بن أبي طالب، ثم أسلم بعدهما عدد قليل كان أولهم أبو بكر وزيد بن حارثة.
بعد ثلاثين سنة من البعثة أراد النبي أن يظهر ما خفي من أمره لأنه كان من قبل يدعو إلى الإسلام سراً، فأول ما دعا عشيرته، وقد ذكر المؤرخ الطبري هذه القصة كما يلي وهي: أن النبي دعا عشيرته إلى وليمة، وكانوا حوالي أربعين رجلاً، فلما أراد رسول الله (ص) أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام وقطع عليه قوله، فتفرَّق القوم ولم يكلمهم رسول الله (ص) فدعاهم محمد في اليوم الثاني، فلما أكلوا تكلم رسول الله (ص) فقال: «يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاءكم بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟» فأحجم القوم عنه جميعاً، فنهض عليّ وهو أصغرهم سناً فقال: «أنا يا رسول الله عونك، أنا حرب على من حاربت» فقال النبي: «إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا» فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع.
رواه الطبري في تاريخه وتفسيره للقرآن إلاَّ أن الطابعين للتفسير حرّفوه، فأبدلوا قوله «على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم» بلفظ إن هذا أخي وكذا وكذا، وأبقوا قوله: «فاسمعوا له وأطيعوا» وفيه كفاية. وما حذفوه وأبدلوه هو إشارة إلى ما صرَّح به التاريخ([169]).
ولمَّا كان تصحيح هذا الحديث من الأهمية بمكان فلا بأس من الإشارة إلى جملة ممن رواه من أجلاَّء علماء الإسلام ليعلم بذلك اشتهاره واستفاضته بينهم، فرواه محمد بن جرير الطبري في تاريخه وتفسيره كما سمعت، ورواه البغوي والثعلبي في تفسيره، والنسائي في الخصائص.
ورواه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، وأبو جعفر الطوسي وغيرهم.
مجيء قريش إلى أبي طالب
وبعد دعوته لعشيرته دعا قريشاً كلها. وجعل يعيب الأصنام ويتلو الآيات في شأنها، فمشى رجال من أشراف قريش فيهم أبو سفيان إلى أبي طالب (وكان مؤمناً برسول الله (ص) يكتم إيمانه) فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سبَّ آلهتنا، وعاب ديننا، وسفّه أحلامنا، وضلّل أبناءنا؛ فإمَّا أن تكفّه عنَّا، وإمَّا أن تخلّي بيننا وبينه. فردَّهم أبو طالب رداً جميلاً، ومضى رسول الله (ص) في دعوته، ولم يزل الإسلام يفشو ويظهر. ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى. قال ابن سعد: لما رأت قريش ظهور الإسلام جاؤوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا وقد رأيت الذي فعل هؤلاء السفهاء مع ابن أخيك من تركهم آلهتنا وتسفيههم أحلامنا. وجاؤوا بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا جئناك بفتى قريش جمالاً ونسباً ونهادة وشعراً يكون لك نصره وميراثه وتدفع إلينا ابن أخيك نقتله. فقال: والله ما أنصفتموني تعطوني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابن أخي تقتلونه.
فلمَّا كان مساء تلك الليلة فقُد رسول الله (ص) فجمع أبو طالب فتيان قومه وقال: ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة واتبعوني إذا دخلت المسجد، وليجلس كل واحد منكم إلى جنب عظيم من عظمائهم فليقتله إن كان محمد قد قتل. ففعلوا، ثم أخبره زيد بن حارثة بسلامة النبي (ص) فلمَّا أصبح أخذ بيده فوقف على أندية قريش ومعه الفتيان فأخبر قريشاً بما كان يريد فعله لو قتل النبي (ص) وأراهم السلاح، فانكسر القوم وكان أشدهم انكساراً أبو جهل.
ثم جاؤوا إلى أبي طالب مرة ثالثة وقالوا: يا أبا طالب إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا، وقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنَّا، وإنَّا والله لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفّه عنّا أو ننازله وإيَّاك حتى يهلك أحد الفريقين. وعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفساً بتسليم ابن أخيه، فأرسل إلى النبي (ص) فأخبره بمقالة قريش، فأجابه النبي: «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». فقال له أبو طالب: إذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبداً.
وأفضى أبو طالب إلى بني هاشم وبني عبد المطلب بقول ابن أخيه وبموقفه، وطلب إليهم أن يمنعوا محمداً من قريش، فاستجابوا له جميعاً إلاَّ أبا لهب فإنه صارحهم بالعداوة وانضمَّ إلى خصومهم عليهم.
إيذاء قريش للمسلمين
اعتصم محمد من أذى قريش ببني هاشم وعمه أبي طالب، كما اعتصم بخديجة في داره من هم نفسه، فقد كانت له ـ بصدق إيمانها وعظيم حبها ـ خير عون … وفي الحق أن قريشاً لم تنم ولم تعد لما عرفت من قبل من دعة النعيم، بل وثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم حتى مات ياسر وزوجته سمية بالتعذيب، ولم ينج ولدهم عمَّار من الموت إلاَّ لشبابه، وراحوا يفتنونهم عن دينهم، حتى ألقى أحدهم عبده الحبشي بلالاً على الرمل تحت الشمس المحرقة، ووضع حجراً على صدره وتركه ليموت، لا لشيء إلاَّ أنه أصرَّ على الإسلام، ولم يزد بلال وهو في هذه الحال على أن يكرر كلمة: «أحد، أحد» متحملاً هذا العذاب في سبيل دينه. وعُذِّبت امرأة لأنها لم ترض أن ترجع عن الإسلام إلى دين آبائها.
وكان المسلمون من غير الموالي يضربون، وتوجه إليهم أشدّ صورة المهانة. ولم يسلم محمد، مع منع بني هاشم وبني عبد المطلب له، من هذه الإساءات. كانت أم جميل زوج أبي لهب تلقي النجس أمام بيته، فيكتفي محمد بأن يزيله. وكان أبو جهل يلقي عليه أثناء صلواته رحم شاة مذبوحة ضحية للأصنام، فيتحمل الأذى، وكان عمرو بن العاص يجمع الأولاد ويعلمهم شعراً في شتيمة النبي وذمه، ويطلقهم وراء النبي يردّدون ذلك الشعر. وكان عقبة بن أبي معيط يعامل النبي أسوأ معاملة. هذا إلى جانب ما كان المسلمون يسمعون من الشتائم حيثما ذهبوا. واستمرَّ الأمر على ذلك طويلاً، فلم يزدادوا إلاَّ حرصاً على دينهم، وابتهاجاً بالأذى وبالتضحية في سبيل عقيدتهم وإيمانهم.
ولم تدع قريش وسيلة ترجو منها القضاء على الإسلام وأهله والحيلولة دون انتشاره إلاَّ توسلت بها، ولا سبيلاً تأمل منه الوصول إلى ذلك إلاَّ سلكتها، وبلغت في ذلك جهدها وغاية استطاعتها؛ فأبى الله تعالى إلاَّ أن يتم نوره ولو كره المشركون.
عمدت أولاً إلى تكذيبه والحط من قدره باللسان والذم والتنقيص لتكفّ الناس عن اتباعه، فقالت تارة أنه ساحر وأخرى أنه كاهن ومرَّة أنه شاعر ومرَّة أنه يعلمه بشر وأغروا به شعراءهم أبا سفيان بن الحارث وعمرو بن العاص وعبد الله بن الزبعري، فلما لم ينجح ذلك فيه، وبقي جاداً في أمره، وأتباعه يزدادون كثرة كل يوم، عمدت إلى أذاه وأذى أصحابه باليد، فرجمته في داره ووضعت السلاء على ثيابه وسلَّطت عليه أطفالها يرمونه بالحجارة وفعلت أفعالاً شبه ذلك وعذَّبت أصحابه بالحبس والضرب والقتل والإلقاء في الرمضاء وغير هذا واضطرتهم بذلك إلى الهرب من بلادهم والهجرة إلى الحبشة ولم تقنع بذلك حتى أرسلت إليهم من يردهم فما زاده في دعوته إلاَّ مضاء وأصحابه به إلاَّ كثرة وثبات يقين فعرضت عليه المال والملك وكل ما يطمع الناس فيه عادة فلم يقبل ولم يمل إلى شيء من ذلك وهددته وأهله وأنذرتهم بالحرب ومشت إلى عمه أبي طالب مراراً لتصده عن نصره وتحمله على إرجاعه عن عزمه بالتهديد وأنواع الحيل فلم يجد ذلك شيئاً فعمدت إلى مقاطعة بني هاشم وحصرهم في شعب من شعاب مكة لا يجالسون ولا يكلمون ولا يبايعون ولا يزوجون حتى يموتوا جوعاً أو يرجع محمد (ص) عن دعوته فصبروا على ذلك ثلاث سنين كما سيأتي.
الهجرة إلى الحبشة
ولمَّا كثر المسلمون ثار كثير من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم… ولما اجتمعوا على منع رسول الله (ص) منهم بعمه أبي طالب،.. قال لهم رسول الله (ص) تفرقوا في الأرض قالوا أين نذهب؟ فأشار إلى الحبشة فهاجروا إليها وذلك في رجب من السنة الخامسة من النبوة وكانوا أحد عشر رجلاً وأربع نسوة. فأقاموا شعبان وشهر رمضان ثم عادوا إلى مكة في شوال لما بلغهم أن قريش أسلمت، فلما قاربوا مكة علموا أن ما بلغهم باطل فلم يدخلها أحد منهم إلاَّ بجوار غير ابن مسعود فإنه مكث يسيراً ثم عاد إلى أرض الحبشة فلقوا أذىً كثيراً فأذن لهم النبي (ص) بالهجرة ثانياً.
الهجرة الثانية إلى الحبشة
وكانوا ثمانين رجلاً وثماني عشر امرأة فيهم جعفر بن أبي طالب ومعه زوجته أسماء بنت عميس فأحسن النجاشي جوارهم وساء ذلك قريشاً فأرسلوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى النجاشي في ردهم ولكن النجاشي رفض ردهم. ثم عادوا بعد ثبوت قدم الإسلام فوصلوا المدينة يوم فتح خيبر.
لماذا اختار الإسلام أفريقيا دون غيرها؟
هنا يعرض لنا السؤال الذي لا بدَّ منه. لماذا اختار الإسلام أفريقيا دون غيرها؟ ولماذا خصَّها محمد (ص) بأن تكون ملجأ لأنصاره؟ هل كان ذلك اعتباطاً أم صدفة؟
الواقع إن كل شيء كان يبعد عن ذهن النبي (ص) التفكير في أفريقيا لو أن دعوة الإسلام لم تكن ذات أهداف إصلاحية عالمية وذات مناهج تحررية عميقة.
فإن أي بلد غير أفريقيا هو أقرب لأن يهاجر إليه المسلمون المضطهدون وأي وطن غير الحبشة هو أسهل ليلقوا فيه الحماية المطلوبة.
لكن الإسلام اختار أفريقيا دون غيرها بالرغم عما يفصلها عنه من بحار وعمار في طريقها من مشقَّات.
لقد كان من المعقول أن تكون الهجرة إلى أي بلد قريب لا يخضع لسلطة قريش وغيرها من العرب الوثنيين، لقد كان من المعقول أن تكون الهجرة إلى البلاد التي تخضع لحكم الروم كسورية أو البلاد التي يحكمها الأكاسرة كالعراق، فإن أي واحد من هذين البلدين جدير بأن يكون مقصد المهاجرين المسلمين، ولكن محمداً (ص) لم يشر إلاَّ إلى أفريقيا، ولم يطلب إلى أتباعه أن يهاجروا إلى غير بلاد اللون الأسود.
ذلك لأن دعوته إنما جاءت لتحرير الإنسانية، وضمان المساواة بين جميع الناس، جاءت هذه الدعوة في الوقت الذي كان فيه الإنسان الأسود هو أحقر مخلوق بنظر الآخرين لا يفرقون بينه وبين حيوان معدّ للخدمة والعمل.
وكان لا بدَّ من خوض أعنف المعارك لرفع ظلم الإنسان عن الإنسان، وضمان سيادة الحرية والمساواة، وكانت دولة القياصرة ودولة الأكاسرة الدولتين المسيطرتين في ذلك العصر والمتمثل بهما شر أنواع الحكم فساداً، والدولتين اللتين تحميان طغيان البيض على السود، وتنفذان هذا الطغيان على أسوأ الأشكال.
فلذلك كان الاصطدام بين هاتين الدولتين وبين الإسلام أمراً محتوماً، فلم يكن من المعقول أن يلجأ إليهما المسلمون في حال الضعف ثم يناضلوهما في حال القوة.
لقد كان محمد ودعوته الإسلامية وأتباعه المسلمون أشرف وأكرم من أن يقابلوا الإحسان بالإساءة، فكيف يحتمون بمن هم مصممون على محاربتهم وتخليص الإنسانية من فساد حكمهم، وكيف يلجأون إلى جماعة سيهاجمونهم في المستقبل.
لذلك كان لا بدَّ من اختيار مكان في غير بلاد الروم وبلاد الأكاسرة، لا بد من اختياره في بلاد العرق الأسود، هذا العرق الذي سيكون أول ما يفكر الإسلام في حمايته وإنقاذه من الظلم ثم في إعلاء شأنه وتكريمه.
كان لا بدَّ من اختيار مكان الهجرة في بلاد لن يقع صدام بينها وبين المسلمين في المستقبل لأن الإسلام إنما جاء لتحريرها مما كانت تخضع له من مهانة وإذلال.
ولذلك اختار محمد (ص) أفريقيا السوداء مكاناً لهجرة أنصاره. ثم اختار من أفريقيا السوداء نفسها رجلاً دفعه إلى أعلى مكانة يطمح إليها إنسان. اختار بلالاً الأفريقي الأسود اللون ليكون مؤذنه الخاص، وبذلك دخلت قضية السود في عهد من التكريم والإعظام لم يحلم به من قبل حالم.
حصار الشعب وأمر الصحيفة
ولما بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه إياهم ورأوا عدم وصولهم إلى النبي (ص) لقيام عمه أبي طالب دونه كتبوا على بني هاشم صحيفة أن لا يزوجوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم أو يسلموا إليهم رسول الله (ص) وختم عليها أربعون خاتماً، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة وحصروهم في شعب أبي طالب أول المحرم سنة سبعة من البعثة فدخل بنو هاشم الشعب عدا أبي لهب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لشدة عداوتهما للرسول (ص) وأبو سفيان أسلم بعد ذلك. وانحاز إليهم بنو المطلب بن عبد مناف فكانوا أربعين رجلاً وحصن أبو طالب الشعب وكان يحرسه ليلاً نهاراً وأخافتهم قريش فكانوا لا يخرجون ولا يأمنون إلاَّ من موسم إلى موسم، موسم العمرة في رجب وموسم الحج في ذي الحجة وقطعوا عنهم الميرة، إلاَّ ما كان يحمل سراً وهو شيء يسير لا يمسك أرماقهم حتى بلغ بهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب وذلك أشدَّ ما لقي رسول الله (ص) وأهل بيته بمكة.
وكان هشام بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي يأتي بالبعير بعد البعير قد أوقره طعاماً أو تمراً إلى فم الشعب فينزع عنه خطامه ويضربه على جبينه فيدخل الشعب فبقوا في الشعب سنتين أو ثلاث سنين وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم فمشى هشام بن عمرو إلى زهير بن أبي أمية المخزومي وزهير ختن أبي طالب على ابنته عاتكة وقال: أرضيت أن يكون أخوالك هكذا؟ قال: فما أصنع وأنا رجل واحد؟ قال: وجدت ثانياً، قال أبغنا ثالثاً فما زالوا كذلك حتى صاروا خمسة فيهم غير هشام وزهير، مطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود فأقبلوا إلى أودية قريش فقال زهير: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة فقال أبو جهل: كذبت والله لا تشق. فقال زمعة: أنت والله أكذب فقال أبو البختري: صدق والله زمعة. وقال مطعم وهشام مثل ذلك، قال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. وقام مطعم إلى الصحيفة فشقها وخرج بنو هاشم من حصار الشعب في السنة العاشرة أو التاسعة من النبوة إلى مساكنهم.
وفاة خديجة وأبي طالب
وتوفيت خديجة وأبو طالب وفي تاريخ وفاتهما اختلاف كبير فقيل توفيا في عام واحد، توفي أبو طالب بعد البعثة بست سنين وثمانية أشهر وأربعة وعشرين يوماً وتوفيت خديجة بعده بثلاثة أيام فسمى رسول الله (ص) ذلك العام عام الحزن، وقيل توفيت خديجة قبل الهجرة بسنة حين خرج رسول الله (ص) من الشعب وتوفي أبو طالب بعدها بسنة. وكما أوصى عبد المطلب ابنه أبا طالب بنصر النبي (ص) فقام به أحسن قيام كذلك أوصى أبو طالب ابنيه علياً وجعفراً وأخويه حمزة وعباساً بنصره فقاموا به أحسن قيام لا سيما علي وحمزة وجعفر.
وقال رسول الله (ص) : ما زالت قريش كاعة عني حتى مات أبو طالب فلما توفي نالت قريش من رسول الله (ص) واجترأت عليه فخرج إلى الطائف يعرض نفسه على القبائل ومعه زيد بن حارثة بعد ثلاثة أشهر من موت خديجة فأغروا به صبيانهم وسفهاءهم يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة حتى أدموا رجليه وزيد يقيه بنفسه حتى شجَّ في رأسه ففر منهم إلى حائط عتبة وشيبة ابني ربيعة فدخله ورجعوا عنه وجلس إلى ظل شجرة فأرسل عتبة وشيبة غلاماً لهما نصرانياً يقال له عداس بعنب في طبق فوضعه بين يديه فقال باسم الله وأكل منه فعجب عداس من ذلك، قال هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد فسأله عن بلده وعن دينه فأخبره أنه نصراني من أهل نينوى. قال: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: وما يدريك؟ قال: ذاك أخي كان نبياً وأنا نبي فأكب عداس عليه يقبل رأسه ويديه فعجب ابنا ربيعة من ذلك وقالا: لا يصرفنك هذا الرجل عن دينك فهو خير من دينه وعاد رسول الله (ص) إلى مكة في جوار مطعم بن عدي وجعل يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم وفي منازلها.
الجهر بالدعوة
وأقام رسول الله (ص) بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة منها ثلاث سنين مستخفياً ثم أعلن دعوته في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي المواسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم بمنى والموقف يسأل عن القبائل قبيلة قبيلة ويسأل عن منازلهم ويأتي إليهم في أسواق المواسم عكاظ ومجنة وذي المجاز، وكانت العرب إذا حجَّت تقيم بعكاظ شهر شوال ثم بسوق مجنة عشرين يوماً ثم بسوق ذي المجاز إلى أيام الحج فكان يتبعهم في منازلهم ليدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلاَّ الله تفلحوا. فلم يستجب له أحد منهم.
إسلام الأنصار
وجاء إلى مكة أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس من الخزرج سكان المدينة فعرض عليهما رسول الله (ص) الإسلام فأسلما ثم رجعا إلى المدينة ثم أسلم ثمانية أو ستة من الأنصار.
ولمَّا كان العام المقبل من العام الذي لقي فيه رسول الله (ص) النفر الستة أو الثمانية كما مرَّ لقيه اثنا عشر رجلاً من الخزرج فأسلموا. فسميت بيعة العقبة الأولى. ثم فشا الإسلام بالمدينة فأسلم كثير من أهلها.
ولما حضر الحج مشى من أسلم بالمدينة بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج وموافاة رسول الله (ص) وهم سبعون يزيدون رجلاً أو رجلين فلقيهم النبي ليلاً ومعه عمه العباس فأعلنوا له إسلامهم. فسميت بيعة العقبة الثانية.
الهجرة إلى المدينة
لما صدر السبعون من عند رسول الله (ص) وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين أذِن لهم النبي (ص) في الهجرة إلى المدينة فهاجروا ونزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم ولم يبق منهم بمكة إلاّ قليل.
قصة الغار ومبيت علي على الفراش
ولما رأى ذلك المشركون اجتمعوا في دار الندوة ليأتمروا على رسول الله (ص) وأسرُّوا ذلك بينهم وبعد نقاش دار بينهم اتفقوا على أن يختاروا عشرة رجال شجعان من كل قبيلة رجل، ويسلحوهم تسليحاً قوياً حتى إذا جاء الليل هجموا عليه كلهم فيضربونه حتى يقتلوه. وعلم النبي بذلك فدعا علي بن أبي طالب وأخبره أنه عزم على الهجرة إلى المدينة وطلب إليه أن ينام تلك الليلة في فراشه ليوهم قريشاً أن النبي لا يزال نائماً. وقد كان في ذلك خطر شديد على علي بن أبي طالب لأن الرجال العشرة سيهجمون عليه وهم يظنونه محمداً وبالرغم من هذا الخطر فقد رضي علي أن يقوم بذلك وانصرف النبي لترتيب أمر سفره وأمر رسول الله (ص) أبا بكر وهند بن أبي هالة، وهو ربيب رسول الله أمه خديجة زوجة النبي، أن يقعدا له بمكان ذكره لهما في طريقه إلى الغار ولبث مع علي يوصيه حتى صلَّى العشاءين ثم خرج في فحمة العشاء الآخرة. حتى أتى إلى أبي بكر وهند فنهضا معه حتى وصلوا الغار وهو غار جبل ثور بأسفل مكة فدخلا الغار ورجع هند إلى مكة لما أمره رسول الله (ص) فلما انتصف الليل وانقطع الأثر أقبل القوم على علي يقذفونه بالحجارة ولا يشكون أنه رسول الله حتى إذا قرب الفجر هجموا عليه فلمَّا بصر بهم علي (ع) قد انتضوا السيوف وأقبلوا بها وثب إليهم فأجفلوا أمامه وبصروه فإذا هو علي فقالوا: إننا لا نريدك فما فعل صاحبك؟ قال: لا علم لي به فأذكت قريش عليه العيون وأرسلوا يفتشون عليه فلما وصلوا الغار كادوا يصعدون إليه فلما قربوا منه قال بعضهم إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد فرجعوا وانتظر علي إلى الليلة الثانية فانطلق هو وهند بن أبي هالة حتى دخلا على رسول الله (ص) في الغار فأمر رسول الله (ص) هنداً أن يبتاع له ولصاحبه بعيرين.
ثم أوصى علياً (ع) بحفظ ذمته وأداء أمانته وكانت قريش تدعو محمداً (ص) في الجاهيلة الأمين وتودعه أموالها وكذلك من يقدم مكة من العرب في الموسم، وجاءته النبوة والأمر كذلك فأمر علياً أن يقيم منادياً بالأبطح غدوة وعشية ألا من كانت له قبل محمد أمانة فليأت لتؤدى إليه أمانته. وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أراد الهجرة معه من بني هاشم وغيرهم وقال له إذا قضيت ما أمرتك فكن على أهبة الهجرة وانتظر قدوم كتابي إليك ولا تلبث بعده وأقام رسول الله (ص) في الغار ثلاث ليال ثم ارتحل مع صاحبه حتى قارب المدينة فنزل في قبا ينتظر قدوم علي.
هجرة علي بن أبي طالب
ثم كتب رسول الله (ص) إلى علي بن أبي طالب مع أبي واقد الليثي يأمره بالمسير إليه وكان قد أدَّى أمانته وفعل ما أوصاه به فلمَّا أتاه الكتاب ابتاع ركائب وتهيأ للخروج وأمر من كان معه من ضعفاء المؤمنين أن يتسللوا إلى ذي طوى وخرج علي (ع) بالفواطم: فاطمة بنت رسول الله (ص) وفاطمة بنت أسد بن هاشم وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وزاد بعض المؤرخين فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وتبعهم أيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله (ص).
فلما قارب «ضجنان» أدركه الطلب لأن قريش صعب عليها أن ينجو محمد، وأن يخرج علي بالنسوة جهاراً فأرسلت الفرسان ليردوه وهم ثمانية فرسان ملثمون معهم مولى لحرب بن أمية اسمه جناح فقال علي لأيمن وأبي واقد: أنيخا الإبل وأعقلاها وتقدم فأنزل النسوة ودنا القوم فاستقبلهم علي منتضياً سيفه، فقالوا: ظننت أنك يا غدَّار ناج بالنسوة؟ فارجع لا أبا لك قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: لترجعن راغماً أو لنرجعن برأسك ودنوا من المطايا ليثوروها فحال علي (ع) بينهم وبينها فأهوى له جناح بسيفه فراغ من ضربته وضرب جناحاً على عاتقه. والظاهر هو أن جناحاً لما أهوى له بالسيف انحنى لأن الفارس لا يمكنه أن يضرب الراجل إلاَّ وهو منحن فضربه علي على عاتقه ولو لم يكن منحنياً لم تصل ضربته إلى عاقته وشدَّ على أصحابه وهو على قدميه شدَّة ضيغم.
فتفرَّق القوم عنه وقالوا: احبس نفسك عنَّا يا ابن أبي طالب قال: فإني منطلق إلى أخي وابن عمي رسول الله (ص) فمن سرَّه أن أريق دمه فليدن مني ثم أقبل على أيمن وأبي واقد وقال لهما: أطلقا مطاياكما ثم سار ظافراً قاهراً حتى نزل «ضجنان» فلبث به يومه وليلته ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين فيهم أم أيمن مولاة رسول الله (ص) وبات ليلته تلك هو والفواطم.
وأقام رسول الله (ص) بقبا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجده وخرج يوم الجمعة إلى المدينة وقيل مكث أربع عشرة ليلة ولعلَّه الأقرب إلى الاعتبار وركب ناقته، وحشد المسلمون حوله عن يمينه وشماله بالسلاح، وأدركته الجمعة في بني عوف فصلاَّها في المسجد الذي في بطن وادي «رانوناء» ومعه مائة من المسلمين فكانت أول جمعة صلاَّها بالمدينة.
المرحلة الجديدة
كان بيثرب «المدينة» يومئذٍ المسلمون من مهاجرين وأنصار، وكان بها المشركون من سائر الأوس والخزرج، ثم كان بها اليهود، يقيم منهم بنو قينقاع في داخلها، ويقيم بنو قريظة في فدك، وبنو النضير على مقربة منها، ويهود خيبر في شمالها، أما المهاجرون والأنصار فقد ألَّف الإسلام بينهم بأوثق الرباط وأما المشركون من سائر الأوس والخزرج، فقد ألفوا أنفسهم بين المسلمين واليهود ضعافاً نهكتهم الحروب الماضية، فاتجه همهم للوقيعة بين هؤلاء وأولئك. وأما اليهود فبادروا بادئ الأمر إلى حسن استقبال محمد ظناً منهم أن في مقدورهم استمالته إليهم وإدخاله في حلفهم، والاستعانة به على تأليب جزيرة العرب حتى تقف في وجه النصرانية التي أجلت اليهود عن فلسطين وانطلق كل على أساس تفكيره يمهد أسباب النجاح لبلوغ غايته([170]).
زوجات النبي
من بين زوجات النبي كانت زينب بنت جحش. ومن المؤسف أن فريقاً من المستشرقين ذكروا تزوجه منها بصورة مشوَّهة، وساعدهم على ذلك غفلة بعض المسلمين فيما فسّروه وشرحوه. مثل قولهم أن النبي (ص) جاء إلى منزل زوجها زيد فوجدها تغتسل فقال سبحان خالقك أو أن الهواء رفع الستر فرآها نائمة فوقعت في نفسه فقال شبه ذلك وأنه لما جاء زوجها زيد أخبرته فأراد طلاقها ليتزوجها النبي (ص) فقال له أمسك عليك زوجك ونحو ذلك. والحقيقة أن زينب كانت بنت عمة النبي (ص) وكان يعرفها طفلة وشابة وهذا يكذب أنه لما رآها وقعت في قلبه.
وكان النبي هو الذي ارتأى تزويجها من زيد مولاه الذي كان قد تبناه كما كان أخوها عبد الله بن جحش يرفض هذا الزواج. فلم تكن بنات الأشراف الشريفات يتزوجن من الموالي وإن أعتقوا ويرين التزوج بهم عاراً، وكان النبي يريد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة على العصبية وحدها، وهو لا يرى أن يطبق ذلك أول ما يطبقه على امرأة من غير أسرته، لذلك أصرَّ على زينب وعلى أهلها أن تتزوج زيداً.
فلما تزوجته جعلت تستطيل عليه بقربها من رسول الله وأنها ابنة عمته وأنها قرشية وزيد عبد سابق من الموالي.
فاشتكى زيد إلى النبي (ص) مراراً من سوء خلقها معه وأراد طلاقها، والنبي (ص) يقول له: أمسك عليك زوجك. ثم لما طال الأمر طلَّقها.
وكانت العرب في الجاهلية تعتبر المتبنى بمنزلة الابن من حيث الميراث وأحكام الزواج. وكان الإسلام قد أبطل ذلك وبهذا الإبطال صار يجوز للرجل أن يتزوج ممن كانت زوجاً لمن تبناه، ولم يعد من حق المتبنى أن يرث من يتبناه. ولكن كيف السبيل إلى تنفيذ هذا ومن من العرب يستطيعه وينقض تقاليد الأجيال السابقة جميعاً.
وقد رأى النبي في زواجه من زينب رداً لاعتبارها بعد طلاقها ثم تطبيقاً للشريعة على نفسه، ولكنه بقي في نفسه بعض الإحجام لما عسى أن يقوله الناس في مخالفة هذه العادة المتأصلة في نفوسهم، وهذا ما أراده القرآن في آيته: ﴿وتخفِى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾.
وهكذا تزوج من زينب ليكون قدوة فيما أبطل الشارع من الحقوق المقررة للتبني والادعاء. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا﴾.
هذه هي قصة زينب بنت جحش وزواج محمد منها. فهي ابنة عمته، وكان يراها ويعرف مبلغ جمالها قبل أن تتزوج زيداً، وهو الذي خطبها على زيد وهو كان يراها بعد أن تزوجت زيداً. على أنه كان من شأنها بحكم صلة القرابة من ناحية وزوج دعيه زيد من ناحية أخرى أن تتصل به لمصالحها ولتكرار شكوى زيد منها، وقد نزلت هذه الأحكام جميعاً، فأيَّدها ما حصل من زواج زيد لزينب وتطليقه إياها وزواج محمد منها بعد ذلك، هذه الأحكام التي ترفع المعتق إلى مكانة الحر الشريف والتي تبطل حقوق الأدعياء وتقضي عليها بصورة عملية لا محل للبس ولا للتأويل فيها.
وهكذا القول في بقية زوجاته فقد تزوَّج خديجة في الثالثة والعشرين من عمره، مع ذلك ظلَّت خديجة وحدها زوجة ثمانية وعشرين سنة حتى تخطى الخمسين. هذا على حين كان تعدد الزوجات أمراً شائعاً بين العرب في ذلك العهد. وقد ظلَّ محمد مع خديجة سبع عشرة سنة قبل بعثه وإحدى عشرة بعده وهو لا يفكر قط في أن يشرك معها غيرها. ولم يعرف عنه قبل زواجه منها أنه كان ممن تغريهم مفاتن النساء. فمن غير الطبيعي أن نراه وقد تخطى الخمسين ينقلب فجأة هذا الانقلاب الذي يجعله ما إن يرى بنت جحش وعنده نساء خمس غيرها، حتى يفتن بها وحتى تستغرق تفكيره ليله ونهاره. ومن غير الطبيعي، أن نراه، وقد تخطى الخمسين، يجمع في خمس سنوات أكثر من سبع زوجات، وفي سبع سنوات تسع زوجات، وذلك كله بدافع من الرغبة في النساء.
فهو كما قدمنا، لم يشرك مع خديجة أحداً مدى ثمان وعشرين سنة، فلما ماتت تزوج سودة بنت زمعة أرملة الكران بن عمرو بن عبد شمس. ولم يرو راوٍ أن سودة كانت من الجمال أو من المكانة بما يجعل لمطمع من مطامع الدنيا أثراً في زواجه منها. إنما كانت سودة زوجاً لرجل من السابقين في الإسلام الذين احتملوا في سبيله الأذى والذين هاجروا إلى الحبشة وقد أسلمت سودة وهاجرت معه، وعانت من المشاق ما عانت. ولقيت من الأذى ما لقيت. فإذا تزوجها محمد بعد ذلك ليعولها وليرتفع بمكانتها إلى أمومة المؤمنين، فذلك أمر يستحق من أجله أسمى التقدير.
وكذلك زواجه من زينب بنت خزيمة ومن أم سلمة. فقد كانت زينب زوجاً لعبيدة بن الحارث بن المطلب الذي استشهد يوم بدر، ولم تكن ذات جمال، وإنما عرفت بطيبتها وإحسانها حتى لقبت أم المساكين، وكانت قد تخطت الشباب، فلم يك إلاَّ سنة أو سنتان ثم قبضها الله، فكانت بعد خديجة الوحيدة من أزواج النبي التي توفيت قبله. أما أم سلمة فكانت زوجاً لأبي سلمة وكان لها منه أبناء عدة. وكان أبو سلمة جرح في أحد ثم برئ جرحه فاشترك في إحدى الغزوات، ثم نغر عليه جرح أحد فمات بسببه. وبعد أربعة أشهر من وفاته خطب محمد أم سلمة إلى نفسها، فاعتذرت بكثرة العيال وبأنها تخطت الشباب، فما زال بها حتى تزوج منها وحتى أخذ نفسه بالعناية بتنشئة أبنائها. أَبَعْدَ ذلك يمكن أن يقال أن أم سلمة كانت ذات جمال هو الذي دعا محمداً إلى التزوج منها؟ إن يكن ذلك فقد كانت غيرها، من تفوقها جمالاً وشباباً، ومن لا يبهظه عبء عيالها لكنه إنما تزوج منها لهذا الاعتبار السامي الذي دعاه ليتزوج زينب بنت خزيمة، والذي زاد المسلمين به تعلقاً وجعلهم يرون فيه نبي الله ورسوله، ويرون فيه إلى ذلك أباً لكل من فقد أباه شهيداً في سبيل الله([171]).
معركة بدر
وفي السنة الثانية للهجرة حدثت معركة بدر بين المسلمين بقيادة النبي وبين قريش فانتصر فيها المسلمون انتصاراً كبيراً قتل فيه فريق من أكبر زعماء قريش. وكان مفتاح النصر في هذه المعركة إن ثلاثة من هؤلاء الزعماء الكبار تقدموا يطلبون المبارزة وهم عتبة بن ربيعة (والد هند زوجة أبي سفيان وأم معاوية) وأخوه شيبة وابنه الوليد، فتقدم إليهم ثلاثة من المسلمين هم حمزة بن عبد المطلب عم النبي (ص) وعبيدة بن الحارث بن المطلب «من بني أعمامه» وعلي بن أبي طالب. فقتل حمزة عتبة وقتل علي بن أبي طالب الوليد وسقط عبيدة وشيبة قتيلين معاً. فزعزعت هذه الصدمة صفوف المشركين وحطَّمت معنوياتهم وكانت سبيل النصر الأكبر. وكان بين القتلى خلال المعركة من زعماء المشركين أبو جهل وحنظلة ابن أبي سفيان شقيق معاوية والعاص بن سعيد بن العاص وغيرهم.
معركة أُحد
كانت معركة أحد محاولة للانتقام من معركة بدر وقد حدثت في السنة الثالثة للهجرة، انتصر المسلمون في أوّلها ثم تضعضعوا في نهايتها لمخالفة بعضهم أوامر النبي وقتل فيمن قتل فيها من زعماء المسلمين حمزة عم النبي.
اليهود والإسلام
ظنَّ اليهود أول نزول النبي في المدينة أنهم يستطيعون محالفة الإسلام على النصرانية التي كانوا يضمرون لها حقداً دفيناً، فلما لم يستطيعوا ذلك جهروا بعدائهم للإسلام ونقضوا عهودهم وانتهى أول صراع بجلاء يهود بني النضير عن المدينة في السنة الرابعة من الهجرة وكان قبل ذلك قد انتهى أمر يهود بني قينقاع في السنة الثانية. وفي السنة الخامسة انتهى أمر يهود بني قريظة وفي السنة السابعة انتهى أمر يهود خيبر.
وقعة الخندق أو الأحزاب
كانت في السنة الخامسة للهجرة حيث قاد أبو سفيان جيشاً من المشركين يزيد عدده على عشرة آلاف مقاتل بقصد القضاء على الإسلام قضاءً نهائياً في معقله بالمدينة فعلم المسلمون بتحفز الجيش إليهم فحفروا حول المدينة خندقاً فوجئ به المشركون ولكن عدداً من شجعانهم يقودهم عمرو بن عبد ود قفزوا بخيولهم فوق الخندق. وكان عبور الخندق وكثافة الجيش المحاصِر قد فعلت فعلها في ضعضعة معنويات المسلمين.
علي حسم الموقف
وقد شبه بعض المؤرخين المعاصرين عبور عمرو بن عبد ود الخندق بعبور اليهود قناة السويس في منطقة البحيرات المرة (الدرفسوار) في حرب تشرين الأول سنة 1973 وقال: «ولو نجح عمرو وصحبه في تثبيت أقدامهم على جانب الخندق الداخلي كما نجح اليهود في تثبيت أقدامهم على ضفة القناة الغربية لعبر جيش أبي سفيان الوثني كله إلى المدينة، ولكان الخطر الذي أحدثه عبور عمرو أعظم من الخطر الذي أحدثه العبور اليهودي فالمسلمون يومئذ لم يكن لديهم مثل ما كان لدى الجيش المصري من إمدادات وأحلاف عربية وغير عربية.
ومع هذا التشابه بين المعركتين القديمة والحديثة نجد أن بينهما فارقاً كبيراً، إذ كان زوال الخطر الوثني في معركة الأحزاب نتيجة لبطولة شخص واحد ومبادرته وحضور ذهنه، بينما كان زوال الخطر اليهودي نتيجة جهود الشعب المصري حكومة وجيشاً وعدد من العوامل الداخلية والخارجية حيث تضافرت جميعها لإزالة ذلك الخطر.
وواقع ما حدث في معركة الخندق أن نواة الأمة الإسلامية التي لم يكن لها بديل على وجه الأرض أحدق بها خطر ماحق نتيجة عبور عمرو، فأزال علي بن أبي طالب الخطر ببطولته وحضور ذهنه ومبادرته السريعة.
ويلخص السيد محسن الأمين في موسوعته (أعيان الشيعة) الموقف بما يلي: لما عبر عمرو بن عبد ود وجماعته الخندق تقدموا نحو معسكر المسلمين فجالت بهم خيلهم بين الخندق وجبل سلع الذي جعله النبي (ص) خلف ظهره، بادر علي (ع) فرابط عند الثغرة التي أقحموا خيولهم منها ليمنع من يريد عبور الخندق من ذلك المكان، فإنه لم يكن في الحسبان أن المشركين يعبرون الخندق، فلما رأوهم عبروه على حين غفلة بادر علي بمن معه ليمنعوا غيرهم. (انتهى).
ويقول المؤرخ المعاصر بعد كلامه المتقدم موضحاً الأمر:
إن مبادرة علي لسد الثغرة التي أحدثها اجتياز عمرو وصحبه ومنعه الآخرين من اللحاق بعمرو قد أوقفا الخطر وحصراه بعمرو وأصحابه. ولنا أن نقول إن الثغرة لو بقيت مفتوحة لاجتاز عدد كبير من فرسان المشركين إلى المدينة ولساعد اجتيازهم على إقامة جسر بين حافتي الخندق يعبر عليه الجيش كله.
فغفلة ساعة كان من الممكن أن تتحول إلى خطر ماحق. ولم يحدث ذلك لأن علياً كان سريع الاستجابة للخطر الجديد هادئ الأعصاب حاضر الذهن غير هياب للمخاطر.
وقد تعمد علي استفزاز عمرو ليبارزه، فحاوره محاورة استفزازية لم يملك عمرو نفسه معها من أن يتقدم لمبارزة علي، فتغلب عليه علي وقتله. وقد كان قتله حسماً للموقف. فالذين عبروا مع عمرو راعهم مقتله، فعادوا يعبرون الخندق هاربين.
إن قتل عمرو أثبت لجيش أبي سفيان الوثني أنهم غير قادرين على اجتياز الخندق مرة ثانية. وإن ما عجز عمرو عن تحقيقه لا يكون مستطاعاً لسواه، وبذلك أصبح الجيش الوثني أمام أحد أمرين: إما الانسحاب أو متابعة الحصار إلى أن يستسلم المسلمون أو يضطروا لعبور الخندق لقتال المشركين. إن متابعة حصار من هذا النوع كانت غير ممكنة للجيش الوثني، فهو جيش غير نظامي وليس لديه من المواد الغذائية اللازمة للمقاتلين وخيولهم وإبلهم. وقد حدث جدال بين الوثنيين وحلفائهم اليهود جعل تعاونهم على الحرب صعباً.
إذن كان أمام جيش أبي سفيان الوثني بعد فشل محاولة عمرو وقتله وتعذر عبور فرسانهم إلى الجانب الآخر من الخندق حل واحد: هو الانسحاب، وهذا ما فعلوه.
ولا ينبغي أن ننسى أمراً مهماً هو أن قتل عمرو وفرار صحبه وهلاك بعضهم قبل تمكنهم من العودة قوى معنويات المسلمين كثيراً بعد أن كانت الأكثرية منهم منهارة نفسياً ـ كما وصفهم القرآن.
لقد عاد إليهم الأمل بالاستمرار والانتصار.
أحداث أخرى
وظلَّ الإسلام يوالي انتشاره وانتصاره فمن صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة الذي اعتبره بعض المسلمين انهزاماً ثم ثبت أنه كان نصراً معنوياً وصارت بعض نتائجه مشكلة من مشاكل قريش إلى غزوة خيبر في السنة السابعة، إلى غزوة مؤتة في السنة الثامنة التي أسفرت عن استشهاد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وغيرهما من القادة ثم انتهت بتراجع المسلمين وانسحابهم.
فتح مكة ووقعة حنين
ثم توجت الأحداث بالفتح المبين فتح مكة الذي قضى على مقاومة قريش وأدَّى إلى استسلامها استسلاماً نهائياً في السنة الثامنة للهجرة. وإذا كان هذا الفتح قد أخضع المقاوم الأول وهو قريش فقد ظلَّت هناك قبيلتان كبيرتان متمردتين هما هوازن وثقيف اللتان حشدتا ما لا يقل عن ثلاثين ألف مقاتل لصد تقدم الإسلام. وقاد النبي اثني عشر ألفاً، فالتقى الفريقان في وادي حنين فكانت الغلبة أول الأمر للمشركين وانهزم المسلمون. وثبت النبي مع عشرة أنفس بينهم تسعة من بني هاشم والآخر أيمن ابن أم أيمن الذي قتل وسلَّم التسعة. ثم رجع المسلمون إلى نفوسهم وتجمعوا من جديد وهزموا المشركين.
وبهذه المعركة انتهت المقاومة الجديّة في جزيرة العرب.
غزوة تبوك
ويبدو أن هذا النصر المتتابع وتركز قاعدة الإسلام قد أهمّ الروم المجاورين في الشام فبلغ النبي (ص) أن هرقل قد أعدَّ جيشاً كثيفاً من العرب والروم تقدمت طلائعه حتى بلغت البلقاء، فمشى النبي بجيش مجموعه ثلاثون ألفاً فيه عشرة آلاف فارس حتى بلغ تبوك. فلما بلغ خبر هذا الجيش مسامع الروم آثروا الانسحاب، فلما علم النبي بذلك عاد بالجيش إلى المدينة.
جيوب تنتهي
وظلَّت للمقاومة جيوب متفرقة لم يكن القضاء عليها عسيراً فتساقطت الواحد بعد الآخر حتى انتهت.
اليمن
كان النبي قد أرسل علي بن أبي طالب في السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة إلى اليمن ليدعو أهلها إلى الإسلام فأسلمت إحدى قبائلها الكبرى وهي همذان في يوم واحد ثم تتابع فيها انتشار الإسلام ولكنه لم يعم اليمن كلها.
وفي السنة العاشرة أرسل النبي علياً مرة ثانية مع قوة قليلة لا تتجاوز الثلثمائة فارس ليرى أمر اليمن، ويبدو أن من لم يسلموا استقلوا القوة الإسلامية فناوشوها قليلاً ولما رأوا عجزهم تراجعوا ثم أسلم الجميع. ورجع علي إلى الحجاز فالتقى بالنبي (ص) في مكة وهو يحج حجة الوداع.
حجة الوداع
كانت سنة عشرة من الهجرة وسميت بذلك لأنه لم يحج بعدها وقيل لأنه ودَّع فيها الناس وأعلمهم بدنو أجله. وكان المسلمون يسمونها حجة الإسلام وكان ابن عباس يكره أن يقال حجة الوداع ويقول حجة الإسلام فقد كانت حجة الوداع لأن محمد رأى فيها مكة لآخر مرة. وكانت حجة الإسلام لأن الله قد أكمل فيها للناس دينه وأتمَّ عليهم نعمته. ولم يحج قبلها منذ هاجر.
أراد رسول الله (ص) التوجه إلى الحج وأداء ما فرض الله تعالى عليه فيه فأذّن في الناس بالحج وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الإسلام فتجهز الناس للخروج معه وحضر إلى المدينة من ضواحيها ومن حولها خلق كثير وتأهّبوا للخروج فخرج (ص) بهم يوم الخميس أو يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. وفي السيرة الحلبية: خرج معه أربعون ألفاً وقيل أكثر من ذلك عدا من حجَّ معه من أهل مكة واليمن. قال ابن سعد خرج من المدينة فصلَّى الظهر بذي الحليفة ركعتين وكاتب علياً (ع) بالتوجه إلى الحج من اليمن فلمَّا قارب رسول الله مكة عن طريق المدينة قاربها علي عن طريق اليمن وسبق الجيش للقاء النبي وخلف عليهم رجلاً منهم فأدرك النبي وقد أشرف على مكة فسلَّم عليه وأخبره بم صنع وأنه سارع للقائه أمام الجيش فسرّ رسول الله بذلك وابتهج بلقائه.
عن ابن هشام ملخصاً: لما أقبل علي من اليمن لتلقي رسول الله بمكة تعجَّل إلى رسول الله واستخلف على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه فتصرف ذلك الرجل بالغنائم تصرفاً لم يجده علي محقاً فيه فأعاد الأمر إلى ما كان عليه. فأظهر بعضهم تذمره من ذلك فأمر رسول الله منادياً فنادى في الناس: ارفعوا ألسنتكم عن علي بن أبي طالب فإنه خشن في ذات الله عزَّ وجلَّ غير مداهن في دينه فكف القوم عن ذكره وعلموا مكانه من النبي وسخطه على من رام الغمزة فيه. وقد أمر النبي (ص) الناس ببعض التعليمات الجديدة بشأن الحج ولكن أكثرهم لم يطبقها وخالفوها فغضب النبي (ص) لمخالفتهم له أشدّ الغضب.
روى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة قالت: قدم رسول الله فدخل علي وهو غضبان قلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار، قال: أو ما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولما أراد النبي دخول مكة اغتسل ودخلها نهاراً من أعلاها من كداء وضرب خيامه بالأبطح ومضى حتى انتهى إلى باب بني شيبة وهو المعروف اليوم بباب السلام فدخل المسجد وطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلَّى خلف المقام ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة من فوره ذلك، ثم عاد إلى منزله. فلمَّا كان قبل التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهر ثم خرج يوم التروية إلى منى فبات بها ثم غدا إلى عرفات فوقف بها وخطب الناس بعرفات خطبة أكَّد فيها على تحريم الربا والقتل وأخذ مال الغير وأوصى بمعاملة النساء معاملة حسنة ثم ختم خطبته بقوله: إني تارك فيكم ما إن تمستكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
خبر غدير خم
ثم إن رسول الله (ص) لما قضى مناسكه قفل راجعاً إلى المدينة فوصل إلى الموضع المعروف بغدير خم يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة وهو مكان قريب من الجحفة بناحية رابغ وليس هو بموضع إذ ذاك يصلح للنزول لعدم الماء فيه والمرعى فنزل به ونزل المسلمون. وعلم أنه إن تجاوز غدير خم انفصل منه كثير من الناس إلى بلدانهم وبواديهم فأراد أن يجمعهم لسماع النص على علي وتأكيد الحجة عليهم فيه. فنزل بذلك المكان ونزل المسلمون حوله وكان يوماً قائظاً شديد الحر وأمر بجمع الرحال ووضع بعضها فوق بعض ثم أمر مناديه فنادى في الناس: الصلاة جامعة فاجتمعوا إليه. فلما اجتمعوا إليه صعد على تلك الرحال حتى صار في ذروتها ودعا علي بن أبي طالب فرقى معه حتى قام عن يمينه ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ووعظ فأبلغ في الموعظة ونعى إلى الأمة نفسه وقال إني قد دعيت وأوشك أن أجيب وقد حان مني خفوق من بين أظهركم وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا. ثم نادى بأعلى صوته: ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. فقال لهم: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله. ثم نزل وكان وقت الظهيرة وصلَّى ركعتين ثم أذَّن مؤذنه لصلاة الظهر فصلَّى بهم الظهر وجلس في خيمته وأمر علياً أن يجلس في خيمة له بإزائه وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهنؤوه ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل الناس ذلك([172]).
وفي السيرة الحلبية لابن هشام: لما وصل (ص) إلى محل بين مكة والمدينة يقال له غدير خم بقرب رابغ جمع الصحابة فخطبهم إلى أن قال: فقال يا أيها الناس: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب «إلى أن قال»: ثم حضَّ على التمسك بكتاب الله وأوصى بأهل بيته قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا وقال في حق علي لما كرَّر عليهم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثلاثاً، وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف ورفع يد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره وأعن من أعانه واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. ثم قال: وهذا حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح.
وقال ابن كثير الشامي في تاريخه اعتنى بأمر هذا الحديث يعني حديث الغدير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة يعني خطبة يوم الغدير. ونقول: إن حديث الغدير متواتر ويكفي أن يكتب فيه مثل الطبري مجلدين.
مرض النبي ـ جيش أسامة
لم يطل بالمسلمين المقام في المدينة بعد عودهم من حجة الوداع حتى أمر النبي بتجهيز جيش أسامة بن زيد وجعل فيه كبار المهاجرين والأنصار ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم. واستثنى علي بن أبي طالب فلم يدخله في هذا الجيش ولم يجعله تحت قيادة أسامة.
وأمر النبي أسامة أن يسير إلى موضع قتل أبيه زيد بن حارثة وبعد يومين مرض النبي، ولكنه مع ذلك خرج فعقد لواء بيده لأسامة وخرج أسامة فعسكر بالجرف. فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب رسول الله غضباً شديداً فخرج وقد عصَّب على رأسه عصابة فصعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ولئن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله، وأيم الله إن كان للإمارة لخليقاً وأن ابنه من بعده لخليق للإمارة، ثم نزل فدخل بيته. وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول. واشتدَّ مرض رسول الله فجعل يقول انفذوا بعث أسامة. وروى ابن هشام في سيرته أن رسول الله استبطأ الناس في بعث أسامة وهو في مرضه فخرج عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر وقال: انفذوا بعث أسامة، ثم نزل. وتأخر الناس في جهازهم وقال ابن سعد: فجعل أسامة وأصحابه يتجهزون وقد عسكر بالجرف فمرض رسول الله وهو على ذلك ثم وجد من نفسه راحة فخرج عاصباً رأسه فقال: أيها الناس انفذوا بعث أسامة ثلاث مرات. وروى ابن سعد بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) : إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأنهما لن يفترقا فانظروا كيف تخلفونني فيهما. وقال المفيد في الإرشاد: إنه (ص) تحقق من دنو أجله فجعل يقوم مقاماً بعد مقام في المسلمين يحذرهم الفتنة بعده والخلاف عليه ويؤكد وصاتهم بالتمسك بسنته والاجتماع عليها والوفاق ويحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواية على اتفاق واجتماع من قوله: يا أيها الناس إني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفونني فيهما: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا تسبقوهم فتفرقوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا. أيها الناس لا ألفينكم بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان (ص) يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه ثم أنه عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الأمر وأمره وندبه أن يخرج بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم واجتمع رأيه على إخراج جماعة من مقدمي المهاجرين والأنصار في معسكره حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في أمر الرياسة ويطمع في التقدم على الناس بالإمارة ويستتب الأمر لمن استخلفه من بعده ولا ينازعه في حقه منازع فجد في إخراجهم وأمر أسامة بالبروز عن المدينة بعسكره إلى الجرف وحثَّ الناس على الخروج إليه والمسير معه وحذرهم من التلكؤ والإبطاء عنه فبينا هو في ذلك اشتدَّ عليه المرض الذي توفيه فيه «انتهى كلام المفيد».
وقال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة:
وإذا أمعنَّا في مجاري هذه الحوادث وتأملناها بإنصاف مجرد عن شوائب العقائد أمكننا أن نقول أن النبي (ص) مع ما تحققه من دنو أجله ومع عروض المرض له واشتداده عليه وهو مع ذلك كله يجتهد في تجهيز جيش أسامة ويحث عليه ويكرر الحث مراراً ويؤمر أسامة وهو غلام على وجوه المهاجرين والأنصار ولا يشغله ما هو فيه من شدة المرض وتحقق دنو الأجل عن الاشتداد في تجهيز جيش أسامة.
وقد كان مقتضى ظاهر الحال وسداد الرأي أن لا يبعث جيشاً فيه أكابر الصحابة وجمهور المسلمين في مثل تلك الحال التي يتخوف على نفسه فيها الموت لأن تدارك ما يخاف وقوعه عند وفاته وأحكام أمر الخلافة في حياته أهم من تسيير جيش لغزو الروم بل لا يجوز في مثل تلك الحال إرسال الجيوش من المدينة ويلزم تعزيز القوة فيها استعداداً لما يطرأ من الفتن بوفاته وقد صرَّح بذلك في قوله أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، لا سيما أنه قد بلغه ارتداد جماعة من العرب في عدة أماكن وادعاء بعضهم النبوة لما بلغهم مرضه كما نصَّ عليه الطبري في تاريخه. وعدم تمام ما حثَّ عليه من تجهيز جيش أسامة وبقاء أسامة معسكراً بالجرف حتى توفي النبي، كل ذلك يدلنا على أن في الأمر شيئاً وأن تجهيز هذا الجيش لم يكن أمراً عادياً لقصد الغزو والفتح بل لو قطعنا النظر عن ذلك لوجدنا أن ظاهر الأمر يقتضي أن يشتغل في مثل تلك الحال بنفسه وما عراه من المرض الشديد لا بتسيير الجيوش لغزو ليس فيه ما يقتضي الفور والعجلة مثل مهاجمة عدو أو طروء حادث لا يحسن التأخر عنه.
وروى ابن سعد في الطبقات بسنده عن أبي مويهبة مولى رسول الله (ص) عنه (ص) أنه قال في جوف الليل: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فخرجت معه حتى جاء البقيع فاستغفر لأهله طويلاً ثم قال ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى.
اشتداد مرض النبي
واستمر المرض فيه أياماً وثقل فجاء بلال عند صلاة الصبح ورسول الله مغمور في المرض فنادى: الصلاة رحمكم الله فأخبر رسول الله (ص) بندائه. يقول السيد محسن الأمين: وهنا اختلفت الرواية هل أمر رسول الله أحداً أن يصلي بالناس أو لا، فروى ابن هشام في سيرته أنه حين دعاه بلال إلى الصلاة قال: مروا من يصلي بالناس فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر فقال له: قم فصل بالناس وكان أبو بكر غائباً فلمَّا كبر سمع رسول الله صوته فأرسل إلى أبي بكر فجاء بعد أن أتمَّ عمر الصلاة صلَّى بالناس وروى الطبري عن عائشة أنه قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقالت عائشة أنه رجل رقيق فأعاد فغضب وقال: إنكم صواحب يوسف فخرج يعتمد على رجلين وقدماه تخطان في الأرض فلما دنا من أبي بكر تأخَّر فأشار إليه أن قم في مقامك فقعد إلى جنب أبو بكر قالت عائشة:
فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر وروى ابن سعد وغيره نحوه. وقال المفيد إنه قال: يصلي بالناس بعضهم فإني مشغول بنفسي فقالت عائشة مروا أبا بكر وقالت حفصة مروا عمر فقال رسول الله (ص) : اكففن فإنكن صويحبات يوسف وقام مبادراً وإنه لا يستقل على الأرض من الضعف فأخذ بيد علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فاعتمد عليهما ورجلاه تخطان الأرض من الضعف فلمَّا خرج إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب فأومأ إليه بيده أن تأخر عنه فتأخر وقام مقامه فكبَّر وابتدأ الصلاة التي كان قد ابتدأ بها أبو بكر ولم يبن على ما مضى من فعاله (اهــ) أقول: ما لنا ولما رواه هؤلاء المؤرخون المختلفون في العقيدة المختلفون في النقل فبعض يروي أنه لم يأمر أحداً بعينه أصلاً وبعض أنه لم يأمر بذلك في أول الأمر ثم أمر أبا بكر بعدما سمع عمر يكبر وأن الناس صلوا الصبح مرتين وبعض يروي نه أمر أبا بكر من أول الأمر، ما لنا ولهذه الأخبار المتناقضة لكننا نقول أنهم اتفقوا جميعاً على أن رسول الله خرج إلى المسجد في حالة شديدة من المرض والضعف حتى أنه لا يكاد يستقل ولا ينقل قدميه بل اعتمد على رجلين ورجلاه تخطان الأرض خطاً وصلى جالساً فإن كان يريد بذلك تأييد أبي بكر فقد عينه للصلاة وصلى الناس خلفه ولو لم يخرج لكان أشد تأييداً له لأنه بخروجه وقعت الشبهة في أنه لعله لم يرض بتقدمه، وائتمام الناس بأبي بكر وائتمام أبي بكر بالنبي يوجب أن يكون إماماً ومأموماً في وقت واحد وهذا غير جائز في الشرع ولِمَ لم يتركه إماماً إلى آخر الصلاة؟ (انتهى كلام السيد محسن).
طلب الدواة والقرطاس
«قال المفيد» فلما أتمَّ النبي الصلاة انصرف إلى منزله واستدعى أبا بكر وعمر وجماعة ممن حضر بالمسجد من المسلمين ثم قال ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة فقالوا بلى يا رسول الله فقال: فلم تأخرتم عن أمري؟ فقال أبو بكر: إني خرجت ثم رجعت لأجدد بك عهداً وقال عمر يا رسول الله إني لم أخرج لأني لم أحب أن أسأل عنك الركب فقال النبي (ص) : انفذوا جيش أسامة يكررها ثلاث مرات ثم أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف فمكث هنيهة مغمى عليه وبكى المسلمون وارتفع النحيب من أزواجه وولده ونساء المسلمين وجميع من حضر من المسلمين، فأفاق رسول الله فنظر إليهم ثم قال ائتوني بدواة لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ثم أغمي عليه فقام بعض من حضر يلتمس دواة فقال له عمر: إرجع فإنه يهجر فرجع وندم من حضر على ما كان منهم من التضييع في إحضار الدواة وتلاوموا بينهم وقالوا إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون لقد أشفقنا من خلاف رسول الله فلما أفاق قال بعضهم ألا نأتيك بدواة يا رسول الله فقال أبعَد الذي قلتم؟ لا ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيراً وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا وروى البخاري في الجزء الرابع من صحيحه قال: لما حضر رسول الله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده فقال عمر أن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف الحاضرون فاختصموا منهم من يقول قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال رسول الله قوموا. ورواه ابن سعد مثله إلاَّ أن في ألفاظه بعض الاختلاف قال: لما كثر اللغط والاختلاف وغموا رسول الله قال قوموا عني. وروى البخاري في الجزء الثالث من صحيحه: اشتدَّ برسول الله وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر؟ استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من شبه جزيرة العرب وأجيزوا الوفود نحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. ورواه البطري في تاريخه إلاَّ أنه قال لا تضلوا بعدي وقال: فذهبوا يعيدون عليه وسكت الراوي عن الثالثة عمداً أو قال فنسيتها. ورواه ابن سعد في الطبقات مثله إلاَّ أنه قال ائتوني بدواة وصحيفة وقال فذهبوا يعيدون عليه وقال فسكت الراوي عن الثالثة، فلا أدري، قالها فنسيتها أو سكت عنها عمداً. قال السيد محسن الأمين: والمتأمل لا يكاد يشك في أن الثالثة سكت عنها المحدثون عمداً لا نسياناً وأن السياسة اضطرتهم إلى السكوت عنها عمداً وتناسيها وأنها هي التي طلب الدواة والكتف ليكتبها لهم. وروى البخاري في صحيحه قال: لما حضر رسول الله وفي البيت رجال قال النبي هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده فقال بعضهم أن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف من في البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا.
قال القسطلاني في إرشاد الساري بعد قوله فقال بعضهم: إن القائل هو عمر بن الخطاب وروى ابن سعد في الطبقات: قال اشتكى النبي يوم الخميس فقال: ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً فقال بعض من كان عنده أن نبي الله ليهجر. ورواه الطبري في تاريخه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بتفاوت يسير قال: قال رسول الله: ائتوني باللوح والدواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده فقالوا إن رسول الله يهجر.
وقال الأستاذ أحمد أمين صاحب كتاب فجر الإسلام في كتابه يوم الإسلام:
وقد أراد الرسول (ص) في مرضه الذي مات فيه أن يعين من يلي الأمر بعده، ففي الصحيحين أن رسول الله (ص) لما احتضر قال: «هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده» وكالن في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب فقال عمر: إن رسول الله (ص) قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله فاختلف القوم واختصموا منهم من يقول قربوا إليه يكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: القول ما قاله عمر: فلما أكثروا اللغو والاختلاف عنده، قال لهم: قوموا فقاموا.
ثم يعلق الأستاذ أحمد أمين على ذلك قائلاً: وترك الأمر مفتوحاً لمن شاء جعل المسلمين طوال عصورهم يختلفون على الخلافة.
ابنته فاطمة
وكانت ابنته فاطمة تعوده كل يوم وكان يحبها ذلك الحب الذي يمتلئ به وجود الرجل للإبنة الواحدة الباقية له من كل عقبة. وكانت الحمى تصل به حتى يغشى عليه أحياناً ثم يفيق وهو يعاني منها أشد الكرب، حتى قالت فاطمة يوماً وقد حزَّ الألم في نفسها لشدة ألم أبيها: واكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. يريد أنه سينتقل من هذا العالم، عالم الأسى والألم.
وفاته
وتوفي وعمره ثلاث وستون سنة، بعث وعمره أربعون وأقام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة بعد الهجرة عشر سنين.
ولما توفي رسول الله كان أبو بكر بمنزله بالسنح خارج المدينة، قال الطبري وابن سعد وغيرهما: فقال عمر: إن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات، والله ليرجعن رسول الله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر فدخل فرآه ثم خرج فقال أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ الآية، قال عمر فلما تلاها وقعت إلى الأرض وعرفت أن رسول الله قد مات، وقال السيد محسن الأمين: وقد سبق لعمر أن قال نظير ذلك في مرض رسول الله (ص) حين طلب الدواة والصحيفة في حديث ابن سعد.
والمظنون أنه لم يكن ليخفى عليه موت النبي وأن الذي دعاه إلى ذلك أمر سياسي في المقامين فأراد في المقام الأول صرف الناس عن أمر الصحيفة وفي المقام الثاني صرفهم عن التكلم بشيء حتى يحضر أبو بكر والله أعلم «انتهى».
قال المفيد: ولم يحضر دفنه أكثر الناس لما جرى بين المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة وفات أكثرهم الصلاة عليه لذلك.
ملاحظة في كتاب الدكتور هيكل
«حياة محمد»
يقول في ص 60 ـ 61 ـ 62 من الطبعة الثالثة ما حاصله أنه يلقي على عاتق علماء الإسلام القيام بالمباحث الإسلامية ـ لإقناع المستشرقين ـ بدقة ونزاهة ثم قال: وعندي أن القيام به على وجه صالح يقتضي التفريق بين فترتين مختلفتين من تاريخ الإسلام «أولهما» من بدء الإسلام إلى مقتل عثمان، «الثانية» من مقتل عثمان إلى أن أُقفل باب الاجتهاد، ففي الفترة الأولى بقي اتفاق المسلمين تاماً لم تغير منه روايات الاختلاف على الخلافة ولا حرب الردة ولا الفتوحات أما بعد مقتل عثمان فقد دبَّ الخلاف بين المسلمين وقامت الحروب الأهلية بين علي ومعاوية، واستمرت الثورات ظاهرة وخفية. ولعبت الأهواء السياسية دوراً خطيراً في الحياة السياسية نفسها، ثم وازن بين خطبة لأبي بكر وخطبة للمنصور وقال أن الموازن بينهما يرى مدى التغير العظيم في القواعد الأساسية للحياة الإسلامية في أقل من قرنين تغيراً نقلها من المشورة بين المسلمين إلى الحكم المطلق. ثم قال: إن الفترة الأولى هي التي تقررت فيها القواعد الصحيحة للحياة الإسلامية وهي وحدها التي يمكن الاعتماد على ما وقع فيها لمعرفة هذه القواعد ىالصحيحة أما بعد هذه الفترة فعلى الرغم من ازدهار العلم أيام الأمويين وخاصة أيام العباسيين قد اندست يد العبث بهذه القواعد الأساسية الصحيحة لتقيم مقامها قواعد كثيراً ما تتنافى مع روح الإسلام تحقيقاً لأغراض سياسية شعوبية وكان غير العرب والذين تظاهروا بالإسلام من اليهود والنصارى هم الذين روجوا لهذه القواعد الجديدة غير متورعين عن اختراع الأحاديث عن النبي ولا عن ادعاء أشياء على الخلفاء الأولين لا تتفق مع سيرتهم. هذه الفترة الأخيرة لا يمكن الاعتماد على ما دُوِّنَ فيها دون تمحيصه بغير تأثر بالأهواء ويجب أن نرد مما وقع الخلاف عليه كل ما لا يتفق مع القرآن أما صدر الإسلام إلى مقتل عثمان فيمكن الاعتماد على ما يروي مباشرة عنه «انتهى ملخصاً».
ونقول: تفريقه بين الفترة الأولى والفترة الثانية بأن الأولى بقي اتفاق المسلمين فيها تاماً لم تغيره روايات الخلاف على الخلافة الخ والثانية وقع الاختلاف فيها بين المسلمين وقامت الحروب ودخلتها الأهواء السياسية غير صحيح لأمور:
الأول: أن الفترة الأولى كان الاختلاف فيها على الخلافة موجوداً من أولها فعلي كان يرى نفسه أحق بها وكان كثير من المسلمين يرون معه رأيه. وسعد بن عبادة طلبها لنفسه ولم يبايع وسكن حوران ثم اغتيل بسهم المغيرة بن شعبة.
ووقع الخلاف فيها بين الزهراء والخليفة الأول على فدك وعلى الميراث وماتت فاطمة وهي واجدة عليه كما رواه البخاري وانفرد الخليفة الأول برأيه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولم توافق على ذلك الزهراء ولا بعلها ولا أولياؤه.
الثاني: أن الأهواء السياسية مخلوقة من يوم خلق الإنسان لم يختص بها زمان دون زمان فحصرها فيما بعد قتل عثمان ليس بصواب.
الثالث: أن الخلاف وقع بين الخليفة الأول والثاني في أمر خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة وتزوج امرأته وكان الثاني لا يميل إليه وفور توليه الخلافة عزله عن قيادة الجيش فهل يا ترى كان هذا من الاتفاق التام المدعى.
الرابع: أن الموازنة بين الخطب لا يمكن أن يستفاد منها الموازنة بين الأشخاص وسيرتهم وهذا واضح.
الخامس: دعواه انتقال الحياة الإسلامية من الشورى إلى الحكم المطلق بين المسلمين في أقل من قرنين غير صواب فتولي عمر الخلافة لم يكن بالشورى بل بنص أبي بكر عليه.
السادس: قوله أن الفترة الأولى هي التي يمكن الاعتماد على ما وقع فيها لمعرفة القواعد الصحيحة للحياة الإسلامية لا يكاد يتم فأيام الخليفة الثالث من أولها إلى مقتله كانت تذهب فيها يد مروان حتى أدَّت إلى قتله فأي قواعد صحيحة للحياة الإسلامية كانت فيها وكانت أبرز أمهات المؤمنين شخصية لا تزال تحرض عليه وتلقبه بما تلقبه وتخرج قميص الرسول وتقول ما تقول طمعاً في نقل الخلافة إلى قريبها التيمي كما دلَّ عليه قولها لما قتل: أيها ذا الأصبع وغير ذلك من كلامها وقد تركته هي وقريبها والزبير محصوراً وذهبوا إلى مكة ولم ينصروه بل حرضوا عليه فلما قتل خرجوا إلى البصرة يطلبون بدمه فهل هذه هي القواعد الصحيحة للحياة الإسلامية؟
السابع: إن الثورات لم تختص بالفترة الثانية، فالفترة الأولى كانت مملوءة بالثورات الفكرية ظاهرة وخفية وهي أهم من ثورات الحرب وهي التي سببت الحروب الأهلية والثورات في الفترة الثانية.
فالمتأمل المنصف يعلم أن الحياة الإسلامية في الفترة الأولى لم تكن دائماً مبنية على قواعد صحيحة وتلك القواعد هي التي زعزعت الحياة الإسلامية في خلافة الخليفة الثالث وفي باقي أدوار الفترة الثانية.
الثامن: دعواه أن في الفترة الثانية قد اندست يد العبث بقواعد الإسلام الصحيحة تحقيقاً لأغراض سياسية هي دعوى صحيحة فقد اجتهد الأمويون والعباسيون في اختلاق الأحاديث عن النبي في ذم علي وأتباعه وبذلوا على ذلك الأموال الطائلة وولوا الولايات الجليلة لمن يسمونهم صحابة ولغيرهم حتى رووا لهم أن آية ﴿وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك لحرث والنسل والله لا يحب الفساد﴾ نزلت في حق علي لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل إلى غير ذلك وحتى منعوا أن يسمي أحد باسمه أو يكنى بكنيته أو يروي عنه شيئاً ونصبوا للفتوى أناساً عملوا بآرائهم وبالمقاييس وأعرضوا عن مذهب أهل البيت ورواياتهم وما هو إلاَّ مذهب الرسول فوقع الخلل في قواعد الإسلام الصحيحة أما دعواه أن ذلك كان لأغراض شعوبية فهي دعوى غير صحيحة فالذين أفسدوا قواعد الإسلام الصحيحة ليقيموا مقامها قواعد تتنافى مع روح الإسلام تحقيقاً لأغراض سياسية هم بنو أمية العرب الصميمون وتابعهم بنو العباس ولم يكن للشعوبية في ذلك أدنى أثر.
التاسع: كون غير العرب لا سيما الفرس روجوا لهذه القواعد الخ فهذه نغمة لا يزال قوم يتغنون بها وهي نغمة شعرية مزوقة مزيفة قالها شخص وتبعه غيره وساعدت على رواجها العصبية المذهبية والعداوة الدينية واتباع الأهواء ولا حظ لها من الحقيقة. قال مروجو هذه النغمة ومزوقوها: إن الفرس لما فتحت بلادهم في عهد الخليفة الثاني دخلوا في الإسلام وتظاهروا بحب أهل البيت ليفسدوا في الإسلام، وينتقموا من أهله، وهذه دعوى غاية في السخافة فالذين دخلوا في الإسلام من الفرس في عهد الفتح الإسلامي كانوا أهل مذهب واحد بل لم يكن في جميع بلاد الإسلام عربهم وفرسهم إلاَّ مذهب واحد من حيث الأصول والفروع، وإنما حدث في الدولة الأموية: ما أطلق عليه العلوية والعثمانية، وفي الدولة العباسية اسم السنة والشيعة والمذاهب الأربعة، وهذا متأخر عن الفتح الإسلامي بكثير ولا أثر للفرس فيه وإن كان دخل في بلاد الفرس شيء منه فبعدما دخل في بلاد العرب، فبلاد الفرس في أول الفتح الإسلامي لم يكن فيها مذاهب متعددة، وبعد حدوث المذاهب كان الغالب على أهلها خلاف مذهب أهل البيت إنما انتشر مذهب أهل البيت فيها في عهد الصفويين من المائة التاسعة فما فوق ومع ذلك كانت لا تزال بخارى والأفغان وغيرها على خلاف ذلك، فمتى كان هذا الزمان الموهوم الذي اندست فيه يد العبث بقواعد الإسلام الصحيحة لتقيم مقامها قواعد تتنافى مع روح الإسلام لأغراض سياسية شعوبية؟ وأحرى أن يكون العابثون بقواعد الإسلام الصحيحة هم الذين قُتِلَ آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وعشائرهم في بدر وغيرها على الإسلام، فأرادوا الانتقام من الإسلام بسيف الإسلام وتحت لواء الإسلام تحقيقاً لأغراض سياسية انتقامية لا شعوبية.
العاشر: كون الذين تظاهروا بالإسلام من اليهود والنصارى ممن روَّجوا لهذه القواعد الجديدة فهذه أيضاً نغمة من فروع النغمة السابقة، أما في حق اليهود فنسبها ناسب إلى شخصية خرافية سموها عبد الله بن سبأ، وزعموا أنه كان يهودياً وأسلم ثم ادعى في علي الألوهية وأتباعه يعرفون بالسبئية([173])، فزعموا أنه هو الذي أثار فتنة عثمان وفعل ما فعل. وقد علم فساد ذلك مما مرَّ في الأمر السادس وعلم من هو الذي أثار فتنة عثمان وأن ابن سبأ ـ على فرض وجوده، وهو لم يوجد أصلاً ـ أقل وأذلَّ من ذلك. وأما في حق النصارى فلم يبينهم ولسنا نعلمهم لنبدي رأينا فيهم.
الحادي عشر: كون من ذكرهم هم الذين روَّجوا لهذه القواعد الجديدة بما اخترعوه من الأحاديث عن النبي وبادعاء أشياء على الخلفاء الأولين لا تتفق مع سيرتهم هو غير صحيح فالذين روَّجوا قواعد جديدة في الإسلام غير متورعين عن اختراع الأحاديث عن النبي ولا عن ادعاء أشياء على ابن عمه لا تتفق مع سيرته هم بنو أمية الذين بذلوا في ذلك الأموال العظيمة وولوا الولايات الجليلة على ذلك وتابعهم بنو العباس كما أشرنا إليه في الأمر الثامن لا الفرس ولا الذين تظاهروا بالإسلام من اليهود والنصارى.
الثاني عشر: إذا كان ما دُوِّنَ في الفترة الأخيرة لا يمكن الاعتماد عليه دون تمحيصه بغير تأثر بالأهواء ألزم عدم الاعتماد على ما يروى عن الفترة الأولى التي جعلها وحدها محل الاعتماد، لأن ما وقع في الفترة الأولى إنما نقله أهل الفترة الثانية التي لا يمكن الاعتماد على ما دُوِّنَ فيها والفترة الأولى لم تكن فترة تدوين. وإن كان فإنما نقله لنا أهل الفترة الثانية.
الثالث عشر: ما شرطه للاعتماد على ما دُوِّنَ في الفترة الأخيرة من التمحيص بغير تأثر بالأهواء نريد أن نسأله عن هذا الشرط أين يوجد لنتبع من يوجد فيه «فكل يَدعي وصلاً بليلى».
الرابع عشر: جعله صدر الإسلام إلى مقتل عثمان يمكن الاعتماد على ما يروى مباشرة عنه لا يفهم له معنى محصل، فالراوون عنه مباشرة إنما نقل لنا رواياتهم أهل الفترة الثانية الذين لا يعتمد على نقلهم([174]).
ركائز التفكير الإسلامي
1 ـ القرآن والعقل:
إن القرآن يجعل للعقل السلطان الأعلى في إدراك كل معاني الحق والخير من أتفه الأمور كإماطة الأذى عن الطريق، إلى أعظمها وهو وجود الله وصفات كماله. في القرآن أكثر من 300 آية تدعو إلى تحكيم العقل وتزري إزراءً شديداً بالذين لا يحكمون عقولهم، وأبلغ هذه الآيات وأوجعها قوله: ﴿إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون﴾. وكل إيمان لا يبنى على العقل لا يعد من الإيمان الكامل. أما إيمان العجائز فإنما هو مقبول من باب العذر ورفع الحجر عن العاجزين.
والقرآن يكره الجمود على تقاليد الآباء والأجداد إذا كانت هذه التقاليد تناهض أحكام العقل القاطعة، ويهزأ بهؤلاء الجامدين، ويسخر من الخرافات والأساطير، وليس فيه أسرار يحدث تصورها تناقضاً في الذهن. وكل نص في القرآن يحدث تصوره، في الظاهر، تناقضاً عقلياً في الذهن يجب تأويله حتى يرتفع التناقض.
فالإسلام، إذن هو الدين السماوي الذي يجعل الجدل العقلي الصارم طريقاً إلى الوصول إلى الحق.
هذه حقائق يقينية مقررة، حتى تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة، ومن جهلها أو أنكرها فهو جاهل لحقيقة القرآن والإسلام.
2 ـ القرآن والحرية:
إن حرية الإنسان، في نظر القرآن، هي أمر طبيعي وضروري وبديهي. وإن حرية الفرد مطلقة إلى آخر حدود الإطلاق، ولا تقف إلاّ إذا اصطدمت بالحق أو بالخير.
وهذا المفهوم الجامع، كما أنه يشمل كل أنواع الحريات، من حرية التفكير وحرية العقيدة والقول والعمل والتملك والتصرف، فإنه يشمل، كذلك، كل أنواع الحق والخير. بالنسبة إلى الفرد ذاته، وبالنسبة إلى المجتمع، لا فرق، وبالنسبة إلى غيره من الناس، في ذلك كله، بين أن يكون الفعل أو القول مباحاً بذاته للفرد، أو حقاً من حقوقه المشروعة، أو ضرباً من القربات إلى الله. فلو أسرف الفرد في أكل الطيبات إسرافاً مضراً بصحته انقلب المباح حراماً، ولو أسرف في إساءة استعمال حقه وقف حقه، ولو أسرف في الزهد والتقشف، والتبتل، بل في العبادة نفسها، بل في الصدقات والمبرات، إلى الحد الذي تصطدم عنده حريته بخير نفسه أو زوجه أو ولده أو وارثه أو المجتمع، لانقلبت قرباته هذه كلها إلى محرمات يمنعها القرآن.
3 ـ القرآن والعلم:
إن القرآن يجعل لحقائق العلم الطبيعية القاطعة، القوة نفسها للحقائق الرياضية القاطعة، أي السلطان نفسه الذي للعقل. لأن العلوم الطبيعية إنما هي انكشاف للنواميس التي خلقها الله في الكون، فإنكارها، هو بالضرورة، إنكار للعقل الذي يدرك النواميس وإنكار للذي خلق النواميس، ومعارضة للقرآن الذي استدلَّ في آيات كثيرة، بهذه النواميس على وجود الله وقدرته. وهذه الإنكارات تؤلف بذاتها تناقضاً عقلياً صارخاً بين الإيمان والعقل.
وليس صحيحاً القول أن العلم الذي حثَّ على طلبه الإسلام هو في جوهره العلوم الدينية والشرعية وما يتعلق بها وليس الفيزياء والكيمياء. ولو كان الغزالي وهو الذي يقول ذلك. بل الحث عام يشمل علم الدين ويشمل علم الطب وكل علم ينفع الناس والمجتمع. وليس أدلَّ على ذلك من الآية من سورة فاطر، التي يخلع بها القرآن وصف الخشية الكاملة على علماء الطبيعة، ويكاد يحصرها بهم حين يقول: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾. فهل العلماء هنا علماء الشريعة والفقه، أم هم علماء الطبيعة العالمون بأسرار النواميس في الحياة والنبات والحيوان والمطر وطبقات الأرض؟
4 ـ القرآن ليس بموسوعة:
ولكن القرآن ليس بموسوعة للعلوم والفنون. وما فيه من الإشارات إلى بعض النواميس الطبيعية إنما هو للتدليل على وجود النظام المحكم، ثم الاستدلال العقلي بهذا النظام على وجود الله، وأما قول القرآن: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ فليس معناه أنه موسوعة لعلوم الأولين والآخرين، كما يقول بعض البلهاء. بل معناه أنه لم يترك أصلاً من الأصول ولا مبدأ من المبادئ التي يرتكز عليها الحق والخير إلاَّ ذكره وبيّنه.
5 ـ نهج القرآن في الخطاب:
إن إعجاز القرآن اللغوي لا يقوم على بلاغته المعروفة عند بلغاء العرب فحسب، وإنما يقوم على قدرة عجيبة في التعبير عن الحق بشأن النواميس الطبيعية والاجتماعية، التي لم تكن معروفة للعرب، أو معروفة للبشر، بيان يفهمه البدوي الساذج على قدره، ويفهم أسراره المدهشة العالم أو الفيلسوف على قدره. لأنه ما كان لله العليم الحكيم أن يخاطب الناس بأمور لا يفهمونها ولا سمعوا بها ولا تتسع لإدراكها معارفهم.
فإذا قال لهم سبحانه: ﴿ويمسك السماء أن تقع على الأرض﴾ [الحج: 65] أو قال لهم: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين﴾ ﴿وجعلنا آية النهار مبصرة﴾ [الإسراء: 12]، أو قال لهم: ﴿يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل﴾ [الزمر: 6]، أو قال لهم: ﴿والفلك تجري في البحر بأمره﴾ [الحج: 65]، أو قال لهم: ﴿أفرأيتم النار التي تورون* أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون﴾ [الواقعة: 71 و72]، أو قال لهم: ﴿ألم نجعل له عينين﴾ [البلد: 8]، أو قال غير ذلك من مئات الآيات الدالة على قدرته المشيرة إلى النواميس التي وضعها في مخلوقاته، فإنه يقول لهم ما يفهمونه على ظاهره من غير أن يشوش أفهامهم ويذهل عقولهم بذكر مما لا يفهمون من أسرار نواميس الجاذبية، والنور، والبصريات، ودوران الأرض على نفسها أمام الشمس، وقانون أرخميدس، أو أسرار عملية المطر، أو أسرار ناموس الاحتراق عند اتحاد الكربون مع الأوكسجين. ولكنه سبحانه يقول لمن سيأتي من العلماء الذين يطلعون على هذه الأسرار: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾. وقد جاء الوقت وانكشف بعض الأسرار وتبين الحق.
6 ـ قانون العلية:
من ركائز التفكير العقلية في القرآن أمر الفطرة، ومن جملتها «قانون العلية» ذلك أن في عقولنا قوانين فطرية وهي التي سماها كانط «قوانين العقل المنظمة».
ومن جملتها، بل من أعظمها قانون العلية، الذي يتطلب بالبداهة لكل معلول علة ولكل مسبب سبباً، هذا مقرر، وليس لنا أن نتطلب عقولاً وراء عقولنا التي فطرنا الله عليها ﴿فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها﴾ [الروم: 30]. وبهذه الفطرة من قانون العلية ندرك وجود الله. ومهما اختلف المتفلسفون في هذه الفطرة وكونها مكتسبة من تجارب الإنسان الطويلة، أو كونها من خلق الله، فإن قانون العلية الذي اعتبره ديكارت صادقاً وغير خادع، واستدلَّ به على الله، وعلى صفات كماله، وهو على كل حال القانون العقلي الذي يتحكم في إدراكنا لكل ما في الوجود، وعليه يقوم العلم، وعليه تقوم المعرفة، وعليه تقوم الحياة، وعليه يقوم الإيمان بالله.
7 ـ ميزان التناقض:
إن النظر العقلي يدور في كل شيء من الماديات والمعنويات، والمشاهدات والمغيبات حول أحكام ثلاثة: الوجوب والإمكان والاستحالة هذا مفهوم عند أبسط الناس علماً وفهماً، ولكن الذي يشتبه ويخفى على بعض أرقى المثقفين من الشباب أحياناً، هو التفريق بين نوعين من المستحيل: المستحيل العقلي وهو الذي يشكل تصور وجوده أو تصور عدمه تناقضاً عقلياً في الذهن، كقولنا الواحد ربع الاثنين لا نصف الاثنين، أو قولنا جزء الشيء أكبر من الشيء أو قولنا جبل لبنان يدخل في الفنجان. أما المستحيل العادي فهو لا يحدث تناقضاً عقلياً في الذهن، ولكننا بحكم العادة نظن أنه مستحيل، وما هو كذلك ولكننا تعودنا أن نراه مستبعداً كالمستحيل ثم عرفتنا الأيام أنه ليس بمستحيل عقلي: مثل الصعود إلى السماء، والتخاطب والتناظر من أقاصي الأرض، والوصول إلى القمر. والميزان الضابط في تكذيب الخبر ليس استبعاده واستغرابه بل هو كونه يحدث تناقضاً عقلياً، كما يقول لايبنتز. فإن أحدثه نفيناه وإن لم يحدثه توقفنا عن التكذيب. فلا يغفلن الشباب المثقف عن التفريق بين هذين النوعين من المستحيل إذا هو تورَّط في جدل مع نفسه حول الله والدين وأخبار القرآن.
8 ـ نطاق العقل:
من ركائز التفكير الإسلامي الراسية على أصول القرآن، التفريق في الإدراك، بين عالم الغيب وعالم الشهادة. وهذا نفسه ما عرفته الفلسفة وأوضحه كانط. فهنالك نوعان من الإدراك للموجودات، إدراك لكُنْه الشيء بذاته، وإدراك لوجوده بالدليل، مع العجز المطلق عن إدراك كُنْه ذاته. فالعقل البشري قد يستطيع إدراك كنه الشيء بذاته إلى حد ما، ضمن نطاق محدود، وهو نطاق العالم المادي المحسوس «عالم الشهادة» أما في عالم الغيب غير المحسوس فالعقل يستطيع إدراك وجود الشيء بالاستدلال، ويستطيع إدراك بعض صفاته من آثاره، ولكنه يعجز عن إدراك كنه ذاته. هذا مقرر لا يحتمل الجدل وبهذا الإدراك نستدل على وجود الله، وعلى بعض صفات كماله، من آثاره بدون أن نستطيع إدراك كُنْه ذاته.
9 ـ التصور والتعقل:
ومن ركائز الفكر الإسلامي الذي ينبع من أصول القرآن أن نفرق بين التعقل والتصور وهكذا يقول العلم، وهكذا تقول الفلسفة الصحيحة. فليس كل ما يمكن تعقله يمكن تصوره لأننا قد نعقل وجود الشيء بالدليل، ولكن لا نستطيع أن نتصوره. وليس عجزنا عن تصور الشيء الذي تعقلناه مبرراً للقول بعدم وجوده. أترانا نستطيع أن نتصور أن صحيفة من ورقة السجاير الرقيق الرقيق، إذا قطعت بالتضعيف 45 مرَّة ثم ركمت صعوداً تدق بالقمر؟ ولكننا بالحساب البسيط نتعقله. وإذا ألقي إلينا من المجرة مثلاً جهاز تلفزيون أفلا نستدل به على وجود صانع، ثم نستدل به على بعض صفات ذلك الصانع، التي منها أنه عاقل وفلكي وعالم؟ ولكننا مع تعقل وجوده وتعقل بعض صفاته لا نستطيع تصور كنه ذاته، لأننا لم نشاهده ولم نحسه فلا ندري أهو من البشر أم من نوع الإنسان الآلي، ولكن هل يصح، في حكم العقل، أن ننكر وجوده لأننا لا نستطيع تصور كنه ذاته بعدما تعقلنا وجوده وبعض صفاته بالدليل العقلي القاطع؟
10 ـ غايات الأشياء:
ومن ركائز التفكير الإسلامي الراسية على أصول القرآن إننا محجوبون عن إدراك بدايات الأشياء ونهاياتها. هذا مقرر، هكذا خلقت عقولنا بل هكذا خلقت حواسنا، حتى في عالم المادة الذي نعيش فيه، كما يقول باسكال. فالصوت إذا أفرط في الشدة، يصم أسماعنا، أو على الأصح لا نسمعه، والنور إذا أفرط في الشدة يغشي أبصارنا بل يصعقنا كما صعق موسى، والقرب يمنعنا من الرؤية إذا أفرط، كما يمنعنا البعد. هكذا في عالم الشهادة فكيف إذا كان الأمر الذي نريد معرفة أولياته وبداياته ونهاياته وغاياته في عالم الغيب؟
11 ـ الظن والحق:
من ركائز التفكير الإسلامي ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ [النجم: 28] وهذا هو نفسه منطق العقل في إثبات الشيء ونفيه. هنالك فرق كبير، عند القطع والجزم بين الإثبات والنفي، فنحن نجزم بثبوت الشيء الذي يقوم الدليل العقلي أو العلمي القاطع على وجوده. ولكن لا يحق لنا أن نجزم بنفي الشيء أو الخبر الذي لم يقم لدينا الدليل على وجوده. إلاَّ إذا كان تصور وجود هذا الشيء، أو هذا الخبر، يشكل تناقضاً عقلياً في الذهن، كما يقول لايبنتز. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، وكان الشيء أو الخبر من النوع الممكن، فإننا نقف أمامه موقفنا من كل ممكن غير مستحيل، فلا نقطع بثبوته عقلاً ولا نقطع بنفيه عقلاً.
12 ـ نواميس الله لا تختلف:
﴿فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا﴾ [فاطر: 43].
وكذلك يقول العلم أن النواميس الكونية ثابتة لا تتعطل ولا تختلف. ولكن الإنسان يستطيع أن يوقف تأثير ناموس بناموس آخر. ولا يقال، هنا، أن الإنسان عطل فعل الله، أو عطَّل خلق الله. ولكن يقال أن ناموس الله تعطَّل بناموس الله، كما في تأخير نمو الخلية الإنسانية في الجنين أو إفسادها أو تشويهها بالمواد الكيميائية أو بالأشعة.
هذه أهم الركائز في التفكير الإسلامي النابع من معين القرآن، وهي تكاد تكون كالبديهيات في منطق العلم ومنطق القرآن، وهي الكفيلة بالرد على كل التساؤلات والشكوك والصعوبات التي أثيرت وتثار وبالرد على كل صعوبة يجدها الشاب الثقيف في بعض آيات القرآن، حتى يفهمها، أو يكف عن تكذيبها على الأقل. ويكفي الشاب الثقيف إذا كان يسأل للاستفهام حقاً، لا للجدل والمراء ﴿بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير﴾ [الحج: 9] أن يعرض شكه على هذه الركائز. وينعم النظر فيها، ليجد الجواب الذي يرضاه العقل السليم، والمنطق القويم، والقرآن الكريم.
نديم الجسر
الرق في الإسلام
الإسلام لم ينظر لمشكلة الرقيق على أنها مشكلة قائمة بذاتها منفصلة عن غيرها من المشاكل بل نظر إليها على أنها مشكلة تظافرت عليها عوامل كثيرة حتى أوجدتها. فهي وليدة عديد من المشاكل التي لولا وجودها ما وجدت مشكلة الرقيق.
كذلك تتبع الإسلام المشاكل التي تسببت في وجود نظام الاسترقاق، ووضع الحلول الحاسمة التي تقضي على هذا النظام القديم المتوارث من آلاف السنين، وتقتلع جذوره الضاربة في أعماق المجتمعات الإنسانية، تقتلها من الأساس.
كانت منابع الرق قبل الإسلام تتلخص فيما يلي:
1 ـ الحروب وما ينتج عنها من أسرى.
2 ـ القرصنة واللصوصية والخطف.
3 ـ الربا والميسر.
4 ـ توالد الرقيق.
أما أسرى الحرب فقد حدد الإسلام مصيرهم في الآية القرآنية: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ وهكذا فليس الرق مفروضاً على الأسرى فإما إطلاقهم قربة لله وحرصاً على مكارم الأخلاق التي يدعو القرآن دائماً إليها، وإما أن يفتدي الأسرى أنفسهم بالمال، أو يفتدى المسلمون الذين في أيدي أعدائهم بمن في أيديهم من أسرى الأعداء.
كما اعتبر الإسلام القرصنة واللصوصية والخطف أعمالاً إجرامية محرَّمة فلم يقر سرقة الناس من بلادهم أو الإغارة عليهم ثم استرقاقهم، بل جعل عقوبة ذلك صارمة وكذلك حرم الربا والميسر وما يترتب عليهما. وبقي التوالد وقد فرض الإسلام تحرير المرأة المستعبدة حينما تحمل من زوجها الحر وتلد له ولداً.
وقد بقيت في المجتمع الإسلامي رواسب للرقيق من عصور الجاهلية ورواسب من أسرى الحروب التي كانت مشتعلة، وقد دعا الإسلام إلى تحرير ما بقي من الرق، وجعله يقف مع غيره أمام القضاء موقف الند للند في جميع الحقوق والواجبات، أما في الجرائم فقد خفف عنه العقوبة في مقابل ما نقص من حريته.
وطريقة الإسلام في أحكامه، أنه عندما يتعلق الأمر أو النهي بمسألة اعتقادية أو أخلاقية فإنه يقضي فيها فيما يريد قضاءً حاسماً منذ اللحظة الأولى.
ولكن عندما يتعلق بعادة شعورية أو بوضع اجتماعي فإنه يتريث ويأخذ الأمر باليسر والتدرج حتى يبلغ إلى الهدف الذي يرمي إليه في رفق وهوادة.
فعندما كانت المسألة مسألة عقيدة كالشرك أمضى أمره بتحريمه في خطوة جازمة قاطعة. كذلك صنع في تحريم الزنا والسرقة والغش والخيانة … وغيرها. لأن التحريم البات هنا إبطال لأمر ليس عميق الجذور في أعماق النفس أو أعماق المجتمع، ولا يترتب عليه انتقال مفاجئ من عادة إلى عادة، أو من وضع إلى وضع.
فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة شعورية وألف وعرف والعادة تحتاج أحياناً إلى التدرج في تركها، فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع، وفي هذا إشارة إلى أن تركها أولى. ثم جاءت الخطوة الثانية بتحريم الصلاة على السكارى حتى يعلموا ما يقولون. والصلاة تقع في خمسة أوقات معظمها متقارب لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب بعد تضييق الفرص الشعورية بما قدم أن الإثم أكبر من النفع. حتى إذا جاءت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر.
وأما في الرق فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي، وعرف دولي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق. والأوضاع الاجتماعية تحتاج إلى تعديل شامل لمقدماتها وارتباطاتها. والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية. ولم يأمر الإسلام بالرق قط، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى. ولكن الإسلام جاء فوجد الرق نظاماً عالمياً، ووجد استرقاق الأسرى عرفاً دولياً. فلم يكن بد من أن يتريث في علاج هذا الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل، وقد اختار أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله مع الزمن إلى الإلغاء دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها.
بدأ بتجفيف موارد الرق ومنابعه كلها كما رأينا فيما تقدم فيما عدا أسرى الحرب الشرعية. ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق الأسرى المسلمين حسب العرف الدولي العام في ذلك الزمان وما كان الإسلام قادراً يومئذٍ على أن يجبر المجتمعات على مخالفة ذلك العرف الدولي. ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصوراً على الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين. بينما الأسرى المسلمون يلاقون مصيرهم السيئ في عالم الرق هناك وفي ذلك إطماع للمعادين للإسلام في أهل الإسلام.
لهذا الوضع الاجتماعي القائم لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى بل قال: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ ولكن لم ينص كذلك على عدم استرقاقهم. وترك للدولة المسلمة معاملة أسراها حسب ما تتفق عليه مع محاربيها فتفدي من تفدي من الأسرى من الجانبين، وتتبادل الأسرى من الفريقين. وتسترق من يسترقون المسلمين كي لا يصبح الأسارى من المسلمين أرقاء والأسارى من غير المسلمين طلقاء. وذلك إلى أن يتسنى تنظيم هذا العرف باتفاق.
وبتجفيف موارد الرق كلها ما عدا هذا المورد الذي لا اختيار للإسلام فيه يقل العدد، وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بالوسائل الآتية:
1 ـ الحق للمسترق في طلب الحرية بالمكاتبة وإلزام القضاء بإجبار سيده على ذلك. كما فرض على المجتمع معاونته بالمال حتى يحقق حريته وينالها بأسرع وقت.
2 ـ فرض على الدولة إخراج ثُمن وارداتها من الزكاة لتحرير العبيد.
3 ـ جعل كفارات المآثم عتق العبيد. مثلاً من قتل خطأ فعليه دفع الدية وتحرير عبد. وأمثال هذا كثير.
4 ـ من قال لعبده أنت حر بعد وفاتي فليس له أن يبيعه وليس له أن يرجع فيما قال.
5 ـ الترغيب بتزويج الأرقاء والمسترقات من الأحرار والحرائر.
6 ـ كل مسترقة تنال حريتها بمجرد أن تلد من سيدها.
7 ـ حث القرآن على الإعتاق وجعله من أعظم القربات عند الله.
حينما نعلم هذا نعلم أن الإسلام قد وضع منهاجاً عملياً للوصول بالرقيق إلى التحرير التام. ولم يكتف الإسلام بتحرير العبيد، بل رفعهم إلى أعلى مستوى في المجتمع، فنحن نرى أن بعض البلاد التي حرمت الرق وحررت العبيد لا تزال تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية ولا تسمح لهم أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم وقد اختار النبي لأعظم وظيفة دينية عبدً محرراً هو بلال الحبشي حين جعل منه مؤذنه الخاص. كما اختار لأول جيش أرسله إلى خارج الجزيرة العربية عبداً محرراً هو زيد بن حارثة وجعل تحت قيادته فريقاً من رجال أكبر الأسر القرشية.
أثر الحضارة الإسلامية
في الحضارات الإنسانية
نشأت في العالم حضارات متعاقبة أو متعاصرة، قبل ظهور الإسلام كانت هناك الحضارة المصرية والحضارة البابلية والحضارة الأغريقية الرومانية، وكانت في الشرق الأقصى حضارة للهند وحضارة للصين.
كل هذه الحضارات قد ازدهرت زمناً في التاريخ القديم، ثم آل بها الأمر إلى الفتور والاضمحلال، ولم يكن لها من بقية عند ظهور الإسلام غير ما خلفته من المصنوعات وأساليب المعيشة المادية.
وأما العلوم والمعارف فقد ركدت أو احتجبت قبل الدعوة الإسلامية ببضعة قرون، واندثرت أوراق الكتب التي ألَّفها حكماء اليونان أو بقيت في حوزة من لا يقرأها ولا يفهمها، وربما قرأها وحاول فهمها ليحرمها باسم الدين.
وزالت شريعة الرومان، وهي تراث رومة الأكبر، ثم تراث الذين تدربوا على الحكم في ظلالها بعد زوال السطوة الرومانية، وأصبحت ولايات الدولة القديمة مثلاً للفوضى واختلال الأمن وثورات الفتنة والشقاق التي لا تهدأ في ناحية منها إلاَّ لتضطرب وتضطرم في ناحية أخرى.
وجاء القرن السادس للميلاد والعالم الحاضر لا تفرقه عن الهمجية إلاَّ أساليبه التي تعلمها بالوراثة الآلية لصنع الغذاء وطهو الغذاء.
وهنا ظهر الإسلام.
فإذا أردنا أن نلخص أثره في الحضارات السابقة فخلاصة هذا الأكثر في كلمات معدودات أنه أحياها وجعلها «حاضرة» بعد أن كانت من بقايا الماضي المهجور.
أما الحضارات التي تتابعت بعد ذلك فليس منها حضارة واحدة خلت من آثار الدعوة الإسلامية، وليس منها حضارة واحدة كانت تتبع طريقها الذي اتبعته لو لم تسبقها الدعوة الإسلامية إليه.
نشأت الحضارة الإسلامية في الرقعة الوسطى من القارات الثلاث التي تألف منها العالم القديم، فبعد أن كانت هذه الرقعة حاجزاً فاصلاً بين حضارات المشرق والمغرب جاشت فيها الحياة فأصبحت كالعروق الحية التي تنقل الدم في بنية واحدة، ولم يكن في المغرب شيء يعطيه في ذلك العصر ولكنه أخذ من المشرق كل ما عرفه وأحسَّ الحاجة إليه.
واجتم محصول العلوم الإنسانية كلها في هذه الرقعة المتوسطة من الكرة الأرضية، فلم يبق علم عرفه الإنسان قبل ذلك إلاَّ وهو معلوم بين أبنائها، وتجمعت زبدة الثقافة الصينية والهندية والمصرية واليونانية والرومانية في ظل دولة واحدة، فحق لها أن تسمى خلاصة حضارات الإنسان، بعد أن كانت حضارات تفرقة لهذه الأمة أو تلك، تنعزل تارة وتتصل تارة أخرى من بعيد.
وبرزت حكمة اليونان من قبورها المطوية، وكأنما تكفل أبناء الإسلام الغرباء عن القارة الأوروبية بنقل حكمتها العليا من طرفها الشرقي إلى طرفها الغربي في الأندلس وأفريقية الشمالية، فلما سمع الأوروبيون بفلسفة اليونان أخذوها من أيدي المسلمين في الغرب قبل أن يعرفوا كلمة من لغتها ومصنفاتها.
أول أثر، بل أكبر أثر، لحضارة الإسلام في الحضارات السابقة لها هو أنها جمعتها ووصلت بينها وجعلتها أمانة إنسانية واحدة ثم أدَّت هذه الأمانة أحسن أداء.
ولم يكن ذلك حتماً لزاماً لو لم تكن دعوة الإسلام قابلة لاستيحاء تلك الحضارات وتحصيلها والمحافظة عليها وإعدادها لما يأتي بعدها ويتممها أو يزيد عليها.
كان من الجائز جداً أن تقوم على الرقعة الوسطى قوة تقضي على ما بقي وتحجب الماضي عن الحاضر والمستقبل وتعيش فترة من الزمن ثم تنطوي في ظلام من بعده ظلام.
لكن الحضارة الإسلامية لم تهدم شيئاً كان قائماً يوم ظهورها، بل أعادت إلى البناء ما تداعى وتهدم ثم زادت عليه، فاستقام علم الإنسان في طريقه غير مقتضب ولا معطل ولا محتاج إلى جهد في الاستعادة والتجديد.
ومن القرن السادس للميلاد إلى القرن العشرين لم ينشأ في العالم أثر جديد لا يرجع إليها بسبب قريب أو بعيد.
فالحضارة الأوروبية في القرن العشرين ترجع إلى عصر النهضة، وعصر النهضة يرجع إلى ثقافة المسلمين في الأندلس وإلى الثقافة التي عاد بها الصليبيون من الديار الإسلامية، وربما كان كشاف الأوروبيين قادرين يوماً على الوصول إلى العالم الجديد مع تطاول الزمن بدافع من الدوافع التي نجهلها الآن. أما وصولهم إلى العالم الجديد كما حدث في التاريخ فإنما هو على التحقيق أثر التراث الإسلامي في المغرب ونتيجته لم يكن لها مقدمات غير ذلك التراث وما تتابع منه أو تتابع بعده من الأحداث.
ولم تصل الحضارات الإسلامية إلى أمة شرقية ثم تركتها بغير أثر محمود في أطوارها وعاداتها، فكانت شريعة المساواة درساً مهذباً لشرائع الطبقات في البلاد الهندية، وكانت القدوة بالرحالين والتجار من المسلمين «تبشيراً سمحاً» لأجيال الهند والملايو والصين التي يبلغ أعقابها اليوم مئتي مليون من النفوس، ولم يحدث مثل هذا لغير الدعوة الإسلامية مع بذل الجهود في التبشير والاستعمار.
وقد كان أثر الإسلام فيمن دانوا به معجزة لا نظير لها بين معجزات التاريخ.
إنه حفظ لهم قوة من قوى المقاومة لم تنهزم أمام الدول العاتية المستعدة لإخضاع من يقاومها بالمال والعلم والسلاح، وعجب الباحثون من أين جاءت أبناء الإسلام هذه القوة بعد ضياع المجد والسلطان، بل بعد ضياع العلم والثقافة والتجرد من كل سلاح أمام المستعمر والمزود بكل سلاح؟
ولم يشأ أولئك الباحثون أن يلتفتوا إلى مصدر تلك القوة وهو منهم قريب.
مصدرها العقيدة الإسلامية!.
وسر الغلبة في العقيدة الإسلامية أنها انفردت بمزية لم تكن لدين آخر ولا لثقافة أخرى.
وتلك المزية هي أنها عقيدة شاملة تأخذ الإنسان كله ولا تقتطع منه جزءاً تسميه جانب الروح أو جانب الآخرة وتترك ما عداه من جوانب للجسد أو للدنيا.
فهي عقيدة ونظرة إلى الدنيا ونظالم معيشة وآداب وسلوك، وهي لهذا لا تدع للإنسان جزءاً للحاكم الأجنبي وجزءاً يتجه به إلى الله…. وقد وجدت عبادات تسمح للمرأة أن تسلم جسدها لبعل على غير عقيدتها، وتسمح للمحكوم أن يسلم زمامه لسيد من غير قومه وغير ملته، وتسمح للمتدين بها أن يعيش في وطن لا معالم فيه لقواعد إيمان لأنه إيمان ينفصل عن الدنيا ويرتبط بالحياة الأخرى على غير طريقها، ولكن النفس الإسلامية لم تعرف قط هذه التجزئة في كيان الإنسان فرداً كان أو جماعة، فهي لا تخضع للمتسلط عليها إلاّ وهي شاعرة بمذلة هذا الخضوع متربصة بمن يخضعها إلى حين.
ذلك هو سر القوة التي استفادها المسلمون من عقيدتهم، فحافظوا بها حين آلت الحضارة إلى غيرهم أن يصمدوا لسيطرتها حتى تعود إليهم، وليس أقوى من عقيدة تصون للنفس وحدتها وتعصمها أن تتمزق بدداً أو تتفرق شعاعاً كلما دالت الدولة وتغيرت طوالع الزمن بين سعوده ونحوسه وإقباله وإدباره، وتلك هي عقيدة الإسلام.
ويزيد في هذه القوة أنها لا تقاوم الحضارة إذا جاءت من جانب غير جانبها، فهي موافقة لتقدم الحضارات وليست عائقاً معترضاً في سبيلها، وهي مالكة لأسباب التجديد كلما وجب التقدم من طور قديم إلى طور جديد، وكأنها ـ وقد وحدت نفس الإنسان ـ قد وحدت تاريخ الإنسان فلا انقطاع فيه بين ماضيه وآتيه إلى آخر الزمان، ولا داعية للتخلف عن ركب الحضارة في عهد من العهود كائناً من كان رائدها على تعاقب الأجيال، وإذا آمن المسلم بطلب العلم «ولو في الصين» فإنما يؤمن بطلبه وإن تمادى به البعد في الزمن المقبل، ولا يقصر البعد على موقعه حيث كان.
ولسنا نعمد، إلى نكتة من نكت الجناس حين نقول أن التوحيد في الإسلام هو مدى قوته بجميع مانيه: توحيد الإله وتوحيد النفس الإنسانية وتوحيد العالمين: عالم الأرواح وعالم الأجساد.
إنها حقيقة الحضارة الإسلامية، أو العقيدة الإسلامية مصدر تلك الحضارة، ولسيت جناساً في اللفظ تستدعيه كلمة التوحيد.
وإذا كتب للإنسان مستقبل في عالم الإيمان يعصمه من هذا البلبال الذي سلطته الحضارة الحديثة على ضميره، فلن يكون هذا المستقبل إلاّ لعقيدة توحده وتلم ما تبدد من وجدانه، وتضعه كما وضعت عقيدة الإسلام أبناءها من قبل في عالم واحد تواجهه نفس واحدة متمالكة الأوصال متماسكة الجسد والروح.
عباس محمود العقاد
غير المسلمين في الدولة الإسلامية
الدولة الإسلامية لو طبق فيها الإسلام تحفظ جميع حقوق الذميين «أي غير المسلمين» كحقوق المسلمين على السواء بلا نقص ولا بخس، حتى إذا افتقر الذمي فرضت له عطاء في «بيت المال» وكما قال أحد القادة «أي شيخ عجز عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه … طرحت جزيته إن كان ذمياً، وطرحت زكاته إن كان مسلماً وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله».
وإذا قيل أن الجزية والخراج المفروضتين على الذميين يعدان نقصاً أو بخساً لحق ضمان أموالهم على الدولة الإسلامية، فذلك خطأ كبير.
فالجزية والخراج يؤخذان من الذميين كما تؤخذ الزكاة من المسلمين …. للإنفاق منها جميعاً على مرافق الدولة من إدارة وأمن وتعليم، ودفاع، وضمان اجتماعي في حالة الافتقار أو عجز الشيخوخة، كما أشرنا إليه من قبل.
وقد ذهب عدد من الفقهاء إلى أن ما يؤخذ من زكاة المسلمين يزيد على ما يؤخذ من الذميين، في حين يحظى الجميع بحماية الدولة الإسلامية ورعايتها على قدم العدل والرحمة والمساواة.
إن الجزية لم تكن ضريبة استغلال واستثمار، بل كانت ضريبة إسهام في نفقات الدولة، وإعفاء من الخدمة العسكرية لمن لا يؤمنون بأهداف الجهاد الإسلامي.
وإن مبلغ الجزية كان زهيداً جداً بجانب ما كان يدفعه المسلم من زكاة ماله إلى الدولة.
فقد كانت الجزية على ثلاثة أنواع: على العمال اثنا عشر درهماً في السنة، أي في كل شهر درهم واحد، وعلى التجار ذوي الثروات المتوسطة أربعة وعشرون درهماً أي درهمان في كل شهر، وثمانية وأربعون درهماً على الأغنياء والمقتدرين من أهل الذمة ولو كانوا يملكون الملايين.
بينما يجب على المسلم أن يدفع ربع العشر من ماله كله لا من أرباحه وحدها، فلو كان هناك ذمي ومسلم … يملك كل واحد منهم مليون درهم لا تأخذ الدولة الإسلامية من هذا الذمي إلاَّ ثمانية وأربعين درهماً فحسب، بينما تأخذ من المسلم الغني خمسة وعشرين ألف درهم زكاة لماله.
هذه هي الجزية التي كانت في الواقع مظهر رحمة وحماية وعفة عن أموال غير المسلمين مع تمتعهم بكل ما يتمتع به المسلمون من حماية لأموالهم وممتلكاتهم وأرواحهم، وعقائدهم، وتتمتع بحق التكافل الاجتماعي عند المرض والشيخوخة والعجز عن العمل.
ومن السخف ما قيل من أن الجزية كانت إكراهاً لغير المسلمين على اعتناق الإسلام وعندما يكون أهل الذمة مطمئنين إلى دينهم مقتنعة به عقولهم راضية به نفوسهم لا يتركونه خشية من دفع اثني عشر درهماً في السنة، أو أربعة وعشرين، أو حتى ثمانية وأربعين وأي إنسان يترك دينه خوفاً من دفع هذا المبلغ الزهيد.
ومع ضمان الدولة الإسلامية للذميين حماية أرواحهم وأموالهم، ورعايتها لفقرائهم وشيوخهم عند العجز عن العمل ـ فقد ضمنت لهم حرية اعتقادهم وتشريعهم وقرر الفقهاء «أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون به يتركون عليه».
وهناك ـ فوق ذلك كله ـ تنبيه النبي وتوجيهه للحكام المسلمين من بعده: «من ظلم معاهداً (أي غير مسلم)، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه، فأنا حجيجه يوم القيامة».
أحمد محمد جمال
جغرافية العالم الإسلامي
ـ 1 ـ
انطلق الإسلام من الحجاز، وبدأت موجته تكتسح العالم منتشرة في جنوب غرب وأواسط آسيا وشمال أفريقيا وجنوب غرب أوروبا وجزر البحر المتوسط، وبذا امتد الإسلام من جنوب فرنسا وأسبانيا حتى وصل السند وتاخم حدود الصين ومنغوليا.
وقد انتشر الإسلام في فترة أخرى في جنوب آسيا عام 391هـ ـ 1000م([175]) حيث استولى المسلمون من العرب والأتراك على الجهات الجبلية الغربية من جنوب آسيا ثم امتدَّ من هذه الجهات إلى المناطق الأخرى من جنوب القارة، كما انتشر خلال هذه الفترة، في أفريقيا الشرقية حتى مقديشو وفي فترة لاحقة ساد بقية أفريقيا الشرقية والغربية خصوصاً بعد إلغاء تجارة الرق. فامتدت رقعة الدول الإسلامية من شمال بلاد التركستان حتى وصلت الملايو وأندونيسيا وجزائر كومودور وتنزانيا.
ويشغل العالم الإسلامي في الوقت الحاضر رقعة شاسعة من العالم القديم «آسيا، أفريقيا، أوروبا» ممتدة من شرق أفريقيا جنوب تنجانيقا وباتجاه قلب القارة السوداء شمال خط الاستواء حتى خليج غينيا. ويسير خط الحدود مع ساحل المحيط الأطلسي غرب القارة ثم سواحل البحر المتوسط الجنوبية نحو بحر إيجه «يضاف له في أوروبا كل من ألبانيا وتركيا الأوروبية».
ثم يواصل خط الحدود سيره مع شواطئ البحر الأسود الجنوبية وباتجاه بحر قزوين جنوب جبال القفقاس نحو الشرق مع حوالي خط عرض 50 درجة شمالاً مخترقاً سهول القرغيز حيث ينتهي بجبال التاي. وبعدها يتجه نحو الجنوب الغربي مع جبال تيان شان وعقدة بامير «سقف العالم» مخترقاً جبال هندكوش حتى الهملايا والبنجاب الشرقية وصحراء ثار حيث ينتهي بساحل البحر العربي. يضاف له مقاطعات سنكيانغ الصينية حيث تبلغ نسبة المسلمين فيها أكثر من 75 بالمئة من مجموع سكان المقاطعة.
ثم يظهر العالم الإسلامي مرة أخرى في جنوب شرق آسيا متمثلاً في الباكستان الشرقية «بنغلادش» وأندونيسيا وماليزيا «الملايو، سرادوك، بورنيو الشمالية، ثم سنغافورا». ويعتبر المحيط الهندي الحدود الجنوبية للعالم الإسلامي إذ يمكن اعتبار خط عرض 10 درجات جنوباً الحدود الجنوبية له حيث يمر من جنوب أندونيسيا في آسيا وجنوب تنجانيقا «بين جزر مورو وزنجبار» في أفريقيا.
فالعالم الإسلامي شغل رقعة جغرافية واسعة في قارات العالم القديم، بين خطي عرض 50 درجة شملاً و10 درجات جنوباً، وخطي طول 80 درجة شرقاً و15 درجة غرباً. وفي جنوب شرقي آسيا يمر خط طول 140 درجة شرقاً من جزيرة غينيا الجديدة في أندونيسيا فهو يقع داخل نطاق خطوط عرض متعددة تبلغ حوالي 60 درجة عرضية مما يجعله ذا بيئات طبيعية متنوعة لذا يتنوع فيه المناخ والنباتات والإنتاج الزراعي. وهذا التنوع يساعد على إمكان تبادل المنتوجات المختلفة داخل نطاق هذا العالم.
وهذه الرقعة غنية بالإنتاج الزراعي والحيواني والثروات المعدنية الهائلة والقوى المحركة والمواد الأولية، فالعالم الإسلامي على هذه الاعتبارات يتوفر فيه كل ما يساعد على قيام وازدهار الصناعة والتجارة كما أن لموقعه أهمية استراتيجية بحيث يجعله صالحاً للدفاع أو الهجوم. فهو عالم بري وعالم بحري، فالبر فيه عبارة عن معبر بين ثلاث قارات والبحر عبارة عن منفذ بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي عبر المضايق فالقنوات المائية كما أن وجود الصحاري الشاسعة يجعل هذا الموقع صالحاً لإجراء التجارب الذرية.
وموقعه يشغل عالمين متباينين في الإنتاج بين أوروبا الغربية الصناعية وشرق وجنوب آسيا الزراعية مما يسهل قيام التجارة بينهما ونقل المواد الأولية والغذائية إلى أوروبا، والصناعة إلى آسيا وأفريقيا.
وقد أثّرت الظروف الطبيعية، في هذه الرقعة على الحياة البشرية، فساعدت على نشوء حضارات راقية قديمة ارتبطت بالزراعة واستخدام الري مما ساعد على توفر الإنتاج الغذائي. كما أن المنطقة هي في الواقع، مهبط الديانات السماوية ومنها انتشرت إلى بقية أنحاء العالم ونتيجة لهذه الأهمية تكالبت قوى الاستعمار والصهيونية في الماضي والحاضر، للسيطرة عليه واستثمار خيراته والاستفادة من استراتيجية موقعه واستغلال قواه البشرية.
يتألف العالم الإسلامي من عدة دول وأقطار تضم ما يقارب من 37 دولة مستقلة (19 في آسيا، 17 في أفريقيا، 1 في أوروبا) ([176]).
ويشغل العالم الإسلامي اليوم، في القارات الثلاث، ما يقارب م 24,4 بالمئة من مساحة العالم و18 بالمئة من سكان المعمورة. فمساحته تقرب من (32) مليون كيلومتر مربع. وسكانه من (600) مليون مسلم([177]) موزعين على النحو الآتي:
ـ 72 بالمئة في قارة آسيا أي حوالي 25,3 بالمئة من سكان القارة.
ـ 25 بالمئة في قارة أفريقيا أي حوالي 60 بالمئة من سكان القارة.
ـ 3 بالمئة في قارة أوروبا وبقية العالم.
وفي داخل العالم الإسلامي يكون المسلمون أكثر من 90 بالمئة من مجموع السكان في 25 قطراً. وفي حوالي 30 قطراً يكون المسلمون بين 50 و90 بالمئة من مجموع السكان (8 في آسيا و13 في أفريقيا).
وفي قارة آسيا تقرب مساحة العالم الإسلامي من 14 مليون كيلومتر مربع، أي حوالي 31,6 بالمئة من مساحة القارة بما فيها مساحة آسيا العربية البالغة أكثر من 3,5 مليون كيلومتر مربع. ويتوزع المسلمون في الدول الإسلامية التي تشمل البلاد العربية وهي: الكويت، العربية السعودية، اليمن، مسقط، عمان، البحرين، قطر (من 99 إلى 100 بالمئة)، الأردن 96 بالمئة، العراق 95 بالمئة، سوريا 83 بالمئة، لبنان أكثر من 50 بالمئة، أفغانستان 100 بالمئة، تركيا وإيران 98 بالمئة، باكستان وأندونيسيا 95 بالمئة، كشمير 90 بالمئة، ماليزيا (بورنيو، سرواك 80 بالمئة والملايو 70 بالمئة) سنغافورة أكثر من 50 بالمئة، الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي المنحل وهي: التاجيك 98 بالمئة، التركمان 90 بالمئة، القرغيز 89 بالمئة، أوزبكستان 80 بالمئة، أذربيجان 75 بالمئة، القوزاق 65 بالمئة.
أما المسلمون في الدول غير الإسلامية، فتأتي الهند في مقدمتها حيث يزيد عددهم فيها على 15 بالمئة من سكانها([178]) والنسبة بين منطقة وأخرى مختلفة، ففي منطقة البنجاب الشرقية وصحراء ثار تصل النسبة بين 25 و50 بالمئة وتتناقص النسبة في سهل الكنج بحيث تتراوح بين 10 و15 بالمئة، وفي هضبة الدكن مشابهة لما هي عليه في منطقة سهل الكنج.
وتأتي الصين، بعد الهند، حيث يزيد عدد المسلمين على 5 بالمئة من مجموع السكان ويتركز عدد كبير منهم في مقاطعة سينكيانغ إذ يزيد عددهم على ثلاثة ملايين وربع المليون مسلم أي 75 بالمئة من مجموع سكان المقاطعة([179]). أما بقية المسلمين فهم أقليات موزعة في تيمور البرتغالية 20 بالمئة، سيلان 9 بالمئة «وهم خليط من العرب والسنهاليين من حيث الأصل» بورما 4 بالمئة، «بمناطق مندنا وبعض جزر سولو جنوب البلاد»، سيام «تايلاند» 3 بالمئة، الهند الصينية «لاووس، فيتنام، كمبوديا» 1 بالمئة، وأقلية مسلمة في منغوليا وتايوان «فرموزة» والبقية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي غير المسلمة مثل: جورجيا 15 بالمئة، أرمينية 12 بالمئة جمهوريتي روسيا وأوكرانيا 2 بالمئة والبقية في جمهورية روسيا البيضاء والمناطق الأخرى.
وأما قارة أفريقيا فتقرب مساحة العالم الإسلامي فيها من 18 مليون كيلومتر مربع، أي حوالي 60 بالمئة من مساحة القارة، بضمنها أفريقيا العربية التي تقرب مساحتها من 9,5 مليون كيلومتر مربع بما فيها الصحراء المغربية وموريتانيا.
ويتوزع بقية المسلمين في الدول غير الإسلامية، في كل من الحبشة 50 بالمئة «حكومتها مسيحية» رواندة 40 بالمئة، غينيا البرتغالية 32 بالمئة، ليبيريا وكينيا 20 بالمئة، وفولتا العليا وساحل العاج أكثر من 15 بالمئة، جزيرة موريتشس 13 بالمئة، سيراليون 11 بالمئة، نياسلاند وموزمبيق 10 بالمئة، جنوب أفريقيا 8 بالمئة، داهومي 7 بالمئة، غينيا البريطانية 5 بالمئة، غانا والغابون 2,5 بالمئة([180])، غينيا الأسبانية وأوغندة 3 بالمئة، جزيرة رينيون 2 بالمئة أما البقية فموزعون في كل من روديسيا الشمالية والجنوبية بتسوانالاند، جزيرة مدغشقر، الكونغو «البلجيكي» جزيرة سيشيل، الكونغو الأوسط، بورندي، وباقي دول أفريقيا([181]).
أما في قارة أوروبا وجزر البحر المتوسط فيتركز المسلمون اليوم جنوب شرق القارة، وتقرب مساحة الدول الإسلامية فيها «تركيا الأوروبية وألبانيا» من 42,524 كيلومتر مربع. ويبلغ عدد مسلميها حوالي 3 ملايين نسمة. ونسبة المسلمين في ألبانيا 75 بالمئة.
ويزيد عدد المسلمين في بقية دول أوروبا غير الإسلامية على 4 ملايين نسمة، أي أن مجموعهم في قارة أوروبا يزيد على 7 ملايين مسلم موزعين في يوغوسلافيا 11 بالمئة ويزيد عدد المسلمين فيها على مليونين ونصف المليون، فهم أكبر جالية إسلامية في أوروبا وتعتبر سراجيفو أكبر مركز لهم وعندهم 800 مسجد في أنحاء يوغسلافيا، وبلغاريا أكثر من 9 بالمئة، اليونان 2 بالمئة، والبقية في بولونيا وفرنسا وفنلدنة وألمانيا وإنكلترا.
أما جزر البحر المتوسط فعلى رغم من أن المسلمين سيطروا عليها في الماضي وتركوا آثاراً بارزة فيها، فإن عدد المسلمين اليوم فيها محدود، وغالبيتهم متمركزة في قبرص حيث يشكلون أكثر من 18 بالمئة من سكانها.
وفي العالم الجديد «أمريكا الشمالية واللاتينية» حوالي 620,000 مسلم غالبيتهم في البرازيل، وهم على الأغلب من أصل عربي وكايانا الهولندية حيث يوجد 520,000 مسلم أي ربع سكان المستعمرة وأغلبهم من الزنوج وفي جزيرة ترينيداد أكثر من 25,000 مسلم هندي وقد بنوا أكثر من 50 مسجداً في الجزيرة وفي الأرجنتين أكثر من 30,000 مسلم أكثرهم من مهاجري سوريا ولبنان ويكثرون في روازريو والعاصمة بونس أيرس وتصدر لهم صحف عربية، كما هو الحال في الرازيل والولايات المتحدة ويوجد أكثر من 10,000 مسلم في الولايات المتحدة «قبيل الحرب العالمية الثانية».
وفي كندا أقلية من المسلمين، وقد افتتح في جامعة «ماك جيل» بمونتريال سنة 1953 معهد للدراسات الإسلامية. وهناك جماعات إسلامية شكلها العمال الموقتون والدائمون في كايانا الفرنسية «300»، وجزر الأنتيل الفرنسية «3000» وكولومبيا وفنزويلا وشيلي «4000» والمكسيك وجامايكا «1000».
عباس فاضل السعدي
جغرافية العالم الإسلامي
ـ 2 ـ
يمتد الجناح الغربي للعالم الإسلامي والذي يمثل الوطن العربي جزءاً منه ليغطي مساحة ضخمة في كل من غرب آسيا والشمال الأفريقي محيطاً بمعظم البحر المتوسط في قسميه الكبيرين الشرقي والجنوبي أو بعبارة أخرى يمتد هذا الجناح الغربي حول شرق وجنوب البحر المتوسط بجزره وسهوله وهضابه وسلاسله الجبلية المتشعبة صانعاً قوساً هلالياً ضخماً.
إذ يمر خط عرض 37 شمالاً بالأطراف الشمالية للوطن العربي كما يحف خط عرض 2 جنوباً بأطرافه الجنوبية، وبذلك يحتضن الوطن العربي أقاليم مناخية ونباتية متباينة مما أدى إلى التباين الواضح في الإنتاج الزراعي. فحيث يسود مناخ البحر المتوسط بصيفه الدافئ الجاف وشتائه المعتدل الممطر وذلك في فلسطين ولبنان وغرب سوريا وشمال العراق، تظهر في الأودية الجبلية وعلى جوانب التلال وفي السهول الساحلية زراعة الزيتون والكروم وأشجار الفاكهة الأخرى كالمشمش والبرقوق والخوخ والسفرجل والكمثري والتفاح والموالح. كذلك تجود زراعة الحبوب كالقمح والشعير. وكان شجر الأرز يكسو جبال لبنان في الماضي وكانت أخشابه تصدر إلى أقطار الشرق الأوسط المختلفة ولم يبق من أشجار تلك الغابات إلا القليل، ولكن عناية الحكومات بغرس وزيادة مساحة الغابات ستعيد إلى هذه الأرجاء سمعتها القديمة. وغير أشجار الأرز توجد أشجار البلوط والصنوبر والسرو وبعض أنواع أخرى.
وإلى الشرق والجنوب من النطاق السابق يسود المناخ شبه الصحراوي في معظم الأردن وباقي سوريا وغرب العراق. وهنا تظهر المراعي الفقيرة حيث ينمو العشب في موسم المطر الشتوي ويكون مرعى طيباً للحيوانات التي يربيها البدو كالأغنام والماعز، وتستخدم أصوافها في صناعة نوع من السجاد الخشن. وحيث تتوفر مياه الري من الآبار والعيون والنهيرات الصغيرة تظهر زراعة الحبوب والفاكهة والنخيل كما هو الحال في واحة دمشق التي تعتمد على مياه الآبار ونهر بردى وكذلك في الأردن التي تنساب شرقاً نحو سهول العراق.
وتعيش كل من مصر وشبه الجزيرة العربية في ظل مناخ صحراوي بكامل صفاته، ويلاحظ أن الجزء الشمالي من شبه الجزيرة وكذلك الأطراف الشمالية من مصر تستلم بعض الأمطار في فصل الشتاء على حين أن معظم الأمطار التي تسقط في جنوبي بلاد العرب يجيء في نصف السنة الصيفي. وحيث تسقط الأمطار القليلة ينبت العشب الذي يعتمد عليه البدو في تغذية إبلهم وخيولهم وأغنامهم وماعزهم وماشيتهم. وتتركز الزراعة في بطون الأودية لأن موارد الماء الجوفي قريبة للسطح كما هو الحال مثلاً في وادي الرمة الذي ينحدر شرقاً نحو الخليج الفارسي وفيه يقترب الماء الجوفي من السطح ويتوفر المرعى وتقوم في هذا الوادي مدينتا عنيزة وبريدة وهما من أهم المراكز التجارية في أواسط بلاد العرب. وتعتبر مصر هبة النيل والعراق هبة الرافدين دجلة والفرات ولولا مياههم لكانت كل من مصر وأرض الجزيرة لا تختلف في شيء عن الصحاري المتاخمة.
أما اليمن فتتمتع بمناخ شبه موسمي إذ أدى ارتفاع التضاريس إلى تصادم الرياح الغربية الرطبة فتسقط الأمطار صيفاً. وزاد في قيمة المطر الساقط وجود الضباب إذ أنه يكثر من درجة الرطوبة ويقلل من التبخر ولهذا تكثر زراعة البن. وقد حوَّل السكان المنحدرات الجبلية إلى مدرجات وأقاموا السدود لحجز مياه الأمطار وشقوا القنوات لري المدرجات وقد ساهم هذا النشاط في قيام الحضارات القديمة كحضارة سبأ، وكان السبب في القضاء عليها تهدم السدود التي كانت أساس قيام تلك المدينة الزراعية.
واستفاد الوطن العربي كثيراً من موقعه الممتاز مطلاً على البحر الأبيض المتوسط([182])، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي. فالبحر الأبيض المتوسط هو أكبر بحار العالم الداخلية، ويصله مضيق (طارق) بالمحيط الأطلسي كما تصله قناة السويس بالبحر الأحمر والمحيط الهندي ولا يزيد اتساع مضيق طارق على 15 كلم، أما قناة السويس فيبلغ طولها 171 كلم وعرضها 60 متراً. وهكذا أصبح الوطن العربي مطلاً على أهم طريق ملاحي عالمي يربط المحيط الأطلسي والأمريكيتين بالمحيط الهندي والشرق الأقصى، مما أدى إلى نشاط تجاري ملحوظ كما يبدو في الموانئ الرئيسية كالإسكندرية وبيروت والبصرة.
أما الإسكندرية فهي ميناء مصر الأول إذ يرد إليها نحو 75% من واردات البلاد ويصدر منها نحو 91% من الصادرات المصرية. ويرجع هذا المركز الممتاز إلى عوامل جغرافية مختلفة تتلخص في:
1 ـ تتمتع الاسكندرية بموقع جغرافي ممتاز فهي أقرب الموانئ المصرية إلى الموانئ الأجنبية الرئيسية، هذا فضلاً عن حسن مواصلاتها بجهات القطر المختلفة فهي على اتصال وثيق بالدلتا والوادي عن طريق السكك الحديد والطرق الزراعية والصحراوية وترعة المحمودية.
2 ـ عظم اتساع الميناء إذ تبلغ المساحة المائية لميناء الإسكندرية 1680 فدَّاناً ويحميه حاجزا أمواج يبلغ طولهما 4 كيلو مترات هذا فضلاً عن الأرصفة العديدة التي يوجد عليها مخازن وسقائف مختلفة يبلغ مجموع مسطحها 34 فداناً. وقد جهزت بعض الأرصفة بالآلات الرافعة لتفريغ البضائع من البواخر وشحنها فيها. وقد قسمت هذه الأرصفة وفقاً لأنواع البضائع المختلفة كرصيف الفحم ورصيف البترول وغيرهما. أما بيروت فهي المنفذ الرئيسي لجمهورية لبنان، بل أهم الثغور في القسم الشمالي من شرق البحر الأبيض المتوسط وميناؤها جيد ومواصلاتها سهلة مع الداخل فهي مركز لشبكة كبيرة من الطرق تربطها بالمدن الرئيسية في سوريا ولبنان كدمشق وحلب وحمص وحماة وطرابلس، وبيروت على اتصال جيد ببغداد وذلك بالطريق الصحراوي الذي يبدأ من دمشق.
والبصرة هي الميناء الأوحد للعراق ولها تجارة عظيمة مع بغداد بطريق النهر والسكك الحديد ويصل إليها كثير من السفن التجارية الآتية من الخليج الفارسي غير أنها تقوم في إقليم تكثر به المستنقعات. وأهم صادراتها البلح وهو كبير الأهمية في تجارة العراق كأهمية القطن في مصر.
وساعد هذا الموقع على تقوية العلاقات التجارية بين أجزاء الوطن العربي فمصر مثلاً تستورد الفاكهة والجلود من سوريا ولبنان والبلح من العراق والبترول من المملكة العربية السعودية والكويت، كما تصدر إلى هذه الأجزاء بعض الفائض من إنتاجها كالأرز والمنسوجات والكتب.
وشجَّع هذا الموقع بعض شعوب الوطن العربي على الهجرة للتجارة والثراء فوصل اليمنيون إلى أقصى جنوب شرق آسيا وجزر الهند الشرقية كما وصل اللبنانيون إلى الأمريكيتين، وكانت لهم جاليات أصابت شيئاً عظيماً من الثراء وكثيراً ما يعود هؤلاء المهاجرون بثرواتهم إلى أوطانهم الأولى فيبنون فيها القصور وينشؤون المنشآت العديدة.
وإن موقع الوطن العربي بين المعسكرين الشرقي والغربي جعله منطقة احتكام بمصالح السياسة الروسية من ناحية والسياسة الغربية من ناحية أخرى وتتمثل هذه المصالح في السيطرة على مناطق البترول وفي استغلال دول الوطن العربي كسوق هام لتصريف مصنوعات هذه الدول المتنافسة.
فمنذ أواخر القرن التاسع عشر أخذ النفوذ البريطاني ينتشر في مصر وفلسطين والعراق وجنوب بلاد العرب، كما أخذ النفوذ الفرنسي يظهر في سوريا ولبنان والمغرب واستمر هذا النفوذ قوياً حتى تحرك الشعور القومي فتخلصت سوريا ولبنان والمغرب من النفوذ الفرنسي.
من هذا العرض العام يبدو واضحاً أن الموقع الجغرافي للوطن العربي قد لعب دوراً هاماً في التوجيه الاقتصادي والسياسي لهذا الإقليم، وقد خلق منه منطقة حيوية في قلب العالم القديم.
وأما الجناح الشرقي من العالم الإسلامي فهو يمتد في مساحات واسعة تغطي غرب وجنوب وجنوب شرق وشرق آسيا فضلاً عن المجموعات الجزرية التي تتمثل في الأقواس الجزرية لجمهورية أندونيسيا الإسلامية والفلبين. وآسيا هي كبرى قارات العالم وأعظمها اتساعاً بين الشمال والجنوب والشرق والغرب فهي تمتد ما بين القطب الشمالي وجنوب خط الاستواء كما وتتسع في امتدادها بين المحيط الهادي والبحر المتوسط مطلة أيضاً على المحيط الكبير المتجمد الشمالي والمحيط الهندي والبحر الأحمر وهي في هذا الاتساع الجغرافي الطبيعي العظيم تنقسم إلى خمسة أقاليم تضاريسية رئيسية تتمثل في:
(أ) السهل السيبيري في أقصى الشمال الذي يمتد غرباً ليندمج مع السهل الأوروبي الشمالي.
(ب) ونطاق الهضاب الوسطى ما بين هضاب الصين شرقاً حتى هضبة الأناضول غرباً.
(جـ) النطاق الجبلي الألبي المعقد تضاريسياً بسلاسله الضخمة والذي يمتد بين مرتفعات جنوب الصين حتى مرتفعات لبنان غرباً ويشكل حائطاً ضخماً ولكنه غني بممراته الجبلية وأنفاقه الحديثة وشبكاته النهرية المتعددة.
(د) نطاق الهضاب الجنوبية ما بين هضاب جنوب الصين والهند الصينية حتى هضبة الدكن الهندية وهضاب الوطن العربي الآسيوي إلى البحر المتوسط.
(هـ) نطاق الجزر الهلالية الشكل التي تحيط بشرق وجنوب القارة والتي أهمها نطاق اليابان والنطاق الأندونيسي في أقصى الجنوب الشرقي.
وآسيا في ظل هذا النظام التضاريسي المتباين تحتضن أنواعاً مناخية ونباتية متباينة من أهمها:
1 ـ النطاق الصحراوي البادي في أقصى الشمال ويليه جنوباً.
2 ـ نطاق الغابات الصنوبرية الباردة ثم.
3 ـ النطاق الصحراوي المعتدل. مُمثَّلاً في الهضاب الوسطى ثم.
4 ـ نطاق الغابات الجنوبي حيث السلاسل الجبلية الجنوبية الألبية وبعده يمتد.
5 ـ نطاق من الحشائش الحارة (السافنا) في الصين والهند وقد اختفى تقريباً وحلّت محله زراعة الحبوب من ذرة وأرز وقمح.
6 ـ النطاق الحار الصحراوي في كل الوطن العربي الآسيوي وأخيراً.
7 ـ نطاق الغابات الاستوائية والموسمية في جنوب شرق القارة ولا سيما جزر أندونيسيا وبالإضافة إلى الثروة النباتية الضخمة فآسيا غنية في ثروتها المعدنية والنفطية وكذلك في ثروتها السمكية والبحرية المتنوعة وقد استغلت هذه الثروات منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضر وذلك بفضل المد الإسلامي من كل جوانب هذه القارة إذ انتقل المسلمون الأوائل من بلاد الحجاز وهضبة نجد إلى كل من جنوب وشرق ووسط آسيا ناشرين الدين الإسلامي الحنيف ومستثمرين لهذه الثروات الطبيعية المختلفة وهم يشكلون في الوقت الحاضر نحو ربع سكان العالم في معظم آسيا والوطن العربي الكبير ما بين البحر المتوسط حتى قلب أفريقيا القارة السمراء وفقاً لما يأتي:
أولاً: أقاليم تصل فيها نسبة المسلمين إلى أكثر من 90% من عدد السكان وتتمثل في([183]):
(أ) الوطن العربي الواسع الامتداد الذي يكاد يحاط بالمياه من معظم جوانبه مطلاً على خليج فارس والمحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر المتوسط. وهو بهذا الموقع الجغرافي الممتاز يتحكم في أهم طريق ملاحي في العالم الذي يمتد ما بين موانئ شرق آسيا ولا سيما طوكيو وبكين إلى ميناء سنغافورة ومنها إلى ميناء عدن عند مدخل البحر الأحمر ثم قناة السويس إلى البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
(ب) النطاق الإسلامي الذي يمتد محتضناً باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا محاطاً بخمسة بحار هامة في الملاحة البحرية هي المحيط الهندي والخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأسود والبحر المتوسط وهو بذلك يشرف على مضائق بحر مرمرة (البسفور والدردنيل) التي تربط الجنوب الروسي بالمياه الدافئة من ناحية كما يشرف على الممرات الجبلية (ممر خيبر وممر بولان) التي تربط بين القلب الآسيوي والمحيط الهندي من ناحية أخرى.
(ج) النطاق الجزري الأندونيسي الذي يشكل البوابة البحرية بين المحيط الهندي متحكماً في كل الطرق البحرية الملاحية بين شرق آسيا وجنوبها من جهة وبين أستراليا وشرق أفريقيا من جهة أخرى، هذا فضلاً عن تنوع ثروته الاقتصادية؛ المعدنية والغابية والزراعية والصناعية والسمكية.
ثانياً: أقاليم تصل فيها نسبة المسلمين ما بين 50% إلى 90% من عدد السكان في:
(أ) النطاق الجنوبي مما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي ممثلاً في كزاخستان، تاجيكستان، أزبكستان، أذربيجان، وهي من أهم مناطق التوسع الزراعي الحديث وتتميز بتنوع أنماط التربة الرسوبية الجيدة مع وفرة في المياه ولا سيما بعد تنفيذ مشروع تحويل بعض مياه السهل السيبيري من الشمال عن طريق حفر قناة صناعية تحمل مياه نهر أُوب إلى الجنوب وقد نجحت زراعة القطن والحبوب والفاكهة.
(ب) غرب الصين في إقليم سنكيانج أو الحوض الأحمر لخصوبة تربته الحمراء التي تمتاز بارتفاع نسبة أكاسيد الحديد فضلاً عن وفرة مياه الري ويعتبر نهر بانجستي وروافده وأنهار هضبة التبت المصدر المائي الهام والحوض من أغنى أقاليم الصين الزراعية وانتشرت الزراعة الحديثة في أراضي كل الحوض وعلى المدرجات الهضبية المجاورة بحيث يوجد فائض إنتاج يُصدر إلى مناطق الصين الأخرى.
(ج) إقليم كشمير في شمال الهند وهو إقليم جبلي غني بالثروة المعدنية ومساقط المياه حيث الطاقة الكهربائية الهائلة ويعتبر صمام أمان بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الهندي الباكستاني.
(د) إقليم بنغلاديش في دلتا نهر الكانجزوما وما حولها.
(هـ) جنوب الملايو وشمال جزيرة بُرنيو وجزيرة تدناو بجنوب الفلبين وكلها مناطق تمتاز بغطاء كثيف من الغابات الموسمية الغنية بأخشابها الاقتصادية ولا سيما أشجار الشاي والمطاط والأبنوس وشجرة الورد وكلها ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.
ثالثاً: أقاليم تقل فيها نسبة المسلمين عن 50 % من السكان ممثلة في مناطق متناثرة من جنوب وشرق آسيا ولا سيما في الهند وشرق الصين وتايلاند والفليبين وسريلانكا وهي تشمل أقليات عُرفت بنشاطها الاقتصادي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وبمستواها الثقافي الرفيع بين السكان.
ومن هذا العرض التحليلي لتوزيع المسلمين جغرافياً في آسيا يتضح لنا:
1 ـ أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في مناطق هامة من جنوب وجنوب غرب آسيا فضلاً عن النطاق العربي الذي يحيط بمعظم البحر المتوسط.
2 ـ إن كل مناطق المسلمين في آسيا تمتاز بتنوع النشاط الاقتصادي وارتفاع المستوى الاجتماعي والثقافي بين السكان.
3 ـ يسيطر المسلمون على بعض أهم المواقع الجغرافية الحساسة عالمياً ممثلة في خليج فارس وهو أهم مصادر النفط في العالم ويليه قناة السويس التي تُشكِّل قلب أهم طريق ملاحة بحري في العالم والبوابة البحرية التي تربط بين المحيطين الهندي والهادي وإقليم الممرات الجبلية الذي يربط بين قلب آسيا والجنوب الآسيوي فضلاً عن الموقع الجغرافي الهام لإقليم طنجة مشرفاً على مضيق جبل طارق البوابة الغربية لحوض البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وقناة بنما.
والجناحان الشرقي والغربي يكمل أحدهما الآخر في ظل ما يأتي جغرافياً:
1 ـ تبدو من هذا العرض التحليلي ظاهرة التباين في تنوع الإنتاج الاقتصادي مما يدعم خلق سوق إسلامية مشتركة على نطاق واسع بين كل الأقاليم الإسلامية.
2 ـ يلاحظ أن هذا النطاق الجغرافي الفخم الذي يمتد ما بين غرب البحر المتوسط إلى شرق وجنوب شرقي آسيا مطلاً على المحيطين الهندي والهادي والذي يسكنه نحو ربع سكان العالم يفتقر إلى الاستثمار الزراعي الحديث في كثير من مناطقه مثل:
(أ) وسط وجنوب السودان حيث مساحات واسعة من المستنقعات([184]) والسبخات تتطلب عمليات التجفيف لتحول إلى تربة جيدة تصل مساحتها إلى أكثر من 40 مليون هكتار. وتصل مساحة المستنقعات في السودان الجنوبي إلى نحو 8300 كلم مربع. ويتجه التفكير في العصر الحديث إلى تعميق مجاري المياه في السودان الجنوبي ممثلاً في نهر بحر الجبل ونهر الزراف ونهر الغزال التي تتجمع مياهها في بحيرة نو ومنها إلى النيل الأبيض حتى الخرطوم. وذلك بالإضافة إلى شق قناة صناعية في منطقة المستنقعات بعمق يصل إلى خمسة أمتار لتصرف 55 مليون متر مكعب من المياه في اليوم وبذلك يقل الفاقد في منطقة المستنقعات التي تجف تدريجياً علماً بأن مقدار الفاقد يقدر بنحو 40 مليار متر مكعب يفقدها النيل في منطقة مجراه الأعلى.
(ب) إقليم حوض بحر آرال والأراضي المجاورة في جنوب ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي والذي يمتد ما بين بحر قزوين وجبال أورال وهضاب منغوليا ومرتفعات شمال إيران في مساحات شاسعة تنتمي إلى المناخ شبه الجاف وتغطيها أنماط جيدة من التربة ولا ينقصها إلا التوسع في استثمار مصادر المياه النهرية والجوفية وهناك مشروع ضخم تحت التنفيذ يتمثل في التوسع في حفر الآبار الجوفية بالإضافة إلى الاستفادة من مياه نهر الفلجا عن طريق مد شبكة من القنوات الحديثة([185]).
(ج) يمتاز العالم الإسلامي بجناحيه بعدد كبير من شبكات الأودية الجافة الغنية بتربتها الرسوبية الخصبة ووفرة مياهها الجوفية في ثلاث طبقات حاملة لهذه المياه ولقد بدأ التوسع الزراعي في كثير من هذه الشبكات ومن أهمها أودية الشمال الليبي([186]) مثل وادي كعام ووادي درنة وأودية شبه جزيرة سيناء مثل وادي العريش وأودية هضبة نجد وإقليم الإحساء الذي يمتد إلى خليج فارس ومن أشهر الأودية وادي الدواسر ووادي الرحمة هذا بالإضافة إلى شبكات الأودية الجافة في جنوب وغرب إيران وفي أفغانستان وباكستان وغرب الصين وجنوب ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي وشمال غرب الهند وهضبة الدكن.
(د) وأخيراً نشير إلى هذه المساحات الضخمة من المنخفضات الداخلية والتي لم تُسْتَثْمَر إلا في أضيق الحدود مثل منخفض فزان ومنخفض الجفرة ومنخفض الكفرة في الهضبة الليبية وكذلك منخفضات الصحراء الغربية في مصر مثل منخفض سيوه ومنخفض الداخلة ومنخفض الخارجة ومنخفض البحرية وكذلك منخفضات وسط إيران وجنوب باكستان. ونشير أيضاً إلى المساحات الضحلة من البحيرات الشاطئية والداخلية مثل بحيرات شمال دلتا النيل وبحيرات هضبة الشطوط الجزائرية وبحيرات جنوب تونس وبحيرات وسط وغرب إيران وكلها تشكل أراضي تحت التجفيف التدريجي لتحويلها إلى مناطق للتوسع الزراعي الحديث.
هذا يشكل عرضاً عاماً لإمكانيات التوسع الزراعي في النطاق الإسلامي الضخم الآسيوي الإفريقي مما يدعم التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي بين هذه المناطق.
3 ـ يفتقر هذا النطاق الجغرافي الضخم إلى التوسع في شبكات النقل بأنواعها المختلفة وفقاً لما يأتي كأمثلة متنوعة لإمكانيات هذا التوسع في مجال النقل:
(أ) استكمال خط السكك الحديد الذي يمتد من الدار البيضاء بالمغرب إلى الإسكندرية فشمال سيناء([187]) ومنها يعبر الأردن والعربية السعودية إلى العراق ثم يخترق إيران إلى أفغانستان وباكستان حيث يتشعب إلى شعبتين رئيسيتين إحداهما تواصل امتدادها إلى جنوب ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي حتى غرب الصين والثانية ترتبط بخط الهلال الهندي الخصيب إلى بنغلاديش وجنوب شرقي آسيا. وبذلك يصبح أطول وأهم خط سكك حديد في العالم بتشعباته المختلفة.
(ب) التوسع في شبكات الطرق البرية لتخدم شبكات السكك الحديد ولا سيما في اتجاهين رئيسيين أحدهما يتوغل في وسط وشرق آسيا والثاني نحو الحزام الصحراوي الإفريقي لربط دول وسط وغرب إفريقيا بالوطن العربي الإفريقي حتى حوض البحر المتوسط عن طريق إحياء شبكات طرق القوافل القديمة.
(ج) التكامل والتعاون بين شركات الملاحة البحرية الإسلامية التي تغذي الخط الملاحي التجاري الذي يمتد من موانئ شرق آسيا وجنوبها الشرقي وجمهورية أندونيسيا إلى سنغافورة التي تمثل البوابة بين المحيطين الهادي والهندي ثم يخترق هذا الخط الملاحي المحيط الهندي حيث تتصل به الخطوط الفرعية من خليج البنغال وخليج فارس وشرق إفريقيا وكلها تتجمع عند ميناء عدن ويخترق الخط باب المندب عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر المتوسط ومضيق جبل طارق ليرتبط بخطوط المحيط الأطلسي إلى قناة بنما فالمحيط الهادي إلى شرق آسيا وذلك بالإضافة إلى الخط الملاحي التجاري الذي يخترق البحر الأبيض ماراً بميناء استانبول ومضيق البسفور ومضيق الدردنيل إلى ميناء أزمير وبحر إيجه إلى جزيرة كريت نحو الخط الرئيسي عند الإسكندرية.
(د) التكامل بين شركات النقل الجوي الإسلامية العربية لتنظيم وتحسين خدمات النقل الجوي عبر هذا النطاق الإسلامي الضخم ما بين المحيطين الهادي والأطلسي وعبر المحيط الهندي والبحر المتوسط وذلك بالتوسع في خلق خطوط جوية جديدة ولا سيما نحو وسط آسيا من ناحية وإلى الغرب الإفريقي من ناحية أخرى لربط هذه المناطق الإسلامية النائية والتي في حاجة ماسة إلى تدعيم ربطها اقتصادياً وسياحياً مع باقي أجزاء هذا النطاق الإسلامي الضخم بفرعيه الإفريقي والآسيوي.
وهذا التحليل الجغرافي يؤكد على حقائق هامة منها:
1 ـ إن هذا النطاق الإسلامي الذي يحتضن معظم أفريقيا شمال خط الاستواء ومعظم غرب ووسط وجنوب وشرق آسيا كبرى قارات العالم، يعتبر أهم وأضخم وأغنى نطاق جغرافي في العالم لما يمتاز به من تنوع فريد في الإنتاج الاقتصادي والإمكانيات الاقتصادية.
2 ـ إن الموقع الجغرافي الممتاز لهذا النطاق الإسلامي جعله يشرف على أهم المضايق والقنوات البحرية التي يمر بها أهم طريق تجاري بحري في العالم ما بين شرق آسيا والمحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس([188]) إلى البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وقناة بنما فضلاً عن شبكات الطرق والسكك الحديد وخطوط النقل الجوي التي أشرنا إليها سابقاً مما أعطى للإقليم ثقلاً عظيماً في المجال السياسي الاستراتيجي.
الدكتور محمد إبراهيم حسن
عدد المسلمين
أين يقف العالم الإسلامي من التحولات الضخمة في مطلع القرن المقبل القرن الواحد والعشرين؟ هذا السؤال كان محور أبحاث ومناقشات ندوة عقدت في القاهرة في تشرين الأول 1991 بعنوان «العالم الإسلامي … والمستقبل» أقامها مركز دراسات العالم الإسلامي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة القاهرة.
قدم الدكتور علي الدين هلال ورقة حول «مستقبل النظام الدولي» حلل فيها التطورات السريعة التي يشهدها العالم الآن وطرح نظرة استشرافية لما يمكن أن تتبلور عليه خريطة العالم الجديدة ثم انتهى إلى موقعنا الآن كعالم إسلامي ـ عربي في ضوء هذه التحولات.
وقال الدكتور هلال: إن علينا أولاً إدراك أن التطور التاريخي لا يعرف الاندفاعات العشوائية أو الانقطاعات المفاجئة، وإن لكل شيء مقدماته وأصوله وجذوره، ثانياً: إدراك أننا إزاء تطور لم يكتمل بعد وأننا أحياناً لا نرى سوى قمة جبال الجليد طافية، وأننا نعيش وسط هذا التحول الهائل ومن ثم فإن أفكارنا تتأثر بالأحداث الجارية والتطورات المتلاحقة، وإن سرعة التطور لا تسمح للباحث برفاهية التفكير الهادئ أو البعيد عن جلبة الأحداث.
وعلينا ثالثاً: التواضع في أحكامنا واجتهاداتنا، فهذه التطورات ما زالت تتلاحق وتتسارع، وما زالت تداعياتها على الأوضاع الدولية تتشكل وتتبلور، في هذا السياق يكون من غير العلمي إطلاق أحكام نهائية، وذلك بسبب طابع السيولة الذي يميز العلاقات المعاصرة.
وعلينا رابعاً: تجاوز الانطباعات السريعة التي تخلفها سرعة التطورات وسبر أغوارها في إطار تاريخي أوسع، وتدبر آثارها على منطقتنا وبلادنا وشعوبنا.
وفي ورقة أخرى تقدم بها الدكتور أحمد صدقي الدجاني بعنوان «التضامن الإسلامي … وإمكان قيام نظام إقليمي في العالم الإسلامي» طرح الباحث فكرة وجود نظام إقليمي في العالم الإسلامي وحاول أن يضع تصوراً نظرياً لفكرته.
بدأ الدجاني الحديث عن ثلاثة مصطلحات: التضامن الإسلامي، والعالم الإسلامي، والنظام الإقليمي، وقال: إن التضامن الإسلامي ظهر كفكرة، ثم كمشروع بعد بروز ضرورات التعاون بين المسلمين ضد الاستعمار الغربي.
أما مصطلح العالم فيشير إلى أن التنوع فيه هو القاعدة لا الاستثناء، والنظام الإقليمي هو في علم السياسة: «مجموع العلاقات والتفاعلات بين مجموعة من الدول التي تقع في إقليم جغرافي واحد، وتخضع لقواعد وقوانين منتظمة، وتستوحي الولاء لفكرة وسلطة عليا».
ويلقي الكاتب نظرة «تحليلية» على واقع العالم الإسلامي، فعدد المسلمين اليوم حوالي بليون نسمة، أي 20 في المئة من مجموع البشر في العالم. وموقعهم الجغرافي أو موقع عالمهم نصف الكرة الأرضية الشمالي والقديم، وتتنوع التضاريس في العالم الإسلامي، كما تتنوع مجموعات المسلمين في العنصر واللغة والطائفة. وفي العالم الإسلامي أديان أخرى غير الإسلام، كما ينقسم إلى أكثر من أربعين دولة ويحتوي على ثروات هائلة، لكنه واقع على اختلاف دوله في استراتيجية السوق الرأسمالية وفي أسر التمايزات الاجتماعية والاقتصادية الظالمة. كما تتنوع في العالم أنظمة الحكم، وليس لتلك الأنظمة مرجعية واحدة أو مرجعيات محددة، ويواجه العالم الإسلامي أخطاراً كثيرة من ضمنها الخطر الصهيوني، والاستراتيجيات الغربية القديمة والمستجدة بعد انهيار الكتلة الشيوعية في أوروبا، ويشهد منذ عقد من السنين «صحوة» قوامها وعي الذات، ومعرفة العدو.
وفي نهاية ورقته يطرح الدجاني إمكانية قيام نظام إقليمي إسلامي فاعل، ويتوصل إلى أن النظام الإقليمي يقوم في العادة بين دول دائرة «حضارية» واحدة، ويهدف إلى تحقيق التكامل، ويتطلب التأسيس توافر عنصر القيادة للإدارة العملية، وتوافر رأي عام، ومواجهة تحديات مشتركة. وفي ظل هذه الشروط الضرورية يلقي نظرة على تناقضات الواقع في العالم الإسلامي في الحقبة الحديثة، بعد استنتاجه توافر الشروط لقيام مثل هذا النظام.
التهديدات الأمنية
وناقشت الندوة بحثاً بعنوان «التهديديات الاستراتيجية والأمنية للعالم الإسلامي» قدمه الدكتور أحمد شوقي الحنفي، درس فيه معنى المصطلحات: التهديد، والأمن، والعالم الإسلامي، وقال: إن التهديدات مسألة نسبية، وتوجد لدى كل دولة، أما الأمن فمسألة اجتماعية شاملة متعددة الأبعاد والمجالات، ولا تقتصر على المجال العسكري. وفي مصطلح «العالم الإسلامي» صعوبات ناجمة عن أنه ليس نظاماً إقليمياً فاعلاً أو فرعياً داخل النظام الدولي، ولذا وجب دراسة القواسم المشتركة لتلك الدول وتحليلها.
وتعرض الباحث بالنقد للفكرة القائلة بأن التهديد يأتي من الخارج فقط، وبدأ بحثه بذكر مصادر التهديدات فذكر أولاً التهديدات الداخلية، وقسمها إلى تهديدات سياسية ناجمة عن انعدام الديموقراطية في أكثر بلدان العالم الإسلامي، وضآلة المشاركة الشعبية، والانفصال بين السلطة والمجتمع، ويخلف ذلك ضعفاً عاماً في مجالات أخرى، ويزيد من إمكانات التعرض للتهديد الخارجي.
وتأتي ضمن التهديديات السياسية: المشاكل بين الدول المتجاورة في العالم الإسلامي مما يدل على الضعف التركيبي للمكونات السياسية لهذا العالم، ثم إنهما «العالمين العربي والإسلامي» يفتقدان نموذج الدولة على المستويين النظري والتطبيقي مع تصاعد التيارات الإسلامية الرافضة للتجربة العالمية الحديثة كلها.
وعرض في نهاية ورقته رؤية مستقبلية لحلول ممكنة لإضعاف وجوه التهديد، فتحدث عن الإمكانات الضخمة وضرورة حصرها وضبطها والوعي بالتهديدات والمخاطر، وإعادة البناء الإنساني. وحصر الأمر في نقاط ثلاث هي: تطوير النظم السياسية، وتطوير مناهج التعليم، وإرساء نظام اجتماعي إنساني.
وألقيت في ندوة «العالم الإسلامي …. والمستقبل» الكثير من الأبحاث والأوراق منها: «بين النظام المقصور والنظام المنشور» لمحمد خليفة، و«التكنولوجيات الحديثة ودورها في العلاقات الدولية» لعبد الله هلال، و«المتغيرات السياسية في العالم الإسلامي، الحاضر والمستقبل» لأحمد الموصللي، و«التعليم والبحث العلمي في العالم الإسلامي: الواقع والمستقبل» لعمر التومي الشيباني، و«أحوال الزراعة في الدول الإسلامية وكيفية تطويرها» لعلي عبد الله خيري، و«الإعلام وتأثيره على البنية الاجتماعية والهوية الإسلامية» لصلاح الدين الجورشي، وغيرها من البحوث. استمرت أعمال الندوة أربعة أيام متتالية في جلسات صباحية ومسائية.
علي بن أبي طالب (ع)
هو علي بن أبي طالب «واسمه عبد مناف» بن عبد المطلب «واسمه شيبة الحمد» بن هاشم «واسمه عمرو» بن عبد مناف «واسمه المغيرة».
مولده
ولد يوم الجمعة 13 رجب على قول الأكثر وقيل ليلة الأحد الثالث والعشرين منه، وقيل يوم الأحد سابع شعبان بعد عام الفيل بثلاثين سنة وقيل بتسع وعشرين بعد مولد النبي (ص) بثلاثين سنة وقيل بثمان وعشرين، قبل النبوة باثنتي عشرة سنة وقيل بعشر سنين، وهو الذي صححه في الإصابة قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة وقيل بخمس وعشرين وكانت ولادته بمكة في الكعبة. ويمكن تقدير تاريخ مولده بين 600 أو 604 ميلادية.
أبوه
اسمه عبد مناف، وأبو طالب كنيته كني بأكبر أولاده، وهو أخو عبد الله أبي النبي (ص) لأمه وأبيه، وأبو طالب هو الذي كفل رسول الله (ص) صغيراً وقام بنصره وحامى عنه وحاطه كبيراً وتحمل الأذى في سبيله من مشركي قريش ومنعه منهم ولقي لأجله عناء عظيماً وقاسى بلاء شديداً وصبر على نصره والقيام بأمره حتى أن قريشاً لم تطمع في رسول الله (ص) حتى توفي أبو طالب ولم يهاجر النبي إلاَّ بعد وفاته. وكان أبو طالب مسلماً لا يجاهر بإسلامه ولو جاهر لم يمكنه ما أمكنه من نصر رسول الله (ص) على أنه قد جاهر بالإقرار بصحة نبوته في شعره مراراً.
وأول صلاة جماعة كانت أن النبي كان يصلي وعلي بن أبي طالب معه إذ مرَّ به أبو طالب وابنه جعفر معه، فقال: يا بني صل مع ابن عمك، فانضم جعفر إليهما وانصرف أبو طالب مسروراً وروي عن علي (ع) أنه قال: قال لي أبي الزم ابن عمك.
أمه
فاطمة بنت أسد بن هاشم. وهي أم سائر ولد أبي طالب. وكانت لرسول الله (ص) بمنزلة الأم، رُبِّي في حجرها وكان شاكراً لبرِّها وكان يسميها أمي وكانت تفضله على أولادها في البر. سبقت إلى الإسلام وهاجرت إلى المدينة ولما توفيت حزن عليها النبي وباشر دفنها بنفسه، فقيل يا رسول الله رأيناك تصنع شيئاً لم تكن تصنعه بأحد قبلها؟ فقال: إنها كانت من أحسن خلق الله صنعاً بي بعد أبي طالب. إن هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني. ولدت طالباً ولا عقب له وعقيلاً وجعفراً وعلياً وكل واحد أسن من الآخر بعشر سنين وأم هانئ.
كنيته
يكنى أبا الحسن. وكان يكنى أيضاً بأبي تراب كناه به رسول الله (ص) ففي كتاب الاستيعاب: قيل لسهل بن سعد أن أمير المدينة يريد أن يبعث إليك لتسب علياً عند المنبر قال: كيف أقول؟ قال: تقول: «أبا تراب» فقال: والله ما سماه بذلك إلاَّ رسول الله (ص)، قال وكيف ذلك يا أبا العباس؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع في صحن المسجد فدخل رسول الله (ص) على فاطمة فقال أين ابن عمك قالت هو ذاك مضطجع في صحن المسجد فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. فوالله ما سماه به إلاّ رسول الله (ص) والله ما كان اسم أحبَّ إليه منه. وكان أعداؤه لا يطلقون عليه غيرها كأنهم يعيرونه بها مع أنها موضع الفخر. وجعلوها نقيصة له كما أنهم كانوا لا يطلقون على أتباعه إلاَّ الترابي والترابية.
وصية أبيه له عند وفاته
لما حضرت أبا طالب الوفاة أوصى ابنيه علياً وجعفراً وأخويه حمزة وعباساً بنصر النبي فقاموا به أحسن قيام لا سيما علي وحمزة وجعفر.
وفي جمع علي معهم وهو غلام صغير وأخوه جعفر أكبر منه والآخران عماه وهما أسن منه دليل كافٍ على ما كان يتوسمه أبو طالب في ابنه علي من مخايل الشجاعة والرجولة والبأس والنجدة وأنه سيكون خير ناصر للنبي (ص) وأعظم محام عنه ومؤازر له وما أخطأت فراسته فيه بل أصابت فكان عند فراسته فيه بأقصى حد يتصور.
ما جرى له عند وفاة أبي طالب
ولما توفي أبو طالب، جاء علي إلى النبي (ص) فأعلمه بوفاته فحزن عليه حزناً شديداً وأمر علياً بتغسيله روى السيد فخار بن معد الموسوي في كتابه الذي ألَّفه في إسلام أبي طالب أن أبا طالب لما مات جاء علي (ع) إلى النبي (ص) فآذنه بموته فتوجع عظيماً وحزن شديداً ثم قال امض فتول غسله فإذا رفعته على سريره فأعلمني ففعل فاعترضه رسول الله (ص) وهو محمول على رؤوس الرجال فقال له: وصلتك رحم يا عم وجزيت خيراً فلقد ربيت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت كبيراً ثم تبعه إلى حفرته.
أولاده
عدهم المسعودي في مروج الذهب خمسة وعشرين وقال المفيد في الإرشاد أنهم سبعة وعشرون ما بين ذكر وأنثى ثم قال: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة أسقطت بعد النبي (ص) ذكراً كان سماه رسول الله (ص) وهو حمل محسناً فعلى قول هذه الطائفة هم ثمانية وعشرون وقال ابن الأثير: المحسن توفي صغيراً. والمفيد عدهم مع المحسن فزاد محمداً الأوسط وأم كلثوم الصغرى والبنت الصغيرة ورملة الصغرى والذي وصل إلينا من كلام المؤرخين والنسابين وغيرهم يقتضي أنهم ثلاثة وثلاثون ويمكن كون هذه الزيادة من عد الاسم واللقب اثنين مع أنهما واحد وهم:
1 ـ الحسن، 2 ـ الحسين، 3 ـ زينب الكبرى، 4 ـ زينب الصغرى المكناة أم كلثوم: أمهم فاطمة البتول، 5 ـ أم كلثوم الكبرى ذكرها ابن الأثير مع زينب الكبرى. وقال المسعودي: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى أمهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص) ويمكن الجمع بين قول المفيد زينب الصغرى المكناة أم كلثوم الكبرى بأنها زينب الصغرى بالنسبة إلى زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى بالنسبة إلى أم كلثوم الصغرى الآتية التي هي من غير فاطمة، 6 ـ محمد الأوسط أمه أُمامة بنت أبي العاص لم يذكره المفيد ولا المسعودي (7، 8، 9، 10) العباس وجعفر وعبد الله وعثمان الشهداء بكربلاء أمهم أم البنين الكلابية. وقال المسعودي أمهم أم البنين بنت حزام الوحيدية ولم يذكر معهم عثمان. 11 ـ محمد الأكبر المكنى بأبي القاسم المعروف بابن الحنفية أمه خولة الحنفية، 12 ـ محمد الأصغر المكنى بأبي بكر وبعضهم عد أبا بكر ومحمداً الأصغر اثنين والظاهر أنهما واحد. 13 ـ عبد الله وأو عبيد الله الشهيدين بكربلاء أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية. 14 ـ يحيى أمه أسماء بنت عميس. 15 و16 ـ عمر ورقية توأمان أمهما أم حبيب الصهباء بنت ربيعة التغلبية وعمر عاش خمساً وثمانين سنة. 17 و18 و19 ـ أم الحسن ورملة الكبرى وأم كلثوم الصغرى أمهم أم سعد بنت عروة بن مسعود الثقفية واقتصر المفيد والمسعودي على أم الحسن ورملة ولم يصفاها بالكبرى. 20 ـ بنت ماتت صغيرة أمها محياة الكلبية ولم يذكرها المفيد والمسعودي. 21 ـ أم هانئ. 22 ـ ميمونة. 23 ـ زينب الصغرى. 24 ـ رملة الصغرى ولم يذكرها المفيد ولا المسعودي. 25 ـ رقية الصغرى ولم يذكرها المسعودي. 26 ـ فاطمة. 27 ـ أمامة. 28 ـ خد. 29 ـ أم الكرام. وقال المسعودي أن أم الكرام هي فاطمة. 30 ـ أم سلمة. 31 ـ أم أبيها ذكرها المسعودي. 32 ـ جمانة المكناة أم جعفر. 33 ـ نفيسة. لأمهات شتى.
زينب وأم كلثوم
ومقتضى قول غير المفيد أن زينب وأم كلثوم أربعة: صغيران وكبيران وبه صرَّح المسعودي فجعل أم كلثوم الكبرى وزينب الصغرى من فاطمة الزهراء وجعل أم كلثوم الصغرى من غيرها. أما المفيد فلم يذكر أم كلثوم الصغرى كما عرفت وذكر زينب الكبرى وزينب الصغرى من غير الزهراء ولم يكنها أم كلثوم. ولا شك أنه كان لأمير المؤمنين عليه اسلام بنتان كلتاهما تكنى أم كلثوم إحداهما توفيت بالمدينة والأخرى التي كانت بالطف ذكرهما المؤرخون والأولى توفيت قبل وقعة الطف وحينئذٍ فلا يبعد أن تكون أم كلثوم التي كانت بالطف والتي خطبت بالكوفة هي زينب الصغرى التي ذكرها المفيد وهو الموافق للاعتبار فإنها وزينب الكبرى شقيقتا الحسين (ع) فلم تكونا لتفارقاه ولا ليفارقهما وإذا كانت الكبرى وهي زوجة عبد الله بن جعفر لم تفارقه وزوجها حي فأحرى أن لا تفارقه الصغرى وهي في النبل بمرتبة تلي مرتبة زينب الكبرى. أما القبر الذي بقرية راوية قرب دمشق فهو منسوب لزينب الصغرى المكناة أم كلثوم كما وجد في صخرة على قبرها رأيتها وكما ذكره ابن جبير في رحلته فإن صح ذلك فهي شقيقة الحسين (ع) أما كيف جاءت إلى الشام وتوفيت ودفنت هناك فالله أعلم بصحة ذلك وليس في شيء من التواريخ والآثار ما يشير إليه. وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق أن القبر الذي بقرب «راوية» هو لأم كلثوم وليست بنت النبي (ص) لأنها توفيت بالمدينة ولا أم كلثوم بنت علي من فاطمة لأنها ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع وإنما هي امرأة من أهل البيت سميت بهذا الاسم ولا يحفظ نسبها. وظاهر هذا القول انحصار أم كلثوم بنت علي (ع) في واحدة وهو مخالف لما عليه المؤرخون والنسابون. وياقوت في معجم البلدان اقتصر على أن في قرية «راوية» قبر أم كلثوم لم يزد على ذلك([189]). والنسل من أولاد علي للحسن والحسين عليهما السلام ومحمد بن الحنفية. والعباس وعمر.
أول الناس إسلاماً
كان علي (ع) أوَّل من آمن بالنبي (ص) ثم أسلمت خديجة، وبعضهم يروي أن خديجة أسلمت قبل علي. وكيف كان فلا ريب في أن إسلامهما في زمان متقارب كما لا ريب في أن أول الناس إسلاماً من الذكور علي ومن النساء خديجة.
النبي يقول: هذا أخي ووصيي وخليفتي
روى ذلك الطبري في تاريخه وتفسيره، والبغوي، والثعلبي في تفسيره والنسائي في الخصائص وصاحب السيرة الحلبية ومحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي والشيخ المفيد في الإرشاد، وغيرهم وأورد الطبري القصة في تاريخه كما يلي:
لما نزلت: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ دعا رسول الله (ص) قومه إلى طعام وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فقال:
«إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكن أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟».
فأحجم القوم جميعاً إلاَّ علياً فإنه قال: «أنا يا نبي الله». فقال النبي: «هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا» فقاموا يضحكون ويقولون لأبي طالب أمركَ أن تسمع لإِبنكَ وتطيع.
مبيت علي مكان النبي
كما فدا أبو طالب النبي بولده علي فكان يقيم النبي من مرقده خوفاً عليه من اغتيال المشركين وينيم ولده علياً مكانه ليكون فداء له لو قصده المشركون باغتيال، كذلك فدا علي النبي (ص) بنفسه بعد وفاة أبيه فنام على فراش النبي ليلة الغار وفداه بنفسه وسنَّ له أبوه في المحافظة على النبي إلى حد الفداء بالنفس سنة اتبعها علي بعد وفاة أبيه ووطن نفسه عليها واستهان بالموت في سبيلها، وذلك أن قريشاً ائتمرت برسول الله (ص) في دار الندوة لما أعياهم أمره ورأوا دعوته لا تزداد إلاّ انتشاراً فأجمع رأيهم على اغتياله ليلاً وهو في فراشه وانتخبوا من قبائلهم العشر من كل قبيلة رجلاً شجاعاً ليهجموا عليه ليلاً فيقتلوه ويضيع دمه في القبائل ويرضى بالدية، ودفعا لهذا الخطر عزم النبي على الهجرة إلى المدينة في تلك الليلة، وكان مفهوم أنه إذا شعر المتآمرون بأن فراش النبي خال منه فإنهم سيتعقبونه ويخرجون في أثره، لذلك رأى النبي أن يبيت علي في فراشه فإذا جاء المتآمرون في أول الليل فإنهم سيظنون أن النبي في الفراش فينتظرون إلى الساعة المعينة ثم يهجمون عليه. وبذلك كان علي معرضاً لخطر القتل.
فدعا رسول الله (ص) علياً (ع) وأخبره بذلك وقال له عزمت أن أهجر دار قومي وأنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي هذه وإني آمرك بالمبيت على فراشي ليخفي بمبيتك عليهم أمري، واشتمل ببردي الحضرمي «وكان له برد حضرمي أخضر أو أحمر ينام فيه» ثم ضمَّه النبي إلى صدره وبكى. وكانت قريش تنظر إلى فراش النبي (ص) فيرون عليه علياً فيظنونه النبي (ص).
وأمر رسول الله (ص) أبا بكر وهند بن أبي هالة أن يقعدا له بمكان ذكره لهما ولبث مع علي يوصيه ويأمره بالصبر حتى صلى العشاءين ثم خرج في فحمة العشاء الآخرة والرصد من قريش قد أطافوا بداره ينتظرون إلى أن ينتصف الليل، حتى أتى إلى أبي بكر وهند فنهضا معه حتى وصلوا إلى الغار فدخلا الغار ورجع هند إلى مكة فلما أغلق الليل أبوابه وانقطع الأثر أقبل القوم على علي يقذفونه بالحجارة ولا يشكون أنه رسول الله، حتى إذا قرب الفجر هجموا عليه. فلما بصر بهم علي قد انتضوا السيوف وأقبلوا بها إليه أمامهم خالد بن الوليد وثب علي وأخذه سيف خالد وشدَّ عليهم فأجفلوا أمامه إلى ظاهر الدار وبصروه فإذا هو علي فقالوا إنا لم نردك فما فعل صاحبك؟ قال لا علم لي به …
أخباره في غزوة بدر
كانت وقعة بدر في شهر رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة عشر منه على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة، وكان المسلمون فيها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وكان المشركون تسعمائة وخمسين أو عشرين مقاتلاً. وعندما اصطفت الصفوف وتهيأت للقتال برز من صف المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة ودعوا إلى المبارزة فبرز إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار وهم معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث فلم يرضوا أن يبارزوهم ورأوا أنهم غير أكفاء لهم وقالوا لهم ارجعوا ثم نادوا يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، فقال لعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ولحمزة بن عبد المطلب ولعلي بن أبي طالب أن يبارزوهم، فبارز علي الوليد، وكان أصغر القوم وبارز عبيدة شيبة وهما أسن القوم ولعبيدة سبعون سنة وبارز حمزة عتبة وهما أوسط القوم سناً. ومن الطبيعي أن يبارز الرجل من يناسبه في السن، هذه رواية الواقدي والمفيد في الإرشاد. وقال ابن سعد في الطبقات: الثابت أن حمزة بارز عتبة وأن عبيدة بارز شيبة، وروى ابن إسحاق في المغازي أن عبيدة بارز عتبة وحمزة بارز شيبة وكانت النتيجة قتل الوليد وعتبة وشيبة من المشركين وكذلك قتل عبيدة بن المطلب من المسلمين، وذل المشركون بمقتل هؤلاء الزعماء الثلاثة وظهرت إمارات النصر للمسلمين فهجموا على المشركين واشتبك الفريقان في القتال. وأقبل حنظلة بن أبي سفيان نحو علي فقتله، كما أقبل نحوه العاص بن سعيد بن العاص فقتله علي. والعاص هذا هو جد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق الذي كان عاملاً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية يوم قتل الحسين (ع) ولما أخبر بقتله وسمع واعية بني هاشم ضحك وأنشد الشعر شامتاً.
قال الواقدي: ولما رأت بنو مخزوم مقتل من قتل قالوا: أبو الحكم لا يخلص إليه ـ يعنون أبا جهل ـ فأحدقوا به وألبسوا لامته عبد الله بن المنذر فقتله علي وهو يظنه أبا جهل ثم ألبسوها حرملة بن عمرو فصمد له علي فقتله ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلى فأبى وبمقتل هؤلاء الشجعان وغيرهم ضعفت معنويات المشركين وتضعضعت صفوفهم ثم كانت هزيمتهم العامة وكان علي لم يتجاوز العشرين سنة من عمره عند حدوث هذه المعركة.
أخباره في معركة أحد
أحد: اسم جبل غير بعيد عن «المدينة» سميت باسمه المعركة المشهورة بين قريش والمسلمين وكانت في شهر شوال لسبع خلون منه أو للنصف منه يوم السبت سنة ثلاث من الهجرة، وكان سببها أن المشركين اجتمعوا وقرروا غزو المدينة للأخذ بالثأر بما أصابهم يوم بدر فكتب العباس كتاباً وأرسله مع رجل من غفار إلى النبي (ص) يخبره بخبرهم استأجره وشرط عليه أن يصل المدينة في ثلاثة أيام فوصلها وسلَّم الكتاب. وأقبل المشركون في ثلاثة آلاف وقائدهم أبو سفيان وساروا حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد مقابل المدينة فأقاموا الأربعاء والخميس والجمعة وبات رؤساء الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير بالسلاح بباب رسول الله (ص) ليلة الجمعة خوفاً عليه من الاغتيال حتى أصبحوا وحرست المدينة تلك الليلة فلما أصبح النبي (ص) يوم الجمعة خطب أصحابه فكان مما قاله: إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها فأنا أعلم بها منهم، فكان رأيه البقاء بالمدينة واختلف رأي أصحابه فكان رأي أكثر وجوههم موافقاً لرأيه وكان رأي الشبان الذين لم يحضروا بدراً وبعض الشيوخ: الخروج فلما رأى النبي (ص) أكثرهم يريد الخروج وافقهم. ومع ذلك كان النصر فيها مضموناً لولا مخالفة الرماة كما يأتي: وسار من المدينة بعد العصر في ألف من أصحابه، فلما وصل النبي إلى مكان يسمى «الشيخين» عرض عسكره وبات هناك ثم سار سحراً حتى وصل إلى بستان يسمى الشوط بين المدينة وأُحُد فصلَّى فيه صلاة الصبح ومن هناك رجع عبد الله بن أُبي بن سلول في ثلاثمائة من المنافقين وبقي النبي في سبعمائة فلما نهض من الشيخين زحف المشركون على تعبئة فوصل إلى أحد فجعل أحد خلف ظهره وجاء المشركون فاستدبروا المدينة واستقبلوا أحداً وأعطى المشركون لواءهم إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار لأن لواء قريش كان لهم في الجاهلية، فلما علم رسول الله (ص) أن لواء المشركين مع بني عبد الدار أخذ اللواء من علي ودفعه إلى رجل من بني عبد الدار اسمه مصعب بن عمير وقال نحن أحق بالوفاء منهم، فلما قتل مصعب رده إلى علي. وصفّ المشركون صفوفهم وكان لهم ميمنة وميسرة فيهما مائتا فرس وخالد بن الوليد في الميمنة وعكرمة بن أبي جهل في الميسرة وصفّ النبي (ص) أصحابه وجعل الرماة خلف العسكر عند فم الشعب الذي في جبل احد وكانوا خمسين رجلاً وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال أنضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا فإن الخيل لا تقدم على النبل وأثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا فإنا لا نزال غالبين ما ملكتم مكانكم فإن أدخلناهم مكة فلا تبرحوا وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم.
وبرز طلحة بن أبي طلحة بن عثمان العبدري صاحب لواء المشركين وطلب البراز مراراً فلم يجبه أحد فبرز إليه علي بن أبي طالب فقتله. ثم أخذ لواء المشركين أبطالهم واحداً بعد واحد فقتلوا جميعاً وفي ترتيب أسماء من أخذ اللواء بعد طلحة وعددهم ومن قتلهم بعض الاختلاف بين المؤرخين:
قال ابن الأثير: كان الذي قتل أصحاب اللواء علي قال أبو رافع وروى الطبري وعلي بن إبراهيم والمفيد ما يدل على أن علياً (ع) قتل أصحاب اللواء جميعهم واحداً بعد واحد أما الطبري في روايته الآتية قال لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية إلخ فهذا ظاهر أنه هو الذي قتل أصحاب الألوية جميعهم. وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: كانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدري فبرز إليه علي فقتله فسقط وسقطت الراية ثم أخذ الراية أبو سعيد بن أبي طلحة فقتله علي وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عثمان بن أبي طلحة فقتله علي وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها مسافع بن أبي طلحة فقتله علي وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها الحارث بن أبي طلحة فقتله علي وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها أبو عزيز بن عثمان فقتله علي وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عبد الله بن أبي جميلة فقتله علي وأخذها أرطأة بن شرحبيل من بني عبد الدار فقتله علي وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها مولاهم صواب فضربه علي فقتله. وسقطت الراية إلى الأرض فأخذتها عمرة بنت علقمة الحارثية.
وهذا اللواء كان شؤماً على بني عبد الدار فقد قتلت رجالهم تحته ووقع على الأرض حتى رفعته امرأة.
وقال أبو سفيان لخالد بن الوليد وهو في مائتي فارس مع عكرمة بن أبي جهل إذا رأيتمونا قد اختلطنا بهم فأخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا من ورائهم وكان خالد كلما أتى من يسرة النبي (ص) ليجوز حتى يأتيهم من قبل السفح ردَّه الرماة حتى فعل وفعلوا ذلك مراراً. قال المفيد: وبارز الحكم بن الأخنس فضربه علي فقتله. ولما قتل أصحاب اللواء انهزم المشركون وانتقضت صفوفهم ولحقهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا حتى أخرجوهم عن المعسكر قال الطبري وأمعن في الناس أبو دجانة وحمزة وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين فأنزل الله عليهم نصره وصدقهم وعده وكانت الهزيمة لا شك فيها وجعلوا ينهبون ويغنمون فلما رآهم الرماة تاقت نفوسهم إلى الغنيمة وتناسوا أمر النبي (ص) لهم أن يلزموا مراكزهم أكانت للمسلمين أم عليهم ومبالغته في الوصية بذلك فقال بعضهم لبعض: لم تقيمون هنا في غير شيء وقد هزم الله العدو وهؤلاء إخوانكم ينهبون عسكرهم فاذهبوا فاغنموا معهم فذكرهم البعض وصية النبي أن لا يبرحوا من مكانهم فأجابوهم بأن النبي لم يرد هذا وقد هزم العدو فخطبهم أميرهم ونهاهم عن الذهاب وأمر بطاعة الرسول فعصوه وانطلقوا وبقي معه دون العشرة.
فلما رأى خالد بن الوليد أن الرماة قد تركوا مراكزهم ولم يبق منهم إلاَّ القليل كرَّ عليهم بالخيل وتبعه عكرمة فراماهم القوم حتى قتلوا بعدما فني نبلهم وراماهم عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ثم قاتل بسيفه حتى قتل. ولما رأى المشركون خيلهم تقاتل رجعوا عن هزيمتهم وكروا على المسلمين من أمامهم وهم غارون آمنون مشتغلون بالنهب وكرَّ عليهم خالد بخيله من ورائهم وجعلوا المسلمين مثل الحلقة وانتقضت صفوف المسلمين وجعل بعضهم يضرب بعضاً من العجلة والدهشة حتى قتل منهم سبعون رجلاً بعدد من قتل من المشركين يوم بدر أو أكثر وتفرقوا في كل وجه وتركوا ما انتهبوه فأخذه المشركون. وتركوا ما بأيديهم من أسرى المشركين.
قال المفيد: ولما جال المسلمون تلك الجولة أقبل أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة وهو دارع وهو يقول يوم بيوم فعرض له رجل من المسلمين فقتله أمية وصمد علي بن أبي طالب لأمية فقتله.
وكانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وأم معاوية جعلت جعلاً لوحشي بن حرب إن هو قتل رسول الله أو علي بن أبي طالب أو حمزة فقال لها أما محمد فلا حيلة لي فيه لأن أصحابه يطيفون به وأما علي فإنه إذا قاتل كان أحذر من الذئب وأما حمزة فإني أطمع فيه لأنه إذا غضب لم يبصر بين يديه، فرمى حمزة بحربته فقتله. وتفرق الناس كلهم عن رسول الله (ص) وأسلموه إلى أعدائه ولم يبق معه أحد إلاَّ علي (ع) فبعضهم ذهبوا إلى المدينة وبعضهم صعدوا فوق الصخرة التي في جبل أحد وقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم وبعضهم ذهبوا إلى جبل بناحية المدينة فأقاموا به ثلاثاً ثم عاد جماعة من أصحاب الصخرة أربعة أو خمسة فحاموا عن النبي مع علي (ع) وكان عودهم بسبب ثبات علي وكان علي هو المتميز وحده بالمحاماة عن النبي (ص) فكان كلما أقبلت إليه جماعة من المشركين عازمين على أن يقتلوه مجتهدين في ذلك يقول له يا علي احمل عليهم فيحمل عليهم ويفرقهم ويقتل فيهم وهكذا حتى نجاه الله من كيدهم وسلِم منهم.
وثاب إلى رسول الله نفر كان أولهم عاصم بن ثابت وأبو دجانة وسهل بن حنيف ولحقهم طلحة بن عبيد الله.
قال ابن هشام: لما انتهى رسول الله (ص) إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس فجاء به إلى رسول الله (ص) وغسل عن وجهه الدم وصبَّ على رأسه الماء وقال ابن الأثير: لما جرح (ص) جعل علي ينقل له الماء في درقته من المهراس ويغسله فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانقه وتبكي، وعالجت الجرح حتى انقطع الدم. وقال الواقدي: خرجت فاطمة عليها السلام في نساء وقد رأت الذي بوجه أبيها فاعتنقته وجعلت تمسح الدم عن وجهه. قال أيضاً: خرج محمد بن مسلمة مع النساء وكنَّ أربع عشرة امرأة قد جئن من المدينة يتلقين الناس منهن فاطمة عليها السلام. والظاهر هو أن الخبر وصل إلى المدينة من بعض المنهزمين الذين دخلوها فلم تتمالك فاطمة حتى جاءت من المدينة لتنظر ما جرى على أبيها وبعلها والمسلمين. وقال المفيد في الإرشاد: انصرف المسلمون مع النبي (ص) إلى المدينة فاستقبلته فاطمة عليها السلام ومعها إناء فيه ماء فغسل وجهه. وهذا يدل على أن استقبالها له كان في نفس المدينة أو قريباً منها وأنها لم تخرج إلى أحد الذي يبعد عن المدينة فرسخاً أو أكثر وهذا هو الأقرب إلى الاعتبار.
ولما انصرف أبو سفيان ومن معه بعث رسول الله علي بن أبي طالب (ع) فقال أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون فإن كانوا قد اجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة قال علي فخرجت في آثارهم فرأيتهم اجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل.
وبعدما انصرف المشركون فرغ الناس للنظر في حال من فقد منهم فمن كان حياً جريحاً أسعفوه ومن كان ميتاً دفنوه، فأول ما سأل النبي عن سعد بن الربيع الخزرجي فوجد حياً بآخر رمق ومات ثم قال من له علم بعمي حمزة ولا بدَّ أن يكون علم أنه قتيل أو جريح وإلاَّ لم يتخلف عنه فقال الحارث بن الضمة أنا أعرف موضعه والظاهر أنه رآه لما سقط فيمكن أن يكون حياً ويمكن كونه ميتاً لكنه لم يعلم أنه قد مثل به التمثيل الفظيع فلما رآه قد مثل به كره أن يرجع إلى رسول الله (ص) فيخبره فلم يرجع فلما أبطأ استشعر رسول الله من إبطائه فظاعة الحال فقال لعلي اطلب عمك وإنما لم يرسله من أول الأمر إشفاقاً عليه من أن يرى عمه قتيلاً أو جريحاً فتتحرك فيه عاطفة الرحم فيشتد حزنه فلما لم يعد إليه الحارث بخبره لم يجد بداً من إرسال علي، فكره علي أن يعود إليه فيخبره بما رأى فلم يعد فعندما لم يجد بداً من أن يطلبه بنفسه فوجده قد بقر بطنه عن كبده وجدع أنفه وأذناه، فعلت به ذلك هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان فبكى مع ما به من الصبر والجلد.
أخباره في وقعة الخندق
كانت معركة الخندق في ذي القعدة أو شوال سنة خمس من الهجرة بعد غزوة أحد بسنتين وسببها أنه لما أجلى رسول الله (ص) بني النضير إلى خيبر لنقضهم العهد خرج جماعة من أشرافهم إلى مكة فألَّبوا قريشاً وعاهدوهم على قتال رسول الله ووعدوهم لذلك موعداً. ثم اتصلوا بقبائل أخرى فتجهزت قريش ومن تبعها فكان عدد الجميع عشرة آلاف يقودهم «أبو سفيان».
ولما تهيأوا للخروج أتى ركب من خزاعة في أربع ليال فأخبروا رسول الله (ص) فأخبر الناس وندبهم فأشار سلمان الفارسي بأن يحفروا خندقاً حول المدينة فحفروه في ستة أيام أو أكثر ففرغوا منه قبل مجيء قريش والمسافة بين مكة والمدينة عشرة ايام بسير الإبل ومسيرة جيش فيه عشرة آلاف إن لم يزد على عشرة أيام لمن ينقص فإذا أنقصنا منها أربعة أيام التي سارها ركب خزاعة بقي ستة. هذا إن لم تكن قريش تأخرت عن مسير الركب يوماً أو أكثر. ورفع المسلمون النساء والصبيان في الآطام «جمع أطم» وهو بناء كالحصن وهذه الآطام كانت بين بيوت المدينة وكانت المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من سائر جوانبها إلاَّ جانباً واحداً وهو الذي فيه الخندق ولا يتمكن أحد من الدخول إليها إلاَّ من ذلك الجانب فلذلك جعلوا النساء والذراري في الآطام ومنه يعلم أن الخندق لم يكن على جميع جوانب المدينة بل على بعض جوانبها. وخرج رسول الله (ص) في ثلاثة آلاف فعسكر إلى سفح سلع وهو جبل فوق المدينة فجعل سلعاً خلف ظهره والخندق بينه وبين القوم. وكانت اليهود ثلاث قبائل معاهدين للنبي فنقض الأولان العهد وبقيت قريظة فدسَّ أبو سفيان حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد سيد قريظة لينقضوا العهد فلم يقبل فلم يزل به حتى قبل وعظم البلاء واشتدَّ الخوف وبقي المشركون محاصِرين المدينة قريباً من شهر ولم يكن بينهم إلاَّ الحصار والترامي بالنبل والحصى.
وجاء فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل ونوفل بن عبد الله المغيرة وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب إلى مكان ضيق فيه كان قد أغفله المسلمون فأكرهوا خيولهم فطفرت بهم فوق الخندق وجالت بهم بين الخندق وسلع وصاروا والمسلمون على صعيد واحد.
وخرج علي في نفر من المسلمين ووقفوا في وجههم على ما تقدم ذكره في وقعة الخندق في سيرة النبي (ص) فلا نكرر ذكره هنا، بل نحيل القارئ إلى هناك وفي الإرشاد: روى علي بن الحكم الأودي سمعت أبا بكر بن عياش يقول: لقد ضرب (بفتح الضاد) علي يوم الخندق ضربة ما كان في الإسلام أعزَّ منها، ولقد ضُرب (بضم الضاد) علي (ع) ضربة ما ضرب في الإسلام أشأم منها «يعني ضربة ابن ملجم له».
أخباره في غزوة خيبر
كانت غزوة خيبر في جمادى الأولى أو المحرم سنة سبع من الهجرة وكان يهود خيبر مظاهرين لغطفان على رسول الله (ص) وكان المسلمون في هذه الغزوة ألفاً وأربعمائة أرسلهم النبي بقيادة رجل من المهاجرين، فرجع منهزماً، ثم أرسل رجلاً آخر من المهاجرين أيضاً فانهزم، فقال رسول الله لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراراً غير فرار يفتح الله على يديه. قال الطبري: إن أبا بكر أخذ راية المسلمين ثم نهض فقاتل قتالاً شديداً ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً هو أشد من القتال الأول ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله فقال: «والله لأعطينها غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» ولم يكن علي حاضراً، فتطاول الناس لها، ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك.
وجاء علي فأعطاه النبي الراية ووجهه إلى الحصن وخرج إليه أهل الحصن وكان أول من خرج إليه من داخل الحصن الحارث أخو مرحب وكان معروفاً بالشجاعة فثبت له وانهزم اليهود إلى الحصن ولما رأى مرحب أن أخاه قد قتل خرج سريعاً من الحصن في سلاحه فتلقاه علي فقتله وفي رواية «الخرائج» ما يدل على أن مرحباً هرب مع من هرب إلى الحصن لما حمل عليهم علي وأن قتله كان بعد فتح الحصن ولم يذكره غيره.
وفي السيرة الحلبية قال بعضهم: الأخبار متواترة بأن علياً هو الذي قتل مرحباً، به جزم مسلم في صحيحه، وقال ابن الأثير هو الصحيح الذي عليه أهل السير والحديث، وفي الاستيعاب أنه الذي عليه أكثر أهل السير والحديث، وقال الحاكم في المستدرك أن الأخبار متواترة بأسناد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اهــ. فلا يلتفت إلى الخبر الشاذ الذي رواه محمد بن إسحاق من أن قاتله محمد بن مسلمة ولكن الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد لم يذكر إلاَّ هذا الشاذ الذي وضعه أعداء علي وحاسدوه وأعرض عن الخبر المتواتر فلم يذكره أصلاً ولا أشار إليه ولا عجب فهذا ديدنه في كتاب من غمط علي حقه في كل مقام ما استطاع.
وكان اسم الحصن القموص وكان أعظم حصون خيبر وكان منيعاً وكان اليهود قد خندقوا على أنفسهم كأنهم تعلموا ذلك من يوم الأحزاب فإن الخنادق لم تكن معروفة عند العرب وتدل الروايات على أن علياً (ع) تترس بباب عظيم كان عند الحصن من خشب أو حديد لما سقط ترسه من يده وأنه قلع باب الحصن ودخله وهو أعظم من الباب الذي تترس به، روى ابن هشام عن أبي رافع مولى رسول الله: قال خرجنا مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله (ص) برايته فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهود فطاح ترسه من يده فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ. وفي السيرة الحلبية: فحمل مرحب على علي فضربه فطرح ترسه من يده فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده وراء ظهره. وهذا الباب غير باب الحصن بل هو باب أصغر منه كان ملقى عند الحصن فأخذه علي فتترس به ويوشك أن يكون وقع هنا اشتباه من صاحب السيرة الحلبية في قوله ثم ألقاه وراء ظهره لأن ذلك وارد في باب الحصن لا في الباب الذي تترس به فإن الروايات الآتية الواردة في قلع باب الحصن تدل على أنه رمى باب الحصن خلفه. أما ما جاء في باب الحصن ففي بعض الروايات أن علياً (ع) تترس به أيضاً وفي بعضها أنه جعله بعد الفتح جسراً وفي بعضها أنه دحا به خلفه أربعين ذراعاً. قال المفيد: لما قتل علي مرحباً رجع من كان مع مرحب وأغلقوا باب الحصن عليهم دونه فصار إلى الباب فعالجه حتى فتحه وأكثر الناس من جانب الخندق فأخذ علي (ع) باب الحصن فجعله على الخندق جسراً لهم حتى عبروا فظفروا بالحصن وغنموا الغنائم.
وهذا يدلنا على أن مرحباً كان قد خرج من الحصن ومعه جماعة ليقاتل وإذا كان الحصن حوله خندق كما مرَّ فلا بدَّ أن يكون مرحب ومن معه عبروا على جسر خشبي عند باب الحصن فوق الخندق كما هو الشأن في الخنادق التي حول الحصون والمدن فلما قتل مرحب وعاد من معه هاربين إلى الحصن عبروا على ذلك الجسر فيمكن أن يكونوا رفعوه لما دخلوا الحصن فأعاده علي ومن معه وعبروا عليه ويمكن أن يكون علي قد أعجلهم عن رفعه فعبر عليه هو ومن معه ومثل هذا الجسر يكون عادة صغيراً لا يكفي إلاَّ لعبور النفر القليل في دفعة واحدة فلذلك لما قلع باب الحصن جعله جسراً على الخندق ليعبر عليه أكثر من معه، الذين كانوا خارج الخندق ولم يعبر معه منهم إلاَّ القليل لضيق الطريق.
يوم الغميصاء
في شوال سنة ثمان من الهجرة مع بني خزيمة أو جذيمة بن عامر. في معجم البلدان: الغميصاء موضع قرب مكة كان يسكنه بنو جذيمة الذين أوقع بهم خالد بن الوليد. وحاصل القصة أن النبي بعد فتح مكة أنفذ خالد بن الوليد إلى بني خزيمة بن عامر وكانوا بالغميصاء يدعوهم إلى الإسلام ولم يرسله محارباً وأرسل معه عبد الرحمن بن عوف وكان بنو خزيمة مسلمين ولم يعلم رسول الله (ص) بإسلامهم وكانوا قد قتلوا في الجاهلية الفاكة بن المغيرة عم خالد بن الوليد وعوفاً أبا عبد الرحمن بن عوف فلمَّا رأوا خالداً أخذوا السلاح فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قال: فما بال السلاح؟ قالوا: خفنا أن تكونوا بعض من بيننا وبينهم عداوة من العرب. فقال ضعوا السلاح، فقال أحدهم: يا بني جذيمة إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلاَّ الأسار وما بعد الأسار إلاَّ ضرب الأعناق وأبى أن يضع سلاحه فما زالوا به حتى نزعوا سلاحه ونزعوا سلاحهم فأمر بهم خالداً فكتفوا ثم قتل من قتل، فقال له عبد الرحمن بن عوف. عملت بأمر الجاهلية في الإسلام، حتى كان بينهما شر. فلما بلغ ذلك رسول الله رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ثم دعا علي بن أبي طالب (ع) فقال: يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم فخرج حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله (ص) به فُودِيَ لهم الدماء وما أصيب من الأموال.
بعثه إلى اليمن
وذلك بعد فتح مكة، بعثه النبي إلى همدان ليدعوهم إلى الإسلام فأسلمت همدان كلها في يوم واحد. قال المفيد في الإرشاد: ومن ذلك ما أجمع عليه أهل السير أن النبي (ص) بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام وأنفذ معه جماعة من المسلمين فيهم البراء بن عازب وأقام خالد على القوم ستة أشهر يدعوهم فلم يجبه أحد منهم فساء ذلك رسول الله (ص) فدعا علياً وأمره أن يرجع خالداً ومن معه وقال له إن أراد أحد ممن مع خالد أن يبقى معك فاتركه. قال البراء فكنت ممن حمل معه فلما انتهينا إلى أوائل أهل اليمن وبلغ القوم الخبر تجمعوا له فصلَّى بنا علي الفجر ثم تقدم أمامنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله (ص) فأسلمت همدان كلها في يوم واحد وكتب بذلك علي إلى رسول الله (ص) ثم تتابع بعد إسلام همدان أهل اليمن كلهم على الإسلام.
أخباره في غزوة تبوك
وقد كانت هذه الغزوة في رجب سنة تسع من الهجرة وكان سببها أنه بلغ النبي أن الروم قد جمعوا جموعاً كثيرة في سورية وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء.
فهز النبي حملة لردهم وخرج بها، واستخلف علياً على المدينة لأنه خشي أن يغتنم بعض المنافقين غياب النبي والجيش فيقوموا بحركة على المدينة فأراد أن يتدارك ذلك بترك شخصية قوية تنوب عنه إذا حدثت أحداث غير متوقعة فاختار لهذه المهمة علياً.
بعثه بسورة براءة
في أول يوم من شهر ذي الحجة بعث النبي (ص) سورة براءة مع أبي بكر، ثم أرسل علياً حتى لحق أبا بكر فأخذها منه.
أخباره في معركة حنين
كانت وقعة حنين بعد فتح مكة. وحنين اسم واد قريب من مدينة الطائف كانت فيه المعركة، وذلك أنه لم يبق متمرداً على الدعوة الإسلامية إلاَّ قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف وبعض القبائل الصغيرة، فاجتمع هؤلاء كلهم واستعدوا لحرب محمد وجاؤوا حتى نزلوا وادي حنين وكانوا ثلاثين ألفاً بقيادة مالك بن عوف، فخرج النبي لصد هجومهم، وكانوا قد كمنوا في شعاب الوادي ومضائقه. فلما وصل المسلمون في أواخر الليل خرجوا عليهم من الكمائن وفاجأوهم بهجوم شديد غير منتظر فانهزم المسلمون ولم يثبت مع النبي إلاَّ عشرة أشخاص من أقربائه يقودهم علي بن أبي طالب ظلوا يحمونه ويدافعون عنه. ثم أرسل النبي من ينادي الناس للقتال. وأقبل حامل لواء المشركين «أبو جرول» والمشركون يتبعون لواءه الأسود فتلقاه علي فقتله وسقط اللواء إلى الأرض فكان ذلك بداية هزيمة المشركين.
يوم الغدير
حين رجع النبي (ص) من حجة الوداع وبلغ الموضع المعروف باسم «غدير خم» بين مكة والمدينة نزل هناك فخطب الناس وقال في خطبته:
«من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبَّ من أحبَّه وابغض من أبغضه وانصر من نصره، وأعن من أعانه، وأخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار».
ملتقى النفوس البشرية
في كل ناحية من نواحي النفوس البشرية ملتقى بسيرة علي بن أبي طالب.
لأن هذه السيرة تخاطب الإنسان حيثما اتجه إليه الخطاب البليغ من سير الأبطال والعظماء، وتثير فيه أقوى ما يثيره التاريخ البشري من ضروب العطف ومواقع العبرة والتأمل.
في سيرة علي ملتقى بالعاطفة المشبوبة والإحساس المتطلع إلى الرحمة والإكبار. لأنه الشهيد أبو الشهداء، يجري تاريخه وتاريخ أبنائه في سلسلة طويلة من مصارع الجهاد والهزيمة، ويتراءون للمتتبع من بعيد واحداً بعد واحد شيوخاً جللهم وقار الشيب ثم جللهم السيف الذي لا يرحم، أو فتياناً عوجلوا وهم في نضرة العمر يحال بينهم وبين متاع الحياة، بل يحال بينهم أحياناً وبين الزاد والماء، وهم على حياض المنية جياع ظماء.
وفي سيرة علي بن أبي طالب ملتقى الخيال حيث تحلق الشاعرية الإنسانية في الأجواء أو تغوص في الأغوار. فهو الشجاع الذي نزعت به الشاعرية الإنسانية منزع الحقيقة ومنزع التخيل، واشترك في تعظيمه شهود العيان وعشّاق الأعاجيب.
وتلتقي سيرته بالفكر كما تلتقي بالخيال والعاطفة، لأنه صاحب آراء في التصوف والشريعة والأخلاق سبقت جميع الآراء في الثقافة الإسلامية.
وللذوق الأدبي ـ أو الذوق الفني ـ ملتقى بسيرته كملتقى الفكر والخيال والعاطفة، لأنه كان أديباً بليغاً له نهج من الأدب والبلاغة يقتدي به المقتدون، وقسط من الذوق مطبوع يحمده المتذوقون، وإن تطاولت بينه وبينهم السنون. فهو الحكيم الأديب، والخطيب المبين، والمنشئ الذي يتصل إنشاؤه بالعربية ما اتصلت آيات الناثرين والناظمين.
وللنفس الإنسانية نواحيها الكثيرة غير نواحي العطف والتخيل والتفكير وتذوق الحسن الجميل من التعبير.
فمن نواحيها الكثيرة التي لم تنقطع قط في زمن من الأزمان، هي ناحية الخلاف بين الطبائع والأذهان، أو ناحية الخصومة الناشئة أبداً على رأي من الآراء، أو حق من الحقوق أو وطن من الأوطان.
فقد يفتر العقل والذوق بعض حين، وقد يفتر الخيال والعاطفة بعض حين، ولكن الذي لم يفتر قط ولا نخاله يفتر في حين من الأحايين خصام العقول وجدل الألسنة واختلاف المختلفين وتشيع المتشيعين.
وإن ها هنا للمجال الرغيب القريب في سيرة هذا الإمام الأوحد التي لا تشبهها سيرة في هذه الخاصة بين شتى الخواص، وهو قد قال في ذلك أوجز مقال حين قال:
«ليحبني أقوام حتى يدخلوا النار في حبي، ويبغضني أقوام حتى يدخلوا النار في بغضي» أو حين قال: «يهلك فيّ رجلان، محب مفرط بما ليس فيَّ، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني».
وصدق في غلو الطرفين من محبيه ومن مبغضيه، فقد بلغ من حب بعضهم إياه أن رفعوه إلى مرتبة الآلهة المعبودين، وبلغ من كراهة بعضهم إياه أن حكموا عليه بالمروق من الدين: هنا الغلاة يعبدونه وينهاهم عن عبادته فلا يطيعونه. ويستتيبهم فيصرون على ما هم فيه أي إصرار.
وهناك الخوارج يعلنون كفره ويطلبون منه التوبة إلى الله عن عصيانه … ويسبونه على المنابر كما سبه خصومه الأمويون الذين خالفوهم في العقيدة ووافقوهم على السباب ….
ميدان من ميادين الملاحاة لم يتسع ميدان متسعه في تواريخ الأبطال المعرضين للحب والبغضاء يقول أناس: هو الله. ويقول أناس: كافر مطرود من رحمة الله.
وناحية أخرى من نواحي النفس الكثيرة تلاقيها سيرة علي في أكثر من طريق: وتلك هي ناحية الشكوى والتمرد أو ناحية التوق إلى التجديد والإصلاح.
فلقد أصبح اسم علي علماً يلتف به كل مغصوب، وصيحة ينادي بها كل طالب إنصاف، وجعل الغاضبون على كل مجتمع باغ، وكل حكومة جائرة يلوذون بالدعوة العلوية كأنها الدعوة المرادفة لكلمة الإصلاح، أو كأنها المتنفس الذي يستروح إليه كل مكظوم … فمن نازع في رأي، ففي اسم علي شفاء لنوازع نفسه، ومن ثار على ضيم ففي اسم علي حافز لثورته ومرضاة لغضبه، ومن واجه التاريخ الإسلامي بالعقل أو بالذوق أو بالخيال أو بالعاطفة فهناك ملتقى بينه وبين علي في وجه من وجوهه، وعلى حالة من حالاته. وتلك هي المزية التي انفرد بها تاريخ علي بين تواريخ غيره، فأصبحت بينه وبين قلوب الناس وشائج تخلقها الطبيعة الآدمية إن قصر في خلقها التاريخ والمؤرخون.
صفاته
كان علي أول هاشمي من أبوين هاشميين. فاجتمعت له خلاصة الصفات التي اشتهرت بها هذه الأسرة الكريمة وتقاربت سماتها وملامحها في كثير من أعلامها المتقدمين، وهي في جملتها النبل والأيد والشجاعة والمودة والمروءة والذكاء، عدا المأثور في سماتها الجسدية التي تلاقت أو تقاربت في عدة من أولئك الأعلام.
وربما صحَّ من أوصاف علي في طفولته أنه كان طفلاً مبكر النماء سابقاً لأنداده في الفهم والقدرة، فكانت له مزايا التبكير في النماء كما كانت له أعباؤه ومتاعبه التي تلازم أكثر المبكرين في شيخوخة الآباء.
ونشأ رجلاً مكين البنيان في الشباب والكهولة، حافظاً لتكوينه المكين حتى ناهز الستين.
وتدل أخباره ـ كما تدل صفاته ـ على قوة جسدية بالغة في المكانة والصلابة على العوارض والآفات. فربما رفع الفارس بيده فجلد به الأرض غير جاهد ولا حافل ويمسك بذراع الرجل فكأنه أمسك بنَفَسه فلا يستطيع أن يتنفس، واشتهر عنه أنه لم يصارع أحداً إلاَّ صرعه، ولم يبارز أحداً إلاَّ قتله، وقد يزحزح الحجر الضخم لا يزحزحه إلاَّ رجال، ويحمل الباب الكبير يعيى بقلبه الأشداء.
وكان إلى قوته البالغة، شجاعاً لا ينهض له أحد في ميدان مناجرة، فكان لجرأته على الموت لا يهاب قرناً من الأقران بالغاً ما بلغ من الصورة وربهة الصيت، واجترأ وهو فتى ناشئ على عمرو بن عبد ود فارس الجزيرة العربية الذي كان يقوم بألف رجل عند أصحابه وعند أعدائه.
وقد ازدانت شجاعته بأجمل الصفات التي تزين شجاعة الشجعان الأقوياء … فلا يعرف الناس حلية للشجاعة أجمل من تلك الصفات التي طبع عليها علي بغير كلفة ولا مجاهدة رأي. وهي التورع عن البغي، والمروءة مع الخصم قوياً أو ضعيفاً على السواء، وسلامة الصدر من الضغن على العدو بعد الفراغ من القتال.
فمن تورّعه عن البغي، مع قوته البالغة وشجاعته النادرة، أنه لم يبدأ أحداً قط بقتال وله مندوحة عنه، وكان يقول لابنه الحسن: «لا تدعون إلى مبارزة. فإن دعيت إليها فأجب. فإن الداعي إليها باغ والباغي مصروع».
وعلم أن جنود الخوارج يفارقون عسكره ليحاربوه، وقيل له إنهم خارجون عليك فبادرهم قبل أن يبادروك، فقال: «لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسيفعلون».
وكذلك فعل قبل وقعة الجمل، وقبل وقعة صفين، وقبل كل وقعة صغرت أو كبرت ووضح فيها عداء العدو أو غمض، يدعوهم إلى السلم وينهي رجاله عن المبادأة بالشر، فما رفع يده بالسيف قط إلاَّ وقد بسطها قبل ذلك للسلام.
كان يعظ قوماً فبهرت عظته بعض الخوارج الذين يكفرونه فصاح معجباً إعجاب الكاره الذي لا يملك بغضه ولا إعجابه: «قاتله الله كافراً ما أفقهه» فوثب أتباعه فنهاهم عنه، وهو يقول: إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
وقد رأينا أنه كان يقول لعمرو بن عبد ود: إني لا أكره أن أهريق دمك …. ولكنه على هذا لم يرغب في إهراق دمه إلاَّ بعد يأس من إسلامه ومن تركه حرب المسلمين. فعرض عليه أن يكف عن القتال فأنف، وقال: إذن تتحدث العرب بفراري، وناشده: يا عمرو. إنك كنت تعاهد قومك ألاَّ يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلاَّ أخذت منه إحداهما. قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى الإسلام أو إلى القتال. قال: ولم يا ابن أخي؟… فوالله ما أحب أن أقتلك …. فلم يكن له بعد ذلك من إحدى اثنتين: أن يقتله أو يقتل على يديه.
وعلى ما كان بينه وبين معاوية وجنوده من اللدد في العداء لم يكن ينازلهم ولا يأخذ من ثاراته وثارات أصحابه عندهم إلاَّ بمقدار ما استحقوه في موقف الساعة: فاتفق في يوم صفين أن خرج من أصحاب معاوية رجل يسمى كريز بن الصباح الحميري فصاح بين الصفين: من يبارز؟ فخرج إليه رجل من أصحاب علي فقتله كريز ووقف عليه ونادى: من يبارز؟ فخرج إليه آخر فقتله وألقاه على الأول، ثم نادى ثالثة: من يبارز؟ فخرج إليه الثالث فصنع به صنيعه بصاحبيه، ثم نادى رابعة: من يبارز؟ فأحجم الناس ورجع من كان في الصف الأول إلى الصف الذي يليه، وخشي علي أن يشيع الرعب بين صفوفه فخرج إلى ذلك الرجل المدل بشجاعته وبأسه فصرعه ثم نادى نداءه حتى أتمَّ ثلاثة صنع بهم صنيعه بأصحابه، ثم رجع إلى مكانه.
أما مروءته في هذا الباب فكانت أندر بين ذوي المروءة من شجاعته بين الشجعان، فأبى على جنده وهم ناقمون أن يقتلوا مدبراً أو يجهزوا على جريح أو يكشفوا ستراً أو يأخذوا مالاً. وظفر بعد معركة الجمل بعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وهم ألدّ أعدائه المؤلبين عليه فعفا عنهم ولم يتعقبهم بسوء، وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر عليه من جيش ذي عدة فأعرض عنه وتركه ينجو بحياته حين كشف عن سوأته اتقاء لضربته … وحال جند معاوية بينه وبين الماء في معركة صفين وهم يقولون له: ولا قطرة حتى تموت عطشاً. فلما حمل عليهم وأجلاهم عنه سوغ لهم أن يشربوا منه كما يشرب جنده، وزار السيدة عائشة بعد وقعة الجمل فصاحت به صفية أم طلحة الطلحات: أيتم الله منك أولادك كما أيتمت أولادي. فلم يرد عليها. قال رجل أغضبه مقالها: يا أمير المؤمنين، أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟ فانتهره وهو يقول: ويحك، إنَّا أمرنا أن نكف عن النساء وهنَّ مشركات أفلا نكف عنهن وهن مسلمات؟…..
وإنه لفي طريقه إذ أخبره بعض أتباعه عن رجلين ينالان من عائشة فأمر بجلدهما مائة جلدة. ثم ودع السيدة عائشة أكرم وداع وسار في ركابها أميالاً وأرسل معها من يخدمها ويحف بها. قيل أنه أرسل معها عشرين امرأة من نساء عبد القيس عممهن بالعمائم، وقلَّدهن السيوف … فلما كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأففت وقالت: هتك ستري برجاله وجنده الذين وكلهم بي فلما وصلت إلى المدينة ألقى النساء عمائمهن وقلن لها: إنما نحن نسوة.
وكانت هذه المروءة سنته مع خصومه، ومن استحق منهم الكرامة ومن لم يستحقها، ومن كان في حرمة عائشة ومن لم تكن له قط حرمة، وهي أندر مروءة عرفت من مقاتل في وغر القتال.
وتعدلها في النبل والندرة سلامة صدره من الضغن على أعدى الناس له وأضرَّهم به وأشهرهم بالضغن عليه. فنهى أهله وأصحابه أن يمثلوا بقاتله وأن يقتلوا أحداً غيره، ورثى طلحة الذي خلع بيعته وجمع الجموع لحربه رثاء محزون يفيض كلامه بالألم والمودة، وأوصى أتباعه ألا يقاتلوا الخوارج الذين شقوا صفوفه وأفسدوا عليه أمره وكانوا شراً عليه من معاوية وجنده، لأنه رآهم مخلصين وإن كانوا مخطئين وعلى خطئهم مصرين.
وتقترن بالشجاعة ـ ولا سيما شجاعة الفرسان المقاتلين بأيديهم ـ صفة لازمة لها متممة لعملها قلما تنفصل عنها وكأنها والشجاعة أشبه شيء بالنضح للماء، أو بالإشعاع للنور، فلا تكون شجاعة الفروسية إلاَّ كانت معها تلك الصفة التي نشير إليها، وهي صفة «الثقة» أو الاعتزاز، أو الإدراع بالهيبة والتهويل على الخصوم ولا سيما في مواقف النزال.
وقد يسميها بعض الناس زهواً وليس هي به ولا هي من معدنه وسمته، وإن شابهته في بعض الملامح والألوان.
أما هذا الاعتزاز الذي نشير إليه، أو هذه الثقة التي تظهر لنا في صورة الاعتزاز فهي جزء من شجاعة الفارس المقاتل لا يستغني عنه ولا يزال متصلاً بعمله في مواجهة خصومه، وهو عرض للقوة يساعد الفارس في إرهاب عدوه وإضعاف عزيمة من يتصدى لحربه … مثله هنا كمثل العروض التي تعمد إليها الجيوش لإعلان بأسها وتخويف الأعداء من الاستخفاف بها والهجوم عليها. فهو كالشجاعة أداة ضرورية من أدوات القتال لا تنفصل عنها، وليس كل ما فيها ضرباً من الخيلاء يرضي به الشجاع غروره ويتيه به في غير حاجة إلى التيه.
ولهذا تحمس الناس للفخر العسكري من قديم الزمان وتحدثوا به وتناقلوه، فسمحوا للفارس ـ بل لعلهم أوجبوا عليه ـ أن يروغ من خصمه بالفخر المرعب إذ يتقدم لنزاله. وأن يلاقيه وهو ينشد الأشعار في ذكر وقعاته والتهويل بضرباته والإشادة بغزواته، وعلموا أنهم ـ وقد احتاجوا إلى شجاعته ـ محتاجون كذلك إلى فخره وحماسته وإيقاع الرعب في جنان قرنه، فشاعت قصائد الفخر والحماسة كما شاعت قصائد الحب والمناجاة، وهي أحب القصائد إلى القلوب.
هذه الصفة لازمة لفرسان الميدان ولا سيما فرسان العصور الأولى الذين يقفون للقتال وجهاً لوجه، وينظر أحدهم إلى قرنه وهو يهجم عليه، وكانت هذه الصفة من صفات علي يفهمها من يريد أن يفهم ولا يضيق صدراً بفضله، وينكرها من ينفس عليه فيسميها الزهو أو يسميها الجفوة والخيلاء.
مرَّ الزبير بن العوام مع رسول الله في بني غنم، فرأى رسول الله علياً على مقربة منه فضحك له رسول الله. فقال الزبير: لا يترك علي زهوه. فقال النبي: «إنه ليس به زهو، ولتقاتلنه وأنت له ظالم».
فليس هو بالزهو المكروه، ولكنها الشجاعة التي يمتلئ بها الشجاع والثقة التي تتراءى مكشوفة في صراحتها واستقامتها، لأن صاحبها لم يتكلف مداراتها ولم يحس أنه محتاج إلى مداراتها ولأنه هو لا يقصدها ولا يعتمد إبداءها.
وقد كان مدار هذا الخلق في علي ثقة أصيلة فيه لم تفارقه منذ حبا ودرج. وقبل أن يبلغ مبلغ الرجال فما منعته الطفولة الباكرة يوماً أن يعلم أنه شيء في هذه الدنيا وأنه قوة …. جوار يركن لها المستجير. ولقد كان في العاشرة أو نحوها يوم أحاط القوم القرشيون بالنبي عليه الصلاة والسلام ينذرونه وينكرونه وهو يقلب عينه في وجوههم ويسأل عن النصير ولا نصير … لو كان بعلي أن يرتاع في مقام نجدة أو مقام هزيمة لارتاع يومئذٍ بين أولئك الشيوخ الذين رفعتهم الوجاهة ودفعتهم آداب القبيلة البدوية إلى مقام الخشية والخشوع. ولكنه كان علياً في تلك السن الباكرة كما كان علياً وهو في الخمسين أو الستين … فما تردد وهم صامتون مستهزئون أن يصيح صيحة الواثق الغضوب أنا نصيرك. فضحكوا منه ضحك الجهل والاستكبار، وعلم القدر وحده في تلك اللحظة أن تأييد ذلك الغلام أعظم وأقوى من حرب أولئك القوم.
علي هذا هو الذي نام في فراش النبي ليلة الهجرة، وقد علم ما تأتمر به مكة كلها من قتل الراقد على ذلك الفراش.
وعلي هذا هو الذي تصدى لعمرو بن عبد ود مرة بعد مرة والنبي يجلسه ويحذره العاقبة التي حذرها فرسان العرب من غير تحذير، يقول النبي: إجلس. إنه عمرو. فيقول: وإذا كان عمرواً؟! كأنه لا يعرف أن يخاف ولا يعرف كيف يخاف ولا يعرف إلاَّ الشجاعة التي هو ممتلئ بها واثق فيها في غير كلفة ولا اكتراث.
وتمكنت هذه الثقة فيه لطول مراس الفروسية التي هي كما أسلفنا جزء منها وأداة من أدواتها.
وزادها تمكيناً حسد الحاسدين ولجاجة المنكرين، وكلاهما خليق أن يعتصم المرء منه بثقة لا تنخذل، وأنفة لا تلين. فمن شواهد هذه الثقة بنفسه أنه حملها من ميدان الشجاعة إلى ميدان العلم والرأي حين كان يقول: «اسألوني قبل أن تفقدوني».
ومن شواهدها أنه كان يقول والخارجون عليه يرمونه بالمروق: «ما أعرف أحداً من هذه الأمة عبد الله بعد نبينا غيري، عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة تسع سنين».
وزاده اتهام من حوله معتصماً بالثقة بنفسه، وأبدى هذه الخليقة منه أنه كان لا يتكلف ولا يحتال على أن يتألف. بل كان يقول: «شر الأخوان من تكلف له» ويقول: «إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه» فكان الذين ينتظرون منه الاصطناع والإرضاء يخطئون ما انتظروه، ولا سيما إذا هم انتظروه من أرزاق رعاياه وحقوقهم التي اؤتمن عليها، فيحسبون أنها الجفوة البينة وأنه الزهو المقصود وما هو بهذا ولا بتلك إنما هي شجاعة الفارس بلوازمها التي لا تنفصل منها، وإنما هو امتعاض المغموط المسيء ظناً بمن حوله يتراءى على سجيته في غير مداراة ولا رياء. فما كان يتكلف إظهار تلك الخلائق زهواً كما يسمونه أو جفوة كما يحسبونها، بل كان قصاراه ألاَّ يتكلف الإخفاء.
نعم كان ملاك الأمر في أخلاق علي، أنه كان لا يتكلف إظهار شيء ولا يتكلف إخفاء شيء ولا يقبل التكلف حتى من مادحيه، فربما أفرط الرجل في الثناء عليه وهو متهم عنده حتى يعلن له طويته ويقول هل: «إنَّا دون ما تقول وفوق ما في نفسك».
وكانت قلَّة التكلف هذه توافق منه خليقته الكبرى من الشجاعة والبأس والامتلاء بالثقة والمنعة. وكانت تسلك معه مسلك الحقيقة والمجاز على السواء. كأنه يعني ما صنع وهو لا يعنيه وإنما يجيء منه على البديهة كما تجيء الأشياء من معادنها: كان مثلاً يخرج إلى مبارزيه حاسر الرأس ومبارزوه مقنعون بالحديد. أفعجيب منه أن يخرج إليهم حاسر النفس وهم مقنعون بالحيلة والرياء؟ وكان يغفل الخضاب أحياناً ويرسل الشيب ناصعاً وهو لا يحرم خضابه في غير ذلك من الأحيان. أفعجيب منه، مع هذا، أن يقل اكتراثه لكل خضاب ساتراً ما ستر، أو كاشفاً ما كشف من رأي وخليقة.
بل كانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقة أخرى كالشجاعة في قوتها ورسوخها. وهي قريبة للشجاعة في نفس الفارس وقلَّما تفارقها. ونعني بها خليقة الصدق الصراح الذي يجترئ الرجل به على الضر والبلاء كما يجترئ به على المنفعة والنعماء. فما استطاع أحد قط أن يحصي عليه كلمة خالف فيها الحق الصراح في سلمه وحربه، وبين صحبه أو بين أعدائه، ولعلَّه كان أحوج إلى المصانعة بين النصراء مما كان بين الأعداء، لأنهم أرهقوه باللجاجة. واعنتوه بالخلاف. فما عدا معهم قول الصدق في شدة ولا رخاء، وكان أبداً عند قوله: «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك».
وصدق في تقواه وإيمانه كما صدق في عمل يمينه ومقالة لسانه، فلم يعرف أحد من الخلفاء أزهد منه في لذة الدنيا أو سيب الدولة وكان وهو أمير المؤمنين يأكل الشعير وتطحنه امرأته بيديها، قال عمر بن عبد العزيز وهو من أسرة أموية تبغض علياً وتخلق له السيئات وتخفي ما توافر له من الحسنات: «أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب». وقال سفيان: «إن علياً لم يبن آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة» وقد أبى أن ينزل القصر الأبيض بالكوفة إيثاراً للخصائص التي يسكنها الفقراء. وعلى هذا الزهد كان على أبعد الناس من كزازة طبع وضيق حظيرة وجفاء عشرة، بل كانت فيه سماحة يتبسط فيها حتى يقال دعابة، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال له: «لله أبوك لولا دعابة فيك» وأنه قال لمن سألوه في الاستخلاف: «وإن ولي علي ففيه دعابة».
وأغرق عمرو بن العاص في وصف الدعابة فسماها «دعابة شديدة» وطفق يرددها بين أهل الشام ليقدح بها في صلاح علي للخلافة، وإنما نقول أن عمرو بن العاص أغرق في هذا الوصف، وأن الدعابة المعيبة لم تكن قط من صفات علي لأن تاريخ علي وأقواله ونوادره مع صحبه وأعدائه محفوظة لدينا لا نرى فيها دليلاً على خلق الدعابة فضلاً عن الدليل على الإفراط فيه. فإن كان لهذا الوصف أثر فربما كان مرجع ذلك أن علياً خلا من الشغل الشاغل سنين عدة، فأعفاه الشغل الشاغل من صرامته وأسلمه حيناً إلى سماحته وأحاديث صحبه ومريديه فحسبت هذه الدعة من الدعابة البريئة ثم بالغ فيها المبالغون، ولم يثبتوها بقصة واحدة أو شاردة واحدة تجيز لهم ما تقولوه.
وقد كانت لعلي صفات ومزايا فكرية تناصي المشهور المتفق عليه من صفاته النفسية ومزاياه الخلقية، فاتفق خصومه وأنصاره على بلاغته واتفقوا على علمه وفطنته، وتفرقوا فيما عدا ذلك من رأيه في علاج الأمور ودهائه في سياسة الرجال.
والحق الذي لا مراء فيه أن علياً كان صاحب الفطنة النافذة، وأنه أشار على عمر وعثمان أحسن المشورة في مشكلات الحكم والقضاء، وكان يفهم أخلاق الناس فهم العالم المراقب لخفايا الصدور ويشرحها في عظاته وخطبه شرح الأريب اللبيب.
إلى هنا متفق عليه لا يكثر في الخلاف، ثم يفترق الناس في رأيه رأيين، فيقول أناس أنه كان على قسط وافر من الفهم والمشورة، ولكنه عند العمل لا يرى ما تقضي به الساعة الحازبة ولا ينتفع بما يراه. ويقول أناس بل هو الاضطرار والتحرج يقيدانه ولا يقيدان أعداءه وإنهم لدونه في الفطنة والسداد. وهو قد اعتذر لنفسه بما شابه من هذا العذر حين قال: «والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس».
ولكننا نستطيع أن نجزم هنا بحقيقتين لا نحسبهما تتسعان لجدال طويل، وهما أن أحداً لم يثبت قط أن العمل بالآراء الأخرى كان أجدى وأنجع في فض المشكلات من العمل برأي علي، وإن أحداً لم يثبت قط أن خصوم علي كانوا يصرفون الأمور خيراً من تصريفه، لو وضعوا في موضعه واصطلحت عليهم المتاعب التي اصطلحت عليه.
هذه صفات تنتظم في نسق موصول: رجل شجاع لأنه قوي. وصادق لأنه شجاع، وزاهد مستقيم لأنه صادق ومثار للخلاف لأن الصدق لا يدور بصاحبه مع الرضا والسخط والقبول والنفور، وأصدق الشهادات لهذا الرجل الصادق أن الناس قد أثبتوا له في حياته أجمل صفاته المثلى، فلم يختلفوا على شيء منها إلاَّ الذي اصطدم بالمطامع وتفرقت حوله الشبهات، وما من رجل تتعسف المطامع أسباب الطعن فيه ثم تنفذ منه إلى صميم.
مفتاح شخصيته
«آداب الفروسية» هي مفتاح هذه الشخصية النبيلة الذي يفضي منها كل مغلق ويفسر منها كل ما احتاج إلى تفسير.
وآداب الفروسية هي تلك الآداب التي نلخصها في كلمة واحدة «النخوة» ….
وقد كانت النخوة طبعاً في علي فطر عليه، وأدباً من آداب الأسرة الهاشمية نشأ فيه، وعادة من عادات الفروسية العملية التي يتعودها كل فارس شجاع متغلب على الأقران، وإن لم يطبع عليها وينشأ في حجرها. لأن الغلبة في الشجاع أنفة تأبى عليه أن يسف إلى ما يخجله ويشينه ولا تزال به حتى تعلمه النخوة تعلماً، وتمنعه أن يعمل في السر ما يزري به في العلانية.
وهكذا كان علي في جميع أحواله وأعماله: بلغت به نخوة الفروسية غايتها المثلى، ولا سيما في معاملة الضعفاء من الرجال والنساء. فلم ينس الشرف قط ليغتنم الفرصة، ولم يساوره الريب قط في الشرف والحق أنهما قائمان كأنهما مودعان في طبائع الأشياء. فإذا صنع ما وجب عليه، فلينس من شاء ما وجب عليهم، وإن أفادوا كثيراً وباء هو بالخسارة.
أصاب المقتل من عدوه مرات فلم يهتبل الفرصة السانحة بين يديه، لأنه أراد أن يغلب عدوه غلبة الرجل الشجاع الشريف، ولم يرد أن يغلبه أو يقتص منه كيفما كان سبيل الغلب والقصاص.
قال بعض من شهدوا معركة صفين: لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفين وجدناهم قد نزلوا منزلاً اختاروه مستوياً بساطاً واسعاً وأخذوا الشريعة ـ أي مورد الماء ـ فهي في أيديهم، وقد أجمعوا على أن يمنعونا الماء. ففزعنا إلى أمير المؤمنين فخبرناه بذلك فدعا صعصعة بن صوحان فقال له: ائت معاوية وقل له إنَّا سرنا مسيرنا إليكم ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم، وإنك قدمت إلينا خيلك ورجلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك، ونحن من رأينا الكف عنك حتى ندعوك ونحتج عليك وهذه أخرى قد فعلتموها إذا حلتم بين الناس وبين الماء. والناس غير منتهين أو يشربوا فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء ويكفوا ثم ننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له وقدمتم له».
ثم قال راوي الخبر ما معناه أن معاوية سأل أصحابه فأشاروا عليه أن يحول بين علي وبين المورد غير حافل بدعوته إلى السلم، ولا بدعوته إلى المفاوضة في أمر الخلاف، فأنفذ معاوية مدداً إلى حراس المورد يحمونه ويصدون من يقترب منه، ثم كان بين العسكرين تراشق بالنبل فطعن بالرماح وضرب بالسيوف حتى اقتحم أصحاب علي طريق الماء وملكوه.
وهنا الفرصة الكبرى لو شاء علي أن يهتبلها، وأن يغلب أعداءه بالضمأ كما أرادوا أن يغلبوه قبل ساعة … وقد جاء أصحابه يقولون: والله لا نسقيهم. فكأنما كان هو سفير معاوية وجنده إليهم يتشفع لهم ويستلين قلوبهم من أجلهم. وصاح بهم: «خذوا من الماء حاجتكم وارجعوا إلى عسكركم وخلوا عنهم، فإن الله عزَّ وجلَّ قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم».
ولاحت له فرصة قبل هذه الفرصة في حرب أهل البصرة، فأبى أن يهتبلها وأغضب أعوانه إنصافاً لأعدائه، لأنه نهاهم أن يسلبوا المال ويستبيحوا السبي وهو في رأيهم حلال. وقالوا: أتراه يحل لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم؟ فقال: «إنما القوم أمثالكم، من صفح عنا فهو منا ونحن منه، ومن لج حتى يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر».
وسنَّ لهم سنَّة الفروسية أو سنة النخوة حين أوصاهم ألاَّ يقتلوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح ولا يكشفوا ستراً ولا يمدوا يداً إلى مال.
ومن الفرص التي أبت عليه النخوة أن يهتبلها فرصة عمرو بن العاص وهو ملقى على الأرض مكشوف السوأة لا يبالي أن يدفع عنه الموت بما حضره من وقاء، فصدف بوجهه عنه آنفاً أن يصرع رجلاً يخاف الموت هذه المخافة التي لا يرضاها من منازله في مجال صراع. ولو غير علي أُتيح له أن يقضي على عمرو لعلم أنه قاض على جرثومة عداء ودهاء فلم يبال أن يصيبه حيث ظفر به.
لقد كان رضاه من الآداب في الحرب والسلم رضا الفروسية العزيزة من جميع آدابها ومأثوراتها، فكان يعرف العدو عدواً حيثما رفع السيف لقتاله … ولكنه لا يعادي امرأة ولا رجلاً مولياً ولا جريحاً عاجزاً عن نضال ولا ميتاً ذهبت حياته ولو ذهبت في سبيل حربه. بل لعله يذكر ماضيه يومئذٍ فيقف على قبره ليبكيه ويرثيه ويصلي عليه.
وهذه الفروسية هي التي بغضت إليه أن ينال أعداءه بالسباب وليس من أدب الفارس أن ينال أعداءه بغير الحسام.
فلما سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حروبهم بصفين قال لهم: «إني أكره أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب إلى القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لجَّ به».
إسلامه
ولد علي في داخل الكعبة، وكرم الله وجهه عن السجود لأصنامها، فكأنما كان ميلاده ثمة إيذاناً بعهد جديد للكعبة وللعبادة فيها.
وكاد علي أن يولد مسلماً ….
بل لقد ولد مسلماً على التحقيق إذا نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح، لأنه فتح عينيه على الإسلام، ولم يعرف قط عبادة الأصنام، فهو قد تربى في البيت الذي خرجت منه الدعوة الإسلامية وعرف العبادة من صلاة النبي وزوجه الطاهرة قبل أن يعرفها من صلاة أبيه وأمه، وجمعت بينه وبين صاحب الدعوة قرابة مضاعفة ومحبة أوثق من محبة القرابة. فكان ابن عم محمد وربيبه الذي نشأ في بيته ونعم بعطفه وبره …. وقد رأينا الغرباء يحبون محمداً ويؤثرونه على آبائهم وذويهم. فلا جرم يحبه هذا الحب من يجمعه به جد، ويجمعه به بيت، ويجمعه به جميل ومعروف: جميل أبي طالب يؤديه محمد وجميل محمد يحسه ابن أبي طالب ويأوي إليه …
وملأ الدين قلباً لم ينازعه فيه منازع من عقيدة سابقة ولم يخالطه شوب يكدر صفاءه ويرجع به إلى بقاياه … فبحق ما يقال إن علياً كان المسلم الخالص على سجيته المثلى، وإن الدين الجديد لم يعرف قط أصدق إسلاماً منه ولا أعمق نفاذاً فيه.
كان المسلم حق المسلم في عبادته، وفي عمله وعلمه، وفي قلبه وعقله، حتى ليصح أن يقال أنه طبع على الإسلام فلم تزده المعرفة إلاَّ ما يزيده التعليم على الطباع.
كان عابداً يشتهي العبادة كأنها رياضة تريحه وليست أمراً مكتوباً عليه.
وكان على محجة في الإسلام لا يحيد عنها لبغية ولا لخشية. وآثر الخير كما يراه على الخير كما يراه الناس.
وكان دينه له ولعدو دينه، فما كان الحق عنده لمن يرضاه دون من يقلاه، ولكنه كان الحق لكل من استحقه وإن بهته وآذاه ….
وجد درعه عند رجل نصراني فأقبل به إلى شريح ـ قاضيه ـ يخاصمه مخاصمة رجل من عامة رعاياه، وقال: إنها درعي ولم أبع ولم أهب، فسأل شريح النصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟…. قال النصراني: ما الدرع إلاَّ درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب، فالتفت شريح إلى علي يسأله: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟…. فضحك علي وقال: أصاب شريح. ما لي بينة. فقضى بالدرع للنصراني فأخذها ومشى وأمير المؤمنين ينظر إليه … إلا أن النصراني لم يخط خطوات حتى عاد يقول: أما أنا فاشهد أن هذه أحكام أنبياء … أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه يقضي عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين. اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. فقال: أما إذا أسلمت فهي لك. وشهد الناس هذا الرجل بعد ذلك وهو من أصدق الجند بلاء في قتال الخوارج يوم النهروان …
وأحسن الإسلام علماً وفقهاً كما أحسنه عبادة وعملاً. فكانت فتاواه مرجعاً للخلفاء والصحابة في عهود أبي بكر وعثمان وعمر. وندرت مسألة من مسائل الشريعة لم يكن له رأي فيها يؤخذ به أو تنهض له الحجة بين أفضل الآراء.
إلاَّ أن المزية التي امتاز بها علي بين فقهاء الإسلام في عصره أنه جعل الدين موضوعاً من موضوعات التفكير والتأمل ولم يقصره على العبادة وإجراء الأحكام، فإذا عرف في عصره أناس تفقهوا في الدين ليصححوا عباداته ويستنبطوا منه أقضيته وأحكامه، فقد امتاز علي بالفقه الذي يراد به الفكر المحض والدراسة الخالصة، وأمعن فيه ليغوص في أعماقه على الحقيقة العلمية، أو الحقيقة الفلسفية كما نسميها في هذه الأيام.
سياسته
تسري في صفحات التاريخ أحكام مرتجلة يتلقفها من فم إلى فم، ويتوارثها جيل عن جيل، ويتخذها السامعون قضية مسلمة، مفروغاً من بحثها والاستدلال عليها، وهي في الواقع لم تعرض قط على البحث والاستدلال. ولم تجاوز أن تكون شبهة وافقت ظواهر الأحوال، ثم صقلتها الألسنة فعزَّ عليها بعد صقلها أن تردها إلى الهجر والإهمال.
من تلك الأحكام المرتجلة قولهم أن علياً بن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بخدع الحرب والسياسة.
وعزز القول به أنه خالف الدهاة من العرب فيما أشاروا به عليه، وأنه لم ينجح بعد هذه المخالفة في معظم مساعيه، فكان من الطبيعي أن يقال أنه مني بالفشل لأنه عمل بغير ما أشار به أصحاب الدهاء والخدع الناجحة في الحرب أو السياسة.
وقد يكون كذلك أو لا يكون، فسنرى بعد البحث في آرائه وآراء المشيرين عليه أي هذين القولين أدنى إلى الصواب.
ولكن هل خطر لأحد من ناقديه، في عصره أو بعد عصره، أن يسأل نفسه: أكان في وسع علي أن يصنع غير ما صنع؟
وهل خطر لأحد منهم أن يسأل بعد ذلك: هبه استطاع أن يصنع غير ما صنع فما هي العاقبة؟…. وهل من المحقق أنه كان يفضي بصنيعه إلى عاقبة أسلم من العاقبة التي صار إليها؟….
لم نعرف أحداً من ناقديه، خطر له أن يسأل عن هذا أو ذاك …. إن السؤال عن هذا أو ذاك هو السبيل الوحيد إلى تحقيق الصواب والخطأ في رأيه ورأي مخالفيه، سواء كانوا من الدهاة أو غير الدهاة…..
والذي يبدو لنا نحن من تقدير العواقب على وجوهها المختلفة أن العمل بغير الرأي الذي سبق إليه لم يكن مضمون النجاح ولا كان مأمون الخطر، بل وربما كان الأمل في نجاحه أضعف والخطر من أتباعه أعظم، لو أنه وضع في موضع العمل والإنجاز وخرج من حيز النصح والمشورة.
وهذه هي المسائل التي خالفه فيها الدهاة، أو خالفه فيها نقدة التاريخ الذين نظروا إليها من الشاطئ، ولم ينظروا إليها نظرة الربَّان في غمرة العواصف والأمواج.
فالمآخذ التي هي من هذا القبيل، يمكن أن تنحصر في المسائل التالية وهي:
1 ـ عزل معاوية.
2 ـ معاملة طلحة والزبير.
3 ـ عزل قيس بن سعد من ولاية مصر.
4 ـ تسليم قتلة عثمان.
5 ـ قبول التحكيم.
وهي كلها قابلة على الأقل للخلاف والاحتجاج من كلا الطرفين، فإن لم يكن خلاف وكان جزم قاطع … فهو على ما نعتقد أقرب إلى رأي علي وأبعد من آراء مخالفيه وناقديه.
قيل في مسألة معاوية أن علياً خالف فيها رأي المغيرة وابن عباس وزياد بن حنظلة التميمي وهم جميعاً من المشهورين بالحنكة وحسن التدبير.
تلك آراء المشيرين من ذوي الحنكة، وذلك ما عمل به الإمام وارتضاه، فأيهما على خطأ وأيهما على صواب؟.
سبيل العلم بذلك أن نعلم أولاً: هل كان الإمام مستطيعاً أن يقر معاوية في عمله بالشام؟.
وأن نعلم بعد هذا: هل كان إقراره أدنى إلى السلامة والوفاق لو أنه استطاع؟.
وعندنا أن الإمام لم يكن مستطيعاً أن يقر معاوية في عمله لسببين: أولهما: أنه أشار على عثمان بعزله أكثر من مرة، وكان إقراره وإقرار أمثاله من الولاة المستغلين أهم المآخذ على حكومة عثمان.
فإذا أقرَّه وقد ولي الخلافة، فكيف يقع هذا الإقرار عند أشياعه؟ ألا يقولون إنه طالب حكم لا يعنيه إذا وصل إلى بغيته ما كان يقول وما سيقوله للناس؟.
وإذا هو أعرض عن رأيه الأول، فهل في وسعه أن يعرض عن آراء الثائرين الذين بايعوه بالخلافة لتغيير الحال والخروج من حكم عثمان إلى حكم جديد؟…
فكيف تراهم يهدأون ويطيعون إذا علموا أن الولايات باقية على حالها، وإن الاستغلال الذي شكوا منه وسخطوا عليه لا تبديل فيه؟.
وندع هذا ونزعم أن إقرار معاوية بحيلة من الحيل مستطاع … فهل هو على هذا الزعم أسلم وأدنى إلى الوفاق؟.
كلا على الأرجح، بل على الرجحان الذي هو في حكم التحقيق. لأن معاوية لم يعمل في الشام عمل والٍ طوال حياته، ويقنع بهذا المنصب ثم لا يتطاول إلى ما وراءه. لكنه عمل فيها عمل صاحب الدولة التي يؤسسها ويدعمها له ولأبنائه من بعده … فجمع الأقطاب من حوله، واشترى الأنصار بكل ثمن في يديه، وأحاط نفسه بالقوة والثروة، واستعدَّ للبقاء الطويل، واغتنام الفرصة في حينها، فأي فرصه هو واجدها خير من مقتل عثمان والمطالبة بثأره؟
وإنما كان مقتل عثمان فرصة لا يضيعها، وإلاَّ ضاع منه الملك وتعرض يوماً من الأيام لضياع الولاية. وما كان مثل معاوية بالذي يفوته الخطر من عزله بعد استقرار الأمور، ولو على احتمال بعيد … فماذا تراه صانعاً إذا هو عزل بعد عام من مبايعته لعلي وتبرئته إياه من دم عثمان؟.
إنما كان مقتل عثمان فرصة لغرض لا يقبل التأخير.
وإذا كان هذا موقف علي ومعاوية عند مقتل عثمان، فماذا كان علي مستفيداً من إقراره في عمله وتعريض نفسه لغضب أنصاره.
لقد كان معاوية أحرى أن يستفيد بهذا من علي، لأنه كان يغنم به حسن الشهادة له وتزكية عمله في الولاية، وكان يغنم أن يفسد الأمر على علي بين أنصاره، فتعلو حجته من حيث تسقط حجة علي.
وأصدق ما يقال بعد عرض الموقف على هذا الوجه من ناحيتيه أن صواب علي في مسألة معاوية كان أرجح من صواب مخالفيه … فإن لم تؤمن بهذا على التقدير والترجيح فأقل ما يقال أن الصواب عنده وعندهم سواء.
والتقدير في مسألة طلحة والزبير أيسر من التقدير في مسألة معاوية، لأن الرأي الذي عمل به علي معروف، والآراء التي تخالفه لا تعدو واحداً من ثلاثة، كلها أغمض عاقبة، وأقل سلامة، وأضعف ضماناً من رأيه الذي ارتضاه.
فالرأي الأول أن يوليهما العراق واليمن أو البصرة والكوفة، وكان عبد الله بن عباس على هذا الرأي فأنكره الإمام لأن البصرة والكوفة بهما الرجال والأموال، ومتى تملَّكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع ويضربان الضعيف بالبلاء، ويقويان على القوي بالسلطان، ثم ينقلبان عليه أقوى مما كانا بغير ولاية، وقد استفادا من إقامة الإمام لهما في الولاية تزكية يلزمانه بها الحجة، ويثيران بها أنصاره عليه.
والرأي الثاني أن يوقع بهما ليفترقا ولا يتفقا على عمل، وهو لا ينجح في الوقيعة بينهما إلاَّ بإعطاء أحدهما وحرمان الآخر، فمن أعطاه لا يضمن انقلابه مع الغرة السانحة، ومن حرمه لا يأمن أن يهرب إلى الأثرة كما هرب غيره، فيذهب إلى الشام ليساوم معاوية، أو يبقى في المدينة على ضغينة مستورة.
على أنهما لم يكونا قط متفقين حتى في مسيرهما من مكة إلى البصرة، فوقع الخلاف في عسكرهما على من يصلي بالناس، ولولا سعي السيدة عائشة بالتوفيق بين المختلفين لافترقا من الطريق خصمين متناقضين.
ولم تطل المحنة بهما متفقين أو مختلفين، فانهزما بعد أيام قليلة وخرج علي من حربهما أقوى وأمنع مما كان قبل هذه الفتنة، ولو بقيا على السلم المدخول لما انتفع بهما بعض انتفاعه بهذه الهزيمة العاجلة.
والرأي الثالث أن يعتقلهما أسيرين، ولا يبيح لهما الخروج من المدينة إلى مكة حين سألاه الإذن بالمسير إليها، ثم خرجا منها إلى البصرة ليشنَّا الغارة عليه ….
والواقع أن علياً قد استراب بما نوياه حين سألاه الإِذن بالسفر إلى مكة … فقال لهما: «ما العمرة تريدان، وإنما تريدان الغدرة».
ولكنه لم يحبسهما، لأن حبسهما لن يغنيه عن حبس غيرهما من المشكوك فيهم، وقد تركه عبد الله بن عمر ولم يستأذنه في السفر، وتسلل إلى الشام أناس من مكة ومن المدينة ولا عائق لهم أن يتسللوا حيث شاؤوا، ولو أراد حبسهم جميعاً لما تسنى له ذلك بغير سلطان قاهر، وهو في ابتداء حكمه لما يظفر بشيء من ذلك السلطان، وأغلب الظن أن سواد الناس كانوا يعطفون عليهم وينقمون حبسهم قبل أن تثبت له البينة بوزرهم. وما أكثر المتحرجين في عسكر الإمام علي من حبس الأبرياء بغير برهان؟. لقد كان هؤلاء خلقاء أن ينصروهم عليه وقد كانوا ينصرونه عليهم، وخير له مع طلحة والزبير أن يعلنوا عصيانهم فيغلبهم من أن يكتموه فيغلبوه ويشككوا بعض أنصاره في عدله وحسن مجاملته معهم. وعلى هذا كله، حاسنوه ولم يصارحوه بعداء.
لم يكن الجيش الذي خرج من مكة إلى البصرة بيائس من الخروج إليها إذا لم يصحبه طلحة والزبير فقد كانت «العثمانية» في مكة حزباً موفور العدد والمال … فهي مسألة تلتبس فيها الطرائق، ولا يسعنا أن نجزم بطريقة منها أسلم ولا أضمن عاقبة من الطريقة التي سلكها علي وخرج منها غالباً على الحجاز والعراق، وما كان وشيكاً أن يغلب عليهما لو بقي معه طلحة والزبير على فرض من جميع الفروض التي قدمناها.
أما عزل قيس بن سعد من ولاية مصر مع أن قيساً بن سعد كان أقدر أصحابه على ولاية مصر وحمايتها، وكان كفؤاً لمعاوية وعمرو بن العاص في الدهاء والمداورة، فعزله علي لأنه شك فيه، وشك فيه لأن معاوية أشاع مدحه بين أهل الشام، وزعم أنه من حزبه والمؤتمرين في السر بأمره.
وكان أصحاب علي يحرضونه على عزله، وهو يستمهلهم ويراجع رأيه فيه حتى اجتمعت الشبهات لديه. فعزله وهو غير واثق من التهمة ولكنه كذلك غير واثق من البراءة.
وشبهاته مع ذلك لم تكن بالقليل ولا بالضعيفة، فإن قيساً بن سعد لم يدخل مصر إلاَّ بعد أن مرَّ بجماعة من حزب معاوية، فأجازوه ولم يحاربوه وهو في سبعة رجال لا يحمونه من بطشهم، فحسبوه حين أجازوه من العثمانية الهاربين إلى مصر من دولة علي في الحجاز.
ولما بايع المصريون علياً على يديه، بقي العثمانيون لا يبايعون ولا يثورون، وقالوا له: «أمهلنا حتى يتبين لنا الأمر» فأمهلهم وتكرهم وادعين حيث طاب لهم المقام بجواب الإسكندرية.
ثم أغراه معاوية بمناصرته والخروج على علي، فكتب إليه قيس كلاماً لا إلى الرفض ولا إلى القبول، ويصح لمن سمعه بهذا الكلام أن يحسبه مراوغاً لمعاوية أو يحسبه مترقباً لساعة الفصل بين الخصمين إذ كان ختام كتابه إلى معاوية: «أما متابعتك فانظر فيها، وليس هذا مما يسرع إليه وأنا كاف عنك فلا يأتيك شيء من قبلي تكرهه، حتى نرى وترى».
وأراد علي أن يستيقن من الخصومة بين معاوية وقيس، فأمر قيساً أن يحارب المتخلفين عن البيعة … فلم يفعل وكتب إليه: «متى قاتلناهم ساعدوا عليك عدوك، وهم الآن معتزلون والرأي تركهم».
فتعاظم شك علي وأصحابه، وكثر المشيرون عليه بعزل قيس واستقدامه إلى المدينة …. فعزله واستقدمه، وتبيَّن بعد ذلك أنه أشار بالرأي والصواب، وإن ترك المتخلفين عن البيعة في عزلتهم خير من التعجيل بحربهم، لأنهم هزموا محمداً بن أبي بكر والي مصر الجديد، وجرَّأوا عليه من كان يصانعه ويواليه.
ولكننا نبالغ على كل حال، إذا علقنا على هذا التصرف الجرائر التي أصابت علياً من بعدها.
ومن عجائب هذه القصة أن معاوية ندم على تقريب قيس من جوار علي، وقال: «لو أمددته بمائة ألف كانوا أهون علي من قيس» لأنه قد ينفعه وهو قريب منه في عامة أموره ولا ينحصر نفعه له في سياسة مصر وحدها.
ثم تأتي مسألة القصاص من قتلة عثمان التي كانت أطول المسائل جدلاً بين علي وخصومه، فإذا هي أقصرها جدلاً مع براءة المقصد من الهوى وخلوص الرغبة في الحقيقة.
فقد طالبوه بالعقوبة ولم يبايعوه، مع أن العقوبة لا تكون إلاَّ من ولي الأمر المعترف له بإقامة الحدود.
وطالبوه به ولم يعرفوا من القتلة، ومن هم الذين يؤخذ بدم عثمان منهم من القبائل أو الأفراد.
وأعنتوه بهذا الطلب لأنهم علموا أنه لا يستطاع قبل أن تثوب السكينة إلى عاصمة الدولة، واعفوا أنفسهم منه ـ وهم ولاة الدم كما يقولون ـ يوم قبضوا على عنان الحكم وثابت السكينة إلى جميع الأمصار.
وقد تحدث علي مرة في أمر العقوبة من قتلة عثمان، فإذا بجيش يبلغ عشرة آلاف يشرعون الرماح ويجهرون بأنهم «كلهم قتلة عثمان» فمن شاء العقوبة فليطبقها عليهم جميعاً.
ولو أن المطالبين بدم عثمان التمسوا أقرب الطرق إلى الثأر له، والقصاص من العادين عليه، لقد كان هذا أقرب الطرق إلى ما أرادوا … يؤيدون ولي الأمر حتى يقوى على إقامة الحدود، ثم يحاسبونه بحكم الشريعة حساب إنصاف ….
أما الذين لاموه لقبوله التحكيم، فيخيل إلينا من عجلتهم إلى اللوم أنهم كانوا أول من يلومه ويفرط في لومه لو أنه رفض التحكيم وأصرَّ على رفضه، لأنه لم يقبل التحكيم وله مندوحة عنه ولكنه قبله بعد إحجام جنوده عن الحرب، ووشك القتال في عسكرهم خلافاً بين من يقبلونه ويرفضونه.
وقبله بعد أن حجز الحفاظ والقراء نيفاً وثمانين فزعة للقتال لشكهم في وجوب القتال وذهاب البعض إلى تحريمه.
وبعد أن توعدوه بقتله كقتل عثمان، وأحاطوا به يلحون عليه في استدعاء الأشتر النخعي الذي كان يلاحق أعداءه مستحصداً في ساحة الحرب على أمل النصر القريب.
والمؤرخون الذين صوبوا رأيه في التحكيم وخطئوه في قبول أبي موسى الأشعري، على علمه بضعفه وتردده، ينسون أن أبا موسى كان مفروضاً عليه، كما فرض عليه التحكيم في لحظة واحدة وينسون ما هو أهم من ذلك، وهو أن العاقبة متشابهة سواء ناب عنه أبو موسى الأشعري أو ناب عنه الأشتر أو عبد الله بن عباس …. فإن عمرو بن العاص لم يكن ليخلع معاوية ويقر علياً في الخلافة، وقصارى ما هنالك أن الحكمين سيفترقان على تأييد كل منهما لصاحبه ورجعة الأمور إلى مثل ما رجعت إليه …
وإن توهم بعضهم أن الأشتر أو ابن عباس كان قديراً على تحويل ابن العاص عن رأيه، والجنوح به إلى حزب علي، بعد مساومته التي ساومها في حزب معاوية …. فليس ذلك على التحقيق بمقنع معاوية أن يستكين ويستسلم، وحوله المؤيدون والمترقبون للمطامع يعز عليهم إخفاقهم كما يعز عليه إخفاقه.
فليس في أيدي المؤرخين الناقدين إذن حل أصوب من الحل الذي أذعن له علي على كره منه سواء أذعن له وهو عالم بخطئه أو أذعن به وهو يسوي بينه وبين غيره في عقباه.
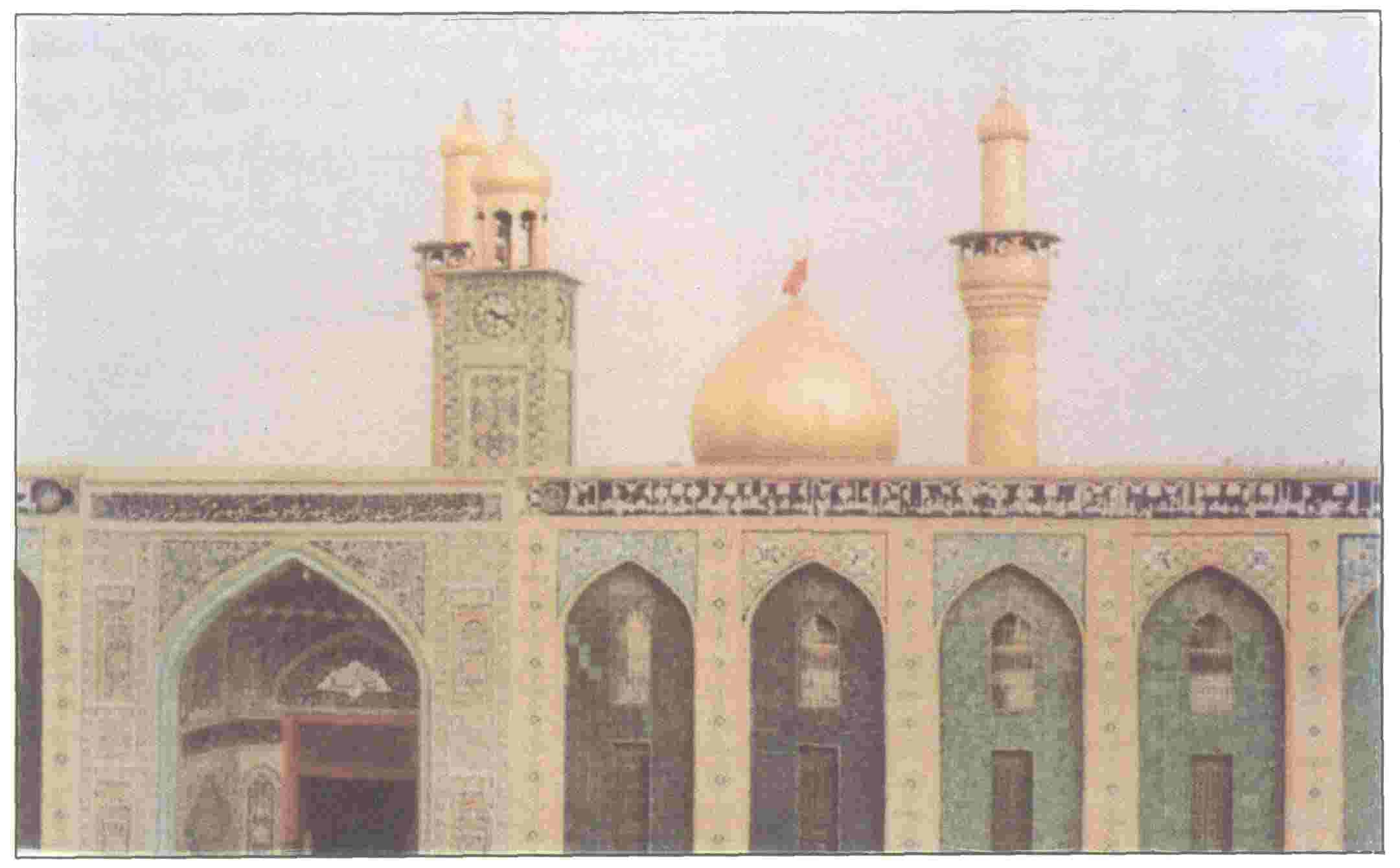 عباس العقاد
عباس العقاد
مقام أمير المؤمنين الإمام علي (ع) ـ النجف
علي بعد وفاة الرسول (ص)
حينما توفي رسول الله (ص) خلَّف أمة ومجتمعاً ودولة.
وأقصد بالأمة المجموعة من المسلمين الذين كانوا يؤمنون برسالته ويعتقدون بنبوته وأقصد بالمجتمع تلك المجموعة من الناس التي كانت تمارس حياتها على أساس تلك الرسالة وتنشئ علاقاتها على أساس التنظيم المقرر لهذه الرسالة وأقصد بالدولة القيادة التي كانت تتولى، تزعم التجربة في ذلك المجتمع، والاشتغال على تطبيق الإسلام وحمايته مما يهدده من أخطار وانحراف.
هذه الأمة بحكم أن الانحراف قصَّر عمر التجربة، وبحكم أن الانحراف زوَّر معالم الإسلام، بحكم هذين السببين الكمي والكيفي، الأمة غير مستوعبة، الأمة تتحصَّن بالطاقات التي تمنعها وتحفظها عن الانهيار أمام الكافرين وأمام ثقافات الكافرين، فتتنازل بالتدريج، عن عقيدتها عن آدابها، عن أهدافها وعن أحكامها.
في مقابل هذا المنطق وقف الأئمة عليهم السلام على خطين:
الخط الأول: هو خط محاولة تسلم زمام التجربة، زمام الدولة، محو آثار الانحراف، إرجاع القيادة إلى موضعها الطبيعي لأجل أن تكتمل العناصر الثلاثة: الأمة والمجتمع والدولة.
الخط الثاني: الذي عمل عليه الأئمة عليهم السلام، هو خط تحصين الأمة ضد الانهيار، بعد سقوط التجربة وإعطائها من المقومات، القدر الكافي، لكي تبقى وتقف على قدميها، وتعيش المحنة بعد سقوط التجربة، بقدم راسخة وبروح مجاهدة، وبإيمان ثابت.
والآن، نريد أن نتبين هذين الخطين في حياة أمير المؤمنين (ع)، مع استلال العبر في المشي على هذين الخطين.
على الخط الأول خط محاولة تصحيح الانحراف وإرجاع الوضع الاجتماعي والدولي في الأمة الإسلامية إلى خطه الطبيعي، في هذا الخط، عمل (ع) حتى قيل عن علي (ع) أنه أشد الناس رغبة في الحكم والولاية، اتهمه معاوية بن أبي سفيان، بأنه طالب جاه، وأنه طالب سلطان. اتهمه بالحقد على أبي بكر وعمر، اتهمه بكل ما يمكن أن يتهم الشخص المطالب بالجاه وبالسلطان وبالزعامة.
أمير المؤمنين (ع) عمل على هذا الخط خط تسلم زمام الحكم، وتفتيت هذا الانحراف، وكسب الزعامة زعامة التجربة الإسلامية إلى شخصه الكريم، بدأ هذا العمل عقيب وفاة رسول الله (ص) مباشرة، حيث حاول إيجاد تعبئة وتوعية فكرية عامة في صفوف المؤمنين.
لم يكن يفهم من علي (ع) إلاَّ أن له حقاً شخصياً يطالب به، وهو مقصر في مطالبته، إلاَّ أن المسألة لم تقف عند هذا الحد، فضاقت القصة على أمير المؤمنين (ع) من هذه الناحية، ومع أننا نجد في مراحل متأخرة من حياة أمير المؤمنين (ع) المظاهر الأخرى لعمله على هذا الخط، لمحاولة تسلمه أو سعيه في سبيل تسلم زعامة التجربة الإسلامية وتفادي الانحراف الذي وقع، إلاَّ أنَّ الشيء الذي هو في غاية الوضوح من حياة أمير المؤمنين (ع)، أنه (ع) في عمله في سبيل تزعم التجربة، وفي سبيل محاربة الانحراف القائم ومواجهته بالقول الحق وبالعمل الحق، وبشرعية حقه في هذا المجال، كان يواجه مشكلة كبيرة جداً، وقد استطاع أن ينتصر على هذه المشكلة انتصاراً كبيراً جداً أيضاً.
هذه المشكلة التي كان يواجهها هي مشكلة الوجه الظاهري لهذا العمل والوجه الواقعي لهذا العمل.
قد يتبادر إلى ذهن الإنسان الاعتيادي لأول مرة إن العمل في سبيل معارضة زعامة العصر، والعمل في سبيل كسب هذه الزعامة، أنه عمل في إطار فكري، أنه عمل يعبِّر عن شعور هذا العامل بوجوده، وفي مصالحه، وفي مكاسبه، وبأبعاد شخصيته، هذا هو التفسير التلقائي الذي يتبادر إلى الأذهان، من عمل يتمثل فيه الإصرار على معارضيه في زعامة العصر على كسب هذه الزعامة، وقد حاول معاوية كما أشرنا أن يستغل هذه البداهة التقليدية في مثل هذا الموقف من أمير المؤمنين (ع).
إلاَّ أن الوجه الواقعي لهذا العمل من قبل الإمام (ع) لم يكن هذا، الوجه الواقعي هو أن علياً كان يمثل الرسالة وكان هو الأمين الأول من قبل رسول الله (ص) على التجربة على استقامتها وصلابتها، وعدم تميعها على الخط الطويل، الذي سوف يعيشه الإسلام والمسلمون بعد النبي (ص). فالعمل كان بروح الرسالة ولم يكن بروحه هو، كان عملاً بروح تلك الأهداف الكبيرة، ولم يكن عملاً بروح المصلحة الشخصية، لم يكن يريد أن يبني زعامة لنفسه، وإنما كان يريد أن يبني زعامة الإسلام وقيادة الإسلام في المجتمع الإسلامي، وبالتالي في مجموع البشرية على وجه الأرض.
هذان وجهان مختلفان، قد يتعارضان في العامل نفسه، وقد يتعارضان في نفس الأشخاص الآخرين، الذين يريدون أن يفسروا عمل هذا العامل.
هذا العامل قد يتراءى له في لحظة أنه يريد أن يبني زعامة الإسلام لا زعامة نفسه، إلاَّ أنه خلال العمل، إذا لم يكن مزوداً بوعي كامل. إذا لم يكن مزوداً بإرادة قوية، إذا لم يكن قد استحضر في كل لحظاته وآنات حياته، إنه يعيش هذه الرسالة ولا يعيش نفسه، إذا لم يكن هكذا، فسوف يحصل في نفسه ولو لا شعورياً انفصام بين الوجه الظاهري للعمل وبين الوجه الحقيقي للعمل، وبمثل هذا الانفصام سوف تضيع أمامه كل الأهداف أو جزء كبير من تلك الأهداف سوف ينسى أنه لا يعمل لنفسه بل هو يعمل لتلك الرسالة سوف ينسى أنه ملك غيره وأنه ليس ملكاً لنفسه. كل شخص يحمل هذه الأهداف الكبيرة، يواجه خطر الضياع في نفسه، وخطر أن تنتصر أنانيته على هذه الأهداف الكبيرة، فيسقط في أثناء الخط، يسقط في وسط الطريق، وهذا ما كان علي (ع) معه على طرفي نقيض. علي (ع) كان يصرّ دائماً على أن يكون زعيماً، يصرّ دائماً على أن يكون هو الأحق بالزعامة، علي الذي يتألم، الذي يتحسّر أنه لم يصبح زعيماً بعد محمد (ص)، الذي يقول: (لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى)، في غمرة هذا الألم، في غمرة هذه الحساسية، يجب أن لا ننسى أن هذا الألم ليس لنفسه، إن هذه الحساسية ليست لنفسه، إن كل هذا العمل وكل هذا الجهد، ليس لأجل نفسه بل من أجل الإسلام. وكذلك كان يربي أصحابه على أنهم أصحاب تلك الأهداف الكبيرة، لا أصحاب زعامته وشخصه، وقد انتصر علي (ع) انتصاراً عظيماً في كلتا الناحيتين.
انتصر علي على نفسه، وانتصر في إعطاء عمله إطاره الرسالي وطابعه العقائدي انتصاراً كبيراً.
علي ربّى أصحابه على أنهم أصحالب الأهداف لا أصحاب نفسه، كان يدعو إلى أن الإنسان يجب أن يكون صاحب الحق، قبل أن يكون صاحب شخص بعينه. علي هو الذي قال: «اعرف الحق تعرف أهله» كان يربي أصحابه، يربي عمَّاراً وأبا ذرّ والمقداد: على أنكم اعرفوا الحق … ثم احكموا على علي في إطار الحق. وهذا غاية ما يمكن أن يقدمه الزعيم من إخلاص في سبيل أهدافه. أن يؤكد دائماً لأصحابه وأعوانه ـ وهذا مما يجب على كل المخلصين ـ أن المقياس هو الحق وليس هو الشخص. إن المقياس هو الأهداف وليس هو الفرد.
هل يوجد هناك شخص أعظم من علي بن أبي طالب. لا يوجد هناك شخص أعظم من علي إلاَّ أُستاذه، لكن مع هذا جعل المقياس هو الحق لا نفسه.
لما جاءه ذلك الشخص وسأله عن الحق في حرب الجمل هل هو مع هذا الجيش أو مع ذلك الجيش، كان يعيش في حالة تردد بين عائشة وعلي، يريد أن يوازن بين عائشة وعلي، أيهما أفضل حتى يحكم بأنه هو مع الحق أو عائشة. جهودها للإسلام أفضل أو جهود علي أفضل، قال له: اعرف الحق تعرف أهله.
علي كان دائماً مصرًّا على أن يعطي العمل الشخصي طابعه الرسالي، لا طابع المكاسب الشخصية بالنسبة إليه، وهذا هو الذي يفسّر لنا كيف أن علياً (ع)، بعد أن فشل في تعبئته الفكرية عقيب وفاة رسول الله (ص)، لم يعارض أبا بكر وعمر معارضة واضحة سافرة طيلة حياة أبي بكر وعمر، وذلك أن أول موقف اعتزل فيه علي المعارضة بعد تلك التعبئة الفكرية وإعطائها شكلاً واضحاً صريحاً كان عقيب وفاة عمر، يوم الشورى حينما خالف أبا بكر وعمر، هذا عندما حاول عبد الرحمن بن عوف حينما اقترح عليه المبايعة أن يبايعه على كتاب الله وسنة وسنة رسوله وسيرة الشيخين، قال علي (ع) : بل على كتاب الله وسنة نبيه واجتهادي. هنا فقط أعلن عن معارضة عمر، في حياة أبي بكر وعمر بعد تلك التعبئة، لم يبد موقفاً إيجابياً واضحاً في معارضتهما، والوجه في هذا، هو أن علياً (ع) كان يريد أن تكون المعارضة في إطارها الرسالي، وأن ينعكس هذا الإطار على المسلمين، أن يفهموا أن المعارضة ليست لنفسه، وإنما هي للرسالة، وحيث إن الانحراف لم يكن قد تعمق بعد والمسلمون القصيرو النظر، الذين قدموا غيره عليه، هؤلاء المسلمون القصيرو النظر لم يكونوا يستطيعون أن يعمقوا النظر إلى هذه الجذور، التي نشأت، فكان معنى مواصلة المعارضة بشكل جديد أن يفسر من أكثر المسلمين، بأنه عمل شخصي، وأنها منافسة شخصية.
علي بن أبي طالب (ع) بعد أن تمَّ الأمر لعثمان، بعد أن بويع عثمان يوم الشورى، قال: إني سوف اسكت ما سلمت مصالح المسلمين وأمور المسلمين، وما دام الغبن عليَّ وحدي، وما دمت أنا المظلوم وحدي، وما دام حقي هو الضائع وحده. أنا سوف أسكت سوف أبايع سوف أُطيع عثمان، هذا هو الشعار الذي أعطاه بصراحة مع أبي بكر وعمر وعثمان، وبهذا الشعار أصبح في عمله رسالياً، وانعكست هذه الرسالة على عهد أمير المؤمنين، وبقي (ع) ملتزماً بما تعهَّد به من السكوت إلى أن بدأ الانحراف في حياة عثمان بشكل مفضوح، ولهذا أسفر علي (ع) عن المعارضة وواجه عثمان بما سوف نتحدث عنه بعد ذلك.
فعلي (ع) في محاولته لتسلم زمام التجربة وزعامة القضية الإسلامية كان يريد أن يوفق بين هذا الوجه الظاهري للعمل، وبين الوجه الواقعي للعمل، واستطاع أن يوفق بينهما توفيقاً كاملاً، استطاع هذا في توقيت العمل، واستطاع هذا في تربيته لأصحابه، على أنهم أصحاب الأهداف لا أصحاب الأشخاص، واستطاع في كل هذه الشعارات التي طرحها، أن يثبت أنه بالرغم من كونه في قمة الرغبة لأن يصبح حاكماً، لم يكن مستعداً أبداً لأن يصبح حاكماً مع اختيار أي شرط من الشروط المطلوبة التي تنال من تلك الرسالة.
علي بن أبي طالب (ع) بالرغم من أنه كان في أشد ما يكون سعياً وراء الحكم، جاءه المسلمون بعد أن قتل عثمان، عرضوا عليه أن يكون حاكماً، قال لهم: بايعوا غيري وأنا أكون كأحدكم، بل أكون أطوعكم لهذا الحاكم، الذي تبايعونه، ما سلمت أمور المسلمين في عدله وعمله، يقول ذلك، لأن الحقد الذي تواجهه الأمة الإسلامية كبير جداً، تتمادى بذرة الانحراف، الذي عاشه المسلمون بعد النبي (ص) إلى أن قتل عثمان، هذا الانحراف الذي تعمق، الذي ارتفع، هذا الانحراف الذي طغى والذي استكبر، الذي خلق تناقضات في الأمة الإسلامية، هذا عبء كبير جداً.
ماذا يريد أن يقول، يريد أن يقول: لأني أنا لا أقبل شيئاً إلاَّ على أن تصفّوا الانحراف، أنا لا أقبل الحكم الذي لا يصفّي هذا الانحراف لا الحكم الذي يصفّيه، هذه الإحجامات عن قبول الحكم في مثل هذه اللحظات كانت تؤكد الطابع الرسالي، بحرقته بلوعته، لألمه لرغبته أن يكون حاكماً، استطاع أن ينتصر على نفسه، ويعيش دائماً لأهدافه، واستطاع أن يربي أصحابه أيضاً على هذا المنوال.
هذا هو الخط الأول وهو خط محاولة تسلمه لزمام التجربة الإسلامية.
وأما على الخط الثاني:
وهو خط تحصين الأمة لقد كانت الأمة تواجه خطراً، وحاصل هذا الخطر هو أن العامل الكمي والعامل الكيفي، سوف يجعلان هذه الأمة لا تعيش الإسلام، إلاَّ زمناً قصيراً.
بحكم العامل الكمي الذي سوف يسرع في إفناء التجربة ولن تعيش إلاَّ مشوهة بحكم العامل الكيفي، الذي يتحكم في هذه التجربة، ولذا بدأ الإمام بتحصين الأمة، وبالتغلب على العاملين: العامل الكمي والعامل الكيفي.
أما التغلب على العامل الكمي فكان في محاولة تحطيم التجربة المنحرفة وتحجيمها وإفساح المجال للتجربة الإسلامية لتثبت جدارتها وذلك بأسلوبين:
الأسلوب الأول: هو التدخل الإيجابي الموجه في حياة هذه التجربة بلحاظ قيادتها.
القادة والزعماء الذين كانوا يتولون هذه التجربة، كانوا يواجهون قضايا كثيرة لا يحسنون مواجهتها، كان يواجههم مشاكل كثيرة لا يحسنون حلَّها، ولو حاولوا لوقعوا في أشد الأضرار والأخطار، لأوقعوا المسلمين في أشد التناقضات، ولأصبحت النتيجة محتومة أكثر، ولأصبحت التجربة أقرب إلى الموت، وأقرب إلى الفناء وأسرع إلى الهلاك، هنا كان يتدخل الإمام (ع) وهذا خط عام سار الأئمة عليهم السلام كلهم عليه، فكان الإمام (ع) يتدخل تدخلاً إيجابياً، موجهاً في سبيل أن ينقذ التجربة من المزيد من الضياع ومن المزيد من الانحراف، ومن المزيد من السير في الضلال.
كلنا نعلم، بأن المشاكل العقائدية التي كانت تواجهه (ع) والزعامة السياسية بعد النبي (ص). هذه المشاكل العقائدية التي كان يثيرها، وتثيرها القضايا الأخرى التي بدأت تندرج في الأمة الإسلامية والأديان الأخرى التي بدأت تعاشر المسلمين، هذه المشاكل العقائدية لم تكن الزعامات السياسية وقتئذٍ على مستوى حلها، كان الإمام (ع) يعين تلك الزعامات في التغلب على تلك المشاكل العقائدية.
كلنا نعلم بأن الدولة الإسلامية واجهت في عهد عمر خطراً من أعظم الأخطار، خطر إقامة إقطاع لا نظير له في المجتمع الإسلامي، كان من المفروض أن يسرع في دمار الأمة الإسلامية، وذلك حينما وقع البحث بين المسلمين بعد فتح العراق، في أنه هل توزع أراضي العراق على المجاهدين المقاتلين، أو أنها تبقى ملكاً عاماً للمسلمين، وكان هناك اتجاه كبير بينهم إلى أن توزع الأراضي على المجاهدين الذين ذهبوا إلى العراق وفتحوا العراق، وكان معنى هذا أن يعطى جميع العالم الإسلامي، أي يعطي العراق، وسوريا، وإيران ومصر وجميع العالم الإسلامي الذي أسلم بالفتح، سوف يوزع بين هؤلاء المسلمين المجاهدين، سوف تستقطع أراضي العالم الإسلامي لهؤلاء، وبالتالي يتشكل إقطاع لا نظير له في التاريخ.
هذا الخطر الذي كان يهدد الدولة الإسلامية، وبقي عمر لأجل ذلك أياماً متحيراً لأنه لا يعرف ماذا يصنع، لا يعرف ما هو الأصلح، وكيف يمكن أن يعالج هذه المشكلة.
علي بن أبي طالب (ع) هو الذي تدخل وحسم الخلاف، وبيَّن وجهة النظر الإسلامية في الموضوع، وأخذ عمر بنظر الإمام أمير المؤمنين (ع) وأنقذ بذلك الإسلام من الدمار الكبير.
وكذلك له تدخلات كبيرة وكثيرة، النفير العام الذي اقترح على عمر والذي كان يهدد العاصمة في غزو سافر، كان من الممكن أن يقضي على الدولة الإسلامية، هذا الاقتراح طرح على عمر، كاد عمر أن يأخذ به، جاء علي (ع) إلى المسجد مسرعاً على ما أتذكر في بعض الروايات تقول: جاء مسرعاً إلى عمر، قال له: لا تنفر نفيراً عاماً، كان عمر يريد أن يخرج مع تمام المسلمين الموجودين آنذاك في المدينة، وعندها تفرغ عاصمة الإسلام مما يحميها من غزو المشركين والكافرين، منعه من النفير العام.
وهكذا كان علي (ع) يتدخل تدخلاً إيجابياً موجهاً في سبيل أن يقاوم المزيد من الانحراف، والمزيد من الضياع، كي يطيل عمر التجربة الإسلامية ويقاوم عامل الكم الذي ذكرناه.
هذا أحد أسلوبي مقاومة العامل الكمي.
الأسلوب الثاني: لمقاومة العامل الكمي كان هو المعارضة.
يعني كان تهديد الحكام ومنعهم من المزيد من الانحراف، لا عن سبيل التوجيه، وإنما عن سبيل المعارضة والتهديد.
في الأول كنا نفرض أن الحاكم فارغ دينياً، وكان يحتاج إلى توجيه، والإمام (ع) كان يأتي ويوجه، أما الأسلوب الثاني، فيكون الحاكم فيه منحرفاً ولا يقبل التوجيه، إذن فيحتاج إلى معارضة، يحتاج إلى حملة ضد الحاكم هذا، لأجل إيقافه عند حده، ولأجل منعه من المزيد من الانحراف.
وكانت هذه هي السياسة العامة للأئمة عليهم السلام.
لقد قاد المعارضة لعثمان، واستقطب آمال المسلمين ومشاعر المسلمين، واتجاهات المسلمين، نحو حكم صحيح، ولهذا كان هو المرشح الأساسي بعد أن فشل عثمان، واجتمع عليه المسلمون.
الإمام علي (ع) كان يتصدى للمعارضة لأجل أن يوقف الانحراف.
هذان أسلوبان كانا هما الأسلوبان المتبعان لمواجهة العامل الجديد.
ثم هذه المعارضة نفسها كانت تعبر من ناحية أخرى عن الخط الثاني، وهو المحافظة على الأمة الإسلامية من الانهيار بعد سقوط التجربة حيث أن المسلمين لم يعيشوا التجربة الصحيحة للإسلام، أو بعدوا عنها، والتوجيه وحده لا يكفي، لأن هذا العمل لا يكفي لأن يكسب مناعة. المناعة الحقيقية والحرارة الحقيقية للبقاء والصمود كأمة، إذن كان لا بدَّ من أن يحدد الموقف. من أن يحدد الوجه الحقيقي للإسلام، في سبيل الحفاظ على الإسلام، وهذا الوجه الحقيقي للإسلام قدمه علي بن أبي طالب (ع) من خلال معارضته للزعامات المنحرفة أولاً، ومن خلال حكم الإمام بعد أن مارس الحكم بنفسه.
من خلال هذين العملين، ومن خلال العمل السياسي المتمثل في المعارضة، والعمل السياسي المتمثل في رئاسة الدولة بصورة مباشرة، قدم الوجه الحقيقي للإسلام، الأطروحة الصحيحة للحياة الإسلامية الأطروحة الخالية من كل تلك الألوان من الانحراف.
طبعاً هذا لا يحتاج إلى حديث، ولا يحتاج إلى تمثيل لأنه واضح.
أمير المؤمنين حينما تولى الحكم، لم يكن يستهدف من تولي الحكم تحصين التجربة أو الدولة، بقدر ما كان يستهدف تقديم المثل الأعلى للإسلام، لأنه كان يعرف أن التناقضات، في الأمة الإسلامية، بلغت إلى درجة لا يمكن معها أن ينجح عمل إصلاحي إزاء هذا الانحراف مع علمه أن المستقبل لمعاوية، وأن معاوية هو الذي يمثل القوى الكبيرة الضخمة في الأمة الإسلامية.
كان يعرف أن الصور الضخمة الكبيرة التي خلقها عثمان والتي خلقها انحراف هذه القوى، كلها إلى جانب معاوية، وهو ليس إلى جانبه ما يعادل هذه القوى، لكن مع هذا قبل الحكم، ومع هذا بدأ تصفية وتعرية الحكم والانحراف الذي كان قبله، ومع هذا مارس الحكم وضحى في سبيل هذا الحكم بعشرات الآلاف من المسلمين، في سبيل أن يقدم الأطروحة الصحيحة الصريحة للإسلام وللحياة الإسلامية.
إن علي بن أبي طالب (ع) في معارضته، وعلي بن أبي طالب في حكمه لم يكن يؤثر على انحراف الشيعة فقط، بل كان يؤثر على مجموع الأمة الإسلامية، علي بن أبي طالب ربى المسلمين جميعاً شيعة وسنة، حصَّن المسلمين جميعاً شيعة وسنَّة، علي بن أبي طالب أصبح أطروحة ومثلاً أعلى للإسلام الحقيقي، من الذي كان يحارب مع علي بن أبي طالب؟ هؤلاء المسلمون الذين كانوا يحاربون في سبيل هذه الأطروحة العالية في سبيل هذا المثل الأعلى، أكانوا كلهم شيعة بالمعنى الخاص؟ لا، لم يكونوا كلهم شيعة. هذه الجماهير التي انتفضت بعد علي بن أبي طالب على مر التاريخ، بزعامات أهل البيت بزعامات العلويين الثائرين من أهل البيت، الذين كانوا يرفعون راية علي بن أبي طالب للحكم، هؤلاء كلهم شيعة؟.
كان أكثرهم لا يؤمن بعلي بن أبي طالب إيمان الشيعة، ولكنهم كانوا ينظرون إلى علي أنه المثل الأعلى، إنه الرجل الصحيح الحقيقي للإسلام، حينما أعلن والي عبد الله بن الزبير سياسة عبد الله بن الزبير، وقال بأننا سوف نحكم بما كان يحكم به عمر وعثمان، وقامت جماهير المسلمين تقول لا بل بما كان يحكم به علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب كان يمثل اتجاهاً في مجموع الأمة الإسلامية.
الخلافة العباسية كيف قامت؟ كيف نشأت؟ قامت على أساس دعوة كانت تتبنى زعامة الصادق من آل محمد (ص). الحركة السلمية التي على أساسها نشأت الخلافة العباسية كانت تأخذ البيعة للصالح، للإمام الصادق من آل محمد (ص)، يعني هذه الحركة استغلت عظمة الإسلام، عظمة هذا الاتجاه، وتجمع المسلمون حول هذا الاتجاه، ولم يكن هؤلاء مسلمون شيعة، أكثر هؤلاء لم يكونوا شيعة، لكن كانوا يعرفون أن الاتجاه الصالح، الاتجاه الحقيقي، الاتجاه الصلب العنيف كان يمثله علي بن أبي طالب (ع)، والواعون من أصحاب علي (ع) والواعون من أبناء علي (ع). ولهذا كثير من أبناء العامة، ومن أئمة العامة، من أكابر أصحاب الإمام الصادق (ع)، كانوا أناساً عاميين يعني كانوا أناساً سنة، ولم يكونوا شيعة.
دائماً كان الأئمة عليهم السلام يفكرون، في أن يقدموا الإسلام لمجموع الأمة الإسلامية، أن يكونوا مناراً، أن يكونوا أطروحة، أن يكونوا مثلاً أعلى.
كانوا يعملون على خطين، خط بناء المسلمين الصالحين، وخط ضرب مثل أعلى لهؤلاء المسلمين، بقطع النظر عن كونهم شيعة أو سنة.
هناك علماء من أكابر علماء السنة، أفتوا بوجوب الجهاد، وبوجوب القتال بين يدي ثوار آل محمد (ص)، وأبو حنيفة نفسه الذي كان من أئمة السنة، أفتى بوجوب الجهاد مع راية من رايات علي (ع)، مع راية تحمل شعار علي بن أبي طالب، قبل أن يتعامل أبو حنيفة مع السلاطين.
إذن فاتجاه علي بن أبي طالب، لم يكن اتجاهاً منفرداً، اتجاهاً محدوداً، كان اتجاهاً واسعاً على مستوى الأمة الإسلامية كلها، لأجل أن يعرّف الأمة الإسلامية وأن يحصن الأمة الإسلامية بالإسلام، وبأهداف الإسلام، وكيف يمكن للإنسان أن يعيش الحياة الإسلامية في إطار المجتمع الإسلامي.
المهم من هذا الحديث، أن نأخذ العبرة وأن نقتدي، حينما نرى أن علي بن أبي طالب (ع) على عظمته يربي أصحابه على أنهم أصحاب الهدف، لا أصحاب نفسه. يجب أن لا أفكر أنا، ويجب أن لا تفكر أنت، بأن تربي أصحابك على أنهم أصحابك، وإنما هم أصحاب الرسالة، أي واحد منكم ليس صاحباً للآخر، ولهذا يجب أن نجعل الهدف دائماً مقياساً، نجعل الرسالة دائماً مقياساً. احكموا عليَّ باللحظة التي انحرف فيها عن الهدف، لأن الهدف هو الأعز هو الأغلى، هو رب الكون، الذي يجب أن تشعروا بأنه يملككم، بأنه بيده مصيركم، بيده مستقبلكم، إنه هو الذي يمكن أن يعطيكم نتائج جهادكم.
هل أنا أعطيكم نتائج جهادكم، أو أي إنسان على وجه الأرض يمكن أن يعطي الإنسان نتائج جهاده، نتائج عمله، نتائج إقدامه على صرف شبابه، حياته، عمره، زهده على تحمله آلام الحياة، تحمله للجوع تحمله للظلم، تحمله للضيم، من الذي يعطي أجر كل هذا؟ هل الذي يعطي أجر هذا أنا وأنت، لا أنا ولا أنت يعطي أجر هذا، وإنما الذي يعطي أجر هذا هو الهدف فقط. هذا هو الذي يعطي النتيجة والتقييم، هو الذي سوف يغير أعمالنا، هو الذي سوف يصحح درجاتنا.
محمد باقر الصدر
الثورة الشعبية التي
سبقت خلافة علي
من الإنصاف والخير أن نذكر أن الجمهور الذي ثار على سوء الحكم في عهد عثمان لم يكن أرعن في ثورته، فقد اتصل بأولياء الأمور والسلطة وطالب بواسطة ممثليه مراراً وتكراراً، ولكن مطاليبه في كل مرة كانت تبوء بالفشل وكان فشلاً ذريعاً متواصلاً ومن النوع المثير، فلا بدع أن هب الشعب هبته الغضبى وتركزت الثورة الانتقامية في رأسه تركز الفكرة الثابتة لا تحول عنها في كثير أو قليل.
هبطت وفود الأمصار المدينة مرة وأخرى إلى مرات كثيرة، وكانت في كل مناسبة تحمل طائفة من أمانيها وهي ملأى بالرجاء تود لو صدقت أحلام آمالها، وكانت ترجع في كل مرة بوعود معسولة ولكن لا تلبث أن تستحيل إلى صدى يأس فيه غرور السراب.
ساءها في كل تجربة وكل محاولة إخفاق المنقلب، فأغيظت كذي النفس الجريحة على من لا يفتأ ينكأ جراحه ويجري دماءه، ولم يسعها كظم عواطفها الملتهبة فهدرت صاخبة محتجة تريد وضع حد لآلامها وبأساتها المستعرة، فكانت تصطدم مراراً وتكراراً بما يوقظ فيها شعور الخيبة المنتقم. لذلك لم تكن الجماعات ترى في أي مكان إلاَّ ملتئمة على بعضها تتهامس في أمر خطير.
وفي هذه الملتهبة كان أبو ذر الغفاري ينتقد ولا يبالي على أي وجه فسر عليه انتقاده، ويتحدى المجتمع والدولة وكل أسرة الحكم تحدياً جارحاً بمنطق الدستور الانطلاقيين المتجاوزين مذاهب سلوكهم.
رأى ولمس مقدار تهاوي الناس في الترف بالعدوى وتهافتهم على الرفاه من أي طريق، وتستتبع خطة هذا السلوك إباحية ولا مبالاة، فجعل من نفسه وأتباعه حاجزاً يقاوم التيار، فوقف في كل مكان يبشر بمبادئه وبعبارة أصح يقرع سمع الناس بما قد عاهد عليه النبي وبما قد سمعه منه ووعاه بين يديه، ولكن بعضاً من الناس كانوا قد استناموا إلى هذا الجديد وتذوقوه ولذتهم أشياؤه، فأبوا عليه وأبى عليهم فانطلق لا يبالي غضباً ولا رضى.
وكان أبو ذر يرى أن فكرة الحياة الإنسانية هي الفضيلة والإنسان هو الفاضل فقط. إذن فعلى الناس أن يحلوا أشياء الفضيلة بينهم، وأن يوفروا كل جهودهم على تحقيقها وانتهاج سننها وأساليبها وأما أولئك الذين يجمعون أكبر جدهم وهمهم على التزيد من متارف الحياة الناعمة وأسباب العيش الرفيه، فإنهم لا يفضلون في اعتباره عن سائمات وجدت سبيل حظوظها. والإنسان عنده إذا جمع، همه هذا الجمع فإنه ينقلب حيواناً فقط ميزته أنه أقدر على التحيل بما فيه من الفكر، وأما الإنسانية فإنها عنصر غريب عنه. ولكي يكون إنساناً كذلك لا بدَّ له من حياة أخرى مادتها الفضيلة، والفضيلة، في نظره هي التجرد والعمل.
هو يريدنا أن نعمل ونكافح ما استطعنا إلى ذلك، كما يريدنا أن نتجرد أيضاً فلا ننغمس في مدى الفتوة، يريد منَّا سيراً بما فينا من حياة عضوية ذات حرارات، واستعلاء بما فينا من روح لا تفتأ تنشد السمو.
وليس أضرَّ على الكائن الإنساني من أن يسير بالحياة فقط، إذ بهذا يشبه سير الرحى تتحرك وهي قابعة بمحلها. وفرق ما بين الإنسان والحيوان إن الثاني تسير به الحياة والأول يسير بالحياة ويستعلي دوماً بالروح التي هي فكرة الحياة وغايتها وضميرها وأخلاقيتها. وإذا كانت الحركة ضرورية للحياة، والفضيلة التي هي التجرد ضرورية للإنسانية، فلكي نكون أحياء إنسانيين يجب أن نعمل ويجب أن نتجرد، وأما إذا عملنا فقط فقد نحرنا عنصر الإنسانية فينا وأسففنا، كما تتعقد الحياة حين نضعها في معترك أطماعنا وشباك شهواتنا. فكان يوصي ويلح أن نعمل وأن نتجرد أي عمل ولا ندخر، فحض بأقسى أسلوب وأعنفه على عدم الكنز ولوح ما شاءت له فكرته وشاء ضميره بقوله تعالى:
﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾.
وهو يرى أيضاً أن الدولة كالفرد سواء بسواء، فإذا كنزت ولم تتجرد انحطَّت وتولدت لديها الأطماع فتحدى الدولة كما تحدى الأفراد وحارب الكنز الإجماعي كما حارب الكنز الفردي. وشنَّها شعواء على دنيا القصور وحياة الترف، فقد نظر إليها نظرة إلى مأتم للمثالية العليا والأحلام السامية، فموكب الإنسانية لا بدَّ أن يتوقف ويتحول، وينقلب موكب رجم إذا شئنا الولوج به في دنيا الشهوات.
ومن ناحية أخرى أحسَّ بآلام البؤس في الناس، وأحسَّ بأن الدولة تتوسل بالتسميات القانونية إلى انتهاب المسميات الحقوقية من أربابها والاستحواذ على الثروة الاجتماعية وتبديدها دون مستحقيها، فقدر واستنتج أن الحكومة المنتخبة هي ذات الحق الأول في التصرف بالأموال الشائعة. إذن فتسميتها مال الخزينة بمال الله التي يراد منها الشيوع، وسيلة للتلاعب والاستحواذ فحمل حملة نكراء على هذه التسمية المغلوطة ونادى بأنها مال المسلمين، هذه التسمية التي تؤدي في تسلسلها المنطقي الحقوقي إلى منع حرية التصرف، وإلى وجوب توزيعها عليهم وتعلق حقوقهم بها.
وبلغ من شدة وطأة هذه الدعوة أن جعل الأنانيون الطامعون يفرون من طريقه كلما رأوه، وزاد في تأثير دعوته وانتشارها أنه كان يشفع أقواله هذه بأحاديث مأثورة سمعها من النبي.
وكانت في الكوفة حركة أقوى من سائر الحركات الأخرى في المدن والعواصم، وهناك وضعت «عريضة الحق» أو «مطالب الإصلاح فلم تقابل من الهيئة الحاكمة بالحسنى بل بالإعراض، فتألبوا وكان أن توسط علي بن أبي طالب بينهم وبين الخليفة فوعدوا خيراً، وما إن بارحوا المدينة حتى أوعزت السلطة العليا إلى معاوية «بالقبض عليهم»، وبعد ذلك أفرج عنهم فعادوا إلى المطالبة مرة أخرى، بيد أنهم استعدوا للخصومة مهما نجم عنها. ومهما احتبكت ألوانها الكالحة … وكانت عريضة الحق تشتمل على:
(أ) إبعاد البطانة المشرفة على تسيير الأمور حالياً ولا سيما مروان بن الحكم.
(ب) الرجوع إلى سياسة الأموال التي درج عليها النبي دون السياسة التي جرى على سنتها الخليفة الثاني ولا تزال.
(ج) ضرب اليد على طماعية قريش.
(د) الحد من صلاحية الولاة والأمراء فيقيد تصرفهم بالخراج والأموال العامة.
(هـ) الحيلولة دون الأمراء واستذلال الأهلين.
وفدت الوفود تحت ستار الحج وهي تخفي أغراضها الدامية الثورية وشاع الهمس في المدينة وانطلقت عبارات الانتقاد تؤج كالنار في الهشيم، وقد اتصلت بعلي أخبارهم فتخوف مغبة الأمر وبادر إلى الاجتماع بعثمان فقال له:
«الناس ورائي وقد كلموني فيك، ووالله ما أدري ما أقول لك، وما أعرف شيئاً تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه».
إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغكه، وما خصصنا بأمر دونك. وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله، وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك … ثم يقول:
فالله في نفسك. فإنك والله ما تبصر من عمى، وما تعلم من جهل، وإن الطريق لواضح بين…».
وظلَّ عثمان يعلل بمختلف الأعذار ولا يستقر على رأي. وكان أحياناً يذعن لنصائح علي ويعزم على إصلاح الأمور. ومما قاله له علي: «إن معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت تعلمها، فيقول للناس هذا أمر عثمان فيبلغك ولا تغير على معاوية».
ولكن معاوية لم يزل بعثمان يوغر صدره على علي، ويضرب له المثل بشدته عليه فيقول:
«هكذا يستقبل وأنت أمامه وسلفه وابن عمه وابن عمته، فما ظنك بما غاب عنك منه؟». وكذلك يقول سعيد بن العاص وسائر بطانته: «حتى أجمع ألا يقوم دونه» وعلي حيال تردد عثمان لم يسعه إلاَّ أن يقول:
«ما يريد عثمان أن ينصحه أحد، اتخذ بطانة أهل غش ليس منهم أحد إلاَّ وقد تسبب بطائفة من الأرض يأكل خراجها ويستذل أهلها».
وكان عمرو بن العاص في هذه الأثناء يحرض الناس على عثمان ويجبه سياسته علانية ويتجسس عليه ويفضح الأحاديث التي تجري داخل داره، ولا يلقى أحداً إلاَّ أدخل في روعه كراهيته ويستغل المناسبات والظروف حتى قال يصف نفسه:
«أنا أبو عبد الله إذا حككت قرحة نكأتها، إن كنت لألقى الراعي فأحرضه على عثمان» …. وهذا عثمان يستشيره في جماعة من صحبه فيقول له عمرو:
«أرى أنك قد ركبت الناس بما يكرهون، فاعتزم أن تعتدل، فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل، فإن أبيت فاعتزم عزماً وامض فيه قدماً» … ويقابله حينما خطب عثمان على ملأ من الصاخبين المتمردين بقوله:
«يا أمير المؤمنين: إنك قد ركبت نهابير وركبناها معك، فتب نتب» … وهذه عائشة تجترئ وهو يخطب فتقول وقد نشرت قميص النبي:
«هذا قميص النبي لم يبل، وقد أبليت سنته» … وهذان طلحة والزبير يعينان الثائرين بالمال.
والجموع المتألبة الوافدة من كل مكان، حيال ما ترى وحيال ما تحس به من آلام في قراراتها، تفتحت ثائرتها ومضت في اندفاعها متنمرة غاضبة. فبذل علي كل جهد لتخفيف ثائرتهم وتبريد غلوائهم، وحمل عثمان على إعطائهم مهلة ثلاثة أيام. فلما انتهت اجتمعوا على بابه «مثل الجبال» على حد تعبير المؤرخين، قال عثمان لمروان: «اخرج وكلمهم فإني أستحي أن أكلمهم» فخرج مروان إلى الباب «والناس يركب بعضهم بعضاً» فقال:
«ما شأنكم قد اجتمعتم كأنما جئتم لنهب؟ …. شاهت الوجوه، كل إنسان آخذ بأذن صاحبه؟ … جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا؟ أُخرجوا عنَّا. أما والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم أمر لا يسركم، ولا تحمدوا غب رأيكم … ارجعوا إلى منازلكم والله ما نحن بمغلوبين على ما في أيدينا».
كانت هذه الخطبة المملوءة حمقاً ورعونة، شرارة شديدة الأثر في إذكاء الثورة وتقريب خطواتها. ومروان لم يفلح فيها بإثارة الناس فقط، بل أفلح أيضاً بإثارة علي نفسه الذي ضمن للجمهور تسوية الأمور على ما يرغب، وقد أسقط في يده حقاً وما وسعه تحت عاصفة نفسه وعاصفة الجمهور المائج إلاَّ أن يقول مقالته المشهورة لعثمان:
«ما رضيت من مروان ولا رضي منك، إلاَّ بتحرفك عن دينك وعن عقلك، مثل جمل الظعينة يقاد حيث يسار به. والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا في نفسه. وأيم الله إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك، وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك، أذهبت شرفك وغلبت على أمرك».
ودخلت عليه امرأته نائلة ابنة الفراقصة فقالت:
«أتكلم أو أسكت» … فقال: تكلمي … فقالت:
«قد سمعت قول علي وإنه ليس يعاودك، وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء» … قال: فما أصنع؟ قالت: «تتقي الله وتتبع سنة صاحبيك من قبلك، فإنك متى أطعت مروان قتلك. ومروان ليس له عند الناس قدر ولا هيبة ولا محبة، وإنما تركك الناس لمكان مروان منك، فأرسل إلى علي فاستصلحه فإن له منك قرابة وهو لا يعصى». فأرسل عثمان إلى علي فأبى أن يأتيه وقال: «قد أعلمته أنني لست بعائد».
كبر على علي مثل ذلك المنطق الذي فاجأ به الجموع، مروان بلسان الخليفة، وهو يعلم أنه لم يكن بينهم في هذه المرحلة العصيبة وبين التلظي والتهاب الوضع القائم، إلاَّ كلمة رعناء كالتي فاه بها مروان. على أنها هدمت قيمة وساطته وألقت في روع الناس ارتياباً حقيقياً حاداً في جدوى مداخلته، لهذا ـ وهو في مقياس كل عصر مبرر ـ تنحى واعتزل واعتصم في حدود هذا التنحي والاعتزال … ولكن علياً مع كل ما هو عاتب وواجد، لم يزل يقدر ويذهب في مدى تقديره بعيداً فينتهي إلى الكارثة ويتراءى له شبحها، فيرهب هوتها ويخشى وقوعها. إذن يجب أن لا يظل بعيداً وإن توارى من الميدان إزاء موقف بطانة عثمان من الجمهور هذا الموقف النابي المثير، فبادر إلى تقديم ولديه ـ لاعتباراتهما التقديرية ـ كي ينهنهوا عوادي الأحداث وطائشات الخطوب … وحين بلغه «أن الناس حصروا دار عثمان ومنعوه الماء بعث إليه بثلاث قرب، وقال للحسن والحسين: اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على بابه ولا تدعا أحداً يصل إليه بمكروه، وكان أن خضب الحسن بالدماء وشجَّ قنبر مولاه».
وبات علي مطمئناً فقد رتب الأمور جيداً، وهو واثق من أن مجرى الحادث سيسير على هذا الشكل: يضطر عثمان تحت ضغط الجمهور إلى إجابة مطالب الإصلاح وتنحية بطانته ولا سيما مروان، ولوجود ابنيه اطمأن من عدم دنو الخطب منه. فإن وجودهم يعبر عن معارضة عملية أكيدة من جانبه، فلا يتصل به مكروه دام يضع حداً لحياته، وإنما كل ما في الأمر أنه سيضع حداً لأساليب الحكم الاستبدادية ومهازله العابثة.
هذا ما عرف التاريخ عن علي وبنيه إزاء المصرع، بينما عرف من ناحية ثانية أن عثمان وهو محاصر كتب إلى معاوية وهو بالشام:
«إن أهل المدينة قد كفروا، وأخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة فابعث إلى من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول» فإذا بمعاوية حينما جاءه كتابه يتربص به ولا يجيبه.
ومن تهكمات القدر أن يحرض عمرو بن العاص على قتل عثمان، وتجبهه عائشة علانية، ويتخلى معاوية عن نجدته، ويعين عليه طلحة والزبير كلاهما. ثم ينفر هؤلاء أنفسهم هنا وهناك، يطالبون بدمه علي بن أبي طالب الذي أخلص له النصيحة وحذَّره من هذا المصير، وكان مجنه دون رواكض الخطوب.
بعد تولي الخلافة
أصبح علي الخليفة واجتمعت في يديه مقاليد الأمور، فثاب إلى المجتمع هدوء مشفوعاً بالأمل وارتقاب فجر جديد.
وبدأ علي أول ما بدأ بإعطاء الحق إلى الشعب، فقد وجد أن مشاكلهم المعلقة أضحت مزمنة لم يبت فيها بشيء، فعطف على آلام هذا الجمهور وواساه بنفسه وقلبه ما وجد إلى ذلك سبيلاً.
وذهب مع تقريره بأن المجتمع الذي يقوم النظام فيه على برنامج غير مكتوب، يظل عرضة للعبث والتلاعب والتصرفات التي من شأنها أن تضيره، إذا لم يقصد أولاً وقبل كل شيء إلى الاختيار وانتفاء الشخصيات التي تضم إلى الكفاءة، الإخلاص والضمير. بل من رأي علي أن الإصلاح حتى في المجتمعات التي يستوي النظام فيها على برامج مكتوبة، لا يتم على وجه مضمون إلاَّ بالشخصية المنتقاة. ولمس إلى ذلك أن أكبر عناصر الشكوى وأهم أجزائها هو الجزء الخاص بالأمراء والولاة، فبدر قدماً إلى تغيير التعيينات.
وكان طلحة والزبير كلاهما مرشحاً لولاية من ولايات الأمصار الكبرى، فلما أظهرا على أن التعيينات الجديدة لم يصبهما منها نصيب، امتعضا أي امتعاض ولمسا في الظرف الذي لم يزل قلقاً مضطرباً ما يمكنهما من القيام بحملة ضغط على الخليفة الجديد، لا سيما وقد وجد في الناس من يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين باشروا الاغتيالات بالنفس.
وعلي لم يؤخرهما من حيث أنهما ليسا بالجديرين، بل لأن الظرف لم يزل يعج بالحزبية ولم يزل متشبعاً بروحها. فإذا بعث بهما إلى الأقاليم التي تناصرهما كالكوفة بالنظر إلى الزبير والبصرة بالنظر إلى طلحة، فقد سهل لهما حرية التصرف والانفراد بالرأي لمكان الثقة الحزبية. وحرية التصرف هي التي بات يشكو الناس منها كما كان الحال بمعاوية في الشام على عهد عثمان، على أن الأمير يصبح بهذه الحزبية المناصرة قليل الاهتمام بأوامر السلطة العليا، مما تتخذ به الأقاليم في كل مكان شكل إقطاعيات لا تتصل بالمرجع الأعلى الإيجابي إلاَّ اتصالاً اسمياً … وإذا تأزمت العلاقة بين الرئاسة العليا والأمير، استطاع الانفراد بإقليمه وقطع العلاقة التي لم تكن تعبر عن اتصال إيجابي. وهذا خطر يهدد الدولة وداء وبيل في جسم الحكم، خصوصاً إذا تواطأت طائفة من أمراء الأقاليم على العصيان باتفاق المصالح الموجبة، فإنه يقع الخطر الحقيقي على الكيان الحكومي. كما تظل هذه السمة الإسمية للأقليم الإقطاعي ينبوع ضرر للرئيس الأعلى، وذلك حين لا يحفل الأمير بالأوامر التي تصدر له ولا يرهب مرجعه فيعبث كيف شاء، ويكون المسؤول عن تصرفه هو الرئيس الأعلى في نظر الشعب فيتهم بالتواطؤ معه أو بالتغافل عنه، رغم أنه في الواقع لا يستطيع أن يحيك معه حيكاً، مثلما كان الحال في زمن عثمان فقد أصبح اتصال الأقاليم بمركز الخلافة اسمياً، والأمير إقطاعي يتصرف كيف حلا له لا ينتظر أمراً ولا يخضع لأمر. وإنما يستخدم ذلك الطابع «هذا أمر الخليفة» ستاراً فقط كما كان يفعل معاوية في الشام.
وإذا بعث بهما علي إلى الأقاليم الأخرى وليس لهما فيها أنصار وأشياع بل على العكس أعداء حزبيون، فقد أعاد الوضع إلى القلق ودفع الجمهور إلى التمرد بالشكوى المصطنعة. لذلك عمد إلى مداواة الحالة العامة وخنق الحزبية وعنعناتها وإيجاد جسم اجتماعي سليم أولاً … فبين يديه مجتمع مريض وهو يتطلب شخصيات جديدة لم تنخرط في الحقل العام والحياة السياسية الصاخبة المتناحرة، حتى إذا تمَّ له ما يريد عاد ففكر فيهما وفي سواهما. ولكنهما فسَّرا إغفالهما بالعداء، فانصرفا إلى إيجاد الوسائل القمينة بالضغط فوجها وجههما شطر مكة. وبينا هما في الطريق لقيا عائشة وهي عائدة من مكة، فرويا لها ما كان من أمر الثائرين وعثمان، وما كان من أمرهم وعلي، وكاشفاها بما عزما عليه. وصادف هذا رغبة في ضميرها وهوى كامناً، فحملاها على الرجوع وسهَّلا لها الخوض في معمعة سياسية طاحنة، اتصلت حتى انقلبت دموية حادة.
ولما هبطوا مكة وجدوا فيها فلول الأمويين، ففكروا جميعاً باستغلال الموقف وترتيبه على هذا الشكل:
يعصي بالشام معاوية وهم يعصون بالعراق حتى إذا استقام لهم الأمر واستقروا، حاصروا الحجاز وانتزعوا مقدرات السلطة العليا بمطالبهم.
أدرك علي كل ما دار بخلدهم وما عزموا عليه، وأدرك فوق ذلك أن الخطب سيعدو دائرته الضيقة، لنزول عائشة إلى الميدان بما تبعثه من خامدات النفوس وفي المحيط العربي خصوصاً. أليست امرأة وامرأة لها قيمتها ومنزلتها الروحية الفريدة؟ فهي زوج النبي وابنة الخليفة الأول. ومن ناحية ثانية أليس الموضوع نفسه حساساً مثيراً؟ أليس كل الثائرين الذين تم الحادث على أيديهم في صفوف علي؟ أليست نفسية الجموع شديدة الحساسية بفضاعة الدم المطلول وضغينة المحاكمة والموازنة؟ أليس الظرف متبلبلاً يميد بالفوضى؟ إذن ففي الأمر عقدة خطيرة ولا بدَّ أن يستغلها هؤلاء الواجدون.
فكَّر وقدَّر وقلَّب وجوه الرأي حتى انتهى إلى أن الحالة الناشبة البادية ستستحيل إلى فوضى فظيعة قد تندك معها معالم المجتمع الإسلامي، وانتهى أيضاً إلى أن صفة التبلبل وهي تساعد على الدس والانتهاز لا يحسمها إلاَّ عمل سريع عنيف. وفكر كثيراً قبل أن ابتدأ بطلحة والزبير ومن ورائهما عائشة، فقد لمس خطر هؤلاء الذين يملكون من أسباب السيطرة والتأثير الروحي قدراً كبيراً.
ومن ناحية ثانية فقد استجلى طبيعة البصرة على ضوء الروحية التي كانت بارزة في العراق إذ ذاك، فوضع يده على مكان التفكك والتفسخ وعدم الانسجام والتماسك، بينما الشام كانت على العكس متماسكة بوحدة الدم والتغرير. إذن فالبصرة أقل عناء وأكثر خطراً وأبعد نفوذاً بما يملك اللاجئون إليها من صدى بعيد، عميق التجاوب في النفسية العربية العامة. فكان لزاماً أن ينبعث من فوره إليهم ويتخذ البصرة هدف ضربته الأولى الخاطفة الساحقة، فيرهب بها المتمردين في كل مكان ومجال.
وأقام خطته على حرب السرعة ليكون نجاحها مضموناً، فيعيد الثقة المفقودة، بعد الثورة، إلى العاصمة، كما استعان بالنقد والدعاية كأداة حربية فظيعة الفتك، وأدرك ضرورة هذا العنصر في الحرب فهبت أم سلمة زوج النبي وهي من أعوانه إلى انتقاد عائشة على شكل حاد، فيما أقدمت عليه من مغامرة فكتبت إليها، ومن جهة ثانية أذيع الكتاب وهو:
«من أم سلمة زوج النبي، إلى عائشة أم المؤمنين. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو.
أما بعد: فقد هتكت سدة بين رسول الله وأمته. جمع القرآن ذيولك فلا تسحبيها، وسكر خفارتك فلا تبتذليها، فالله من وراء هذه الأمة … لو علم رسول الله أن النساء يحتملن الجهاد عهد إليك، أما علمت أنه قد نهاك عن الفراطة في الدين. فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال، ولا يرأب بهن إن انصدع. جهاد النساء غض الأطراف وضم الذيول، وقصر الموادة. ما كنت قائلة لرسول الله لو عارضك ببعض هذه الفلوات، ناصة قعوداً من منهل إلى منهل. وغداً تردين على رسول الله، وأقسم لو قيل لي يا أم سلمة ادخلي الجنة لاستحييت أن ألقى رسول الله هاتكة حجاباً ضربه علي … فاجعليه سترك وقاعة البيت حصنك، فإنك أنصح ما تكونين لهذه الأمة ما قعدت عن نصرتهم. ولو أني حدثتك بحديث سمعته من رسول الله لنهشت نهش الرقشاء المطرقة. والسلام».
وكان لهذه الدعاية الحربية أثرها الكبير، فأم سلمة أم المؤمنين أيضاً وهي تشجب على عائشة حركتها وتنتقدها انتقاداً لاذعاً. وقد تركت أثرها المرغوب به والمتوخى نيله وكان أبرز ما تركت أثران بارزان:
1 ـ إعطاء صورة نابية عن محاولة النساء مثل هذه المحاولة، فقد رووا «أن أبي عتيق ـ وعائشة عمته ـ لقيها في بعض مآتي الطريق راكبة على بغلة فقال لها:
إلى أين يا أماه؟
قالت: أصلح بين حيين من أحياء المسلمين تقاتلا.
قال: «عزمت عليك إلا رجعت، فما غسلنا أيدينا من يوم الجمل حتى نعود إلى يوم البغلة».
2 ـ شجع الزعماء والأمراء على أن ينكروا عليها، فقد كتب إليها زيد بن صوحان رداً على كتابها إليه:
«سلام عليك أما بعد: فإنك أمرت بأمر وأمرنا بغيره، أمرت أن تقري في بيتك وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكون فتنة. فتركت ما أمرت به وكتبت تنهيننا عما أمرنا به والسلام».
فمضى الخطباء يحصون عليها تبلبلها وتناقضها، فبعد أن كانت تثير الناس على عثمان وكذلك طلحة والزبير، إذا بهم يخرجون جميعاً مدعين الطلب بثأره في أحرج الساعات العصيبة، وبذلك يسهلون سبيل العمل للانتهازيين النفعيين.
فحرب الدعاية التي اصطنعها علي وقذف بها خصومه، أثَّرت أثرها الكبير وفككت الوحدة في المعسكر الآخر. «فاعتزل بالجلحاء ـ من البصرة على فرسخين ـ الأحنف بن قيس، واعتزل معه زهاء ستة آلاف من بني تميم».
وعلى هذا الوضع فاجأهم علي بجنده «وفيه ثمانمائة من الأنصار وأربعمائة ممن شهد بيعة الرضوان، وكانت راية علي مع ابنه محمد بن الحنفية وعلى ميمنته الحسن وعلى ميسرته الحسين، وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر وعلى المقدمة عبد الله بن عباس. وزحف علي نحو الجمل بنفسه في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار ونادى بعقر الجمل فوقعت الهزيمة.
كانت معركة الجمل بدون ريب أو كادت تكون، هي المعركة الفاصلة، وأن تنقلب من حيث القيمة ثانوية وأن تعتبر حركة فرعية لتطهير بعض عناصر الشغب الباقية، خصوصاً والمقاومة الكفاحية آخذة بهذا الشكل من السرعة والدعاية الموفقة التي أشعرت الناس كافة بالاشمئزاز من شغب المشاغبين. بيد أن الحال تبدلت وجعلت لصفين الصفة الحاسمة الرئيسية لاعتبارات:
1 ـ استحالة فكرة العقيدة وروحيتها الأخلاقية عند علي إلى فكرة ثابتة، والفكرة عن الثوابت تصرف كل قوى المرء الروحية والمعنوية إليها، وتقف جهوده العملية في سبيلها ومدى غايتها فقد تركزت تركز الأعصاب، فصاحبها لا يفكر ولا يرى ولا يحس أو لا يحب أن يفكر وأن يرى وأن يحس إلاَّ في مواقع ميولها، كما لا يدبر ويقدر إلاَّ على ضوئها. لذلك لم تكن سياسة علي مشتقة من صميم الحياة كما هي بمساوئها، بل من روح الحياة كما ينبغي أن تكون بفضائلها. فهذا الرجل الذي عرفناه دموياً في قضية الانتصار للعقيدة، نراه شديد الكراهية لسياسة الدماء وأساليبها في قضية قمع حركات المتمردين، فهو يفرق جيداً بين الكفر والعصيان. ولكن وسطه لم يكن يفهم هذا الفرق فهماً حسناً ولا يفرق بينهما أبداً، فقد رأينا عثمان الخليفة يسمي تمرد أهل المدينة كفراً في كتابه إلى معاوية، ونرى كثيراً من الناس ينظرون إلى خصومهم نظرة الكافرين وبالتالي يجب أن يطبقوا عليهم أحكام الكفار وقانون الارتداد.
كان الجمهور متشبعاً بهذه الفكرة وما يترتب عليها ويلابسها، فإذا بعلي المتشرع العبقري والمسلم الواعي لحقيقة الإسلام يحمل على أساس هذه الفكرة لئلاَّ يتورط الناس في استباحة مقتضياتها القانونية، التي تخولها حالة الحرب في الأسرة والمال والملك والقيمة الشخصية، التي يتبع فقدها الأسر والاسترقاق وبين للناس بمنطقه العميق أن هناك صفة ثالثة هي الفسق وهو لا يبعد بالمرء أبداً عن دائرة الإيمان، كما لا تترتب عليه الاستباحة بل التأديب فقط.
وانظر كيف يستأتي إلى إقناعهم بخطأ فكرتهم حين قالوا: «أحل لنا دماءهم وحرِّم علينا أموالهم» فقال علي:
هي السنة في أهل القبلة.
قالوا: ما ندري ما هذا؟
قال: فهذه عائشة رأس القوم أتقسمونها فيما تقسمون من الأسرى؟
قالوا: سبحان الله آمنا.
قال: فهي حرام؟
قالوا: نعم.
قال: فإنه يحرم من أبنائها ما حرم منها ثم نادى في الناس: لا يسلبن قتيل ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يحل متاع. ولكن الجمهرة الكبرى ساذجة بسيطة في فكرة التدين، فوقع عليهم هذا النداء وقع اليأس في محل الأمل، وجعلهم يلغطون كثيراً ويتأففون كثيراً وحملهم على تفكير طويل فيما هو الفرق بين الكفر والعصيان، وفيما هو الفرق بينهما وبين الإيمان.
فأما أولئك البداة الأعراب الذين لم يفهموا الدين إلاَّ على شكل سطحي، استعصى على تفكيرهم فهم الفروق الدقيقة بينهما فمضوا على أنه لا فرق واقتنعوا بما انتهوا إليه. واشتملوا على نوع من التسخط الخفي كان غير مشعور به إلاَّ قليلاً، لأنهم بمقتضى نظريتهم حال الخليفة بينهم وبين حقهم في الغنم ومنعهم إياه. ومن هؤلاء كانت نواة الخوارج، وقد صاغوا فكرتهم هذه فيما بعد بأن مرتكب الكبيرة كافر.
وأولئك الذين صحبوا النبي طويلاً وعرفوا كثيراً من منطق الإسلام اشتملوا على اطمئنان كبير حينما أوضح لهم علي الفرق كما لو لمسوه.
2 ـ نظريته في خصومه أنهم مسلمون فلا يجوز أخذهم في غير حدود الإسلام وقانونه وذلك حين سأل الناس عن الخوارج «أمشركون هم؟».
قال: من الشرك فروا … قيل: فمنافقون هم؟
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلاَّ قليلاً. قيل: فما هم؟
قال: إخواننا بغوا علينا … وكان لا يفتأ يقول: «لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا: فسقوا وظلموا».
إذن فلا بدَّ أن يفاوضهم ولا بد من أن يلاينهم ما وسعه ذلك ووجد فيه أملاً، دون لجوء إلى العنف الذي لا يستحله إلاَّ بعد أن يعنتوه.
فنراه يفاوض معاوية ويرسل إليه الرسول بعد الرسول والكتاب تلو الكتاب، ويذكره بموقف أبيه منه، وإذا به يتهمه بالعقوق في رفق. قال في بعض كتبه إليه:
«وقد كان أبوك أبو سفيان أتاني حين قبض رسول الله، فقال: أبسط يدك أبايعك فأنت أحق الناس بهذا الأمر، فكنت أنا الذي أبيت عليه مخافة الفرقة بين المسلمين لقرب عهد الناس بالكفر. فأبوك كان أعلم بحقي منك، وإن تعرف من حقي ما كان أبوك يعرفه تصب رشدك وإلاَّ فنستعين الله عليك».
ولكن معاوية كان قد ساوره الطمع ولعبت أحلامه الكبرى أمام ناظريه، ولم يكن شيء من هذا خافياً على علي، بل كان ينظر ويبتسم فهو يريد أن يحل المشكلة القائمة ولكن على طريقته المثالية وبمنطق القانون الذي يقدسه. وعلي وإن لمس أن الظرف يتأزم عليه والوقت يتعقد، فإنه يريد أن يحارب حرب الحق وينتصر للعدالة بالعدل وإلاَّ فهو في نظره يخدع ضميره ويخدع الناس، إذا سمح لنفسه بانتهاك قداسة الحق بسبيل تأييد قضايا الحق.
عبد الله العلايلي
رأي جبران خليل جبران في علي (ع)
في عقيدتي أن ابن أبي طالب كان أول عربي لازم الروح الكلية وجاورها وسامرها، وهو أول عربي تناولت شفتاه صدى أغانيها على مسمع قوم لم يسمعوا بها من ذي قبل، فتاهوا بين مناهج بلاغته وظلمات ماضيهم، فمن أعجب بها كان إعجابه موثوقاً بالفطرة، ومن خاصمه كان من أبناء الجاهلية.
مات علي بن أبي طالب شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه، مات وفي قلبه الشوق إلى ربه. ولم يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره حتى قام من جيرانهم الفرس أناس يدركون الفارق بين الجواهر والحصى.
مات قبل أن يبلغ العالم رسالته كاملة وافية، غير أنّي أتمثله مبتسماً قبل أن يغمض عينيه عن هذه الأرض.
مات شأن الأنبياء الباصرين الذين يَأتون إلى بلد ليس ببلدهم وإلى قوم ليس بقومهم وإلى زمن ليس بزمنهم. ولكن لربك شأناً في ذلك وهو أعلم.
جبران
ما سمي بالشورى
خلافة إسلامية أم إمارة قرشية؟
لما أصيب عمر رضي الله عنه من طعنة أبي لؤلؤة جعل أمر الخلافة بين ستة أشخاص: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأمر أن يؤخذ بأكثرية الأصوات فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف. ثم وصف كل واحد منهم فعابه بعيب يكفي وحده لجعل الموصوف غير أهل للخلافة، ما عدا علياً فإن كل ما استطاع أن يقول عنه: إن فيه دعابة. وهذه صفة مدح أكثر من أن تكون صفة ذم. ثم اعترف له أنه لو ولي الأمر لحمل الناس على الحق الواضح وهذا القول لم يقله في أي واحد من الآخرين بل ألصق بهم العيوب المسيئة دون أن يذكر لهم حسنة واحدة.
ومع ذلك فقد كان تدبيره الذي دبر فيه أمر انتخاب الخليفة يؤدي حتماً إلى إبعاد علي عن الخلافة. ويكفي في ذلك أنه جعل صوت عبد الرحمن بن عوف هو المعمول به إذا تساوت الأصوات. ومعلوم أن عبد الرحمن بن عوف تربطه بعثمان صلات وثيقة من القرابة والمصاهرة فعبد الرحمن متزوج من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن عم عثمان وهي مع ذلك أخت عثمان من أمه. كما كان معروفاً أن سعد بن أبي وقاص لا يخالف رأي ابن عمه عبد الرحمن فكلاهما من بني زهرة وهكذا كان التدبير محكماً لأن يأتي عثمان ولكن مداورة. وسبب هذه المداورة أنه لم يكن من السهل مواجهة الرأي العام الإسلامي بترشيح عثمان رأساً مع وجود علي … فكان لا بدَّ من هذا الأسلوب ومن التدرج بالأمر وهو ما كان وما جرَّ الويلات بعد ذلك على الإسلام والمسلمين.
ولكي نعرف حقيقة شعور الشعب في ذلك الوقت وإنه كان مع علي وإن رجال قريش الذين حاربوا النبي من قبلهم وحدهم ضد علي، وبنفس العصبية والحقد اللذين حاربوا بهما محمداً حاربوا بهما علياً. لكي نعرف ذلك ننقل هنا مثلاً من الحوادث التي كانت تجري حين اجتمع الستة ليختاروا أحدهم والحوار الذي ننقله مأخوذ من تاريخ الطبري وغيره من كتب المؤرخين وهو بهذا النص الحرفي:
اجتمع الناس وكثروا على باب المنزل الذي فيه الاجتماع وكان هوى قريش في عثمان، فأقبل المقداد بن الأسود والناس مجتمعون وهم لا يشكون بأن البيعة ستكون لعلي فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقوله: أنا المقداد، إنكم إن بايعتم علياً سمعنا وأطعنا، وإن بايعتم عثمان سمعنا وعصينا.
فقام عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي «وهو من قريش وممن قاتل محمداً وآذاه» فنادى: أيها الناس إنكم إن بايعتم عثمان سمعنا وأطعنا، وإن بايعتم علياً سمعنا وعصينا، فقال المقداد: يا عدو الله وعدو رسوله وعدو كتابه ومتى كان مثلك يسمع له الصالحون؟. فقال له عبد الله: ومتى كان مثلك يجترئ على الدخول في أمر «قريش»؟.
فقال عبد الله بن أبي سرح: «وهو من قريش وكان من أشد أعداء محمد»: أيها الملأ إن أردتم أن لا تختلف قريش فيما بينها فبايعوا عثمان، فقال عمار بن ياسر: إن أردتم أن لا يختلف المسلمون فيما بينهم فبايعوا علياً.
ولكن عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان، فلما بويع عثمان قام عمار بن ياسر محتجاً. فقال له هشام بن الوليد بن المغيرة: ما أنت وما رأت قريش لأنفسها أنك لست في شيء من أمرها وإمارتها فتنح عنها.
وتكلمت قريش بأجمعها وصاحوا بعمار وانتهروه.
قال الشعبي وأقبل عمار ينادي:
| يا ناعي الإسلام قم فانعه | قد مات عرف وبدا منكر |
هذا ما حدثنا به التاريخ في صفحاته فماذا نستنتج من ذلك؟.
نستنتج منه أن الذين مهدوا للخليفة الثالث والذين أيَّدوه وأوصلوه إلى الخلافة كانوا يعتبرون أن الأمر الذي هم بصدده هو أمرة قرشية تسيطر فيها طبقة خاصة على جماهير الشعب وتستغله وتستأثر بخيراته دون حسيب أو رقيب. أما الشعب الذي عبَّر عنه المؤرخون ـ فيما تقدم من الكلام ـ بلفظة «الناس» وعبَّر عنه عمار بلفظة «المسلمون» أما الناس أما المسلمون أي الشعب فلا حق له حتى بإبداء الرأي وبالتذمر.
ما أنت وما رأت قريش لنفسها؟ هكذا جبهوا المجاهد القديم ابن الشعب عمار بن ياسر، إنها إذن قريش ترى لنفسها، وليس الأمر أمر خلافة إسلامية ودعوة محمدية، بل هو أمر إمرة قرشية، وأين كانت قريش يوم كان محمد (ص) يدعو الناس إلى الإسلام فيجيبه عمار وأبو عمار وأم عمار وأخو عمار ثم المقداد بن الأسود ومن هو في طبقة عمار والمقداد.
كانت قريش وعلى رأسها أبو سفيان تعلنها على النبي (ص) حرباً لا هوادة فيها أقل ما يناله فيها شتمه وإلقاء الأقذار عليه ومحاولة قتله وأقل ما ينال أتباعه أن تلبسهم قريش أدراع الحديد وتصهرهم في الشمس وتذيقهم العذاب ألواناً ثم لا تكتفي بالتنكيل بالرجال بل تربط المرأة بين بعيرين وتطعنها بالحراب حتى تموت.
هذا بعض ما جرى لآل عمار حتى ماتت أم عمار مشتومة مطعونة بحربة من حراب قريش فكانت أول شهيدة في الإسلام.
نعم هذا ما كانت تفعله قريش وعلى رأسها أبو سفيان فلما انتصر الإسلام وأثمر جهاد المستضعفين وصبرهم وإيمانهم، وأصبح الإسلام دولة ذات مغانم برزت قريش للسيطرة على الإسلام ودولته واعتبرته إمارة قرشية وصارت تقول لعمار وللجماهير الشعبية التي ينطق بلسانها عمار والمقداد: «إنك لست من أمر قريش وأمرتها في شيء فتنح عنها»، فلا عجب أن يهتف عمار:
| يا ناعي الإسلام قم فانعه | قد مات عرف وبدا منكر |
لأن الإسلام الذي هو قبل كل شيء عدالة اجتماعية وإنصاف وحق، لا فضل فيه لأحد على أحد إلاَّ بالتقوى والعمل الصالح، والذي لا مكان فيه لتحكم الظالمين واستثمار الشعب واحتكار المنافع، أصبح إمارة قرشية ثم صارت تستغله أسرة واحدة فتحارب رجاله الأولين وتقضي على مبادئه ودستوره، ولم يعد فيه مكان إلاَّ للظالمين المتنكرين للشعب وحقوقه، تستغله أسرة واحدة كانت أول من حارب الإسلام وآخر من سالمه حين لم تجد بداً من المسالمة.
وظلَّ عداء قريش يلاحق علياً أين اتجه لأنها كانت ترى فيه العدو الذي يمثل محمداً ورسالته أحسن تمثيل وترى فيه اليد التي قاتل بها محمد.
روى ابن الأثير في الجزء الثاني من تاريخه أن حديثاً جرى بين الخليفة الثاني وعبد الله بن عباس قال فيه الخليفة: «يا ابن عباس إن قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فاختارت «قريش» لأنفسها فأصابت».
وروى أبو سعيد الأبي في كتابه قال: «وقع بين عثمان وعلي كلام». فقال عثمان: «ما أصنع إن كات قريش لا تحبكم وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين رجلاً كأن وجوههم شنوف الذهب».
وروى الشعبي ما خلاصته: إن عثمان حين استشعر نقمة الناس عليه أرسل إلى علي جماعة فيهم زيد بن ثابت والمغيرة بن الأخنس الثقفي، فتكلم زيد وختم كلامه بقول: «وقد مشينا إليك نصيحة لك وكراهية أن يقع بينك وبين ابن عمك ـ أي عثمان ـ أمر نكرهه لكما».
وأجابه علي (ع) بقوله: «ما أحب الاعتراض ولا الرد عليه إلاَّ أن يأتي حقاً لله لا يسعني أن أقول فيه إلاَّ بالحق، ووالله لأكفن عنه ما وسعني الكف».
فقال المغيرة بن الأخنس: إنك والله لتكفن أو لتكفن (بالبناء للمجهول) «إلى آخر ما قال من مثل هذا الكلام وأوقح منه».
قال له علي (ع) من كلام له: «أأنت تكفني»؟…
أما المغيرة هذا الذي واجه علي بن أبي طالب بما واجهه فهو ابن الأخنس بن شريك وكان الأخنس بإجماع أهل الحديث من أكابر المنافقين في عهد النبي (ص) وذكروه كلهم في المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا يوم الفتح بألسنتهم دون قلوبهم وابنه الحكم بن الأخنس قتله علي (ع) يوم «أُحد»([190]) كافراً في الحرب، فجاء المغيرة بن الأخنس ينتقم لأبيه وأخيه ويشفي حقده على علي في ظل الإسلام وبرسالة من خليفة المسلمين. ونترك الكلام هنا للكاتب المصري أحمد عباس صالح الذي قال:
مجلس السبعة([191])
هو مجلس لم يكن موجوداً بصفة رسمية ولا بصفة غير رسمية في عهد الرسول، إنما هو مجلس أوجده عمر بن الخطاب ليتولى ترشيح الخليفة، أو اختياره بصورة أدق، وهذا المجلس لم يكن فيه من يمثل مصالح الشعب إلا علياً بن أبي طالب([192]) ولم تكن له وظيفة رسمية إلا اختيار الخليفة في مدة حددها عمر أيضاً هي ثلاثة أيام … أما فيما عدا ذلك فالخليفة يستشير في أمور الدولة من يستشيرهم سواء من هذا المجلس أو من غيره. وأياً كانت الدوافع التي دفعت عمر بن الخطاب لتشكيل المجلس بصورته هذه، فإنه كان مكوناً حين وفاة عمر من سبعة أشخاص لهم أن يشيروا وأن يطلبوا البيعة لأنفسهم فيما عدا عبد الله بن عمر الذي كان له أن يشير فقط ولم يكن له أن يرشح نفسه للخلافة هؤلاء السبعة كانوا: عبد الله بن عمر، وهو رجل «وقذته العبادة» كما قال عنه معاوية بعد ذلك. إذ كان أقرب إلى التصوف والتفرغ للعبادة منه إلى رجل الدولة والمناضل السياسي، وعبد الرحمن بن عوف وهو من أغنى الأغنياء يحرك أداة الحكم بواسطة غيره ولا يتصدر هو السلطة وخير من يمثل سراة قريش في هذا المجلس … وعثمان بن عفان وهو من سراة قريش وأحد أقطاب بني أمية ثم سعد بن أبي وقاص وهو من أغنياء قريش وأحد القادة الكبار في المعارك الإسلامية الهامة وهواه بالطبع مع غير علي، ثم الزبير بن العوام، وهو أيضاً من أثرى أثرياء قريش، ثم طلحة وهو أيضاً من سراة قريش وأخيراً علي بن أبي طالب.
ولنا أن نتصور موقف علي بن أبي طالب من زملائه الستة، أنه أحد الذين يختارون الخليفة وهذه مهة سهلة، ولكن الصعب أن يبدأ باختيار نفسه، وهو في نفس الوقت يعلم أن أحداً منهم لن يختاره فهم جميعاً في كفة من حيث هواهم السياسي، وهو وحده في كفة، وهذا لا يطعن في إسلام أعضاء مجلس الشورى، فكلهم من ذوي البلاء الحسن في الإسلام، ولكن وضعهم الطبقي ومصالحهم تجعل لهم مفهوماً خاصاً للعدل الاجتماعي يختلف مع ما يدعو إليه علي.
وإنه لمن الصعب على أي إنسان، وإن كان يتصدى للخدمة العامة، تصدياً يستهدف مصلحة الأمة أن يرشح نفسه في هذا الجو شبه المعادي.
والذي حدث أن أحداً لم يرشح علياً، «فيما عدا موقف الزبير» بل بدا أن الجميع يريدون ترشيح أنفسهم. ومن المتصور أن يطمح طلحة والزبير أو سعد بن أبي وقاص في الخلافة، ولكن هذا الطموح يصبح غريباً شيئاً ما في وجود علي بن أبي طالب الذي كان حزب كبير من أحزاب المسلمين يعتقدون أنه كان أولى بالخلافة من أبي بكر ثم أولى بها من عمر.
وليس هناك شك في أن كلاً من أعضاء المجلس يعتقد أنه أقل جدارة بالمنصب من علي. وأن منطق الحوادث ومركز علي في الإسلام، وميل غالبية المسلمين إليه، كل هذا قد يجعلهم يترددون كثيراً أو قليلاً في التفكير في منافسة علي بن أبي طالب في قيادة المسلمين.
على أن الذي حدث غير ذلك، فقد بدا أن الجميع يريدون ترشيح أنفسهم ومنافسة علي.
وهناك أيضاً ما يثير الانتباه بالنسبة للفتوحات الكبيرة التي تمت في عهد عمر … لقد سمعنا عن قيادات أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص. ولكننا لم نسمع عن قيادة لعلي بن أبي طالب. ولقد كان من السهل تفسير هذا لو أن علياً لم يكن محارباً من الطراز الأول. أما وعلي من أخطر فرسان المسلمين، بل أخطرهم على الإطلاق، فهو المحارب الذي لم يهزم أبداً، وهو الذي كان يتقدم للقتال عندما يبرز مقاتل من الأعداء ينهزم أمامه فرسان المسلمين فما أن تدور رحى المعركة حتى يبدو تفوق علي الخارق للعادة ويسقط العدو صريعاً. وعلي فعل ذلك وهو بعد فتى لم يتجاوز العشرين ثم استمر يفعله في كل المعارك التي خاضها المسلمون، وحين نشب القتال بينه وبين معاوية الذي كان يعد جيش الشام إعداداً مبيتاً لهذه المعركة الفاصلة انتصر علي حتى اضطرَّ جيش معاوية أن يرفع المصاحف على الحراب طلباً لوقف القتال والاحتكام إلى القرآن. فعلي محارب على رأس جميع المحاربين.
فما السر إذن في أن علياً لم يبرز في فتح من فتوحات الإسلام؟.
من المؤكد أن إبعاده عن القيادة الحربية في المعارك الهامة لم يأت اعتباطاً، فالواضح أن عمر بن الخطاب كان حذراً في كل خطوة يخطوها، وقصة عزله خالد بن الوليد وتولية أبي عبيدة بن الجراح قصة شائعة، وسواء أكانت انتصارات خالد، أم خلافه القديم مع عمر هو السبب في هذا العزل فإن هذه الحادثة تدل على شدة حذر عمر وحدة توقعاته للمستقبل.
كان إذن هناك تجنب لعلي وحزب علي في ميادين القتال، كما كان هناك أيضاً تجنب لهم في تولية المناصب. وعلي وحزبه منذ اللحظة الأولى رضوا بأن يكونوا حزب المعارضة فيبينوا الأخطاء وينبهوا إليها أو يقفوا ضد قرار يرون أنه مجانب للصواب. وهذا ما فعله حزب علي طوال حكم عمر.
فجو التجاهل من السلطة لعلي كان موجوداً. ولا شك أن تشكيل مجلس الشورى بصورته هذه تم عن قصد وتبصر من جانب عمر.
على أي حال فإن أعضاء المجلس بدوا كما لو كان كل منهم يريد خلافة المسلمين لنفسه. ولهذا تصدى عبد الرحمن بن عوف لينفرد باختيار الخليفة، إذ بادر بخلع نفسه ليكون في موقف المحايد.
وهنا أصبح هو صاحب الحق في أن يختار من بين زملائه الخمسة ولسنا ندري ما كان موقف علي من هذه المبادرة. إنما الواضح أنه سكت على مضض وترك الأمور تسير في طريقها فما من سبيل لتغيير اتجاهها.
واعتكف عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام وهي المدة التي حددها عمر للبت في أمر الترشيح وراح يجري اتصالات جانبية انتهت إلى أن يحصر الترشيح في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ليختار هو بينهما. طلب من علي أن يبايعه على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر فقال علي: لا … ولكني أحاول ذلك جهدي وطاقتي. وطلب من عثمان مبايعته على كتاب الله وسنَّة رسوله وفعل أبي بكر وعمر فقال: اللهم نعم … فبايعه … هذا ما ترويه القصة. فعلي أراد أن يحتاط لنفسه فيما يختص بفعل أبي بكر وعمر فرفض البيعة بلا تحديد. وأياً كانت الحقيقة فقد انتهى عبد الرحمن بن عوف أخيراً إلى ترشيح عثمان ومبايعته.
ولم يكن أمام علي إلاَّ أن يسلم بهذه النتيجة بعد أن بديت هذه البداية فاضطرَّ لمبايعة عثمان. لقد لعب حزبه دور المعارضة في أيام عمر فلا ضير أن يستمر هذا الدور في عهد عثمان، والحرب بين المعارضة والحكومة ستبدأ دون مساومات.
خلافة عثمان
وفي اليوم الأول لخلافة عثمان دخلت المعارضة المعركة بكل ثقلها وطلبت التحقيق في مقتل عمر عن طريق محاكمة عبد الله بن عمر … ومع أن القضية حفظت وانتهى الأمر، فإن هذه البداية كان لها معناها، وهي أن المعارضة ستقاتل بكل ما فيها من قوة.
أما السلطة بقيادة عثمان بن عفان فقد لجأت إلى الأسلوب التقليدي الذي يتبعه الحكم غير الشعبي في كل العصور، وهو إغراق الناس بالمال لضمان سكوتهم ورضائهم، ومثل هذا الحكم يفعل ذلك مرة واحدة، ثم يتحول بعد ذلك إلى الإفادة من هذا المال على أوسع نطاق.
لم يغير عثمان في سنته الأولى والياً من الولاة الذين عينهم عمر بل أبقاهم كما كانوا … وكانت الامبراطورية الإسلامية حينذاك تتكون من إحدى عشرة ولاية بما فيها المدينة، كانت مكة والطائف وصنعاء والكوفة والبصرة ومصر وحمص ودمشق وفلسطين والبحرين وما يتبعها هي الولايات التي تخضع للحكم المركزي في المدينة، وكان هناك عامل واحد على الجند هو الذي يتولى أمور التعبئة وتحضير الجيوش. وبهذا يكون جهاز الحكم الرئيسي مكوناً من أحد عشر عاملاً بخلاف كاتب الخلافة الذي كان يعتبر في مركز أقوى من مركز العمال أنفسهم…
وللقارئ أن يتصور ولاية كمصر يحكمها عامل من قبل الخليفة، ومع هذا العامل جميع الأجهزة التي تسير الدولة. على أن أكبر الولايات وأغناها كانت أربعاً: هي الكوفة والبصرة ومصر والشام.
في هذه الحكومة الكبيرة لم يفعل عثمان بن عفان شيئاً. لم يعزل عاملاً واحداً مدة سنة بأكملها، وكأنه هو ومستشاريه، كانوا يتحسسون الطريق للسيطرة على الامبراطورية.
كان أغلب هؤلاء العمال ليسوا من أمية إلاَّ معاوية بن أبي سفيان الذي كان والياً على دمشق، وسوف نرى بعد ذلك كيف سارت سياسة عثمان بالنسبة للولايات.
أما الخطوة التي استهل بها حكمه فهي زيادة أعطيات الناس. وهذه الأعطيات أشبه بالمرتبات أو المعاشات بصرف النظر عن الأعمال التي يزاولونها سواء كانت تجارة أو زراعة أو صناعة وهذه الأعطيات كانت تمنح نتيجة لبلائهم في الإسلام وتصرف بصفة دورية منتظمة.
وبالطبع أحدثت هذه الزيادة أثرها وسكنت من خواطر الناس وجعلتهم يسكتون عن أشياء كثيرة يستعدون لإثارتها ربما كان منها إثارة مسألة البيعة ذاتها أو مقتل عمر ومحاكمة عبيد الله ابنه لقتله الهرمزان وجفينة واتبع عثمان هذا الإجراء بإجراء آخر هو دعوة الوفود من الأمصار والولايات ليعطيها ويجزيها. ثم زاد على ذلك فضاعف لأهل المدينة عطاءهم في رمضان. ثم أصبح يقيم من بيت المال مآدب عامة يؤمها الناس. كل هذه التوسعة تمت في الأسبوع الأول من حكم عثمان بن عفان.
ولا شك أن هذه التوسعة أحدثت أثرها في عامة الناس فسكنوا إلى حكمه وزال ما كان يمكن أن يضمروه للخليفة الجديد.
وانتقل عثمان بن عفان من إرضاء المسلمين بالصلات والأعطيات والإجازات إلى خاصة المسلمين والقيادات الكبرى منهم على وجه خاص. فهذا هو يصل من بيت المال الزبير بن العوام أحد أعضاء مجلس الشورى وأحد المرشحين للخلافة بستمائة ألف … ووصل عضواً آخر في المجلس هو طلحة بمائتي ألف … ونزل له عن دين كان عنده.
ونحن لا نعرف لماذا وزعت هذه الصلات الضخمة من بيت المال ولماذا استأثر بها هذان الزعيمان دون غيرهما. إلاَّ إذا كان عثمان يرى أن يتألفهما لجانبه، وأنهما أقرب الأعضاء إلى هذا الاحتمال وسوف نجد بعد ذلك أنه يسترضي سعد بن أبي وقاص فيعينه عاملاً على الكوفة فلم يبق بعد ذلك إلاَّ عبد الرحمن بن عوف صاحب المال الوفير وعبد الله بن عمر وهو رجل زاهد، ثم علي بن أبي طالب.
ولا شك أن علياً لم يوافق على هذه الصلات المبالغ فيها والتي ليس لها معنى إلاَّ تبديد مال المسلمين وتسخيره، في الأغراض السياسية.
وما أن مضى العام الأول من خلافة عثمان حتى كان الجو مهيئاً لتوزع الولايات على بني أمية وعلى من يقول بقولهم.
عين الوليد بن عقبة بن أبي معيط «وآل أبي معيط هم آل عثمان» والياً على الكوفة. والوليد هذا رجل مشكوك في إسلامه فقد ارتدَّ ثم عاد فأسلم وكان دائماً محل شك في عامة المسلمين ومن النبي حتى أنه نزل قرآن فيه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾. وهذا الفاسق هو الوليد بن عقبة نفسه.
وبالطبع كان ذهاب الوليد إلى الكوفة مصدر قلاقل ومتاعب لم يلبث عثمان أن عزله ليضع مكانه رجلاً آخر من بني أمية هو سعيد بن العاص. ورجلاً آخر من أقاربه هو عبد الله بن سعيد بن أبي سرح والياً على مصر. وهو أيضاً من المشكوك في إسلامهم فقد كان من الذين سخروا من النبي وقاوموه أشد المقاومة واشتهر عنه أنه كان يقول ساخراً من القرآن: «سأنزل مثل ما أنزله الله». وكان من الذين أهدر الرسول دمهم لولا أن جاء به عثمان للرسول مسلماً.
وهكذا سار عثمان في الولايات هذه السيرة يعزل هذا ويعين ذاك ليسيطر حزبه تماماً على الحكم، كما ظهرت في عهده وبالقرارات التي أصدرها الملكيات الكبيرة، وتحولت الدولة إلى نظام جديد للأغنياء وذوي العصبية من قريش عامة ومن بني أمية خاصة([193]).
موقف المعارضة
ولم تسكت المعارضة بل مضت تعبئ الجماهير، وتهاجم الخليفة صراحة، ورأينا في هذه الحملات علياً يتصدر المعارضة … ورأينا عمار بن ياسر وأبا الدرداء وعبد الله بن مسعود وأبا ذر الغفاري، ثم محمد بن أبي بكر ومالك الأشتر وغيرهم كثير ممن يكونون الدعامات الشعبية أو ممن التقت مصالحهم مع الشعب يهاجمون سياسة عثمان هجوماً عنيفاً.
وقد جاهر عمار بالهجوم على الخليفة، كما جاهر أبو ذر باتهام الخليفة وعماله بالخروج على شريعة الإسلام وراح يحض الأغنياء على أن يطرحوا كنز المال ويعدد لهم الآيات القرآنية والسنَّة النبوية حتى نفاه عثمان إلى الشام ليكون تحت رقابة معاوية الذي خلص له حكم الشام كله في عهد عثمان حيث كانت له ولاية دمشق وحدها في عهد عمر، والذي كان يخوف به عثمان خصومه ومعارضيه، وعند معاوية وقف أبو ذر أمام قصر الوالي الجديد «الخضراء» ليهاجم ذلك الإسراف في استغلال المسلمين، وليهدد بأنه حتى الآن يوجه الخطاب إلى الأغنياء، وإنه من غده سيوجهه إلى الفقراء ليقوموا بالثورة، وأوذي أبو ذر في سبيل ذلك إيذاءاً كثيراً حتى انتهى به الأمر إلى النفي وحرمانه من العطاء ففقد أبناءه واحداً واحداً وكان يمضي أياماً بلا طعام.
ومات أبو ذر في صحراء الربذة وحيداً مع زوجه العجوز لا يملك إلاَّ عنزة والقليل البالي من الثياب.
وما حدث لأبي ذر حدث لغيره من رجال الشعب، فكان هذا كله تنبيهاً للرأي العام ودعوة إلى الثورة.
وكان محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر في مصر يدعوان إلى مثل ما دعا به أبو ذر. ويقال: إن عمار بن ياسر انضمَّ إليهما في مصر ودعا دعوتهما ولعمار مكانة في الإسلام.
أما في الكوفة فكان هنالك مالك الأشتر وهو صاحب الخطاب الناري الذي وجهه إلى عثمان يتهمه بالجور والظلم، والذي لعب دوراً كبيراً في إقصاء سعيد بن العاص، والي عثمان عن الكوفة وسوف نرى مالكاً بعد ذلك في مواقفه العديدة إلى جانب زعيم الشعب علي بن أبي طالب.
كان السخط عاماً إذن في المدينة …. يجرؤ عثمان على ضرب وإهانة كبار الصحابة وخاصة صحابة النبي الأوفياء من الذين يرون في تطبيقات عثمان للإسلام حيدة عن أصوله. كما كان السخط في الكوفة على أشده وفي مصر زاد الغليان وأصبحت الثورة أمراً لا بدَّ منه حتى تأخذ عدالة الإسلام طريقها إلى التنفيذ. ولكن الأمر لم يكن سهلاً. فلقد ضرب الفساد في كل الأرجاء واختلطت القيم السامية بالأخلاق الوضيعة واخترعت القصص لتجريح زعماء الشعب وضعف من ضعف من المناضلين تحت تأثير المال والمتاعب، وصار الصراع حول المناصب والجاه هو أساس كل شيء وأصبح المناضلون في دوامات بين التزام الجادة أو المشي مع التيار واستغلَّ الحزب الحاكم هذا كله ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يفرق شمل المعارضة تماماً … وفي نفس الوقت لم تكن العناصر المعارضة لحكم عثمان كلها شعبية، إذ كان هناك الذين فاتتهم المناصب، أو الثروة والأعطيات والصلات.
حركة المصريين
لسنا نعرف كيف دبرت الثورة، أو على الأقل هل تمت بخطة وتدبير أم جاءت تلقائية نتيجة للسخط العام. ولكن المؤكد أن الرسائل كانت توجه من المدينة من كبار أصحاب النبي إلى المقيمين في الأمصار من المسلمين بأن الجهاد الحقيقي من أجل الإسلام لم يعد في فتح الثغور والأمصار بل في إزالة الحكم المنحرف وإسقاطه. وإقامة حكم جديد على أساس سليم من كتاب الله وسنة رسوله.
ومن المحتمل أن هذه الرسائل كانت تتلى في المحافل، أو في اجتماعات سرية، وتحدث أثرها المعنوي الكبير فأصحاب هذه الرسائل لهم من المنزلة والمكانة في الإسلام ما لعثمان نفسه إن لم تزد.
والطريقة التي جاء بها المصريون إلى المدينة تدل دلالة قاطعة على أنهم قد فكروا ودبروا حتى لا يمنحوا للخليفة فرصة الاستنجاد بجيش من الشام أو من غيرها لمقاومتهم. فقد خرجوا على أنهم ذاهبون للعمرة. فإذا بهم يذهبون إلى المدينة رأساً في عدد يقارب الألف وهناك يستقبلهم عثمان ويجادلهم ويجادلونه فيعد أنه سوف يقلع عن الأخطاء التي ارتكبها. وسوف يعزل الولاة الذين نهبوا ثروة المسلمين ووطأوهم بالأقدام وفرقوا شملهم. وذهب الوفد عائداً ومضى الوقت ولم يغير عثمان عن سياسته ويقال إنه بعد أن وعد واستعبر غير رأيه كاتبه وزيره ومستشاره مروان بن الحكم بن عم عثمان وابن الرجل الذي حارب النبي وأذاه حرباً عنيفة قاسية حتى رفض النبي أن يساكنه مدى الحياة بعد أن أتى به عثمان مسلماً، إذ أنه بعد إسلامه الخادع لم يكف عن إيذاء النبي والسخرية به. على أن الأرجح أن عثمان صرف وفد مصر ريثما يفكر ويتأمل، ولعله ظنَّ أن هذه الثورة لن تلبث أن تنطفئ أو لعله فكَّر في الانتقام من زعمائها، وقد أمسك وفد المصريين خادماً خاصاً للخليفة ومعه كتاب منه لعامله على مصر أن يفتك بقادة المصريين. ولكن ماذا ينتظر الخليفة وقد بدت بوادر الثورة في شكل تجمعات لأول مرة، وأصبحت نذرها واضحة، إذا كان سَيَفي بما وعد فله الحق ألاَّ يتخذ من الإجراءات ما يحميه من هذه الثورة، وإن كان أخذ بمشورة مروان بن الحكم، فتنصل من وعده وترك الأمور تسير سيرها الأول ـ وهذا ما حدث ـ فكان المنطق يقتضي أن يأخذ حذره من ثورة مؤكدة ظهرت بوادرها في الجدل الذي ثار بينه وبين الوفد واضطرَّ فيه أن يبذل الوعود.
ولعل عثمان لم يكن يتوقع أن تصل الثورة إلى ما وصلت إليه فيما بعد … ولعله كان يعتقد أن معاوية وعبد الله بن أبي سرح وغيرهما سوف ينجدانه عندما يتحزب الأمر. فكان في مركز قوة تجعله لا يأخذ حيطته الكافية. على كل حال فإن تلك الرسالة ليست شيئاً بعيداً عن الاحتمال، فقد كان عثمان ينفي الثائرين ضده، وقد كان يأمر بضربهم ضرباً مبرحاً على علو مكانتهم في الإسلام. وكان يرسل بعضهم لمعاوية حتى يعاقبهم ولعبد الرحمن بن خالد ليذلهم ويكسر شوكتهم فمثل هذه الرسالة ليست بمستبعدة.
والذي حدث من المصريين أنهم انتظروا حتى يفي الخليفة بوعده فلم يف. ولا شك أن أهل الكوفة وقد استطاعوا أن يعزلوا عامل الخليفة ويصروا على تولية أبي موسى الأشعري، قد عرفوا بما دار بين المصريين وبين عثمان. وانتظروا كما انتظر المصريون فلما لم يتحقق شيء من وعد عثمان بدأوا يستعدون هم أيضاً لمواجهته، وربما تم الاتفاق لخلعه. فحديث الخلع كان شائعاً، وقد ردَّ عليه عثمان في أكثر من مناسبة، زاعماً أن قميص الخلافة قد كساه الله إياه، فلا يملك خلعه عنه إلاَّ الله، متناسياً أن الله قد ترك للناس تصريف أمور دنياهم.
تكاتف إذن أهل الكوفة وأهل مصر، ومن المؤكد أن كثيرين من أهل المدينة تكاتبوا وأهل هذين البلدين فجاءت الوفود من الكوفة والبصرة ومصر وذهبوا إلى المدينة ليخلعوا عثمان.
ويقال أن علياً بن أبي طالب والزبير بن العوام وغيرهما من كبار المسلمين وقد عسكروا بأصحابهم حينما علموا بمقدم الوفود مما دفع هذه الوفود إلى إظهار العودة، حتى إذا سكن علي وأصحابه إلى بيوتهم عادوا فدهموا المدينة واحتلوها بغير قتال.
وهذه الواقعة مشكوك فيها، فالأمور لا تمضي بهذا الشكل الهين، وليس من المعقول أن تنطلي مثل هذه الحيلة على كبار المسلمين والتي يقال أن الوفود قد احتالت بها لتحتل المدينة دون قتال … ولقد ناصب علي العداء لعثمان ولامه وهاجمه، بل رفض الوساطة بين الثوار وعثمان بعد أن توسط في وفدهم الأول فخذله عثمان إذ لم يف بعهده.
إنما الأرجح أن علياً قد جلس يترقب ما يحدث محاولاً أن يخفف من ثائرة الثوار، وأن يوفق إلى خلع عثمان دون لجوء إلى إراقة الدماء. ولذلك كان يتصدى للثوار مهدئاً ومقنعاً كما كان يتصدى لعثمان ناصحاً وموجهاً … حتى إذا اعتلى عثمان المنبر ليخطب في الوفود. عنف الثوار وقام قوم من أنصاره يدافعون عنه فهبَّ الثوار فأقعدوهم عنوة، ثم انتهى الجدل إلى أن حصبوا بعضهم بعضاً حتى أصيب عثمان نفسه وغشي عليه وحمله أصحابه إلى بيته. فحاصر الثوار البيت إلى أن وقعت الواقعة وقتل الخليفة في بيته.
إن الثورة إذا اشتعلت لا يستطيع أحد إيقافها، وهذا ما حدث بالضبط ومن المؤكد أن علياً لم يكن يريد أن تتطور الأمور إلى سفك الدماء وكان يكره أن تكون هذه سابقة في الإسلام لها ما يليها من آثار. ولذلك قد بذل جهداً حقيقياً للإمساك بزمام الثورة وأرسل ولديه للحفاظ على حياة الخليفة يدافعون عنه مع المدافعين، إلاَّ أن الحوادث انفلت عيارها ولم يكن بد من النتيجة الحتمية وهي القضاء على الخليفة.
وقد أسفرت الثورة عن نتائجها، وحققت هدفها الأول وهو تولية زعيم الشعب علي بن أبي طالب، ليبدأ الإسلام يسترد سيرته الأولى وتمضي الثورة الاجتماعية في الطريق التي رسمها الرسول.
ثورة الشعب
من الصعب أن نتابع التطور السياسي والاجتماعي في المجتمع العربي دون أن نمسك دائماً بالخيوط الأولى لطرفي الصراع، تلك الخيوط التي نسجت في وقت مبكر جداً، وقبل الدعوة الإسلامية، والتي خلقتها الظروف الاجتماعية والفكرية في تلك المدينة التجارية الشهيرة مكة … وعلى أساسها تشكلت قوى الصراع، حتى انطلقت الدعوة الإسلامية لتكون عقيدة الفقراء والمستضعفين، وسلاحهم الثوري، ودليل عملهم في نضالهم من أجل حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
والدعوة الإسلامية لا تختلف عن أي ثورة كبرى من الثورات التي عرفتها الإنسانية، في أنها تنطوي على جانبها المادي، كما تنطوي على جانبها الروحي، وقد تبدأ الشرارة بمحركات قاهرة من الواقع الأليم، ولكنها تنطلق دائماً من هذه البداية المتواضعة لتصوغ فكراً إنسانياً شاملاً يمتد إلى كل نشاط إنساني. إن الثورات الكبرى لا تحدث لتعيد توزيع الثروة توزيعاً عادلاً فحسب، بل إنها تبني هيكلاً روحياً وفكرياً وفلسفة جديدة تمضي بها البشرية جميعاً خطوات على طريق التطور.
ومن هنا تنتقل الثورات من بؤرة ميلادها إلى كل مكان في الأرض … ولهذا فكل ثورة حقيقية هي بالضرورة ثورة عالمية.
ولا ينقص هذا أو يضعفه محلية الأوضاع التي تنطلق منها الثورة، لأن الثورة التي تستحق هذا الاسم ليست تعديلاً في المراكز الاقتصادية والاجتماعية في بيئة معينة أو ظروف معينة، بل تعديل جذري لحياة الإنسان وفكرته عن العدل والحرية والكرامة، ونزوعه الأزلي للاتصال بالفكرة العليا التي تجمع هذا كله. فكرة الله.
إن الانطلاق من الأوضاع الاجتماعية لا يعني انحصار الثورة في إطار هذه الأوضاع، بل إنه من الصعب أن نميز في العمل الثوري جانبه الاجتماعي من جانبه الفكري، أو الروحي فكلاهما متداخل، تداخل معنى الحق والحرية والعدل في معنى الله ورمزه، وكل منحى إلى الخير الجزئي هو منحى إلى الخير المطلق. إلى الله.
كان حزب العدل الاجتماعي في صدر الإسلام هو الحزب الأكثر إيماناً بالإسلام والأقرب الى روحه، والأشد تمسكاً بمبادئ الإسلام، ولهذه الاعتبارات أيضاً كان أقل الأحزاب المصارعة قدرة على التآمر وسفك الدماء حتى من أجل نجاح فكرة العدل والحرية، فمن كانت له المثل العليا من أهدافه يستحيل عليه أن يتوسل إليها بأساليب تتنافى مع المثل العليا.
ومن ناحية أخرى نجد أن الأحزاب التي تزدري الجماهير وتؤمن بالتسلط والامتياز والاستئثار بالثروة سريعة العمل مطلقة اليد والفكر، ترتكب ما تشاء من الجرائم دون لحظة تردد مما يكسبها النصر السريع وهي في نفس الوقت تشترك في سمة واحدة، فأغلب قادتها من الخصوم الأشداء للإسلام. ومن الذين استسلموا للدين الجديد حين لم يكن هناك بد من الاستسلام، فهم من المهدر دمهم لما ارتكبوا من جرائم ضد الإسلام ثم عفا عنهم نبي الإسلام، ومن الطلقاء ومن المتأخر إسلامهم.
وإذا حاولنا أن نحصي أسماء قيادات الحزب المتسلط باستثناء عثمان بن عفان ونفر قليل من كبار المسلمين الأوائل وجدنا أن الذين تولوا السلطة فعلاً في عهد عثمان ممن تنطبق عليهم صفة الطلقاء وأبنائهم أو ممن وقفوا من الإسلام موقف خصومة، وعداء حتى كسرت شوكتهم وأعلنوا إسلامهم نفاقاً.
وقد ينساق إلى قيادة هذا الحزب بعض المسلمين الكبار الذين كانت أوضاعهم الاجتماعية قبل الإسلام وبعده أوضاعاً ممتازة من حيث الثروة والمكانة الاجتماعية، وهؤلاء من حسن إسلامهم لم يستطيعوا التخلص تماماً من تأثير أوضاعهم عليهم فتحددت رؤيتهم الإسلامية للعدل الاجتماعي وضاقت حدودها فكان هواهم مع الأحزاب المتسلطة، وكانت هذه الأحزاب تستغل شهرتهم وحسن بلائهم وتنافسهم فيما بينهم أحسن استغلال في شدهم إليها وضمهم إلى صفوفها.
ولقد كانت للفتوحات الإسلامية الأولى تأثيرات واسعة النطاق على الجيش الإسلامي، إذ فتحت أمامهم الثغور واحتلوا من الممالك ما لم يحتله في عصرهم غيرهم من الأمم العريقة. ولهذا اتسعت أمامهم الغنائم، وبدأ الصراع على الأسلاب وتصدرت السياسة مكان الحق ولكنها لم تستطع أن تنفرد بالتصرف دون أن تستند إلى مزاعم من الدين.
لقد تغيرت الأوضاع الاجتماعية إذن، لم يعد طرفا الصراع الأساسيين هما تجار مكة وأثرياؤها ضد فقرائها ومستضعفيها بل أصبح من الاتساع بحيث شمل ملايين من البشر بمختلف طبقاتهم وميولهم، وأصبح المقاتلون المسلمون فاتحين مسيطرين لا مجرد مستضعفين أو فقراء. وهذه هي الصعوبة في الأمر. فالدافع الاجتماعي لثورة الشعب اختفى تقريباً، فما من رجل مسلم من المستضعفين لا يستطيع أن ينضم إلى جيش من هذه الجيوش، أو لا يستطيع أن يغنم من غنائم الحرب.
ودعوة الشعبيين إلى تطبيق العدل الاجتماعي لا تجد لها سنداً إلاَّ فيما يستطيع أن يقنع به الفكر والعقيدة عقل الإنسان، وأخلاقيات معينة يكونها الدين الإسلامي في نفس معتنقيه. ولكي تحدث هذه الأخلاقيات أثرها ينبغي أن يصل الإنسان إلى أعلى مراتب الفكر، وأعلى مراتب الخلق الإنساني وهو أمر لا يتوافر في جميع الناس.
واستغلَّ الحزب المتسلط في خلافة عثمان هذه الأوضاع فوسع فيها ما استطاع وأغدق على المحاربين وهم القوة الضاربة في أي ثورة، وترك الخلاف المذهبي يأخذ مجراه، مطمئناً إلى أن الغلبة في النهاية لحكم الأوضاع الاجتماعية على القيم الروحية والأخلاقية.
وجاء المتسلطون في خلافة عثمان فأطلقوا الملكيات ولم يقيموا عليها حدوداً ما. وأصبح الحكم مستقراً لولا أنه تجاوز قيادته الحزبية إلى نعرة قبلية فمكن لآل أبي معيط ولآل أمية على رؤوس غيرهم من القبائل. وأصبح يحصر القيادة والسلطة في تلك القيادة التي كانت تتصدر فيما مضى المشركين ضد المسلمين. ومع ذلك فقد كان هناك المعدومون وأصحاب الثروات الطائلة.
ووجد الشعبيون الأحرار أنهم يدعون للثورة أنماطاً متعددة من الناس. الأثرياء المبعدون عن المناصب، رجال الجيش غير المقربين، أو غير المنتمين إلى أمية وأحلافها، كبار الصحابة الذين لم يعد لهم يد فيما يجري من أمور الدولة، وفي النهاية الجماهير التي لم يكفل تماماً حقها في الرزق.
ونستطيع القول بأن الشعبيين الأحرار وجدوا حولهم حلفاء لم يكن يتوقع أن يعقدوا معهم حلفاً. بل ولم يكونوا يريدون أن يعقدوا معهم حلفاً. ولذلك سنرى دائماً أن كثيراً من زعماء الانقلابات في ذلك العصر يتأرجحون بين الخير والشر في سرعة عجيبة، وسنجد أن قاتل ومشتت العلويين فيما بعد رجل كان إلى جانب علي في بداية ثورة الشعب.
وفي هذا الصراع كان الشعبيون الأحرار يأملون أن يمسكوا بدفة الحكم، ويوجهوها وجهتها الإسلامية الصحيحة، ويبدو أنهم لم يحسبوا حساب كل هذه القوى المتعارضة التي انضمت إلى صفوفهم لأغراض متفاوتة.
وحين نتحدث عن بداية ثورة الشعب، سنجد أن غالبية كبار المسلمين في المدينة كانوا يضيقون بسيرة عثمان وحاشيته في الحكم، رغم أن عثمان أغدق عليهم من بيت المال الثروة الوفيرة، سنجد أن طلحة والزبير من بين المحرضين على الثورة ضد عثمان. ثم ينقلبان فجأة بعد مبايعة علي بالخلافة يحاربان ضده. وسنجد أن عائشة تهاجم عثمان وتحض على الثورة ضده، ثم تتحول إلى حرب علي مع طلحة والزبير.
لم تكن القوى الثائرة ضد عثمان متوحدة فكرياً، ولم تكن دوافعها للثورة دوافع مشتركة.
وإلى جانب هذا فالثورة لم تمتد إلى قلب البلاد المفتوحة أو إلى شعوبها. فحين نسمع أن الذي بدأ الثورة على عثمان هم المصريون لا يخطر على بالنا الشعب الذي يسكن مصر منذ قديم الزمان، بل قادة المسلمين الذين استقروا في مصر، ومن البديهي أنه لم يكن من المستطاع أن تدخل شعوب الدول المغلوبة في هذا الصراع السياسي. أولاً لأن غالبيتها لم تدخل في الإسلام في أول عهود الفتح، وثانياً لأنها لم يمض عليها وقت طويل يتحقق فيه الاندماج في العالم الجديد، بحيث يصبح ركناً أساسياً تؤثر فيه وتتأثر به، وكذلك القول عن غير مصر.
على أن الأمر لا يخلو من ظهور بعض أبناء هذه الولايات في الجو السياسي ولكنه ظهور محدود الأثر ويكاد يكون معدوم القيمة.
وهنا يتردد اسم عبد الله بن سبأ وهو شخص قيل أنه كان يهودياً وأسلم، تصوره بعض كتب التاريخ على أنه كان الشيطان وراء الفتنة التي قتل فيها عثمان، بل وراء الأحداث جميعاً …. وقد وقف منه الكتاب مواقف متعارضة فمنهم من ينكر وجوده أصلاً، ومنهم من يعتبره أساس في كل ما جرى بل اساس ما دخل في الإسلام من مذاهب غريبة منحرفة.
وعبد الله بن سبأ شخص خرافي بغير شك، فأين هو من هذه الأحداث جميعاً، وأين هو من الصراعات الناشبة في هذا العالم الكبير المتعدد … وماذا يستطيع شخص مهما تكن قيمته أن يلعب بمفرده بين هذه التيارات المتطاحنة. إن الأحداث السريعة العنيفة المتلاحقة لم تكن في حاجة إلى شخص ما حتى ولو كان الشيطان نفسه لأن أصولها بعيدة الغور وقوة اندفاعها لا قبل لأحد بالسيطرة عليها أو توجيهها فضلاً عن تشابكها أو تعددها بما لا يدع لأي قوة أن تزيدها تعقداً.
وساذج بغير شك التفكير الذي يتجه إلى خلق شخصية خرافية كهذه ليعطيها أثراً أي أثر فيما حدث من أحداث. وأكثر سذاجة منه من يظن لهذا الرجل تأثيراً على كبار الصحابة ومنهم أبو ذر الغفاري نفسه الذي لم يقبل مناقشة من أبي هريرة المحدث المعروف فضربه فشجه. إنما كل ما حيك من قصص حول عبد الله بن سبأ هو من وضع المتأخرين فلا دليل على وجوده في المراجع القديمة فضلاً عن وجوده أصلاً.
الكتل المتصارعة إذن لم تكن متجانسة، ولم تكن من عناصر غير العناصر العربية، فأهل مصر الثائرون هم من قادة العرب الذين أقاموا فيها. وأهل الكوفة والبصرة والشام كلهم سواء في أنهم رجال الجيش، أو السياسة من العرب، الذين أقاموا فيها وليسوا هم من أبنائها الأصليين.
والذي حدث أن اتجهت أكثر من قوة سياسية إلى إسقاط عثمان وكانت الكتب تنطلق من المدينة إلى الثغور لتحدث الجيش والقادة السياسيين على أن يتجهوا إلى المدينة لإسقاط عثمان وخلعه، وهذه الكتب من عناصر مختلفة ليست من الشعب، بل لم تقف بعد ذلك إلى جانب الشعبيين الأحرار.
ومن الصعب ـ ولم يمض على الإسلام إلاَّ فترة وجيزة ـ أن يتنازل المسلمون بسهولة عن المبادئ الإسلامية، وكان علي بن أبي طالب يمثل في نظر غالبية المسلمين الرجل الوحيد الأقرب إلى روح الإسلام وأصوله الصحيحة. ولكنه في نفس الوقت يمثل السياسي المتشدد، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين من القادة والطامحين والمستفيدين ينظرون إلى تولية علي بن أبي طالب نظرة حذر وتردد. وأصحاب المصالح أولى بهم أن يتخوفوا من علي وأن يعملوا جهدهم أن لا يصل إلى الخلافة.
وعلى ذلك فمجيء علي إلى الخلافة هو أمر دونه القتال.
والعوامل التي دفعت إلى الثورة على خلافة عثمان عديدة بتعدد أطرافها وبعضها كان خفياً استتر وراء خروج عثمان ومعاونيه على الأصول الإسلامية وهو الشعار العام الذي اتخذته الثورة وهو الموضوع الذي ناقشه أهل المدينة مع عثمان في المسجد. وهو نفسه الذي ناقشه أهل مصر حين وفدوا على المدينة في المرة الأولى يطلبون من عثمان أن يحق الحق ويتبع ما يوصي به الإسلام من مبادئ.
وتحت هذا الشعار الكبير «العودة إلى المبادئ الإسلامية الصحيحة» من حيث إعطاء كل ذي حق حقه، ومن حيث تساوي المسلمين في الحقوق ومن حيث عدالة الإسلام الاجتماعية التي عمل على تحقيقها رسول الله (ص) من قبل ودعا إلى إتمامها علي بن أبي طالب وحزبه من بعد، كل هذا كان شعار الثورة، وفي كل مناسبة تجادل فيها المعارضون مع عثمان كانت المناقشة تدور حول هذه المعاني، بل أن كتب التاريخ تحفظ لنا الكثير من المناقشة التي دارت بين عثمان وأبي ذر الغفاري قبل الثورة حول عدالة الإسلام الاجتماعية كما تحفظ لنا ما جرى بين علي بن أبي طالب وعثمان في هذا النطاق أيضاً، وكذلك المناقشات بين عمار وعبد الله بن مسعود وغيرهما من زعماء الشعب، وبين عثمان.
وهذا هو المعنى العام الذي التفت حوله الثورة، وتذرعت به. وهو الذي كان يمثل اتجاه الرأي العام لدى المسلمين. ومع ذلك فقد كانت تختفي تحت هذا المعنى أغراض كثيرة ومصالح تتفق مع أصحاب هذه النظرة في إسقاط عثمان وتختلف معهم في أنهم لا يريدون أن يمضي العدل الاجتماعي إلى أقصى مداه.
فهناك الذين حرموا من المناصب لاستئثار بني أمية بها، ومنهم عمرو بن العاص نفسه الذي عزل عن ولايته ليتولاها بدلاً عنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح قريب عثمان، وما يظن أحد أن عمرو بن العاص كان موافقاً لسياسة علي وحزبه، ومواقفه جميعاً تنأى به عن أن يكون ذا هدف اجتماعي في خلع بيعة عثمان. وهناك معاوية نفسه الذي أثار تقاعسه عن نجدة عثمان تساؤل الكتاب والمؤرخين.
فسواء كان هذا التقاعس مبيتاً أو مدبراً فإنه كان يفتح ثغرة إلى الخلافة أمام معاوية أو جاء نتيجة عدم تقدير طلحة والزبير اللذان كانا يطمعان في الخلافة، وهما قد أرسلا إلى القادة في الثغور ليعودوا إلى المدينة حيث يحتاج الكفاح في سبيل الله إليهم أكثر من حاجتهم إليهم في الثغور.
أغراض أخرى متناقضة للشعار العام الذي سارت به الثورة ولكنها جمعت أصحابها حول الثورة وتكاتفت جميعها لخلع بيعة عثمان.
كان الجميع يحاولون الاستفادة من الموجة الثورية العارمة، وكل حسب ظروفه وقدراته.
أما بالنسبة لعلي وحزبه فإن الأمر كان مختلفاً، فهذا الحزب هو الذي تولى المعارضة الهادئة في عهد أبي بكر وعهد عمر ثم المعارضة العنيفة في عهد عثمان، فقد كان أعضاء هذا الحزب لا يعملون في الخفاء بل كانوا يخطبون جماهير المسلمين في المساجد والأماكن العامة مهاجمين هذا العهد ومذكرين أصحابه بوجوب العدول عن سيرتهم فيه لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله، ولقد انتشروا في كل البقاع، انتشروا في الشام نفسها ولاقوا فيها عنتاً شديداً. وقد عرفنا كيف أوذي أبو ذر في الشام ولا نظن أن أبا ذر كان الداعي الوحيد ضد هذا الحكم. فقد رأينا رجالاً غيره يجهرون في حضرة معاوية بالجدل الحاد فلا يملك معاوية إلاَّ أن يسكت بل أن يتمشى معهم تقية وانتظاراً للحظة المناسبة، وما حدث في الشام حدث في مصر وفي الكوفة والبصرة بل وفي المدينة أيضاً.
وإذا كانت هناك مكاتبات سرية بين كبار القادة المسلمين وبين قادة الجند في هذه الأمصار، فإننا لا نستطيع التأكد من أن الثورة دبَّرت ورسمت خطوطها بواسطة حزب علي.
من المؤكد أن قادة الثورة قد دبروها، وحسبوا حسابها، فهذا واضح من طريقة خروجهم من مصر، وواضح من طريقة عودتهم المفاجئة.
أما إن علياً كان على علم بهذا التدبير ومشتركاً فيه فهذا ما لا يستطيع أحد إثباته، ولكن رجلاً كعلي لا يمكن أن يرسل ولديه الحسن والحسين ليكونا إلى جانب عثمان في حصاره في بيته، وهو مدبر للثورة عليه.
لقد جاهر علي عثمان بالرأي المضاد القوي، في أكثر من مناسبة، بل وبمناسبة وفود الثوار، إلاَّ أنّه لم يخرج من هذا النطاق إلى المشاركة الإيجابية في إسقاطه، لقد رفض في آخر الأمر الوساطة، ورفض أن يقف في وجه الثوار، وكان واضحاً أنه يؤيد ما يريده الثوار. أما أنه حضَّ على قتل عثمان فهذا ما لم يثبت أبداً. بل على العكس لدينا من أقواله ما ينفي هذا، ولدينا من المعرفة بسلوكه ما يتناقض مع احتمال وجود أي اتفاق سابق على وقوع الثورة.
والراجح أن الثوار من الأحرار حزب الشعب قد خفوا للعمل، وأنهم عملوا وفي اعتبارهم أن يرشحوا علياً للخلافة، أما علي نفسه فلم يحط بهذا التدبير علماً.
ولا يعيب علياً أن يشترك في الثورة بل على العكس يعيبه ألا يشترك فيها وألاَّ يوجهها التوجيه الصحيح، فما الإسلام إلاَّ ثورة، وما كفاح الرسول العنيد إلاَّ مثال للثورية الإيجابية في كل خطوة من خطواته.
على أن الأشبه بأخلاق علي بن أبي طالب هو ما فعله فعلاً من نصحٍ شديد ومن جهر بالخصومة لعثمان، وهو الذي يعلم حق العلم معنى الحديث الشريف: «من رأى منكم منكراً فليقوّمه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان»، فعلي كزعيم كبير ورجل مسموع الكلمة بين المسلمين كان يجاهر بلسانه، وكان يؤجل الثورة بالقوة على عثمان، ولعله لم يفقد الأمل في أن يعود عثمان إلى الجادة، وقد جرَّب علي هذا كله في خلافة عمر ووجد استجابة مهما تكن حذرة ومتلكئة فإنها كانت مثمرة ومبشرة بكل خير.
وعلي كان يحذر الفتنة والإسلام لم يزل غضاً والعهد بحروب الردَّة ليس بعيداً، والخلق الإسلامي لم يتأصل بعد في كل النفوس.
على أنه ربما كان علي قد رأى أن تخلع بيعة عثمان، ووافق عليها، أما أن يخلع عنوة وبالقتل فهذا ما لا سند له. ولولا أن تمسك عثمان بقميص الخلافة حتى الموت ما وقعت الواقعة وما قتل الشيخ في بيته هذه القتلة الشنعاء. فما زال الثوار يطلبون خلع عثمان وما زال أكثر الصحابة حتى من أعضاء مجلس الشورى يسكتون على هذا الطلب دليل الموافقة، وما زال عثمان يقول: «لا أخلع قميصاً كساني الله» حتى حدث أن ثارت ثائرة الثوار ولم يجد الخليفة نصيراً يؤيده في الثبات على الخلافة، فرمى أنصاره صحابياً شيخاً من خلف أسوار البيت فقتلوه، وكان دماً بدم، وصعد الثوار إلى حجرة عثمان فبادروه بالطعن وكان أولهم محمد بن أبي بكر الصديق نفسه فيما تروي بعض الروايات.
ولم يستشعر أحد حينذاك ـ أي غضاضة فيما حدث ـ بل على العكس بلغت حماسة الرأي العام في المدينة، سواء من أهلها أو من الثوار الوافدين، حداً جعلت دفن عثمان يتم ليلاً وفي حذر شديد وفي مكان غير لائق.
بيعة علي
ورشَّح الثوار علياً للخلافة، وطلبوا البيعة له.
ولقد قيل في هذه المبايعة الكثير، قيل بأن الثوار عرضوا البيعة على علي فتردد، وقيل أن أهل المدينة من المهاجرين والأنصار فكروا ليختاروا بين الأربعة الباقين طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعلي. أو هم قد فكروا في الثلاثة المتنافسين طلحة والزبير وعلي لأن سعداً اعتزل الفتنة وآثر ألاَّ يكون طرفاً فيها.
وهذا يصور الثورة على أنها كانت عشوائية تماماً، وأنها لم تكن تندرج تحت سياسة معينة تهدف إلى إصلاح ما أفسد عثمان، أو إلى سياسة هي على النقيض من السياسة التي اتبعها عثمان.
فالثورة منذ أيامها الأولى كانت تطلب إلى عثمان أن يخلع نفسه، فليس من المعقول أن لا يكون لدى الثوار ـ عندئذٍ ـ اسم الخليفة الذي يحقق أهداف الثورة.
وإذا كان هوى أهل مصر ـ وهم الذين قاموا بالجانب الأكبر مع الثورة ـ مع علي، فما الذي يعنيه هذا التردد وذلك التفكير الذي أشار إليه المؤرخون … بل هم قد زعموا أن علياً تردد فألح عليه الثوار من مؤيديه. بل قيل أيضاً أن أهل الكوفة وكان هواهم مع الزبير قد حاولوا أن يجعلوا الخلافة للزبير. وقد يكون الزبير قد دبَّر واتفق مع أهل الكوفة سلفاً على أن يبايعوه بعد خلع عثمان. وقيل أيضاً أن هوى أهل البصرة كان مع طلحة، ولكن الثورة بقيادة المصريين وبموافقة غالبية أهل المدينة من المهاجرين والأنصار كانت واضحة الأهداف منذ أول انتفاضة لها، الأمر الذي يبرر ذلك الاتفاق السري بين طلحة وبعض أهل البصرة وبين الزبير وبعض أهل الكوفة … فما لم يكن واضحاً هو لو أن الاتجاه نحو علي ما كانت هناك حاجة لكل هذه التدابير.
ومنطق الحوادث يقتضينا أن نرفض الرأي الذي يقول بأن أهل المدينة وأن الثوار بعد مقتل عثمان وقعوا في حيرة لا يدرون لمن يبايعون بالخلافة، وأن علياً قد تردد هو أيضاً وأن الثوار قد ألحوا عليه، وأنه لم يقبل إلاَّ حين رأى المهاجرين والأنصار يلحون عليه أيضاً.
المعقول أن الثورة كانت تتجه من الوهلة الأولى للرجل وللحزب الذي يمثل اتجاهاتها وإن المعارضين لخلافة علي حاولوا أن يرتبوا أمورهم بحيث لا تتحقق هذه الخلافة. ولكنهم لم يملكوا أن يفعلوا شيئاً إزاء تتابع الحوادث وسرعتها.
والمتوقع في هذه الحالة أن يتجه الثوار إلى علي فيبايعونه، وأن يتجه غالبية أهل المدينة فيبايعونه وقد اشتركوا فعلاً مع الثوار في معارضة عثمان وطلب خلعه، ثم اشتركوا فيما حدث من حصار لبيت عثمان، ولا نستطيع بالتالي أن نخرجهم من نطاق الثورة بشكل من الأشكال.
والروايات تقول أن البيعة لعلي أعلنت بعد مقتل عثمان بخمسة أيام وبعضها يقول أنها أعلنت بعد ثمانية أيام …. المهم أن الخلافة ظلَّت شاغرة خمسة أيام على الأقل، وأن الغافقي قائد الثوار المصريين تولى السلطة مؤقتاً حتى يبت في أمر الخلافة.
وذلك أنه بعد مقتل عثمان ظهرت التيارات المعارضة على حقيقتها، فسعد بن أبي وقاص اعتزل ونحن نعلم مطامعه القديمة في الخلافة أيام الاختيار بين علي وعثمان، ويبدو أنه لم تكن له قوة يحسب حسابها في التنافس على الخلافة حين قتل عثمان فآثر أن يعتزل فلا يحسب عليه شيء من حساب الفتنة وما وراءها. ورأينا كذلك أن عبد الله بن عمر قد اعتزل أيضاً وهو أمر يتفق مع خصاله الشديدة. أما طلحة والزبير وقد اشتركا في التحريض على خلع عثمان فقد أبيا أن يبايعا بل طلبا البيعة لنفسيهما.
ولا شك أنه كان لكل من هؤلاء الأربعة وثلاثة منهم ممن رشحهم عمر للخلافة بعده، أنصار ومؤيدون من المهاجرين والأنصار، ولا شك أن علياً كان يريد أن يبدأ عهده بموافقة الجميع، مما اضطرَّ زعماء الثورة أن يقوموا باتصالات سريعة لضمان البيعة الإجماعية لعلي وهذا هو السبب في مضي تلك الأيام الخمسة أو الثمانية التي استغرقتها المفاوضات.
وما قيل من أن علياً امتنع عن قبول البيعة التي عرضها الثوار قد يكون تخريجاً مبالغاً فيه. فالواقع أن الثورة كانت تعني علياً وتقصده منذ ارتفع صوت المعارضين بالنقد الصريح ومنذ ألقيت الخطب في المساجد.
ولم يكن علي مرغماً على قبول البيعة له كما قيل في بعض الروايات فهذا يعارض تماماً كل مواقفه السابقة، ولا يقبل بالتالي ما قيل من أن الثوار قد هددوه بالويل إن هو رفض. كل ما هنالك أن علياً أراد أن يستوثق من موافقة الجميع وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار. وأن يوفق ما أمكن التوفيق بين غالبية الآراء حتى قبل البيعة ولم يستثن من ذلك أحداً إلاَّ سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، وتحت ضغط الجماهير بايع طلحة والزبير لعلي.
ولكن هذه المبايعة كانت محفوفة بالمتاعب، فالشام في يدي معاوية، ولم يسمع لها رأي بعد، ولم يمثلها أحد من الوفود الحاضرة، وموقف معاوية معروف سلفاً.
على أن الأخطر من هذا كله ظهور المتناقضات التي أخفاها الإجماع على خلع عثمان، فأصحاب المصالح والمنافع ظهروا على حقيقتهم معارضين لعلي، والطامعون في المناصب ظهروا على حقيقتهم، وبدا أن الأمر يسير من تعقيد إلى تعقيد.
ومع ذلك فقد بادر علي إلى العمل وهو محيط بكل هذه الأوضاع، محاولاً أن يبت فيها بتاً سريعاً، فعين في الأمصار الرئيسية الكوفة والبصرة ومصر والشام واليمن رجالاً من الشعب فتسلم الجميع زمام أعمالهم فيما عدا عامل الشام الذي ردَّه جنود معاوية، فقرر علي أنه لا مناص من حرب معاوية وبدأ الاستعداد للقتال.
وما كان علي يملك أن يجند الجيوش لو لم تكن الغالبية له، أو لو لم يكن وراءه الرأي العام لجماهير المسلمين.
ولم تتقاعس قوى النفعيين بل بدأت العمل بكل قدراتها، فإذا بطلحة والزبير يلتقيان في مكة، وإذا بهما يدبران لحرب علي في البصرة، وإذا بالسيدة عائشة تنضم إليهما تدفعها في ذلك عوامل شخصية أكثر مما هي موضوعية.
وقد تم الحلف بين طلحة والزبير وعائشة، وأوشك أن يتم بين زوج أخرى من أزواج النبي هي أخت عبد الله بن عمر لولا أن ردَّها عبد الله عن ذلك.
وقد فتحت جبهة جديدة غير جبهة الشام ضد الخلافة في الأيام الأولى مباشرة لإعلانها، وهو أمر لم يحدث لأي خليفة فيما عدا حروب الردة وهي أمر مختلف تماماً عما حدث هنا. إن خلافة عمر مضت هينة رفيقة لا تعترضها إلاَّ معارضة واعية صبورة، ثم جاءت خلافة عثمان فلم تواجهها معارضة إلاَّ مواجهة الرأي لا القوة إلى أن تطورت الحوادث وأصبح خلعها بالثورة أمراً لا مفر منه.
وما هذا الاندفاع في حرب الخلافة الجديدة إلاَّ دليل على ما يدركه خصومها من نواياها السياسية وهي في الواقع حرب مصالح، حرب طاحنة لا تعرف التسويف.
وكان على الخلافة أن تضرب بسرعة أيضاً وأن تصفي الموقف قبل أن تتعدد الاضطرابات ويفلت منها الزمام.
وقرر علي أن يفرغ من معارضة طلحة والزبير أولاً فحشد قواه وبدأ حروب التصفية.
وكان على الحكم الشعبي أن يجري من الإصلاحات وأن يصدر من القوانين ما يشعر جماهير الثورة بأن الحق في طريقه لأن ينفّذ، وإن الإسلام الأصيل بدأ يعود مسيرته الأولى إلاَّ أن حرب طلحة والزبير جاءت سريعة، كما كان تحفز الشام دافعاً للاستعداد له بل ومبادرته.
ومع ذلك فإن علياً بدأ العمل فعلاً ولكن في هذه الظروف الشديدة.
أحمد عباس صالح
بعض المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين (ع)
إن المتسلم للقيادة الفعلية، المتسلم لزمام التجربة بعد النبي (ص) كان من المحتوم أن يجنح إلى الانحراف، لأنه كان يعيش رواسب جاهلية، وبالتالي لم يكن يُمثل الدرجة الكاملة للإِنصهار مع الرسالة، هذه الدرجة التي هي شرط أساسي لتزعم هذه التجربة، وهي التي يمكن أن تفسّر موقف الشيعة من اشتراطهم العصمة لقيادة هذه التجربة.
الفكرة من هذا الحديث تقوم على هذا الأساس، على أساس أن قيادة التجربة، يجب أن تكون على مستوى العبء، وهذا في الواقع ليس من مختصات الشيعة، ليس من مختصات الشيعة الإيمان، بأن الإمام يجب أن يكون معصوماً، بل هذا ما تؤمن به كل الاتجاهات العقائدية في العالم على الإطلاق.
أي اتجاه عقائدي في العالم، يريد أن يبني الإنسان من جديد في إطاره، ويريد أن ينشئ للإنسانية معالم جديدة، فكرية وروحية واجتماعية، يشترط لأن ينجح، وأن ينجز وأن يأخذ مجراه في خط التاريخ، يشترط أن يكون القائد الذي يمارس تطبيق هذا الاتجاه، معصوماً ….
فالقائد في نظر الماركسية مثلاً بوصفها اتجاهاً عقائدياً، يريد أن يبني ويصنع الإنسان، ويبلوره في إطاره الخاص، يشترط فيه أن يكون معصوماً.
إلاَّ أن مقاييس العصمة تختلف.
الاتجاه الماركسي يجب أن يكون القائد الذي يمارس تطبيقه معصوماً بمقاييس ماركسية، والقائد الذي يمارس زعامة التجربة الإسلامية، يجب أن يكون معصوماً بمقاييس إسلامية، والعصمة في الحالتين بمفهوم واحد، هو عبارة عن الانفعال الكامل بالرسالة، والتجسيد الكامل لكل معطيات تلك الرسالة، في النطاقات الروحية والفكرية والعملية.
هذه هي العصمة.
والشيعة لم يشذوا باشتراط العصمة في الإمام، عن أي اتجاه عقائدي آخر، ولهذا نرى في الاتجاهات العقائدية الأخرى، كثيراً ما يتهم القائد الذي يمثل الاتجاه، بأنه ليس معصوماً، يوجه إليه نفس التهمة، التي نوجهها نحن أصحاب علي بن أبي طالب (ع) إلى الذين تولوا السلطات في المسلمين.
نفس هذه التهمة يوجهونها إلى القادة الذين يعتقدون بأنهم لم ينصهروا بأطروحاتهم ولم يتفاعلوا باتجاهاتها تفاعلاً كاملاً.
بالأمس القريب جزء كبير من الماركسية في العالم انشطر على قيادة الاتحاد السوفياتي، واتهم القيادة التي كانت متمثلة في حكام روسيا، بأنهم أناس غير مهيئين لأن يكونوا قادة للتجربة الماركسية، يعني غير معصومين بحسب لغتنا.
إلاَّ أن نفي العصمة عنهم بمقاييس ماركسية لا بمقاييسنا الخاصة، لا بمقاييس إسلامية.
فأصل الفكرة، تؤمن به كل الاتجاهات العقائدية، وإنما المقياس للعصمة يختلف باختلاف طبيعة هذه الاتجاهات العقائدية.
نعم، العصمة في الإسلام، ذات صيغة أوسع نطاقاً من العصمة في الاتجاهات العقائدية الأخرى، وهذه السعة في صيغة العصمة تنبع من طبيعة سعة الإسلام نفسها، لأن العصمة كما قلنا، هي التفاعل الكامل والانصهار الشامل والتجاوب مع الرسالة في كل أبعاد الإسلام … والرسالة الإسلامية تختلف عن أي رسالة أخرى في العالم، لأن أي رسالة أخرى في العالم تعالج جانباً واحداً من الإنسان، الماركسية التي تمثل أحدث رسالة عقائدية في العالم الحديث تعالج جانباً واحداً من وجود الإنسان وتترك الإنسان حينما يذهب إلى بيته، حينما يذهب الإنسان إلى مخبئه، حينما يخلو الإنسان بنفسه، تترك الإنسان، ليس لها أي علاقة معه في هذه الميادين، وإنما تأخذ بيده في مجال الصراع السياسي والاقتصادي لا أكثر.
فصيغة الرسالة بطبيعتها صيغة منكمشة محدودة، صيغة تعالج جانباً من الحياة الانسانية، فالعصمة العقائدية التي لا بدَّ أن تتوفر في أي قائد ماركسي، مثلاً هي العصمة في حدود هذه المنطقة التي تعالجها الرسالة العقائدية الماركسية.
أما الرسالة الاسلامية فهي تعالج الإنسان من كل نواحيه، وتأخذ بيده إلى كل مجالاته ولا تفارقه وهو على مخدعه في فراشه وهو في بيته وبينه وبين ربه، بينه وبين نفسه، بينه وبين أفراد عائلته، وهو في السوق، وهو في المدرسة، وهو في المجتمع، وهو في السياسة، وهو في الاقتصاد، وهو في أي مجال من مجالات حياته، ولهذا تكون الصيغة المحدودة من العصمة على أساس هذه الرسالة أوسع نطاقاً وأرحب أفقاً وأقسى شروطاً، وأقوى من ناحية مفعولها وامتدادها في كل أبعاد الحياة الإنسانية.
فعصمة الإمام عبارة عن نزاهة في كل فكرة وكل عاطفة وكل شأن، والنزاهة في كل هذا عبارة عن انصهار كامل مع مفاهيم وأحكام الرسالة الإسلامية، في كل مجالات هذه الأفكار والعواطف والشؤون.
إذن فالعصمة التي هي شرط لمجموع الاتجاهات العقائدية، نحن أيضاً نؤمن بها كشرط في هذا الاتجاه.
وبطبيعة الحال فإننا عندما نقول، إن العصمة شرط في هذا الاتجاه، العصمة بحد ذاتها أيضاً ليست أمراً حتمياً غير قابل للزيادة والنقصان، والتشكيك، نفس العصمة إذا حولناها إلى مفهوم النزاهة والتجاوب الكامل مع الرسالة فيكون أمراً مقولاً بالتشكيك في الشدة والضعف، وبوصف أن أئمة أهل البيت عليهم السلام المرتبة الأسمى والأكمل من هذه المراتب المقولة بالتشكيك المختلفة شدة وضعفاً.
ومن هنا نأتي إلى ما كان موضوع الحديث، موضوع الحديث أن هؤلاء الذين تسلموا أمر التجربة لم يكونوا معصومين حتى بأدنى مراتب العصمة حتى بالحد الأدنى من مراتب النزاهة والتفاعل مع الرسالة الإسلامية، وحينئذٍ حيث أن التجربة تجربة تمثل اتجاهاً عقائدياً، واتجاهاً رسالياً، ليس اتجاه أناس يمثلون وجهة نظر معينة في الكون والحياة والمجتمع، يمثلون رسالة لتغيير الحياة على وجه الأرض وتغيير التاريخ، إذن هذه التجربة العقائدية الضخمة على هذا المستوى، بحاجة إلى قيادة عقائدية معصومة تتوفر فيها فعالية عالية جداً من النزاهة والتجرد والموضوعية والانفعال بمعطيات هذه الرسالة فكيف إذا لم تكن هذه المواصفات موجودة في القيادة؟.
قد يقال: إنها كانت موجودة في الأمة ككل، والأمة ككل، كانت تمارس المراقبة، وكانت تمارس التوجيه، وكانت تمارس المراقبة للحكم القائم حتى لا ينحرف، الأمة ككل كانت معصومة، وإذا كانت الأمة ككل معصومة، إذن فالعصمة قد حصلنا عليها عن طريق الوجود الكلي للأمة.
إلاَّ أنَّ هذه الفكرة غير صحيحة، نحن نؤمن بأن الأمة في وجودها لم تكن معصومة أيضاً، كما أن الذين تولوا الحكم، لم يكن يتوفر لديهم الحد الأدنى من النزاهة المطلوبة لزعامة تجربة من هذا القبيل، الأمة بوصفها الكلي وبوجودها المجموعي أيضاً لم تكن معصومة، طبعاً إذا استثنينا من ذلك الزعامة المعصومة الموجودة في داخل هذه الأمة المتمثلة في اتجاه أمير المؤمنين علي (ع)، هذا بالرغم من أننا نعترف ونفتخر ونمتلئ اعتزازاً بالإيمان بأن الأمة الإسلامية التي أسسها وحرسها النبي (ص) ضربت أروع نموذج للأمة في تاريخ البشرية على الإطلاق، الأمة الإسلامية التي أمكن للنبي (ص) بوقت قصير جداً، في مدة لا تبلغ ربع قرن، أن ينشئ أمة لها من الطاقة والإرادة، لها من المؤهلات اللازمة القدر الكبير، الذي لا يمكن أبداً أن يتخيل الإنسان الاعتيادي كيف أمكن إيجاده في ربع قرن أو أقل؟ هذه الأمة التي قدمت من التضحيات في أيام النبي (ص) في سبيل رسالتها ما لم تقدم مثله اي أمة من أمم الأنبياء قبل النبي (ص)، هذا التسابق على الجنة، التسابق على الموت، الإيثار الذي كان موجوداً بين المسلمين، روح التآخي التي شاعت في المسلمين، المهاجرين والأنصار، كيف عاشوا كيف تفاعلوا، كيف انصهروا، انظروا إلى أهل بلد واحد ينزح إليهم أهل بلد آخر، فيأتون إليهم ليقاسموهم خيرات بلدهم، ومعاشهم، وأموالهم، وهؤلاء يستقبلونهم برحابة صدر، ينطلقون معهم ينظرون إليهم على أنهم أخوة لهم، يعيشون مجتمعاً واحداً وكأنهم كانوا قد عاشوا مئات السنين، هذه الانفتاحات العظيمة في كل ميادين المجتمع التي حققتها الأمة بقيادة الرسول (ص) هذه الانفتاحات، التي لا مثيل لها، بالرغم من كل هذا نقول إن الأمة لم تكن معصومة.
إن هذه الانفتاحات كانت قائمة على أساس الطاقة الحرارية التي كانت تمتلكها الأمة من لقاء القائد الأعظم، ولم تكن قائمة على أساس درجة كبيرة من الوعي الحقيقي للرسالة العقائدية. نعم كان الرسول (ص) الأعظم، يمارس عملية توعية الأمة، وعملية الارتفاع بها إلى مستوى أمة معصومة، هذه العملية التي كانت مضغوطة، والتي بدأ بها النبي (ص) لم ينجز شيئاً منها في الخط هذا، وإنما الشيء الذي أنجز في هذا الخط، خط عمل النبي (ص) على مستوى الأمة ككل، هو إعطاء هذه الأمة طاقة حرارية في الإيمان بدرجة كبيرة جداً، مثل هذه الطاقة الحرارية التي تملكها الأمة يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، وفي كل لحظة من لحظات انتصارها أو انكسارها، كانت هي المصدر وهي السبب في كل الانفتاحات العظيمة، روح القائد هي التي تجذب وهي التي تحصد، وهي التي تقود هؤلاء إلى المثل العليا والقيم الضخمة الكبيرة التي حددها الرائد الأعظم (ص) بين أيديهم، إذن فهي طاقة حرارية وليست وعياً.
وقلنا أيضاً فيما سبق، إن الطاقة الحرارية والوعي قد يتفاعلان ويتفقان في كثير من الأحيان ولا يمكن أن نقارن في الحالات الاعتيادية بين أمة واعية، وبين أمة تملك طاقة حرارية كبيرة دون درجة كبيرة من الوعي، المظاهر تكون مشتركة في كثير من الأحيان، لكن في منعطفات معينة من حياة هذه الأمة، يتبين الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية في لحظات الانفعال الشديد، سواء كان انفعالاً موافقاً لعملية الانتقال، أو انفعالاً معاكساً، لأن الوعي لا يتزعزع في لحظة الانفعال ويبقى صامداً ثابتاً، لا يلين ولا يتميع، وعي الإنسان، إيمان الإنسان بأهدافه ومسؤولياته، فوق كل الانفعالات، فوق كل المشاكل، فوق كل الانتصارات. أي انتصار يحققه الإنسان، لا يمكن أن يخلق انفعالاً يزعزع وعيه، إذا كان واعياً وعياً حقيقياً يبقى على الخط، لا يشط ولا يشذ ولا يزيد أو ينقص.
محمد (ص) هذا الرجل العظيم، يدخل إلى بيت الله الحرام منتصراً في لحظة، لم تزعزع هذه اللحظة من خلقه، لم تخلف فيه نشوة الانتصار، وإنما خلفت فيه ذل العبودية لله شعر بذل العبودية لله أكثر مما يشعر بنشوة الانتصار، هذا هو الذي يمثل الوعي العظيم، لكن المسلمين عاشوا نشوة الانتصار، في لحظات عديدة لحظات الصدمة، لحظات المشكلة، لحظات المأساة. الواعي يبقى ثابتاً، يبقى صامداً أمام المشكلة لا يتزعزع، لا يلين لا يكف لا يتراخى، يبقى على خطه واضحاً. النبي (ص) لم يكن يبدو منه أي فرق بينه وهو حال دخوله إلى مكة فاتحاً، وهو مطرود بالحجارة من قبائل العرب المشركين، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يقول له: لا يهمني ما يصنع هؤلاء إذا كنت راضياً عني، نفس الروح التي نجدها في لحظة انقطاعه، في لحظة مواجهته البشرية التي تحمل ألوان الشرور، في لحظة تمرد الإنسان على هذا الوجه الذي جاء ليصلحه، لم تتبدل حالته في هذه اللحظة وبين حالته، والإنسانية تستجيب والإنسانية تخضع، والإنسانية تطأطئ رأسها بين يدي القائد العظيم (ص) هذا هو الوعي.
أما الأمة فإنها لم تكن هكذا، ولا نريد أن نكرر الشواهد مرة أخرى حتى يأتي البحث كاملاً، الشواهد على أن الأمة كانت غير واعية، وإنما هي طاقة حرارية مرَّت في الأيام السابقة، إذن فالأمة الإسلامية كانت تحمل طاقة حرارية كبيرة، ولم تكن أمة واعية بدرجة كبيرة فلم تكن العصمة متوفرة لا في القيادة، ولا في الأمة بوجودها المجموعي، ومن أجل هذا كان الانحراف حتمياً، وهكذا بدأ الانحراف، وقلنا إن الخط الذي بدأه الأئمة (عليهم السلام) هذا الخط ينحل إلى شكلين:
الأول: خط محاولة القضاء على هذا الانحراف بالتجربة، أليست التجربة تجربة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. هذه التجربة انحرفت بإعطاء زمامها إلى أناس لا يؤمَّنُون عليها وعلى مقدراتها، وعلى ممتلكاتها، الخط الأول كان يحاول أخذ هذه التجربة، تسلم زمام التجربة.
الثاني: هو الخط الذي كان يعلمه الأئمة عليهم السلام حتى في الحالات التي كانوا يرون أن ليس في الإمكان السعي وراء تسلم زمام التجربة، وهو خط الضمان لوجود الأمة مستقبلاً.
قلنا إن التجربة حينما انحرفت، كان من المنطقي في تسلسل الأحداث، أن يتعمق هذا الانحراف ثم يتعمق حتى تنهار التجربة، وإذا انهارت التجربة أمام أول غزو، أمام أول تيار، إذن فلن تحارب عن إسلامها كأمة، فبعد أن تنهار الدولة والحضارة الحاكمة، وسوف تتنازل عن إسلامها بالتدريج لأنها لم تجد في هذا الإسلام المنحرف ما تدافع عنه، إذ ماذا جنوا من هذا الإسلام.
كيف نقدر أن نتصور أن الإنسان غير العربي يدافع عن الإسلام الذي يتبنى زعامة العربي لغير العربي؟ كيف يمكن أن نتصور أن الإنسان العربي والفارسي يدافع عن كيان يعتبر هذا الكيان هو ملك لأسرة واحدة من قبائل العرب وهي أسرة قريش؟ كيف يمكن أن نفرض أن هؤلاء المسلمين يشعرون بأنهم قد وجدوا حقوقهم قد وجدوا كرامتهم، في مجتمع يضج بكل ألوان التفاوت والتمييز والاستئثار والاحتكار؟
إذن كانوا قد تنازلوا عن هذا الإسلام حينما تنهار التجربة بعد تعمق الانحراف.
إلاَّ أن الذي جعل الأمة لا تتنازل عن الإسلام، هو أن الإسلام له مثل آخر قدم له، مثل واضح المعالم، أصيل المثل والقيم، أصيل الأهداف والغايات، قدمت هذه الأطروحة من قبل الواعين من المسلمين بزعامة الأئمة عليهم السلام من أهل البيت عليهم السلام … ولنعرف مسبقاً قبل أن نأتي إلى التفاصيل، أن هذه الأطروحة التي قدمها الأئمة عليهم السلام للإسلام لم تكن تتفاعل فقط مع الشيعة المؤمنين بإمامة أهل البيت عليهم السلام فقط، هذه الأطروحة كان لها صدى كبير في كل العالم الإسلامي فالأئمة عليهم السلام كانت لهم أطروحة للإسلام وكانت لهم دعوى لإمامة أنفسهم، صحيح أن الدعوى لإمامة أنفسهم لم يطلبوا لها إلاَّ عدداً ضئيلاً من مجموع الأمة الإسلامية، ولكن الأمة الإسلامية بمجموعها تفاعلت مع هذه الأطروحة، إذن فكان الخط الكبروي للأئمة عليهم السلام هو تقديم الأطروحة الصحيحة للإسلام والنموذج والمخطط الواضح الصحيح الصريح، للإسلام، في كل مجالات الإسلام في المجالات الخاصة والمجالات العامة، في المجالات الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية، والخلقية والعبادية، كانوا يقدمون هذه الأطروحة الواضحة، التي جعلت المسلمين على مر الزمن يسهرون على الإسلام ويقيمونه وينظرون إليه بمنظار آخر غير منظار الواقع الذي يعيشونه، غير منظار التجربة الفريدة التي يعيشونها.
هذا هو الخط الثاني الذي عمل عليه الأئمة عليهم السلام.
أمير المؤمنين حينما واجه الانحراف في التجربة قام بعملية تعبئة فكرية في صفوف المسلمين، إلاَّ أنه لم يستطع أن يستثير المسلمين بالدرجة التي تحول مجرى التجربة ويجعل هناك تبدلاً أساسياً في الخط القائم. لم يستطع ذلك، وهذا أمر طبيعي، يعني من الطبيعي أن ينتهي أمير المؤمنين إلى عدم النجاح في القضاء على الانحراف.
يجب أن نعرف أن علياً (ع) لم يكن رئيساً حينما فشل، ولم يكن قاصراً حينما فشل، كل هذا لم يكن، لأن كل هذا غير محتمل في شخص هو قمة النشاط، وقمة الحيوية وقمة الحرص. كان موقفه حرجاً غاية الحرج تجاه الموانع، أما ما هي صيغة هذه الموانع، هذه الموانع تحتاج إلى دراسة مفصلة لنفسية المجتمع الإسلامي في أيام الرسول (ص). فهنالك عوامل كثيرة لها دخل في نسج خيوط هذه الموانع. يمكن أن نذكر بعضها على سبيل المثال:
العامل الأول: التفكير اللاإسلامي من ولاية علي بن أبي طالب (ع)، رسول الله (ص) جعل علياً بعده حاكماً على المسلمين، وإماماً للمسلمين ككل، المسلمون، ولنتكلم عن المسلمين المؤمنين بالله ورسوله حقاً، هؤلاء المسلمون المؤمنون بالله وبرسوله حقاً، قلنا إنهم لم يكونوا من الواعين بدرجة كبيرة، نعم كان عندهم طاقة حرارية تصل إلى درجة الجهاد، إلى الموت في سبيل الله هؤلاء الذين قاموا بعد النبي (ص) ضد علي بن أبي طالب (ع)، أنا لا أشك بأنهم مرَّت عليهم بعض اللحظات، كانوا على استعداد لأن يضحوا بأنفسهم في سبيل الله، وأنا لا أشك أن الطاقة الحرارية كانت موجودة عند هؤلاء، سعد بن عبادة الخزرجي مثلاً، هذا الذي عارض علي بن أبي طالب (ع) إلى حين، والذي فتح أبواب المعارضة على علي بن أبي طالب إلى حين، سعد هذا، كان مثل المسلمين الآخرين يكافح ويجاهد، غاية الأمر لم يكن لديه الوعي، هؤلاء المسلمين المؤمنون بالله ورسوله (ص)، لم يكونوا على درجة واحدة من الوعي وكانت الكثرة الكاثرة منهم أناساً يملكون الطاقة الحرارية، بدرجة متفاوتة، ولم يكونوا يملكون وعياً، إذن فقد تبادر إلى ذهن عدد كبير من هؤلاء أن محمداً (ص) يفكر أن يعلي مجد بني هاشم، أن يعلي كيان هذه الأسرة؛ أن يمد بنفسه بعده فاختار علياً، اختار ابن عمه، لأجل أن يمثل علي بن أبي طالب أمجاد أسرته، هذا التفكير كان تفكيراً منسجماً مع الوضع النفسي الذي يعيشه أكثر المسلمين كراسب الجاهلية، كراسب عرفوه ما قبل الإسلام، ولم يستطيعوا أن يتحملوا تحملاً تاماً، أبعاد الرسالة، ألسنا نعلم … ماذا صنعوا في غزوة حنين، حينما وزع رسول الله (ص) المال، وزع الغنائم على قريش ولم يعط الأنصار، وزعه على قريش على أهل مكة، ولم يعط أهل المدينة، ماذا صنع هؤلاء ماذا صنع أهل المدينة؟ أخذ بعضهم يقول لبعض: إن محمداً لقي عشيرته فنسينا، لقي قريشاً ونسي الآوس والخزرج، هاتين القبيلتين اللتين قدمتا ما قدمتا للإسلام، إذن فكان هؤلاء على المستوى الذي تصوروا في هذا القائد الرائد العظيم، الذي كان يعيش الرسالة، آثر قبيلته بمال، فكيف لا يتصورون أنه يؤثر عشيرته بحكم، بزعامة، بقيادة على مر الزمن وعلى مر التاريخ.
هذا التصور كان يصل إلى هذا المستوى المتدني من الوعي، هؤلاء لم يكونوا قد أدركوا بعد أبعاد محمد (ص) ولم يكونوا قد أدركوا أبعاد الرسالة الإسلامية، وكانوا بين حين وحين يطفو على أنفسهم الراسب الجاهلي وينظرون إلى النبي من منظار ذلك الراسب الجاهلي، ينظرون إليه كشخص يرتبط بالعرب ارتباطاً قومياً، ويرتبط بعشيرته ارتباطاً قبلياً ويرتبط بابن عمه ارتباطاً رحمياً، كل هذه الارتباطات كانت تراود أذهانهم بين حين وحين، وأنا أظن ظناً كبيراً أن علي بن أبي طالب (ع) لو لم يكن ابن عم النبي (ص) لو أن الصدفة لم تشأ أن يكون الرجل الثاني في الإسلام لو لم يكن من أسرة محمد (ص) لو كان من عدي، أو لو كان من تميم، لو كان من أسرة أخرى، لكان لهذه الولاية مفعولاً كبيراً جداً، لقضي على هذا التفكير اللاإسلامي … لكن ما هي حيلة محمد إذا كان الرجل الثاني في الإسلام ابن عمه، لم يكن له حيلة في أن يختار شخصاً دون شخص آخر وإنما كان عليه أن يختار الرجل الثاني في الإسلام، في تاريخ الرسالة، في كيان الرسالة، وفي الجهاد … في سبيل الرسالة، وفي الاضطهاد في سبيل الرسالة، لقد كان هذا من باب الاتفاق ابن عم محمد (ص). هذا الاتفاق فتح باب المشاغبة على هؤلاء. هذا هو العامل الأول، هذا العامل يعيش في نفوس المؤمنين بالله تعالى وبرسوله (ص).
العامل الثاني: عامل يعيش في نفوس المنافقين، والمنافقون كثيرون في المجتمع الإسلامي، خاصة وأن المجتمع الإسلامي كان قد انفتح قبيل وفاة رسول الله (ص) انفتاحاً جديداً على مكة، وكانت قد دخلت مكة أيضاً داخل هذا المجتمع، ودخلت قبائل كثيرة في الإسلام قبيل وفاة رسول الله (ص). وكان هناك أناس كثيرون قد دخلوا الإسلام نفاقاً، ودخلوه طمعاً، ودخلوه حرصاً على الجاه، ودخلوه استسلاماً للأمر الواقع، لأن هذا مُسلّم، لأن محمداً فرض زعامته على العرب. لم يكن شخص يفكر في أن تزعزع هذه الزعامة، إذن فلا بدَّ من الاعتراف بهذه الزعامة.
دخل كثير من الناس بهذه العقلية. وهؤلاء كانوا يدركون كل الإدراك أن علي بن أبي طالب (ع) هو الرجل الثاني للنبي (ص) وهو الاستمرار الصلب العنيد للرسالة، لا الاستمرار الرخو المتميع لها. وهؤلاء كانوا مشدودين إلى أطماع وإلى مصالح كانت تتطلب أن تستمر الرسالة ويستمر الإسلام، لأن الإسلام إذا انطفأ، معنى هذا أنه سوف تنطفئ هذه الحركة القوية التي بنت دولة ومجتمعاً والتي يمكن أنه تطبق على كنوز دولة كسرى وقيصر وتضم أموال الأرض كلها إلى هذه الأمة، كان من المصلحة أن تستمر هذه الحركة، لكن كان من المصلحة أن لا تستمر بتلك الدرجة من الصلابة والجدية، بل أن تستمر بدرجة رخوة هينة لينة.
كان لا بدَّ وأن تستمر الرسالة لكي تستمر بشكل لين هين، بشكل ينفتح على مطامح أبي سفيان، بشكل يمكن أن يتعامل معه أبو سفيان الذي جاء إلى علي (ع) في لحظة قاسية تلك اللحظة التي يشعر فيها الإنسان عادة بقدر كبير من المظلومية حيث يرى كيف أن الناس قد تنكروا لكل أمجاده وأنكروا كل جهاده حتى أخوته لرسول الله (ص) في هذه اللحظة جاءه أبو سفيان يعرض عليه القيادة بين يديه، يعرض عليه أن يزعّمه في سبيل أن يكون هو اليد اليمنى للدولة الإسلامية، يأبى علي (ع) ذلك، يأبى وهو مظلوم، وهو متآمر عليه، وهو مضطهد حقه، وبهذا كانت قيادة علي بن أبي طالب (ع) وزعامته تمثل خطراً على مصالح المنافقين فكان لا بدَّ في سبيل الحفاظ عليها من قبل المنافقين هؤلاء أن يخلقوا في سبيلها العراقيل ويقيموا الحواجز والموانع.
العامل الثالث: وهو مرتبط بمراحل نفسية خلقية، علي بن أبي طالب (ع) كان يمثل باستمرار تحدياً بوجوده التكويني، كان يمثل تحدياً للصادقين من الصحابة لا للمنحرفين من الصحابة، كان يمثل تحدياً بجهاده، بصرامته، باستبساله، بشبابه، بكل هذه الأمور، كان يضرب الرقم القياسي الذي لا يمكن أن يحلم به أي صحابي آخر، كل هؤلاء كانوا يودون أن يقدموا خدمة للإسلام.
أتكلم عن الصحابة الصالحين. الصحابة الصالحون كانوا يودون أن يقدموا خدمة للإسلام ولكن علي بن أبي طالب (ع) كان يفوقهم بدرجة كبيرة، بدرجة هائلة.
معاوية يقول في كتابه لمحمد بن أبي بكر بأن علياً كان في أيام النبي (ص) كالنجم في السماء لا يطاول، الأمة الإسلامية كانت تنظر إليه كالنجم في السماء بالرغم من أن العدد الكبير منها لم يكونوا يحبونه، كان علي مجاهداً بدرجة لا يمكن أن يقاس به شخص آخر، كان صامداً زاهداً، بدرجة لا يمكن أن يقاس به شخص آخر، وهكذا في كل كمالات الرسالة الإسلامية، إذن فعلي كان تحدياً، كان استفزازاً للآخرين، وهؤلاء الآخرون ليسوا كلهم يعيشون الرسالة فقط، بل جملة منهم يعيشون أنفسهم أيضاً، يعيشون أنانيتهم أيضاً، وحينما يشعرون بهذا الاستفزاز التكويني من شخص هذا الرجل العظيم الذي كان يتحداهم وهو لا يقصد أن يتحداهم، بل يقصد أن يهديهم، وأن يبني لهم مجدهم، يبني لهم رسالتهم وعقيدتهم، لكن ماذا يصنع بأناس يعيشون أنفسهم.
فهؤلاء الأناس كانوا يفكرون في أن هذا تحد واستفزاز لهم. كان رد الفعل لهذا مشاعر ضخمة جداً ضد علي بن أبي طالب (ع).
يكفي مثال واحد ليتضح هذا الموقف. النبي (ص) يسافر من المدينة إلى غزوة من الغزوات فيخلف علياً مكانه أميراً على المدينة، فهل تركه الناس، لا إنما أخذوا يشيعون بالرغم من أن رسول الله (ص) في المرات السابقة كان يستخلف أحد الأنصار على المدينة غير علي، فكانوا يشيعون، بأنه ترك علياً لأنه لا يصلح للحرب؟؟ علي بن أبي طالب هذا الرجل الصلب، العنيد، المترفع، هذا الرجل الذي يقول: لا يزيدني إقبال الناس عليَّ ولا ينقصني إدبارهم عني. هذا الرجل الصلب استفز الأعصاب إلى درجة أنه اضطر أن يلحق بالنبي (ص)، فيسأله النبي (ص) عن سبب تركه المدينة، فيقول: الناس يقولون بأنك طردتني لأني لا أصلح للحرب؟؟.
يمكن أن تنكر أية فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب (ع)، ولكن هل يمكن أن ينكر أن علي بن أبي طالب لا يصلح للحرب؟ أنظروا الحقد كيف وصل عند هؤلاء المسلمين بأن أخذوا يفسرون إمارة علي بن أبي طالب (ع) على المدينة بأنه لا يصلح للحرب، فيقول رسول الله (ص) كلمته المشهورة: إن علياً مني بمنزلة هارون من موسى، إنه لا ينبغي أن أخرج من المدينة إلاَّ وأنت فيها إثباتاً لوجودي ولتحمي المدينة.
هذا الموقف من هؤلاء لا يمكن أن يفسر إلاَّ على أساس هذا العامل النفسي هذا العامل الثالث.
وهناك عوامل أخرى، هذه العوامل كلها اشتركت في سبيل أن تجعل هناك موانع قوية جداً اصطدم بها النبي (ص) عند تشريع الحكم، واصطدم بها علي بن أبي طالب عند محاولة مقابلة الانحراف وتعديل التجربة وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي، ولهذا فشل في زعزعة الوضع القائم.
قلنا إنه حينما وجد الانحراف، لم تكن الأمة على مستوى المراقبة بوصفها المجموعي، لم تكن قادرة على ضمان عدم وقوع هذا الحاكم المنحرف بطبيعته في سلوك منحرف، لأن كون الأمة على هذا المستوى من الضمان، إنما يكون فيما إذا وصلت الأمة بوصفها المجموعي إلى درجة العصمة، أي إذا أصبحت الأمة كأمة تعيش الإسلام عيشاً كاملاً عميقاً، مستوعباً مستنيراً منعطفاً على مختلف مجالات حياتها، هذا لم يكن، بالرغم من أن الأمة الإسلامية وقتئذٍ، كانت تشكل أفضل نموذج للأمة في تاريخ الإنسان على الإطلاق. يعني نحن الآن لا نعرف في تاريخ الإنسان، أمة بلغت في مناقبها، وفضائلها، وقوة إرادتها وشجاعتها وإيمانها وصبرها وجلالتها وتضحيتها ما بلغته هذه الأمة العظيمة حينما خلفها رسول الله (ص).
الذي يقرأ التاريخ تاريخ هؤلاء الناس، الذين عاشوا مع النبي (ص) تبهره أنوارهم في المجال الروحي والفكري والنفسي، في مجال الجهاد والتضحية في سبيل العقيدة. ولكن هذه الأنوار التي تظهر للمطالع لم تكن نتيجة وضع معمق تعيشه الأمة في أبعادها الفكرية والنفسية، بل كانت نتيجة طاقة حرارية هائلة اكتسبتها هذه الأمة بإشعاع النبي (ص).
هذه الأمة التي عاشت مع أكمل قائد للبشرية، اكتسبت عن طريق الإشعاع من هذا القائد، درجة كبيرة من الطاقة الحرارية صنعت المعاجز، وصنعت البطولات والتضحيات التي يقل نظيرها في تاريخ الإنسان.
ولا أريد أن أتكلم عن هؤلاء الناس في أيام رسول الله (ص). وإيثار كل واحد منهم للإسلام والعقيدة، إيثاره بكل وجوده وطاقاته بكل إمكانياته وقدراته. هذه النماذج الرفيعة إنما هي نتاج هذه الطاقة الحرارية التي جعلت الأمة الإسلامية تعيش أيام رسول الله (ص) محنة العقيدة والصبر وتتحمل مسؤولية هذه العقيدة بعد وفاته (ص) وتحمل لواء الإسلام بكل شجاعة وبطولة إلى مختلف أرجاء الأرض هذه هي طاقة حرارية وليست وعياً لذا يجب أن نفرق ونميز بين الطاقة الحرارية وبين الوعي:
الوعي: عبارة عن الفهم الفعَّال الإيجابي المحقق للإسلام في نفس الأمة، الذي يتأصل ويستأصل جذور المفاهيم الجاهلية السابقة استئصالاً كاملاً. ويحوّل تمام مرافق الإنسان من مرافق الفكر الجاهلي إلى مرافق الفكر الإسلامي والذوق الإسلامي.
أما الطاقة الحرارية: فهي عبارة عن توهج عاطفي حار، بشعور قد يبلغ في مظاهره نفس ما يبلغه الوعي في ظواهره بحيث يختلف الأمر، فلا يميز بين الأمة التي تحمل مثل هذه الطاقة الحرارية وبين أمة تتمتع بذلك الوعي إلاَّ بعد التبصر.
إلاَّ أن الفرق بين الأمة الواعية والأمة التي تحمل الطاقة الحرارية كبير، فإن الطاقة الحرارية بطبيعتها تتناقص بالتدريج بالابتعاد عن مركز هذه الطاقة الحرارية.
والمركز الذي كان يمون الأمة بهذه الطاقة الحرارية هو شخص النبي (ص) القائد. فكان طبيعياً أن تصبح طاقة الأمة بعده في تناقص مستمر، حال الشخص الذي يتزود من الطاقة الحرارية للشمس والنار، ثم يبتعد عنهما، فإن هذه الحالة تتناقص عنده باستمرار.
هكذا كان، وتاريخ الإسلام يثبت أن الأمة الإسلامية كانت في حالة تناقص مستمر من هذه الطاقة الحرارية التي خلفها النبي (ص) في أمته حين وفاته بخلاف الوعي فإن الوعي بذلك المعنى المركز الشامل المستأصل لجذور ما قبله ذلك الوعي من طبيعته الثبات والاستقرار، بل التعمق على مر الزمن، لأنه بطبيعته يمتد ويخلق له بالتدريج خيالات جديدة وفقاً لخط العمل وخط الأحداث، فالأمة الواعية هي أمة تسير في طريق التعميق في وعيها والأمة التي تحمل طاقة حرارية هائلة، هي الأمة التي لو بقيت وحدها مع هذه الطاقة الحرارية فسوف تتناقص طاقتها باستمرار.
وهناك فرق آخر: هو أن الوعي لا تهزه الانفعالات، يصمد أمامها، أما الطاقة الحرارية فتهزها الانفعالات، الانفعال يفجر المشاعر الباطنية المستترة، يبرز ما وراء الستار، ما وراء سطح النفس كأن الطاقة الحرارية طاقة تبرز على سطح النفس البشرية، وأما الوعي فهو شيء يثبت في أعماق هذه النفس البشرية، ففي حالة الانفعال، سواء كان الانفعال انفعالاً معاكساً، يعني حزناً وألماً أو كان انفعالاً موافقاً، أي فرحاً ولذة وانتصاراً، في كلا الحالتين سوف يتفجر ما وراء الستار ويبرز ما كان كامناً وراء هذه الطاقة الحرارية في الأمة المزودة بهذه الطاقة فقط، أما الأمة الواعية فوعيها يجمد ويتقوى على مر الزمن فكلما مر بها انفعال جديد أكَّدت شخصيتها الواعية في مقابل هذا الانفعال، وصبغته بما يتطلبه وعيها من موقف.
هذا هو الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية.
نحن ندعي أن الأمة الإسلامية العظيمة التي خلفها القائد الأعظم (ص) والتي ضربت أعظم مثل للكون في تاريخ الإنسان إلى يومنا هذا، هذه الأمة كانت تحمل طاقة حرارية كبيرة، ولم تكن تحمل وعياً مستنيراً مجتثاً لأصول الجاهلية فيها.
والدليل على هذا كله واضح من تاريخ الأمة نفسها وكشاهد على ذلك، علينا أن ننظر إلى غزوة حنين، غزوة هوازن بعد فتح مكة، ماذا صنعت هذه الأمة العظيمة بتلك الطاقة الحرارية في لحظة الانفعال، رسول الله (ص) خرج بجيش من الأنصار ومن قريش من أهل مكة فانتصر في معركته وأخذ غنائم كثيرة، وكان قراره توزيع الغنائم كلها جميعاً على من خرج من مسلمي مكة، فوزعها كذلك، ولم يعط مسلمي الأنصار شيئاً منها، هذه لحظة انفعال نفسي، إن هؤلاء الأنصار يرون أنفسهم خرجوا مع رسول الله (ص) من المدينة ليفتحوا مكة، وفتحوها وحققوا للأمة أعظم انتصاراتها في حياة النبي (ص) وبعد هذا يدخل النبي (ص) في الدين أناساً جدداً يستقلون بتمام الغنائم ويأخذونها. هذه لحظة انفعال، في هذه اللحظة من لحظات الانفعال لا تكفي الأمة الطاقة الحرارية بل تحتاج الأمة إلى وعي يثبتها لتستطيع أن تتغلب على لحظة الانفعال، هل كان مثل هذا الوعي موجوداً؟… الجواب أنه لم يكن: فإن الأنصار أخذوا يثيرون ما بينهم الهمس القائل: بأن محمداً (ص) لقي أهله وقومه وعشيرته، فنسي أنصاره وأصحابه، هؤلاء الذين شاركوه في محنته، هؤلاء الذين ضحوا في سبيله، هؤلاء الذين قاوموا عشيرته في سبيل دعوته، نسيهم وأهملهم وأعرض عنهم، لأنه رأى أحباءه وأولاد عمه، رأى عشيرته…
أنظروا إلى هذا التفسير، يبدو من خلال الأنصار وكأن المفهوم القبلي متركز في واقع نفوسهم، إلى درجة يبدو معه لهم، أن محمداً (ص) وهو الرجل الأشرف والأكمل، الذي عاشوا معه، وعاشوا تمام مراحل حياته الجهادية، ولم يبد في كل مراحله الجهادية أي لون من الألوان يعطي شعوراً قبلياً قومياً، بالرغم من هذا، وبالرغم من خلوه من أي شعور يشير إلى ذلك. في لحظة الانفعال قالوا: بأنه وقع تحت تأثير العاطفة القبلية والقومية. هذه العاطفة القبلية أو القومية هذا الترابط القبلي كيف كان قوياً في نفوسهم بحيث أنهم اصطنعوه تفسيراً للموقف في لحظة من لحظات الانفعال، رسول الله (ص) سمع بالهمس، أطلع على أن هناك بذور فتنة ضده في الأنصار، فأرسل على أبناء الأنصار من الأوس والخزرج، وجمعهم عنده ثم التفت إليهم (ص) وقال ما معناه: لقد بلغني عن بعضكم هذا الموضوع أن محمداً نسي أصحابه وأنصاره حينما التقى بقومه، فسكت الجميع واعترف البعض بهذه المقالة. حينئذٍ أخذ رسول الله (ص) يعالج الموقف والمشكلة وذلك بإعطاء المزيد من الطاقة الحرارية، لأن هذه المشكلة ذات حدين، حد آني وحد المدى الطويل، الحد على المدى الطويل يجب أن يعالج عن طريق التوعية على الخط الطويل، وهذا ما كان يمارسه (ص)، والمشكلة بحدها الآني يجب أن تعالج أيضاً معالجة آنية، والمعالجة الآنية لا تكون إلاَّ عن طريق إعطاء مزيد من هذه الطاقة الحرارية للسيطرة على لحظة الانفعال، ماذا قال (ص) ؟ كيف ألهب عواطفهم، قال لهم: ألا ترضون أن يذهب أهل مكة إلى بلادهم بمجموعة من الأموال الزائفة، وأنتم ترجعون إلى بلادكم بمحمد (ص) برسول الله (ص).
هذه كانت دفعة حرارية حوَّلت الموقف في لحظة حيث أخذ هؤلاء الآوس والخزرج يبكون أمام رسول الله (ص) ويستغفرون ويعلنون ولاءهم واستعدادهم وتعلقهم به، أراد رسول الله (ص) أن يعمق هذا الموقف العاطفي أكثر فعندما سكن بكاؤهم وهدأت عواطفهم قال لهم: ألا تقولون لي مقابل هذا، ثم أخذ يترجم بعض الأحاسيس المستترة في نفوسهم حتى يهيج عواطفهم تجاهه، ويتيح لذلك المجلس جواً عاطفياً وروحياً، بعد ذلك يتغلب على الموقف إلى آخر القصة.
هذه الأمة التي تحمل الطاقة الحرارية تنهار أمام لحظة انفعال.
شاهد آخر في لحظة انفعال أخرى أيضاً في تاريخ هذه الأمة:
الأمة بعد وفاة رسول الله (ص) تملكتها لحظة انفعال كبيرة، لأن رسول الله (ص) راحل وكان رحيله (ص) يشكل هزة نفسية هائلة بالنسبة إلى الأمة الإسلامية، التي لم تكن قد تهيأت بعد ذهنياً وروحياً لأن تفقد رسول الله (ص)، في هذه اللحظة من الانفعال أيضاً المشاعر التي كانت في الأعماق برزت على السطح.
المهاجرون: هناك تكلمنا عن الأنصار، وهنا نتكلم عن المهاجرين، ماذا قال المهاجرون في لحظة الانفعال؟…. هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من بلادهم، وتركوا دورهم وعوائلهم وقومهم في سبيل الإسلام، ماذا قالوا، وماذا كان موقفهم؟.
قالوا إن السلطان سلطان قريش، إن سلطان محمد سلطان قريش، نحن أولى من بقية العرب، وبقية العرب أولى من بقية المسلمين.
هنا يبرز الشعور القبلي والشعور القومي، في لحظة انفعال، لأن هذه اللحظة من الانفعال تشكل صدمة بالنسبة إلى الطاقة الحرارية يصبح الإنسان معها في حالة غير طبيعية حيث لا يوجد عنده وعي فينهار أمام تلك الأفكار وهذه العواطف.
إذن لحظة الانفعال هي التي تحدد أن هذه الأمة تحمل وعياً، أو طاقة حرارية.
ماذا صنع المسلمون في لحظة الانتصار والاستيلاء على كنوز كسرى وقيصر، المسلمون في هذه اللحظة، أخذوا يفكرون في الدنيا أخذوا يفكرون في أن يقتنص كل واحد منهم أكبر قدر ممكن من حطامها.
والأزمة التي مرَّت بعمر بن الخطاب في تحقيق حال الأرض المفتوحة عنوة، وأن الأرض المفتوحة عنوة هل تقسم على المقاتلين أو أنها تجعل لبيت المال، وتجعل ملكاً عاماً، هذه الأزمة تبيّن، كيف أن هذه الأمة ترددت في لحظة الانفعال، لأن وجوه المهاجرين والأنصار، هؤلاء الأبرار المجاهدون هؤلاء الذين عاشوا كل حياتهم الكفاح والجهاد في سبيل الله، هؤلاء أخذوا يصرون إصراراً مستميتاً على أن هذه الأرض يجب أن توزع عليهم، وعلى أن كل واحد منهم يجب أن ينال أكبر قدر ممكن من هذه الأرض، إلى أن أفتى علي (ع) بأن الأرض للمسلمين جميعاً، لمن هو موجود الآن ولمن يوجد بعد اليوم إلى يوم القيامة.
هذه اللحظات لحظات انفعال، لحظات الانفعال الانخذالية، ولحظات الانفعال الانفصالية هي التي تحدد أن الأمة هل تحمل طاقة حرارية، أو تحمل وعياً.
إذن كان وعي الأمة يحمل وراءه قدراً كبيراً من الرواسب الفكرية والعاطفية والنفسية التي لم تكن قد استئصلت بعد؟
وربما قيل: إذن ماذا كان يصنع النبي (ص) إذا لم تكن قد استئصلت هذه الرواسب؟
وجوابه: إن هذه الرواسب ليس من السهل استئصالها، لأن الدعوة الإسلامية التي جاء بها النبي (ص) لم تكن مجرد خطوة إلى الأمام، بل كانت طفرة بين الأرض والسماء.
إذ لاحظنا حال العرب قبل الإسلام، ولاحظنا مستوى الرسالة الإسلامية نرى أن المستوى هو مستوى الطفرة بين الأرض والسماء، لا مستوى الحركات الإصلاحية التي توجد في المجتمعات العالمية، وهي مستوى الخطوة إلى الأمام، أي حركة إصلاحية تنبع من الأرض وتنبع من عبقرية الإنسان بما هو إنسان، تزحف بالمجتمع خطوة إلى الأمام لا أكثر، المجتمع كان قد وصل إلى الخطوة السابقة، في خط التقدم، وحينئذٍ من الممكن في زمن قصير أن تستأصل رواسب الخطوة السابقة، بعد الدخول في الخطوة التالية، لأن الفرق الكيفي، بين الخطوة السابقة والثانية مثلاً، فرق قليل ضئيل التشابه، بين الخطوتين تشابه كبير جداً هذا التشابه الكبير، أو ذاك التفاوت اليسير، يعطي في المقام إمكانية التحويل، إمكانية اجتثاث تلك الأصول الموروثة من الخطوة السابقة.
لكن ماذا ترون وما تقدرون، عندما جاء النبي (ص) إلى مجتمع متأخر يعيش الفكرة القبلية بأشد ألوانها ونتائجها، وأقسى مفاهيمها وأفكارها، جاء فألقى فيها فكرة المجتمع العالمي، الذي لا فرق فيه بين قبيلة وقبيلة، وبين شعب وشعب، وبين أمة وأمة، وقال: إن الناس سواسية كأسنان المشط.
هذه الطفرة الهائلة بكل ما تضم من تحول فكري وانقلاب اجتماعي، وتغيير في المشاعر والمفاهيم والانفعالات هذه الطفرة لم تكن شيئاً عادياً في حياة الإنسان، وإنما كانت شيئاً هائلاً في حياته. إذن فكيف يمكن أن نتصور، أن هذا المجتمع الذي طفر بهذه الطفرة مهما كان هذا المجتمع ذكياً، وصبوراً على الكفاح ومهما كان قوياً ومؤمناً برسول الله (ص) كيف يمكن أن نتصور في الحالات الاعتيادية، أنه يودع تماماً ما كان عنده من الأفكار والمشاعر والانفعالات، ويقلب صفحة جديدة كاملة، دون أي اصطحاب لموروثات العهد السابق، هذا غير ممكن إلاَّ في فترة طويلة جداً مع أن رسول الله (ص) لم يعش لمجتمع ودولة كمربي تربية كاملة في المدينة إلاَّ عشر سنوات فقط، علماً أن جزءاً كبيراً من المجتمع الإسلامي دخل الأحداث بعد وفاة رسول الله (ص) ومجتمع مكة الذي دخل في حظيرة الإسلام وقت فتح مكة، وقبل سنتين فقط من وفاة رسول الله (ص).
فكيف يمكن أن نتصور من خلال هذه الأزمنة القصيرة ومع تلك الطفرة الهائلة الكبيرة إثبات تلك الأصول.
فالأصول إذن كان من المنطقي والطبيعي أن لا تبقى وكان من المنطقي والطبيعي أيضاً أن لا تجتث إلاَّ في خلال أمد طويل، وخلال عملية تستمر مع خلفاء الرسول (ص) بعده. إلاَّ أن هذه العملية قُطعت بالانحراف، بتحول خط الخلافة عن علي (ع). وهذا لا يثير استغراباً، أو يسجّل نقطة ضعف، بالنسبة إلى عمل الرسول (ص) بل ينسجم مع الرسالة مع عظمتها وجلالتها ومع تخطيط النبي (ص).
فهذه هي الأمة التي تحمل طاقة حرارية، أمة غير واعية وإذا كانت تحمل هذه الطاقة وهي غير واعية، فليست بقادرة على حماية التجربة الإسلامية وعلى وضع حد لانحراف الحاكم الذي تولى الحكم، إذ بالصيغة الأصولية التي قلناها، من أن الأمة بوصفها المجموعي ليست معصومة، ما دامت تحمل طاقة حرارية فقط، ولا تحمل وعياً مستنيراً يجتث أصول الجاهلية فيها. وما دامت كذلك فهي لا تقف في وجه هذا الانحراف. وقد قلنا بأنه حتى لو أخذنا الحاكم بغير المفهوم الشيعي، مع هذا تبقى طبيعة الأشياء وطبيعة الأحداث تبرهن على أن يكون هذا الحاكم عرضة للانحراف ولتحطيم التجربة الإسلامية، وبالتالي تحطيم جميع الأصول الموضوعية والإطار العام لهذه التجربة الشريفة المباركة. فإن الحاكم أولاً هو جزء عادي من هذه الأمة التي قلنا بأنها لم تكن تحمل وعياً مستنيراً بل كانت تحمل طاقة حرارية، ولنفرض أن هذا الحاكم لم يكن شخصاً متميزاً من هذه الأمة بانحراف خاص، وبتخطيط سابق، للاستيلاء على الحكم، لنفرض أن هذا لم يكن، وإنما هو جزء عادي من هذه الأمة تدل سوابقه على ذلك فمعنى كونه جزءاً من هذه الأمة أن الحاكم يستبطن قدراً كبيراً من الأفكار الجاهلية والعواطف الجاهلية والمشاعر الجاهلية، وهذا كان واضحاً من اللحظة الأولى، وفي الحجج التي أوردها المهاجرون ضد الأنصار. وكان من الواضح أن تقييم الخلافة لم يكن تقييماً إسلامياً، فهذه الرواسب الفكرية والعاطفية للجاهلية سوف تعمل عملها في سلوك هذا الحاكم، وفي تخطيطه.
وإذا أضفنا إلى ذلك أيضاً أن الحاكم لم يكن قد هيئ أبداً لأن يكون حاكماً، وللحاكم مشاكله الخاصة وسلوكه الخاص وثقافته الخاصة، الحاكم خاصة إذا كان حاكماً في صدر دعوة جديدة ذات حرارة خاصة وثقافة جديدة، فلا بدّ وأن يكون هذا الحاكم مهيئاً بصورة مسبقة تهيؤاً ثقافياً وعلمياً وروحياً، لأن يكون حاكماً!…
وقصدنا من عدم التهيؤ هو عدم التهيؤ الثقافي والعلمي، بمعنى أنه لم يكن قد استوعب الإسلام، عمر نفسه كان يقول: شُغِلنا أيام رسول الله (ص) في الأسواق والحرب؟. تأتيه مشكلة فلا يعرف الجواب عنها فيبعث للمهاجرين والأنصار ليستفتيهم مرة ثانية وثالثة ورابعة، حينما يتكرر هذا المطلب منه ويقف موقفاً سلبياً تجاه المشاكل من الناحية الدينية، فيعتذر عن ذلك فيقول شغلتنا أيام رسول الله (ص) الحرب والعمل في الأسواق.
رسول الله (ص) لم يهيئ هذا الحاكم
نعم رسول الله (ص) لم يكن قد اشتغل لتهيئة مجموعة من الأمة لتحكم الناس وإنما هيأ قادة معينين من أهل البيت عليهم السلام ليحكموا.
كان رسول الله (ص) يعمل على خطين للتوعية: الخط الأول هو التوعية على مستوى الأمة، وهذه التوعية للأمة بوصفها رعية بالمقدار الذي تتطلبه الرعية الواعية من فهم وثقافة، وكان له خط عمل على مستوى آخر من التوعية، للصفوة التي اختارها الله سبحانه وتعالى حتى تخلفه لقيادة هذه التجربة كانت توعية على مستوى القيادة وعلى مستوى الحاكمية.
وهؤلاء الذين تولوا الحكم بعد رسول الله (ص) لم يكونوا قد عاشوا على هذا المستوى للتوعية من الناحية الفكرية والثقافية، ألسنا جميعاً نعرف أن الصحابة اختلفوا في المسائل الواضحة جداً، اختلفوا في حكم سنَّةٍ كان يمارسها رسول الله (ص) أما أعينهم مدة طويلة اختلفوا في حكم صلاة الجنائز، هذه المسألة العبادية الصرفة البعيدة عن كل مجالات الهوى والسياسة والاقتصاد، فالاختلاف هنا اختلاف ناشئ من الجهل حقيقة، لا اختلاف ناشئ من الهوى، ليس من قبيل الاختلاف في حكم الأرض وفي حكم الغنيمة وحكم الخمس.
كل هذا ينشأ من عدم التهيئة سابقاً ومن عدم الاستعداد لممارسة الحكم ولقيادة هذه التجربة يضاف إلى ذلك أن الأمة كانت تحمل طاقة حرارية ولم تكن واعية إلى أن الحاكم كان قاصراً أو مقصراً، يضاف إلى كل ذلك أن الإسلام كان على أبواب تحول كمي هائل، كان على أبواب أن يفتح أحضانه لأمم جديدة، لم تر النبي (ص) ولم تسمع آية من القرآن منه على الإطلاق. تلك الأمة التي خلفها النبي (ص) كانت تحمل طاقة حرارية، لكن بعد أن اتسعت الأمة كمياً وضمَّت إليها شعوباً كثيرة، ضمت إليها الشعب العربي بأكمله، وضمَّت إليها من الشعوب الأخرى من الفارسية والتركية والكردية والهندية والأفغانية والأوروبية وغيرها، ما بال هذه الشعوب التي لم تكن قد رأت رسول الله (ص) ولم تسمع منه كلمة من القرآن، هل يترقب أن يكون لها وعي، أو يترقب أن يكون لها طاقة حرارية؟ تلك الطاقة، كانت نتيجة كفاح مستمر مع أشرف قائد على وجه الأرض. إن هذه الشعوب التي دخلت حظيرة الإسلام، لم تكن قد عاشت هذا الكفاح المستمر مع القائد إذن فهذا الانفتاح الهائل على الشعوب الأخرى أيضاً ضعَّف مناعة هذه الأمة، وأضعف من قدرتها على الحماية، وفتح بالتالي مجالات جديدة للقصور والتقصير أمام الحاكم.
الحاكم الذي لم يكن مهيئاً نفسياً لأن يحكم في مجتمع المدينة. كيف يكون مهيئاً نفسياً وفكرياً وثقافياً لأن يحكم بلاد كسرى وقيصر ويجتث أصول الجاهلية، الفارسية والهندية والكردية والتركية، إضافة إلى اجتثاث الجاهلية العربية، هذه الجاهليات التي كانت كل واحدة منها تحتوي على قدر كبير من الأفكار والمفاهيم الأخرى، جاهليات عديدة متضاربة فيما بينها عاطفياً وفكرياً وكلها في مجتمع واحد وفي حالة عدم وجود ضمان لا على مستوى الحاكم، ولا على مستوى الأمة؟!
لئن كان أولئك الذين خلفهم رسول الله (ص) قد رأوا بأم أعينهم، في لحظة قصيرة، تجسيداً واقعياً حياً للنظرية الإسلامية للحياة وللمجتمع في أيام رسول الله (ص) ورأوا تصرفات رسول الله (ص) في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي، وسمعوا من رسول الله (ص) أنه يقول: الناس سواسية كأسنان المشط فإن هذه الشعوب التي دخلت في الإسلام جديداً، لم تكن قد سمعت كل هذا بل سمعت هذا من الحكام الجدد الذين كانوا يقودون زعامة التجربة فإذا كان أمينها حاكماً منحرفاً، وكانت الأمة غير قادرة على مواجهة هذا الانحراف، وكانت على أبواب توسع هائل ضخم يضم شعوباً لا تعرف شيئاً أصلاً عن هذه النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية إنما تعرف الواقع الذي يتجسد خارجاً والذي عاشته كواقع وهو أن فاتحاً مسلماً سيطر على بلادها. إذن كان من المفروض ومن المنطق بحسب طبيعة الأشياء، أن تتحول النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية إلى نظرية أخرى وفق خط الحاكم الموجود فعلاً والذي يجسد في سلوكه وتصرفاته، حقيقة بعيدة عن الحقيقة التي عمل رسول الله (ص) على تجسيدها في حياته، فنظرية الحكام للحكم وكما عاشوها واقعياً وسياسياً واقتصادياً كانت كفيلة بأن تطمس تلك الأطروحة الصالحة فكرياً وروحياً كما انطمست سياسياً واقتصادياً من قبل، ولذا كان أمراً طبيعياً أن يعمل قادة أهل البيت عليهم السلام على التخطيط لحماية إسلامهم من أن يندرس، وذلك عن طريق الدخول في الصراع السياسي مع هؤلاء الحكام.
الأئمة عليهم السلام دخلوا في صراع مع الخلفاء ومع الزعامات المنحرفة، دخلوا في الصراع يحملون في أيديهم مشعل تلك النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية بكل بهائها ونورها وجمالها وكمالها ولم يكونوا يستهدفون من هذا أن يعيدوا خط التجربة لأن المؤسف أن خط التجربة لم يكن بالإمكان أن يعود مرة أخرى إلى الاستقامة بعد أن انحرف، لم يكن الصراع السياسي يستهدف في المقام أن يعيد التجربة إلى خطها المستقيم أو على المدى الطويل الطويل، ولم يكن هذا هو الهدف الآني للصراع السياسي وإنما كان الهدف الآني للصراع هو أن يبثوا الوعي في المسلمين والشعوب الجديدة التي دخلت في الإسلام على النظرية الحقيقة للإسلام عن الحياة، عن المجتمع عن الدولة عن الاقتصاد وعن السياسة وعن الآخرة ويبينوا لهم بصدق ما هو مفهوم الإسلام في هذه المجالات وصولاً إلى ترسيخ هذه النظرية في أذهان الناس.
صحيح أن النظرية كانت موجودة في القرآن، وكانت موجودة في النصوص، ولكن هذا لا يكفي وحده للوصول إلى الهدف وذلك:
أولاً: لأن النظرلايات حينما تكون حبراً على ورق لا تكفي لأن تعطي صورة واضحة عن الحقيقة الصادقة في أذهان الناس.
ثانياً: لأن القرآن والسنَّة لم تكن قد فهمته هذه الشعوب الجديدة التي قد دخلت في الإسلام. السنة: لم يكونوا قد سمعوا عنها شيئاً وإنما سوف يسمعون عنها عن طريق الصحابة. وأما القرآن الكريم فلم يكونوا قد سمعوا شيئاً عن تفسيره أيضاً، وإنما بدأوا يسمعونه عن طريق الصحابة، فلا بدَّ حينئذٍ من تجسيد حي لهذه النظرية الإسلامية، وحيث لم يكن بالإمكان تجسيده عن طريق الحكم، كان من الضروري تجسيده عن طريق المعارضة للزعامات المنحرفة على يد علي (ع) والحسن والحسين عليهم السلام أئمة المرحلة الأولى.
دور ممارسة المرحلة الأولى
كان علي (ع) يعبر عن آلام الأمة وعن آمالها، ومظالمها أمام عثمان، ويعظه ويوبخه، ويذكره الله وأيام الله والآخرة ورسول الله (ص) ولكن عثمان لم يكن يتَّعظ.
لماذا كان حريصاً كل الحرص على أن يبدو صراعه موضوعياً عقائدياً يستهدف النظرية لا الشخص يستهدف تثبيت دعائم نظرية حقيقية للإسلام، لا تدعيم شخصه، كان الإمام (ع) حريصاً على أن تكون التصورات والانعكاسات التي يعيشها الناس عن صراعه على مستوى أن صراعه صراع نظري عقائدي وليس صراعاً شخصياً لأن هذا كان من أكبر الوسائل لتثبيت حقانية هذه النظرية التي يقدمها. أليس هو يريد أن يثبت للذهنية الإسلامية أن النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية هذه لا تلك التي يطبقها الزعماء المنحرفون كيف يستطيع أن يرسخ هذا في الذهنية الإسلامية على أنه صراع عقائدي ونضالي في سبيل تثبيت النظرية، ولهذا انتظر أمير المؤمنين (ع) أن يبرز الانحراف واضحاً ثم يبدأ الصراع. لأن هؤلاء الناس الغير الواعين لا يشعرون بمرارة الانحراف إلاَّ إذا دخل الانحراف إلى بيوتهم، إلاَّ إذا مسَّ جلودهم، أما قبل هذا فلا يترقب من الأمة الغير الواعية، أن تشعر بالانحراف.
بعدما تكشَّف الانحراف في أيام عثمان إلى درجة لم يكن بحاجة إلى صعوبة لتشعر به الأمة الغير الواعية، شعرت الأمة الإسلامية بذلك خصوصاً في السنوات الأخيرة من أيام عثمان، فدخل الإمام (ع) في الصراع بشكل مكشوف ليثبت للتجربة الإسلامية دعائم النظرية الأخرى، فكان (ع) هو رمز نظرية إسلامية للحياة الاجتماعية تختلف عن النظرية المطبقة لواقع الحياة الاجتماعية تختلف عن النظرية المطبقة لواقع الحياة الاجتماعية على ما سوف نشرح.
إن أمير المؤمنين (ع) حينما تولى الخلافة بعد مقتل عثمان، أراد أن يشرح للمسلمين بطريقته الخاصة، أن المسألة ليست بالنسبة إليه تبديل شخص بشخص آخر، وليست مسألة فارق اسمي بين زعيم الأمس وزعيم اليوم، وإنما المسألة هي مسألة اختلاف شامل كامل للمنهج، وفي كل القضايا المطروحة.
إلاَّ أنه لعلاجها وتصفيتها، كان يريد أن يبين للمسلمين ضرورة أن ينظر إليه بوصفه قائماً على الخط، وقيماً على المنهج وأميناً على الرسالة. وعنواناً لدستور جديد، يختلف عن الوضع المنحرف القائم.
لأجل هذا امتنع عن قبوله الخلافة أول الأمر، فقال لهم فكروا في غيري، واتركوني وزيراً لمن تستخلفونه، فأنا لكم وزير خير مني أمير، يعني على مستوى حياة الدعة والكسل، على مستوى الرخاء واليسر، على مستوى الحياة الفارغة من المسؤولية، على مستوى هذه الحياة أنا وزير خير مني أمير، لأني حينما أكون أميراً سوف أرهقكم، سوف أتعبكم سوف أفتح أمامكم أبواب مسؤوليات كبرى تجعل ليلكم نهاراً، وتجعل نهاركم ليلاً، هذه الهموم التي تجعلكم دائماً وأبداً تعيشون مشاكل الأمة في كل أرجاء العالم الإسلامي، هذه الهموم التي سوف تدفعكم إلى حمل السلاح ـ من دون حاجة مادية ـ لأجل تطهير الأرض الإسلامية من الانحراف الذي قام عليها …
أتركوني وزيراً أكون أفضل لكم على مستوى هذه الحياة مني وأنا أمير، لأني كوزير لا أملك أن أرسم الخط، أو أن أضع المخطط، وإنما أنصح وأشير وحينئذٍ يبقى الوضع مستمراً، أصروا عليه بأن يقبل الخلافة، ففرض عليهم الشروط فقبلوها إجمالاً دون أن يسألوه التوضيح، أعطاهم فكرة عن أن عهده هو عهد منهج جديد للعمل السياسي والاجتماعي والإداري، فقبلوا هذا العهد، وكان هذا سبباً في أن ينظر المسلمون من اللحظة الأولى، إلى أن علياً بن أبي طالب (ع) بوصفه نقطة تحول في الخط الذي وجد بعد النبي (ص)، لا بوصفه مجرد خليفة، فانتعشت مع هذا العهد الجديد آمال كثيرة.
وحينما بويع علي (ع)، كانت أكثر الصعاب التي واجهها بعد بيعته، هو انشقاق معاوية وتخلف الشام بكامله لابن أبي سفيان عن الانضمام إلى بيعته. هذا التناقض، شق المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية إلى شقين، ووجد في كل منهما جهاز سياسي وإداري لا يعترف بالآخر. ومنذ البدء، كان هناك فوارق موضوعية واضحة، بين وضع علي بن أبي طالب (ع) السياسي والإداري، ووضع معاوية السياسي والإداري، تجعل هذه الفوارق معاوية، أحسن موقفاً وأثبت قدماً، وأقدر على الاستمرار في خطه من إمام الإسلام (ع).
هذه الفوارق الموضوعية لم يصنعها الإمام (ع) وإنما كانت نتيجة تاريخ، فـ:
أولاً: كان معاوية يستقل بإقليم من أقاليم الدولة الإسلامية، ولم يكن لعلي أي رصيد أو قاعدة شعبية في ذلك الإقليم على الإطلاق، لأن هذا الإقليم، قد دخل في الإسلام بعد وفاة رسول الله (ص) وانعزال علي عن خط العمل، وكان هذا الإقليم، قد دخل ودشن حياته الإسلامية بولاية يزيد أخي معاوية، ثم بعد بولاية معاوية، وعاش الإسلام من منظار آل أبي سفيان، ولم يسمع بعلي (ع)، ولم يتفاعل مع الوجود الإسلامي والعقائدي، هذا الإمام العظيم لم يكن يملك شعاراً له رصيد أو قاعدة شعبية في المجتمع الذي تزعمه معاوية، وحمل لواء الانشقاق فيه، في حين، العكس فإن شعار معاوية كان يملك رصيداً قوياً وقاعدة قوية في المجتمع الذي تزعمه الإمام (ع) لأن معاوية، كان يحمل شعار الخليفة القتيل، والمطالبة بدمه.
هذا كان أمير ذلك المجتمع الذي تزعمه علي (ع)، وكان لهذا الخليفة القتيل أخطبوط في هذا المجتمع وقواعد. وهكذا كان شعار ابن أبي سفيان يلتقي مع وجود ومع قاعدة ورصيد في داخل مجتمع أمير المؤمنين (ع) بينما لم يكن شعار علي يلتقي مع قاعدة ورصيد في داخل مجتمع معاوية.
ثانياً: كانت طبيعة المهمة تميز معاوية عن علي بن أبي طالب (ع)، لأن أمير المؤمنين (ع) بوصفه الحاكم الشرعي، والمسؤول عن الأمة الإسلامية كان يريد أن يقضي على هذا الانشقاق الذي وجد في جسم الأمة الإسلامية وذلك بشخصية هؤلاء المنحرفين، وإجبارهم بالقوة على انضمامهم إلى الخط الشرعي، وكان هذا يستدعي الدخول في الحرب، التي تفرض على علي (ع) الطلب من العراقي أن يخرج من العراق، تاركاً أمنه ووحدته واستقراره، ومعيشته ورخاءه ليحارب أناساً شاميين لم يلتق معهم بعداوة سابقة، وإنما فقط بفكرة أن هؤلاء انحرفوا، ولا بدَّ من إعادة أرض الشام للمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، فكان موقف علي (ع) يتطلب ويفترض ويطرح قضية الهجوم على أناس لا يملكون ـ في غالبيتهم ـ الوعي لخطورة تراخيهم على قمع هذا الانحراف، انطلاقاً من عدم استيعابهم لأبعاده؟!
في حين أن معاوية بن أبي سفيان، يكتفي من تلك المرحلة، بأن يحافظ على وجوده في الشام، ولم يكن يفكر (ما دام أمير المؤمنين) أن يهاجم أمير المؤمنين، وأن يحارب العراق ويضم العراق إلى مملكته، وإنما كان يفكر فقط، في أن يحتفظ بهذا الثغر من ثغور المسلمين، حتى تتهيأ له الفرص والمناسبات والظروف الموضوعية، بعد ذلك يتآمر على الزعامة المطلقة في كل أرجاء العالم الإسلامي. فمعاوية لم يكن يقول للشامي، أترك استقرارك ووحدتك، واذهب إلى العراق محارباً، لأن هذا الشخص خارج عن طاعتي، ولكن كان علي (ع) يقول هذا للعراقي، لأن علياً (ع) كان يحمل بيده مسؤولية الأمة، ومسؤولية إعادة وحدة المجتمع الإسلامي، بينما كان كل مكسب معاوية وهمَّه أو قصارى أمله، أن يحافظ على هذا الانشقاق ويحافظ على هذه التجزئة التي أوجدها في جسم المجتمع الإسلامي. وشتان بين قضية الهجوم حينما تطرح وقضية الدفاع.
ثالثاً: كان هناك فرق آخر بين معاوية والإمام (ع) وهو أن معاوية، كان يعيش في بلد لم يكن قد نشأت فيه زعامات سياسية طامحة إلى الحكم والسلطان من ناحية ولم يكن فيه أناس ذوي سابقة في الإسلام، ممن يرى لنفسه الحق أن يساهم في التخطيط وفي التقدير، وفي حساب الحاكم، وفي رسم الخط، لم يكن هكذا، الشام أسلمت في عهد معاوية وأخيه، كلهم كانوا نتيجة لإسلام معاوية ولإسلام أخي معاوية، ولإسلام من استخلف معاوية على الشام ولم يكن قد مني بتناقضات من هذا القبيل.
أما علي (ع) فكان يعيش في مدينة الرسول (ص) كان يعيش في حاضرة الإسلام الأولى التي عاش فيها الرسول (ص) وعاش بعد ذلك أبو بكر، وعاش بعد ذلك عمر وعثمان، حتى قتلا، ومن ناحية كان يواجه كثيراً ممن يرون أن من حقهم أن يساهموا في التخطيط، وأن يشتركوا في رسم الخط، كان يواجه علي (ع) أشخاصاً كانوا يرونه نداً لهم، غاية الأمر أنه ندّ أفضل، ند مقدم، لكنهم صحابة كما أنه هو صحابي عاش مع النبي (ص) وعاشوا مع النبي (ص).
طبعاً إننا نعلم أيضاً، بأن خلافة علي كانت بعد وفاة النبي (ص) بعشرين سنة، وهذا معناه، أن ذلك الامتياز الخاص الذي كان يتمتع به أمير المؤمنين في عهد الرسول (ص) كالنجم لا يطاول، ذاك الامتياز الخاص كان قد انتهى مفهومه وتضاءل أثره في نفوس المسلمين، الناس عاشوا عشرين سنة يرون علياً مأموماً، يرونه منقاداً، يرونه جندياً بين يدي أمير. هذا الإحساس النفسي خلال عشرين سنة أذهب تلك الآثار التي خلفها عهد النبوة، وهكذا كان علي (ع) يُنظر إليه بشكل عام، عند الصحابة الذين ساهموا في حل الأمور وعقدها وكانوا يمشون في خط السقيفة، هؤلاء الصحابة الذين قدموا للإسلام في صدر حياتهم، وكانوا قد قدر لهم بعد هذا أن يمشوا في خط الانحراف، هؤلاء كانوا ينظرون إلى علي الأخ الأكبر، الزبير صحيح كان يخضع لعلي (ع) لكن كان يخضع له كالأخ الأكبر لا يرى أن إسلامه مستمد منه، هذه الحقيقة الثانية الثابتة التي كانت واضحة على عهد النبي (ص) حُرِّفت خلال عهد الانحراف، ولهذا كان الزبير يعترف بأن علياً أفضل منه، لكنه لا يرى نفسه مجرد آلة ومجرد تابع يجب أن يؤمر فيطيع، فكان هناك أناس من هذا القبيل، هؤلاء يريدون أن يشتركوا في التخطيط ويشتركوا في رسم الخط، في ظرف هو أدق ظرف وأبعده عن عقول هؤلاء القاصرين.
رابعاً: كانت توجد هناك الأطماع السياسية والأحزاب السياسية التي تكوَّنت، واستفحلت نتيجة لما سمي بالشورى في تعيين الرجال السبعة الذين عيَّنهم عمر ليختاروا من بينهم خليفة، هذه الأحزاب السياسية كان يفكر في أمرها ويفكر في مستقبلها ويفكر في أنه كيف يستفيد أكبر قدر ممكن من الفائدة في خضم هذا التناقض، وهذا بخلاف معاوية لم يكن قد مني بصحابة أجلاَّء يعاصرونه ويقولون له نحن صحابة كما أنت صحابي، بل كان أهل الشام أسلموا في عهده وعهد أخيه، لم ير أحد منهم رسول الله (ص) ولم يسمع أحد القرآن إلاَّ عن طريق معاوية، إذن كانت حالة الاستسلام في المجتمع الشامي بالنسبة إليه لا يوجد ما يناظرها بالنسبة إلى الإمام (ع) في مجتمع المدينة والعراق.
خامساً: كان هناك فرق آخر بين الإمام (ع) ومعاوية، وحاصل هذا الفرق هو أن الإمام (ع) كان يتبنى قضية هي في صالح الأضعف من أفراد المجتمع، وكان معاوية يتبنى قضية هي في صالح الأقوى من أفراد المجتمع، أمير المؤمنين (ع) كان يتبنى الإسلام بما فيه من قضايا العدالة الاجتماعية التي يمثلها النظام الاقتصادي للإسلام، وهذه القضايا لم تكن في صالح الأقوى، بل كانت في صالح الأضعف، ومعاوية كان يمثل الجاهلية بفوارقها وعنفوانها وطبقاتها، وهذا لم يكن في صالح الأضعف بل كان في صالح الأقوى، وذلك أنه بعد رسول الله (ص) حينما دخل العراق والشام وبقية البلاد في داخل المجتمع الإسلامي، لم يقدر الخلفاء الذين تزعموا زعامة المسلمين على تذويب التنظيم القبائلي الذى كان موجوداً في هذه البلاد، بل بقي التنظيم القبائلي سائداً وبقي زعيم كل قبيلة هو الشخص الذي يرتبط كهمزة الوصل بين قبيلته وبين السلطان. وهذا التنظيم القبائلي بطبيعته، يخلق جماعة من الزعماء ومن شيوخ هذه القبائل الذين لم يربِّهم الإسلام في المرتبة السابقة ولم يعيشوا أيام النبوة عيشاً صحيحاً مما جعل من هؤلاء طبقة معينة ذات مصالح، وذات أهواء وذات مشاعر في مقابل قواعدها الشعبية مما يوفر لهم أسباب النفوذ والاعتبار.
الآن تصوروا مجتمعاً إسلامياً تركه الخلفاء وهو يعم بالتقسيمات القبلية بمعنى أن كل قبيلة كانت تخضع إدارياً وسياسياً لزعامة تلك القبيلة التي تشكِّل كما قلنا همزة وصل بين القبيلة وبين الحاكم الذي يسهل عليه أن يرشي رؤساء هذه القبائل بقدر الإمكان وكان عاملاً من عوامل القوة بالنسبة إلى معاوية، هذه الظروف الموضوعية لم يصنعها الإمام (ع) وإنما هي صنعت خلال التاريخ وأوجدت لمعاوية مركزاً قوياً ووجد للإمام مركز ضعف ولولا براعة التضحية وكفاءته الشخصية ورصيده الروحي في القطاعات الشعبية الخاصة الواسعة، لولا ذلك لما استطاع (ع) أن يقوم بما مرَّ به نفسه من حروب داخلية خلال أربع سنوات.
هكذا بدأ الإمام بخلافته ودشَّن عهده، وبدأ الانقسام مع هذا العهد على يد معاوية بن أبي سفيان، وأخذ الإمام يهيئ المسلمين للقيام بمسؤولياتهم الكبيرة للقيام بدورهم في تصفية الحسابات السابقة، في تصفيتها على المستوى المالي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي والإداري أيضاً، كل ذلك كان يحتاج إلى الكفاح والقتال فأخذ يدعو الناس إلى القتال وخرجوا إليه فعلاً. لقد درسنا إلى هنا علياً مع معاوية بحسب ظروفه الموضوعية، فلا بدَّ وأن ندرس الذهنية العامة للمسلمين أيضاً، كيف كان يُفسر هذا الخلاف الموجود بين علي ومعاوية.
الذهنية العامة للمسلمين بدأت تفسر هذا الخلاف، بأنه خط خلافة راشدة، وبين شخص يحاول الخروج على هذه الخلافة، كانوا ينظرون إلى علي بشكل عام على أنه هو الخليفة الراشد، الذي يريد أن يحافظ على الإسلام، ويحافظ على خط القرآن في حين أن معاوية يحاول أن يتآمر على هذا المفهوم. استطاع أمير المؤمنين (ع) أن يثبت هذا الانطباع، بالرغم من كل الظروف الموضوعية التي قلناها، في ذهن القاعدة الشعبية الواسعة، في كل أرجاء العالم الإسلامي، عدا القطر الذي كان يرتبط بمعاوية، وهذه الذهنية هي التي كانت تصبغ المعركة بين علي ومعاوية بطابع الرسالة، كأن تعطيه معنى رسالياً. وكانت تفسر هذه المعركة بأنها معركة بين الجاهلية والإسلام، بين فكرين، بين هدفين، وليس بين زعامتين وشخصيتين، إلاَّ أن الأمر تطور إلى الأسوأ حيث إن المسلمين بدأوا يشكون شكاً واسع النطاق، بأن المعركة بين أمير المؤمنين (ع) وبين معاوية بن أبي سفيان معركة رسالية.
من الصعب جداً أن نتصور أنه كيف يمكن للمسلمين أن يشكوا في أن المعركة القائمة بين إمام الورع والتقى والعدالة، وبين شخص خائن جاهلي منحرف عدو رسول الله (ص) كانت معركة رسالية إلاَّ أني لا أشك في أن عدداً كبيراً من المسلمين على مرَّ الزمن في عهد خلافة أمير المؤمنين بدأ يشك في أن هذه المعركة، أهي رسالية حقيقية أو غير رسالية وهنا يجب أن نعرف أن المسلمين الذين شكوا من هم. إنهم أولئك الذين عرفناهم عقيب وفاة الرسول (ص) بشخص المبادئ التي طرحها (ص)، هم أولئك المسلمون الذين خلفهم الرسول فكانت خير أمة أخرجت للناس، على مستوى إيمانهم وطاقتهم الحرارية وإشعاعهم وشحنهم من النبي (ص)، ولكن لم يكن لهم من الوعي العقائدي الراسخ إلاَّ شيء قليل، هذا المعنى شرحناه وبيَّناه وبيَّنا جهاته وقلنا إن الأمة لم تكن على مستوى الوعي وإنما كانت على مستوى الطاقة الحرارية، إذن فنحن لن نتوقع فيها أن تبقى مشتعلة، وتبقى على جذوتها وحرارتها بعد وفاة رسول الله (ص)، يبقى هذا أيضاً غير منطقي، إذن يجب أن نفكر في أن هذه الطاقة الحرارية قد تضاءلت بدرجة كبيرة وحتى تلك الصبابة من الوعي تلك الجذور من الوعي التي كان رسول الله (ص) قد بدأ بها كي يواصل بعد هذا خلفاؤه المعصومون عملية توعية الأمة، حتى تلك البذور قد فتّت، وأخفقت ومنع بعضها عن الإثمار، وبقي بعضها الآخر بذوراً منقسمة أيضاً. وحينما نتصور الأمة الإسلامية بهذا الشكل، من ناحية أخرى يجب أن نتصور مفهوم المسلمين عن معاوية، نحن الآن ننظر إلى معاوية بعد أن استكمل حظه من الدنيا، وبعد أن دخل الكوفة وصعد على منبر علي بن أبي طالب (ع) وقال إني لم أحاربكم لكي تصوموا أو تصلوا وإنما حاربتكم لكي أتأمّر عليكم، بعد أن أعلن بكل صراحة ووقاحة عن هدفه، وبعد أن طرح بكل برودة شعار الخليفة المظلوم وشعار الخليفة القتيل، دخل عليه أولاد عثمان بن عفان وقالوا له: لقد جعلنا هذا الأمر وتم الأمر لك يا أمير المؤمنين، فما بالك لا تقبض على قتلة أبينا، قال: أو لا يكفيكم أنكم صرتم حكَّام المسلمين.
نحن ننظر إلى معاوية بعد أن ارتكب الفظائع وغير أحكام الشريعة وأبدع في السنة، ننظر إلى معاوية بعد أن استخلف يزيد ابنه على أمور المسلمين، وبعد أن قتل مئات من الأبرار والأخيار، ننظر إلى معاوية بعد أن تكشفت أوضاعه، لكن فلنفرض أن شخصاً ينظر إلى معاوية قبل أن تكشف له هذه الأوضاع، لنفترض أن أولئك الأشخاص يعيشون في إطار الأمة الإسلامية وقتئذٍ، معاوية ماذا كان يكشف عن أوضاعه وقتئذٍ على المسلمين، ماذا كان من أوراق معاوية مكشوفاً وقتئذٍ؟ كان معاوية شخصاً قد مارس عمله الإداري والسياسي بعد وفاة رسول الله (ص) بأقل من سنة، خرج إلى المدينة وذهب إلى الشام كعامل عليها، وبقي معاوية هناك مدللاً محترماً معززاً، وبعد هذا جاء عثمان فوسع من نطاق ولاية معاوية، وضمَّ إليه عدة بلاد أخرى، إضافة إلى الشام، ولم يطرأ أي تغيير في ابن أبي سفيان، فمعاوية لم يكن شخصاً مكشوفاً، ثم دخل الصراع لأول مرة شعار الأخذ بالثأر لدم عثمان، هذا الشعار الذي أخذه معاوية وكان يبدو للبسطاء من الناس وكثير من المغفلين، كان شعاراً له وجهة شرعية، كان يقول بأن عثمان قتل مظلوماً، وعثمان بالرغم من أنه خان الأمانة من استهزاء بالإسلام، وبالرغم من أنه صيَّر الدولة الإسلامية إلى دولة عشيرة وقبيلة، وبالرغم من أنه ارتكب الجرائم التي أدنى عقابها القتل، بالرغم من هذا، ابن أبي سفيان يقول: قتلت عثمان مظلوماً. وليس هناك من يعرف بأن عثمان يستحق القتل، كثير من الناس البسطاء أيضاً يقولون: عثمان قتل مظلوماً. فلا بدَّ من القصاص، فيا علي إن كنت قادراً فأعطنا قاتليه، وإن كنت عاجزاً، فأنت عاجز عن أن تطبق أحكام الإسلام فاعتزل الحكم لأن الخليفة يشترط فيه القدرة على تطبيق أحكام الإسلام.
هذا هو الشعار الذي أبرزه معاوية في مقابل الإمام (ع)، والإمام (ع) في مقابل هذا الشعار لم يكن يريد بأن يصرح بأن عثمان كان جديراً بأن يقتل، أو كان يجب أن يقتل، لأنه لو صرَّح بهذا، لتعمَّق اتهام معاوية وطوَّر التهمة من قول أعطني، إلى قول: إنك قتلت عثمان، فبقي شعار معاوية شعاراً مضللاً إلى حد كبير.
ثم لا بدَّ وأن نلاحظ الجهود والأتعاب والتضحيات التي قام بها المسلمون في كنف علي (ع). لا أدري هل إن أحداً جرّب أو لم يجرب هذا الإيحاء النفسي، حينما تكون المهمة صعبة على الإنسان وثقيلة، حينئذٍ توسوس له نفسه بالتشكيك في هذه المهمة بمختلف التشكيكات، فحينما يصعب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذٍ يأخذ بالوسوسة، من قال بأن هذا الرجل مبطل، من قال إنه قادر على هذا الكلام من قال إن شروط الأمر بالمعروف تامة، وهكذا يوسوس لأجل أن يستريح من هذه المهمة، لأجل أن يلقي عن ظهره هذا العبء الكبير، كل إنسان يميل بطبعه إلى الدعة، إلى الكسل إلى الراحة إلى الاستقرار، فإذا وضعت أمامه مهام كبيرة، حينئذٍ، إذا وجد مجالاً للشك في هذه المهمة فسوف يكون عنده دافع نفسي إلى أن يشك، يُشكل لأجل أنه يريد أن يشك، ويشكل لأجل أنه من مصلحته أن يشك، وهذا كان موجوداً على عهد الإمام (ع).
العراقيون قدَّموا من التضحيات شيئاً كثيراً بذلوا أموالهم ونفوسهم ودمائهم في حروب ثلاثة، آلاف من العراقيين ماتوا وقتلوا، عشرات من الأطفال يتموا، آلاف من النساء أصبحن أرامل، آلاف من البيوت والعوائل تهدمت، كثير من المدن والقرى غارت عليها جيوش معاوية، كثير من هذه المآسي والولايات حلَّت بهؤلاء المسلمين، نتيجة ماذا ولأجل ماذا؟ لأجل أن يزداد مالهم؟ لا، لأجل أن يزداد جاههم؟ لا، وإنما لحساب الرسالة، لحساب الخط، لحساب المجتمع الإسلامي، لأجل هذا الهدف الكبير، وهذا هدف كبير أعز من كل النفوس وأعز من كل الدماء وأعز من الأموال. لكن نحن يجب أن نقدر موقف هؤلاء الذين ضحُّوا وبذلوا وقدموا، ثم أصبحوا يشككون لأن من مصلحتهم أن يشككوا، وأصبح الإمام يدفعهم فلا يندفعون، يحركهم، فلا يتحركون، لماذا؟ لأن من مصلحتهم أن يعطوا للمعركة مفهوماً جديداً، وهو أن القصة قصة زعامة علي أو معاوية، ما بالنا وعلي ومعاوية؟ إما أن يكون هذا زعيماً وإما أن يكون ذلك زعيماً، نحن نقف على الحياد ونتفرج، فإما أن يتم الأمر لهذا أو لذاك، هذا التعبير بداياته، وهذا التفسير الذي أوحت مصلحة هؤلاء وهؤلاء هو الذي كان يشكل عقبة دون أن يتحركوا دون أن يتحرك هؤلاء من جديد إلى خط الجهاد، هذا التعبير هو الذي جعل أمير المؤمنين (ع) يبكي من على المنبر، وينعى أصحابه الذين ذهبوا، أولئك الذين لم يشكوا في خطه وفيه لحظة أولئك الذين آمنوا به إلى آخر لحظة، أولئك الذين كانوا ينظرون إليه كامتداد لرسول الله (ص)، من قبيل عمار وأمثاله، هذا عمار الذي وقف بين الصفين، ووضع سيفه على بطنه، وقال: اللهم إنك تعلم أن لو كان رضاك أن أغمد هذا في بطني حتى أخرجه من ظهري لفعلته، اللهم إنك تعلم أني لا أعلم رضاك إلاَّ في قتال هؤلاء المانعين المنحرفين، كان يبكي لأمثال عمار، لأن عمار وأمثاله كانوا قد ارتفعوا فوق هذه الشكوك، قد طلَّقوا مصالحهم الشخصية لمصلحة الرسالة، كانوا قد غضوا النظر عن كل الاعتبارات الخاصة في سبيل حماية كيان الإسلام، وفي سبيل إعادة مجد المجتمع الإسلامي ووحدة المجتمع الإسلامي إلى هؤلاء.
أصبح هؤلاء الذين كانوا يفكرون في الهموم الكبيرة يفكرون في الهموم الصغيرة، أصبحوا يفكرون في قضاياهم، يجب أن لا نعتب عليهم، نحن أسوأ منهم فنحن لم نرتفع لحظة هكذا، نهبط وهؤلاء ارتفعوا لحظة ثم هبطوا. هؤلاء خرجوا من بلادهم وطلقوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم في سبيل الله، وفي سبيل قضية ليس لهم ربح مادي فيها. هؤلاء فعلوا هذا ساعة ثم أدركهم الشيطان، أما نحن فلا ندري إذا وقفنا مثل هذا الموقف هل نصمد ولو ساعة أو نبقى مكاننا، على أي حال هؤلاء كانوا ثلة، لم يكونوا عمار بن ياسر، هؤلاء بدأ الشك يتسرب إلى نفوسهم، بدأوا يشكون في هذا الإمام (ع) الصالح حتى تمنى الموت، لأن الإمام (ع) أصبح يحس أنه انقطع عن هؤلاء، وأصبح منفصلاً عنهم. إنهم أصبحوا لا يفهمون أهداف رسالته. ومن أَمَرِّ ما يمكن أن يقاسيه زعيم أو قائد أن يعيش في جماعة لا تتفاعل معه فكرياً، ولا تعيش مع أهدافه ولا مع خطه، مع إنسان يبذل كل ما لديه في سبيلهم، وهم لا يحسون أن كل هذا في سبيلهم، وإنما يشكون فيه، في نيته، هذا هو الامتحان العسير الذي قاساه، أفضل الصلاة والسلام عليه، لكن بالرغم من كل هذا الامتحان يحاول أن يبث من روحه الكبير في هذا المجتمع المتفتت الذي بدأ يشك، والذي بدأ يتوقف. كان يحاول أن يبث فيهم من روحه الكبير، إلى أن خرَّ شهيداً في مسجد الكوفة.
محمد باقر الصدر
مثالية وانتهازية
سوف نلتقي ونحن نعرض لسيرة الحكم الإسلامي بمواقف لعلي بن أبي طالب يعدها بعض المؤرخين مظهر ضعف أو وقوعاً في الخطأ، أو غير ذلك من الأوصاف التي وصف بها هذا الزعيم الإسلامي العظيم بالفعل، وهو أمر محير فعلاً، فلو أن علياً بن أبي طالب كان أقل التزاماً لمثاليته الإنسانية لكسب جولته مع خصوم الشعب، ولكن ما الذي كان يبقى من مبادئه وأهدافه بعد ذلك.
إن النزعة التحررية في الإسلام لم تمت بموت علي، فثورات الشعب لم تنقطع بعد مقتله، بل امتدت عبر التاريخ الإسلامي كله، تكتسب في كل عصر صورة جديدة تناسب هذا العصر. وقد بقيت جذوة العدل الاجتماعي متوهجة طوال العصور، رغم تعدد الفتوح الإسلامية، ورغم الأساليب العديدة التي لجأ إليها الحاكمون المتسمون بدهاء قلَّما عرف تاريخ الشعوب الأخرى مثيلاً لها، فقد ألفت الكتب تحت أعينهم وتوجيههم لتدمغ خصومهم بكل صفة شنيعة، بل شكلت فرق مزيفة تنتسب إلى الشعب حتى تدمغ الحركات الشعبية بالانحراف بل والكفر، وكثيراً ما تجد هذه الفرق المزيفة أنصاراً لها من أبناء الشعب المضللين فتتضخم وتزداد إيغالاً في المروق، حتى يختلط الأمر على المؤرخ الحديث، فلا يستطيع أن يميز نزعة الشعب الحقيقة من النزعات الملفقة.
ولهذا أصبح التاريخ الإسلامي غامضاً شيئاً ما، يجتهد فيه المؤرخ اجتهاده كله ليخرج بالحقيقة أو ما هو أقرب إلى الحقيقة.
ورغم هذا الحشد الهائل من التراث بما فيه من صدق وبما فيه من افتراء، فإن تلك الجذوة التي فجَّرها الإسلام، على يدي نبيّه، ثم على يدي علي بن أبي طالب لم تنطفئ أبداً، وكان المسلمون دائماً يستشعرونها في كل عصر ولو بشكل غامض وكلَّما أحسوا ضغط الحكام وظلمهم.
ولهذا كانت قابلية الشعب الإسلامي في كل زمان لفكرة العدل الاجتماعي، ولهذا لم تتوقف تلك النزعة في كل العصور عن أن تظهر في شكل من الأشكال كثورة اجتماعية تريد أن تنتصف للمستضعفين من أصحاب السلطان والثراء من المستغلين والمستأثرين.
ولقد قلت من قبل أن الثورة ليست تغييراً في المراكز الاقتصادية فحسب بل هي قبل كل شيء تغيير جذري في وجهة نظر الإنسان إلى الكون. هي نظرة جدية أكثر اتساعاً إلى الكون الغامض. وإلى علاقات البشر بعضهم ببعض. وإلى الطريق الأمثل الذي يجب أن تختطه البشرية في مسيرها الطويل الأبدي إلى أن تكون أكثر فهماً وإدراكاً لحقيقة وجودها. وكل ثورة في التاريخ البعيد أو القريب، لم تأت بنظام اقتصادي توزع به الثروة توزيعاً جديداً. بل جاءت قبل ذلك بفلسفة جديدة، تستوي في ذلك الديانات السماوية والثورات الحديثة حتى الثورة البرجوازية، والثورات الاشتراكية الحديثة.
ولقد يفلح علي بن أبي طالب أو غيره من عظماء التاريخ البشري في أن يقيم مجتمعاً اقتصادياً يسوده العدل الاجتماعي بالقياس إلى عصره، ولكن على أسس وبأساليب لا تتفق مع فكرة العدل وأهدافها، فلا يلبث هذا البناء أن يتغير ولا تبقى منه إلاَّ تلك الأساليب التي تصبح تراثاً رهيباً يتجنبه البشر فيما يلي ذلك من العصور.
ولو لم يسر علي بن أبي طالب سيرته المثالية هذه، أكانت تبقى تلك الجذوة مشتعلة وكامنة في النفوس؟
ومن الغريب أنه ما من فكرة عظيمة تبقى في الأرض وتؤتي ثمارها إلاَّ بالتضحية والفداء بل وبالعذاب أقسى ما يكون العذاب، وهذا النوع من الرجال العظماء هو الذي قدِّر عليه أن يخوض التجربة حتى النهاية، وأن يمتحن بكل أنواع العذابات دون أن يتردد أو يتراجع وكأن دوره الوحيد أن يكون مثالاً في التاريخ البشري، كأنه علامة من علامات الطريق.
وإذا خرجنا عن هذا التعميم إلى واقع الحياة في عصر علي وما فيه من صراعات، فسوف نجد أن كل شيء يرشحه لأن يلعب دور الفدية والمثال.
فقد كان كل طريق أمامه مفتوحاً إلى هذه النهاية الأليمة المشرقة أشد ما يكون الإشراق.
ولهذا فإن علياً لعب دوره الجليل كأعظم ما يلعب الإنسان الفائق دوره في التاريخ.
فها هو ذا يتسلم السلطة في مجتمع تغيرت فيه المراكز الاقتصادية تغيراً مفاجئاً فبعد أن كان العرب مجموعة من القبائل التي تحيا حياة خشنة، صاروا فاتحي أكبر امبراطورية في عصرهم يأتيهم الخراج من أركان الأرض ويتنافسون في الاستيلاء عليه، ويتصارعون في الوثوب إلى مراكز السيادة والحكم، ولم يعد المجاهدون من المهاجرين والأنصار فئة مغلوبة على أمرها فقيرة في مواردها وحقوقها وأمنها، بإزاء سطوة رأس المال المكي وعصبية القبائل الحاكمة بل سادة وحكاماً، حتى بين خصومهم الطبقيين الأقدمين، ونتيجة للفتوح صار كل رجل من ثوار المهاجرين والأنصار يحتل مركزاً كبيراً أو صغيراً في هذه الأرض الواسعة ذات الخيرات العديدة المفاجئة. بل إن الخصوم الطبقيين سرعان ما تلاقوا وتساووا في الوضع الاجتماعي وزالت حدة الصراع الطبقي ليحل محلها صراع على الغلب والسيطرة والانفراد بالسلطة واتخذ هذا الصراع شكله المذهبي أو العقائدي، أكثر مما اتخذ صراعاً طبقياً.
في هذا الظرف المتغير جاء علي بن أبي طالب إلى الخلافة.
ماذا كان يستطيع أن يقدم لعرب الجزيرة المنطلقين في كل مكان، من عدل اجتماعي.
نعم كانت هناك فوارق طبقية، وإلاَّ فلماذا قام أبو ذر في المدينة ثم في الشام يدعو إلى تحريم كنز المال ويدعو إلى توزيعه على المسلمين، نعم كانت هناك حقوق مسلوبة يدافع عنها عمار بن ياسر وأبو الدرداء، وعبد الله بن مسعود وغيرهم من زعماء الشعب.
لقد تحول المهاجرون والأنصار إلى سادة بغير شك، وجرت الأموال من أيديهم بغير شك. ولكن المسلمين لم يكونوا هم المهاجرين والأنصار فحسب، بل كثيرون غيرهم من سكان البادية والقبائل اليمنية والمستوطنين في الأمصار المفتوحة وغيرهم من الأعداد الوفيرة التي كوَّنت قاعدة المسلمين في ميادين القتال.
كان هناك إذن فقر وكان هناك غنى فاحش لا يصدقه المعاصرون، فإن ثروات بعض كبار المسلمين كانت تعد بالملايين، وكان هناك الفقر الذي جعل صحابياً كبيراً كأبي ذر يفقد أبناءه بسبب سوء التغذية حين قطع عنه عطاؤه، أو حين أسرف على نفسه بالصدقة على الفقراء بكل مال يقع في يده.
على أن القوى التي كانت تتصدى للقيادة وتتصارع على المناصب كانت على شيء من السعة في الرزق مع تفاوت كبير أو صغير في الدرجات، وصراعها فيما بينها بما تمثله من اتجاهات لا تحركه إلاَّ العقيدة أو لا تحركه إلاَّ العقيدة في المقام الأول، فالشعبيون الأحرار كانوا يرون أن الإسلام يسوي بين الناس في الحقوق. والآخرون كانوا يرون أن يستأثروا بالمال كله ما دام جاءهم عن مغنم في حرب أو من تجارة واسعة، بل في أحيان كثيرة حتى إذا جاء من بيت مال المسلمين نفسه.
وكان الحكام يعتقدون أن بيت المال هو حق لهم يوزعونه على أنفسهم إن أرادوا … وكثيراً ما كانوا يريدون ذلك.
ففي الأيام الأخيرة من حكم عثمان كان ولاته يأخذون لأنفسهم ما يريدون دون رقيب. حتى إذا احتج خازن بيت المال، وهو لا يحتج عادة إلاَّ إذا كان من هذا النوع من المسلمين الشعبيين الأحرار، اضطهدوا هذا الخازن أو طروده كما فعل عثمان نفسه مع عبد الله بن مسعود وقال قولته الشهيرة: إنما أنت خازن لنا، يعني أنه ليس خازناً للمسلمين بل للخليفة وأعوانه.
والواقع أن خازن بيت المال ـ فيما عدا الرجال من أمثال عبد الله بن مسعود ـ كان له نصيب في هذا المال متواطئاً مع الوالي نفسه، أو غير متواطئ.
وما أكثر ما حمل الوالي المعزول كل ما في بيت المال وذهب به إلى مكة أو المدينة وابتنى له هناك قصراً واشترى الجواري والقيان واستقبل الشعراء، وقضى حياة التقاعد المؤقت أو الدائم في دعة ولهو دون أن يحاسب على ذلك من السلطة المسؤولة، حتى يبدو أن هذا صار عرفاً بين السادة الحاكمين.
وليس هناك شك في أن الإسلام الحقيقي كان يكره هذا ويحاربه، وآية ذلك اللجاجات الكثيرة التي قامت حوله، بل والثورة على عثمان تلك الثورة التي أدَّت إلى وصول علي بن أبي طالب إلى الحكم.
وحين نحصي أعمال علي بن أبي طالب في مجال توزيع الثروة، سنجد أنه لم تمتد يده إلى الأموال التي استولى عليها أنصار الحكم العثماني، فهو لم يفرغ ساعة من الزمان ليعيد توزيع الثروة، ويثبت أساس النظام الاقتصادي.
كل ما استطاع أن يضيفه هو توزيع ما يرد إلى بيت المال على المسلمين في حينه، فلا يختزن عن المسلمين شيئاً منه، حتى روي أنه كان يوزع الخيط والأبر، وكان يعتز كثيراً بأن يكنس بيت المال ويرشه بعد تفريغ ما فيه ويصلي فيه ركعتين.
فهو هنا يطبق رأي العدل الإسلامي الذي عبَّر عنه هو لعمر بن الخطاب من قبل. وعبَّر عنه أبو ذر لعثمان ومعاوية من بعده، بأن المال مال المسلمين، وأنه حق لهم، يوزع عليهم ولا يحتجز دونهم أو يستأثر به بعضهم ويحرم منه البعض الآخر.
على أن الآخرين كانوا يعلمون المدى الذي سيسير عليه علي بن أبي طالب … فهم يعلمون فحوى نظريته في الملكية، أو على الأصح فحوى نظر الإسلام إلى الملكية، وقد تحاجج بها كثيراً مع عثمان، وتحاجج بها أنصاره من أمثال عمار وأبي ذر. فقالا أنه لا يحق للمسلم أن يمتلك مالاً إلاَّ من نتاج عمل يديه، لا من عمل الآخرين، وأنه فوق ذلك لا يصح أن يختزن المسلم ما يزيد على حاجته وحاجة عياله. فالكنز شيء هاجمه الإسلام أشدَّ المهاجمة. وكثيراً ما كانوا يرددون الآية الكريمة: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾ إلى آخر الآية … فكل مال فائض أو كل فضل مال ينبغي أن يتخفف منه صاحبه إلى غيره من المسلمين المحتاجين، فلا يجوز أن تشبع وجارك جائع، أو تكسى وجارك عار. وبالتالي فلا يجوز أن تنعم بأطايب الحياة من سكنى القصور، وجارك يسكن العراء أو يأوي إلى بيت متداع … إن المال يقسم على المسلمين حتى تكفى حاجتهم جميعاً. فالمال في النهاية مال المسلمين، وكل ما على الأرض من خيرات هي هبة الله للناس، يتصرف فيها خليفة المسلمين باتفاقهم وبأمرهم ولصالحهم جميعاً.
هذه المبادئ الثلاثة البسيطة هي جماع كل فلسفتهم، وهي في نفس الوقت تمثل الخطر الذي يهدد به حكم علي هؤلاء الذين أثروا ثراء فاحشاً، واكتنزوا من الذهب والفضة ما حذرهم منه القرآن وما خوفهم من أنه سوف تكوى به جباههم وظهورهم يوم القيامة.
كان النفعيون يعلمون أن هذه مبادئ علي، وأنه سوف يطبقها عاجلاً أو آجلاً، وأنه إلى جانب ذلك، سوف ينفذ سنة رسول الله من حيث تساوي البشر في الحقوق فلا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لأبيض على أسود إلاَّ بالتقوى، وأن أمر المسلمين لا ينفرد به رجل مهما تكن مكانته. بل إن الأمر شورى بينهم، وإن في الحياة قصاصاً. إلى آخر تلك المبادئ الإسلامية السامية التي تكفل جانب العدل الاجتماعي والحرية والكرامة والأمن والطمأنينة.
وإن يكن طلحة والزبير قد ثارا بعلي وخلعا بيعته لطمعهما في الخلافة فإنما بلا شك يكرهان أيضاً ما يتصوران أنه مغالاة في تطبيق تلك المبادئ الإسلامية، إذ يخشيان خشية كامنة أو غامضة لا تسفر عن نفسها حتى لهما من هذه المعاني واحتمال ظهورها إلى واقع الحياة على يدي علي.
حكم علي إذن يهدد المراكز الاقتصادية الممتازة، ويهدد أصحاب الوظائف وطلاَّب المناصب ممن اشتركوا في الثورة على عثمان، لأنهم يعلمون أن علياً سيختار لهذه المناصب من يعتقد أنه يستطيع إدارتها على المبادئ الإسلامية خير إدارة، وبمعنى آخر فلن يكون لوالي علي مغنم في بيت المال أو في أي مجال آخر. اللهم إلاَّ العمل الدائب في خدمة المسلمين وتأمين معاشهم، وهو أمر لا يغري أحداً من الطامعين لأنه يتطلب منه أن يتخلى عن المراكز وعن كل أبَّهة السلطة، ويفرغ المنصب من كل هالاته.
فأصحاب المراكز الاقتصادية الممتازة مهددون بتغيير مراكزهم بحيث لا يمتازون على أحد، وطلاَّب المناصب أحسوا بفراغ المنصب حتى إن ظفروا بمنصب.
حرب الجمل
وحين دعا طلحة والزبير إلى خلع البيعة وجدا من يساندهما في مكة، ومن يخرج معهما إلى السواد، ووجدوا في السواد من ينتظرهما ويؤيدهما … والغريب أنهما لم يظهرا حقيقة مقصدهما من خلع البيعة لعلي، فهما قد خلعاها لطمعهما فيها من ناحية، وإبقاء على الأوضاع الاجتماعية الراهنة من ناحية أخرى، كان هذا موقفهما الحقيقي، وكان أيضاً موقف مؤيديهم وأنصارهم فيما يخص المساس بالأوضاع الاجتماعية، أما ما أعلناه فهو القصاص لعثمان من قاتليه الذين سكت عنهم علي، بل إنهما اتهما علياً بالتآمر على قتل عثمان، متناسين أنهما كانا من بين المحرضين على الثورة على عثمان، وأن علياً نفسه وقف من أحدهما موقفاً متشدداً حين جمع حوله الثائرين وحضَّهم على عثمان.
وهذه هي الحجة التي استعملها طلحة والزبير ومعهما عائشة، وهي نفس الحجة التي استعملها معاوية وأنصاره من بعدهما، ولم يظهر أحد من خصوم ثورة الشعب السبب الحقيقي لتلك الثورة العنيفة التي أشعلوها منذ الأيام الأولى لخلافة علي بن أبي طالب.
وقد ظلَّ السبب الحقيقي كامناً في النفوس لا يجسر أحد على أن يفضحه.
إنه صراع بين فكرتين متضادتين، إحداهما تؤمن بالعدل الاجتماعي، أساساً صلباً من أسس الإسلام، والأخرى تؤمن بأن الإسلام عبادة وتأدية للفرائض بما فيها الزكاة، أما غير ذلك فهو نافلة، وحسبهم معاً أن يقولوا لا إله إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله.
وإن تستر الأغراض الحقيقية وراء حجة ظاهرة أبعد ما تكون عن الحقيقة أمر اتبعه الساسة من قديم الزمان، واتبعه هذا الجيل من العرب ومضوا فيه، يتجادلون على أساسه مع خصومهم، بينما الهدف الأصيل مخفي في طي الكتمان، ولا تلبث المجادلات حول الحجة الوهمية تتراكم حتى تغطي فعلاً على الحقيقة.
وهكذا كان الحال حين وصل طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى البصرة، إذ ما كادوا يستقرون حتى أرسل لهم عثمان بن حنيف عامل علي بالبصرة وفداً يجادلهم فيما يريدون فإذا بهم يجيبون بأنهم يطالبون بدم عثمان وبإعادة طرح أمر الخلافة شورى بين المسلمين، وزعم طلحة والزبير أنهما بايعا عن إكراه، وأن بيعتهما لهذا لا تجوز.
ولقد تصدَّى لهما من الحاضرين من أهل البصرة كثيرون، مذكراً بتلك الكتب التي كانت ترد على البصرة منهما بالتحريض على عثمان فكيف عادا اليوم يطلبان بدمه.
ولكنهما وجدا قوماً في البصرة يصدقونهما ويجادلون خصومهم. على أن هذا الأمر انتهى إلى هدنة. فقد سمح الوالي ببقاء الثائرين بالبصرة لا يعكرون صفو أمنها حتى يأتي علي بن أبي طالب الذي كان قد عرف أنه تحرك من المدينة لملاقاتهم.
إلاَّ أن الثائرين لم يفوا بعهدهم فسرعان ما هاجموا عثمان بن حنيف بليل فقتلوا من قتلوا ممن حوله، ثم نتفوا لحيته وشاربه وهو يؤدي صلاة العشاء بعد أن أوسعوه ضرباً وأطلقوه إلى علي، واستولوا على بيت المال.
ومع ذلك فحين استقبل علي عامله عثمان بن حنيف بحالته هذه لم تثر به حمية الغضب فيحمل بجيشه على خصومه وينكل بهم. بل كظم غضبه وواصل مسيرته إلى البصرة، حتى إذا شارف حدودها توقف، وأرسل الرسل مرة أخرى إلى الثائرين يجادلونهم بالحسنى.
إلاَّ أنَّ ما في النفوس شيء والاقتناع بالحجة، والرأي الصائب شيء آخر. فلم تلبث الأمور أن تعقدت ورفض الثائرون منطق الحجة وصمموا على القتال وحتى هذه اللحظة لم تخرج علياً عن طوره، فأمر أحد رجاله بأن يرفع المصحف بين الفريقين ليجعله حكماً بين المتخاصمين.
والجدير بالذكر أن علياً دعا هذا الفتى الذي سيرفع المصحف وقال له أنه قد يقتل بنبال الثائرين، ولم يتردد الفتى إلاَّ قليلاً ثم رفع المصحف وتقدم الصفوف حتى وقف تجاه جيش الثائرين ورفع المصحف بكلتا يديه … وكان ما توقعه علي … إذ رشق الفتى بالسهام حتى سقط قتيلاً.
وهكذا كانت الحرب التي اشتهرت بوقعة الجمل حيث وضعت عائشة في هودجها وأحاط بها الثائرون يدافعون عنها، تلهبهم حماسة افتعلها القادة افتعالاً مستغلين مكانة أم المؤمنين متوقعين ما سيحدثه وجودها بينهم من أثر. وقد حدث ما توقعوه، إذ قاتل المقاتلون بحمية وحماسة حتى أمر علي بنحر الجمل فسقط الجمل واجتمع أصحاب علي حول هودج عائشة فنقلوه إلى مكان أمين وكان بينهم أخوها محمد بن أبي بكر.
وانتهت المعركة بهزيمة المتمردين وسقط طلحة والزبير قتيلين.
ويقف علي بن أبي طالب بين قتلاه وقتلى المتمردين عليه في حالة من القلق والتمزق تشبه حالة أبطال التراجيديا فبين خصومه رجال من الذين أبلوا بلاءً حسناً في الإسلام، ومن القادة والأبطال الذين آمنوا عن صدق. فيم يقتل هؤلاء؟ وكيف لا يرون الحق وهو واضح، هم مسلمون وهو يريد خير الإسلام وحقيقته، وهو أعلم المسلمين جميعاً بحقيقة الإسلام بشهادة وإجماع المسلمين، فلماذا تقع الفتنة؟ ولماذا تقع تلك المآسي؟.
وها هوذا يتأمل القتلى من الجانبين متصدع القلب، ويهمهم متوجهاً إلى الله في ألم شديد:
| أشكو إليك عجري وبجري | شفيت نفسي وقتلت معشري |
وكان أن أصدر أمره بدفن القتلى من الجانبين، وبألاَّ يجهز أحد من أفراد جيشه على جريح أو يطارد أحداً من الفارين.
وأضاف إلى ذلك أنه ليس في هذه الحرب مغنم للمنتصر، فما كان يملكه المتمردون هو ملك لهم أمر بجمعه في المسجد وأرسل المنادي ينادي بأن من عرف له شيئاً له فليأخذه.
ولسنا نعرف مثالاً لذلك في أي عصر من العصور، فقد احتجَّ جيش علي لأن غنائم معركته حرَّمت عليه، وقال بعضهم: «أحل لنا دمهم وحرم علينا أموالهم» ولكن علياً لم يلق بالاً إلى هذا الاحتجاج فقد كان يضع مبادئ عليه أن يقرّها حتى ولو صادفت احتجاجاً أو اعتراضاً.
ولكن الأخطر من هذا موقفه الحزين المتألم، فقد انتقل هذا الموقف إلى الجميع وإذا بالحزن يعم الجانبين، كل يذكر قتلاه وجرحاه ويذكر تلك الحرب الغريبة التي قتل فيها فريقان من المسلمين، أما حزن علي فكان حزناً متبصراً، حزناً من أجل هؤلاء الذين قتلهم قبل هؤلاء الذين قاتل بهم، ومن أجل الرسالة السامية التي تتعرض للفتنة وهي في قمة نجاحها وانتصارها … من أجل هذا العمى الذي أصاب فريقاً من المسلمين، فلم يروا دينهم حق الرؤية، ولم ينظروا إلى أبعد من المطامع الشخصية، ولعلَّ حزنه قد اتجه إلى نفسه فقد كتب عليه أن يكون المقاتل الأخير، والمسلم الذي يضرب أحسن المثل، من أجل أن تبقى الرسالة وتتجه إلى اتجاهاتها الصحيحة. إن أكبر الأعباء قد ألقي على كاهله أن يقف أمام عواطفه الجياشة بطبعها، أن ينتصر للقضية حتى النهاية وأن يجرع ألم هذا الانتصار حتى النهاية أيضاً.
أما عامة المسلمين فقد انعكس حزن علي في صدورهم إلى أقرب مصادر هذا الحزن، إلى خيبة الأمل في المغنم، إلى فقدان الانتصار لمعنى البهجة والفرح، ثم إلى نتائج المعركة من قتلى ضائعين.
حرب صفين
انتهت هذه المعركة لتبدأ المعركة الأكبر، معركة الشام بقيادة معاوية الرجل الذي يمثل النقيض تماماً، هو أيضاً شخصية فريدة، جمعت فيه كل خصائص الرجل الذي لا تشل حركته أي قيمة من القيم، إنه ابن أبي سفيان الشهير، وابن تلك المرأة التي مضغت كبد حمزة عم النبي حين سقط قتيلاً بيدي عبد لها. لقد تربى معاوية في حجر أبي سفيان رأس القوى الرجعية في مكة، وتربى علي في حجر النبي بكل ما تحمله النبوة من فداء وتضحية وإيجابية للخير المطلق.
ولو كان معاوية مكان علي لما أرسل وفاوض وحض على الصلح وهو يملك القوة التي تستطيع تحقيق الإرادة. ولو كان مكانه عقب واقعة الجمل لملأ قلبه الفرح ولأمر بالتمثيل بجثث خصومه، ولأعدى أنصاره بزهوه وفرحه، فلم تظهر بادرة حزن في صفوفه، ولأباح لهم مال المهزومين وأولادهم ونساءهم([194]). وبدلاً من أن يوزع ما في بيت المال على المسلمين جميعاً، لاختار دهاتهم ورؤوساهم وأغدق عليهم فضمنهم إلى جانبه.
أما وعلي غير معاوية فقد كان اعتماده كله على أن يوقظ الجوانب الإيجابية في صفوف رجاله مهما كانت صعوبة ذلك. كان يريد أن يصنع رجاله على مثاله، لا أن يصنع بهم نصراً فحسب، ولقد استطاع أن يهيئهم ويعدهم لأن يكونوا هؤلاء الرجال وكان يأمل أن يجابهوا الأزمات فينمو ما غرس فيهم وتثبت الخصال التي بثها في صدورهم، ولكن علياً علمهم أنه لا ينبغي لإمام المسلمين أن ينفرد بالرأي ولا أن يكره أحداً عليه. علمهم معنى كرامة الإنسان من حريته في إبداء رأيه، ومن انطلاقه في التفكير والاختيار، فما كان يبرم أمراً قبل أن يستشير وأن يبين حجته، علمهم أن يخالفوا رأيه فيناقشهم ويجادلهم، فإذا كانت الأغلبية لهم عدل عنها، وترك التجربة العملية تكشف الراي المصيب من الرأي المخطئ: كان علي يضع اهتمامه بالإنسان وقلبه في المقام الأول، كان يتجه إلى داخل الإنسان يبنيه ويؤكده، أما عناصر الخصوم فكانت تتجه إلى الخارج. إلى الحوادث واحتمالاتها وإلى مواطن الضعف في الإنسان لتنميها وتستغلها. كان الناس في نظر الفريق الذي يرأسه معاوية أعداء وشهوات، وكان الناس في نظر الفريق الذي يمثله علي شخصيات إنسانية تكمن فيها نوازع السمو والحرية وينبغي تنمية هذه النوازع وإبرازها.
وكان الانتصار الحقيقي الذي ينشده علي هو سمو النفس الإنسانية واتصالها بالمبادئ الإسلامية اتصالاً أصيلاً كأنه غريزة أو فطرة، ولهذا كان انتصاره في موقعة الجمل هزيمة لتلك المبادئ كلها. كان فشلاً في رسالته تلك، أن يخلق الشخصية الإسلامية في قلب كل رجل.
وحين تحرك جيش علي لملاقاة معاوية سبقته النذر والوفود والمجادلات والرسائل. كانت رسائل متسمة بالود والحض على التزام الصواب، وكانت رسائل معاوية سباباً وإقذاعاً: «… عرفنا ذلك في نظرك الشزر وقولك الهجر، وتنفسك الصعداء، وإبطائك عن الخلفاء. في كل ذلك تقاد كما يقاد الجمل المخشوش. ولم تكن لأحد منهم «الخلفاء» أشد حسداً منك لابن عمك عثمان وكان أحقهم ألا تفعل به ذلك لقرابته وفضله … فقطعت رحمه، وقبحت حسنه، وأظهرت العداوة، وأبطنت له الغش وألبت الناس عليه، حتى ضربت آباط الإبل إليه من كل وجه، وقيدت الخيل من كل أفق … وقد بلغني أنك تنتفي من دم عثمان وتتبرأ منه. فإن كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته نقتلهم به …».
وانظر إلى كتاب علي ورقته: «… وذكرت بأن ابن عفان كان في الفضل ثالثاً … «ثالث الخلفاء» … فإن يكن عثمان محسناً فسيلقى رباً شكوراً يضاعف الحسنات ويجزي بها، وإن يكن مسيئاً فسيلقى رباً غفوراً رحيماً لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، أما الحسد فمعاذ الله أن أكون أسررته أو أعلنته. أما الإبطاء فما اعتذر إلى الناس منه … وإن عثمان صنع ما رأيت فركب الناس منه ما قد علمت وأنا من ذلك بمعزل، إلاَّ أن تتجنى فتجن ما بدا لك. وذكرت قتلته بزعمك وسألتني دفعهم إليك. ما أعرف له قاتلاً بعينه. وقد ضربت الأمر إلى أنفه وعينه فلم أره يسعني دفع من قبلي ممن اتهمته وأظننته إليك».
والكتب المتبادلة بين علي ومعاوية تكشف عن أسلوب كل منهما حتى ليبدو أن الجانب الأضعف هو علي، وكأنه يتردد في القتال، أما إذا علمت أن علياً كان يستطيع أن يبطش بطشاً نهائياً بجيش معاوية فستقع في الحيرة … لماذا لم يبطش علي بمعاوية، لماذا يتخطى تلك اللحظة الحاسمة في تاريخ الإسلام فيأخذ بناصية الأمر، ويرد إلى الحق سيرته.
إن انتصاراً كهذا لم يكن يريده علي … كان يريد صدق الباطن ونقاوته، لا انتصار الظاهر وسطحيته ولهذا احتمل أن يراسله عامل من عماله بتلك الجفوة فلا يذكر لقب الخلافة في كتبه، بل يوسعه شتماً.
ولقد احتمل علي من معاوية ما يحنق المؤرخ وهو يرقب هذا الصبر الغريب البعيد الغور أشد الحنق.
على أن علياً لم يتحرك للقتال إلاَّ حين تحرك خصومه. وبدأ معاوية بداية تتفق مع استعداده فاحتل عند «صفين» موقع الماء ليمنع جيش علي منه. فلم يهاجمه علي بل أرسل من يطلب أن يكون الماء شركة بين الفريقين فلا ينبغي أن يحرم منه فريق وأن يستأثر به الفريق الآخر حتى ولو كان الأمر أمر حرب. ومن البديهي أن يرفض معاوية فيهجم جيش علي فيجليه عن الماء ويحتله جميعاً. وبدلاً من أن يحرم علي خصومه بعد أن حرموه، أمر أن يكون الماء شركة بين المتقاتلين.
وتمضي الحرب على هذا الاسماح من جانب علي، والمكر والخديعة من جانب معاوية. حتى إذا انهزم جيش معاوية رفعت المصاحف، ولم يكن علي بالذي يجهل دخائل النفوس، بل كان يقرأ صدور خصومه كما لو كانت كتاباً مفتوحاً، فهو لم يخدع أبداً بل هو لم يهزم أبداً في معركة من المعارك التي خاضها جميعها. في كل حربه منذ أن وقف إلى جوار الرسول محارباً ولم يكد يتجاوز الحلم حتى أصبح كهلاً على أعتاب الشيخوخة. وبالطبع كان يدرك أن رفع المصاحف لا يقصد وجه الحق، ولا ما يقرره كلام الله المكتوب في هذه المصاحف. فهو أول من رفع المصاحف ليس بعد القتال والهزيمة بل قبل أن يبدأ القتال.
ولكن جيش علي انقسم، أو أحدث فيه الانقسام. فرسل معاوية قبل المعركة كانت تذهب إلى سراة القوم وضعاف النفوس ممن لم تدركهم بعد أخلاقيات علي وصحبه فتغريهم بالمال والمناصب وتدبر معهم كيف يحدثون الانقسام.
فإذا بفريق من جيش علي يطلب وقف القتال والاحتكام إلى القرآن، وإذا بحجة علي ونقاشه المنطقي يذهب هباء فقد اشتري هذا اللجاج بالمال فكيف يباع بالحق.
وكان على الخليفة بعد أن بذل كل الجهد ليوحد الصفوف ومواصلة القتال أن يوقف القتال.
ووقع علي بين فريق يريد مواصلة القتال وهو الأقل، وفريق يوافق على الاحتكام وهو الأكثر، وكان عليه أن يختار جانب الغالبية بعد أن عجز عن الإقناع.
ولعل علياً ـ وهذا هو أسلوبه دائماً ـ كان واثقاً من النصر، فهو يعلم أن الحق في جانبه، وأنه لا محالة منتصر قرب العهد أو بعد. وتمت ألعوبة التحكيم وأتت بنتائجها المثيرة للسخرية … ولكن بعد أن خرج عليه الذين أرغموه على وقف القتال دون أن يدركوا معنى التشاور والمشاركة الاختيارية في القتال. وبعد أن ضعفت نفوس بالرشوة وبشظف القتال.
ومع ذلك فقد سار سيرته يحاول ويقنع، فإذا لم يفلح الجدل والإقناع والتخيير بين السلام والقتال دخل المعركة حانقاً ومضطراً فكتب له النصر في كل معركة.
وعندما رفض ألعوبة التحكيم المخزية وقرر القتال كان الوهن قد تسرب إلى الصفوف، كانت الحرية ضيفاً طارئاً على النفوس، وكانت الشخصية الإنسانية أمراً من الصعب أن يوجد قبل أهوال وأهوال فها هو ذا حاكم يقسم أموال الدولة على المسلمين جميعاً، فيجد كل فرد رزقه مكفولاً … فما الحاجة إلى القتال. وما معنى المبدأ، وما معنى النضال.
وكان علي يقول إن معنى هذا كله أن تقلب الأمور وأن تستذل النفوس، وأن تتدنى أرواح الناس فتزهق دون رحمة أو لحظة من تردد، وأن يستأثر الأقوياء بالأموال والخيرات وأن يحرم الضعفاء من كل شيء فلا يجدون القوت الضروري.
ولكنهم لم يدركوا شيئاً من هذا، تقاعسوا وانكبوا على حياتهم الرخية التي أنشأها لهم علي …. ويسرتها مبادئ الإسلام، دون أن يواجهوا ذلك العداء المتربص بكل هذه الخيرات.
بعد صفين
ويقف علي موقفاً قلَّما نرى مثاله في التاريخ … يدعو هؤلاء إلى الاستعداد لقتال أهل الشام فلا يجد مجيباً. وكأنه يطلب القتال لنفسه لا لحياتهم ولا لحياة الأجيال من بعدهم، وقد كان علي يستطيع أن يجيِّش الجيوش ويذهب بهم خلف أي مغريات. أن يبيح لهم الغنائم، أن يمني طامحيهم بالمناصب، أن يفعل شيئاً من هذا الذي فعله معاوية مريداً به الباطل، فلا ضير أن يفعله هو مريداً به الحق. إلاَّ أن هذا لم يكن من خطة علي بل لعلَّ انتصاره يكون عندئذٍ انتصاراً ناقصاً نقصاً خير منه الهزيمة.
وها هو ذا وقد بلغ به اليأس مداه يقول في جمعهم: «أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة قلوبهم وأهواؤهم. ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم. كلامكم يوهي الصم الصلاب وفعلكم يطمع فيكم عدوكم إذا دعوتكم إلى الجهاد قلتم كيت كيت، وذيت ذيت، أعاليل بأباطيل. وسألتموني التأخير، فعل ذي الدين المطول، حيدي حياد، لا يدفع الضيم الذليل، ولا يدرك الحق إلاَّ بالجهد والعزم واستشعار الصبر. أي دار بعد داركم تمنعون؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه … ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب. أصبحت لا أطمع في نصركم ولا أصدق قولكم. فرق الله بيني وبينكم، أبدلني بكم من هو خير لي منكم. أما أنكم ستلقون بعدي ذلاً شاملاً، وسيفاً قاطعاً، وأثرة يتخذها الظالم فيكم سنة، فيفرق جماعتكم، ويبكي عيونكم، ويدخل الفقر بيوتكم، وتتمنون عن قليل أنكم رأيتموني فنصرتموني … فستعلمون حق ما أقول. ولا يبعد الله إلاَّ من ظلم».
ولنا أن نسأل أين كانت القيادات الشعبية؟ لقد قتل نهم من قتل في المعارك التي خاضوها، لأنهم أول المتقدمين. وكم استنفذ علي خيرة رجاله في مقاتلة الخوارج والانقلابات التي يدبرها خصوم الشعب، والغارات التي كان يشنها معاوية بين الحين والحين.
وعلي نفسه كان يصنع قياداته الجديدة من قلب المعركة، وما تتكون القيادات الجديدة بين يوم وليلة. أما الصحابة الأولون والمناضلون الأشدَّاء فقد بلغ أغلبهم سن الشيخوخة ومع ذلك فلم يخلدوا إلى الراحة، قد رأينا في صفين الصحابي الكبير والإنسان الجليل العظيم عمار بن ياسر يخوض المعركة وهو قد جاوز الثمانين في أغلب الروايات خوض شاب في الثلاثين حتى استشهد فيها وهو إلى جانب زعيمه وزميله، لتصدق نبوءة النبي حين نظر إليه ذات يوم وهو في جمع من صحبه وقال: «تقتلك الفئة الباغية».
إن القيادات القديمة لم تفترق عن علي، وقد بذلت جهدها كله في التوعية والإقناع، ولكن عددها كان قد قل، بينما المعركة أحوج ما تكون إلى هذه القيادات التي وقفت إلى جوار النبي وتعلمت منه عشرين عاماً أو يزيد.
وعلى الرغم من هذا كله فلم ييأس علي، ولم يغير خطته فيشتري قلوب رجاله بثمن بخس، كان يريد شعباً قوياً بذاته، رجالاً حقيقيين. وكانت خطته هي الصواب، فلم يلبث أن دخل الاقتناع قلوب الرجال ولم تلبث التوعية أن أتت ثمارها، وبدأ علي فعلاً يستعد للقتال بجيش ضخم لم يدخل فيه أحد عن رهبة أو رغبة.
وهنا تقع الجريمة الكبرى فيقتل علي بيد مجرم من الخوارج، فمن هم الخوارج؟.
هذا ما سيأتي تفصيله.
أحمد عباس صالح
أشأم ليلة
ـ 1 ـ
الليلة التي اغتيل فيها علي بن أبي طالب هي أشأم ليلة بعد يوم توفي فيه رسول الله (ص)، فاليوم الذي توفي فيه رسول الله (ص) كان اليوم الذي خلف فيه النبي (ص) تجربته الإسلامية في مهب القدر، في رحبة المؤامرات التي أتت عليها بعد برهة من الزمن واليوم الذي اغتيل فيه الإمام أمير المؤمنين (ع) كان اليوم الذي قضى على آخر أمله في إعادة خط تلك التجربة الصحيحة، هذا الأمل الذي كان لا يزال يعيش في نفوس المسلمين الواعين متجسداً في شخص هذا الرجل العظيم، الذي عاش منذ اللحظة الأولى هموم الدعوة وآلامها واكتوى بنارها وشارك في بنائها لبنة لبنة … وأقام صرحها مع أستاذه (ص) مدماكاً فوق مدماك.
هذا الرجل الذي كان يعبر عن كل هذه المراحل بكل همومها ومشاكلها وآلامها ….
هذا الرجل هو الذي كان يمثل هذا الأمل الوحيد الذي بقي للمسلمين الواعين في أن تسترجع التجربة خطها الواضح الصريح وأسلوبها النبوي المستقيم …. حيث إن الانحراف في أعماق هذه التجربة كان قد طغى وتجبَّر واتَّسع بحيث لم يكن هناك أي أمل في أن يقهر هذا الانحراف …. اللهم إلاَّ على يد رجل واحد كعلي بن أبي طالب (ع) ولهذا كانت حادثة اغتيال هذا الإمام العظيم …. حينما خرَّ صريعاً تقويضاً حقيقياً لآخر أملٍ حقيقي في قيام مجتمع إسلامي صحيح على وجه الأرض إلى يوم غير معلوم، وأجل غير محدود.
كان هذا الاغتيال المشؤوم عقيب حكم مارسه الإمام (ع) طيلة أربع أو خمس سنوات تقريباً حيث بدأ منذ اللحظة الأولى لتسلم زمام الحكم عقلية التغيير الحقيقية في كيان هذه التجربة المنحرفة وواصل سعيه في سبيل إنجاح عملية التغيير واستشهد، وخرَّ صريعاً بالمسجد وهو في قمة هذه المحاولة أو في آخر محاولة إنجاح عملية التغيير وتصفية الانحراف الذي كان قد ترسَّخ في جسم المجتمع الإسلامي متمثلاً في معسكر منفصل عن الدولة الإسلامية الأم.
والظاهرة الواضحة في هذه الأربع أو الخمس سنوات التي مارس فيها الإمام (ع) عملية الحكم وإلى أن خرَّ صريعاً في سبيل إقامة العدل على الأرض، كان غير مستعد بأي شكل من الأشكال وفي أي صيغة من الصيغ لتقبل أنصاف الحلول بالنسبة إلى تصفية هذا الانحراف أو لتقبل أي معنى من معاني المساومة أو المعاملة على حساب هذه ا|لأمة التي كان يرى بكل حرقة وألم أنها تهدر كرامتها وتباع بأرخص ثمن.
هذه الظاهرة تسترعي الانتباه سياسياً من ناحية وتسترعي الانتباه فقهياً من ناحية أخرى.
ـ أما من الناحية السياسية فقد استرعت انتباه أشخاص معاصريه للإمام (ع) واسترعت انتباه أشخاص حاولوا أن يحللوا ويدرسوا حياة الإمام (ع).
فقد لوحظ على الإمام أن عدم تقبله بأي شكل من الأشكال لهذه المساومات وأنصاف الحلول كان يُعَقّد عليه الموقف ويثير أمامه الصعاب ويرسخ المشاكل ويجعله عاجزاً عن مواجهته لمهمته السياسية والمضي بخط تجربته إلى حيث يريد.
فمثلاً: ذاك الشخص الذي جاء إليه بعقلية هذه المساومات واقترح عليه أن يبقي معاوية بن أبي سفيان والياً على الشام برهة من الزمن قائلاً: إن بإمكانك إبقاء معاوية والياً على الشام برهة من الزمن وهو في هذه الحالة سوف يخضع ويبايع وبعد هذا يكون بإمكانك استبداله أو تغييره بأي شخص آخر بعد أن تكون قد استقطبت كل أطراف الدولة وقد تمت لك البيعة والطاعة في كل أرجاء العالم الإسلامي، فاشتر بإبقاء هذا الوالي أو ذلك الوالي، هذا الحاكم أو ذلك الحاكم، بإبقاء هذه الثروات المحرمة في جيب هذا السارق أو في جيب ذلك السارق برهة من الزمن ثم بعد هذا يمكنك أن تصفي كل هؤلاء الولاة الفجرة وترجع كل هذه الثروات المحرمة إلى بيت المال.
فالإمام (ع) في جواب هذا الشخص، رفض هذا المنطق واستمر في خطه السياسي يرفض كل مساومة ومعاملة من هذا القبيل، ومن هنا قال معاصروه، وقال غير معاصرين أنه كان بإمكانه أن يسجل نجاحاً كبيراً، وأن يحقق توفيقاً من الناحية السياسية أكثر، لو أنه قبل أنصاف الحلول، ولو أنه مارس هذا النوع من المساومات ولو بشكل مؤقت.
ـ أما من الناحية الفقهية فهي ناحية التزاحم، الفقه يقول: بأنه إذا توقف واجب أهم على مقدمة محرمة فلا بد من الحفاظ على ذلك الواجب الأهم وفي سبيل حرمة المقدمة لا يجوز تبرير ترك الواجب الأهم حينما يقال ذلك إذا توقف إنقاذ نفس محترمة من الغرق على اجتياز أرض مغصوبة لا يرضى صاحبها باجتيازها فلا بدَّ من اجتيازها حيث تسقط هنا حرية هذا المالك وعدم رضاه، لأن النتيجة أهم من هذه المقدمة، كما فعل رسول الله (ص) في بعض غزواته مثالاً مشابهاً لهذا المثال، حيث كان الجيش الإسلامي مضطراً إلى الخروج من المدينة عن طريق معين، وهذا الطريق كان فيه مزرعة لأحد الصحابة، وكان لا بدَّ للجيش حينما يمر على هذه المزرعة وبحكم طبيعة مروره كجيش من أن يتلف كثيراً من محاصيل هذه المزرعة ويصيبها بأضرار فصاحب المزرعة ما هان عليه أن يقدم هذه الأضرار في سبيل الله وفي سبيل الرسالة … احتج على ذلك وصرخ ثم جاء إلى رسول الله (ص) فقال: مزرعتي ومالي، فلم يجبه رسول الله (ص) وأصدر أوامره إلى الجيش، فمشى في هذه المزرعة حتى لم يبق في هذه المزرعة شيء مما كان يخاف تلفه صاحب المزرعة إلاَّ وتلف.
كان ذلك لأن النتيجة كانت أهم من المقدمة كان هذا الجيش يسير لأجل أن يغير وجه الدنيا ولأجل تغيير وجه الدنيا إذا تلفت مزرعة، إذا ضاعت هناك ثروة صغيرة لشخص، في سبيل أن يحفظ مقياس توزيع الثروات في العالم على الخط الطويل الطويل، فهذا أمر صحيح ومعقول من الناحية الفقهية فمن الناحية الفقهية دائماً يقرر أن الواجب إذا توقف على مقدمة محرمة وكان ملاك الواجب أقوى من ملاك الحرمة، فلا بدَّ أن يقدم الواجب على الحرام.
وعلى هذا الضوء حينئذٍ تثار هذه القضية في هذه الظاهرة التي استوضحناها في حياة أمير المؤمنين (ع) كحاكم.
وهي أنه لماذا لم يطبق هذه القاعدة في سبيل استباحة كثير من المقدمات المحرمة، أليس إجماع الرأي عليه، أليس تملكه زمام قيادة مجتمع إسلامي، أليس هذا أمراً واجباً محققاً لمكسب إسلامي كبير، لأنه هو الذي سوف يفتح أبواب الخيرات والبركات ويقيم حكومة الله على الأرض؟…
إذن فلماذا في سبيل تحقيق هذا الهدف إذا توقف هذا الهدف على مقدمة محرمة من قبيل إمضاء ولاية معاوية بن أبي سفيان برهة من الزمان، أو إمضاء الأموال المحرمة التي نهبها آل أمية، أو غيرهم من الأسر التي وزَّع عليها عثمان بن عفان أموال المسلمين؟…..
لماذا لا يكون السكوت مؤقتاً عن غير هذا النهب والسلب مقدمة للواجب الأهم.
ولماذا لا يكون جائزاً حينئذٍ على أساس توقف الواجب الأهم على ذلك؟….
الواقع هو أن الإمام (ع) كان لا بدَّ له أن ينهج هذا الطريق ولم يكن بإمكانه كقائد رسالي يمثل الإسلام وأهدافه، لم يكن بإمكانه أن يقبل هذه المساومات وأنصاف الحلول ولو كمقدمة وليس قانون باب التزاحم الفقهي هنا صالحاً للانطباق على موقف أمير المؤمنين (ع) وذلك بعد أن أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:
النقطة الأولى: أنه لا بدَّ وأن يلحظ في المقام أن أمير المؤمنين (ع) كان يريد أن يرسخ قاعدة سلطانه في قطر جديد من أقطار العالم الإسلامي وهذا القطر هو العراق.
وكان شعب العراق وأبناء العراق مرتبطين روحياً وعاطفياً مع الإمام (ع) ولكن لم يكن شعب العراق ولا أبناء العراق يعونَ رسالة علي (ع) وعياً حقيقياً كاملاً، ولهذا كان الإمام بحاجة إلى أن يبني تلك الطليعة العقائدية، ذلك الجيش العقائدي الذي يكون أميناً على الرسالة وأميناً على الأهداف وساعداً له ومنطلقاً بالنسبة إلى ترسيخ هذه الأهداف في كل أرجاء العالم الإسلامي.
والإمام (ع) لم يكن يملك هذه القاعدة بل كان بحاجة إلى أن يبنيها. إذن كيف يبني هذه القاعدة؟
هل يمكن أن يبني هذه القاعدة في جو من المساومات وأنصاف الحلول؟ حتى لو كانت هذه المساومات وأنصاف الحلول جائزة شرعاً إلاَّ أن جوازها الشرعي لا يؤثر في هذه الحقيقة النفسية الواقعية شيئاً وهي أن شخصاً لا يمكن أن يعيش في جو من المساومات وأنصاف الحلول فيكتسب روحية أبي ذر أو يكتسب روحية عمار بن ياسر، روحية الجيش العقائدي الواعي البصير بأن المعركة ليست للذات وإنما هي للأهداف الكبيرة التي هي أكبر من الذات.
هذه الروحية لا يمكن أن تنمو ولا يمكن لعلي (ع) أن يخلقها في من حوله في حاشيته وفي أوساطه وقواعده الشعبية، في جو من المشاحنات والمساومات وأنصاف الحلول حتى لو كانت جائزة … إن جوازها لا يغير من مدلولها التربوي شيئاً ولا من دورها في تكوين نفسية هذا الشخص بأي شكل من الأشكال…
إذن فالأمام (ع) كان أمامه حاجة ملحّة حقيقية في بناء دولته إلى قاعدة شعبية واعية يعتمد عليها في ترسيخ الأهداف في النطاق الأوسع وهذه القاعدة الشعبية لم تكن جاهزة له حينما تسلم زمام الحكم حتى يستطيع أن يتفق معها.
على أن هذه المساومات وأنصاف الحلول إنها ضرورات استثنائية لا توجب الانحراف عن ذلك الخط … إنما كان على عليّ (ع) أن يبني ذلك الجيش العقائدي، كان على علي (ع) أن ينتزع الخيّر الخيّر الطيّب الطيّب من جماعته وحاشيته العراقيين لكي يشكل منهم كتلة واعية من قبيل مالك الأشتر وغيره وهؤلاء لم يكن بالإمكان ممارسة بناء نفسي وروحي وفكري وعاطفي حقيقي لهم في جو مليء بالمساومات وأنصاف الحلول …. كانت المساومات وأنصاف الحلول نكسة بالنسبة إلى عملية التربية لهذا الجيش العقائدي وكان فقدان هذا الجيش العقائدي يعني فقدان القوة الحقيقية التي يعتمد عليها الإمام (ع) في بناء دولته لأن أي دولة عقائدية بحاجة إلى طليعة عقائدية تستشعر بشكل معمق وموسع أهداف تلك الدولة وواقع أهميتها وضرورتها التاريخية ولهذا كان لا بدَّ من الحفاظ على صفاء وطهر عملية التربية لبناء هذا الجيش العقائدي كان لا بدَّ لآلاف من أمثال مالك الأشتر أن يشهدوا إنساناً لا تزعزعه المغريات ولا يتنازل إلى أي نوع من أنواع المساومات حتى يستطيعوا من خلال حياة هذا الرجل العظيم أن يتبينوا المدلول الرسالي الكامل لأطروحة الأبعاد الواسعة للصيغة الإسلامية للحياة. إذن فكان على عليّ (ع) لأجل ممارسة عملية التربية لبناء هذا الجيش العقائدي كان لا بدَّ له أن يترفع عن هذه المساومات والحلول الوسط، لكي يستطيع أن يخلق ذلك الجو الرفيع نفسياً وفكرياً وروحياً والذي سوف ينشأ في داخله وفي أعماقه … جيل يستطيع أن يحتضن أهداف أمير المؤمنين (ع) ويضحي من أجلها في حياته وبعد وفاته …
النقطة الثانية: لا بدَّ من الالتفات أيضاً إلى أن أمير المؤمنين (ع) جاء في أعقاب ثورة، ولم يجئ في حالة اعتيادية، ومعنى ذلك أن البقية الباقية من العواطف الإسلامية، كل هذه العواطف تجمعت، ثم ضغطت، ثم انفجرت في لحظة ارتفاع … وماذا ينتظر القائد الرسالي غير لحظة ارتفاع في حياة أمة، لكي يستطيع أن يستثمر هذه اللحظة في سبيل إعادة هذه الأمة إلى سيرها الطبيعي.
كان لا بدَّ للإمام (ع) أن يستثمر لحظة الارتفاع الثورية هذه، لأن المزاج النفسي والروحي وقتئذٍ لشعوب العالم الإسلامي، لم يكن ذاك المزاج الاعتيادي الهادئ الساكن لكي يمشي حسب مخطط تدريجي، وإنما كان هو المزاج الثوري الذي استطاع أن يرتفع إلى مستوى قتل الحاكم والإطاحة به، لأنه انحرف عن كتاب الله وسنة نبيه (ص)، إذن هذا الارتفاع الذي وجد في لحظة في حياة الأمة الإسلامية لم يكن من الهين إعادته، وبعد ذلك كان لا بدَّ للحاكم الذي يستلم زمام المسؤولية في مثل هذه اللحظة أن يعمق هذه اللحظة، أن يمدد هذه اللحظة، أن يرسخ المضمون العاطفي والنفسي في هذه اللحظة عن طريق هذه الإجراءات الثورية التي قام بها أمير المؤمنين.
لو أن الإمام علي (ع) أبقى الباطل مؤقتاً وأمضى التصرفات الكيفية التي قام بها الحكام من قبل، لو أنه سكت عن معاوية وسكت عن أحزاب أخرى مشابهة لمعاوية بن أبي سفيان إذن لهدأت العاصفة ولانكمش هذا التيار العاطفي النفسي، وبعد انكماش هذا التيار العاطفي وهدوء تلك العاصفة لن يكون بمقدور الإمام (ع) أن يقوم بمثل هذه الإجراءات.
النقطة الثالثة: ولا بدَّ أيضاً من الالتفات إلى نقطة هي: أن الإمام (ع)، كان حريصاً على أن تدرك الأمة كأمة أن واقع المعركة بينه (ع) وبين خصومه، بينه وبين معاوية ليست معركة بين شخصين، بين قائدين، بين قبيلتين، وإنما هي معركة بين الإسلام والجاهلية المتلبسة اليوم بلباس الإسلام.
كان حريصاً على أن يفهم الناس أن واقع المعركة هو واقع المعركة بين رسول الله (ص) والجاهلية التي حاربته في بدر وأحد وغيرهما من الغزوات وكان هذا الحرص سوف يمنى بنكسة كبيرة لو أنه (ع) أقرَّ معاوية، وأقرَّ مخلفات عثمان السياسية والمالية، لو أنه أقرَّ هذه المخلفات ولو إلى برهة من الزمن إذن لترسخ في أذهان الناس، وفي أذهان المسلمين بشكل عام شك في أن القضية ليست قضية رسالية وإنما هي قضية أهداف حكم، إذا انسجمت مع واقع هذه المخلفات فتلغي هذه المخلفات ذلك الشك الذي نما عند الأمة في أمير المؤمنين (ع) بالرغم من أنه لم يكن يوجد له أي مبرر موضوعي وإنما المبرر كانت له مبرراته الذاتية بالرغم من أنه لم يكن يوجد أي مبرر موضوعي للشك، وبالرغم من أن المبرر الوحيد للشك كان مبرراً ذاتياً وبالرغم من هذا استفحل هذا الشك وقرر، وامتحن هذا الإمام العظيم (ع) بهذا الشك ومات واستشهد والأمة شاكة … ثم استسلمت الأمة بعد هذا وتحولت إلى كتلة هامدة بين يدي الإمام الحسن (ع) هذا كله بالرغم من أن الشك لم يكن له مبرر موضوعي فكيف إذا افترضنا أن الشك وجدت له مبررات موضوعية بحسب الصورة الشكلية.
كيف لو أن المسلمين رأوا أن علياً بن أبي طالب (ع) الذي هو رمز الأهداف الرسالية هذا الشخص يساوم ويعمل ويبيع الأمة ولو مؤقتاً مع خيار الفسخ.
كيف يمكن للأمة أن تدرك الفرق بين بيع بلا خيار الفسخ وبين بيع يكون فيه خيار الفسخ إن البيع على أي حال طبيعته هو البيع وأمير المؤمنين (ع) كانت مهمته الكبرى هي أن يحافظ على وجود الأمة على أن لا تتنازل الأمة عن وجودها، الأمة التي قالت لعمر بن الخطاب، لأكبر خليفة تولى الحكم بعد رسول الله (ص)، إذا انحرفت عما نعرف من أحكام الله وسنة رسوله (ص) نقوِّمنك بسيوفنا، هذه الأمة التي قالت هذه الكلمة بكل شجاعة لأكبر خليفة بعد رسول الله (ص) كانت قد بدأت تتنازل عن وجودها أو بتعبير آخر كانت هناك مؤامرات عليها لكي تتنازل عن وجودها، وكان على علي بن أبي طالب (ع) أن يحافظ على هذه الأمة، ويحصنها ضد أن تتنازل عن وجودها، عملية التنازل عن الوجود كان يمثلها معاوية بن أبي سفيان، وجذور معاوية في تاريخ الإسلام، هذا الذي عبَّر عنه وقتئذٍ، بأن الإسلام أصبح هرقلية وكسروية، الهرقلية والكسروية كان يكنى بها عن تنازل الأمة عن وجودها، يعني تحولت التجربة الإسلامية من أمة تحمل رسالة إلى ملك وسلطان يحمل هذه الرسالة بمستوى وعيه لهذه الرسالة وإخلاصه لهذه الرسالة سلباً وإيجاباً، هذه المؤامرة الكبيرة التي نجحت بعد هذا والتي توجت بكل المآسي والمحن والكوارث التي كانت ولا تزال إلى يومنا هذا هي نتيجة تنازل الأمة عن وجودها، نتيجة خداع الأمة، وتحجيمها أو الضغط عليها حتى تنازلت عن وجودها في عقد لا يقبل الفسخ …
أمير المؤمنين (ع) كان يريد وقد أدرك الأمة في اللحظات الأخيرة من وجودها المستقل، أن يمدد هذا الوجود المستقل، أن يشعر الأمة بأنها ليست سلعة تباع وتشترى، أنها ليست شيئاً يساوم عليها، إذن كيف يشعرها بأنها ليست سلعة تباع وتشترى، إذا كان هو يبيعها ويشتريها، ولو في عقود قابلة للفسخ؟
كيف يستطيع أن يُشعر الأمة بأنها لا تباع ولا تشترى، ليست وفق رغبات السلاطين وليست وفق رغبات الحكام.
كيف يمكن أن يُفهم الأمة ذلك إذا كان هو يبيع قطاعات من هذه الأمة لحكام فجرة من قبيل معاوية بن أبي سفيان، في سبيل أن يسترجع هذه القطاعات بعد ذلك.
بطبيعة الحال كان هذا معناه مواكبة المؤامرة التي كان روح العصر يتفجر أو يتمخض عن مثلها والتي كان أمير المؤمنين (ع) واقفاً لأجل أن يحبطها وينقذ الأمة منها، وحينئذٍ لا يمكن بحال من الأحوال أن نفترض أن الإمام (ع) يساهم في حَبْكِ هذه المؤامرة.
النقطة الرابعة والأخيرة: هي أن علي بن أبي طالب (ع) لم يكن يتعامل مع الفترة الزمنية القصيرة التي عاشها فقط، وإنما كان يحمل هدفاً أكبر من ذلك، أمير المؤمنين (ع) كان يحس بأنه قد أدرك المريض وهو في آخر مرضه، قد أدركه حيث لا ينفع العلاج ولكنه كان يفكر في أبعاد أطول وأوسع للمعركة.
لم يكن يفكر فقط في الفترة الزمنية التي عاشها وإنما كان يفكر على مستوى آخر أوسع وأعمق، هذا المستوى يعني أن الإسلام كان بحاجة إلى أن تقدم له في خضم الانحراف بين يدي الأمة أطروحة واضحة صريحة نقية لا شائبة فيها ولا غموض، لا التواء فيها ولا تعقيد، لا مساومة فيها ولا نفاق ولا تدجيل.
لماذا؟…. لأن الأمة كتب عليها أن تعيش الحكم الإسلامي المنحرف، هذا الإسلام إسلام مشوّه ممسوخ إسلام لا يحفظ الصلة العاطفية فضلاً عن الفكرية بين الأمة ككل وبين الرسالة، لا يمكن أن تحفظ هذه الصلة العاطفية والروحية بين الأمة الإسلامية وبين الإسلام على أساس هذا الإسلام المعطى لهارون الرشيد، ولمعاوية بن أبي سفيان، ولعبد الملك بن مروان، هذا الإسلام لا يمكن أن يحفظ هذه الصلة فكان لا بدَّ لحفظ هذه الصلة بين جماهير الأمة الإسلامية وبين هذه الرسالة، من إعطاء صورة واضحة محدودة للإسلام وهذه الصورة أُعطيت نظرياً على مستوى ثقافة أهل البيت (ع) وأعطيت عملياً على مستوى تجربة الإمام (ع) فكان الإمام (ع) في تأكيده على العناوين الأولية في التشريع الإسلامي، وفي تأكيده على الخطوط الرئيسية في الصيغة الإسلامية للحياة كان في هذا يريد أن يقوم المنهاج الإسلامي واضحاً غير ملوّث بلوثة الانحراف التي كتبت على تاريخ الإسلام مدة طويلة من الزمن، وكان لا بدَّ لكي يتحقق هذا الهدف من أن يعطي هذه التجربة بهذا النوع من الصفاء والنقاء والوضوح دون أن يعمل ما أسميناه بقوانين باب التزاحم.
وهكذا كان وظلَّ الإمام (ع) صامداً مواجهاً لكل المؤامرات التي كانت الأمة تساهم في صنعها وفي حياكتها على أساس جهلها وعدم وعيها وعدم شعورها بالدور الحقيقي الذي يمارسه (ع) في سبيل حماية وجودها من الضياع وحماية كرامتها من أن تتحول إلى سلعة تباع وتشتري حتى خرَّ صريعاً على يد شخص من هذه الأمة التي ضحَّى في سبيلها …. خرَّ صريعاً في المسجد فقال:
فزتُ وربِّ الكعبة ….
لنحاسب علياً وهو في آخر لحظة من لحظات حياته (ع) حين قال: فزت ورب الكعبة.
هل كان علي أسعد إنسان أو أتعس إنسان؟…
هناك مقياسان:
فتارة نقيس علياً (ع) بمقياس الدنيا، وأخرى نقيس علياً بمقاييس الحق.
لو كان قد عمل كل عمله للدنيا، لنفسه، فهو أتعس إنسان … ومن أتعس من علي (ع) الذي بنى كل ما بنى وأقام كل ما أقام من صرح ثم حرم من كل هذا البناء ومن كل هذه الصروح؟.
هذا الإسلام الشامخ العظيم الذي يأكل الدنيا شرقاً وغرباً هذا الإسلام بني بدم علي (ع) بني بخفقات قلب علي (ع) بني بآلام علي (ع)، بُني بنار علي (ع)، كان علي هو شريك البناء بكل محن هذا البناء بكل آلام هذا البناء وفي كل مآسي هذا البناء أي لحظة محرجة وجدت بتاريخ هذا البناء لم يكن علي (ع) هو الإنسان الوحيد الذي يتجه إليه نظر البنَّاء الأول (ص) ونظر المسلمين جميعاً لأجل إنقاذ عملية البناء، إذن فعلي (ع) كان هو المضحي دائماً في سبيل هذا البناء، هو الشخص الذي أعطى ولم يبخل الذي ضحى ولم يتردد الذي كان يضع دمه على كفه في كل غزوة في كل معركة، في كل تصعيد جديد لهذا العمل الإسلامي الراسخ العظيم …
إذن شيّدت كل هذه المنابر بيد علي (ع) واتسعت أرجاء هذه المملكة بسيف علي (ع).
جهاد علي كان هو القاعدة لقيام هذه الدولة الواسعة الأطراف لكن ماذا حصَّل علي (ع) من كل هذا البناء في مقاييس الدنيا، إذا اعتمدنا مقاييس الدنيا؟.
لو كان علي (ع) يعمل لنفسه فماذا حصَّل علي (ع) من كل هذه التضحيات من كل هذه البطولات؟ ماذا حصل غير الحرمان الطويل الطويل، غير الإقصاء عن حقه الطبيعي بقطع النظر عن نص أو تعيين من الله سبحانه وتعالى؟ كان حقه الطبيعي أن يحكم بعد أن يموت النبي (ص) لأنه الشخص الثاني عطاء للدعوة وتضحية في سبيلها.
أُقصي من حقه الطبيعي، قاسى ألوان الحرمان، أنكرت عليه كل امتيازاته، معاوية بن أبي سفيان هو الذي يقول لمحمد بن أبي بكر، كان علي كالنجم في السماء في أيام رسول الله (ص) ولكن أباك والفاروق ابتزَّا حقه وأخذا أمره، وبعد هذا نحن شعرنا أن بإمكاننا أن ندخل في ميدان المساومة مع هذا الرجل ويقول عن نفسه، يحدث عن مقامه في أيام النبي (ص)، وكيف أخذ المقام هذا يتنازل بالتدريج نتيجة لمؤامرات الحاكمين عليه، حتى قيل علي ومعاوية.
إذن فعلي (ع) حينما واجهه عبد الرحمن بن ملجم بتلك الضربة القاتلة على رأسه الشريف، كان ماضيه كله ماضي حرمان وألم وخسارة لم يكن قد حصل على شيء منه، لكن الأشخاص الذين حصلوا على شيء عظيم من هذا البناء هم أولئك الذين لم يساهموا في هذا البناء هم أولئك الذين كانوا على استعداد دائم للتنازل عن مستوى هذا البناء في أية لحظة من اللحظات أولئك حصلوا على مكاسب عريضة من هذا البناء، أما هذا الإمام الممتحن الذي لم يفر لحظة، الذي لم يتلكأ في أي آن، الذي لم يتلعثم في قول أو عمل، هذا الإمام العظيم لم يحصل على أي مكسب من هذا البناء بأي شكل من الأشكال، انظروا إن هذه الحادثة يمكن أن تفجر قلب الإنسان، وما الإنسان غير العامل، حينما ينظر في حال عامل على هذا الترتيب ينفجر قلبه ألماً لحال هذا العامل المسكين، لحال هذا العامل التعيس، الذي بنى فغير الدنيا ثم لم يستفد من هذا التغيير ثم تعالوا انظروا إلى المستقبل الذي ينظره الإمام علي (ع) بعين الغيب هذا ماضيه، فماذا عن مستقبله؟.
كان يرى بعين الغيب أن عدوه اللدود سوف يطأ منبره، سوف يطأ مسجده، سوف ينتهك كل الحرمات والكرامات التي ضحى وجاهد في سبيلها سوف يستقل بهذه المنابر التي شيدت بجهاده وجهوده ودمه، سوف يستغلها في لعنه وسبه عشرات السنين.
إذن فهو كان ينظر بعين الغيب إلى المستقبل بهذه النظرة، لم يكن يرى في المستقبل نوعاً من التكذيب يتدارك به هذا الحرمان، الأجيال التي سوف تأتي بعد أن يفارق الدنيا، كانت ضحية مؤامرة أموية جعلتها لا تدرك أبداً دور الإمام علي (ع) في بناء الإسلام.
هذا هو حرمان الماضي وهذا هو حرمان المستقبل.
وبالرغم من كل هذا قال (ع) : فزت ورب الكعبة، حينما أدرك أنها اللحظة الأخيرة وأنه انتهى خط جهاده وهو في قمة جهاده وانتهى خط محنته وهو في قمة صلاته وعبادته، قال: فزت ورب الكعبة، لأنه لم يكن إنسان الدنيا، ولو كان إنسان الدنيا لكان أتعس إنسان على الإطلاق لو كان إنسان الدنيا لكان قلبه يتفجر ألماً وكان قلبه ينفجر حسرة ولكنه لم يكن إنسان الدنيا، لو كان إنسان الدنيا فسوف يندم ندماً لا ينفعه معه شيء، لأنه بنى شيئاً انقلب عليه ليحطمه. أي شيء يمكن أن ينفع هذا الشخص؟ إذا فرضنا أن شخصاً أراد أن يربي شخصاً آخر لكي يخدمه فلما ربى ذاك الشخص ونمي واكتمل رشده جاء ليقتله ماذا ينفع هذا الشخص ندمه غير أن يموت.
هذا الرجل العظيم قال: فزت ورب الكعبة، كان أسعد إنسان ولم يكن أشقى إنسان لأنه كان يعيش لهدفه، ولم يكن يعيش للدنيا، كان يعيش لهدفه ولم يكن يعيش لمكاسبه ولم يتردد لحظة وهو في قمة هذه المآسي والمحن، في صحة ماضيه، وفي صحة حاضره، وفي أنه أدَّى دوره الذي كان يجب عليه.
هذه هي العبرة التي يجب أن نأخذها.
نحن يجب أن نستشعر دائماً أن السعادة في عمل العامل لا تنبع من المكاسب التي تعود إليه نتيجة لهذا العمل.
يجب أن لا نقيِّم سعادة العامل على أساس كهذا، لأننا لو قيِّمناه على هذا الأساس فقد يكون حظنا كحظ الإمام الذي بنى إسلاماً ووجّه أمة، ثم بعد هذا انقلبت عليه هذه الأمة لتلعنه على المنابر ألف شهر.
نحن يجب أن لا نجعل مقياس سعادة العامل في عمله هو المكاسب والفوائد التي تنجم عن هذا العمل وإنما رضى الله سبحانه وتعالى، وإنما حقانية العمل، كون العمل حقاً وكفى، وحينئذٍ سوف نكون سعداء سواء أثّر عملنا أو لم يؤثر، سواء قدر الناس عملنا أم لم يقدروا، سواء رمونا باللعن أو بالحجارة على أي حال سوف نستقبل الله سبحانه وتعالى ونحن سعداء لأننا أدَّينا حقنا وواجبنا، لئن ضيَّع هؤلاء السعادة ولئن ضيعوا فهمهم، ولئن استولى عليهم الغباء فخلطوا بين علي (ع) ومعاوية، لئن انصرفوا عن علي وهم في قمة الحاجة إليه فهناك من لا يختلط عليه الحال، من يميز بين علي (ع) وبين أي شخص آخر، ذاك هو الحق وتلك هي السعادة.
ـ 2 ـ
كنا نتحدث عن تلك الظاهرة الفريدة في المرحلة التي قضاها الإمام عليه السلام حاكماً متصرفاً ومصرفاً لشؤون المسلمين.
هذه الظاهرة الفريدة هي ما ألمحنا إليها من أن الإمام عليه السلام كان حريصاً كل الحرص على إعطاء العناوين الأولية للصيغة الإسلامية للحياة، والوقوف على التكليف الواقعي الأولي بحسب مصطلح الأصوليين، دون تجاوزه إلى ضرورات استثنائية تفرضها طبيعة الملابسات والظروف.
قلنا إن هذه النقطة بحثت من الناحية الفقهية ومن الناحية السياسية معاً، فقيل مثلاً:
ـ لماذا لم يرتض الإمام بأنصاف الحلول أو بشيء من المساومة؟….
ـ لماذا لم يسكت؟.
ـ لماذا لم يُمْضِ ولو بصورة مؤقتة الجهاز الفاسد الذي تركه وخلّفه عثمان بعد موته؟.
ـ لماذالم يُمْضِ الجهاز حتى إذا أطاعه هذا الجهاز وأسلم له القيادة بعد ذلك يستطيع أن يمارس بشكل أقوى وأعنف عملية التصفية؟.
كنا نعالج هذه المسألة وقلنا إن الجواب على هذا السؤال وتفسير هذه الظاهرة الفريدة في الحياة للإمام عليه السلام يتضح بمراجعة عدة نقاط استعرضنا من هذه النقاط أربع:
النقطة الأولى: هي أن الإمام عليه السلام كان بحاجة إلى إنشاء جيش عقائدي في دولته الجديدة التي كان يخطط لإنشائها في العراق، وهذا الجيش العقائدي لم يكن موجوداً بل كان بحاجة إلى تربية وإعداد فكري ونفسي وعاطفي وهذا الإعداد كان يتطلب جواً مسبقاً صالحاً لأن تنشأ فيه بذور هذا الجيش العقائدي. وهذا الجو ما لم يكن جواً كفاحياً رسالياً واضحاً،، لا يمكن أن تنشأ في أحضانه بذور ذلك الجيش العقائدي، لو افترضنا أن الجو كان جو المساومات وأنصاف الحلول حتى في حالة كون أنصاف الحلول تكتسب الصفة الشرعية بقانون التزاحم على ما ذكرناه حتى في هذه الحالة تفقد الصيغة مدلولها التربوي.
النقطة الثانية: هي أن الإمام عليه السلام جاء لتسلم زمام الحكم في لحظة ثورة لا في لحظة اعتيادية، ولحظة الثورة تستبطن لحظة تركيز وتعبئة وتجمع كل الطاقات العاطفية والنفسية في الأمة الإسلامية لصالح القضية الإسلامية فكان لا بدَّ من اغتنام هذه اللحظة بكل ما تستبطنه من هذا الزخم الهائل عاطفياً ونفسياً وفكرياً.
النقطة الثالثة: التي ركَّزنا عليها، هي أن ظاهرة الشك في مجتمع الإمام عليه السلام هذه الظاهرة التي بيَّناها وكيف أنها عصفت بالتجربة واستطاعت أن تقضي على الآمال والأهداف التي كان معقودة عليها، هذا الشك بالرغم من أنه لم يكن يملك في سيرة الإمام عليه السلام أي مبرر موضوعي، وكانت مبرراته ذاتية محضة بالنحو الذي شرحناه تفصيلاً فيما مضى فقد استفحل وطغى، فكيف لو افترضنا أن هذه المبررات الذاتية أضيفت إليها مبررات موضوعية من الناحية الشكلية، إذن لكان هذا الشك أسرع إلى الانتشار والتعمق والرسوخ وفي النهاية إلى تقويض هذه التجربة.
النقطة الرابعة: التي ختمنا بها الحديث هي عبارة عن أن أنصاف الحلول أو المساومة هنا كانت في الواقع اشتراكاً في المؤامرة وكانت تحقيقاً للمؤامرة من ناحية الإمام عليه السلام ولم يكن تعبيراً عن الإعداد لإحباط هذه المؤامرة لأن المؤامرة لم تكن مؤامرة على شخص الإمام علي عليه السلام لم تكن مؤامرة على حاكمية الإمام علي عليه السلام حتى يقال: إنه يمهد لهذه الحاكمية بشيء من هذه الحلول الوسط، وإنما المؤامرة كانت مؤامرة على وجود الأمة الإسلامية، على شخصية هذه الأمة، على أن تقول كلمتها في الميدان بكل قوة وجرأة وشجاعة، على أن تَنْسَلِخ عن شخصيتها وينصب عليها قيم من أعلى يعيش معها عيش الأكاسرة والقياصرة مع شعوب الأكاسرة والقياصرة. هذا الذي كان يسمّى بالمصطلح الإسلامي بالهرقلية والكسروية.
هذه هي المؤامرة.
فلو أن الإمام عليه السلام كان قد مارس أنصاف الحلول، لو كان قد باع الأمة بيعاً مؤقتاً مع خيار الفسخ، إذن لكان بهذا قد اشترك في إنجاح وفي سلخ الأمة عن إرادتها وشخصيتها.
كانت الأمة وقتئذٍ بحاجة كبيرة جداً لكي تستطيع أن تكون على مستوى مسؤوليات ذلك الموقف العصيب، وعلى مستوى القدرة للتخلص من تبعات هذه المؤامرة.
كان لا بدَّ من أن تشعر بكرامتها بإرادتها، بحريتها بأصالتها، بشخصيتها، في المعترك وهذا كله مما لا يتفق مع ممارسة الإمام عليه السلام لأنصاف الحلول.
النقطة الخامسة: التي لا بدَّ من الالتفات إليهافي هذا المجال هي أن الإمام عليه السلام لو كان قد أمضى هذه الأجهزة الفاسدة التي خلفها عثمان الخليفة من قبله فليس من المعقول بمقتضى طبيعة الأشياء أن يستطيع بعد هذا أن يمارس عملية التغيير الحقيقي في هذه التجربة التي يتزعمها.
وفي الواقع أن هذا الفهم لموقف أمير المؤمنين عليه السلام الذي أعرضه في هذه النقطة مرتبط بحقيقة مطلقة تشمل موقف أمير المؤمنين عليه السلام وتشمل أي موقف رسالي عقائدي آخر مشابه لموقف أمير المؤمنين عليه السلام أي موقف آخر يستهدف تغييراً جذرياً أو إصلاحياً حقيقياً في مجتمع أو بيئة أو حوزة أو في أي مجتمع آخر من المجتمعات، وهذه الحقيقة المطلقة هي أن كل إصلاح لا يمكن أن ينشأ على يد الأجهزة الفاسدة نفسها التي لا بدَّ أن يطالها التغيير.
فلو افترضنا أن الزعيم المسؤول عن إصلاح تلك البيئة أقرَّ الأجهزة الفاسدة التي يتوقف الإصلاح على إزالتها وعلى تبديدها، لو أنه أقرّ هذه الأجهزة وتعاون معها وأمضاها ولو مؤقتاً، ثم بعد أن اكتسب القوة والمزيد من القدرة، وامتدّ أفقياً وعامودياً في أبعاد هذه التجربة التي تزعمها، بعد هذا استبدل هذه الركائز بركائز أخرى هذا المنطق منطق لا يتفق مع طبيعة العمل الاجتماعي ومع طبيعة الأشياء وذلك لأن هذا الزعيم من أين سوف يستمد القوة من أين سوف تتسع له القدرة؟ من أين سوف يمتد أفقياً وعامودياً؟.
هل تهبط عليه هذه القوة بمعجزة من السماء؟ لا … وإنما سوف يستمد هذه القوة من تلك الركائز نفسها…
أي زعيم في أية بيئة يستمد قوته وتتعمق هذه القوة عنده باستمرار. من ركائزه، من أسسه، من أجهزته التي هي قوته التنفيذية التي هي واجهته على الأمة، التي هي تعبيره، التي هي تخطيطه، فإذا افترضنا أن هذه الأجهزة كانت هي الأجهزة الفاسدة التي يريد المخطط الإصلاحي إزالتها وتبديلها بأجهزة أخرى، فليس من المعقول أن يقول الزعيم في أية لحظة من اللحظات، وفي أي موقف من المواقف: دع هذه الأجهزة معي دعني أعمل مع هذه الأجهزة حتى أمتد حتى أشمخ وبعد أن أمتد وأشمخ أستطيع أن أقضي على هذه الأجهزة.
فإن الشموخ الناتج من هذه الأجهزة لا يمكن أن يقضي على هذه الأجهزة. النتيجة منطقياً مرتبطة بمقدماتها والنتيجة واقعياً مرتبطة أيضاً بركائزها وأسسها، فهذا الشموخ المستمد من ركائز فاسدة، من أجهزة فاسدة، لا يمكن أن يعود مرة أخرى فيتمرد على هذه الأجهزة.
هذا الزعيم حتى لو كان حسن النية، حتى لو كان صادقاً في نيته وفي تصوره سوف يجد في نهاية الطريق أنه عاجز عن التغيير، سوف يجد في نهاية الطريق أنه لا يتمكن أن يحقق أهدافه الكبيرة لأن الزعيم مهما كان زعيماً، والرئيس مهما كان حاكماً وسلطاناً، لا يغير بيئة بجرة قلم، لا يغير بيئة بإصدار قرار بإصدار أمر، وإنما تتغير البيئة عن طريق الأجهزة التي تنفذ إرادة هذا الزعيم، وتخطيط هذا الزعيم، إذن كيف سوف يستطيع هذا الزعيم أن ينفذ إرادته، أن يحقق أهدافه أن يصل إلى أمله؟.
فطبيعة الأشياء وطبيعة العمل التغييري في أي بيئة تفرض على أي زعيم يبدأ هذا العمل أن يبني زعامته بصورة منفصلة عن تلك الأجهزة الفاسدة وهذا ما كان يفرض على الإمام عليه السلام أن لا يمضي مخلفات عثمان الإدارية والسياسية؟…
النقطة السادسة: التي لا بدَّ من الالتفات إليها أيضاً في هذا المجال هي أن الإمام عليه السلام لو كان أمضى ولو مؤقتاً الأجهزة التي خلفها عثمان أمضى مثلاً ولاية معاوية بن أبي سفيان وحاكميته على الشام لحصل من ذلك على نقطة قوة مؤقتة.
لو باع الأمة من معاوية بيعاً مؤقتاً مع خيار الفسخ إذن لاستطاع بذلك أن يحصل على نقطة قوة ونقطة القوة هي أن معاوية سوف يبايعه وسوف يبايعه أهل الشام وهذه النقطة نقطة قوة في حساب عملية التغيير لكن في مقابل هذا أيضاً سوف يحصل معاوية بن أبي سفيان، على نقطة قوة كما حصل الإمام عليه السلام على نقطة قوة ونقطة القوة التي سوف يحصل عليها معاوية هي اعتراف الإمام عليه السلام صاحب الأطروحة الجديدة صاحب الخط الإسلامي الآخر المعارض على طول الزمن منذ تشكلت السقيفة بشرعية معاوية بن أبي سفيان بأن معاوية رجل على أقل التقادير يوصف بأنه عامل قدير على تسيير مهام الدولة وعلى حماية مصالح المسلمين وعلى رعاية شؤونهم، هذا الاعتراف هو المدلول العرفي الواضح لمثل هذا الإمضاء في الذهنية الإسلامية العامة، فنقطة قوة لمعاوية مقابل نقطة قوة لعلي عليه السلام ….
ونحن إذا قارنَّا بين هاتين النقطتين فلن ننتهي إلى قرار يؤكد أن نقطة القوة التي يحصل عليها الإمام عليه السلام هي أهم في حساب عملية التغيير الاجتماعية التي يمارسها الإمام عليه السلام من نقطة القوة التي يحصل عليها معاوية، خاصة إذا التفتنا إلى أن تغيير الولاة في داخل الدولة الإسلامية وقتئذٍ لم يكن عملية سهلة ولم يكن عملية بهذا الشكل من اليسر الذي نتصوره في دولة مركزية تسيطر حكومتها المركزية على كل أجهزة الدولة وقطاعاتها.
ليس معنى أن معاوية يبايع أو يأخذ البيعة لخليفة في المدينة أن جيشاً في الحكومة المركزية سوف يدخل الشام وأن هناك ارتباطاً عسكرياً حقيقياً سوف يجد بين الشام وبين الحكومة المركزية وإنما يبقى هذا الوالي بعد أخذ البيعة همزة الوصل الحقيقية بين هذا البلد وبين الحكومة المركزية لضعف مستوى الحكومة المركزية وقتئذٍ من ناحية، ومن ناحية أخرى لترسيخ معاوية في الشام بالخصوص لأن الشام لم تعرف حاكماً مسلماً قبل معاوية وقبل أخي معاوية ومذ دشَّن الشام حياته الإسلامية فإنما دشَّنها على يد أولاد أبي سفيان. إذن ترسخ معاوية من الناحية التاريخية والصلاحيات الاستثنائية التي أعطيت له في أن ينشئ له سلطنة وملكية في الشام.
هذه الصلاحيات الاستثنائية التي أخذها معاوية لأجل إنشاء مظاهر ملكية مستقلة في الشام، لا تشبه الوضع السياسي في الدولة الإسلامية في باقي الأقاليم وهذا مما رسَّخ نوعاً من الانفصالية في الشام عن باقي أجزاء جسم الدولة الإسلامية.
ثم الصلاحيات التي أخذها من عثمان بن عفان حينما تولى الخلافة، وحينما شعر بأنه قادر على أن يستهتر بشكل مطلق بالأمر والنهي، بحيث لم يبق طيلة مدة خلافة عثمان أي ارتباط حقيقي بين الشام والمدينة وإنما كان هو الآمر والناهي في الشام مما جعل الشام يعيش حالة شبه انفصالية في الواقع، وإن لم تكن انفصالية بحسب العرف الدستوري للدولة الإسلامية وقتئذٍ، وهذا مما يعقد الموقف على أمير المؤمنين عليه السلام ويجعل نقطة القوة التي يحصل عليها وهي مجرد البيعة في الأيام الأولى نقطة غير حاسمة بينما إذا أراد بعد هذا أن يعزل معاوية فبإمكان معاوية أن يثير ـ إلى جانب وجوده المادي القوي المترسخ في الشام ـ الشبهات على المستوى التشريعي والإسلامي.
ـ لماذا يعزلني؟.
ـ ماذا صدر مني حتى يعزلني بعد أن اعترف بأني حاكم عادل صالح لإدارة شؤون المسلمين؟….
ـ ما الذي طرأ وما الذي تجدد؟.
مثل هذا الكلام كان بإمكان معاوية أن يوجهه حينئذٍ إلى الإمام عليه السلام ولم يكن للإمام عليه السلام أن يعطي جواباً مقنعاً للرأي العام الإسلامي وقتئذٍ على مثل هذه الشبهة.
بينما حين يعزله من البداية يعزله على أساس أنه يؤمن بعدم صلاحيته، وبأنه لا تتوفر فيه الشروط اللازمة في الحاكم الإسلامي، وهو لا يتحمل مسؤولية وجوده كحاكم، في الفترة السابقة التي عاشها معاوية حاكماً من قبل.
النقطة السابعة: التي لا بدَّ من الالتفات إليها في هذا المجال هي: أن هذه الشبهة تفترض أن معاوية بن أبي سفيان لو أن الإمام عليه السلام أمضى حاكميته وأمضى ولايته لبايعه ولأعطى نقطة القوة هذه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ولكن لا يوجد في الدلائل والقرائن التي كانت تكتنف موقف الإمام عليه السلام ما يوحي بصحة هذا الافتراض، فإن معاوية لم يعص علياً لأجل أنه عزل عن الولاية، وإنما كان ذلك في أكبر الظن جزءاً من مخطط لمؤامرة طويلة الأمد للأموية على الإسلام، الأموية كانت تريد أن تنهب مكاسب الإسلام بالتدريج هذا النهب الذي عبَّر عنه بأقسى صورة أبو سفيان حينما ركل قبر حمزة رضوان الله عليه بقدمه وهو يقول: إن هذا الدين الذي بذلتم دماءكم في سبيله، وضحيتم في سبيله قوموا واقعدوا انظروا كيف أصبح كرة في يد صبياننا وأطفالنا.
كان الشرف الأموي يريد أن يقتنص وأن ينهب مكاسب البناء الإسلامي والوجود الإسلامي، وكانت هذه المؤامرة تنفذ على مستويات وكانت المرحلة الأولى من هذه المؤامرة ترسخ الأخوين في الشام يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية بن أبي سفيان بعد يزيد. ومحاولة استقطاب معاوية للشام، عن طريق بقائه هذه المدة الطويلة فيها.
ثم كان معاوية بن أبي سفيان بنفسه، ينتظر الفرصة الذهبية التي يتيحها مقتل عثمان بن عفان هذه الفرصة الذهبية التي تعطيه سلاحاً غير منتظر يمكن أن يمسكه ويدخل به إلى الميدان … ولهذا تباطأ عن نصرة عثمان بن عفان، كان عثمان يستنصره ويستصرخه ويؤكد له أنه يعيش لحظات الخطر ولكن معاوية كان يتلكأ في إنقاذه وكان معاوية ـ على أقل تقدير ـ قادراً على أن يؤخر هذا المصير المحتوم لعثمان إلى مدة أطول لو أنه وقف موقفاً إيجابياً حقيقياً في نصرة عثمان بن عفان إلاّ أنه تلكأ وتلعثم وكان يخطط لكي يبقى هذا التيار كاسحاً ولكي يخرج عثمان بن عفان على يد المسلمين ميتاً ثم بعد هذا لكي يأتي ويمسك بزمام هذا السلاح ولكي يقول أنا ابن عم الخليفة المقتول ومن المعلوم أن معاوية لن يتاح له في كل يوم، أن يكون ابن عم الخليفة المقتول، فهذه الفرصة الذهبية التي كانت على مستوى الأطماع والآمال الأموية لنهب كل مكاسب الإسلام هذه الفرصة الذهبية لم يكن من المظنون أن معاوية سوف يغيرها عن طريق الاكتفاء بولاية الشام، ولاية الشام كانت مرحلة، أما منذ قتل عثمان بدأ معاوية في نهب كل الوجود الإسلامي، وتزعم كل هذا الوجود وكان هذا يعني أن تعيينه أو إبقاءه والياً على الشام لن يكون على مستوى أطماعه في المرحلة الأولى التي بدأت بمقتل عثمان بن عفان من مراحل المؤامرة الأموية على الإسلام.
وأخيراً لا بدّ من الالتفات أيضاً إلى شيء آخر: هو أن الوضع الذي كان يعيشه الإمام عليه السلام في ملاحظة طبيعة الأمة في ذلك الوضع، وطبيعة الإمام عليه السلام في ذلك الوضع، لم يكن ليوحي بالاعتقاد بالعجز عن إمكان النجاح لعملية التغيير دون مساومة.
ومن الواضح أن الفكرة الفقهية التي أشرنا إليها سابقاً عن توقف الواجب الأهم على المقدمة المحرمة، إنما تكون فيما إذا كان هناك توقف بالفعل، بحيث يحرز أنَّ هذا الواجب الأهم لا يمكن التوصل إليه إلاَّ عن طريق هذه المقدمة المحرمة، والظروف وطبيعة الأشياء وقتئذٍ لم تكن توحي، ولم تكن تؤدي إلى اليقين بمثل هذه التوقف.
وذلك لأن المؤامرة التي كان علي عليه السلام قد اضطلع بمسؤولية إحباطها حينما تولى الحكم لم تكن قد نجحت بعد بل كانت الأمة في يوم قريب سابق على يوم مقتل عثمان قد عبرت تعبيراً معاكساً مضاداً لواقع هذه المؤامرة ولمضمون هذه المؤامرة.
هذه المؤامرة صحيح أنها تمتد بجذورها إلى أمد طويل قبل هذا التاريخ، المؤامرة على وجود الأمة الإسلامية، فإن الأمة الإسلامية التي سهر عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على إعطائها أصالتها وشخصيتها وكرامتها ووجودها، حتى كان قد ألزم نفسه وألزمه ربه بالشورى والتشاور مع المسلمين لأجل تربية المسلمين تربية نفسية وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم وإشعارهم بأنهم هم الأمة التي يجب أن تتحمل مسؤوليات هذه الرسالة التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي تعيش هذه الروحية وتعيش على هذا المستوى عاطفياً ونفسياً، وبدأت جذور المؤامرة للقضاء على وجود الأمة كافة وتحويل الوجود إلى السلطان والحاكم.
أول جذر من جذور هذه المؤامرة أعطي كمفهوم في السقيفة حينما قال أحد المتكلمين فيها من ينازعنا سلطان محمد.
والسقيفة وإن كانت بمظهرها اعترافاً بوجود الأمة لأن الأمة تريد أن تتشاور في أمر تعيين الحاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن المفهوم الذي أعطي في السقيفة والذي كتب له أن ينجح يوم السقيفة، وأن يمتد بأثره بعد ذلك بعد يوم السقيفة هذه، المفهوم كان بحد ذاته ينكر وجود الأمة.
كان ينظر إلى النبوة على أنها سلطان قريش أنها سلطان عشيرة معينة وهذه العشيرة المعينة هي التي يجب أن تحكم وأن تسود، نظرية مالكية العشيرة، التي تتحدى وجود الأمة، وتنكر عليها أصالتها ووجودها وشخصيتها، هذه النظرية طرحت كمفهوم في السقيفة ثم بعد هذا امتدت واتسعت عملياً ونظرياً.
عمر بن الخطاب كان أيضاً يعمق بشكل آخر هذا المفهوم.
في مرة من المرات سمع عمر بن الخطاب أن المسلمين يتحلقون حلقاً حلقاً، ويتكلمون في أن أمير المؤمنين إذا أصيب بشيء فمن يحكم المسلمين بعد عمر؟.
المسلمون أناس يحملون همّ التجربة همّ المجتمع هم الأمة تطبيقاً لفكرة: إن كل مسلم يحمل الهموم الكبيرة يفكرون في أن عمر بن الخطاب حينما يموت، من الذي يحكم المسلمين؟.
هذا تعبير عن وجود الأمة في الميدان.
انزعج عمر بن الخطاب جدًّا لهذا التعبير عن وجود الأمة. لأنه يعرف أن وجود الأمة في الميدان معناه وجود علي عليه السلام في الميدان، معناه وجود الخط المعارض في الميدان، كلما نمت الأمة كلما تأصل وجودها أكثر واكتسبت إرادتها ووعيها بدرجة أعمق، كان علي هو الأقدر وهو الأكفأ لممارسة عملية الحكم، لهذا صعد على المنبر وقال ما مضمونه: أن أقواماً يقولون ماذا ومن يحكم بعد أمير المؤمنين؟…. ألا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرَّها.
يعني ماذا يريد أن يقول في هذا الكلام، يريد أن يقول في هذا الكلام بأن المسلمين لا يجوز أن يعودوا مرة أخرى إلى التفكير المستقل في انتخاب شخص وإنما الشخص يجب أن يعين لهم من أعلى. لكن لم يستطع ولم يجرؤ أن يبين هذا المفهوم وإلاَّ هو في نفسه كان هكذا يرى….
كان يرى أن الأمة يجب أن تستمع منه هو يعين من أعلى هذا الحاكم، لا أن الأمة نفسها تفكر في تعيين هذا الحاكم كما فكَّرت مثلاً عقيب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك فلتة وقى الله المسلمين شرَّها، والأمة يجب ألاَّ تعود إلى هذه الفلتة مرة أخرى.
إذن فما هو هذا البديل؟ هذا البديل لم يبرزه لكن البديل كان في نفسه هو أني أنا يجب أن أعيّن هذا أيضاً، وبعد هذا عبَّر عن هذا البديل بكل صراحة وهو على فراش الموت، وحينما طلب منه المتملقون أن يوصي وألاَّ يهمل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما طلبوا منه ذلك عبر عن هذا البديل بكل صراحة فأسند الأمر إلى ستة أيضاً كان فيه نوع من التحفظ لأنه لم يعين واحداً وحيداً لا شريك له وإنما عيّن ستة كأنه يريد أن يقول: بأني أعطيت درجة من المشاركة للأمة عن طريق أني أسندت الأمر إلى ستة هم يعينون فيما بينهم واحداً منهم.
طبعاً عبد الرحمن بن عوف الذي كان قطب الرحى في هؤلاء الستة أيضاً لم يستطع في تلك المرحلة أن يطفئ دور الأمة، لم يحل المشكلة عن طريق التفاوض فيما بين هؤلاء الستة، في اجتماع مغلق وإنما ذهب يستشير الأمة ويسأل المسلمين من الذي ترشحونه من هؤلاء الستة؟ إلى هنا كانت الأمة لا تزال تحتفظ بدرجة كبيرة من وجودها بحيث أن عمر بن الخطاب لم يستطع أن يغفل وجود الأمة، يسأل هذا ويسأل ذاك من تريدون من هؤلاء الستة؟ يقول ما سألت عربياً إلاَّ وقال: علي بن أبي طالب عليه السلام وما سألت قرشياً إلاَّ وقال عثمان بن عفان يعني جماهير المسلمين كانت تقول علي بن أبي طالب عليه السلام وعشيرة واحدة معينة كانت تريد أن تنهب الحكم من الأمة كانت تقول عثمان لأن عثمان بن عفان كان تكريساً لعملية النهب بينما علي بن أبي طالب عليه السلام كان تعبيراً وتأكيداً لوجود الأمة في الميدان، ولهذا أرادته الأمة، وأرادت العشيرة عثمان.
ثم بعد هذا جاء عثمان بن عفان. وفي دور عثمان بن عفان تكشفت المؤامرة أكثر فأكثر وامتدت أكثر فأكثر.
أصبحت العشيرة تحكم وتقول بكل صراحة بأن المال مالنا والخراج خراجنا والأرض أرضنا إن شئنا أعطينا للآخرين وإن شئنا حرمناهم.
لكن هذا كلام يقال خارج نطاق الدستور، أما في نطاق الدستور فكانت لا تزال الصيغة الإسلامية وهي أن المال مال الله والناس سواسية، المسلمون كلهم عبيد الله لا فرق بين قرشيّهم وعربيّهم وبين عربيّهم وأعجميّهم، بين أي مسلم وأي مسلم آخر، هذه كانت الصيغة الدستورية حتى في عهد عثمان لكن هذا الوالي الأموي المتغطرس أو ذاك الأموي المتعجرف أو هذا الأموي المستعجل والمتهور كان ينطق بواقع آخر لا يعبر عن الدستور حيث ينظر إلى الأمة على أنها قطيع يتحكم به كيف يشاء وعلى أن أرض الإسلام مزرعة ينتفع بخيراتها من يشاء هو ويحرم من خيراتها من شاء ولكن منطق الدستور الإسلامي كان هو المتجذر في نفوس أبناء الأمة.
هذا المنطق هو أن أرض السواد ملك الأمة وأن الأمة هي صاحبة الرأي فهي القائدة وهي سيدة الموقف وهذا يعني أن المؤامرة لا تزال غير ناجحة بالرغم من الجذور، بالرغم من المقدمات بالرغم من الإرهاصات النظرية والعملية بالرغم من كل ذلك، المؤامرة لم تكن ناجحة، الأمة كانت هي الأمة، الأمة كانت تأتي إلى عثمان وتقول: لا نريد هذا الوالي لأن هذا الوالي منحرف منحرف لا يطبِّق كتاب الله وسنَّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يستطيع عثمان بن عفان أن يجيب بصراحة ويقول ليس لك إرادة، هذا الوالي يمثلني أنا، وأنا الحاكم أنا الحاكم المطلق لم يكن يستطيع عثمان بن عفان أن يقول هذا، وإنما كان يعتذر ويقيل ويرجع. وهكذا كان يناور مع الأمة يشتغل بمناورات من هذا القبيل مع هذه الأمة التي بدأت تحس بالخطر على وجودها، فعبّرت الأمة تعبيراً ثورياً عن وجودها وعن كرامتها فقتلت الخليفة وبعدها اتجهت طبيعياً إلى الإمام عليه السلام لكي يعبر من جديد عن وجودها لكي يحبط المؤامرة لكي يعيد إلى هذه الأمة كل كرامتها خارج نطاق الدستور وداخل نطاق الدستور لكي يقضي على كل انحراف خرج به الحكام عن الدستور، عن الصيغة الإسلامية للحياة.
فمن هنا كانت القضية لا تزال في بدايتها لا تزال الأمة هي الأمة لا تزال بحسب مظهرها على أقل تقدير هي تلك الأمة التي قتلت الحاكم في سبيل الحفاظ على وجودها وعلي عليه السلام صاحب الطاقات الكبيرة هو الشخص الوحيد الذي يؤمل فيه أن يصفي عملية الانحراف.
فالظروف والملابسات لم تكن تؤدي إلى يأس … كانت تؤدي إلى أمل وما وقع خارجاً خلال هذه الأربع سنوات كان يؤكد هذا الأمل فإن علياً عليه السلام لولا معاكسات جانبية لم تكن تنبع من حقيقة المشاكل الكبرى في المجتمع، لاستطاع أن يسيطر على الموقف.
لولا مسألة التحكيم مثلاً، لولا أن شعاراً معيناً طرح من قبل معاوية هذا الشعار الذي انعكس بفهم خاطئ عند جماعة معينة في جيش الإمام عليه السلام لولا هذا لكان بينه وبين قتل معاوية وتصفيته بضعة أمتار.
إذن كان الأمل في أن علياً عليه السلام يمكنه أن يحقق الهدف ويعيد للأمة وجودها من دون حاجة إلى المساومات وأنصاف الحلول كان هذا الأمل أملاً معقولاً وكبيراً ولهذا لم يكن هناك مجوز لارتكاب أنصاف الحلول والمساومات.
ولكن هذا الأمل قد خاب كما قلنا. انتهى آخر أمل حقيقي في هذه التصفية حينما خرَّ هذا الإمام عليه السلام العظيم صريعاً في مسجده صلوات الله عليه وانتهى آخر أمل في هذه التصفية وقدر للمؤامرة على وجود الأمة أن تنجح وأن تؤتي مفعولها كاملاً.
غير أن الإمام عليه السلام حينما فتح عينيه في تلك اللحظة العصيبة ورأى الحسن عليه السلام وهو يبكي ويشعر ويحس ويدرك بأن وفاة أبيه هي وفاة لكل هذه الآمال أراد أن ينبهه إلى أن الخط لا يزال باقياً وإلى أن التكليف لا يزال مستمراً وأن نجاح المؤامرة لا يعني أن نلقي السلاح.
نعم المؤامرة يا ولدي نجحت ولهذا سوف تشردون وسوف تقتلون ولكن هذا لا يعني أن المعركة انتهت يجب أن تقاوم حتى تقتل مسموماً، ويجب أن يقاوم أخوك حتى يقتل بالسيف شهيداً ولا بدَّ أن يستمر الخط حتى بعد أن سرق من الأمة وجودها لأن محاولة استرجاع الوجود إذا بقيت في الأمة فسوف يبقى هناك نفس في الأمة سوف يبقى هناك ما يحصن الأمة ضد التميع والذوبان.
الأمة حينما تتنازل عن هذه الإرادة والشخصية لجبار من الجبابرة حينئذٍ تكون عرضة للذوبان والتميع في أتون أي فرعون من الفراعنة.
لكن إذا بقي لدى الأمة محاولة استرجاع هذا الوجود باستمرار، هذه المحاولة التي يحاولها خط علي عليه السلام ومدرسة علي عليه السلام والشهداء والصديقيون من أبناء علي عليه السلام وشيعته، إذا بقيت هذه المحاولة فسوف يبقى مع هذه المحاولة أمل في أن تسترجع الأمة وجودها وعلى أقل تقدير سوف تحقق هذه المحاولة كسباً آنياً باستمرار وهو تحصين الأمة ضد التميع والذوبان المطلق في إرادة ذلك الحاكم وفي إطار ذلك الحاكم. وهذا ما وقع.
محمد باقر الصدر
الخوارج
من الأخطاء الشائعة في فكر المستشرقين وبعض الذين نقلوا عنهم من العرب، تقدير فرق الخوارج، باعتبارها تمثل الديمقراطية العربية والمعارضة للحكم الاستبدادي في التاريخ العربي القديم.
ولكن الخوارج لم يكونوا كذلك، أو لم يبدأوا كذلك على الأقل، بل كانوا فرقة تحوم حولها تهم العمالة للفكر الاستبدادي الذي تزعمه معاوية بن أبي سفيان، وفي أحسن الفروض، فرقة مراجعة، تميل إلى السفسطة، أفسدت العمل الثوري العظيم الذي تزعمه الإمام الشهيد علي بن أبي طالب.
نشأة الخوارج
يتحدث المستشرقون عن نشأة الخوارج فيزعم فيلهوزن أنهم من جماعة القرّاء، أي الدعاة الأوائل للإسلام من حفظة القرآن والحديث والسنة، أي أصلب العناصر الإسلامية. ذلك استناداً إلى «عبارة جافة»([195]) لأبي مخنف أوردها الطبري. ويزعم «برنوف» استناداً إلى رواية أخرى لأبي مخنف أيضاً أنهم من البدو، ويزعم مؤرخ عربي أن الخوارج عرب انضم إليهم مواليهم من غير العرب([196]) «كما أنه كان لهؤلاء الموالي من المجوس الذين أسلموا بعض التأثير على العقيدة الخارجية»([197]).
ولو تتبعنا ما قيل من تكهنات حول قضية الخوارج لمؤرخين آخرين لاستغرقنا في بحث أشبه بعمل النسابين العرب القدامى، هل هم من تميم أو هم من القبائل الشمالية أو هم من القبائل اليمانية، إلى غير ذلك من أسباب التفكير العنصري أو القبلي.
فالخوارج نشأوا حزباً سياسياً، له مصالح سياسية واقتصادية، وربما نتيجة مناورة من حزب معاوية أيضاً.
فحين بدأت الثورة ضد عثمان تبدو في الأفق، وضح أن الطامعين في الخلافة من أعضاء الشورى يجمعون الأنصار ويكتبون الكتب. وتكوّنت تقريباً ثلاثة اتجاهات، الأول من كبار الأثرياء في المجلس بزعامة طلحة يريد استبعاد علي بن أبي طالب، والثاني الحزب الأموي ويريد استبعاد علي أيضاً، وإنشاء دولة بقيادة بني أمية، وهو الحزب الأكثر تمثيلاً لمصالح الأثرياء لما يملكون من ثروة، ومن مراكز السلطة التي أسندها إليهم عثمان بن عفان. والحزب الثالث حزب علي الذي يمثل الفقراء والمستضعفين والحالمين بالعدل الاجتماعي الذي نادى به الإسلام([198]). وهذه التيارات الثلاثة فعلاً قد اصطدمت بعضها ببعض. التيار الأول صفي في معركة «الجمل» بواسطة حزب علي بن أبي طالب، والتيار الثاني استطاع أن يصفي علياً بن أبي طالب وحزبه.
وسنلاحظ تياراً رابعاً قعد عن الاشتراك في الصراع كان على رأسه عبد الله بن عمر، الذي لاذ بالتقوى والورع، وابتعد عن الصراع، وحتى هذا التيار ـ الذي كان له أنصار ـ لم يصدر عن التقوى والورع وحدهما بل عن ظروف سياسية قد تكون أقل بروزاً، ولكنها أساسية وموجهة للموقف الذي وقفه أصحابه. فنحن نعرف أن علياً بن أبي طالب كان يمثل المعارضة في حكم عمر بن الخطاب في السنوات الأولى من خلافته.
فعبد الله بن عمر وغيره من أتقياء قريش كانوا أميل إلى الوسط، وسنجد أن هذا الوسط كان أميل لتبرير فعل عثمان بن عفان والعطف عليه، وإن كان ينقده.
ولكن ما موقف الخوارج من هذه التيارات جميعاً؟.
والواقع أن الصراع لم يكن قد تبلور تماماً في حزبين أساسيين هما حزب علي وحزب معاوية حين بدأت الثورة على عثمان بن عفان. ولكن بعد أن بويع علي بالخلافة بدت عناصر الصراع تستقطب بعضها، بحيث تعدد الصراع بين حزب علي وحزب معاوية. فالمحاربون في معركة «الجمل» لم يلبثوا أن أسفروا عن ميلهم السياسي فانضموا إلى معاوية كما انضمّ من صفوف علي إلى معاوية بعض من لم تكن تربطهم بالثورة العلوية مفاهيم اجتماعية.
والخوارج ليسوا بدعاً في عملية الاستقطاب، فهم جماعة استدرجوا إلى شرخ في جبهة علي، ثم غدر بهم ولم ينالوا جزاءهم الحق ثمناً لهذا الشرخ الذي أحدثوه من أصحاب المصلحة فيه، فمضوا في موقفهم مستقطبين تلك العناصر الورعة التي لم تفهم من الصراع الدائر، إلاّ أنه تنافس بين سلطات، ولعلهم لم يلتفتوا إلى الجانب الاجتماعي التفاتاً واعياً.
وهناك ما يدعو إلى التشكك في أول الخارجين يوم معركة صفين، فلو تتبعنا أنباء هذه المعركة من بدايتها لتكشفت لنا كل الأساليب التي أتبعها معاوية لإحداث الشرخ في جبهة علي.
معركة صفين
معركة صفين هي معركة التحول في الصراع الدائر بين حزب العدل الاجتماعي، وحزب رأسمالية التجار وكبار الملاك. فلقد استطاع معاوية أن يجمع جيشاً كبيراً يقوده ويحرضه كبار الأثرياء، واتجه لملاقاة جيش علي بعد كتابات ورسائل متبادلة بينه وبين الخليفة، اتسمت بالإقذاع من جانب معاوية وبالحلم والإسماع من جانب علي، رغم أن معاوية لم يكن إلاّ عاملاً من عماله. وكانت حجة معاوية وأنصاره طلب تسليم قتلة عثمان المنطوين تحت لواء الخليفة وفي جيشه، لإيقاع القصاص بهم. ولم يلبث أن رفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى القرآن.
وفيم الاحتكام إلى القرآن في الصراع الدائر بين الطرفين. وما أساس الصراع الدائر؟ أنه فيما يبدو قضية عثمان والاقتصاص من قتلته. أو هكذا كان موضوع المجادلة السائد بين الطرفين.
ولكن الهدف الأساسي الأكثر وضوحاً من دراسة وتأمل الكتب المتبادلة، والمناقشة الدائرة بين الرسل والزعماء هو قلب نظام الحكم والاستيلاء عليه.
ولما كان معاوية يعلم أن قوته العسكرية وحدها لا تكفي لتحقيق النصر فقد لجأ إلى تفتيت وحدة قيادات جيش علي، ضاغطاً على الأسباب الحقيقية للصراع، وهي الثروة والتسلط والتفرد من جانب، والعدل الاجتماعي من الجانب الآخر. ومن البديهي أن اتصالات رجاله برجال علي كانت مدروسة، وانتقى الرجال الذين يقبلون وجهة نظره، بعد أن يعري الموقف من جانبه العاطفي والحماسي لتبقى المصلحة الاقتصادية متصدرة.
ولقد نجح معاوية في ذلك، حتى أننا نستطيع القول بأن رفع المصاحف كان توقيتاً لإعلان التمرد.
فكيف لجيش سينتصر انتصاره فجأة. بل كيف لجيش يقاتل وراء ابن أبي طالب وهو من هو في الإسلام، أن يقتنع بحجة رفع المصاحف وهو يعلم عن معاوية ما يعلم، ويزيد الأمر وضوحاً أن علياً رفض التحكيم إلى المصحف كاشفاً تلك الحيلة الخادعة من اللحظة الأولى، فكيف لجيش علي وهو منتصر وتحت قيادة رفيعة المكانة في الإسلام أن يقبل وقف القتال، بعد أن رفضه قائده الأعلى، إلاّ أن يكون وراء كل هذا تدبير، ولقد يكفي أن يصرخ قائد في فصيلة أوقفوا القتال ليقف القتال قبل أن يتبينوا جلية الأمر. إن اتصالات رجال معاوية كانت بهذا الصنف الذي يملك أن يصيح بوقف القتال، فيقف القتال.
ويزيد الموقف وضوحاً أن علياً خطب واستعمل ما يملك من الحجج، ولكن خطبه ذهبت هباء. لأن الذين أرادوا أن يقف القتال لم يريدوه على أساس من القضية التي يحاربون من أجلها، بل على أساس آخر تماماً.
وهكذا وجد علي نفسه مضطراً لقبول التحكيم. فمن كان طلاب وقف القتال؟.
لقد كان أول الخوارج في طليعتهم … وسنرى الآن ذلك الجدل الذي نشب بين علي بن أبي طالب وبين أول فرقة للخوارج لنتبين أين كان موقفهم من قضية التحكيم. فبعد أن كشف التحكيم عن لعبة اشترك فيها الكثيرون ممن استقطبهم حزب معاوية من جيش علي، كان من بينها تعمد اختيار أبي موسى الأشعري، وهو رجل عثماني الميل، يمثل ذلك التيار القديم الذي تزعمه عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من القاعدين عن الاشتراك في الصراع. فلقد عارض أيضاً علي بن أبي طالب في اختيار أبي موسى الأشعري ولكن من نادوا بوقف القتال نادوا باختيار أبي موسى، وانتهت القضية إلى خلع أبي موسى لعلي من الخلافة وترشيح عمرو بن العاص لمعاوية، الأمر الذي لم يكن موضعاً للتحكيم أصلاً.
إن الجدل الذي دار بعد ذلك بين علي والخوارج يكشف عن دورهم في كل تلك المؤامرة المتعددة الجوانب.
علي بن أبي طالب: ألا تعلمون أن هؤلاء القوم «حزب معاوية» لما رفعوا المصاحف قلت لكم، إن هذه مكيدة ووهن، وأنهم لو قصدوا إلى حكم المصاحف لم يأتوني بل سألوني التحكيم. أفعلمتم أنه كان منكم أحد أكره لذلك مني؟.
الخوارج: اللهم نعم.
علي: فهل علمتم أنكم استكرهتموني على ذلك حتى أجبتكم إليه، فاشترطت أن حكمهما نافذ ما حكما بحكم الله عز وجل، فإن خالفاه فأنا وأنتم من ذلك براء.
الخوارج: نعم، ونحن مقرون بأنّا قد كفرنا ونحن تائبون فأقرر بمثل ما أقررنا وتب … ننهض معك إلى الشام.
وبالطبع رفض علي هذا اللجاج الفج، وانضمّ إليه منهم من انضم وأبى الباقون فقاتلهم علي حتى هزمهم.
وفي الوقت الذي كان الخليفة يقاتل الخصوم، كان الخوارج يهاجمونه ويقومون بالدعوة ضده، ويتهمونه بالكفر لأمر هم أصحابه الأولون.
وإِنَّ لنا أن نستريب في هذه الفرقة، وفي دوافعها. فهي أولاً دعت إلى وقف القتال، وثانياً تحمست لاختيار أبي موسى الأشعري ممثلاً لعلي، وثالثاً تراجعت عن هذا كله وناصبت حزب العدل الاجتماعي العداء حتى وصل الأمر إلى قتاله وتحريض الناس ضده وتقسيم وحدة الصف وراءه.
فهل نستطيع الزعم بأن فكرة الخوارج من صنع صاحب المصلحة في الأثر الذي ستحدثه؟.
نستطيع ذلك، على الرغم من أن الخوارج ناصبوا معاوية العداء، ولكن بعد أن صفي حزب العدل الاجتماعي تماماً.
ولن نستغرب كثيراً حين نعلم أن جريمة قتل علي بن أبي طالب كان أداتها رجلاً من الخوارج، وأنها نتيجة مؤامرة لم تتحقق فصولها تماماً ورائحة الخيانة تبدو فيها. فاغتيال الإمام لم يتم إلا بعد أن وحّد جيشه واستعد لضرب الثورة المضادة الضربة النهائية والحاسمة.
وأن القول بأن خارجين ثلاثة وكل إليهم قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص، لم ينجحوا إلا في قتل علي وحده، وفي هذا الظرف بالذات، لا يغير من الحقيقة في شيء فإن حزب العدل الاجتماعي ضرب بقتل علي ضربة قاضية بعد أن كان على أعتاب نصر نهائي.
وأن أصحاب الجريمة الأصليين يستطيعون أن يستتروا خلف أي لافتة، أو أي مظهر، وهي سياسة تتبع حتى الآن في المؤامرات التي يحوكها الاستعمار ونراها كل يوم تحت لافتات تبدو محلية تماماً.
مبادئ الخوارج
تلك كانت بداية الخوارج، وهي بداية تدين المؤسسين بالخيانة، وتفتيت وحدة القوى الثورية، بل وضربها مهما تكن الدعاوى التي استندت إليها.
أما بعد ذلك، وقد بدا أن مصلحة حزب معاوية الإبقاء عليهم حتى يضعفوا شيعة علي، بل وأن يناصبوهم العداء فيتساوى معاوية في نظر مؤيديهم والعاطفين عليهم مع الإمام المقتول.
ولكن ما المبادئ الأساسية التي ساروا عليها؟.
لقد تورطوا في إثم لم يستطيعوا الرجوع عنه، وعلى ذلك فليفلسفوا موقفهم، وليمضوا إلى أقصى غاية للتطرف.
فقالوا بنظرية «لا حكم إلاّ لله» وهو تقرير غامض ظهر بعد واقعة التحكيم، فهل يعني أنه ليس للبشر أن يحكموا في قضية فصل فيها القرآن.
إن كان هذا المعنى هو المقصود، فإن فكرة التحكيم الغرض منها الاستناد إلى القرآن تحكيمه لا إلى مخالفته.
وهم ينتقلون من هذه الفكرة الغامضة إلى مسألة الإمامة فيقولون بحق الاختيار الحر للخليفة من جانب المسلمين بلا أي قيد، كالنسبة إلى قريش أو الحرية، أو النسبة إلى العرب، إلاّ أن يكون المختار مسلماً نقياً([199]).
ثم دخلوا في مسائل العقيدة، فكفروا علياً لأنه قبل التحكيم، كفروا مسلمين كثيراً بخطأ في الراي، حتى ولو كان هذا الخطأ من وجهة نظرهم وحدهم. وقتلوا مسلمين لهم ماض في الدعوة والجهاد بحجة الكفر لأنهم لم يكفروا علياً ولم يجحدوا التحكيم.
وقد جعلوا إقناع الناس بآرائهم أمراً جبرياً، إن لم يقتنعوا قتلوا.
ومضوا على ذلك يسنون تشريعات بعضها يحرم التزاوج من فئات من المسلمين وبعضها يضع الصغائر في مقام الكبائر، إلى غير ذلك من النزعات التشددية التي لا تفسير لها، إلاّ تلك البداية المريبة التي بدأوا بها خروجهم.
ومع ذلك فأهم ما دعوا إليه هو انتخاب الإمام انتخاباً حراً.
أما التشدد في الدين فلم يكن من بينهم من يستطيع الزعم بأنه أنصح إسلاماً من علي بن أبي طالب أو من زملاء كفاحه.
ونقطة غريبة أخرى، هي أنهم لم يولوا القضية الاجتماعية انتباهاً كبيراً، وفيما عدا شذرات هنا وهناك لا نستطيع أن نجد منهجاً واضحاً في علاج المشكلة الاجتماعية هذا المنهج الذي كان أوضح ما يكون لدى الإمام المقتول، وكان أساس كفاحه.
إن الخوارج فرق دفعت إلى التعصب الأعمى والانغلاق ولدت أول ما ولدت في ظروف الجمود، وقد ولدت ولادة تدعو إلى الريبة، وتلصق برجالها تهم الخيانة لو استبعدنا العمد لقضية العدل الاجتماعي حين خذلوا القيادة الثورية الحقة، وقاتلوها وهي تقاتل قوى الثورة المضادة.
أحمد عباس صالح
الفكر الاجتماعي
لعلي بن أبي طالب (ع)
لا نعتقد أن بالإمكان دراسة الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب، ولا تقييم الجانب الثوري في هذا الفكر، إلاَّ في ضوء الوضع الاجتماعي لهذا الإمام، وهو الوضع الاجتماعي الوثيق الصلة بوضع الهاشميين الاجتماعي، قياساً إلى أوضاع غيرهم من «البطون»([200]) العشرة التي تتكون منها قبيلة قريش، أي الأوضاع الاجتماعية لهذه «البطون».. لا بعد الإسلام فحسب، بل وقبيل ظهوره، ذلك أننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن الأوضاع الاجتماعية لهذه «البطون» كانت ذات تأثير كبير في موقفها من دعوة الإسلام، بمحتواها الاجتماعي المتقدم والمتعاطف مع الفقراء والعبيد وضحايا الربا الفاحش، وكل المستضعفين في الأرض، أي مع الجماهير التي أراد الإسلام لهم أن يكونوا هم الأئمة وهم الوارثون. كانت المواقف الاجتماعية «لبطون» قريش العشرة ذات تأثير كبير على موقفها من الإسلام، وأيضاً كانت لها تأثيرات هامة على صراعات السلطة التي ظهرت بعد وفاة الرسول (ص)، من حول منصب الخلافة والإمامة، ومن ثم كانت لها تأثيرات على موقف ممثلي هذه «البطون» من علي بن أبي طالب، وتوليه منصب الخلافة، وأيضاً على موقفه الاجتماعي إزاء الثروات التي حازها ممثلو هذه «البطون»، والمناصب التي تولوها، والتغييرات الاجتماعية التي أراد إحداثها عندما آلت إليه السلطة بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان.
ولما كان هذا الموضوع كبيراً، وتلزم للإحاطة بمعالمه الرئيسية دراسة هامة وكبيرة ومقصورة عليه ـ وهو ما يخرج عن موضوعنا وإطار بحثنا ـ فإننا نكتفي هنا بتقديم لمحة تكشف الفكرة التي نرى أن بحثها وتحديدها أمر ضروري لفهم الأساس المادي الواقعي للفكر الاجتماعي والثوري عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذه اللمحة تتمثل في رؤيتنا للسلطة العليا التي كانت تتربع على قمة النظام السياسي في شبه الجزيرة العربية عندما ظهر الإسلام في مكة.. أي ـ بتعبيرنا المعاصر ـ الحكومة القرشية التي اعترف العرب في شبه الجزيرة بتميزها وسيادتها.. وهي الحكومة التي احتكرت مناصبها ومسؤوليتها وميزاتها البطون العشرة لقبيلة قريش.. أين كان الفرع الهاشمي ـ فرع الرسول وعلي بن أبي طالب ـ من هذه الحكومة؟.. وما وزن المسؤولية التي كان يتولاها إذا ما قيست بالمسؤوليات الأخرى التي كانت تحتكرها باقي «البطون»؟.. وهو الأمر الذي يعكس الوضع الاجتماعي للفرع الهاشمي، ومن ثم يلقي الضوء على طبيعة الفكر الاجتماعي الذي ساد في صفوف أبناء هذا الفرع، لدى الرسول، ممثلاً في الفكر الاجتماعي المتقدم، ولدى علي بن أبي طالب، وهو الموضوع الذي نعقد له هذه الصفحات.
حكومة العرب قبل الإسلام
كانت هذه الحكومة تتألف من عشرة «وزارة» ـ إذا استعملنا تجاوزاً مصطلحات عصرنا، مع اعترافنا بالفوارق الكبيرة في المضامين ـ يمثل كل وزير منهم بطناً من «البطون» العشرة التي تتكون منها قبيلة قريش.. وأهم من ذلك فإن التغييرات التي كانت تصيب هذه المناصب كانت منحصرة في تغيير الأشخاص، أما اختصاص بمسؤولية محددة أي «وزراء» محددة، فكان أمراً مستقراً ودائماً، لأنه مرتبط بوزن كل «بطن» من هذه البطون من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والحربية في محيط القبيلة القرشية العام.
لقد كانت قريش تتألف من عشرة «بطون» هي:
1 ـ هاشم: وكان يمثله في الحكومة «العباس بن عبدالمطلب» الذي كان يتولى منصب «سقاية الحجاج» الذين يحجون إلى الكعبة قبل الإسلام.. أي توفير الماء اللازم لشربهم، والإشراف على توزيعه.
2 ـ أمية: وكان يمثله في الحكومة «أبو سفيان بن حرب»، وكانت مسؤوليته فيها هي القيادة الحربية لجيوش قريش في القتال إذ كان عنده راية قريش المسماة «العقاب».
3 ـ نوفل: وكان يمثله في الحكومة «الحارث بن عامر»، وكانت مسؤوليته القيام على الأموال التي ترصدها قريش لإنفاقات موسم الحج، والتي يسمونها: «الرفادة».
4 ـ عبدالدار: وكان يمثله في الحكومة «عثمان بن طلحة»، وكانت مسؤولياته مرتبطة بالكعبة له سدانتها وحجابتها، والقيام على دار الندوة، التي كانت يومئذٍ بمثابة البرلمان.
5 ـ أسد: وكان يمثله في الحكومة «يزيد بن زمعة بن الأسود»، وكانت مسؤوليته فيها «المشورة»، إذ كان المرجع في الأمور المشكلة على هذه البطون.
6 ـ تيم: وكان يمثله في الحكومة «عبد الكعبة ـ أو عبدالله ـ بن عثمان»، أي «أبو بكر الصديق» ـ كما اشتهر اسمه بعد ذلك ـ وكانت مسؤوليته فيها تقدير الديات والمغارم التي تلزم قريشاً والتعهد بأدائها وتنظيم ذلك، وكانوا يسمون هذه المسؤولية: «الأشناق».
7 ـ مخزوم: وكان يمثله في الحكومة «خالد بن الوليد»، وكانت مسؤوليته فيها القيام على الأموال المخصصة للحرب والقتال، وكذلك قيادة الخيل والفرسان في الحرب وكانوا يسمون هذه المسؤولية «القبة والأعنة».
8 ـ عدي: وكان يمثله في الحكومة «عمر بن الخطاب» وكانت مسؤوليته فيها شبيهة بمسؤولية وزير الخارجية، وكانوا يسمونها يومئذٍ «السفارة».
9 ـ جمح: وكان يمثله في الحكومة «صفوان بن أمية»، وكان مسؤولاً عن «الأيسار والأزلام» يذهب القوم إليه كي يديرها ويستشيرها قبل إقدامهم على مهمات الأمور.
10 ـ سهم: وكان يمثله في الحكومة «الحارث بن قيس»، وكانت مسؤوليته «الحكومة»، أي التحكيم، وكذلك القيام على الأموال الموقوفة على الآلهة التي يعبدونها..
كانت هذه هي حكومة قريش، التي مثلت أعلى سلطة عربية عرفتها هذه البقعة من شبه الجزيرة العربية عندما ظهر الإسلام..
أين بنو هاشم من هذا البناء؟:
وإذا كانت هذه هي المسؤوليات الأساسية التي عرفتها حكومة قريش، والتي توزعتها «بطونها» حسب الوزن المادي والمالي والقتالي الذي اجتمع لكل «بطن» من «بطونها»، فإننا نستطيع أن نقول: إن الفرع الهاشمي من قريش لم يكن يمسك بمسؤولية من المسؤوليات الهامة ـ مادياً واقتصادياً وحربياً ـ في تلك الحكومة، وأن مسؤولية «سقاية الحجاج» في موسم حجهم لا تنهض كي توازي المسؤوليات الأخرى التي كان يقبض أصحابها على رايات القتال أو ميزانياته، أو أموال المغارم والديات، أو السفارة إلى الخارج حيث البلاطات والعروش في القيصرية الرومانية والكسروية الفارسية.. إلخ.. إلخ..
كان الهاشميون فقراء، ومن ثم فلم تكن لهم المسؤوليات الهامة ولا الخطيرة في حكومة الأغنياء حكومة ملأ قريش وتجارها وملاك قوافل تجارتها وعبيدها.
وعلى هذه الحقيقة، ذات الدلالة الهامة في موضوعنا، تأتي الدلالة والشواهد الكثيرة، والتي نكتفي هنا ببعضها، من مثل:
1 ـ عندما أخذ الرسول الهاشمي يدعو بطون قريش، بمكة في بداية الإسلام، إلى تعاليمه، انطلقوا يعارضونه من منطلق طبقي صريح وواضح لا لبس فيه. فلقد كانوا يرون في دعوته تلك طموحاً سياسياً واجتماعياً للقيادة، ولبناء مجتمع جديد، وكانوا يرون كذلك ـ وهو الأهم ـ أن انتساب محمد إلى الفرع الهاشمي الفقير في قريش يجعله غير جدير بتولي هذا المكان القيادي، وتساءلوا من هذا المنطلق الطبقي: أليس الأحق بذلك غني من الأغنياء في شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد أحد العظماء فيها، وخاصة: عظيم مكة «الوليد بن المغيرة» وعظيم الطائف «عروة بن مسعود الثقفي»؟!
ولقد ردَّ القرآن الكريم على هذا التساؤل الجاهلي بتقرير حقيقة اجتماعية ثورية وهامة، تقول: إن هذا التمايز الطبقي الذي تؤمنون به، وتجتهدون للمحافظة عليه، وتريدون النبوة لعظيم من العظماء الذين اكتسبوا العظمة بمعاييره ومقاييسه، إن هذا النظام ليس ميزة تستحق المدح والتمسك بها، بل هو سلبية من سلبيات الحياة الاجتماعية، وبلاء أصاب الناس، وما ثمرته إلا تسخير بعض الناس للبعض الآخر، ومن ثم فإن ميزاته وامتيازاته لا تصلح معياراً على أساسه يختار الله من يختار لدينه الجديد.
جاء هذا التساؤل الجاهلي، ووقع عليه ذلك الرد القرآني في سورة الزخرف، المكية، في آياتها التي تقول: ﴿وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ؟..﴾ ثم استنكر القرآن تساؤلهم ذلك فقال: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ؟﴾ ثم حدثهم عن واقع مجتمعهم الطبقي، وكيف أن قسمة الأموال فيه، وما هي عليه من امتيازات للبعض دون البعض، إنما تمثل واقعاً يائساً أثمر إذلال بعضهم للبعض الآخر، فقال: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيَّاً﴾ ثم حدثهم عن ذلك الدين الجديد، ونبيه، وما يناضل المسلمون من أجل بنائه، وكيف أنه أفضل من ذلك الواقع السيء والمنهار الذي يتمسكون به، فقال: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾([201]).
فهو إذن منطق طبقي، كان يحتج أصحابه على دعوة الإسلام، لا بنقدها ونقض جوهرها، وإنما بأن الداعي إليها من الفرع الفقير في قريش، وليس من طبقة الأغنياء والموسرين.
2 ـ كان في مقدمة الأسلحة التي استخدمها أغنياء قريش ضد المسلمين، سلاح المقاطعة الاقتصادية عندما كتبوا وثيقة بهذه المقاطعة، وأودعوها في جوف الكعبة، كي تكون لها الحرمة والقداسة لا ينقضها بطن من البطون، وتم عزل المسلمين، اقتصادياً واجتماعياً، في «شعب بني هاشم»، لا يبيعهم أحد طعاماً ولا شراباً ولا لباساً، حتى اضطرَّ الكثير منهم إلى الهجرة للحبشة إلى أن يحين فك ذلك الحصار.. ولو كان الهاشميون أغنياء، ولو كان الذين انخرطوا في الدين الجديد موسورين لما كان هذا الحصار ولا تلك المقاطعة سلاحاً مؤثراً، ولكن الملأ من قريش قد استغلوا فقر أنصار الدين الجديد كي يوجعوهم بهذه المقاطعة وذلك الحصار..
3 ـ وكما لم ير القرآن في فقر الرسول عيباً ولا منقصة، كذلك لم ير في فقر الذين أسلموا عيباً ولا منقصة للدين الجديد، بل لقد أبصر في ذلك ميزة وأمراً طبيعياً يتفق مع موقف العداء الذي يتخذه هذا الدين من النظام الاجتماعي الظالم الذي كان سائداً في ذلك الحين.. وحاول القرآن كثيراً أن يبصر أعداء الدعوة الجديدة بأن منطقهم الطبقي هذا ليس جديداً، فلقد تبنَّاه من قبل كل الذين أبصروا المخاطر من التغييرات الجديدة على مصالحهم التي حازوها بالاستغلال، ورغم ذلك فإن تيار التغير الاجتماعي الذي تبشر به الدعوة الجديدة سينتصر كما انتصر من قبل عبر التاريخ.. قال القرآن ذلك لأغنياء قريش، وذكر لهم أمثلة من التاريخ لعلهم يتذكرون.. فقصَّ عليهم موقف أسلافهم من أغنياء قوم نوح عندما اعترضوا على دعوته لأن جمهور الذين اعتنقوها هم من الفقراء والعامة، لا من السادة والصفوة والأغنياء. فقال حاكياً قول أغنياء قوم نوح عندما قالوا له: ﴿قَالُواْ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ؟!﴾([202]).
وقال المفسرون: إن مرادهم «بالأرذلين» هم العامة والفقراء «الأقلون جاهاً ومالاً»([203]).. وحكى القرآن، في موطن آخر، قول هؤلاء القوم، الصادر من منطقهم الطبقي، عندما قالوا لنوح: ﴿مَا نَرَاكَ إلاَّ بَشَراً مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا..﴾([204]).
كما تحدث القرآن إلى أغنياء قريش عن إرادة أخرى، غير إرادتهم تنطلق من منطق آخر غير منطقهم الطبقي، وتريد أن تحل في المجتمع مقاييس جديدة هي على العكس تماماً من مقاييسهم، فإذا كانوا يريدون السيادة والقيادة لعظيم من العظماء والأغنياء، فإن إرادة الله تريد العكس، أن تكون السيادة والقيادة لهؤلاء الفقراء المؤمنين.. وإن هذه الإرادة هي التي ستنتصر، لأنها هي التي انتصرت عبر التاريخ، فمنطقهم الطبقي هو منطق فرعون، أما منطق القرآن وإرادة المؤمنين به فإنها تسترشد بعبرة التاريخ التي تمثلت في قول القرآن، وهو يتحدث عن رفض منطق فرعون الطبقي، عندما قرر قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾([205]).
4 ـ بل لقد كانت معركة الإسلام الرئيسية ضد قريش، حاربوا أنصاره بمكة، وعندما أراد الرسول عرض الإسلام على القبائل الأخرى أقاموا من حوله الحصار والمواقع والعقبات.. وعندما هاجر إلى المدينة غزوة فيها وحاربوه. وعندما تمكن من الانتصار عليهم وتطويعهم لسلطانه التحق كثير منهم بصفوفه لأنه لم يعد أمامهم إلاَّ الاختيار بين الإسلام وبين السيف؟!. كان هذا موقف قريش من الدعوة الجديدة، وموقف الدعوة الجديدة من مصالح أغنياء قريش، والمرة الوحيدة التي ذكر فيها لفظ «قريش» في القرآن كان ذكره في معرض الإنكار عليهم إعراضهم عن الدين الجديد بينما هم يتمتعون ويرتعون في نعيم الله الذي وفَّر لهم مال التجارة والأمن من الأعداء ﴿لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ * إِلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفِ﴾([206]).
فهو إذن منطق جديد، وثوري ينتصر به القرآن للعامة والجمهور والمجموع، ويعلن أن السيادة والقيادة لهم، وأن لهم الإمامة، ولهم ميراث طيبات هذه الحياة..
وكل ذلك ـ وغيره أكثر منه ـ يؤكد أن الفرع الهاشمي الذي انبعثت منه أنوار الدعوة الجديدة لم يكن الأكثر مالاً ولا الأعلى نفوذاً ولا الأقوى سلطاناً في مجتمع مكة عندما ظهر الإسلام.. وإن وضعه الاجتماعي هذا كان مصدراً هاماً لمعارضة الأغنياء لتلك الدعوة الثورية الجديدة ووقوفهم ضدها وضد تأثيراتها الاجتماعية على ثرائهم ونفوذهم..
ما بعد الرسول:
ولكن الصراع السياسي والعسكري والاجتماعي والفكري قد انتهى، في شبه الجزيرة العربية، بانتصار الدين الجديد، وتوحدت هذه المنطقة تحت رايات الإسلام، وخضعت لسلطان نبي من بني هاشم، الفرع الفقير في قريش، والذي لم يكن سلطانه ملحوظاً في حكومتها قبل الإسلام… وترتبت على ذلك تغييرات اجتماعية جعلت من العبيد والرعاة والفقراء قادة يقودون الحروب، ويؤمون الناس في الصلاة ويجلسون للفصل في المنازعات كقضاة، ويتولون الإمرة على الأقاليم، ويروي الناس عنهم الأحاديث ويلتمسون عندهم علم الدين الجديد.. حدث ذلك وغيره من الآثار الاجتماعية الجديدة والثورية، التي ليس هنا مكان الحديث عنها في هذه الصفحات.
ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام.. وكان أبرز أبناء الفرع الهاشمي عندئذٍ علي بن أبي طالب، الذي كان يطمح إلى منصب خلافة الرسول، والذي كان يرى في نفسه ويرى فيه عدد من الصحابة، أو من فقراء الصحابة إذا شئنا الدقَّة، الضمانة الأساسية لاستمرار المنهج الاجتماعي الذي شهدته شبه الجزيرة على يد دعاة الإسلام، وأيضاً الضمانة الأساسية كي لا يعود ملأ قريش وأغنيائها، الذين التحقوا بالإسلام عندما لم يجدوا طريقاً لمقاومته، أن لا يعودوا للإمساك بالسلطة والسلطان من جديد تحت رايات الدين الجديد وأعلامه؟!…
كان علي يطمح إلى ذلك، وتؤهله لهذا الطموح مؤهلات كثيرة، ليس مكان الحديث عنها في هذه الصفحات. ولكن قريشاً ـ نعم قريش ـ كانت بالمرصاد، فاجتمع رؤساؤها واختاروا أبا بكر الصديق، ـ وكان قبل الإسلام وزيراً في حكومتها، يتولى فيها منصباً هاماً ـ ومن بعده كان العهد إلى عمر بن الخطاب ـ وكان هو الآخر وزيراً في حكومة ما قبل الإسلام، يتولى سفاراتها الخارجية ـ ومن بعده عهد رؤوس قريش بالأمر إلى عثمان بن عفان ـ هو من بطن أمية ذي السلطان العالي في حكومة قريش الجاهلية ـ بينما استبعد، حتى ذلك التاريخ، علي بن أبي طالب، أبرز ممثلي الفرع الهاشمي في ذلك التاريخ.
ولقد قالها عمر بن الخطاب صراحة لعبد الله بن عباس، عندما حدَّثه عن أن قريشاً قد قررت أن لا تعطي السلطة للهاشميين بعد وفاة الرسول، فكفى الهاشميين شرف النبوة الروحي والمعني؟! أما السلطان السياسي والمادي والدنيوي فلقد آثرت به قريش من كانوا يتولونه قبل الإسلام؟!.. قال عمر لعبد الله بن عباس: «إن الناس قد كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة، وأن قريشاً اختارت لنفسها فأصابت!!».
ونحن نعتقد أن الملأ من قريش، الذين مالوا بالخلافة عن علي بن أبي طالب، إنما كانوا يخشون من علي نهجاً اجتماعياً ثورياً ومتقدماً ـ أو على الأقل كان هذا موقف نفر غير قليل منهم، لا يكنون له المحبة ولا الولاء ـ ونعتقد كذلك أن هذا التيار القرشي القديم الذي يمثله هذا النفر من الأغنياء، ومن سار في طريقهم، قد حققوا مطامحهم الاجتماعية، على حساب التعاليم الاجتماعية الثورية التي بشَّر بها الإسلام، وعلى حساب جماهير الفقراء، عندما تولى الخلافة عثمان بن عفان.. فلقد حدثت يومئذٍ التحولات الاجتماعية التي عارضها علي وأنصاره، والتي استفاد منها أغنياء قريش القدامى، ومن سار في طريقهم الاجتماعي، وهي التحولات التي ثار عليها الناس حتى بلغوا في ثورتهم حد قتل عثمان ثم فرضوا على بقايا رؤوس قريش مبايعة علي بالخلافة كي يقوم بالتغيير لما وقع في ظل حكم عثمان بن عفان.
وحتى نصل إلى الحديث عن التغييرات والأفكار الاجتماعية عند علي بن أبي طالب، لا بدَّ لنا من رؤية تلك الأوضاع الاجتماعية التي استحدثها الناس على عهد عثمان، لأنها هي التي تفسر لنا الثورة عليها وفي ضوئها يمكن لنا أن نرى فكر علي بن أبي طالب الاجتماعي في حجمه الطبيعي وصورته الحقيقية.
التحولات الاجتماعية في عهد عثمان
لقد حدثت بالفعل تحولات اجتماعية في عهد عثمان بن عفان([207]) لم تكن موجودة في عهد البعثة ولا في زمن أبي بكر وعمر، ففي عهد الرسول، لم تكن الفتوحات الكبرى قد حدثت بعد، ومن ثم فإن ثروة المجتمع لم تكن ذات وزن كبير، حتى أن الدولة العربية الإسلامية التي قامت يومئذٍ لم تعرف نظاماً مستقراً ومقنناً لماليتها من حيث الضبط والتنظيم للواردات والمصروفات.. ولم يختلف الحال كثيراً في عهد أبي بكر الصديق، لا من حيث الحدود التي امتدت إليها الفتوحات، تقريباً، ولا من حيث ثروة الدولة، بل لقد تأثّرت بالانقسامات التي حدثت على سلطة أبي بكر القائمة في «المدينة»، واستنفذت منها الحروب التي سميت «بحروب الردة» قدراً كبيراً من الجهد والنفقات، حتى أن بيت المال ـ (خزانة الدولة) ـ عند وفاة أبي بكر، لم يكن به سوى دينار واحد قد سقط وتخلف بطريق الخطأ والنسيان!!.
وفي عهد عمر بن الخطاب امتدت فتوحات الدولة حتى شملت المجتمعات الغنية الثلاثة التي كانت أهم مصادر للثروة في الإمبراطورية العربية: مصر والشام والعراق. وجاءت إلى عاصمة الدولة كنوز القياصرة والأكاسرة، وفيها أكوام من التحف والعملات الذهبية التي ذهل لمرآها كثيرون من الصحابة.
وجاهد كثير من الناس لاقتناء الثروة وبناء الدور المريحة.
ولقد كان الفرع الأموي، من قريش، في مقدمة الذين استفادوا من هذا التطور الاجتماعي الجديد.
بل يبدو أن الفرع الأموي، بزعامة أبي سفيان، قد رأى في تولي عثمان الخلافة فرصة طالما انتظروها كي تعود لهم المكانة الأولى التي فقدوها منذ ظهور الإسلام على يد محمد بن عبدا الله، من الفرع الهاشمي الفقير من بني عبد مناف.. ولقد ذكر عمار بن ياسر أنه قد حدث «عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان، ودخل داره، ومعه بنو أمية» إن قال لهم أبو سفيان، وكان قد كفَّ بصره: «أفيكم أحد من غيركم؟.. قالوا: لا.. قال: يا بني أمية، تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان، ما زلت أرجوها لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة!! فانتهره عثمان، وساءه ما قال، ونمي هذا القول إلى المهاجرين والأنصار؟!..»([208]) فهو إذاً انقلاب سياسي قد حدث، طالما رجاه وانتظره أبو سفيان وبنو أمية، وهي إذاً بداية حقبة من الحكم يعدون أنفسهم لتلقفه كالكرة حتى يصير ملكاً وراثياً يتولاه الصبيان. لقد سنحت لهم الفرصة، ورأوا في شخصية عثمان المناخ المناسب كي يحققوا ما يريدون.. ولذلك كان حكم هذا الخليفة بداية لأحداث وتطورات استحدثت في الحياة الاجتماعية الإسلامية، سعى إليها البعض، واغتنمها البعض، وناضل ضدها البعض الآخر.. ومن ثم كانت الصراعات التي برز فيها حزب علي بن أبي طالب، وكانت «الفتنة» ـ (الثورة) ـ التي شهدها آخر عهد عثمان بن عفان.
فلقد انتشر كثير من الصحابة، في الأمصار، وأقطعهم عثمان مساحات من الأرض التي كانت ملكية عامة لبيت مال المسلمين، فوزعت عليهم الأرض التي سبق أن صودرت لحساب بيت المال، والتي كانت مملوكة لكسرى وقيصر والأمراء والقواد الذين حاربوا ضد الفتح الإسلامي لهذه البلاد، وهي التي كانت تسمى أرض «الصوافي»، وكان دخلها على عهد عثمان 50,000,000 درهم، كما كان عثمان أول من أقطع أرض العراق([209]).
وتغير حال العمال والولاة، فاستخدم عثمان الكثير من أقربائه، وحتى الذين كانوا يعملون على عهد عمر لم يعودوا يخشون شدة عمر، واستبدوا بالأمر من دون عثمان.. ومن حديث لعلي بن أبي طالب، عشية الثورة على عثمان، يعيب عليه فيه ضعفه إزاء الولاة والعمَّال، يقول له فيه: «إن عمر كان يطأ على صماخ من ولي ـ إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى العقوبة وأنت لا تفعل.. ضعفت ورققت على أقربائك» وعندما يقول له عثمان: «وهم أقرباؤك أيضاً»؟! يقول له علي: «أجل.. إن رحمهم مني لقريبة، ولكن الفضل في غيرهم» وعندما يعترض عثمان ويحتج بأنه قد ولى معاوية بعد أن ولاَّه عمر من قبل، يرد علي قائلاً: «أنشدك الله!! هل تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من (يرفأ)، غلام عمر له؟!» أما الآن «فإن معاوية يقتطع الأمور دونك ويقول للناس: هذا أمر عثمان، وأنت تعلم ذلك فلا تغير عليه؟!»([210]).
وانعكست هذه التطورات السياسية والإدارية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى عدد كبير من الولاة والصحابة والعمال. فسعيد بن العاص، والي عثمان على الكوفة، يسير في الناس سيرة منكرة، ويستبد بالأموال دونهم، ويقول عن أرض العراق: إنها بستان قريش؟!.. فيعترض عليه مالك الأشتر بن الحارث النخعي، قائلاً: «أتجعل ما أفاء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا بستاناً لك ولقومك؟!»([211]) يحدث هذا مع سعيد بن العاص ـ الأموي ـ رغم أنه قد ولي هذا المنصب كي يصلح ما أفسده الوالي السابق الوليد بن عقبة الذي استبدَّ وفسق وفجر. وفي هذه السيطرة القرشية المستبدة يقول أحد الشعراء الكوفيين:
| فررت من الوليد إلى سعيد | كأهل الحجر إذ فزعوا فباروا | |
| يلينا من قريش كل عام | أمير محدث أو مستشار | |
| لنا نار تحرقنا فنخشى | وليس لهم ولا يخشون نار([212]) |
وتتبدى مظاهر الثراء والبذخ على عدد كبير من الصحابة، فالزبير بن العوام يبني له عدة دور ضخمة فخمة بالبصرة والكوفة، ومصر، والإسكندرية، وعندما تحضره الوفاة يحصون في ثروته 50,100 دينار، وألف فرس، وألفاً من العبيد والإماء.. إلخ([213])..
وطلحة بن عبيدالله التميمي يبتني لنفسه هو الآخر إحدى الدور الفخمة بالكوفة، وأخرى بالمدينة يشيدها «بالآجر والجص والساج، ويبلغ دخله من ممتلكاته بالعراق وحدها ألف دينار في اليوم الواحد؟ «وقيل أكثر من ذلك، وبناحية (الشراة) أكثر مما ذكرنا»([214])!!
ـ وعبدالرحمن بن عوف الزهري، تصبح ثروته مضرب الأمثال «فعلى مربطه مائة فرس، وله ألف بعير، وعشرة آلاف شاة من الغنم» وعندما توفي قدرت ثروته أكثر من مليونين ونصف من الدراهم ولقد بلغ حجم القدر الذي أحضر منها إلى عثمان بن عفان في «البدر» و«الأكياس» قدراً من العظم جعله يحجب رؤية عثمان عن الرجل الواقف أمامه؟!»([215]).
ويذكر سعيد بن المسيب أن في ثروة زيد بن ثابت ـ وكان من المدافعين عن عثمان حين ثار الناس ما كان يكسر بالفؤس، غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار؟!»([216]).
أما يعلي بن منية فإنه يخلف في تركته 500,000 دينار، تضاف إليها عقارات وديون له على الناس تقوم بمبلغ 300,000 دينار([217])؟!.
ويشيع في المدينة بناء الدور الفخمة الحديثة، ويتخذون لها الأماكن الجميلة في «الضواحي». فعلى بعد أميال من المدينة يبني «المقداد» بـ«الجرف» داراً «مجصصة الظاهر والباطن» ويجعل في «أعلاها شرفات»([218]) ويصنع مثله بـ«العقيق» «سعد بن أبي وقاص»([219]).
ونشهد مصادر التاريخ الإسلامي المعتمدة تسجل على هذا العهد ـ وللمرة الأولى ـ بوادر فكر نظري يجتهد كي يبرر للخليفة والحاكم التمتع بالأموال العامة الخاصة ببيت مال المسلمين.. فيروي «الزبير بن بكار» في كتابه (الموفقيات) عن ابن عباس قوله: «لما بنى عثمان داره بالمدينة أكثر الناس عليه في ذلك، فبلغه، فخطبنا.. فقال: أتانا عن أناس منكم أنهم يقولون: أخذ فيئنا، وأنفق شيئنا، واستأثر بأموالنا.. مالي ولفيئكم وأخذ مالكم؟! ألست من أكثر قريش مالاً؟!.. وهبوني بنيت منزلاً من بيت المال، أليس هو لي ولكم؟!! ألم أقم أموركم، وأني من وراء حاجاتكم؟!. فلم لا أصنع في الفضل ـ (الزيادة عن حاجات الناس) ـ ما أحببت؟ فلم كنت إماماً إذاً؟!.. فما لي لا أفعل في فضول الأموال ما أشاء؟!»([220]).
كما تتحدث مصادر التاريخ هذه عن استخدام بنات عثمان وتمتعهن بالحلي المملوك لبيت المال فيروي الزبير بن بكار عن «الزهري» قوله: «لما أتي عمر بجوهر كسرى، وضع في المسجد، فطلعت عليه الشمس فصار كالجمر» وأراد عمر أن يقسمه بين المسلمين، فقال له خازن بيت المال: (يا أمير المؤمنين إن قسمته بين المسلمين لم يسعهم ـ (لم يكفهم) ـ وليس أحد يشتريه، لأن ثمنه عظيم، ولكن تدعه إلى قابل ـ (تؤجله إلى العام القادم) ـ فعسى الله أن يفتح على المسلمين بمال فيشتريه منهم من يشتريه). قال: ارفعه فأدخله بيت المال.. وقتل عمر وهو بحاله، فأخذه عثمان لما ولي الخلافة فحلى به بناته؟!..»([221]).
وتشهد الدولة الإسلامية أول خليفة من خلفائها يترك عند مماته ثروة طائلة، فيحصون لعثمان يوم مقتله «عند خازنه من المال خمسين ومائة ألف دينار (150,000) وألف ألف درهم (1,000,000) «وذلك غير قيمة «ضياعه بوادي القرى وحنين» تلك التي قدِّرت بمبلغ 100,000 دينار هذا عدا الخيل والإبل، وغيرها من الممتلكات والمقتنيات([222]).
ونحن نود ـ قبل أن ننتقل للحديث عن أثر هذه التحولات المستحدثة في المجتمع الإسلامي ـ أن ننبه إلى أن صحبة هؤلاء الرجال لرسول الله (ص)، وسبق الكثير منهم إلى الإسلام، وبلاءهم الحسن في نشر الإسلام وإقامة دعوته، لم يكن له أن يمنع سعيهم هذا الذي حدث في سبيل الدنيا، لأن النفس البشرية عندما تتاح لها الفرصة لذلك، دونما مانع من القانون ورادع من النظام، فقلَّما تحجم عن السعي في هذا الطريق. وهذه الموانع قد زالت، أو كادت، ومن ثم استباح الكثيرون لأنفسهم واستحلوا هذا النمط من أنماط الحياة.. ولقد كانت للقوم شبهة حل تجعل لهم هذا الأمر مباحاً لا حرج عليهم فيه.. يشهد لذلك قول عثمان بن عفان عن عبدالرحمن بن عوف، عندما أحضرت له بعض أكياس دنانيره ودراهمه، بعد وفاته: «إني لأرجو لعبدالرحمن خيراً، لأنه كان يتصدق، ويقري الضيف، وترك ما ترون»([223]). أي أنه قد كانت هناك «وجهة نظر» تمثل موقفاً فكرياً يرى أنه لا حرج على الناس ولا على ضمائرهم من السعي في هذا السبيل، وأن التقوى والإيمان لن ينقص منهما جمع الأموال، بشرط أن يتصدق أصحابها ويكرموا الضيوف ويبذلوا منها قدراً معلوماً في بعض وجوه «البر والإحسان».
بل لقد حدث أن استباح البعض ما حرمه الرسول على سبيل القطع في هذا الميدان.. وفي (صحيح مسلم) نقرأ هذا الحديث الشاهد لما نقول: «حدثنا عبدالله بن مسلمة، ابن قعنب، حدثنا سليمان ـ يعني ابن بلال ـ عن يحيى ـ وهو ابن سعيد ـ قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمراً قال: قال رسول الله (ص): «من احتكر فهو خاطىء». فقيل لسعيد فإنك تحتكر! قال سعيد: إن معمراً، الذي كان يحدث هذا الحديث، كان يحتكر»؟!!([224]).. فما بالنا باستحداث أمور كانت للبعض فيها شبهة حل؟! ولم يكن في صف الذين أنكروها وحاربوها سوى سلاح الاجتهاد في تفسير النصوص، وقياس الأمر على كليات التعاليم وروح الشريعة الغرَّاء؟!..
وعلى أي الوجوه قلبنا الأمر، فلقد أثمرت هذه التحولات التي شهدها عهد عثمان بن عفان مناخاً اجتماعياً ولَّدَ وشهد العديد من التناقضات والصراعات.. ومن الكلمات الجيدة التي تصف تلك الحالة الجديدة قول جمال الدين الأفغاني: أنه «في زمن قصير من خلافة عثمان، تغيرت الحالة الروحية في الأمة تغيراً محسوساً وأشد ما كان منها ظهوراً في سيرة وسير العمال والأمراء وذوي القربى من الخليفة، وأرباب الثروة بصورة صار يمكن معها الحس بوجود طبقة تدعى «أمراء» وطبقة «أشراف» وأخرى «أهل ثروة وثراء وبذخ»، وانفصل عن تلك الطبقات: طبقة العمال وأبناء المجاهدين، ومن كان على شاكلتهم من أرباب الحمية والسابقة في تأسيس الملك الإسلامي وفتوحاته، ونشر الدعوة، وصار يعوزهم المال الذي يتطلبه طرز الحياة، والذي أحدثته الحضارة الإسلامية، إذ كانوا مع كل جريهم وسعيهم وراء تدارك معاشهم لا يستطيعون اللحاق بالمنتمين إلى العمال ورجال الدولة. وقد فشت العزة والأثرة والاستطالة وترفرت مهيئآت الترف في حاشية الأمراء وأهل عصبيتهم، وفي العمال، وبمن استعملوه وولوه من الأعمال.. إلخ.. فنتج من مجموع تلك المظاهر التي أحدثها وجود الطبقات المتميزة عن طبقة العاملين والمستضعفين في المسلمين، تكون طبقة أخذت تتحسس بشيء من الظلم، وتتحفز للمطالبة بحقهم المكتسب من مورد النص، ومن سيرتي الخليفة الأول والثاني: أبي بكر وعمر»([225]).
علي يتصدى لتغيير هذا الواقع
ولقد كان صوت علي بن أبي طالب في مقدمة الأصوات التي ارتفعت بالنقد والمعارضة لهذه التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع العربي الإسلامي على عهد عثمان بن عفان بل لا نغالي إذا قلنا أن صوت معارضته ونقده كان أعلى هذه الأصوات.. ومن ثم فإن حركة المعارضة والنقد، ثم الثورة، ضد هذه الأوضاع الجديدة قد اتخذت من علي رمزاً لها، وقيادة تلتف من حولها، كي تمارس الضغط والنقد والتجريح لأصحاب المصلحة الحقيقية في هذه الأوضاع التي طرأت على المجتمع في ذلك الحين.
حدث ذلك حتى قبل مقتل عثمان ومبايعة علي بالخلافة.. ومن هنا كانت الوقائع والأحداث التي سجلتها لنا مصادر التاريخ تحكي علاقة علي بالثائرين على عثمان، وموقف علي من تصرفات عثمان.
* فعندما زحفت جموع الثائرين على ولاة عثمان والتغييرات الاجتماعية التي أحدثها.. عندما زحفوا من الولايات ـ مصر، العراق واليمن، والشام ـ على العاصمة ـ المدينة ـ يطلبون التغيير، ذهبت هذه الجموع إلى علي، وكلموه، وطلبوا منه أن يحمل مطالبهم إلى عثمان، ثم يأتيهم بالجواب، ويحكي علي وقائع مقابلته لعثمان عندما دخل عليه فقال له: «إن الناس ورائي، وقد استسفروني بينك وبينهم.. فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل.. وإن شر الناس عند الله إمام جائر. وإني أنشدك الله أن لا تكون إمام هذه الأمة المقتول.. الذي يفتح عليها القتل والقتال.. ويبث الفتن فيها.. فلا تكونن لمروان ـ (بن الحكم) ـ سَيِقة([226]) يسوقك حيث شاء!..».
فطلب عثمان من علي أن يؤجله الثائرون وقتاً من الزمن يغير فيه المظالم ويجيب فيه المطالب ويحقق الشكايات.. ولكن علياً رفض التأجيل، وطلب إليه التغيير الفوري لما بالمدينة من مظالم، أما مظالم الأقاليم فأجل تغييرها هو الأجل الذي تصل فيه أوامر الخليفة إلى هذه الأقاليم.. وبعبارة (نهج البلاغة): قال عثمان لعلي: «كلِّم الناس أن يؤجلوني حتى أخرج إليهم من مظالمهم، فقال له علي: ما كان بالمدينة فلا أجل فيه، وما غاب فأجله وصول أمرك إليه!..([227]).
* وفي لقاء آخر بين علي وعثمان ينتقد فيه علي عثمان لميله لبني أمية، وإطلاقه العنان لهم كي يستأثروا بخيرات الناس ويحتازوا حقوقهم، وينبهه إلى خروجه عن نهج الأمة الذي سار عليه أبو بكر وعمر، وينكر أن يكون عثمان ـ في نهجه ـ مساوياً لأبي بكر وعمر، فيقول:
«.. أما التسوية بينك وبينهما، فلست كأحدهما؟! إنهما وليا هذا الأمر فظلفا ـ (كفا) ـ أنفسهما وأهلهما عنه، وعمت فيه وقومك عوم السابح في اللجة.. فحتى متى، وإلى متى؟! ألا تنهي سفهاء بني أمية عن أعراض المسلمين وأبشارهم وأموالهم؟! والله ولو ظلم عامل من عمالك حيث تغرب الشمس لكان إثمه مشتركاً بينه وبينك!!»([228])..
* ويبدو أن عثمان قد ظنَّ أن وراء ثورة علي ومعارضته أسباباً يتصل بعضها بحرمانه من الثروة التي يرتع فيها الأمويون والملأ من أغنياء قريش، فاستدعاه يوماً وعرض عليه «صرتان من ورق ـ (فضة) ـ وذهب» وقال له: «دونك خذ من هذا حتى تملأ بطنك، فقد أحرقتني»؟!.. ولكن علياً رفض، وقال لعثمان: «إن كان هذا المال لك كنت أحد رجلين: أما آخذ واشكر، أو أوفر واجهد. وإن كان من مال الله، وفيه حق المسلمين واليتيم وابن السبيل، فوالله ما لك أن تعطينيه ولا لي أن آخذه!» فاحتد عثمان، وسكت علي، ثم عاد إلى منزله وقد عزم على مقاطعة عثمان، وقال: «الله بيني وبينك إن كنت أمرتك بمعروف أو نهيتك عن منكر!!»([229]).
* ومن هنا نستطيع أن نفهم موقف علي من الأحداث التي انتهت بقتل عثمان، وتقييمه لهذه الثورة التي هاجم رجالها منزل الخليفة حيث قتلوه وهو يقرأ القرآن بعد أن حاصروه زمناً طويلاً.. وليس أصدق في التعبير عن موقف علي من هذه الأحداث من قوله هو ذاته عندما يلخص القضية في هذه الكلمات: «.. إنه قد كان على الناس والٍ ـ (عثمان) ـ أحدث أحداثاً، وأوجد للناس مقالاً فقالوا، ثم نقموا فغيروا…»([230]).
أما عن حدث القتل ذاته، وعلاقته به، فإنه يتحدث عنه فيقول: «لو أمرت به لكنت قاتلاً، أو نهيت عنه لكنت ناصراً؟!» أي أنه لم يأمر به، ولم ينه عنه، لأنه لو نهى عنه لكان ناصراً لعثمان على ما أحدث من أحداث… ثم يقول: «وأنا جامع لكم أمره ـ (أمر عثمان) ـ: استأثر فأساء الأثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع، ولله حكم واقع في المستأثر والجازع»!([231]).
هذا عن الموقف من عثمان وما أحدث وأحدث الأمويون من تغييرات.
… وضد قريش
ونحن نعتقد أن موقف علي ضد الفرع الأموي من قريش إنما هو جزء في موقفه العام ضد ملأ قريش وأغنيائها، أولئك الذين ناصبوا الفرع الهاشمي العداء منذ ظهر الإسلام، وخاضوا ضده الحروب، ثم تربصوا ـ حينما هزموا ـ حتى انقضوا على دولة الدين الجديد تحت راياته وأعلامه مؤملين أن يسلبوا هذه التجربة الثورية الجديدة مضمونها الاجتماعي المتقدم الذي أراد به الرسول أن يجعل الذين استضعفوا في الأرض هم الأئمة والوارثين؟!. ولذلك فإننا نلتقي كثيراً في خطب علي وأحاديثه بالشكوى من «قريش».. فيقول مثلاً عندما اختاروا عثمان للخلافة بدلاً منه: «اللَّهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي، وصغروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمر هو لي»([232]).
وعندما بويع بالخلافة، وعقد له عهدها أولئك الذين ثاروا على عثمان وسلطان قريش، تصدَّت قريش لسلطانه، وتحركت من خلف الفرع الأموي، تحت حجة الطلب بدم عثمان.. وعن موقف قريش هذا يتحدث علي فيقول: «مالي ولقريش!! والله لقد قاتلتهم كافرين، ولأقاتلنهم مفتونين، وإني لصاحبهم بالأمس، كما أنا صاحبهم اليوم؟!»([233]).. ثم يكتب إلى أخيه عقيل بن أبي طالب فيقول: «… دع عنك قريشاً وتركاضهم([234]) في الضلال، وتجوالهم في الشقاق.. فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله قبلي…»([235]).
بل إن هذا العداء المستحكم بين الفرع الهاشمي ـ والممثل في علي يومئذٍ ـ وبين قريش، لم يكن إدراكه والحديث عنه مقصوراً على الهاشميين، فهذا عمر بن الخطاب يشخصه بدقة عندما يتحدث عنه إلى عبدالله بن العباس فيقول: «يا عبدالله، أنتم أهل رسول الله وآله وبنو عمه، فما تقول في منع قومكم منكم؟! قال (ابن عباس): لا أدري علتها، والله ما أضمرنا لهم إلاَّ خيراً.. قال (عمر): «… إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتذهبوا في السماء شمخاً وبذخاً.. ولعلكم تقولون: إن أبا بكر أول من أخَّركم.. أما أنه لم يقصد ذلك، ولكن حضر أمر لم يكن بحضرته أحزم مما فعل، ولولا رأي أبي بكر فيّ لجعل لكم من الأمر نصيباً، ولو فعل ما هنأكم قومكم. إنهم ينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره؟!»([236]).
نعم.. إلى هذا الحد بلغت صراحة عمر في التعبير عن العداء المستكن بين ملأ قريش، وبين الهاشميين، حتى لقد قرر أن العلاقة بينهما هي العلاقة بين الثور وجازره؟!. ذلك أن الهاشميين ـ تحت أعلام الإسلام وبواسطته ـ قد أدالوا دولة قريش الجاهلية، وكان سيف علي من أبرز السيوف التي طالما قطعت رقاب أشراف قريش الذين تصدوا لدعوة الإسلام ودولته في ساحات القتال..
العزم والإصرار على التغيير الاجتماعي
ولم يكن علي يخفي ـ حتى على عهد عثمان وقبل توليه الخلافة ـ عداءه للطبقة الجديدة التي احتازت الأموال، وعزمه الأكيد ـ إن هو تولى أمور المسلمين ـ على تغيير هذا الواقع الطبقي الجديد، والعودة إلى نظام المساواة الذي قرره الإسلام وطبقه الرسول ومن بعده أبو بكر.. ومن كلماته الشهيرة التي تعبر عن عزمه هذا قوله: «لو استوت قدماي من هذه المداحض ـ (المزالق) ـ لغيرت أشياء؟!»([237]).. وفي موقف آخر يبدي سخطه لاحتكار بني أمية لثروات الأمة، ويتوعدهم قائلاً: «والله لئن وليتها لأنفضنهم نفض اللحام الوذام التربة»([238])، أي لأزيلنهم كما يزيل عامل اللحام التراب عن الحديدة بواسطة النار؟؟!
وعندما تحقق ما أراد، وبايعه الناس بالخلافة، أعلن ما يمكن أن نسميه ـ بلغة عصرنا ـ الثورة الشاملة ضد الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي كانت محل نقده ومعارضته على عهد عثمان بن عفان.
1 ـ ففي السياسة: أعلن عزل عمال عثمان وولاته على الأقاليم. ولم يتراجع عن ذلك عندما نصح الناصحون وأشفق عليه المشفقون وهذا موقف شهير في كل كتب التاريخ لا يحتاج إلى تقديم الأدلة عليه ولا البراهين..
2 ـ وفي ميدان القطائع: كانت هناك الأرض التي جعلها عمر ملكاً خاصاً لبيت المال، ثم جاء عثمان فأقطعها لأوليائه وأعوانه وولاته وأهل بيته، وبصددها كان موقف علي حازماً وحاسماً.. فلقد ألغى تصرفات عثمان هذه، وقرر رد هذه الأرض إلى ملكية الدولة وحوزة بيت المال، ورفض أن يعترف أو يقر التغييرات «والتصرفات العقارية» التي حدثت في هذه الأرض، وقال عن هذا المال كلمته الحاسمة: «والله لو وجدته ـ (أي المال) ـ قد تزوج به النساء، وملك به الإماء، لرددته.. فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق!..».
ثم أعلن أن التمايز الطبقي الذي رفع من لا يستحق وخفض من لا يستحق قد جاء الوقت لتصفيته، وأن الحين قد حان لخفض الذين ارتفعوا ورفع الذين انخفضوا، فقال: والذي بعث محمداً بالحق أنه «لا بدَّ أن يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا؟!»([239])
3 ـ وفي ميدان العطاء: أحدث علي تغييراً ثورياً لعلَّه كان من أخطر التغييرات الثورية التي قرَّرها، والتي أراد بها العودة بالمجتمع إلى روح التجربة الثورية الإسلامية الأولى.. بل لعلَّ هذا التغيير أن يكون كذلك الموقف الذي جعل العديد من القوى والأطراف تجمع أمرها وتوحد صفوفها وتتصدى لمحاربته، لأنها قد رأت في موقفه هذا نذير خطر يهدد امتيازاتها الطبقية والاجتماعية بالزوال.
ذلك أن النظام الذي كان معمولاً به من عهد النبي (ص) فيما، يتعلق بالعطاء ـ والعطاء هو نظام قسمة الأموال العامة بين الناس، جنوداً كانوا أم غير جنود ـ كان قائماً على فلسفة التسوية بين الناس في قسمة الأموال بصرف النظر عن دور الفرد في النضال ـ سابقاً ـ مع الإسلام أو ضده، وبصرف النظر عن القبيلة العربية التي ينتمي إليها، وسواء أكان من أصل عربي أو كان من الموالي إلخ.. إلخ..
ولما جاء عمر بن الخطاب، ألغى نظام التسوية بين الناس في العطاء ثم حدد المعايير التي على أساسها يكون التمييز بين الناس في العطاء، فالسابقون إلى الإسلام، وقريش ثم الأقربون من قريش، يأتون في المقدمة ثم يكون الترتيب التنازلي في هذا الميدان..
ثم كان عهد عثمان الذي كرَّس القانون السابق ثم سار على دربه أشواطاً وأشواطاً.. حتى أصبح التمايز الطبقي نظاماً بشعاً، بلغت بشاعته حداً جعل الناس يثورون عليه، ثم انتهت ثورتهم بقتل عثمان وتولية علي أميراً على المؤمنين..
ومن هنا كان قرار علي العدول عن تمييز الناس في العطاء، والعودة إلى نظام المساواة قراراً من أخطر قراراته الثورية، لأنه كان يعني انقلاباً اجتماعياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات.. كما كان رد فعل الأغنياء ـ وفي مقدمتهم ملأ قريش وأبناؤهم ـ ضد علي وقراره هذا بداية الثورة المضادة ضد حكمه.
لقد كانت هناك فلسفة اجتماعية تقف خلف موقف علي هذا نستطيع أن نلمسها ونعيها إذا نحن أمعنَّا النظر في كلماته التي يقول فيها: «إن الله، سبحانه، فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلاَّ بما متِّع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك!»([240]).
فهو هناك يؤمن باشتراك الأمة في الثروة، ويقرر أن جوع الفقير مصدره وسببه احتجاز الغني الثروة التي خلقها الله كي يشبع بها هذا الفقير؟!.
* ولقد كان قرار علي التسوية بين الناس في العطاء من القرارات الأولى التي أصدرها عقب بيعته وجاء حديثه عنه في الخطبة التي خطبها في اليوم التالي لبيعته مباشرة، وهي الخطبة التي جاء فيها: «… ألا لا يقولن رجال منكم غداً قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار، وفجروا الأنهار، وركبوا الخيول الفارهة، واتخذوا الوصائف الروقة ـ (الحسان) ـ، فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً، إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه، وأصرتهم ـ (قيدتهم) ـ إلى حقوقهم التي يعلمون، فينقمون ذلك، ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا! ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته، فإن الفضل النير غداً عند الله، وثوابه وأجره على الله، وأيما رجل استجاب لله وللرسول، فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا، فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد الله، والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غداً أحسن الجزاء وأفضل الثواب، لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا ثواباً، وما عند الله خير للأبرار، وإذا كان غداً ـ إن شاء الله ـ فأغدوا علينا، فإن عندنا مالاً نقسمه فيكم، ولا يتخلفن أحد منكم، عربي ولا عجمي، كان من أهل العطاء أو لم يكن، إلاَّ حضر..».
فنحن هنا بإزاء موقف ثوري، اجتهد فيه علي لنفسه وللمسلمين، وبما أن الإسلام ـ ديناً وتشريعاً ـ لم يكن له موقف واضح ومقرر بالنصوص في هذا الموضوع ـ لقد اتخذ فيه أبو بكر موقفاً.. ثم جاء عمر فاتخذ موقفاً آخر.. ثم جاء علي فاتخذ هذا الموقف الجديد ـ وهو الموقف الذي يعلن المساواة التامة بين الناس في العطاء، سواء أكانوا عرباً أم غير عرب، وسواء أكانوا من السابقين إلى الإسلام أم من الذين تأخروا في الدخول فيه. والذي يلغي اتخاذ السبق إلى الإسلام والفضل في الدين ستاراً أو سبيلاً لاحتياز الثروات والأموال، والذي يدخل في ديوان العطاء من لم يكن قد دخل من قبل فيه..
وكما كان هذا الموقف الثوري أول قرارات علي عندما ولي الخلافة، كانت معارضة الأغنياء لهذا القرار أول معارضة حدثت لعلي في ذلك التاريخ.. وكما يقول أحد شيوخ المعتزلة ومؤرخيهم ـ أبو جعفر الأسكافي ـ: فلقد «كان هذا ـ (الأمر) ـ أول ما أنكروه من كلامه. وأورثهم الضغن عليه، وكرهوا إعطاءه وقسمه بالسوية»([241]).. بل وثارت بين المعارضين وبين علي المناقشات والمجادلات حول هذا الموضوع، إذ استنكر الأغنياء والأشراف أن يتساووا بالموالي وبمن كانوا غلماناً وأرقَّاء عندهم بالأمس القريب؟! «فقال سهيل بن حنيف: يا أمير المؤمنين، هذا غلامي بالأمس وقد أعتقته اليوم؟! فقال (علي): نعطيه كما نعطيك؟! فأعطى كل واحد منهما ثلاثة دنانير، ولم يفضل أحداً على أحد»([242]).
ولقد كان في مقدمة الذين اعترضوا على موقف علي هذا: طلحة بن عبيدالله، والزبير بن العوام، وعبدالله بن عمر، وسعيد بن العاص، ومروان بن الحكم «ورجال من قريش وغيرها».. بل لقد بلغوا في معارضتهم لقرار التسوية هذا حد نقض بيعتهم لعلي وإعلان الحرب عليه، تحت ستار الطلب بدم عثمان، على حين كانوا هم الذين تقدموا الناس في الثورة على عثمان؟!!..
وإزاء هذه المعارضة شنَّ علي بن أبي طالب حملة ضد هذا الفريق، وألقى عدة خطب أوضح فيها موقفه الفكري والأسس التي بني عليها اجتهاده هذا.. فقال مثلاً: «.. أما هذا الفيء فليس لأحد على أحد فيه أثرة، وقد فرغ الله من قسمته، فهو مال الله، وأنتم عباد الله المسلمون، وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا، وعهد نبينا بين أظهرنا، فمن لم يرض به فليتول كيف شاء، فإن العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه..»([243]).
بل لقد دارت مناقشة مباشرة في مواجهة جرت بين علي وبين طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام ـ وهما اللذان قادا الحرب ضده ـ حول هذا الموضوع… فقال لهما علي: «ما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟».
قالا: خلافك عمر بن الخطاب في القسم، إنك جعلت حقنا في القسم كحق غيرنا، وسويت بيننا وبين من لا يماثلنا فيما أفاء الله علينا بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا وظهرت عليه دعوتنا، وأخذناه قسراً قهراً ممن لا يرى الإسلام إلاَّ كرهاً.
فقال علي: أما القسم والأسوة، فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بادىء بدء! فقد وجدت أنا وأنتما رسول الله يحكم بذلك، وكتاب الله ناطق به، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.. وأما قولكما: جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبين غيرنا، فقديماً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم، فلم يفضلهم رسول الله في القسم ولا آثرهم في السبق، والله سبحانه موف السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم، وليس لكما، والله، عندي ولا لغيركما إلاَّ هذا.
فقال الزبير في ملأ من الناس: هذا جزاؤنا من علي! قمنا له في أمر عثمان حتى قتل، فلما بلغ منا ما أراد جعل فوقنا من كنا فوقه!!..»([244]).
فقال علي ـ لما عاتبه بعض أصحابه على التسوية في العطاء، وطلب تمييز البعض إرضاء للخصوم ـ: «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟! والله لا أطور ـ (آمر) ـ به.. لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله؟!..»([245]).
كانت هذه وقفة ـ بل ثورة ـ علي ضد التمايز الطبقي الذي استشرى ورسخ على عهد عثمان.. وهو الاستشراء والرسوخ الذي يتحدث عنه شارح (نهج البلاغة) ـ «ابن أبي الحديد» ـ، فيقول: «فإن قلت: إن أبا بكر قسم بالسواء كما قسمه أمير المؤمنين علي، ولم ينكروا ذلك كما أنكروه أيام أمير المؤمنين علي، فما الفرق بين الحالتين؟!».. ثم يجيب ابن أبي الحديد فيقول: «أن أبا بكر قسم محتذياً لقسم رسول الله، فلما ولي عمر الخلافة، وفضل قوماً على قوم، ألفوا ذلك، ونسوا تلك القسمة الأولى وطالت أيام عمر وأشربت قلوبهم حب المال وكثرة العطاء. وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة، ولم يخطر لأحد من الفريقين أن هذه الحال تنتقض أو تتغير بوجه ما، فلما ولي عثمان أجرى الأمر على ما كان عمر يجريه، فازداد وثوق القوم بذلك، ومن ألف أمراً شقَّ عليه فراقه وتغيير العادة فيه، فلما ولي أمير المؤمنين علي أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيام رسول الله وأبي بكر، وقد نسي ذلك، ورفض، وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة، فشقَّ ذلك عليهم، وأنكروه وأكبروه، حتى حدث ما حدث من نقض البيعة ومفارقة الطاعة..»([246]).
نعم.. كان هذا هو موقف علي ـ بل كانت هذه ثورة من الثورات التي فجرها في المجتمع العربي الإسلامي عندما ولي أمره ـ ولم تثن عزمه عن موقفه هذا تلك المخاطر التي لاحت أمامه في الشقاق الذي بدأه طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام، ثم في الحرب التي أشعلاها ضده بعد أن نقضا بيعتهما إياه.. كما لم تثنه عن موقفه هذا الحرب التي أعلنتها قريش ـ خلف الفرع الأموي بزعامة معاوية ـ ضده وضد سياسته الاجتماعية.. بل لقد ازداد استمساكاً بفكره الاجتماعي هذا، وإصراراً على تطبيق روح الإسلام الداعية إلى المساواة.. وحتى عندما جاءته الأخبار بأن الأغنياء والأشراف الذين بايعوه في المدينة وفي الأقاليم قد أخذوا يتسللون إلى الشام وينضمون إلى جيش معاوية، ظلَّ مستمسكاً بموقفه هذا المنحاز إلى المساواة.. وفي هذا الصدد نجده يكتب إلى «سهل بن حنيف» الأنصاري ـ عامله على المدينة ـ يقول: «.. أما بعد، فقد بلغني أن رجالاً ممن قبلك يتسللون إلى معاوية، فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم، ويذهب عنك من مددهم.. فإنما هم أهل دنيا مقبلون عليها.. قد عرفوا العدل ورأوه. وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة، فهربوا إلى الأثرة، فبعداً لهم وسحقاً!!»([247])، وعندما بلغه أن عامله على «أردشير خرة» ـ مصقلة بن هبيرة الشيباني ـ يفضل أهله على غيرهم في العطاء كتب إليه: «.. بلغني عنك أمر أن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وأغضبت إمامك.. إن حق من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا الفيء سواء..»([248]).
كما يكتب إلى الأسود بن قطيبة ـ صاحب جند «حلوان» ـ: «أما بعد، فإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل، فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء، فإنه ليس في الجور عوض من العدل..»([249]).
وعندما يولي أمر مصر إلى «الأشتر النخعي» يكتب له في عهده فيقول: «… وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة.. فعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور، وينتصف منك للمظلوم»([250]).
نعم.. كانت هذه سياسة علي بن أبي طالب، موقفاً أصيلاً تمسك به، ولم يرهب المخاطر الحقيقية التي تهددت سلطته بسببها، وهي المخاطر التي أودت بسياسته، بل وبحياته، وهو الأمر الذي عبر عنه عبدالله بن العباس، عندما كتب إلى الحسن بن علي، بعد موت علي والبيعة للحسن فقال: «… واعلم أن علياً أباك إنما رغب الناس عنه إلى معاوية لأنه آسى ـ (ساوى) ـ بينهم في الفيء وسوى بينهم في العطاء، فثقل عليهم ذلك!..»([251]).
على أن هناك حقيقة هامة في الفكر الاجتماعي الثوري لعلي بن أبي طالب لا بدَّ من التنبيه عليها، وهي أن الرجل لم يتخذ موقفه الثوري هذا ضد جمع الثروة واحتيازها تحت تأثير الزهد في الدنيا والرغبة عن نعيمها ـ كما قد يظن البعض ـ فالرجل كان من أنصار أن يجعل الإنسان لنفسه حظاً طيباً من طيبات هذه الحياة، بل وأن تظهر آثار نعم الحياة على الناس، فهو القائل: «… ولير عليك أثر ما أنعم الله به عليك..»([252]). كما كان عدواً للفقر كارهاً له مدركاً للأخطار التي يتهدد بها حياة الناس.. وذلك الأمر يتجلى في كلماته التي يقول فيها: «إن الفقر (هو) الموت الأكبر… الفقر يخرس الفطن عن حجته..» وعن الفقر تحدث إلى ابنه محمد بن الحنفية فقال: «يا بني، إني أخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل داعية للمقت..» وعن موقفه هو من الفقر كان دعاؤه إلى الله: «… اللهم صن وجهي باليسار ـ (الغنى) ـ ولا تبذل جاهي بالاقتار. فأسترزق طالبي رزقك، واستعطف شرار خلقك، وابتلي بحمد من أعطاني، وافتتن بذم من منعني!» بل لقد بلغت عبقرية الإمام في هذا المقام إلى الحد الذي أدرك فيه العلاقة الوثيقة بين حب الإنسان لوطنه وبين ما يكفله هذا الوطن لأهله من حقوق مادية تيسر لهم فيه أمور الحياة.. وهو ما نسميه الآن ـ بلغة عصرنا ـ «المضمون الاجتماعي والاقتصادي للوطنية».. وعن هذا المعنى العميق تعبر كلمات الإمام علي الجامعة التي تقول: إن «الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة»؟!! وإن «المقل غريب في بلدته..»([253]).
فهو موقف اجتماعي إذن.. وفكر منظم يستند إلى فلسفة تؤمن بالمساواة بين الناس.. وليس بموقف الزاهد المحب للفقر الهارب من زينة الحياة الدنيا وزخرفها، كما يتصور بعض الناس شخصية أمير المؤمنين.
طبقات المجتمع ومكانها
بل إن هذا الموقف الاجتماعي الذي ألمحنا من خلال الحديث عنه إلى فكر الإمام علي المتعلق بالثروة والمساواة بين الناس إزاءها، ليس سوى جزئية من الجزئيات التي ينتظمها موقف عام وتصور كلي كان لدى الرجل إزاء المجتمع الذي حاول أن يقيم دعائمه في ذلك التاريخ.. وهو تصور نستطيع أن نستشف قسماته وملامحه إذا نحن أمعنَّا النظر في تلك الوثيقة الهامة التي كتبها إلى الأشتر النخعي عندما ولاه على مصر.. ففيها نجد، ضمن ما نجد:
(أ) اعترافه بالواقع الذي يقسم المجتمع إلى طبقات..
(ب) وحديث عن العاملين بالأرض، والموقف إزاءهم.
(ج) ثم حديث عن طبقة التجار والصنّاع.
(د) ثم حديث عن المساكين..
(هـ) وأخيراً.. الحديث عن «الخاصة»، والموقف الذي يجب على الوالي عندما يتعامل معهم.
وفي كل ذلك نطالع ملامح واضحة لفكر اجتماعي متقدم تحلى به الإمام علي في الوقت الموغل في التاريخ.
1 ـ انقسام المجتمع إلى طبقات:
وهو انقسام تحدث عنه الإمام علي وأوضح معالمه بالتفصيل.. كما ذكر في ثناياه ما يرتبط ويتعلق بهذه الطبقات من «الفئات».. فعنده أن من طبقات المجتمع وفئاته: الجنود ـ والكتاب ـ والقضاة.. والعمال على الأقاليم والقائمون على شؤون جهاز الدولة.. والفلاحون الذين يدفعون الخراج عن الأرض، مسلمين كانوا أم معاهدين… والتجار وأهل الصناعات.. ثم أهل الحاجة من المساكين، الذين يسميهم: الطبقة السفلى.. وعنده كذلك أن هناك ارتباطاً بين هذه الطبقات والفئات يجعل من جميعها كلاً متكاملاً وجسماً واحداً، وأن الرباط الذي يربطها ويحفظ توازنها هو العدل الذي يجب أن يتوافر لها من قبل الحكام..
أما كلماته التي تحكي عن ذلك فهي التي يخاطب بها «الأشتر النخعي» فيقول: «… واعلم أن الرعية طبقات، لا يصلح بعضها إلاَّ ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها: جنود الله، ومنها: كتاب العامة والخاصة، ومنها: قضاة العدل، ومنها: عمال الإنصاف والرفق، ومنها: أهل الجزية والخراج، من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها: التجار وأهل الصناعات، ومنها: الطبقة السفلى من ذوي الحاجات والمسكنة… فالجنود حصون الرعية.. وسبل الأمن.. ثم لا قوام للجنود إلاَّ بما يخرج الله لهم من الخراج.. ثم لا قوام لهذين الصنفين إلاَّ بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتَّاب. ولا قوام لهم جميعاً إلاَّ بالتجار وذوي الصناعات…»([254]).
2 ـ الذين يفلحون الأرض:
ولقد احتلت مكانة الطبقة التي تفلح الأرض وتستزرعها مكاناً بارزاً وهاماً في الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب، بل أن حديثه عنها ووصاياه بشأنها تجعلنا نقول: إن فكره الاجتماعي قد جعل مكان هذه الطبقة أبرز مكان وأهمه بالقياس إلى باقي الطبقات فقد كانت المجتمعات التي فتحت ـ في العراق والشام ومصر ـ مجتمعات زراعية بالدرجة الأولى، وكان الخراج ـ ضريبة الأرض الزراعية ـ أهم مصدر من مصادر ثروة الدولة، وكان المرتبطون بالأرض يمثلون الأغلبية العددية للسكان، ومن هنا ـ مع فكر الرجل الاجتماعي المتقدم ـ كان المكان الهام والبارز لهذه الطبقة في فكره الاجتماعي.
فهو يطلب من واليه على مصر أن يرعاهم ويتفقد أمرهم، لأن أمر سائر طبقات المجتمع متوقف على أمرهم.. ويرسم له فلسفة تدعو إلى التعمير كوسيلة تثمر بالتبعية تحصيل ضريبة الخراج، فالتعمير والاستصلاح أولاً، ثم التفكير بعد ذلك في تحصيل الخراج.. فيقول له: «وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه صلاحاً لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلاَّ بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله.. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلاَّ بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلاَّ قليلاً. فإن شكوا ثقلاً أو علة.. خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم.. فلا يثقلن عليك أي شيء خففت به المؤونة عنهم.. وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر!!»([255]).
ثم يحدد لعمال الخراج وجباة الضرائب وظائفهم، فهم ليسوا بمتسلطين، وإنما هم القائمون على خزائن الأموال، وهذه الخزائن إنما هي للرعية أصلاً، ومن ثم فإنهم «وكلاء الأمة» كما هم «سفراء الأئمة» ولذلك فهو يدعوهم للإنصاف ويقول لهم: «.. فانصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم» إذا حلَّ أجل خراجهم ولم يتيسر لهم الأداء([256])..
وفيما يتعلق بسلوك الجهاز الحكومي القائم على جمع الضرائب وجباية الخراج، يزخر الفكر الاجتماعي للإمام علي بمجموعة من القواعد والوصايا التي ترسم العلاقة بين هذا الجهاز وبين الفلاحين، وتحدد الحدود التي يجب أن لا يتعداها أهل هذا الجهاز.
فهو يطلب من عامل الخراج أن لا يفزع الناس ولا يروعهم ولا يظهر لهم الكراهة.. وإذا دخل مكاناً لجباية ضرائبه فلينزل بعيداً عن موضع أموال الناس، ولا يذهب إلى مكان ثرواتهم إلاَّ بإذنهم ودعوتهم.. ولا يطلب خراجاً إلاَّ ممن يعترف راضياً بأن لديه النصاب الذي يجب فيه الخراج.. وعند القسمة وتحديد نصيب بيت المال، يقسم عامل الخراج ويدع الاختيار لصاحب المال..
وفوق ذلك كله يقرر الإمام علي بأن هناك حداً أدنى لمستوى المعيشة يلزم توفيره للإنسان، فلا يجوز الاستيلاء على شيء منه وفاء بدين أو خراج مستحق للدولة عند المواطنين، وهذا الحد الأدنى يتمثل في: كسوة الإنسان، صيفاً وشتاء، وأدوات عمله في الأرض، بما فيها الدواب والعبيد..
ثم يعلن تحريم العقوبات البدنية ويمنع استخدامها كوسيلة للكشف عن الأموال التي يعتقد عمال الخراج أنها مخبأة ومستورة لدى الناس.. ويقرر منع المصادرات على الإطلاق، سواء أكان المواطن مسلماً أم غير مسلم، اللهم إلاَّ إذا تعلق الأمر بأدوات قتال يستخدمها البعض في الاعتداء على الإسلام والمسلمين؟!
وعن هذه المبادىء والقواعد والوصايا والقوانين يتحدث الإمام علي إلى عماله على الخراج فيقول: «.. فأنصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم، فإنكم خزّان الرعية، ووكلاء الأمة، وسفراء الأئمة. ولا تحشموا ـ (تغضبوا) ـ أحداً عن حاجته، ولا تحبسوه عن طلبته، ولا تبيعن الناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يحتملون عليها ولا عبيداً، ولا تضربن أحداً سوطاً لمكان درهم، ولا تمسن مال أحد من الناس، مصل ولا معاهد، إلاَّ أن تجدوا فرساً أو سلاحاً يعدى به على أهل الإسلام..»([257]).
وفي «بيان عام» كتبه وصية لمن كان يتولى أمر الخراج، تحدث إلى عامل الخراج يقول: «… ولا تروعن مسلماً، ولا يجتازن عليه كارهاً، ولا تأخذ منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار… فتسلم عليهم.. ثم تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم ـ (أي قال لك: نعم) ـ فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلاَّ بإذنه، فإن أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها؟ ولا تسوءنَّ صاحبها فيها..»([258]).
ثم يستطرد الإمام علي ـ في موطن آخر ـ فيحذر عمال الخراج من ظلم الرعية وخيانة الأمانة، قائلاً لهم: إن «من استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة، ولم ينزه نفسه ودينه عنها، فقد أحلَّ بنفسه، الذل والخزي في الدنيا، وهو في الآخرة أذل وأخزى، وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة..»([259]).
هذا عن الذين يفلحون الأرض من طبقات المجتمع.
3 ـ طبقة التجار والصناع:
أما أصحاب التجارات وأرباب الصناعات فلقد نبَّه الإمام علي عامله في مصر إلى أهمية دورهم ومكانهم في المجتمع، فهم الذين يجلبون احتياجات الناس من مصادرها إلى حيث ييسرونها لمحتاجيها، وهم الذين تقوم بهم وعليهم مرافق البلاد، ومن ثم فإن على الوالي أن يتفقد شؤونهم ويرعى أحوالهم… ولكنه يلفت نظر وإليه إلى ما في هذه الطبقة من سلبيات وعيوب اجتماعية واقتصادية، ففيهم يتفشى البخل والشح، والرغبة في الاحتكار والاستغلال، فعلى الوالي أن يتصدى لمنع كل ذلك ومطالبة أصحابه، بل والتنكيل بهم، في غير إسراف؟!.. فيقول للأشتر النخعي «… ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات، وأوص بهم خيراً، المقيم منهم والمضطرب بماله ـ (أي المتجول في البلدان) ـ والمترفق ببدنه ـ (أي المتكسب بعمله اليدوي) ـ فإنهم مواد المنافع، وأسباب المرافق، وجلابها من المباعد والمطارح، في برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها. فتفقد أمورهم بحضرتك، وفي حواشي بلادك.. واعلم ـ مع ذلك ـ أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين: من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة ـ (احتكاراً) ـ بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف…»([260]).
4 ـ الطبقة السفلى:
ثم يوصي عامله على مصر خيراً بالطبقة السفلى من طبقات المجتمع، وهم الذين لا قدرة لهم على الكسب والتكسب، ومن ثم فإن لهم ـ في فكر علي الاجتماعي ـ حقوقاً مقررة ومقدسة في بيت المال.. وفي هذه الطبقة يعد علي: العاجزين عن العمل «من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى» ـ أي أصحاب الأمراض والعاهات المزمنة ـ وكذلك اليتامى وكبار السن، من «أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة لهم». وكذلك الذين يمنعهم الحياء عن سؤال الناس رغم حاجتهم.. ولكل هؤلاء يطلب الإمام علي تخصيص قسم من أموال «صوافي الإسلام في كل بلد» ـ أي من الأموال العامة الخاصة بالدولة ـ، وأن يتفرغ لرعاية أمرهم وبحث أحوالهم، وعرض شأنهم على الوالي قوم أهل ثقة «ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمورهم..».. بل، وأكثر من ذلك، فإن على الوالي أن يخصص من وقته قسماً يتفرغ فيه لأمور هذه الطبقة، بعد أن يبعد عنهم جنوده وحرَّاسه وأعوانه، حتى يتحدثوا إليه في قضاياهم واحتياجاتهم ومظالمهم دون رهبة، وفي طلاقة لا تحجب ألسنتهم دونها «تعتعة» مصدرها الخوف والإرهاب، فيقول له: «… وتجلس لهم مجلساً عاماً، فتتواضع فيه.. وتقعد عنهم جندك وأعوانك.. حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع، فإني سمعت رسول الله يقول في غير موطن: «لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع…»([261]).
5 ـ طبقة «الخاصة»:
ونحن نعتقد أن كلمات الإمام علي التي تحدث بها إلى عامله على مصر ـ الأشتر النخعي ـ هي من أكثر الكلمات حسماً ووضوحاً في الدلالة على الموقف الاجتماعي المتقدم والفكر الثوري الذي كان لدى هذا الإمام العظيم… فهو يطلب من واليه أن يكون اعتماده دائماً وأبداً على «العامة» دون «الخاصة»، لأن «العامة» هم «عماد الدين، وجماع المسلمين، والعدة للأعداء».. بينما «الخاصة» لا همَّ لهم إلاَّ مصالحهم الذاتية الضيقة، ومطالبهم الأنانية الفردية، ثم هم يضعون أنفسهم في خدمة كل ظالم بصرف النظر عن الدول والعهود!!.. ثم يطلب إليه أن يكون يقظاً إلى أطماع طبقة «الخاصة»، فهم يريدون «الاستئثار» بالأموال والاحتكار للمزايا، و«التطاول» على الرعية، وهم يجنحون دائماً إلى «قلة الإنصاف»… ثم ينهاه عن أن يهبهم الهبات أو يقطعهم الإقطاعات، أو يسمح لهم بتسخير الناس لديهم أو الغفلة عن محاولاتهم الاستئثار بالمنافع العامة، مما يجلب لهم المنفعة، ويسبب النقد والسخط على الدولة والولاة؟!.. وعن كل ذلك يقول الإمام علي للأشتر النخعي: «.. ثم إن للوالي خاصة وبطانة، فيهم استئثار وتطاول، وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال؟!. ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك ـ (خاصتك وقرابتك) ـ قطيعة (إقطاعاً ومنحة من الأرض) ـ ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس من شرب أو عمل مشترك، يحملون مؤونته على غيرهم، فيكون مهنأ ذلك ـ (أي منفعته الهنيئة) ـ لهم دونك، وعيبه عليك في الدنيا والآخرة.. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة.. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكراً عند الإعطاء، وأبطأ عذراً عند المنع، وأضعف صبراً عند ملمات الدهر، من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين، وجماع المسلمين والعدة للأعداء، العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم!!»([262]).
ثم ينصح واليه أن لا يتخذ له وزيراً قد شارك في خدمة سلطة ظالمة من قبل فيقول له: «.. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة.. وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم ـ (ذنوبهم) ـ وأوزارهم، ممن لم يعاون ظالماً على ظلمه ولا آثماً على إثمه..»([263]).
هذا عن الطبقات والفئات الاجتماعية التي أبصر فكر الإمام علي الاجتماعي انقسام المجتمع إليها، ودور كل منها في الحياة العامة، وموقفه هو شخصياً وتقديره لكل طبقة من هذه الطبقات.. ولقد رأينا كيف انحاز فكره وموقفه إلى «العامة» ضد «الخاصة»، لأن العامة هم «عماد الدين، وجماع المسلمين، والعدة للأعداء» بينما «الخاصة» أثقل مؤونة في الرخاء، وأقل معونة في البلاء، وأكره للانصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكراً عند الإعطاء، وأبطأ عذراً عند المنع، وأضعف صبراً عند ملمات الدهر..؟!..».
المال العام
وقسمة أخرى من قسمات الفكر الاجتماعي المتقدم للإمام علي تطالعنا في موقفه من حق الحاكم وحريته إزاء المال العام.. فنحن قد أشرنا من قبل إلى تلك الفلسفة التي وجدت طريقها إلى فكر عثمان بن عفان، والتي تبيح للإمام أن يتصرف لحسابه الخاص في «فضول الأموال»، أي ما زاد عن أعطيات الناس، وإلاَّ فلم كان إماماً إذاً؟!! غير أننا نلتقي في الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب بفلسفة هي على النقيض من تلك تماماً..
فهو الذي رفض أن يعطي أخاه «عقيلاً» شيئاً من بيت المال، رغم حالة الفقر الشديد التي كان عليها، عندما أصبح «صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم» رفض علي أن يعطيه «صاعاً» من قمح بيت المال، لأنه رأى أنه بذلك سيكون «ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام؟!»([264]).
وهو الذي رفض أن يعطي أحد شيعته ـ عبدالله بن زمعة ـ شيئاً من بيت المال، وقال له: «.. إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء المسلمين» وأنه ثمرة لجني أيديهم وقتالهم، وما تجنيه الأيدي يكون لأفواه أصحاب هذه الأيدي، لا للذين لم يشاركوهم العمل والجهاد([265])!!
فنحن هنا بإزاء فلسفة متميزة ونظرة خاصة للمال العام، لا تستحل التصرف فيه إلاَّ لأهله، حتى ولو كان مصدر هذا التصرف هو أمير المؤمنين.
وذلك.. مع ما تقدم من التصدي لملأ قريش وأغنيائها… وعزل عمال عثمان الذي حولوا ثروة المسلمين العامة إلى «بستان» خاص لقريش، وجعلوا مال الناس العام «طعمة» خاصة لأفواه قلة قليلة.. والتغيرات الاجتماعية لنظام التمايز والتمييز الطبقي الذي ساد واستشرى زمن عثمان بن عفان، والانحياز إلى طبقة «العامة» ضد «الخاصة» عند التقييم لطبقات الأمة الاجتماعية.. إن ذلك كله، وكثير مثله، يضع يدنا ويفتح عقولنا على صفحة مشرقة من صفحات تراثنا الفكري تتمثل في الفكر الاجتماعي الثوري والمتقدم لعلي بن أبي طالب، وهي صفحة تبعث فينا الفخر والاعتزاز، وتستحق منا التأمل والدرس والاعتبار.
الدكتور محمد عمارة
تكامل الحكمة وشموليتها
في فكر الإمام علي (ع)
يظل هاجسنا عندما نكتب عن الإمام علي بن أبي طالب، وما يمثّله من فكرٍ شمولي مفعم بالحكمةِ، وممارسةٍ قلَّ نظيرُها في التاريخ الإنساني، وقوّةِ مثالٍ لا يزال مُسْتَلْهَماً عبر التاريخ، وحضور مستمر في الوجدان الإسلامي يظل هذا الهاجس متعدِّد الأهداف، بدءاً من إرادة التعريف بحوادث مشرقة من تراثنا الإنساني، إلى الهدف المركزي الذي نشدناه ونظل ننشده بصورةٍ مستمرةٍ، وهو عقلنة السلطة وتهذيبها وترشيدها، في وقت أصبحت فيه وحشاً ضارياً في حياتنا السياسية والإنسانية، يعتدي على حرماتنا وأفكارنا ومقدساتنا وكل تفاصيل حياتنا بما فيها الحياة نفسها. ويقزّم عقولنا وأحلامنا، إلى درجةٍ غَدَتْ فيه الحياة عبئاً قميئاً غير قابل للاحتمال.. إلى هدف إشاعة مناخ المعرفة، والحيوية، والإيجابية، في حياتنا الراهنة، بما تعكسه من عقم وانكماشٍ، وانطواء على السلبية والخيبة، لأن المعرفة من أهمّ عوامل تجديد المجتمعات، وبخاصة عندما تصدر عن نماذج إنسانية فذّة، لم تُستهلكْ فكراً، ومثالاً، وتطلعاً، وحضوراً دائمَ الفعل والتأثير، في ضمائر وعقول الملايين من البشر.
إنّ بعث هذا الفكر وتقديمه بما يلائم حضورنا الخلاّق، والفاعل في العصر، يساهم مساهمة أكيدة في الدفاع عن هويّاتنا أفراداً وجماعات، مهما كبر مستوى هذه الجماعات، في وقت تتعرّض فيه هويات البشر وثقافاتهم، واستقلالهم بالمعنى العريق والشامل، إلى تهديد جدي، بسبب سياسات الهيمنة التي تمارسها الدول الكبرى، وهي تملك ما تملكه من وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تستطيع أن تبثّ «ثقافاتٍ» وقيماً، وأنماطَ حياةٍ، وسياساتٍ موجهةً، بصورة ينتفي فيها أي تكافؤ بينها وبين ما تقدر عليه الشعوب، التي لا تمتلك الإمكانات التي تؤهلها للدفاع عن نفسها، والحفاظ على شخصِها وهويتها، من الاقتلاع والتذويب والتغريب.
والكتابة عن الإمام عليٍّ وهو الذي أبلى جهاداً، وتأمّلاً، وتمرّساً، في مرحلة هي الأهم في التاريخ الإسلامي.. وبخاصة أنّها مرحلة تأسيسية…
نقول إن الكتابة عنه، وعن أمثاله، هي بمثابة تصحيح مستمر للتاريخ الذي يشكِّل ذاكرة البشر.. وهي ذاكرة تفقد توازنها واتزانها، ما لم تتعامل بالحقائق الموضوعية، وتنصف الشخصيات التاريخية التي تتمتّع بغنى فكرٍ، ومصداقيةِ ممارسةٍ يؤهلانها لأن تواكب حركة الحياة التي لا تنقطع عن الصيرورة الدائمة.
ونحن نعتقد أن الحفاظ على الهوية، وإشاعة المعرفة والحكمة، على المستويين الرسمي والشعبي، وإضاءة أحداث التاريخ، وتفاصيله المظلمة والمعقدة، نشداناً لذاكرةٍ مجتمعةٍ أكثر صحةً وتوازناً، مهمةٌ تغدو أكثر إمكانيةً، باختيار نماذج فذّة من تاريخنا، بغية تقديمها وتقييمها بما تستحق من أهمية وجدارة. وذلك لأن التاريخ يعلّمنا أن الشعوب تستهلم أكثر ما تستلهم من النماذج الفذّة ذات التاريخ الذي لا يكف عن التأثير والحضور، ولممارساتها التي تجاوزت المصلحة والأنانية، وكل الاعتبارات غير المبدئية، وهي تجابه أقسى الامتحانات والتحديات.. ولخروجها من كل معارك التحدي، مهزومةً أكثر من منتصرةً، دون أن تجرحَ المثالَ العظيمَ الذي عُرِفَتْ به.. ودون أن تسيء إلى المبادىء التي اعتنقتها.
وتجربة الإمام علي بن أَبي طالب الكبيرة.. بما قدم بها وخلالها من أمثولات عملية ساطعة في دلالاتها واستهدافها المثال الأكثر كمالاً حَرِيَّةٌ أن تجعله عبر التاريخ ماثلاً، يلهم الأجيال المتعاقبة، تكاملَ الحكمةِ وشمولِيتِها والقدرةَ الباهرةَ على السموّ على كل الاعتبارات الخاصة، التي يجدر أن تُسقط وأن تُنحّى لصالح الاعتبارات المبادئية.
وأهمية «عليّ» في التاريخ الإسلامي.. وحضوره المستمر في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة، لا تنبعان من قرابته للرسول (ص) كما يحلو لبعض المؤرخين أن يتعامل مع هذه الشخصية المتكاملة.. على أهمية وحساسية هذا الاعتبار.. بل إن هذه الأهمية تنبع في الدرجة الأولى من حضوره، وإلى جانبه الرسول (ص) لحظةً بلحظة، مسيرةَ الإسلام الصعبة، وهو يتصدّى لتغيير مجتمع وثنيٍّ قبلي عصبي مشرذمٍ.. وما ترك من تراثٍ هائل، يدلّ على سعةِ أفقٍ، وإيغالٍ في ثقافاتِ الأمم السابقةِ، وانخراطٍ عريق في مغامرة الإسلام الكبرى.
ولدى دراسة كل من شخصيتي الرسول (ص) و«علي» مما خلَّفاه من تراث، وما تركاه من أمثولات عملية، يلحظ إلى حد كبير غنى وتكامل هاتين الشخصيتين اللتين انصهرتا في تجربة الإسلام، وهما تواجهان منذ اللحظات الأولى، العداء والتحدي وكل قِيم التشرذم والعصبية، وما أثاره الإسلام المقتحِم، من مخاوفَ جديةٍ، لدى مراكز القوى، التي أضيرت، وهُدِّدَت في ذلك العصر.
ورفقة الرسول (ص) تعني ما تعنيه على صعيدي الرؤية والممارسة في آن واحد. فقد اقتضت هذه الرفقة أن يقاتل «عليّ» في معظم معارك الإسلام العسكرية والسياسية والدعاويّة بكل مستوياتها.. قَاتَلَ كجنديٍّ باسلٍ.. وقَاتَلَ كرجلِ فكرٍ وداعيةٍ. وكان معنيّاً بانتصار الإسلام الذي شكّلت قضيتُه قضيةً شخصيةً وعامةً بالنسبة له.
ومن السهولة بمكان، أن نلحظ هذه الحقيقة الكبيرة في كل وثيقة تأريخ لحياة الرسول، أو لمسيرة الإسلام الأولى على وجه العموم.
ومن المؤكد أن الانخراط المبكر في الإسلام، وهذا أمر معروف بالنسبة لعليّ، قد وضعه في آتون هذه التجربة قتالاً، وتمرساً، وانصهاراً، وامتلاكاً للمعرفة والتجارب، وتأثّراً بشخصية الرسول، واطلاعاً على تفاصيل وأسرار الصراع الذي خاضه الرسول مع مراكز القوى التي اهتزّت، فزعاً على مواقع نفوذها ومصالحها المعروفة في ذلك العصر.
كانت لعلي صفاتُ المجاهد، والداعيةِ، …….. والرجلِ الورع، والخليفة العادل الذي يهجس ويعمل لإقامة مملكة العدل والحق، استناداً إلى مبادىء الإسلام التي اعتبرها في كل مراحل نضاله وسلطته، المرجعَ والمصدرَ والهاديَ في رؤيته وممارسته. ولم يقبل إطلاقاً أن يتساهل في تطبيقها حتى في دائرته الخاصة. ولقد برزت هذه الصفات، إبّان كان يناضل ويجاهد إلى جانب الرسول (ص).. كما برزت بعد وفاته.. واستمرت عندما أمسك بالسلطة، وأخذ يمارسها بقيود صارمةٍ على ذاته، كان لها أثر حاسم على فقدانه إيَّاها.
ورغم ما جابه من تحدياتٍ ومصاعبَ ومطامحَ سلطويةٍ ملتبسة وغير مشروعةٍ، فلقد صمّم أن يكون مبدئيّاً ومن اللحظة الأولى. ورفض استسهال الحلول باللجوء إلى طرقٍ ملتبسة.. كما رفض أن يشتري ولاء الرموز القبلية الكبيرة، والشخصيات الطامحة إلى السلطة بالمال والوعود والإغراءات المؤثّرة في حسم الصراع لمصلحته.. ورفض رغم كل ما قُدِّم له من نصائح، أن يتعاون مع ولاة لا يثق بتاريخهم، ولا يطمئن لمصداقية ممارستهم السلطوية. وإذا كان الإمام قد استطاع أن يلهم، وأن يشدَّ، أجيالاً، مئات من السنين، بما مارسه من جهاد، وما تركه من قوة مثال، ومن تراث، طالما طال معظم، إن لم نقل جميع، جوانب الحياة والدين والسلطة والسلوك الإنساني المتوجب في ظروف الحياة المختلف. فإن ذلك يرتّب عليها مسؤوليةَ أن نقدِّمَهُ، في هذه الحقبة من التاريخ الإنساني العصيب، حيث تهتز الأرض تحت أقدام الشعوب والأمم العريقة، مهدِّدةً إياها بكل أشكال الغزو والسيطرة والمسخ.
إن المشهد الإنساني الراهن مشهد مريع.. وعلى متسع الكرةِ الأرضيةِ، تسيل الدماء، ويسيطر العبث، ويفقد الناس البوصلة والحلم الإنساني الكبير.
ومما يجعل هذا المشهد أكثر مأساويةً، خلوُّ هذا العالم الذي ننتمي إليه، من الحكَم والفيْصل.. أي أن هذه الشعوب المبتلاة بالقهر والطغيان والعجز والهيمنة الدولية، لا تمتلك مرجعية جديرة بأن يُحتكم إليها دفاعاً عن وجودها وثقافتها وهويّتها ومصالحها الجوهرية.
ولا يمكن لأي عامل من العوامل الإنسانية، أن يشكل مصدر عزاء وشفاء وتطلع وأمل، كما تشكل المعرفة، والحكمة، وسير الرجال العظماء، في حياة الشعوب والأجيال التي فجعت بما يمارس على الصعيد الوطني والدولي، من سياسياتٍ قوامها البطش والقمع والفساد والإفساد ومسخ العقل البشري، وخلو الحياة اليومية من ثقافة رفيعة المستوى، ومن ممارسات سياسية ديموقراطية وذات دينامية عالية تشد المجتمع إلى الانتماء، والفعل الإيجابي، والمبادرة، والمسؤولية.
إن الحكمة ـ هنا ـ هي ضالّتنا، أداءً للرسالة التي أعلنّا عنها منذ السطور الأولى. وعليٌّ كان رجل حكمةٍ وفكر. والحكمة تنضح من فكره ومن تجربته، ولقد اتَّصفتْ هذه الحكمة بالشمولية والتنوع والعزف على أكثر الأوتار الإنسانية حسَّاسية. ورغم صعوبة الإحاطة الكلية بكل المجالات التي استهدفها وأعطى رأياً فيها.. إلاَّ أننا آثرنا أن نتناول القضايا الهامة التي لا تزال وستظل قواسم مشتركة بين البشر، والتي لا يزال الاهتمامُ بها وسيظل متوجباً في جميع العصور.
السلطة:
ومن الموضوعات الجوهرية التي تناولها عليٌّ وأعطاها كثيراً من اهتمامه موضوع السلطة في كل تجلياتها السلبية والإيجابية.. وقد ترك بصماتٍ هامة على هذا الموضوع، سواء على المستوى العملي، وعلى المستوى النظري. ونستطيع القول قبل أن نتعرض لآرائه في السلطة أنه أرادها وتهيّبها في آن واحد.. فقد أرادها من أجل أن يطبق المبادىء الإسلامية، مبادىء العدل والحق، التي جاءت في القرآن الكريم، والتي اختطها الرسول (ص) في فكره وممارسته. وتَهيّبها لأنه كان يعرف ثقل مسؤولياتها وتحدياتها.. ولأنه كان بالغ الحرص على تطهره (السلطة ماء آجن) وعلى تجنّب كل ما يمكن أن يمسّه منها على صعيد الغطرسة، أو المال، أو ممارسة الظلم، أو الغفلة عن الرعيّة، أو التقصير فيما يخدم الإسلام، كرسالة تنويرٍ وعدلٍ، وتوحيدٍ، في ذلك العالم المعاصر. ورؤية الإمام «عليٍّ» للسلطة رؤية شاملة، ملحوظة بعمقٍ ودقةٍ في تراثه النظري، وفي ممارسته العملية.. وإذا ما أردنا أن نطلع على رؤيته الشاملة في الممارسة السلطوية الإيجابية، فما علينا إلاَّ أن نقرأ بإمعان وتأمل، رسالته الشهيرة التي أسميت «عهداً»، إلى قائده الشهير «مالك بن الأشتر النخعي» الذي عينه إذ ذاك والياً على مصر.. فهي رسالة شاملة لا تدع جانباً عامّاً أو تفصيلياً، يخص الممارسة السلطوية، على الوجه الأكمل، إلاَّ ويأتي عليه في هذه الرسالة، بدءاً من مواصفات الوالي، أو القائد العسكري، إلى طريقة الحكم، إلى مسألة العنف وإراقة الدماء، إلى الموقف من «العامة» و«الخاصة»، إلى الشروط المتوجب توفرها في الوزراء والقضاة إلى آخر ما هنالك من مواضيع جوهرية أو عادية. [نهج البلاغة المجلد الرابع ابن أبي الحديد]. لكننا عندما نقرأ الأوجه الأخرى من آرائه في السلطة، وما خلّفهُ من حِكَمٍ ومأثوراتٍ فسنذهل لشمولية آرائه، وعمقها، ومطابقتها لما رآه البشر، منذ آلاف السنين، لتجليات السلطة القاهرة، وضرورة الحذر منها سواءٌ، في الممارسة، أو في تجنّب السلطان الجائر الذي لا يمكن أن يُؤمَن جانبُه.
ورغم صعوبة الإحاطة بكل ما تعرض له الخليفة الراشدي، في فهمه للسلطة، وفي الحذر منها أو في ممارستها، أو في التعامل مع من يمارسها، فيمكن أن نوجز معالم رؤيته النظرية والعملية بالقول أنه على الصعيد النظري وضع أفكاراً وقواعد تنبىء بشخصية ديموقراطية وحكيمة سبقت عصرها في الفهم الناضج لتجليات السلطة المختلفة وأنه لا بد للسلطان من رادع. والرادع الذاتي المتمثل إما بالدين، أو بالخلق، أو بامتلاك الحكمة، أمر لا بدّ منه لممارسة السلطة ممارسة صائبة وعادلة. ولا مفرّ من أن تجتمع مع القوة الروادع السابقة، أو بعض منها على الأقل، كي نضمن سلطاناً عادلاً، كي لا يخبط في الرعية خبط عشواء [لا تنفك الدنية من شر حتى تجتمع مع قوة السلطان قوة دينه وقوة حكمته] «نفس المصدر 532». والسلطان كما قدمته الحياة وكما قدّمه التراث الإنساني يمقت الرجال المتنورين، والذين يبدون من العلم والمعرفة والحكمة والإلمام بشؤون الرئاسة ما يفوق ما لدى السلطان. لذا يرى الإمام أن «أضر الأشياء أن تعلم رئيسك أنك أعرف بالرئاسة منه» [نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المجلد الرابع ص369] كما يحذّر الإمام المتعاملين مع السلطان من التماثل معه على أي مستوى من المستويات كي لا يتركوا في نفسه بعضاً من المرارة والحقد عليهم. لذا يقول: «إذا خدمت رئيساً فلا تلبس مثل لباسه. ولا تركب مثل ركوبه. ولا تستخدم كخدمه، فتسلم منه [نفس المصدر ص538]. وإذا كان الناس يحسدون، من بُعْدٍ المقربين إلى السلطان، بسبب ما يتمتعون به من امتيازات أو توهماً منهم أنّهم يمتلكون بعض السلطة، فإن هؤلاء لا يعلمون أن أكثر الناس جزعاً من السلطان أو تهيّباً له هم أولئك الذين يخدمونه، لأن شأنهم «صاحب السلطان كراكب الأسد يهابه وهو لمركوبه أهيب» [نفس المصدر 369].
وحتى لدى الجلوس عند السلطان فلا بدّ أن يُحسبَ حساب مفاجآت قد تحدث، فتثير غضبه: «إذا قعدت عند سلطان فليكن بينك وبينه مقعد. فلعله أن يأتيه من هو آثر عنده منك فلا بد أن تتنحّى من مجلسك، ويكون ذلك نقصاً عليك وشيناً» [نفس المصدر 561] «إن هذا القول يرينا كم أن الإمام بالغ الحساسية إزاء الكرامة البشرية».
والسلطان الغشوم كاره للنصيحة، قلق، ومرتاب إزاء من يخدمه بنزاهة بسبب افتقاره إلى الثقة بالناس. وهو في كل الأحوال أميل لمن يغشه ويخونه ويداهنه. لذا يرى الإمام «علي» أن «من صحب السلطان بالصحة والنصيحة كان أكثر عدواً ممن صحبه بالغش والخيانة» [ص 562 نفس المصدر].
ويتابع الإمام، راسماً الطريقة العملية للتعامل مع السلطان داعياً إلى تقصي أكثر الحالات ملاءمة للاقتراب منه، اختياراً لأفضل تجليات المزاج، والظروف الطبيعية «لا تلتبس السلطان في وقت اضطراب الأمور عليه فإن البحر لا يكاد يسلم صاحبه في حال سكونه فكيف يسلم مع اختلاف رياحه واضطراب أمواجه» [نفس المصدر 569].
والإمام من أكثر الأئمة والرجال الذين مارسوا الحكم دعوةً وإلحاحاً على أهمية التكافؤ الإنساني.. فالبشر متساوون في نظره.. ولا يعلو مقام على مقام، إلاَّ في مجال العلم والأدب والحكمة والدين.. ولا يحق لرجل امتهان آخر على أي صعيد من الأصعدة.. وثمة قصة تؤكد مصداقية هذه النظرة.. وهي أن رجلاً أخذ يمشي وراءه وهو راكب.. فما كان منه إلاَّ أن امتعض وصرخ به: «ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن» [نفس المصدر ص392]. لكن السلبية إزاء السلطة الغاشمة لم تثنه يوماً عن التعاطي الإيجابي، ورسم الحدود المتوجبة، لتقييدها وعقلنتها وترشيدها.. وفي هذا الصدد يقول: «ينبغي للوالي أن يعمل بخصال ثلاث: تأخير العقوبة منه في سلطان الغضب.. والأناة فيما يرتأيه من رأي.. وتعجيل مكافأة المحسن بالإحسان، فإن في تأخير العقوبة إمكان العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان، طاعة الرعية.. وفي الأناة، انفساح الرأي، وحمد العاقبة، ووضوح الصواب [نفس المصدر 537].
وحتى لا نهون.. وكي لا يصدر عنا ما يسيء إلى تاريخنا ويُحسب علينا. وكي نتجنّب بطشاً محتملاً، ينصحنا الإمام «احذروا الكلام في مجالس الخوف» [نفس المصدر 542]. وذلك لأن الكلام في مجالس الخوف هو إما كلام عقيم وسطحي ولا يثير أي تفاعل ولا يقدم أية جدوى، وإما هو كلام قد يؤدي بصاحبه إلى التهلكة.
ويغوص الإمام عميقاً في فهم السلطة وبخاصة في تجلياتها السلبية «حب الرئاسة شاغلٌ عن حب الله» [نفس المصدر 535]. إذ أن السلطة إذا امتلكت قد تضع خللاً في المزاج الإنساني، نزوعاً نحو الغطرسة وانغماساً في الملذات والفساد، وإذا افتُقدت قد تضع أيضاً خللاً كبيراً في الشخصية الإنسانية التي قد تفقد بوصلتها وتوازنها «إذا انقضى ملك قوم جنو في آرائهم» [نفس المصدر ص552].
وفي فهم الإمام للسلطة انحياز صارخ للبشر العاديين، الذين يقع على عاتقهم عبء البناء والعمران.. والذين يتعرّضون للظلم السلطوي «ظلم الضعيف أفحش الظلم» [نفس المصدر ص110] وهو يشد من إزر المظلوم «يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم» [نفس المصدر ص348]. ويكرر مندداً «ألأم الناس من سعى بإنسان ضعيف إلى سلطان جائر» [نفس المصدر ص552]. ورغم مسؤولية السلطان عن جوره إلاَّ أن مسؤولية الناس ثقيلة أيضاً. ونعني بذلك أولئك الذين يضعفون أمام السلطان، مسهِّلين له بذلك سبل ظلمه. لذا يعجب الإمام من مداهنة الناس السلطة ونفاقهم إياها كما يعجب لـ«السلطان كيف يحسن وهو إذا أساء وجد من يمدحه ويزكّيه» [نفس المصدر ص565].
والوعي بالسلطة وتحولاتها المختلفة سمة بارزة في فكر الإمام كما أسلفنا.. إذ أن السلطة العادلة تعكس حالةً معينةً قوامُها الرضا والدينامية، العامة، وتحمّل المسؤولية وسيادة النزاهة والاستقامة إلخ..
وإما السلطة الجائرة فإنها تعكس مناخات مضادة تماماً، قوامها السلبية والتشاؤم والانكماش في كل مجال، وانحطاط الأخلاق وضحالة الفكر.
وعند الانتقال من سلطة إلى أخرى يحدث شبه انقلاب في عالم السلوك والقِيَم والمُثُل.. وعلى صورة السلطان تكون صورة الزمان «إذا تغير السلطان تغير الزمان» [ص 36 نفس المصدر].
والعامة في نظر عليّ هم «عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء» [المصدر نفسه] ومسؤولية السلطان مسؤولية شاملة «اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم» [المصدر السابق].
وخطابه السلطوي يجمع بين مشاعر النبل والإيجابية إزاء الرعية وبين تطلب الحزم والشدة شريطة استخدامها في الزمان والمكان المناسبين. ويتضح هذا التصور في رسالة أرسلت إلى قيس بن عبادة الأنصاري «سر إلى مصر فقد وليتكها. واجمع إليها ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جند، فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك. فإذا أنت قدمتها، إن شاء الله فأحسن إلى المحسن واشتد على المريب وأرفق بالعامة والخاصة فإن الرفق يمن» [مصدر سبق ذكره].
وهذا الإصرار على التناغم والمزاوجة بين الشدة واللين، يدلل على مزاج رجل سلطة يهمه النجاح في إقامة العدل، أكثر ما يهمه نجاحه السلطوي، واستمراره الطويل في موقع السلطة، على حساب المبادىء ومعاناة العامة. كما يدلل في نفس الوقت على أن الإمام يتعامل مع بشر يحبهم ويتحاشى إلحاق أي ضرر بهم «اخفض للرعية جناحك. وابسط لهم وجهك وألن لهم جانبك، وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك» [نهج البلاغة. ابن أبي الحديد ص110 المجلد الرابع].
ويتسم خطابه العام وبخاصة فيما يعني السلطة بتحيّز حاسم إزاء العامة.. وهو تحيُّز تظهره رسالته إلى الأشتر النخعي الذي رشح والياً على مصر كما أسلفنا.. وذلك لأن «العامة هم عماد الدين وجماع المسلمين، والعدة للأعداء» [نهج البلاغة المجلد الرابع] ومسؤولية السلطان شاملة لا تستثني أحداً، كما لا تستثني البهائم والأرض والممتلكات «اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. أطيعوا الله ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه [الثقافة الإسلامية العدد 52 العام 1993]. وخطابه السلطوي يجمع بين مشاعر النبل والمحبة والإيجابية إزاء الرعية وبين تطلّب الحزم والشدة شريطة استخدامهما في المكان والزمان المناسبين.
العلم والمشورة:
تتجلى الحكمة في فكر الإمام عليّ بن أبي طالب على أهم القضايا جوهرية وحساسية في حياة البشر.. وبمزيج نادر من التأمّل الشامل في شؤون الحياة، يقدم حكماً ومأثورات إيجابية تغطّي معظمَ إن لم يكن كل الهواجس البشرية. وفي النصوص التالية تباعاً سنرى مدى انخراط الإمام في شؤون الحياة. ومدى فهمه لعقول البشر وميولهم وهواجسهم وتقلباتهم وأمزجتهم المختلفة والمتناقضة. وسنرى أنه أعطى وبصورة مبكرة مسألتي المشورة والعلم الأهمية الجديدة.
ورغم الجراح المريرة التي أصابته في حياته والمتأتية عن رؤيته خذلانَ الناس للقضايا العادلة، وأنانيتهم وجشعهم وارتدادهم المبكر، وترددهم، وانغماسهم في الفساد، وفي ممالأة السلطة، سعياً وراء الامتيازات والمنافع.. فلقد كان إيجابياً يحضُّ على العلم والمشورة، ويقدم لمعاً حكمية، تدل دلالة قاطعة على رجل خبر الحياة في كل اضطرابها والناس في كل تحولاتهم، مهما اتخذت تلك التحولات من لبوسات غامضة وحذرة. ونرى الإمام في قوله وفي فعله يُعلي من شأن العلم إعلاءً كثيراً، إلى درجة أنه يعتبره سلاحاً ناجعاً وحاسماً «العلم سلاح من وجده صال به ومن لم يجده صيل عليه» [المصدر السابق 560].
وتذكرنا وجهة النظر الآنفة بوجهة النظر الحديثة التي تؤكد أنه في الصراع العالمي الدائر فإن الغلبة لمن يخوض معركة بالعلم على مختلف الأصعدة والمستويات. وإذا كان ينظر للعلم بهذه الأهمية، فمن البديهي أن ينظر للعلماء بالأهمية المماثلة. لأن العلماء هم الذين ينشرون العلم، وينقلون المجتمعاتِ نقلاتٍ نوعيةً هي أشبه بانقلاب كبير. ولهذا فهو يحث على تكريم العلماء وإنزالهم المنزلة اللائقة.. كما يحث الحكام على التعامل الدائم معهم، استعانةً ومشورةً وأخذاً مما لديهم من علم وحكم ووجهات نظر:
«أكثر من مدارسة العلماء ومناقضة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس [الثقافة الإسلامية عدد 52 محمد باسم صندوق] وهو ينظر إلى العلماء بأهمية تفوق تلك الأهمية التي يوليها للحكام «الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك» [552 نهج البلاغة، ابن أبي الحديد].
ويتابع مكرساً المكانة المرموقة للعلماء إذ يقول أن «الجاهل صغير وإن كان شيخاً والعالم كبير وإن كان حدثاً» [564.. نفس المصدر].
وأي جشع هو جشع مستهجن باستثناء الإقبال على العلم والنهم إليه الذي لا يمكن أن يقف عند حد معين «نهومان لا يشبعان طلب عالم وطالب دنيا» [نفس المصدر 504]. و«كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلاَّ وعاء العلم فإذا يتسع» [نفس المصدر 335] والعقلاء لم يصبحوا عقلاء إلاَّ بمقدار ما نهلوا من علم وخاضوا من تجارب وأصغوا وتحاوروا وعايشوا عقلاء وحكماء مثلهم. لذا يدعو الإمام إلى مجالسة العقلاء سواء كانوا أعداء أم أصدقاء لـ«لأن العقل على العقل يقع» [556 نفس المصدر] ومن يَصِمْهُ العلماء، فهو مذموم. وذمُّه هنا أشدُّ وطأةً على الصعيد الأدبي، من أية عقوبة أخرى يوقعها السلطان (ذم العقلاء أشد من عقوبة السلطان) [540 نفس المصدر]. وكثيراً ما نرى الحكمة لديه وقد وصلت إلى مستوى كبير من الإحاطة والتكامل «لا غنى كالعقل. ولا فقر كالجهل. ولا ميراث كالأديب. ولا ظهير كالمشاورة» [نفس المصدر 267].
وأما المشورة فإنه يعالجها بعمق وفيما يتعدّى الصورة التقليدية التي وجدت لدى حكماء آخرين. إذ أنها مطلوبة كي لا يحدث الخطأ. ومطلوبة من أجل العدل. ومطلوبة امتحاناً للعدو والصديق. كما أنّها مطلوبة كي لا يتعثّر السلطان، أو كي لا يقع في ممارسة الظلم سواء عن حسن نية أو عن سوئها. وفي كل هذا الحالات وفي غيرها نرى حكماً عميقة، مستقاةً في فكرٍ نافذٍ وتجربة فذةٍ.
فعندما يدعو إلى مشاورة العدو «استشر عدوك لتعرف مقدار عداوته» [نفس المصدر 559] تأخذ الاستشارة بعداً أكثر عمقاً، يتعدى مستوى امتحان عدو ملتبس بغية معرفة عداوته، لتصل إلى مستوى امتحان المسؤولية الأخلاقية للبشر. إذ عندما يُستشار امرؤ حتى من قبل عدوه، يجدر به أن يتحرر من عدائه، مهما كانت درجة هذا العداء. لكن استشارة الأعداء مُرةً. ولا شك أن المرء لا يطلبها إلاَّ في حالات عصيبة. لذا وضعها الإمام في موقعها «استشارة الأعداء من باب الخذلان» [نفس المصدر 552].
وينتقل بنا الإمام الحكيم من مستوى إلى مستوى أرقى وأبعد في نشدان المشورة وتطلّبها. إذ هي ليست امتحاناً لدرجة العداوة، وحسب، وإنما هي امتحان لنزوع الإنسان للعدل والخير، ولمقدرته على تجاوز أزمة العداء مهما كانت مستحكمة: «إذا عرفت طبع الرجل فاستشره فإنك تقف من مشورته على عدله وجوره وخيره وشره» [نفس المصدر 538]. والمشورة بقدر ما توفر لنا وعلينا من عناء التأمّل والبحث عن حلول للمعضلات التي تعترضنا، فإنها تشكل تعباً سواء لمن تُطلب منه أو لمن يقع عبء المواجهة عليه «المشورة راحة لك وتعب على غيرك» [572].
وبقدر ما يجب أن تضيق دائرة السر يجدر أن تتسع دائرة المشاورة حسب رأي الإمام: «اجعل سرك إلى واحد ومشورتك إلى ألف» [نفس المصدر 555]، «من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ» [نفس المصدر 326]. وهذا ما يمكن الساعي إلى الاستشارة من امتلاك أفكار وحلول وآراء أكثر نجاعةً في معالجة المعضلة التي هو بصدد معالجتها.
والمشورة مطلوبة من أي مصدر يقدم على تقديمها بما يمتلكه من حكمة وخبرة.. غير أن للإمام رأياً يعكس عقلاً حادّاً وناضجاً وخبيراً بما لدى البشر من طاقات في مختلف أعمارهم وبخاصة في مرحلة الشباب «إذا احتجت المشورة في أمرٍ قد طرأ عليك فاستبدِ ببداية الشبان، فإنهم أحدّ أذهاناً وأسرع حدساً، ثم رده بعد ذلك إلى رأي الكهول والشيوخ ليستعقبوه ويحسنوا الاختيار له» [نفس المصدر 568].
تكامل الحكمة وشموليتها:
من الأهمية بمكان التأكيد المستمر على أن الإمام «عليّ» كان نموذجاً للبطل الإيجابي في الحياة.. بمعنى أنه برغم كل ما حفلت به التجربة الإنسانية عبر التاريخ المعروف للبشر من مآسٍ وويلات واكتواء بنيران الأنانية والجشع والنزوع إلى الغطرسة والقوة والتجبّر، وبرغم كل تعقيدات التجربة الإسلامية ومرارتها وانتكاساتها المبكرة، فإنه ظلّ يصدر عن فكر إنساني إيجابي رحب، داع إلى المسؤولية والجد والتواصل الإيجابي بين البشر.
ومن الظلم بمكان أن يقرأ تراثه المعرفي في قراءة سلبية، أو أحاديةً، إبرازاً لجانب المرارة الذي كان يبديه في ظروف عصيبة اتصفت بالضعف والتخاذل والانسحاب من مسؤوليات وتطلبات الموقف التاريخي. في حين مضى هو يدفع الثمن الباهظ، ويسجل الأمثولة الكبيرة التي لما تزل حية وملهمة حتى الوقت الحاضر. ومصدر إيجابية الإمام علي ينبع من ممارسته العملية والفعلية لقناعاته وأفكاره. وهو لم يدعُ أبداً إلى الانسحاب من معركة الرسالة التي يحملها الإنسان. ومن أداء ثمن نصرة هذه الرسالة، حتى لو كان هذا الثمن هو الحياة نفسها. ولقد ترك لنا تراثاً جديراً بأن يضاف إلى التراث الإنساني الفذ الجدير بأن يكون بمثابة بوصلة تضيء طريق الإنسان الذي لا يكف عن النضال والمجاهدة في سبيل نصرة الحق والفضيلة والعدل: «يا بني اجعل نفسك ميزاناً بينك وبين غيرك. فأحبب لغيرك ما تحبه لنفسك. وأكره له ما تكره لها. ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك. ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك» [الثقافة الإسلامية العدد 52/1993]. ولماذا يصطرع الناس ويأكلُ بعضهم بعضاً، إذا كان أي منهم يحب للآخرين ما يحب لنفسه؟.
لا يمشي الناس خبط عشواء، وما من حركةٍ إلاَّ ويحتاج فيها الإنسان إلى معرفة، هكذا يقول تراث الإمام. إنه يرصد من خلال التجربة والمسؤولية والتأمّل، وليس من برجٍ عالٍ. لقد خبر الناس والعلاقات في كل حالات القوة والضعف وانعدام الرؤية ووضوحها.
كا ما نهجس به.. وما يخطر وما لا يخطر في البال مرئيّ وملحوظٌ في حكمته: الإلحاح على العمل.. الدعوة إلى التكافؤ في العلاقات الإنسانية.. تزكية التأمّل الإنساني.. شجب الجشع وإدانة الفقر.. الدعوة إلى استغلال الزمن استغلالاً إيجابياً إلى الحد الأقصى.. تقوية الذات وتحصينها ضد الشهوات.. التزام الحق والعدل ولو أدّى ذلك إلى الخسران والهزيمة.. المسؤولية إزاء الذات وإزاء الآخر وإزاء المجتمع.. الدعوة إلى نبذ الخوف والانخراط المقتحِم والفاعل في التجربة الإنسانية.. الدعوة إلى التعاطي الإيجابي مع الناس، انطلاقاً من أن حسن الظن هو القاعدة مع توجب الحذر وبخاصة من السلطان.. الإلحاح على عدم الإذعان للعادة القاهرة.. الجهاد والمجاهدة بدءاً من الدائرة الخاصة وحتى أنأى الدوائر.. تعليم النفس كمسؤولية أولى.. التمتع بمزاج إيجابي دائم وعدم «استيحاش الطريق» مهما قلّ المجاهدون وخذلت القضايا العادلة، إلى آخر ما يلح على العقل والضمير الإنسانيين من هواجس ومسائل عادية أو كبيرة.
إننا إزاء «نصٍ» ـ [حكمة] بالغ الكشافة قوامه التأمّل العميق المستخلص من تجربة عميقة وثقافة تتسم بالشمولية، يلحُّ على استشعار عظم المسؤولية وجماليتها وروعتها تطلباً للحق والعدل «ما خاب امرؤ عدل في حكمه وأطعم من قوته وذخر من دنياه لآخرته». [نفس المصدر ص530].. ولذا فمهما كان الثمن الذي يدفعه الإنسان في حياته فليكن شعاره: «اختر أن تكون مغلوباً وأنت منصف ولا تختر أن تكون غالباً وأنت ظالم» [نفس المصدر 532].
ولأن الحياة رسالة مضنية بسبب ما يعترض الإنسان الصالح فإن «موت الصالح راحة لنفسه، بينما موت الطالح راحة للناس» [نفس المصدر 538].
والرجل الصالح، سيّد القوم، أو الذي يصلح أن يكون سيدهم، هو رجل يعنيه ما يمثله وما يقوم به، ولا يعنيه اعتبارٌ آخر يتعلّق بطعام أو لباس أو مظهر، أو أي مجد زائف لا يُعتَدُّ به «لا يكون الرجل سيّد نفسه حتى لا يبالي أي ثوبيه يلبس» [نفس المصدر 542].
و«عليّ» لا يهجس بحكمة الحاضر والماضي، وإنما بالحكمة المستمرة والشاملة، والشاملة لكل تقلبات الحياة وتغيرات القِيَم سمواً وارتداداً. وفي مجال العسر واليسر يقدم الحكمة التي لا يميتها الزمن: «إذا أيسرت فكل الرجال رجالك. وإذا أعسرت أنكرك أهلك» [نفس المصدر ص546]. ولأن كرامة الإنسان كانت الأثمن لديه، نرى تراثه يحفل بما يلح على التصرف الذي يحافظ عليها. حتى لكأن هذا الخليفة العظيم مكرِّسٌ فكره وعقله وكل ذاته، للدفاع عن كرامة البشر وإعلاء شأنهم.. ولذا نراه يكتب راصداً الحالات الإنسانية في كل تجلياتها.. داعياً في كل ما يصدر عنه إلى التشبث بالقِيَم والدفاع عن كرامة الإنسان مندداً إلى ما لا نهاية بالصلف والذل والصغار والفقر والضعف أمام الرغبات الخاصة وكل خضوع باستثناء الخضوع أمام الحق والعدل.
● «رب صلف أدى إلى تلف» [546].
● «السفلة إذ تعلموا تكبروا.. وإذا تمولوا استطالوا.. والعلية إذا تعلّموا تواضعوا وإذا افتقروا صالوا» [547 نفس المصدر].
● «ما وضع أحدٌ يَدَهُ في طعام أحد إِلاَّ ذلّ به» [547 نفس المصدر].
● «تواضع الرجل في مرتبته ذبٌّ للشجاعة عند سقطته» [546 نفس المصدر].
● «الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع» [548 نفس المصدر].
● «لا تصحب في السفر غنياً فإنك إن ساويته في الإنفاق أضرَّ بك وإن تفضّل عليك استذلّك» [553 نفس المصدر].
● «احتمال الفقر أحسن من احتمال الذل.. لأن الصبر على الفقر قناعة والصبر على الذل ضراعة» [548 نفس المصدر].
● «عبد الشهوة أذلّ من عبد الرق» [570 نفس المصدر].
● «الغنى الأكبر اليأس عما في أيدي الناس» [394 نفس المصدر].
● «المنية ولا الدنية والتقلل ولا التوسل» [427 نفس المصدر].
● «من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته» [479 نفس المصدر].
● «ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى» [42 نفس المصدر].
● «احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع» [465 نفس المصدر].
● «فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها» [273 نفس المصدر].
● «ما ابتلى الله أحداً بمثل الإملاء له» [291 نفس المصدر].
● «من أمل أحداً هابه ومن جهل شيئاً عابه» [554 نفس المصدر].
● «إذا كنت في مجلس ولم تكن المحدَّثَ أو المحدِّث فقم» [556 نفس المصدر].
● «من وطأته الأعين وطأته الأرجل» [555 نفس المصدر].
● «إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذاك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن لا يعجبنك إن أكرمك الناس لدين أو أدب» [557 نفس المصدر].
وينقلنا الإمام عليٌّ المتأمل ملياً في جميع شؤون وشجون الحياة، من اهتمام إلى اهتمام ومن حقل إلى حقل.. وفي كل حقل من الحقول التي يرتادها يرينا مدى إيغاله في فهم النفس الإنسانية في سموها وسقوطها.. ويلحُّ علينا في كل شأن، أن نتسلح بالسلاح الناجع.. غير أن أمضى الأسلحة لدى هذا الخليفة المتفرد هي أسلحة العدل، والحق، والحكمة، والأناة، والعقل المهذَّبِ بالتجارب، والقناعة المختارة من ضرورة التحرر من ضغط الحاجات المذلة.
وللحلم مقام كبير في تراث علي.. وهو مقام يذهب إلى مستوى الإدهاش والتساؤل: من أية تجربة ومجتمع استقى هذا الإنسان العظيم كل تلك الثقافة والعقل الحصيف؟ لا سيما وأن المجتمع الذي بدأ يصيغه الإسلام وينقله من حالة إلى حالة أرقى، كان مجتمعاً بسيطاً في كل شأن من شؤونه. إن جدية الإمام الكبيرة إزاء المشروع الإسلامي الكبير وغنى شخصيته الفذة قدمتا حكمة التأمّل والحلم والواقع.
ومن أجل النجاح في المشروع الإنساني الكبير لا بدّ من التأمل «أصاب متأمل أو كاد أو أخطأ مستعجل أو كاد» [نفس المصدر 548].
والحلم في نظر الإمام قوة.. فهو الذي يتسبب بالنصر.. وهو الذي يحجم الهزيمة في حال وقوعها. وهو الذي يستقوى به في كل الحالات وكأنما هو حارس يقظ بالمعنى الإيجابي لنا وعلينا.. لذا يصف الإمام الحلم وصفاً قلَّ نظيره: «الحلم عشيرة» [نفس المصدر 469]. والعشيرة هي التي تنصر أفرادها وتقويهم وتستقوي بهم. وهي التي ترعاهم وتوجههم وتحرسهم أيضاً.
وفي كل مناسبةٍ، يلح الإمام على الفرد العادي وعلى السلطان، بضرورة التعامل مع أهل الحكمة والتجارب «عليكم بمجالسة أهل التجارب فإنها تقوم عليهم بأغلى الغلاء ونأخذها منهم بأرخص الرخص» [نفس المصدر ص567].
ونستطيع أن نمتلك الحلم بالمحاولة تلو الأخرى.. أو بمحاولة الاقتداء والسير على طريق ذوي الحلم والتشبه بهم «إن لم تكن حليماً فتحلّم، فإنه قلَّ من تشبهَ بقومٍ إلاَّ أوشك أن يكون منهم» [ نفس المصدر 335].
والإلحاح على التجربة.. على الانخراط الدينامي في معارك الحياة ومسؤولياتها، ملحوظ في تراث الإمام إغناءً للعقل والروح والشخصية والإنسانية: «العقل غريزة تربيها التجارب» [نفس المصدر 570].
وليس ثمة امتحان لعقل الإنسان أكثر من التعامل اليومي حيث لا يقدر الناس على إخفاء عاهاتهم والنقص في عقولهم عند الاحتكاك بهم.
كما أن «الولاية ـ السلطان» هي امتحان للبشر فيما إذا كانوا ينزعون نحو القوة والبطش أم كانوا ينزعون للحلم والعدل أثناء ممارستهم للسلطة «العقل يظهر بالمعاملة وشيمة الرجال تُعرف بالولاية» [نفس المصدر 550].
ويكاد كلامنا.. لساننا الذي هو أداة الكلام يفصح عن ماهيتنا، ويبرز معدننا الحقيقي، وما هو مخبوء في أعماقنا «تكلَّموا تُعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه» [نفس المصدر 421].
وتحدي الحلم يظهر أثناء الغضب، وليس في اللحظات العادية في حياة الإنسان.. إذ في حالة الغضب تُمتحن على أقصى ما يكون الامتحان والمسؤولية والقدرة على ضبط النفس في الحالة العصبية التي يخرج فيها الناس العاديون عن طورهم «ليس الحلم ما كان حال الرضا.. بل الحلم ما كان حال الغضب» [نفس المصدر ص557].
ويحمّل الإمام «عليّ» الإنسان، مسؤوليةَ سكونه واختياره، إذ «الشيطان» الشر شيء كامن في النفس وليس خارجها «شيطان كل إنسان نفسه» [نفس المصدر 547]. والشيطان في كل الأحوال هو أهواؤنا الخاصة عندما تغلب علينا. ومن أهم المواقف في تراث الإمام موقفه من الفقر.. إذ هو موقف يتخذ أبعاداً فلسفية وأخلاقية وإنسانية عميقة. ويصلح الفقر في فكره أن يكون موضعاً مستقلاً لمعالجة مستقلة. ويمكن أن نلحظ هذه الأبعاد المتعددة من خلال أقواله: «الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل داعية للمقت» [نفس المصدر 320] «الفقر هو الموت الأكبر» [نفس المصدر 321] «الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن» [نفس المصدر 321]. غير أن الفقر الذي تجب مقاتلته بكل السبل «لو تمثل لي الفقر رجلاً لقتلته» يجدر أن لا يصل تبرمنا به إلى درجة الكفر إذعاناً ويأساً.. كما لا يجدر أن يدفعنا الغنى إلى درجة البطر والطغيان «لا يكن فقرك كفراً وغناك طغياناً» [نفس المصدر 548].
ويتعدّى فكر الإمام، الثوابت والأقانيمَ الكبرى، ليطال تفاصيل لا تحصى، من الهواجس والعلاقات الإنسانية المهمة أيضاً.
فعل صعيد الصداقة يُعلي الإمام من شأن هذه العلاقة المقدّسة.. ويفضلها حتى على علاقة الأخوة، إذ «الصديق نسيبُ الروح والأخ نسيب الجسد» [نفس المصدر 549] «أقصر الناس من قصَّر في طلب الصديق.. وأعجز منه من وجده فضيّعه» [نفس المصدر 549] وليس سهلاً ـ هكذا تقول الحكمة الإنسانية ـ العثور على الصديق الوفي.. لذا يقول الإمام: «أبعد الناس سفراً من كان في طلب صديق يرضاه» [نفس المصدر 552].
ويدعو الإمام إلى الاحتراس في ملحمة الحياة الصعبة لأن «الضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي المغترّ بالعدو الضعيف» [نفس المصدر 552] لكن الاحتراس ليس «خارجياً» وحسب، وإنما هو داخلي أيضاً. لذا يتوجب على الإنسان أن يمعن في تأمّل عيوبه بعين العدو المترصد المدقق «كن في الحرص على تفقد عيوبك كعدوك» [نفس المصدر 553].
ويتابع الإمام متحرّياً، ومدققاً، ومتقصِيّاً، ومطاولاً كل جانب وكل هاجس إنساني: «ليس تكمل فضيلة الرجل حتى يكون صديقاً لمتعاديين» [نفس المصدر 556]. «ما انتقم الإنسان من عدوه بأعظم من أن يزداد من الفضائل» [نفس المصدر 566]. لكن هذه الهواجس في مجملها تتمحور حول العدل وهزم الشر في النفس وفي المجتمع «أعم الأشياء نفعاً موت الأشرار» [نفس المصدر 565]. «العدل أفضل من الشجاعة لأن الناس لو استعملوا العدل عموماً لاستغنوا عن الشجاعة» [نفس المصدر 565]. لكنه وهو يقتحم الحكمة تأملاً وتمرساً في شجون وشؤون الحياة يعرج على مسائل تتعلق بضرورة الاتعاظ بما نمر به ونعانيه «أجهل الجهال من عثر بحجر مرتين» [نفس المصدر 566].
وتصل حكمته الإنسانية إلى القمة عندما يقول قولاً ربما لم يضاهه قول سابق في فهم فلسفة الزمن وكيفية التعامل معه تعاملاً إيجابياً يعكس المستوى الحضاري والأخلاقي للشخص المعني «من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أدّاه، أو مجدٍ بناه، أو حمدٍ حصّله، أو خيرٍ أسَّسه، أو علم اقتبسه، فقد عقَّ يومه» [نفس المصدر 567]. ولأن الإمام خبير في النفس الإنسانية سمواً وصلابة، ضعة وضعفاً فهو يقول منبّئاً: «يأتي على الناس زمنٌ عضوضٌ يعضُّ فيه الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك وتنهد فيه الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون» [نفس المصدر 519] ويدعو إلى حياة إنسانية مفعمة باللطف والمحبة والغنى في التواصل الإنساني: «خالطوا الناس مخالطةً إن متم معها بكوا عليكم.. وإن عشتم حنوا إليكم» [نفس المصدر 245]. ولأن كل مثلبةٍ تقود إلى أخرى وصولاً إلى الانهيار يقول الإمام محذراً: «الاستئثار يوجب الحد.. والحسد يوجب البغضة.. والبغضة توجب الاختلاف.. والاختلاف يوجب الفرقة، والفرقة توجب الضعف.. والضعف يوجب الذل.. والذل يوجب زوال الدولة وذهاب النعمة» [نفس المصدر].
ولأن الإمام إيجابي في فكره وفي سلوكه لذا لا يحذّر وحسب.. وإنما يوصي ويرسم ملامح الطريق.
«لا يرجون أحد منكم إلاَّ ربه. ولا يخافن إلاَّ ذنبه. ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. ولا خير في جسدٍ لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه» [نفس المصدر 279].
وينفرد الإمام بنظرة غير تقليدية للإيمان الذي يجب أن يتجسد بسلوك عملي «الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد» [نفس المصدر 254]. ويحذر الإمام من إبداء مشاعر البغضاء والضغينة.. وذلك لأن «الضغائن تورث كما تورث الأموال» [نفس المصدر 552].
وترينا حكمته النزّاعة باستمرار نحو العدل، الجانبَ العمليَّ المتوجبَ، في سلوكنا الحياتي، إذ لا نستطيع أن نؤدي دوراً إيجابياً في الحياة بدون امتلاك شخصية ومصداقية الرجل العادل..
وهو غير هيّاب من التجربة الإنسانية، إذ يدعو إلى اقتحامها بسلاح الصدق والعدل والشجاعة والرؤية النافذة «إذا هبت أمراً فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه» [نفس المصدر 326].
كما يدعو في تراثه الحافل إلى أن يطبع الجهاد حياتنا إذ «لا صلحت دنيا ولا دين إلاَّ به» [الثقافة الإسلامية العدد (21) 1988].
وبعد: هل أحطنا بحكمة الإمام علي بن أبي طالب؟ هل أحطنا به مفكراً وحكيماً ومتأملاً؟
نعتقد أن الإمام سيظل جديراً بأن يدرس تاريخاً وتراثاً ومثالاً.
لقد أَرَادَنا على مرّ السنين والأجيال أن نكون نموذجاً كاملاً ما أمكن.. أو اقتراباً من الكمال.
ولعلنا لا نقدر أن نقدم تصوراً لما ينشد من الكمال البشري أكثر من التصور التالي نختم به الدراسة. ونحن مأخوذون حتى الثمالة بهذه الشخصية التي تحضرنا في أنبل وأعظم تجلياتنا.. والتي تحضرنا في بأسنا وقنوطنا وحاجتنا العصيبة لمن يقول لنا قولاً فصلاً في كل حالة من حالاتنا العادية والعصيبة:
«كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه. وكان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد.. ولا يكثر إذا وجد. وكان أكثر دهره صامتاً، فإن قال بذ القائلين ونقع غليل السائلين. وكان ضعيفاً مستضعفاً، فإن جاء الجد فهو ليث عادٍ، وصل وادٍ، لا يأتي بحجة حتى يأتي قاضياً. كان لا يلوم أحداً على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره. وكان لا يشكو وجعاً إلاَّ عند برئه. وكان يفعل ما يقول ولا يقول ما لا يفعل. وكان إن غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. وكان على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم. وكان إذا بدهه أمران نظر أيهما أقرب إلى الهوى فخالفه. فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها، فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير» [نفس المصدر ص378].
يوسف عبد الحميد
الإمام علي (ع) وحقوق الإنسان
تعتبر حقوق الإنسان أهم إنجاز تحقق في المجال الحقوقي والسياسي في العصر الحديث. ولم تكن هذه الحقوق هبة من الحاكمين، بل أتت بعد سيول الدماء والعذاب والمعاناة التي تكبدتها الشعوب على أيدي الملوك والأباطرة.
وكان الغرب أول ما عرف شيئاً عن هذه الحقوق في القرن الثالث عشر في بريطانيا حيث أصدر الملك جون ابن الملك هنري الثاني ما سُمي «الشرعة العظمى» Magna Carta في حزيران سنة 1215م لتضع حداً لصلاحيات الملك وموظفيه في مجال الضرائب وحجر الأموال وليعترف للمواطنين بحق التنقل، ولتسهيل التقاضي.
ثم تلت هذه الشرعة ما سمي «بالهابياس كوربس» Hapeas corpus سنة 1679م وهي تعني واجب الموظف المولج بالسجن أن يحضر السجين إلى المحاكمة فور طلبه، وحظر إبعاده المواطنين.
وتلا الهابياس كوربس ما سُمي «بشرعة الحقوق Bill of rights سنة 1689م والتي حرمت الملك من حق تعليق القوانين واستحداث المحاكم الخاصة وفرض الضرائب والتجنيد في حالات السلم، وأعطت المواطنين حق الادعاء بوجه الملك وسمحت للأمراء بالاحتفاظ بالسلاح للدفاع عن النفس، كما فرضت حرية الانتخاب ومنحت النائب الحصانة ومنحت التمييز أمام القضاء.
وبعد 87 سنة صدر إعلان فرجينيا في أميركا، الذي أكّد المساواة الطبيعية وحق الحياة والحرية والتملك، كما فرض فصل السلطات بعد أن اعتبر الشعب مصدرها.
وفي السنة نفسها وضع إعلان الاستقلال الأميركي الذي أقرَّ الانفصال عن بريطانيا لما ارتكبه الملك من تجاوزات في الحد من الحرية للمجالس التمثيلية وعدم تقيده بالقوانين وفرضه الضرائب الباهظة وإقامته الجيوش غير الضرورية في المستعمرات.
ثم وضعت التعديلات العشر الأولى للدستور الأمريكي التي أكدت الحريات العامة والحقوق الفردية، كالحريات الدينية وحرية الفكر والتجمع وحمل السلاح وحرمة المنازل والتعويض في حالة الاستملاك ومشاركة المحلفين بالمحاكمات.
ثم صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا سنة 1789م، ليعلن المساواة والحرية وكون الشعب مصدر السلطة ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، كما أكد على حرية المعتقد وحرية التعبير عن الرأي وعدم فرض الضرائب إلا في سبيل الصالح العام وعدم الاستملاك إلاّ في سبيل المصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
وبعد الحرب العالمية الثانية أقر في فرنسا في مقدمة دستور 1946م نظام للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أضيف إلى إعلان الحقوق التقليدي، فاعترف بمساواة الجنسين: الرجال والنساء وبالحرية النقابية وبالحق في التعليم وكذلك الحق في السكن والتعليم المجاني والحق بالراحة.
أما على الصعيد العالمي فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما سمي «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» في العاشر من كانون الأول سنة 1948م، الذي اعترف بالكرامة الإنسانية معلناً المساواة والإخاء بين جميع الشعوب ومؤكداً على الحرية والسلامة البدنية وعلى الضمانات القضائية كما على حرمة المسكن وسرية المواصلات والمراسلات وعلى حرية التنقل والحق في الزواج وحق الملكية والحريات الفكرية وحرية التجمع والحريات الديمقراطية عن طريق المساهمة في إدارة شؤون البلاد وتولي الوظائف والمشاركة في الانتخابات العامة.
كما أكد الميثاق على الحق في الضمان الاجتماعي والعمل والتربية والتعليم، ولم يسمح للحكومات بتقييد الحريات إلا بموجب قانون.
هذه النصوص التي دفعت الإنسانية في سبيل الحصول عليها ثمناً باهظاً لم ترقَ إلى مستوى الاعتراف المطلق بحقوق الإنسان وحرياته بل هي سمحت في المجال الداخلي ـ داخل الدولة ـ بتقييدها كما أنها أخضعتها في زمن الحروب والظروف الاستثنائية وفي حالات المشاكل والكوارث الداخلية لقوانين الطوراىء.
أما على الصعيد الخارجي فهي لم توضع موضع التطبيق إلا بشكل خادع بعض الأحيان، حيث رأينا عمليات الغزو والسلب والنهب والتقتيل أصبحت ديدناً للدول الكبرى حيال سكان الدول الضعيفة والمستعمرة.
وبعد كل هذا نرى الحاكمين لا يتعاملون مع النصوص على أساس الإيمان العميق بمضمونها وبروحها، بل هم ينظرون إليها كقوانين يمكن البحث عن طريق للتحايل عليها والتخلص من التزاماتها.
أما مسألة أن يكون الشعب مصدر السلطة، فهي حقوقياً من الأوهام Fictions التي لا يمكن أن تطبق بشكل صادق وأمين. فقد كان الأمر شعاراً طرح في مواجهة السلطة البابوية والسلطة الملكية اللتين تمسكتا بالحق الإلهي وبأن الله أو الملك هو مصدر السلطة.
ولكن على الصعيد العملي يقتصر دور الشعب الذي يعبّأ بأيديولوجية معينة أو بأيديولوجيات أن يختار من تفرضهم هذه الأيديولوجيات بشكلها الواقعي. فالشعب لا يفرز بشكل واعٍ قيادات يفوّض إليها السلطة، بل هو يوافق على الاختيار بين هذا أو ذاك ممن تصدوا أو دُفعوا بواسطة قوى المال والقوى الضاغطة إلى التصدي، الأمر الذي لا يقره الإسلام في أساسه النظري لأن الإسلام يؤمن بأن السلطة مصدرها الله، فعلى من يتصدى لها أن ينفذ أوامر الله بدقة.
لقد قيد الإسلام الحاكم بالأوامر والنواهي وأوجب عليه الالتزام بها، فكان بعض الحاكمين ملتزماً بها وبعُد حكم الآخرين عنها، والسؤال هنا كيف كان موقف الأحكام الإسلامية من ما سُمي حقوق الإنسان، وكيف جسّد أحد أبرز الملتزمين بهذه الأحكام، الإمام علي بن أبي طالب، هذا الأمر؟
كان الإمام علي يحكم بما أنزل الله([266]) وكان يوصي عماله بالحكم بذلك. فكان يرى أن الحاكم مقيد بعدد من القيود الشرعية فعلاً لحالات من الضيق والشدة. بل إن فترة حكمه كلها كانت ظرفاً استثنائياً بمفهوم اليوم، وهي تبرر بشرائع اليوم اللجوء إلى صلاحيات ديكتاتورية، ولكن الإمام بقي محافظاً على التعاليم الإلهية فلم يحدّث نفسه بخرقها، وهو الذي كان يقول: «قد يرى الحوّل القلَّب وجه الحيلة ودونها أمر مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي العين بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين»([267]).
كما كان يفسر عدم لجوئه إلى خرق الحقوق ولا سيما حق المساواة ليكسب زعماء القبائل بالسؤال: «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وُلّيت عليه؟ والله لا أطور به ما سمر سمير وما أمَّ نجم في السماء نجماً..»([268]).
أما القيود التي ألزم الإمام نفسه بها والتي ألزم كل حاكم إسلامي بها نظراً لتمسكه بها في أحلك الظروف، فهي عديدة ويمكن تصنيفها تصنيفاً حديثاً كما يلي:
الحق في الحياة
كان الحكام في السابق يتصرفون على أنهم المالكون لأرواح الناس، فكان لا يمنعهم مانع من قتلهم أو التضحية بأرواحهم بإرادتهم الخاصة، ولكن الأديان السماوية أتت لتضع حداً لهذا الحق المزعوم معتبرة أن الله هو رب البشر لا الملوك ولا الأباطرة، وهذا ما تقيّد به علي وأمر عماله أن يتقيدوا به. يقول في عهده لمالك الأشتر عندما ولاّه مصر: «إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس من شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا فيه من الدماء يوم القيامة. فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله وعندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن»([269]).
هذا مبدأ طبّقه عليّ بكل دقة لا سيما في مشاكله مع الخوارج، فهؤلاء خرجوا من الكوفة والبصرة وتجمعوا مسلحين. فلم يبادر الإمام إلى قتالهم وقتل أي منهم فيما كان يجهز للمسير إلى الشام، فكان جماعته يتخوفون من انقضاض الخوارج على النساء والذراري، أثناء غياب الرجال في الحرب، لذلك كانوا يطالبون بضربهم. ولكن علياً كان يرفض معتبراً أن ليس له الحق في هذا الأمر([270])، وكان يقول للخوارج: «لا نبدأكم بحرب حتى تبدؤونا به»([271]).
وهذا ما طبقه عليّ في مناسبات أخرى. فقد أتاه الخريّت بن راشد ذات يوم فقال له: «.. إني خشيت أن يفسد عليك عبدالله بن وهب وزيد بن حصين (من رؤوس الخوارج) قد سمعتهما يذكرانك بأشياء لو سمعتها لم تفارقهما حتى تقتلهما.
فقال علي: «إني مستشيرك فيهما. فماذا تأمرني؟».
فقال الخريت: «آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقبتيهما».
فقال علي: «لقد كان ينبغي لك أن تعلم أني لا أقتل من لم يقاتلني ولم يظهر لي عداوة. وكان ينبغي لك، لو أنني أردت قتلهما أن تقول لي: اتق الله، بم تستحل قتلهما ولم يقتلا أحداً ولم ينابذاك ولم يخرجا عن طاعتك»([272]).
على أن ما تقيد علي بحرمته ليس فقط دماء المسلمين بل دماء أهل الذمة أيضاً إذ يوصي مالك بن الحارث الأشتر بالرحمة بالناس مسلمهم وذميهم بقوله: «ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين وإما نظير لك بالخلق»([273]).
كما يوصي ابنه الحسن بأهل الذمة بقوله: «الله الله في ذمة نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم»([274]).
وهكذا، فإن حياة الإنسان يجب الحفاظ عليها ولا يجوز سفك الدماء إلا عندما يكون ذلك تنفيذاً لأمر الله عز وجل الذي يقول: «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً»([275]). والذي يقول: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا…»([276]). بهذا تتضح الأحوال التي يجوز فيها القتل وهي حالات الدفاع عن الجماعة أو عن الدين.
أما إذا قتل الحاكم أحد الأفراد خطأ فإنه مسؤول عن ديته، يقول الإمام مخاطباً مالك الأشتر: «وإن ابتليت بخطإ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة، فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم»([277]).
أما إذا قتل إنسان ولم يعرف بالتحديد قاتله فإن ديته على بيت مال المسلمين، كأن يقتل في زحام يوم الجمعة أو بأية طريقة أخرى. بناء على مبدإ أقره الإمام علي([278]).
حق الملكية الخاصة
وكما كان الحكام يعتبرون أنفسهم قديماً مالكين للبشر، كانوا يتصرفون على أنهم المالكون لثروات رعاياهم أيضاً؛ يتصرفون بها عندما يحلو لهم مصادرة أو على شكل ضرائب ورسوم تقررها وتحددها مصالحهم. وقد استمر هذا الأمر في بلدان الشرق والغرب إلى أن قامت في أوروبا هيئات تمثل المواطنين مهمتها البت في مسألة الضرائب، واعترف لها أخيراً بحق واسع جداً في هذا المجال، وإن يكن حصل مؤخراً التفاف على هذا الحق عن طريق إقرار قيود على حق البرلمان في هذا الصدد، إذ أن البرلمانات اليوم لا يحق لها أن تقترح ما يزيد النفقات أو يقلص واردات الخزينة، كما أن هناك اعتمادات لا يصح لها أن تتصدى لها كالمصروفات الملكية في بريطانيا ورواتب القضاة. أما الأديان السماوية فقد وضعت حداً للحكام في مجال المساس بأموال المواطنين إذ رسمت حدود الله ومنعت من تعديها.
وهكذا فقد كانت الملكية الخاصة مصونة في رأي الإمام علي، فلا يجوز للسلطة ولا لغيرها الاعتداء عليها. ذلك أن «أعظم الخطايا اقتطاع مال امرىء مسلم بغير حق أو غير مسلم»([279])، لذلك فكان علي يوصي عماله بالقول: «ولا تمسن مال أحد من الناس مصل ولا معاهد»([280])، كما كان يؤكد كل ذلك بقوله لقادته: «ولا تستأثرن على أهل المياه بمياههم، ولا تشربن مياههم إلا بطيب أنفسهم، ولا تظلمن معاهداً ولا معاهدة ولا تسخرن بعيراً ولا حماراً، وإن ترجلت وحبست..»([281]).
وأكثر من هذا، فإن علياً كان يوصي حتى عند تحصيل الحقوق العامة ـ الضرائب ـ أن يصار إلى ذلك بالتؤدة واللين ودون استعمال أي نوع من أنواع العنف على الأشخاص والأموال، فهو يقول لرجل من ثقيف استعمله على الخراج: «إياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج أو تبيع دابة يحمل عليها في درهم. فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو»([282]).
وقد تكررت هذه الوصية لسائر عماله على الخراج وكان يضيف عليها: «ولا تبيعن الناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف»([283]).
أما تحصيل الزكاة، فكان الإمام يعتمد فيه على إرادة المكلّف بالدفع إلى أبعد الحدود، ودون أي مظهر من مظاهر القوة أو السلطة، فيقول لأحد عماله: «انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تروعنَّ مسلماً ولا تجتازنّ عليه كارهاً ولا تأخذ من أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تمالط أبياتهم: ثم امضِ إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تمزج (تقصّر) بالتحية لهم ثم تقول: «عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدونه إلى الله. فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه وإن أنعم لك فنعم. فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه فإن أكثرها له.
فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به ولا تنقزن بهيمة، ولا تفزعنّها ولا تسوء صاحبها منها. واصدع المال من عين ثم خيّره، فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره. ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره، فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله. فاقبض حق الله منه. فإن استقال (طلب الإعادة) فأقله ثم اخلطها ثم اصنع مثل الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حق الله في ماله»([284]).
على أن الحقوق المالية تبقى محفوظة ولا يجوز انتهاكها حتى ولو عوقب صاحبها أشد العقوبات. فإن أعدم توزع على ورثته وإن أقيم عليه الحد لا تسقط عنه، يقول علي في نقاشه مع الخوارج: «وقد علمتم أن رسول الله (ص) رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورّثه أهله. وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات. فأخذهم الرسول (ص) بذنوبهم وأقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله»([285]).
السخرة
وفي مجال السخرة كان الحكام يمارسون أبشع الصلاحيات، إذ كانوا يسوقون الأعداد الكبيرة من المواطنين لتعمل بشكل مجاني، أو شبه مجاني، في الأشغال العامة وحتى في بناء القصور والمعابد، أو لصالح المجهودات الحربية المخصّصة لخدمة مصالح الحاكمين.
وقد أتت الأديان السماوية لتضع حداً لهذا الأمر، وقد نفذ علي موقف الأديان السماوية بكل دقة، إذ كان ينهى عماله عن إجبار الناس على عمل من الأعمال وذلك بقوله: «ألا لا تسخروا المسلمين»([286]).
على أن السخرة الممنوعة ليست فقط تلك التي تتم لخدمة السلطان وحسب، بل حتى التي قد تؤدي إلى نفع القائم بها. فقد ورد أن بعض الفلاحين أتوا علياً يعرضون عليه أن يعيدوا حفر نهر كان طمر. فكتب إلى عامله يقول: «… ولست أرى أن تجبر أحداً على عمل يكرهه. فادعهم إليك، فإن كان الأمر في النهر على ما وصفوا، فمن أحب أن يعمل فمره بالعمل، والنهر لمن عمل دون من كرهه».
شرعية الجرائم والعقوبات
اعتبر هذا المبدأ مطلباً هاماً للفئات الاجتماعية المضطهدة في كل العصور حتى عرفته إعلانات حقوق الإنسان. وقد رفع كشعار لمنع التحكم الكيفي وإنزال العقوبات الانتقامية بالناس لا سيما المعارضون منهم للأنظمة الحاكمة. وقد قضى هذا المبدأ من جهة بعدم اعتبار تصرف ما جريمة يعاقب عليها، كما ويمنع إنزال عقوبة بأحد من الناس لم ينص عليها القانون كجزاء على فعل ارتكبه، ومن وجهة ثانية قضى بأن لا يعتبر تصرف ما جرماً أو يسمح بإنزال عقوبة على أساس قانون لاحق، وذلك ليكون الإنسان عندما يتصرف، على بينة من قانونية أو عدم قانونية تصرفه ومن العقوبات التي قد يستحقها إذا ما اقترف جرماً ما، وليحظر على الحاكم أن يصدر قوانين تعاقب على أفعال لم تكن تعتبر جرائم عند إتيانها أو تضع عقوبات معينة على جرائم لم تكن توضع على مرتكبيها من قبل.
أما في الإسلام، فإن هذا المبدأ يحتوي على شق واحد وهو أن الجرائم هي المحددة بالقانون الإلهي والعقوبات، كذلك ولا يمكن لأحد أن يستحدث جرائم أو عقوبات، وليس هناك قانون لاحق بعد التنزيل؛ يقول علي: «إن المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أول ويحرّم العام ما حرّم عاماً أول وإن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرّم عليكم، ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرّم الله»([287])، والله لم يترك مجالاً لأحد في التشريع، فهو «لم يخف عنكم شيئاً من دينه ولم يترك شيئاً رضيه أو كرهه إلا وجعل له علماً بادياً وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه»([288]). كل ذلك بناءً على ما حدَّده الله في كتابه من أنه ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاَّ مَا آتَاهَا﴾([289]).
ومن هنا كان حرص علي على عدم قتال الخوارج وعدم أخذ المغانم من أعدائه المسلمين وعدم منعه طلحة والزبير من ترك المدينة إلى مكة ليكوّنوا فيما بعد جيشاً يغزو البصرة، وقوله بخصوص الخوارج: «لا أقاتلهم حتى يقاتلوني» رغم علمه بأنهم «سيفعلون»([290]).
ثم هو في إحدى خطبه في الخوارج، يأخذ عليهم إنزال العقوبات والتنكيل بالناس دون ذنب ارتكبوه، فيقول لهم: «فإن أبيتم إلاّ أن تزعموا أني أخطأت وضللت، فلم تضللون عامة أمة محمد (ص) بضلالي وتأخذونهم بأخطائي وتكفرونهم بذنوبي، سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواع البرء والسقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب»([291]).
وعندما سبّ الخارجي أمير المؤمنين بقوله؛ «قاتله الله كافراً ما أفقهه » وهمّ أصحابه بقتله، ردع علي أصحابه عن ذلك وأكد لهم القاعدة الشرعية التي تأمر بعقوبة متناسبة مع الجريمة، حتى لو كانت واقعة على رئيس الدولة، مع عدم نسيان الحث على العفو فقال: «رويداً إنما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب»([292]).
ثم أنه لما ضربه ابن ملجم، حذر أهله من إنزال ما يتجاوز العقوبة الشرعية به. وقد أوصى ابنه الحسن به حتى ينجلي الأمر، وأمره أن «إرفق بأسيرك وارحمه وأحسن إليه واشفق عليه.. بحقي عليك يا بني، إلا ما طيبتم مطعمه ومشربه وأرفقوا به إلى حين موتي»([293]).
ويشرح الإمام موقفه من ابن ملجم فيضيف: «إن أبقَ فأنا ولي دمي وإن أفنَ فالفناء ميعادي» ويذكرهم بمحاسن العفو مرة أخرى فيقول: «وإن أعف فالعفو لي قربة وهو لكم حسنة فاعفوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم».
أما إذا لم يرد الحسن وإخوانه العفو، فلا يلجأ إلى الظلم: «يا بني عبدالمطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: «قتل أمير المؤمنين، قتل أمير المؤمنين»، ألا لا تقتُلن بي إلا قاتلي». ولكن على أساس المساواة في القتل: «انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله (ص) يقول: «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور»([294]).
على أن القصاص برأي علي، يجب أن يوقع دونما استعجال حتى يترك المجال للمجرم إلى التوبة، وهكذا فإن الإمام لا يكتفي بالإيصاء بأنه «لا يجوز القصاص قبل الجناية، وبأنه يجب أن تعذروا «من لا حجة لكم عليه»، وبالتأكيد أنه لا يأخذ على التهمة ولا يعاقب على الظن»([295]). بل هو يغلّب الرحمة كما رأينا فيقول في عهده إلى مالك الأشتر: «وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم والطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه… ولا تندمنّ على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت عنها مندوحة..»([296]).
وفي كلام آخر له يقول: «لا تتبع الذنب العقوبة واجعل بينهما وقتاً للاعتذار»([297]). هذا وكان علي يجعل الشك لمصلحة الظنين فيقول: «إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد باطل»([298]). كما كان يوصي القاضي بقوله: «… ودع عنك أظن وأحسب وإذا…»([299]).
وأكثر من ذلك فإنه كان يرى إنه لو تاب المستوجب لحد من حدود الله في بيته لكان أفضل من أن يقر ويقام عليه الحد. فقد أتاه رجل من مزينة أربع مرات يعترف بالزنا فأجّله الثلاث الأول قائلاً له: حتى نسأل عنك. وفي الرابعة قال له: «ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ. أفلا تاب في بيته. فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد»([300]).
كل هذا يؤكد أن علياً لم يكن يسمح بتطبيق أي قانون سوى القانون المنزل([301]) وأياً تكن الظروف.
الحريات البدنية
وهي الموازية، في بعض وجهها، للهابياس كوربس Hapeas corpus الإنكليزية. فقد حرّمت قوانين الدول المتقدمة التضييق على شخص الإنسان بشكل غير مشروع، واعترفت بحرية التنقل ومنعت التعذيب لانتزاع الإقرار من المتهمين، كما قضت بالتعويض على المسجونين إذا تبينت براءتهم. وهذه الأمور لم تحظ علمياً بالاهتمام والاحترام في معظم دول العالم، وحتى في البلدان الغربية التي عرفت النهضة الحديثة، فإن تبني هذه المبادىء ليس مطلقاً، لا سيما المبدأ الأخير القاضي بالتعويض على المسجونين ظلماً الذي يطبق، عندما يطبق، بشكل خجول.. وما زال الناس يسجنون لفترات طويلة جداً على ذمة التحقيق. فإذا برّئوا لم ينالوا التعويض الملائم عن تعطيلهم وعما يمكن أن يكون لحق بهم وبعائلاتهم من أذى. على أن التدابير المتخذة والتعويض الجزائي إذا حصل، فهي لا تطال الأجانب، بل فقط المواطنين وهذا ما يدل على عدم الإيمان الفعلي بهذه الأمور، بل فقط على الالتزام بقانون ملزم.
وما زالت الإنسانية اليوم تكافح لمنع السجن الاحتياطي الطويل والإفراج عن عشرات ألوف المساجين السياسيين في مختلف بقاع العالم ممن يقضون حياتهم في السجون، أو القسم الأهم فيها بحيث يخرجون، إذا خرجوا، عاجزين أو مرضى.
أما في الإسلام، فإن الأمر مختلف تماماً، ذلك بأنه يؤمّن الحرية للناس جميعاً، لعربيهم وعجميهم أبيضهم وأحمرهم وأسودهم، كما أنه يمنع من الظلم والتعسف، وهذا ما طبّقه علي، حيث تسنى له أن يطبقه.
فهو لم يقيد حرية الحركة والانتقال حتى لأولئك الذين كان يُخشى أن يتحركوا ضده، فهو لم يمنع طلحة والزبير من ترك المدينة إلى مكة، رغم أنه كان يعرف أنهما لم يقصدا العمرة التي ادعيا بل الغدرة كما قال.
وهو لم يقيد حركة الخوارج، كما رأينا، ولم يمنع الفارين إلى معاوية.
كما حرّم علي ممارسة العنف على الناس بدون وجه حق. فالمتهم لا يجوز تعذيبه مهما كانت تهمته. فحتى في تهمة القتل قضى علي بـ«التلطف في استخراج الإقرار «من الظنين»([302]). ثم هو رفع العقوبة عن المقر إذا كان إقراره نتيجة لعنف على شخص أو ماله أو نتيجة لتهديد. فكان يقول: «من أقر عن تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه»([303]).
وحتى في حال ثبوت الجريمة وإنزال العقاب فإنه يجب عدم التجاوز. فقد كان علي يعرض السجون كل يوم جمعة، فمن كان عليه حد أقامه عليه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله([304]).
أما في حال التهمة فكان علي لا يسجن على ذمة التحقيق إلا متهماً بدم، كما كان لا يسجن بعد معرفة الحق وإنزال الحدود لأن الحبس بعد ذلك ظلم([305]).
أما حق الدفاع فكان لا يجوز المساس به. فالمحاكمة يجب أن تكون متناقضة Contradictoire بمعنى أنه يجري التعايش بين مدع ومدعى عليه. لا أن يعول على أقوال أحدهما فقط، يقول علي مفسراً هذا الأمر: «إن الحدود لا تستقيم إلا على المحاجّة والمقاضاة وإحضار البينة»([306]). من هنا امتنع القضاء على غائب([307]).
أما بالمسائل المالية فكان علي لا يقر السجن إلا في حالات استثنائية تدخل اليوم في قانون الجزاء. فكان لا يسجن إلا الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلماً ومن ائتمن على أمانة فذهب بها. كان يسجن المفاليس من الأقرباء أي من يدعي ذلك أو يبذر ليحرم دائنيه من حقوقهم. أما المدين العادي فهو لا يقيد ولا يضرب ولا يضيق عليه في شيء([308])، ولا يحبس المعسري الدين ولا المفلسين([309]). أما إذا كان له مال فيباع لتسديد الدين([310]).
أما السجن فإنه ليس وضعاً للإنسان في ظروف لا تطاق قد تدفع به إلى المعصية، فعلي كان يخرج فئات من أهل السجن ليشهدوا الجمعة بشروط معينة ثم يعيدهم([311]).
وأخيراً، فإن الدولة تضمن أخطاء القضاة بحيث تدفع ما يستحق للمظلوم أو لأوليائه بالدم والقطع([312]).
المساواة
لم تكن المساواة معروفة في العهود القديمة، لأن الناس كانوا ينقسمون إلى طبقات وفئات، كانت «الخاصة» تستأثر بالأموال وبالمناصب وتشكل البطانة للحاكمين.
وكان أقارب الحاكم من أفراد الأسرة المالكة وأبناء عصبته هم أكثر أهل الخاصة حظوة لدى الحاكم إلا من يشكل خطراً عليه فإنه كان يبعد.
وقد حملت تعاليم الإسلام مبدأ المساواة على أكمل وجه، وإن لم يكن هذا المبدأ قد طبق إلا لحظة بسيطة في التاريخ الإسلامي، إلى أن أتت الدساتير الحديثة منادية به ولكن بشكل محدود ونسبي، حيث ما زالت المحاباة سائدة بقدر أو بآخر في جميع بلدان العالم؛ وأخطر دليل عليها ما كان يجري في الولايات المتحدة الأميركية، وما زال يجري بأشكال مختلفة حتى اليوم، من نظام يسمح للرئيس المنتخب بأن يعزل آلاف الموظفين الكبار ليأتي بأنصاره وبمن وعدهم بالمناصب أثناء حملته الانتخابية مكانهم وهو ما يعرف بنظام الغنائم Spoils system.
فالدساتير اليوم تعترف بالمساواة أمام القانون، أي بالحقوق المتساوية لمن يملكون المؤهلات القانونية المتساوية، أو يكونون في أوضاع حقوقية متشابهة، ولكن المبدأ ليس مقدساً على الصعيد العملي وحتى على الصعيد النظري، دائماً.
أما الإمام علي فقد كافح من أجل ترسيخ هذا المبدأ في زمن كانت القبلية والوجاهة قد استعادتا من أنفاسهما ما كان الرسول (ص) قد أخمده.
فلقد أقام علي المساواة في التكاليف ولم يرش أحداً بها، وطالب عمال عثمان بالمال الذي حصلوا عليه دون غيرهم من المسلمين بدون وجه حق، من كان منهم من بني أمية أو من غيرهم. وفرض التكاليف على الجميع بشكل عادل وعلى أموالهم لا على أي أساس آخر.
وقد تجلت المساواة عند الإمام بأوضح ما تجلت في مسألة العطاء، وهو الراتب المعطى لأفراد المجتمع الذين يشكلون الجيش الاحتياطي الجاهز وللمعوقين أيضاً.
في هذا الصدد كان الرسول (ص) يساوي بين الجميع أياً كان بلاؤهم، فيعطي علياً الذي امتاز بكل المآثر المعروفة كما يعطي من كانوا لا يقومون بأي مجهود متميز وذلك تطبيقاً لنص شرعي موحد. وقد طبق أبو بكر مبدأ المساواة في العطاء، ولكن عمر رأى رأياً آخر فوزع العطاء بشكل متفاوت، فقسم المسلمين إلى طبقات على أساس النسب والسابقة، فكانت الحصص تتراوح بين مايتي درهم واثني عشر ألف درهم. فكان يعطي العباس بن عبدالمطلب والسيدة عائشة سنوياً لكل منهما اثني عشر ألفاً وكل من نساء الرسول الأخريات عشرة آلاف ما عدا ثلاث منهم جويرية وصفية وميمونة اللواتي خص كلاً منهن بستة آلاف.
أما المهاجرون، فالبدريون منهم نال الواحد منهم خمسة آلاف فيما نال الواحد من بدريي الأنصار أربعة آلاف. أما مسلمو ما بين أحد إلى الحديبية فكان عطاء الواحد منهم أربعة آلاف وبعد الحديبية ثلاثة آلاف، وأما مسلمو ما بعد وفاة الرسول فقد نالوا حسب الأحوال: 2500 و2000 و1500 و1000 و200([313]).
واستفاد عثمان من هذا الاجتهاد ودفع به حتى حدود غير معقولة فأخذ يخص أقاربه ومريديه بأموال لا عهد للعرب بها في ذلك العصر، ومنهم من كان مطروداً من قبل رسول الله (ص). فكان من جملة عطاءاته، مثلاً، أن أعطى الحكم بن أبي العاص، وهو عمه، وكان رسول الله قد أهدر دمه ثم طرده، مئة ألف وأعطى مروان ابنه فدكاً وهي نحلة فاطمة (عليها السلام) من أبيها (ص) إضافة إلى خمس أرمينيا ومئة ألف درهم، وأعطى عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص أربعمائة ألف درهم. أما عبدالله بن سعد بن أبي سرح، الذي ادعى أنه زوّر في كتابة القرآن والذي كلّف بقتل محمد بن أبي بكر فقد نال من عثمان إمارة حمص ثم ولاية مصر إضافة إلى خمس أفريقيا. كما نال أبو سفيان في إحدى الأعطيات مايتي ألف، وجرى تقسيم أموال العراق بين أقاربه، كما أقطع ابن عمه الحرث بن الحكم بن أبي العاص سوق نهروز في المدينة، كان وقفاً على مصالح المسلمين وزوجه ابنته ونقطه بمائة ألف، ثم أعطى ابنته جواهر كسرى لتتحلى بها.
هذا وقد أصبح الزبير يمتلك مباني في الكوفة والبصرة ومصر إضافة إلى أراضي عظيمة وماية فرس وماية أمة وخمسين ألف دينار. وكان دخل طلحة من العراق ألف دينار يومياً، وقد امتلك القصور في المدينة والكوفة، وكان عبدالرحمن بن عوف يمتلك نصف مليون دينار، إضافة إلى إبل وخيل»([314]).
فلما حكم علي أعاد المساواة بين الجميع في العطاء، بين العربي والأعجمي وبين سيد القوم وسائر الناس وبين من أسلم حديثاً أو قديماً، تماماً كما كان يفعل رسول الله (ص)، فثارت ثائرة الزعما ضده.
لقد حدّد علي أصحاب العطاء فقال: «ألا إنه من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، أجرينا عليه أحكام القرآن وأقسام الإسلام»([315]).
ثم حدد علي كيفية التوزيع فقال: «فأما هذا الفيء فليس لأحد منه على أحد أثرة، قد فرغ الله عز وجل من قسمه فهو مال الله وأنتم عباد الله المسلمون»([316]).
ولما احتج القوم قال: «لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف والمال مال الله»([317]).
ولقد ناقشه مالك الأشتر بأمر المساواة متمنياً عليه أن يؤثر الزعماء ليستطيع استمالتهم. فقال له: «أنت تأخذهم يا أمير المؤمنين بالعدل وتعمل فيهم بالحق، وتنصف الوضيع من الشريف، فليس لشريف عندك فضل منزلة على الوضيع، فضجت طائفة ممن معك من الحق إذ عموا به واغتموا من العدل إذ صاروا إليه… فإن تبذل المال يا أمير المؤمنين تمل إليك أعناق الرجال». فأجابه علي: «… ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل كان الله يقول: «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» وأنا من أن أكون مقصراً فيما ذكرت أخوف. وأما ما ذكرت من أن الحق ثقل عليهم ففارقوا لذلك، فقد علم الله أنهم لم يفارقونا من جور ولا لجأوا إذ فارقوا العدل… وأما ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع الرجال فإنه لا يسعنا أن نؤتي أحداً من الفيء أكثر من حقه.. وقد بعث الله محمداً وحده فكثره بعد القلة وأعزه بعد الذلة، وإن يرد الله أن يولينا من الأمر يذلل لنا صعبه ويسهل لنا حزنه»([318]).
قد عاتبه أيضاً فريق من أصحابه متمنياً عليه ما تمناه الأشتر فقالوا له: «يا أمير المؤمنين، أعطِ فضل هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم واستمل من تخاف خلافه من الناس وفراره (إلى معاوية أثناء الحرب والهدنة). فقال لهم علي: «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله لا أفعل ما طلعت شمس وما لاح في السماء نجم»([319]). أما لماذا هذه المساواة؟ «فلأن آدم لم يلد عبداً ولا أمة وأن الناس كلهم أحرار… فمن كان له بلاء نصر في الخير فلا يمنّن به على الله عز وجل»([320]).
ولما عاتبه عثمان بن حنيف لإعطائه نفسه ما أعطى غلاماً أعتقه قبلها بيوم، وعاتبته عربية([321]) لمساواته إياها بأعجمية كان يقول: «والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق. هذا العطاء لا يخضع إذاً لأي معيار سوى الإسلام وهو فيء المسلمين وجلب أسيافهم فمن شركهم في حربهم كان له مثل حظهم وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم»([322]).
على أن صاحب العطاء يجب أن يقاتل كلما دعاه الإمام إلى الجهاد، فإن تخلف فهو يحرم. كان هذا هو الموقف الذي اتخذه علي من عبدالله بن عمر ومن سعد بن أبي وقاص ومن محمد بن مسلمة الأنصاري ومن المغيرة بن شعبة الذين أتوا الإمام بعد صفين يطالبون بعطائهم. فسألهم الإمام([323]).
ـ ما خلفكم عني؟
فقالوا: «قتل عثمان ولا ندري أحل دمه أم لا وقد كان أحدث أحداثاً ثم استتوبوه فتاب.. ثم دخلتم في قتله فلسنا ندري أصبتم أم أخطأتم مع أنا عارفون بفضلك يا أمير المؤمنين وسابقتك وهجرتك».
فقال علي: «ألستم تعلمون أن الله عز وجل أمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. فقال: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إَحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]. فقال سعد: «يا علي أعطني سيفاً يعرف الكافر من المؤمن. أخاف أن أقتل مؤمناً فأدخل النار». ولكن علياً أنهى النقاش بقوله لابن عمر: «شككت في حربنا فشككنا بعطائك».
هذا هو المعيار وقد طبقه علي على خاصة أهله. فهذه ابنته أم كلثوم التي استعارت عقداً من صاحب بيت المال، فرده علي وقال لها: «ليس إلى ذلك من سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك»([324]).
وهذا عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يقول لعمه: «يا أمير المؤمنين، لو أمرت لي بمعونة أو نفقة فوالله مالي نفقة إلا أن أبيع دابتي» فيجيبه علي: «لا والله لا أجد لك شيئاً إلا أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيك»([325]).
ثم إن أمر حديدة عقيل بن أبي طالب أشهر من أن يذكر.
وهذا هو سلوك علي مع نفسه. فهو يحمل سيفه ليبيعه في السوق ويشتري بثمنه إزاراً»([326]). على أن الناس لم يرضخوا أو يقروا جميعاً هذا النهج، بل إن بعضهم شنها حرباً دامية ضد علي، وكانوا أحياناً من كبار المسلمين كطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة. فقد طلب الشيخان المذكوران أن يبقيا متميزين في العطاء. ولكن الإمام رفض. فلما أصرا وذكراه بعطاء عمر وتفضيله أهل السابقة. فقال لهما: «كأن عمر حري بأن يصيب دون رسول الله (ص)»([327]).
ولقد حذّر الإمام القوم فأبلغ قائلاً لهم: «… أيها الناس فلا يقولن رجال قد كانت الدنيا غمزتهم فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار وركبوا أفره الدواب ولبسوا ألين الثياب فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً، وإن لم يغفر لهم الغفار، إذ منعتهم ما كانوا فيه يخوضون وصيّرتهم إلى ما يستوجبون فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: ظلمنا ابن أبي طالب وحرمنا ومنعنا حقوقنا، فالله عليهم المستعان»([328]).
ولكن التحذير والنصح لم ينفعا، فما كان من القوم إلا أن ساروا إلى البصرة فسفكوا فيها من الدماء ما يفوق التصور. على أن المساواة في العطاء لم تكن عند علي إلا النموذج للمساواة في كل الأمور. ومنها يساوي بين نفسه وبين رجل من أهل الذمة أمام القاضي، وهو الخليفة، وهو يغضب عندما يكنّيه عمر ويدعو خصمه اليهودي باسمه وهما ماثلين كخصمين أمامه.
كما يساوي علي بين نفسه وبين عامة الناس فيرفض التعظيم والتبجيل. ويقول لحرب بن شرحبيل الشامي الذي مشى إلى جانبه وهو راكب: «إرجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن»([329]). ويخاطب دهاقين الأنبار الذين ترجلوا له وأسرعوا أمامه عند مسيره إلى الشام فيقول: «ما هذا الذي صنعتموه؟» فيقولون: «خلق منا نعظم به أمراءنا». فيقول: «والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم وإنكم لتشقّون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربح الدعة معها الأمان من النار»([330]).
هذا وكان علي يوصي عماله بالعدل بين الناس ومساواتهم في كل الأمور والرفق بهم. يقول موصياً محمد بن أبي بكر: «.. وأخفض للرعية جناحك.. وآسي بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك»([331]).
ولقد آمن علي بالمساواة حتى كان تقشفه مواساة للفقراء ويفسر ذلك بقوله: «إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره»([332]).
حرمة الحياة الخاصة
إن هذه الحرمة هي من أكثر حقوق الإنسان امتهاناً منذ القدم وحتى اليوم، حيث كان الترويع ودخول البيوت ليلاً وخصوصاً في ساعات الفجر الأولى والتجسس على المواطنين وما يزال، ديدن الكثير من الحكومات. وإذا كانت بعض الأنظمة الديمقراطية وضعت حداً لكل هذا في الأحوال العادية وعلى النطاق النظري، إلا أن حرمة الحياة الخاصة ما زالت عرضة للانتهاك الذي يسمح به القانون. فقد كشف، مثلاً، سنة 1979م أن في فرنسا مئة ألف خط هاتفي مراقب وقِس على هذا.
أما الإسلام فقد حمى الحياة الخاصة أشد الحماية بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسَّسُواْ﴾([333]). ﴿لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ﴾([334]). ﴿وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ لأن ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً﴾([335]).
وهذا ما حرص عليه علي أشد الحرص في السلم كما في الحرب، فنهى في الحرب عن المسير ليلاً([336]) وعن الهجوم([337])، وهذا أمر لا قيمة له في أذهان قادة الجيوش اليوم.
كما أنه نهى، حتى في الحرب، مقاتلين عن دخول البيوت من تلقائهم بقوله: «ولا تدخلوا داراً إلا بإذني»([338]).
كما نهى علي عن تتبع العورات، إذ جاء في عهده لمالك الأشتر: «وليكن أبعد رعيتك منك واشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس فإن في الناس عيوباً الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها فإنما عليك تطهير ما ظهر لك.. فاستر العورة ما استطعت.. وتغاب عن كل ما لا يصح لك ولا تعجلن على تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين»([339]). أما إذا خيف من ارتكاب المعاصي، فإن الله هو المتكفل بعقاب المذنبين في حال الخفاء، أما الوالي فما عليه الخوف على رعيته لأن المعصية كما قال رسول الله (ص) «إذا أخفيت لم تضر إلا بصاحبها ولكن إذا أظهرت أضرت بالعامة» يقول علي بنفس المعنى: «والله يحكم على ما غاب عنك»([340]).
الحقوق السياسية
إن الاعتراف بالحقوق السياسية حديث نسبياً، إذ كان الناس في العصور السابقة يجبرون على أتباع سياسة الملوك والسلاطين، إلى أن جاءت إعلانات الحقوق الحديثة ومن أهمها، في هذا الصدد، مقدمة الدستور الأميركي، في سنة 1791م التي اعترفت بحرية الفكر والتجمع، و«إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الفرنسي لسنة 1789م الذي اعترف بحرية التعبير عن الرأي، وأخيراً صدر عن الأمم المتحدة «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» في سنة 1948م. ولكن الإسلام سبق الجميع بحظره على الحاكم أن يتعرض للحريات السياسية، وهذا ما كرّسه علي بن أبي طالب في نهجه عند توليه الخلافة.
لقد بدأ علي بتطبيق هذا المبدأ يوم بيعته، حيث عارضها عدد من المسلمين كعبدالله بن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري فلم يجبرهم على بيعته.
وفي حروبه لم يلزم علي أحداً بالانضمام إلى جيشه لا يوم الجمل ولا في معركة صفين ولا النهروان. وأخيراً فإنه لم يتصد للخوارج الذين كفّروه وتركوا الصلاة خلفه وتجمعوا وساروا في البلاد، وكان يقول: لا نمنعهم الفيء ولا نحول بينهم وبين دخول مساجد الله ولا نهيجهم ما لم يسفكوا دماً وما لم ينالوا محرماً»([341]).
وهو لم يقاتلهم إلا بعد مباشرتهم أعمال الفساد في الأرض، عندما تعرضوا لعبدالله بن خباب بن الأرت ولزوجته فقتلوهما وبقروا بطن المرأة وهي حامل.
وكان علي معهم في نقاش جدي باشره، أكثر من مرة، بنفسه أو بواسطة عبدالله بن العباس، وحتى في الصلاة ولم يفتروا ولم يفتر في إلقاء الحجج. فقد قرأ مرة أحد الخوارج وهو خلف علي في المسجد في صلاة الصبح: «إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين»([342]). فقرأ علي على الفور: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ﴾([343]).
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أحدث فئة من فئات حقوق الإنسان. فقد تبلورت بعد الحرب الأولى وترسخت وتأكدت بعد الحرب الثانية، فكانت نتيجة للفكر الاشتراكي والفكر الفاشي، كما أتت لمعالجة ذيول الحرب ولمواجهة الأزمة الاقتصادية الكبرى التي أصابت النظام الرأسمالي وآثار الحرب والأزمة التي أصابت الفئات الدنيا في المجتمع. فالفكر الاشتراكي يوفر العلم للجميع ويلغي الملكية الفردية فتصبح وسائل الإنتاج ملكاً للدولة. والفكر الفاشي يمركز السلطة ويحشد طاقات المجتمع فيعطيه إمكانية التطور السريع ويخفف ـ مؤقتاً ـ من حدة الأزمات.
أما الحروب والأزمات الاقتصادية وخصوصاً الأزمة الكبرى لسنة 1929م، فقد أفرزت شرائح واسعة جداً من الفقراء المعوزين الذين أخذوا يهدّدون السلم الاجتماعي.
كل هذا دفع الأنظمة الليبرالية، المؤمنة بالملكية الخاصة وبالمبادرة الفردية الحرة، إلى تعديل نظرتها إلى أسس النظام الذي أقامته على حرية المرور وحرية العمل Laisser passer laisser faire فوضعت بعض القيود على هذه الحرية وسمحت بالمساس بالملكية الفردية من أجل تحصيل ضرائب ورسوم وتكليفات جديدة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للفئات الدنيا في المجتمع.
ولكن الإسلام في زمن الضيق كما في زمن البحبوحة، بعدما اتسعت دولته واستقرت وتنامت مواردها، أقام نظاماً للضمان الاجتماعي شديد التطور كانت بداياته في المدينة عندما تخلى الأنصار للمهاجرين عن شطر من أموالهم.
وقد أعطى الإمام علي لهذا الضمان شكله الأرقى الملائم لعصره والذي يشكل الأساس له في العصور اللاحقة، إذ أقامه على نمط العدالة الاجتماعية لم يعرف العالم لها مثيلاً قديماً وحديثاً.
الغنى والفقر
تقوم فلسفة الإمام علي الاجتماعية على الإيمان بأن الحقوق المفروضة في أموال الأغنياء لصالح الفقراء،« فما جاع فقير إلا بما متّع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك»([344]). من هنا، فإنه يكفي أن يدفع الأغنياء التزاماتهم الشرعية المتوجبة عليهم حتى يكتفي الفقراء، وليس فقط ليتبلغوا أو ليتقوتوا، وهذا يفهم، بشكل واضح، من وصايا علي لعماله، فهو يقول لعبد الله بن العباس عامله على البصرة: «أما بعد فانظر ما اجتمع عندك من غلات المسلمين وفيئهم فاقسمه فيمن قبلك حتى تغنيهم وابعث إلينا بما فضل نقسمه فيمن قبلنا والسلام»([345]). هذه النظرة تتناقض مع الاشتراكية التي تلغي الملكية الفردية فينعدم الأغنياء المكلفون، كما تختلف عن الرأسمالية الليبرالية التي تمنح الحرية الاقتصادية للقوى الجبارة كي تنافس القوى الأقل كفاءة وتنتهي بسحق الفئات الدنيا. ثم هي لا تتفق تماماً مع التدخلية الحديثة التي تؤمّن بعض حاجات الفئات المعوزة من المجتمع؛ لأن الإمام يعتبر أن جميع الناس يجب أن توفر لهم حاجاتهم الضرورية، حتى ليأمر بالبحث عن أفراد الطبقة السفلى في المجتمع، لا سيما أولئك الذين لا يمدون أيديهم ويقنعون بأقل الأشياء، ليعاملوا على قدم المساواة مع غيرهم من الفقراء. وحتى يتمكن الوالي من ذلك فإن عليه أن يكلف أهل التواضع بالبحث عن هؤلاء ورفع حوائجهم وكذلك حوائج الأيتام والعجزة. يقول الإمام في عهده إلى مالك الأشتر عندما ولاه مصر: «ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنى. فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعترّاً. واحفظ الله ما استحفظك من حق فيهم واجعل لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات صواف الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى وكل قد استرعيت حقه، ولا يشغلنك عنهم بطر فإنك لا تعذر بتضييع التافه لإحقاقك الكثير المهم. فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر خدك لهم وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممّن تقحمه العيون وتحقره الرجال. ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه، فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. وتعهّد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه»([346]).
على أن الإسلام خص فئات من الناس بموارد محددة كالزكاة، مثلاً، التي توزع على الفقراء والمساكين وفي سبيل عتق الرقاب وفك دين العاجزين عن الوفاء وللمسافرين الذين تنقطع بهم السبيل من جملة من توزع عليهم كما تقول الآية، «سورة التوبة»: ﴿إِنَّمَا ألصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
كما أن أخماس الغنائم توزع أيضاً فيمن توزع عليهم، على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقد جاء في الآية 41 من سورة الأنفال: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
الحالات الاستثنائية
أشرنا إلى أن الدولة الحديثة تُعتبر دولة القانون، وعلى أن الدساتير والقوانين المدنية، تضمن الحريات العامة والحقوق الفردية. وذكرنا أن هذه الضمانة ليست مطلقة، بل هي تخرق في الحالات الاستثنائية، بحيث تبيح القوانين إقامة الديكتاتورية أو إعلان حالة الطوارىء أو حالة الحصار.
فمن جهة، يتمتع رئيس الدولة ـ إذا ما تعرض النظام للخطر ـ بصلاحيات ديكتاتورية تسمح له بأن يتخذ جميع الاحتياطات، بما فيها الحلول محل السلطات العامة جميعاً ومصادرة الحريات العامة، حتى يتمكن من إعادة الأمور إلى مجراها الأساسي. وهذا ما تعترف به المادة 16 من الدستور الفرنسي للرئيس، فتعطيه الحرية في تقدير: أن مؤسسات الجمهورية أصبحت في خطر وأنها تتعرض للشلل، أو أن وفاء الدولة تجاه الغير قد أعيق. فعندها يعلن الرئيس حالة الديكتاتورية المؤقتة ويتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي يراها كفيلة بإعادة الأموال إلى نصابها دون رقيب أو حسيب، اللهم إلا البرلمان الذي لا يمتلك، في هذه الحالة، إلا إمكانية اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو خرق الدستور ومحاكمته، وهذه مسألة يكاد أن يكون حصولها مستحيلاً.
كما أن الدستور الأميركي يعطي رئيس الدولة صلاحيات استثنائية في حالة الحرب تسمح له بمصادرة الحريات على أوسع نطاق. وقد استخدم الرئيس روزفلت هذا الحق، إبان الحرب العالمية الثانية، فاعتقل اليابانيين المقيمين في الولايات المتحدة أو ضيق على حرياتهم كما اعتقل بعض الأميركيين من أصل ياباني.
وأخيراً فإن المادة 81 من الدستور الألماني تعطي السلطة التنفيذية إمكانية انتزاع صلاحية التشريع من الرايشستاغ في حالة الضرورة التي لها حق إعلانها بنفسها.
وإلى هذا فإن الحكومات تستطيع إعلان حالة الطوراىء أو حالة الحصار، فتسمح لنفسها ضمن مهلة معينة أن تعلق إمكانية التمتع بما تراه من الحقوق والحريات، فتصادر الأموال والأشخاص وتمنع التجمعات وتحدد إقامة الأشخاص الذين تعتبرهم خطرين، وتحل السلطة العسكرية محل السلطة المدنية. كل ذلك إذا كان الخطر داهماً؛ أما تقدير حق الأمر فيعود إلى السلطة التنفيذية نفسها، فإذا وافقتها السلطة التشريعية فإنها تستطيع أن تمارس هذه الصلاحيات لفترة طويلة.
هذا في القرن العشرين، بعد كل ما عانته الإنسانية حتى توصلت إلى إقرار الحقوق والحريات المعروضة. أما الإمام علي فقد اعتبر أن حريات الإنسان وحقوقه لا يمكن المساس بها لا في زمن الحرب ولا في السلم. وقد علمنا أن فترة حكمه كانت كلها حالة استثنائية تبرر، في أنظمة اليوم، اللجوء إلى الديكتاتورية وتسمح بإعلان حالة الطوارىء. ولكن لم يغير أي شيء ولم يعط نفسه أية صلاحيات إضافية. فهو عندما بويع، كانت الأحوال مضطربة، وما أن هدأت شيئاً ما حتى أعلن معاوية تمرده في الشام.
الخوارج عندما تركوا الكوفة والبصرة وراحوا يتجمعون، فيما الإمام يجهز الجيش للمسير إلى الشام للحرب الفاصلة، لم يقاتلهم رغم إلحاح قادته، ورغم توفر إمكانية أن ينقضوا على الكوفة بعد مغادرة الجيش إلى الشام. ولكن الإمام رفض معتبراً أن ما يسمح له بحربهم غير متوفر ولم يتعلل بالظروف الاستثنائية. وبعد معركة النهروان، ومعاودة الخوارج ترك الكوفة لم يقاتلهم الإمام إلا بعد أن أفسدوا في الأرض.
أما مسألة المصادرة، فقد رأينا أن الإمام كان يرفضها بشكل مطلق، فهو كان يأمر قادته بعدم إرغام الناس على العمل أو استخدام وسائل النقل المتوفرة لديهم ـ الدواب ـ إلا برضاهم ومقابل أجر. كما إنه لم يسمع بأي نوع آخر من المصادرة، حتى إنه منع جيشه من شرب الماء إلا برضا أصحابه كما رأينا. وتلك كانت معجزة علي فعلاً، وهي تشكل تحدياً لكل الحضارات وفي مقدمها الحضارة المعاصرة، التي اعتبرت الإنسان هو القيمة الأساسية في الكون التي تسخر كل الإمكانات من أجلها، فهل تستطيع هذه الحضارة أن تفكر بالالتزام بما التزم به علي تجاه الإنسان.
ضمانة ضوابط الحكام ـ محاسبة الحاكمين:
شكلت مسألة الثورة على الحاكم الظالم هاجساً لكل الذين اهتموا بحقوق الإنسان في أوروبا، منذ الشرعة العظمى البريطانية Magna carta في سنة 1215م حتى الأمس القريب.
فقد حوت الشرعة أنه إذا خالفها الملك يتولى أربعة بارونيون لفت نظره ليصحح خلال أربعين يوماً، فإن رفض، رفع الأمر إلى بقية البارونيين الخمسة والعشرين وعُمّم على أفراد الشعب لكي يناهضوا الملك.
ثم أعطت شرعة الحقوق البريطانية Bill of rights المواطنين حق الادعاء بوجه الملك أمام القضاء عن تصرفات موظفيه غير المحقة.
أما في فرنسا فقد اعترف دستور سنة 1793م بحق الثورة للشعب، أو لفئة، بسبب تعدي الحكومة على حقوقه واعتبر ذلك حقاً مقدساً.
إلا أن دستور سنة 1795م ألغى هذا الحق معتبراً أن الشعب لا يحتاج إلى ضمانة دستورية للثورة ضد الحكام المتجاوزين للحدود.
وأتى أخيراً ميثاق عصبة الأمم لينظم جهة ترفع إليها الشكاوى ضد الحكومات ولكن فقط في حال خرق حقوق الأقليات. ثم استعاد الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان إمكانية الادعاء ضد الدول التي تمارس الظلم. كما نظمت كل الدول طرقاً للوصول إلى الحكم وأقامت أنظمة قضائية للنظر بالتجاوزات الحكومية؛ كما كلفت البرلمان بمحاسبة الوزارة سياسياً وأحياناً بمحاسبة رئيس الدولة، كما رأينا.
وهكذا غاب الحق بالثورة على أساس أن نشوء الأحزاب التي كانت محرّمة، إلى ما بعد الثورة الفرنسية، وخوضها اللعبة الديمقراطية، أعطى الشعوب الإمكانية النظرية للتغيير. كما أقيم قضاء خاص أحياناً كلف القضاء العدلي، نفسه، في النظر في تجاوز حد السلطة على أيدي السلطة التنفيذية، فإذا تحقق من ذلك أبطل أنظمتها وحكم عليها، أحياناً بالتعويض.
كما أصبح بإمكان البرلمان إسقاط الحكومة أو منحها الفرصة للحياة، عن طريق حقه في حجب الثقة أو إعطائها على أساس من سياسة الحكومة.
أما في الأزمنة القديمة، فإن كل هذه التدابير لم تكن معروفة، وكان يجري التغيير فقط بالقوة المسلحة. إلى أن كان الإسلام الذي أقر محاسبة المسؤولين وخلعهم عندما يستلزم الأمر ذلك كما أكّده علي. فالإمام يمكن خلعه بسبب حدث يحدثه، وهذا ما أثاره علي مع طلحة والزبير اللذين نكثا بيعته فطلب إليهما إن كان أحدث حدثاً أن يسموه له([347]). كما أنه أكد للأشعث بن قيس([348]) في رسالة إليه أنهما خلعا بيعته بدون حدث أحدثه. وقال عن عثمان إنه أحدث أحداثاً([349]).
وقد توسع الإمام في هذه المسألة ـ فيما بعد ـ مقرّاً إمكانية المحاسبة على كل الصعد، وأول ما أقره علي ونفذه بنفسه هو صلاحية القاضي بمحاكمة الخليفة نفسه، ناهيك عن عماله، تماماً كما يحاسب جميع المواطنين.
أما عن الحق في التغيير، فإن الإمام يعتبره ليس حقاً للشعب فحسب، بل هو واجب على كل من يستطيع التحرك وبأية وسيلة مستطاعة، على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوصى به الله تعالى وأوصى به الرسول في قوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».
وقد أكد علي على هذا المعنى مراراً، فهو يقول: «من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه سلم وبرىء ومن أنكره بلسانه فقد أُجر ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونوّر قلبه اليقين»([350]). وتأكيداً على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الظلم يقول علي: «وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي.. وأفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر»([351]).
ولهذا يصبح الوقوف في وجه معصية الحاكمين شرطاً لمرضاة الله عن أوليائه، هو لا يرضى عنهم إذا تخلوا عنه: «إن الله لا يرضى لأوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر»([352]).
وهكذا يتبين أن علياً كان الرائد في مجال حقوق الإنسان التي لم تطبق، حتى بشكلها النسبي المعروف اليوم، إلا بعد الحرب العالمية الأولى وفي عدد محدود من البلدان.
صحيح أن الإعلانات حوتها منذ زمن، ليس بالقصير نسبياً، ولكنها لم تطبق إلا بعد صراعات مريرة أدت إلى تغيير موازين القوى لصالحها..
أما في الإسلام، فلقد حوى القرآن والسنة الحقوق والحريات، ولكن علياً التزم به بعقله وقلبه ورعاها رعاية لم تحظ بها ولا نعتقد أنها ستحظى بها. ذلك أن مبادىء الحقوق والحريات، وإن يكن أتى بها الإسلام وطبقها الرسول (ص)، إلا أن قادة المسلمين سمحوا لأنفسهم بصلاحيات استنسابية تجاهها، الأمر الذي كان الفقهاء، في غالبية الأحيان، يسهلونه. ولكن علياً لم يكن من هذا النمط.
على أن موقف قادة اليوم، ممن يقيمون الوزن للحقوق والحريات لا يمكن مقارنته بموقف علي، ذلك أنهم اليوم، وبعد استقرار موازين القوى على نحو معين، التزموا بها مُكرهين فأخذوا يتحايلون عليها حيثما أمكنهم ذلك، وحتى داخل بلدانهم. أما خارجها، وحيث لا يشعرون بإلزام فعلي، فإنهم يضربون بها عرض الحائط. فإذا توجهنا إلى قادة العالم الثالث فإننا نجد، ـ رغم احتواء الدساتير والقوانين على مبادىء الحقوق والحريات ـ نجد أن الإنسان لا وزن له ولا قيمة كلما تعارضت مواقفه مع مواقف النظام، إنه يعيش في عصور جاهلية مغرقة.
أما علي، فإن المسألة عنده كانت لا تحتمل إلا الالتزام والاحترام الحقيقيين دون أن يسمح لنفسه ولقادته بتعديلها.
ولعل أهم من كل هذا، أن الحكومات اليوم تستطيع أن تعلن حالة الطوارىء فتتهرب من الالتزام بالحقوق والحريات. أما علي فقد التزم بها في كل المحن والكوارث التي ألمت به دون أن يغير أو يبدل.
إن هذا هو الإيمان المطلق الذي لا يدانيه إيمان.
الدكتور محمد طي
علي والزمان
تاريخٌ هو الليلُ والويلُ والهول الأكبر.
لا قويٌّ فيه ـ بمقياس قوة البهيمة ـ إلا وهوَ آمرٌ مطاعٌ ينكّلُ ويقتل ويغزو ويسطو ويضربُ الخلقَ بالترويع.
ولا لصٌّ فيه إلاّ وهّمتُه أن يأكلَ الناس معَ الآكلين.
ولا سفّاحٌ إلاّ ورقابُ الأبرياءِ والمستضعفينَ محصدةٌ لسيفه.
ولا جاهلٌ إلاّ وقصرُه من جماجم المفكّرين.
ولا شرّيرٌ إلاّ ويمشي في الأرضِ مرحاً، وهو يحسَبُ أنه يخرِقُ الأرضَ ويبلغُ الجبالَ طولاً.
ولا جروٌ وعواءٌ من جراءِ هؤلاءِ إلاّ وله رأيٌ وصوتٌ ويدٌ في تحديد مدة الحياة للأحياء.
ذلك هو الفصلُ الأطولُ والأشملُ في مسيرةِ البشر عبرَ ألوف السنين.
وشوهدتْ في دياجير التاريخ مناراتٌ تعلو وتُضيء.
وسُمعتْ في فضاءِ التاريخ أصواتٌ تخلّعتْ لها أبدانُ الطغاةِ الأغبياءِ، ومالت بها الدنيا عليهم تقول: إنّ للإنسان قيمة غيرَ التي تعرفون، وإن للجماعة صورة غير التي تصنعون.
في طليعة تلك المناراتِ الواقفةِ على مفارقِ الأزمنة والتي لولاها لما استحقّت الحياةُ أن تُحيا، كان عليٌّ بن أبي طالب، وكانت على يده ثورةٌ مستمرّةٌ مع الزمان على أنظمةٍ آخذةٍ من كلِّ بغي وعدوان. ثورةٌ كانت ولا تزالُ برداً على المستضعفين وسلاماً ونعمةً موفورة.
ودخلت الإنسانية بظهور عليٍّ ونهجه مرحلةً نيّرة خيّرة. وعرف التاريخ بعليِّ الصيغةَ الكونية المُثلى للعقل العربي المبدع، وللخلقِ العظيم، والضميرِ العملاق، كما عرف نهجاً للعدالةِ الاجتماعيةِ المنبثقةِ مفاهيمُها من احترام الحياة والرحمة بالأحياة، واستلهام قوةِ الكونِ المركزيةِ العظمى التي هي الله. وحين تجري مفاهِيمُ العدالةِ الاجتماعيةِ من هذه الينابيع الصافية، تُصبحُ الصورةُ الظاهرة للعدالةِ الإنسانية التي تشمُلُ الظاهرَ والباطنَ جميعاً.
ولا يستقي مفاهيمَ العدالة من مناهلِها الكونية إلاّ عبقريُّ العقلِ والقلبِ والروح الذي ينظرُ إلى الفردِ وكأنه ينظرُ إلى الناسِ جميعاً. وينظرُ إلى مجتمعهِ وكأنه ينظرُ إلى كلِّ مجتمع. وينظرُ إلى زمانه ليرى فيه كلَّ زمان. فالإنسان في جوهرهِ هو الإنسان حيث كان من الزمان والمكان. وحاجاتُه وأشواقهُ هي هي في الجوهر مهما اختلفت المواقعُ وتعاقبتِ العصور. وما المواقعُ المكانيةُ الزمانية بالنسبة لعبقريّ العقلِ والقلبِ والروحِ إلاّ مناخاتٌ خارجية يخترقُها كلَّها بعقليةٍ كاشفةٍ واحدةٍ ونهجٍ واحد، فلا تتبدّلُ فيها نظرتُه إلى جوهرِ الأمور.
من هذا المنطلق عالج الإمامُ الأعظمُ عليٌّ بن أبي طالب أمورَ الجماعةِ في مكانهِ وزمانهِ فعالجَ بها أمورَ كلِّ الجماعات في كلِّ مكانٍ وزمان.
أدرك عليٌّ، كما لم يدرك سواه، أن اللبنة الأولى في بناءِ المجتمع السليم: اللبنةَ التي إن لم تكن هي الأساس فلن يكون هنالك بناء، هي توفيرُ أسباب العيشِ للجماعةِ موزّعةً توزيعاً عادلاً، لا غُبنَ فيه، فلا يكونُ في المجتمع حارمٌ ومحروم، وقاهرٌ ومقهور، ومتخمٌ وجائع. ومِن مبادئه التي تكشفُ عن هذا الجانبِ الأهمِّ في معنى العدالة الاجتماعية، والذي إذا فُهم وعُمِلَ به حالَ دون طغيانِ الشرورِ التي تصيبُ الجماعة وفي طليعتها الظلمُ والقهر والفسادُ والإفساد وانتظام الناسِ في فئاتٍ متنافرة وطبقاتٍ متناحرة… هذه المبادىء التي نرى فيها المبدأ الأساس نفسه الذي رآه صاحبُ الثورةِ الفرنسية الكبرى وأحدُ آباءِ الإنسانية الكبار الشاعرُ الفيلسوف جان جاك روسو في القرنِ الثامنَ عَشَرَ، لتكونَ المرتَكَزَ في بناءِ المجتمع العادل، كما نرى فيها المبدأَ الأساسَ نفسَه الذي اكتشفَه فلاسفةُ الاجتماع وعلماؤه في أوروبا بأواسطِ القرنِ التاسعَ عَشَرَ عندما أعلنوا، استناداً إلى العلم لا إلى المِزاج، أنَّ كلَّ ما يصيبُه المرءُ من أسباب النعمةِ الفائضة عن حاجته، لا يكونُ إلاَّ ممّا اقتُطع من حاجةِ أهل العَوز وأُخذَ منهم اغتصاباً، وهو اغتصابٌ قد تبرّرهُ القوانينُ المرعيَّةُ التي صنعها الأغنياءُ لقهر الفقراءِ، والأقوياءُ لإذلالِ الضعفاءِ، والفئةُ القليلةُ لنهب العامة، ولتوطيد ما يسمّونه «الأمن» على هذا الأساس… هذا مع ملاحظة هامة هي أن الإمامَ علياً سبق هؤلاء الفلاسفة والعلماء الأصفياءَ أكثرَ من ألفِ سنة إلى إدراك هذه الحقيقة وإلى إعلانها عندما قال: «ما مُتِّعَ غنيٌّ إلاَّ بما جاع به فقير. وما رأيتُ نعمةً موفورة إلا وإلى جانِبها حقٌّ مضيَّع!».
هذا القول العظيمُ ليس قولاً وحسب، إنه كشفٌ علميٌّ عن حقيقةٍ ثابتةٍ لم تنكشف لعلماءِ الغرب إلا في القرنين الأخيرين، عند طغيان العصر الصِّناعي الذي مكَّن الفئةَ القليلةَ من استغلال العامّة على صورة فاجرة.
على هذا الأساس المنطقي يرى الإمام أن يبدأَ بناء المجتمع العادل. وعلى أساس الرعايةِ الصادقةِ الأمينة للعدالَةِ الاجتماعية، وللجماعة، تعملُ السلطةُ في نهج الإمام هذه السلطة التي كانت ولا تزالُ في كثير من أقاليم الأرض وسيلةً للحصولِ على المال والمزيد من التشامخ والتبذّخِ، مهما ادعى عكسَ ذلك المدعون، ومهما تقنع المتقنّعون ونافق المنافقون وأظهروا خلافَ ما يُضمرون، ومهما غطَّوا الواقع بالعبارات البرَّاقة الرقراقة السراقة، كالنظر في أحوال البلاد وخدمةِ العباد، ورفعِ الظلمِ عن الجماعة ومحاربةِ العوزِ والمجاعة، إلى آخر الأكاذيب المودَعة في عبارات جاهزة يتناولُها ويلوكُها كلُّ من شاء أن يلعبَ بلسانه ويضحك على إخوانه، ونحن نعلمُ وهم يعلمون أن شرّ الشياطين شيطانٌ يصلي!
وصاحب السلطان في نهج الإمام هو ذاك الذي انتزع له الإمامُ صورة عن نفسِهِ هو إذ قال: «لو فُقدتْ شاةٌ في الحجازِ أو اليمامة، لشعرتُ بأنني مسؤولٌ عنها إلى يوم القيامة!».
لقد كان إحساسُ عليٍّ بمسؤولية السلطان وبمعناه، إحساسَ الأنبياء وكبارِ الفلاسفةِ والشعراء الذين يُحيَونَ مُثُلاً ساميةٌ وأحلاماً وأشواقاً لا يعرفُها سواهم، ومن وحي هذا الإحساس العميق تمثّل جهدَ صاحبِ السلطان الذي عليه أن يعمل كلَّ شيء لخير المجتمع، حتى إذا فعل قال له هذا القول الذي ينزعُ به عن أسمى المشاعرِ والمسالك معاً: «إذا فعلت كلَّ شيء، فكن كمن لم يفعل شيئاً»!
الإمامُ عليٌّ الذي نظر إليه النبيُّ الكريمُ ذات مرةٍ وقد تمثلتْ له مزاياه العظيمة فقال له في هدوء: «يا عليُّ، إن فيك لَشَبَهاً من عيسى ابن مريم!».
الإمامُ الذي اخترق بعقلهِ المبدعِ حدودَ كلِّ مكانٍ وكلِّ زمان، والذي وصفه الفيلسوف شبليَ الشميّل بقوله: «الإمامُ عليّ، عظيم العظماء، نسخةٌ مفردةٌ لم يرَ الشرقُ لها ولا الغربُ صورةً طبق الأصلِ، لا قديماً ولا حديثاً…» ليكنْ فخرنا في غدنا كما هو فَخرُنا في ماضينا، والنظرُ إلى الماضي جزءٌ من النظر إلى المستقبل. ولنهتدِ به، ولنأخذْ من أفكارِهِ وأقوالهِ وسيرتهِ دستوراً مستقطراً من هذه الأفكارِ وهذه الأقوالِ وهذه السيرة! ونحن في أشدِّ الحاجةِ إليه وإلى أمثاله في هذا العصر الذي يبلعُ فيه وحشُ المال كلَّ قيمةٍ في الدنيا، وكلَّ معاني الإنسان، يشتري السلطانَ والإدارةَ والقانون والأقلام والضمائر، ويقضي على العقولِ والقلوبِ والأخلاقِ والأحلام، ويمسخُ الحياةَ مسخاً مريعاً ويُلغي معانيها وكلَّ أسباب السعادة فيها! وحشُ المال الذي يخور ويجور، ويدور في ضجيج مؤجِّج، وإعلانٍ مُملَج، وعلى أيدي عبادّهِ من الأساطين والدهاقين والعرافين، حماة الحمى حماحم رب السما تُستباحُ المقدسات الإنسانية وتنهار الحضارة! وكما أنَّ عليّاً المتّصلَ عقلُه ووِجدانُه بجوهرِ الوجودِ الإنساني ككلّ، ليس لزمانٍ أو لمكان، بل لكل زمانٍ ومكانٍ، فهو ليس لقومٍ ولا لدين، هو للناس أجمعين!
إنه المنارةُ المشرقةُ على مفارق العصور!
جورج جرداق
الاستراتيجية والتكتيك
العسكري عند علي (ع)
تناول الكثير من الكتّاب مختلف جوانب حياة الإمام علي بالبحث والتنقيب، واكتشفوا من خلال مسيرة البحث الطويلة تلك ـ والتي سوف لن تنتهي أبداً ـ الكثير من الصفات النادرة النبيلة التي كان يتمتع بها الإمام وأخرجوها للعالم على شكل كتب أصبحت تتداول في كل بيت ومكتبة تشهد للإمام بالحجة الواضحة بما يملكه من تلك المواهب والصفات، فمنهم من كتب عن شجاعته ومنهم من كتب عن عدالته واستقامته في حياته ومنهم من كتب عن إنسانيته وعروبته ومنهم من كتب عن زهده بحيث لم يبقَ مما هو معروف من الصفات الحميدة إلا ووجد بأنه المبرز المتقدم فيها. وعلى كثرة ما كتب عنه (ع) إلاّ أن جانباً آخر مهماً من حياته لم تتم معالجته بالصورة التي تبرز ما يملكه من قدرات وإمكانيات كبيرةٍ وفهمٍ واسع في مجال آخر، أعني به مجال القيادة العسكرية والقدرة على إدارة الحرب والتخطيط لها، وربما كان سبب ذلك يعود إلى أن كل من يتناول صفاته وقدراته الأخرى في البحث والتنقيب لم يكن يمتلك الخبرة والقدرة المهنية التي تؤهله لأن ينعطف على هذا الجانب فينقب فيه مكتشفاً كنوزه الرائعة، أي أن كل من كتب عن الإمام علي استطاع أن يبرز في الجوانب التي يمتلك فيها خبرة أو اختصاصاً مكنه في أن يخوض ما خاض فيه خارجاً بنتائج وآراء مهمة وجيدة، أما الجانب العسكري في حياة الإمام علي فإنه يحتاج هو الآخر إلى من يمتلك الخبرة في هذا المجال تمكنه من البحث والتنقيب منتهياً إلى إبراز هذا الجانب الهام من حياة الإمام الزاخرة الممتلئة بالكفاح المسلح والجهاد المتواصل حتى آخر يوم من حياته الشريفة دفاعاً عن المثل والقيم الإسلامية والإنسانية التي نذر حياته من أجلها، وكتب التاريخ العربي والإسلامي مليئة بمشاهد فريدة ناصعة له، تستحق منا أن نلتفت إليها نافضين عنها غبار الزمن مقدمة بحلة عصرية يتقبلها ذوق العسكري والمثقف على حد سواء، وربما كان من الأسباب التي جعلت الكُتّاب المعاصرين يحجمون عن الكتابة في هذا الجانب هو كون حروب الإمام علي كانت داخلية وإن البحث فيها مدعاة لإثارة هواجس البعض ومشاعرهم، إلا أننا لا نجد ذلك مبرراً لأن نقف أمام هذا التراث العظيم من الخبرة والموهبة موقف الإهمال، ونحن هنا نهدف إلى الدراسة المجردة البعيدة عن الخوض في الأسباب التي أدت إلى هذه الحروب والتي يمتلك إزاءها الكثير من المسلمين مواقف فكرية مختلفة كانت ولا زالت جزءاً من أسباب الاختلاف بينهم. وبالطبع فإن هذا لا يعني بأننا سوف نعزل الحرب بصورة عامة عن أسبابها ـ وهي سياسية ـ لأننا سوف لن نوفق بصورة كاملة إلى الوصول إلى عرض جاد وحقيقي، لأن الحرب أساساً هي إحدى وسائل السياسة. بل إنها آخر وسيلة من وسائلها فهي إذن جزء منها، إلاّ أننا سوف نبذل جهدنا كي نبتعد عن المواضع التي تثير أو تساعد على إثارة تلك الأسباب لأننا لا نهدف أساساً إلى ذلك والله الموفق.
الاستراتيجية والتكتيك عند الإمام علي (ع)
تبرز قدرة الإمام علي وفهمه «الاستراتيجي» واضحين للعيان خلال تقدمه الكبير على رأس قواته من الكوفة ـ وبالتحديد من منطقة التحشد التي انتخبها في منطقة النخيلة والتي تقع إلى مسافة حوالي 20 كلم جنوب كربلاء ـ إلى منطقة صفين حيث قطع مسافة لا تقل عن 1000 كلم عبر فيه الوديان والسهول والصحاري على رأس جيش يصل تعداده إلى ما يزيد عن الخمسين ألفاً من المقاتلين حيث أعد العدة وأكمل استعداداته لهذا التقدم الطويل بكل تفاصيله ومتطلباته. يعتبر كل من عاملي الأمن والاستخبارات من أهم مبادىء نجاح التقدم، ولم يكن هذا الأمر قد غاب عن الإمام مطلقاً وقد درس الأرض التي تعتبر مفتاح نجاح عملية التقدم، ووضع على ضوء تلك الدراسة خطة واضعاً نصب عينيه المبدأين اللذين أشرنا إليهما آنفاً، فالأرض التي قرر الإمام أن يتقدم عليها تحدها من الغرب صحراء قاحلة تنتهي إلى أرض الشام، حيث لم يغفل الإمام احتمال أن يدفع خصمه بقوة قادرة على إرباك عملية التقدم متوجهة شرقاً باتجاه نهر الفرات عبر المسالك الكثيرة التي تخترق الصحراء، لذا فإنه قد أفرد قوة مقدمة تعدادها اثنا عشر ألفاً من الفرسان تسير بمحاذاة الجانب الأيمن لنهر الفرات مزوداً إياها بوصايا واضحة عن واجباتها وأساليب عملها هي أروع وصايا يصدرها قائد لجزء من قواته مكلف بواجب خاص ـ متحدث عنها بصورة مفصلة ـ وقد سبق إرسال الإمام للمقدمة تلك إرسال فرقة بقيادة مالك الأشتر انطلقت من المدائن وسارت بمحاذاة نهر دجلة متجهة إلى الموصل ونصيبين ودارا ثم انكفأت بمحاذاة نهر الخابور مخترقة جبال سنجار متجهة إلى عانة وهيت، وبذا يكون الإمام قد أتم الإجراءات التي تكفل له ضمان أمن قواته المتقدمة شمالاً، بعد أن ظهرت تلك القوة في مناطق الموصل والجزيرة وأعالي الفرات تذكر بأن جيش الإمام يستطيع الوصول إلى أقصى نقطة تمتد إليها سلطة الدولة شمالاً، وقد قام مالك الأشتر قائد تلك القوة بالظهور في المناطق التي توالي معاوية في كل من حرّان والرقة وقرقيسيا، مما ترك أثراً كبيراً في نفوس عامة الناس ومنعهم من القيام بأي عمل مناوىء لسلطة الخلافة. تقدمت بقية القوات والتي تتألف من القسم الأكبر مع الجنبات والمؤخرة، ـ الساقات ـ بين نهري دجلة والفرات حيث عبرت قواته كربلاء متجهة إلى بابل ومنها إلى المدائن التي تركها بسرعة مارّاً بالخانق الضيق الذي يفصل بين النهرين والذي تقع فيه الآن مدينة بغداد متجهاً شمالاً نحو مدينة الأنبار الواقعة على نهر الفرات، ثم تقدم منها بمحاذاة الجانب الأيسر لنهر الفرات مارّاً بهيت وحدية وعنة ثم الرقة حيث عبر منها إلى الجانب الأيمن من نهر الفرات نحو الجزيرة المترامية التي تفصل العراق عن الشام.
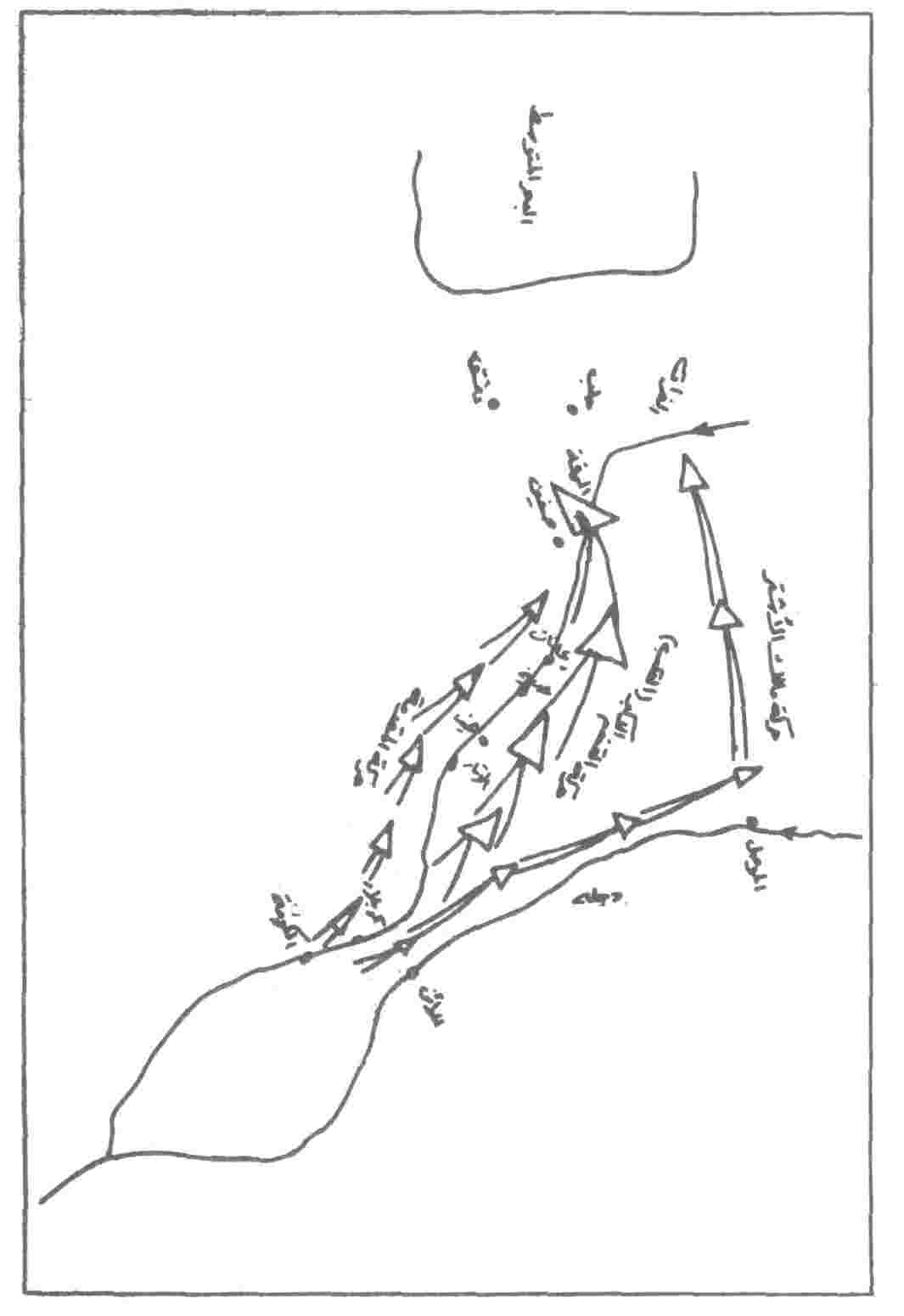 وكانت خطة الإمام أن تلتقي قواته في الرقة حيث كانت تتألف من ثلاثة مجموعات: جيش مالك الأشتر الذي أرسله إلى الموصل والجزيرة، وقوة المقدمة بقيادة زياد بن النضر وشريح بن هانىء، وقوات القسم الأكبر التي يقودها هو، وكانت خطته تلك تستهدف في الواقع تأمين عاملي الأمن والاستخبارات الجيدة ـ الحصول على المعلومات عن العدد ـ وقد أمكنه ذلك بالفعل فكانت قوات الأشتر وقوات المقدمة ترسل له يومياً المعلومات المفصلة عن طبيعة الأرض واتجاهات السكان وطبيعة تعاطفهم وموقفهم من الحرب، كما قامت بعمليات جس النبض في المنطقة التي تقدمت فيها حيث نشبت بعض المعارك المحدودة بين قوات مالك الأشتر وقوات أرسلها معاوية لنفس الغرض، وقد كانت الخطة تهدف أساساً إلى ظهور قوات الإمام من أعالي الشام في منطقة الرقة التي تواجه سهل حلب الفسيح، مما سيترك آثاراً هامة على سكان المدن الواقعة شمال الجزيرة بموازاة حافاتها حتى مدينة حمص ـ التي امتنع عدد كبير من أهلها من المشاركة في جيش معاوية ـ إضافة إلى أنه قد اكتسح كل المقاومات التي نظمتها قوة مقدمة أفرزتها قوات معاوية دون قتال يذكر مع العلم بأن مناطق فارس كلها إلى الشرق وولايات الجنوب حتى نجد والحجاز كانت موالية له. كما يخضع شمالي أرض الخلافة بصورة مطلقة له، وبذا يكون قد أمن جناحه الأيمن بصورة كاملة، كما أن خط سيره الممتد عبر سهول مروية وأرض ملائمة للتقدم وبمحاذاة الجانب الأيسر لنهر الفرات قد أمن له الماء بصورة مستمرة خلال مسيره الطويل إلى أرض المعركة التي انتخبها مسبقاً من أرض العدو قريبة إلى قاعدته الرئيسية في دمشق، أي أن المعركة ستكون فاصلة وحاسمة، لن يكون لعدوه فرصة إعادة تنظيمه لمعركة مشابهة لتلك التي ستجري في صفين وقد يكون مستحيلاً عليه أن يستطيع أن يقاتل مرة أخرى.
وكانت خطة الإمام أن تلتقي قواته في الرقة حيث كانت تتألف من ثلاثة مجموعات: جيش مالك الأشتر الذي أرسله إلى الموصل والجزيرة، وقوة المقدمة بقيادة زياد بن النضر وشريح بن هانىء، وقوات القسم الأكبر التي يقودها هو، وكانت خطته تلك تستهدف في الواقع تأمين عاملي الأمن والاستخبارات الجيدة ـ الحصول على المعلومات عن العدد ـ وقد أمكنه ذلك بالفعل فكانت قوات الأشتر وقوات المقدمة ترسل له يومياً المعلومات المفصلة عن طبيعة الأرض واتجاهات السكان وطبيعة تعاطفهم وموقفهم من الحرب، كما قامت بعمليات جس النبض في المنطقة التي تقدمت فيها حيث نشبت بعض المعارك المحدودة بين قوات مالك الأشتر وقوات أرسلها معاوية لنفس الغرض، وقد كانت الخطة تهدف أساساً إلى ظهور قوات الإمام من أعالي الشام في منطقة الرقة التي تواجه سهل حلب الفسيح، مما سيترك آثاراً هامة على سكان المدن الواقعة شمال الجزيرة بموازاة حافاتها حتى مدينة حمص ـ التي امتنع عدد كبير من أهلها من المشاركة في جيش معاوية ـ إضافة إلى أنه قد اكتسح كل المقاومات التي نظمتها قوة مقدمة أفرزتها قوات معاوية دون قتال يذكر مع العلم بأن مناطق فارس كلها إلى الشرق وولايات الجنوب حتى نجد والحجاز كانت موالية له. كما يخضع شمالي أرض الخلافة بصورة مطلقة له، وبذا يكون قد أمن جناحه الأيمن بصورة كاملة، كما أن خط سيره الممتد عبر سهول مروية وأرض ملائمة للتقدم وبمحاذاة الجانب الأيسر لنهر الفرات قد أمن له الماء بصورة مستمرة خلال مسيره الطويل إلى أرض المعركة التي انتخبها مسبقاً من أرض العدو قريبة إلى قاعدته الرئيسية في دمشق، أي أن المعركة ستكون فاصلة وحاسمة، لن يكون لعدوه فرصة إعادة تنظيمه لمعركة مشابهة لتلك التي ستجري في صفين وقد يكون مستحيلاً عليه أن يستطيع أن يقاتل مرة أخرى.
ولم يكن الإمام يجهل التكتيك ـ تعبئة القوات في ساحة الحرب ـ بل كان يملك من الخبرة في هذا المجال ما يفوق به غيره من القادة المعروفين في التاريخ العسكري، فلننظر إلى توجيهه المكتوب الذي أصدره إلى كل من زياد بن النضر وهانىء بن شريح ولقد كتب لهم توجيهاته تلك كما يفعل القادة في الحروب الحديثة ويقصد من ذلك هو إلزامهم بتطبيق تلك الأوامر وعدم إعطائهما أي عذر بسبب نسيانهما لها فيما لو أصدرها شفهياً، لم تكن الأوامر حرفية تدخل في كل التفاصيل الواجب أتباعها عند كل موقف فقد ترك لهما الحرية في معالجة الأمر عند حدوث اشتباك محدود ومعالجة موقف طارىء. إلا أنه ألزمهما بالإطار العام لعمل المقدمة التي كلفا بقيادتها. كما أن الإمام قد قام بمعالجة الخلاف الذي وقع بينهما بنظرة القائد الثاقبة، فعندما كتبا له بأنهما لا يعرفان من هو المسؤول عن قيادة القوة أجابهما بكتاب أوضح فيه درجات القيادة. فقد قسم القوة إلى قسمين وجعل على كل واحد منهما أميراً أما إذا واجهت القوة موقفاً يقتضي منها وجود قائد واحد كأن تشتبك مع العدو أثناء تقدمها، فإن قائد القوة زياد بن النضر وهو المسؤول عن إدارتها وقيادتها، وإن افترقت القوتان فعلى كل واحدة منهما أمير، وهذا الأسلوب متبع الآن في الحرب الحديثة حيث توضع قوة بأمرة قوة أخرى لأغراض الحركات حيث يصدر أمر الحركات الخاص بهذه القوة ويحدد فيه القائد المسؤول عن قيادتها، وهي درجة من درجات القيادة في العمليات، وما فعله الإمام مهم جداً، لأنه يتوجب وجود قائد واحد يكون وحده المسؤول عن إدارة العمليات لأن وجود قائدين في آن واحد على رأس القوة سوف يفقدها قابلية اتخاذ القرار السريع والضروري لمعالجة أي موقف طارىء وهناك مثل معروف تتداوله الجيوش الحديثة حول مشكلة تعدد القادة وهو «قائد واحد غير كفوء خير من عدة قادة أكفاء».
كتب الإمام توجيهه التالي:
«بسم الله الرحمن الرحيم
من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هانىء سلام عليكما، فإني أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإني قد وليت مقدمتي زياد بن النضر وأمرته عليها، وشريح على طائفة منها أمير، فإن أنتما جمعكما بأس فزياد بن النضر على الناس، وأن افترقتما فكل واحد منكما أمير الطائفة التي وليناه أمرها. واعلما أن مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم. فإذا أنتما خرجتما من بلادكما فلا تسأما من توجيه الطلائع. ومن نفض الشعاب والشجر والخَمرِ في كل جانب كي لا يغتركما عدو، أو يكون لكم كمين، ولا تسيرن الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبية، فإن دهمكم داهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبية، وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الإشراق أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار، كي ما يكون ذلك لكم ردءاً وتكون مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين. واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال وبأعالي الإشراف ومناكب الهضاب يرون لكم لئلا يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمن. وإياكم والتفرق، فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً، وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً. وإذا غشيكم ليل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والأترسة، ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم، وما أقمتم فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلة، ولا تلفى منكم غرة، فما قوم حفوا عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كانوا كأنهم في حصون، واحرسا عسكركما بأنفسكما، وأياكما أن تذوقا نوماً حتى تصبحا إلا غراراً أو مضمضمة، ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكما، وليكن عندي كل يوم خبركما ورسول من قبلكما فإني ـ ولا شيء إلا ما شاء الله ـ حثيث السير في آثاركما. عليكما في حربكما بالتؤدة، وإياكم والعجلة إلا أن تمكنكم فرصة بعد الأعذار والحجة. وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن تبدآ أو يأتيكما أمري إن شاء الله والسلام».
تقسم القوة المتقدمة عادة إلى الأقسام التالية (وهذا التقسيم لم يتبدل في جوهره مطلقاً وظلت الجيوش المتقدمة خلال كل الحروب قديمها وحديثها تتبع نفس الأساليب هذه حتى عصرنا الراهن وقد اتبع الإمام نفس تلك الأساليب خلال تقدمه هذا):
أولاً: المقدمة.
ثانياً: القسم الأكبر.
ثالثاً: المجنبات ـ واحدة أو اثنين ـ حسب طبيعة الأرض وتهديد العدو.
رابعاً: المؤخرة ـ أو الساقات ـ.
ويؤثر في كل قسم من هذه الأقسام الأربعة وفي حجم قواته ونوعية أسلحته عوامل كثيرة أهمها: طبيعة الأرض وقوة العدو التي يفرزها على محور تقدم القوات ونوع التسليح المعادي، وهذه العوامل تفرض نفسها على جسم كل منها في كل العصور والأزمان. فتأليف قوة المقدمة يتأثر بطبيعة الأرض، جبلية كانت أم سهيلة أم صحراوية، كما يتأثر بحجم القوات التي يفرزها العدو على محور تقدمها لفرض فرص الإعاقة عليها، أو إيقاع أكبر ما يمكن من الخسائر بها، كما يؤثر نوع التسليح المعادي على حجم القوة ونوع التسليح الواجب، امتلاكها له. ويظهر ذلك جلياً في الحرب الحديثة، فإذا كانت الأرض تسهل حركة نوع معين من القوات كالدروع مثلاً، كأن تكون مفتوحة وصلبة كالأراضي الصحراوية والسهلية، فإن قوة المقدمة يمكن أن تحتوي على نسبة من الدروع، أما إذا كانت جبلية قليلة المسالك فإنها تعتمد على المشاة الذين ينتقلون على الحيوانات، كما أن مقاومة العدو ـ قوته ـ إن كانت كبيرة، فإنها تحتاج إلى قوة أكبر في المقدمة، وإذا كان العدو يملك قوة نارية ضخمة في مواقع الإعاقة التي يتركها على محور أو محاور التقدم فإننا سنحتاج إلى أسلحة تؤمن قوة نارية ملائمة لمعالجة قوة العدو تلك، حيث تفرز مدفعية معينة أو قوة مدرعة لتأمين هذا التوازن، إلا أن امتزاج هذه العوامل الثلاثة هو الذي يؤثر في القرار النهائي على حجم وطبيعة تسليح القوة المتقدمة، وهذه العوامل الثلاثة تؤثر أيضاً على تشكيل قوات المقدمة. وهذه العوامل الثلاثة فرضت تأثيرها كذلك على تشكيل قوة المقدمة خلال الحروب السالفة، فالأرض تؤثر على نوع القوة راجلة أو راكبة، نوع تسليحها وثقله وهكذا.
مجنبة
المقدمة
القسم الأكبر
مجنبة
مجنبة
مؤخرة
ولم يكن العرب في الجاهلية يعرفون هذا التقسيم للقوات لا أثناء التقدم ولا أثناء المعارك التي كانت تأخذ طابع الكر والفر المنهك للقوات، إلا أنهم تعلموه من خلال احتكاكهم بجيوش الدولتين التي قاتلوها أثناء الفتح الإسلامي لبلاد الشام والعراق وهما الدولتان البيزنطية والفارسية.
وقد أوضح الإمام علي (ع) واجبات المقدمة بدقة رائعة تبعث على الإعجاب ولم يك توجيهه هذا يقل روعة وبياناً عن أي كراسة عسكرية تدرس في كليات الأركان في مختلف جيوش العالم.
فواجب المقدمة الأساسي هو الاستطلاع والصد، أما القسم الأكبر، وهي عيون المقدمة التي ترى فيها العدو، كما جرت العادة أن تفرز المقدمة قوة صغيرة أمامها تسمى بالطليعة تتقدم أمام المقدمة تكون بمثابة عين لها. حيث يوصي الإمام قائدي قوة المقدمة أن لا يملاَّ من إخراج الطلائع أمام قواتهما وتوجيهها إلى كل الاتجاهات، فتقوم بالتفتيش في كل الوديان والغابات، ولقد جاءت كلمة (نَفض) بليغة جداً في معناها اللغوي فهي تعني الجماعة الحشد الذين ينتشرون في الأرض ليتحسسوا وبالتالي لينظروا هل فيها عدو أو خوف، والغاية من ذلك هي حرمان العدو من مباغتة القوة أو وقوعها في كمين، ينصبه العدو لها أثناء تقدمها، وقد أمر الإمام (ع) أن تكون الكتائب المتقدمة متأهبة للقتال دوماً وذلك بأن تأخذ شكل الانفتاح النهائي للمعركة لأن ذلك يجنب القوة ضياع الوقت، وفي حالة تقدم المقدمة بشكل اعتيادي فإن القائد سوف يحتاج بالتأكيد إلى وقت تستغرقه عملية إصدار الأوامر ثم انفتاح القوة يميناً ويساراً وإلى الأمام مما سيمكن العدو من الفرار بعد أن يقوم بضرب القوة لذا فإن تقدم قوة المقدمة، وهي منفتحة بتشكيل المعركة، سوف يمكنها من الرد الفوري والسريع إزاء أي هجوم مباغت معادي يمنع العدو من التملص والفرار مما يضطره إلى الانسحاب دون أن ينفذ هجومه أو تتحرك كمائنه.
يوضح الإمام كذلك أسلوب احتلال معسكر في العراء، وهو موضوع عالجته كراسات التعبية في المناطق الجبلية أيضاً، فالإمام يطلب إنشاء هذا المعسكر عندما تقترب القوة من العدو أو يقترب هو منها في المناطق المرتفعة أو سفوح الجبال أو في منعطفات الأنهار كي تؤمن لهذه المعسكرات ستراً طبيعياً من رصد ونيران العدو ـ سهامه ورماحه قديماً ـ كما يؤمن ذلك حماية لأحد جوانب المعسكر مما يؤدي إلى الاهتمام بمراقبة جهة معينة أو اثنتين، والذي تفرضه طبيعة الأرض وهذا الأسلوب يجبر العدو على التحرك باتجاه معين، كما يقتضي أن تخرج، القوة التي اتخذت لها معسكراً، قوة من الراصدين أو الرقباء تدفعهم إلى المناطق المرتفعة التي تحيط بالمعسكر، فتقوم بالرصد وإخبار القوة المعسكرة بأي حركة يقوم بها العدو. وبهذا يحرم من مباغتة القوة والهجوم عليها وهي في معسكرها دون استعداد أو إنذار مسبق، ولبقاء القوة متماسكة أهمية كبيرة في تنفيذ الواجبات وصد غارات العدو وإفشال كمائنه، فإذا انقسمت القوة إلى مجموعات ثانوية تنتقل الواحدة بعيداً عن الأخرى دون تنسيق بكتل صغيرة، فإنها ستصبح عرضة للتدمير الواحدة بعد الأخرى، لذا فإن الإمام ينصح القائدين بأن يعسكرا سوية ويرتحلا سوية كي لا يصبحا هدفاً سهلاً اصطياده في حال تفرق القوة وتنقلها بوحدات فرعية ليلاً ونهاراً ثم يعود الإمام (ع) إلى وصف المعسكر، الذي تتخذه القوة أثناء تنقلها أو عند مقابلتها للعدو قبل نشوب القتال، فيحدد شروطاً هامة فيه تتعلق ببنائه أولاً وأسلوب العمل داخله من حيث توزيع الأسلحة والقوات. وكراسات التعبئة في المناطق الجبلية أكدت على شروط معينة في بناء المعسكر وهي بناء جدار حول المعسكر من أكياس الرمل أو المواد التي تتيسر في المنطقة، ثم توزيع القوات داخله، كما تثبت الأسلحة على جداره الخارجي، لأن بعض المعسكرات التي تمكث فيها القوات فترة طويلة يعمد فيها إلى بناء جدار داخلي إضافة إلى جدارها الخارجي لتأمين الحماية للمقاتلين الذين يكلفون بالدفاع عن المعسكر من نيران الهاونات عند سقوطها داخل المعسكر، وعدم الخروج ليلاً من المعسكر، إخراج الدوريات والكمائن على الطرق المحتملة لتحرك العدو، احتلال القمم المسيطرة على المعسكر لحرمان العدو من استخدامها كقواعد نارية أو الهجوم على المعسكر الذي أسس أسفلها أو على مقربة منها، والإمام يطلب من قائدي القوة أن ينتبها إلى تأمين حماية جيدة لمعسكرهما عندما يحلاّن فيه بعد طول تنقل، فيطلب إنشاء جدار للمعسكر من رماح المقاتلين وتروسهم يتم غرزها في الأرض بصورة متلاصقة لتشكيلة هذا الجدار، يقف رماة النبال خلف هذا الجدار على أهبة الاستعداد لتوجيه نيرانهم ـ سهامهم ـ نحو العدو عندما ترصد حركته من بعيد، ويشبه الإمام (ع) هذا المعسكر الذي أنشىء على هذه الصورة بالقلعة أو الحصن الذي يعطي المتحصنين فيه قوة ومنعة تمنع العدو من مباغتة القوة وتدميرها.. وقد كان القائد «الإسكندر المقدوني» يستخدم الأشجار في بناء هذا الجدار عندما يؤسس معسكراً له في العراء. حيث يقوم بقطعها فوراً ثم غرز رؤوسها التي يعمد إلى بريها كي تصبح مدببة يسهل نفاذها في الأرض ودقها، ولأن المناطق التي تنقل فيها الإسكندر كانت مناطق غابات أو تكثر فيها الأشجار، ولأن أوروبا كلها كانت أرضاً مغطاة بالغابات الكثيفة والأشجار لذا فإن الإسكندر كان يستفيد منها بصورة آلية لأنها تساعد على العمل بهذه الشاكلة، أما المناطق التي عاش فيها الإمام (ع) والمناطق التي تنقل فيها لم تكن فيها أشجار طبيعية يمكن الاستفادة منها لأغراض بناء المعسكرات، لذا فإنه أوصى باستخدام رماح ودروع المقاتلين لهذا الغرض، ولو أنه واصل تقدمه خلال مناطق مشجرة أو مناطق غابات لاستبدل رماح وتروس مقاتليه بأشجار يقطعها من الغابات التي يجتازها ويترك رماح وتروس مقاتليه بأيديهم لحاجتهم لها عند نشوب قتال خلال مهاجمة العدو للمعسكرات التي تنشأ في العراء.
وينتقل الإمام إلى مهمات القادة في تلك المواقف وهي السهر على أمن القوة وسلامتها، ويأمر قائدي المقدمة أن يشرفا شخصياً على ترتيبات الحراسة والتأكد من سلامتها وذلك ببقائهما ساهرين عليها ليلاً يتنقلون من مركز رصد وحراسة إلى آخر، ويذكرهما بأن لا يناما إلا قليلاً كي يستطيعا أن يعالجا المواقف الطارئة بسرعة وأن يظلاّ هكذا حتى يلتقيا بقوات العدو، ثم يعرج الإمام إلى الواجب الرئيسي لهذه القوات، بعد أن يبين أسلوب تعبئتها وتنقلها فيأمر قائدي القوة بإرسال تقارير يومية ـ تسمى اليوم «تقارير الاستخبارات» ـ تتضمن معلومات تفصيلية عن العدو والأرض والطقس إلى القسم الأكبر أو القلب الذي يكون في حالة حركة معقباً قوة المقدمة، وتوضح كراسات كليات الأركان واجبات قوة المقدمة بصورة مقاربة لما بيّن الإمام، فتثبت واجبين أساسيين وهما: الأخبار عن العدو والاشتباك معه عند الضرورة القصوى لأنها قوات قليلة لا طاقة لها على القتال لمدة طويلة أو الدخول في معارك حاسمة مع قوات العدو التي ربما كانت أكثر منها عدداً وأقوى تسليحاً، خاصة إذا كانت قوات العدو التي تلتقي بها ـ قوة المقدمة ـ هي القلب أو الجزء الأكبر من قواته، وهنا يذكر الإمام الحالات والظروف التي ترغم فيها قوة المقدمة على القتال فيوصي بالتأني في الدخول في معارك مع العدو أولاً، وهذا أمر يجب أن تنتبه إليه قوة المقدمة دوماً وتضعه نصب أعينها، فلا تدخل في معركة مع العدو إلا بعد أن تجد نفسها قد امتلكت المبادأة في ظروف ملائمة جداً لتحقيق نصر مضمون، كما أوصاها في الحالات الأخرى بعدم القتال إلا أن يبدأ به أو بأمرٍ يصدره هو شخصياً لقائد القوة المكلف بقيادتها عند حدوث اشتباك مع العدو.
ما تقدم، مجرد تأمل أولي ببعض النصوص المأثورة عن أمير المؤمنين (ع) والناظرة إلى الأساليب العسكرية التي كان يتبعها الإمام (ع) في حروبه مع أعدائه وقد أجرينا مقارنة سريعة مع الفن (التكتيكي) في التعبئة والزحف وتوزيع الأدوار لآخر ما وصلت إليه «الأكاديميات» العسكرية الحديثة، والنتيجة الأولية التي ظهرت هي أن الإمام كان قد قطع شوطاً كبيراً في التخطيط العسكري بمختلف مراحله وأشكاله، ونحن إذ نقدم هذه الدراسة نأمل أن يوفقنا الباري تعالى إلى إتمام دراسة وافية عن هذا الجانب من حياة الإمام علي (ع).
العقيد الركن: أحمد الزيدي
نهج البلاغة
إن كتاب «نهج البلاغة» جمعه الشريف الرضي محمد بن الحسين المتوفى 406هـ، وأودع فيه ما اختاره من كلام أمير المؤمنين (ع)، وقد أتم جمعه في رجب سنة 400 للهجرة، كما نص هو على ذلك في آخر الكتاب. وقد وهم جرجي زيدان ـ فنسب جمع النهج للشريف المرتضى علي بن الحسين، وربما تابع فيه بغير تثبت ـ بروكلمان الذي قال: «والصحيح أنه من جمع الشريف المرتضى».
ولو رجع بروكلمان وجرجي زيدان ومن شايعهما إلى كتابي الشريف الرضي: حقائق التأويل والمجازات النبوية ـ وهما مطبوعان ومعروفان؛ لوقفا على تكرار الإشارة من الرضي إلى كونه هو الجامع لكتاب النهج.
وحظي هذا الكتاب من الأهمية والشأن بما لم يحظ به كتاب غيره على مر العصور، وأصبح له من الشروح ما بلغ (75) شرحاً في حساب بعض المؤلفين، و(101) من الشروح في حساب مؤلف آخر.
وقد حاول بعض الناس أن يثير شكوكاً في صحة نسبة الكتاب إلى الإمام، والحقيقة أن هذه الشكوك لا تستحق المناقشة، والشريف الرضي أرفع من أن تلحقه التخرصات، وأمير المؤمنين أعظم من أن يخترع له محبوه منقبة ينحلونه إياها. وقد كان غاية ما أمكن أن يقولوه هو أن جامع «النهج» لم يذكر أسانيده فيما روى، وقد انبرى لرد ذلك في عصرنا الشيخ عبدالله نعمة في كتاب سماه: «مصادر نهج البلاغة» وكذلك فعل السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب في كتاب سمّاه: «نهج البلاغة وأسانيده».
وفيما يلي كلمة عن «النهج»، وبلاغة علي (ع) وأقواله، بقلم: جورج جرداق.
قال جورج جرداق:
من تتبع سير العظماء الحقيقيين في التاريخ لا فرق بين شرقي منهم أو غربي، ولا قديم ومحدث، أدرك ظاهرة لا تخفى وهي أنهم، على اختلاف ميادينهم الفكرية وعلى تباين مذاهبهم في موضوعات النشاط الذهني، أدباء موهوبون على تفاوت في القوة والضعف.
هذه الحقيقة تتركز جلية واضحة في شخصية علي بن أبي طالب (ع) فإذا هو الإمام في الأدب، كما هو الإمام في ما أثبت من حقوق وفي ما علم وهدى، وآيته في ذلك «نهج البلاغة» الذي يقوم في أسس البلاغة العربية في ما يلي القرآن من أسس وتتصل به أساليب العرب في نحو ثلاثة عشر قرناً فتبني على بنائه وتقتبس منه ويحيا جيدها في نطاق من بيانه الساحر.
أما البيان فقد وصل على سابقه يلاحقه، فضم روائع البيان الجاهلي الصافي المتحد بالفطرة السليمة اتحاداً مباشراً، إلى البيان الإسلامي الصافي المهذب المتحد بالفطرة السليمة والمنطق القوي اتحاداً لا يجوز فيه فصل العناصر بعضها عن بعض. فكان له من بلاغة الجاهلية، ومن سحر البيان النبوي، ما حدا بعضهم إلى أن يقول في كلامه: إنه «دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق».
ولا عجب في ذلك، فقد تهيأت لعلي جميع الوسائل التي تعهد لهذا المكان بين أهل البلاغة. فقد نشأ في المحيط الذي تسلم فيه الفطرة وتصفو، ثم إنه عايش أحكم الناس محمد بن عبدالله، وتلقى من النبي رسالته بكل ما فيها من حرارة وقوة، أضف إلى ذلك استعدادته الهائلة العظيمة، فإذا بأسباب التفوق تجتمع لديه من الفطرة ومن البيئة جميعاً!.
أما الذكاء، الذكاء المفرط، فتلقى له في كل عبارة من «نهج البلاغة» عملاً عظيماً. وهو ذكاء حي، قادر، واسع، عميق، لا تفوته أغوار. إذا هو عمل في موضوع أحاط به بعداً فما يفلت منه جانب ولا يظلم منه كثير أو قليل، وغاص عليه عمقاً، وقلبه تقليباً، وعرّكه عركاً، وأدرك منه أخفى الأسباب وأمعنها في الاختفاء كما أدرك أصدق النتائج المترتبة على تلك الأسباب: ما قرب منها أشد القرب، وما بعد أقصى البعد.
ومن شروط الذكاء العلوي النادر هذا التسلسل المنطقي الذي تراه في النهج أنى اتجهت. وهذا التماسك بين الفكرة والفكرة، حتى تكون كل منهما نتيجة طبيعية لما قبلها، وعلة لما بعدها. ثم إن هذه الأفكار لا تجد فيها ما يستغنى عنه في الموضوع الذي يبحث فيه. بل إنك لا تجد فيها ما يستقيم البحث بدونه، وهو لاتساع مداه، لا يستخدم لفظاً إلا وفي هذا اللفظ ما يدعوك لأن تتأمل وتتمعن في التأمل، ولا عبارة إلا وتفتح أمام النظر آفاقاً وراءها آفاق.
فعن أي رحب وسيع من مسالك التأمل والنظر يكشف لك قوله: «الناس أعداء ما جهلوا»، أو قوله: «قيمة كل امرىء ما يحسنه». أو «الفجور دار حصن ذليل!». وأي إيجاز معجز هو هذا الإيجاز: «من تخفف لحق». وأي جليل من المعنى في العبارات الأربع وما تحويه من ألفاظ قلائل فصلت تفصيلاً، بل قل: أنزلت تنزيلاً!
ثم عن أي حدة في الذكاء واستيعاب للموضوع وعمق في الإدراك، يشف هذا الكشف العجيب عن طبع الحاسد وصفة نفسه وحقيقة حاله: «ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد: نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم. مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملك!».
ويستمر تولد الأفكار في «نهج البلاغة» من الأفكار، فإذا أنت منها أمام حشد لا ينتهي. وهي مع ذلك لا تتراكم، بل تتساوق ويترتب بعضها على بعض. ولا فرق في ذلك بين ما يكتبه علي (ع) وما يلقيه ارتجالاً. فالينبوع هو الينبوع ولا حساب في جريه لليل أو نهار.
ففي خطبه المرتجلة معجزات من الأفكار المضبوطة بضابط العقل الحكيم والمنطق القويم. وإنك لتدهش، أمام هذا المقدار من الأحكام والضبط العظيمين، حين تعلم أن علياً لم يكن ليعد خطبه ولو قبيل إلقائها بدقائق أو لحظات.
فهي جائشة في ذهنه منطلقة على لسانه عفو الخاطر لا عنت ولا إجهاد كالبرق إذ يلمع ولا خبر يأخذه أو يعطيه قبل وميضه. وكالصاعقة إذ تزمجر ولا تهيء نفسها لصعق أو زمجرة، وكالريح إذ تهب فتلوي وتميل وتكسح وتنصب على غاية، ثم إلى مداورها تعود، ولا يدفعها إلى أن تروح وتجيء إلا قانون الحادثة ومنطق المناسبة في حدودها القائمة لا قبل ولا بعد!
ومن مظاهر الذكاء الضابط القوي في «نهج البلاغة»، تلك الحدود التي كان علي (ع) يضبط بها عواطف الحزن العميق إذ تهيج في نفسه وتعصف. فإن عاطفته الشديدة ما تكاد تغرقه في محيط من الأحزان والكآبات البعيدة، حتى يبرز سلطان العقل في جلاء ومضاء، فإذا هو آمر مطاع.
ومن ذكاء علي المفرط الشامل في نهجه كذلك؛ أنه نوع البحث والوصف، فأحكم في كل موضوع، ولم يقصر جهده الفكري على واحد من الموضوعات أو سبل البحث. فهو يتحدث بمنطق الحكيم الخبير عن أحوال الدنيا، وشؤون الناس، وطبائع الأفراد والجماعات. وهو يصف البرق والرعد والأرض والسماء، ويسهب في القول في مظاهر الطبيعة الحية، فيصف خفايا الخلق في الخفاش والنملة والطاووس والجرادة وما إليها. ويضع للمجتمع دساتير وللأخلاق قوانين. ويبدع في التحدث عن خلق الكون وروائع الوجود. وإنك لا تجد في الأدب العربي كله هذا المقدار الذي تجده في نهج البلاغة من روائع الفكر السليم والمنطق المحكم، في مثل هذا الأسلوب النادر.
أما الخيال في نهج البلاغة فمديد وسيع، خفاق الجوانح في كل أفق. وبفضل هذا الخيال القوي الذي حرم منه كثير من حكماء العصور ومفكري الأمم، كان علي (ع) يأخذ من ذكائه وتجاربه المعاني الموضوعية الخالصة، ثم يطلقها زاهية متحركة في إطار تثبت على جنباته ألوان الجمال على أروع ما يكون اللون. فالمعنى مهما كان عقلياً جافاً، لا يمر في مخيلة علي إلا وتنبت له أجنحة تقضي فيه على صفة الجمود وتمده بالحركة والحياة.
فخيال علي نموذج للخيال العبقري الذي يقوم على أساس من الواقع، فيحيط بهذا الواقع ويبرزه ويجليه، ويجعل له امتدادات من معدنه وطبيعته، ويصبغه بألوان من مادته ولونه، فإذا الحقيقة تزداد وضوحاً، وإذا بطالبها يقع عليها أو تقع عليه!
وقد تميز علي بقوة ملاحظة نادرة، ثم بذاكرة واعية تخزن وتتسع. وقد مر من أطوار حياته بعواطف جرها عليه حقد الحاقدين ومكر الماكرين، ومر منها كذلك بعواطف كريمة أحاطه بها وفاء الطيبين وإخلاص المخلصين. فتيسرت له من ذلك جميعاً عناصر قوية تغذي خياله المبدع. فإذا بها تتعاون في خدمة هذا الخيال وتتساوق في لوحات رائعة حية، شديدة الروعة والحيوية، تتركز على واقعية صافية تمتد لها فروع وأغصان، ذات أوراق وأثمار.
ومن ثم يمكنك، إذا أنت شئت، أن تحول عناصر الخيال القوي فهي نهج البلاغة إلى رسوم مخطوطة باللون، لشدة واقعيتها واتساع مجالها وامتداد أجنحتها وبروز خطوطها. ألا ما أروع خيال الإمام إذ يخاطب أهل البصرة وكان بنفسه ألم منهم بعد موقعة «الجمل»، قائلاً: «لتغرق بلدتكم حتى كأنني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طير في لجة بحر»([353]).
أو في مثل هذا التشبيه الساحر: «فتن كقطع الليل المظلم».
أو هذه الصورة المتحركة:
«وإنما أنا كقطب الرحى: تدور علي وأنا بمكاني!».
أو هذه اللوحة ذات الجلال التي يشبه فيها امتدادات بيوت أهل البصرة بخراطيم الفيلة، وتبدو له شرفاتهن كأنها أجنحة النسور: «ويل لسكككم العامرة وللدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور وخراطيم كخراطيم الفيلة!».
ومن مزايا الخيال الرحب قوة التمثيل، والتمثيل في أدب الإمام وجه ساطع بالحياة. وإن شئت مثلاً على ذلك فانظر في حال صاحب السلطان الذي يغبطه الناس، ويتمنون ما هو فيه من حال، ولكنه أعلم بموضعه من الخوف والحذر، فهو وإن أخاف بمركوبه إلا أنه يخشى أن يغتاله. ثم انظر بعد ذلك إلى علي كيف يمثل هذا المعنى يقول:
«صاحب السلطان كراكب الأسد يغبط بموقعه، وهو أعلم بموضعه».
وإن شئت مثلاً آخر فاستمع إليه يمثل حالة رجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه، فيقول: «إنما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه!» والردف: هو الراكب خلف الراكب. ثم إليك هذا النهج الرائع في تمثيل صاحب الكذب: «إياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب: يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب!».
أما النظرية الفنية القائلة: بأن كل قبيح في الطبيعة يصبح جميلاً في الفن، فهي إن صحت؛ فإنما الدليل عليها قائم في كلام ابن أبي طالب في وصف من فارقوا الدنيا. فما أهول الموت وما أبشع وجهه. وما أروع كلام ابن أبي طالب فيه وما أجمل وقعه. فهو قول آخذ من العاطفة العميقة نصيباً كثيراً، ومن الخيال الخصيب نصيباً أوفر؛ فإذا هو لوحة من لوحات الفن العظيم لا تدانيها إلا لوحات عباقرة الفنون في أوروبا. ساعة صوروا الموت وهوله لوناً ونغماً وشعراً.
فبعد أن يذكر علي (ع) الأحياء بالموت، ويقيم العلاقة بينهم وبينه. يوقظهم على أنهم دانون من منزل الوحشة بقول فيه من الغربة القاسية لون قاتم ونغم حزين: «فكأن كل امرىء منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته، فيا له من بيت وحدة ومنزل وحشة، ومفرد غربة!». ثم يهزهم بما هم مسرعون إليه ولا يدرون، بعبارات متقطعة متلاحقة؛ وكأن فيها دوي طبول تنذر تقول: «ما أسرع الساعات في اليوم، وأسرع الأيام في الشهر، وأسرع الشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر!» بعد ذلك يطلق في أذهانهم هذه الصورة الرائعة التي يأمر بها العقل، وتشعلها العاطفة، ويجسم الخيال الوثاب عناصرها، ثم يعطيها هذه الحركات المتتابعة، وهي بين عيون تدمع وأصوات تنوح وجوارح تئن، قائلاً: «وإنما الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم». ثم يعود فيطلق لعاطفته وخياله هذه اللوحة الخالدة من لوحات الشعر الحي:
«ولكنهم سقوا كأساً بدلتهم بالنطق خرساً، وبالسمع صمماً، وبالحركات سكوناً. فكأنهم في ارتجال الصفة صرعى سبات([354])! جيران لا يتآنسون، وأحباء لا يتزاورون، بليت بينهم عرى التعارف، وانقطعت منهم أسباب الإخاء، فكلهم وحيد وهم جميع، وبجانب الهجر وهم أخلاء، لا يتعارفون لليل صباحاً، ولا لنهار مساء. أي الجديدين([355]) ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً([356])».
ثم يقول هذا القول الرهيب: «لا يعرفون من أتاهم، ولا يحفلون من بكاهم، ولا يجيبيون من دعاهم!».
فهل رأيت إلى هذا الإبداع في تصوير هول الموت ووحشة القبر وصفة سكانه في قوله:
«جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون!»؟ ثم هل فطنت إلى هذه الصورة الرهيبة لأبدية الموت التي لا ترسمها إلا عبقرية علي: «أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً!»؟ ومثل هذه الروائع في «النهج» كثير.
هذا الذكاء الخارق، وهذا الخيال الخصب في أدب الإمام يتحدان اتحاد الطبيعة بالطبيعة، مع العاطفة الهادرة التي تمدها بوهج الحياة. فإذا الفكرة تتحرك وتجري في عروقها الدماء سخية حارة. وإذا بها تخاطب فيك الشعور بمقدار ما تخاطب العقل لانطلاقها من عقل تمده العاطفة بالدفء. وقد يصعب على المرء أن يعجب بأثر من آثار الفكر أو الخيال في ميادين الأدب وسائر الفنون الرفيعة، إن لم تكن للعاطفة مشاركة فعالة في إنتاج هذا الأثر، ذلك أن المركب الإنساني لا يرضيه، طبيعياً، إلا ما كان نتاجاً لهذا المركب كله. وهذا الأثر الأدبي الكامل هو ما نراه في نهج البلاغة. وإنك لتحس نفسك مندفعاً في تيار جارف من حرارة العاطفة وأنت تسير في نهج البلاغة من مكان إلى آخر.
أفلا يشيع في قلبك الحنان والعطف شيوعاً وأنت تصغي إلى علي (ع) يقول: «لو أحبني جبل لتهافت» أو «فقد الأحبة غربة!» أو «اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي» وقالوا: «ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه، فاصبر مغموماً أو مت متأسفاً! فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي!».
وإليك كلاماً له عند وفاة السيدة فاطمة، يخاطب به ابن عمه الرسول:
«السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك، والسريعة اللحاق بك! قلّ، يا رسول الله، عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعزّ!» ومنه «أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهّد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم!».
ثم إليك هذا الخبر:
روى أحدهم عن نوف البكالي بصدد إحدى خطب الإمام علي قال:
«خطبنا هذه الخطبة بالكوفة أمير المؤمنين (ع)، وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي، وعليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه ليف وفي رجليه نعلان من ليف، فقال (ع)، في جملة ما قال:
«ألا أنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاً وأقبل منها ما كان مدبراً. وأزمع الترحال عباد الله الأخيار، وباعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى! ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين أن لا يكونوا اليوم أحياء يسيغون الغصص ويشربون الرنق؟! قد، والله، لقوا الله فوفاهم أجورهم وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم! أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية؟».
قال: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة فأطال البكاء!.
وأخبر ضرار بن ضمرة الضبائي قال: فأشهد لقد رأيته ـ يقصد الإمام ـ في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في ظلامه قابض على لحيته يتململ ويبكي بكاء الحزين، ويقول: «يا دنيا، يا دنيا، إليك عني! أبي تعرضت أم إليَّ تشوقت؟ لا حان حينك، هيهات! غرّي غيري، لا حاجة لي فيك: قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها! فعيشك قصير، وخطرك يسير، وأملك حقير! آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد!».
هذه العاطفة الحارة التي عرفها الإمام في حياته، تواكبه أنّى اتجه في نهج البلاغة، وحيث سار. تواكبه في ما يحمل على الغضب والسخط، كما تواكبه في ما يثير العطف والرضا.
حتى إذا رأى تخاذل أنصاره عن مساندة الحق فيما يناصر الآخرون الباطل ويحيطونه بالسلاح وبالأرواح تألم وشكا، ووبّخ وأنّب، وكان شديداً قاصفاً، مزمجراً، كالرعد في ليالي الويل! ويكفيك أن تقرأ خطبة الجهاد التي تبدأ بقوله: «أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الصم الصلاب إلخ…»، لتدرك أية عاطفة متوجعة ثائرة هي تلك التي تمد هذه الخطبة بنبض الحياة وجيشانها!.
وإنه لمن المعيي أن نسوق الأمثلة على تدفق العاطفة الحية التي تبث الدفء في مآثر الإمام. فهي في أعماله، وفي خطبه وأقواله، مقياس من المقاييس الأسس. وما عليك إلا أن تفتح هذا الكتاب، كي تقف على ألوان من عاطفة ابن أبي طالب، ذات القوة الدافقة والعمق العميق! الأسلوب والعبقرية الخطابية.
أما من حيث الأسلوب، فعلي بن أبي طالب ساحر الأداء. والأدب لا يكون إلا بأسلوب، فالمبنى ملازم فيه للمعنى، والصورة لا تقل في شيء عن المادة. وأي فن كانت شروط الإخراج فيه أقل شأناً من شروط المادة!
وإن قسط علي بن أبي طالب من الذوق الفني، أو الحس الجمالي، لمما يندر وجوده. وذوقه هذا كان المقياس الطبيعي الضابط للطبع الأدبي عنده. أما طبعه هذا فهو طبع ذوي الموهبة والأصالة الذين يرون فيشعرون ويدركون فتنطلق ألسنتهم بما تجيش به قلوبهم وتنكشف عنه مداركهم انطلاقاً عفوياً. لذلك تميز أدب علي بالصدق كما تميزت به حياته. وما الصدق إلا ميزة الفن الأولى ومقياس الأسلوب الذي لا يخادع.
وإن شروط البلاغة، التي هي موافقة الكلام لمقتضى الحال، لم تجتمع لأديب عربي كما اجتمعت لعلي بن أبي طالب. فإنشاؤه مثل أعلى لهذه البلاغة، بعد القرآن. فهو موجز على وضوح، قوي جياش، تام الانسجام لما بين ألفاظه ومعانيه وأغراضه من ائتلاف، حلو الرنة في الأذن موسيقي الوقع. وهو يرفق ويلين في المواقف التي لا تستدعي الشدة ويشتد ويعنف في غيرها من المواقف، لا سيما ساعة يكون القول في المنافقين والمراوغين وطلاب الدنيا على حساب الفقراء والمستضعفين وأصحاب الحقوق المهدورة. فأسلوب علي صريح كقلبه وذهنه، صادق كطويته، فلا عجب أن يكون نهجاً للبلاغة.
وقد بلغ أسلوب علي من الصدق حداً ترفع به حتى السجع عن الصنعة والتكلف. فإذا هو على كثرة ما فيه من الجمل المتقاطعة الموزونة المسجعة، أبعد ما يكون عن الصنعة، وأقرب ما يكون من الطبع الزاخر.
فانظر إلى هذا الكلام المسجع وإلى مقدار ما فيه من سلامة الطبع: «يعلم عجيج الوحوش في الفلوات، ومعاصي العباد في الخلوات، واختلاف الحيتان في البحار الغامرات، وتلاطم الماء بالرياح العاصفات!» أو إلى هذا القول من إحدى خطبه: وكذلك السماء والهواء، والرياح والماء، فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر، والماء والحجر، واختلاف هذا الليل والنهار، وتفجر هذه البحار، وكثرة الجبال، وطول هذه القلال، وتفرق هذه اللغات والألسن المختلفات إلخ…» وأوصيك خيراً بهذا السجع الجاري مع الطبع: «ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب([357]) وأجرى فيها سراجاً مستطيراً([358]) وقمراً منيراً في فلك دائر، وسقف سائر إلخ…» فإنك لو حاولت إبدال لفظ مسجوع في هذه البدائع جميعاً، بآخر غير مسجوع، لعرفت كيف يخبو أشراقها، ويبهت جمالها، ويفقد الذوق فيها أصالته ودقته وهما الدليل والمقياس. فالسجع في هذه الأقوال العلوية ضرورة فنية يقتضيها الطبع الذي يمتزج بالصناعة امتزاجاً حتى لكأنهما من معدن واحد يبعث النثر شعراً له أوزان وأنغام ترفق المعنى بصور لفظية من جوها ومن طبيعتها.
ومن سجع الإمام آيات ترد النغم على النغم رداً جميلاً، وتذيب الوقع في الوقع على قرارات لا أوزن منها على السمع ولا أحب ترجيعاً. ومثال ذلك ما ذكرناه من سجعاته منذ حين، ثم هذه الكلمات الشهيات على الأذن والذوق جميعاً: «إنه يوم جديد، وأنا عليك شهيد، فاعمل فيّ خيراً، وقل خيراً!».
وإذا قلنا أن أسلوب علي تتوفر فيه صراحة المعنى وبلاغة الأداء وسلامة الذوق، فإنما نشير إلى القارىء بالرجوع إلى روائع نهج البلاغة ليرى كيف تتفجر كلمات علي من ينابيع بعيدة القرار في مادتها وبأية حلة فنية رائعة الجمال تمور وتجري وإليك هذه التعابير الحسان في قوله: «المرء مخبوء تحت لسانه». وفي قوله: «الحلم عشيرة» أو في قوله: «من لان عوده كثفت أغصانه» أو في قوله: «كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع» أو في قوله أيضاً: «لو أحبني جبل لتهافت». أو في هذه الأقوال الرائعة: «العلم يحرسك وأنت تحرس المال. رب مفتون بحسن القول فيه. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت سلبته محاسن نفسه. ليكن أمر الناس عندك في الحق سواء. افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً فإن صغيره كبير وقليله كثير. هلك خزان المال وهم أحياء. ما متّع غني إلا بما جاع فقير!».
ثم استمع إلى هذا التعبير البالغ قمة الجمال الفني أراد به أن يصف تمكنه من التصرف بمدينة الكوفة كيف شاء، قال: «ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها..».
فأنت ترى ما في أقواله هذه من الأصالة في التفكير والتعبير، هذه الأصالة التي تلازم الأديب الحق بصورة مطلقة ولا تفوته إلا إذا فاتته الشخصية الأدبية ذاتها.
ويبلغ أسلوب علي (ع) قمة الجمال في المواقف الخطابية، أي في المواقف التي تثور بها عاطفته الجياشة، ويتقد خياله فتعتلج فيه صور حارة من أحداث الحياة التي تمرس بها. فإذا بالبلاغة تزخر في قلبه وتتدفق على لسانه تدفق البحار. ويتميز أسلوبه، في مثل هذه المواقف. بالتكرار بغية التقرير والتأثير، وباستعمال المترادفات وباختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين، وقد تتعاقب فيه ضرورة التعبير من أخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار. وتكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس. وفي ذلك ما فيه من معنى البلاغة وروح الفن. وإليك مثلاً على هذا خطبة الجهاد المشهورة، وقد خطب علي بها الناس لما أغار سفيان بن عوف الغامدي على مدينة الأنبار بالعراق وقتل عامله عليها:
«هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها وقتل منكم رجالاً صالحين».
«وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة، فينزع حجلها وقلبها، ورعاثها، ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم كلم، ولا أريق لهم دم، فلو أن امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً، ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً.
«فيا عجباً! والله يميت القلب ويجلب الهم اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. فقبحاً لكم حين صرتم غرضاً يرمى: يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزَوْن ولا تغزُون، ويعصى الله وترضون!».
فانظر إلى مقدرة الإمام في هذه الكلمات الموجزة، فإنه تدرج في إثارة شعور سامعيه حتى وصل بهم إلى ما يصبو إليه. وسلك إلى ذلك طريقاً تتوفر فيه بلاغة الأداء وقوة التأثير. فإنه أخبر قومه بغزو سفيان بن عوف الأنبار، وفي ذلك ما فيه من عار يلحق بهم. ثم أخبرهم بأن هذا المعتدي إنما قتل عامل أمير المؤمنين في جملة ما قتل، وبأن هذا المعتدي لم يكتف بذلك بل أغمد سيفه في نحور كثيرة من رجالهم وأهليهم.
وفي الفقرة الثانية من الخطبة توجه الإمام إلى مكان الحمية من السامعين، إلى مثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي، وهو شرف المرأة. وعلي يعلم أن من العرب من لا يبذل نفسه إلا للحفاظ على سمعة امرأة وعلى شرف فتاة، فإذا هو يعنّف هؤلاء القوم على القعود دون نصرة المرأة التي استباح الغزاة حماها ثم انصرفوا آمنين، ما نالت رجلاً منهم طعنة ولا أريق لهم دم.
ثم إنه أبدى ما في نفسه من دهش وحيرة من أمر غريب: «فإن أعداءه يتمسكون بالباطل فيناصرونه ويدينون بالشر فيغزون الأنبار في سبيله، فيما يقعد أنصاره حتى عن مناصرة الحق فيخذلونه ويفشلون عنه».
ومن الطبيعي أن يغضب الإمام في مثل هذا الموقف، فإذا بعبارته تحمل كل ما في نفسه من هذا الغضب فتأتي حارة شديدة مسجعة مقطعة ناقمة: فقبحاً لكم حين صرتم غرضاً يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون. ويعصى الله وترضون!».
وقد تثور عاطفته وتتقطع فإذا بعضها يزحم بعضاً على مثل هذه الكلمات المتقطعة المتلاحقة: «ما ضعفت، ولا جبنت، ولا خنت، ولا وهنت!». وقد تصطلي هذه العاطفة بألم ثائر يأتيه من قوم أراد لهم الخير وما أرادوه لأنفسهم لغفلة في مداركهم ووهن في عزائمهم، فيخطبهم بهذا القول الثائر الغاضب، قائلاً: «ما لي أراكم أيقاظاً نوّماً، وشهوداً غيباً، وسامعة صماء، وناطقة بكماء… إلخ».
والخطباء العرب كثيرون، والخطابة من الأشكال الأدبية التي عرفوها في الجاهلية والإسلام ولا سيما في عصر النبي والخلفاء الراشدين لما كان لهم بها من حاجة. أما خطيب العهد النبوي الأكبر فالنبي لا خلاف في ذلك. أما في العهد الراشدي، وفي ما تلاه من العصور العربية قاطبة، فإن أحداً لم يبلغ ما بلغ إليه علي بن أبي طالب في هذا النحو. فالنطق السهل لدى علي (ع) كان من عناصر شخصيته وكذلك البيان القوي بما فيه من عناصر الطبع والصناعة جميعاً ثم إن الله يسر له العدة الكاملة لما تقتضيه الخطابة من مقومات أخرى على ما مر بنا. فقد ميّزه الله بالفطرة السليمة، والذوق الرفيع، والبلاغة الآسرة، ثم بذخيرة من العلم انفرد بها عن أقرانه، وبحجة قائمة، وقوة إقناع دامغة، وعبقرية في الارتجال نادرة. أضف إلى ذلك صدقه الذي لا حدود له وهو ضرورة في كل خطبة ناجحة وتجاربه الكثيرة المرة التي كشفت لعقله الجبار عن طبائع الناس وأخلاقهم وصفات المجتمع ومحركاته. ثم تلك العقيدة الصلبة التي تصعب مداراتها وذلك الألم العميق الممزوج بالحنان العميق وبطهارة القلب وسلامة الوجدان وشرف الغاية.
إنه من الصعب أن تجد في شخصيات التاريخ من اجتمعت لديه كل هذه الشروط التي تجعل من صاحبها خطيباً فذاً، غير علي بن أبي طالب ونفر من الخلق قليل وما عليك إلا استعراض هذه الشروط، ثم استعراض مشاهير الخطباء في العالمين الشرقي والغربي، لكي تدرك أن قولنا هذا صحيح لا غلوّ فيه.
وابن أبي طالب على المنبر رابط الجأش شديد الثقة بنفسه وبعدل القول. ثم إنه قوي الفراسة سريع الإدراك يقف على دخائل الناس وأهواء النفوس وأعماق القلوب، زاخر حنانه بعواطف الحرية والإنسانية والفضيلة، حتى إذا انطلق لسانه الساحر بما يجيش به قلبه أدرك القوم بما يحرك فيهم الفضائل الراقدة والعواطف الخامدة.
أما إنشاؤه الخطابي فلا يجوز وصفه إلا بأنه أساس في البلاغة العربية. يقول أبو الهلال العسكري صاحب «الصناعتين»: ليس الشأن في إيراد المعاني ـ وحدها ـ وإنما هو في جودة اللفظ، أيضاً وصفائه، وحسنه وبهائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركيب والخلو من أود النظم والتأليف.
من الألفاظ ما هو فخم كأنه يجر ذيول الأرجوان أنفة وتيهاً. ومنها ما هو قعقعة كالجنود الزاحفة في الصفيح. ومنها ما هو كالسيف ذي الحدين. ومنها ما هو كالنقاب الصفيق يلقى على بعض العواصف ليستر من حدتها ويخفف من شدتها. ومنها ما له ابتسامة السماء في ليالي الشتاء! من الكلام ما يفعل كالمقرعة، ومنه ما يجري كالنبع الصافي.
كل ذلك ينطبق على خطب علي في مفرداتها وتعابيرها. هذا بالإضافة إلى أن الخطبة تحسن إذا انطبعت بهذه الصفات اللفظية على رأي صاحب الصناعتين، فكيف بها إذا كانت، كخطب ابن أبي طالب، تجمع روعة هذه الصفات في اللفظ إلى روعة المعنى وقوته وجلاله!
وإليك شيئاً مما قلناه في الجزء الثالث من كتابنا «الإمام علي صوت العدالة الإنسانية» بصدد بيان الإمام لا سيما ما كان منه في خطبه:
نهج البلاغة آخذ من الفكر والخيال والعاطفة آيات تتصل بالذوف الفني الرفيع ما بقي الإنسان وما بقي له خيال وعاطفة وفكر، مترابط بآياته متساوق، متفجر بالحس المشبوب والإدراك البعيد، متدفق بلوعة الواقع وحرارة الحقيقة والذوق إلى معرفة ما وراء هذا الواقع، متآلف يجمع بين جمال الموضوع وجمال الإخراج حتى ليندمج التعبير بالمدلول، أو الشكل بالمعنى، اندماج الحرارة بالنار والضوء بالشمس والهواء بالهواء، فما أنت إزاءه إلا ما يكون المرء قبالة السيل إذ ينحدر والبحر إذ يتموّج والريح إذ تطوف. أو قبالة الحدث الطبيعي الذي لا بد له أن يكون بالضرورة على ما هو كائن عليه من الوحدة لا تفرق بين عناصرها إلا لتمحو وجودها وتجعلها إلى غير كون!.
بيان لو نطق بالتقريع لانقض على لسان العاصفة انقضاضاً! ولو هدد الفساد والمفسدين لتفجر براكين لها أضواء وأصوات! ولو انبسط في منطق لخاطب العقول والمشاعر فأقفل كل باب على كل حجة غير ما ينبسط فيه! ولو دعا إلى تأمل لرافق فيك منشأ الحس وأصل التفكير فساقك إلى ما يريده سوقاً، ووصلك بالكون وصلاً، ووحّد فيك القوى للاكتشاف توحيداً. وهو لو راعاك لأدركت حنان الأب ومنطق الأبوة وصدق الوفاء الإنساني وحرارة المحبة التي تبدأ ولا تنتهي أما إذا تحدث إليك عن بهاء الوجود وجمالات الخلق وكمالات الكون، فإنما يكتب على قلبك عداد من نجوم السماء!.
بيان هو بلاغة من البلاغة، وتنزيل من التنزيل. بيان اتصل بأسباب البيان العربي ما كان منه وما يكون، حتى قال أحدهم في صاحبه أن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق!.
وخُطَبُ علي جميعاً تنضح بدلائل الشخصية حتى لكأن معانيها وتعابيرها هي خوالج نفسه بالذات وأحداث زمانه التي تشتعل في قلبه كما تشتعل النار في موقدها تحت نفخ الشمال فإذا هو يرتجل الخطبة حسّاً دافقاً وشعوراً زاخراً وإخراجاً بالغاً غاية الجمال.
وكذلك كانت كلمات علي بن أبي طالب المرتجلة، فهي أقوى ما يمكن للكلمة المرتجلة أن تكون حيث الصدق، وعمق الفكرة، وفنية التعبير، حتى أنها ما نطقت بها شفتاه ذهبت مثلاً سائراً.
فمن روائعه المرتجلة قوله لرجل أفرط في اتهامه بنفسه: «أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك».
ومن ذلك أنه لما اعتزم أن يقوم وحده لمهمة جليلة تردد فيها أنصاره وتخاذلوا، جاء هؤلاء وقالوا له وهم يشيرون إلى أعدائه: يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم. فقال من فوره: «ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها، فإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي، كأنني المقود وهم القادة».
ولما قتل أصحاب معاوية محمداً بن أبي بكر فبلغه خبر مقتله قال: «إن حزننا عليه قدر سرورهم به. إلا أنهم نقصوا بغيضاً ونقصنا حبيباً».
وسئل: أيهما أفضل العدل أم الجود؟ فقال: «العدل يضع الأمور مواضعها، والجود يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهما».
وقال في صفة المؤمن، مرتجلاً:
«المؤمن بشره في وجهه، وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدراً وأذل شيء نفساً يكره الرفعة، ويشنأ السمعة، طويل غمه، بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته شكور صبور، سهل الخليقة، لين العريكة!».
وسأله جاهل متعنت عن معضلة، فأجابه على الفور: «اسأل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وإن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت!».
والخلاصة أن علي بن أبي طالب (ع) أديب عظيم نشأ على التمرس بالحياة وعلى المرانة بأساليب البلاغة فإذا هو مالك ما يقتضيه الفن من أصالة في شخصية الأديب، ومن ثقافة خاصة تنمو بها الشخصية وتتركز الأصالة.
أما اللغة، لغتنا العربية الحبيبة التي قال فيها مرشلوس، في المجلد الأول من كتاب «رحلة إلى الشرق» هذا القول الذكي: «اللغة العربية هي الأغنى والأفصح والأكثر والألطف وقعاً بين سائر لغات الأرض. بتراكيب أفعالها تتبع طيران الفكر وتصوره بدقة، وبأنغام مقاطعها الصوتية تقلد صراخ الحيوانات ورقرقة المياه الهاربة وعجيج الرياح وقصف الرعد»، أما هذه اللغة بما ذكر مرشلوس من صفاتها وبما يذكر، فإنك واجد أصولها وفروعها وجمال ألوانها وسحر بيانها، في أدب الإمام علي (ع)!
وكان أدباً في خدمة الإنسان والحضارة!
جورج جرداق
الأغراض الاجتماعية
في نهح البلاغة
تمهيد
إن شخصية الإمام علي من أقوى الشخصيات التي عرفها التاريخ ولست بسبيل أن أفصّل ما فيها من نبل وقوة وخصائص تستهوي الأفئدة، وإنما سبيلي أن أبحث جانباً من جوانب هذه الشخصية الرائعة المستفيضة. هو جانب النظرة الاجتماعية فيها، تلك النظرة التي أودعها نهج البلاغة والتي بلغت من العمق والبيان درجة أغرى سموها بعض أشياع الأمويين وفريقاً من الباحثين، إلى نفيها عنه والذهاب إلى أنها هدية الخلود، صاغها للجد حفيده الشريف الرضي، الشاعر الموهوب.
أقسام البحث
غير أن هذه الآراء كثيرة مبعثرة وكثيراً ما يتكرر الرأي الواحد أكثر من مرة، وليس «نهج البلاغة» بمقسم تقسيماً يفصل كل مجموعة متشابهة من الآراء عمَّا عداها، وهذا هو موطن الصعوبة ولكنه أيضاً مهمة الباحث، وعلى هذا فسنقسم الآراء إلى:
1 ـ علاقة الإنسان بربه.
2 ـ علاقة الإنسان بنفسه.
3 ـ علاقة الإنسان بغيره.
4 ـ ثم سياسة الدولة وهو باب متشعب كما سنرى.
وقد يعترض معترض بأن القسمين الأولين الباحثين في علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه يجب أن يستبعدا من بحث مقصور على الأغراض الاجتماعية؛ أي على ما يقوم بين الناس من معاملات ليس منها معاملات الفرد للخالق ولا لنفسه التي بين جنبيه؛ ولكن هذا الاعتراض غير وجيه، إلاَّ بالنسبة للآراء الميتافيزيقية البحتة التي بحث فيها الإمام بحثاً مطولاً عن منشأ الكون وعلاقة الأجرام بعضها ببعض، وكيفية خلق الملائكة والبشر، تلك الآراء التي وجدناها خارجة عن موضوعنا فاستبعدناها، أما علاقة الإنسان بربه: فالمقصود بها هنا، الوصايا التي وجهها الإمام إلى مجتمعه ليعمل بها فيما يختص بالخالق الجليل، وبذلك تكون أعمالاً بشرية، إن لم تكن اجتماعية بالمعنى العلمي الحرفي، فهي اجتماعية لأنها مطلوب القيام بها من الجماعة ولأنها مظهر اجتماعي ومؤثر قوي في السلوك الاجتماعي البحت؛ أي في سلوك الأفراد إزاء بعضهم بعضاً. أما فيما يختص بعلاقة الإنسان مع نفسه فالمسألة أوضح، لأنا بتدريب أنفسنا على منهج خاص نخلقها خلقاً جديداً، وهذا الخلق مؤثر أبعد التأثير في نوع تعاملنا مع الآخرين، ولأن العدوى موجودة في الخير وفي الشر، فكوننا على هذه الحال، أو تلك؛ إغراء لمن هم دوننا ولمن هم بمعرض التأثر بمثالنا على أن يحتذوا ذلك المثال، ولأننا نحن مكوّنوا المجتمع وكما نكون يكون.
هذا إلى أن هذين القسمين شيء قليل بالنسبة للقسمين الآخرين.
علاقة الفرد بربه
ـ 1 ـ
ضم نهج البلاغة بين دفتيه صفحات نادرة في تمجيد الله وتجليل صفاته، وكثر فيه النصح بإلقاء النفس إلى الله، كما جاء في وصية الإمام لابنه وبشكره على نعمائه وعدم الاغترار بما يوفق إليه من النجاح: «وإذا أنت هديت لقصدك، فكن أخشع ما تكون لربك».
وأوصى ابن أبي بكر بقوله: «… ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه فإن في الله خلفاً من غيره» وبمثل هذا كان يفتتح خطاباته إلى ولاته وقضاته: ولنستمع إلى قوله حين بعث بعض عماله إلى الصدقة: «آمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيات عمله حيث لا شاهد غيره ولا دليل دونه وآمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرّ» وليس غريباً أن يوصي بما أوصى به القرآن من الرجوع إليه وإلى الحديث عند التباس الأمور فيقول: «وأردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور». وليس غريباً أيضاً أن يعتبر الشكوى من نوائب الزمان شكوى من الله فيقول: «من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه».
وقد ظهرت عقيدته الراسخة في الله ودعوته إلى نصرة دينه في قوله: «لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله، فإن الله لا يضيع أولياءه» «وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله؟».
على أن نغمته الزاهدة لا تفتأ تتكرر فهو يقول لنا هنا: «من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته» ويقول لنا هناك أن «الرزق رزقان رزق تسعى إليه ورزق يسعى إليك» وهذا قول حكيم لأنه لا يدعو إلى الكسل وانتظار الرزق من الله، بل يقول أن السعي يزيد الرزق ولكن يجب على المرء ألاَّ يشتغل بجميع جوارحه بالسعي وراء الدنيا فيغفل عن العمل الصالح.
سبق إيراد قوله (ع): «إن من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه».
والآن نضم إلى ذلك قوله: «ولا يحمد حامد إلاَّ ربه، ولا يلم لائم إلاَّ نفسه». إن النص الأول يدعونا إلى عدم شكوى الزمان، لأن الزمان يجري كما قضى الله وقدر فثورتنا عليه ليست إلاَّ ثورة على قضاء الله وقدره، أما النص الثاني فإنه يدعونا إلى أن نعتقد أن الخير من الله، وأن الشر من أنفسنا أي أن الله أعطانا عقلاً نميز به بين الطريقين كما قال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾([359]) فإن سلكنا طريق الشر فلا نلم إلاَّ أنفسنا. وإن سلكنا طريق الخير فلا نحمد إلاَّ الله لأنه هو الذي أرشدنا.
علاقة الإنسان مع نفسه
ـ 2 ـ
(أ) قال في وصيته إلى ابن أبي بكر: «… فأنت محقوق أن تخالف على نفسك» أي أن تخالف هواك وتحكم عقلك. ثم قال في موضع آخر: «من كان له من نفسه واعظ، كان عليه من الله حافظ». وأوضح ذلك الرأي بموضع ثالث بقوله: «من لم يعن نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر، لم يكن له من غيرها زاجر ولا واعظ».
لقد عرف الإمام علي أن بالنفس نوازع شر ونوازع خير فدعا إلى التشديد عليها حين تأمر بالسوء واستعان عليها بالله في قوله: «والله المستعان على نفسي وأنفسكم» ثم اعتمد على الضمير اليقظ وأهاب بنا أن نقويه فإنه عاصمنا ومنه المزدجر. وقد زاد من عنايته بالتدريب النفسي أنه اعتقد أن الطباع كسبية فقال: «إن لم تكن حليماً فتحلّم فإنه قل ما تشبه بقوم إلاَّ أوشك أن يكون منهم» وأنه اعتقد أن الإنسان مفطور على الخير وأن الخير في عودته لفطرته فقال: «الله بعث في الناس رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته» فمهمة الأنبياء عنده أعادتنا إلى الفطرة التي فطرنا عليها.
(ب) ونلاحظ أنه أكثر من النهي عن «الإمل» لا الأمل الذي نعرفه والذي حثَّ الله عليه بل أوجبه في ذكر أقواله تعالى: ﴿لاَ يَاْيْئَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾([360]) وإنما الأمل بمعنى الاعتماد على طول الأجل، وارتكاب المحرمات، وإرجاء الفرائض اعتماداً على ذلك وهذا رأي نشاركه كلنا فيه فإن كل ما بالعالم يمر في سرعة وثابة وما أنصف ولا أصاب من يبذر في صحته أو ماله اعتماداً على وفرة صحته أو ماله ولا من يؤجل العمل انتظاراً للغد. فإن الغد يمر ونمر معه، وإذن فما أحرانا أن نعمل بنصيحة الإمام القائلة: «وبادروا أجالكم بأعمالكم» وأن نتدبر قوله: «إن أخوف ما أخافُ عليكم أتباع الهوى وطول الأمل».
(جـ) لم أكد أبدأ الكتابة في علاقة الإنسان بربه حتى شعرت بنحولة الفاصل بين هذا القسم والقسمين الأخيرين، وها أنذا الآن أشعر بهذه النحولة أيضاً: فها هي حكم ووصايا تدخل في سلوك المرء مع نفسه وتدخل في سلوكه مع غيره كقوله: «قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير» ومثل قوله: «امش بدائك ما مشى بك» وقوله: «الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب» وقوله البليغ: «أفضل الزهد إخفاء الزهد» ونهيه: «وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين» فإن دعوته إلى الشجاعة والجرأة وانتهاز فرص الخير وتحمل الداء وعدم الاستنامة إليه، والصبر بنوعيه، وإخفاء الزهد أي الزهد في سبيل التظاهر والزهد بالقلب مع مواصلة العمل والجهاد، ونهيه عن الإعجاب بالنفس وحب الثناء، كل هذه العهود يتناولها المرء بينه وبين نفسه وبين غيره، أما أمره: «ولا تتمن الموت إلاَّ بشرط وثيق» أي لا تعرض نفسك للهلاك إلاَّ أن تقضي غاية سامية وضرورة لازمة، فإنه أدخل في نطاق المعاملة النفسية.
علاقة المرء مع غيره
ـ 3 ـ
(أ) إذا كان علي (ع) قد وضع لنا هذه القاعدة النبيلة في قياس الفضيلة والخير وهي: ألاَّ نعمل في السر ما نخجل من عمله في العلن حيث قال: «واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحى منه في العلانية» فإنه قد حبانا أيضاً بمقياس نبيل لأعمالنا تجاه الآخرين في قوله الخالد: «يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلم» ولو اتبع البشر هاتين النصيحتين لامتنع الظلم والشر جميعاً، غير أنه يمكن أن نلاحظ ملاحظة متواضعة على النصيحة الأولى: تلك أن نظرة المجتمع قد تتغير نحو بعض الفضائل أو الرذائل فإذا كان ما يستحى من عمله يعمل على رؤوس الأشهاد فهل الفضائل خالدة؟ أم هي يجري عليها ناموس التطور؟ وهل يطيع نصيحة الإمام أم لا يطيعها رجل يحتسي الخمر على قارعة الطريق غير خجل لكثرة من يحتسونها؟ أما أنا فأميل إلى القول بأن الفضائل خالدة، وأن الكذب لن يكون فضيلة لأن الناس يكذبون، بل الفضيلة فضيلة والرذيلة رذيلة ولن يزال راكبها يشعر في نفسه بالتضاؤل وبنوع من الحياء لا حين يلقى أمثاله ولكن حين يلقى الأخيار.
وما لي أذهب بعيداً؟ إن الإمام يفسر لنا ذلك في موضع آخر حيث يقول في بيان شاف: «إن المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أول ويحرم العام ما حرم عاماً أول وإن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرَّم الله عليكم، ولكن الحلال ما أحلَّ الله والحرام ما حرَّم الله».
(ب) وإذا ذكرنا تطور الفضائل وخلودها فلنستعرض رأي الإمام القائل: «اقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا على الله ظالمين». إن من الناس من لا يريد أن يسلم بأن الانظلام فضيلة:
| ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه | يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم |
وربما مال أيضاً إلى أن يقول مع هيغل: «إن ظفر شعب هو البرهان القوي على حقوقه» غير أن عبارة الإمام إنما يراد بها مبالغة في التنفير من الظلم.
(جـ) ولقد دعا الإمام إلى التعاون دعوة صريحة في عبارة نبيلة حيث قال يودع جنوداً ذاهبين للقتال: «وأي امرىء منكم أحسّ من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من أحد إخوانه فشلاً، فليذب عن أخيه بفضل نجدته التي فضل بها عليه كما يذب عن نفسه فلو شاء الله لجعله مثله». وما أوصى به الإمام جنود جيشه يصح أن يستوصي به جنود الحياة. إن الغني لو ذبَّ عن الفقير بفضل ماله الذي فضل به عليه والعالم لو ذب عن الجاهل بفضل علمه والحكيم لو أرشد السفيه بفضل حكمته، لو كان هذا سبيل الناس في الحياة، لانتصر جيشهم على آلام الحياة القابلة للانهزام. إن الإمام لا يزال يلح في دعوته إلى التعاون، وأنه ليسوقها هنا في منطق واضح وحجة لازمة: «أيها الناس إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم» «ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه، ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة، وتقبض منهم عنه أيدٍ كثيرة». إن الإنسان مدني بالطبع أو هو كما وصفه فليسوف اليونان «حيوان اجتماعي» ولهذا دعا الإمام دعوته.
(د) وقد تكررت دعوة الإمام هذه في صورة أخرى في حثه على الصدقة بقوله البليغ: «وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غداً حين يحتاج إليه فاغتنمه وحمّله إياه». وبوصيته: «إن اللسان الصالح ـ أي الذكرى الطيبة ـ يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يورثه من لا يحمده». وفي تذكيره بفريضة الزكاة في قوله: «إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلاَّ بما مُتِّع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك». وقد بلغ من تقريره للتعاون ولأثر الزكاة والإحسان في إسعاد إفراد المجتمع جميعاً أنه استنَّ تشريعاً طريفاً بقوله: إن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه» أي أن من كان له دين ولم يكن واثقاً أن مدينه سيرده إليه سالماً، ثم رده إليه بعد عامين مثلاً، وجب عليه أي على صاحب المال الدائن أن يدفع للفقراء زكاة هذا المال للسنتين الماضيتين. ولست أعرف حكم الشريعة الإسلامية في هذا. ولكني ألاحظ أن رأي الإمام وجيه إذا اعتبرنا أن المال صار بالنسبة للدائن مفقوداً بوجوده عند من لا يثق به. فإذا عاد إليه فكأنما عثر على كنز غير منتظر. وإذاً فليس كثيراً أن يدفع منه شيئاً للفقراء إن لم يكن زكاة عنه فشكراً لله عليه. «ومن كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه» كما قال الإمام وكما قال شكسبير: «إن التشاريف العظيمة أحمال عظيمة».
(هـ) لقد زهد الإمام بهذه الدنيا وأهاب بها أن تغر غيره. بل لقد زمجر منها في صرخته: «والله لو كنت شخصاً مرئياً وقالباً حسّياً لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني وألقيتهم في المهاوي» هكذا كانت نظرته الصادقة إلى الحياة فلا عجب أن يمتلأ قلبه بالعطف على الناس وأن يدعو إلى إنقاذ الضعفاء وعدم خزن المال بكلمته الرهيبة: «يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك».
إن الشعور السائد على نهج البلاغة كله هو شعور التنديد بالتهالك على الدنيا: «وحفظ ما في يديك أحب إليَّ من طلب ما في يد غيرك… فاخفض في الطلب وأجمل المكتسب فإنه رب طلب قد جرَّ إلى حرب.. فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم». هذه وصاياه ولكنه لا يدعو إلى الزهد الذي ينافي الدين والحياة. فهو يعمل ويحارب. ولكن على أرض الشرف ولغاية نبيلة.
(و) إن ما مرَّ بنا من دعوته إلى التعاون والإحسان ووفاء الزكاة ليس إلاَّ بعض دعوته إلى «الحب العام» فإن قلبه النبيل قد غمر بهذه العاطفة الشريفة وثبتها إيمانه القوي المنقطع النظير وليس غريباً ممن صادق النبي ـ والأصدقاء قليل ـ وشاطره آلامه وجهاده، فشعر بحلاوة الصداقة. ومن عانى من الحسد والحقد اللذين دفعا معاوية وغيره لمناوأته. ومن خبر تأثير التخاذل والتباغض حين خرج الخوارج وتخاذل قومه، ليس غريباً على من هذا شأنه أن يهيب بنا: «ولا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب ولا تباغضوا فإنها الحالقة». وأن يقول «صحة الجسد من قلة الحسد» ذلك القول الذي تؤيده ملاحظتنا اصفرار الوجه ونحوله فيمن عرفوا بالحقد. وأن يقسم لنا: «والذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلباً سروراً إلاَّ وخلق الله من ذلك السرور لطفاً فإذا نزل به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل» وأن يوصينا خيراً بجيرتنا قائلاً: «الله الله في جيرانكم فإنها وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم».
(ز) قلت أنه قد عرف الصداقة في نفسه وخبرها فلنستمع إلى وصاياه بصددها. لقد بالغ في طلب الحرص على الصديق الوفي حتى قال: «ولا يكن على مقاطعتك أقدر منك على صلته» وأوصى بالبحث عن الرفيق قبل الطريق. وحمد الذين «يتواصلون بالولاية ويتلاقون بالمحبة» ودعا إلى عدم الكلفة بين الأصدقاء بقوله: «شر الأخوان من تكلف له» ولكنه نصح أيضاً بعدم الاندفاع في حب الصديق أو بغض العدو بقوله: «أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما» ولقد نتساءل كيف يشك الإنسان في صديق وفي خيره فيحتاط في صداقته وكيف تستقيم صداقة مع تحوط. ولكنا لا يصعب علينا أن نعرف ما حمل الإمام على قول ذلك فقد عانى من تقلب الأصحاب وانشقاق الأخوان ما عانى. ولعلَّ هذا العناء هو ما دفعه ـ ولنقل ذلك ونحن بمعرض آدائه في الصداقة ـ إلى أن يقول: «الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله» إن هذه الكلمة القوية ما كانت لتصدر من ذلك القلب الوادع المسالم لولا أن أصابته شظايا الغدر فثار.
(حـ) دعا الإمام إلى القصد في الحب والبغض، وهذه الدعوة تذكرنا بدعوات له أُخر تحثّ كلها على الاعتدال وعدم الاندفاع، وليس أبلغ من قوله في الحدة أنها: «ضرب من الجنون مستحكم» وقوله الذي يذكرنا بنظرية الأوساط، وبالمثل الفرنسي: les deux extremes se touchent.
وهو: «اليمين والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي الجادة»، وقد أنذر بأنه سيهلك فيه صنفان: «محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق»، وهذه الكلمات هي، بجانب دعوتها إلى القصد، دعوة إلى الخصومة الشريفة ونزع الهوى الشخصي عند مناقشة أعمال الحكام والسواس.
(طـ) ما كان نهج البلاغة وقد ضمَّ بين دفتيه هذه الآراء الاجتماعية الكثيرة ليغفل «المرأة» وشأنها في المجتمع. ولقد عبَّر الإمام عن رأيه فيها بوضوح، فإذا به رأي قاس لا يقل قسوة وعنفاً عن رأي «شوبنهور» فيها وذلك الرأي يتلخص في قوله: «المرأة شرٌّ كلها وشرُّ ما فيها أنه لا بدَّ منها» وهكذا ذهب في موضوع آخر إلى أن «خيار خصال النساء شرار خصال الرجال» وهذا القول قد يحمل على أن ما يستحب في النساء لا يستحب في الرجال. ولكن هذا الاحتمال لا يؤثر في الموضوع، فرأي الإمام في المرأة واضح وقد نعتها في موضع ثالث بأنها: «عقرب حلوة اللبسة». ثم دعا الناس إلى أن يتقوا شرار النساء ويكونوا من خيارهن على حذر وألاَّ يطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر، وبمثل هذا نهى في موضع آخر عن التمكين لهن والسماح لهن بالتشفع والرجاء في أمور الناس. والذي نلاحظه أنه (ع) قد سلَّم بأن بين النساء خياراً بدليل قوله: «وكونوا من خيارهن على حذر» فهو يتهم الطبيعة النسوية على العموم ويخشى أن تتغلب على خيار النساء فيصبحن شريرات.
(ي) لم يكن رأي الإمام في النساء صادراً عن تعصب جنسي، فإن المعركة لم تكن قد نشبت بعد بين النساء والرجال، وما كان علي ليتعصب وهو الذي ذم العصبية في الخطبة «القاصعة» وردَّ أصلها إلى تعصب إبليس للنار ضد الطين: «أما إبليس فتعصب على آدم لأصله وطعن عليه في خلقه» فقال: «أنا ناري وأنت طيني» وأما الأغنياء من مترفة الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم فقالوا: «نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» «فإن كان لا بدَّ من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الفعال». وليست الدعوة ضد العصبية دعوة هينة فالعصبية سبب لمصائب كثيرة كان منها حروب كثيرة أثارها التعصب للجنس أو الدين أو اللون أو المذهب أو الوطن. ولعلَّ مما يبين كراهيته (ع) للتعصب، وهو حقيق أن يكره التعصب لما ذاق من تعصب أهل الشام لمعاوية، قوله: «ليس بلد بأحق منك من بلد، خير البلاد ما حملك».
(ك) وقد نهى (ع) عن الغش في المكاييل، وعن احتكار التجارة وقبح الغيبة بتحليل بديع قائلاً: «وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه.. وأيم الله لئن لم يكن عصاه «عصى الله» في الكبير وعصاه في الصغير لجرأته على عيب الناس أكبر.. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه وليكن الشكر شاغلاً له عن معافاته مما ابتلي به غيره».
وكذلك دعا إلى الاتحاد قائلاً: «وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب»، ونهى عن البدعة في قوله: «وما أحدثت بدعة إلاَّ ترك بها سنة فاتقوا البدع، والزموا المهيع، وحذَّر من تعلم النجوم: «إلاَّ ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار».
(ل) إن من تحصيل الحاصل أن نقول أن الإمام دعا إلى اتباع الحق، وإنما الذي نريد هو أن نرى فهمه للحق كيف كان، وأن نرى نسبة هذا الفهم إلى نظريات أخرى في الحق.
يقول «اهرنغ» وغيره من متشرعي الألمان الذين تأثروا بمبدأ فناء الفرد في الدولة: إن الحق هو ما جعلته الدولة حقاً، ويقول الواقعيون: إن الحق ليس إلاَّ من وضع الإنسان ولم يخرج تكييفه عن إرادته وهواه ويقول اهرنغ أيضاً: «إن أساس الحق ليس فكرة منطقية وإنما هو القوة ويقول هيغل: «إن ظفر شعب هو البرهان القوي على حقوقه».
هذا هو رأي فريق من العلماء في الحق ومقياسه وهو رأي خطر وقد اتهمه الفرنسيون بأنه سبب الحرب العالمية، واتهموا الألمان لأنهم أنصاره ومروجوه. وهو رأي يعارضه فريق كبير من العلماء والناس، وقد كان «قوبيه» لسان هذه المعارضة في قوله: «الحق فكرة تتوجه نحو المستقبل وأساسها الضمير الإنساني والشعور بالمساواة والحرية للجميع، ورأي «باسكال» أن القوة يجب ألا تستعمل إلاَّ لخدمة الحق: «علينا أن نحمل العدالة والقوة معاً وإنما «لا نقصد إلاَّ ما كان حقاً، ولا نستعمل القوة إلاَّ لتوطيد الحق».
هذان هما الرأيان المتعارضان فإلى أيهما ينتمي رأي الإمام علي؟ لسنا محتاجين إلى أقل تفكير للقول أن رأيه هو الثاني. قال الإمام علي: «حق وباطل ولكل أهل، فلئن أمر الحق لقديماً فعل، ولئن كثر الباطل فربما ولعل، ولعل ما أدبر شيء فأقبل» وهذا النص واضح صريح في أن الإمام لا يرى كثرة الباطل تجعله حقاً، بل ينتظر أن تزول دولته قائلاً أن الشيء قد يدبر فيقبل، أي أنه مؤمن بخلود الحق وهو القائل في غير نهج البلاغة: «دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة» وقد تروى «دول الباطل ودولة الحق» لأنهم لم يفرقوا كثيراً بين العدل والحق.
أما نظرية الحق والدولة فهي منافية لرأي الإمام بالطبع ما دام يعتبر الحق خالداً، وهو لا يفتأ ينهى الولاة عن ظلم الرعية ويدعو إلى المساواة والشورى والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. أي أنه لا يرى للحاكم حق اختراع الحقوق ولا يرى الحق كما رآه الواقعيون من وضع الإنسان. ولا يرى انتصار شعب برهاناً على حقوقه بل يقول: «إن الله لم يقصم جباري دهر قط إلاَّ بعد تمهيل ورخاء. ولم يجبر عظم أحد من الأمم إلاَّ بعد ذل وبلاء».
وإذا كان اتفق مع القائلين بأن الحق أزلي وبأنه تراعى فيه مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. فإنه اتفق مع رأي باسكال القائل باستعمال القوة لتوطيد الحق فالإمام يقول: «وإني لراضٍ بحجة الله عليهم وعلمه فيهم فإن أبوا أعطيتهم حد السيف وكفى به شافياً من الباطل وناصراً للحق». وخاطبه قوم في عقاب قاتلي عثمان، فقال إن الحكمة تقضي بالتريث حتى يستتب الأمر «وإذا لم أجد بداً فآخر الدواء الكي» أي القتل والحرب يستعملهما حين تفشل وسائل السلم، وحين يرفض خصومه الاحتكام إلى الله.
يقول فريق من الناس أن الحق قد يتعدد، فأنا أظن الأمر وأنت تظن نقيضه، ولكني محق وأنت مثلي محق، ويقول آخرون أن الحق واحد لا يتعدد، وقد أخذ الإمام بهذا الرأي الأخير فقال: «ما اختلفت دعوتان إلاَّ كانت إحداهما ضلالة».
سياسة الدولة
ـ 4 ـ
إن للإمام آراء قيمة محكمة في طبيعة الحكم، وسياسته، ومهمة الحاكم، وكيفية انتقاء القضاة، وتقسيم العمل، ومهمة العلماء إلى غير ذلك، وقد جمعت رسالته إلى الأشتر النخعي كثيراً من الأمور، ولكنها لست الوعاء الوحيد الذي ننشد فيه ذلك الحكم فنقصر بحثنا عليها.
(أ) قال: «لا بدَّ للناس من أمير برٍ أو فاجر يعمل في أمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتؤمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر» وهذا كما نرى رأي يعاكسه الفوضويون اليوم وقد عاكسه الخوارج بالأمس، ولكن ما كان لعلي الحكيم الذي اعتنق دين النظام صبياً أن يدعو بدعوتهم لقد عرف أن النظام هو كفيل النجاح، وتألم وشكا قومه لأن: «المعروف عندهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المهمات على آرائهم، كأن كل امرىء منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات».
(ب) وإذا كان قد مقت الخروج عما يمكن أن نسميه «الرعية» فإنه كذلك قد مقت أيضاً الاختلاف بين الفقهاء والمفسرين في الفتيا قائلاً: «ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد».
وليس يصعب علينا أن نلمح أن الذي استفزه إلى هذا الانتقاد هو رغبته في النظام وفي توحيد القضاء.
(ج) وإذا كان قد دعا إلى «الشرعية» وعدم تشعب الآراء واستقلال كل برأيه، فليس معنى هذا أنه دعا إلى الاستبداد والحكم المطلق، بل على العكس لا نزال نسمعه يلح بالدعوة إلى الشورى، فيقول لنا: «من استبدَّ برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها» ويكرر ذلك في أماكن أخرى وبألفاظ كثيرة.
وقال في كتاب لأحد ولاته: «وإن ظنت الرعية بك حيفاً فاصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بأصحارك فإن في ذلك رياضة منك لنفسك ورفقاً برعيتك وأعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق».
وهذه كلمات كبيرة حكيمة، فيها نوع من المسؤولية الوزارية كما نعرفها ونسميها وفيها أيضاً بيان لحكمتها فهي تزيل شكوك الرعية ثم هي رياضة للنفس على تقبل النقد وعدم الإزورار منه، وعلى التدقيق في الأعمال علماً بأن هناك من سيحاسب عنها.
إن النزعة الديمقراطية في نهج البلاغة أبين من أن تحتاج إلى بيان: فها هو يأمر الوالي بأن يجلس لذوي الحاجات دون جند أو حرس لكيلا يتعتعوا في توضيح مسائلهم.
بل قد فضل العامة على الخاصة وإن سخط الخاصة فقال: «إن سخط العامة يجحف برضى الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد أثقل على الوالي من الرعية مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكراً على الإعطاء، وأبطأ عذراً عند المنع، وأضعف صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصة وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء، العامة من الأمة فليكن صغوك لهم وميلك معهم». وهذا كلام صريح في تفضيلهم والاعتماد عليهم، وأنا شخصياً أميل إلى الظن بأن هذا الكلام كان له تأثير في سلوك بعض زعمائنا الذين عرفوا بميلهم إلى الإمام علي والتشبه بكلامه في أكثر من موضع. ولن أطيل في تفصيل هذه الديمقراطية، ولنردد في سرور قول الإمام الجامع: «إن أعظم الخيانة خيانة الأمة وأفظع الغش غش الأئمة» وقوله الذي يذكرنا بالقول السائر: صوت الشعب من صوت الله «إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده».
(د) وإذا كان الإمام قد أخذ بالديمقراطية كما وضح فمن الطبيعي أن نراه نصير الحرية يهيب بابنه «ولا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حراً» وأن نراه رفع لواء المساواة لا يزال يذكرها ويوصي بها ويقول لمن يوليه «وآس ـ وساو ـ بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم». ويقول في موضع آخر: إن المال لو كان ماله لساوى بين الناس فكيف والمال مال الأمة؟.
(هـ) ولكن للجمهور سيئاته كما أن له حسناته فلنسمع كلمة الإمام في الغوغاء. قال: «الناس ثلاثة فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق». ووصف الغوغاء في موضع آخر من أنهم من إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا نفعوا لأن كل صانع ينصرف إلى عمله فيحصل النفع، وقد وضع الإمام أصبعه على آفة وطبيعة من آفات وطبائع الجماهير هي سرعة التقلب، تلك الخاصة الجماهيرية التي وضحها شكسبير أبلغ إيضاح في «يوليوس قيصر» وكذلك أصاب في أن اجتماعها غلبة وتفرقها ضياء وفي أن اجتماعها قد يكون في بعض الأحايين مجلبة للضرر، كما أن تفرقها مجلبة للنفع لانصراف كل عامل إلى عمله، وهذه النظرة إلى الجماهير قد تبدو متعارضة بعض التعارض مع ما سبق من رأيه فيهم ولكن بيان نقص الغوغاء لا يستلزم استبعاد رأيهم.
(و) عرض (ص) الصفات الواجب توفرها في الإمام فقال: «من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» وذم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم في أكثر من موضع. وحدد العلاقة بين الراعي والرعية فقال:
«أيها الناس إن لكم عليَّ حقاً ولي عليكم حق، فأما حقكم عليَّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا، وأما حقي عليكم بالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم». ولنلاحظ هنا أنه يجعل من حقه على الشعب أن ينصحه الشعب وهذا مبالغة في السعي وراء الكمال وكم هو نبيل قوله لقومه رداً على من أثنى عليه: «فلا تكلموني بما تكلمون به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي فإنه من استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست بنفسي بفوق أن أخطىء».
وذم خلة الغدر فقال: «والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة». فأمير المؤمنين إذن على خلاف مع «أمير» مكيافلي.
وأدلى علي بآراء قيمة فيما يجب في الولاة فقال إنهم ملزمون بأن يعيشوا عيشة جمهور الشعب «لكيلا يتبيغ بالفقير فقره» أي لكيلا يسخط الفقير لفقره وليتعزى بحال أميره: «أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر أو أكون لهم أسوة في جشوبة العيش؟».
ونصح علي الولاة بقوله مؤكداً لأحدهم: «ولا يطولن احتجابك عن رعيتك» وتلك نصيحة حق فإن كثرة ظهور الحاكم بين الرعية استئلاف لقلوبها وإشهار لها بأن الحاكم مهتم بمصالحها، ثم هو منير للحاكم سبيل حكمه ومعطيه الصورة الواضحة لحال شعبه فيعمل على نورها.
وقال: «إنه ليس شيء أدعى إلى حسن ظن راعٍ برعيته من إحسانه إليهم» أي أن الراعي حين يحسن لرعيته يطمئن قلبه ويأمن خيانتهم.
وأمر باحترام التقاليد الشعبية فكان حكيماً بعيد النظر «ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية».
ووجه علي نصيحة غالية كل الغلو صادقة كل الصدق في قوله: «إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ومن شاركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأئمة وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم… ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك» ونظرية علي صحيحة تماماً فإن من أثم فيما مضى لا يؤمن إثمه فيما حضر، ومن اتصل بالظلمة بالأمس لا يؤمن اتصاله بهم اليوم وأعانتهم على كيدهم بماله من سلطة الوزارة. وكان حكيماً في قوله: «فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة وداولهم بين القسوة والرأفة».
وأمر الوالي أن لا يرغب عن رعيته «تفضيلاً بالإمارة عليهم فإنهم الأخوان في الدين والأعوان على استخراج الحقوق» ثم قال له: «وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم وإلاَّ فإنك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامة بؤساً لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين». ودعاه إلى أن يساوي نفسه بهم فيما الناس فيه سواء وهذا القيد يظهر بعد نظره وفهمه لحقيقة المساواة الممكنة.
ودعا إلى تشجيع المحسن وعقاب المسيء قائلاً: «ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء». ولفت نظر جباة الضرائب إلى الرفق بالأهلين وعدم بيع شيء ضروري ـ وهذا ما فعلته القوانين الحديثة إذ منعت الحجز على الملابس ومرتبات الموظفين ـ وبالغ في الرفق الحكيم فقال: «فإن شكوا ثقلاً أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم» وهذا بعد نظر حكيم وسياسة مالية محكمة تزيد وضوحاً في قوله: «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلاَّ بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد»، وإذا تذكرنا ما جرَّ التعسف في جبي الضرائب في فرنسا وولايات تركيا وغيرها عرفنا قيمة هذه النصيحة التي يؤيدها المنطق ويسندها التاريخ.
(ز) وقد أدى بعد نظر الإمام به إلى أن يدعو إلى تقسيم العمل، ذلك المبدأ الذي لم نعرفه إلاَّ حديثاً فقد قال ناصحاً: «واجعل لكل إنسان من خدمك عملاً تأخذ به فإنه أحرى ألا يتواكلوا في خدمتك» وقال من رسالة إلى الأشتر النخعي أيضاً: «واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلاَّ ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها عمال الإنصاف والرفق ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ومنها التجار وأهل الصناعات ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكلاً قد سمى الله سهمه» ثم فصل بعد ذلك وظيفة كل فرقة.
وتمشياً مع قاعدته في تقسيم العمل واختصاص كل بما يحسنه ردَّ على من قال له: إنك تأمرنا بالسير إلى القتال فلم لا تسير معنا؟ إنه لا يجوز أن يترك مهماته من قضاء وإدارة وجباية ضرائب، وكذلك نصح عمر بألاَّ يخرج للقاء الفرس بنفسه «لأن الأمير كالنظام من الخرز يجمعه» ولأنه إن خرج انتقضت عليه العرب من أطرافها.
(حـ) إن هذا الإمام المجرب ما كان ليغفل الدعوة على الاتعاظ بالتجارب في الحكم فها هو ذا يقول «إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها» ويقول في مكان آخر: «استدل على ما لم يكن بما كان» ثم يقول أيضاً: «العقل حفظ التجارب» ولست أحمل هذا القول الأخير أكثر مما يحتمل إذا قلت: أنه هو الرأي الفلسفي المعارض للرأي القائل بأن العقل يتفاوت عند الأشخاص بطبيعته. والذاهب على العكس إلى أن العقل ليس إلاَّ عمل التجارب والتهذيب. والدافع لحجة الرأي الأول القائلة بأنا لو ربينا أشخاصاً ذوي أعمار واحدة تربية واحدة في بيئة واحدة لنشأوا رغم ذلك مختلفي العقليات، بأنهم إنما يختلفون لسبق تأثرهم بمزاج وراثي مختلف.
(ط) وتكلم الإمام في رسالته إلى الأشتر([361]) عن القضاة كلاماً قال عنه الأستاذ العشماوي أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة أن كلاماً غيره في أي دستور من دساتير العالم لم يفصل مهمة القضاة وطرق اختيارهم مثل ما فعل. قال الإمام: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرحهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل. ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، واعط من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك» وهذا دستور حكيم بل هو أحكم ما نعرفه وحسبه أنه انتبه إلى وجوب إجزال العطاء المالي للقضاة ليستغنوا بذلك عن الارتشاء وأنه شدد في إعطائهم منزلة قريبة من الوالي ليقطع بذلك الطريق على الوشاة وليعمل القضاة في جو هادىء.
وفي غير هذه الرسالة ذم من يتصدى للحكم وليس أهلاً له قائلاً: «جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشواً من رأيه ثم قطع به، جاهل خباط جهالات عاش ركاب عشوات تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث إلى الله» وفي موضع آخر يقول: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألاَّ يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها» ومعنى هذا أن على الخواص مهمة هي عدم الصبر على الظلم بل مجاهدته ولو لم يقع عليهم.
(ي) وتكلم في سياسة الجند وأمر جيشه ألا يتتبع عند الفوز فاراً ولا يهين امرأة وإن سبته فإن النساء ضعيفات. وهذا دليل الخصومة الشريفة ونبل الخلق. وقال في عهده إلى الأشتر: «وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته وأفضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون همهم هماً واحداً في جهاد العدو فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك، وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية. وإنه لا تظهر مودتهم إلاَّ بسلامة صدورهم ولا تصح نصيحتهم إلاَّ بحيطتهم على ولاة أمورهم وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مودتهم فأفسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله ثم اعرف لكل امرىء منهم ما أبلى ولا تضيفن بلاء امرىء إلى غيره ولا تقصرن به دون غاية بلائه ولا يدعونك شرف امرىء إلى أن تعظم من بلائه ما كان ضعيفاً ولا ضعة امرىء إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيماً».
ختام
والآن وقد سرنا في نهج البلاغة شوطاً يغرينا بالاستزادة فلنقف، وإذا كان الإمام علي قد نهى قومه عن أن يمدحوه فلا يخافن اليوم اغتراراً وهو بعيد عن حياة الغرور، إن نحن انحنينا أمام عبقريته، لقد حبانا نهج البلاغة فأحسن ما حبانا، فلنطبق عليه قوله: «قيمة كل امرىء ما يحسنه».
عبده حسن الزيات
المجتمع والطبقات الاجتماعية
عند الإمام علي (ع)
الإرث الثقافي، وليس الحضارة المادية، هو أثمن ما خلفه الإنسان للإنسان فبالثقافة يستكمل الإنسان وجوده الحق، لأنها تمده بالمعنى الذي لا يكون لولاه سوى وجود تافه في ميزان القيم والأقدار.
وليست الحضارة المادية، مهما عظمت سوى حسنة صغيرة من حسنات الثقافة الإنسانية إذا قيست بالآثار المعنوية لهذه الثقافة.
ولا تفوتنا ملاحظة أن أغلب الآثار الثقافية وقتية وليست خالدة، وتخص بعض الشعوب دون أن تكون للإنسانية كلها، وذلك لأنها تصدر بتأثير عوامل اجتماعية معينة فتلبي حاجات عقلية واجتماعية معينة، ثم تفقد قيمتها عندما ينتفي العامل الذي أثارها، ولا يكون لها من الأصالة والعمق والعمومية ما يهيىء لها أن تتعدى محيطها الخاص إلى محيط أوسع.
وإلى جانب هذا الإرث الثقافي الموضعي الوقتي تختص كل أمة من الأمم بآثار قليلة تعتبرها خالدة عندها، لا ينال من جدتها الزمان مهما طال لأن البحث فيها يتصل بما يدخل في الكيان الصميمي لتلك الأمة فهي لذلك تعتبر عند هذه الأمة خالدة ما دام لها كيان.
وأقل منها تلك الآثار التي تعتبر ملكاً للإنسانية كلها في كل زمان فلئن كان القسم الأعظم من الثقافة الإنسانية محدوداً بحدود الزمان والمكان ولئن كان القسم القليل منها محدوداً بالمكان وحده، فإن القسم الأقل والأعظم قيمة، من الثقافة الإنسانية لا يحده زمان ولا مكان.
هذه الآثار خالدة عند الناس كلهم لأنها لم توضع لفريق دون فريق ولم يراع فيها شعب دون شعب، وإنما خوطب بها الإنسان أنى وجد وكان ولأنها تلامس كل قلب، وتضمد كل جرح، وتكفكف كل دمعة كانت ملكاً للناس أجمعين، وكانت خالدة عند الناس أجمعين.
وهي قليلة، ولكنها لا تزال على قلتها، تثير في الناس الدوافع الطيبة النبيلة وتسمو بهم إلى أعلى إلى ملاعب النور، كلما شدتهم عوامل الشر إلى التراب.
ونهج البلاغة من هذه الآثار.
وسواء نظرت إليه من ناحية الشكل أو من ناحية المضمون وجدته من الآثار التي تقل نظائرها في التراث الإنساني على ضخامة هذا التراث. فقد قيل في بيان صاحبه أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، بيان معجز البلاغة، تتحول الأفكار فيه إلى أنغام، وتتحول الأنغام فيه إلى أفكار، ويلتقي عليه العقل والقلب، والعاطفة والفكرة فإذا أنت من الفكرة أمام كائن حي، متحرك ينبض بالحياة، ويمور بالحركة، وتلك هي آية الإعجاز في كل بيان.
ولم يكرّس هذا البيان المعجز لمديح سلطان، أو لاستجلاب نفع، أو للتعبير عن عاطفة تافهة مما اعتاد التافهون من الناس أن يكرسوا له البيان… إن البيان في نهج البلاغة قد كرس لخدمة الإنسان.
فلم يمجد الإمام الأعظم في نهج البلاغة قوة الأقوياء وإنما مجد نضال الضعفاء، ولم يمجد غنى الأغنياء وإنما أعلن حقوق الفقراء ولم يمجد الظالمين العتاة، وإنما مجد الأتقياء والصلحاء.
إن الحرية والعبودية، والغنى والفقر، والعدل، والظلم، والجهل والعلم، والحرب والسلم، والنضال الأزلي في سبيل عالم أفضل لإنسان أفضل، هو مدار الحديث في نهج البلاغة.
فنهج البلاغة كتاب إنساني بكل ما لهذه الكلمة من مدلول: إنساني باحترامه للإنسان وللحياة الإنسانية وإنساني بما فيه من الاعتراف للإنسان بحقوقه في عصر كان الفرد الإنساني فيه عند الحاكمين هباءة حقيرة لا قيمة لها ولا قدر، إنساني بما يثيره في الإنسان من حب الحياة والعمل لها في حدود تضمن لها سموها ونقاءها.
لهذا ولغيره كان نهج البلاغة وسيبقى على الدهر أثراً من جملة ما يحويه التراث الإنساني من الآثار القليلة التي تعشو إليها البصائر حين تكتنفها الظلمات.
وحق له أن يكون كذلك وهو عطاء إنسان كان كوناً من البطولات، ودنيا من الفضائل، ومثلاً أعلى في كل ما يشرّف الإنسان.
وهذه دراسات من نهج البلاغة قصدت من وضعها إلى أن أكشف عن ناحية ما فطن لها من كتبوا عن الإمام علي (ع) وهي أراؤه في الاجتماع والاقتصاد والسياسة، فإن آراء الإمام الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لم تلاق من الكتّاب العناية التي تستحقها وكأن البحث في نشاطه السياسي قد صرفهم عن البحث عن نشاطه العلمي مع أن نشاطه السياسي لا يمكن أن يفهم حق الفهم إلا إذا درس على ضوء آرائه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وشيء آخر حفّزني إلى وضع هذه الدراسات وهو أن قسماً كبيراً من الوعاظ يقدمون نهج البلاغة إلى الجماهير على أنه كتاب وعظي يشل في الإنسان إرادة الحياة، على ما هو المعروف من أساليب كثيرة من وعاظ هذه الأيام فأردت أن أكشف في هذه الدراسات عن أن نهج البلاغة ليس كتاباً وعظياً بقدر ما هو كتاب يعني بمشاكل الإنسان الروحية والاجتماعية والاقتصادية ويضع لها الحلول، وحتى القسم الوعظي منه ينكشف إذا ردّ إلى أصوله الاجتماعية، عن مفاهيم لا تمت إلى ما يقوله هؤلاء الوعاظ بصلة، ولا تلتقي معه على صعيد([362]).
فكرة المجتمع في نهج البلاغة
لعل فكرة المجتمع من أقدم الفِكَر التي اهتدى إليها الإنسان ـ الفِكَر التي لعبت دوراً خطيراً في تطوير الحياة الإنسانية، ودفعت بالإنسان إلى القيام بتجارب كثيرة كانت، على ما فيها من أخطاء وحماقات، تربة خصبة لتجارب أعظم أصالة وأشد أحكاماً وأقرب إلى شريعة الصواب من سابقها، وكانت أيضاً حافزاً إلى القيام بمحاولات جديدة تهدف إلى تطوير الحياة الاجتماعية وإرسائها على ركائز تضمن لها استقرارها ونموها.
ودخلت هذه الفكرة دورها الذهبي ـ ولا تزال فيه حتى اليوم ـ يوم جعلها العقل العلمي ميداناً لبحثه، فخرجت، بهذا، عن أن تكون ميداناً لتجارب جماهيرية عشواء، أو ميداناً لتطبيقات السياسيين الضيقي الأفق، الناظرين إلى قريب، المبتغين النفع العاجل من جلّ ما يصنعون ـ خرجت عن أن تكون ميداناً لمثل هذه التجارب الفجة لتصير ميداناً للنظر العلمي المتزن الرصين. وصار من همّ الفيلسوف ـ وهو رجل المعرفة الأول الذي عرفته البشرية بعد النبي ـ أن يتعرف على آليات الحياة الاجتماعية وقوانينها، ويدرس اتجاهاتها، ويصنف هذه القوانين والاتجاهات.
خصها بمزيد من العناية سقراط وأرسطو وأفلاطون، هذه القمم الشامخة في الفكر الفلسفي، وتعاقب بعدهم فلاسفة كثيرون لم يغفلوا هذه الفكرة ولم يبخسوها حقها من البحث والتفكير.. حتى جاء ابن خلدون فسجل في (مقدمته) حدثاً علمياً عظيماً بالنسبة إلى هذه الفكرة حين خطا الخطوة الأخيرة، فجعل منها علماً قائماً بنفسه يفترق عن الفلسفة في مادته وهي الحياة الاجتماعية، ويفترق عنها في منهجه وهو الملاحظة، ويفترق عنها في غايته وهي التعرف على أحسن الوسائل لتنمية الحياة الاجتماعية.
وجاء العصر الحديث، عصر الجماهير، فزادت أهمية هذه الفكرة وحصلت على هبتها العظمى من أوغست كنت في الفلسفة الوضعية وأصبح لها دوائر معارف خاصة هي دوائر المعارف الاجتماعية، وأصبح لها معاهد علمية خاصة لا تخلو منها جامعة تشرف عليها هيئات علمية تخصصت في هذا العلم: علم الاجتماع.
هذا عرض خاطف، وأرجو ألا يكون مقتضباً جداً، لمراحل تكون فكرة المجتمع وتبلورها. وهنا تجيء لحظة التساؤل عن صلة نهج البلاغة بهذا كله؟ والجواب عن ذلك أننا أردنا أن نكشف عن أن نهج البلاغة لم يحظ بالالتفات الجدير به من هذه الناحية وسنرى بعد أن نعرف أن لفكرة المجتمع في نهج البلاغة مكاناً مرموقاً بين ما اشتمل عليه من بحوث، وبعد أن نعرف أن الإمام علي قد تمرس بهذه الفكرة وعاناها كما لم يتمرس بها ولم يعانها حاكم في زمانه على الإطلاق وبعد أن نعرف أن معاناته لها قد انتهت به إلى نتائج باهرة ـ بعد أن نعرف هذا كله يتبين لنا أن نهج البلاغة كان يجب أن ينال حظاً من الالتفات إليه من الاجتماعيين، لأنه يسجل حدثاً مهماً في فكرة المجتمع.
لا نريد أن نقول أن الإمام علي قد اخترع علم الاجتماع لنرتفع بنسب هذا العلم من ابن خلدون إليه بعد أن تبين للدوائر الاجتماعية أن الأب الشرعي لهذا العلم ليس أوغست كنت، لا نريد أن نقول هذا فلم يكرس الإمام نفسه لاختراع العلوم، وإن كان قد شارك في هذا المجال الإبداعي فاخترع وحده العلم الذي حفظ للعربية أصولها وضمن لها الخلود ذلك هو علم النحو، لقد كانت مشاكل السياسة والإدارة والحرب هي شاغله الأول وهي ميدانه الأصيل كحاكم. إن الذين نريد أن نقوله هو أنه ـ كحاكم عادل ـ قد فكر في المجتمعات التي حكمها، وفكر في أفضل الطرق والوسائل التي تنمي حياتها الاجتماعية وترتفع بها إلى الذورة من الرفاهية والقوة والأمن، مع ملاحظة أنها تدين بالإسلام وأن شؤون اقتصادها وحربها وسلمها وعلائقها الاجتماعية تخضع لقوانين الإسلام، وأنها يجب أن تأخذ سبيلها إلى النمو في إطار إسلامي بحت. وقد هداه تفكيره إلى نتائج باهرة في التنظيم الاجتماعي: فالحكم وضرورته، والنزعة القبلية وعقابيلها، وشغب الغوغاء ونتائجه، ودعامات المجتمع ومقوماته، والطبقات الاجتماعية وآليتها كل ذلك خصه الإمام بمزيد من البحث والتفكير، وطبق النتائج التي اهتدى إليها على المجتمعات الإسلامية، ولولا أن أعداءه الأشرار شغلوه عن أن يفرغ لمهام العمل السلمي لترك لنا من أعماله شيء عظيم.
وإن ما بين أيدينا من كلامه في المجتمع ليدل دلالة واضحة على أنه راصد اجتماعي من الطراز الأول، وأن تقسيمه للطبقات الاجتماعية وتعريفه بآلياتها ليدخل في باب الحدس العبقري والإلهام.
ويقيناً لو أن الشريف الرضي حين جمع كتاب نهج البلاغة حفظ لنا كل ما وقع إليه من كلام أمير المؤمنين علي، ولم يؤثر الفصيح الباذخ وحده، لانتهى إلينا من ذلك شيء عظيم، ولو ضم ما ضاع من كلامه إلى ما حفظ إلى زمان الشريف لانتهى إلينا من ذلك شيء أجل وأعظم خطراً وقدراً.
وسيكون مصب البحث في حديثنا هذا هو الطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة، وقبل أن نأخذ سبيلنا إليه يحسن بنا أن ندخل في حسابنا أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى بحثنا هذا، فلقد قلنا آنفاً أن الإمام علي لم يقصد إلى وضع أصول علم جديد وإنما فكر ـ كحاكم عادل ـ في شؤون المجتمع وخرج من تفكيره بنتائج طبقها أو أراد تطبيقها على المجتمع، فلذلك لم يفرغ آراءه الاجتماعية كلها في قالب علمي مجرد، وإنما قدم بعضها مفرغاً في التجربة العملية، ولا يسلبها قيمتها كحقيقة موضوعية أنها مفرغة في قالب تجريبي اجتماعي يسبغ عليها، بدل جمود الحقيقة العلمية المجردة حيوية وحركة تنشآن من حيوية الجماعات وحركيتها.
الطبقة الاجتماعية
لا نعرف متى دخلت فكرة الطبقة، كوحدة اجتماعية كبيرة وذات مدى امتدادي رحب، في تركيب المجتمع الإنساني. ففي تاريخ الإنسان المكتوب لا نجد حضارة تألقت ثم انطفأت إلا وكانت تعرف فكرة الطبقات، وكان لهذه الفكرة واقع عياني يضرب بجذوره عميقاً في تنظيماتها الاجتماعية. كل المجتمعات التي وجدت وبادت والتي لا تزال مستمرة الوجود تقوم على النظام الطبقي وهذا يعني في ظاهر الحال أنه لم يمر على البشرية وقت طويل لم تعرف فيه فكرة الطبقات.
وربما كان هذا حقاً بالنظر إلى ما نرجحه في تعليل نشوء المجتمع الإنساني، فالمجتمع الإنساني، فيما نرجح، يخضع في نشوئه لعاملين: عامل الغريزة «بمعناها الواسع الذي يشمل عاطفة الأبوة والدوافع النفسية إلى تكوين العائلة» وعامل الثقافة بمعناها الواسع أيضاً. وهذا يعني أن المجتمع الإنساني وجد منذ اللحظة التي تعدد فيها أفراد النوع، فلم يمر على الإنسان أمد طويل كان فيه حيواناً غير اجتماعي.
ومنذ أخذ المجتمع الإنساني في الاتساع وجدت فكرة الطبقة سبيلها إلى العقل، فالأفراد يختلفون في مقدار ما يأتونه من أعمال البر والخير، ويختلفون في المواهب وفي القدرة البدنية، ويختلفون تبعاً لهذا في القدرة على الصيد وحيازته… وهذه الامتيازات وأخرى غيرها وجدت سبيلها إلى الوعي الإنساني في تصورات طبقية استتبعت فكرة الطبقات.
هذا، ولكننا حين نريد أن نتناول الطبقات بالبحث لا يمكن أن نتناولها على هذا المستوى الساذج البسيط، فقد أصبحت الطبقة مؤسسة اجتماعية ضخمة تمدها بالغذاء تقاليد عريقة، وتقوم على جذور موغلة في أعماق الماضي.
الانقسام الطبقي
ما هو المبدأ الذي يقوم عليه الانقسام الطبقي؟
لقد اختلفت آراء الاجتماعيين في هذا المبدأ، فبعضهم يرى أنه المهنة وثان يرى أنه الدخل والثروة، وثالث يرى أنه الدخل والمهنة معاً.
ولأجل الحصول على جواب صحيح لهذا السؤال نلاحظ أن هذا المبدأ يختلف باختلاف النظر إلى الطبقة كمؤسسة اجتماعية، فتارة ينظر إلى الطبقة باعتبارها تقوم بدور معين في العمليات الاجتماعية، وتقدم خدمات معينة إلى المجتمع وأخرى ينظر إليها باعتبارها كتلة بشرية ذات مستوى «مادي» اقتصادي واحد وذات مزاج نفسي وعقلي خاص يوحد بين مفاهيم أفرادها في الأسرة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية ومختلف الأذواق والطباع والعادات.
لا بد من اعتبار المهنة وحدها مبدأ للانقسام الطبقي إذا نظرنا إلى الطبقة من زاوية الدور الذي تقوم به في العمليات الاجتماعية، وذلك لأن هذا الدور يشتق من المهنة التي تمارسها الطبقة. أما حين ننظر إلى الطبقة من زاوية مستوى الحياة المادي والمعنوي الذي تتمتع به فلا بد من اعتبار مبدأ الانقسام الطبقي المهنة والدخل معاً، فالمهنة بما تخلفه في صاحبها من آثار نفسية معينة، والدخل بما يتيحه لصاحبه من مستوى معيشي معين يشتركان في صياغة الحياة المادية والنفسية للإنسان.
ويختلف مبدأ الانقسام الطبقي عن هذا وذاك حين ننظر إلى الطبقة الاجتماعية من زاوية المركز الاقتصادي الذي تتمتع به في المجتمع حسب نظام الإنتاج والتوزيع، ففي هذا الحال لا بد من جعل مبدإ الانقسام الطبقي الداخل وحده، لأن مجموع دخل الطبقة يعبر عن المركز الاقتصادي الذي تحتله بين الطبقات الأخرى. والدخل ينظر إليه هنا باعتباره ثروة متكدسة قارة ذات إمكانات اقتصادية لا باعتباره وسيلة إلى بلوغ مستوى معيشي معين([363]).
هذه مبادىء مختلفة للانقسام الطبقي وهي تختلف باختلاف زاوية النظر إلى الطبقة كما رأينا.
إن هذه المبادىء كلها إنما تعتبر مبادىء انقسام طبقي فقط، ولا تستتبع حكماً تقويمياً للطبقات. فمبادىء المهنة أو الدخل والمهنة معاً تشير إلى سبب الانقسام وحده؛ أما إن هذه الطبقة ذات قدر معين تحتله في سلم القيم والأقدار فذلك شيء لا يتضمنه مبدأ من هذه المبادىء على الإطلاق.
وهنا نتساءل: ما هو المبدأ الذي يستتبع الحكم التقويمي للطبقات؟ وبعبارة أخرى: نحن لا نتمثل المجتمع في أذهاننا سطحاً مستوياً تتساوى فيه الرؤوس، وإنما نتمثله هرمي الشكل، فيما توجد طائفة من الناس تحتل قمة الهرم توجد طائفة أخرى تحتل قاعدته، وتوجد بينهما طوائف تختلف بالرفعة والانحطاط على حسب قربها أو بعدها عن القمة والحضيض.
وإذن فإن كان لكل طبقة من الناس قيمة معينة في التصنيف الهرمي الاجتماعي، فمن أين جاء هذا التصنيف الذي يستتبع أحكاماً تقويمية لمختلف الطبقات؟
إننا، فيما أحسب لا نستطيع أن نضع أيدينا على ضابط حقيقي لهذا التصنيف الاجتماعي؛ إلا إذا درسناه من زاوية القيمة العليا للحياة. وذلك لأن أي حكم تقويمي إنما حدث بسبب هذه القيمة العليا، فترى أنه كلما قرب المرء من هذه القيمة وشارك فيها وزاد في تأكيدها واكتسب خصائصها ارتفعت قيمته وعلت منزلته وبالعكس نراه كلما بعد عنها ولم يساهم إلا بقسط ضئيل فيها أو لم يساهم فيها على الإطلاق هبط في المنزلة الاجتماعية.
والقيمة العليا للحياة قد تكون الاقتصاد أو الفضيلة أو السياسة أو الحرب. وقد تكون هذه القيمة العليا عبارة عن المبدأ الذي استدعى التشعب الطبقي، وذلك كما في المجتمعات التي يكون الاقتصاد هو القيمة العليا فيها، فقد رأينا أن الاقتصاد وحده أو منضماً إلى المهنة يكون المبدأ للانقسام الطبقي؛ فإذا ما كان بالإضافة إلى هذا قيمة عليا أيضاً استتبع حينئذٍ أحكاماً تقويمية تتفاوت بتفاوت القدرة الاقتصادية التي تملكها كل طبقة من الطبقات، وقد تكون القيمة العليا شيئاً آخر غير المبدأ الذي سبب الانقسام الطبقي، وحينئذٍ تحدث هذه القيمة انقساماً في داخل كل طبقة من الطبقات، وذلك كما لو كانت القيمة العليا للحياة عبارة عن الفضيلة فإن هذه القيمة تستتبع أحكاماً تقويمية تحدث انقساماً في داخل الطبقات نفسها، فقد يكون الفرد منتسباً من حيث المهنة أو المهنة والدخل أو القوة الاقتصادية إلى طبقة ضعيفة ومنحطة المستوى المعيشي ولكنه يكون بسبب قربه من القيمة العليا التي هي الفضيلة في ذروة الهرم الاجتماعي([364]).
ومهما يكن من أمر فإن هذه القيم التي ذكرنا تستتبع أحكاماً تقويمية تختلف باختلافها ويتشكل وضع المجتمع صحة وفساداً بسبب ما تخلّفه فيه هذه القيم من آثار وهذا ما نلمسه حين ندرس الطبقات على أساس أن المثل الأعلى للحياة هو الفضيلة أو الاقتصاد.
فتارة تكون القيمة العليا للحياة هي الفضيلة… هي أن يكون الإنسان فاضلاً ورحيماً بالضعفاء، باذلاً لهم المعونة دون أمل في تلقي الجزاء، ساعياً في خدمة النوع مؤثراً لذلك على مصالحه الخاصة وأطماعه، مستعداً للتعاون مع الغير في سبيل المنفعة العامة، منافحاً عن الحق أياً كان موطنه ومستقره محارباً الباطل في جميع أشكاله وألوانه، شاعراً بمسؤوليته كإنسان عاملاً على ضوء هذه المسؤولية بحرارة وإيمان.
تارة تكون القيمة العليا للحياة عبارة عن هذا، وحينئذٍ تتحدد المراتب الاجتماعية على أساس هذه المفاهيم، فيرقى إلى القمة كل من استطاع أن يجعل من نفسه مثلاً أعلى للفضيلة ويحتل المرتبة السفلى من المجتمع أولئك الذين لا فضيلة لهم أو الذين يستمسكون بالفضيلة استمساكاً واهياً، وما بينهما تتفاوت المراتب الاجتماعية على أساس الحصيلة الأخلاقية التي يحويها الإنسان ويعمل عليها.
في مجتمع كهذا توجد طبقات، وقد رأيت الأساس الذي أدى إلى انقسامها، ولكن هذا التفاوت الطبقي الناشىء عن تفاوت المستوى الاقتصادي والمعيشي عند هذه الطبقات من الناس لا يأخذ صفة الصراع المتمثل في استغلال الطبقات العليا للسفلى ومحاولة هذه الأخيرة التفلّت من أسر هذا الاستغلال بالثورة أو بغيرها من أساليب الصراع، وإنما تنظر الطبقات السفلى إلى العليا نظر حب ورحمة وإكبار، لأنها لا ترى في الطبقات العليا مستغلين يريدون امتصاص دمائها وجهدها وإنما ترى فيهم رسل إصلاح ضحوا بمصالحهم في سبيل مصالح الجميع، وتنكروا لأنفسهم وشهواتهم في سبيل الآخرين فهم ليسوا مستغلين لأن أكفهم لم تتعود غير العطاء. وفي مجتمع كهذا تنظر الطبقات العليا إلى السفلى نظرة رحمة وإشفاق وتحاول جهدها أن تنشلها من الوهدة التي قبعت فيها إلى الأفق العالي حيث يقبل جبينها نور الشمس. لا صراع ولا تناحر لأن الطبقات السفلى هنا لم تنحط عن القمة لأنها منعت من الصعود. لا صراع ولا تناحر لأن الأجنحة التي يحلق بها الإنسان هنا ليست شيء خارجاً عن النفس يملكه فريق ولا يجده الآخرون، وإنما هي شيء ينبع من النفس.. هي أنت بما أودع الله فيك من إمكانات الصعود ولم تبق حيث أنت لأنك لا تملك هذه الإمكانات وإنما لأنك فضلت واقعك اللاذ على الأفق العالي حيث الثمن هو التضحية وإنكار الذات. وفي مجتمع كهذا يحتل الاقتصاد مرتبة ثانوية من حيث التقويم فإذا اتخذه الإنسان وسيلة لنشر الفضيلة كان مزيّة يحمد عليها، وإلا كان رذيلة لا تهبه قيمة ولا تسبغ عليه قدراً.
وأخرى تكون القيمة العليا للحياة هي الاقتصاد… النجاح المادي الخارق القائم على تكديس الأموال وتراكم العقارات، حينئذٍ تتحدد المراتب الاجتماعية على هذا الأساس، فيرتفع إلى القمة أولئك الأغنياء الكبار ملوك المال والأعمال، ويقبع في الحضيض أولئك الذين لا يملكون شيئاً أو يملكون شيئاً قليلاً، وتتفاوت مراتب الناس بين هاتين الطبقتين على مقدار ما يملكون.
في مجتمع كهذا توجد طبقات كما رأيت، ولكن التفاوت الطبقي يأخذ صفة الصراع، لأن ما سبب الانقسام الطبقي هو مصدر القيمة في المجتمع، ولأن القيمة العليا هنا شيء خارج عن النفس فلا يكون للطبقات السفلى حينئذٍ أمل بالارتفاع.
ومن هنا ينشأ عند الطبقات السفلى شعور بالاستغلال ويواكب هذا الشعور شعور آخر فالطبقات العليا عند هؤلاء تعني ـ بالنسبة إليهم ـ المزاحم على متع الحياة والسعادة والقوة، ويولد هذا الشعور في أنفسهم مشاعر الحقد والبغضاء ويدفع إلى الخيانة والإجرام.
وهذا التخطيط الذي ذكرناه يصح بالنسبة إلى كل المجتمعات التي تجعل الاقتصاد مثلاً أعلى لها، سواء منها ما يرفع إلى القمة الرأسماليين أو ما يرفع إليها العمال والفلاحين لأن الصراع في هذه الأخيرة هو الصراع في المجتمعات الرأسمالية ومنابعه هنا هي منابعه هناك، فالأحقاد والمطامع والنيات السيئة والمكر الخبيث هي المد النفسي الذي يطغى على الكتلة الاجتماعية في المجتمعات الشيوعية وينسج مصيرها. غاية ما في الباب أن قمة الهرم الاجتماعي وقاعدته متعاكستان، فبينما يحتل الرأسماليون القمة في المجتمعات الرأسمالية، يحتلها العمال في المجتمعات الشيوعية القائمة اليوم. على أننا لا نستطيع أن نعقل ما تصوره الدعاية الشيوعية من أن الطبقة العاملة في المجتمعات الشيوعية هي التي تحتل قمة الهرم الاجتماعي. إن العلماء والأطباء والمهندسين والكتاب والممثلين ورؤساء المصانع ورؤساء الهيئات العالمية والمزارع التعاونية يتمتعون بميزات اجتماعية واقتصادية لا تتاح لسائر العمال.
وإذن لا فرق بين المجتمعات الرأسمالية والشيوعية في العقابيل التي تنشأ من جعل الاقتصاد قيمة عليا، ولأن كان ثمة فرق فأنّما هو في السطح والشكل، أما الأعماق وأما ينابيع الصراع فهي واحدة في كل هذه المجتمعات.
وهكذا ترى كيف أن جعل الاقتصاد قيمة عليا للحياة يسوق إلى التفسخ الاجتماعي. ولا أتصور جريمة أكبر من جريمة الماديين الذين ينادون بأن الاقتصاد هو القيمة العليا في الحياة، أنهم بخرافتهم هذه يجرون المجتمع إلى شر عظيم، ويشوهون المثل الإنسانية العليا.
الطبقات الاجتماعية
من هذين المثلين تعرف أن الطبقات الاجتماعية لا يمكن أن تدرس دارسة موضوعية صحيحة تؤدي إلى فهمها حقاً وإلى وعي مستلزماتها القريبة والبعيدة إلا إذا تناولها الباحث على صعيد المثل الأعلى في الحياة للمجتمع الذي يدرس الطبقات فيه.
ولا بد لنا، إذا رمنا وعياً حقيقاً لرأي الإمام في هذه المسألة أن نتناول مسألة الطبقات الاجتماعية على هذا الصعيد.
لقد اعترف الإسلام كما اعترف الإمام بالطبقات الاجتماعية القائمة على أساس اقتصادي أو مهني أو عليهما معاً وذلك لأن وجود هذه الطبقات ضرورة لا غنى عنها ولا مفر منها في المجتمع، فلا بد أن يوجد تصنيف مهني يقوم بسدّ حاجات المجتمع، المتجددة، ولا بد أن يوجد أناس لديهم مال كثير وآخرون لا يملكون من المال إلا قليلاً لأن التحكم التام في توزيع الثروات أمر مستحيل إطلاقاً، وإذا اختلفت المهن وتفاوتت الثروات فلا بد أن يختلف مستوى المعيشة ويتفاوت طراز الحياة المادي والنفسي وحينئذٍ توجد الطبقات.
وقد رأينا أن التفاوت الطبقي يصير منبعاً للصراع الطبقي إذا جعل الاقتصاد مثلاً أعلى للحياة، وإذن فالتفاوت الطبقي الناشىء عن التفاوت الاقتصادي خطر بقدر ما هو ضروري وإذا لم يوضع للمجتمع نظام يذهب بالخطر من هذا التفاوت ويستبقي جانب الخير فيه فإنه خليق بأن يسبب للمجتمع بلبلة تقوده إلى الدمار.
وهنا تتجلى عبقرية الإسلام وعبقرية الإمام.
فقد تدارك الإسلام هذه الثغرة فسدها بنظام من القوانين عظيم، وجاء الإمام فوضع قيوداً أخرى تحول بين التفاوت الطبقي وبين أن يخلف في المجتمع عقابيله الضارة وآثاره الوبيلة.
وعند الحديث عن التدابير الحكيمة التي وضعها الإسلام لوقاية المجتمع من شرور التفاوت الطبقي يجيء الحديث عن المثل الأعلى للحياة في الإسلام قبل كل حديث.
وحديثنا عن المثل الأعلى للحياة في الإسلام يسوقنا إلى الحديث عن المثل الأعلى للحياة عند الإمام. وما نهج البلاغة إلا انعكاس الإسلام في نفس الإمام. ومن هنا كان الحديث عن أحدهما يلزمه الحديث عن الآخر كما تستهدي العين بخيوط الشعاع على مركز الإشراق.
إن المثل الأعلى للحياة في الإسلام وعند الإمام هو التقوى. فقلّ أن ترد سورة في القرآن لم يرد فيها الأمر بالتقوى، تقوى الله. وقلّ أن ترد خطبة أو كلام في نهج البلاغة لم يرد فيه الأمر بالتقوى تقوى الله. فالقرآن أمر بالتقوى، وفصلها ومدح المتقين والإمام أمر بالتقوى ووصفها ومدح المتقين.
قال (ع):
«أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها حق الله عليكم، والموجبة على الله حقكم، وأن تستعينوا عليها بالله، وتستعينوا بها على الله، فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة، وفي غد الطريق إلى الجنة. مسلكها واضح وسالكها رابح، ومستودعها حافظ، لم تبرح عارضة نفسها على الأمم الماضين والغابرين، لحاجتهم إليها غداً… فاهطعوا بأسماعكم إليها، وكظوا بجدكم عليها، واعتاضوها من كل سلف خلفاً».
وقال (ع):
«إما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم، وشفاء مرض أجسادكم، وصلاح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم، وجلاء عشا أبصاركم، وأمن فزع جأشكم، وضياء سواد ظلمتكم… فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعد دنوها واحلولت له الأمور بعد مرارتها وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمها، وسهلت له الصعب بعد إنصابها، وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها. وتحدّبت عليه الرحمة بعد نفورها، وتفجرت عليه النعم بعد نضوبها، ووبلت عليه الكرامة بعد ارذاذها».
وقال (ع):
«… فإن تقوى الله مفتاح سداد، وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة بها ينجح الطالب وينجو الهارب، وتنال الرغائب».
ولكن ما هي التقوى؟
إن الإمام (ع) لم يتعرض لوصف التقوى من داخل إذا صح التعبير. إنه اكتفى على كثرة ما قاله فيها بوصفها من خارج: ميزاتها، وفضلها، وثمرتها، وأصحابها، أما هي بذاتها: مقوماتها، طبيعتها، فأمر لم يتعرض له الإمام (ع) وإنما تعرض له القرآن ولعل الإمام ترك الكلام في هذه الجهة اعتماداً على ما جاء في القرآن واعتماداً على أن المسلمين إذ ذاك كانوا ولا شك يعون ما هي التقوى، فاكتفى بتشويقهم إلى الأخذ بها والاعتصام بحبلها. أو أن الإمام قد تكلم في هذا الموضوع وأعطاه حقه من البيان ولكن الشريف رحمه الله لم يقع على شيء منه، أو وقع عليه ولم يكن بين ما اختاره. وعلى أي حال ففيما قدمه لنا القرآن غنى وكفاية.
قال الله تعالى:
﴿… ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفُقونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُوْلَئِكَ عَلَى هُدىً مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْحِلُونَ﴾([365]).
وقال تعالى:
﴿* لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالْصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾([366]).
وقال تعالى:
﴿* وَسَارِعُوَاْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الَّناسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾([367]).
وقال تعالى:
﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾([368]).
وروي عن النبي (ص) أنه قال: جماع التقوى في قوله تعالى: ﴿* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾([369]).
من هذه النصوص الإلهية، وغيرها أكثر منها، نعرف طبيعة التقوى. إنها الفضيلة في أرفع معانيها وأجل صورها. إنها الإيمان بالله في أطهر حالاته وأسمى معانيه، وبذل المال لمن أعوزه المال… ولكن كيف…؟ إنها بذل المال على حبه… حب الله تعالى، فلا امتنان على المعطي ولا أفضال، ومتى؟ إنها بذله في السراء والضراء. وهي الصبر في جميع المواطن وفي جميع الأحوال. وهي كظم الغيظ، وهي العفو عن الناس، وهي العدل فيهم والإحسان إليهم، وهي… وهي…
هذه هي التقوى، فإذا حققت التقوى في نفسك: وعيت وجود الله وأمره ونهيه في كل ما تلمُّ به من فعل أو قول، وتحرّيت الفضيلة أنّى كانت فأخذت بها وأخضعت نفسك لها، وجعلت من نفسك وجميع إمكاناتك خلية إنسانية حية، تعمل بحرارة وإخلاص على رفع مستوى الكيان الاجتماعي الذي تضطرب فيه، وصدرت في ذلك كله عن إرادة الله المتجلية فيما شرع من أحكام، تكون قد حققت في نفسك المثل الأعلى الذي نصبه الإسلام.
فالمال لا يكسب قيمة إلا إذا بذل حيث أجاز الله أن يبذل، وإلا إذا اتخذ وسيلة إلى رضوان الله. أما أولئك الذي لا يبذلون أموالهم فلا جدوى منهم للجماعة، ولذلك فلا مزية لهم على غيرهم من الناس الذين لا مال لهم. والسلالة لا قيمة لها حين لا يكون صاحبها متقياً لله. والقوة لا قيمة لها حين لا يستخدمها صاحبها في مرضاة الله. والسلطان، أنه لا يكسب صاحبه قيمة إلا إذا كان ذا تقوى.
هناك أغنياء وفقراء وحاكمون ومحكومون، وأقوياء وضعفاء وأناس تحدروا من سلالات لها ماض عريق وآخرون ليس لهم ماض مذكور، ولكن كل هذا لا يرفع من صاحبه ولا يضع إلا إذا اقترن بالتقوى أو عري عنها. وتعاليم الإسلام صريحة في ذلك لا لبس فيها ولا غموض، فهي تنص على أن القطب الذي يدور عليه التفاضل ليس شيئاً غير التقوى.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.
وقال النبي (ص): «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى».
وقال الإمام علي (ع): لا تضعوا من رفعته التقوى، ولا ترفعوا من رفعته الدنيا.
وإذن فالقيم الاجتماعية تتفرع عن هذا الأصل، وتنبثق من هذا الينبوع.
وهكذا تكون الرغبة في الخير ورضوان الله، ومساعدة الضعفاء، وتكريس المواهب في سبيل الجماعة تقرباً إلى الله هي رائد كل إنسان وعى مبادىء الإسلام وهكذا تكون الطبقات مظهر حب، ورحمة وتآزر، وإيثار وتعاون على البر والتقوى يدل أن تعبر عن تفسخ وانحلال.
هذا هو المثل الأعلى للحياة في الإسلام وعند الإمام.
ولكن الإسلام حين جعل الفضيلة مصدر القيمة الاجتماعية، وأراد أتباعه على أن يحملوا أنفسهم على هذا المركب صوناً للمجتمع من أخطار التفاوت الطبقي لم يغفل أمر الواقع النفسي والشعوري للإنسان.
فإن القوي الغني يتغنى بالفضيلة في كل آن، ولكنه عندما تستيقظ فيه نوازع العدوان يمضي في سبيل الشر دون أن يصغي إلى نداء فضيلة أو تقريع ضمير. وعندئذٍ تغدو الفضيلة ضلاًّ لا أثر له في صيانة المجتمع من أخطار التفاوت الطبقي. لذلك لم يكل أمر تحقيق القيمة العليا إلى الإنسان وحده وإنما جعل لها سنداً من القانون ليكون لها من القوة ما يحمل الأغنياء الأقوياء والفقراء الضعفاء على التمسك بها. وكان من ذلك أن ساوى بين جميع الطبقات في الحقوق والواجبات فالجميع سواء أمام الله والجميع سواء أمام القانون، وجريمة الغني هي جريمة الفقير، وجريمة الرفيع هي جريمة الوضيع، وجريمة الأمير هي جريمة الصعلوك، لا يمتهن هؤلاء لضعفهم ولا يحابى أولئك لشرفهم.
وبهذا حال بين الطبقات العليا وبين أن تطغى وتعتز، لأنه أثبت لها أن الغنى والسلالة والماضي العريق لن تجدي شيئاً أمام القانون. وحال بين الطبقات السفلى وبين أن تشعر بالحيف والضعة والاستغلال، لأنه أثبت لها أن الفقر وضعة النسب لا تجعل من القانون لها عدواً، وإنما هي ادعى لأن تجعله أرفق بها، وأحنى عليها، وأرعى لشؤونها في السراء والضراء.
وحين تحتد الفروق الاقتصادية فتتسع وتتعمق، وتغيض منابع الفضيلة من المجتمع وتسوده نوازع الحيوان.
فأنت لا تستطيع أن تطلب من جائع لا يجد القوت أن يصير فاضلاً، لأن الحرمان لا يدفع إلى الفضيلة وإنما يخلق تصورات الحرمان التي تدفع إلى التمرد والإجرام حين لا يجد المحروم اليد البارة الوصول.
إن الجائع الذي لا يجد ما يسد جوعته وإن خشن وهان، والعاري الذي يجد للريح مثل لسع السياط وللشمس مثل مس الحميم، والمريض الذي لا يجد ثمن الدواء ولا الخلاص من اللأواء ـ هؤلاء لا يستطيعون أن يتغنوا بالفضيلة حين يرون الغني الكاسي الصحيح الذي لا يعرف معنى للجوع فالفضيلة ليست طعاماً ولا كساء ولا دواء، أن هؤلاء ينقلبون إلى قتلة ومجرمين ولصوص حين لا يجدون ما يسدون به حاجتهم الأولية من طريق مشروع.
وهكذا يظهر إلى العيان الصراع الطبقي بالرغم من أن المثل الأعلى هو الفضيلة ومكارم الأخلاق.
وعى الإسلام هذا الواقع فلم يكل أمر صيانة المجتمع من أخطار التفاوت الطبقي إلى المثل الأعلى وحده، وإنما أولى الاقتصاد ما له من الأهمية في أمر الصيانة والعلاج. فجعل في أموال الأغنياء ضريبة ترد على الفقراء فترد عنهم غائلة الحاجة، وتباعد ما بينهم وبين الحرمان، وبذلك يشعر الفقراء أنهم ليسوا مهملين: لا عين ترعاهم ولا يد تأسو جراحهم، وتقيلهم عثرات الزمان… بل يشعرون أنهم ملء سمع المجتمع وبصره فتختفي دوافع الإجرام من أنفسهم، وحينذاك يقول لهم الإسلام أن المثل الأعلى هو الفضيلة، ويطلب إليهم أن يكون فضلاء… وأن يجعلوا الأرض أختاً للسماء.
عند الإمام
وعى الإمام علي أن الإنسان الجائع، المستغَل، المحروم، المصفد بالإغلال لا يستطيع أن يكون فاضلاً، وأن من اللغو أن يوعظ بالوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، وأن إنساناً كهذا ينقلب كافراً: كافراً بالقيم والفضائل، والإنسان. إن معدته الخاوية، وجسده المعذب، ومجتمعه الكافر بإنسانيته، المتنكر له، وشعوره بالاستغلال، وميسم الضعة الذي يلاحقه أنّى كان ـ هذه كلها تجعله لصاً، وسفاحاً وعدواً للإنسانية التي لم تعترف له بحقه في الحياة الكريمة.
ووعى أن المجتمع القائم على سيادة فريق وعبودية فريق، مجتمع لا يمكن أن توجد فيه فضيلة ولا يمكن أن يوجد فيه فضلاء، إنه ليس إلا مجتمع تسيّر أفراده الأحقاد والمكر والاستغلال.
على أساس من هذا الوعي جعل الإمام علي الإصلاح الاقتصادي أساساً للإصلاح الاجتماعي.
ولقد كان من الطبيعي جداً ـ حتى عند المفكرين والمصلحين ـ في عصر الإمام علي وقبله أن يوجد أناس جائعون فقراء، وأن يوجد أغنياء يحارون كيف ينفقون أموالهم، فلم يكن الفقر بذاته والغنى بذاته مشكلة اجتماعية تطلب حلاً، لأنها أمر طبيعي لا محيد عنه، إنما المشكلة هي: كيف السبيل إلى إسكات الفقراء وحماية الأغنياء؟ فكان الإمام علي هو أول من كشف أن الفقر والغنى مشكلة اجتماعية خطيرة، ونظر إليها على أساس أفاعليها الاجتماعية.
إن فلسفة الفقر عنده تجتمع في هاتين الكلمتين:
«ما جاع فقير إلا بما متع به غني».
و«ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق، مضيع».
ومن هنا أصبح من أبرز المشاكل التي حفل بها منهجه الإصلاحي يوم ولي الحكم مشكلة الفقر والغنى.
ولقد كان مجتمعه إذ ذاك يعاني جراحاً عميقة بسبب هذه المشكلة، فقد ولي الإمام علي الحكم والتفاوت الطبقي في المجتمع الإسلامي على أشد ما يكون عمقاً واتساعاً.
ففي زمان عمر كانت الطريقة المتبعة في التقدير وإظهار الكرامة هي التفضيل في العطاء، فلما ولي الخلافة عثمان اتبع هذه الطريقة أيضاً ولكنه خرج بها عن حدود المعقول، ففضل من لا سابقة له في الكفاح ولا قدم له في الإسلام على ذوي السوابق والأقدار. وقد أدت هذه الطريقة إلى العاقبة التعسة التي صار إليها عثمان وحكومته والمجتمع الإسلامي في زمانه، فقد أوجد هذا اللون من السياسة المالية طبقة من الأشراف لا تستمد قيمتها من المثل الأعلى للإسلام وإنما تستمدها من السلالة والغنى والامتيازات التي أسبغها عليها عثمان، وطبقة الشعب التي ليس لديها مال ولا امتيازات ولا ماض عريق وكان من عقابيل ذلك أن أحس الفقراء الضعفاء بالدونية واستشعر الأشراف الاستعلاء، وحرم الفقراء المال الذي تدفق إلى جيوب الأغنياء.
فلما ولي الإمام علي الحكم ألفى بين يديه هذا الإرث المخيف الذي يهدد باستئصال ما غرسه النبي في نفوس المسلمين، وقد عالج هذا الواقع الذي سيق إليه بالتسوية بين الناس في العطاء فالشريف والوضيع، والكبير والصغير، والعربي والعجمي، كلهم في العطاء سواء. فلم يجعل العطاء مظهراً للتفاضل بين الأفراد والأفراد والطبقات والطبقات. وبهذا أظهر للناس أن القيمة ليست بالمال، وحال بين الفقراء والضعفاء وبين الشعور بالدونية، وبين الأشراف والأقوياء وبين أن يشعروا بالاستعلاء. وأهاب بالناس أن يثوبوا إلى الله فيجعلوا التقوى مناط التفاضل ومقياس التقويم.
وقد ثارت الطبقة الأرستقراطية لسياسة المساواة المالية التي قام بها الإمام فأشاروا عليه أن يصطنع الرجال بالأموال، فقال:
«أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟ لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف وإنما المال مال الله ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف..».
ولم يكن هذا كل ما ينتظر الطبقة الأرستقراطية على يديه يوم أمسك بالزمام، لقد كانت أموال الأمة تتدفق ـ تحت عينيه ـ في زمن عثمان إلى جيوب فريق من الناس، فأخذ على نفسه عهداً بمصادرتها، بردها إلى أهلها وكان أن أعلن للناس يوم ولي الحكم مبدأ من جملة المبادىء التي أعدها لمحاربة الفقر الكافر في مجتمعه الموشك على الانهيار، فقال:
«ألا أن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله، فهو مردود في بيت المال. فإن الحق لا يبطله شيء».
وكم كان يقض مضجعه عدم التوازن في توزيع الثروات في زمانه فتراه يصرخ أكثر من مرة من على منبر الكوفة بمثل هذا القول:
«… وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً والشر فيه إلا إقبالاً أضرب بطرفك حيث شئت من الناس: هل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً؟ أو غنياً بدل نعمة الله كفراً؟ أين خياركم وصلحاؤكم وأحراركم وسمحاؤكم؟ وأين المتورعون في مكاسبهم، والمتنزهون في مذاهبهم؟
لا يعالج الفقر عند الإمام علي بالمواعظ والخطب، وإنما يعالج بحماية مال الأمة من اللصوص والمستغلين، ثم بصرفه في موارده. وبهذا عالجه الإمام، فكان عيناً لا تنام عن مراقبة ولاته على الأمصار، وعن التعرف على أموال الأمة وطرق جبايتها وتوزيعها. وكم من وال عزل وحوسب حساباً عسيراً لأنه خان أو ظلم أو استغل، وكم كتاب كتبه إلى ولاته يأمرهم أن يلزموا جادة العدل فيمن ولّوا عليهم من الناس، وبينما هو يأمرهم بهذا يضع عليهم العيون والرقباء ليرى مدى طاعتهم وتنفيذهم لأوامره، لقد كان بهذا، أول من اخترع نظام التفتيش.
ولقد كان يكتب إلى ولاته: «إن أعظم الخيانة خيانة الأمة» وليس الولاة أعضاء في شركة مساهمة هدفها أن تستغل الأمة وإنما هم كما كان يكتب إليهم «خزان الرعية، ووكلاء الأمة، وسفراء الأئمة».
وكون الأموال العامة هي أموال الأمة مفهوم لم يأخذ صيغته الحقة إلا على لسان الإمام علي وفي أعماله.
لقد جاءه أخوه عقيل يطلب زيادة عن حقه فرده محتجاً بأن المال ليس له وإنما هو مال الامة، وجاء ثانٍ يطلب اليه أن يعطيه مالاً، مدلاً بما بينهما من رابطة الحب فرده قائلاً:” إن هذا المال ليس لي ولا لك انما هو فيء للمسلمين”.
بهذا كله لم يكل الاسلام ولا الإمام علي أمر التزام الفضيلة في السلوك إلى الضمير وحده وإنما جعلا لها سنداً من القانون يكفل لها أن تصير واقعاً اجتماعياً تنبني عليه العلاقات الاجتماعية والسلوك الإنساني، ولكنهما لم يجعلا القانون كل شيء في حياة الإنسان لئلا يكون آلة مسيرة لا تملك اختيار ما تريد، وإنما أناطا جانباً من سلوكه بملزمات الضمير بعد أن أيقظ هذا الضمير، ولم يكل أمر صيانة المجتمع من أخطار التفاوت الطبقي إلى الفضيلة وحدها، لأنها لا تسد حاجات الإنسان التي لا يقوى بدونها على التزام الفضيلة ومكارم الأخلاق، وإنما أناط جانباً من مهمة الصيانة بالاقتصاد لأنه هو الذي يسد حاجات الإنسان.
وهكذا، بين الضمير اليقظ والقانون الواعي لحاجات الفرد والمجتمع ينمو الإنسان، ويأخذ سبيله إلى الكمال النسبي الذي يتاح للإنسان.
وحيث قد تبين لنا موقف الإمام من الطبقات الاجتماعية والتفاوت الطبقي، فلنسلك سبيلنا إلى دراسة الطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة.
مصدرنا الوحيد، من نهج البلاغة، في دراسة الطبقات الاجتماعية عند الإمام علي هو كتابه إلى مالك بن الحارث الأشتر حين ولاه مصر ولكن يشاء الله لحكمة خفية ألاَّ يطبق في مصر شيء من هذا القانون الذي كتبه الإمام علي فقد دس معاوية من قضى على الأشتر وهو في أعتاب مصر بسم دسّ في كأس من عسل، وبعد ذلك قتل محمد بن أبي بكر وتمت لمعاوية الغلبة على مصر فنزل عنها لعمرو بن العاص وفاء بالعهد الذي بينهما.
وما بين أيدينا من هذا العهد ليس تمامه. لا، وإنما قطع منه اختارها الشريف الرضي. وليته أثبته كله، إذن لزدنا بصراً بآراء الإمام في هذا الموضوع، ولكن ماذا نصنع والشريف لم يختر إلا البليغ من كلام علي (ع).
ويحسن بنا أن ننوّه، ونحن على أعتاب البحث عن الطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة، بأن التقسيم الطبقي الذي ذكره الإمام يقوم بالدرجة الأولى على الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها كل طبقة، وهناك تقسيم آخر يتم في داخل الطبقات هو التقسيم على أساس المثل الأعلى، والتقسيم الأول لا يستتبع حكماً تقويمياً على الشخص المنتسب إلى طبقة ما يجعله في القمة أو ينحدر به إلى الحضيض. إن التقسيم الذي يستتبع الحكم التقويمي أعني الذي يحدد قيمة الشخص إنما هو التقسيم الثاني، فالإنسان، الذي يستغل إمكاناته في سبيل خير المجتمع هو في القمة أما الإنسان الذي يتخذ هذه الإمكانات سبيلاً إلى العبث والإفساد وإضرار المجتمع فذلك شخص يحتل مركزه في الطبقات السفلى.
وإذن فترتيب الطبقات في التقسيم لا يعني ترتيبها في القيمة، فيكون الجنود هم الطبقة العليا ويكون المعدومون هم الطبقة السفلى، وتكون قيمة ما بينهما على هذا الترتيب قرباً من الجنود وبعداً عنهم، لا، فقد عرفت أن الإمام لم يراع قيمة طبقة حين قدمها وأخرها، وإنما راعى الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها، أما القيمة فلا تقاس إلا بالتقوى.
ونقدم بين يدي بحثنا هذا ملاحظة لها خطرها، وهي: إن هناك طبقات افترض الإمام وجودها وتحدث عنها كأهل الخراج، والتجار، والصناع، والمعدمين، وهناك طبقات لم يفترض وجودها وإنما تكلم رأساً في كيفية إنشائها وتكوينها، فإلام تشير هذه الملاحظة؟
إن ما تشير إليه هذه الملاحظة، فيما أرى، أمر طريف جداً ومعجب حقاً فالطبقات التي تكلم الإمام في كيفية إنشائها وتكوينها هي: طبقات العسكريين، والوزراء، والولاة، والقضاة. وهذه الهيئات هي التي تشرف على تسيير الجهاز الاجتماعي، وبها يتعلق مصيرها النيّر أو الوبيل، وقد كان هذا الجهاز قبل عهد الإمام فاسداً ومتهرئاً فأراد الإمام أن ينشأه من جديد.
ومن هذه الملاحظة نستكشف مدى عظمة الإمام في المسائل الاجتماعية فالمجتمع، خيره وشره، نحن نصنعه بأيدينا، وليس ضربة لازمة لنا أن نعيش في مجتمع متذائب متداع لا يوفر لأفراده فرصاً حسنة، وإنّما بإمكاننا أن نعيش في مجتمع حسن التنظيم يجد فيه كل فرد من الأفراد المجال الرحب لتحقيق مطامحه التي يريد، ولا يتم ذلك إلا إذا أصلحنا الأجهزة الاجتماعية المتداعية أو بدلناها بأخرى أجدى منها.
بهذه العقلية العظيمة الواعية نظر الإمام (ع) إلى مجتمع مصر في أيامه، وبهذه العقلية العظيمة الواعية وضع له هذا النهج وسن له هذا القانون، ولكن مجتمع مصر لم يسع بتطبيق هذا النظام.
طبقات المجتمع
قسم الإمام الرعية إلى طبقات سبع: الجنود، كتّاب العامة والخاصة، وهم بمنزلة الهيئة الوزارية ومساعديها، القضاة، الولاة، الزراع، التجار، الطبقة السفلى.
ولكنه في مورد ثان جعل القضاة والولاة والكتاب طبقة واحدة، وإن كان فيما بعد قد جرى في الكلام عن الطبقات على تقسيمه الأول.
ومع أنه يمكن إدراج الكتّاب والولاة في طبقة واحدة باعتبارهم إداريين من حيث الوظيفة، وباعتبار أن «نوع الحياة» الذي يحيونه واحد أيضاً، فإن مستوى الدخل والإنفاق والتصورات الاجتماعية عندهم واحدة أو متقاربة تقارباً شديداً ـ أقول مع أنه يمكن إدراج هاتين الطائفتين في طبقة واحدة جعلهما الإمام طبقتين متمايزتين. واحسب أن الذي دفعه إلى ذلك هو رغبته الأكيدة في التنصيص التام على كيفية تأليف كل جهاز من أجهزة الحكم في الدولة لئلا يقع اللبس والإبهام في اشتراك طائفتين مختلفتي مجال النشاط في حديث واحد. ونحن، محافظة منا على إبراز جميع خصائص العهد، سنجري في كلامنا عن الطبقات حسب تقسيمه (ع) وإن لم تكن ثمة ضرورة، بلحاظ الطبقات ذاتها، تدعو إلى أتباع هذا النهج.
العسكريون
وبعد أن قسم الإمام الطبقات على النحو الذي رأيت، تقدم بملاحظة ذات مغزى، وهي أن كل واحدة من هذه الطبقات، عدا الطبقة التي لا تستطيع عملاً، ضرورية للمجتمع، والعمل الذي تقوم به ضروري الوجود، وكما أنه يعتمد في وجوده على جهود الآخرين كذلك جهود الآخرين لم تكن لتوجد لولاه. ولذلك قال (ع): «الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى لبعضها عن بعض».
لولا الجنود لانعدم الأمن، وحينئذٍ تنعدم التجارة ويختل نظام الزراعة، وإذا اختل هذان انهار الكيان الاجتماعي، ولولا التجارة والزراعة لما وجدت الضرائب التي تمد الجنود بالمال والسلاح، ولولا التجارة لحدثت أزمات اجتماعية تنشأ من تكدس الإنتاج في غير مكان الحاجة إليه وعدم وجوده في مكان الحاجة إليه، والعمال «الولاة» والكتاب يشرفون على تنظيم هذا النشاط الاجتماعي ولولاهم لتسيب واتجه اتجاهات غير صالحة ولولا القضاة للجأ الناس إلى تسوية مشاكلهم بالعنف، وذلك يؤدي إلى بلبلة الاجتماع. وإذن، فالنشاطات الاجتماعية متشابكة ومتداخلة، وليس فيها لأحد على أحد فضل، فكل واحد من الناس يؤدي عملاً يأخذ في مقابله من المجتمع أعمالاً كثيرة، ولو كف المجتمع عن تقديم المعونة له لما أمكنه أن يقوم بشيء.
قال (ع):
«… فالجنود بإذن الله حصون الرعية، وزين الولاة، وعز الدين، وسبل الأمن، وليست تقوم الرعية إلا بهم، ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم، ويعتمدون عيه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم. ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامّها. ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، ويقيمونه من أسواقهم، ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم».
وحيث كان النشاط الاجتماعي متشابكاً على هذا النحو، متداخلاً على هذه الشاكلة فيجب أن تشق له القنوات التي يجري فيها على نحو لا يختل ولا يتدافع، ولا يطغى لون منه على لون، وأمر هذا موكول إلى الحاكم.
قال (ع):
«وفي الله لكل سعة، ولكل على الوالي بقدر ما يصلحه، وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل».
العسكريون خطر وضرورة في آن
هم خطر لأن الطبقة التي ينتمون إليها هي أقوى طبقات الأمة كلها، فالجيش طوع أمرهم، والسلاح تحت أيديهم، ولا قوة تمنعهم من الثورة إذا ما أرادوا، ولا حاجز يحول بينهم وبين ظلم الرعية إذا تمكن ذلك من أنفسهم، ووجد هوى في صدورهم. والوجدان الذي ينتظم أفراد هذه الطبقة يقتضيهم ذلك وينزع بهم نحوه، فإن التصورات التي يتكون منها هذا الوجدان هي تصورات القوة والغلبة والفتك وما يتبع هذه من تصورات الخيلاء والاستعلاء. وطبيعة عملهم العسكري تقتضيهم أن يواجهوا مشاكلهم من طريق العنف والقسر وتحملهم على أن يحلوها من هذا الطريق. وطبيعة عملهم أيضاً تجعلهم ينظرون إلى المجموعات الإنسانية «كوحدات عددية» تقوم بعمل معين لا أكثر ولا أقل وذلك لأنهم لا ينظرون من الجندي الذي يدين لهم بالطاعة إلى أكثر من أنه آلة تجيد استعمال السلاح، أما ما وراء ذلك من صفات نفسية وسمات ذاتية فلا ينظرون إلى شيء منها، لأن هذه كلها تنطمس في التجمع البشري الضخم المسمى بالجيش، ولأنها لا تغني كثيراً في أداء المهمة المطلوبة من الجندي، وإذا كانوا ينظرون إلى الجماعة الإنسانية على هذا النحو فلا يؤمنون من الانحراف عن جادة الصواب في معاملتهم مع الناس، لأن الصفات النفسية هي التي يجب أن تلحظ في هذه المعاملة وهم يغفلونها لأن طبيعة عملهم تقتضي ذلك كما رأيت.
هذا الوجدان الطبقي «وهو ضروري إذ لولاه لما كانوا عسكريين» خطر إذا احتد وعبر عن نفسه في غير أوانه وجرى في غير أقنيته الحقيقية، هذا هو وجه الخطر فيهم.
وهم ضرورة لأن وجودهم يحفظ الأمن ويصون الدولة، ويردع السفيه ويضرب على يد المعتدي.
وحيث كانوا ضرورة فلا بد من وجودهم، وحيث كانوا خطراً فلا بد من تفاديه. وإذا قد لزم هذا وذاك فقد شرع الإمام (ع) لحاكم مصر نظاماً يستهدي به في تأليف هذه الطبقة من جديد، وشريعة يجري عليها في انتخاب من يريد ضمه إليها من رعيته، وسنة يأخذ بها في معاملتها. وقصد من ذلك كله إلى أن يؤمّن من هذه الطبقة جانب الضرورة، وينأى بها عن أن تكون مصدر خطر وإرهاب.
الشخصية العسكرية ضرورة لازمة للقائد العسكري لزوم الهواء لكل كائن حي.
وهذه الشخصية عبارة عن طائفة من الصفات تلتقي في القائد فتكوّن له شخصية. فيجب أن يكون القائد العسكري متصفاً بصفة النفوذ والهيبة التي تجعله نافذ الأمر، وذلك لأن الصفة الأولى المطلوبة من الجندي هي الطاعة وبدونها لا يمكن أن ينجح جيش على الإطلاق، وما لم يكن للقائد العسكري صفة النفوذ والهيبة بعدت الطاعة عن منال يديه، وحينئذٍ لا ينجح في عمله العسكري. ويجب أن يكون واجداً لصفة الخبرة بمن يعمل تحت يديه من مرؤوسيه، عارفاً بإمكاناتهم وكفاءاتهم ليضع كلاً منهم موضعه اللائق به لأن خطأ بسيطاً في تعيين قائد ربما أدى إلى كارثة قومية. ويجب أن يكون واجداً للثقافة العسكرية: عارفاً بأساليب قيادة الجيش وحركاته والاستراتيجية العسكرية. ولما كان القائد هو المثل الأعلى للجندي وجب أن يكون هذا القائد مثلاً يحتذى لجنوده، في الصبر على المكاره، والتفاني في القيام بالواجب، وهما من ألزم الصفات العسكرية في الجنود والقادة على السواء.
ولا توجد هذه الصفات في عامة الناس، وهي ليست صفات تنحدر بالوراثة من جيل إلى جيل، بل لا بد فيها من التربية المنهجية الواعية. ولم تكن في زمن الإمام (ع) مدارس وكليات عسكرية تقدم مثل هؤلاء القادة في كل وقت، هذه الملاحظات دفعت بالإمام إلى تعيين العناصر التي يؤخذ منها هؤلاء. هذه العناصر هي البيوتات الشريفة ذات الأحساب والتقاليد المتوارثة، فقد كانت هذه البيوتات تأخذ أبناءها بتربية قاسية واعية توفر لهؤلاء الأبناء الثقافة العسكرية وهي من أهم ما كان يأخذ به العرب ويعنون باتقانه، وتغرس في أنفسهم الشعور بالمسؤولية والتحمل والصبر على المكاره. وقد كانت هذه البيوتات تحتل في نفوس أبناء الشعب، وهم الذين يؤخذ منهم عامة الجند، مركزاً سامياً حصلت عليه بسبب الخدمات التي تقدمها هذه البيوت للأمة في الحرب والسلم على السواء، وهذا يوفر للقائد صفة الهيبة، ويضمن له نفوذ الأمر وحصول الطاعة.
قال (ع):
«ثم الصق بذوي المروءات والأحساب، وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة، والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم، وشعب من العرف».
ولكن هؤلاء القادة يستمدون من وسطهم العائلي تصورات القوة والاستعلاء لمكان ما لهم من مركز مرموق في المجتمع، ويستمدون من وظيفتهم الجديدة ما يعزز هذه التصورات ويمدها بالحرارة والفعالية وينزع بها إلى التحقيق نظراً إلى ما توفر لهم من الهيمنة على الجيوش والسلاح، ويستمدون من ثقافتهم ما يزين لهم الفعل ويبرر لهم العمل ـ هذه الينابيع الثلاثة للوجدان الطبقي عند العسكريين تعمل دائماً على إثارة هذا الوجدان وبعثه. وهنا يظهر وجه الخطر فيهم، وقد وضع الإمام العلاج الواقي من هذا الخطر.
فإلى جانب الصفات السابقة يجب أن تتوفر في القائد صفات أخرى منها الثقافة، وهذه الثقافة لا يكفي فيها أن تكون «علماً» بالواجبات الدينية فقط وإنما يجب أن تكون «وعياً» لهذه الواجبات بحيث تكون في جهاز القائد النفسي قوة دافعة تحمله على أن يسير على هديها في حياته العملية، ولا تبلغ هذه الثقافة هذا المدى في تأثيرها إلا إذا استحالت في القائد إلى «طاقة شعورية» محركة. ومنها أن يكون أميناً لا تمتد يده إلى ما ليس له، حليماً لا يحمله الغضب على فعل ما لا تحمد عقباه، واسع الصدر يجد العذر موقعاً في نفسه، رحيماً بالضعيف لا يتخذه موضوعاً لإظهار مدى سلطته..
وهكذا، فإلى جانب الثقافة الدينية التي يجب أن تبلغ من نفس القائد مرتبة الطاقة الشعورية يجب أن يكون على مستوى أخلاقي عال يصده عن الفساد، ويمسكه على الجادة، ويأخذ بعنقه إلى الهدى.
قال (ع):
«… فولّ من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، وأنقاهم جيباً، وأفضلهم حلماً، ممن يبطىء عند الغضب، ويستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء، وينبو على الأقوياء، وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف».
وبعد أن نهج الإمام القواعد التي يجب أن تتبع في اختيار أفراد هذه الطبقة أخذ في بيان الأسلوب الذي يجب أن تعامل به.
يرى الإمام أنه لا يجوز للحاكم أن يعتمد على التربية وحدها، وعلى الخلق الشخصي وحده فيما يرجع إلى ضمان إخلاص هذه الطبقة. فهو بقدر ما يحرص على أن يكون القادة العسكريون ذوي تربية عالية وخلق متين يحرص كذلك على توفير ما يتوقون إليه من الناحيتين: المادية والمعنوية.
فهؤلاء القادة يتوقون إلى أن يروا أن أعمالهم التي يقومون بها تلاقي التقدير الذي تستحقه عند الحاكم، ويتوقون إلى أن يروا أن عين من فوقهم ترعاهم وتتعاهد أعمالهم وتوفيها ما تستحق من جزاء. وهؤلاء القادة كغيرهم من الناس، خاضعون للضرورات الاقتصادية، وربما كانت حاجتهم إلى المال أكثر من حاجة غيرهم إليه، وإذ كانوا كذلك فلا بد للحاكم من مراعاة حالتهم الاقتصادية.
ولا يجوز له أن يعتمد على الخلق والتربية في ضمان إخلاصهم وتمسكهم بمثلهم العليا، فإن الحاجة تدفع إلى الإجرام. ولا بد له من تتبع مآثرهم والإشادة بها، ومدحهم والثناء عليهم بما أبلوا من بلاء حسن وأتوا من فعل عظيم.
فأما حين تغفل عنهم عينه، فلا يتفقد أحوالهم، ولا يوليهم منه جانب اللين والرأفة ـ حين يجدون هذا منه يشعرون بأن أعمالهم لا تجد ثوابها وإن جهدهم يذهب أدراج الرياح، ويعظم في أعينهم الصغير ويصغر العظيم، وتنعدم ثقتهم بالحاكم، ويذهب وده من قلوبهم، فلا يمحضونه النصح، ولا يخدمونه بصدق، لأنهم لا يجدون في أنفسهم ما يدفعهم إلى خدمته وهو متخاذل عنهم مقصر معهم، ويدفعهم هذا الموقف النفسي إلى استثقال دولته، واستطالة مدته، والتبرم بحكمه، فإذا يمنعهم، وهذا موقفهم منه، عن أن ينتقضوا عليه ويكيدون له ويواجهوه بما لو أحسن السياسة لاتقاه؟
قال (ع):
«ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الولدان من ولدهما، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به، ولا تحقرن لطفاً تعاهدتهم به، وإن قل، فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك. ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمها فإن لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به، وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه… فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك. وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد، وظهور مودة الرعية، وأنه لا تظهر مودتهم إلاَّ بسلامة صدورهم، ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة الأمور وقلة استثقال دولهم، وترك استبطاء انقطاع مدتهم، فافسح لهم في آمالهم، وواصل في حسن الثناء عليهم، وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله».
وتأمل الفقرة الأخيرة: «… فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل..» فإنها تتضمن مغزى عميقاً، فبدلاً من أن يوجه اللوم إلى الناكل لنكوله، مما قد يولد في قلبه الضغن والنية السيئة ـ بدلاً من هذا يبعث إلى العمل عن طريق المنافسة، فحين يسمع الثناء على ذوي البلاء الحسن من أقرانه، وحين يرى أن العمل يجد صدى مستحباً عند الرئيس يعبر عنه بالتقدير، يندفع إلى العمل بباعث نفسي فيجد فيه متعة ولذة يدفعانه إلى إتقانه، بدل أن يزاوله مكرهاً، لو دفع إليه عن طريق اللوم فلا يجد فيه لذة ولا يشعر نحوه بأي سرور نفسي يدفعه إلى التجويد والإتقان.
وعلى الحاكم أن يكون يقظاً في تتبع أفعالهم، فينسب الفعل إلى صاحبه، ولا يتجاوز به إلى غيره، ولا يقصر في جزائه، فإن غفلته عنهم تشعرهم بأن أعمالهم لا تجد ثوابها الحق، ولا تلقى التقدير الذي تستحق.
قال (ع):
«ثم أعرف لكل امرىء منهم ما أبلى، ولا تضيفن بلاء امرىء إلى غيره، ولا تقصر به دون غاية بلائه».
والمقياس في الجزاء والثواب وحسن الأحدوثة نفس العمل، لا السلالة ولا الغنى ولا أي شيء آخر.
قال (ع):
«ولا يدعونك شرف امرىء إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراً ولا ضعة امرىء إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيماً».
والمشاركة الوجدانية من الأمور التي يجب توفرها بين القائد وجنوده. فحينما تتوفر المشاركة الوجدانية بين القائد وجنوده ويشعرون بأنهم ليسوا تحت سلطان جبار يسومهم العذاب ويتخذهم سبلاً إلى إظهار سلطانه ووسائل لخدمة مآربه، وإنما هم تحت رعاية أب بار يعمل لخيرهم، ويسعى لإسعادهم، ويجدب عليهم، ويرأف بهم، ويوجههم نحو ما فيه صلاحهم… حينما يستقر في أعماقهم هذا الشعور يعملون بإخلاص وإتقان وحرارة وإيمان، ويقبلون على عملهم بشوق رغبةً منهم في إبهاج قائدهم وإشاعة الزهو والفرح في قلبه، فإن القائد بجنوده، وكلما كان عملهم رائعاً ومتقناً دلّ ذلك على حسن توجيهه وواسع خبرته وعظيم معرفته. وليس يخاف ما يعود به هذا على الدولة من القوة والتماسك.
وكما أن المحبة والعطف والخلق الحسن شروط لازمة في حصول هذا الشعور عند الجنود فإن تأمين الناحية الاقتصادية شرط لازم أيضاً. فلا يسع جندياً أن يخلص لعمله وهو يسمع، بقلبه، صراخ زوجته وأطفاله من الجوع أو العري أو المرض، لذلك أرشد الإمام الحاكم إلى أن طبقة العسكريين يجب أن تتألف ممن يولون كلا الناحيتين: الاقتصادية والمعنوية عظيم اهتمامهم، وأن خير قواده خيرهم لجنوده، وأحدبهم عليهم، وأرفقهم بهم، وأرعاهم لشؤونهم في السراء والضراء، فإن هذا هو السبيل الوحيد إلى توليد هذه المشاركة الوجدانية التي تعود على الدولة بأجل الفوائد وأعظم الخيرات.
القضاة
وإن الإمام (ع) ليقدر هذه السلطة حق قدرها، فيختم وصاياه إلى عامله فيما يتعلق بها بقوله:
«… فانظر في ذلك نظراً بليغاً، فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى، وتطلب به الدنيا».
وهذا ما لم نشاهد منه في غير هذه الطبقة من الطبقات التي يتألف منها جهاز الحكم، مما يدل على أنه كان يعي كيف أن القضاء حين يصير إلى غير أهله ينقلب إلى أداة للظلم: ظلم الضعفاء، ويصير مؤسسة ترعى مصالح الأقوياء فحسب.
وقد تحدث كثيراً عن هؤلاء الذين يتسنمون مناصب القضاء وليسوا لها بأهل، فيتحولون بهذا المنصب إلى أداة للشر والإفساد.
قال (ع):
«.. وآخر قد تسمى عالماً وليس به، فاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل من ضلال، ونصب للناس شركاً من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، وعطف الحق على أهوائه يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع. ويقول: واعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان».
وقال (ع):
«.. ورجل قمش جهلاً، موضع في جهال الأمة، عادٍ في أغبش الفتنة، عمٍ بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالماً وليس به، بكر فاستكثر من جمع، ما قلّ منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن، واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشواً رثاً من رأيه، ثم قطع به، فهو من لَبْسِ الشبهات في مثل نسج العنكبوت».
ولأجل تفادي هذا المصير السيىء لسلطة القضاء، وضع (ع) نظاماً يجب أن يتبع في تأليف هذه الطبقة، يضمن أن تكون على مستوى عال من الكفاءات المناطة بها.
تؤتى السلطة القضائية من ناحيتين، الأولى: ناحية القاضي نفسه فإذا كان غير كفء لمنصبه أسفّ بهذا المنصب، ولم يؤد حقه المفروض. والثانية: ناحية المنصب نفسه، فما لم يكن مستقلاً في حكمه لا يخضع لتأثير هذا وإرادة ذاك، لم تكن هناك سلطة قضائية بالمعنى الصحيح، وإنما تكون السلطة القضائية حينئذٍ أداة لإلباس رأي فلان ثوب الحق وإسباغ مسحة الباطل على دعوى فلان. ولا تؤتى السلطة القضائية من غير هاتين الناحيتين.
وقد رسم الإمام في عهده إلى الأشتر ثلاثة أمور ينبغي أن تتبع في انتقاء أفراد هذه الطبقة ومعاملتهم، واتباع هذه الأمور يكفل لهم أن يمارسوا مهمتهم بحرية، وأن يؤدوا هذه المهمة بإخلاص.
هل يكفي في صلاحية الرجل للقضاء أن يكون على معرفة بمواد القانون الذي يقضي به دون اعتبار لتوفر ميزات أخرى فيه؟
إن الجواب السديد على هذا السؤال هو النفي، فلا يكفي في القاضي أن يكون على علم بمواد القانون فحسب، لأنه إذا لم تتوفر فيه غير هذه الصفة يكون عالماً بالقانون، ولا يصلح أن يكون قاضياً، لأن منصب القضاء يتطلب من شاغله، إلى جانب علمه بالشريعة، صفات أخرى فصّلها الإمام في عهده، وأناط اختيار طبقة القضاة بتوفرها، وهذا يعني أن فاقدها ليس جديراً بهذا المنصب الخطير.
يجب أن يكون القاضي واسع الصدر كريم الخلق، وذلك لأن منصبه يقتضيه أن يخالط صنوفاً من الناس وألواناً من الخلق، ولا يستقيم له أن يؤدي مهمته على وجهها إلا إذا كان على مستوى أخلاقي عالٍ يمسكه عن التورط فيما لا تحمد عقباه.
ويجب أن يكون من الورع وتأصل العقيدة، والوعي لخطورة مهمته وقيمة كلمته، بحيث يرجع عن الباطل إذا تبين له أنه حاد عن شريعة العدل في حكمه، ولم يصبها اجتهاده، ولم يؤده إليها نظره، فلا يمضي حكماً تبين له خطأه خشية قالة الناس.
ويجب أن يكون من شرف النفس، ونقاء الجيب، وطهر الضمير، بحيث «لا تشرف نفسه على طمع» في حظوة أو كرامة أو مال، فضلاً عن أن يتأصل فيه الطمع ويدفعه إلى تحقيق موضوعه، وذلك لأن القاضي يجب أن يجلس للحكم ضميراً نقياً، وروحاً طاهراً، وعقلاً صافياً، ونفساً متعالية عن مسافّ الأغراض، وألا يشغل نفسه بعرض من أعراض الدنيا لأن ذلك ربما انحرف به من حيث لا يدري فأدان من له الحق، وبرأ من عليه الحق. لتأثره بهاجس نفسه، وهاتف قلبه، ومطمح هواه.
ويجب أن يكون من الوعي لمهمته بحيث لا يعجل في الحكم، ولا يسرع في إبرامه، وإنما عليه أن يمضي في دراسة القضية ويقتلها بحثاً ويستعرض وجوهها المختلفة، فإن ذلك أحرى أن يهديه إلى وجه الحق وسنة الصواب، فإذا ما استغلق الأمر واشتبه عليه فلا يجوز له أن يلفق للقضية حكماً من عند نفسه، وإنما عليه أن يقف حتى ينكشف له ما غمض عنه، وينجلي له ما اشتبه عليه.
هذه الصفات يجب أن تتوفر في القاضي، ويجب أن يناط اختيار الرجل لمنصب القضاء بما إذا توفرت فيه، وبذلك يضمن الحاكم ألا يشغل منصب القضاء إلا الأكفاء في عملهم، ودينهم، وبصرهم بالأمور.
قال (ع):
«ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك: ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصوم، وأصبهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء.
وهنا، كما في كل موطن، يضع الإمام بين عينيه التأمين الاقتصادي ليضمن الاستقامة والعدل وحسن السيرة.
فالقاضي مهما كان من سموّ الخلق، وعلو النفس، وطهارة الضمير، إنسان من الناس يجوز عليه أن يطمع في المزيد من المال، والمزيد من الرفاهية، وإذا جاز عليه هذا جاز عليه أن ينحرف في ساعة من ساعات الضعف الإنساني فتدفعه الحاجة إلى قبول الرشوة، ويدفعه العدم إلى الضعف أمام الإغراء، وإذا جاز عليه ذلك أصبحت حقوق الناس في خطر، فلا سبيل للمظلوم إلى الانتصاف من الظالم وتغدو الحكومة حكومة الأقوياء والأغنياء.
هذه أمور قدرها الإمام حق قدرها، وأدرك مدى خطرها، فوضع الضمانات لتلافيها. وذلك يكون أولاً: بأن يتعاهد الحاكم قضاء قاضيه وينظر فيما أصدره من الأحكام، فإن ذلك كفيل بأن يمسك القاضي عن الانحراف، ويستقيم به على السنن الواضحة لأنه حينئذٍ يعلم أن المراقبة ستكشف أمر الحكم الجائر، ووراء ذلك ما وراءه من عار الدنيا وعذاب الآخرة. وثانياً: بأن يعطي المزيد من المال لينقطع داعي الطمع من نفسه فيجلس للقضاء وليس في ذهنه شيء من أحلام الثروة والمال.
قال (ع):
«… ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس».
والقاضي، بعد، إنسان يخاف: يخاف على ماله أن ينهب، ويخاف على مكانته أن تذهب ويخاف على كرامته أن تُنال، ويخاف على حياته أن يعتدي عليها بعض من حكم عليهم من الأقوياء، فإذا لم تكن لديه ضمانات تؤمنه كل ذلك اضطره الخوف إلى أن يصانع القوي لقوته، والشرير لشره، وحينئذٍ يطبق القانون من جهة واحدة. يطبق على الفقراء والضعفاء الذين يؤمن جانبهم.
هذا الخوف ينشأ من عدم تأمين مركز القضاء وصيانته ضد الشفاعات وينشأ من زجه في المساومات السياسية وغيرها، وحينئذٍ تكفي كلمة من قوي أو غني لسلب القاضي مركزه ومكانته.
هذه الناحية وعاها الإمام (ع) وأعد لها علاجها، فيجب أن يكون القاضي، لكي يأمن ذلك كله، من الحاكم بمكانة لا يطمع فيها أحد غيره، ولا تتاح لأحد سواه، وبذلك يأمن دسَّ الرجال له عند الحاكم، ويثق بمركزه وبنفسه، وتكسبه منزلته هذه رهبة في قلوب الأشرار يقوى بها على حملهم على الحق وردهم إليه حين ينحرفون عنه ويتمردون عليه.
قال (ع):
«… وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظراً بليغاً، فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى، وتطلب به الدنيا».
هذه هي الضمانات الثلاثة التي وضعها الإمام (ع)، مبيناً فيها النهج الذي يحسن أن يتبع في انتخاب أفراد هذه الطبقة، وشارحاً كيفية معاملتهم ليؤدوا مهمتهم على نحو نموذجي.
وقد سجل الإمام بما شرعه هنا سبقاً عظيماً على إنسان اليوم، وذلك لأن استقلال مركز القضاء وعدم تأثره بأي سلطة أخرى، وتأمين الناحية الاقتصادية للقاضي، ونظام التفتيش القضائي، جهات تنبه لها الإمام وجعلها واقعاً يخلف في حياة المجتمع آثاره الخيرة، في عصر كانت سلطة القضاء أداة يدبره الحاكمون والمتسلطون كما يحبون.
ولا شيء ادعى إلى ثقة الناس بالقضاء من نفوذ حكم القاضي على جميع الناس، حتى على من تربطهم بالحاكم الأعلى قرابة قريبة أو صداقة حميمة، فإنَّ ذلك خليق بأن يطمئن الرجل العادي، ويدخل في روعه أنه حينما يدخل مجلس القضاء لا يواجه بنظرة احتقار. وإن الحاكم الأعلى لأحرى الناس بالمحافظة على ذلك والحرص عليه، فإذا ما اعتدى بعض خاصته على بعض الناس وجب عليه أن يرده إلى الحق حين يروغ عنه، ويرده إلى الجادة حين يؤثر العصيان.
قال (ع):
«وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، وكن في ذلك صابراً محتسباً، واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغ عاقبة ذلك بما يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك محمودة».
الولاة
إنهم رجال الإدارة، وأيدي الحاكم التي تمتد في أطراف بلاده، والأداة التي يستعين بها على تنفيذ أمره وإمضاء ما يريد إمضاءه من الشؤون. وهم المرآة التي ينظر بها الرعية إليه، وأعمالهم تنسب إليه وتحمل عليه، ويناله خيرها وشرها.
والوجدان الطبقي لهذه الطبقة ينزع بها نحو التسلط الناشىء من تصورات القوة والهيبة والنفوذ، ويصبح هذا الوجدان خطراً وبيلاً إذا عبّر عن نفسه في غير موضعه، وجرى في غير أقنيته.
لهذا وذاك، لمكان الخطر فيهم، ومبلغ الفائدة منهم، احتاط لهم الإمام واحتاط منهم، فوضع الشروط التي ينتخبون على أساسها، والطريقة التي يعاملون بها، و«الكوابح» التي تمنعهم عن أي يسيئوا سلطانهم وأن يخرجوا به عما أنشى لأجله من منفعة الرعية إلى استغلاله في سبيل المنافع الخاصة والمصالح الشخصية.
لا يدخل في هذه الطبقة كل من شاء له الحاكم أن يدخل وإنما يدخل فيها من خبر المجتمع عن كثب، فعرف حاجاته، وتبين نقائصه، فإنسان كهذا إذا ولي عملاً مضى فيه على بصيرة، فلا يرتجل الخطط ارتجالاً دون أن يعي حاجات المجتمع، ويلبي في خططه ومناهجه هذه الحاجات.
وإلى جانب التجربة والخبرة العملية يجب أن يتوفر له مستوى عال من الأخلاق، فهو كما قلنا، المرآة التي ينظر بها الشعب إلى الحاكم، ولذلك فينبغي أن يكون على خلق رفيع يمسكه عن الشطط ومجانبة العدل، ويستقيم به على الجادّة، ويؤم به قصد السبيل. فالحياء خلق يجب أن يتوفر فيه، والحياء هنا ليس على معناه المبتذل وإنما هو الحياء من النفس… من تلويثها بالظلم والعدوان والتهاون في القيام بالواجب، وهذا الخلق يدفع بصاحبه دائماً إلى التعالي والتسامي. ويجب أن تتوفر فيه صفة القناعة بأن لا يلوث نفسه برذيلة الطمع التي توشك أن تنقلب إلى حقيقة خارجية حين تجد لها محلاً في نفس الإنسان، وصدى في تصوراته.
وإلى جانب هذه الميزات يجب أن يجمع بعد النظر، وأصالة الفكر، وجودة الفهم، فهذه الصفات ضرورية لمن أنيط به أمر جماعة من الناس واعتبر مسؤولاً عن أمنهم ونشاطهم الاجتماعي.
ولم يكن في زمن الإمام (ع) مدارس تعدّ الموظفين الإداريين وتلقنهم الثقافة الإدارية، لذلك أرشد الإمام الحاكم إلى اختيار هؤلاء من بين أبناء الأسر المحافظة على التقاليد، الآخذة أبنائها بطراز عال من التربية، العاملة على تنشئتهم تنشئة نموذجية.
قال (ع):
«… وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقاً وأصح أعراضاً، وأقل في المطامع إسرافاً، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً».
ويخضع هؤلاء الولاة في ولاياتهم للاختبار، فحين ينتقيهم الحاكم ممن توفرت فيهم الشروط السابقة يجب عليه أن يوليهم اختباراً، فيرى، وقد عرف نظرياً مدى كفاءاتهم، إلى كفاءاتهم في المجال العملي، فإذا أثبتوا أنهم أكفاء حقاً، وأنهم يعون مسؤوليات عملهم وآلياته ثبتوا وإلا عزلوا، واستبدل بهم غيرهم. لهذا المبدأ، مبدأ الاختبار، يجب أن يخضع اختيار الولاة، أما أن يوليهم الأعمال تحبباً إليهم، ودون أن يستشير في أمرهم، ودون أن يعرف مدى كفاءاتهم، فذلك جور عن الحق، وانحراف عن الجادة، وخيانة للأمة في مصالحها، فإن مصالح الأمة أمانة في يد الحاكم يجب أن يسلمها إلى أكفاء ولاته.
ومن هنا نعلم أن القوانين الحديثة التي تنص على وجوب خضوع الموظف الإداري الحديث العهد بالوظيفة لفترة اختبار تطول وتقصر، لم تأت بجديد، فقد أدرك الإمام بقرون وقرون هذه الحقيقة وسجلها في قانونه العظيم.
قال (ع):
«ثم انظر في أمور عمالك فولَّهم اختباراً، ولا تولهم محاباة وأثرة، فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة».
وليس يكفي في حسن الظن بهم والركون إليهم مراعاة الدقة في انتخابهم، فإن الوجدان الطبقي لهؤلاء ينزع بهم نحو التسلط وإظهار القوة وحين يجري هذا الوجدان في غير أقنيته يصير خطراً على الرعية، لأنه يدفع صاحبه حينئذٍ إلى الانحراف والزيغ.
لأجل هذا يقرر الإمام أن على الحاكم ألا يغفل عن تعقب هذه الطبقة ومراقبتها، فيلزمه بانتخاب رقباء من أهل الدين والمعرفة والأمانة يبثهم في أطراف البلاد، ويجعلهم عيوناً له على عماله، يراقبونهم في أعمالهم. ويرصدون مبلغ ما يتمتع به هؤلاء الولاة من خبرة في الإدارة، وقدرة على التنظيم، ومعرفة بوجوه الإصلاح، ثم يرفعون ذلك كله إلى الحاكم فينكل بالمنحرف الذي خان أمانته، ويستأديه ما حاز لنفسه من أموال المسلمين، ويجعله عبرة لغيره. ويشجع الصالح في نفسه، الصالح في عمله. ويرشد المخطىء إلى وجه الصواب.
إن هذا التدبير يمسك الوالي عن الإسراف، ويحمله على العدل في الرعية. لأنه حين يعلم أن ثمة عيناً ترقب أفعاله يحذر من الخروج عن الجادة، ويحرص على اتباع ما يصلح بلاده. وهذا التدبير الذي نهجه الإمام هو نظام التفتيش المعمول به في أربعة أنحاء المعمورة.
قال (ع):
«… ثم تفقد أعماله، وابعث العيون من أهل الصدق والأمانة عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة، والرفق بالرعية. وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلة، ووسمته بالخيانة، وقلدته عار التهمة».
ولقد كان الإمام (ع) يحرص أشد الحرص على اتباع هذا الأسلوب مع ولاته، ففي نهج البلاغة طائفة كبيرة من كتبه إلى عماله تدور كلها حول هذا المعنى، فيها تنديد بخيانة، وعزل عن ولاية، وزجر عن ظلم الرعية، وفيها توجيه وإرشاد ونصيحة.
قال (ع):
«… وإن عملك ليس لك بطعمة، ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك، ليس لك أن تفتات في رعية، ولا تخاطر إلا بوثيقة، وفي يديك مال من مال الله عز وجل، وأنت من خزانه حتى تسلمه إليّ».
وقال:
«بلغني عنك أمر أن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك، وأغضبت إمامك: أنك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم، وأريقت عليه دماؤهم، فيمن أعتامك من أعراب قومك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لئن كان ذلك حقاً لتجدن بك عليّ هواناً، ولتخفن عندي ميزاناً».
وقد كانت شرور هذه الطبقة هي التي سببت الثورة على عثمان، فقد ولّى على البلاد الأحداث من ذوي قرابته، ممن لا خبرة لهم في الحكم، ولا عاصم لهم من دين، ولا ورع لهم عن المحارم، فظلموا الرعية، وامتصوا دمائها، وكانت عاقبة ذلك وبالاً.
وعلى النقيض من هذا كانت سياسة الإمام مع ولاته، فهو ينتخبهم انتخاباً، ثم يوليهم اختباراً ثم يراقبهم، ويحملهم على الإصلاح ما وجد إلى ذلك سبيلاً.
والعامل الاقتصادي أداة يستخدمها الإمام هنا ـ كما في كل موطن ـ لأجل ضمان استقامة الولاة على ما سنّه لهم من شرائع العدل. ولذلك لم يغفل الإمام (ع) ما للعامل الاقتصادي من عظيم الأثر في إصلاح هذه الطبقة وإفسادها، فقد تدفع الحاجة أحدهم إلى الخيانة والظلم، وهم ـ كما عبر عنهم الإمام في بعض كتبه ـ: «خزان الرعية، ووكلاء الأمة، وسفراء الأئمة». فلو ضيق عليهم الحاكم في الرزق، ولم يرفِّه عليهم في النعمة، كان حرمانهم مدعاة إلى أن تطمح أعينهم إلى ما ائتمنوا عليه من مال، وذلك داعية الى الرغبة في الخيانة، واختلاس شيء من أموال الأمة.
لهذا أشار الإمام على حاكم مصر بأن يوسع على الولاة في الرزق، لئلا يتخذوا الحاجة مبرراً للخيانة.
قال (ع):
«ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوك، وثلموا أمانتك».
الكتّاب
الكتاب وأعوانهم هم الهيئة الوزارية ووكلاؤها، ومديروها. وإلى هذه الطائفة يرجع أمر الدولة كله: سلمها، وحربها، واقتصادها، وكل ما يلمّ به من خير أو شر. فهي الجهاز الأعلى الذي ينظم النشاط الاجتماعي، ويشرف على توجيهه. وعلى قدر ما تكون عليه هذه الطائفة من الصلاح والاستقامة، تصلح الدولة، وتستقيم ويعظم شأنها.
وقد نص الإمام (ع) في عهده على من يصلح أن يلحق بهذه الطائفة ومن لا يصلح لذلك، وأفاض في ذكر الصفات التي يجب أن تتوفر في الوزير، وبين الأسلوب الذي يحسن بالحاكم أن يتبعه في الأخذ منه والسماع عنه.
من جملة ما قدمناه بين يدي هذا البحث ملاحظة ذكرنا فيها أن الإمام كتب هذا العهد وهو يطمح إلى إنشاء جهاز جديد للحكم في مصر، جهاز واعٍ لمسؤولياته، تقدمي في برامجه ومشروعاته، ليستجيب للحاجات التي يفتقر إليها المجتمع. وقد رأيناه في البحوث المتقدمة محافظاً على هذه السمة في عهده، فهو دائماً يؤكد أن جهاز الحكم يجب أن يكون سليماً، واعياً، تقدمياً، عاملاً لمصلحة المجتمع.
وها هو، بالنسبة إلى طائفة الوزارة ومن يتعلق بهم، ينص على هذا المعنى ويؤكده تأكيداً وافياً.
فلا يجوز أن يدخل في هذه الطبقة رجال كانوا وزراء للظلمة والأشرار وذلك لأن تأليف هذه الطبقة من هؤلاء يستتبع عواقب وخيمة تعود بالضرر على الدولة. فهم، وقد استمرؤوا فعل الظلم وتعودوا على مقارفته لا يعفّون عن العودة إليه والارتكاس فيه. وإذا كانوا ذوي أنفس شريرة مست أعمالهم المجتمع كله نظراً إلى سعة سلطانهم، وعظيم قدرتهم، لأن ملاك القوى كلها مجتمع عندهم. وضرر آخر ينجم عن دخولهم في هذه الطبقة، فالشعب الذي عرفهم بالجور، وذاق منهم مرّ الظلم تذهب ثقته بالحكم المهيمن عليه حين يراهم قد عادوا إلى مراكزهم، ويعتبره حكماً أقيم لمصلحة طبقة خاصة، ومتى ذهب إيمان الشعب بحاكميه أهمل من حقوق الحاكمين عليه ما يجب أن يؤديه، لاعتقاده أنه حين يلبيهم فيما يطلبون لا يقوم بعمل يعود بالنفع عليه.
وقد أصبح من المعطيات البديهية في علم الاجتماع أن ما يثير الشعوب ليس الظلم نفسه وإنما الشعور بالظلم، وسيطرة أشخاص مثل هؤلاء على دفة الحكم يوقظ في الشعب تصورات الظلم الذي ذاقه على أيديهم في عهودهم السابقة، وهذا كاف لأن يولد في نفسه الشعور بالظلم وإن لم يكونوا ظالمين: وهكذا تحدث بين الحاكم والمحكوم هوّة تبعد أحدهما عن الآخر، وتسلب ثقة كل منهما بالآخر، وفي بعض ذلك ما يجر الدولة إلى مصير وبيل.
قال (ع):
«إن شرّ وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأئمة، وإخوان الظلمة».
ولا يجوز أن يناط اختيار أفراد هذه الطبقة بالفراسة وحسن الظن فإن الرجال يتصنعون الصلاح، ويتظاهرون بالمقدرة والأمانة، ليظفروا بمثل هذا المنصب، فيخدعون الفراسة، وينتزعون حسن الظن بتصنعهم دون أن يكونوا على شيء من الصلاح والكفاءة.
إن اختيار أفراد هذه الطبقة يجب أن تلاحظ فيه اعتبارات متعددة.
يجب أن يكونوا على معرفة تامة بمحيطهم وبحاجاته، ليصدروا في إدارته عن وعي.
ويجب أن يكونوا إلى جانب المعرفة أكفاء، ذوي مقدرة على تصريف ما أنيط بهم من أمور.
ويجب أن يكونوا إلى جانب هذا وذاك ـ ممن يعرفهم الشعب بالحب له، والحدب عليه، ورعاية مصالحه وتيسير حاجاته، والسهر على رفاهيته وسعادته، فإن هذه الطبقة حين تتألف من مثل هؤلاء يطمئن الشعب إلى الحكم ويستريح إلى أعمال الحاكم([370]).
ويعرف ذلك كله بالنظر إلى سابق ما ولوه من أعمال الصالحين من الحكام: هل أحسنوا إدارته؟ وهل برهنوا فيه على دراية بأساليب الإصلاح؟ وهل كانت للشعب فيهم ثقة؟ فإذا اجتمعت فيهم هذه الصفات: من قدرتهم وكفائتهم، إلى معرفتهم بمحيطهم، إلى حب الشعب لهم، وإيمانه بهم، حقَّ لهم أن يدخلوا في هذه الطائفة، وحق على الحاكم أن يؤلفها منهم.
قال (ع):
«.. ثم لا يكن اختبارك إياهم على فراستك واستنامتك، وحسن الظن منك، فإن الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم، وحسن خدمتهم، وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة، شيء، ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك: فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثراً، وأعرفهم بالأمانة وجهاً، فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره».
لم يكن مبدأ انفصال السلطات الثلاث: «التشريعية والتنفيذية، والقضائية» مبدأ معترفاً به في الدولة الإسلامية. بل لم يكن للدولة للإسلامية في عهودها الأولى وزارة بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ. لقد كانت السلطات كلها تتجمع في يد الحاكم الأعلى، فهو المرجع الأول والأخير في كافة الشؤون.
ولا أحسب أن دولة في عالم اليوم لا تأخذ بمبدأ فصل السلطات، أما حقيقة أو ظاهراً، وحجة فلاسفة الحكم على رجحان هذا المبدأ هي أن تركه يؤدي إلى تجمع السلطات كلها في يد واحدة، وذلك يجر إلى طغيان الفرد. أما حين تنفصل السلطات فلا يمكن أن يحصل الطغيان لأن كل واحد ممن يملكون سلطة معينة يترك الطغيان خشية أن تعارضه السلطات الأخرى.
ونقول: إن هذا المبدأ قد يكون معقولاً حين يكون القانون الذي تسير عليه سلطتا التنفيذ والقضاء قانوناً وضعياً يمكن أن يكون المتحكم في وضع مواده وتفسيرها هو الأهواء والشهوات وأما حين يكون القانون دينياً ليس لأي سلطة مهما بلغت من النفوذ والقوة أن تحرفه، وتتلاعب فيه وتجعله في صالح فريق من الناس دون آخرين وحين يكون هذا القانون معروف الحدود مفصل المواد فلا ضرورة تدعو إلى فصل السلطات لأن أي انحراف عنه يعرف فيعزل المنحرف ويقوّم الشاذ([371]).
على أن هذا لا يمكن أن يأخذ به على إطلاقه: أي كلما كان القانون وضعياً وجب اتباع مبدأ فصل السلطات وذلك لأن الحاكم الأعلى إذا كان عادلاً وكفواً لم يعد تجمع السلطات في يده بأي ضرر لأن الطغيان ـ وهو المحذور الذي من أجله وضع هذا المبدأ ـ مأمون من قبل إنسان كهذا ولا يغني فصل السلطات شيئاً حين يكون القائمون عليها فاسدين وشريرين لأن هذا المبدأ لا يمنعهم من التعاون على الشر والطغيان وبدل أن يعتدي الحاكم على حقوق الناس ويعرف بالظلم والعدوان يمكنه هذا المبدأ من الاعتداء على حقوق الناس باسم القانون والمصلحة العامة وكلنا يعرف كيف تكون سلطات التشريع ـ وهي أعلى السلطات ـ في بعض البرلمانات مصدر المساومة على حقوق الشعب أو الجماعات أو الأفراد.
قدمت هذا الحديث لأخلص منه إلى القول بأن الظن يذهب ببعض الكتّاب إلى أن الإمام (ع) قد شرع في عهده إلى الأشتر مبدأ فصل السلطات في خلال حديثه عن الوزراء ويجعل ذلك مفخرة من مفاخر الإمام لأنه اهتدى إلى هذا المبدأ قبل فلاسفة الحكم في الغرب بمئات الأعوام.
وهذا وهم لا واقع له في كلام الإمام. فقد رأينا أولاً أن مبدأ فصل السلطات إذا صح في المجتمعات التي تحكم بقوانين وضعية فإنه لا يصح في المجتمعات التي تحكم بقوانين سماوية. وقد رأينا ثانياً أنه حتى في المجتمعات التي تحكم بقوانين وضعية لا يعود هذا المبدأ بالنفع المقصود منه في كثير من الأحوال. وثالثاً أن الإمام تكلم في هذا الموضع عن الوزارة والوزارة عبارة عن السلطة التنفيذية فكيف يشرع مبدأ فصل السلطات في داخل إحدى السلطات مع أن هذا المبدأ يجب أن يشرع في تشكيل الدولة العام؟ ورابعاً أنه هو لم يأخذ بهذا المبدأ في حكمه فيكف يأمر به أحد عماله؟
الذي أراه هو أن الإمام نظر فرأى أن طائفة الوزراء هي أعظم أجهزة الدولة أهمية، لأن جميع الشؤون تناط بها، وترجع إليها، وتصدر عنها، في السياسة والإدارة والحرب.
ولا يصح أن تناط هذه المهام بشخص واحد أو بمجموعة من الأشخاص، فإن الإحاطة بدقائق كل هذه المهام ومعرفة أسرارها لا تتاح في العادة للشخص الواحد، ولو أتيحت لواحد فأنيط به أمرها لما أحسن التصرف، ولوقع في الخطأ وسوء التدبير، لأن اضطلاعه بها يرهقه ويبهظه فأما أن يصرفها كلها فيقع في الخطأ، وينأى عنه بعد النظر وإصالة الرأي وسلامة التدبير. وأما أن يهمل بعضها ويصرف بعضها الآخر فيقع الاضطراب في أعمال الدولة بسبب إهماله.
وإن أنيطت المهام بجماعة من الناس دون تحديد المهمة الملقاة على عاتق كل منهم وقعت البلبلة وشاع الإهمال، فينقض أحدهم ما أبرمه الآخر، ويصرف أحدهم ما أمسكه صاحبه، ويمضي اثنان أمرين متضادين، ويهمل كل واحد منهم بعض المهمات اتكالاً على رفاقه.
فأحسن الوسائل لضمان سير أعمال الدولة على مستوى عال من حسن التدبير، وإصابة الهدف هو ما قرره الإمام (ع)، وهو أن يناط بكل واحد من هؤلاء الوزراء بعض مهمات الدولة ويراعى في إلحاق من اختير للوزارة لعمل من الأعمال أن يكون ذا اختصاص بذلك العمل وذا خبرة بدقائقه وأسراره ليؤدي ما استعصى منه على خير وجه.
قال (ع):
«واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. ومهما كان في كتّابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته».
وفي هذه الفقرة الأخيرة «ومهما يكن…» قرار الإمام أن الحاكم مسؤول عما يكون في وزرائه من العيوب، وذلك لأنه ـ وقد اختار ـ يجب أن يتحمل مسؤولية اختياره.
وعلى رأس هؤلاء جميعاً رئيسهم، وهو من يقال له (كاتب الكتّاب) ومهمة هذا الوزير هي الإشراف على من دونه من الوزراء، ومراقبة أعمالهم، ومهمته أيضاً هي تولي السياسية العليا للدولة مع الحاكم، فهو عضد الحاكم في رسم الخطط السياسية، وإعلان الحرب وعقد معاهدات الصلح، والتعرف على نيات من يخاف منهم على أمن الدولة وكيانها، فهو مع الحاكم الأعلى، العقلان اللذان يديران عملية الحكم كلها.
هذا الوزير يشترط فيه الإمام شروطاً لا يصلح بدونها:
فيجب أن يمتاز عن بقية الوزراء بأن يكون خيرهم، وذلك بأن يكون أكثر منهم إلماماً بشؤون الدولة وإمكاناتها، ليتسنى له أن يوجه كلاً منهم إذا انحرف، ويفهم عنه إذا قال.
ويجب أن يكون عارفاً بمركزه وأنه لا يخرج عن كونه وزيراً يستمد الصلاحية ممن استوزره، فلا تبطره الكرامة التي حصل عليها، فتدفعه إلى إشاعة خلافه مع الحاكم بين الناس، لأن ذلك يشعر الناس بأن في جهاز الحكم خللاً، وربما سبب شيوع ذلك تحفز المشاغب إلى إظهار شغبه اغتناماً لفرصة الانشقاق. إن الإمام يطلب مع الوزير أن لا يسلم بوجهة نظر الحاكم في كل ما يقول وإلا كان ببغاء ولم يكن وزيراً، أن عليه أن يجاهر برأيه حين يرى الحق في جانبه، ولكن ذلك يجب أن يبقى سراً بينه وبين الحاكم ولا يجوز أن يذاع في الناس.
ويجب أن يكون على وعي بحقيقة السياسة التي تسير عليها الدولة فيتبع في أوامره التي يصدرها إلى الولاة وفي مباحثاته السياسية هدى سياسة الدولة، ولا يغفل عنها فيلزم نفسه بما يتنافى وسياسة دولته التي يمثلها.
ويجب أن يكون عارفاً بأحابيل السياسة وألاعيبها، فيحافظ على التزامات الدولة السياسية التي تعود عليها بالنفع والقوة، ويعرف وجه الحيلة في إخراج الدولة من المآزق السياسية التي يكيدها بها أعداؤها.
ويجب أن يكون إلى جانب هذه جميعاً أجمع وزرائه لوجوه صالح الأخلاق، لأن المهام التي تناط به تتطلب قوة في الدين تمسكه على الجادة وشعوراً بالمسؤولية يحمله على الإخلاص والإتقان، وعفة تعصمه من الإغراء.
قال (ع):
«ثم انظر في حال كتّابك، فول على أمورك خيرهم. وأخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة فيجترىء بها عليك في حضرة ملأ، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك، وإصدار جواباتها على الصواب عنك، فيما يأخذ لك ويعطي عنك، ولا يضعف عقداً أعتقده لك، ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور، فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل».
وفي هذه الفقرة الأخيرة: «ولا يجهل..» يشترط الإمام في الوزير أن يكون واقعياً، ينظر إلى الأمور نظرة جدية، ويعرف واقعه تمام المعرفة، فإذا كان مركزه ضعيفاً احتاط لنفسه بما يحتاط به الضعيف ولا يهمل الاحتياط غروراً منه واستعلاء، وإذا كان قوي المركز وجب عليه أن يمثل دور القوي. ولا يهن أمام خصومه فيعطيهم من نفسه ما لو شاء لمنعه، ثم لا يلحقه من وراء ذلك شيء.
قلنا إن الوزير الذي يصوب كل ما يقوله الحاكم حتى إذا كان مخطئاً فيه ليس وزيراً وإنما هو ببغاء تقمصت أهاب وزير. وظيفة الوزير هي أن يتعاون مع الحاكم الأعلى على إدارة جهاز الحكم إدارة صحيحة، وعليه إذا أخطأ الحاكم في الرأي أن يرده إلى الصواب وعليهما أن يتعاونا على معرفة أصلح الوجوه فيما يأخذان ويدعان من الأمور، لذلك يجب أن يعطي الوزير حرية الرأي بحيث لا يقيده في هذا المجال شيء لأنه كل ما كان أوسع حرية عظمت فائدته، ويجب أن ينال الوزير من الحضوة بمقدار ما يكون صريحاً في رأيه، معالناً الحاكم بالحق راداً له إلى الصواب فكلما ازداد قولاً بالحق وإيثاراً للصدق ازداد كرامة ورفعة. وأما حين يتبين الوزير في الحاكم أنه لا يطلب النصح وإنما يطلب الموافقة على رأيه فقط فإنه ينقلب إلى ببغاء، وحينئذٍ يسير الحاكم بالدولة معصوب العينين لأن أحداً لا يجرؤ أن يقول في وجهه كلمة الحق.
قال (ع):
«وليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعاً ذلك من هواك حيث وقع… ثم رضهم على ألا يطروك، ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة».
الزرّاع
هذه الطبقة من أعظم الطبقات الاجتماعية وأبلغها أثراً في حياة المجتمع.
ففي زمان الإمام (ع) كانت هذه الطبقة أضخم الطبقات الاجتماعية، وكانت مركز الكثافة في المجتمع، كما أن مركز الكثافة فيه هي طبقة العمال في العصر الحديث.
وكانت المجتمعات القديمة مجتمعات زراعية في الدرجة الأولى، فكان كيان الأمة الاقتصادي يقوم على الأرض ومنتجاتها، لأن الصناعة لم تكن إذ ذاك على حال تسمح بأن يقوم عليها الصرح الاقتصادي للأمة، لضعفها وضيق نطاقها. ولم تكن التجارة وحدها كذلك لتسمح بإقامة هذا الصرح في كثير من البلدان، لعدم انتظام التجارة العالمية إذ ذاك ولضعف المواصلات، ولعدم وجود طرق تجارية كافية ومأمونة في جميع الأوقات.
إذن فقد كان الكيان الاقتصادي يقوم في الدرجة الأولى على الأرض ومنتجاتها، والرفاهية الاقتصادية منوطة بأن تتاح للأرض أفضل الفرص التي تمكنها من أن تعطي عطاء كثيراً، ومنوطة بأن تتاح للزارع أفضل الوسائل التي تعينه على صيانة أرضه، وخدمتها، والحصول منها على نتاج وفير.
وقد برهن الإمام (ع) في عهده إلى الأشتر أنه على وعي تام لمدى أهمية هذه الطبقة في الكيان الاجتماعي، ثم للعمليات الاجتماعية التي يعتبر نشاط هذه الطبقة ضرورياً لاستمرارها.
يقرر الإمام (ع) أن النشاط الاقتصادي كله يتوقف على ما يدفعه أهل الخراج من الأموال. فسكان المدن على أقسام: الجنود المقاتلة، وأصحاب الحرف والصناع، وأصحاب التجارات، والذين لا يستطيعون عملاً يرتزقون منه، أو لديهم أعمال لا يكفيهم ريعها. ويوزع قسم كبير من أموال الخراج على الجنود، وعلى الفقراء، وعلى من لا يكفيه عمله من ذوي الأعمال. وبهذه القوة الشرائية التي يحدثها هذا المال تستمر العمليات الاجتماعية، فتنشط حركة التجارة والصناعة، لأن في أهل المدن حاجة إلى الطعام والكساء والآنية والوقود وغيرها. يحصلون عليها من التجارة والصناع والعمال، وبهؤلاء حاجة إلى الزراع فيشترون منهم المواد الحيوانية والنباتية وغيرها، لأجل أن يلبوا حاجات المدن المتجددة، وبالزراع حاجة إلى الكساء والآنية والسلاح وما إليها، فيحصلون بهذا المال الذي يصير إليهم على ما يريدون.
وهكذا يتوقف ازدهار النشاط الاقتصادي على طبقة الزراع، وإذن فاضطراب أمور هذه الطبقة لن يعود عليها بالضرر وحدها، وإنما يمتد بآثاره الضارة إلى المجتمع كله، فيشل نشاطه، ويؤدي به إلى أزمات اقتصادية حادة ينجم منها التفسخ الاجتماعي.
قال (ع):
«وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس عيال على الخراج وأهله».
وتعتمد هذه الطبقة اعتماداً مطلقاً على الأرض، وعلى العناصر الطبيعية، وعلى سواعدها.
فيجب أن تصان الأرض لتبقى في حالة جيدة، ولتستفيد من العناصر الطبيعية إلى أقصى مقدار ممكن، فيجب أن تشق الترع، وتبني القناطر والسدود، وتحفر الآبار، لتتوفر للأرض حاجاتها من المياه وينتظم نظام الري، ويجب شق الطرق الزراعية التي تمكن هذه الطبقة من الاتصال ببعضها، وتسهل قضاء المهام الزراعية والاستعانة بالعمال الزراعيين.
وصيانة الأرض ليست أمراً يعود بالنفع على هذه الطبقة وحدها، وإنما يعود بالنفع على الدولة كلها، فقد رأينا ما لنشاط طبقة الفلاحين من تغلغل حيوي في العمليات الاجتماعية، فصيانة الأرض والحال هذه من المصالح العامة، فيجب الإنفاق عليها من الأموال العامة.
فأما حين تهتم الحكومة بالجباية فقط وتهمل أمر الإصلاح والعمارة حين تتجه هذا المتجه يصير بها الأمر إلى أن تخرب البلاد وتهلك العباد ثم لا تجد مورداً تجبي منه المال لعدم وجود إنتاج صحيح، لأن الخراج كثرة وقلة متصل بحالة الأرض، فعلى مقدار ما تأخذ الأرض تعطي وعلى مقدار ما تعطي تكون قدرة أهلها على إجابة الحاكم إلى أداء ما يفرضه عليهم من خراج.
قال (ع):
«… وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله… وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً».
وطبقة الفلاحين أكثر الطبقات كدحاً، وأشقها عملاً، فعند من عداهم من الطبقات والطوائف وقت مخصص من اليوم للعمل، وأوقات أخرى للراحة والتسلية، بخلاف الفلاحين فإن عملهم يمتد طول اليوم، وعلى مدار العام. وهذا العمل أما في مركز الإنتاج وهو الحقل، وأما في بيوتهم بإعداد البذار والآلات وما إليها. وحتى في الأوقات التي ينقطعون فيها عن العمل هنا وهناك لا ينقطعون عنه في أحاديثهم وتصوراتهم وطبيعة عملهم تفرض عليهم هذا اللون من الحياة، وهذا المقدار من الجهد فغيرهم من الناس يستطيع أن يتحكم بعمله فيختار الوقت الملائم لأدائه ثم ينقطع عنه، أما الفلاح فعمله ينحصر في مساعدة العناصر الطبيعية على أن تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل، فهو عبد لهذه العناصر وعليه أن يكون يقظاً دائماً ليعمل ما يجب عمله، ولما كان عمله متصلاً بهذه العناصر فإن أي تقصير منه يعود عليه بضرر كبير، لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الطبيعة البيولوجية ويسخرها حسب هواه.
هذا العمل المرهق يجب أن يقابله مستوى من المعيشة ومقدار من الدخل يشعران هذه الطبقة بأنها حين تعمل لا تستغل لصالح الآخرين وإنما تعمل لنفسها في الدرجة الأولى.
ويجب أن يشعر الفلاح بأنه سيد أرضه وأن لا أحد يمكن أن ينازعه في هذه السيادة.
وحيث كان من اللازم مراعاة حال الفلاح وتمكينه من أن يحيا على مستوى لا يشعر معه بالاضطهاد والاستغلال، وحيث كان من اللازم إشعاره بأنه سيد أرضه ـ لهذا وذاك يجب أن يكون مسموع الكلمة فيما يتصل بأرضه وبقدرتها على الإنتاج، فإذا اشتكى ثقل الخراج لعدم تناسبه مع إنتاج الأرض أو شكى آفة المّت بالأرض فأثرت على إنتاجها أو ذهبت به فلذلك لا يستطيع دفع ما فرض عليه من المال، إذا شكى شيئاً من هذا كان من اللازم أن يسمع كلامه فيوضع عنه من المال مقدار ما يصلحه.
وقد ذهب الظن بالبعض إلى أن هذه المعاملة تؤثر على مالية الدولة وتضعفها ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب، لأن هذه الوضعية التي يحصل عليها الفلاح تعود على الدولة نفسها بفوائد عظيمة تزيد في ازدهارها ورفاهيتها. وذلك لأن هذا المال يصرف في إصلاح الأرض وعمارتها، ويصرف في سد حاجات الفلاح نفسه من مسكنه وملبسه ومرافق حياته الأخرى فيكون في ذلك تزيين للبلاد بما أتاح لها هذا المال من العمران ويكون في ذلك شعور هذه الطبقة بالطمأنينة والرضى مما يدفعها وهي أكثر طبقات المجتمع عدداً وأعظمها إنتاجاً إلى المحافظة على الحكم القائم والدفاع عنه لأنه يحفظ لها مصالحها. ولدينا شاهد من التاريخ على هذا فقد كان نابليون الثالث (إمبراطور فرنسا) ممن حدبوا على هذه الطبقة ورعوا مصالحها، وحموها من عتاة الظلمة، وأشعروا الفلاح الفرنسي أنه سيد أرضه وأن أمرها منوط به وحده، وقد كان موقفة هذا مما دفع بالفلاحين إلى أن يخصوه بأصواتهم في الانتخابات دائماً لما لمسوه من رعايته لمصالحهم وفهمه لموقفهم.
وهذه النتيجة «عطفهم على الحكم القائم» مع عمران أرضهم تجعلهم على استعداد للمعونة حين تطلب منهم، لحسن ظنهم بالحكم القائم ورغبتهم في استمراره من جهة، ولأن حالهم المالية تسمح لهم بالمساعدة لوفرة الإنتاج.
فهذا المال الذي وضع زاد في عمران البلاد، ومن ثم زاد في إيرادها ومن ثم جعلها تحتمل من الضرائب فوق ما كانت تحتمل وهي أقل عمراناً، وحمل الفلاحين على حب الحكم القائم وبذل المعونة له حين يشكو العجز وتأييده حين يشكو الخذلان.
قال (ع):
«فإن شكوا ثقلاً أو علة، أو انقطاع بآلة، أو إحالة أرض اغتمرها غرق، أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك، وتزيين ولايتك، مع استجلابك حسن ثنائهم، وتبجحك باستفاضة العدل فيهم، معتمداً فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم، والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم، ورفقك بهم فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حملته».
ولهذه الفقرات وجوه أخرى من الدلالة، عظيمة القيمة، بالغة الأهمية فمن الشروط الأساسية لنجاح العمل وازدهاره أن يقبل العامل عليه بهمة ونشاط، وأن يشعر نحوه بالحب والرغبة. وأن يحس حين يزاوله أنه ينمي به شخصيته الإنسانية، ويؤكد قدرتها على الإبداع ـ إذا كان هذا هو موقف العامل النفسي من عمله ازدهر العمل وتقدم، ولا يمكن أن يقف العامل من عمله هذا الموقف إلا إذا شعر بأن عمله له، وبأنه يعود عليه بالنفع والفائدة.
ومن هنا اعتبرت الملكية الخاصة من أعظم الأسباب الدافعة إلى ازدهار العمل، لأن هذا اللون من الملكية يدفع العامل إلى بذل طاقته كلها مع شعوره بالسرور لأنه يعمل لنفسه.
ويتغير هذا الموقف حين يكون العمل للغير ولا يرجع إلى العامل من ثمراته شيء يذكر فإنه حين ذاك يشعر بالكراهية نحو عمله، ويتهاون فيه ولا يتحرى كماله واتقانه ويتحرى الفرص للتهرب منه وهذا يضعف سير العمل، ويهبط به، ويسري هذا الموقف النفسي إلى صاحب العمل نفسه فيتمنى العامل هلاكه، ليتخلص منه.
هذه الملاحظات تفيدنا هنا. فحينما توضع على الفلاحين الضرائب الفادحة التي لا تتناسب مع دخلهم، مع إهمال عمارة الأرض وصيانتها يشعر هؤلاء الفلاحون أنهم لا يعملون لأنفسهم ولا يجنون من وراء كدحهم المرهق شيئاً ذا قيمة وإنما يعملون لغيرهم، ويستغلون لهذا الغير استغلالاً بشعاً وذلك يلخق في نفوسهم كراهية عملهم والتذمر منه.
إن هذه المعاملة التي تحدث هذا الشعور وتدفع إلى هذا الموقف تخلف في المجتمع آثار ضارة قد تقوض المجتمع من أساسه.
هذه المعاملة تدفع بأضخم طبقة في الأمة إلى انحلال أخلاقي فظيع، فهذا الفلاح الذي يستغل الحاكم جهده دون أن يعوضه عليه شيئاً يريد أن يعيش، وهو يتوسل إلى غايته هذه بالكذب والغش والتهريب والسرقة فبدلاً من أن يعيش من أرضه بجهده يضطر إلى العيش من جيوب الآخرين بسلاحه، وينقلب قاطع طريق، مجرماً، عدواً للمجتمع، بعد أن كان المفروض فيه أن يكون لبنة تزيد صرح المجتمع قوة ومناعة.
ومن جملة آثارها أن تنتقل الأيدي الفتية الشابة إلى بلاد أخرى هرباً من الظلم، وطلباً للقمة العيش. فمن لم يصبر على الظلم أما أن يتحول إلى قاطع طريق وإما أن يهاجر، وهذا يسلب من البلاد زهرة شبابها، فإن الذين يهاجرون هم الأقوياء المغامرون، ذوي المستوى الأخلاقي العالي الذي يمنعهم من الإجرام. وإلام يؤدي هذا؟ أنه يؤدي إلى هبوط الإنتاج فهذه الأيدي الفتية هي التي تدير عمليته، وحين تنقطع عن العمل فلا بد من أن يصاب الإنتاج بالشلل.
ومن جملة آثارها أن تنتقل رؤوس الأموال الكبيرة إلى خارج البلاد، فإن أصحاب الثروات يستغلون أموالهم عن طريق الزراعة في المجتمعات الزراعية، فيعمرون الأرض، ويحيون مواتها، ويصلحون نظام الري، ويوجدون عملاً للكثيرين. ولكن غاية هؤلاء هي الربح، فإذا ما رأوا أن الضرائب والمظالم تذهب بثرواتهم فضلاً عن أرباحهم آثروا تجميد أموالهم أو نقلها إلى بلد آخر يأمنون فيه العدوان وينجم عن هذا تعطيل شبان كثيرين يتجهون إلى الهجرة أو إلى الإجرام، وتزيد البلاد خراباً. ويزيد الكيان الاقتصادي ضعفاً.
ومن جملة آثارها أن تتحد الأمة على بغض الحكم القائم، ثم لا تلبث أن تثور عليه وتجعله أثراً بعد عين.
هذه الكوارث الاجتماعية تنشأ من عدم التبصر في إمكانات الإنتاج وحالة المنتجين. وقد وضع الإمام (ع) من المبادىء ما يعصم أتباعه من التردي، فبين أن على الحاكم قبل أن يفكر في وضع الضريبة أن يلاحظ حالة الأرض فيعمرها ويصلحها، وأن يراعي حالة العامل النفسية والمعيشية، فيضمن له العيش في مستوى لائق لئلا يشعر بالاضطهاد وعندما يفرغ من ذلك كله يحق له أن يضع الضريبة التي تتناسب مع مستوى الإنتاج ومقدرة المنتجين.
قال (ع):
«وإنما يؤتي خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعبر».
ولا يكفي هذه وحده في ازدهار هذه الطبقة وتقدمها، فقد يكون الحاكم محسناً إليها رؤوفاً بها، ومع ذلك ينالها الظلم، ويلحق بها الحيف.
إن هذه الطبقة بحاجة إلى الحماية من طبقة الخاصة والنبلاء، فهؤلاء يظلمون، ولا يتناهون عن منكر فعلوه، ولا يفيئون إلى حق، اعتزازاً بقوتهم وغناهم وصلتهم بالحاكمين، ولذلك فيجب أن تحمى هذه الطبقة منهم بقطعهم عنها، ويكون ذلك بألا يجعل الحاكم لهم سبيلاً عليها ولا صلة بها، فلا يقطعهم الحاكم أرضاً تتصل بأرض من هم دونهم قوة وقدراً لأنهم يستغلون المرافق العامة في سبيل منافعهم الخاصة، ويعتدون على أرض غيرهم فيلحقونها بأرضهم، ويعفيهم الجباة من الضرائب مراعاة لمنزلتهم، ويضعون ما رفعوه عنهم على أعناق غيرهم ممن ليس له مثل منزلتهم، وذلك أفدح الظلم وأقبحه.
فإذا ما حدث شيء من ذلك وتعدى أحد هؤلاء على بعض الناس فظلمه بأن وضع عليه خراجه، أو سلبه أرضه، أو حرمه الانتفاع بالمرافق العامة، وجب على الحاكم أن يؤدّبه ويرده إلى العدل كائناً من كان.
قال (ع):
«ثم أن للوالي خاصة وبطانة، فيهم استئثار وتطاول، وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع مادة تلك الأحوال. ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحاميتك قطيعة، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤنته على غيرهم، فيكون مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابراً محتسباً واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه فإن مغبة ذلك محمودة».
التجار والصناع
إذا كانت الزراعة هي ينبوع النشاط الاقتصادي في العصور القديمة فإن التجارة هي المظهر الأكمل لهذا النشاط في جميع العصور.
إذن، فطبقة التجار تشكل وحدة اجتماعية عظيمة القيمة، بعيدة الأثر في الكيان الاجتماعي. ولو أن اضطراباً ألّم بنشاط هذه الطبقة لاضطرب المجتمع كله فتحدث المجاعات في بعض الأطراف بينما تتكدس المواد الغذائية في أطراف أخرى، وبينما توجد في بعض المناطق سلع كثيرة للاستهلاك توجد مناطق أخرى تعاني نقصاً في سلع الاستهلاك.
وهؤلاء التجار ـ في كلام الإمام ـ على قسمين: منهم المقيم المستقر بماله وتجارته. ومنهم المتجول المضطرب بماله بين البلدان يرصد حاجة كل بلد فيتجر فيه بالسلعة التي يفتقر إليها.
وأما الصناع فيجب أن تدخلهم في طبقة التجار ونفهمهم على أنهم منها هنا وذلك لأمرين، الأول: أن لكل من هؤلاء الصناع عملاً خاصاً مستقلاً يتّجر به وحده أو يشاركه فيه غيره فهو يتمتع بنتيجة عمله وليس مستخدماً عند غيره كما هو حال العامل الآن. الثاني: أن الوجدان الطبقي عند التجار والصناع واحد كما سنرى والميزان في عد طائفتين من الناس طبقة واحدة هو وحدة الوجدان الطبقي فيها.
هناك تلازم وثيق بين الازدهار الاقتصادي وبين التجارة فكلما نشطت حركة التجارة ارتفعت نسبة الإنتاج وكلما ضعف أمر التجارة هبطت هذه النسبة وتبعتها في الهبوط المكانة الاقتصادية للأمة. ونضرب لهذا مثلاً بحالة المقاطعات الفرنسية في عصر الإقطاع، ثم بحالة هذه المقاطعات بعد ضعف أمر الإقطاع ونشوء البرجوازية.
ففي عهد الإقطاع الذي ساد أوروبا منذ انهيار إمبراطورية شارلمان إلى ما بعد الحركة الأولى للحروب الصليبية ضعفت الحركة التجارية في أوروبا ضعفاً عظيماً فتبعها الإنتاج في الهبوط، واكتفى سكان كل إقطاعية بإنتاج ما يلزمهم ويكفيهم من المواد الغذائية واقتصروا منها على أنواع خاصة تسد حاجتهم ولا تستدعيهم بذل جهد كبير فلم يكن شيء سوى سد الحاجة مطلباً لهم، نعم كانت ثمة استثناءات خاصة في السلاح والثياب والأثاث للزعيم، وكانت هذه تنقل من أقاليم بعيدة نسبياً. وهكذا كانت المقاطعات الفرنسية، الأوروبية كلها، تجنح في الاقتصاد نحو سياسة الاكتفاء الذاتي، وعدم إنتاج ما يزيد على الحاجة.
ولكن ما إن التهبت شرارة الحروب الصليببة التي ذهبت بكثير من النبلاء والإقطاعيين، وما أن حدثت تطورات اجتماعية أخرى كالنزوح من الريف إلى المدينة، وتأييد الملك، واختراع المدفع الذي ذهب بقيمة الحصون… ما أن حدث هذا حتى عادت التجارة فنشطت نشاطاً عظيماً، ونشأت طبقة البرجوازيين التجارية التي ينتقل أفرادها بين البلدان، واستتبع ذلك ارتفاع مستوى الإنتاج، فزرع الزارع أنواعاً جديدة لم يكن ليزرعها لولا طلب التجار لها، واشترى أشياء جديدة «ملابس وأسلحة، وآنية، وأدوات زينة» لم يكن ليقدر على شرائها لولا نشاطه الجديد، وتفنن الصانع في صنعه، فلم يعد يصنع ما يسد الحاجة فقط، وإنما أخذ يصنع ما يرضي حاسة الجمال أيضاً. وقامت المشاريع الصناعية الكبرى فنشأت البرجوازية المالية والبرجوازية الصناعية. وهكذا ارتفع مستوى الإنتاج بسبب نشاط الحركة التجارية.
وعندما نبحث عن أسباب التدهور التجاري الذي حل بفرنسا وغيرها من دول أوروبا في عصر الإقطاع نجد أسباباً مختلفة: منها عدم وجود الطرق التجارية الصالحة في جميع الأوقات بين مختلف أنحاء البلاد ومنها قطاع الطرق، وعصابات اللصوص والقتلة التي تترصد القوافل التجارية ومنها عدم وجود سلطة مركزية تثبت الأمن، وتضرب على أيدي المفسدين في الأرض، لأن السلطة المركزية في عصر الإقطاع كانت واهنة، وكان السلطان الفعلي بأيدي الإقطاعيين وكان هؤلاء في حالة حرب دائمة فهم في شغل عن تأمين السبل والضرب على أيدي المفسدين. ومنها الرسوم الجمركية الفاحشة والضرائب الباهظة التي تفرض على البضاعة عند حدود كل مقاطعة وعند كل جسر ومعبر مما يرتفع بثمن السلعة إلى مبلغ كبير لا يقوى عليه الفرد المحدود الدخل.
هذه الأمور أضعفت الحركة التجارية وحصرتها في نطاق شديد الضيق. ولكن الوضع تغير عندما حدثت التطورات الاجتماعية التي أشرنا إليها. فقد استتبع ضعف شأن الإقطاعيين تحول الشعب إلى تأييد الملك فاشتد ساعد السلطة المركزية، وعند ذلك ضربت هذه السلطة على أيدي اللصوص وقطاع الطرق ومهدت السبل التجارية وأمنتها ووحدت الضرائب فاتسع مجال التجارة ونجم عنها الازدهار الاقتصادي الذي أشرنا إليه.
وما نشك في أن الإمام كان على وعي لهذا كله يوم كتب للأشتر عهده الذي عهد إليه. فقد استوصاه بالتجار خيراً وأمره بأن يوصي بذلك ولاته وعماله، وما هذا الخير الذي أراده لهم إلا تسهيل مهمتهم ليؤدوا خدماتهم للمجتمع على الوجه الأكمل، فلا يجوز أن تكون المكوس والضرائب باهظة تستصفي الربح كله أو تبقي منه شيئاً لا يسد الحاجة، ولا يحمل صاحبه على المخاطرة، لأن ذلك يلجئه إلى أن يجمد ماله فلا ينميه بالتجارة، ويلحق بالمجتمع من ذلك ضرر كبير ينشأ من توقف حركة العرض والطلب التي ينجم عنها هبوط المستوى الاقتصادي.
ويجب أن تكون الطرق التجارية صالحة في جميع الأوقات ليتيسر للتجار التنقل بين أطراف البلاد، وليتمكنوا من تلبية الرغبات في جميع الأنحاء، وليستطيعوا استنزاف الفائض الإنتاجي من منطقة فيسدوا به حاجة منطقة أخرى تعاني نقصاً فيه.
ويجب أن يستتب الأمن، لئلا يمسك الخوف التاجر عن التنقل ويقعد به الفرق من أن يذهب ضحية العدوان.
قال (ع):
«ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً، المقيم منهم والمضطرب بماله، والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع، وأسباب المرافق، وجلاّبها من المباعد والمطارح، في برك وبحرك، وسهلك وجبلك. وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترؤون عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك، وفي حواشي بلادك».
ذهب «سان سيمون» إلى أن الوجدان الطبقي الذي يميز طبقة الصناع والتجار هو الإنتاج، وإنماء الثروة الفردية عن طريق تشكيل المادة على نحو ينتفع به الإنسان، أو عن طريق الاتجار بهذه المادة. وهم، بهذا يخالفون طبقة الحاكمين لأن هؤلاء يجعلون مظهر سلطانهم على الإنسان (كان سيمون يكتب هذا في سنة 1818م) أما التجار والصناع فقد جعلوا سلطانهم على المادة، ولذلك فهم طبقة مسالمة لا يخشى منها شر بخلاف من كان سلطانهم على الإنسان، فإنهم ينزعون إلى الشر والتسلط.
وهو يرى أن البرجوازية الصناعية والتجارية قد حققت انقلاباً هائلاً في نظرة الإنسان إلى وسيلة جمع المال، وبدلت المفاهيم الاقتصادية التي سيطرت على العقل الإنساني آلاف السنين، فبينما كانت هذه المفاهيم تقضي بأن أحسن الوسائل لجمع المال هي السيطرة على طائفة من الناس واستخدامها، نرى هذه الطبقة الناشئة تؤكد أن السبيل الأفضل لذلك هو السيطرة على المادة وتسخيرها لحاجات الإنسان بواسطة قوى العلم.
ويرى سيمون أن من الضروري للتقدم الإنساني أن تتاح لهذه الطبقة جميع فرص النمو لتعم ثورتها المباركة على النظرة التقليدية لوسائل جمع المال([372]).
ولا يصعب علينا أن نتبين روح هذه النظرية في عهد الإمام، فقد رأيت أنه قد أوصى الحاكم بالتجار والصناع، وأمره أن يرعى شؤونهم ويتفقد أحوالهم ويفسح لهم في المجالات ليتسنى لهم أن يساهموا مساهمة خصبة في رفع مستوى الإنتاج وإنماء الحياة الاقتصادية.
وتأمل في قوله: «… فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته» فإنه يؤكد، فيه وجوب العناية بهم والرعاية لهم لأنهم لا يخشى منهم شر فطبيعة عملهم والوجدان الذي يدفعهم إلى هذا العمل فيهما خير المجتمع ورفاهه. وأما قوله: «وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك». بعد أن أمره وأمر عماله برعايتهم فإنه يشبه أن يكون أمراً بإنشاء دائرة خاصة تعنى بشؤون التجار.
قلت: إننا لا يصعب علينا أن نتبين روح هذه النظرية في عهد الإمام ولكن في هذا العهد ملاحظة عميقة واعية غفل عنها سان سيمون وأولتها الأبحاث الاجتماعية الحديثة عناية كبيرة.
وذلك أنه إذا كان من الحق أن نعترف بأن طبقة التجار والصناع طبقة محبة للسلم طبقة يعود نشاطها على المجتمع بالخير، فإن من الحق أن نعترف أيضاً أنها تصير في بعض الأحيان ذات نشاط عدواني مضر بالمجتمع فعندما تستحكم «العقلية التجارية» في التاجر والصانع إلى حد أنها تدفع بهما إلى التماس الثروة من أقرب الطرق ـ عندما يحدث هذا تجنح هذه الطبقة إلى التسلط والسيطرة على الإنسان بصورة غير مباشرة، ولكنها بالغة الضرر، وذلك بالاحتكار والتوسل به إلى السيطرة على الأسواق والتحكم بالأسعار وبالتطفيف في الموازين وبالغش وبيع الأصناف الرديئة وبكل طريق يضمن ربحاً وفيراً في مقابل رأسمال قليل.
عندما يحدث هذا الانحراف في عمل هذه الطبقة تصير خطراً، وإذن فكما تجب معونتها تجب مراقبتها أيضاً لئلا تنحرف انحرافاً يضر بالشعب، ويحرم الفقير من بلغة عيشه، فحينما ترتفع الأسعار وتبقى الأجور كما هي تحدث أزمة عند من لا تفي أجورهم بالأسعار الجديدة.
هذه الظاهرة، ظاهرة انقلاب هذه الطبقة إلى خطر، لاحظها الإمام وتقدم إلى عامله بأن يلاحظها، وبين له العلاج. فعندما يحدث الانحراف يتعين على الحاكم بأن يقوم بتدبير زجري يرجع الأمور إلى نصابها، وذلك إما بمنع المحتكر من الاحتكار وإجباره على البيع بالسعر المعقول، وإمّا بتعميم المادة المحتكرة على تجار عديدين يبيعونها بالسعر العادي، فإذا ما احتكر تاجر بعد النهي عوقب ليرتدع، وأمر عامله أن يجعل الأسعار على مستوى لا يعجز عنه أوساط الناس، ولا يخسر به التاجر. وأمره أن يضبط المكاييل والموازين لئلا يبخس البائع المبتاع.
قال (ع):
«واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة. فامنع من الاحتكار فإن رسول الله (ص) منع منه، وليكن بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكّل به وعاقبه من غير إسراف».
العمال ومن لا يستطيعون عملاً
هذه الطبقة طبقة الفقراء تتألف ممن لا يستطيعون عملاً لعاهة فيهم لا يقدرون معها على العمل، أو لا يستطيعونه لكبر السن وضعف البنية، أو لا يستطيعونه لصغر السن كالأيتام الذين لا كافل لهم، أو يستطيعون ويعملون، ولكن عملهم لا يمدهم بالكفاية، ولا ييسر لهم مستوى لائقاً من العيش.
هذه الطبقة تتألف من هذه الطوائف، وإذا لم تلاق عناية من المجتمع ينحرف قويها إلى طريق الجريمة، ويموت ضعيفها جوعاً، وهي في الحالين سبة وخطر على المجتمع. وإذن فلا بد من تدبير يحمي المجتمع منها، ويدفع البؤس عن أفرادها، ويحول قويهم إلى خلية إنسانية عاملة وينهض بهم إلى مستوى الحياة الحرة الكريمة.
وقد سن الإمام (ع) قانوناً تعامل به هذه الطبقة استجاب فيه إلى أحكام الإسلام.
وفي كلام الإمام عن هذه الطبقة نرى تشريعاً عمالياً ناضجاً إلى أبعد الحدود، ومستوعباً تمام الاستيعاب، وهو على نضجه الكامل واستيعابه التام، سابق للتشريعات العمالية الحديثة بأكثر من ألف ومائتي عام.
ففي النصف الثاني من القرن الثاني عشر ظهرت طلائع الثورة الصناعية في إنكلترا، وهي أول بلد أوروبي شهد الانقلاب الصناعي الحديث. وقد تمت للثورة الصناعية عناصرها المكونة حين اخترع البخار كقوة محركة، وعمم في صناعة المحركات. واستتبع ذلك اتساع نطاق الصناعة وتركزها في المدن، وحينئذٍ حدثت الهجرة من الريف إلى المدينة فقد باع الفلاحون أرضهم من كبار الملاك، وانتقلوا إلى المصانع الجديدة كعمال، وعند ذلك ظهرت طبقة العمال إلى الوجود على نحو فعال، وانتقلت مراكز الكثافة في المجتمع من الفلاحين إليها. ومن هذا الحين بدأت هذه الطبقة تستشعر الظلم أفدح وأقسى ما يكون، فلم يكن لمطامع أصحاب المصانع حد ولا غاية، وكان العامل يعمل أكثر ساعات نهاره بأجر زهيد، فإذا ما استغنى عنه صاحب العمل، أو حلت به آفة، أو اعتراه وهن أو بلغ سناً لا يقوى فيها على العمل، طرد من عمله.
وبدا كأن هذا الوضع الشائن سيستمر إلى الأبد ـ وبدا كأن الكيان الاقتصادي القائم على هذا الاستغلال سيبقى منيعاً وبدا كأن واقع العمال التعس أمر لا مفر منه ولا معدى عنه. ولكن شيئاً من هذا لم يستمر فقد نبهت هذه المظالم الوعي العمالي ودفعتهم إلى تحسين مستواهم الاقتصادي عن طريق الصراع. وقد عملوا كثيراً، وقد أخفقوا كثيراً، ولكنهم وفقوا أخيراً إلى تخفيض ساعات العمل ورفع الأجور والتعويض عند الصرف من العمل، والضمان الاجتماعي بإعانة مالية تدفع للعامل المتعطل من صندوق الدولة.
ونقدم هنا ملاحظات:
الأولى: أن هذا لم يتم إلا بجهود العمال أنفسهم فلا المجالس التشريعية ولا أصحاب العمل انتبهوا إلى حالة العمال واهتموا بتحسينها، ولم يستجب أصحاب العمل لمطالب العمال، ولم تسن التشريعات الملائمة إلا بعد صراع دام عقوداً من السنين.
الثانية: أن هذه الإعانة التي تعطى للعامل المتعطل إنما تعطى له بشكل إحسان وصدقة، لا باعتبارها حقاً له.
الثالثة: أن هذه التشريعات لا تشمل بعض الحالات، فمن يعمل ولا يكفيه عمله لا يدخل فيها، ومن يعمل ويحصل على أجر مناسب ولكن عرض له ما جعله مفتقراً إلى المزيد من المال لا يدخل فيها وكذلك لا يدخل فيها الأيتام، ومن لا كافل لهم ولا يستطيعون العمل لصغر السن أي لا تعتبر الدولة نفسها مسؤولة عنهم.
وإذا رجعنا إلى عهد الإمام لنقارن بينه وبين النتائج التي خرجنا بها، فماذا نجد؟
نلاحظ أولاً: أن التشريعات الكافلة للطبقة العاملة ومطلق من لا يستطيع العمل للمرض أو لكبر السن أو لصغره ـ هذه التشريعات صدرت من فوق، من طبقة الحاكمين، ومغزى أن تكون التشريعات الحامية لطبقة العمال قد صدرت من فوق من دون أن يحدث من هذه الطبقة تحسس يلجىء إلى هذا، كبير القيمة، فهو يدل على أن الإمام كان يفكر في هذه الطبقة ويعمل لخيرها.
وثانياً: أن ما تدفعه الدولة إلى هؤلاء ليس إحساناً منها إليهم، وإنما هو حق لهم عليها، يجب أن تؤديه. وعهد الإمام صريح في هذا كما سترى. ومغزى هذه الملاحظة عظيم، فعندما يأخذ المعوز ما يأخذه على أنه «إحسان» يشعر بالدونية، أما حين يأخذه على أنه «حق» فإنه لا يشعر بشيء من هذا.
وثالثاً: أن التشريع الذي سنه الإسلام وذكره الإمام يشمل كل حالة عجز، فمن لا يستطيعون عملاً لمرض أو هرم أو صغر سن، أو يعملون ولكن أجرهم لا يكفيهم ـ هؤلاء جميعاً تكفلهم الدولة، وتعتبر نفسها مسؤولة عنهم.
وعهد الإمام صريح في أن على الحاكم أن ينشىء لهذه لطبقة دائرة خاصة ترعى شؤونها، فهو يقول: «ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمورهم» وقد جرى (ع) على هذا فيما نقل ابن أبي الحديد إذ قال: «وكان لأمير المؤمنين علي (ع) بيت سماه بيت القصص يلقي فيه الناس رقاعهم».
وإذن، فالبرغم من سبق عهد الإمام على التشريعات العمالية الحديثة بأكثر من ألف ومائتي عام نلاحظ أنه أوعى لحاجات هذه الطبقة وأرعى لشؤونها، وأشمل لطوائفها من هذه التشريعات. نعم تمتاز هذه التشريعات بأنها أكثر تفصيلاً من عهد الإمام، وبأنها تشتمل على ملاحظات لم ترد في هذا العهد، ولكن ذلك لا يكسبها ميزة حقيقة، فالعبرة بروح التشريع وبشموله، ولا شك، بعد ما عرفت، في أن عهد الإمام أشمل.
قال (ع):
«ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين، وأهل البؤسى والزمنى، فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى وكل قد استرعيت حقه، ولا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير المهم، فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر خدك لهم وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم بالأعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه فإن هؤلاء من الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. وكل فاعذر إلى الله في تأدية حقه إليه. «وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه. وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العافية، فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم».
ونستطيع أن نتصور عظيم اهتمامه (ع) بهذه الطبقة حين نتأمل لقوله: «ثم الله الله..» وقوله: «فلا تشخص همك عنهم، ولا تصعر خدك لهم» يأمر واليه بأن يتواضع لهم لئلا يشعروا بالذل من جهة وليضرب لأغنياء رعيته مثلاً من نفسه في معاملته لهذه الطبقة. وقوله: «فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم». وأما قوله: «فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً» وقوله: «وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم» وقوله: «وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن، ممن لا حيلة له، ولا ينصب للمسألة نفسه» فإنها تنطوي على مضمون عظيم القيمة فهؤلاء الذين يمنعهم الحياء وشرف النفس من إظهار فقرهم ومن نصب أنفهم للمسألة يموتون جوعاً إذا لم يبحث عنهم الحاكم ويرعى أمورهم ولذلك أمر الإمام واليه بأن يتفقد هؤلاء وأمثالهم، ويوكل بهم من يتفقدهم.
ولا أظن أن حكومة من الحكومات الحديثة بلغ فيها التشريع العمالي، والتأمين الاجتماعي من النضوج والوعي للمسؤولية الاجتماعية إلى حد أن تؤلف هيئة تبحث عن ذوي الحاجة والفاقة فترفع حاجتهم بأموال الدولة، كما نرى ذلك في عهد الإمام.
ولا أظن أن قلوب المشرعين وعقولهم اجتمعت على أن تخرج للدنيا تشريعاً عمالياً فأفلحت في أن تخرجه أنبض من تشريع الإمام بالشعور الإنساني العميق.
المجتمع وحدة عامة
كنا فيما تقدم نتحدث عن آراء الإمام في المجتمع باعتبار تركيبه الداخلي، أعني الطبقات الاجتماعية. والآن نريد أن نتحدث عن رأي الإمام في المجتمع كوحدة عامة، فلا ننظر إليه من داخل كما صنعنا في بحث الطبقات، وإنما ننظر إليه من خارج باعتباره وحدة إنسانية عامة لا تلحظ فيها الفروق وكنا نتحدث عن آراء الإمام في إصلاح المجتمع عن طريق التأمين الاقتصادي وإصلاح جهاز الحكم. ونتحدث الآن عن آرائه في إصلاح المجتمع عن طريق العوامل النفسية ذات الأثر في الجماعة الإنسانية.
للاجتماع الإنساني مظهران: مظهر حقيقي، ومظهر مزيف.
أما المظهر الحقيقي للاجتماع الإنساني فهو ذلك الذي يبدو الناس فيه وقد شاعت بينهم الألفة، وجمعتهم المحبة، وقاربت ما بينهم وحدة الوسائل والغايات. وهو ذلك الذي يعي فيه الأفراد المسؤولية، ويشعرون أن القانون الذي يجب أن يسود هو قانون: حقي وواجبي. وهو ذلك الذي يعي فيه الأفراد أن الغاية من الاجتماع الإنساني هي التعاون على إيجاد الفرص المناسبة التي تمكن كل فرد من إظهار قدرته، وتحقيق ذاته على نحو فعال مجدٍ، وليس عملاً يراد منه إيجاد الفرص المناسبة لطائفة من الناس على حساب آخرين.
وأما المظهر المزيف للاجتماع الإنساني فهو ذلك الذي يبدو فيه الأفراد «مجتمعين» فحسب، فلا توحد بينهم ألفة، ولا تلم شتاتهم محبة، ولا يلتقون على هدف صحيح. وهو ذلك الذي يسعى فيه كل فرد إلى امتلاك كل ما يستطيع دون وعي لحاجات الآخرين ودون اهتمام لمصائرهم. وهو ذلك الذي يسود فيه قانون الكلمة الواحدة، قانون: حقي، فقط. إن هذا الطراز من الاجتماع أحق بأن يسمى «تجمعاً» ذئبياً من أن يسمى اجتماعاً: إنسانياً.
هذان مظهران للاجتماع الإنساني ويحسن بنا أن نلتمس الأسباب التي تسوق إلى هذا وذاك.
روح العدوان غريزة أصيلة في نفس الإنسان. وإنما كانت أصيلة فيه لأنها ضرورية لحياته، فلولاها لما كان في الإنسان ما يحفزه إلى حماية نفسه من كواسر السباع وفواتك الهوام، ولما كانت له القدرة على الصيد ولا على أي عمل يتطلب صراعاً مع كائن حي آخر في سبيل حفظ الحياة.
وأوقات الحاجة إلى هذه الغريزة هي حين تتعرض الحياة الإنسانية لخطر فاتك سواء كان من الإنسان أو الحيوان. ولكن لا يمكن أن يودع في النفس الإنسانية جهاز يولد هذه الغريزة في أوقات الخطر ويعدمها في أوقات الأمان. وحيث لا يكون هذا الجهاز فيجب أن يبقى وجود هذه الغريزة مستمراً في جميع الأوقات.
وهي في أوقات الخطر تعمل عملها الذي يسرت له وأودعت في الإنسان لأجله. وأما في أوقات الأمان فإن وجودها يصبح مشكلة خطيرة قد تمتد بآثارها إلى كافة الخليات الاجتماعية في المجتمع.
ففي المجتمعات التي تدين بحضارة لا تجعل للإنسان هدفاً سامياً في الحياة ولا تعلمه إلا أن يبالغ في إرواء شهواته ونزعاته، تعبر هذه الغريزة عن نفسها في عدوان بعض الأفراد على بعض، لأنها ـ كغريزة ـ لا بد لها من التعبير عن نفسها، وحيث لا تقدم لها الحضارة موضوعاً للتعبير يصرفها ويحولها عن الأفراد لا بد أن تعبر عن نفسها في هؤلاء الأفراد، وحينئذٍ ينقلب المجتمع الإنساني إلى مجتمع ذئبي تناحري، ذي غرائز عدوانية ضارية تعبر عن نفسها باستمرار.
هذه هي الأسباب التي تذهب بروح الاجتماع الإنساني وتسبغ عليه مظهراً اجتماعياً مزيفاً.
وجاء الإسلام والمجتمع الإنساني كله في واقع تعس نشأ من أن الحضارات التي كان يدين بها كانت حضارات لا تتجاوز بالإنسان مدى الحس. وكان المجتمع العربي يعاني الأزمة في أحد مظاهرها، فقد كان يقوم إلى جانب ما يعانيه من جدب روحي، على أساس قبلي. وكان هذان العاملان: الجدب الروحي والروح القبلية يثيران غريزة العدوان أعتى وأضر ما تكون.
وقد عالج الإسلام هذه المشكلة، أولاً، بأن حارب عناصر الفساد والانحلال في الإرث الثقافي المهلهل الذي دعت إليه تلك الحضارات وجاء بلون ثقافي جديد حري بأن يعيد تكوين الإنسان الروحي من جديد، وجعل للحياة الإنسانية هدفاً أعلى من إرواء الحس باللذة، جعل لها الفضيلة هدفاً، وأمر الإنسان بالمسير إليه. وثانياً بأن وجه غريزة المقاتلة إلى موضوعين أحدهما أعداء الإسلام الذين يكيدون له، ويبغون عليه، ويريدون إطفاء نور الله فيه. والثاني هو الشيطان، هذا الكائن الذي هو أعدى أعداء الإنسان يزين له الظلال، ويحبب إليه الانحراف ويدفعه عن طريق الإغواء والإغراء إلى تشويه الشخصية الإنسانية وتلويثها وقد أكد الإسلام عداوة الشيطان للإنسان تأكيداً مطلقاً، وأكد وجوب الاحتراز منه والحذر من مكائده والتحصن من شباكه تأكيداً مطلقاً، وبذلك وجه غريزة القتال والعدوان إلى موضوع يستفيد منه المجتمع أعظم الفائدة، فالإنسان، منذ اليوم، يكافح الشيطان من أجل أن يسمو… من أجل أن يحقق الإنسان.
وقد أحرز النبي (ص) نصراً باهراً حين استطاع، عن طريق الإسلام، أن يجمع العرب على رمز يوحد بينهم في الوسائل والغايات، وأن يكوّن من الشراذم العربية أمة عربية. ولكن الظرف الزماني لم يسعفه على استئصال الروح القبلية من نفس العربي فما أن قبضه الله إليه حتى حدث ما بعث هذه الروح من جديد… حتى ولي الخلافة عثمان فعبرت عن نفسها بسبب سياسته تعبيرات شديدة، فلما ولي الإمام الحكم جوبه بهذا الواقع، واقع المجتمع العربي المسلم الذي ساقته الروح القبلية إلى مصير وبيل. فنصب نفسه لمحاربة هذه الروح.
وقد كانت طريقته في العلاج فذة رائعة، سنقف في فصل آت على جانب منها يتناول التثقيف الفردي وتعليم أصحابه روح الإسلام، أما هنا فنتحدث عن كفاحه للروح القبلية باعتبارها نزعة هدامة.
ولا بد أنه (ع) تكلم كثيراً في هذا الموضع، لأن واقعه كان يدعوه إلى ذلك، ولئن لم يصل إلينا كل ما قال أو أكثره فإن ما في نهج البلاغة يغني في مقام التعرف على آرائه في هذه المسألة، وثمة خطبة من طوال خطبه خصصها لمحاربة هذه النزعة في مجتمعه، وقد ذكر الشريف مختاراً منها، ونحن ذاكرون طرفاً مما اختار نستشهد به على أن الإمام كان يعي العمليات الاجتماعية، وكان يعي ما وراء هذه العمليات من دوافع نفسية تحمل عليها وتدفع إليها.
وأعظم خطبة تضمنت ذلك، وتجلى فيها غرض الإمام الاجتماعي هي خطبته القاصعة، ففيها صرح الإمام بأن الاجتماع الإنساني الحق لا يمكن أن يجتمع مع النزعة القبلية. وفيها يضرب الأمثال التي تشهد لدعاواه والتي تدل على أن النزعة القبلية، بما لها من آثار سيئة، هي التي محقت المجتمعات القديمة.
قال (ع):
«.. فاطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية، وأحقاد الجاهلية، فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته، واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم، وإلقاء التعزز تحت أقدامكم، وخلع التكبر من أعناقكم، واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من غير ما فضل جعل الله فيه سوى ما ألحقت العصبية بنفسه من عداوة الحسد».
ثم يضرب لهم الشواهد، ويبصرهم عبر التاريخ. فهذا الواقع الاجتماعي المزري جر أمماً قبلهم إلى الانهيار، وجدير بهم أن يعتبروا بمن قبلهم ممن غفلوا عن عدوهم الكامن في أعماقهم، وصرفوا بإغرائه وإيحاءه عداوتهم إلى إخوانهم في الدين والإنسانية:
«فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته ووقائعه ومثلاته، واتعضوا بمثاوي خدودهم ومصارع جنوبهم واستعيذوا بالله من لواقح الكبر كما تستعيذوه من طوارق الدهر.. واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال فتذكروا في الخير والشر أحوالهم واحذروا أن تكونوا أمثالهم، فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم، فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم، وزاحت الأعداء له عنهم، ومدت العافية فيه عليهم، وانقادت النعمة له معهم، ووصلت الكرامة عليه حبلهم، من الاجتناب للفرقة، واللزوم للألفة، والتحاض عليها والتواصي بها. واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم، وأوهن منتهم من تضاغن القلوب وتشاحن الصدور، وتدابر النفوس، وتخاذل الأيدي» ثم يضرب لهم الأمثال بحال بني إسرائيل كيف جمعتهم الدعوة الواحدة ولم شعثهم الهوى الجميع، فعظم أمرهم ثم اختلفوا فذهب ريحهم ووهنوا وذلوا. وضرب لهم الأمثال بحال العرب قبل الإسلام كيف كانوا ثم كيف اتحدوا بالإسلام فأصبحوا يطاعون في بلاد كانوا فيها أذلة ضعفاء ثم ذكر أن أعظم ما أمتن الله به عليهم هو أنه جمعهم وألف بين قلوبهم وجعلهم إخواناً، قال:
«فإن الله سبحانه قد أمتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها، بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر».
ورؤساء القبائل هم أصحاب المصلحة في استشراء العصبية القبلية والتفكك الاجتماعي، فلو وعى الناس الحياة الاجتماعية وراعوا المصلحة العامة وحدها لما بقيت لهؤلاء الرؤساء قيمة، لأن وجودهم منوط بهذه العصبية، وقد عرف الإمام (ع) ذلك، فوجه إليهم صفعة مدوية حين صرخ بالناس:
«ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم، وألقوا الهجينة على ربهم، وجاحدوا الله ما صنع بهم مكابرة لقضائه ومغالبة لآلائه، فإنهم قواعد أساس العصبية، ودعائم أركان الفتنة، وسيوف اعتزاء الجاهلية، فاتقوا الله… ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم وخلطتم بصحتكم مرضهم، وأدخلتم في حقكم باطلهم، وهم أساس الفسوق وإحلاس العقوق اتخذهم إبليس مطايا ظلال وجنداً بهم يصول على الناس وتراجمة ينطق على ألسنتهم، استراقاً لعقولكم، ودخولاً في عيونكم، ونفثاً في أسماعكم فجعلكم مرمى نبله، وموطىء قدمه، ومأخذ يده».
وعلى هذا النسق العالي من البيان الشامخ يمضي الإمام (ع) في بيان أمراض المجتمع. ويكشف عن أسبابها النفسية، ويبرهن بذلك على وعي خارق للعمليات الاجتماعية وأسباب انحرافها وطرق إصلاحها وننصح بالرجوع إلى الخطبة القاصعة وقراءتها بإمعان، فقد لا يعطي ما قدمناه فكرة صحيحة تامة عنها([373]).
الحُكام
يشترط في الحاكم أن يكون كريم النفس لئلا تدفعه الطماعية وشدة الحرص إلى العدوان على أموال المسلمين. واشترط فيه أن يكون عالماً لأنه قائد المسلمين الأعلى فيجب أن يهديهم ولو كان جاهلاً لأظلهم. واشترط فيه أن يكون لين العريكة رحب الصدر واشترط فيه أن يكون عادلاً في إعطاء الأموال فيسوي بين الناس في العطاء ولا يفضل قوماً على حساب آخرين استجابة لشهوات نفسه وميول قلبه. واشترط فيه أن يكون نزيهاً في القضاء فلا يرتشي لأن ذلك مؤذن بذهاب العدل في الأحكام. واشترط فيه أن يكون عاملاً بالسنة فيجري الحدود ولو على أقرب الناس إليه، ويعطي الحق من نفسه كما يطلبه من غيره.
قال (ع):
«… وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمام المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيظلم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الخائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة».
قال:
«لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع».
وقال متحدثاً عن الإمام:
«ومن نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم».
وهذه الكلمات تقوم على فلسفة للحكم عند الإمام (ع) تتلخص في أن الحكم، وهو ضرورة اجتماعية، أقيم لصالح المجتمع، ولا يمكن أن يعمل الحكم لصالح المجتمع إلا إذا كان على رأسه إنسان كامل الصفات، واع لمهمته، أما حين يكون الحاكم إنساناً غير واعٍ للمسؤولية وغير عامل على إصلاح المجتمع ورفع شأنه فإن الحكم ينقلب إلى وسيلة للظلم. وستتضح لنا الخطوط الكبرى لهذه الفلسفة فيما يأتي.
حقوق الرعية على الحاكم تستمد معناها من طبيعة الحكم الذي يمارسه الحاكم. فهناك حكم يقوم لأجل عائلة من العائلات الكبيرة وحينئذٍ يعمل الحاكم لأجل هذه العائلة، ويسخر جميع مرافق الدولة لها ولمن يقوم عليه سلطانها وهناك حكم يقوم لصالح طبقة من الطبقات وحينئذٍ يعمل الحاكم لأجل هذه الطبقة، ولا ينيل الرعية شيئاً إلا إذا كان فيه ما يعود بالخير على هاتيك الطبقة التي يقوم من أجلها الحكم. ومرة يقوم الحكم من أجل الرعية وحدها وحينئذٍ يعمل الحاكم للرعية وحدها. وفي هذا اللون من الحكم توجد للرعية على الحاكم حقوق يصح أن نتحدث عنها فأي لون من ألوان الحكم بشر به نهج البلاغة ووضع قواعده الإمام؟
إذا رجعنا إلى نهج البلاغة وجدنا أن الحكم الذي كان يمارسه الإمام (ع) والذي كان يحمل عماله على أن يمارسوه هو هذا الحكم الذي يقوم من أجل الرعية وحدها. وقد تقدم منا في حديثنا عن المجتمع والطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة أنْ عرضنا إلى طرف من ذلك، فرأينا كيف أن الإمام في عهده العظيم إلى مالك الأشتر قد وضع الأسس المتينة لإنشاء جهاز حكم يعمل للشعب وللشعب فقط، غير ملقٍ بالاً إلى منافع طبقة خاصة تسعد على حساب الشعب وتنعم بجهوده، وسنعرض في حديثنا هذا طرفاً من الشواهد التي تدل على أن الحكم الذي مارسه الإمام (ع) ودعا إلى ممارسته هو الحكم من أجل الشعب وما تقدم في بحث الطبقات الاجتماعية وما سيمر هنا يؤلف هيكلاً يكاد أن يكون كاملاً لفلسفة الحكم عند الإمام (ع).
من ضرورات الحكم الصالح المشاركة الوجدانية بين الراعي والرعية، إذ بها يستطيع الحاكم أن يتعرف على آمال المحكومين وآلامهم ومطامحهم وأن يعي حاجاتهم ومخاوفهم، فيعمل لخيرهم ويضع كل شيء مما يصلحهم موضعه. ويشعرهم ذلك برعايته لهم وحياطته لأمورهم وعمله لصالحهم فيدعمون حكمه بحبهم وإيثارهم له ويؤازرونه في السراء والضراء على السواء. ولا يحصل شيء من هذا إذا ما أغلق الحاكم دونهم قلبه وأغمض عنهم عينه إنه حينذاك لا يعرف شيئاً من أمورهم ليعمل على الإصلاح وتكون عاقبة ذلك أن يفقد حبه في قلوبهم ويشعرون بأنه شيء غريب عنهم مفروض عليهم كالحشرة الطفيلية التي تعيش على دماء الحيوان الذي تلتصق به.
قال (ع):
«… وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه».
ولكي تحصل هذه المشاركة الوجدانية ولكي تؤتي أكلها يجب على الوالي أن يخالط الرعية وأن يمكنهم من مخالطته ومطالعته بما يريدون، لأن احتجابه عنهم سبب لجهله بأحوالهم، وسبب لانصراف قلوبهم عنه وتفاقم موجدتهم عليه.
قال (ع):
«… فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق، وقلة علم بالأمور. والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير، ويقبح الحسن ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل. وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليس على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب».
ولكي يبقى ما بين الوالي ورعيته من وشائج الود، ويبقى ما للوالي في قلوب الرعية من جميل الأثر وحسن الظن، يجب عليه أن يبدد من أذهانهم كل ما يتوهمون فيه الظلم والحيف فيبين لهم خطته ويشرح لهم نهجه ليؤيدوا سياسته عن قناعة بها وإيمان بصلاحها وجدواها. ويجب عليه ألا يمن على رعيته بما يفعل، فإن منصبه يفرض عليه أن يخدمهم، ولو من عليهم لذهب جميل أثره من قلوبهم. وعليه أن يتجنب الكذب فيما يعطي من عهد والتزيد فيما يصف من عمل، فإن الكذب داعية المقت والتزيد أخو الكذب.
قال (ع):
«وإن ظنت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك، واعدل عنك ظنونهم بأصحارك، فإن في ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقاً برعيتك، وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق».
وإياك والمن على رعيتك بإحسانك، أو التزيد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإن المن يبطل الإحسان، والتزيد يذهب بنور الحق، والخلف يوجب المقت عند الله والناس، قال الله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقّتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾.
والسبيل الأقوم الذي يؤدي إلى تأكيد حب الحكم في نفوس الرعية ويحملها على عضده والدفاع عنه هو ما أشار إليه (ع) بقوله:
«واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم، وتخفيفه المؤونات عنهم، وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن ويقطع نصباً طويلاً، وأن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده، وأن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده».
ولم كل هذا؟ لأن الحكم إنما أقيم لصالح الشعب، ولذلك فيجب أن يرعى مصالح الشعب، ويجب أن يستلهم في أعماله حاجات هذا الشعب. أما هذه الطبقة طبقة الخاصة والنبلاء التي تحسب أن كل شيء مسخر لها وما عليها إلا أن تدعو فتجاب وتأمر فتطاع، هذه الطبقة ليس لها في حكومة الإمام امتيازات، فهي وسائر الناس سواء وعلى الحاكم، حين تتعدى حدودها وتطلب ما ليس لها، أن يردها إلى قصد السبيل.
قال (ع):
«أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك ألا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده… وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكراً عند الإعطاء وأبطأ عذراً عند المنع، وأضعف صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين، والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم، وميلك معهم».
وهكذا حكم الإمام (ع) بأن الحكم إنما أقيم من أجل الشعب فيجب أن يبقى خالصاً للشعب وحده.
وإذا كان الحكم قد أقيم من أجل الشعب فهذه الأموال التي تجبى منه لم تجبَ لتنفق على إرواء شهوات طائفة من الناس يومها دهرها وبغيتها لذتها، وهي تتمتع بحياة فارغة لاهية، إنما جبي هذا المال منه ليرد عليه في صورة خدمات عامة، ومؤسسات عامة، هذا هو مصرف أموال الدولة. وأمير المؤمنين (ع) صريح في هذا فقد تكرر منه أمره إلى عماله بصيانة مال الأمة، وصرفه في موارده وعدم التفريط به.
قال (ع):
«… فانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيباً به مواضع الفاقة والخلات، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا».
حقوق الرعية على الحاكم
وإذا كان الإمام (ع) قد وضع أسس هذه اللون من الحكم ومارسه، ودعا إلى ممارسته، فللحديث عن حقوق الرعية محل في هذا البحث كما أسلفنا. ولم يغفل الإمام الحديث عن هذه الحقوق بل عرض لها بالذكر في مواطن كثيرة، فما هي حقوق الرعية على الوالي؟
لقد تحدث مرة عن هذه الحقوق فقال:
«ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر».
وقال:
«.. فأما حقكم عليّ فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيلاً تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا».
وقال:
«… إنه ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه، الا بلاغ في الموعظة، والاجتهاد في النصيحة، والإحياء للسنة، وإقامة الحدود على مستحقيها، وإصدار السهمان على أهلها».
في هذه النصوص أجمل الإمام حقوق الرعية على الراعي في توفير الأمن في الداخل والخارج، وتأمين الحياة الاقتصادية، والتعليم والتوجيه الاجتماعي، وإقامة العدل.
ولا يضرنا إجمال هذه النصوص بعد أن عرفنا أن أطول وثيقة كتبها (ع) وأجمعها لحقوق الرعية هي عهده إلى الأشتر، ففي صدر هذا العهد أجمل هذه الحقوق إجمالاً ثم فصلها بعد ذلك تفصيلاً. أجملها فقال: «هذا ما أمر به عبدالله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها».
ثم فصلها بعد ذلك، فأفاض أولاً في بيان وظيفة العسكريين وواجباتهم والسبيل الذي يحسن بالحاكم أن يتبعه للاستفادة منهم، ثم فصل الكلام في جهاز الحكم: الولاة والوزراء والقضاة، فوضع أسس الحكم العادل التقدمي الواعي. وتكلم بعد ذلك عن الزراع والتجار والصناع والفقراء، فبين حقوقهم على الحكم من توفير المجالات لهم، وإعداد أحسن الفرص لنجاحهم في أعمالهم. ثم تحدث عن حالة البلاد العمرانية فأفاض في الحديث وبيّن خطورة هذه الناحية في أمن الرعية ورفاهها وإطّراد تقدمها.
وفي هذا العهد نظر الإمام (ع) إلى المجتمع كله بما فيه من طوائف وطبقات، وبيّن فيه حقوق هذا المجتمع كلها، ونرى ما يدعونا إلى تفصيل الكلام في ذلك هنا بعد أن تبين من خلال حديثنا عن الطبقات الاجتماعية، لأنه حينما تحدث عن الطبقات لم يتناولها على نحو تجريدي، وإنما تناولها بالحديث باعتبار مالها من حقوق، وقد قدمنا ملاحظة بين يدي ذلك الحديث قلنا فيها:
«… لم يفرغ آراءه الاجتماعية كلها في قالب علمي مجرد، وإنما قدم بعضها مفرغاً في التجربة العملية التي قام بها، ولا يسلبها قيمتها، كحقيقة موضوعية، أنها مفرغة في قالب تجريبي اجتماعي يسبغ عليها بدل جمود الحقيقة العلمية المجردة، حيوية وحركية تنشآن من حيوية الجماعات وحركيتها».
طبيعة الحق وحقوق الحاكم على الرعية
تحدث الإمام (ع) عن طبيعة الحق فلاحظ أنه لا يمكن أن يكون لأحد حق على غيره إلا ويكون عليه لغيره واجب، وهناك تقابل دائم بين الحق والواجب فحيثما يكون الحق يتبعه الواجب. ولكن الناس ـ غالباً ـ يريدون استيفاء حقوقهم دون أن يؤدوا ما عليهم من واجبات غير عالمين أنه حينما يتمرد الإنسان على واجبه فلا يأتي به يسقط حقه الذي يدعيه. قال (ع):
«… فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده، ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، ولكنه جعل حقه على عباده أن يطيعوه، وجعل جزائهم عليه مضاعفة الثواب تفضلاً منه وتوسعاً بما هو المزيد من أهله».
وقال:
«… ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب افتراضها بعضها بعضاً، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض».
وننبه هنا إلى أن هذه الحقوق حقوق الإمام، ليست امتيازات على سائر الناس يحصل عليها الإمام بسبب الحكم، وذلك لأن الحكم، عند الإمام، لا يسبب للحاكم أي امتياز شخصي أبداً. وها هو يخاطب الأشتر، عامله على مصر، بقوله:
«وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة، والتغابي عما تعنى به مما قد وضح للعيون، فإنه مأخوذ منك لغيرك، وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور، وينتصف منك للمظلوم».
وقال (ع) مخاطباً أصحابه في صفين:
«… وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر، ويوضع أمرهم على الكبر، وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء، ولست ـ بحمد الله ـ كذلك ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا علي بجميل بلاء لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من التقية في حقوق لم أفرغ بعد من أدائها، وفرائض لا بد من إمضائها، فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا فيّ بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة».
وإذا لم تكن حقوق الحاكم من هذا الباب فما هي طبيعتها إذن؟ حقوق الحاكم كما يجعلها الإمام في نهج البلاغة هي أمور يعطاها لأنها ضرورية لاستمرار الحكم وصلاحه فهذه الحقوق هي:
«… وأما حقي عليكم: فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم».
وهي: «… عليكم حق الطاعة وألا تنكصوا عن دعوة، ولا تفرطوا في صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق».
«.. فلات كفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل».
وتكاد ترجع كل هذه الحقوق إلى الوفاء بالبيعة، فإن الإمام يبايع على السمع والطاعة. وإذا لم يسمع المحكومون حين يدعوهم ولم يطيعوا حين يأمرهم، ولم ينصحوا له ولم يثبتوا على ولائه لم يستطع الإمام أن يسيّر أداة الحكم على نحو صالح.
التعاون بين الحكم والشعب
ولا يمكن أن يصلح شيء من أمور الدولة إلا إذا وجد جو صالح للعمل، ويوجد هذا الجو بتحقق الرغبة المشتركة بين الحاكم والمحكومين في إصلاح ما يفتقر إلى الإصلاح وتقويم ما يحتاج إلى التقويم من شؤون الناس وشؤون البلاد. والذي يعبر عن هذه الرغبة المشتركة هو تعاون الوالي مع الرعية على القيام بذلك كله، ويتحقق التعاون بينهما بأن يقوم كل منهما بما عليه من واجبات بعد أن يتلقى كل منهما ما له من حقوق. فعلى الرعية أن تعطي الوالي ما له عليها من حقوق فتطيعه إذ أمر، وتجيبه إذا دعا، وتنصحه إذا كان في حاجة إلى ذلك، وعلى الوالي إذا حصل على ذلك كله أن يستغله في إصلاح شؤون رعيته. أما حين لا تبذل الرعية للوالي طاعتها ولا تمحضه نصيحتها، ولا تلبي دعوته إذا دعا، وأما حين تفعل ذلك كله ولكن الوالي يستغله في رعاية مصالح نفسه ويهمل مصالح رعيته فإن ذلك مؤذن بشيوع الظلم، وسيطرة الظلمة، وفساد الدولة.
قال (ع):
«… وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاماً لإلفتهم، وعزاً لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلاَّ باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذلالها السنن، فصلح ـ بذلك ـ الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامح الأعداء. وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته، اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور وكثر الادغال في الدين، وتركت محاج السنن، فعمل بالهوى وعطلت الأحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حق عطل ولعظيم باطل فعل، فهناك تذل الأبرار وتعز الأشرار وتعظم تبعات الله عند العباد، فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون فيه».
وقال في التعاون بين الراعي والرعية:
«… ولكن من واجب حقوق الله على العباد: النصيحة بمبلغ جهدهم، والتعاون على إقامة الحق بينهم، وليس امرؤ ـ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته ـ بفوق أن يعاون على ما حمله الله من حقه. ولا امرؤ ـ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون ـ بفوق أن يعين على ذلك أو يعان عليه».
محمد مهدي شمس الدين
الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر عند علي (ع)
من فرائض الإسلام الكبرى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد ورد تشريع هذه الفريضة في الكتاب الكريم والسّنّة الشّريفة في عدة نصوص دالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر على جميع المسلمين بنحو الواجب الكفائي([374]).
كما وردت نصوص أخرى كثيرة في الكتاب والسّنّة، منها ما يشتمل على بيان الشّروط التي يتنجز بها وجوب هذه الفريضة على المسلم. ومنها ما يضيء الجوانب السياسية والاجتماعية لهذه الفريضة، كما يوضح المبدأ الفكري الإسلامي العام الّذي ينبثق منه هذا التّشريع، دلّ على وجوب هذه الفريضة من الكتاب الكريم قوله تعالى:
﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾([375]).
فقد دلّت هذه الآية على وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من وجهة دلالة لام الأمر في «ولتكن» على الوجوب.
كما أنّ ظاهرها أنّ الواجب هنا كفائي لا عيني، لأن مفاد الأمر تعلّق بأنّ تكون في المسلمين أُمة تأمر وتنهى، لا بجميعهم على نحو العينيّة الاستغراقيّة وعليه فإذا قامت جماعة منهم بهذا الواجب سقط الوجوب عن بقيّة المكلّفين كما هو الشّأن في الواجب الكفائي.
ولم يحدّد في القرآن والسّنّة عدد مخصوص لأفراد هذه الأمّة، فيراعى في عدد الأفراد القائمين بالواجب مقدار الوفاء بالحاجة.
وقد جعل الله تعالى في كتابه الكريم وعي هذه الفريضة، وأدائها حين يدعو وضع المجتمع إلى ذلك، من صفات المؤمنين الصّالحين، فقال تعالى:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾([376]).
فقد دلّت الآية المباركة على تضامن المؤمنين بعضهم مع بعض في عمل الخير والبرّ والتقوى، وأنّهم جميعاً من جنود هذه الفريضة حين يدعوهم الواجب إليها.
وسياق الآية الكريمة دالّ على وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، من حيث أنّ بقيّة ما ورد في الآية كلّه من الواجبات المعلومة في الشريعة (الصّلاة، والزّكاة، وطاعة الله ورسوله)([377])، وإنْ لم تكن الدّلالة السّياقيّة من الدّلالات التي لها حجيّة في استظهار الأحكام الشّرعية.
كما ورد مدح المؤمنين والمؤمنات ـ كأفراد ـ في الآية الآنفة، فقد ورد في آية أخرى مدح المسلمين كافّة ـ كأمة ومجتمع ـ من حيث وعيهم لهذه الفريضة وعملهم بها، وتلك هي قوله تعالى:
﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾([378]).
وقد مدح الله في كتابه الكريم المسلمين من أهل الكتاب، أتباع الأنبياء السّابقين قبل بعثة النّبيّ محمّد (ص) بوعيهم لهذه الفريضة والعمل بها، ممّا يكشف عن إنّها فريضة عريقة في الإسلام منذ أقدم عصوره وصيغهِ، وأنّها قد كانت فريضة ثابتة في جميع مراحله التّشريعيّة التي جاء بها أنبياء الله تعالى جيلاً بعد جيل. قال تعالى:
﴿* لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾([379]).
وقد كان إحياء هذه الفريضة، وجعلها إحدى هواجس المجتمع من شواغل أمير المؤمنين علي (ع) الدّائمة. وقد تناولها في خطبه وكلامه ـ كما تعكس لنا ذلك النّماذج التي اشتمل عليها نهج البلاغة ـ من زوايا كثيرة:
تناولها كقضيّة فكريّة لا بدّ أنْ توعى لتغني الشّخصية الواعية، وباعتبارها قضية تشريعية تدعو الأمّة والأفراد إلى العمل.
ومن هذين المنظورين عالجها بعدة أساليب.
لقد أعطاها منزلة عظيمة، تستحقها بلا شك، بين سائر الفرائض الشرعيّة، فجعلها إحدى شعب الجهاد الأربع: «… والجهاد منها ـ من دعائم الإيمان ـ على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين، فمَن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين ومَن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ومن شنىء الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة» وجعل الإمام هذه الفريضة، في كلام له آخر تتقدم على أعمال البر كلها، فقال:
«… وما أعمال البِرِّ كلها، والجهاد في سبيل الله عِند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلاَّ كنفثة في بحر لُجيٍّ…».
ومن السهل علينا أن نفهم الوجه في تقدّم هذه الفريضة على غيرها إذا لاحظنا أنّ أعمال البرّ تأتي في الرّتبة بعد استقامة المجتمع وصلاحه المبدئي ـ الشّرعي والأخلاقي ـ وأنّ الجهاد لا يكون ناجعاً إلاّ إذا قام به جيش عقائدي، وهذه كلّها تتفرع من الوعي المجتمعي للشريعة والأخلاق، ومن الحد الأدنى للالتزام المسلكي بهما.
في بعض كلماته بيّن الإمام جانباً من الأسباب الموجبة لهذا التّشريع، فقال:
«فرض الله… والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ردعاً للسفهاء».
فعامّة النّاس الذين قد يقعون في إثم ترك الواجبات لأنّهم لا يعرفونها على وجهها أو يجهلونها، يمكّنهم الأمر بالمعروف من التعلّم والتفقّه، بالإضافة إلى أولئك الّذين يقعون في إثم ترك الواجب وهم يعرفون الواجب والحرام حيث يردّهم الأمر بالمعروف إلى جادّة الصّواب والاستقامة، كما يرد إليه السّفهاء الّذين يتجاوزون في لهوهم وعبثهم حدود الله.
وللأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر مراتب متدرجة من الأدنى إلى الأعلى، فهي فريضة مرنة تستجيب للحالات المتنوعة وللأوضاع المختلفة. فربّ إنسان تنفع في ردعه الكلمة، وربّ إنسان لا ينفع في شأنه إلاّ العنف.
ولكلّ حالة طريقة أمرها ونهيها الّتي يقدرها الآمر والنّهي العارف، ويتصرّف بقدرها فلا يتجاوزها إلى ما فوقها حيث لا تدعو الحاجة إليه، ولا ينحط بها إلى ما دونها بحيث لا يؤثّر ذلك في ردع السّفيه عن غيّه وحمله على الاستقامة والصّلاح.
وثمّة حالات من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لا بدّ فيها من القتال، وهذه حالات تحتاج أن يقود عملية الأمر والنهي فيها الحاكم العادل وفي هذه الحالات الخطيرة جداً لا يجوز لآحاد الناس أو جماعاتهم أن يقوموا به دون قيادة حاكم شرعي عادل!
وإذا كانت مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتدرج صاعدة من الإنكار بالقلب إلى الإنكار باللّسان إلى الإنكار باليد، وللإنكار باللّسان درجات وللإنكار باليد درجات…
وإذا كانت الحالات العادية للأمر والنّهي تتفاوت في خطورتها وأهميتها بما يستدعي هذه المرتبة من الإنكار أو تلك…
فإنّ الحالات الكبرى الّتي لا بدّ فيها من تدخل الحاكم العادل والأمّة كلّها قد تبلغ درجة من الخطورة لا بدّ فيها من الإنكار بالقلب واللّسان وأقصى حالات الإنكار باليد ـ أعني القتال.
وهذا هو ما كان يواجهه المجتمع الإسلامي في عهد الإمام (ع)، متمثلاً تارة في ناكثي البيعة الّذين خرجوا على الشرعيّة واعتدوا على مدينة البصرة، ولم تفلح دعوته لهم بالحسنى في عودتهم إلى الطاعة واضطروه إلى أن يخوض ضدّهم معركة الجمل في البصرة. أو المتمردين على الشرعية في الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان الّذي رفض جميع الصيغ السّياسيّة الّتي عرضها عليه الإمام ليعود من خلالها إلى الشرعية. أو المارقين الخوارج على الشرعية والّذين رفضوا كلّ عروض السّلام الّتي قُدِّمت لهم، وأصروا على الفتنة ومارسوا الإرهاب ضدّ الفلاحين والآمنين والأطفال والنّساء.
في هذه الحالات وأمثالها على المسلم المستقيم أن يبرأ من الانحراف في قلبه وأن يدينه علناً بلسانه، وأن ينخرط في أيّ حركة يقودها الحاكم العادل لتقويم الانحراف بالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك.
قال (ع)، فيما يبدو أنه تقسيم لمواقف النّاس الّذين كان يقودهم من المنكر المبدئي الخطير الّذي كان يهدّد المجتمع الإسلامي كلّه في استقراره، وتقدمه، ووحدة بنيه:
«فمنهم المنكرُ للمنكرِ بيده ولسانه وقلبه، فذلك المستكمل لخصال الخير. ومنهم المنكرُ بلسانه وقلْبه والتَّارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومُضيّع خصلة، ومنهم المنكرُ بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة ومنهم تارك لإنكارِ المُنكرِ بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الأحياء».
ونلاحظ أن الإمام سمّى التّارك في هذه الحالة الخطيرة، لجميع مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر «ميّت الأحياء» ونفهم صدى هذا الوصف إذا لاحظنا أن إنساناً لا يستشعر الأخطار المحدقة بمجتمعه، ولا يستجيب لها أيّ استجابة، حتى أقل الاستجابات شأناً وأهونها تأثيراً، وأقلها مؤونةً وهي الإنكار بالقلب الّذي يقتضيه مقاطعة المنكر واعتزال أهله ـ إنّ إنساناً كهذا بمنزلة الجثة الّتي لا تستجيب لأيّ مثير لأنّها خالية من الحياة الّتي تشعر وتستجيب.
ويقول عبدالرحمان بن أبي ليلى الفقيه وهو ممن قاتل مع الإمام في صفّين، أنّ الإمام كان يقول لهم حين لقوا أهل الشّام:
«أيها المؤمنون. إنه من رأى عدواناً يعمل به، ومنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء، ومَنْ أنكره بلسانه فقد أُجِرَ، وهو أفضل من صاحبه. ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظّالمين هي السفلى فذلك الّذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق، ونوَّرَ في قلبه اليقين».
ونلاحظ هنا أنّ الإمام وضع للإنكار بالسّيف ـ وهو أقصى مراتب الإنكار باليد ـ شرطاً، هو أن تكون الغاية منه إعلاء كلمة الله لا العصبيّة العائلية أو العنصريّة، ولا المصلحة الخاصة، والعاطفة الشّخصية. وهذا شرط في جميع أفعال الإنسان، وفي جميع مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، إلاّ أنّ الإمام (ع) صرّح به في هذه المرتبة لخطورة الآثار المترتبة على القيام بها من حيث أنّها قد تؤدّي إلى الجرح والقتل.
ويقدّر الإمام أنّ كثيراً من الناس يتخاذلون عن ممارسة هذا الواجب الكبير فلا يأمرون بالمعروف تاركه ولا ينهون عن المنكر فاعله بسبب ما يتوهمون من أداء ذلك إلى الإضرار بهم: أن يعرضوا حياتهم للخطر، أو يعرضوا علاقاتهم الاجتماعية للاهتزاز والقلق، أو يعرضوا مصادر عيشهم للانقطاع… وما إلى ذلك من شؤون.
ولقد لحظ الشارع هذه المخاوف، فجعل من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم ترتب ضرر معتدٍّ به على الآمر والناهي.
ولكنّ كثيراً من الناس لا يريدون أن يمسّهم أيّ أذى أو كدر. وهذا موقف ذاتي وأناني شديد الغلوّ لا يمكن القبول به من إنسان يفترض فيه أنه ملتزم بقضايا مجتمعه كما هو شأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فهو إنسان يستبدّ به القلق لأيّ انحراف يراه، ويدفعه قلقه وأخلاقه إلى أن يتصدّى للانحراف بالشّكل المناسب، وهو الذي قال فيه الإمام في النصّ السّابق «المستكمل لخصال الخير».
لقد نبّه الإمام ـ في موضعين من نهج البلاغة على أنّ التّخاذل عن الأمر والنهي خشية التعرض للأذى ناشىء عن أوهام ينبغي أن يتجاوزها المؤمن الملتزم بقضية مجتمعه، فلا يجعلها هاجسه الَّذي يشلّه فيحول بينه وبين الحركة المباركة المثمرة، فقال الإمام فيما خاطب به أهل البصرة في إحدى خطبه، وقد كانوا بحاجة إلى هذا التَّوجيه، لما شهدته مدينتهم، وتورّط فيه كثير منهم في فتنة الجمل.
«وإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله سبحانه، وإنهما لا يقرِّبان من أجلٍ، ولا ينقصان من رزق».
ونوجّه النظر إلى قوله (ع) أنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر خلقان من خلق الله عزّ وجلّ، فالله هو الآمر بكلّ معروف، والناهي عن كلّ منكر، وإذن فإنّ المؤمن الملتزم بقضية مجتمعه الواعي للأخطار المحدقة به، يمتثل ـ حين يأمر وينهى ـ لله تعالى ويتبع سبيله الأقوم.
وقال الإمام في موقف آخر:
«وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يُقرِّبان من أجلٍ ولا ينقصان من رزق».
قلنا إنّ إحياء هذه الفريضة، وجعلها إحدى هواجس المجتمع الدّائمة، وإحدى الطّاقات الفكرية الحيّة المحرّكة للمجتمع كان من شواغل الإمام الدّائمة.
وكان يحمله على ذلك عاملان.
أحدهما إنّه إمام المسلمين، وأمير المؤمنين، ومن أعظم واجباته شأناً أن يراقب أمّته، ويعلّمها ما جهلت، ويعمّق وعيها مما علمت، ويجعل الشّريعة حيّة في ضمير الأمة وفي حياتها.
وثانيهما هو قضيته الشّخصيّة في معاناته لمشاكل مجتمعه الدّاخلية والخارجية في قضايا السياسة والفكر.
فقد كان الإمام يواجه في مجتمعه حالة شاذة لا يمكن علاجها والتغلب عليها إلاّ بأن يجعل كلّ فرد بالغ في المجتمع ـ والنّخبة من المجتمع بوجه خاص ـ من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كلّ موقف تدعو الحاجة إليهما وخاصة في المواقف الخطيرة، قضية التزام شخصي واع وصارم.
لقد شكا الإمام كثيراً من النّخبة في مجتمعه، وأدان هذه النّخبة بأنّها نخبة فاسدة في الغالب لأنّها لم تلتزم بقضية شعبها ووطنها وإنّما تخلّت عن هذه القضية سعياً وراء آمال شخصية وغير أخلاقية…
أكثر من هذا: لقد اتّهم الإمام هذه النخبة مراراً بأنّها خائنة. ومن مظاهر عدم التزامها بقضية شعبها أو خيانته هو تخليها الّذي لا مبرّر له عن ممارسة واجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وإذ يئِس الإمام من التأثير الفعّال في هذه النّخبة فقد توجّه بشكواه رأساً إلى عامة الشّعب محاولاً أنْ يحركه في اتجاه الالتزام العملي بقضيته العادلة، موجهاً وعيه نحو الأخطار المستقبلية، محذراً له من تطلّعات نخبته.
نجد هذه التّوجه نحو عامة الشعب مباشرة ظاهراً في الخطبة القاصعة التي تضمّنت ألواناً من التّحذير، النّابض بالغضب، من السقوط في حبائل النّخبة.
وكانت قضية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ـ فيما يبدو ـ والتراخي أو اللاّمبالاة الّتي تظهرها النّخبة نحو هذه القضية ـ إحدى أشدّ القضايا إلحاحاً على ذهن الإمام وأكثرها خطورة في وعيه.
وكان أسلوب التّنظير بالتاريخ إحدى الوسائل الّتي استعملها الإمام في تحذيره لشعبه وفي تعليمه الفكري لهذه الفريضة.
لقد كانت شكواه وتحذيراته المترعة بالمرارة والألم نتيجة لمعاناته اليومية القاسية من مجتمعه بوجه عام ومن نخبة هذا المجتمع بوجه خاص.
ولا بدّ أنّ هؤلاء وأولئك قد سمعوا من الإمام مراراً كثيرة مثل الشّكوى التّالية الّتي قالها في أثناء كلام له عن صفة من يتصدّى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل:
«إلى الله أشكو من معشر يعيشون جُهَّالاً ويموتون ضلاَّلاً. ليس فيهم سلعة أَبْوَر([380]) من الكتاب إذا تُلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب إذا حُرّف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر».
كان النّهج الّذي سار عليه الإمام في حكمه نهج الإسلام الذي يستجيب لحاجات عامّة الناس في الكرامة، والرّخاء، والحرّية.
وكان هذا النّهج يتعارض، بطبيعة الحال، مع مصلحة طبقة الأعيان وزعماء القبائل الّذين اعتادوا على الاستمتاع بجملة من الامتيازات في العهد السّابق على خلافة أمير المؤمنين علي (ع).
وقد كان لهذه الطّبقة ذات الامتيازات أعظم الأثر في الحيلولة بشتّى الأساليب دون تسلّم الإمام للسّلطة في الفرص الّتي مرّت بعد وفاة رسول الله (ص)، وبعد وفاة أبي بكر، وبعد وفاة عمر، ولكنَّه بعد وفاة عثمان تسلّم السلطة على كراهية منه لها، وعلى كراهية من النّخبة له، فقد قبلت به مرغمة لأن الضغط الذي مارسته الأكثرية الساحقة من المسلمين في شتّى حواضر الإسلام شلّ قدرة النّخبة المالية وطبقة الأعيان على التأثير في سير الأحداث، فتكيّفت مع الوضع الجديد الّذي وضع الإمام علياً ـ بعد انتظار طويل ـ على رأس السّلطة الفعليّة في دولة الخلافة.
وقد كشفت الأحداث الّتي ولدت فيما بعد عن أنّ هذا التكيّف كان مرحليّاً، رجاء أن تحتال في المستقبل، بطريقة ما ـ لتأمين مصالحها وامتيازاتها.
وحين يئست طبقة الأعيان هذه من إمكان التأثير على الإمام وتبدّدت أحلامهم في تغيير نهجه في الإدارة وسياسة المال وتصنيف الجماعات تغييراً ينسجم مع مصالحهم فيحفظ لها مراكزها القديمة، ويبوّئها مراكز جديدة، ويمدّها بالمزيد مِن القوة والسّلطات على القبائل والموالي من سكان المدن والأرياف… حين يئست هذه الطّبقة من كلّ هذا وانقطع أملها… طمع كثير من أفراد هذه الطّبقة بتطلّعاته إلى الشّام ومعاوية بن أبي سفيان، فقد رأوا في نهجه وأسلوبه في التعامل مع أمثالهم ما يتفق مع فهمهم ومصالحهم.. وتخاذل بعض أفرادها عن القيام بواجباتهم العسكرية في مواجهة النشاط العسكري المتزايد الّذي قام به الخارجون عن الشّرعية في الشّام، هذا النشاط الّذي اتّخذ في النّهاية طابع الغارات السريعة وحروب العصابات.
وكان تخاذلاً لا يمكن تبريره بجبنهم فشجاعتهم ليست موضع شك على الإطلاق.
ولا يمكن تبريره بقلّتهم، فقد كانت الأمّة قادرة أن تزود حكومتها الشرعية بجيوش جرّارة وجنود أقوياء مدرّبين جعلت منهم طبيعتهم، وثقافتهم، وحروب الفتح التي خاضوها مدة سنوات طويلة من خير المقاتلين في العالم.
ولا يمكن تبريره بنقص في التّسليح وعدة الحرب وعتادها، فقد كانت معامل السّلاح نشطة لتأمين احتياطي ضخم من السّلاح لمجتمع كان لا يزال محارباً.
ولا يمكن تبريره بسوء الحالة الاقتصاديّة، فقد كان المال العام وفيراً بعد أنْ أصلحت الإدارة الماليّة في خلافة الإمام.
لم يكن إذن ثمة سبب للتَّخاذل سوى الموقف السّياسي غير المعلن الّذي صممت النّخبة من الأعيان وزعماء القبائل على التّمسك به والتّصرّف في القضايا العامّة وفقاً له، إلى النّهاية، وذلك يهدف تفريغ حكومة الإمام علي من قوة السّلطة، وجعلها عاجزة عن الحركة بسبب عدم توفر الوسائل الضّرورية لها، وهذا ما يؤدّي في النّهاية إلى انتصار التَّمرّد على الشّرعية.
كان هذا الموقف السّياسي غير المعلن هو سبب التَّخاذل.
وقد كان هذا الموقف غير معلن، بل كان قادة هذه النّخبة يوحون بإخلاصهم وتفانيهم، لأنّ هذه النخبة كانت تخاف، إذا أعلنت موقفها وكشفت عن نواياها وأهدافها البعيدة وأمانيها المخزية، من جمهور الأمّة أنْ يكشف لعبتها ضد آماله ومصالحه، فيدينها ويعاقبها.
وقد حفظ لنا الشريف في نهج البلاغة نصوصاً كثيرة يلوم فيها الإمام نخبة مجتمعه لوماً قاسياً مرّاً على تراخيهم وتخاذلهم عن القيام بالتزاماتهم العسكرية في الدّفاع عن الشرعية، ولا شكّ أنّ الإمام في آخر عهده كان مضطرّاً للإكثار من هذا اللّوم والتقريع، كقوله في إحدى خطبه:
«ألاَ وإنّي قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً، وسرّاً وإعلاناً، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غُزِي قوم قط في عقر دارهم([381]) إلاّ ذلُّوا، فتواكلتم وتخاذلتم([382])، حتى شُنَّت([383]) عليكم الغارات، ومُلكت عليكم الأوطان…
فيا عجباً! عجباً والله يميت القلب، ويجلب الهمَّ، من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، وتفرقكم عن حقكم! فقبحاً لكم وترحاً([384]) حين صرتم غرضاً يرمى: يُغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون».
«فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم: هذه حمَّارَة القيظ أمهلنا يسبَّخ عنا الحرُّ([385])، وإذا أمرتكم بالسّير إليهم في الشتاء قلتم: هذه صَبَّارة القُرِّ([386])… كل هذا فراراً من الحر والقر، فإذا كنتم من الحر والقر تفرُّون، فأنتم والله من السيف أفرُّ».
«يا أشباه الرجال ولا رجال! حلومُ الأطفال، وعقول ربَّات الحجال([387]) لوددتُ أني لم أرَكم ولم أعرفكم معرفة ـ والله ـ جرَّت ندماً وأعقبت سدماً»([388]).
«قاتلكم الله! لقد ملأتم قلبي قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً، وجرعتموني نغب التهمام أنفاساً([389]) وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتَّى لقد قالت قريش: إنّ ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا عِلم له بالحرب، لله أبوهم وهل أحدٌ منهم أشدُّ لها مِراساً وأقدمُ فيها مقاماً مني لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين وهأنذا قد ذرَّفتُ([390]) على الستين! ولكن لا رأي لمن لا يطاع».
بهذه المرارة وبهذا الغضب، وبهذه السّخرية، وبهذا الاحتقار كان الإمام يواجه هذه النخبة الّتي تخاذلت عن القيام بواجبها، أو خانت قضية شعبها.
ويبدو أن هذه الطبقة ـ أو فريقاً منها ـ كانت تحاول، ستراً لمواقفها التي عمل الإمام على فضحها، أنْ تتظاهر في بعض الحالات بالغيرة والحميّة الدّينية، فتتخذ مواقف لفظية آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر دون أنْ تترجم ذلك إلى أفعال وممارسة عملية، شأنها في ذلك شأن الكثيرين ممّن يسترون خياناتهم وأنانيتهم، وحرصهم على المتاع الدّنيوي بالمواقف الأخلاقية اللّفظية.
ولكنّ الإمام عليّاً(ع) كان يعرف هؤلاء، ومن السّهل معرفتهم في كلّ زمان، وكان يفضح هذه المواقف المنافية بقسوة، لأنها تضيف إلى جريمة الخيانة السّياسيّة رذيلة النّفاق والتّمويه على بسطاء النّاس، فيقول مبصِّراً مجتمعه بفساد العلاقات الناشىء عن فساد النّخبة:
«… وهل خُلقتم إلا في حُثالة([391]) لا تلتقي إلا بذمهم الشفتان، استصغاراً لقدرهم، وذهاباً عن ذكرهم، فإنّا لله وإنا إليه راجعون».
«ظهر الفساد فلا منكر مغيِّر، ولا زاجر مزدجر. أفبهذا تريدون أنْ تجاوروا الله في دار قدسه، وتكونوا أعزَّ أوليائه عنده؟ هيهات! لا يخدع الله عن جنته ولا تنال مرضاته إلاّ بطاعته».
«لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، والنّاهين عن المنكر العاملين به».
وإذا كانت مصلحة الحكم المستبد الطبقي أو الفئوي تقضي بأن يصمت الشعب ولا يرتفع منه صوت اعتراض أو احتجاج، أو إدانة مهما أصابه من مظالم، ومهما حل بحقوقه من انتهاكات، فإن مصلحة الحكم الشّعبي الملتزم بالمصالح الحقيقية للناس العاديّين البسطاء هي على العكس من ذلك… إنّ مصلحة هذا الحكم الّذي يستمد فاعليته وقوته من مجموع الشعب هي في أنْ يتكلّم الناس في الشّأن السّياسي مؤيدين أو منتقدين لحماية مصالحهم الحقيقيّة في مواجهة البنى العليا في المجتمع التي تتبع سياسات مضادّة لمصالح مجموع الشعب على المدى القريب أو البعيد، والّتي تعمل باستمرار لتكوين حالات اجتماعية، ومشاغل واهتمامات فكريّة تصرف فئات الشعب عن مصالحها الجوهرية([392]) وتقعد بها عن مساعدة الحكم الشّعبي الّذي يمثل هذه المصالح ويعمل لتحقيقها، هذا إذا لم تفلح هذه البنى العليا في أنْ تؤلّب بعض فئات الشّعب ـ نتيجة للتّضليل ـ ضد هذا الحكم.
وسكوت الشّعب في حالة النّشاط المعادي الّذي تقوم به البنى العليا، أو عدم مبالاته، بترك السّاحة خالية أمام هذه القوى لتفسد على الحكم الشّعبي سياساته المستقبليّة دون أن تخشى عقاباً، لأنّ الحكم في هذه الحالة يقف في مواجهة تلك القوى وهو أعزل، وهذا يمنعها من التّغلب عليه أو من تجاوزه.. وهذا ما كان يحدث في كثير من الحالات في عهد الإمام (ع)، وكان يثير غضبه على النّخبة لفسادها، ويحمله على كشف عيوبها أمام أعين النّاس.
لقد كان الإمام (ع) حريصاً أشدّ الحرص على أنْ يحرّك الجماهير ويدفع بها دوماً إلى أنْ تعبّر عن رأيها، وتعلن عن مواقفها.
وتعكس لنا النّصوص إدراك الإمام العميق للأهميّة الكبرى والحاسمة التي تبيّنها هذه المسألة في عمله السّياسي، وذلك في مظهرين:
الأول: كثرة المناسبات الّتي أثار فيها الإمام موضوع الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وتنوّع الأساليب الّتي شرحه بها. هذا أمر ملفت للنّظر بالنّسبة إلى حكم شرعي ثابت في القرآن الكريم والسّنّة النبوية ويعتبره الفقهاء من الأحكام القطعية الضّرورية، إنّ هذا الاهتمام المستمر على مسألة الأمر والنّهي يكشف عن أنّ الإمام كان يواجه في المجتمع حالة غفلة عن الحكم الشّرعي بوجوب الأمر والنهي، وحالة تراخ عن القيام بهذه الفريضة الإسلامية على وجهها، وهذه الغفلة وهذا التراخي حملاه على أنّ يذكّر المسلمين بفريضة الأمر والنّهي ما استطاع.
الثّاني: عنف الأسلوب الذي عبّر به الإمام عن أفكاره وعن معاناته حين كان يوجّه خطاباته إلى المسلمين في هذا الموقف أو ذاك مقرّعاً لائماً، أو مشجعاً حاثاً لهم على أداء هذه الفريضة.. وهو ما يكشف عن أنّ الإمام يعاني من قلق عميق وغضب مكبوت نتيجة لما يراه في المجتمع من إهمال وتراخ.
قد حثّ الإمام المسلمين على الالتزام العملي بفريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في حياتهم العامّة وعلاقاتهم الاجتماعية والسّياسّة بأساليب متنوعة، ونظر إليها من زوايا متعدّدة.
ومن جملة الأساليب الّتي اتّبعها في تعليمه الفكري والسّياسي بالنّسبة إلى هذه الفريضة أسلوب التّنظير التّاريخي، فمن ذلك قوله في الخطبة القاصعة:
«وإنَّ عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه، وأيّامه ووقائعه، فلا تستبطئوا وعيده جهلاً بأخذه، وتهاوناً ببطشه، ويأساً من بأسه، فإنَّ الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم، إلاَّ لِتَركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلعن الله السفهاء لركوب المعاصي، والحلماء لترك التناهي».
نلاحظ أنّ الإمام عبّر في هذا النّص، كما في نصوص أخرى ـ عن إنكاره بشأن ما يراه في مجتمعه من تهاون وتراخ في امتثال فريضة الأمر والنّهي، بأسلوب شديد الوقع يتجاوز النصيحة الرّقيقة الهادئة إلى الإنذار الشّديد، والتّحذير من أهوال كبرى مقبلة واستعان على تصوير ذلك بالتذكير بما حلّ في القرن الماضي من اللعن نتيجة لإهماله هذه الفريضة أو تراخيه عن القيام بها.
واللّعن هنا ليس عقاباً روحياً وأخروياً فقط، إنّه هنا يأخذ معنى سياسيّاً، إنّ اللّعن هو البعد عن رحمة الله ورعايته، وهذا يعني أنّ الملعون يتعرّض للنّكبات السياسيّة والاجتماعيّة الّتي تؤدي به في النهاية إلى الانحطاط والانهيار.
والظاهر أنّ الإمام يعني بالقرن الماضي الإسرائيليّين، فإنّ في كلامه هنا قبساً من الآية الكريمة:
﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾([393]).
في النص التالي اتّبع الإمام أسلوب التّنظير بالتاريخ أيضاً في تعليمه الفكري لمجتمعه بشأن فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، معيداً إلى أذهان مستمعيه قصة ثمود القرآنية، والنّكبة المرعبة الّتي أبادتهم حين عصوا أمر الله تعالى إليهم في شأن ناقة نبيهم صالح (ع).
وليس من همنا هنا عرض الحادث التاريخي القرآني وإّنما نبغي الكشف عن استخدام الإمام للتاريخ في تعليمه الفكري.
والإمام في التنظير الوارد في النص التّالي يثير مسألة ذات أهمية بالغة في العمل السّياسي، وهي أنّ حركة التاريخ تقودها دائماً جماعة قليلة العدد من الناس تملك القدرة على الحركة فتبادر إلى اتخاذ المواقف، في حين أن غيرها من الناس يكون في حالة سكون، فتكوّن بحركتها وقائع جديدة تحمل الناس على قبولها، وتضع السّلطة أمام أمر واقع.
وحين تكون هذه الجماعة المتحركة القليلة العدد ملتزمة بقضايا مجتمعها، عاملة في سبيل مصلحته، فإنّ واجب المجتمع أن يساندها ويقدّم لها العون المعنوي والمادّي في جهادها.
أمّا حين تعمل هذه الجماعة ضد مصالح المجتمع العليا والحقيقة ـ رغم ما توشّي به عملها من ألوان خادعة ـ فإنّ على المجتمع أن يتحرك ويقف في وجهها، ويلجم اندفاعها ذوداً عن مصالحه.
أمّا سكوت المجتمع وسكونه وسلبيته تجاه مواقف هذه الجماعة فإنّه جريمة يرتكبها في حق نفسه، لأن الكارثة حين تقع في النهاية نتيجة لأعمال الجماعة المتحركة لا تميّز بين المسبّبين لها وبين السّاكتين عنها. إنّها حين تقع تصيب بشرورها المجتمع كله، بل لعلّها، في قضايا السياسة والفكر، تصيب السّاكتين عنها أكثر مما تصيب المسببين لها، والّذين تكمن مصلحتهم في الانحراف والتزوير.
ومن هنا فإنّ ما اصطلح عليه في لغة السّياسة في هذه الأيام باسم الأكثريّة الصامتة، هذه الأكثريّة التي لا تبدي فيما يجري أمامها وعليها ولا تعيد، وإنما تقبل ما يقوم به الآخرون مختارة أو مرغمة، راضية أو ساخطة،… هذه الأكثرية الصّامتة بموقفها هذا تقوم بدور الخاذل للحق أو المتواطىء على الجريمة.
وذلك لأن الصّمت في هذه الحالات ليس علامة على البراءة والطّيبة، وإنّما هو علامة الجبن والغفلة والفرار من المسؤولية.
وهذه السّلبية الّتي هي في مستوى الجريمة لا تعفى من العقاب، والعقاب في هذه الحالة لا تقوم به السلطة وإنّما تقوم به القوانين الاجتماعية الّتي تصنع الكارثة، يقوم به القدر الّذي لا يميز بين السّاكن والمتحرك وإنّما يجرف الجميع، يقوم به الله تعالى الّذي يؤاخذ الجميع بذنوبهم: المتحركين بذنب المعصية، والساكتين بذنب توفير أجواء الجريمة أمام المجرمين ليرتكبوا جرائمهم.
ولذا، فإنّ الأكثرية الصّامتة، من هذا المنظور، لا تضمّ أبرياء، وإنّما تضمّ متواطئين وجبناء، سبّبوا، بإيثارهم للسّلامة الشخصية العاجلة، كوارث عامّة مستقبليّة، وجبنهم الّذي يكشف عن أنانيتهم الرّخيصة والذلّيلة يكشف عن أنّهم ليسوا جيلاً صالحاً لأن يبني حياة مزدهرة.
إنّ الكوارث الاجتماعية، كالكوارث الطّبيعيّة، تجرف في طريقها، حين تقع النّبات النّافع والنّبات الضّار، ولا تميّز بينهما في الدّمار.
«… وإنَّه سيأتي عليكم من بعدي زمانٌ ليس فيه شيء من الحق، ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، فقد نبذ الكتاب يومئذٍ حملته، وتناساه حفظته فالكتاب يومئذٍ وأهله طريدان منفيان، وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مُؤْو.. فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم، ومعهم وليسا معهم، لأنَّ الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا…».
وتصور الفقرة الأخيرة من هذا النّص أبلغ تصوير واقع الانفصال بين الأمة وبين قيادتها الفكريّة نتيجة لاغترابها الثقافي، وانفصالها ـ في مجال تكوين المفاهيم والتوجيه ـ عن أُصولها الفكرية.
وهذا الاغتراب الثّقافي ـ الحضاري النّاشىء عن هجر الأصول ـ وليس عن التفاعل مع الآخرين ـ يؤدّي إلى موقف في المنكر والمعروف خطير، فإنّ ثمّة مقياسَيْنِ للقيم والمثل الأخلاقية. أحدهما المقياس الموضوعي، والآخر المقياس الذّاتي.
المقياس الموضوعي هو الّذي يجعل شريعة المجتمع وعقيدته منبعاً للقيم الأخلاقية ففي مجتمع إسلامي، مثلاً، يكون منبع القيم هو العقيدة والشّريعية الإسلاميتان.
وكذلك الحال في مجتمع مسيحي مثلاً أو بوذي.
وهذا المقياس يقضي بأن يكون المجتمع ملتزماً بعقيدته وشريعته في مؤسساته ونظمه وعلاقاته بدرجة تجعله تعبيراً عن تلك العقيدة والشّريعة.
والمقياس الذّاتي هو الّذي يجعل منبع القيم الأخلاقية شخص الإنسان، فالإنسان في هذه الحالة هو الّذي يخترع أخلاقياته وقيمه الّتي تكيّف سلوكه تجاه المجتمع وعلاقاته في داخل المجتمع، ويستبعد هذا المقياس أي مصدر للقيم خارج الذّات للقيم والأخلاقيّات.
قال (ع):
«أيها الناس. إنما يجمع الناس الرضى والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد، فعمهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضى».
وقد حذّر الإمام مجتمعه في إحدى استبصاراته نحو المستقبل من وضعيّة فكريّة وثقافية تؤدّي إلى هجر الأصول الثقافية والفكرية التي تكوّن روح المجتمع الإسلامي وتسمه بطابعه الخاص المميّز له عن سائر التجمعات الثقافية ـ الحضارية، وتعطيه دوره المميّز والخاص في حركة التاريخ العالمي وبناء الحضارة… وتؤدّي به ـ نتيجة لانبثاقه عن أصوله ـ إلى أن يكون نسخة من ثقافة أخرى، ووحدة من وحدات حضارة أخرى، وتغدو الأصول الثقافية التي ترجع كلّها إلى الكتاب والسّنّة مجرّد أشكال يتداولها النّاس دون أن يكون لها دور في تكوين المفاهيم، وبناء الشخصية، ورسم طريق العمل.
إنّ المسلمين أنفسهم، يومئذٍ، سينبذون الكتاب باعتباره مصدراً للمفاهيم الفكريّة، ويتّجهون نحو منابع غريبة عن ثقافتهم وحضارتهم، وعقيدتهم وشريعتهم، وتاريخهم، يستمدّون منها الغذاء العقلي والنفسي، والتوجيه السلوكي.
وننبّه هنا إلى أنّ الاغتراب الثقافي الناشىء عن هجر الأصول ـ وهو ما حذّر الإمام منه ـ غير الانفتاح الثّقافي ـ الحضاري الذي يتولّد من الطّموح إلى التفاعل مع الآخرين واكتشاف صيغهم الحضاريّة والتعرّف على فتوحهم الفكريّة مع الحفاظ على الأصول، والأمانة للذّات ومقوّماتها… فهذا الانفتاح أمر مطلوب مرغوب، وقد مارسه المسلمون وكانوا سادة فيه حين أنشأوا الحضارة الإسلامية العظيمة التي انفتحت على كلّ الإنجازات الخيّرة في الحضارات الأخرى، فاكتشفوها وكيّفوها وفقاً لقيم الإسلام، ومفاهيم الإسلام، وأخلاقيات الإسلام المستمدة من الكتاب والسّنّة والفقه.
وحينئذٍ يقع التعارض بين عقيدة المجتمع الرّسمية وشريعته، وبين أخلاقيّات وقيم أفراده وفئاته، ففي مجتمع إسلامي مثلاً، أو مسيحي أو بوذي، لا بدّ أن نكتشف ـ في حالة شيوع المقياس الذّاتي للقيم بين الأفراد ـ أن التزام المجتمع بعقيدته وشريعته التزام شكلي يرافق الإلحاد العملي.
والأثر الذي يترتب على التزام المقياس الموضوعي للقيم في المجتمع أو المقياس الذّاتي هام جداً.
أولاً: يؤدي اعتماد المقياس الموضوعي إلى نمو الفرد دون عُقد وتمزقات داخلية، لأنّه يوفّر حالة التّجانس والتّكامل بين محتوى الضّمير والعقل وبين التعبير السّلوكي في العلاقات مع المجتمع وفي داخله.
أمّا اعتماد المقياس الذّاتي فإنّه يؤدي إلى خلاف ذلك، لأنّ اتباع المقياس الذّاتي يحدث للفرد تمزقات داخلية وعُقداً في نفسه، لأنّه يجعله دائماً في حالة تعارض وتجاذب بين إلزام العقيدة والشّريعة وبين رغبات الذات باعتبارها مصدراً للقيم، ويؤدي ذلك إلى انعكاسات ضارة لا تقتصر على الأفراد، وإنما تتجاوزهم إلى المجتمع نفسه.
وثانياً: إنّ المقياس الموضوعي بما يوفّره من تجانس في داخل الفرد بين أخلاقياته من جهة ومعتقده وشريعته من جهة أخرى يؤدي إلى تلاحم واسع النطاق داخل المجتمع، ويكون لدى المجتمع نظرة واحدة إلى المشكلات، ويؤدي أيضاً إلى تكوين مواقف واحدة أو متقاربة بين الجماعات تجاه التحديات التي تواجه المجتمع.
أمّا اعتماد المقياس الذاتي فإنه يؤدي إلى العكس من ذلك. إنّه يؤدّي إلى تخلخل البنية الاجتماعية، وتعدّد الفئات ذات المنازع الفكريّة والسّياسيّة المختلفة، ويكوّن مناخاً ملائماً لتولّد المشاكل الاجتماعية وتعاظمها، لأن المقياس الذّاتي لدى الأفراد والجماعات شديد التنوّع والاختلاف.
وهذا التشرذم يؤدّي: إمّا إلى العجز عن اتخاذ مواقف موحّدة على الصّعيد القومي أو الوطني نتيجة لتعدّد الإرادات والميول، وأمّا الى الاستسلام للدّعاية السياسيّة التي يخطط لها وينفذها فريق من ذوي الأغراض والغايات الخاصة يخضع عقول الناس لمفاهيمه وقناعاته، ويحملها على قبول اختيارات قد لا تنسجم مع المصالح الحقيقية للأمّة، وإنّما تنسجم مع مصالح هذا الفريق الذي يملك وسائل الدّعاية والإعلان والإعلام، وهذا هو ما يحدث في العصر الحديث، ويؤدّي إلى كوارث كبرى على الأصعدة الوطنية في بعض الحالات، وعلى الصعيد العالمي في بعض الحالات الأخرى، حيث يعرّض سلام العالم كلّه أو سلام قارّة بكاملها لمطامح ومطامع حفنة صغيرة من الناس تكيّف عقول شعوب بكاملها، دافعة بها إلى اتخاذ مواقف سياسيّة تناقض مصالحها الوطنية، ومصالح جميع الشّعوب، وقضية فلسطين أكبر شاهد على ما نقول.
لقد نبّه الإمام (ع) إلى هذا الخطر، وحذّر منه مجتمعه، فقال: «فيا عجباً، وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفِرَق على اختلاف حججها في دينها. لا يقتصُّون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصيٍّ، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون([394]) عن عيب. يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات. المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا. مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المهمات على آرائهم، كأن كل امرىءٍ منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات».
وأخيراً، لقد بلغ من خطورة فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر عند علي (ع) أنّه جعلها إحدى وصاياه البارزة الهامة لابنَيهِ الإمامين الحسن والحسين (عليهما السلام) وقد تكرّرت هذه الوصية مرتين. إحداهما لابنه الإمام الحسن في وصيته الجامعة التي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفّين. والأخرى في وصيته للإمامين الحسن والحسين في وصيته لهما وهو على فراش الاستشهاد بعد أن ضربه ابن ملجم المرادي بالسّيف.
وقال (ع) في الوصية الأولى:
«وأْمُرْ بالمعروف تكن من أهلهِ، وانكر المنكر بيدك ولسانك وباينْ([395]) مَن فعله بجهدك وجاهد في الله حقّ جِهاده ولا تأخُذك في الله لومة لائم».
وقال (ع) في الوصية الثّانية:
«… أُوصيكما وجميع ولدي وأَهلي ومن بلغه كتابي… وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فيولَّى عليكم شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم» (راجع القاصعة).
محمد مهدي شمس الدين
الأمل عند علي (ع)
الإنسان يعيش في الحاضر مشدوداً بين وترين: الماضي والمستقبل، فهو لا يني يحمل الماضي في وعيه، وفي ذاكرته، وفي تركيب جسده، مثقلاً بأحزانه وأفراحه، ومخاوفه وآماله، ومندفعاً بها نحو المستقبل، يضيء عينيه نور الأمل الذي يغمر قلبه بالحياة الأفضل. ولكنّه أمل معذب بالحيرة، والقلق، والمخاوف من خيبات الأمل.
وهذه الحقيقة بارزة في تكوين وحياة الإنسان الفرد بوضوح، وهي لا تقلّ وضوحاً في حياة الأمم والشّعوب والجماعات.
وقد وقف الإسلام في تعليمه التّربوي الإيماني للأفراد في وجه الميل إلى الإغراق في الأمل، لأنه حين يشتدّ ويغلب على مزاج الإنسان يجعله غير واقعي، ويحبسه في داخل ذاته، وينمي فيه الشعور بـ«الأنا» على نحو لا يعود الآخرون موضوعاً لاهتمامه وعنايته أو يجعله قليل الاهتمام بهم، وهذا أمر مرفوض في دين يجعل الاهتمام الشّخصي بالآخرين أحد المقوّمات الأساسيّة للشّخصية الإنسانية السّليمة، ولأنّ الإغراق في الأمل يحول بين الإنسان وبين كثير من فرص كثيرة للتكامل الرّوحي والأخلاقي.
والنّصوص القرآنيّة في هذا الشّأن كثيرة، كذلك النّصوص النّبوية الواردة في السّنّة. وقد حفلت مواعظ الإمام عليّ في نهج البلاغة بالتّحذير من الاسترسال مع الآمال.
وهذا لا يعني ـ بطبيعة الحال ـ أنّ تأميل الإنسان في مستقبله ـ باعتدال وواقعية ـ ممارسة غير أخلاقية في الإسلام، كيف وقد حذّر الله تعالى في القرآن الكريم من اليأس ونهى عنه في آيات تذكر برحمة الله وروح الله، ومن ذلك تعليم يعقوب (ع) لبنيه حين أمرهم بالبحث عن يوسف وأخيه، وذلك كما ورد في قوله تعالى:
﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَاْيْئَسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَاْيْئَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾([396]).
فإنّ يعقوب طبق مبدأ مشروعيّة الأمل العام المطلق على حالة فردية هي حالته وحالة بنيه.
هذا على الصّعيد الفردي.
وأمّا على الصّعيد الجماعي في الأمم والشعوب والجماعات فإن الأمل عامل هامّ جداً وأساسي في تنشيط حركة التّاريخ وتسريعها، وجعلها تتغلب بيسر على ما يعترضها من صعوبات ومعوّقات.
والأمل الموضوعي القائم على اعتبارات عملية تنبع من الجهد الإنساني، واعتبارات عقيدية وروحيّة… هذا الأمل يشغل حيزاً هامّاً وأساسيّاً في تربية الله تعالى للبشريّة السّائرة في حياتها على خط الإيمان السّليم.
وقد اشتمل القرآن الكريم على آيات محكمات تتضمن وعد الله تعالى بالنّصر والعزّة لأهل الإيمان وقادتهم من الأنبياء والتّابعين لهم بإحسان.
قال الله تعالى:
﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾([397]).
وقال تعالى:
﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾([398]).
وقال تعالى:
﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾([399]).
وقد وجّه الله تعالى في القرآن الكريم رسوله محمداً (ص) والمسلمين إلى أنّ الأمل بالنّصر والحياة الأفضل يجب أن يبقى حيّاً نابضاً دافعاً إلى العمل حتَّى في أحلك ساعات الخذلان والهزيمة وانعدام الناصر… لقد كانت الآمال بالنّصر تتحقّق في النّهاية على أروع صورها حين يخالج اليأس قلوب أهل الإيمان، وحين يصل الرّسل الكرام إلى حافة اليأس:
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ * حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ * لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾([400]).
إن الأمل الجماعي بمستقبل أكثر إشراقاً وأقلّ عذاباً، أو مستقبل مترع بالفرح خال من المنغصات… إنّ هذا الأمل يستند إلى «وعد إلهي»، فهو إذن، ليس مغامرة في المستقبل، وإنما هو سير نحو المستقبل على بصيرة.
وهو أمل يرفض الواقع التّجريبي الحافل بالمعوّقات نحو مستقبل مثالي مشروط «بالعمل» المخلص في سبيل الله، وفي سبيل الله بناء الحياة، وعمارة الأرض، وإصلاح المجتمع. كما أنّ هذا المستقبل مشروط «بالصّبر» على الأذى في جنب الله، و«الصدق» في تناول الحياة والتعامل معها ومع المجتمع و«الرّضا» بقضاء الله تعالى.
والسنة حافلة بالنصوص التي تغرس في قلب الإنسان روح الأمل وتملأ وعيه ببشائر المستقبل الأفضل استناداً إلى وعد الله تعالى.
والتّأمّل العميق الواعي في نصوص الكتاب الكريم والسّنّة الشريفة التي تفصح عن العلاقة بين الله والإنسان، وتكشف عن طبيعة هذه العلاقة… كذلك التأمّل في الفقه المبني على هذين الأصلين.. إنَّ هذا التأمّل يكشف عن أنّ العلاقة بين الله والناس مبنيّة على ثلاث حقائق ربّانيّة يقوم عليها وجود المجتمع البشري، وديمومته، ونموّه وتقدّمه:
1 ـ الحقيقة الأولى هي الإنعام المطلق غير المشروط بشيء على صعيد الشّروط المادّيّة للحياة بما يكفل لها الدّيمومة والنموّ التّصاعدي نحو الأفضل، فقد خلق الله الإنسان، وزوّده بالمواهب العقليّة والنفسية والرّوحيّة، التي تتيح له أن يتعامل مع الطّبيعة المسخّرة له، وتمكنه من اكتشاف خيراتها وكنوزها، ومعرفة قوانينها وتوجيه هذه الاكتشافات والمعارف لخدمة نفسه ونوعه.
2 ـ الحقيقة الثانية هي الرّحمة الّتي «كتبها الله على نفسهِ»([401]) والّتي وسعت كلّ شيء»، وإقالة العثرات ـ على صعيد الأمم والجماعات والمجتمعات، والأفراد ـ، والتّجاوز عن الخطايا والسّيئات، ومنح الفرص المتجدّدة لتصحيح السّلوك، وتقويم الإعوجاج، والتَّوبة والإنابة إلى الله تعالى والعمل بقوانينه وشرائعه.
وهذه الحقيقة نابعة من معادلة تقابل بين حقيقتين كونيّتين:
(أ) خيرية الله الشّاملة المطلقة.
(ب) الحقيقة الموضوعيّة الثّابتة في الفكر الإسلامي، وهي أنّ الإنسان خُلِق ضعيفاً.
وما يخالف هذه الحقيقة من الآلام والكوارث فهو على قسمين:
الأول ـ ناشىء عن عمل الطّبيعة وقوانينها، وهي قوانين تعمل، في غرضها الأقصى، لخير الجنس البشري بصورة شاملة وغير مقيّدة بزمان أو رقعة جغرافيّة، وهذا ما يجعلها قوانين عادلة وإن أصابت بالآلام بعضاً من البشر في زمان أو مكان بعينه.
وهذا بالنسبة إلى الكوارث الطّبيعية التي تحصل بغير تدخل من الإنسان أو تقصير منه. أمّا ما يحدث في الطّبيعة نتيجة لعمل الإنسان نفسه أو سلبيّته. أو عدم التزام بالقوانين (في عصرنا الحاضر: تلويث البيئة، مثلاً، أو روح الاستغلال والعدوان في المجتمعات الصّناعيّة ضدّ العالم الثّالث، مثلاً)… هذا النوع من الكوارث يدخل في القسم الثّاني التّالي.
الثاني ـ ناشىء عن سوء اختيار الإنسان، واستعجاله الخير قبل توفّر شروطه ونضجها، ومن عدوان بعضه على بعض.
3 ـ الحقيقة الثالثة هي البشارة من الله تعالى بأن أمور الحياة والمجتمع تصير إلى أفضل وأحسن ممّا عليه في الحاضر. ولكن هذه البشارة لا تتحقّق بطريقة إعجازيّة محضة. إنّ تحقيق البشارة يتمّ وفاء بالوعد الإلهي، ومن ثمّ ففيها عنصر غيبي غير تجريبي، ولكن تحقيقها مشروط بالعمل البشري:
﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً﴾([402]).
﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلئِكَ هُمْ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾([403]).
﴿… وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً﴾([404]).
من هذا المنطلق الثّابت في الفكر الإسلامي، ومن البشائر المحدّدة في الكتاب الكريم والسّنّة النّبويَّة بفرج شامل آت في «النهاية» يملأ الأرض عدلاً بعدما ملئت ظُلماً وجَوراً»… من هذا المنطلق، ومن هذه البشائر كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) يرى نور الأمل في المستقبل، وكان يبشّر بأنّ فرجاً آتياً لا ريب فيه:
إنّ حركة التاريخ تقضي به، وإنَّ وعد الله يقضي به، والله لا يخلف الميعاد.
وقد كانت رؤية الإمام لحركة التاريخ في المستقبل لا تقتصر علي رؤية النّكبات والكوارث ـ كما توحي بذلك كثرة النّصوص الحاكية عن ذلك في نهج البلاغة ـ وإنما تشمل البشائر أيضاً.
وكانت رؤية الإمام دقيقة، محدّدة، مضيئة، واضحة المعالم، في نطاق الخطوط الكبرى والتّيّارات الأساسيّة لحركة التاريخ، وإن لم تشتمل على التّفاصيل، من ذلك هذا الشاهد على رؤيته لحركة الثّورة العادلة الّتي لا تنطفئ مهما تكالبت عليها الرّياح الهوج، فقد قال له بعض أصحابه، لما أظفره الله بأصحاب الجمل: «وددت أنّ أخي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك» فقال له الإمام(ع):
«أهوى أخيك معنا([405])؟، فقال: نعم. قال: فقد شهدنا. ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيعرف بهم الزَّمان([406]) ويقوى بهم الإيمان».
هذا الأمل الكبير الآتي الّذي يبشّر به الإمام (ع) يتمثّل في قيام ثورة عالميّة تصحّح وضع عالم الإسلام، ومن ثمّ وضع العالم كله، وردت في نهج البلاغة نصوص قليلة نسبياً تحدّد بعض ملامح هذا الأمل، فمن ذلك قوله (ع):
«حتى يُطلع الله لكم من يجمعكم، ويضم نشركم([407])».
ومن النّصوص الّتي اشتمل عليها نهج البلاغة في هذا الشأن قول الإمام:
«ألا وفي غد ـ وسيأتي غد بما لا تعرفون ـ يأخذ الوالي من غيرها عُمَّالها على مساوىء أعمالها، وتُخرج له الأرض أفاليذ كبدها([408]) وتُلقي إليه سِلماً مقاليدها، فيريكم كيف عدلُ السيرة، ويُحيي ميت الكتاب والسنة».
هذا الأمل المضيء في الظلمات ليس أملاً قريباً إذا نظرنا إليه بمنظار آمال الأفراد ـ كل واحد بخصوصه ـ، فقد يمضي الموت بالأفراد دون أن تكتحل عيونهم بفجر هذا الأمل… إنّه بالنسبة إليهم ـ كأفراد ـ بعيد… بعيد. كذلك هو أمل بعيد بالنّسبة إلى كلّ مجتمع بمفرده وخصوصه، فقد تمضي القرون على مجتمع دون أنْ يحقّق في نظامه، ومؤسّساته هذا الأمل العظيم.. ولكنّ هذا الأمل على مستوى النّوع البشري كلّه أمل قريب، لأنّ الأحداث الّتي تغيّر مسار الجنس البشري كلّه لا تقاس بأعمار الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات ولا بالحركة التاريخيّة في هذا النّطاق أو ذاك أو ذيّاك، وإنّما تقاس بما تناسب مع حجم النّوع الإنساني كلّه، ومع حركة التّاريخ العالمي كلّها.. إن ألف سنة، مثلاً، في عمر فرد زمن كبير طويل… كذلك الحال بالنّسبة إلى عمر حركة تاريخيّة في مجتمع من المجتمعات، ولكن ألف سنة في عمر البشرية كلّها زمن قصير بالنسبة إلى فترات التّحوّل التّاريخيَّة الكبرى التي أدخلت تغييراً أساسياً على المسار التاريخي للجنس البشري كلّه، فنقلته من مستوى معين إلى مستوى أعلى منه مرتبة ونوعيّة. إنّ فترات التّحوّل التّاريخيّة الكبرى ـ كما نعلم ـ تستغرق أُلوف السّنين، أو ـ بالأحرى ـ عشرات الألوف من السّنين.. إنها حركة التاريخ الكبرى.
وفي انتظار أن تنجز حركة التاريخ الكبرى عملها في نقل الإنسانيّة إلى مستوى أعلى لم تفلح في بلوغه من قبل… في انتظار ذلك تستمر حركة التاريخ في دوائرها الصّغرى في العمل على تغيير حال البشر: أفراداً، وجماعات، ومجتمعات، ومجموعات إقليميّة.
إنّ حركة التّاريخ في دوائرها الصّغرى تغيّر الإنسان نحو الأفضل على الصّعيد المادّي كما يثبت ذلك الواقع التجريبي، ولكنّها لا تغيّره نحو الأفضل دائماً على الصّعيد المعنوي والأخلاقي، بل قد تعود به إلى الوراء كما يثبت الواقع التّجريبي أيضاً، وبالنّسبة إلى كثير من مظاهر حضارة عصرنا بشكل خاص.
والمسؤول عن التّخلف المعنوي للبشر ليس القدر، إنّه إرادة البشر أنفسهم، فإنّ العالم الأخلاقي لدى الفرد والمجتمع ليس عالماً معطى وجاهزاً يأخذه الناس كما يستعملون الوصفات الطبيّة أو المعادلات الرّياضيّة، إنما يتم بناؤه بالمعاناة اليوميّة للناس مع شهواتهم ورغائبهم الشرّيرة، ومجاهدتهم لأنفسهم من أجل التغلب عليها. إنّ العالم الأخلاقي ليس سهل البناء كالعالم المادي التّجريبي، لأنّه تجاوز الإنسان لنفسه باستمرار نحو إنسانيّة أغنى وأعلى، ومن هنا فإنّ العالم الأخلاقي يبني التّعامل مع المستحيل وكأنّه ممكن، إنه في التكوين دائماً، لأنّ الإنسان كلّما بلغ ذروة جديدة في تكامله المعنوي لاحت لعينيه ذروة أسمى وأعلى.
وإذن، فالبشر، بانتظار أن يتحقّق هذا الأمل العظيم، لا يجوز أن يجمدوا وإنّما عليهم أن يتحركوا في أطر دوائر التاريخ الصّغرى نحو بلوغ ذرى إنسانيّة جديدة أعلى مما بلغوه في كفاحهم الدائب نحو مزيد من الكمال والنّور.
وإذن، فالمسلمون، باعتبار أنّ هذا الأمل العظيم سيتحقق بإذن الله في نطاقهم بما هم جماعة بشريّة عقيديّة ومن خلال الإسلام نفسه بما هو دينهم،… المسلمون ينتظرون هذا الأمل العظيم قبل غيرهم من الجماعات العقيديّة في المجتمع البشري.
لقد رأينا أنّ حركة التّاريخ في دوائرها الصّغرى لا تتوقّف، ونوع هذه الحركة ـ تقدّميّة صاعدة أو رجعيّة هابطة (على صعيد المعنويّات والأخلاق) ـ يتوقف على إرادة البشر أنفسهم، فهم الّذين يبنون عالمهم الأخلاقي الأمثل وهو لا يبنى إلاَّ بالعمل الإيجابي الّذي يحرّكه الطموح نحو إنسانيّة أفضل.
محمد مهدي شمس الدين
الوعظ عند علي (ع)
يحسب بعض المثقفين من ناشئة هذا الجيل أن الإسلام تنكر للدنيا ودعا إلى التزهيد فيها واعتبارها أذى كبيراً لا يجمل بالمرء أن يصيب منه قليلاً ولا كثيراً. والكتب الموضوعة للتبشير بالحضارة الغربية، تساعد على تركيز هذه الفكرة عن الإسلام في نفوس هؤلاء. وتسهم إسهاماً كبيراً في تركيزها أيضاً البرامج التعليمية المدخولة التي تهمل دور الإسلام العظيم في إنقاذ العالم وتقدمه، وإن عرضته فإنما تعرض إسلاماً مشوهاً خالياً من الحياة.
كل هذا جعل هذه الناشئة تنظر إلى الإسلام نظر ذعر وتخوف مبعثهما الجهل لا العلم، وتوجّه هذه النظرة أيضاً إلى التراث الإسلامي في ميادين الفلسفة والأخلاق والأدب. ونهج البلاغة من جملة هذا التراث الذي ينظر إليه على هذا النحو، فهذا الكتاب، عند ناشئة الجيل يحتوي على طائفة من الخطب قيلت في التزهيد بالدنيا والتنفير منها، والنعي على المتمسكين بها والآخذين بنصيب من مباهجها وأفراحها، وهو لذلك كتاب لا يلائم روح عصرنا هذا لأنه يشلّ في الإنسان رغبته في العمل ويعطّل حسّ الحياة فيه ويدفعه إلى القناعة بحياة ذليلة واهنة مظلمة شوهاء.
ولم لا؟ ألم تصدر هذه الخطب والأقوال من رجل ركل الدنيا بقدمه وخرج عنها، ودعا الناس إلى أن يركلوها بأقدامهم ويخرجوا عنها؟
هذه نظرة طائفة كبيرة من شباب الجيل إلى نهج البلاغة.
والأسلوب الوعظي الذي يتناول فيه كثير من الوعاظ في المساجد والمحافل مهمتهم يدعم نظرة ناشئة الجيل إلى نهج البلاغة ويعززها، فهم يتناولون مهمتهم على نحو خاطىء لأنهم يعتمدون في وعظهم اعتماداً مطلقاً على التنفير من الدنيا وعلى ذمها والتزهيد فيها واعتبارها أذى كبيراً يحول بين الإنسان وبين أن يصبح إنساناً حقاً، ويجدون في نهج البلاغة على الخصوص معيناً لا ينضب من الشواهد على ما يقولون.
أننا إذ نرجع إلى مبادىء الإسلام لنتعرف على وجهة نظره إلى الدنيا نجد هذه المبادىء تشجع الإقبال على الدنيا، وتحترم العمل، وتمجد العامل، وتعنى بنشاط الإنسان الدنيوي كما تعنى بنشاطه الأخروي، يدل على ذلك ما شرعه الإسلام من قوانين تتناول جميع ألوان نشاطه الدنيوي.
والإمام (ع) هو أعظم أصحاب النبي (ص) فهماً للإسلام ووعياً لأسراره فلا يعقل أن يقول شيئاً يخالف روح الإسلام العامة ونظرته الشاملة إلى الإنسان. ولكننا نرجع إلى نهج البلاغة فنجده مكتظاً بالتنفير من الدنيا وردع الناس عنها، فكيف نلائم بين ما نراه في نهج البلاغة وبين ما نعرفه عن الإمام (ع).
إن الوعاظ والناشئة جميعاً راحوا ضحية خطأ كبير سبب لهم سوء الفهم وسوء التأويل لما جاء في نهج البلاغة من ذم الدنيا.
فعندما نريد أن نفهم نصاً من النصوص يتضمن رأياً في الإنسان وفي مصيره يجب علينا أولاً أن نفهم الثقافة التي صدر عنها هذا النص، ثم نفهم الواقع التأريخي الذي صدر فيه النص، فإذا تم لنا من ذلك ما أردنا وضعنا النص في إطاره التاريخي الخاص وأحطناه بظروفه النفسية المعينة وفسرناه من وجهة نظر الثقافة التي ألهمت قائله، فحينئذٍ يتهيأ لنا أن نفهم النص فهماً صحيحاً. أما حين نجرد النص من إطاره التاريخي، ثم ننظر إليه بغير الروح التي صدر عنها فإن أملنا بالفهم الصحيح يكون عقيماً لأننا حينئذٍ لن نحصل على الفهم الصحيح أبداً.
وهنا يكمن الخطأ الكبير الذي انزلق إليه من حسب نهج البلاغة داعياً إلى تحقير الحياة الدنيا والتنفير عنها. إن هؤلاء حينما ذهب بهم الوهم هذا المذهب كانوا على جهل بالمثل الأعلى للحياة في الإسلام من جهة أولى، وكانوا على جهل بنظرة الروح العربية الأصيلة إلى الحياة والموت والمال من جهة ثانية، وكانوا على جهل بالواقع التاريخي الذي صدر فيه القسم الوعظي من نهج البلاغة من جهة ثالثة.
فعلينا لكي نفهم القسم الوعظي من نهج البلاغة فهماً صحيحاً أن نعني بفهم هذه الأمور الثلاثة، وسيكون هذا سبباً في دراسة الواقع الاجتماعي في زمان الإمام دراسة موسعة.
ـ 1 ـ
ونبدأ بالمثل الأعلى للحياة في الإسلام.
لقد عرفنا أن المثل الأعلى للحياة في الإسلام هو التقوى. وقد فهمنا أن التقوى هي الفضيلة في أرفع معانيها، وعرفنا أن الإنسان المتقي هو الإنسان الذي وعى وجود الله وأمره ونهيه في كل ما يلم به من فعل أو قول، وجعل من نفسه خلية إنسانية حية تعمل بحرارة وإخلاص على رفع مستوى الكيان الاجتماعي الذي تضطرب فيه، وصدر في ذلك كله عن إرادة الله المتجلية فيما شرع من أحكام.
هذا هو المثل الأعلى للحياة في الإسلام، فما الذي يحول بين الإنسان وبين بلوغه؟
الذي يحول بين الإنسان وبين بلوغ هذا المثل الأعلى هو أن تقفر حياته من الشعور بالله كطاقة نفسية فاعلة، ويتبع ذلك بصورة حتمية أن يفقد الدين ما له من أثر توجيهي في حياة الإنسان، وإذا فقد الإنسان هذين (الشعور بالله والدين) لم تعد الجماعة التي يعيش فيها تعني بالنسبة إليه شيئاً، ولا يعود يستلهم في سلوكه سوى ذاته هو، والنتيجة الطبيعية لهذا هي أن يصبح إنساناً فردياً أنانياً.
إذا استوى وجود الإنسان على هذا النحو كان بعيداً عن التقوى، وكان واقعه حائلاً بينه وبين التقوى.
وقد قلنا إن وجه الفائدة في جعل التقوى مثلاً أعلى للحياة هو اشتقاق مفهوم الطبقة الذي يستتبع حكماً تقويمياً لطائفة من الناس من التقوى بدلاً من أن يشتق هذا المفهوم من الاقتصاد أو الحرب، وبذلك تكون الطبقات ظاهرة اجتماعية تعود على المجتمع بالخير بدلاً من أن تكون تعبيراً حاداً عن التفسخ الاجتماعي.
فإذا عدنا لنرى واقع المجتمع الإسلامي في الوقت الذي ولِّيَ فيه الإمام الحكم ألفيناه مجتمعاً مريضاً منحرفاً أقفرت ضمائر أفراده من الشعور بالله، وفقد الدين قوته الدافعة عندهم، واستشرت الروح القبلية فيهم وعاد المثل الأعلى للحياة عندهم المال والقوة.
ويقتضينا فهم هذا الواقع أن نلم بالأسباب التي أدت إليه.
ولِّيَ عثمان بن عفان الخلافة فكانت خلافته إيذاناً ببزوغ عهد سياسي جديد، فلقد اتبع عثمان منذ ولي الحكم سياسة خطرة في المال والولايات، فقد طفق يهب خواصه وذوي رحمه ومن يمت إليه بنسب أو سبب الأموال العظيمة ويخصهم بالمنح الجليلة ويحملهم على رقاب الناس. وولى على البلدان الإسلامية شباناً من بني أمية لا يحسنون الحكم ولا السياسة، ذوي روح تسلطية عاتية لم ينل منها الإسلام لأن إسلام هؤلاء كان غشاء فقط ولم يخالط قلوبهم.
وهكذا كونت هذه السياسة طبقة أرستقراطية من الأغنياء المترفين الذين لا تزال تعتمل في صدورهم القيم البدوية الجاهلية. وقد امتد نفوذ هذه الطبقة في خلافة عثمان امتداد هائلاً، فسيطرت على الحكم سيطرة مطلقة وحازت الأموال العظيمة التي أفاءَها الله على المسلمين، والتي كان المفروض فيها أن تذهب إلى المعدمين والفقراء، وانتشرت هذه الطبقة في طول البلاد الإسلامية وعرضها حين فتح لها عثمان باب الهجرة والتنقل في البلاد الإسلامية.
وإلى جانب هؤلاء كانت ثمة طبقة أخرى تتألف من الإعراب وأهل البادية وكانت القوى المسلحة في الدولة الإسلامية تتألف منهم، ينضم إليهم من دخلوا في الإسلام من الأمم الأجنبية، هؤلاء الأجانب والأعراب، كانوا يلقون في زمن عثمان حيفاً كبيراً من طبقة الأرستقراطيين الناشئة الطامحة إلى مزيد من القوة والاستعلاء بسبب ما يعتمل في نفوس أفرادها من قيم البداوة.
وكانت عاقبة ذلك أن تضخمت الفروق بين الطبقات تضخماً مرعباً من الناحية المادية والمعنوية.
وانقلبت الأثرة إلى طغيان، وانقلب الحقد إلى زئير، وتراكم الطغيان حتى وجد رد فعلٍ طاغ في ثورة المظلومين الذين أثقلهم الظلم الفادح على حكومة عثمان وعلى ولاته، وكانت عاقبة ذلك كله قتل عثمان.
وجاء الناس إلى الإمام يطلبون منه أن يلي الحكم، ولكنه أبى عليهم ذلك، لا لأنه لم يأنس من نفسه القوة على ولاية الحكم وتحمل تبعاته، فقد كان (ع) على تمام الأهبة لولاية الحكم، كان قد خبر المجتمع الإسلامي من أقطاره وخالط كافة طبقاته وراقب حياتها عن كثب ونفذ إلى أعماقها، وتعرف على الوجدان الطبقي الذي يشدها ويجمعها.
وقد مكنه من ذلك كله المركز الفريد الذي كان يتمتع به من النبي (ص)، فهو وزيره ونجيبه وأمين سره وقائد جيوشه ومنفذ خططه ومعلن بلاغاته… هذه المنزلة الفريدة التي لم يكن أحد من الصحابة يتمتع بها أعدته إعداداً تاماً لمهمة الحكم. وقد كان النبي يبتغي من وراء إناطة هذه المهام كلها به إعداده للمنصب الإسلامي ليصل إليه وهو على أتم ما يكون أهلية واستعداداً. ولقد غدا من نافلة القول أن يقال أنه (ع) هو الخليفة الذي كان يجب أن يلي حكومة النبي في المجتمع الإسلامي.
وإذ لم يقدر له أن يصل إلى الحكم بعد النبي فإنه لم ينقطع عن الحياة العامة، بل ساهم فيها مساهمة خصبة، فقد كان أبو بكر ثم عمر ومن بعدهما عثمان لا يسعهم الاستغناء عن آرائه في السياسة والقضاء والحرب، وخاصة في خلافة عثمان فقد كان فيها على أتم الصلة بالتيارات التي تمخر المجتمع الإسلامي، لكن عثمان لم ينتفع كثيراً بالتوجيه الذي كان الإمام يقدمه إليه لأن بطانة متعفنة كانت تحيط بهذا الخليفة.
فأنت ترى أنه لم يأب الحكم لأنه لم يأنس من نفسه القوة عليه، وإنما أباه لأمر آخر: لقد كان يرى المجتمع الإسلامي وقد تردى في هوة من الفوارق الاجتماعية التي ازدادت بعداً بسبب السياسة الغير الحكيمة التي اتبعها ولاة عثمان مدة خلافته، ولقد كان يرى التوجيهات الدينية العظيمة التي عمل النبي طيلة حياته على إرساء أصولها في المجتمع العربي قد فقدت فاعليتها في توجيه حياة الناس.
وكان (ع) يعرف السبيل الذي يردّ الأشياء إلى نصابها، فإنما صار الناس إلى واقعهم هذا لأنهم فقدوا الثقة بالقوة الحاكمة التي تهيمن عليهم… فقدوا الثقة بهذه القوة كناصر للمظلوم وخصم للظالم فراحوا يسعون إلى إقرار حقوقهم وصيانتها بأنفسهم. وهكذا، رويداً رويداً انقطعت الصلة بينهم وبين الرموز المعنوية التي يجب أن تقود حياتهم. والسبيل إلى تلافي هذا الفساد كله هو إشعار الناس أن حكماً صحيحاً يهيمن عليهم لتعود إلى الناس ثقتهم الزائلة بحكامهم. ولكن شيئاً كهذا لم يكن سهلاً قريب المنال فهناك طبقات ناشئة لا تسيغ مثل هذا، ولذلك فهي حَرِيَّة أن تقف في وجه كل برنامج إصلاحي وكل محاولة تطهيرية، ولذلك أبى عليهم قبول الحكم، لأنه قدر ـ وقد أصاب ـ أنه سيلاقي معارضة عنيفة من كل طبقة تجد صلاحها في أن يبقى الفساد على حاله.
لأجل هذا قال للجماهير يوم هرعت إليه تسأله أن يلي الحكم.
«دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً».
ولكن القوم أبوا عليه إلا أن يلي الحكم، وربما رأى (ع) أنه إذا لم يستجب لهم فربما توثب على حكم المسلمين من لا يصلح له فيزيد الفساد فساداً، ورجا أن يخرج بالناس من واقعهم الاجتماعي التعس الذي أحلتهم فيه اثنتا عشرة سنة مضت عليهم في خلافة عثمان إلى واقع أنبل وأحفل بمعاني الإسلام، وهكذا استجاب لهم، فبويع خليفة للمسلمين.
ولقد دأب، بعد أن بويع على بيان الهدف الذي ابتغى من وراء ولاية الحكم، وذلك بأن يكون في مركز يمكنه من أن يصلح ما يفتقر إلى الإصلاح من شؤون الناس، وأن يرفع عن المظلومين فادح ما رزحوا تحته من ظلم، فتراه يقول:
«… أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز».
وقال:
«اللَّهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك».
وقال: «ولكني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال الله دولاً، وعباده خولاً، والصالحين حرباً، والفاسقين حزباً، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام، وجلد حداً في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ…».
لأجل هذا كله قبل (ع) أن يتولى الحكم.
وما أن بويع حتى عالنهم بسياسته التي عزم على اتباعها من أجل تحقيق الأهداف التي قبل الحكم لأجلها، وقد عرفت أن هذه السياسة لم تكن شيئاً مرتجلاً اصطنعه لنفسه يوم ولي الخلافة، وإنما كانت خططاً مدروسة ومنتزعة من الواقع الذي كان يعانيه المجتمع الإسلامي آنذاك ومعدة لئن تبلغ بهذا المجتمع خطوات إلى أمام ومهيئة لتنيل هذا المجتمع المطامح التي كان يحلم بها ويصبو إليها.
وقد كانت إصلاحاته السياسية تتناول ثلاثة ميادين: الإدارة، والمال، والحقوق.
ففيما يرجع إلى سياسة الإدارة عزل ولاة عثمان على الأمصار، هؤلاء الولاة الذين كانوا السبب المباشر في الثورة لظلمهم وبغيهم وعدم درايتهم بالسياسة وأصول الحكم، وولى من قبله رجالاً ذوي دين وعقل وبعد نظر وحسن تدبير.
وفيما يرجع إلى الحقوق نادى بأن المسلمين جميعاً سواء في الحقوق والواجبات في الإسلام، وقد كانت هناك فروق حقوقية جاهلية نسفها الإسلام ولكن عهد عثمان أعادها، فقريش ذات الماضي العريق في السيادة على القبائل العربية عادت في زمن عثمان فاتعلت جيدها وأعادت تلك الفروق، فغدا أناس ليس لهم ماض مشرف بالنسبة إلى الإسلام ونبيه يتعالون على أعظم المسلمين جهاداً وسابقة وبلاء، لمجرد أنهم قرشيون. هذه الفروق المعنوية الجاهلية حطمها الإمام، فقال:
«الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه».
وفيما يرجع إلى سياسة المال وقف موقفاً صارماً، فصادر جميع ما أقطعه عثمان من القطائع وما وهبه من الأموال العظيمة لطبقة الأرستقراطيين، وقد صرح بذلك في أول خطبة خطبها بعد خلافته، فقال:
«أيها الناس! إني رجل منكم، لي مالكم وعلي ما عليكم، وإني حاملكم على منهج نبيكم، ومنفذ فيكم ما أمر به، ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله، فهو مردود في بيت المال فإن الحق لا يبطله شيء، ولو وجدت قد تزوج به النساء، وملك الإماء، وفرق في البلدان لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق».
وكانت سنة رسول الله (ص) في توزيع الأموال هي التسوية بين الفاضل والمفضول، لأن النظر في هذا الأمر إلى الحاجة لا إلى الفضل، ولأن الفضل ليس عرضاً يشرى ويباع، ولأن الفاضل يجد عند الله وعند الناس ثواب فضله، ولكن أبا بكر وعمر فضلاً بعض الناس على بعض، وإذا كانا قد فضلا فإنهما قد فعلا ذلك بحكمة أما عثمان فقد فضل دون مقياس للتفضيل، وبذلك زاد التفاوت بين الطبقات فحشاً وبعداً، فلما جاء الإمام (ع) عدل عن هذه السياسة وسوى بين الناس في العطاء.
وبقدر ما كانت هذه السياسة مصدر جذل وفرح للطبقة المستضعفة الفقيرة الرازحة تحت أثقال من الظلم، كانت أيضاً صفعة مدوية لقريش ولغرورها وخيلائها واستعلائها على الناس، فمن أين لها بعد اليوم أن تحوز الأموال العظيمة دون أن تنفرج شفتان تقولان لها: من أين لك هذا؟ وكيف لها بعد اليوم أن تستعلي وتستبد وتفرض على الناس في ظل الإسلام سلطانها عليهم في الجاهلية؟.. وكانت هذه السياسة صفعة مدوية لزعماء القبائل العربية الذين كانوا يقبضون ليسكتوا، وكانت هذه السياسة صفعة مدوية لمن مالأ عثمان وولاته على سياستهم من أهل المدينة وغيرهم. وكانت صفعة مدوية لولاة عثمان المعزولين المجردين من السلطان والذين ينتظرهم مصير لا يحسدون عليه عند الحاكم الجديد بما ظلموا وأساؤوا السيرة وجاروا على الرعية.
كل هؤلاء أورثهم كرباً شديداً مصير الحكم إلى علي بن أبي طالب، ولعلهم قد فكروا أن يساوموه على بذل طاعتهم له بأن يغضي عما سلف منهم ويأخذهم باللين والهوادة فيما يستقبلون، فأرسلوا إليه بعض زعماء بني أمية يقول له:
«يا أبا الحسن.. إنك قد وترتنا جميعاً… ونحن نبايعك على أن تضع عنا ما أصبناه من المال أيام عثمان…».
ولكنه أبى عليهم ذلك وأصر على أن يحملهم على الخطة التي يريد، والتي يرى الصلاح في اتباعها.
* * *
وقد حدث ردّ الفعل عند هؤلاء في حرب الجمل، وما حرب الجمل في واقعها إلا تدبيراً دبره من لم يماش الحكم الجديد أهواءهم من بني أمية وغيرهم من ولاة عثمان إلا أن الحركة في صميمها كانت أموية خالصة.
وقد كان القائمون بهذه الحركة يريدون أن يعطفوا أزمة الحكم إلى جانبهم بعد أن صفرت أيديهم من مساعدة الإمام لهم على ما يبتغون. ولكن الإمام (ع) قضى على الحركة في مهدها، ففر من أخطأه السيف ممن تولى كبره إلى الشام.
* * *
وانتقل الإمام، بعد أن فرغ من أمر الجمل، بحكومته من الحجاز إلى العراق، واتخذ الكوفة قاعدة لحكمه. والكوفة يومئذٍ مركز الثقل في المجتمع الإسلامي الناشىء.
وفي العراق استمر الإمام على سياسته المالية والإدارية التي أستنها لنفسه وأذاعها في الناس، فالمساواة في الأعطية أمر مفروغ منه، ومؤاخذة العمال على الصغيرة والكبيرة ومراقبتهم وإذكاء العيون عليهم أمر لازم لا معدى عنه.
لقد كان حرياً بهذه السياسة الواعية لآلام الشعب وآماله، والطامحة إلى إسعاده، أن تنجح لو لم تعاكسها سياسة أخرى. ففي الوقت الذي قامت فيه حكومة الإمام في الكوفة قامت حكومة أخرى في الشام برئاسة معاوية بن أبي سفيان، وبينما كانت حكومة الإمام تسير على نهج يحقق للرعية أقصى قدر مستطاع ـ في ظروفها الاقتصادية والسياسية والعسكرية ـ من الرفاهية والأمن والعدالة، كانت حكومة معاوية تسير على نهج آخر في الحكم يقوم على شراء الضمائر بالمال وتفضيل طائفة على حساب حرمان طائفة أخرى، وتعطيل السبل وتعكير الأمن، ولم يكن معاوية يبالي في أن ينزل بدافعي الضرائب من الزراع والتجار أفدح الظلم في سبيل أن يحصل منهم على مزيد من المال يغذي به أطماع حفنة من رؤساء القبائل العربية يؤلفون جهازه العسكري المتأهب دائماً لقمع أي حركة تحررية تقوم بها جماعة من الناس.
وقد آتت هذه السياسية أكلها جيداً في العراق، فقد كان رؤساء القبائل في العراق يرون سياسة معاوية فيعجبون بها، فهي تلبي ما يطمحون إليه من غنى ووجاهة وارتفاع قدر بينما هم لا يجدون شيئاً من هذا في حكومة الإمام.
على هذا النحو كانت سياسية معاوية تؤثر في العراق، وقد وعى ذلك جماعة من المخلصين للإمام فقالوا له: «يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال، وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم واستمل من تخاف خلافه من الناس» ناظرين إلى ما يصنع معاوية، ولم يكن رؤساء القبائل العربية في العراق يطمعون بأكثر من هذا، ولكن الإمام أجابهم قائلاً:
«أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه، والله ما أطور به ما سمر سمير، وما أمّ نجم في السماء نجماً، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويهينه عند الله».
وقد صارت الشام ملاذاً لمن يغضب عليه الإمام لخيانة خانها في عمله أو جريرة جرها على نفسه ومطمحاً لمن يريد الغنى والمنزلة فيجد عند معاوية الإكرام والرفعة والعطاء والمنزلة الاجتماعية وقد كتب مرة إلى عامله سهل بن حنيف في شأن قوم من أهلها لحقوا بمعاوية.
«وإنما هم أهل دنيا مقبلون عليها، ومهطعون إليها، وقد عرفوا العدل ورأوه، وسمعوه ووعوه، وعلموا أن الناس عندنا أسوة فهربوا إلى الأثرة فبعداً لهم وسحقاً».
وهكذا فعلت سياسة معاوية فعلها في مجتمع الإمام، فتمالأ رؤساء أصحابه على الخيانة؛ وتخاذلوا عن نصره فلا يجيبونه حين يدعوهم ولا ينصرونه حين يستنصرهم.
وقد كان (ع) يعرف كيف يجعلهم إلى صفه لو أراد، فيفضلهم ويعطيهم الأموال ويحملهم على رقاب الناس ويرضي غرورهم القبلي، ولكن ذلك كان ينقلب به إلى جبار يدعم ملكه بالسيف بدل أن يكون أباً للرعية تدعم ملكه القلوب، لقد قال لهم مرة:
«… وإني لعارف بما يصلحكم ويقيم أودكم ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي».
هذا هو الواقع الاجتماعي والسياسي الذي كان عليه مجتمع الإمام ومن الجلي أن مجتمعاً يمارس حياته الاجتماعية والسياسية على هذا النحو مجتمع بعيد عن التقوى بعداً شاسعاً، فالتقوى والقبلية شيئان متضادان، والتقوى ونصرة الباطل شيئان متضادان، والتقوى وحب الأثرة والتكبر شيئان متضادان.
هذا الواقع كيف كان يسع الإمام أن يعدّله، هل كان عليه أن يجاري أهواء أصحابه فيبذل لهم ما تطمح إليه أنفسهم؟، لقد قال: «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور…». هل يقتلهم؟ إن ذلك كفيل بإحراج مركزه وإثارة الناس عليه. هل ينفيهم؟ إن ذلك يدفعهم إلى المجاهرة بولائهم لمعاوية وبذلك يجرون وراءهم قبائلهم.
لقد كان آمن المواقف معهم إبقاؤهم تحت سمعه وبصره، إن قعدوا عن نصرته لا يستطيعون نصرة عدوه. ثم حاول أن يبدل نظرة الناس إليهم ويبدل نظرتهم إلى هذه المطامح التي يطمحون إليها بوسيلتين. الأولى وقد كان يتوجه بها إلى الرجل العادي وهي محاربة النزعة القبلية فقد كان عليه السلام يعلم أن قوة هؤلاء الرؤساء مستمدة من إيمان قبائلهم بهم فإذا تزعزع هذا الإيمان لم يعد لهم من قيمة. وأما الوسيلة الثانية فهي الموعظة، وهو يبين فيها للرؤساء أن ما يطمحون به وهم من الوهم، وإن حاضرهم خير لهم من دنيا يصيبونها عن طريق الخيانة والغدر ونصرة الباطل، وسنرى أن الألوان الوعظية في نهج البلاغة تدور حول هذا القطب، وقد كان يتوجه بهذه المواعظ أيضاً إلى الأفراد العاديين الذين يخشى من أن يفتنهم رؤساؤهم بتحبيب دنيا معاوية إلى أنفسهم.
ولعل هذا يفسر كثرة تكرار الإمام لمواعظه فقلما ترى خطبة من خطبه خالية عن الموعظة فقد كان يقصد من وراء هذا التكرار أن يثبت توجيهاته في ضمائرهم لتكتسب هذه التوجيهات قوة الطاقة الشعورية فيأمن زيغهم وانحرافهم.
هذا عن الحالة السياسة والاجتماعية التي كانت تسود عصره (ع) وعن صلتها بالقسم الوعظي من النهج.
ـ 2 ـ
في الخلق العربي الأصيل جنبة جديرة بالتنويه حقيقة بالشرح لأنها مفتاح كثير من الخلائق العربية الكريمة. هذه الجنبة التي عنيت هي «الواقعية» كما يفهمها العربي ويسير على ضوئها في الحرب ومنع الجار ونصر الضعيف وبذل المال وطلب اللذة.
إن الموت حتم على كل إنسان ومصير لكل حي. وموعد الموت مجهول غامض فلا يدري متى يحل ويأزف، وكما يدخل في الظن أن يكون بعيداً يدخل في الظن كذلك أن يكون قريباً. وماذا بعد الموت؟ أنه القبر والوحدة والوحشة. والمصير إلى القبر لازم فلا مفر منه ولا معدى عنه. والدنيا…؟ أليس التقلب طبعاً أصيلاً فيها؟ أليس التلون ملازماً لها؟ فقد ينقلب الحال بالعزيز إلى الذل وبالغني إلى الفقر وبالصحيح إلى المرض وبالسعيد إلى الشقاء.
وإذا كان هذا كله حقاً فلماذا أصدّ النفس عن اللذة حين تشتهي اللذة؟ ولما الفرار من الحرب حين تستعر الحرب؟ ولماذا إمساك اليد عن بذل المال حين يفد صاحب الحاجة الفقير وصاحب الغرم الثقيل؟. إن أيامنا على الأرض معدودة، ونهايتنا بعد الحياة الموت وبعد الموت القبر وبعد ذلك في حسبان الجاهليين النسيان والفراغ؛ فلماذا لا نمتع أنفسنا بلذاتها؟ ولماذا نمسك أيدينا عن صنع وجود كريم لنا يبقى بعد ذهابنا في قلوب الناس على ألسنتهم بما نصنع من خير وبما نسدي من معروف؟
إن العجز كل العجز والخرق كل الخرق أن يتمرد إنسان على واقعه فيظن الخلود لنفسه، ويدفعه ذلك إلى إمساك يده عن البذل وإمساك نفسه عن الحرب والضن عليها بلذاتها.
هذه النظرة الواقعية ليست شيئاً مرتجلاً وإنما هي نتاج تفكير يفلسف الحياة والموت وتقلب الأنساب بينهما، وهي أكثر ما تكون شيوعاً في الشعر العربي.
اسمع طرفة بن العبد كيف يقول في تعليل إسرافه في إنفاقه وإسرافه في ملاذه، وعدم إمساك يده عن البذل وعدم إمساك نفسه عن اللذة:
| أرى قبر نحام بخيل بماله | كقبر غوي في البطالة مفسد | |
| ألا أيهاذا اللائمي أحضر الوغى | وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ | |
| فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي | فدعني أبادرها بما ملكت يدي |
ويقول يزيد بن الحكم الثقفي وهو ينصح ابنه:
| ما بخل من هو للمنون | وريبها غرض رجيم؟ | |
| ويرى القرون أمامه | همدوا كما همد الهشيم! |
وحاتم الطائي يقول لزوجته:
| أماويّ ما يغني الشراء عن الفتى | إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر؟ | |
| أماويّ إن يصبح صداي بقفرة | من الأرض لا ماء لدي ولا خمر | |
| ترى أن ما أنفقت لم يك ضرني | وأن يدي ما بخلت به صفر |
وأياس بن القائف يقول:
| يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم | وترمي النوى بالمقترين المراميا | |
| فاكرم أخاك الدهر ما دمتما معاً | كفى بالممات فرقة وتنائيا |
وقال النمر بن تولب:
| وحثت على جمع ومنع ونفسها | لها في صروف الدهر حق كذوب | |
| وكائن رأينا من كريم مرزإ | أخي ثقة طلق اليدين وهوب | |
| شهدت وفاتوني وكنت حسبتني | فقيراً إلى أن يشهدوا وتغيبي | |
| أعاذل أن يصبح صداي بقفرة | بعيداً نآني صاحبي وقريبي | |
| تري أن ما أبقيت لم أك ربه | وإن الذي أمضيت كان نصيبي | |
| وذي إبل يسعى ويحسبها له | أخي نصبٍ في رعيها ودؤوب | |
| غدت وغدا رب سواه يسوقها | وبدل أحجاراً وجال قليب |
وقال أيضاً:
| قامت تباكي أن سبأت لفتية | زقاً وخابية بعود مقطع | |
| وقريت في مقرى قلائص أربعا | وقريت بعد قرى قلائص أربع | |
| أتبكيا من كل شيء هين | سفه بكاء العين ما لم تدمع | |
| فإذا أتاني إخوتي فدعيهم | يتعللوا بالعيش أو يلهوا معي | |
| لا تطرديهم عن فراشي أنه | لا بد يوماً أن سيخلو مضجعي | |
| هلا سألت بعاد ياء وبيته | والخيل والخمر التي لم تمنع |
وقال الحارث بن حلزة:
| بينا الفتى يسعى ويسعى له | تاح له من أمره خالج | |
| يترك ما رقح من عيشه | يعبث فيه همج هامج | |
| لا تكسع الشول بأغبارها | أنك لا تدري من الناتج |
وقال الهذلي:
| إن الكرام مناهبوك المجد كلهم فناهب، | أخلف وأتلف، كل شيء ذرّ عنه الريح ذاهب |
وقالت امرأة:
| أنت وهبت الفتية السلاهب | وابلاً يحار فيها الحالب | |
| وغنماً مثل الجراد الهارب | متاع أيام وكل ذاهب |
وقال تميم بن مقبل:
| فأخلف وأتلف إنما المال عارة | وكله مع الدهر الذي هو آكله |
هذه الواقعية هي في العربي خلق أصيل كما رأيت. وقد جاء الإسلام فأكدها وهذبها وسما بها، ووجهها وجهة اجتماعية. فإذا كان الموت شيئاً لازماً لنا، وكنا نعتقد بأن وراء دنيانا هذه دنيا أخرى أعظم وأحفل وأنبل أو دنيا أخرى أنكد وأجفى وأبلغ في الإيذاء فلماذا لا نعدّ العدة لرحيلنا؟ ولماذا يلهينا حاضرنا الحقير عن مستقبلنا المرقوب؟ ولماذا التكالب والوحشية؟ ولماذا نصرّ على أخذ الدنيا عن طريق الختل والغدر؟ ولماذا نصر على ظلم إخواننا من الناس في سبيل أن نزيد ذهبنا المكدس درهماً جديداً؟ ولماذا نباغض إخواننا في الدين والإنسانية والوطن في سبيل عرض حقير فنفسد حياتنا على أنفسنا ونفسد حياة إخواننا ونعيش غرباء لا تجمعنا عاطفة ولا تصل بين قلوبنا رحمة ولا يتألق في أعيننا لأخواننا حب.. آلا يكفينا أن الموت سيفرق بيننا؟ لا.. لا..، أكرم أخاك الدهر ما دمتما معاً.
هذه الواقعية الوادعة المحببة وهذا الشعور الإنساني الفياض الدافق كانا غريبين عن نفوس الناس وقلوبهم في مجتمع العراق أيام الإمام (ع)، وقد كان الإمام يعمل على إعادة الشعور بها إلى النفوس، وسنجده في بعض الألوان التي احتواها القسم الوعظي من كلامه ينعى على الناس تركها ويحضهم على الرجوع إليها والصدور في سلوكهم عنها.
وثمة لون آخر من كلامه (ع) ربما لا يسمى وعظاً، ولكنه يندد فيه بالناس على تركهم لهذا اللون من النظر إلى الحياة والموت ويدعوهم إلى الرجوع إليه.
قال:
«.. وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً والشر إلا إقبالاً ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً… اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً، أو غنياً بدّل نعمة الله كفراً، أو بخيلاً اتخذ البخل بحق الله وفراً، أو متمرداً كأن بإذنه عن سمع المواعظ وقرا…».
وقال:
«.. فمن آتاه الله مالاً فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، فإن فوزاً بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة».
ـ 3 ـ
لا يريد منا الإمام (ع) أن نقطع أنفسنا عن دنيانا وأن نحرمها لذات هذه الدنيا، وأن نغلّ غرائزنا وشهواتنا عن الانطلاق. أن التحرر عن طريق الحرمان شيء عظيم ونبيل ولكن أكثر الناس لا يستطيعونه ولا يقوون على احتماله.
فها هو (ع) يقرر في إحدى كلماته المضيئة الهادية عقم كل محاولة ترمي إلى اقتطاع الإنسان من واقعه: واقع جسمه وغرائزه ورغباته كإنسان، وواقع حياته ذات المطالب والحاجات، وواقع كينونته الاجتماعية. يقرر (ع) عقم كل محاولة ترمي إلى اقتطاعه من هذا الواقع بالتنكر لغرائزه ورغباته وحاجات حياته ولكن لماذا؟ لأن أسر هذه الغرائز والرغبات مودع في طبيعة الإنسان ولا يسعه التفلت من أسرها إلا بالاستحالة إلى ذات أخرى.
قال (ع):
«الناس أبناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب أمه».
كنى بذلك عن أن دوافع الإنسان إلى إجابة حاجات نفسه وشهواتها مودعة فيه وإذا كانت مودعة فيه فهي جزء من كيانه وهي تسهم في حبك جزء من نسج وجوده الإنساني، ولذلك فهو يحبها ويقبل عليها ويأخذ بحظ منها ولكن لا لوم عليه في ذلك فهو حينما يقبل عليها إنما يلبي بإقباله هاتفاً ملحاً لا قبل له بكتم صوته مهما أوتي من عزيمة ومضاء.
وهنا تأتي قصة عاصم بن زياد شاهد صدق على ما نقول:
دخل (ع) على العلاء بن زياد الحارثي يعوده فلما رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا أما أنت لها في الآخرة كنت أحوج؟ وبلى أن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف، وتصل فيها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة.
فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. قال: وماله؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. قال: عليَّ به، فلما جاء قال:
يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك.
فقال عاصم: يا أمير المؤمنين: هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك..؟ قال: ويحك إني لست كأنت، أن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره.
ففي هذه القصة نرى الإمام (ع) يلوم العلاء على سعة داره ويتخذ لومه سبيلاً إلى بيان وجوه الانتفاع بها فيشير إلى أنه لا حرج على المرء في أن يجمع بين الدنيا والآخرة، فيمتع نفسه في الدنيا بمباهجها ويبلغ في الآخرة عليا الدرجات.
ثم يؤنب عاصماً على فعله حين هجر الدنيا ولبس العباءة، فبين له أن بفعله هذا أناني يعمل لنفسه، إذ أن جدوى عمله لو استطاعه ووالاه لا ترجع إلا إليه، وأما غيره من الناس فلا يصيب منه نفعاً وخاصة أهله وولده وهم ألصق الناس به، وبين أن من الخير له أن يجمع بين العمل لنفسه والعمل لغيره وأن يجمع بين الدنيا والآخرة. والطيبات..؟ هل حرمها الله؟ كلا أن الإنسان مدعو لأن يصيب منها شريطة ألا يستغرق فيها على نحو يلهيه عن الغاية الرفيعة لوجوده.
وقال (ع):
«للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرمّ معاشه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل. وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمة المعاش، أو خطوة في معاد أو لذة في غير محرم».
وقال (ع):
«خذ من الدنيا ما أتاك وتولى عما تولى عنك فإن أنت لم تفعل فاجمل في الطلب».
هذا موقفه من الدنيا: لا حرج على الإنسان أن يطلب الدنيا ويسعى إليها ويصيب من لذاتها، ولكن عليه أن يطلب الدنيا من طريق الحل، ويصيب من لذتها ما يحل ويجمل ثم لا يتهالك على الدنيا ولذاتها على نحو غير إنساني بحيث ينقلب من إنسان ذي مشاعر نبيلة وإمكانات رفيعة عالية إلى مجرد آلة… آلة بشعة لجمع النقود وتكديسها لتنفق في وجوه غير إنسانية. أن هذا ليس جديراً بالإنسان أن يفعله، أجمل في الطلب لتعطي لنفسك حقها ولربك حقه.
والفقر…؟ ما هو موقف الإمام منه؟.
إن الإمام ليكره الفقر ويستعيذ بالله منه، ويأمر الناس بالاستعاذة بالله منه وينعته بأقبح النعوت قال (ع):
«الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة».
«الفقر يخرس الفطن عن حجته».
«الفقر الموت الأكبر».
«ألا وأن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. ألا وأن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب».
وقال لابنه محمد بن الحنفية:
«يا بني أني أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت».
وإن إنساناً ينعت الفقر بهذه النعوت لا يمكن أن يقال عنه أنه يحبذ الفقر ويكره الغنى، ولقد كان (ع) يستعيذ بالله من الفقر ويسأله أن يغنيه فمن دعاء له (ع):
«اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالأقتار، فاسترزق طالبي رزقك، واستعطف شرار خلقك، وابتلى بحمد من أعطاني، وافتتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع أنك على كل شيء قدير».
ومن دعاء له (ع):
«اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في هداك، أو أضام في سلطانك، أو أضطهد والأمر لك» وهكذا ترى أنه (ع) يحارب الفقر حرباً لا هوادة فيها، ويحذر منه، ويستعيذ بالله أن يبتليه به.
أن الدنيا عنده جديرة بالإقبال عليها، والعمل فيها والأخذ بحظ من متعها ولذاتها، وأن الفقر عنده أمر مذموم خطر، على الإنسان أن يتخلص منه ويستعيذ بالله من بلوائه.
ـ 4 ـ
وإذ قد تم لنا أن نلم بالمثل الأعلى للحياة في الإسلام والواقع الاجتماعي الذي كان يعانيه الإمام، والواقعية العربية التي احتضنها الدين ورأي الإمام (ع) في الدنيا والآخرة والغنى والفقر، فلنأخذ سبيلنا إلى دراسة القسم الوعظي من نهج البلاغة.
والقسم الوعظي على ضروب وألوان، ففيه مواعظ بالتحذير من أتباع الهوى وطول الأمل، وأخرى بالحض على العمل قبل فوات الفرصة، وثالثة بالتذكير بالماضين، ورابعة بتقلب الدنيا.
ماذا يعني أتباع الهوى وطول الأمل في الدنيا؟
أما أتباع الهوى فهو يعني أن الإنسان يبني مشاريعه على أسس غير عقلية، ومن ثم فهي غير واقعية، وإنما هي قائمة على نزوات وشهوات ضخمها الخيال. وأما طول الأمل فيعني أن الإنسان يغمض عينيه عن أعظم حقيقة هو لا بد ملاقيها وهي الموت.
وإذن فهذا اللون من الوعظ موجه إلى الذين يتهالكون على الدنيا تهالكاً خطراً يجرهم إلى أمرين خطيرين أولهما تزييف الواقع الذي يحيونه، وهذا ما يسميه بطول الأمل، وثانيهما ضمور الحاسة الأخلاقية في النفس إلى حد يجعل الإنسان ضعيفاً أمام رغائبه وأهوائه. ويترك إلى هذه الرغائب والأهواء أمر صياغة مصيره.
قال (ع):
«أيها الناس، أن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وأما طول الأمل فينسي الآخرة..».
العمل للدنيا على نحو يوجب ضمور الحس الأخلاقي في النفس وعلى نحو يوجب تزييف الواقع وحسبان الخلود مما يوجب الاندفاع في حياة مادية تجرد الإنسان من معناه الإنساني لتحيله إلى مجرد آلة لجمع النقود ـ هذا العمل شر كله، لأنه يفسد الشخصية الإنسانية ويهبط بها، ولذلك فهو عمل منهي عنه.
وهاتان الآفتان النفسيتان، اتباع الهوى وطول الأمل، لا تحلان إلا في نفس اطرحت الواقعية العربية التي هذبها وأكدها الإسلام. وقد كان الواقع الاجتماعي في زمن الإمام يبعد بين الإنسان وبين هذه الواقعية وينأى به عنها.
وهذا النحو من العمل للدنيا يسبب التفسخ الاجتماعي، فهو لا يقتصر بآثاره الضارة على الفرد وحده، وإنما يمتد بهذه الآثار إلى المجتمع.
قال (ع):
«.. قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم، ونبت المرعى على دمنكم، وتصافيتم على حب الآمال وتعاديتم في كسب الأموال لقد استهام بكم الخبيث وتاه بكم الغرور».
أرأيت إلى هؤلاء الذين جمعتهم الإنسانية فوحدت غرائزهم وقواهم ومداركهم ثم جمعهم الدين والوطن فوحدا آمالهم وآلامهم وأهدافهم ومطامحهم كيف جعلهم العمل للدنيا، على نحو جنوني، يفقدون أجلّ ميزاتهم الإنسانية فلا يتوازرون ولا يتناصحون ولا يتباذلون، واستحالت هذه النبالات في أعماقهم إلى غرائز ذئبية فخبثت سرائرهم وفسدت ضمائرهم وانفصمت عرى الود فيما بينهم، وانظر كيف ساقهم ذلك إلى الجبن الاجتماعي فيغضي أحدهم عن عيب صاحبه لأنه يخشى أن يواجهه بعيبه.
وقد عرفت أنه (ع) لا يتنكر لمن يعمل للدنيا على نحو لا يحيله إلى آلة جشعة لا تعرف معنى للشبع ولا للوقوف، وهو في هذا اللون الوعظي لا يدعو إلى هجر الدنيا وإنما يدعو إلى التخفيف من الضراوة في طلبها ويدعو إلى النظر إليها من زاوية الواقع وحده.
وإن طائفة من الناس تحيا هذا اللون البشع من الحياة المادية الخالصة التي وصفها الإمام (ع) في النص الذي قدمناه لبعيدة كل البعد عن المثل الأعلى للحياة في الإسلام فهؤلاء الذين أقفرت ضمائرهم من الشعور بالله وصار دين أحدهم لعقة على لسانه قد انقلب كل منهم إلى أنانية تمشي فيتنكر لمجتمعه ويسير على هدى شهواته. وأن العمل للدنيا على هذا النحو الذي يفقد الإنسان أجلّ ميزاته لهو عمل جدير بأن يحارب.
ـ 5 ـ
والتذكير بالماضين وبما عرض لهم من طوارق الدهر ونوازل الأيام، وبما ألم بهم من نكبات وآلام وكيف أن كل ما نصبوا أنفسهم لجمعه من مال لم يغن عنهم شيئاً حين حلَّ بهم الموت… هذا التذكير بالماضين يتخذه الإمام (ع) وسيلة إلى تجسيم الواقع الذي يزيفه الناس ويفرون منه ويتمردون.
والتاريخ عند العاملين للدنيا على نحو جنوني ينقلب إلى مادة للتسلية واللهو بدل أن يكون منبعاً للعبرة ومقيلاً من العثرة، وينقلب أيضاً صدى ميتاً لكائنات لا تصلهم بها صلة ولا تشدهم إليها وشيجة فلا تثير مآسيه فيهم طائف حزن ولا تمدهم تجاربه بالبصيرة. ويحاول الإمام في هذا اللون من مواعظه أن يصل ما انقطع بينهم وبين التاريخ بصلات الفكر والعاطفة، ووشائج العقل والقلب ليعود التاريخ في أنفسهم مادة غنية بالحياة والحركة فهي توجه وترشد وتمسك بالإنسان عن الزيغ والانحراف.
قال (ع):
«… وخلف لكم عبراً من آثار الماضين قبلكم، من مستمتع خلاقهم ومستفتح خناقهم، أرهقتهم المنايا دون الآمال، وشذ بهم عنها تخرم الآجال، لم يمهدوا في سلامة الأبدان ولم يعتبروا في أنف الأوان… أولستم أبناء القوم والآباء وإخوانهم والأقرباء؟ تحتذون أمثلتهم، وتركبون قدتهم، وتطأون جادتهم؟ فالقلوب قاسية عن حظها، لاهية عن رشدها، سالكة في غير مضمارها، كأن المعنيّ سواها وكأن الرشد في إحراز دنياها».
وهكذا يقرر (ع) صلة التاريخ بهم، وأنه ليس غريباً عنهم فهو تأريخ أبائهم وأمثالهم، ويقرر أيضاً أن هذا التاريخ مشلول عن عمله، فهو لا يقوم بدوره في صياغة حياتهم، لأنهم لا يزالون ينتهجون نفس الخطة التي انتهجها من قبل آباؤهم فكأن الدنيا عندهم غاية كل شيء ومنقطع كل غاية.
وقال (ع):
«.. فقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الأقلال وأمن العواقب ـ طول أمل واستبعاد أجلٍ ـ كيف نزل به الموت، فأزعجه عن وطنه وأخذه من مأمنه محمولاً على أعواد المنايا يتعاطى به الرجال الرجال، حملاً على المناكب وإمساكاً بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيداً ويبنون مشيداً ويجمعون كثيراً كيف أصبحت بيوتهم قبوراً وما جمعوا بوراً وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين».
وإذن فلم يغن عن هؤلاء تزييفهم لواقعهم وغرورهم بأنفسهم وحسبانهم أنهم خالدون. لقد دهمهم هذا الواقع وهم يحسبون أنهم في أمان، فهل أغنت عنهم أموالهم وهل حصنتهم قصورهم؟ لا، لقد ذهبوا، فليكن لك فيما صار إليه أمرهم عبرة تدفعك إلى اليقظة، وترحض عنك الغفلة.
ومن البين أن الإمام (ع) في هذا اللون من مواعظه لا يريد الناس على أن يفروا من دنياهم ويتركوا العمل لها، فقد رأيناه يكره هذا اللون من السلبية، إنما يريد إن يحملهم على أن ينظروا إلى الحياة من زاوية الواقع، وأن يصدروا في سلوكهم عن هذه الفلسفة العربية الواقعية الوادعة المصيبة.
ـ 6 ـ
ذكر الإمام (ع) أن طول الأمل ينسي الآخرة، ومن البين أن الإنسان حين ينسى أن ثمة عالماً آخر سيصير إليه فإنه يحصر جميع وجوه نشاطه في العمل لدنياه، ولا يتورع في عمله هذا عن سلوك أقبح الطرق الموصلة إلى حيازة المزيد من المال والتمتع بالمزيد من القوة، وهكذا يدفع طول الأمل إلى اتباع الهوى الذي عرَّفه الإمام؛ بأنه يصد عن الحق فهو يحمل صاحبه على ركوب كل شيء في سبيل الوصول إلى ما يريد.
فإذا تمكن طول الأمل واتباع الهوى من نفس إنسان حملاه على طلب الدنيا على نحو جنوني يجعله خطراً اجتماعياً وعلى نسيان العمل للآخرة.
في بعض الألوان الوعظية التي يحتويها القسم الوعظي من نهج البلاغة يحارب الإمام (ع) هذا الانحراف ويدعو الغافلين عن مصيرهم إلى العمل له. فإذا كان طول الأمل غروراً خادعاً وكان اتباع الهوى باطلاً وكنا نعلم بأن المصير هو الموت، وأننا سنصير بعد الموت إلى دنيا أخرى نجزى فيها بما قدمناه من أعمالنا نثاب إن أحسنا ونؤخذ بجرائرنا إن كنا من ذوي الجرائر. وإذا كان هذا كله حقاً فلماذا لا نقدم لأنفسنا ما نحرزها به غداً ونحن نعلم إننا حينذاك لا نملك أن نعمل شيئاً فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل، ونحن نعلم أن الموت قد يلم بنا في أي لحظة فلماذا التسويف؟
ومن البين أنه (ع) لا يدعو إلى ترك الدنيا وإنما يدعو إلى العمل للآخرة وكأن الإمام يدعو إلى الجمع بين الآخرة والدنيا، فهو لا ينهى عن العمل للدنيا؛ وإنما ينهى عن الاستغراق في هذا العمل بحيث ينسى الآخرة، ويقفر ضمير الإنسان من الشعور بالله، وينقطع ما بينه وبين مجتمعه من أواصر الود والرحمة، وذلك كله يحول بينه وبين أن يبلغ المثل الأعلى في الإسلام.
قال (ع):
«فليعمل العامل منكم في أيام مهله قبل إرهاق أجله، وفي فراغه قبل أوان شغله، وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه، وليمده لنفسه وقدومه، وليتزود من دار ظعنه لدار إقامته».
ولم يكن هذا العمل الذي أراده منهم صلاة ولا صوماً ولا حجاً فتلك أمور كانوا يأتون بها ولا يقعدون عنها لقد كان العمل الذي أراد هو الفضيلة، هو أن يكون كل منهم خلية اجتماعية حية تكدح في سبيل خير المجموع، هو أن يكونوا أحراراً فلا تستعبدهم الشهوات فتحملهم على الانحراف عن الحق ولا تستعبدهم الحياة فتحملهم على الرضا بها مسفة حقيرة عارية من كل نبالة رفيعة وهدف عظيم. كان يريدهم أن يحطموا أصنام اللحم التي يعبدونها أعني ساداتهم ورؤساءهم ومن له عليهم سلطان ليخلصوا العبادة لله وحده.
وقال (ع):
«… أن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب ويعاقب ولها يرضى ويسخط أنه لا ينفع عبداً ـ وأن أجهد نفسه وأخلص فعله ـ أن يخرج من الدنيا لاقياً ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها: أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته، أو يشفى غيظه بهلاك نفس، أو يُعرَّ بأمر فعله غيره، أو يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه أو يلقى الناس بوجهين، أو يمشي فيهم بلسانين إعقل ذلك فإن المثل دليل على شبهه».
في كل هذا لا يدعو الإمام إلى ترك الدنيا والانعتاق من أسرها؛ وإنما يدعو إلى تناولها برفق، ويدعو الناس إلى أن يكونوا كائنات سامية تجمع الدنيا إلى الآخرة، فلا تمعن في تلك إمعاناً يلهيها عن الاستعداد لهذه، ولا تغرق في هذه إلى حد يعطل فيها شخصية الإنسان.
ـ 7 ـ
والقسم الذي يعظ فيه الإمام (ع) بتقلب الدنيا وعدم قرارها على حال هو أشد الألوان الوعظية، فيما يبدو، حلوكة وتشاؤماً، أنه يصف فيه الدنيا بالتقلب والمكر والخداع. ويشبهها بالحية السامة ويدعو إلى الزهد فيها والانقطاع عنها.
ويلوح، في بادي النظر، أن الإمام في هذا القسم يدعو إلى ترك العمل للحياة ويدعو إلى الاستراحة إلى خيالات الموت والقبر، فيشل في الإنسان الرغبة في الحياة والإقبال عليها، ويقعد به عن الجهاد من أجلها ويحيله إلى إنسان متذائب واهن القوى.
ولكن قليلاً من التأمل والإمعان كفيل بأن يبين خطأ هذا الرأي.
فقد سبق منا أن تعرفنا على رأيه في الدنيا والعمل لها فرأيناه يحبذ العمل لها والإقبال عليها والتمتع بطيباتها شريطة ألا يقعد به ذلك عن العمل لآخرته والاستعداد لها، وشريطة ألا ينقلب به العمل للدنيا إلى وحش يصيب مجتمعه بالضرر في سبيل أن يزيد ثراءه، ورأيناه لا يشجع الانقطاع عن الدنيا والاستغراق في العمل للآخرة وحدها، ويعتبر ذلك أنانية لا يجمل بالرجل الكامل إن يمارسها، وسلبية لا تعبير إنساني سامياً فيها، يتبين ذلك كله في موقفه من العلاء بن زياد وأخيه عاصم.
ورأيناه يجمل رأيه في الدنيا والآخرة في هذه الفقرات:
«للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم معاشه وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل. وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير محرم».
هذا هو موقف الإمام من الدنيا والآخرة، فهو يشجع على العمل للدنيا في غير إسراف، ويأمر بالعمل للآخرة ولكن في غير إعنات. وهذا هو الموقف الطبيعي المعقول من الدنيا والآخرة فلا هو يقعد بالمجتمع عن تقدمه ولا هو يحيل الإنسان إلى آلة حاسبة فحسب.
ولكن هذا الموقف لا يلائم ما يقال عن هذا اللون من ألوان وعظه (ع) من أنه يدعو فيه إلى الاستراحة إلى خيالات الموت والقبر.
وإذا شئنا أن نلتمس حلاً صحيحاً لهذا التنافي الذي يلوح بين رأي الإمام في الدنيا وبين ما يبدو من هذا اللون الوعظي وجدنا مفتاح هذا الحل في وصفه للزهد وتعريفه له.
فالإمام (ع) يعرض في هذا اللون الوعظي جملة من الحقائق التي لا مراء فيها بأسلوب وعظي أعني مثير للرهبة في النفس.
فهو يقرر في كلامه: أن حياتنا بقدر ما تبدو رتيبة هي متقلبة في عنف وبقدر ما تبدو مسالمة هي تتربص في كتمان، وبقدر ما تبدو جميلة عظيمة فإنها تنطوي على حقارات وقبائح كثيرة، ثم يكون ختامها الموت، وهو حتم علينا سواء أرضيناه أم كرهناه.
وإذن فهؤلاء الذين يحسبونها مسالمة وادعة دائماً ويعتبرونها جميلة عظيمة دائماً ويعتبرونها حلوة سائغة دائماً مخدوعون إذ لا واقع لما يحسبون فهي في واقعها خليط من السعادة والشقاء والقلق والاطمئنان والشدة واللين، والإمام (ع) يبتغي في هذا اللون الوعظي أن يعرفهم بواقعها ليزهدوا فيها. والزهد الذي يريده الإمام غير الزهد في وعي العامة من الناس، فالزهد في وعي هؤلاء لا يعدو أن يكون موقفاً سلبياً من الحياة يشل في الإنسان إمكانات الخلق والإبداع عنده ويحيله إلى إنسان متذائب واهن. وكلمة زاهد في وعي هؤلاء تستدعي صورة كائن أقل ما يقال فيه أنه عالة على المجتمع. أما الزهد عند الإمام فهو تعبير آخر عن رأيه السابق في الدنيا والآخرة.
قال (ع) في صفة الزهد:
«أيها الناس: الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم».
فقد رأينا أن طول الأمل ينسي الآخرة ونسيان الآخرة يدفع بالمرء إلى اتباعٍ هواه، وعند ذلك يعود الإنسان خطراً اجتماعياً لأن ذلك ينقلب به إلى حيوان ذي غرائز طاغية لا كابح لها تطلب المزيد من كل شيء، فقصر الأمل عبارة عن وعي الإنسان لواقع حياته وأن الموت مدركه الآن أو غداً. وهذا الوعي يمسك يده عن الظلم حين لا يستطيع أن يصل إلى أغراضه إلاّ عن طريق الظلم، ويسل من نفسه الشره والمطامع والأحقاد. والشكر عند النعم، وهو الركيزة الثانية التي يقوم عليها الزهد عبارة عن فعل الخير وإسداء المعروف إلى الناس، فليس المراد من الشكر هنا الشكر باللسان لأن الشكر باللسان لا يقدم ولا يؤخر في رقي المجتمع وتقدمه. أن الشكر المراد هنا هو الشكر بالفعل. فهذا الذي يعرف الدنيا على واقعها زاهد فيها ولذلك فهو لا يمسك يده عن اصطناع المعروف لأنه يعي أن ما ينفقه في سبل الخير باق له عند الله وعند الناس. أما ما أمسك يده عليه فيصير إلى غيره ليتمتع به. والورع عند المحارم وهو الدعامة الثالثة من دعائم الزهد نتيجة طبيعية لفهم الدنيا على واقعها، فإذا كانت الدنيا لا تستقر على حال وكانت خاتمتها الموت لماذا نتهالك عليها على نحو يذهب بما فيها من بهجة فتغدو سلسلة من القلق والتربص والخداع والآلام؟ لماذا لا نأخذ منها بقدر، مترقبين نهايتها سعيدة كانت أو شقية فلئن كانت سعيدة فستنقضي ولماذا لا نقضيها على نحو أفضل ولئن كانت شقية فستنقضي أيضاً ولماذا نزيدها شقاء وتعاسة. حسبنا ما نلقى منها.
هذا هو الزهد، فهل نجد فيه تنفيراً من الدنيا وإقصاء عنها، لا، أنه الموقف الصحيح من الدنيا بين موقف المتهالكين عليها على نحو جنوني وبين موقف المباعدين لها على نحو مرضي.
وقال (ع):
«الزهد كلمة بين كلمتين من القرآن: قال الله سبحانه ﴿لِكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَا آتَاكُمْ﴾([409]) ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه».
فأولئك الذي يملك عليهم البابهم فوات شيء كانوا يترقبون الحصول عليه لا يؤمن منهم أن يقارفوا الإثم في سبيل الحصول عليه، وهؤلاء الذين تمتلىء أنفسهم بتصورات هذا الفائت لا يعود لديهم من فراغ النفس وصفاء الضمير ما يتيح لهم التسامي إلى دنيا أرحب وأنبل وأحفل بمثل الخير، وهؤلاء الذين يأسون على ما فاتهم ويفرحون بما أتاهم لا يستطيعون أن يشكروا الله على نعمته بأفعالهم فليسوا والحال هذه ذوي فائدة للمجتمع.
إن الزاهدين هم الذين ينظرون إلى الأمور نظرة واقعية فلا يملك عليهم البابهم فوات ما فاتهم ولا يعمي بصائرهم عن واقع حياتهم فرحهم بما أوتوا.
هذا هو الزهد الذي دعا إليه الإمام أصحابه وأرادهم عليه، فهل فيه تنفير عن الدنيا؟ اللَّهم لا وإنما هو كما قلنا: الموقف الطبيعي بين موقف المتهالكين على الدنيا على نحو جنوني والمباعدين لها على نحو مرضي.
هذا هو الزهد الذي يدعو إليه الإمام (ع) في هذا القسم الوعظي من كلامه. وهو موقف يوازن بين حاجات الإنسان الجسمية والروحية وهو موقف يجعل من الإنسان كائناً اجتماعياً ذا جدوى لمجتمعه ينفعه ويغنيه. ويجب أن نعي أن المتهالك على الدنيا، والمعدوم من الشعور الأخلاقي، المجرد من الإنسانية، الغير الشاكر، وبعبارة وجيزة الغير الزاهد هو خطر على المجتمع عالة عليه أكثر من خطر ذلك الزاهد الذي فهم الزهد فهماً خاطئاً فاتخذ من الدنيا موقفاً سلبياً مرضياً.
لأن غاية صنيع هذا أنه لا يعمل، وأنه يعيش عالة على أهله وذويه أما ذاك فعمله أنه يمتص دماء الفقراء بنشاطه الذي لا يعود على هؤلاء الفقراء في صورة خدمات اجتماعية.
وإذن فليس في هذا اللون الوعظي تشويه للحياة الدنيا وإبعاد عنها وذم لها إذا تناولها الإنسان كما ينبغي أن يتناولها، فلم يسرف فيها إسرافاً يحمله على الظلم وينقلب به إلى حيوان خطر. وإنما هو كبقية الألوان التي قدمنا فيما سبق ينصح فيه بالنظر إلى الدنيا كما هي لا كما تصورها لنا أوهامنا وأحلامنا، فإذا ما تم لنا فهمها دعانا إلى العمل فيها على هدى هذا الفهم. وقد رأينا أن موقفه من الحياة هو الموقف الصحيح الذي يدعو إليه الإسلام، أما الوعاظ الذين أخذوا كلامه على ظاهره، وأما ناشئة الجيل التي انفعلت بإيحاآت غريبة فهم جميعاً مخطؤون في فهمهم للقسم الوعظي من نهج البلاغة لأنهم لم يلقوا بالاً إلى المثل الأعلى في الإسلام الذي أراد الإمام أصحابه على الصعود إليه، ولم يلقوا بالاً إلى الواقع الاجتماعي الذي حمل الإمام على أن يفيض في مواعظه هذه الإفاضة ويعرض فيها هذه الألوان. ولم يعرفوا النظرة الواقعية الإسلامية الى الحياة الدنيا، النظرة التي تعبر عن نظرة الإمام إلى الحياة والإنسان.
محمد مهدي شمس الدين
علي بن أبي طالب في الشعر
كان علي بن أبي طالب (ع) ملهماً للشعراء على طوال العصور، وكانت سجاياه مصدراً للملاحم الشعرية الأصيلة، التي افتقدها الشعر العربي فلم يجدها إلاَّ عند شعراء المدائح العلوية وحدهم، عند الحميري وعند الكعبي وعند الأزري والعشرات من أمثالهم.
وعدا عن الملاحم فالقصائد التي تغنت بعلي هي غرة في جبين الشعر العربي في كل عصر…
إن النفوس البريئة التي لم تشوهها العصبيات، ولم تدنسها الأهواء، تتطلع أبداً إلى علي متمثلة فيه أنبل الخصال وأشرف المبادىء وأسمى الأهداف.
إن النفوس البريئة الكريمة تهيم أبداً بعلي، فيتدفق الشعر على السنة شعرائها عذباً سائغاً صادقاً، لا عند العرب وحدهم، بل عند غيرهم من الأمم ففي الشعر الفارسي والتركي والأردوي والسندي والمولتاني والكجراتي والألباني، ما يجمع في أدب كل أمة، دواوين من الشعر الحي الخالد.
ونكتفي هنا بنشر قصيدتين من شعر هذا العصر محيلين من يريد الاستزادة إلى موسوعة (أعيان الشيعة) وقصيدتين من الشعر القديم وقصيدة من المتوسط بينهما:
للسيد حسن محمود الأمين المتوفى سنة 1949م:
| فرقان مدحك يجلو ظلمة الريب | وآية الصدق تمحو آية الكذب | |
| تأبى علي القوافي إن أردت سوى | ثناك لكن له ينقاد كل أبي | |
| كالشمس مجدك يدنو وهو مرتفع | عن المنال لو أن الشمس لم تغب | |
| فما سناك عن النائي بمبتعد | ولا علاك من الداني بمقترب | |
| ما رام طائر فكر نحوه صعداً | إلاَّ هوى واقعاً عنه إلى صبب | |
| لو جال ما جال فكر المرء مرتقياً | إليك من سبب عال إلى سبب | |
| وجاء بالشعر دراً واستعان على | تبيان فضلك بالأنباء والكتب | |
| واستنطق الخرس من أقلامه فأتت | بالمعجزين بديع النظم والخطب | |
| ورام داني علاك أرتد منقلباً | نكساً على الرأس أو نكساً على العقب | |
| مناقب لك قد سارت شواردها | في كل أفق مسير الأنجم الشهب | |
| لم يحرز القوم ما أحرزت من قصب | ولم ينالوا وإن جدوا سوى النصب | |
| ما القوم كفؤك في علم ولا عمل | ولا فخار ولا مجد ولا حسب | |
| ولدت في البيت بيت الله فارتفعت | أركانه بك فوق السبعة الحجب | |
| وتلك منزلة لم يؤتها بشر | بلى ومرتبة طالت على الرتب | |
| ورحت تدرج في حجري نداً وعلا | ما بين أكرم أم في الورى وأب | |
| صحبت أحمد قبل الناس كلهم | ولم تكن عنه في حال بمنقلب | |
| صحبته وهو مغلوب فكنت له | في كل حادثة كالعين والهدب | |
| كأول الناس بالكرار آخرهم | فخراً وبدؤهم بالفخر كالعقب | |
| أضاف مجداً إلى مجد أبوه به | إضافة الذهب الأبريز للذهب | |
| ولم تزل عين خير الرسل ناظرة | إليه تكلؤه من أعين النوب | |
| ومذ ترعرع أدناه وقربه | منه وأنزله بالمنزل الخصب | |
| بحجره ضمه في يوم مسغبة | مخففاً عن أبيه وطأة السغب | |
| وكان يقطف من أزهار حكمته | ما شاء من أثر غض ومن أدب | |
| قد طهرته يد الباري فلا دنس | به يلم ولا ريب من الريب | |
| ما عفرت تربة الأصنام جبهته | كغيره لا ولم يذبح على النصب | |
| ساوى النبي وواساه بمحنته | ولم يكن حبله عنه بمنجذب | |
| ما عد من سنه إلاَّ كأنمله | حتى أصاب الذي بالعد لم يصب | |
| ونال أعلى مراقي الفضل وارتفعت | عليه أعلامه خفاقة العذب | |
| وحينما صدع الهادي بدعوته | للناس لباه قبل الناس للطلب | |
| أعطاه من نفسه ما لم يكن أحد | يعطاه من أحد في سالف الحقب | |
| وراح يكشف عنه كل داجية | من الخطوب ويجلو قسطل الكرب | |
| وقام من دونه بالسيف مصطلياً | نار الوغى غير هياب ولا نكب | |
| ويوم ندب ذوي القربى لنصرته | هل غيره من ذوي القربى بمنتدب | |
| لم يحفلوا بوعيد لا ولا عدة | لشر منقلب أو خير منقلب | |
| شتان بين مجيب للنداء ومن | أصمه الغي لم يسمع ولم يجب | |
| ويوم ضجت ثنايا مكة ودوت | شعابها بصدى الضوضاء والشعب | |
| وبات كل قبيل من قبائلها | يراقب الصبح أن يبصر سنا يثب | |
| وأجمع القوم أن يلقوا نبيهم | عند انبساط السنا في هوة العطب | |
| من في فراش رسول الله بات وقد | مدت إليه يد الرامين عن كثب | |
| رامت قريش به كيداً فكادهم | بالمرتضى وبه أن يرمهم يصب | |
| وقاه بالنفس والأعداء راصدة | تستنهض الموت بين السمر والقضب | |
| فأنزل الله (من يشري) بمدحته | ومن شرى نفسه لله لم يخب | |
| من مثله وبه باهى ملائكه | ومن له مثل ذاك الموقف العجب | |
| كم غمرة خاض يوم الشعب دونهم | وكم أنالهم في الشعب من أرب | |
| وكم له من يد بيضاء أخرجها | من غير سوء ولم تضمم من الرهب | |
| غرماً وجدك من أدى أمانته | ومن تحمل عنه مغرم الطلب | |
| أم من بأظعانه قد سار منفرداً | ولم يكن لسوى الماضي بمصطحب | |
| قد حاطهن بعزم غير منثلم | لدى الكفاح وبأس غير منثلب | |
| كفاه فخراً مؤاخاة النبي له | يوم المؤاخاة بين الصحبة النجب | |
| لو لم يكن خيرهم ما كان دونهم | لذلك الشرف الأعلى بمنتخب | |
| على علي رحى الإسلام دائرة | (وهل تدور رحا إلاَّ على قطب) | |
| كم كربة عن رسول الله فرجها | بمقول ذرب أو صارم ذرب | |
| سائل عتاه قريش يوم نفرهم | للحرب من ردهم بالويل والحرب | |
| خفوا لبدر سراعاً غير أنهم | ناؤوا بثقل المواضي والقنا السلب | |
| مالت بهم خيلاء طالما ظهرت | عليهم في ظهور الخيل والنجب | |
| أغراهم أنهم جم عديدهم | عند التصادم جم المال والأهب | |
| سرعان ما ضربوا فيها قبابهم | حتى هوت نكس الأعماد والطنب | |
| ريعوا بأغلب نظار على شوس | رفت عليه بنود النصر والغلب | |
| تقسموا فغدا للسيف بعضهم | حظاً وبعضهم للأسر والهرب | |
| من آب منهم فبالخسران أوبته | ومن علا هامه الصمصام لم يؤب | |
| لا تعجبن إذا أردى الكمي ولم | يسلبه فالليث لا يلوي على السلب | |
| قد أحصيت عدة القتلى فكان له | نصف ونصف لباقي الذادة الغلب | |
| واسأل بأحد سراياهم وقد نسلت | إلى الكفاح كمن ينحط من حدب | |
| ودار كأس الردى والسمر قد خطرت | والبيض غنت على الأدراع واليلب | |
| وفر من فر عن نصر النبي وقد | ضاق الخناق وشدت عقدة اللبب | |
| من غيره فرق الجيش اللهام ومن | سواه أودى بكبش الفيلق اللجب | |
| قد ضارب القوم حتى عاد صارمه | كضده رافلاً في بردة الشجب | |
| وآب كالأعزل الشاكي فقلده | بمصلت غير ناب الحد خير نبي | |
| لم يدخر لسواه ذو الفقار ولم | تخمد بغير شباه جمرة العرب | |
| تراه عند اشتداد الأمر مبتهجاً | ولم تذهب الحلم منه سورة الغضب | |
| واسأل بعزور والرهط الذين سعوا | من حوله في ظلام الحالك الأشب | |
| راموا على غرة قتل النبي وما | راموا سوى قتل وحي الله والكتب | |
| من حال من دون ما راموا وصدهم | عن قصدهم غير ذاك الباسل الحرب | |
| أذاق (عزور) كأس الحتف مترعة | والجأ النفر الباقين للهرب | |
| وكر ثانية في صحبه فقضى | عليهم بشبا عزم وذي شطب | |
| ألقى على حصنهم والملتجين له | قذائفاً من شظايا الخوف والرعب | |
| آل النضير وإن شيدت حصونهم | ليسوا من النبع إن عدواً ولا الغرب | |
| واسأل به فارس الأحزاب يوم سرا | وحوله عصب تأوي إلى عصب | |
| تقحم الخندق المشهور وهو على | مطعم يعقد الآذان بالذنب | |
| كالطير مرتقياً والسيل منحدراً | يعلو على الهضب أو يهوي عن الهضب | |
| ستون عاماً قضاها في الحروب ولم | توجس حشاشته خوفاً ولم تجب | |
| إن شبَّ عن طوقه عمرو وشاب ولم | يشب عن طوقه عمرو ولم يشب | |
| قد جال إذ جال والأبطال محجمة | كأنهم وهم الأشهاد في الغيب | |
| كم قد دعا معلناً في المسلمين إلاَّ | مبارز منكم يلقى المنية بي | |
| فلم يكن بينهم إلاَّ أبو حسن | وهم ثلاثة آلاف بمنتدب | |
| هناك قد وقف الإسلام أجمعه | والكفر أجمعه في موقف عجب | |
| ليثان كرَّا وصالا والعجاج بنى | عليهما قبباً مسدولة الحجب | |
| والناس من عسكري هذا وذاك رنت | إليهما وأدارت طرف مرتقب | |
| فلم يكن غير رد الطرف ناظره | حتى بدت لعلي آية الغلب | |
| أقام عمراً على ساق وأثكله | باختها فمشى زحفاً على الركب | |
| وافاه عند اللقا كالطود منتصباً | فخر كالطود لكن غير منتصب | |
| لوقع صارمه في الخافقين صدى | يمشي مع الدهر من حقب إلى حقب | |
| هبت عليه من «الكرار» عاصفة | ذرته ذرو سوافي الريح للكثب | |
| بقتله نال دين الله بغيته | وأحرز السبق واستولى على القصب | |
| واستوثق الأمر للإسلام وانقلبت | عساكر الشرك عنه أي منقلب |
للشيخ عبد المهدي مطر. أنشدها حين أهدي باب ذهبي لضريح أمير المؤمنين في النجف الأشرف سنة 1373هـ 1953م:
| إرصف بباب علي أيها الذهب | واخطف بأباصر من سروا ومن غضبوا | |
| وقد لمن كان قد أقصاك عن يده | عفواً إذا جئت منك اليوم اقترب | |
| لعلَّ بادرة تبدو لحيدرة | أن ترتضيك لها الأبواب والعتب | |
| فقد عهدناه والصفراء منكرة | لعينه وسناها عنده لهب | |
| ما قيمة الذهب الوهاج عند يد | على السواء لديها التبرو الترب | |
| ما سرّه أن يرى الدنيا له ذهباً | وفي البلاد قلوب شفها السغب | |
| ولا تضجر أكباد مفتتة | حتى يذوب عليها قلبه الحدب | |
| أو يسقط الدمع من عيني مولهة | أجابها الدمع من عينيه ينسكب | |
| تهفو حشاه لأنات اليتيم بلا | أم تناغي ولا يحنو عليه أب | |
| هذي هي السيرة المثلى تموج بها | روح الوصي وهذا نهجه اللحب | |
| فاحذر دخول ضريح أن تطوف به | إلاَّ بإذن علي أيها الذهب | |
| باب به ريشة الفنان قد لعبت | فأودعته جمالاً كله عجب | |
| تكاد لا تدرك الأبصار دقته | مما تماوج في شرطانه اللهب | |
| كأن لجة أنوار تموج به | خلالها صور الرائين تضطرب | |
| سبائك صبها الأبداع فارتسمت | روائع الفن فيها الحسن منسكب | |
| يدنو الخيال لها يوماً لينعتها | وصفاً فيرجع منكوساً وينقلب | |
| أدلت بها يد فنان منمقة | تعنو لروعتها الأجيال والحقب | |
| ملء الجوانح ملء العين رهبتها | ومربض الليث غاب ملؤه رهب |
* * *
| يا قالع الباب والهيجاء شاهدة | من بعد ما طفحت كأس بمن هربوا | |
| بابان لم ندر في التبريح أيهما | أشهى إليك حديثاً حين يقتضب | |
| باب من التبر أم باب يقومه | مسماره وجذوع النخل والخشب | |
| هذا يشع عليه التبر ملتهباً | وذاك راح بنار الحقد يلتهب | |
| وأي داريك أحرى أن نطوف بها | وان تجللها الأستار والحجب | |
| دار تحج بها الدنيا لمجدك أم | دار عليك بها العادون قد وثبوا | |
| هذي تدال بها للحق دولته | زهواً وفي تلك فيء الحق يغتصب | |
| حتى إذا جاءت الدنيا مكفرة | عما جنته وجاء الدهر يتهب | |
| شادت عليك ضريحاً تستطيل على | هام السماء به الأعلام والقبب | |
| وتلك عقبى صراع قد صبرت له | وذا فديتك مظلوماً هو الغلب |
* * *
| بلغ معاوية عني مغلغلة | وقل له وأخو التبليغ ينتدب | |
| قم وانظر العدل قد شيدت عمارته | والجور عندك خزي بيته خرب | |
| تبني على الظلم صرحاً رن معوله | بجانبيه وهدت ركنه النوب | |
| أبت له حكمة الباري بصرختها | أن لا يخلد مختال ومرتكب | |
| قم وانظر الكعبة العظمى تطوف بها | حشد الألوف وتجثو عندها الركب | |
| تأتي له من أقاصي الأرض طالبة | وليس إلاَّ رضا الباري هو الطلب | |
| قل للمعربد حيث الكأس فارغة | خفض عليك فلا خمر ولا عنب | |
| سموك زوراً أمير المؤمنين وهل | يرضى بغير (علي) ذلك اللقب | |
| هذا هو الرأس معقود لهامته | تاج الخلافة فأخسأ أيها الذنب | |
| يا باب (حطة) سمعاً فالحقيقة قد | تكشفت حيث لا شك ولا ريب | |
| مواهب الله قد وافتك مجزية | ما كنت تبذل من نفس وما تهب | |
| هذي هو الوقفات الغر كنت بها | للدين حصناً منيعاً دونه الهضب | |
| هذي هي الضربات الوتر يعرفها | ضلع بها انقد أو جنب بها يجب | |
| هذي هي اللمعات البيض كان بها | عن وجه خير البرايا تكشف الكرب | |
| هذي هي النفس قد روضت جامحها | فراق للعين منها عيشها الجشب | |
| فلا الخوان لها يوماً ملونة | منه الطعوم ولا أبرادها قشب | |
| لا تكتسي وفتاة الحي عارية | ولا تعب ومهضوم الحشا سغب | |
| نفس هي الطهر ما همت بموبقة | وليس تعرف كيف الذنب يرتكب | |
| هذي التي انقادت الأجيال خاشعة | لهديها وترامت عندها النجب | |
| تعيفوا وركبنا في سفينته | فميز اللج من عافوا ومن ركبوا | |
| وساوموا فاشترينا حب «حيدرة» | ولا نبيع ولو أن الدنا ذهب | |
| يا فرصة كنت للإسلام ضيعها | حقد النفوس وأبلى جدها اللعب | |
| شجوا برغمك أمراً أنت تعصبه | في ذمة الله ما شجوا وما شجبوا | |
| فرحت تنفض من هذا الحطام يداً | إذ شمت فيه يد الأطماع تنتشب | |
| تكالب عنه قد نزهت محتقراً | له وعندك ما يشفى به الكلب | |
| فاستنزلوك عن العرش الذي ارتفعت | بك القواعد منه فهو منتصب | |
| لو أنصفوك لفاض العلم منتشراً | في الخافقين وسارت بالهدى كتب | |
| ولازدهى باسمك الإسلام دوحته | فينانة وفناه مربع خصب | |
| ولابتنيت عليه من سماء علا | ما ليس تأفل عن أفاقها الشهب | |
| لله أنت فقد حملت من محن | ما لم يطق صابر في الله محتسب | |
| أمر به ضاقت الدنيا بما رحبت | ولم يضق عنه يوماً صدرك الرحب |
من قصيدة لسفيان بن مصعب العبدي المتوفى حدود سنة 120هـ:
| ما هز عطفي من شوق إلى وطني | ولا اعتراني من وجد ومن طرب | |
| مثل اشتياقي من بعد ومنتزح | عن (الغري) وما فيه من الحسب | |
| أزكى ثرى ضم أزكي العالمين فذا | خير الرجال وهذي أشرف الترب | |
| إن كان عن ناظري بالغيب محتجباً | فإنه عن ضميري غير محتجب | |
| مرت عليه ضروع المزن رائحة | من الجنوب فروته من الحلب | |
| بل جاد ما ضم ذاك الترب من شرف | مزن المدامع من جار ومنسكب | |
| ولو تكون لي الأيام مسعدة | لطاب لي عنده بعدي ومقتربي | |
| يا راكباً جسرة تطوي مناسمها | ملاءة البيد بالتقريب والخبب | |
| بلغ سلامي قبراً بالغري حوى | أوفى البرية من عجم ومن عرب | |
| واجعل شعارك لله الخشوع به | وناد خير وصي صنو خير نبي | |
| اسمع أبا حسن أن الأولى عدلوا | عن حكمك انقلبوا عن خير منقلب | |
| ما بالهم نكبوا نهج النجاة وقد | أوضحته واقتفوا نهجاً من العطب | |
| ودافعوك عن الأمر الذي اعتلقت | زمامه من قريش كف مغتصب | |
| ظلت تجاذبها حتى لقد خرمت | خشاشها([410]) تربت من كف مجتذب | |
| وأنت توسعه صبراً على مضض | والحلم أحسن ما يأتي مع الغضب | |
| وكنت قطب رحى الإسلام دونهم | ولا تدور رحى إلاَّ على قطب |
من قصيدة لأبي تمام الطائي المتوفى سنة 231هـ:
| أخوه إذا عد الفخار وصهره | فلا مثله أخ ولا مثله صهر | |
| وشد به أزر النبي محمد | كما شد من موسى بهارونه الأزر | |
| وما زال صباراً دياجير غمرة | يمزقها عن وجهه الفتح والنصر | |
| هو السيف سيف الله في كل مشهد | وسيف الرسول لا ددان ولا دثر([411]) | |
| فأي يد للذم لم يبر زندها | ووجه ضلال ليس فيه له أثر | |
| ثوى ولأهل الدين أمن بعده | وللواصمين الدين في حده ذعر | |
| يسد به الثغر المخوف من الردى | ويعتاص([412]) من أرض العدو به الثغر | |
| بأحد وبدر حين ماج برجله | وفرسانه أحد وماج بهم بدر | |
| ويوم حنين والنضير وخيبر | وبالخندق الثاوي بعقوته عمرو | |
| سما للمنايا الحمر حتى تكشفت | وأسيافه حمر وأرماحه حمر | |
| مشاهد كان الله كاشف كربها | وفارجه والأمر ملتبس أمر | |
| ويوم الغدير استوضح الحق أهله | بفيحاء لا فيها حجاب ولا سر | |
| أقام رسول الله يدعوهم بها | ليقربهم عرف وينآهم نكر | |
| فكان له جهر بأثبات حقه | وكان لهم في بزهم حقه جهر | |
| لكم ذخركم أن النبي ورهطه | وجيليهم ذخري إذا التمس الذخر | |
| جعلت هواي الفاطميين زلفة | إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمر |
للحاج هاشم الكعبي المتوفى سنة 1221هـ من قصيدة:
| أخذوا بمسروب السارب وجانبوا | عذباً يمير الوافدين برودا | |
| أنّى يشق غبار شأوك معشر | كنت الوجود لهم وكنت الجودا | |
| يجنون ما غرست يداك قضية | ألقت على شهب العقول خمودا | |
| أنّى هم والخيل بنشر وقعها | نقعاً تظن به السماء كديدا | |
| ومواقف لك دون أحمد جاوزت | بمقامك التعريف والتحديدا | |
| فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى | تهدي إليك بوراقاً ورعودا | |
| فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما | يهدي القراع لسمعك التغريدا | |
| فكفيت ليلته وقمت معارضاً | بالنفس لا فشلاً ولا رعديدا | |
| واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم | جبلاً أشم وفارساً صنديدا | |
| رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى | أو ما دروا كنز الهدى مرصودا | |
| ما أنصفتك عصابة جهلتك إذ | جعلت لذاتك في الوجود نديدا | |
| قد خالفت نص النبي عليك في | «خم» وهم كانوا عليه شهودا | |
| باعتك وابتاعت بجوهر ذاتك الـ | ـعلوي سفلي المبيع رديدا | |
| ضلت أدلتها أتبدل بالعمى | رشداً وبالعدم المحال وجودا |
علي بن أبي طالب في الشعر العالمي
الإسلامي وفي القصة والملحمة العربيتين
مؤرخو الأدب العربي المحدثون يقررون جازمين خلو الشعر العربي القديم من الملاحم والقصص، ويعللون ذلك بمختلف التعاليل. يقررون ذلك ويلقونه لقرائهم وطلابهم كحقيقة مسلمة يبتنى عليها الكثير من النتائج.
والحقيقة هي عكس ما قرره هؤلاء المؤرخون، فالشعر العربي القديم لم يخل من الملحمة والقصة، بل أن بعض تلك الملاحم وبعض تلك القصص يبلغ ذروة الإبداع، ويُسلك مع روائع الشعر العربي الأصيل.
ولو وسَّع هؤلاء المؤرخون مطالعاتهم وتغلغلوا قليلاً في بطون بعض المدونات المطبوعة المنتشرة لعدلوا عن رأيهم ورجعوا عن تقريرهم، ولباهوا بما تضمنه الشعر العربي من فن القصة والملحمة.
أما القصة فهي متكاملة جامعة لكل ما يطلب في القصص العالمي من شروط الإبداع والتكامل. وأما الملحمة فليست على هذا المستوى، إذ ينقصها بعض ما يشترط في هذا النوع من الشعر، ولكنها تظل على كل حال شعراً ملحمياً لا يجوز تجاهله عندما يؤرخ المؤرخون للأدب العربي.
الشعر القصصي والشعر الملحمي موجودان في شعر الشعراء الذين شاقتهم سيرة علي بن أبي طالب، وما تضمنته شخصيته من خصائص تفرد بها فأولعوا بذلك وانبهروا به فترجموا هذا التولع وهذا الانبهار إلى شعر عال، كان الموجز منه قصصاً جميلة عذبة، وكان المطول منه نوعاً من الملاحم التي لا تقل روعة عن أي ملحمة عالمية شهيرة.
وأكثر من ذلك فقد كانت شخصية علي بن أبي طالب مؤثرة لا في الشعر العربي وحده حيث أوجدت فيه الملحمة والقصة، بل في أشعار كل اللغات الإسلامية، وكانت العامل الأقوى في تحويل بعض تلك اللغات من لغات تخاطب إلى لغات تدوين وكتابة.
فاللغة الأردوية مثلاً، وهي اللغة الرسمية لدولة الباكستان ولغة عشرات الملايين من المسلمين الهنود. إن هذه اللغة لم تكن في بادىء أمرها إلاَّ لغة تخاطب فقط، ولم تكن لغة شعر وأدب وتدوين، وكان السبب في تحولها إلى كل ذلك هم الذين انبهروا بشخصية علي بن أبي طالب مضافاً إليها شخصية ولده الحسين فكان أن نطقوا بالشعر معبراً عما انبهروا به، وكان لا بدَّ من تدوين هذا الشعر. فكان ديوان الملك الشاعر محمد قطب شاه (973 ـ 1030هـ) هو أول ديوان شعري باللغة الأردوية، وشعر هذا الديوان مستوحى من شخصية علي أولاً ثم من شخصية الحسين.
ثم تتابع الشعر الأردوي بعد ذلك فكانت فيه الملاحم العلوية والحسينية كشعر الشاعر (سودا) (1125 ـ 1195هـ) وشعر الشاعر (غالب) (1212 ـ 1286هـ) وشعر الشاعر (أنيس) (1216 ـ 1291هـ) وشعر الشاعر (دبير) 1218 ـ 1292هـ) وغيرهم من الشعراء الهنود.
وكذلك القول في غيرها من لغات الباكستان كاللغة الملتانية، فقد كان أول ما دون فيها مدائح علي بن أبي طالب ومراثي الحسين في شعر ملحمي رائع، فمن ذلك ملحمة (ذو الفقار) في خمسمائة بيت التي نظمها الشاعر (غلام حيدر فدا)، وقصائد الشاعرين الأخوين (فداء حسين جهندير) و(نذير حسين جهندير)، والثاني منهما نظم باللغة الملتانية خطبة زينب في دمشق فجاءت في مئة وعشرين بيتاً.
وهناك أيضاً في اللغة نفسها شعراء غير هؤلاء نذكر منهم غلام علي، والسيد فضل حسين شاه، ميزتهم الأولى مدائح أهل البيت ومراثيهم.
ومن (سركودها) إلى (ديرة إسماعيل خان) إلى ما قبل مدينة (ملتان) بعشرين ميلاً على ضفَّة نهر السند تسكن جماعة، خرج من بينهم كبار شعراء المدائح العلوية والمراثي الحسينية الذين يبلغ المدون من شعرهم ما يقرب من ثلثي شعر اللغة الملتانية، ما عدا غير المدون الذي ينتقل على الأفواه من إنسان لآخر.
ومثل هذا يمكن أن يقال في اللغة السندية وبقية اللغات الباكستانية.
وشاعر الأتراك المتفوق (فضولي) الذي يسميه الأتراك رئيس الشعراء ويعدونه أستاذ الكل، والذي لقَّبه الشاعر التركي المشهور عبدالحق حامد: (بالشاعر الأعظم وشيخ الشعراء وأعظم شعراء الشرق)، شاعر الأتراك هذا سار على الطريق نفسه، وقد صرَّح هو في أمدوحة نظمها وهو في جلال السن بأنه مدح علي بن أبي طالب خمسين سنة. وليس في الشعراء الأتراك من له شهرة فضولي إذا استثنينا نسيمي ونوائي. وعدا الشاعر فضولي فإن الأدب التركي يزخر بالشعر العلوي والحسيني، ففي القرن الرابع عشر نظم الشاعر نقيب أوغلي قصة الحسن والحسين، وهو معاصر لشلبي عريف المتوفى سنة 719هـ وفي القرن نفسه هناك قصيدة (دستان مقتل حسين) نظمها شاعر يدعى شادي أو شياد سنة 763هـ بقسطموني، كذلك نظم معاذ أوغلي حسن البك بازاري ما يعرف بالمثنوي في غزوات علي. وفي سنة 803هـ (1400م) كان أول ما صنف في الروملي قصيدة في رثاء السيدة فاطمة الزهراء نظمها خليل إمام مسجد قره بولت من أعمال أدرنة.
وكذلك ظهرت في القرن الرابع عشر تواليف شعبية تصف غزوات النبي (ص) ومعجزاته بصفة عامة وبطولات علي (ع) بصفة خاصة، وقد صيغت هذه التواليف في قالب المثنويات.
وأما في النثر فقد ظهرت كتب السير التي ألفت في الزهراء والحسن والحسين (عليهم السلام) وما جرى بكربلاء. وكل الذي ذكرناه يعد من روائع الأدب التركي.
وفي الشعر الألباني بلغت المدائح العلوية والمراثي الحسينية الذروة وفي الطليعة منها ملحمة الشاعر نعيم فراشري التي نظمها ما بين السنة 1892 ـ 1895م وطبعت لأول مرة سنة 1898م والتي بلغ عدد أبياتها عشرة آلاف بيت وسماها (كربلا). وفي اللغة البنغالية، لغة الشاعر طاغور نظم الشاعر محمد خان (مقتل الحسين) سنة 1645م والشاعر عبدالحكيم نظم (كربلا) والشاعر حياة محمود نظم (جنك نامه) 1723م والشاعر محمد يعقوب نظم (مقتول حسين) سنة 1694م. وهذا الذي نُظم في الحسين هو امتداد لما نُظم في أبيه.
ولسنا الآن بصدد استقصاء الملاحم العلوية في شعر اللغات الإسلامية، وإنما أردنا الإشارة إلى ما تركته شخصية علي بن أبي طالب من أثر في الشعر الإسلامي العالمي، تاركين التفاصيل إلى وقت آخر.
وإذا كانت تلك الشخصية قد أثمرت ما أثمرت من ملاحم في الشعر غير العربي، فقد كان من العجيب أن لا يكون لها مثل هذا الإثمار في الشعر العربي، وهي بهذا الشعر أعلق وإليه أقرب.
وقد كان على مؤرخي الأدب العربي أن تلفتهم هذه الظاهرة فتدفعهم إلى التنقيب والتفتيش، ولو فعلوا لما عانوا مشقة في العثور على ما يبتغون.
في الشعر القصصي يأتي (السيد الحميري) (105 ـ 173هـ) بارزاً مجلياً فقد تقصى قضايا علي بن أبي طالب قضية قضية فنظمها كلها شعراً، حتى لقد وقف ذات يوم في المربد بالبصرة وهو راكب على جواد، ونادى من جاءني بمنقبة لعلي بن أبي طالب لم أنظم فيها شعراً فله جوادي هذا، فذكر له رجل حاضر هناك منقبة وقال له هل نظمت فيها شيئاً من الشعر؟ فقال: لا، ونزل عن جواده ودفعه إلى الرجل.
وقبل الحديث عن شعره القصصي لا بدَّ لنا من كلمة تعريف به: فهو إسماعيل بن محمد، وغلب عليه لقب: (السيد الحميري)، ولد بعُمان ونشأ بالبصرة وتوفي ببغداد أول أيام الرشيد بعد أن أدرك خمسة من ملوك بني العباس: السفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد.
وهو في الطليعة من شعراء عصره وتميز عنهم بشعره الملتزم الذي خصَّ به أهل البيت جميعاً وميز علياً فأفرده بروائعه التي تكوَّن بمجموعها الشعر القصصي العربي، وانصرف عن مدح الملوك والأمراء إلاَّ ما ندر وأوجبته الضرورة، وابتعد عن التكسب بمالهم، مما حمل شاعراً مثل بشار بن برد أن يقول له: لولا أن الله شغلك بمدح أهل البيت لافتقرنا!. أي أنه لو زاحمهم على مدح أصحاب السلطة لفاقهم في ذلك فيكسد شعرهم ويبور.
وقد عبر عن التزامه بكثير من الشعر مثل قوله:
| إلى أهل بيت أذهب الرجس عنهم | وصفوا من الأدناس طراً وطيبوا | |
| إلى أهل بيت ما لمن كان مؤمناً | من الناس عنهم في الولاية مذهب | |
| ومن خصيم لامني في هواهم | وعاذلة هبت بليل تؤنب |
ثم يشير إلى تركه مدح المتسلطين وحرمانه نفسه من جوائزهم:
| تركت امتداح المفضلين ذوي الندى | ومن في ابتغاء الخير يسعى ويرغب |
ثم يشير إلى توقي الناس له وتباعدهم عنه حتى أقرباؤه لاشتهاره بأنه معارض عنيد:
| وفارقت جيراناً وأهل مودة | ومن أنت منهم حين تدعى وتنسب | |
| فأنت غريب فيهم متباعد | كأنك مما يتقونك أجرب |
ثم يعلن إصراره على موقفه وعدم التحول عن مبدئه مهما لقي من حرمان وتنكر:
| فقلت دعيني لن أحبّر مدحة | بغيرهم ما حجَّ لله راكب |
وقد ذكر أحد من جمعوا شعره في عصره أنه جمع له ألفين وثلاثمائة قصيدة في أهل البيت وظنَّ أنه قد استوعب شعره حتى جلس إليه يوماً رجل فسمعه ينشد شيئاً من شعره، فإذا بهذا الرجل ينشده ثلاث قصائد لم تكن عند جامع شعره فقال: وعرفت حينئذٍ أن شعره ليس مما يدرك.
وكان له ديوان مجموع في حياته يفهم من بعض الروايات أنه كان معروفاً محفوظاً. ولكن الأيام ذهبت بشعره ولم يبق منه إلاَّ ما كان في تضاعيف الكتب والمؤلفات. ويقول صاحب الأغاني: كان السيد إذا استنشد شيئاً من شعره لم يبدأ بشيء إلاَّ بقوله:
| أجد بآل فاطمة البكور | فدمع العين منهمر غزير |
ومن نقمته على المداحين قوله وقد سمع الشاعر بشاراً ينشد الشعر:
| أيها المادح العباد ليعطى | أن لله ما بأيدي العباد | |
| فاسأل الله ما طلبت إليهم | وارج نفع المنزل العواد | |
| لا تقل في الجواد ما ليس فيه | وتسمي البخيل باسم الجواد |
وبلغ من التزامه الكامل بمبدئه أنه كان لا يطيق الجلوس في مجلس لا يتردد فيه ذكر الذين التزم بهم وخصهم بمدائحه فقد حضر مجلساً خاض حاضروه في ذكر الزرع والنخل فنهض فقالوا له: ممّ القيام؟ فقال:
| إني لأكره أن أطيل بمجلس | لا ذكر فيه لفضل آل محمد | |
| لا ذكر فيه لأحمد ووصيه | وبنيه ذلك مجلس قصف ردي | |
| إن الذي ينساهم في مجلس | حتى يفارقه لغير مسدد |
أما أبرز قصائده القصصية فهي القصيدة التي عرفت باسم (القصيدة المذهبة)، وقد قال فيها التوزي: لو أن شعراً يستحق أن لا ينشد إلاَّ في المساجد لحسنه لكان هذا، ولو خطب به خاطب على المنبر في يوم جمعة لأتى حسناً وحاز أجراً، مع أن التوزي هذا لم يكن مع الشاعر على فكر واحد ولا يعتنق جميع مبادئه، ولكن إعجابه بالشعر دعاه إلى هذا القول. وكذلك كان الحال مع الشاعر مروان بن أبي حفصة الذي يتناقض كل التناقض في الاتجاه مع السيد الحميري. ولكن نزعته الشعرية وتقديره للفن تغلبا على ذلك فعندما تليت القصيدة في حضوره كان يقول عند كل بيت: سبحان الله ما أعجب هذا الكلام.
والقصيدة تروي حياة علي بن أبي طالب رواية قصصية تجمع كل شروط القصة الشعرية، ويمكن أن تعتبر في هذا المجال أعلا نموذج لهذا الضرب من الشعر، ودليلاً واضحاً على أن الأدب العربي لم يخل ـ كما يطيب لمؤرخي هذا الأدب أن يقولوا ـ من الشعر القصصي الرفيع، وهذا نموذج من تلك القصيدة يروي القصة عذبة الرواية، رائقة السرد، جميلة التركيب، تتدفق تدفق السلسال:
| ولقد سرى فيما يسير بليلة | بعد العشاء بكربلا في موكب | |
| حتى أتى متبتلاً في قائم | ألقى قواعده بقاع مجدب | |
| بانيه ليس بحيث يلقى عامراً | غير الوحوش وغير أصلع أشيب | |
| في مدمج زلق أشم كأنه | حلقوم أبيض ضيق مستصعب | |
| فدنا فصاح به فأشرف ماثلاً | كالنسر فوق شظية من مرقب | |
| هل قرب قائمك الذي بوئته | ماء يصاب، فقال ما من مشرب | |
| إلا بغاية فرسخين ومن لنا | بالماء بين نقأ وقيٌّ سبب | |
| فثنى الأعنة نحو وعث فاجتلى | ملساء تبرق كاللجين المذهب | |
| قال: اقلبوها إنكم إن تقلبوا | ترووا ولا تروون إن لم تقلب | |
| فاعصوصبوا في قلعها فتمنعت | منهم تمنع صعبة لم تركب | |
| حتى إذا أعيتهم أهوى لها | كفا متى ترد المغالب تغلب | |
| فكأنها كرة بكف حزوّر | عبل الذراع دحابها في ملعب | |
| فسقاهم من تحتها متسلسلاً | عذباً يزيد على الألذ الأعذب | |
| حتى إذا شربوا جميعاً ردها | ومضى فخلت مكانها لم يقرب | |
| أعني ابن فاطمة الوصي ومن يقل | في فضله وفعاله لم يكذب([413]) | |
| ليست ببالغة عشير عشير ما | قد كان أعطيه مقالة مطنب |
ويقص قصة هجرة النبي (ص) ومبيت علي (ع) في فراشه لتضليل المتربصين بقتله، بهذا الأسلوب الرائق العذب:
| وسرى بمكة حين بات مبيته | ومضى بروعة خائف مترقب | |
| باتوا وبات على الفراش ملفعاً | فيرون أن محمداً لم يذهب | |
| حتى إذا طلع الشميط كأنه | في الليل صفحة خد أدهم مغرب | |
| ثاروا لأخذ أخي الفراش فصادفت | غير الذي طلبت أكف الخيب | |
| فوقاه بادرة الحتوف بنفسه | حذراً عليه من العدو المجلب | |
| حتى تغيب عنهم في مدخل | صلى الإله عليه من متغيب | |
| وجزاه خير جزاء مرسل أمة | أدى رسالته ولم يتهيب | |
| فتراجعوا لما رأوه وعاينوا | أسد الإله وعصبوا في منهب | |
| قالوا اطلبوه فوجهوا من راكب | في مبتغاه وطالب لم يركب | |
| حتى إذا قصدوا لباب مغارة | ألفوا عليه نسيج غزل العنكب | |
| صنع الإله له فقال فريقهم | ما في المغار لطالب من مطلب | |
| ميلوا وصدهم المليك ومن يرد | عنه الدفاع مليكه لا يعطب | |
| حتى إذا أمن العيون رمت به | خوص الركاب إلى مدينة يثرب | |
| فاحتل دار كرامة في معشر | آووه في سعة المحل الأرحب |
ويقص قصة خيبر وفتح علي لحصون اليهود وقتله مرحباً:
| وله بخيبر إذ دعاه لراية | ردت عليه هناك أكرم منقب | |
| فمشى بها قبل اليهود مصمماً | يرجو الشهادة لا كمشي الأنكب | |
| تهتز في يمنى يدي متعرض | للموت أروع في الكريهة محرب | |
| في فيلق فيه السوابغ والقنا | والبيض تلمع كالحريق الملهب | |
| والمشرفية في الأكف كأنها | لمع البروق بعارض متحلب | |
| وذوو البصائر فوق كل مقلص | نهد المراكل ذي سبيب سلهب | |
| حتى إذا دنت الأسنة منهم | ورموا فنالهم سهام المقنب | |
| شدوا عليه ليرجلوه فردهم | عنه بأسمر مستقيم الثعلب | |
| ومضى فأقبل مرحب متذمراً | بالسيف يخطر كالهزبر المغضب | |
| فتخالسا مهج النفوس فأقلعا | عن جري أحمر سائل من مرحب | |
| فهوى بمختلف القنا متجدلاً | ودم الجبين بخده المتترب | |
| أجلى فوارسه وأجلى رجله | عن مقعص بدمائه متخضب |
ويقص قصة غدير خم:
| وبخم إذ قال الإله بعزمه | قم يا محمد بالولاية فاخطب | |
| وانصب أبا حسن لقومك إنه | هاد وما بلغت إن لم تنصب | |
| فدعاه ثم دعاهم فأقامه | لهم فبين مصدق ومكذب | |
| جعل الولاية بعهده لمهذب | ما كان يجعلها لغير مهذب |
وعلى هذا النسق يروي حياة علي بن أبي طالب مرحلة مرحلة، بمثل هذا الشعر السهل الممتنع، فيتألف من مجموع ذلك قصة متكاملة شيقة تدحض زعم الزاعمين خلو الأدب العربي من الشعر القصصي، وتؤكد مع غيرها من شعر السيد الحميري أن هذا الأدب يستطيع أن يباري آداب الأمم الأخرى بهذا النوع من الشعر.
ويختم السيد الحميري قصته هذه بالإصرار على آرائه مصوراً حاله حين يسمع ذكر الناس الذين أحبهم:
| وكأن قلبي حين يذكر أحمداً | ووصي أحمد نيط من ذي مخلب | |
| بذرى القوادم من جناح مصعد | في الجو أو بذرى جناح مصوب | |
| حتى يكاد من النزاع إليهما | يفري الحجاب عن الضلوع الصلب | |
| هبة وما يهب الإله لعبده | يزدد ومهما لا يهب لا يوهب |
الشعر الملحمي
كما قلت فيما تقدم أقول الآن: إنه إذا كانت القصة الشعرية العربية قد جاءت في شعر الشعراء الملتزمين متكاملة جامعة لكل ما في القصص العالمي من شروط الإبداع والتكامل، فإن الملحمة الشعرية العربية عند هؤلاء الشعراء لم تكن على هذا المستوى إذ ينقصها بعض ما يشترط في هذا النوع من الشعر، ولكنها تظل على كل حال شعراً ملحمياً، أو على الأقل نواة الشعر الملحمي العربي التي تمهد لمن يريد أن يسلك هذا السبيل في المستقبل.
ولكن لم يظفر الشعر العربي بعد هذه المحاولات الناجحة بمن ينسج على منالها، فضلاً عمن يتجاوزها إلى الأكمل، لذلك ظلت وحدها مظهر الملحمة العربية. وقد كانت جديرة بعناية مؤرخي الأدب العربي ودارسيه، ولكن لم تنل هذه العناية وأهملت إهمالاً لأسباب ليس من الضروري تبيانها في هذا المقال.
وأقدم من عرفناه ممن نظموا في هذا الفن (أحمد بن علوية الأصفهاني) المتوفى سنة 320هـ بعد أن تجاوز المئة من سني عمره. فقد نظم ملحمته في ألف بيت من الشعر على روي واحد، سميت بالألفية وبالمحبرة، ومع توالي الأزمان أخذ يضيع بعضها حتى لم يوجد منها في عصر العلامة الحلي المتوفى سنة 726هـ سوى ثمانمائة بيت ونيف وثمانين بيتاً، ثم تتابعت القرون ويتتابع معها ضياع (الألفية) حتى لم يصل منها إلى هذا القرن إلاَّ مقطوعات متفرقة في أكثر من مكان، فعمل بعض المؤلفين على جمعها وضمها بعضها إلى بعض، فاجتمع لأحدهم 224 بيتاً ولآخر ما يقرب منه 250 بيتاً. وقد كانت ـ على ما يبدو من روايات المؤرخين ـ متداولة معروفة، فقد جاء في معجم الأدباء إنها عرضت على أبي حاتم السجستاني فأعجب بها وقال: يا أهل البصرة غلبكم أهل أصفهان.
ومن نماذجها وصفه لمواقف علي في معركة بدر:
| وله ببدر إن ذكرت بلاءه | يوم يشيب ذوائب الولدان | |
| كم من كمي حل عقدة بأسه | فيه وكان ممنع الأركان | |
| فرأى به هصراً يهاب جنابه | كالضيغم المستبسل الغضبان | |
| إذ من ذوي الرايات جدل عصبة | كانوا كأسد الغاب من خفان | |
| لا سيف إلاَّ ذو الفقار ولا فتى | إلاَّ أبو حسن فتى الفتيان |
وعن يوم غدير خم يقول:
| وله إذا ذكر الغدير فضيلة | لم ننسها ما دامت الملوان | |
| قام النبي له بشرح ولاية | نزل الكتاب بها من الديان | |
| إذ قال بلغ ما أمرت به وثق | منه بعصمة كالىء حنان | |
| نادى: ألست وليكم؟ قالوا بلى | حقاً، فقال: فذا الولي الثاني |
وعلى هذا النسق يمضي فيما وصلنا من ملحمته.
ونترك العصور القديمة لنصل إلى هذه الأخيرة فنرى ملاحم تتابع لشعراء مبدعين نذكر منهم الشيخ كاظم الأزري المولود في بغداد سنة 1143هـ والمتوفى سنة 1201هـ الذي نظم ملحمة من ألف بيت ذهبت الأيام بنصفها ولم يصلنا منها إلاَّ خمسمائة بيت. وذلك أن الطباعة لم تكن معروفة في عصره، فوضعها صاحبها في دولاب خوفاً عليها، ولما أخرجوها وجدوا أن الأرضة قد أكلت ما أكلته منها، فأخرجوا منها ما هو متداول اليوم والمعروف باسم (الأزرية). وكان العالم الشهير السيد مهدي الطباطبائي إذا أنشدت أمامه لا يسمعها إلاَّ واقفاً. وفيها يقول عن معركة بدر فيما يقول عنها:
| فارس المؤمنين في كل حرب | قطب محرابها أمام وغاها | |
| وبه استفتح الهدى يوم بدر | من طغاة أبت سوى طغواها | |
| صب صوب الردى عليهم همام | ليس يخشى عقبى التي سواها |
وبعد أن يصف ما جرى يوم بدر ينتقل إلى يوم الخندق ومعركة الأحزاب:
| يوم غصت بجيش عمرو بن ود | لهوات الفلا وضاق فضاها | |
| وتخطى إلى (المدينة) فرداً | بسرايا عزائم سأراها | |
| فدعاهم وهم ألوف ولكن | ينضرون الذي يشب لظاها | |
| أين أنتم عن قسور عامري | تتقي الأسد بأسه في شراها | |
| فابتدى المصطفى يحدث عما | تؤجر الصابرون في أخراها | |
| من لعمرو وقد ضمنت على | الله له من جنانه أعلاها | |
| فالتووا عن جوابه كسوام | لا تراها مجيبة من دعاها | |
| وإذا هم بفارس قرشي | ترجف الأرض خشية أن يطاها | |
| قائلاً ما لها سواي كفيل | هذه ذمة علي وفاها | |
| ومشى يطلب الصفوف كما تمشي | خماص الحشا إلى مرعاها | |
| فانتضى مشرفيه فتلقى | ساق عمرو بضربة فبراها |
ثم يسترسل في الحديث عن معركة خيبر ثم عن معركة حنين وعن يوم غدير خم بعد أن كان قد تحدث عن معركة أحد.
ثم يأتي هاشم الكعبي الذي يستحق أن نطلق عليه لقب (شاعر الملاحم العربية) لأنه لم يكتف بملحمة واحدة نظم فيها حياة علي، بل تعدى ذلك إلى أكثر من ملحمة في الحسين وأنصاره.
والكعبي توفي سنة 1221هـ ونسبته (الكعبي) على اختلاف: أما إلى قبيلة كعب التي تسكن الأهواز ونواحيها، أو إلى بلدة من بلاد القطيف تعرف الآن باسم (كُعيِّب) بضم الكاف وتشديد الياء. وتنطق الكاف شيناً فارسية وتكتب بصورة الجيم تحتها ثلاث نقط.
ومن ملحمته العلوية قوله:
| ومواقف لك دون أحد جاوزت | بمقامك التعريف والتحديدا | |
| فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى | تهدي إليك بوارقاً ورعودا | |
| فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما | يهدي القراع لسمعك التغريدا | |
| واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم | جبلاً أشم وفارساً صنديدا | |
| رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى | أو ما دروا كنز الهدى مرصودا | |
| وغداة بدر وهي أم وقائع | كثرت وما زالت لهن ولودا | |
| قابلتهن فلم تدع لعقودها | نظماً ولا لنظامهن عقيدا | |
| فالتاج عتبة ثاوياً بيمين من | يمناه أردت شيبة ووليدا | |
| سجدت رؤوسهم لديك وإنما | كان الذي ضربت عليه سجودا | |
| وتوحدت بعد ازدواج والذي | ندبت إليه لتهتدي التوحيدا | |
| وعشية الأحزاب لما أقبلت | كالسيل مفعمة تقود القودا | |
| عدلت عن النهج القويم وأقبلت | حلف الضلال كتائباً وجنوداً | |
| فأبحت حرمتها وعدت بكبشها | في القاع تطعمه السباع جنيدا | |
| وبني قريضة والنضير وسلحم | والواديين وخثعما وزبيدا | |
| مزقت جيب نفاقهم فتركتهم | أمماً لعارية السيوف غمودا | |
| وشللت عشراً فاقتنصت رئيسهم | وتركت تسعاً للفرار عبيدا |
ويأتي في عصرنا هذا الشيخ محمد حسين شمس الدين المولود سنة 1280 في قرية (مجدل سلم) بجبل عامل والمتوفى فيها سنة 1343هـ والذي كان شاعر جبل عامل في عصره، وفي الطليعة من شعراء العرب المعاصرين فقد نظم ملحمة سماها (الغديرية) نسبة إلى (غدير خم)، وهي وإن لم تقتصر على الحديث عن يوم (الغدير)، بل كان الحديث عن هذا اليوم بعض ما جاء فيها، فقد سماها بهذا الاسم، لأنه رأى فيه رمزاً لأمجاد علي في حياة النبي (ص) وفيها يقول عن يوم الغدير فيما يقول عنه:
| اليوم أكملت فيه دينكم نزلت | ونعمة الله في الإسلام قد كملت | |
| وألسن الشكر آيات الثناء تلت | إذ حجة المرتضى بالنص فيه علت |
يوم الغدير فأضحى للورى عيدا
| يوم به المصطفى من فوق منبره | علا وأدنى إليه صنو عنصره | |
| وظل يتلو عليهم طيب مخبره | وحياً تنزّل فيه من مطهره |
فيا له من مقام كان مشهودا
وعن يوم بدر وأُحد وخيبر والخندق يقول:
| سل يوم بدر وهل يخفى على أحد | وسل ذوي العلم ماذا كان في أحد | |
| وعج على خيبر مستعلماً تجد | من المآثر ما يأتي على العدد |
وما يشق على الإفهام تحديدا
| يوم به فرّ من قد فرَّ من وجل | وعادت الراية العظمى على خجل | |
| وقال طه سأعطيها إلى رجل | يكر ليس بهياب ولا وكل |
وقد صيغ صارمه للفتح أقليدا
| وكرَّ حيدرة الكرَّار مبتهجاً | على اليهود يقد الهام والمهجا | |
| فأسرعوا هرباً منه بغير حجى | واستوثقوا دون باب الحصن مرتتجا |
والحصن أمنع إحكاماً وتشييدا
| سل ابن ود زعيم الشرك كيف جرى | به ففي أمره ما أوضح الخبرا | |
| يوم استفز جيوش العرب مبتدرا | إلى المدينة لا يبقى لها أثرا |
وجال مقتحماً تلك الأخاديدا
| وظلَّ يدعو إليه من يبارزه | ولا يرى أحداً مما يحاجزه | |
| والمصطفى يتوخى من يناجزه | فقام من بهرت فيه معاجزه |
يستلفت المصطفى بالأذن ترديدا
| فقال خير الورى للمرتضى علناً | هذا ابن ودّ لدى الهيجاء ما وهنا | |
| وكان في قوله للقوم ممتحناً | فقال حيدرة الهيجا له: وأنا |
أولى به دونهم قتلاً وتشريدا
| واستل مرهف عزم دونه القدر | ما إن تخلف عنه في الوغى الظفر | |
| وانقض ما مسه جبن ولا خور | إلى الوغى والوغى منه لها خطر |
عدو الخماسي نحو الماء مورودا
| فقال عمرو ومن أنت فانتسب | فلا أبارز إلاَّ واضح النسب | |
| فقال صنو المصطفى العربي | أنا ابن أكرم أم في الورى وأب |
فاستجمع العزم تقريباً وتبعيدا
| فقال عمرو أما يخشى ابن عمك إذ | دعاك لي فإلى ظل المثقف لذ | |
| وأعطني السلم أشفاقاً عليك وخذ | نصيحتي وبسيفي من حمامك عذ |
لا يرهب الجذع البزل الجلاعيدا
| فقال يا عمرو إني لم أهن جزعا | فكن لما أتوخى منك مستمعا | |
| أرجع بجيشك أو كن للهدى تبعاً | فها أنا والهيجا وأنت معا |
فانظر بأمرك تصويباً وتصعيدا
| فراغ كل إلى صمصامه غضباً | مستجمعاً عزمة منه أحدّ شبا | |
| واستقبل المرتضى عمراً كما طلبا | وأوغل السيف في ساقيه منتصباً |
فخرَّ منعفراً كالطود مهدودا
| فكبَّر القوم بشراً حين جدَّله | ضرباً وأكبرت الأحزاب مقتله | |
| فدمر الكفر تاليه وأوله | واستأصل البغي أعلاه وأسفله |
بضربة تركت أعلامهم سودا
وعلى هذا النسق الملحمي يستمر في الحديث عن مناقب علي ووقائعه وفضائله، ثم يختم ملحمته بثلاثة مقاطع يقول في أحدها ومنه يفهم المقطعان الآخران:
| فأنتم عدتي في النشأتين فلا | أخاف ضيماً ولا أخشى غدا زللا | |
| وما احتقبت سوى حبي لكم عملا | فأنجحوا لي بكم يا سادتي الأملا |
حتى أكون من الناجين معدودا
ونختم هذا الفصل ببعض الملحمة التي نظمها الشيخ حمدان الخير([414]):
| حسب عليها ثواباً حين ألقيها | أني إليك أبا السبطين أهديها | |
| رقيقة يتمشى اللفظ منسجماً | فيها وتكسو لآليه معانيها | |
| حبي يروح ويغدو في جوانبها | يزهو برونقها الحالي ويزهيها | |
| يا سيدي إن يكن غيري([415]) بغيركم | قد أحسن القول تمثيلاً وتشبيها | |
| هذي قصيدته تبدو مقاطعها | سبائك الدر تسبي لب قاريها | |
| ولست كفؤاً لها حتى أجاريها | لكن هواك دعاني أن أجاريها | |
| فمر عصي بياني أن يعاطيني | زمامه ويلين القول لي فيها | |
| وإنني شاعر لم تسم موهبتي | لا يستطيع يراعي أن يوفيها | |
| لولا هواك وسر منك في قلمي | لأعجزتني وأن رقت قوافيها | |
| حسبي من الخير أني فيك أنظمها | وفي مناقبك الغراء أُمليها | |
| وحسب شعري إذا رقت مدائحه | أنيقة يتحلى فيك حاليها | |
| أصنام مكة دكّت ما حنيت لها | رأساً كغيرك تقديساً وتنزيها | |
| حميت فاطمة لما علقت بها | عن السجود إلى أرباب أهليها | |
| طوت ليالي شهور الحمل طاهرة | ثيابها البيض لم تدنس حواشيها | |
| ما أقبلت وهي ترجو أن يطاوعها | جسم لتخضع إلا كنت تثنيها | |
| فجئت طهرك لو رفّت أشعته | على الدياجير لابْيَضّت نواصيها([416]) | |
| وجئت رأسك لم يسجد إلى صنم | والناس قد ألَّهوا الأصنام تأليها | |
| كأنما كنت تدري عن منابرها | وعن منصاتها يوماً سترميها | |
| مولاي أحرزت في التاريخ مكرمة | ونعمة ليس من نعمى تضاهيها | |
| ولدت في الكعبة الميمون طالعها | نوراً تجلَّى بهاء في نواحيها | |
| وهذه في سماء الفضل منقبة | لا يستطيع مبارٍ أن يباريها | |
| دارت على الناس أعوام مرزأة | ماتت بها الأرض واجتثت مجانيها | |
| وكانت والدك المفضال من عوز | يعيش فيها وجيع الحال شاكيها | |
| فجاء أحمد والعباس منزله | يرفّهان عليه العيش ترفيها | |
| قالا: نشاطره أفراد أسرته | وننقذ البيت من حال يعانيها | |
| فاختار طه أبا السبطين حصته | يؤويه داراً ينال العز آويها | |
| نزلت داراً تليد العز يعصبها | بغاره وطريف المجد يزهيها | |
| دار يجللها إعظامها فرشت | خمائل الطهر والإيمان ناديها | |
| جاءت عن المصطفى أطياب رفعتها | وأشرقت من معاليه معاليها | |
| وضيئة بعد بيت الله رتبتها | ومن زكيّ لآليه لآليها | |
| منها تعلمت حتى ليس مسألة | إلاّ وتعلم خافيها كباديها | |
| فيها تشبعت إيماناً كأن به | عطراً إذا نشقته النفس يحييها | |
| أخذت من خلق بانيها مباديه | حتى حسبناك في خلق كبانيها | |
| تحيا وصاحبها خلين ما افترقا | يوماً وتزداد تأديباً وتفقيها | |
| يا حبذا صحبة قامت على شرف | أخلاق طه تنقيها وتصفيها | |
| مولاي تشغل بالي منك مسألة | مهما تبسَّطَ شرحي لا يوفيها | |
| أسلمت غضّاً أمارات الصبا شعل | رفت بطلعتك الغرا تزكيها | |
| أسلمت لما بلغت الست فابتهجت | بك الحنيفة وامتدت أمانيها | |
| لبيت دعوة طه وهي ما برحت | بالغار تفتح للدنيا مآقيها | |
| قل لي إذا هو لا يرتاد ناديها | فمن ليحيا به يرتاد ناديها | |
| لكن إسلامه قالت به فئة | مقالة صفحات العلم تنفيها | |
| مقالة راية الإجحاف عالقة | بها ترفرف كالأحلام تمويها | |
| لو أنصف الحاكم القالي أبا حسن | لزاد إسلامه قدراً وتنبيها | |
| إسلامه في كتاب الحمد مفخرة | كل المفاخر معنى من معانيها | |
| إن كان صاحبه الهادي تَعَجَّله | إلى الحنيفة يحيا في معاليها | |
| فإن صاحبه الهادي رأى فهماً | فيه ولم ير طفلاً ينثني تيها | |
| ما كان طه إلى إيجاب دعوته | يدعو صبياً صغيراً ليس يدريها | |
| وإن تمشى إلى الهادي أبو حسن | يرجوه من قدس دعواه مباديها | |
| إن كان إلهامه العالي أتاح له | سبيلها دون أن يهديه هاديها | |
| فإنها رفعت ما كان من أحدٍ | سواه يبلغ أو يرقى مراقيها | |
| ما قام طه ولا قامت رسالته | حتى تبلغ فيها أمر باريها | |
| تحيا بقلبي فتحييني وتؤنسني | إذا خلوت إلى نفسي أناجيها | |
| في دار طه وفي أكناف دعوته | نشأت لو عرفوا فضلاً لناشيها | |
| فهل لهم سيرة من قبلها عرفت | أجل منها إلى الإسلام توجيها | |
| وهل لهم ما تغنوا مثله شرفٌ | يرويه من صفحات الحمد راويها | |
| لبَّيت دعوة طه ما وقفت لها | حتى مشى من ليالي الست ماشيها | |
| عرفتها قبل أن تعدو مرفرفة | بنودها بربوع الأرض تحييها | |
| رأتك برّاً يواليها بفطرته | يا حبذا فيك إلهام يواليها | |
| نبت بطه على دعواه مكَّته | وأحجم القوم فيها عن تلقيها | |
| وأجمعوا أمرهم يأتون منزله | وقد تهادى من الظلماء ساجيها | |
| ليقتلوه وينجوا من رسالته | ويأمنوا في بواديهم تماديها | |
| فخف جبريل من أطراف جنته | يحمي حقيقة طه من أعاديها | |
| خاف الأمين على طه ودعوته | منهم فأسرع ينجيه وينجيها | |
| وشد طه إلى دار مباعدة | ركابه في فجاج السيل يزجيها | |
| وقال للمرتضى والنفس موجعة | فيها سهام من الآلام تدميها | |
| داري إذا أنا لا أُلفى بساحتها | فنم بها ليظنوا أنني فيها | |
| وهذه كتب عندي لهم وضعت | فأدها بعد أن أغدو لأهليها | |
| يا لهف قلبي عن ساحات مكّته | طه تناءى وعن زاهي ضواحيها | |
| خلّى لينشر دعواه مسارحها | وفات من أجل دعواه مباهيها | |
| تسلّم البيد تطويه مخاطرها | على ركاب له خفت ويطويها | |
| ونام في الدار لم يجزع أبو حسن | على الفراش وديع النفس هاديها | |
| غفا به ملء جفنيه يهدهده | حلم إذا رمقته العين يسبيها | |
| حلم ألذّ من الأطياب عالقة | عليه من روعة الدعوى تزاهيها | |
| حلم تظل به الجنات ضاحكة | كأنه رف من أحلام واديها | |
| مولاي أي فؤاد أنت تحمله | لم يخش من جلبات الشرك داويها | |
| ما خفت من فئة جاءت إليك وقد | ترنحت بأياديها مواضيها | |
| لقيتها وجناح الليل يسترها | بحالك الريش صلب لا يباليها | |
| لقيتها فتوارت عنك مائلة | كأنما البيض ما كانت بأديها | |
| مالت وأسيافها بالغمد نابية | ماذا يفيد من الأسياف نابيها | |
| طه تناءى إلى دار مقدسة | تنشقت طيب دعواه روابيها | |
| ونمت في داره تفدي رسالته | سواك يا سيدي من كان يفديها | |
| حويت لما مشى طه لهجرته | مكارماً غير طه ليس يحويها | |
| رعيت ذمة طه في أمانته | وليس يغرب أن نلفيك راعيها | |
| رعيتها نسمات الطهر شائعة | منها كبيض ورود في بواديها | |
| كرمت حاضرها من بعد هجرته | حتى تفتق مزهواً كماضيها | |
| أدت يداك إلى كل أمانته | كما توصاك طه أن تؤديها | |
| ورحت تلحقه مشياً ليشربه | وما خشيت لمرآه فيافيها | |
| لحقته تتحلى من محاسنه | وتستقي منه نعمى طاب ساميها | |
| هاجرت تحدوك في بيد مروعة | عزيمة لم تكن بيد لتثنيها | |
| وجئت كالبدر طه كل منقبة | ترى على وجهك الحاليْ مرائيها | |
| أتيته لم تخف بعداً تساعده | على بناية دعوى كان يبنيها | |
| وأنت ما زلت من وجد ومن شغف | ترعى بسيفك دعواه وتعليها | |
| لما انتهيت إلى طه بيثربه | آواك طه بدار كان يأويها | |
| صحبته قبل في ساحات مكّته | وجئت صحبته الأولى تثنيها | |
| يا حبذا صحبة طابت مناهلها | روتك من سلسل التقوى غواديها | |
| آخاك طه لآيات ممتعة | وطيّبات خصال فيك يلفيها | |
| وحسب نفسك من فخر ومن شرف | أن راح في يثرب طه يؤاخيها | |
| لا تقبل النفس خدناً في معاشرة | إلا إذا كان في خلق يحاكيها | |
| وأنت أشرقت من أطياب طينته | طيناً تجمع فيه كل ما فيها | |
| مولاي دعوة طه أبصرتك يداً | بيضاء تنقلها الدنيا وترويها | |
| فأنت فوق جبال العز رافعها | وأنت من صحبات الشرك حاميها | |
| آياتك البيض لا تنسى وإن ذكرت | (بدر) تذكر بيض الآي ناسيها | |
| (بدر) معالم فخر عنك باقية | وإن أطيب آي الفخر باقيها | |
| (بدر) أناشيد إعظام وتكرمة | ثغر الخلود على الدنيا يغنيّها | |
| للَّه أنت وإن جاشت مراجلها | تمشي إليها ولا تخشى دواهيها | |
| تمشي ونفسك من إقدامها سكرت | ترى الوطيس رفيقاً من أمانيها | |
| تفلتت من حدود العزم وابتدرت | وليس للعزم من حد يدانيها | |
| ترنو فبرق من الأحداث ملتهب | تنجاب فيه عن الدنيا دياجيها | |
| وترسل الصوت رعداً في زمازمه | ضجت به البيد قاصيها ودانيها | |
| أنّى اتجهت يميل الشرك منكسراً | وينثني موجع الأضلاع داميها | |
| زندٌ تحمل سيفاً تحت ضربته | لا يستقر من الأجبال راسيها | |
| رأيت جانحة البيداء صادية | فرحت من دام أهل الشرك تسقيها | |
| من للوليد ونار الحرب مائجة | كاليم جنت لها أعيان رائيها | |
| خرجت تطلبه ما خفت غطرسة | وصولة كان في الميدان يلقيها | |
| علوته بحسام لو ضربت به | هام الجبال لزالت من أعاليها | |
| وملت في ساحة الميدان مضطرماً | تحمي الرسالة من أحقاد غازيها | |
| ترميهم بحسام رق مضربه | يصافح الرأس عجلاناً فيبريها | |
| سيف كزندك ماض ما انثنيت به | يوماً على ضربة أولى تثنيها | |
| ما زلت تضربهم حتى أريتهم | أن الهزيمة ناداهم مناديها | |
| فرّوا أمامك من أهوال معركة | رخصت فيها من الأرواح غاليها | |
| فرّوا أمامك والأرواح جازعة | كادت تودع من خوف تراقيها | |
| فرّوا فلاحت ربى البيداء تحتهم | كأنها منك قد فرت نواحيها | |
| مولاي أي نضال لست فارسه | وأي سدة مجد لست بانيها | |
| لولاك لم يعرف الإسلام دولته | ولم تمد له الدنيا أياديها | |
| يا طيب ما اختتمت (بدر) برونقه | ويا رضا عنه ما انجابت دياجيها | |
| فيها جزيت حساماً لا يعادله | من الصوارم في حرب يمانيها | |
| ماض على حده تمشي مرنحة | قوافل الموت تزجيه ويزجيها | |
| زانتك (بدر) بتاج من كرامتها | وقلدتك علاً أمضى مواضيها | |
| أولتك أقدس ما يولى به بطلٌ | فذو الفقار معان من معانيها | |
| ويلاه من غزوة يشجي تذكرها([417]) | جالت على راية الدعوى مذاكيها | |
| ويلاه منها روايات مبرحة | ندّى يراعي مداداً من مآسيها | |
| يلتاع قلبي إذا رفت بخاطرتي | فكيف يسلس لي شعري لأرويها | |
| رعناء لم تشهد الدعوى كمشهدها | ولا أضاعت سواها في مغازيها | |
| دقت رباعية الهادي أسنتها | وجرحت خده الباهي مواضيها | |
| دماؤه انسكبت حمراً مشعشعة | كأنها الشمس في أرض مجاليها | |
| رفت على الرمل تسقيه على ظمإ | وغلةٍ فيه دفقاً من معاليها | |
| تلك الرمال وما أندى سلافتها | بين الشفاه وما أحلى تساقيها | |
| البابلية لا تسمو لنكهتها | والفجر في سحر لون لا يحاكيها | |
| وما جرت بالفيافي دون ماء فمن | أدى مروعة الأثمان مجريها | |
| أصنام مكة لم تقبل بها قوداً | ولا وفت دية هامات أهليها | |
| الجاهلية كانت كلها ثمناً | لها ففيها تولت عن صحاريها | |
| دماء طه وهل إلاّ رسالته | وما بها من مروعات يوازيها | |
| مالوا عن الشعب لا بروا ولا صدقوا | ولا رعوا حرمة الدعوى وداعيها | |
| خفوا إلى السلب تغريهم مكاسبه | وكم نفوس حطام السلب يغريها | |
| بهم تغير وجه النصر في (أُحد) | وفيهم خانت الدعوى مراميها | |
| ماذا تكرس من أعمالهم (أحد) | لولاهم لعدت طه عواديها | |
| لكل أجر شهيد في مسارحها | آمال أحمد تبكيه ويبكيها | |
| يا حمزة الخير والأجفان واكفة | حيال ذكرك لم تحبس غواديها | |
| لله أنت مع التاريخ من رجل | لم يخطه من سهام الغدر راميها | |
| طه ينزُّ جراح فيه دامية | إنَّ الجراحات أقساها دواميها | |
| وأنت من حوله كالليث منتصباً | ترميك بيض أعاديه وترميها | |
| تصونه والطوال السمر راعفة | زرق المنايا تثنت في تثنيها | |
| تصون طه وطه بالحضيص لقى | كهالة المجد زاحت عن أعاليها | |
| ورفّ جبريل الميدان مبتسماً | يلومه فيك عن حال تقاسيها | |
| فقال طه له والجفن منكسر | والنفس فيها من الأحزان ما فيها | |
| منّي عليٌّ وإني من أبي حسن | كرامة الخلق تنمينا وننميها | |
| صقران نحن فلا سلم يفرقنا | ولا حروب وإن جنّت سوافيها | |
| فصاح جبريل ضماني لحوضكما | قداسة الحب آختنا أواخيها | |
| وإنني منكما لا زال عهدكما | نعمى بقلبي تصبيني وأصبيها | |
| إذا مشت دعوة الهادي على أحدٍ | ولم تنل غاية كانت ترجيها | |
| فأنت وحدك يا مولاي في (أحد) | جزيت منقبة كالفوز ترضيها | |
| آخيت طه وجبريل وأي فتى | ملائك الله رامت أن يؤاخيها | |
| لولا فخار جزيل نلت في (أحد) | لكنت من مدحتي الغراء أمحيها | |
| وربما لكرامات حبتك بها | زها بقلبي عبيراً فرط حبيها | |
| بعيبنا شعراء الغرب حيث رووا | لنا أساطير خان الحق راويها | |
| يحكون فيها روايات مبالغة | لم يعرف الحق معنى من معانيها | |
| يخادع الحق معناها كما خدعت | لوافحٌ من سراب البيد ساريها | |
| تخيلوا ما حكوا لم يشهدوا بطلاً | كما ترجيه نفسٌ من تشهيها | |
| لو أنهم شهدوا (الأحزاب) ما كتبوا | لنا الأساطير تضليلاً وتمويها | |
| لو أنهم شهدوا أهوالها وقفت | أقلامهم في سماع الدهر تحكيها | |
| تحكي مرسخة الأعطاف عن بطل | وعن شجاع كبير النفس عاليها | |
| وعن حقائق في التاريخ واضحة | فلا خيال ولا وهم يدانيها | |
| كتائب تعبر البيداء زاخرة | تكاد تنطف أحقاداً مواضيها | |
| جاءت إلى يثرب من كل ناحية | وفاجأتها وشر الحرب فاجيها | |
| وخندقت يثرب تنجي حنيفتها | يا ليت شعري هل هذا ينجيها | |
| أبناؤها ذهلوا رعباً كأنهم | لم يبصروا قبل من حرب دواهيها | |
| طاروا شعاعاً وزاغت في محاجرها | أبصارهم فهي عمي في مآقيها | |
| ظنوا بربك ما ظنّوا وما علموا | إن الحنيفة لا يخشى مواليها | |
| مشى (ابن ودّ) وبزت فيه خندقهم | كريمة أي طير لا يماشيها | |
| ما خاف طه ولا أنصار دعوته | وجدّ مغتبطاً للحرب يصليها | |
| والحرب تعرف عمراً إنه بطل | وإنه عند هزج البيض حاميها | |
| تقدم الجيش يلقاه أبو حسن | والحرب غير ذويها لا يلاقيها | |
| صالا طويلاً وثار النقع حولهما | غمامة مطرت رعباً حواشيها | |
| شد الإمام على عمرٍ وعاجله | بضربة منه لا يجدي توقيها | |
| رمته عن سرجه العالي ولا عجب | يدري الحديد ويخشى عزم راميها | |
| يا ضربة ترقص الدنيا لها طرباً | يد الحنيفة بعضٌ من أياديها | |
| مشيت في مسمع الآفاق جلجلة | ورددتك من الدنيا أقاصيها | |
| قلبي يغنيك من وجد ومن شغف | كما تغنّي على الأغصان قمريها | |
| فرقت عن أحمد الهادي أعاديه | وذدت عن دعوة الهادي أعاديها | |
| إن الحنيفة ما شيدت قواعدها | إلاّ عليك ولا قامت رواسيها | |
| ما زلت في مسمع الآفاق أغنية | عن البطولة تحيي روح شاديها | |
| مولاي دعني أرددها فإن بها | أسطورة الشرق لامين يواريها | |
| صاحت ملائكة الرحمن جازعة | الله أكبر لما كنت تهويها | |
| لا سيف للحرب إلا ذو الفقار ولا | يرجى فتى كعلي في دواهيها | |
| وصاح طه وخمر البشر قد لعبت | فيه كما لعبت خمر بساقيها | |
| اليوم دعواي تنجو من مهالكها | وتقطع الوعر من وادي فيافيها | |
| هذا عليٌّ تولاّها بهمته | وردّ بالسيف عنها من يعاديها | |
| خاض الوغى وجرى الإيمان أجمعه | للشرك أجمعه يصليه صاليها | |
| مولاي حسبك من فخر ومن شرف | آي من الحمد تسبي لب تاليها | |
| وحسب نفسك من إطراء مادحها | أن راح طه بأغلى الحمد يطريها | |
| شجاعة تسكر الأقلام إن أخذت | يوماً على صفحات الطرس تحكيها | |
| غنت روائعها الأزمان مولعة | بها وأي زمان لا يغنيها | |
| حصن([418]) تمطى إلى الجوزاء يلبسها | تاجاً وينهل خمراً من سواقيها | |
| تكسرت فوقه الأجيال ما فتحت | أبوابه كفّ غاديها وباديها | |
| غزته أجناد طه وهي تحسبه | كما رأت من حصون في مغازيها | |
| جاءت إليه فلم تدفع صوارمها | بطولة كان دون الباب يبديها | |
| ضاقت بها كل حال فانْثنت هرباً | وضيعت بيض آمال ترجيها | |
| فصاح طه سأعطي رايتي رجلاً | بكل نصر وإعلاءٍ يحلّيها | |
| يحبه الله لم تبعد مفاخرنا | إلا وكان عليه الله يدنيها | |
| أحب خالقه العالي وخالقه | أحبه فهو بر النفس عاليها | |
| أتيت لما رأيت الحرب عابسة | طه وأنت وجيع العين داميها | |
| وهل يعوقك ما في العين من رمد | دعاء طه من الإرماد يشفيها | |
| حصون خيبر والأيام شاهدة | أن الهزيمة من آمال غازيها | |
| صببت من فوقها خيلاً محجّلةً | كرامة النصر تزهو في نواحيها | |
| قلعت لما تأبى باب عزتها | ولا غرابة أن تقلع رواسيها | |
| قلعته بيمين لو قبضت بها | أطراف دنيا لمالت عن نواحيها | |
| رميت (مرحب) لم تأبه لصولته | متى تخوف ليث الحرب عاديها | |
| وعدت بالدين مزهواً ومنتصراً | بيض الكواكب تحكيه ويحكيها | |
| رفت تنوّر ملء الجو رايته | كما تنوّر في نفس أمانيها | |
| تمايلت في سماء المجد زاهية | كأنما هي بعض من دراريها | |
| بنيت للدين أمجاداً مخلّدة | فأي آية مجدٍ لست بانيها | |
| خانت قريش عهود المصطفى ومشت | إلى خزاعة بعد العهد تؤذيها | |
| مالت عليها ببيض الهند مرهفة | وذمة العهد تبكي ليل وافيها | |
| الذئب للغدر لا عهد ولا خلق | يثنيه عن غنمات نام راعيها | |
| فسار أحمد والأجناد تتبعه | ملء الصحارى وعين الله تحميها | |
| كتائب في رحاب البيد هائجة | ما يهيج من الآساد ضاريها | |
| كرامة الذكر نور في أواخرها | وروعة النصر نور في أواليها | |
| تمشي لمكة تغزوها وتفتحها | وتنشر الدين في أرجاء ناديها | |
| فطأطأت مكة أعلام عزتها | واستسلمت ليد الهادي مواليها | |
| وطاف فيها رسول الله يملؤها | نوراً وقد ملئت شركاً نواحيها | |
| رفت على البيت دعواه مشعشعة | كما ترف الأقاحي في بواديها | |
| خفّت إليه تحليه وتلبسه | غلائل الطهر من أثواب هاديها | |
| حنت إلى البيت فانساقت تطوف به | وفي القلوب حنين كاد يلقيها | |
| تمزق الشرك بالأسياف فابتهجت | لمّا تمزق دينٌ كان يشقيها | |
| مولاي هذي على الأجبال منقبة | لا يقدر النجم أن يرقى مراقيها | |
| بالسيف تُنزل من علياء سدتها | لا تأو عن عرشها المزهو يُلقيها | |
| رميتها عن جبال العز باكية | وسقتها لحضيض من مهاويها | |
| رقيت غارب طه لم يرعك به | نور الملائك أو أنوار باريها | |
| لما ارتقيت ألم ينحطّ تمسكه | من الكواكب عاليها وزاهيها | |
| أما غدوت إلى الجوزاء تسألها | خمراً وعطراً وشهداً من سواقيها | |
| عاطتك من خمرها كأساً معتَّقة | ليست تكدِّرُ نارُ الإثم صافيها | |
| وليمة في سماء الله عامرة | مجامر المسك نور من حواشيها | |
| قنديلها الشمس والجوزاء قينتها | والبدر شاعرها والنجم ساقيها | |
| جنان ربك بعض من مسارحها | والمرسلون لفيف من غوانيها | |
| وسدرة العرش تضفي من ظلائلها | فوق المسارح أطياباً تنديها | |
| وليمة لم تكن إلاّ لتبصرها | وتملأ العين أعلى من معاليها | |
| فطب فؤاداً فما في المجد مفخرة | إلاّ وعلياك أعلى من معاليها | |
| الجاهلية لاقت فيك مصرعها | فأنت يا سيدي أعدى أعاديها | |
| مالأتها البغض حتى أنها رضيت | بأن تكون لها قبراً صحاريها | |
| وادي (حنين) لقيت الخير قص لنا | حكاية ينعش الألباب حاكيها | |
| سوى ربوعك لم يشهد وقائعها | وغير جفنك لم يشهد مجاليها | |
| هات الأحاديث تحيي من صراحتها | جوانحاً كاد زور القول يرديها | |
| خيلٌ حسانٌ وأسياف مسللة | تغضي الشموس حياء من تلاليها | |
| إذا نظرت إلى البيداء لم ترها | ليل الغبار عن الأعيان يخفيها | |
| كتائب ليس يحصي الجفن عدتها | فغير وادي حنين ليس يحصيها | |
| جدّت وجد أمير النحل يقدمها | كأنه النور في الظلماء يهديها | |
| بعض الرجال رآها وهي سائرة | ملء البوادي فمادت نفسه تيها | |
| وقال للناس من عجب ومن طرب | مقالة صفحات الذكر ترويها | |
| لن تغلب اليوم من ضعف كتائبنا | فليس يقدر خصم أن يلاقيها | |
| ما أهون الحرب لو كانت متاعبها | قولاً إذا قيل ننجو من غواشيها | |
| خلّ النضال وخل الحرب ناحية | الحرب تكره إلا من محبيها | |
| الحرب إلا على فرسان حومتها | نار بزاوية الأضلاع تشويها | |
| خاض الإمام غمار الحرب مبتهجاً | كأنما نفسه لاقت أمانيها | |
| يرمي الرؤوس فيلقيها مصرعة | تحكي إلى الترب عذراً عن تعديها | |
| كأنها فوق وجه الترب هامدة | ذرا جبال تهاوت عن أعاليها | |
| كم فاجر لو درى ما سوف يبصره | لما أتى غزوة للسيف آتيها | |
| كم مشرك وأبو السبطين يورده | موارد الموت يسقى من عزاليها | |
| أحب دعوة طه من مخافته | وسفّه الشرك والأصنام تسفيها | |
| وادي حنين رعاك الله كم سمةٍ | لولا ربوعك لم تلمح تجلّيها | |
| المسلمون ويالله حين رأوا | نار القتال تنحّوا عن مصاليها | |
| خلّوا النبي لأطراف القنا ونسوا | حياته كيف يرجو الخير ناسيها | |
| طاروا شعاعاً كغزلان رأت أسداً | مروع الشدق يدنو من ملاجيها | |
| لولا علي وهولٌ من بطولته | صواعق الشرك لم تكشف دياجيها | |
| لولاه دارت حنين غير خائفة | نور الحنيفة في أغوار واديها | |
| من كان غير أبي السبطين ينقذها | وقد دهاها من الأهوال داهيها | |
| خلّ المدائح ما كانت لترفعه | قدراً وإن نظمت دراً قوافيها | |
| إن تلبس البدر يوم التم جوهرة | فهل تحليه فيها أم تحليها | |
| صفين كالليلة الظلماء داجية | والقلب يرعن خوفاً من تدجيها | |
| شعت بظلمتها الأسياف لامعة | كأنها ومض برق في نواحيها | |
| صفين أي فؤاد لا تروّعه | إذا تراءت له ذكرى مآسيها | |
| الجو يرنو إلى الأجساد مضطرباً | والأرض تغمض من خوف مآقيها | |
| والنهر يرجو فراراً من شواطئه | وكم مياه أضرتها شواطيها | |
| لئن سقى البيد قبلاً من سلافته | فإنه اليوم تسقيه ويسقيها | |
| كأنه والدماء الحمر تمزجه | سلافة المجد تجري في مجاريها | |
| يغدو إلى الحرب عمرو وهو مبتسم | كأنه ليس يخشى من عواديها | |
| يغدو إلى الساحة الكبرى فيصدمه | بالساح فارس عدنان وحاميها | |
| فكيف يصنع عمرو([419]) والردى لمعت | بنوره أي ستر لا يواريها | |
| دع عنك عمراً وما أبداه من جزع | الأسد غير أسود لا تلاقيها | |
| دعه يرد الردى عنه بسوءته | فنفسه دافعت عنها مساويها | |
| دعه يفر وخزي الجبن زوبعة | وراءه تملأ الدنيا سوافيها | |
| يا عمرو أصعب من لقيا أبي حسن | هزيمة منه لا تفني مخازيها | |
| نفس الأبيّ نجاة العار تقتلها | قبل السيوف وموت المجد يحييها | |
| ما قولة لعلي قالها عمرٌ | بحار سامعها فيها وملقيها | |
| غريبة من بنات الشعر زائفة | فلا دليل ولا رشد يزكيها | |
| أبو تراب سيوف الهند تعرفه | إذا تنادى إلى حرب مناديها | |
| سل عنه دعوة طه في مخاطرها | لولاه لم يسر في الآفاق ساريها | |
| يا شاعر النيل([420]) دع وهماً غررت به | فالوهم يخدع ألباباً ويغريها | |
| سلها إذا شئت هل كانت لتحرقه | نيرانها وهي تزكو في مصاليها | |
| فكيف يحرقه بالدار «صاحبه» | أما تبصر بالأقوال راويها | |
| إنّ النسور تطوف الجو ضاحكة | ولا تخاف عقاباً من قماريها | |
| خل الخيال وخل الوهم ناحية | تطوي الحقائق أوهامي وتخفيها | |
| يابن الكنانة ما قول لهوت به | والشعر في النفس نوع من ملاهيها | |
| الدين لله لا نرضى به بدلاً | ولا نؤله غير الله تأليها | |
| المسلمون جميعاً في عبادتهم | يرون في الدين توحيداً وتنزيها | |
| فكيف تزعم أن الناس قد عبدوا | بعض الأئمة تزويراً وتسفيها | |
| رسالة المصطفى قدس ومعرفة | ما دان إلاّ بتوحيد مواليها | |
| فخل قولك إنّا لا نقر به | شوهت فيه جلال الدين تشويها | |
| غدير خم وما أحلاه منسكباً | بالبيد ينعش من غلواء صاديها | |
| كأنه إذ جرى بالبيد يغمرها | بمائه صفحات من أمانيها | |
| أناخ طه جنود المسلمين به | لغاية غير طه ليس يدريها | |
| كتائب رجعت من حجها فهفت | لراحة بعد سير كاد يفنيها | |
| نادى لها أحمد الهادي وأعجلها | حتى تجمع قاصيها ودانيها | |
| طه على منبر الأقتاب منتصب | خطيب مكة طه في حصاريها | |
| كأنه وعلي تحت ميمنه | شمس تفيض على بدر مباهيها | |
| يا منبراً فوقه طه وصاحبه | أبو تراب تمايل فيهما تيها | |
| يهنيك تحمل من لولاهما بقيت | دنياك في ظلمات من دياجيها | |
| اشرب هنيئاً وزد في الشرب مغتبطاً | حملت من بركات الله صافيها | |
| سمعت خطبة خير الناس عن كثب | لما تقدم بين الناس يلقيها | |
| طه يقول وعين الخلد شاهدة | ذاك المقال وصاياه يوصيها | |
| أظنكم لن تروني بعد عامكم | هذا فنفسي هفت شوقاً لباريها | |
| من كنت مولاه في أمر نهضت به | ودعوتي أنا مولى من مواليها | |
| هذا وصيي وهذا فيكم خلفي | يرعى الرسالة من بعدي ويحميها | |
| قلدته أمرها يرعى جوانبها | قوسي أسلمها بعدي لباريها | |
| يا رب ساعد علياً في إمامته | وانصر مناصرها واخذل معاديها | |
| ووال يا رب من والى أبا حسن | فدعوتي خذلت فيه أعاديها | |
| هذي وصاياك يا ربي نطقت بها | بلغتها مثلما ترضى لأهليها | |
| كشفت عنها غطاء كان يسترها | فانظر إليها ولا ستر يغطيها | |
| مولاي بيعة خم آية نطقت | يفنى الزمان ولا تفنى مباهيها | |
| لما تلتها الليالي قال قائلها | هذي اليواقيت بل هذي غواليها | |
| الصاحبان أبانا من بشائرها | وقدما لك برداً من تهانيها | |
| يا ليت شعري ما للمسلمين نسوا | وحسرة الشمس أن ينسى تجليها | |
| إذا ألم ببعض منهم صَمَمٌ | عنها فحسبك أن الذكر يرويها | |
| ويلي يمحّون ما أملى نبيهم | رواية الحقّ لا تمحى أماليها | |
| وليس ضائرنا أن يكتموا عظة | حديث طه وآي الذكر يغشيها | |
| مولاي دعهم وما قالوا وما اعتقدوا | عقيدة المرء لا يجرى تلافيها | |
| إن أغفلوها فبالأكباد نحملها | نصونها منهم فيها ونحميها | |
| هذي القلوب جعلناها نواديها | وزين القلب أن القلب ناديها | |
| ولاية ملأت برّاً جوانحنا | فالبر والخيرُ من أدنى معانيها | |
| دين وتقوى لعمري أن نقرّ بها | ونعمة الله أنا من مقرّيها | |
| هذي الولاية لا نرضى بها بدلاً | غالي الجواهر لم يبدل بدانيها | |
| ولاية لا ينال السوء تابعها | ولن يذوق نعيم الأجر عاصيها |
هذه لمحة موجزة كل الإيجاز عن أثر علي بن أبي طالب في الآداب الإسلامية العالمية بعامة وفي الأدب العربي بخاصة، نرجو أن يكون فيها خدمة لهذا الأدب، وأن تكون باباً يلجه الباحثون عن الحقائق فيه، والعاملون على التفوق به.
ولم نشر في هذه الكلمة إلى الشعر الفارسي لأنه أكثر من أن يُشار إليه.
من مراثيه
للشاعر المصري محمد عبدالمطلب من قصيدة:
| ألا تبت يد بالغدر ثارت | تمد إلى أبي حسن حساما | |
| لو أن السيف كان له خيار | لعرد عنه وانثلم انثلاما | |
| ولكن القضاء جرى برزء | له انفصمت عرى الصبر انفصاما | |
| بنفسي غرة يجري عليها | دم أزكى من المسك اشتماما |
وللشاعر اللبناني أمين ناصر الدين من قصيدة:
| سالت نفوس زكت إذ سال منك دم | والكعبة انصدعت واسترجع الحرم | |
| وبالحنيفية البيضاء قد نزلت | دهياء تنزل بالراسي فينهدم | |
| والمنبر انحطمت أعواده فهوى | وأوشكت عروة الإيمان تنفصم | |
| وأصبحت رقمات الفضل ذواية | والسيف صل أسى واستعبر القلم | |
| ما بعد خطبك خطب يا أبا حسن | أغشى الورى ظلماً من فوقها ظلم | |
| به أصيبت من العليا مقاتلها | فلا وفاء ولا حلم ولا كرم | |
| تبت يد بابن عم المصطفى فتكت | غدراً ولمن ينب فيها الصارم الخذم | |
| ما انفك ناديك للأقيال محتشدا | حتى أبانك عنه فاجر عرم | |
| مروا به وهو خلو منك فارتمضوا | واستدمعوا فتلاقى الماء والضرم | |
| لم يبق من هيبة النادي سوى أثر | على الرتاج لدى ذكراك يرتسم | |
| يا حبذا الكوفة الشماء من بلد | فيه ضريحك للزوار معتصم | |
| كأنما النور يبدو من جوانبه | وحوله المكرمات الغر تنتظم |
وللحاج محمد رضا الأزري من قصيدة:
| مصاب رمى ركن الهدى فتصدعا | ونادى به ناعي السماء فاسمعا | |
| مصاب على الإسلام ألقى جرانه | وبرقع بالغي الهدى فتبرقعا | |
| فيا ناشد الإسلام قوض سفر | وصاح به داعي النفير فجعجعا | |
| وأصبح كالذود الظماء بقفرة | من الدهر لم تعهد بها الدهر مربعا | |
| فيا هل درى المختار أن حبيبه | بسيف عدو الله أمسى مقنعا | |
| وأقسم لو أصغى النعي لقبره | بكاه أسى في قبره وتفجعا | |
| ومن عجب أن ينزل الموت داره | وقد كان لا يلقاه إلا مروعاً | |
| ليبك التقى منه منار هداية | وتنعى الوغى منه كميا سميدعا | |
| وإن يبكه الإسلام وجدا وحسرة | فقد كان للإسلام حصناً ومفزعا | |
| لقد صرع الإسلام ساعة قتله | فيا مصرع الإسلام عظمت مصرعا | |
| ويا رب دمع كان صعبا قياده | فأصبح منقاداً ليومك طيعا |
فاطمة الزهراء (عليها السلام)
أمها
أمها خديجة، وقد انقطع نسل رسول الله إلا منها.
مولدها
ولدت بمكة يوم الجمعة العشرين من جمادي الآخرة بعد المبعث بسنتين. قال الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: قال: وفي رواية أخرى: سنة خمس من المبعث وقال الكليني، وابن شهرآشوب: ولدت بعد المبعث بخمس سنين وهو المشهور.
وفي كشف الغمة عن ابن الخشاب في موالد ووفيات أهل البيت مرفوعاً عن الباقر (عليه السلام): أنها ولدت بعد النبوة بخمس سنين وقريش تبنى الكعبة؛ ولعله اشتباه من الراوي، أو سهو من النساخ فبناء الكعبة كان قبل النبوة لا بعدها، ويدل عليه ما في مقاتل الطالبيين: أنها ولدت قبل النبوة وقريش تبنى الكعبة. وروى الحاكم في المستدرك، وابن عبد البر في الاستيعاب: أنها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي (ص) أي بعد البعثة بسنة. وفي الإصابة: ولدت بعد البعثة بسنة. ويوجد من يرى: أنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين؛ ولعله اشتباه بين كلمتي قبل وبعد([421]).
شدة شبهها بأبيها
روى ابن عبد البر في الاستيعاب عن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً برسول الله (ص) من فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت تصنع هي به. وفي رواية لأبي داود: كان إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. وعن أم سلمة قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله (ص) أشبه الناس وجهاً برسول الله (ص).
شدة حب النبي لها
روى البخاري في صحيحه، والنسائي في الخصائص بسنده: أن رسول الله (ص) قال: فاطمة مني فمن أغضبها أغضبني. وفي رواية لمسلم في صحيحه: أنها ابنتي بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وفي الإصابة: عن المسور بن مخرمة سمعت رسول الله (ص) على المنبر يقول: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وروى أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني، عن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي دخل على عمر بن عبدالعزيز وهو حدث السن، فرفع عمر مجلسه وأكرمه، وقضى حوائجه. فسئل عمر عن ذلك فقال: أن الثقة حدثني حتى كأني أسمع من رسول الله (ص) أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني يسرني ما يسرها ويغضبني ما يغضبها فعند الله بضعة من رسول الله (ص).
وروى الحاكم في المستدرك: كان رسول الله (ص) إذا رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم ثنى بفاطمة ثم يأتي أزواجه. وإن النبي (ص) كان إذا سافر كان آخر الناس عهداً به فاطمة وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عهداً فاطمة. وفي الاستيعاب: سئلت عائشة أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: فاطمة، فمن الرجال؟ قالت: زوجها.
أخبارها
من أخبارها بمكة: أنه لما ألقت قريش الأقذار على النبي وهو ساجد جاءت فاطمة فرفعت عنه ما ألقوه عليه وأحاطته بحنانها. وكانت له شريكة في كل ما مر به من الشدائد، وبعد وفاة أمها خديجة لم يكن له في بيته غيرها من يخفف عنه متاعبه، فكانت له مكان الأم والبنت تغمره بعواطفها وتقوم على خدمته وتهون عليه همومه، لذلك سماها (أم أبيها) وفي هذه التسمية دلالة على ما كان لها من أثر في حياته العامة وكفاحه. والواقع أنه ما من كلمة يمكن أن تدل على مكانة فاطمة وعلى قوة صمودها إلى جانب أبيها وعلى ما فعلت من أجله، ما من كلمة تدل على ذلك أكثر من أن يسميها أبوها (أم أبيها). وهاجرت إلى المدينة بعد هجرة أبيها بلا فصل حين بعث النبي إلى عليّ أن يهاجر بها والفواطم وأراده أبو بكر على دخول المدينة قبل وصول فاطمة فقال: ما أنا بداخلها حتى يأتي أخي (أي علي) وابنتي: ومن أخبارها بالمدينة: أنه لما جرح النبي (ص) يوم أحد جعل علي ينقل له الماء في درقته من المهراس ويغسله فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانق أباها وتبكي ثم عالجت جراحه حتى انقطع الدم.
تزويج الزهراء بعلي (ع)
روى ابن سعد: خطب علي فاطمة فقال لها رسول الله (ص). أن علياً يذكرك. فسكتت: فزوجها. فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي (ص) ببغلته أو بناقته وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة: اركبي، فأركبها وأمر سلمان أن يقود بها ومشى (ص) خلفها ومعه حمزة وعقيل وبنو هاشم مشهرين سيوفهم ونساء النبي (ص) قدامها ينشدن الأشعار، وأمر بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة، وأن يفرحن وينشدن الأشعار، ويكبرن ويحمدن ونساء النبي (ص) قدامها ينشدن الشعر.
أمر عجيب
بقي علينا أن نذكر أمراً لا يكاد ينقضي منه العجب وهو: أن من زفها سيد المرسلين مع بني هاشم وأصحابه ونساء المؤمنين، واحتفل في زفافها هذا الاحتفال كانت حرية أن يحتفل بتشييعها عند وفاتها بمثل هذا الاحتفال أو أعظم، ولكنها دفنت في الليل سراً وعفي قبرها ولم يعلم موضعه على التحقيق إلى اليوم، فتزار في ثلاثة مواضع ولم يشهد جنازتها إلا علي وولداها ونفر من بني هاشم ونفر قليل من الصحابة!!([422]).
سنها حين زواجها
اختلف في قدر عمر الزهراء يوم تزوج بها علي بناء على الاختلاف في تاريخ مولدها كما مر. فعلى الأكثر: أنها ولدت بعد النبوة بخمس سنين، فيكون عمرها حيث تزوجها تسع سنين، أو عشر سنين، أو إحدى عشرة سنة؛ لأنها تزوجت بعلي بعد الهجرة بسنة. وقيل: بسنتين وقيل: بثلاث سنوات. وقال ابن شهرآشوب في المناقب: ولدت بعد النبوة بسنتين فيكون عمرها يوم تزويجها اثنتي عشرة سنة، أو ثلاث عشرة سنة، أو أربع عشرة سنة بناء على الخلاف في أن تزويجها كان بعد الهجرة بسنة أو سنتين أو ثلاث.
وفي الاستيعاب: كان سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفاً، وكانت سن علي إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وعلى القول: بأنها ولدت قبل النبوة بخمس سنين يكون عمرها يوم تزويجها عشرين سنة. وقال أبو الفرج الأصبهاني، ورواه ابن حجر في الإصابة، وابن سعد في الطبقات: كان لها يوم تزويجها ثماني عشرة سنة وروى ابن سعد في الطبقات: أن تزويجها بعد مقدم النبي (ص) المدينة بخمسة أشهر وبنى بها مرجعه من بدر قال: فاطمة يوم بنى بها علي بنت ثمان عشرة سنة؛ ولعله وقع اشتباه بين تاريخ تزويجها ووفاتها لما ستعرف من أن ذلك سنها يوم وفاتها كما احتملنا وقوع اشتباه في ولادتها بين كونها بعد النبوة بخمس سنين أو قبلها.
وكذلك اختلفت الروايات في يوم وشهر تزويجها. قال ابن شهرآشوب في المناقب: تزوجها علي (ع) أول يوم ذي الحجة. وقال أبو الفرج: كان تزويجها في صفر. وفي رواية: تزوجها في شهر رمضان. وعن المفيد، وابن طاووس ناسبين له إلى أكثر العلماء: أن زفافها كان ليلة إحدى وعشرين من المحرم ليلة الخميس.
بيت فاطمة
كان النبي قد بنى لنفسه بيتاً شرقي المسجد ملاصقاً له سكنه مع ابنته فاطمة، وبنى هناك أيضاً بيوتاً أسكنها أزواجه وبنى لعلي (ع) بيتاً بجنب البيت الذي تسكنه عائشة، وهو الذي دفن فيه النبي (ص). فلما تزوج علي بفاطمة أسكنها في بيت استأجره، ثم عاد إلى ذلك البيت وسكنته فاطمة معه، حتى توفيت وفيه ولد الحسن والحسين وسائر أولاد علي من فاطمة (عليهم السلام)، وبقيت الصخرة التي ولدت عليها الحسنين ظاهرة بعد إلحاق بيتها بالمسجد يعرفها أهل البيت.
ولما كان زمن الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز عامله على المدينة ومكة، أراد الوليد هدم البيت فبعث الوليد إلى عمر بن عبدالعزيز بمال. وقال له: من باعك فاعطه ثمنه، ومن أبي فاهدم عليه وأعطه المال؛ فإن أبى أن يأخذه فاصرفه إلى الفقراء، فرفض الحسن بن الحسن قبضه، وكان يسكن البيت مع زوجته فاطمة بنت عمه الحسين فأمر الوليد بهدمه، فهدم.
فدك وميراث رسول الله
ترك النبي عند وفاته أموالاً خاصة به، كما كان في حياته قد وهب ابنته فاطمة بعض الأرض لتكون مورد رزق لأسرتها، وكان أهم ما تركه مزرعة فدك التي كانت ملكاً له، فلما توفي النبي صادر الخليفة فدكاً من فاطمة ومنعها من التصرف بها، فلما احتجت على ذلك بأنهم يحرمونها من إرثها من أبيها، فضلاً عن أن أباها قد وهبها إياها في حياته. قال الخليفة بأنه سمع رسول الله (ص) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وأما دعوى الهبة فإن عليها أن تثبت ذلك!! ورفض قبول شهادة علي وأم أيمن!!.
وقد عظم على فاطمة أن تمنع من إرثها ويؤخذ منها ما وهبه لها أبوها، فخطبت في ذلك خطبة تعتبر آية من آيات الكلام العربي شرحت فيها هذا الموضوع شرحاً مؤثراً، وتعرضت إلى الأسلوب الذي تم فيه الاستيلاء على الخلافة، وتنبأت بأن ذلك سيكون فتحاً لباب الفتن في الإسلام، وقد حققت الأيام نبوءتها؛ فأصبحت الخلافة لمن غلب، وستأتي التفاصيل في الآتي.
وبقيت فدك في يد الخليفة الأول، ثم في يد الخليفة الثاني، ثم في يد الخليفة الثالث، ثم أقطعها الخليفة الثالث لمروان بن الحكم فوهبها مروان لولديه عبدالملك وعبدالعزيز.
ولما ولي علي الخلافة لم يأخذها وهو أعلم بوجه الحكمة في عدم أخذها. فلما ولي عمر بن عبدالعزيز ردها إلى ولد فاطمة، فلما مات وولي يزيد بن عبدالملك أخذها منهم فلم تزل في يد بني مروان إلى أن ولي السفاح فدفعها إلى الحسن بن الحسن بن علي ليفرقها في ولد فاطمة، فلما ولي المنصور وخرج عليه بنو الحسن قبضها منهم، فلما ولي ابنه المهدي أعادها عليهم، فلما ولي موسى الهادي قبضها منهم وبقيت في يد ملوك بني العباس، حتى ولي المأمون فردها عليهم، فلما ولي المتوكل أخذها منهم. والحقيقة أن حرمان فاطمة مما ورثته عن أبيها ومصادرة فدك منها ترك جرحاً دامياً في النفوس. ونترك القول هنا لعالم من علماء الأزهر هو الشيخ محمود أبو رية:
ما قاله الشيخ أبو رية
وفي مجلة الرسالة المصرية في العدد 518 من السنة 11 ص475 كلام للشيخ محمود أبو رية من علماء مصر، هذا لفظه: بقي أمر لا بد من أن نقول فيه كلمة صريحة هو موقف أبي بكر من فاطمة بنت الرسول وما فعل معها في ميراث أبيها لأننا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي، وأنه قد ثبت أن النبي قد قال أنه لا يورث، وأنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة بعض تركة أبيها وكأن يخصها بفدك وهذا من حقه الذي لا يعارضه فيه أحد إذ يجوز للخليفة أن يخص من شاء بما شاء وقد خص هو نفسه الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبي، على أن فدكاً هذه التي منعها أبو بكر من فاطمة لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان. هذا ما ذكره هذا العالم الأزهري. وقد ورد في (معجم البلدان): أنه أدى اجتهاد عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة أن يرد فدكاً إلى ورثة النبي، فكان علي بن أبي طالب والعباس عمه يتنازعان فيها ويدعي العباس أنه هو وارث النبي. وهذا الكلام قد انفرد بذكره صاحب معجم البلدان، وهو كلام لا يصح، لأنه إذا كان النبي لا يورث ـ كما روى أبو بكر ـ فكيف يدعي العباس أنه وارثه وإذا كان يورث فوارثه ابنته فاطمة.
وسيرد كلام آخر في هذا الموضوع.
فاطمة البطلة المكافحة
كانت فاطمة عزيزة على النبي، وبلغ حبه لها أقصى ما يمكن أن يبلغه حب إنسان لإنسان، ولم تكن أبوته لها هي وحدها مصدر هذا الحب العظيم بل كانت هناك عوامل عديدة زادت النبي تعلقاً بابنته وحباً لها. منها:
أولاً: إنها كانت وحيدته بعد أن فقد الأولاد واحداً بعد واحد.
ثانياً: شخصيتها الفريدة: فمن تتبع أخبارها تبدو له فاطمة ذات شخصية متفوقة وذكاء فطري عظيم وحسن تفهم للأمور وتحمل للشدائد وإدراك لظروف المجتمع الذي تعيش فيه.
ثالثاً: وقوفها إلى جنب أبيها في مطلع الدعوة وهي لا تزال صغيرة السن لا وقوف الفتاة اليتيمة التي فقدت أمها فأصبحت عبئاً على أبيها كما يحدث مثل هذه الحالات. بل وقوف الفتاة التي تدرك ظروف أبيها وتعلم خطر الرسالة التي يدعو لها، وتعرف ما يحيط به من شدائد وأهوال وعداوات. وما يحتاج إليه من مخلصين ومناضلين أكفياء، يشاركونه حمل الأعباء الضخمة التي بات يحملها.
لهذا تناست فاطمة أنها صغيرة السن يتيمة الأم محتاجة لمن يرعاها في بيتها ويقوم على شؤونها، وصممت على أن تقف إلى جنب أبيها وقوف المرأة الصلبة القوية العزيمة المضحية براحتها ورفاهيتها لا وقوف البنت المدللة التي تزيد أباها تعباً على تعبه، ولو أن أي فتاة أخرى غير فاطمة وغير متمتعة بسجايا فاطمة مرت بها ظروف فاطمة لكانت بالفعل في مثل ذلك السن عبئاً على أبيها وشاغلاً من مشاغله وهماً من همومه.
ولكن فاطمة الطفلة صارت ربة بيت أبيها بعد وفاة أمها تكفيه التفكير بمشاغل بيته، ثم صارت عضداً له في الشدائد التي أصابته، فحين يبلغها أن أباها تعرض لأذى قريش تركض إليه ركض اللبوة وتقف إلى جانبه مدافعة عنه ثم تأخذ بيده مزيلة عن جسده ما ألقته قريش عليه أو تضمد جراحه بيديها مترفعة عن ضعف النساء في هذه الحالات مثبتة لأبيها أن إلى جانبه بطلة مكافحة لا طفلة مدللة.
ولم يجد محمد كلمة تعبر عن تقديره لما لقي من ابنته الصغيرة وما أدته له في مواقفه من حنان ومشاركة ونضال أفضل من أن يلقبها (أم أبيها) لقد سماها بهذا الاسم ليدل على ما كان لها من أثر في حياته وفي تأدية رسالته.
وهكذا نرى فاطمة فتاة يتيمة الأم تحمل في منزل والدها وفي أداء رسالته ما لا يمكن أن تحمل مثله فتاة في مثل سنها ومثل ظروفها فمرت طفولتها وصباها في عناء وتنغيص وبلاء. لقد نغص المشركون حياتها في صباها بما كانوا يفعلونه بأبيها وما كانوا يؤذونه به، فكيف عاملها المسلمون في شبابها وهل حرص المسلمون على أن تكون تلك الفتاة شريكة محمد في الكفاح، والتي استحقت أن يقول عنها أنها «أم أبيها»، هل حرص المسلمون على أن يعوضوها في شبابها عما فاتها في صباها من راحة وهناء؟ سنرى جواب ذلك فيما بعد.
وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن فاطمة لم تشارك في الدعوة الإسلامية بجهدها وحده ولم تضح براحتها وحدها ولم تكن بطلة بأعمالها فقط. إن فاطمة قدمت للدعوة الإسلامية فوق هذا ما كانت تحتاجه تلك الدعوة من مال كثير ورثته عن أمها خديجة. فإن خديجة التاجرة الثرية ذات الأموال الكثيرة قد خلفت ما بقي من تلك الأموال لزوجها ولابنتها، وهكذا كانت فاطمة الوارثة لأموال خديجة، فأين ذهب ذاك المال وهل استطاعت فاطمة أن تنعم به؟ لقد وضعت ذاك المال كله في يد أبيها لينفقه على الدعوة الإسلامية ورجالها ورضيت حياة الفقر الشديد وعاشت في الحرمان تطحن القمح بيدها لبيتها.
وعندما انتصرت الدعوة وفاز المسلمون رأى النبي أن من حق ابنته البطلة المكافحة أن تستريح قليلاً، وكانت قد حصلت له مزرعة فرأى أن يهبها لابنته لتعيش بمنتوجها بعد أن أصبحت هي وزوجها ذات أسرة وأطفال. لقد أعطاها مزرعة (فدك). وهكذا كانت هذه المزرعة مورد الرزق لهذه الأسرة النبوية المؤلفة من ابنة النبي وزوجها وأولادهما أسباط النبي.
وفي اليوم الأول بعد وفاة النبي كان أول إجراء اتخذته السلطات الحاكمة هو أن طلبت إلى فاطمة أن ترفع يدها عن (فدك).
وبالرغم مما كانت فيه فاطمة من حزن على أبيها ومن تألم للأسلوب الذي تم فيه الاستيلاء على الخلافة فقد هالها أن يبلغ الأمر إلى هذا الحد فتحرم بعد وفاة أبيها حتى من موارد العيش فكان لا بد لها من النضال من جديد. وهكذا نرى أن فاطمة العزيزة على النبي ووحيدته تضطر لأن تقف على أبواب من أوجدهم أبوها مطالبة بحقها.
واضطرت لأن تسأل بأي حق يحرمونها من رزقها بعد وفاة أبيها، وإذا بالأمر يزداد إمعاناً في تعذيبها بأن توقف موقف المدعية بغير حقها، يطلب منها شهود على أن أباها وهبها (فدكاً) وقد كان من الطبيعي أن لا يحضر النبي الشهود الغرباء ليشهدهم على تصرف عائلي بحت يجريه بينه وبين ابنته. فزاد هذا الطلب في آلام فاطمة إذن فإن البطلة المكافحة التي بذلت راحتها وهناءها وجاهدت بكل صلابة مع أبيها العظيم ثم ضحت بكل ما تملك من مال غزير لإنجاح الدعوة الإسلامية، إذن فهي اليوم متهمة ممن أوجدهم أبوها بأنها كاذبة في دعواها وأن عليها أن تفتش عن شهود ليؤيدوا دعواها. وقد كان هذا فوق أن تحتمله فاطمة العظيمة، ولكنها عزمت على السير معهم إلى النهاية حفظاً لآخر حق لها وتنبيهاً للأمة. فأفهمتهم أنه لم يكن من شأن النبي أن يفتش عمن يشهد له ولابنته على تصرف عائلي بحت يخصهما وحدهما. وأن وضع يدها على فدك وتصرفها بها في حياة أبيها مما هو معروف مشهور كاف لتأييد قولها، ومع ذلك فإنه حين أعلن لها أبوها بأنه وهبها لها كان حاضراً كل من علي بن أبي طالب وأم أيمن. ثم ما شأنكم أنتم بذلك؟ إن المال مال أبي فلو فرضنا أنه لم يكن قد وهبه لي في حياته فإني وارثته الوحيدة.
وهنا كانت الأقدار قد أعدت لفاطمة المفاجأة المذهلة، لقد أجابوها بأنها لن ترث عن أبيها شيئاً لا فدكاً ولا غير فدك وإن جميع أموال أبيها مصادرة. وقال الخليفة: لقد سمعت النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث.
قال هذا القول معترفاً بأن أحداً من المسلمين غيره لم يسمعه من النبي وأنه وحده الذي سمعه.
ثم أضاف بأنه لا يقبل شهادة علي وأم أيمن لأنهما رجل وامرأة وهو يريد رجلين.
على أننا قبل أن نعرض مناقشة فاطمة لهم نتساءل: لماذا يريدنا الخليفة على أن نقبل في هذا الأمر قوله وحده وقد جعل من نفسه شاهداً يشهد لنفسه في دعوى هو فيها المدعى عليه.
وإذا كان يرى أن شهادة رجل وامرأة لا تقبل، فكيف تقبل شهادة رجل وحده؟!
ثم كيف يصح أن يجعل من نفسه خصماً وقاضياً، وشاهداً؟!
إن الطريق السليم في مثل هذا الحال هو الآتي:
إن القاعدة الإسلامية هي أن يرث كل وارث مال مورثه مهما كانت شخصية هذا المورث. وهنا رجل يدعي أنه سمع من النبي غير هذا. إذن فإن عليه وفقاً لكل قانون في العالم أن يعرض هذا القول على المسلمين ثم يختار المسلمون قاضياً ويتقدم هو كشاهد فإذا وجد من يؤيد شهادته أخذ القاضي بالشهادة وإذا لم يجد رد القاضي شهادته. أما أن يرد هو شهادة رجل وامرأة ثم يجعل من نفسه القاضي والخصم والشاهد فذلك أمر لا يقره، لا عرف ولا قانون. هذا بصرف النظر عن شخصية صاحبة الدعوة وشخصية أبيها وشخصيتي الشاهدين.
ومثل هذا القول الذي نقوله قاله الكثيرون من العلماء المنصفين المتحررين من المسلمين ونذكر منهم العالم المصري الشيخ محمود أبو رية الذي مر قوله فيما تقدم.
على أن فاطمة العظيمة رأت في طريقة الاستيلاء على الخلافة ثم في المعاملة التي عوملت بها نذيراً بما سيصير إليه الإسلام في المستقبل البعيد وبما سينتهي إليه الحكم الإسلامي في الآتي من الأيام.
فكانت وهي تكافح عن حقها الشخصي إنما تكافح عن حق الشعب في المستقبل متخذة من حقها مظهراً لتنبيه الشعب وسبيلاً لإنذاره بما سيصير إليه، محذرة من الفتن التي فتح بابها على مصراعيه. وقد تحقق كل ما حذرت منه فاطمة ونبهت إليه وانتهى أمر الإسلام إلى أن يحكمه مثل معاوية ومروان والوليد بن عقبة وعبدالله بن أبي سرح وزياد بن أبيه فضلاً عن يزيد وعبيد الله بن زياد والحجاج وأشباههم.
وعندما استنكر فريق من أخلص المسلمين أن تعامل فاطمة هذه المعاملة ولزموا بيتها مواسين لها في محنتها لم تشعر فاطمة في ليلة من الليالي إلا والجنود تحيط بمنزلها والصياح يتعالى حول المنزل بالتهديد والوعيد، وصاح قائد الجند إنني سأحرق البيت على من فيه! فقيل له: إنه بيت محمد وبيت فاطمة فقال: وإن كان. وبالفعل أتى بحزمة من الحطب وأشعل فيها النار وأراد رميها على البيت.
وهنا يختلف المؤرخون في وصف ما حدث والآثار التي ترتبت على ذلك. ولكن الثابت أن فاطمة وقفت كعادتها موقف البطولة التي اعتادت أن تقفها في مثل هذا الحادث يوم كانت تكافح مع أبيها.
على أن هذه الصدمة كانت أشد الصدمات على نفسها فأثر هذا كله في صحتها فأخذت بالتدهور فلبثت مريضة إلى أن وافاها أجلها بعد أقل من شهرين من وفاة أبيها وهي لم تبلغ العشرين من عمرها.
خطبة فاطمة عندما صودرت أموالها وحرمت من ميراثها
تعتبر هذه الخطبة من أعلى آيات البيان العربي وقد بدأتها فاطمة بالتوجه إلى الله والدعوة إليه ثم بالتوجه إلى النبي أبيها وما كان عليه الناس قبله من جهل ووثنية وفساد وما دعاهم إليه من خير وتوحيد، ثم موته وقد أدى رسالته.
ثم توجهت إلى الحاضرين فتحدثت عن القرآن وما دعاهم إليه وحثهم عليه. وعرضت لمبادىء الإسلام كلها ولخصتها بعبارات موجزة ودعتهم إلى التمسك بها والحفاظ عليها.
ثم أشارت إلى ما عانى النبي في تبليغ دعوته، وما تحمل في سبيلها من أذى، وما كان عليه الناس قبل الإسلام من التقاتل والاختلاف وضيق العيش، وكيف كانوا خاضعين للظالمين والمستبدين، وكيف صدع النبي بدعوته فتجندت الحشود لقتاله والقضاء عليه وكيف كان يوجه ربيبه وابن عمه (علياً) لكل ملمة معرضاً له للمخاطر والأهوال وكيف كان علي يخلص لمحمد وللإسلام فلا يتوانى ولا يتراجع. وكيف أنه لم يكد النبي يموت حتى برز ذوو الأضغان بأضغانهم ثم كيف تُرك النبي ملقى في بيته بين أهله لم يدفن وانصرف عنه المنصرفون ليتنازعوا على تولي الخلافة بعده.
وهنا تبلغ فاطمة في تحليلها للموقف أعظم ما يبلغ إليه الذكاء الإنساني من تصوير لما سيصير إليه أمر المسلمين من تقاتل ووقوع في الفتن بعد أن تم الاستيلاء على الخلافة بالصورة التي تم عليها وبعد أن كانت القوة هي وحدها التي تغلبت، فتقول فاطمة: أنهم يدعون أنهم فعلوا ما فعلوا خوف الفتنة: وترد عليهم قائلة: أنه بما فعلوه قد فتحوا باب الفتن مستشهدة بالآية القرآنية: ﴿أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾.
ثم انتقلت إلى ما فعلوه من مصادرة أموالها ومنعها من أن ترث أباها فقالت: (وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي من أبي… أيها المسلون أأغلب على إرثي، يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي…).
ثم أدلت بالآيات القرآنية التي صرحت بتوريث الأقرباء عامة وتوريث الأنبياء خاصة. وقالت: (زعمتم أن لا أرث لي من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان أَوَلَسْتُ أنا وأبي من ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي).
واسترسلت في خطبتها شارحة مؤنبة مستصرخة وختمت خطبتها منوهة بأنها تكلمت بما تكلمت وهي تعلم أنه لن يستجيبوا لها ولكن لا بد من أن تقدم حجتها.
وخاطبت الناس بعد ذلك منذرة بما سيصير إليه أمر الإسلام من فتن وما سينتهي إليه حال الحكم والحكام فيه بعد أن جرى ما جرى عليها هي نفسها قائلة: (اطمئنوا للفتنة جأشاً وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج دائم شامل واستبداد من الظامين يدع فيأكم زهيداً وجمعكم حصيداً فيا حسرة عليكم).
وقد كانت في هذه الأقوال من أبعد الناس نظراً وأصدقهم فراسة وأعمقهم فكراً فتحقق جميع ما تنبأت به. فبعد أن كان الإسلام ثورة شعبية وحكماً في أشرف درجات الحكم وأعظمها في تحقيق العدل الاجتماعي والمساواة، عاد الإسلام حكماً استبدادياً فردياً يتحكم فيه فرد واحد ظالم بدماء الناس وأموالهم وكراماتهم. ويكفي أن المدينة نفسها التي تعالى فيها صوت فاطمة منذراً محذراً قد شهدت من «السيف الصارم وسطوة المعتدي الغاشم ومن الهرج الشامل الدائم واستبداد الظالمين ما ترك فيئها زهيداً وجمعها حصيداً» على حد تعبير فاطمة، فقد أباحها يزيد بن معاوية لجنوده في وقعة الحرة ثلاثة أيام يقتلون وينبهون ويذلون ويهتكون الأعراض، ويرغمون أبناء الذين حذرتهم فاطمة يرغمونهم على أن يبايعوا مسلم بن عقبة على أنهم عبيد أرقاء ليزيد بن معاوية ومن رفض هذه البيعة قتل.
بل لقد امتدت الحياة بكثيرين من الذي سمعوا كلام فاطمة، امتدت بهم الحياة فبايعوا هذه البيعة وأصيبوا بتلك الفظائع.
ومن قبل أُصيبت أسرة أبي بكر نفسه. أُصيب عبدالرحمن بن أبي بكر بسطوة المعتدين الغاشمين واستبداد الظالمين فأهين وروّع، وشتمه مروان بن الحكم لأنه اعترض على بيعة يزيد، وقال: هذه سنة هرقل وقيصر، فتناوله مروان بقبيح القول، واضطرت عائشة للدفاع عن أخيها فشتمت مروان وشتمت أباه([423]). وقال له معاوية: هممت بأن أقتلك، وقال له: لا تظهر لأهل الشام فإني أخشى عليك منهم. فاضطر للاستتار والتواري ولم يلبث أن مات مقهوراً مهاناً([424]) وربما مسموماً.
كما أُصيب أخوه محمد بن أبي بكر بظلم الظالمين فقتلوه أشنع قتلة وأُصيبت بهم أسرة عمر أُصيب عبدالله بن عمر فأذلوه وأرغموه على البيعة ليزيد ثم على يد الحجاج لعبد الملك ثم شتمه الحجاج وأهانه ثم أرسل له من اغتاله. كما كان قد قتل في فتن الظالمين ابن عمر الآخر عبيدالله.
وأصيب عبيدالله وسليمان ابنا عاصم بن عمر بن الخطاب فقتلتهما سيوف الأمويين يوم الحرة في المدينة.
وأُصيبت من بعد، أسماء بنت أبي بكر بالذل على أيدي الظالمين وأُصيب على أيديهم سبط أبي بكر ابنها عبدالله فذبحوه وصلبوه وهي تسمع وترى.
وبلغ عدد الذين قتلوا في المدينة في وقعة الحرة ممن سمع قول فاطمة من المهاجرين والأنصار والقرشيين ألفاً وسبعمائة رجل منهم معقل بن سنان حامل لواء قومه يوم فتح النبي مكة، ومنهم عبدالله بن زيد قاتل مسيلمة، هذا عدا عمن عذبوا مثل أبي سعيد الخدري الذي نتفوا لحيته.
وأما من غير المهاجرين والأنصار والقرشيين أي من أبناء الذي سمعوا قول فاطمة، فقد قتل ما يزيد على عشرة آلاف بينهم زيد بن عبدالرحمن بن عوف. وأما من بقي حياً فقد أرغم على البيعة على أنه عبد رقيق ليزيد.
وهذا جرى كله في مدينة واحدة هي مدينة الرسول وفي حادثة واحدة هي وقعة الحرة وعلى يد حاكم واحد هو يزيد. ولن نشير إلى ما جرى قبل ذلك وبعد ذلك مثل قتل عبدالرحمن بن خالد بن الوليد بالسم.
هكذا كانت فاطمة في ساعات المحن والشدائد صلبة العود بعيدة النظر صحيحة الاستنتاج قوية التفكير فتحقق كل ما حذرت منه ونبهت إليه.
دسائس على النبي وعلي وفاطمة
ورد في كتاب ذخائر العقبى([425]): أن علياً أراد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة وإن النبي غضب لذلك وصعد المنبر محتداً ناقماً على هذا الأمر شاجباً له بالتفاصيل المزرية التي وردت في الكتاب مما هو طعن صريح بمحمد فضلاً عن أنه طعن بعلي وبفاطمة.
1 ـ أما أنه طعن في محمد فذلك أنه أظهره بمظهر من يرفض أن يطبق الشريعة على نفسه وعلى من يتصل به، في حين أنه يفرض على غيره تطبيقها.
فهو يبيح للناس تعدد الزوجات ولكن يأبى أن يطبق هذا التعدد على بنته.
وهذا من أفظع ما يوجه إلى النبي (ص) من مطاعن ولكن أعداء محمد استطاعوا أن يفعلوا ذلك وأن يستغلوا ذوي النظر القصير فيروونه في كتبهم ولا يرون فيه شيئاً.
2 ـ أما أنه طعن في علي فذلك بإظهاره بمظهر من أغضب فاطمة وأغضب النبي نفسه.
3 ـ وأما أنه طعن في فاطمة فذلك لأنها تأبى تطبيق شريعة الله التي جاء بها أبوها على نفسها.
4 ـ نحن لن نتعرض لسند الخبر فإن هذا الخبر بادي الفساد من نفسه ولكننا نتساءل لماذا خص راوو الخبر بنت أبي جهل بهذا الشرف ولماذا لم ينسبوا إلى علي محاولته التزوج على فاطمة من غير بنت أبي جهل؟!
أكان ذلك لأن بنت أبي جهل كانت من الجمال والكمال بحيث لم تكن أي فتاة عربية غيرها على شيء من مثلهما؟!
إنما خصوا بذلك بنت أبي جهل ليكون الطعن في علي أبلغ وأنفذ فهو لم يختر لإغاظة النبي وابنته فاطمة إلا بنت أعدى عدو للنبي والإسلام.
5 ـ كشفت الدسيسة عن نفسها وفضحت مخترعيها، ولو كانوا أكثر ذكاء لخففوا من غلوائهم ولم يمدحوا أنفسهم وهم يشتمون محمداً وابنته وابن عمه: فقد أوردوا في القصة هذا النص عن لسان النبي: «ذكر ـ أي النبي ـ صهراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال ـ أي النبي ـ: حدثني ـ أي ذلك الصهر من بني عبد شمس ـ فصدقني ووعدني فأوفاني»([426]). ومعنى هذا الكلام أن النبي يثنى على صهره الأموي من بني عبد شمس ويقول عنه: أنه حدثه فصدقه في حديثه ووعده فوفى بما وعد!! والنتيجة الحتمية لهذا الكلام أن صهر النبي الآخر علي بن أبي طالب حدث النبي فكذب في حديثه ووعد النبي فغدر ولم يفِ، وإن النبي ذمه في مصاهرته إياه!!
وهكذا ـ كما قلنا ـ فضحت الدسيسة نفسها بنفسها وأظهرت زيفها دون أن تحوجنا في ذلك إلى كبير عناء.
6 ـ أريد لهذا الخبر الزائف غاية أخرى مضافة إلى غاية الطعن في النبي وفي علي وابنته فاطمة: هذه الغاية هي صرف الأنظار عن حقيقة الذين أغضبوا فاطمة، وجعل المقصود بذلك هو علي بن أبي طالب.
فقد أورد مدبرو الخبر ومنظموه ـ أوردوه بعدة نصوص ليكون في كل نص غاية مستقلة. ومن النصوص التي أوردوها قولهم: «قال النبي: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها».
ثم فسروا هذا الحديث بأن قالوا أن المقصود منه «أن الله حرم على علي أن يتزوج على فاطمة ويؤذي رسول الله».
حديثْ خطبة عليّ
بنت أبي جهل
حديث خِطبة أمير المؤمنين علي (ع) ابنة أبي جهل على حياة رسول الله (ص) وعنده الزهراء الطاهرة سلام الله عليها هو ما نريد تحقيقه والفصل في أمره في مقالنا هذا:
لقد راجعنا هذا الحديث المتعلّق بالنبي والإمام والزهراء… في جميع مظانه، ولاحظنا أسانيده ومتونه، فتدبّرنا في أحوال رواته على ضوء كلمات أعلام الجرح والتعديل، وأمعنّا النظر في مدلوله على أساس القواعد المقرّرة في كتب علوم الحديث.. وبالاستناد إلى ما ذكره المحقّقون من شرّاحٍ الأخبار.. فوجدناه حديثاً موضوعاً، وقضيّةً مختلَقة، وحكايةً مفتعلة… يقصد من ورائه التنقيص من النبي في الدرجة الأُولى، ثم من عليّ والصدّيقة الكبرى…
إنّه حديث اتّفقوا على إخراجه في الكتب… لكنّه ممّا يجب إخراجه من السُنَّة!!
هذه نتيجة التحقيق الذي قمت به حول هذا الحديث وإليك التفصيل:
مُخرِّجو الحديث وأسانيده
قد أشرنا إلى أنّ الحديث متّفق عليه. لكن لا بين البخاري ومسلم فحسب، بل بين أرباب الكتب الستّة كلّهم… وأخرجه أيضاً أصحاب المسانيد والسنن. وغيرهم، ممّن تقدّم عليهم وتأخّر عنهم.. إلاّ القليل منهم.
ونحن نستعرض أوّلاً ما ورد في أهمّ الكتب الموصوفة بالصّحة عندهم، ثم ما أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ثم نتبعه بما رواه الآخرون.
فرواية البخاري:
أخرج البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه:
1 ـ فقد جاء في كتاب الخمس: «حدّثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، أنّ الوليد بن كثير حدّثه، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، حدّثه أنّ ابن شهاب حدّثه: أنّ عليّ بن حسين حدّثه: أنّهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية (بعد) مقتل حسين بن عليّ رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إليَّ من حاجةٍ تأمرني بها؟ فقلت له: لا. فقال: فهل أنت معطيَّ سيف رسول الله (ص)؟ فإنّي أخاف أن يغلبك القوم عليه؟ وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبداً حتى تبلغ نفسي.
إنّ عليّ بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة (عليها السلام) فسمعت رسول الله (ص) يخطب الناس في ذلك على منبره هذا ـ وأنا يومئذٍ محتلم ـ فقال: «إنَّ فاطمة مني، وأنا أتخوّف أنْ تفتن في دينها». ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه، قال: «حدَّثني فصدقني، ووعدني فوفي لي، وإنّي لست أُحرّم حلالاً ولا أُحلّ حراماً، ولكنْ ـ الله ـ لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله أبداً»([427]).
2 ـ وجاء في كتاب النكاح: «حدثنا قتيبة، حدّثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول ـ وهو على المنبر ـ «إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أنْ ينكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب. فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أنْ يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنّما هي بضعة منّي، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها»([428]).
3 ـ وجاء في كتاب المناقب ـ ذكر أصهار النبي منهم أبو العاص بن الربيع ـ حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال حدثني علي بن الحسين، أن المسور بن مخرمة قال: إنّ عليّاً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله (ص) فقالت: يزعم قومك أنّك لا تغضب لبناتك، وهذا عليٌّ ناكح بنت أبي جهل.
فقام رسول الله (ص) فسمعته حين تشهّد يقول: أمّا بعد، أنكحتُ أبا العاص بن الربيع فحدّثني وصدقني، وإنّ فاطمة بضعة منّي، وإنّي أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله عند رجل واحد.
فترك عليٌّ الخطبة.
زاد محمد بن عمرو بن حلحلة: عن ابن شهاب، عن عليّ، عن مسور: سمعت النبي (ص) وذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه فأحسن، قال: «حدّثني فصدقني، ووعدني فوفى لي»([429]).
4 ـ وجاء في باب الشقاق من كتاب الطلاق: «حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة الزهري، قال: سمعت النبي (ص) يقول: «إنّ بني المغيرة استأذنوا في أنْ ينكح عليٌّ ابنتهم. فلا آذن»([430]).
رواية مسلم:
وأخرجه مسلم في باب فضائل فاطمة فقال:
1 ـ «حدّثنا أحمد بن عبدالله بن يونس وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث بن سعد، قال ابن يونس: حدّثنا ليث، حدّثنا عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشي التيمي أنّ المسور بن مخرمة حدّثه أنّه سمع رسول الله (ص) على المنبر وهو يقول: ألا إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أنْ ينكحوا ابنتهم…».
2 ـ «حدّثني أحمد بن حنبل، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن الوليد بن كثير، حدّثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أنّ ابن شهاب حدّثه أنّ عليَّ بن الحسين حدّثه أنّهم حين قدموا المدينة…».
3 ـ «حدّثني عبدالله بن عبدالرحمان الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عليّ بن حسين أنّ المسور بن مخرمة أخبره أنّ عليّ بن أبي طالب خطب…».
4 ـ «وحدّثنيه أبو معز الرقاشي، حدّثنا وهب ـ يعني: ابن جرير ـ عن أبيه، قال: سمعت النعمان ـ يعني: ابن راشد ـ يحدّث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه»([431]).
رواية الترمذي:
وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب/ فضل فاطمة:
1 ـ «حدّثنا قتيبة، حدّثنا الليث عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، قال: سمعت النبي (ص) يقول ـ وهو على المنبر ـ: إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا»…
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
«وقد رواه عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة نحو هذا».
2 ـ «حدّثنا أحمد بن منيع، حدّثنا إسماعيل بن علية، عن أيّوب عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن الزبير: أنّ عليّاً ذكر بنت أبي جهل»…
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
«هكذا قال أيّوب، عن ابن أبي مليكة، عن الزبير. وقال غير واحد عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة. ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً»([432]).
رواية ابن ماجة:
وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح/ باب الغيرة:
1 ـ «حدّثنا عيسى بن حمّاد المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن عبدالله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، قال: سمعت رسول الله (ص) وهو على المنبر يقول: إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم…».
2 ـ «حدّثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عليّ بن الحسين: أنّ المسور بن مخرمة أخبره أنّ عليّ بن أبي طالب خطب… فنزل عليّ عن الخطبة»([433]).
رواية أبي داود:
وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح قائلاً:
1 ـ «حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثني أبي، عن الوليد بن كثير، حدّثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أنّ ابن شهاب حدّثه أنّ عليّ بن حسين حدّثه: أنّهم حين قدموا المدينة…».
2 ـ «حدّثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيّوب، عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال: فسكت علي عن ذلك النكاح».
3 ـ «حدّثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى([434]) قال أحمد: حدثنا الليث، حدّثني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشي التيمي: أنّ المسور بن مخرمة حدّثه أنّه سمع رسول الله (ص) على المنبر يقول: إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من عليّ بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن، إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنّما ابنتي بضعة منّي، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها»([435]).
رواية الحاكم:
وقال الحاكم:
1 ـ «أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، حدثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، أخبرني أبي، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، قال: خطب عليّ ابنة أبي جهل إلى عمّها الحارث بن هشام فاستشار النبي (ص) فقال: أعَن حَسَبها تسألني؟ قال عليّ: قد أعلم ما حسبها ولكن أتأمرني بها؟ فقال: لا، فاطمة بضعة منّي، ولا أحسب إلاّ وأنّها تحزن أو تجزع. فقال عليّ: لا آتي شيئاً تكرهه.
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة».
2 ـ «أخبرنا أبو العبّاس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون.
وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة ـ رجل من أهل مكّة([436]) ـ أنّ عليّاً خطب ابنة أبي جهل، فقال له أهلها: لا نزوّجك على ابنة رسول الله (ص). فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال: «إنّما فاطمة بضعة منّي، فمن آذاها فقد آذاني».
3 ـ «حدّثنا بكر بن محمد الصيرفي، حدثنا موسى بن سهل بن كثير، حدثنا إسماعيل بن عليّة، حدثنا أبو أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن الزبير: أنّ علياً رضي الله عنه ذكر ابنة أبي جهل، فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال: إنّما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها.
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»([437]).
رواية ابن أبي شيبة:
ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة بقوله: «حدّثنا محمد بن بشر عن زكريا، عن عامر، قال: خطب عليّ بنت أبي جهل إلى عمّها الحارث بن هشام، فاستأمر رسول الله (ص) فيها. فقال: عن حسبها تسألني؟ قال عليّ: قد أعلم ما حَسَبُها، ولكن أتأمرني بها؟ قال: لا، فاطمة بضعة منّي، ولا أُحبّ أن تجزع. فقال عليّ: لا آتي شيئاً تكرهه»([438]).
رواية أحمد بن حنبل:
وأخرجه أحمد في (مسنده) وفي (فضائل الصحابة).
وقد جاء في «المسند» ما نصّه:
1 ـ «حدّثنا عبدالله، حدّثني أبي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت النعمان يحدّث عن الزهري عن عليّ بن حسين عن المسور بن مخرمة: أنّ عليّاً خطب…».
2 ـ «حدّثنا عبدالله، حدّثني أبي، ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عليّ بن حسين أنّ المسور بن مخرمة أخبره أنّ عليّ بن أبي طالب خطب…».
3 ـ حدّثنا عبدالله، حدّثني أبي، حدثنا يعقوب ـ يعني: ابن إبراهيم ـ، حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، حدّثني محمد بن عمرو، حدّثني ابن حلحلة الدؤلي([439]) أنّ ابن شهاب حدّثه أنّ عليّ بن الحسين حدّثه ـ أنّهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية (بعد) مقتل حسين بن عليّ ـ لقيه المسور بن مخرمة… أنّ عليّ بن أبي طالب خطب…».
4 ـ حدّثنا عبدالله، حدّثني أبي، حدّثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث ـ يعني: ابن سعد ـ، قال: حدّثني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، قال: سمعت رسول الله (ص) ـ وهو على المنبر ـ يقول: إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا…»([440]).
5 ـ «حدّثنا عبدالله، حدّثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيّوب، عن عبدالله بن أبي مليكة، عن عبدالله بن الزبير، أنّ علياً ذكر ابنة أبي جهل، فبلغ النبي (ص) فقال: إنّها فاطمة بضعة منّي، يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها»([441]).
وجاء في فضائل فاطمة بنت رسول الله من (مناقب الصحابة):
6 ـ «حدّثنا عبدالله، قال: حدّثني أبي، حدثنا يحيى بن زكريّا، قال: أخبرني أبي، عن الشعبي، قال: خطب عليّ…».
7 ـ «حدّثنا عبدالله، قال: حدّثني أبي، حدثنا يزيد، قال: حدّثنا إسماعيل، عن حنظلة، أنّه أخبره رجل من أهل مكّة: أنّ عليّاً خطب…».
8 ـ «حدّثنا عبدالله، قال: حدّثني أبي، حدّثنا سفيان، عن عمرو، عن محمد بن عليّ: إنّ عليّاً (ع) أراد أن ينكح ابنة أبي جهل فقال رسول الله (ص) ـ وهو على المنبر ـ: إنّ عليّاً أراد أن ينكح العوراء بنت أبي جهل، ولم يكن ذلك له أنْ يجمع بين ابنة عدوّ الله وبين ابنة رسول الله، وإنّما فاطمة بضعة منّي».
9 ـ «حدّثنا عبدالله، قال: حدّثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدّثنا أيّوب، عن عبدالله([442]) بن أبي مليكة، عن عبدالله بن الزبير: إنّ عليّاً ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك النبي (ص) فقال: إنّما فاطمة بضعة منّي، يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها».
10 ـ «حدّثنا عبدالله، قال: حدّثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا الليث، قال: حدّثني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، قال: سمعت رسول الله (ص) ـ وهو على المنبر ـ يقول: إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أنْ ينكحوا ابنتهم…».
11 ـ «حدّثنا عبدالله، قال: حدّثني أبي، حدّثنا أبو اليمان، قال: حدّثنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عليّ بن حسين، أنّ المسور بن مخرمة أخبره أنّ عليّ بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة… قال: فنزل عليٌّ عن الخطبة».
12 ـ حدّثنا عبدالله، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا عبدالرزّاق، قال: حدّثنا معمر، عن الزهري، عن عروة. وعن أيّوب، عن ابن أبي مليكة: أنّ عليّ بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل حتى وعد النكاح… فسكت عليّ عن ذلك النكاح وتركه».
13 ـ حدّثنا عبدالله، قال: حدّثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، حدّثنا أبي، قال: سمعت النعمان يحدّث عن الزهري، عن عليّ بن الحسين، عن المسور بن مخرمة، أنّ عليّاً خطب…»([443]).
في المسانيد والمعاجم
روى الهيثمي:
«عن ابن عبّاس أنّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، فقال رسول الله (ص): إنْ كنت تزوّجتها فردّ علينا ابنتنا».
إلى هنا انتهى حديث خالد، وفي الحديث زيادة: قال: فقال النبي (ص): والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله تحت رجل.
رواه الطبراني في الثلاثة والكبير بنحوه مختصراً، والبزّار باختصار.
«وفيه: (عبيد الله بن تمام) وهو ضعيف»([444]).
وروى ابن حجر العسقلاني:
«عليّ بن الحسين: أنّ عليّ بن أبي طالب أراد أنْ يخطب بنت أبي جهل، فقال الناس: أترون رسول الله (ص) يجد من ذلك؟! فقال ناس: وما ذلك؟! إنّما هي امرأة من النساء. وقال ناس: ليجدنَّ من هذا، يتزوّج ابنة عدوّ الله على ابنة رسول الله (ص)!؟
فبلغ ذلك رسول الله (ص)، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد، فما بال أقوام يزعمون أنّي لا أجد لفاطمة، وإنّما فاطمة بضعة منّي، إنّه ليس لأحدٍ أنْ يتزوّج ابنة عدوّ الله على ابنة رسول الله.
هذا مرسل. وأصل الحديث في الصحيح من حديث المسور أنّه حدّث به عليّ بن الحسين([445]).
قلت: وحدّث به عليٌّ بن الحسين الزهريَّ!!
وروى المتقي:
«عن الشعبي، قال: جاء عليّ إلى رسول الله (ص) يسأله عن ابنة أبي جهل وخطبتها إلى عمّها الحارث بن هشام. فقال النبي (ص): «عن أيّ بالها تسألني؟» أعَن حسبها؟ فقال: لا، ولكن أريد أن أتزوّجها، أتكره ذلك؟ فقال النبي: إنّما فاطمة بضعة منّي، وأنا أكره أن تحزن أو تغضب. فقال عليّ: فلن آتي شيئاً ساءك. عب».
«عن ابن أبي مليكة: أنّ عليّ بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل حتى وُعد النكاح، فبلغ ذلك فاطمة، فقالت لأبيها: يزعم الناس أنّك لا تغضب لبناتك، وهذا أبو الحسن قد خطب ابنة أبي جهل وقد وُعد النكاح.
فقام النبي (ص) خطيباً فحمد الله وأثنى بما هو أهله، ثم ذكر أبا العاص بن الربيع فأثنى عليه في صهره، ثم قال: إنّما فاطمة بضعة منّي، وإنّي أخشى أن تفتنوها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله تحت رجل. فسكت عن ذلك النكاح وترك. عب»([446]).
نظرات في أسانيد الحديث
استعرضنا طرق هذا الحديث.. في الصحاح والمسانيد وغيرها.. فوجدنا أنّها تنتهي إلى:
1 ـ المسور بن مخرمة.
2 ـ عبدالله بن العبّاس.
3 ـ عليّ بن الحسين.
4 ـ عبدالله بن الزبير.
5 ـ عروة بن الزبير.
6 ـ محمد بن عليّ.
7 ـ سويد بن غفلة.
8 ـ عامر الشعبي.
9 ـ ابن أبي مليكة.
10 ـ رجل من أهل مكّة.
* ابن عبّاس:
ولم أجده إلاَّ عند أبي بكر البزّار والطبراني، كما في مجمع الزوائد، وقد عرفت أنّ الهيثمي قال بعده: «وفيه: عبيدالله بن تمام، وهو ضعيف».
قلت: ذكره ابن حجر وذكر هذا الحديث من مناكيره. قال: «ضعّفه الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. روى أحاديث منكَرة، وقال الساجي: كذّاب يحدِّث بمناكير، وذكره ابن الجارود والعقيلي وأورد له عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أنّ عليّاً خطب بنت أبي جهل فبعث إليه النبي (ص): إن كنت متزوِّجاً فردّ علينا ابنتنا»([447]).
* عليّ بن الحسين:
رواه ابن حجر العسقلاني، ثم قال: «وأصل الحديث في الصحيح من حديث المسور أنّه حدّث به عليّ بن الحسين».
وفي هامشه: «قال البوصيري: رواه الحارث بسندٍ منقطع ضعيف لضعف عليّ بن زيد بن جدعان. وأصله في الصحيح من حديث المسور».
قلت: سنتكلّم على حديث المسور بالتفصيل.
* عبدالله بن الزبير:
رواه الترمذي وأحمد والحاكم وأبو نعيم([448]) عن أيّوب السختياني عن ابن بي مليكة عنه.
قال الترمذي: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه من المسور وعبدالله بن الزبير جميعاً.
قال ابن حجر: «ورجّح الدارقطني وغيره طريق المسور، وهو أثبت بلا ريب، لأنّ المسور قد روى في هذا الحديث قطعةً مطوّلة قد تقدّمت في باب أصهار النبي.
نعم، يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقط، أو سمعها من المسور فأرسلها([449]).
قلت: إنْ كان قد سمعها من المسور، فسنتكلّم على حديث مسور بالتفصيل، وإنْ كان هو الراوي للحديث بأنْ يكون قد سمع رسول الله (ص) وهو طفل ـ لأنّه ولد سنة إحدى من الهجرة([450]) ـ فحاله في البغض لعليّ وأهل البيت بل للنبيّ نفسه معلوم.
ثم إنّ الراوي عنه «ابن أبي مليكة» مؤذّنه كما ستعرف.
* عروة بن الزبير:
أخرجه أبو داود بسنده عن الزهري عنه.
ولم أجده عند غيره.
وهو منكر: لأنّه مرسل، لأنّ عروة ولد في خلافة عمر.
ولأنّ عروة كان من المشهورين بالبغض والعداء لأمير المؤمنين (ع) كما ستعرف في خبر حول الزهري، وحتى أنّه حضر يوم الجمل مع أصحابه على صغر سنّه([451]).
ووضع حديثاً في فضل زينب بنت رسول الله (ص) جاء فيه: «فكان رسول الله (ص) يقول: هي خير بناتي».
فبلغ ذلك عليّ بن الحسين (ع) فانطلق إليه فقال: ما حديث بلغني عنك أنّك تحدّثه تنتقص حقّ فاطمة؟!.
فقال: «لا أُحدِّث به أبداً».
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح([452]).
ولأنّ الراوي عنه هو «الزهري» وستعرفه.
* محمد بن عليّ:
وهو ابن الحنفية. رواه أحمد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عنه.. وهذا لم أجده إلاّ في الفضائل لأحمد، فلم يَرْوِه غيره ولا هو في مسنده فيما أعلم…
وقد ذكر محقّق الفضائل في هامشه: إنّه مرسل، ومحمد بن الحنفية لم يسنده.
قلت: وذلك لأنّ عمرو بن دينار لم يسمع من محمد بن عليّ؛ ولذا لم يذكروا محمداً فيمن روى عنه عمرو، بل نصّوا على عدم سماعه مِن بعض مَن عُدّ منهم، فابن عبّاس مثلاً أوّل من ذكره ابن حجر فيمن روى عنه، ثم نقل عن الترمذي أنّه قال: قال البخاري: لم يسمع عمرو بن دينار من ابن عبّاس حديث عن عمر في البكاء على الميّت. قال ابن حجر: قلت: ومقتضى ذلك أنْ يكون مدلّساً([453]).
هذا من جهة إرساله…
ومحمد بن عليّ لم يكن من الصحابة، وقد تزوّج أمير المؤمنين (ع) بأُمّه بعد وفاة الزهراء (عليها السلام) بزمن.
* سويد بن غفلة:
أخرج حديثه الحاكم عن أحمد بسنده عن الشعبي عنه، ولم أجده عند غيره وقد صحّحه.
لكن قال الذهبي في تلخيصه: مرسَلٌ قويّ.
وذلك لأنّ سويداً لم يدرك النبي (ص)، فإنه قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله (ص).
فالعجب من الحاكم كيف صحّحه؟!.
ومن الذهبي أيضاً، إذ يرويه عن أحمد بسنده عن الشعبي عن سويد بن غفلة… ساكتاً عنه([454])!
ومن ابن حجر والقسطلاني أيضاً، كيف وافقا الحاكم على صحّة سنده مع تصريحهما بأنّ سويداً لم يلق النبي (ص)([455])!
وكذا من العيني([456])!.
* عامر الشعبي:
أخرجه عنه عبد الرزّاق بن همام ـ كما في كنز العمّال ـ وابن أبي شيبة في المصنّف كما تقدّم، إذ هو المراد من قوله: «… عن عامر» وأحمد في الفضائل.
ومن المعلوم أنّ الشعبي مات بعد المائة، والمشهور أنّ مولده كان لستّ سنين خلت من خلافة عمر([457]).
فالحديث بهذا السند مرسَل.
ولعلّه يرويه عن سويد بن غفلة، وهكذا أخرجه الحاكم وأحمد كما تقدّم عن الذهبي، وقد عرفت أنّه مرسلَ كذلك.
هذا بغضّ النظر عن قوادح الشعبي، والتي أهمّها كونه من الوضّاعين على أهل البيت، فقد رووا عنه أنّه قال: «صلّى أبو بكر الصدّيق على فاطمة بنت رسول الله (ص) فكبّر عليها أربعاً»([458]) وأنّه قال: «إنّ فاطمة لمَّا ماتت دفنها عليّ ليلاً وأخذ بضبعي أبي بكر فقدّمه في الصلاة عليها([459]) فإنّ هذا كذب بلا ريب. حتى اضطرّ ابن حجر إلى أن يقول: «فيه ضعف وانقطاع»([460]).
وكونه من حكّام وقضاة سلاطين الجور كعبد الملك بن مروان وغيره المعادين لأهل البيت الطاهرين.
وأنّه روى عن جماعةٍ كبيرةٍ من الصحابة، وفيهم من نصّوا على أنّه لم يلقهم ولم يسمع منهم، كَعَليّ (ع) وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمر وأُمّ سلمة وعائشة!
ثم إنّ الراوي عنه «زكريّا بن أبي زائدة» قال ابن أبي ليلى: ضعيف.
وقال أبو زرعة: صويلح يدلّس كثيراً عن الشعبي.
وقال أبو حاتم: ليّن الحديث كان يدلّس، ويقال: إنّ المسائل التي كان يرويها عن الشعبي لم يسمعها منه.
وقال أبو داود: يدلّس.
وقال ابنه يحيى بن زكريّا: لو شئت سمّيت لك من بين أبي وبين الشعبي»([461])!.
والراوي عنه ولده يحيى: مات بالمدائن قاضياً لهارون. وقال أبو زرعة: قلماً يخطىء، فإذا أخطأ أتى بالعظائم. وعن أبي نعيم: ما هو بأهلٍ أن يحدَّث عنه([462]).
* ابن أبي مليكة:
رواه عنه عبد الرزّاق بن همام كما في كنز العمّال.
لكنّه مرسَل.
وهو يرويه إمّا عن المسور، وإمّا عن عبدالله بن الزبير، وإمّا عن كليهما جميعاً كما احتمل بعضهم…
أمّا حديث ابن الزبير فساقط بسقوطه نفسه، وأمّا حديث المسور فسنتكلّم عليه.
رجل من أهل مكّة:
الذي عند أحمد: «عن أبي حنظلة أنّه أخبره رجل من أهل مكّة».
والذي عند الحاكم: «عن أبي حنظلة رجل من أهل مكّة».
فمن «أبو حنظلة»؟ ومن «الرجل من أهل مكّة»؟.
أمّا الحاكم فقد رواه ساكتاً عنه!
لكنّ الذهبي تعقّبه بقوله: «قلت: مرسل»!.
ثم إنّ الراوي عنه بواسطة إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي هو: «يزيد بن هارون»… قال يحيى بن معين: «يدلّس من أصحاب الحديث، لأنّه لا يميّز ولا يبالي عَمّن روى»([463]).
* الكلام على حديث مِسْوَر:
لكن الطريق الذي اتّفق عليه أصحاب الصحاح كلّهم هو الأول، وهو وحده الذي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي([464]) وابن ماجة. وانفرد الترمذي بروايته عن ابن الزبير، وقد عرفت تنبيهه على ذلك، وانفرد أبو داود بروايته عن عروة، وقد عرفت ما فيه.
فالمعتمد والأصحّ عندهم جميعاً هو حديث المسور بن مخرمة…!
ثم إنّ روايات القوم عن مسور تنتهي إلى:
1 ـ علي بن الحسين. وهو الإمام زين العابدين (ع).
2 ـ عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة.
والراوي عن الإمام زين العابدين (ع) ليس إلاّ:
محمد بن شهاب الزهري.
والراوي عن ابن أبي مليكة:
1 ـ الليث بن سعد.
2 ـ أيّوب بن أبي تميمة السختياني.
ثم إنّ الدارمي([465]) والبخاري ومسلماً وأحمد وابن ماجة. يروونه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري.
ويرويه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد… عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن الزهري.
ويرويه مسلم عن النعمان عن الزهري.
ونحن لا يهمّنا البحث عن أبي اليمان ـ وهو الحكم بن نافع ـ وروايته عن شعيب ـ وهو ابن حمزة كاتب الزهري وراويته([466]) ـ مع أنّ العلماء تكلّموا في ذلك، حتى قال بعضهم: لم يسمع أبو اليمان من شعيب ولا كلمةً([467]) وإنّ الرجلين كانا من أهل حمص، وهم من أشدّ الناس على أمير المؤمنين (ع) في تلك العصور، ويضرب بحماقتهم المثل([468]).
ولا يهمّنا البحث عن الوليد بن كثير وكان إباضيّاً([469]).
ولا عن أيّوب، ولا عن الليث الذي كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم فحدّثهم بفضائل عثمان فكفّوا!([470]).
ولا عن النعمان ـ وهو ابن راشد الجزري ـ الذي ضعّفه القطّان جدّاً. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري وأبو حاتم: في حديثه وهمٌ كثير. وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في الضعفاء. وقال أبو داود: ضعيف؛ وكذا قال النسائي والعقيلي([471]).
إنّما نتكلّم في ابن أبي مليكة والزهري.
أمّا الأول فيكفينا أنْ نعلم أنّه كان قاضيَ عبدالله بن الزبير ومؤذّنه([472]).
وأمّا الثاني فهو العمدة في عمدة أخبار المسألة، وهو الذي يروي الخبر عن الإمام زين العابدين (ع)!! فلنفصّل فيه الكلام:
إنّ الزهري كان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام).
قال ابن أبي الحديد المعتزلي: «وكان الزهري من المنحرفين عنه. وروى جرير ابن عبد الحميد عن محمد بن شيبة قال: شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليّاً فنالا منه. فبلغ ذلك عليّ بن الحسين فجاء حتى وقف عليهما فقال: أمّا أنت يا عروة، فإنّ أبي حاكَمَ أباك إلى الله فحكم لأبي علي أبيك؛ وأمّا أنت يا زهريّ، فلو كنت بمكّة لأريتك كبر أبيك».
قال: «وروى عاصم بن أبي عامر البجلي، عن يحيى بن عروة، قال: كان أبي إذا ذُكر علياً نال منه»([473]).
ويؤكّد هذا سعيه وراء إنكار مناقب أمير المؤمنين عليّ (ع)، كمنقبة سبقه إلى الإِسلام؛ قال ابن عبدالبَرّ: «وذكر معمر في جامعه عن الزهري قال: ما علمنا أحداً أسلمَ قبل زيد بن حارثة. قال عبد الرزّاق: وما أعلم أحداً ذكره غير الزهري([474]).
وروايته عن عمر بن سعد اللعين قاتلِ الحسين ابن أمير المؤمنين (ع)، قال الذهبي: «عمر بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه. وعنه: إبراهيم وأبو إسحاق. وأرسل عنه الزهري وقتادة. قال ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟!»([475]).
وكونه من عمّال بني أُميّة ومشيّدي سلطانهم، حتى أنكر عليه ذلك العلماء والزهّاد، فقد ذكر عبدالحقّ الدهلوي بترجمته من «رجال المشكاة»: «إنّه قد ابتلي بصحبة الأُمراء بقلّة الديانة، وكان أقرانه من العلماء والزهّاد يأخذون عليه وينكرون ذلك منه، وكان يقول: أنا شريك في خيرهم دون شرّهم! فيقولون: ـ ألا ترى ما هم فيه وتسكت؟!».
ومن هنا قدح فيه ابن معين فقد «حكى الحاكم عن ابن معين أنّه قال: أجود الأسانيد: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله؛ فقال له إنسان: الأعمش مثل الزهري!! فقال: تريد من الأعمش أن يكون مثل الزهري؟!! الزهري يرى العرض والإجازة، ويعمل لبني أُميّة؛ والأعمش فقير صبور، مجانب للسلطان ورعٌ عالم بالقرآن»([476]).
وبهذه المناسبة كتب له الإمام زين العابدين (ع) كتاباً يعظه فيه ويذكِّره الله والدار الآخرة وينبّهه على الآثار السيّئة المترتّبة على كونه في قصور السلاطين، من ذلك قوله: «إنَّ أدنى ما كتمت وأخفَّ ما احتملتَ أن آنستَ وحشة الظالم، وسهّلت له طريق الغيّ.. جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسُلّماً إلى ضلالتهم، داعياً إلى غيّهم، سالكاً سبيلهم.. احذَرْ فقد نُبِّئْت، وبادِرْ فقد أُجِّلْت.. ولا تحسب أنّي أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك، لكنّي أردت أن ينعش الله ما فات من رأيك، ويردّ إليك ما عز من دينك.. أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة، وما الناس فيه من البلاء والفتنة؟!.. فأعْرِض عن كلّ ما أنت فيه حتى تلحق بالصالحين الذين دفنوا في أسمالهم، لاصقةً بطونهم بظهورهم. ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك فتقول: والله ما قمتُ لله مقاماً واحداً ما أحييتُ به له ديناً، أو أمَتُّ له فيه باطلاً؟!»([477]).
هذا، ولقد ورث الزهري العداء للحقّ والنبي وأهل بيته من آبائه، فقد ذكر ابن خلّكان بترجمته: «وكان أبو جدّه عبدالله بن شهاب شهد مع المشركين بدراً، وكان أحد النفر الّذين تعاقدوا يوم أُحد لئن رأوا رسول الله (ص) ليقتلّنه أو ليقتلنَّ دونه، وروى أنّه قيل للزهري: هل شهد جَدّك بدراً؟ فقال: نعم، ولكن من ذلك الجانب. يعني أنّه كان في صفّ المشركين. وكان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير. ولم يزل الزهري مع عبدالملك ثم مع هشام بن عبدالملك. وكان يزيد بن عبدالملك قد استقضاه»([478]).
وإذْ عرفت حال الزهري وموقف الإمام عليّ بن الحسين (ع) منه.. فهل تصدّق أن يكون الإِمام (ع) قد حدّثه بحديثٍ فيه تنقيص على جدّه الرسول الأمين وأُمّه الزهراء وأبيه أمير المؤمنين (ع)؟!
لكنّه الزهري! عندما يضع الحديث على النبي والعترة ومذهبهم يضعه على لسان واحدٍ منهم كي يسهل على الناس قبوله!!.
خذ لذلك مثالاً.. ما وضعه على لسان ابني محمد بن عليّ عنه عن أبيه أمير المؤمنين (ع) أنّه قال لابن عبّاس ـ وقد بلغه أنّه يقول بالمتعة ـ: «إنّك رجل تائه، إنّ رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» هذا الحديث الذي حكم ببطلانه كبار أئمّتهم كالبيهقي وابن عبدالبرّ والسهيلي وابن القيّم والقسطلاني وابن حجر العسقلاني وغيرهم من شرّاح الحديث.
لكنّه وضعه على لسان أفراد من أهل البيت عن سيّدهم أمير المؤمنين (ع) في الردّ على ابن عبّاس وبهذا التعبير!!.
وبقي الكلام في (مسور) نفسه، ويكفينا أنْ نعلم:
أولاً: إنّهَ وُلد بعد الهجرة بسنتين، فكم كانت سنيّ عمره في وقت خطبة النبيّ (ص)؟! وهذا ما سنتكلّم عنه بعدُ أيضاً.
وثانياً: إنّه كان مع ابن الزبير، وكان ابن الزبير لا يقطع أمراً دونه، وقد قتل في قضيّة رمي الكعبة بالمنجنيق، وولي ابن الزبير غسله.
وثالثاً: إنّه كان إذا ذكر معاوية صلّى عليه.
ورابعاً: إنّه كانت الخوارج تغشاه وينتحلونه([479]).
تأمّلات في متن الحديث ومدلوله
وبعد، فإنّه لا بُدّ من التأمّل في متن الحديث ومدلوله… فلا بُدّ من النظر إلى المتن… لأنّه في كلّ موردٍ يختلف فيه متن الحديث والأسانيد معتبرة، يلجأ العلماء إلى القول بتعدّد الواقعة.. أمّا حيث لا يمكن الالتزام بتعدّدها وتعذّر الجمع بين ألفاظ الحديث. فذلك عندهم قرينة قويّة على أنْ لا واقعيّة للقضيّة…
هذا ما قرّره العلماء.. وبنوا عليه في كثير من الأحاديث الفقهيّة وأخبار القضايا التاريخيّة.. ونحو ذلك…
ولا بُدّ من النظر في الدلالة… فقد يكون الحديث صحيحاً سنداً ولكنّه يخالف ـ من حيث الدلالة ـ الضرورة العقلية أو محكم الكتاب أو قطعيّ السُنّة أو واقع الحال…
ونحن ننظر في متن هذا الحديث ومدلوله، بعد فرض صحّة سنده وقبوله.. في فصول:
تأمّلات في خصوص حديث المسور:
1 ـ لقد جاء عن مسور: سمعت النبيّ (ص) «وأنا محتلم قال ابن حجر بشرح البخاري: «وفي رواية الزهري عن عليّ بن حسين عن المسور ـ الماضية في فرض الخمس ـ (يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذٍ محتلم). قال ابن سيّد الناس: هذا غلط. والصواب ما وقع عند الإِسماعيلي بلفظ (كالمحتلم) أخرجه من طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى عليّ بن الحسين. قال: والمسور لم يحتلم في حياة النبي (ص)، لأنّه ولد بعد ابن الزبير، فيكون عمره عند وفاة النبي (ص) ثمان سنين»([480]).
وقال بترجمة المسور: «ووقع في صحيح مسلم([481]) من حديثه في خطبة عليّ لابنة أبي جهل، قال المسور: سمعت النبي (ص) وأنا محتلم يخطب الناس، فذكر الحديث. وهو مشكل المأخذ، لأنّ المؤرّخين لم يختلفوا أنّ مولده كان بعد الهجرة، وقصّة خطبة عليّ كانت بعد مولد المسور بنحو ستّ سنين أو سبع سنين، فكيف يسمّى محتلماً؟!»([482]).
أقول: فهذا إشكال في المتن! ولربّما أمكن الإشكال من هذه الناحية في السند! والعجب من الذهبي كيف توهّم من هذا الحديث كونه محتلماً يومذاك([483]).
2 ـ ذكر المسور قصّة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من عليّ بن الحسين (ع)… وقد وقع الإشكال عندهم في مناسبة ذلك، وذكروا وجوهاً اعترفوا بكون بعضها تكلّفاً وتعسّفاً، ولكنَّ الحقّ أنها جميعها كذلك كما سترى:
قال الكرماني: «فإنْ قلت: ما وجه مناسبة هذه الحكاية لطلب السيف؟ قلت: لعلّ غرضه منه أنّ رسول الله (ص) كان يحترز ممّا يوجب الكدورة بين الأقرباء، وكذلك أنت أيضاً ينبغي أنْ تحترز منه، وتعطيني هذا السيف حتى لا يتجدّد بسببه كدورة أُخرى.
أو: كما أنّ رسول الله (ص) يراعي جانب بني أعمامه العبشمية، أنت راعِ جانب بني أعمامك النوفلية؛ لأنّ المسور نوفليّ.
أو: كما أنّه (ص) يحبّ رفاهيّة خاطر فاطمة، أنا أيضاً أُحبّ رفاهيّة خاطرك، فأعطنيه حتى أحفظه لك»([484]).
هذه هي الوجوه التي ذكرها الكرماني لدفع الإشكال، وقد ذكرها ابن حجر وقال ـ بعد أن أشكل على الثاني بأنّ المسور زهري لا نوفلي ـ: «والأخير هو المعتمد. وما قبله ظاهر التكلّف» قال: «وسأذكر إشكالاً يتعلّق بذلك في كتاب المناقب»([485]).
وكأنَّ العيني لم يرتضِ هذا الوجه المعتمد! فقال: «إنّما ذكر المسور قصّة خطبة عليّ بنت أبي جهل ليعلم عليّ بن الحسين زين العادين بمحبّته في فاطمة وفي نسلها لِما سمع من رسول الله»([486]).
قلت: إذا كان ذكر القصّة ليعلم أنّه يحبّ. رفاهيّة خاطره، أو ليعلم بمحبّته في فاطمة ونسلها.. فأيّ خصوصيّة للسيف؟! وهل كانت الرفاهيّة لخاطره حاصلة من جميع الجهات، وهو قادم من العراق مع تلك النسوة والأطفال بتلك الحال، وبقي خاطره مشوّشاً من طرف السيف، فأراد رفاهيّة خاطره، أو إعلامه بمحبّته له، كي يعطيه السيف؟!
3 ـ وهل من المعقول أنْ يذكر الإنسان لمن يريد أن يعلم بمحبّته له ورفاهيّة خاطره ما يكدِّر خاطره ويجرح عواطفه؟!
وهذا هو الإشكال الذي أشار إليه ابن حجر في عبارته الآنفة. ثم قال في كتاب المناقب: «ولا أزال أتعجّب من المسور كيف بالغ في تعصّبه لعَليّ بن الحسين، حتى قال: إنّه لو أودع عنده السيف لا يُمَكِّن أحداً منه حتى تزهق روحه، رعايةً لكونه ابن ابن فاطمة، ولم يراعِ خاطره في أنّ في ظاهرِ سياق الحديث غضاضه على عليّ بن الحسين، لِما فيه من إيهام غضٍّ من جدّه عليّ بن أبي طالب، حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة، حتى اقتضى أن يقع من النبي (ص) في ذلك من الإنكار ما وقع؟!
بل أتعجّب من المسور تعجّباً آخر أبلغ من ذلك، وهو أنْ يبذل نفسه دون السيف رعايةً لخاطر ولد ابن فاطمة، وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه ـ أعني الحسين والد عليّ الذي وقعت معه القصّة ـ حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة؟!!»([487]).
ثم إنّ ثمّة شيئاً آخر… هو أنّ المسور بن مخرمة لمّا خطب الحسن بن الحسن ابنته: «حمد الله عزّ وجلّ وأثنى عليه وقال: أمّا بعد، فما من نسبٍ ولا سببٍ ولا صهر أحبّ إليَّ من نسبكم وصهركم، ولكنّ رسول الله (ص) قال: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها، وإنّ الأنساب يوم القيامة تنقطع إلاّ نسبي وسببي وصهري، وعندك ابنته ولو زوَّجتك لقبضها ذلك» فانطلق الحسن عاذراً إليه([488]).
ولو كان مسور يروي قصّة خطبة أبي جهل لاستشهد بها وحكى الحديث كاملاً، لشدّة المناسبة بين خطبة عليّ ابنة أبي جهل وعنده فاطمة وخطبة الحسن بن الحسن ابن المسور وعنده بنت عمه!
فهذه إشكالات حار القوم في حلّها الحلّ المعقول…
تأملات في ألفاظ الحديث:
وهنا أسئلة:
الأول: هل خطب عليٌّ ابنة أبي جهلٍ حقّاً؟
الملاحظ أنّ في حديث الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور: «سمعت النبي (ص) يقول: إنّ بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح عليٌّ ابنتهم…».
وفي أغلب طرق حديث الزهري ـ وبعض الأحاديث الأخرى ـ عن عليّ بن الحسين، عن المسور: «أنّ عليَّ بن أبي طالب خطب…».
وفي حديث عبدالله بن الزبير: «أنّ عليّاً ذكر بنت أبي جهل…».
وهذا ليس اختلافاً في التعبير فحسب…
الثاني: هل وُعد عليٌّ النكاح؟.
صريح بعض الأحاديث عن الزهري: «وعد النكاح» وهو ظاهر الأحاديث الأخرى ـ عن الزهري أيضاً ـ التي فيها قول فاطمة للنبي: «هذا عليٌّ ناكحاً» أو «نكح» فإنّه بعد رفع اليد عن ظهوره في تحقّق النكاح فلا بُدّ من وقوع الخطبة والوعد بالنكاح.
لكن في حديث أبي حنظلة: «فقال له أهلها: لا نزوِّجك على ابنة رسول الله (ص)».
الثالث: هل وقع الاستئذان من النبي؟.
صريح الحديث عن الليث عن المسور أنَّه سمع النبي (ص) يعلن أنّه قد استؤذن في ذلك وأنّه لا يأذن. لكن صريح الحديث عن الزهري عن المسور: أنّه سمعه تشهّد ثم قال: «أمّا بعد، أنكحتُ أبا العاص بن الربيع، فحدّثني وصدّقني…» أو نحو ذلك مِمَّا فيه التعريض بِعَليّ وليس فيه تعرّض للمشورة والاستئذان منه! وكذا الحديث عن أيّوب عن ابن الزبير، لا تعرّض فيه للاستئذان، لكن بلا تعريض، فجاء فيه: «فبلغ ذلك النبي (ص) فقال: إنّما فاطمة بضعة منّي…».
الرابع: من الذي استأذن؟
قد عرفت خلوّ حديث الزهري عن الاستئذان مطلقاً.
ثم إنّ كثيراً من الأحاديث تنصّ على استئذان أهل المرأة. وفي بعضها: أنّه استأذن بنفسه وقال له: «أتأمرني بها؟» فقال: «لا، فاطمة بضعة منّي… فقال: لا آتي شيئاً تكرهه».
الخامس: من الذي أبلغ النبي؟.
في حديث أيّوب عن ابن الزبير: «فبلغ ذلك…».
وفي حديث الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور: أنّهم أهل المرأة حيث جاؤوا إليه ليستأذنوه..
وفي حديث سويد بن غفلة: أنّه عليٌّ نفسه، حيث جاء ليستأذنه…
لكنْ في حديث الزهري: إنّها فاطمة!… إنّها لمّا سمعت بذلك خرجت من بيتها وأتت النبيّ (ص) وجَعَلت تخاطبه بما لا يليق! يقول الزهري: «إن عليّاً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله (ص) فقالت: يزعم قومك أنّك لا تغضب لبناتك، وهذا عليٌّ ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله (ص)…».
بل في حديث يرويه مفادُه شيوع الخبر بين الناس!! يقول: «فقال الناس: أترون أنّ رسول الله (ص) يجد من ذلك؟! فقال ناسٌ… وقال ناسٌ..».
وهناك أسئلة أُخرى…
فألفاظ الحديث متناقضة جدّاً، والقضيّة واحدة، وقد تحيّر الشرّاح هنا أيضاً واضطربت كلماتهم ولم يوفَّقوا للجمع بينهما وإن حاولوا وتمحّلوا!!.
تأمّلات في مدلوله:
ثم إنّه يجب النظر في هذه الأحاديث من الناحية الفقهية والناحية الأخلاقية والعاطفية.. بعد فرض ثبوت القضيّة…
فماذا صنع عليّ؟ وما فعلت فاطمة؟ وأيّ شيءٍ صدر من النبي؟
لقد خطب عليٌّ ابنة أبي جهل، فتأذّت الزهراء، فصعد النبي المنبر وقال…
هل كان يحرم على عليٍّ التزوّج على فاطمة أم لا؟.
وعلى الأول: فهل كان على علمٍ بذلك أم لا؟.
لا ريب في أن عليّاً لا يقدم على هذا الأمر المحرَّم عليه مع علمه بالحرمة، فإمّا أن لا تكون حرمة، وإمّا أن لا يكون له علم بها.
لكنّ الثاني: لا يجوز نسبته إلى سائر الناس فكيف بباب مدينة علم النبي (ص)؟!
فهو إذن حين فعل ذلك لم يكن فاعلاً لمحرَّم في الشريعة، لأنّ حاله حال سائر المسلمين الجائز عليهم نكاح الأربع، ولو كان ـ بالنسبة إليه خاصةً ـ حكم دون رجال المسلمين لعلمه!
وحينئذٍ فهل من الجائز خروج الصدّيقة الطاهرة ـ بمجرّد سماعها الخبر ـ إلى رسول الله (ص) لتشكو بعلها وتخاطب أباها بتلك الكلمات القارصة؟!.
إنّه لم يفعل محرَّماً حتى تكون قد أرادت النهي عن المنكر، فهل أنّ شأنها شأن غيرها من النساء ويكون لها من الغيرة ما يكون لسواها؟! وهل كانت غيرتها لإقدام عليٍّ على النكاح أو لكون المخطوبة بنت أبي جهل؟!.
والنبي… يصعد المنبر… بعد أن يرى فاطمة منزعجة… أو بعد أنْ يستأذنه القوم في أن ينكحوا ابنتهم… فيخاطب الناس؟!
وماذا قال؟!
قد اشتملت خطبته على ما يلي:
1 ـ الثناء على صهرٍ له من بني عبد شمس!
2 ـ الخوف من أن تفتن فاطمة في دينها!
3 ـ إنّه ليس يحرِّم حلالاً ولا يحلّ حراماً… ولكنْ لا يأذن!.
4 ـ إنّه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله! وفي لفظٍ: إنّه ليس لأحدٍ أنّ يتزوَّج ابنة عدوّ الله على ابنة رسول الله! وفي ثالث: لم يكن ذلك له أن يجمع…!.
5 ـ إلاّ أنْ يريد ابن أبي طالب أن يطلِّق ابنته (ص) وينكح ابنتهم! وفي لفظ: إن كنت تزوّجتها فردَّ علينا ابنتنا…!.
أترى من الجائز كلّ هذا؟!.
لقد حار الشرّاح ـ وهم يقولون بأنّ عليّاً خطب ولم يكن بمحرّم عليه، وبأنَّ فاطمة تعتريها الغيرة كسائر النساء! ـ في توجيه ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله (ص) في هذه الواقعة…
إنّ عليّاً كان قد أخذ بعموم الجواز.
وفاطمة الزهراء ليست بالتي تُفتن عن دينها أو يعتريها ما يعتري النسوة وقد نزلت فيها آية التطهير من السماء، وكانت سيّدة النساء وعلى فرض ذلك ـ كما تقول هذه الأحاديث ـ فلا خصوصيّة لابنة أبي جهل.
والنبي يعترف في خطبته بأنّ عليّاً ما فعل حراماً، ولكنْ لا يأذن. فهل إذنه شرط؟! وهل يجوز حمل الصهر على طلاق زوجته إن تزوّج بأخرى عليها؟!.
كل هذا غير جائز ولا كائن.
سلّمنا أنّ فاطمة أخذتها الغيرة([489])، والنبي أخذته الغيرة لابنته([490])، فلماذا صعد المنبر وأعلن القصة وشهَّر؟!
يقول ابن حجر: «وإنّما خطب النبي ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا به، إمّا على سبيل الإيجاب، وإمّا على سبيل الأوْلويّة»([491]).
وتبعه العيني([492]).
والمراد بالحكم: حكم «الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدوْ الله» لكنّ ألفاظ الحديث مختلفة، ففي لفظٍ: «لا تجتمع…» وفي آخر: «ليس لأحدٍ…» وفي ثالث: «لم يكن ذلك له». ولذا اختلفت كلمات العلماء في الحكم!.
قال النووي: «قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبيَّ بكلّ حال وعلى كلّ وجه، وإنْ تولّد ذلك الإِيذاءِ مِمَّا كان أصله مباحاً وهو حَيّ. وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعليّ بقوله: لست أُحرِّم حلالاً، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلّتين منصوصتين، إحداهما: أنّ ذلك يؤدّي إلى أذى فاطمة فيتأذّى حينئذٍ النبي (ص) فيهلك من آذاه. فنهى عن ذلك لكمال شفقته على عليٍّ وفاطمة. والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة.
وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنيّة الربيع.
ويحتمل أنّ المراد: تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أُحرِّم حلالاً، أي؛ لا أقول شيئاً يخالف حكم الله، فإذا أحَلَّ شيئاً لم أُحرِّمه، وإذا حرّمه لم أُحلِّله ولم أسكت عن تحريمه، لأنّ سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرّمات النكاح الجمع بين بنت عدوّ الله وبنت نبي الله»([493]).
وقال العيني: «نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته لعلّتين منصوصتين…»([494]).
أقول: أمّا «لا تجتمع…» فليس صريحاً في التحريم، ولذا قيل: «ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلم من فضل الله أنّهما لا تجتمعان».
وأما ليس لأحدٍ…» فظاهر في الحرمة لعموم المسلمين، فيكون حكماً مخصصاً لعموم أدلّة الجواز لكن لا يفتي به أحد… بل يكذّبه عمل عمر بن الخطّاب، حيث خطب ـ فيما يروون ـ ابنة أمير المؤمنين الإِمام عليٍّ (ع) وعنده غير واحدةٍ من بنات أعداء الله كما لا يخفى على من راجع تراجمه.
وأمّا «لم يكن ذلك له» فصريح في اختصاص الحكم بعليّ، فهل هو نهي تنزيهي أو تحريمي؟ إنْ كان الثاني فلا بُدّ أن يفرض مع جهل عليٌّ به، لكنّ المستفاد من النووي وغيره هو الأوّل، فهو (ص) نهى عن الجمع للعلّتين المذكورتين.
أمّا الثانية فلا تتصوَّر في حقّ كثير من النساء المؤمنات فكيف بالزّهراء الطاهرة!.
وأما الأُولى فيردّها: أنّ صعود المنبر، والثناء على صهر آخر ثم القول بأنّه «إلاّ أن يريد ابن «أبي طالب أن يطلّق…»… ينافي كمال شفقته على عليّ وفاطمة… ولعلّ ما ذكرناه هو وجه الأقوال الأُخرى في المقام.
وقال ابن حجر بشرح البخاري: «إلاّ أن يريد ابن أبي طالب…»: «هذا محمول على أنّ بعض من يبغض عليّاً وشى به أنّه مصمّم على ذلك، وإلاّ فلا يظنّ به أنّه يستمرّ على الخطبة بعد أن استشار النبي (ص) فمنعه. وسياق سويد بن غفلة يدلّ على أنّ ذلك وقع قبل أنْ تعلم به فاطمة، فكأنّه لمَّا قيل لها ذلك وشكت إلى النبيَّ (ص) بعد أن أعلمه عليٌّ أنه ترك، أنكر عليه ذلك.
وزاد في رواية الزهري وأنّي لست أُحَرِّم حلالاً ولا أُحلِّل حراماً، ولكن ـ والله ـ لا تُجمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله عند رجلٍ أبداً. وفي رواية مسلم: مكاناً واحداً أبداً. وفي رواية شعيب: عند رجل واحدٍ أبداً.
قال ابن التين: أصحّ ما تحمل عليه هذه القصّة: أنّ النبي (ص) حرّم على عليّ أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل، لأنّه علّل بأنّ ذلك يؤذيه، وأذيّته حرام بالاتّفاق. ومعنى قوله: لا أُحرّم حلالاً، أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة. وأمّا الجمع بينهما الذي لا يستلزم تأذّي النبي (ص) لتأذّي فاطمة به فلا.
وزعم غيره: أنّ السياق يشعر بأنّ ذلك مباح لعليّ، لكنّه منعه النبي (ص) رعايةً لخاطر فاطمة، وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر النبي (ص).
والذي يظهر لي: أنّه لا يبعد أن يعدّ في خصائص النبي (ص) أن لا يُتَزَوَّج على بناته.
ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة (عليها السلام)([495]).
أقول: لا يخفى الاضطراب في كلماتهم… ولا يخفى ما في كلّ وجهٍ من هذه الوجوه…
ولو ذكرنا التناقضات الأخرى الموجودة بينهم لطال بنا المقام…
ومن طرائف الأُمور جعل البخاري كلام النبي خلعاً، ولذا ذكر الحديث في باب الشقاق من كتاب الطلاق…! لكنّ القوم لم يرتضوا ذلك فحاروا فيه:
قال العيني «قال ابن التين: ليس في الحديث دلالة على ما ترجم.
أراد: أنّه لا مطابقة بين الحديث والترجمة.
وعن المهلّب: حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي (ص): (فلا آذن) خلعاً.
ولا يقوى ذلك. لأنَّه قال في الخبر: (إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي) فدلّ على الطلاق. فإنْ أراد أنْ يستدلّ بالطلاق على الخلع فهو ضعيف…
وقيل: في بيان المطابقة بين الحديث والترجمة بقوله: يمكن أن تؤخذ من كونه (ص) أشار بقوله: (فلا آذن) إلى أنّ عليّاً (رضي الله عنه) يترك الخطبة. فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح.
وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله: أورد هذا الحديث هنا لأنّ فاطمة رضي الله تعالى عنها ما كانت ترضى بذلك، وكان الشقاق بينها وبين عليٍّ (رضي الله عنه) متوقَّعاً، فأراد (ص) دفع وقوعه.
وقيل: يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي الحديث، وهو: (إلاّ أن يريد عليّ أن يطلّق ابنتي) فيكون من باب الإشارة بالخلع.
وفيه تأمل»([496]).
وقال القسطلاني: «استشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة وأجاب في الكواكب فأجاد: بأنّ كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينها وبين عليّ متوقَّعاً، فأراد النبي (ص) دفع وقوعه بمنع عليٍّ من ذلك بطريق الإيماء والإشارة.
وقيل غير ذلك مِمَّا فيه تكلّف وتعسّف»([497]).
أقول: وهل ما ذكره الكرماني في الكواكب واستحسنه العيني والقسطلاني خالٍ من التكلّف والتعسّف؟!
إنّه يبتني على احتمالين، أحدهما: أن لا ترضى فاطمة بذلك. والثاني: أن ينجرّ ذلك إلى الشقاق بينهما…!!.
وهل كان منعه (ص) عليّاً من ذلك ـ دفعاً لوقوع الشقاق بطريق الإيماء والإشارة؟! أو كان بالخُطبة والتنقيص والغض والتهديد؟
نتيجة التأمّلات:
ونتيجة التأمّلات في ألفاظ هذا الحديث:
1 ـ إنّ قول المسور «وأنا محتلم» يورث الشكّ في سماعه الحديث من النبي (ص)، وكذا عدم المناسبة المعقولة بين طلبه للسيف من الإمام زين العابدين (ع) وإخباره بالقصّة، ثم إلحاحه في طلب السيف، لأنّ النبي (ص) قال: فاطمة بضعة مني…!
2 ـ إنّ ألفاظ الحديث مختلفة ومعانيها متفاوتة جدّاً، بحيث لم يتمكّن شرّاحه من بيان وجهٍ معقول للجمع بين تلك الألفاظ. ولمّا كانت الحال هذه والقصّة واحدة فلا محالة يقع الشكّ في أصل الحديث…
3 ـ إنّ مدلول الحديث لا يتناسب وشأن أمير المؤمنين والزهراء، وفوق ذلك لا يتناسب وشأن النبي صاحب الشريعة الغرّاء. وحتى لو فعل عليٌّ ما لا يجوز.. لما ثبت من أنّه:
«كان إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول ولكن يقول: ما بال أقوامٍ يقولون: كذا وكذا».
و: «كان رسول الله (ص) قلّ ما يواجه رجلاً في وجه شيء يكرهه».
وقال: «من رأى عورةً فسترها كان كمن أحيا موؤُدة»([498]).
وقد التفت ابن حجر إلى هذه الناحية حيث قال: «وكان النبي (ص) قلّ أن يواجه أحداً بما يعاب به» ثم اعتذر قائلاً «ولعلّه إنّما جهر بمعاتبه عليٍّ مبالغةً في رضا فاطمة (عليها السلام)…»([499]).
لكنّه كما ترى، أمّا أولاً: فلم يرتكب عليٌّ عيباً، وأمّا ثانياً: فإنّ الذي صدر من النبي ما كان معاتبةً. وأمّا ثالثاً: فإنّ المبالغة في رضا فاطمة (عليها السلام) إنّما تحسن ما لم تستلزم هتكاً لمؤمن فكيف بعليّ، وليس دونها عنده إنْ لم يكن أعزّ وأحبّ.
4 ـ وتكذّبه أيضاً سيرة الإمام عليٌّ (ع) وأحواله مع أخيه المصطفى منذ نعومة أظفاره حتى آخر لحظة من حياة النبي الكريمة، فلم يُرَ منه شيء يخالف الرسول أو يكره.
تنبيهان:
1 ـ لقد كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها بضعة النبي (ص) حقّاً، ولقد كرّر النبيّ (ص) قوله: فاطمة بضعة منّي…» غير مرّة، تأكيداً على تحريم أذاها، وأنّ سخطها وغضبها سخطه وغضبه، وسخطه سخط الله وغضبه… وبألفاظ مختلفة متقاربة في المعنى.
وقد روى عنه (ص) هذا الحديث غير واحدٍ من الصحابة، منهم أمير المؤمنين (ع) نفسه… قال ابن حجر: «وعن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليٍّ، قال: قال رسول الله (ص) لفاطمة: إنّ الله تعالى يرضى لرضاك ويغضب لغضبك»([500]).
قال: «وأخرج ابن أبي عاصم، عن عبدالله بن عمرو بن سالم المفلوج، بسندٍ من أهل البيت عن عليٍّ أنّ النبي (ص) قال لفاطمة: إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»([501]).
ولسنا ـ الآن ـ بصدد قول النبي (ص) ذلك في مناسباتٍ متعدّدة… فذاك أمر معلوم..
كما أنّ ترتيب المسلمين الأثرَ الفقهي عليه منذ عهد الصحابة وإعطائهم فاطمة ما كان للنبي من حكمٍ، معلوم.
فالسهيلي الحافظ حكم بكفر من سبّها وأنّ من صلّى عليها فقد صلّى على أبيها، وكذا الحافظ البيهقي، وقال شرّاح الصحيحين بدلالته على حرمة أذاها([502]) وقال الزرقاني المالكي: «إنّها تغضب على من سبّها، وقد سوّى بين غضبها وغضبه، ومن أغضبه كفر»([503]) وقال المناوي: استدلّ به السهيلي على أنّ من سبّها كفر، لأنّه يغضبه، قال الشريف السمهودي: ومعلوم أنّ أولادها بضعة منها فيكونوا بواسطتها بضعة منه…»([504]).
ومن قبلهم أبو لبابة الأنصاري نزّلها منزلة النبي بأمر من النبي… قال الحافظ السهيلي: «إن أبا لبابة رفاعة بن المنذر ربط نفسه في توبةٍ وإنّ فاطمة أرادت حلّه حين نزلت توبته، فقال: قد أقسمت ألاّ يحلّني إلاّ رسول الله (ص). فقال رسول الله (ص): إنّ فاطمة بضعة منّي فصلّى الله عليه وعلى فاطمة. فهذا حديث يدلّ على أنّ من سبّها فقد كفر، ومن صلّى عليها فقد صلّى على أبيها».
ليس المقصود ذلك.
بل المقصود هو أنّ هذا الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما عن «المسور بن مخرمة» ـ في باب فضائل فاطمة ـ مجرّداً عن قصّة خطبة عليٍّ ابنة أبي جهل، قال ابن حجر: «وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة: سمعت رسول الله (ص) على المنبر يقول: فاطمة بضعة منّي، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما رابها»([505]) روياه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة.
بل لم ينجده عند البيهقي والخطيب التبريزي إلاّ مجرّداً كذلك([506])، وكذا الجامع الصغير، حيث لا تعرّض للقصّة لا في المتن ولا في الشرح([507]).
والملاحظ أنّه لا يوجد في هذا السند المجرَّد واحد من ابني الزبير والزهري والشعبي والليث… وأمثالهم…
ونحن نحتجّ بهذا الحديث.. كسائر الأحاديث… وإنْ جرحنا «المسور» و«ابن أبي مليكة» لأنّ «الفضل ما شهدت به الأعداء».
لكن أغلب الظنّ أنّ القوم وضعوا قصّة الخطبة، وألصقوها بالمسور وروايته… لغرضٍ في نفوسهم، ومرضٍ في قلوبهم… حتى جاء ابن تيميّة المجدِّد الآثار الخوارج، والمشيِّد للأباطيل على موضعاتهم ليقول:
«إنّ هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ بل روي بغيره، كما ذكر في حديث خطبة عليّ لابنة أبي جهل لمّا قام النبي (ص) خطيباً، فقال: إنّ بني هشام بن المغيرة… رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية عليّ بن الحسين والمسور بن مخرمة، فسبب الحديث خطبة عليّ لابنة أبي جهل([508])…
لكنّ الحقيقة لا تنطلي على أهلها، والله الموفّق.
2 ـ قد أشرنا في مقدّمة البحث أنّ وجود الحديث ـ أيّ حديث كان ـ في كتابي البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعروفة بالصحاح لا يلزمنا القول بصحّته، ولا يغنينا عن النظر في سنده، فلا يغرّنّك إخراجهم الحديث في تلك الكتب، ولا يهولنّك الحكم ببطلان حديث مخرّج فيها.. وهذا ممّا تنبّه إليه المحقّقون من أهل السُنّة وبحث عنه غير واحدٍ من علماء الحديث والكُتّاب المعاصرين… ولنا في هذا الموضوع بحث مشبع نشرناه في العدد (14) من هذه النشرة، وصدر من بعد ضمن كتابنا «التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف» أيضاً.
تتمّة:
وكأنّ القوم لم يكفهم وضع حديث خطبة ابنة أبي جهلٍ، فوضعوا حديثاً آخر، فيه أنّ أمير المؤمنين (ع) خطب أسماء بنت عميس!.. لكنّه واضح العوار جدّاً، لذا لم يخرجه أصحاب صحاحهم، بل نصَّ المحقِّقون منهم على سقوطه:
قال ابن حجر: «أسماء بنت عميس قالت: خطبني عليٌّ بن أبي طالب، فبلغ ذلك فاطمة، فأتت النبي (ص) فقالت: إنّ أسماء متزوِّجةً عليّاً! فقال لها: ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله».
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط.
وفيهما من لم أعرفه».
ونحن لا نتكلّم على هذا الموضوع الآخر سوى أنْ نشير إلى أنّ واضعه قال: «فأتت النبي فقالت: إنّ أسماء متزوّجة عليّاً» وليس: «هذا عليٌّ ناكح ابنة أبي جهل». وقال عن النبي أنّه قال لفاطمة: «ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله» ولم يقل عنه أنّه صعد المنبر وخطب وقال: «ما كان له…»!!
كلمة الختام
قد استعرضنا ـ بعون الله تعالى ـ جمع طرق هذا الحديث، ودقّقنا النظر في رجاله وأسانيده، وفي ألفاظه ومداليله.. فوجدناه حديثاً مختلقاً من قبل آل الزبير، فإنّ رواته:
«عبدالله بن الزبير».
و«عروة بن الزبير».
و«المسور بن مخرمة» وكان من أعوان «عبدالله» وأنصاره والمقتولين معه في الكعبة، وكان من الخوارج، وكان…
و«عبدالله بن أبي مليكة» وهو قاضي الزبير ومؤذِّنه.
و«الزهري» وهو الذي كان يجلس مع «عروة بن الزبير وينالان من أمير المؤمنين (ع)… وكان…
و«شعيب بن راشد» وهو راوية «الزهري».
و«أبو اليمان» وهو راوية شعيب…
هؤلاء رؤوس الواضعين لهذه الأُكذوبة البيّنة… وقد عرفتهم واحداً واحداً…
وكلّ هؤلاء على مذهب إمامهم «عبدالله بن الزبير» الذي اشتهر بعدائه لأهل البيت (عليهم السلام)، وتلك أخباره في واقعة الجمل وغيرها، ثم حصره بني هاشم في الشِّعْب بمكّة فإمّا البيعة له وإمّا القتل، ثم إخراجه محمد بن الحنفية من مكّة والمدينة وابن عبّاس إلى الطائف.. وعدائه للنبي الأكرم (ص) نفسه.. حتى قطع ذِكْرَه (ص) جُمعاً كثيرة، فاستعظم الناس ذلك، فقال: إنّي لا أرغب عن ذكره، ولكن له أُهيل سوء، إذا ذكرتُه أتلعوا أعناقهم، فأنا أُحبّ أنْ أكبتهم!! مذكورة في التاريخ.
وقد قال أمير المؤمنين (ع) كلمته القصيرة المعروفة: «ما زال الزبير رجلاً منّا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم عبدالله».
فليهذّب السّنّة الشريفة حماتُها الغيارى من هذه الافتراءات القبيحة، والله أسأل أنْ يوفّق المخلصين للعلم والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم، إنّه هو البَرّ الرحيم.
علي الحسيني الميلاني
فاطمة العالمة المعلمة
ما وصلنا من أخبار فاطمة يصورها لنا بصورة المعلمة الأولى للمسلمات اللواتي كن يقبلن على بيتها مستفهمات متعلمات، فتفيض عليهن فاطمة بما وعته من علم وتثقفهن بثقافة العصر وتشجعهن على طلب العلم والمعرفة. وهكذا كان بيتها المدرسة الأولى في الإسلام للمرأة. ورغماً عن فقدان التدوين في عصرها مما حرمنا من أكثر أخبارها فلم يصلنا منها إلا القليل. ورغماً عن قصر حياتها إذ أنها ماتت في عنفوان الشباب. رغماً عن كل ذلك فإن ما بين أيدينا من المصادر التاريخية يمكن أن يعطينا ملامح عن انصرافها لتثقيف الجماهير الإسلامية أفراداً وجماعات، فما ورد في خطبتها من دعوة إلى مقاومة الظلم والاستبداد وحض على التمسك بما نسميه في عصرنا الحاضر بالدستور والقوانين، وما أورده المؤرخون من أخبارها مما سنراه هنا من رحابة صدرها في تثقيفها للراغبين، وإقبال النساء عليها طالبات للعلم، كل هذا يرينا بعض حقائق فاطمة العالمة المعلمة. ولم يقتصر تثقيفها على النساء بل كان الرجال يقصدونها كذلك مستفيدين. ومن أمثلة ذلك أن ابن مسعود جاءها يوماً فقال يا ابنة رسول الله هل ترك رسول الله عندك شيئاً نتعلمه، فقالت فاطمة: يا جارية هاتي تلك الأوراق، فطلبتها فلم تجدها فقالت فاطمة: ويحك اطلبيها فإنها تعدل عندي حسناً وحسيناً «إلى آخر الخبر»([509]).
ومن ذلك أن امرأة جاءت تسأل فاطمة مسائل علمية فأجابتها فاطمة عن سؤالها الأول، وطلبت المرأة تسألها حتى بلغت أسئلتها العشرة، ثم خجلت من الكثرة، فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله، فقالت فاطمة: هاتي وسلي عما بدا لك، إني سمعت أبي يقول: إن علماء أمتنا يحشرون فيخلع عليهم من الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله([510]).
وفاة الزهراء
توفيت في الثالث من جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة من الهجرة وهو المروي عن الصادق (ع) وروي: أنها توفيت لعشر بقين من جمادى الآخرة. وقيل: لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر ليلة الأحد. وعن ابن عباس: في الحادي والعشرين من رجب وقال المدائني، والواقدي، وابن عبد البر في الاستيعاب: توفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان. وروى الحاكم في المستدرك: أنها توفيت لثلاث خلون من رمضان.
واختلف في مدة بقائها بعد أبيها (ص) فقيل: أربعون يوماً ويمكن كونه اشتباهاً بمدة مرضها. وقيل: خمسة وأربعون يوماً. وقيل: شهران رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن عائشة عن جابر. وقيل: سبعون يوماً حكاه ابن عبد البر في الاستيعاب. وقيل: خمسة وثمانون. وقيل: ثلاثة أشهر وهو الذي اعتمده أبو الفرج الأصبهاني. ورواه مسنداً عن الباقر (ع) وعزاه في الاستيعاب: إلى إحدى الروايتين عن الباقر (ع) وقال الحاكم في المستدرك: أنه روي عن أبي جعفر محمد بن علي وهو الذي يقتضيه الجمع بين ما روي عن الباقر أن بدء مرضها بعد خمسين ليلة من وفاة النبي (ص) وما يفهم من بعض الأخبار أنها بقيت مريضة أربعين يوماً. وقيل: خمسة وتسعون يوماً وهو الذي اعتمده الدولابي في الذرية الطاهرة؛ ويقتضيه الجمع بين ما هو المشهور من أن وفاته (ص) في الثامن والعشرين من صفر ووفاتها في الثالث من جمادى الآخرة. وقيل: مائة يوم حكاه ابن عبد البر في الاستيعاب، وهو الذي اعتمده الشهيد في الدروس. أو نحو من مائة يوم أو أربعة أشهر. أو: ستة أشهر رواه الحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية بسنديهما عن عائشة. وفي الاستيعاب: توفيت بعد رسول الله بيسير قال محمد بن علي أبو جعفر: بستة أشهر إلا ليلتين حكاه ابن عبدالبر في الاستيعاب وقيل: ثمانية أشهر حكاه ابن عبد البر عن عمرو بن دينار ورواه الحاكم في المستدرك عن عبدالله بن الحارث. ويدل كلام الاستيعاب ومقاتل الطالبيين: على أنه لم يقل أحد بأكثر من ثمانية أشهر ولا بأقل من أربعين يوماً والمروي صحيحاً من طرق أهل البيت (عليهم السلام): أنها بقيت بعده (ص) خمسة وسبعين يوماً، وتدل عليه أكثر الروايات ويشكل الجمع بين ذلك وبين المشهور عند أصحابنا من أن وفاة النبي (ص) في الثامن والعشرين من صفر؛ إذ تكون وفاتها على هذا في الثالث عشر من جمادى الآخرة فالجمع بين المشهور في وفاة النبي والمشهور في وفاتها ومدلول الرواية الصحيحة غير ممكن، ولا يبعد أن يكون الصواب خمسة وتسعين يوماً فصحف تسعين بسبعين لتقارب حروفهما فيرتفع التنافي وهي يومان من صفر وثلاثة من جمادى الآخرة فهذه خمسة والربيعان وجمادى الأولى تسعون يوماً فهذه خمسة وتسعون يوماً وربما يعضده رواية الثلاثة الأشهر فإن الخمسة الأيام يتسامح فيها([511]).
وأما مدة مرضها فقال ابن شهرآشوب في المناقب: روي أنها ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس (إلى أن قال) ثم مرضت ومكثت أربعين ليلة ثم قضت نحبها وظاهره أنها مكثت أربعين ليلة مريضة لا أنها مكثت بعد أبيها أربعين ليلة. وعن الباقر (ع): أنها مكثت في مرضها خمسة عشر يوماً وتوفيت.
وكان عمرها عند وفاتها ثماني عشرة سنة وقيل: ثماني عشرة سنة وشهرين وقيل: وسبعة أشهر هذا على القول بأنها ولدت بعد المبعث بخمس سنين وعلى القول بأنها ولدت بعده بسنتين يكون عمرها إحدى وعشرين سنة وهو الذي رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن أم الحسن بنت أبي جعفر محمد بن علي عن أخيها جعفر بن محمد قال: ماتت فاطمة وهي ابنة إحدى وعشرين ولدت على رأس إحدى وأربعين من مولد النبي. وعلى قول الاستيعاب في مولدها: أنه بعد البعثة بسنة يكون عمرها اثنتي وعشرين سنة وعلى القول: بأنها ولدت قبل المبعث بخمس سنين يكون عمرها ثماني وعشرين سنة وعن المدائني: ماتت ولها تسع وعشرون سنة وعن الزبير بن بكار عن عبدالله بن الحسن ثلاثون سنة وكل ذلك ناشىء عن الخلاف في تاريخ مولدها، كما أن الاختلاف في تاريخ وفاتها وسنها يوم تزويجها الظاهر أنه ناشىء عن ذلك والله أعلم([512]).
ولم يحضر دفنها والصلاة عليها إلا علي والحسنان (عليهم السلام) وعمار والمقداد وعقيل والزبير وأبو ذر وسلمان وبرير ونفر من بني هاشم وخواص علي (ع) واختلف في موضع دفنها فقيل: دفنت في بيتها وهو الأصح الذي يقتضيه الاعتبار. وقيل: دفنت في البقيع وعن الطبري في (دلائل الإمامة)، عن محمد بن همام: أن المسلمين لما علموا وفاتها جاؤوا إلى البقيع فأشكل عليهم موضع قبرها من سائر القبور فضج الناس ولام بعضهم بعضاً وقالوا: لم يخلف نبيكم فيكم إلا بنتاً واحدة تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة عليها ولا تعرفوا قبرها.
مدائحها
مدحت فاطمة ورثيت بشعر كثير قديماً وحديثاً. فمن الشعر الحديث هذه القصيدة للسيد عبداللطيف فضل الله:
| هتف البيان بمولد الزهراء | سر الوجود وشمس كل سماء | |
| ومضى على الجوزاء يسحب ذيله | مترنحاً من نشوة الخيلاء | |
| ورد البحار الهوج يسبر غورها | ويعب منها قطرة من ماء | |
| فرأى الجلال على تواضع قدسه | تنحط عنه مدارك العقلاء | |
| شمخ الأديم بفاطم وتطاولت | غبراؤه فيها على الخضراء | |
| فتجسمت في الأرض منه رحمة | وشفاعة للناس يوم جزاء | |
| صديقة ما كان لولا حيدر | يلفى لها أحد من الأكفاء | |
| عبرت كهينمة النسيم وواجهت | كدر الحياة وأهلها بصفاء | |
| لم يكشف الناس البلاء ولا ارتووا | إلا بطلعة وجهها الوضاء | |
| يا أخت نساك الملائك بالهدى | وذبالة الأنوار من سيناء | |
| يا لمحة الفردوس حط بطهرها | خلد البقاء على صعيد فناء | |
| يا صفحة بيضاء من انكارها | آب الورى بصحيفة سوداء | |
| يا غيب سر لو أخذت ببعضه | طرفاً من الأعجاز والألجاء | |
| لمشيت فيه على الهواء إذا ابتدى | عيسى يسير على نمير الماء | |
| والاك ربك إذ رضعت ولاءه | وحباك منه ولاية الأشياء | |
| فإذا دعوت فأنت في سلطانه | كالروح حين تهيب بالأعضاء | |
| إن الذي مسخ الأمانة وانطلى | بدماء من ضحى من الشهداء | |
| وطوى عداوة آل بيت محمد | نار ذكت بجوانح البغضاء | |
| فأحالها لله حرباً طوحت | بابن النبي موزع الأشلاء | |
| ثقلت على الأكوان وطأة رجسه | فيها فدارت دورة الأعياء | |
| وحدت به للحشر لعنة ربه | تسري مع الأصباح والأمساء | |
| يا يوم أحمد هل لخطبك أذهوت | فيه الأنام بفتنة عمياء | |
| قلب الوجود وأصبحت أبناؤه | مقلوبة الإحساس والآراء | |
| فاعتاض عن فوق رواسب تحته | وعن الإمام لأهله بوراء | |
| كم في فؤادك فاطم من غصة | توهي فؤاد الصخرة الصماء | |
| أبهذه الدنيا عزاء قائم | وبدار ربك في أمض عزاء | |
| الصبر ضاق لما صبرت على الأذى | وسخيت للأعداء أي سخاء | |
| قدمت من حَسَن ضحية سمهم | ومن الحسين السبط كبش فداء | |
| ومن الوصي على الرسالة خائضاً | من حربهم قدماً ببحر دماء | |
| طفروا إلى الملك العضوض وغلفوا | وجه النهار بليلة ظلماء | |
| ولدوا من الداء العضال فلم يكن | إلا زوالهم شفاء الداء | |
| نظروا المودة في الكتاب فلم يروا | غير السيوف مودة الأبناء | |
| من صفوة طاف الهدى بفنائها | متمسكاً بالكعبة الغراء | |
| جبلت بأسرار السما وتكونت | بما بساق العرش من لألآء | |
| غراء من صلب النبوة والهدى | طلعت على الدنيا طلوع ذكاء | |
| هي صوت ناقوس السماء ولا ترى | في الأرض غير تجاوب الأصداء | |
| وفيوض الطاف سحابة صيفها | وطفاء مغدقة على الأحياء | |
| وسفينة الطوفان ليس بخائب | من بات مشدوداً لها بولاء | |
| آلاؤها ملء الزمان وبيتها | في الكائنات أساس كل بناء | |
| وكأنما كانت لهيكل كونها | قلب الحنان به وعين رجاء | |
| حوراء إذ رفع الإله لواءها | كرماً وضم الخلق تحت لواء | |
| وبرى مناقبها وقال لغرها | كوني بلا عد ولا إحصاء | |
| قلنا لها سر يصان وجوهر | فوق الأنام وطينهم والماء | |
| وربما ولد التراب بمهده | من كان في الملكوت رمز علاء | |
| ولدت لطهر محمد فكأنها | آي الكتاب بمهبط الإيحاء | |
| وكأن ما فيها حقيقة ذاته | غير النبوة أفرغت بوعاء | |
| فإذا الهدى من كل أفق مشرق | والكون أضواء على أضواء | |
| شرفت فحك العرش منكب عزها | كرماً وداست منكب الجوزاء | |
| بأب بلا ند تراه ولم يجد | أحداً يطاولها من الأبناء | |
| علوية النفحات من أنوارها | بيت النبوة مشرق الأنحاء | |
| حرم يطوف به ويخدم أهله | الروح الأمين منبىء الأنباء | |
| نشأت بظل الله لم يعلق بها | دنس ولا وقعت على الأخطاء | |
| حتى إذا طمس الهدى وتبرمت | من حمأة طبعت على الأسواء | |
| رفعت إليه دعاءها فكأنما | ركب البراق بليلة الإسراء |
وقال السيد محمد جواد فضل الله في مدح الزهراء:
| في الذرى أنت إذ يرف العيد | مطلع مشرق ولحن فريد | |
| ومعان من طهر ذاتك يستلهم | من وجهها الجمال القصيد | |
| هي دنياك مشرق للقداسا | ت تلاشت على ذراه الحدود | |
| مجدك الشمس ينطفي إن تبدت | كل نجم من حولها ويبيد | |
| النبوات دوحة أنت منها | ألق مشرق ونفح ودود | |
| كيف يرقى لشأو عزك مجد | وبك المجد تاجه معقود | |
| نفحة من مجهر صاغها الله | مثالاً للطهر كيف يريد | |
| وحباها منه الجلال إهاباً | يتدانى عن نعته التمجيد | |
| يا ابنة الطهر يا حكاية تاريخ | أفاضت عنها الحديث العهود | |
| وتلاحى بها الرواة فسار | بهدى الحق شوطه وحقود | |
| ومن الزيف أن يحرر تاريخ | غريب عن الهدى وصدود | |
| كيف يسمو إلى الحقيقة فكر | لعبت فيه في الصراع الحقود | |
| يتمادى فيمسخ الحق بالوهم | ضلالاً والحق صلد عنيد | |
| لن يضير الضحى إذا نعق إلا | صباح أعشى إلى الدجى مشدود | |
| يا لذلك التاريخ أن يجحف الحق | ظلوم ويستبد مريد | |
| حسب دنيا الزهراء أن أباها | أحمد وهي سره المحمود | |
| حسبها أن تكون كفو علي | وهي لولاه كفوها مفقود | |
| رفع الله شأنها فتباهت | باسمها في الجنان حور وغيد | |
| ورثت طهر أحمد وهداه | فهي من روحه امتداد حميد | |
| فلذة منه أودع الله فيها | كل ما فيه فهي منه وجود | |
| يا ابنة الطهر.. يا جهاداً مريراً | خذلته مطامع وقصود | |
| إن حقاً أضيع في غمرة الفتنة | ما ضاع لو رعته الشهود | |
| حدث كان للسياسة فيه | دورها لو وعى الأمين الرشيد | |
| سل بطون التاريخ عن هزة | المأساة ينبيك حقها المنشود | |
| فلتات كانت وكان حديث | موجع يلهب الأسى ويزيد | |
| أي فتح غنمتموه فهذي فد | ك فاهنأوا بها واستزيدوا | |
| واستدارت أم الحسين وقد | جف وريق من حلمها منكود | |
| يُتلظى بها الحنين إلى الأمس | فأين الحاني وأين العميد | |
| قلبت صفحة المروءات وامتد | أصيل على المدى مرصود | |
| سلب الليث فاستبيح عرين | وانطوى مرتع له معدود | |
| كيف تقلى طليعة الفتح يا ذل | البطولات كيف تمحى العهود | |
| يأنف الصيد من متاهة درب | للسرى فيه ضيعة وشرود | |
| عثر الشوط بالكمي فلا الشوط | حميد ولا السرى محمود | |
| وتلاقت بالمرزحات صروف | كبرت عتمة بها ورعود | |
| يا ابنة الطهر إن يكن وهج المأ | ساة أعياك والنصير قصيد | |
| وأذاب الشباب من عودك الغض | صراع مر وخطب شديد | |
| فضمير التاريخ حر وإن لوّ | ح بالريب شانىء وعنود | |
| باسمك الفذ يهتف الحق في الأ | جيال وليلعق السراب حسود | |
| كيف يخفى الضحى على قمم المجد | فلن يربك الرؤى ترديد | |
| إن بيتاً حواك عرش من المجد | رفيع به الهدى مشدود | |
| حرم تعلق الملائك.. فيه | فنزول في رحبه وصعود |
وقال الشاعر العراقي محمد سعيد الشويلي وهو ممن شردهم الطغيان الصدامي عن العراق:
| أعيدي نثار النجم وامتشقي البحرا | ورُشي على أزهارنا الألق العطرا | |
| ليصهل فينا ألف جرح، نزيفُهُ | على فدكٍ، في نشوة الملتقى أسرى | |
| وترجع أحلام (الفعيلة) نُكّصاً | حوافرها، والبيد مكتظّةٌ جمرا | |
| إلى أين؟ فالأجفان شبَّ احتراقها | و(أمّ أبيها) قد توسدت الصحرا | |
| ومن بيت أحزانٍ تبثّ دموعها | إلى شرفة العلياء تحتضن الكبرا | |
| وتعلن أنَّ الوجد خيلٌ عصيّةٌ | وأن دموع البحر تستنزل القطرا | |
| حنانيك يا زهراء، طيراً بعثتِهِ | بأرواحنا عُذناهُ فاكتشف الفجرا | |
| وإنّ الأُلى طافت عليهم قصائدٌ | بوهج الضحى ماتوا وما شرحوا الصدرا | |
| زمانٌ لدى جفنيه خبّأتِ جمرةً | ليطلع جيلُ الله من دمها ذُخرا |
* * *
| وكم جهدت أن تطفىء الريحُ حولها | مواسم في أحداق عشّاقها خُضرا | |
| فشبّت على الدنيا ربيعاً ولوّحت | إلى كلّ شمس أن قفي وامطري الشعرا | |
| ومن كلّ جرحٍ يعتلي الأفق منبراً | نبيٌّ على أوجاعها ينثر الزهرا | |
| تبلّل أهداب السماء دموعها | فتورق وعياً مخصباً يعشب القفرا | |
| تخطي إلى شلو الضحايا وأذّني | بها تستفق فالذلُّ في جفنها استشرى | |
| فأنت جراحات الضياء قوافلا | يخطو جسورٍ يمتطي ليلها جسرا | |
| مآذن ضجَّ الوحي في شُرُفاتها | فحطّمت الأغلال من أمّةٍ أسرى | |
| وأنت حروفٌ تستبيح ضمائراً | لتعتقها أن تستكين وتغترّا | |
| وترشقهم بالنور علّ وجوههم | تجوع إلى طعم المروءات أو تعرى | |
| توجُّسكِ تاريخُ جيل مصلّبٍ | فكان احتراق الورد عن موته زجراً |
* * *
| أزهراء عذراً إن تمشّت قصائدي | إلى واحتَي عينيك محمومةً عبرى | |
| فإن أزيز الجمر بين ضلوعنا | وقد لوّح الترحال أوجهنا السُمرا | |
| أفيضي علينا من رؤىَ نبويّةٍ | لنغسل أحداق المدى ـ وابلاً غمرا | |
| فمذ كنت في (طه) تصلين نبضةً | بقلب (حراءٍ) عند شريانه سرّا | |
| وأنت امتداد الظلّ خلف وجوده | يحنّ إلى مرأى شواطئِهِ الخضرا | |
| تصلّي لعينيك الجبال تضرّعاً | فما فدك إلا لسجدتها شذرا | |
| فما الأرضون السبع غازل قلبها | ولا عشقت فيها بساتين أو نهرا | |
| لقد ظلّلتها خفقة الوحي فانزوت | تدير الرحى والطهرُ يعتنق النجرا | |
| ولكنّه رفضٌ تصعّد في المدى | ليسكب في لُقيا قوافلنا البحرا | |
| فكان خطاباً حطّم الصخر وارتقى | ليستنزل النجم المعاند في المسرى | |
| يصول على أكتافه ألف فاتح | فيعبر في الطوفان للضفة الأُخرى | |
| وسوف يشبّ الغرس يرتضع الأبا | ويقرأ في أوجاع مهجتها سِفرا | |
| سيعقد عند الشمس شوط ملاحمٍ | ودمعتها المعطاء تلهمه الصبرا |
* * *
| أفيضي علينا يا شعاع صحائفٍ | رؤى وطن، قد ذبّحوا الوطن البكرا | |
| وشدّت على أهدابنا ألف محنةٍ | لينثرنا دولابها في المدى نثرا | |
| تطاردنا الأسياف قتلاً مبرمجاً | على لغة الحاسوب تشبعنا نحرا | |
| فمن عفن بين الطوامير للأسى | ومن وحشة المنفى وأنتِ به أدرى | |
| إلى الموت، والحكّام بلّلها الندى | فباست يد الشيطان وانتفخت شُكرا | |
| فعادت كروش النفط زهواً أبيّة | فأطلقتِ في الإعصار أنجمها الزُهرا | |
| فنجمٌ بقلب الموت أشعل صحوةً | ونجمٌ بقصر الشاه أذّنه فجرا | |
| وقاما برغم العاصفات وأطلعا | جبين الهدى نديان في دمه نضرا | |
| ولكنَّ موج البحر يعشب أرضه | وتبقى قلوب الصخر محشوّةٌ صخرا |
* * *
الحسن بن علي بن أَبي طالب (ع)
أمه
أمه فاطمة بنت رسول الله.
مولده
ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث، أَو اثنتين من الهجرة وهو أول أولاد علي وفاطمة (عليهما السلام). لما ولد الحسن قالت فاطمة لعلي: سمِّه. فقال: ما كنت لأسبق باسمه رسول الله (ص) فجاء النبي (ص) فأخرج إليه فسماه حسن ولم يكن يعرف هذا الاسم في الجاهلية.
أولاده
كان له خمسة عشر ولداً ما بين ذكر وأنثى وهم: زيد، أم الحسن، أم الحسين، الحسن، عمر، القاسم، عبد الله، عبد الرَّحمن، الحسين الملقب بالأثرم، طلحة، فاطمة، أم عبدالله، فاطمة، أم سلمة، رقية، ولم يعقب منهم غير الحسن وزيد.
شدة حب النبي (ص) للحسن والحسين
قال المفيد في الإرشاد: كانا حبيبَي رسول الله (ص) بين جميع أهله (وروى) الترمذي في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك: سئل رسول الله (ص): أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين وكان يقول لفاطمة: ادعي لي ابني فيشمهما ويضمهما إليه.
(وروى) النسائي في الخصائص: عن النبي (ص) أنه قال في الحسن والحسين (عليهما السلام): هذان إبناي وابنا ابنتي اللهم إنك تعلم إني أحبهما فأحبهما (ورواه) في (أسد الغابة) بسنده عن النبي (ص) مثله. وفي الاستيعاب: روي عن النبي أنه قال في الحسن والحسين: اللَّهم إني أحبهما وأحب من يحبهما. (وروى) أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت عن زيد بن أرقم: كنت عند النبي (ص) في مسجده فمرَّت فاطمة خارجة من بيتها إلى حجرة رسول الله (ص) ومعها الحسن والحسين ثم تبعها علي (ع) فرفع رسول الله (ص) رأسه إلي فقال: «من أحب هؤلاء فقد أحبني ومن أبغض هؤلاء فقد أبغضني».
وعن زيد بن أرقم أن النبي (ص) قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: «أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم».
وفي تذكرة الخواص روى أحمد بن حنيل، عن البراء بن عازب: رأيت رسول الله (ص) واضعاً الحسن على عاتقه وهو يقول: «اللَّهم أني أحبه فأحبه». ورواه أبو نعيم في الحلية بسنده عن البراء إلاَّ أنه قال: «من أحبني فليحبه». وروى أحمد بن حنبل بسنده عن أبي هريرة في حديث: فجاء النبي (ص) فجلس بفناء بيت فاطمة (عليها السلام). إلى أن قال: فجاء الحسن يشتد حتى عانقه وقبَّله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. وعن كتاب بشارة المصطفى عن يعلى بن مرة قال: خرجنا مع النبي (ص) وقد دعي إلى طعام فإذا الحسن (ع) يلعب في الطريق فأسرع النبي (ص) أمام القوم ثم بسط يده فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه فجعل يديه في رقبته والأخرى على رأسه ثم اعتنقه فقبَّله ثم قال: حسن مني وأنا منه أحب الله من أحبه.
تواضعه
حكى ابن شهرآشوب في المناقب، عن كتاب الفنون، وكتاب نزهة الأبصار: أن الحسن (ع) مر على فقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها فقالوا له: هلم يا ابن بنت رسول الله إلى الغداء فنزل وقال: فإن الله لا يحب المتكبرين وجعل يأكل معهم ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وكساهم.
إرسال علي ابنه الحسن (ع)
إلى الكوفة قبل حرب الجمل
لما خرج علي إلى العراق في أثر أصحاب الجمل ووصل إلى الربذة بعث عبدالله بن عباس ومحمَّد بن أبي بكر إلى أبي موسى الأشعري إلى الكوفة لما بلغه أن أبا موسى يخذل أهلها عن اللحاق به وكان والياً عليها من قبل عثمان فأقره علي فأبطأ عليه الرجلان قال أبو مخنف: فلما أبطأ ابن عبَّاس وابن أبي بكر عن علي ولم يدر ما صنعا. رحل عن الربذة إلى ذي قار فنزلها وبعث إلى الكوفة الحسن ابنه وعمَّار بن ياسر وزيد بن صوحان وقيس بن سعد بن عبادة ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة فأقبلوا حتى كانوا بالقادسية فتلقاهم الناس، فلما دخلوا الكوفة قرأوا كتاب علي (ع).
في الكوفة
قال أبو مخنف: لما دخل الحسن وعمار الكوفة اجتمع إليهما الناس، فقام الحسن فاستنفر الناس وخطب فيهم يدعوم إلى نصرة أبيه.
قال أبو مخنف: ولما فرغ الحسن بن علي من خطبته قام بعده عمار فخطب خطبة حث فيها الناس على الخروج إلى علي (ع)، فلما سمع أبو موسى خطبة الحسن وعمار قام فصعد المنبر وخطب خطبة طويلة خذل فيها الناس عن علي وبالغ في ذلك فرد عليه عمار ثم جذبه فنزل عن المنبر (ا.هـ). وقال الطبري في تاريخه: أن علياً (ع) أرسل ابن عبَّاس من ذي قار إلى الكوفة فلقي أبا موسى واجتمع الرؤساء فخطبهم أبو موسى فخذلهم، فرجع ابن عبَّاس إلى علي (ع) فأخبره فدعا الحسن ابنه وعمار بن ياسر وأرسلهما إلى الكوفة، فلما قدماها خرج أبو موسى فلقي الحسن (ع) فضمه إليه وقال لعمَّار: يا أبا اليقظان أعدوت فيمن عدا على عثمان وأحللت نفسك مع الفجار؟ قال: لم أفعل ولم يسؤني فقطع عليهما الحسن الكلام وقال: يا أبا موسى لم تثبِّط الناس عنا؟ فوالله ما أردنا إلاَّ الإصلاح، وما مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء. قال أبو موسى: صدقت بأبي وأمي؛ ولكن المستشار مؤتمن. فغضب عمار ورد عليه. فقام رجل من بني تميم ورد على عمار، وثار زيد بن صوحان وطبقته فانتصروا لعمَّار وصعد أبو موسى المنبر، فقام شبث بن ربعي ورد على زيد، وقام الحسن بن علي فقال: أيها الناس أجيبوا دعوة إمامكم وسيروا إلى إخوانكم؛ فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينصره، والله لأن يليه أولو النهي أمثل في العاجلة وخير في العاقبة، فأجيبوا دعوتنا، وأعينونا على أمرنا أصلحكم الله.
وأتت الأخبار علياً (ع) باختلاف الناس بالكوفة فقال للأشتر: أنت شفعت في أبي موسى أن أقره على الكوفة فاذهب فاصلح ما أفسدت. فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة ووصل القصر فاقتحمه وأبو موسى يخطب الناس على المنبر ويثبطهم وعمار يخاطبه والحسن يقول له: اعتزل عملنا وتنح عن منبرنا لا أم لك؛ إذ دخل غلمان أبي موسى يقولون: هذا الأشتر قد جاء، فدخل القصر فضربنا وأخرجنا، فنزل أبو موسى من المنبر.
أخباره في حرب صفين
حضر الحسن والحسين(عليهما السلام) مع أبيهما حرب الجمل وصفين والنهروان. في نهج البلاغة: من كلام له (ع) في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن ابنه (ع) يتسرع إلى الحرب: املكوا عني هذا الغلام لا يهدني فإني أنفس بهذين يعني الحسن والحسين على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله (ا.هـ). ومن أخباره يوم صفين ما ذكره نصر بن مزاحم في كتاب صفين قال: أرسل عبيدالله بن عمر إلى الحسن بن علي (ع) أن لي إليك حاجة فالقني فلقيه الحسن (ع) فقال له عبيدالله: إن أباك قد وتر قريشاً أولاً وآخراً وقد شنئه الناس، فهل لك في خلعه وأن تتولى أنت هذا الأمر؟ فقال: كلا، والله لا يكون ذلك.
وصايا علي لولده الحسن (ع)
كتب أمير المؤمنين لوده الحسن وصية جليلة عظيمة طويلة بعد منصرفه من صفين مذكورة في نهج البلاغة، ووصاياه لابنه الحسن وله وللحسين (ع) في نهج البلاغة كثيرة.
وصية علي لولده الحسن (ع) عند وفاته
كان الحسن (ع) وصي أبيه، أوصى إليه لما ضربه ابن ملجم بالوصية التي ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين: فقال فيها: أوصيك يا حسن وجميع ولدي إلخ…
ما فعله الحسن قبيل مقتل أبيه (ع)
إلى ما بعده دفنه
روى الطبري بإسناده عن أبي عبدالرَّحمن السلمي قال: قال لي الحسن بن علي (ع): خرجت وأَبي يصلي في المسجد فقال لي: يا بني إني بت الليلة أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان (إلى أن قال) قال الحسن (ع) وجاء ابن أبي الهياج فأذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فاعتوره الرجلان فأما أحدهما فوقعت ضربته في الطاق وأما الآخر فأثبتها في رأسه (ا.هـ) والحسن هو الذي تولى غسل أبيه والصلاة عليه وقتل عبد الرَّحمن بن ملجم.
وروى أبو الفرج الأصفهاني بسنده: أن علياً لما توفي ولِّيَ غسله ابنه الحسن وعبدالله بن عباس، وصلى عليه ابنه الحسن. قال أبو الفرج: فأما ابن ملجم فإن الحسن بن علي بعد دفنه أمير المؤمنين دعا به وأمر بضرب عنقه فقال له: إن رأيت أن تأخذ علي العهود أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك بعد أن أمضي إلى الشام فانظر ما صنع صاحبي بمعاوية فإن كان قتله وإلاَّ قتلته ثم عدت إليك حتى تحكم في حكمك؟ فقال: هيهات ثم ضرب عنقه، واستوهبت أم الهيثم بنت الأسود النخعية جيفته منه فوهبها لها فحرقتها بالنَّار.
بيعته بالخلافة
قال المفيد في الإرشاد: كانت بيعته يوم الجمعة 21 رمضان سنة 40 فخطب خطبة قصيرة. قال أبو الفرج: ثم نزل من المنبر فرتب العمال وأمَّر الأمراء ونظر في الأمور.
قال المفيد: فلما بلغ معاوية وفاة علي وبيعة الناس ابنه الحسن (ع) دس رجلاً من حمير إلى الكوفة ورجلاً من بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار ويفسدا على الحسن الأمور، فعرف ذلك الحسن فأمر باستخراج الحميري من عند لحام بالكوفة فأخرج وأمر بضرب عنقه، وكتب إلى البصرة باستخراج القيني من بني سليم فأخرج وضربت عنقه.
المكاتبة بين الحسن وابن عبَّاس ومعاوية
وكتب الحسن إلى معاوية: (أم بعد) فإنك دسست إلي الرجال كأنك تحب اللقاء لا أشك في ذلك فتوقعه إن شاء الله وبلغني أنك شمت بما لم يشمت به ذو الحجى.
فأجابه معاوية: أما بعد فقد وصل كتابك وفهمت ما ذكرت فيه ولقد علمت بما حدث فلم أفرح ولم أحزن ولم أشمت ولم آس.
وروى المدائني أن ابن عبَّاس كتب إلى الحسن: أما بعد فإن المسلمين ولوك أمرهم بعد علي (ع) فشمر للحرب وجاهد عدوك وقارب أصحابك (وهو كتاب طويل).
وتتابعت الرسائل بين معاوية والحسن فلم تأت بنتيجة، وصار كل واحد منهما يتهيأ للقتال. ثم أن معاوية توجه إلى العراق. فسار الحسن متوجهاً للقاء معاوية.
واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب، وأمره باستحثاث الناس وإشخاصهم إليه، فجعل يستحثهم ويخرجهم حتى يلتئم العسكر وسار الحسن حتى أتى دير عبد الرحمن فأقام به ثلاثاً حتى اجتمع الناس ثم دعا عبيدالله بن عبَّاس فقال له: إني باعث معك اثني عشر ألفاً فسر بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات، ثم تصير بمسكن ثم امضِ حتى تستقبل معاوية؛ فإن أنت لقيته فاحبسه حتى نأتيك في أثرك وشيكاً، وليكن خبرك عندي كل يوم وشاور هذين (يعني قيس بن سعد بن عبادة، وسعيد بن قيس الهمداني)؛ فإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك وإن فعل فقاتله فإن أصبت فقيس على الناس، وإن أُصيب قيس فسعيد بن قيس على الناس. فسار عبيدالله حتى انتهى إلى شينور حتى خرج إلى شاهي، ثم لزم الفرات وقرى الفلوجة حتى أتى مسكن، قال المفيد: استنفر الحسن (ع) الناس للجهاد فتثاقلوا عنه ثم خفوا ومعه أخلاط من الناس بعضهم شيعة له ولأبيه، وبعضهم خوارج يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة، وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم، وبعضهم شكاك وأصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون إلى عقيدة.
قال المفيد: وكان قد كتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع والطاعة في السر واستحثوه على المسير نحوهم وضمنوا له تسليم الحسن إليه عند دنوهم من عسكره، وبلغ الحسن ذلك (وروى) الصدوق في العلل: أن معاوية دسَّ إلى عمرو بن حريث، والأشعث بن قيس، وحجار بن أبجر، وشبث بن ربعي دسيساً أفرد كل واحد منهم بعين من عيونه إنك إذا قتلت الحسن فلك مائة ألف درهم، وجند من أجناد الشام، وبنت من بناتي فبلغ الحسن (ع) ذلك. وفي (الخرائج): أن الحسن (ع) بعث إلى معاوية قائداً من كندة في أربعة آلاف فلما نزل الأنبار بعث إليه معاوية بخمسمائة ألف درهم ووعده بولاية بعض كور الشام والجزيرة فصار إليه في مائتين من خاصته، ثم بعث رجلاً من مراد ففعل كالأول بعد ما حلف بالأيمان أنه لا يفعل.
 قال أبو الفرج: ثم أن معاوية وافى حتى نزل قرية يقال لها الحبوبية بمسكن فأقبل عبيدالله بن العبَّاس حتى نزل بإزائه، فلما كان الغد بعث معاوية إلى عبيدالله أن الحسن قد راسلني في الصلح، وهو مسلم الأمر إلي فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاً وإلاَّ دخلت وأنت تابع، ولك إن جئتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم يعجل لك في هذا الوقت النصف، وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر؛ فانسل عبيدالله ليلاً، فدخل عسكر معاوية فوفى له بما وعده، فأصبح الناس ينتظرون أن يخرج فيصلي بهم فلم يخرج وطلبوه فلم يجدوه، وصلى بهم قيس بن سعد ثم خطبهم فقال: أيها الناس لا يهولنكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الجبان؛ أن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قط؛ إن أباه عم رسول الله خرج يقاتله ببدر فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري فأتى به رسول الله (ص) فأخذ فداءه فقسمه بين المسلمين؛ وإن أخاه ولاه علي (ع) على البصرة فسرق مال الله ومال المسلمين فاشترى به الجواري وزعم أن ذلك له حلال؛ وإن هذا ولاه أيضاً على اليمن فهرب من بسر بن أرطأة وترك ولده حتى قتلوا وصنع الآن هذا الذي صنع فنادى الناس: الحمد لله الذي أخرجه من بيننا امضِ بنا إلى عدونا.
قال أبو الفرج: ثم أن معاوية وافى حتى نزل قرية يقال لها الحبوبية بمسكن فأقبل عبيدالله بن العبَّاس حتى نزل بإزائه، فلما كان الغد بعث معاوية إلى عبيدالله أن الحسن قد راسلني في الصلح، وهو مسلم الأمر إلي فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاً وإلاَّ دخلت وأنت تابع، ولك إن جئتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم يعجل لك في هذا الوقت النصف، وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر؛ فانسل عبيدالله ليلاً، فدخل عسكر معاوية فوفى له بما وعده، فأصبح الناس ينتظرون أن يخرج فيصلي بهم فلم يخرج وطلبوه فلم يجدوه، وصلى بهم قيس بن سعد ثم خطبهم فقال: أيها الناس لا يهولنكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الجبان؛ أن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قط؛ إن أباه عم رسول الله خرج يقاتله ببدر فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري فأتى به رسول الله (ص) فأخذ فداءه فقسمه بين المسلمين؛ وإن أخاه ولاه علي (ع) على البصرة فسرق مال الله ومال المسلمين فاشترى به الجواري وزعم أن ذلك له حلال؛ وإن هذا ولاه أيضاً على اليمن فهرب من بسر بن أرطأة وترك ولده حتى قتلوا وصنع الآن هذا الذي صنع فنادى الناس: الحمد لله الذي أخرجه من بيننا امضِ بنا إلى عدونا.
صفحة من القرآن المنسوب إلى خط الحسن (ع)
قال المفيد: وورد على الحسن (ع) كتاب قيس بن سعد يخبره بما صنع عبيدالله بن العبَّاس، فازدادت بصيرته بخذلان القوم له، ولم يبق معه من يأمن غوائله إلاَّ خاصته من شيعته وشيعة أبيه، وهم جماعة لا تقوم لأجناد الشام، فكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح وأنفذ إليه بكتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك به، أو تسليمه إليه فاشترط على نفسه في إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة، وعقد له عقوداً كان في الوفاء بها مصالح شاملة، فلم يثق به الحسن (ع) وعلم باحتياله بذلك واغتياله غير أنه لم يجد بداً من إجابته إلى ما التمس من ترك الحرب وإنفاذ الهدنة؛ لما كان عليه أصحابه مما وصفناه من ضعف البصائر في حقه والفساد عليه والخلف منهم له، وما انطوى عليه كثير منهم في استحلال دمه وتسليمه إلى خصمه، وما كان من خذلان ابن عمه له ومصيره إلى عدوه، وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم في الآجلة.
أما قيس بن سعد بن عبادة فقال أبو الفرج: أنه نهض بمن معه لقتال معاوية وخرج إليه بسر بن أرطأة في عشرين ألفاً: فصاحوا بهم: هذا أميركم قد بايع، وهذا الحسن قد صالح فعلام تقتلون أنفسكم؟ فقال قيس لأصحابه: اختاروا أحد اثنين إما القتال مع غير إمام أو تبايعون بيعة ضلال؟ فقالوا: بل نقاتل بلا إمام. فخرجوا وضربوا أهل الشام حتى ردوهم إلى مصافهم وكتب معاوية إلى قيس يدعوه ويمنيه، فكتب إليه قيس: لا والله لا تلقاني أبداً إلاَّ بيني وبينك السيف والرمح. وجرت بينهما مكاتبات أغلظ كل منهما فيها لصاحبه، ثم انصرف قيس بمن معه إلى الكوفة، وانصرف الحسن (ع). ومما تقدم يعلم أن الحسن (ع) لم يفرط في أمر السياسة وأخذ بالحزم والتدبير فعلم بالجاسوسين اللذين أرسلهما معاوية بعد وفاة علي (ع) وقتلهما، واستحث أهل العراق وسار بمن اتبعه منهم لقتال معاوية، وأرسل اثني عشر ألفاً مقدمة له وأمر عليهم ابن عمه عبيدالله بن العبَّاس وأمره بمشاورة قيس وسعيد لما يعلم من نصحهما، وإن إمارات الخذلان كانت بادية على أهل العراق بتثاقلهم أول الأمر حين دعاهم، وأنهم لم يخرجوا إلاَّ بعد التأنيب والتوبيخ، وإن المخلصين منهم له كانوا أقل قليل وأكثرهم خوارج وأهل عصبية خرجوا تبعاً لرؤسائهم وطمعاً في النهب، وأنه كان يتخوف خذلان أصحابه من أول الأمر، وأنه لم يكن من الرأي أن يسير بهم على تلك الحال إذ لا يؤمن أن يسلموه إلى معاوية، فلما ظهر له فساد نيات الخوارج فيه مع ما كان من فعل عبيدالله بن عبَّاس والقائدين المرسلين بعده، وما علمه من مكاتبة أصحابه معاوية، وما ضمنوه له من الفتك به أو تسليمه إليه، وعلم أنه لو لم يصالح لسلموه إلى معاوية؛ ولكانت المفسدة أعظم. أجاب إلى الصلح مكرهاً مرغماً، واختار أقل الضررين، وأهون المفسدتين، وإن صلحه هذا لا يجعل لمعاوية عذراً ولا يرفع عنه وزراً؛ بل يزيده ذماً وإثماً، ومما يدل على ما ذكرناه ما ذكره ابن الأثير في الكامل قال: لما راسل معاوية الحسن في تسليم الأمر إليه خطب فقال: إنّا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم في مسيركم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم؛ إلاَّ وقد أصبحتم بين قتيلين قتيل بصفين تبكون له وقيتل بالنهروان تطلبون بثأره، فأما الباكي فخاذل وأما الطالب فثائر إلا وأن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا نصفة فإن أردتم الموت رددناه عليه، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضى. فناداه الناس من كل جانب: البقية البقية. وما حكاه سبط ابن الجوزي عن السدي أنه قال: لم يصالح الحسن معاوية رغبة في الدنيا، وإنما صالحه لما رأى أهل العراق يريدون الغدر به وفعلوا معه ما فعلوا، فخاف منهم أن يسلموه إلى معاوية.
وقال (ع) في جملة كلام له رواه الطبرسي في الاحتجاج: والله ما سلمت الأمر إلى معاوية إلاَّ أني لم أجد أنصاراً ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري، حتى يحكم الله بيني وبينه.
ومن مجموع ما مر يعلم الوجه في صلحه([513]).
شروط الصلح
حكى الصدوق عن كتاب الفروق بين الأباطيل والحقوق تأليف محمَّد بن بحر الشيباني قال: بايع الحسن بن علي معاوية على أن لا يسميه أمير المؤمنين، وأن لا يتعقب على شيعة علي شيئاً ويؤمنهم، ولا يتعرَّض لأحد منهم بسوء، ويوصل إلى كل ذي حق منهم حقه، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دارابجرد من بلاد فارس (ا.هـ) وكان فيما شرطه أن يترك سب أمير المؤمنين. وقال ابن الأثير: أنه لم يجبه إلى الكف عن شتم علي فطلب أن لا يشتم وهو سمع فأجابه إلى ذلك، ثم لم يف له به أيضاً (ا.هـ) وعاهد معاوية الحسن على ما تم بينهما من الشروط وحلف له بالوفاء وكتب بينه وبينه بذلك كتاباً ثم لم يف له بشيء مما عاهده عليه.
صورة كتاب الصلح بين الحسن ومعاوية
ذكره ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله، وليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً، على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعالى في شامهم ويمنهم وعراقهم وحجازهم، وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا، وعلى معاوية بذلك عهد الله وميثاقه، وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من بيت رسول الله غائلة سوء سراً وجهراً، ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق، شهد عليه بذلك فلان وفلان وكفى بالله شهيداً.
بعد الصلح
لما تم الصلح سار معاوية حتى نزل النخيلة (وهي معسكر الكوفة) فخطب بالناس خطبة قال فيها: إني كنت منيت الحسن ووعدته بأشياء وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء منها.
وأقام معاوية ومن بعده من ملوك بني أمية على سب أمير المؤمنين علي إلاَّ ما كان من عمر بن عبدالعزيز، وأخاف معاوية شيعة أمير المؤمنين وقتلهم وشردهم وهدم كثيراً من دورهم، فقتل عمرو بن الحمق، وحبس زوجته آمنة بنت الشريد سنتين في سجن دمشق، وقتل حجر بن عدي وأصحابه بمرج عذراء، وحمل عبدالله بن هاشم المرقال إليه مكبلاً بالحديد من العراق إلى الشام. وأما خراج دار ابجرد فقال ابن الأثير: أن أهل البصرة منعوا الحسن منه وقالوا: فيئنا لا نعطيه أحداً قال: وكان منعهم بأمر معاوية، وقال المدائني: كان الحصين بن المنذر الرقاشي يقول: والله ما وفى معاوية للحسن بشيء مما أعطاه: قتل حجراً وأصحاب حجر، وبايع لابنه يزيد، وسم الحسن.
مدة خلافة الحسن
قال ابن عبدالبر في الاستيعاب: سلم الأمر الحسن إلى معاوية في النصف من جمادى الأولى من سنة 41 وكل من قال: أنه كان سنة أربعين فقد وهم (ا.هـ). وفي المستدرك للحاكم: كان ذلك في جمادى الأولى سنة 41 (ا.هـ).
وقيل: كان ذلك لخمس بقين من ربيع الآخر. فعلى الأولى: تكون مدة خلافته الظاهرة سبعة أشهر وأربعة وعشرين يوماً لأن بيعته كانت في الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة 40. وعلى الثاني: تكون خلافته ستة أشهر وأربعة أيام. وقيل: ثلاثة أيام. وقيل: خمسة أيام وذلك بناء على الخلاف في تاريخ وفاة أمير المؤمنين (ع) وعلى الثالث تكون أكثر من ذلك بأيام.
معاتبة أصحاب الحسن
له على الصلح واعتذاره إليهم
قال أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين: اجتمع إلى الحسن (ع) وجوه الشيعة وأكابر أصحاب علي (ع) يلومونه ويبكون إليه جزعاً مما فعله.
وقال المدائني: أن معاوية لما خطب الناس بالكوفة وقال في جملة خطبته: كل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين قال: المسيب بن نجبة للحسن (ع): ما ينقضي عجبي منك بايعت معاوية ومعك أربعون ألفاً ولم تأخذ لنفسك وثيقة وعقداً ظاهراً أعطاك أمراً فيما بينك وبينه ثم قال ما قد سمعت، والله ما أراد بها غيرك قال: فما ترى؟ قال: أرى أن ترجع إلى ما كنت عليه فقد نقض ما كان بينه وبينك فقال: يا مسيب إني لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر عند اللقاء ولا أثبت عند الحرب مني؛ ولكني أردت صلاحكم، وكف بعضكم عن بعض، فارضوا بقدر الله وقضائه حتى يستريح بر ويستراح من فاجر.
قال المدائني: ودخل عبيد بن عمرو الكندي على الحسن (ع) وكان ضرب على وجهه مع قيس بن سعد بن عبادة فقال: ما الذي أرى بوجهك؟ قال: أصابني مع قيس فالتفت حجر بن عدي إلى الحسن وقال كلاماً لا يخلو من سوء أدب حمله عليه شدة الحب ثم قال: إنا رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا. فتغير وجه الحسن وغمز الحسين حجراً فسكت فقال الحسن (ع): يا حجر ليس كل الناس يحب ما تحب ولا رأيه رأيك وما فعلت ما فعلت إلاَّ إبقاء عليك والله كل يوم في شأن.
رجوعه إلى المدينة
قال المدائني: أقام الحسن (ع) بالكوفة أياماً ثم تجهز للشخوص إلى المدينة فدخل عليه المسيب بن نجبة الفزاري وظبيان بن عمارة التميمي ليودعاه فقال الحسن (ع): الحمد لله الغالب على أمره لو أجمع الناس على أن لا يكون ما هو كائن ما استطاعوا (إلى أن قال) فعرض له المسيب وظبيان بالرجوع فقال: ليس إلى ذلك سبيل فلما كان الغد خرج وتوجه إلى المدينة هو وأخوه الحسين (ع) وأهل بيته وحشمهم، وجعل الناس يبكون عند مسيرهم من الكوفة.
تقويم موقف الحسن (ع)
قال الدكتور إبراهيم بيضون:
إذا كان من الصعوبة أو بعضها، متابعة المواقف السياسية لقيادات تلك الفترة المضطربة من تاريخ الدولة الإسلامية، فإن ما أحاط بموقف الحسن إبَّان عهده القصير، كان على جانب من الغموض حيناً وسوء التقدير حيناً آخر، وبالتالي تصبح الكتابة عنه من أصعب المهام، وفي وقت كان التاريخ ولا يزال، يصوغ أكاليل الغار للمنتصر، ذلك الفارس والمقدام والحليم والسياسي الخارق، بينما ينتهي المهزوم جباناً، ضعيف الشكيمة، ما من حيلة له في الحرب والسلم. وقد تصبح محاولة الإنصاف أو إعادة التقويم ظلماً آخر، إن لم يأخذ المؤرخ بناصية الموضوعية والتجرد، ويبتعد عن عاطفته وجموح أحكامه المسبقة، مهما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
وسنحاول هنا التركيز على دوافع الصلح لدى الحسن، متوخّين التحليل العلمي لفهم هذه المسألة دون الخوض في تفاصيل الأحداث المعروفة، إلاَّ ما كان له دور في إلقاء الضوء على شخصية الحسن، لا سيما الجانب القيادي الذي تعرض للنقد والتشكيك. وسنجد عبر قراءة متمعنة للنصوص، أن الشخصية كما التجربة، لم تنقصه في السياسة أو الحرب، حيث اكتسبها من خلال معايشة قريبة، للأحداث الكبرى، بدءاً بالتطورات المثيرة التي شهدتها «المدينة» مع الانتفاضة على عثمان، دون أن تنتهي فصولها في الحرب «الأهلية» التي دارت رحاها في صفين. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت لدى الحسن، القدرة على تحديد الموقف، النابع من رؤية خاصة للأمور، لا سيما الخطير منها (رأيه في مغادرة عليّ المدينة إبَّان حصار عثمان، وكذلك في خروجه إلى العراق عشية معركة الجمل)([514]). هذه المؤشرات وكثير غيرها، لا نستطيع تجاهلها في سياق مناقشة الدوافع التي أملت على الحسن إجراء الصلح مع معاوية، والعزوف عن الحرب التي انطوت على مخاطرة، ليس بالنفس فقط، ولكن بالوجود والكيان والأفكار، لتيار بدا أكثر نضجاً وارتباطاً بالفئات المقهورة التي تمسكت به، تمسكها بالإسلام، بعد أن وجدت خلاصها على يده، وأدركت نخبتها جسامة الدور الذي ينتظرها في الغد القاتم، ومن هذا المنظور كانت سمة الحذر، أبرز ملامح القيادة الشيعية في ذلك الحين، متجسدة في عدم المجازفة بالبقية الصامدة من أصحاب الحسن، وحمل المتطرفين منهم على السير في خط الصلح، وفي وقت كانت تجابه فيه خصماً، لا يتورع عن استخدام أكثر الوسائل شراسةً ومراوغةً لتحقيق أهدافه، التي سرعان ما تصبح مشروعةً ومسوغةً على أرض الواقع، نصاً وسلوكاً والتزاماً، على نحو ما أحدثته المجابهات التالية، وما شهدته من ضرب لبقايا الرموز في المجتمع (مجزرة كربلاء وقذف الكعبة بالمنجنيق، فضلاً عن استباحة المدينة)، بالشدة نفسها التي اصطبغت بها أحداث تلك الفترة.
والحسن، الذي عاش أيضاً تجربة الصدع الكبير في الدولة الإسلامية، لم يلقِ السلاح أو يطوِ مشاريع السياسة، كيف ينصرف لذاته ويستسلم للحياة الهادئة في «المدينة» ولكنه ظل على عهده والتزامه بالفئات التي بلغت معه نهاية الطريق إلى الحرب، دون أن تتخلَّى عنه بعد الانعطاف نحو طريق السلم. فبقي مرجع شؤونها الأول، تعود إليه في الشدائد وتستلهمه القرار المناسب. وإذا كان هنالك من شذَّ عن القاعدة وانتقد الحسن من كبار أعوانه، عندما رفض حجر بن عديّ الكندي الصلح، فإن الأخير كان مدفوعاً ببراءة الموقف السياسي والتطرف في مجابهة السلطة([515]). فعلى الرغم من تحامله العنيف على الحسن، لم يجد الأخير غضاضة في توضيح دوافعه الأساسية لهذا الأمر: «إني رأيت هوى معظم الناس في الصلح وكرهوا الحرب. فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون، فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة من القتل، فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ما، فإن الله كل يوم هو في شأن»([516]).
ولا يتخلَّى الحسن عن دوره القيادي، ومسؤوليته في رسم خطى المستقبل للفئات المرتبطة به. فالنظرة الحذرة لا تبارحه، حتى في معالجة القيادة في أسرته، انطلاقاً من الرؤية ذاتها التي خالجته عشية اتخاذه قرار الصلح مع معاوية. ومن هنا كان الحرص على حسمها قبل موته، حين أوصى الحسين خيراً بأخيه محمَّد ابن الحنفية، في الوقت الذي أوصى الأخير بأن يقف إلى جانب الحسين، الذي ستؤول إليه القيادة، استناداً إلى قول الدينوري: «وأنا أوصيك بالحسين، كأنفه ووزاره»([517]). ولا تهمل هذه النظرة الدقيقة والواعية، المكان الذي أوصى بأن يدفن به، مؤثراً تجنب الصدام في هذه المسألة، على حساب رغبته: «ادفنوني مع جدي.. فإن منعتم فبالبقيع»([518]). ولا يحتاج ذلك إلى تعليق، انطلاقاً من اعتقاد الحسن الجازم بمعارضة السلطة لمشيئته، حيث حال دون تنفيذها مروان بن الحكم([519])، على الرغم من موافقة «الأمير» حينذاك (سعيد بن العاص)، مسوِّغاً اعتراضه على «الطريقة الأموية»، بقوله للحسين: إن أخاك قال: «إذا خفتم الفتنة، ففي مقابر المسلمين، وهذه الفتنة»([520]).
إن تتبع أخبار تلك الحادثة قد يضعنا على مفترق جديد في هذه المسألة، بحيث لا نكون أسرى المتداول من النصوص، التي نركز في معظمها على الإثارة ومخاطبة العواطف، دون الاهتمام، إلاَّ قليلاً، بالمضمون الواقعي للحدث وطرحه في إطار المنهجية العلمية.
ولعل البحث يبدو شائكاً في مناقشة أفكار الحسن بعد توليه الخلافة، إذا ما كانت تصب حقيقةً في مجرى الحرب أم السلم. ذلك أن تواتر الأحداث التي توَّجها اغتيال علي، لم يدع فرصة لخليفته، سواءً كان الحسن أم غيره، أن يتخذ قراراً مستقلاً عن تلك الأحداث، وفي الطليعة قرار الحرب. فنحن إذن أمام قضية لا تقبل الكثير من النقاش، حيث وجد الخليفة الجديد نفسه، أمام خيار حتمي وتركة جسيمة. وقد رجح هذا الالتزام، أن أجواء التعبئة العسكرية والنفسية، كانت لا تزال تسيطر على جبهة العراق حتى بعد اغتيال علي، الذي «بايعه أربعون ألفاً من عسكره على الموت»([521])، استناداً إلى رواية الزهري المعروفة.
على أن الالتزام بقرار الحرب، لا يعني الالتزام بتنفيذه، إذا ما كان القتال فاقداً شروطه الموضوعية الأخرى. فإذا كان الرقم، الذي أشارت إليه رواية الزهري السالفة غير مبالغ فيه، فإن ذلك لا يعني أن كافة القبائل على الجبهة العراقية، كانت مطواعة في قبضة الحسن. وإذا ما استثنينا اثنين من القادة البارزين ـ وهما: الزعيم «الأنصاري» قيس بن سعد، والزعيم الخزاعي سليمان بن صُرد ـ اللذين أظهرا حماسة لا تقبل التردد إلى جانب الحرب([522])، بعد أن وصلا إلى نقطة اللاعودة مع بني أميّة، فإن الآخرين أو جلّهم، بدأوا يعيشون أجواء المهادنة ويتوقون إلى السكينة، بعد سجالية طويلة.
وبتعدي قرار الحرب، الموقف الخاص لدى الحسن، إلى ضرورة جهادية ملحَّة، في وقت بلغت جيوش الشام أطراف العراق بعد اغتيال علي، دون أن يقتصر طموحها هذه المرة على التأثير النفسي، عبر غزوات خاطفة، تشيع الإرهاب والقتل في معسكرات الجبهة العراقية. فلم يكد الحسن يأخذ القليل من مقاليد الحكم في الكوفة، حتى فوجىء بمسير معاوية إلى مسكن([523])، مسبوقاً بحملة عبدالله بن عامر باتجاه المدائن([524]). فسلك طريق الجزيرة إلى الموصل، عبر الأنبار إلى هذه الأخيرة. أما الأولى، فكانت بمثابة «خط الدفاع» الأول للجبهة العراقية، وذلك بقيادة قيس بن سعد([525])، الأكثر صلابة وإخلاصاً بين قادة الحسن، بينما كانت الثانية (المدائن)، التي يفترض أنّها (خط الدفاع) الثاني وقلب الجبهة، هدف عبدالله بن عامر، في مهمة كانت على الأرجح سياسية أكثر منها عسكرية. وتتضارب الروايات في هذا الشأن حول أسبقية الوصول إلى المدائن، حيث يقول الطبري «بايع الناس الحسن بن علي (ع) بالخلافة، ثم خرج بالناس حتى نزل المدائن»([526]). ويماثله اليعقوبي بقوله: «ووجه معاوية إلى الحسن، المغيرة بن شعبة وعبدالله بن عامر بن كريز وعبدالرحمن بن أم الحكم، وأتوه وهو بالمدائن نازل على مضاربه»([527]). أما الدينوري، فيرى في مسيرة الحسن إليها «لمحاربة عبدالله بن عامر بن كريز»([528])، الذي سبقه إليها استناداً إلى هذه الرواية. ولعل ما يعنينا في هذا السياق، ليس التحقق من أسبقية الوصول لأي من الطرفين إلى المدائن، بقدر ما نتوخى إبراز الأهمية العسكرية لهذه المدينة الوسطية العريقة، التي تقع إلى الشمال الشرقي من الكوفة. فهي جغرافياً، تقع على امتداد الممر التقليدي للحملات الحربية، التي تنطلق من الشام عبر الموصل، عسكرياً، كان لديها من المناعة والتحصين، ما لم تتمتع به الكوفة الحديثة العهد.
وفي ضوء هذه الاعتبارات، تأخذ المدائن دورها المحوري في الصراع على العراق بين الطرفين الهاشمي والأموي، وهو دور لم يرتبط بالحسن فقط، حيث يتردد ذكرها إبّان خلافة علي وتتحوَّل إلى معسكر مركزي، تعبر منه القوات إلى الجزيرة([529])، في بدء العمليات الحربية التي جرت في صفين، ومنه تنطلق الإمدادات في حرب الخوارج([530])، بعد ركود القتال على الجبهة الشامية، دون أن تفقد هذا الدور في الأحداث البارزة التي شهدها العراق بعد ذلك، وفي الطليعة منها حركة المطرّف بن المغيرة بن شعبة، حيث نافست المدائن ـ مقر الأخير ـ الكوفة ـ مركز الحكم ودار الإمارة ـ وهزَّت كرسيّ الوالي الثقفي الجبَّار([531]).
وهكذا يرتبط خروج الحسن إلى المدائن، بالصراع المسلح مع الجبهة الشامية المعادية، ويتصل بالطريق التقليدي إليها، على نحو ما أسلفنا ذكره، ومن هذا المنظور يصبح القول، إن المدائن كانت بداية التراجع الفعلي والخطوة المبيتة نحو التفاوض والصلح، بحاجة إلى قرائن لا توفرها الروايات على اختلافها، بما فيها التي أشارت إلى عزوف الحسن عن القتال، في الوقت الذي خرج فيه إلى معسكره في المدائن. وإذا كانت رواية الزهري ـ مؤرخ البلاط المرواني ـ تجعل من هذا الخروج، نوعاً من الابتزاز لكي «يأخذ لنفسه ـ أي الحسن ـ ما استطاع من معاوية ثم يدخل الجماعة»([532])، فإن روايةً غير مسندة لمؤرخ([533]) من القرن السابع، تجنح ربما إلى المبالغة وعدم الدقة في تقويم الموقف العسكري على الجبهة العراقية بعيد مجيء الحسن: «إن أكثر من أربعين ألفاً كلهم قد بايع أباه على الموت، وكانوا أطوع للحسن وأحب فيه منهم في أبيه»([534]). أما كيف تحول الموقف من بيعة على الموت ـ العبارة الواردة ـ في كافة الروايات إلى عزوف عن الحرب، فذلك ما يسوغه المؤرخ السابق، بأن كلاًّ من الطرفين، لا سيما الحسن، تهيّب النتائج بعد اقتراب الجيشين من بعضهما في مسكن([535]).
وإذا كان ما ينقله هذا المؤرخ يحتاج إلى الدقة، فضلاً عن الإسناد لرواياته، فإنه يلقي الضوء بصورة غير مباشرة على تناقضات الجبهة العراقية وتباين الآراء في قيادتها، التي بدت حيناً متشيعة وغير موحدة الموقف، إلى الحد الذي دفع بعضها إلى اتخاذ مبادرات مستقلة، دون العودة إلى القيادة العليا. ولعل ذلك واضح في المواقف المتناقضة، بين عبيدالله بن عبَّاس (رأس الاتجاه المتهادن مع معاوية)، وبين قيس بن سعد (رأس المتصلبين في الاتجاه المعاكس)، وآخرين من القيادات المتطرفة في هذه الجبهة، من أمثال حجر بن عديّ الكندي وسليمان بن صرد الخزاعي. ويبدو أن قيساً لم يشأ تسليم الأمر لمعاوية بهذه السهولة، فظل متصلباً حتى بعد موافقة الحسن على الصلح. وكان هذا الموقف، قد دفع معاوية إلى التعبير عن سخطه الشديد على القائد «الأنصاري»، فيما نسب إليه: «آليت متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده»([536]). على أن الحسن لا يتخلى عن قائده المخلص، فيربط بيعته بالعفو عنه وعن الآخرين من أصحابه. «إني لا أبايعك أبداً وأنت تطلب قيساً أو غيره بتبعة قلّت أو كثرت»([537]).
والواقع أن «الأنصار» بزعامة قائدهم البارز قيس بن سعد، كانوا أكثر الفئات تضرراً من الانتصار الأموي الذي أصبح وشيكاً في ذلك الوقت. فقد ارتبط مصير هؤلاء عضوياً بالبيت الهاشمي، منذ الهجرة النبوية إلى «المدينة»، التي عاشت عصرها الذهبي في أيام النبي والعهد المبكر من الدولة الراشدية. وقد زادت هذا الارتباط لحمة، خيبة الأمل التي واجهت «الأنصار» في السقيفة، وما أسفرت عنه من تكتل قرشي شبه إجماعي، لإبعادهم عن السلطة. وكانت تلك بداية الإنحياز إلى جانب عليّ وأسرته، حيث شعر كلاهما بالحرمان الذي شكَّل عنصراً هاماً للتحالف المصيري بين الطرفين([538]). وكان من الطبيعي، أن تنعكس على «الأنصار» سلبيات العلاقة غير الودية بين البيتين الهاشمي والأموي، ومن ثم تسديد حسابات ثقيلة، تجاوزت أحياناً ما لحق بالبيت الأول. وإذا كانت الحركة التي أودت بشيخ بني أمية (عثمان) في «المدينة»، لم يتورط بها «الأنصار»، فإنهم لم يخرجوا سالمين من تهمة التواطؤ في قتله، أمام الأعين وعلى المسامع منهم. فكانت هذه بداية النفور السافر بين الطرفين، الذي بلغ ذروة العداء في موقعة «الحرّة» الشهيرة، التي سقط فيها المئات من الأنصار.
ولم يكن قيس بن سعد، الذي عاش المنعطف الأخطر للدولة الإسلامية، وشهد انطفاء البريق في صرحها الراشدي، بعيداً عن هذه الهواجس التي راودته في معسكر الأنبار، وهو يخوض حرباً يائسة ضد معاوية، معبِّراً بطريقته غير المساومة، في التخاطب مع جنوده: «اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة أو القتال من غير إمام»([539]). فقد كان يعرف جيداً، معنى انهيار بقايا الخلافة الراشدية وقيام خلافة أموية على أنقاضها، وما ستعكسه هذه المتغيرات الخطيرة على أوضاع «الأنصار» السياسية والاجتماعية.
ولم يكذِّب معاوية هذه المخاوف لدى الزعيم «الأنصاري»، التي جسَّدها القول المنسوب لمعاوية مخاطباً هذا الأخير بعد سنوات قليلة من تنازل الحسن، حسب رواية المدائني: «بماذا تطلبون ما قبلي؟ والله لقد كنتم قليلاً معي كثيراً عليّ، ولقد فللتم حدّي يوم صفين حتى رأيت المنايا تلظّى في أسنتكم»([540])، وذلك عندما اشتدت الضائقة وطغى الحرمان على «الأنصار»، وهو ما عبّر عنه لاحقاً أحد أبناء قيس، عندما أنَّبه معاوية على عدم خروج قومه لاستقبال معاوية أثناء قدومه إلى «المدينة»: «منعنا عن ذلك قلة الظهر وخفة اليد، بإلحاح الزمان علينا وإيثارك بمعروفك غيرنا»([541]).
وهكذا كان موقف الزعيم «الأنصاري» قيس بن سعد، السهم الأخير في الدفاع عن الخلافة الراشدية، التي كانت تحتضر في ذلك الحين. وبقدر ما كان الحسن معجباً بقائده الشجاع والمخلص، كان عليه التعامل مع الأمور بصورة أكثر واقعية، حيث لم يشأ وضع الثمن مزدوجاً، بفقدان السلطة وضرب الفئات التي وقفت معه في الأيام العجاف. فقد تبدلت معطيات كثيرة عبر مسافة الزمن القصير، بين وفاة علي وبيعة الحسن، وعبر مسافة المكان، من الكوفة إلى المدائن، حيث تكشّف الخلل والتناقض والانهيار لدى الأكثرية في الجبهة العراقية. وكان إنقاذ الفئة المستنيرة ـ على اختلاف عروقها ومشاربها ـ التي ستكون نواة ما عُرف بالتشيع في العهد الأموي ـ الثمن غير البخس الذي ظفر به الحسن في وثيقة الصلح، التي كان من أبرز شروطها، حسب ما جاء في «الأخبار الطوال»: «ألاّ يأخذ ـ أي معاوية ـ أحداً من أهل العراق بإحنة، وأن يؤمّن الأسود والأحمر، ويحتمل ما يكون من هفواتهم»([542]).
وفاته
روى الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش، عن محمَّد بن حبيب في أماليه، عن ابن عبَّاس أنه قال: أول ذل دخل على العرب موت الحسن (ع). وفي مقاتل الطالبيين قيل لأَبي إسحاق: متى ذل الناس؟ قال: حيث مات الحسن، وادعي زياد، وقتل حجر بن عدي، وكان الحسن (ع) شرط على معاوية في شروط الصلح أن لا يعهد إلى أحد بالخلافة بعده، وأن تكون الخلافة له من بعده، قال أبو الفرج: وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر الحسن بن علي، وسعد بن أبي وقاص، فدس إليهما سماً فماتا منه.
وقال المدائني دس إليه معاوية سماً على يد جعدة بنت الأشعث بن قيس زوجة الحسن وقال لها: إن قتلته بالسم فلك مائة ألف وأزوجك يزيد ابني، فمرض أربعين يوماً، فلما مات وفي لها بالمال ولم يزوجها من يزيد وقال: أخشى أن تصنعي ببني ما صنعت بابن رسول الله وكان ذلك بعد عشر سنين من إمارة معاوية. وقد أوصى أخاه الحسين بأن يدفنه مع النبي، فإذا حالوا بينه وبين ذلك؛ فليترك ذلك ولا يسفك قطرة من الدم.
قال المفيد: لما مات الحسن غسله الحسين (ع) وكفنه وحمله على سريره، ولم يشك مروان ومن معه من بني أمية أنهم سيدفنونه عند رسول الله (ص)، فتجمعوا لذلك ولبسوا السِّلاح فلما توجه به الحسين (ع) إلى قبر جده رسول الله أقبلوا إليهم في جمعهم، ولحقتهم عائشة على بغل وهي تقول: ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحب. وهو قول القائل: «فيوماً على بغل ويوماً على جمل» وجعل مروان يقول: أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع النبي، لا يكون ذلك أبداً وأنا أحمل السيف، وكادت الفتنة أن تقع. وقال بعضهم: أرأيتم لو مات ابن لموسى أما كان يدفن مع أبيه؟ فقال الحسين (ع): والله لولا عهد الحسن بحقن الدماء وأن لا أهريق في أمره محجمة دم لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله منكم مأخذها وقد نقضتم العهد بيننا وبينكم وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا. ومضوا بالحسن فدفنوه بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.
ولما بلغ معاوية موت الحسن (ع): سجد وسجد من حوله وكبَّر وكبَّروا معه، ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار، وابن عبد البر في الاستيعاب، وغيرهما. فقال بعض الشعراء:
| أصبح اليوم ابن هند شامتا | ظاهر النخوة إذ مات الحسن | |
| يا ابن هند أن تذق كأس الردى | تلك في الدهر كشيء لم يكن | |
| لست بالباقي فلا تشمت به | كل حي للمنايا مرتهن |
ولما أتى نعيه وذلك في إمارة زياد بن سمية بكى الناس فسمع الضجة أبو بكرة أخو زياد وكان مريضاً فقال: ما هذا فقالت له زوجته وكانت ثقفية: مات الحسن بن علي والحمد لله الذي أراح الناس منه فقال: اسكتي ويحك فقد أراحه الله من شر كثير، وفقد الناس بموته خيراً كثيراً يرحم الله حسناً. ذكره المدائني.
وكانت وفاته يوم الخميس لليلتين بقيتا من صفر. وقيل: في السابع منه. وقيل: لخمس بقين من ربيع الأول وفي رواية الحاكم: لخمس خلون منه سنة خمسين من الهجرة أو خمس وأربعين أو تسع وأربعين أو إحدى وخمسين أو أربع وأربعين أو سبع وأربعين أو ثمان وخمسين وله سبع وأربعون سنة أو ست وأربعون وأربعة أشهر وثلاثة عشر يوماً. وقيل: غير ذلك ومات رسول الله وله سبع سنين وستة أشهر. وقيل: ثمان سنين وقام بالأمر بعد أبيه وله سبع وثلاثون سنة وأقام إلى أن صالح معاوية ستة أشهر وخمسة أيام أو ثلاثة أيام على الخلاف في وفاة أمير المؤمنين (ع) أنها ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين من شهر رمضان. وقيل: غير ذلك وبقي بعد الصلح تسع سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً. وقيل: غير ذلك والله أعلم.
كتابة العلم
عن السيوطي في تدريب الراوي: أنه كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثير منهم وأباحها طائفة وفعلوها منهم علي وابنه الحسن (ا.هـ) ولا شك في أنه لولا كتابة العلم لضاع العلم فهي منقبة لعلي وولده (ع).
من مدائح الحسن
قيل في الحسن في القديم والحديث شعر كثير فمما قيل فيه بهذا العصر قصيدة للشاعر أحمد حسن الدجيلي:
| هتف الوحي.. فاستجاب القبيل | لوليد به الحياة تطول | |
| هتف الوحي أن سيولد فجر | يظهر الحق فيه والتنزيل | |
| وبوحي من أصغريه سيرتد | كليلاً ليل الشقا ويزول | |
| إنه المجتبى حفيد رسول | الله فرع الإمامة المأمول | |
| ماجت الأرض بالبشائر لما | قد علاها التكبير والتهليل | |
| وحنت فاطم تضم إليها | قلبها الطهر وهي طهر بتول | |
| توسع الطفل بالحنان وتوليه | من الحب ما به تستطيل | |
| والرسول الكريم دنيا تلاقى | في مجالاتها الضحى والأصيل | |
| جسَّد الله حلمه فهو أفق | حالم بالرؤى وظل ظليل | |
| ليس بدعا فإنه روح طه | قد تجلى وسيفه المسلول | |
| والكتاب الذي به يظهر | الحق جلياً ويورق المستحيل | |
| والسحاب الذي بماطر كفيه | تضوع الربى وتزهو الحقول | |
| أيها الأم الثميه برفق | وليداعب جفونه التقبيل | |
| سوف يلقى ثقل الحياة عليه | إن ثقل الحياة عبء ثقيل | |
| يا وليداً نمته أكرم أم | واصطفاه إلى الصلاح الرسول | |
| وانتقته رسالة الدين نبراساً | تضاء الربى به والسهول | |
| ومعيناً للدين أن جف منه | غصنه الغض واعتراه الذبول | |
| كيف راحت روح الخيانة في | زحفك تضري وفي حماك تصول | |
| كيف ظلت تعيث في جيشك | الصاعد ظلماً كما يعيث الدخيل | |
| وإذا فيه والمقادير تجري | ليس للمرء دونها تحويل | |
| تائه لم يكن لديه دليل | في دروب بها يراد الدليل | |
| إنه المال كم عليه قلوب | رفرفت ولهاً وهامت عقول | |
| إنها الرشوة التي تحمل | الكأس يداها ليحتسيها الخليل | |
| ويموت الضمير من كل قلب | مال حيث الرياح فيه تميل | |
| وإذا كان قائد في جناحيه | رفيف لها وايك بليل | |
| تائهاً أنه أطاع ابن هند | وابن هند به الأماني مثول | |
| سفهاً للنفوس ران عليها | في متاهاتها الظلام الثقيل | |
| لا يلام الربيع بعد ارفضاض | الغيث عنه إذا اعتراه الذبول | |
| فالسحاب الذي يرف عليه | يورق الروض عنده والخميل | |
| وحفيد الرسول ران عليه | من عظيم المصاب خطب جليل | |
| ظل في حيرة أينهض للحرب | وما في يديه إلاَّ القليل؟ | |
| أترى يستجيب للحرب والحرب | رعيل يقفو خطاه رعيل | |
| والمنايا تحوم في كل شبر | من ثراها وفي رباها تجول | |
| وهو صفر اليدين من آل فهر | المغاوير… أين تلك الفحول؟ | |
| إنما الحرب بالفوارس تضرى | وبهم تحتمي القنا والنصول | |
| فإذا أغمد الحسام وفاض | الغدر واجتث ساعد مفتول | |
| لم ير السبط ملجأ غير أن | يعمد للسلم وهو نعم السبيل | |
| هو نهج أراده الله أن يبقى | مناراً وما سواه السبيل | |
| هو نهج أراده الله أن يبقى | ناراً وما سواه بديل | |
| وهو صبح وللصباح شروق | منه والفجر فوقه منديل | |
| أيها القائد الذي في يديه | حقق النصر وهو نعم الدليل | |
| إنما النصر ليس بالدم يجري | في ثرى أرضنا وفيها يسيل | |
| إنها دعوة السماء عليها | رفرف الحب لا الدم المطلول | |
| هي للحق دعوة ولأهليه | حنان وللهدى أكليل | |
| وهي أخت السيف الذي كان فـ | ـي كف علي على عداه يصول | |
| وكلا الدعوتين تنبض بالحق | وكلتاهما ربيع جميل | |
| خسأ المفترون فيك وخابت | أنفس جل سعيها تضليل | |
| فيك ظنوا الخذلان والضعف لكن | عرفوا بعد ذا من المخذول؟ | |
| إنها فكرة السماء تجلت | لو وعتها من الأنام عقول!! | |
| إيه يا ابن النبي أن جراحاً | في حنايا ضلوعنا لا تزول | |
| إن درباً عبَّدته في أفانين | من الحب نجمه لا يحول | |
| ونشرت الهدى على جانبيه | علماً شع فوقه قنديل | |
| وبذرت الإسلام فهو مراح | للبرايا ومربع ومقيل |
الحُسَين بن علي بن أَبي طالب (ع)
ولد بالمدينة في الثالث من شعبان. وقيل لخمس خلون منه سنة ثلاث أو أربع من الهجرة وقيل: ولد في أواخر ربيع الأول. وقيل: لثلاث أو خمس خلون من جمادى الأولى والمشهور المعروف أنه ولد في شعبان.
ولما ولد جيء به إلى جده رسول الله فاستبشر، فلما كان اليوم السابع سماه حسيناً.
شهادته ومدة عمره
قتل شهيداً بكربلاء من أرض العراق عاشر المحرم سنة 61 من الهجرة بعد الظهر مظلوماً ظمآن صابراً محتسباً قال المفيد: يوم السبت والذي صححه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين: أنه استشهد يوم الجمعة. أما ما تعارفه العوام من أنه قتل يوم الاثنين فلا أصل له ولا وردت به رواية وكان عمره يوم قتل 56 سنة وخمسة أشهر وسبعة أيام أو خمسة أيام أو تسعة أشهر وعشرة أيام أو وثمانية أشهر وسبعة أيام أو خمسة أيام أو 57 سنة بنوع من التسامح بعد السنة الناقصة سنة كاملة أو 58 سنة أو 55 سنة وستة أشهر على اختلاف الروايات والأقوال المتقدمة في مولده وغيرها. عاش منها مع جده رسول الله (ص) ست سنين أو سبع سنين وشهوراً وقال المفيد: سبع سنين ومع أبيه أمير المؤمنين 37 سنة قاله المفيد ومع أخيه بعد وفاة أبيه نحو عشر سنين وقال المفيد: إحدى عشرة سنة. وقيل: خمس سنين وأشهراً للاختلاف في وفاة الحسن (ع).
وكنيته: أبو عبدالله.
أولاده
له من الأولاد ستة ذكور وثلاث بنان. علي الأكبر شهيد كربلاء أمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفية. علي الأوسط. علي الأصغر زين العابدين أمه شاهزنان بنت كسرى يزدجرد ملك الفرس ومعنى شاهزنان بالعربية ملكة النساء. وقال المفيد: الأكبر زين العابدين والأصغر شهيد كربلاء والمشهور الأول. ومحمَّد. وجعفر مات في حياة أبيه ولم يعقب أمه قضاعية. وعبدالله الرضيع جاءه سهم وهو في حجر أبيه فذبحه. وسكينة أمها وأم عبدالله الرضيع الرباب بنت امرىء القيس بن عدي. وفاطمة أمّها أم إسحاق بنت طلحة بن عبدالله وزينب. وعقبه من ابنه علي زين العابدين.
ثورته
خلا الجو لمعاوية بعد مقتل الحسن بالسم، أما زياد بن أبيه فقد تكفل بالقضاء على كل العناصر القيادية في العراق، مستعملاً في ذلك أبشع الوسائل.
وفي المدينة عاشت الأرستقراطية العربية في بحبوحة من العيش، عاشت في قصور ناعمة يجلب إليها من كل الأقطار وسائل الترفيه، ويعيش في غرفاتها القيان والعبيد، ويجلس الأمير في حاشية من صحبه وخدمه والمتزلفين إليه.
وكانت أرستقراطية المدينة تكون أساساً من الولاة السابقين الذين فروا بمال بيت المال، أو أغدق عليهم معاوية ما شاءت له سياسته ليتقاعدوا ويكفوا يدهم عن السياسة.
ومن كبار المحاربين وذي الأعطيات الضخمة وأصحاب الثروات الطائلة، ومن أبناء هؤلاء جميعاً وأتباعهم. وستصبح المدينة بعد ذلك مكاناً شاعرياً يظهر فيها الغناء والشعر والموسيقى والرقص كأزهى ما كانت عليه مدينة في عصور الازدهار القديمة.
ومن الممكن تصور كيف كانت تفكر هذه الأرستقراطية. كانت أحاديث السياسة هي الغالبة، وكان البحث عن مواقع القوى ومراكز التجمع والأنصار هو شغلهم الشاغل، في المدينة كذلك كان الحسين ظاهراً كأكثر الرجال شعبية، وأظفرهم برضاء عامة المسلمين وقواعدهم. وكان هناك أيضاً عبد الله بن الزبير، كما كان هناك سعد بن أبي وقاص، كما كان هناك مروان بن الحكم قطب بني أمية الكبير، كما كان هناك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وغير هؤلاء كثيرون من نفس الطبقة أو أقل قليلاً.
وكل من هؤلاء كان يتطلع إلى الخلافة وينظر إلى السياسة ويفكر فيها من هذه الزاوية. ووراءهم مباشرة يأتي الولاة الذين يستمدون سلطانهم في حكم أمصار ضخمة كالعراق ومصر وغيرهما من الانضمام إلى هذا الفريق أو ذاك.
والنظام الفوقي للدولة يتكون عموماً من هذه الأرستقراطية التي تصطرع فيما بينها على السلطة وتكون كل منها تجمعات حولها في مواقع مختلفة تستفيد منها في تدعيم نفوذها، وتربص باللحظة المناسبة للوثوب إلى السلطة.
ولكن أقوى الأحزاب جميعاً، هو الحزب الحاكم المنتصر، حزب معاوية الذي لم يكن يملك النفوذ فقط، بل يملك القوة الرسمية الضاربة أيضاً. وهي القوة الوحيدة المنظمة. وإذا كانت الأرستقراطية العربية المقيمة في المدينة تملك المال الوفير، فإن هذا المال لا يقاس ببيت المال الذي يتحكَّم فيه معاوية، والذي يجبى إليه من جميع الأمصار التي تخضع لحكم الدولة.
وفي هذا الصراع العنيف من أهل السلطة، كثرت التجمعات، وغلبت المصلحة على كل شيء، ووصلت الأخلاق العامة إلى أقصى درجة في الانحدار.
ورأينا كيف يخرج الرجل من ولاء إلى ولاء في سهولة ويسر، وهو في ولائه الثاني أكثر التزاماً من ولائه الأول، ثم لا يلبث أن ينتقل إلى ولاء ثالث بنفس القوة. على تعارض كل جبهة من هذه الجبهات.
وكان القتل هو أبسط الوسائل التي يستعملها الحكام في هذا الصراع، إذ كان التمثيل بالجثث والصلب على الأشجار، وتقطيع الأيدي والأرجل، وألوان العقاب البدني المختلفة هي لغة الحديث اليومية، أما الوقيعة والدس والتزلف والخيانة والسرقة والنهب فهي السمة العامة لتلك المرحلة.
وفي سبيل السلطة لم يكن الرجل ذو النخوة يخجل من أن يثلم عرضه إذا كان في هذا منفعة.
وقصة زياد بن أبي قصة غريبة تدعو للتأمل، حيث نسبه معاوية إلى أبيه أبي سفيان ليكون أخاه، مدعياً أن أبا سفيان قد عاشر أمه سمية وهي زوجة رجل آخر فأنجب زياداً منها.
وأغرب ما في هذه القصة أن ادعاء هذه الأخوة تم في مجلس علني رسمي حتى يتحقق الادعاء على رؤوس الأشهاد فلم يخجل منه زياد، موازناً بين مغانم هذه الأخوة وبين ازدراء الناس له. ففضل أخوة الخليفة على سلامة العرض. وزياد كان في أول أمره مع علي.
ثم على يدي زياد لاقى العلويون القتل والصلب والتقطيع، بعد أن عمل لمعاوية، وكأن بينه وبين البشر ثأراً قديماً.
وزياد هو صاحب قصة حجر المشهورة التي قتل فيها ستة من المسلمين الشرفاء لأنهم رفضوا أن يسبوا علياً أمام الناس، فهذا الانتهازي الغريب الذي كان إلى جانب علي كان يدعو الناس فيأمرهم بأن يسبوا علياً، حتى إذا امتنعوا أوقع بهم أبشع أنواع العذاب.
وقصة حجر وأصحابه أخذت من كتب التاريخ الإسلامي صفحات كثيرة، فكان يؤتى بالرجل منهم بعد أن يحفر قبره أمامه ليعدل عن موقفه فإذا أبى قتل ودفن في قبره المحفور.
والذي فعله زياد هذا يقصر عما فعله بعده ولده عبيدالله بن زياد.
على أن هناك حادثة أخرى تثير التأمل وتكشف عما يستطيع أن يفعله الطموح إلى السلطة بالإنسان وكرامته كما تستطيع أن تكشف عن أخلاقيات معاوية ووجهة نظره إلى الحياة.
فهناك رجل اسمه عبدالله بن سلام كان والياً لمعاوية على العراق تزوج من امرأة هي أرينب بنت إسحاق، وقيل إنها كانت أجمل امرأة في عصرها وأن يزيد بن معاوية رآها فأحبها حتى أمرضه الحب. وعرف معاوية بهذه القصة، وأن المرأة امتنعت على ولده ففكر في أن يطلقها من زوجها ليزوجها من يزيد.
أرسل معاوية إلى عبدالله بن سلام فاستدعاه. وعندما جاء قربه إليه ثم فاتحه في أن يزوجه من ابنته، فما كان من الرجل إلاَّ أن طار فرحاً. ولكن معاوية عاد فقال: إنه لا ينبغي أن يجمع إلى زواجه من ابنته زوجة أخرى، ولم يفكر عبدالله بن سلام إلاَّ قليلاً، فطلق امرأته أرينب وبعد الطلاق فوجىء بأن ابنة معاوية ترفض زواجه، وأن معاوية رجل متحضر يرفض أن يرغم ابنته على زواج تأباه.
أما أرينب فقد رفضت طلب رسول معاوية، وإنقاذاً للموقف سارع الحسين بزواجها، حتى إذا رجع عبدالله بن سلام خائباً، ردها الحسين دون أن يقربها.
مثل هذه القصة تكشف عن المدى الذي وصلت إليه أخلاق الناس، وكيف استطاع الحكم أن يفسد هذه الأخلاق حتى يهبط بها إلى هذا المستوى.
وسنجد أن الأخ يخذل أخاه والابن يعق أباه، وأن الخوف والطمع هما المحركان الأساسيان في هذا المجتمع.
وفي هذا الجو المخيف من انهيار القِيم فكر معاوية في أن يورث الخلافة في بيته ولم ينقض نصف قرن على الإسلام.
وتروي الكتب القديمة أن معاوية قد أوحي إليه بهذه الفكرة من أحد الدهاة المتزلفين هو المغيرة بن شعبة، وكان الخليفة قد غضب عليه في أمر من الأمور، فأراد أن يشتري رضاءه بهذه الزلفى، وأن يضيف إليها إسهامه في انتزاع البيعة من الولاية التي يحكمها.
ومثل هذه الرواية لا تستبعد في هذه الظروف، والواقع يؤكدها، فقد انتهى الأمر فعلاً إلى خلافة يزيد بن معاوية.
ولكن الغريب أن يزيد هذا كان سكيراً عربيداً متبطلاً. وقصة غرامه بأرينب بنت إسحاق تكشف عن طبيعته المتبطلة المتفسخة. وإنها لجرأة في النفاق من المغيرة بن شعبة هذا، أن يقترحه على معاوية خليفة للمسلمين.
وبدأ معاوية يعمل لتنفيذ الفكرة، غير عابىء برد الفعل الخطير الذي سيحدثه في الرأي العام للمسلمين، فما من مسلم إلاَّ ويعلم سيرة يزيد، وما من مسلم إلاَّ ويرفض أن يتحوَّل الإِسلام إلى كسروية أو قيصرية.
ومع ذلك فقد فرض يزيد خليفة على المسلمين وبويع بالخلافة في عهد أبيه.
ولسنا في حاجة إلى تقصي قصة هذه البيعة ولا ما قيل من روايات كثيرة عن الأسلوب الإرهابي الذي اتبعه معاوية إلاَّ أن الواضح أن الشعب كان في واد والسلطة في واد آخر. وحين يحكم السيف، تضيع الكرامة ويستسلم الناس ويستدعون من أنفسهم كل الكوامن الخبيثة ليعايشوا السلطة القاهرة بأسلحة من طباعها.
وفي بعض فترات التاريخ يبدو الواقع حاداً شديد الحدة. فيخيل للإنسان الذي يعايش هذا الواقع أن كل ما قرأه عن القيم الخيرة، والنزوع البشري إلى الخير، إن هو إِلاَّ أوهام كتَّاب حالمين لم يصطدموا بالواقع. فعند احتدام هذا الواقع لا يستطيع الإنسان أن يميِّز بين الخطأ والصواب.
وحين ينتصر الباطل في أفضح صورة في موقعة إثر موقعة، ويكتسح الحكم الإرهابي أمامه كل العقبات، يحدث ما يشبه الوباء العام. وتصبح غالبية الناس جبناء ونهازين وقتلة ومجرمين، حتى يصعب تصديق أن الطبيعة الإنسانية تحتوي على أي إحساس يمت للخير بصلة.
إن نفوس الناس تنهار واحدة إثر الأخرى والعدوى تنتقل انتقال الوباء المستشري وتفقد البشرية إحساسها بالكرامة، وكأنها هي تحكم على نفسها بالانحطاط إلى أبعد مدى، تعاقب نفسها بما ترتكبه من آثام.
وليست بعد ذلك صراعاً بين قوى ظالمة وقوى مظلومة، إنما هي في الواقع صراع بين القِيَم الإنسانية العليا والقيم السفلى. ومهما تلبس القوى المتحكمة تصرفاتها من أردية المنطق والعدالة والسياسة فإنها في الواقع تنخر في صميم الكيان البشري، وتوشك أن تؤدي بهذا الكيان إلى الفناء.
وكل سلطة متحكمة ترى دائماً إلى جانب السيف والمال مفكريها الذين يفلسفون التسلط ويبررونه. ولقد كان معاوية يردد كثيراً «يؤتي الملك لمن يشاء» وكأن ملكه قدر إلهي. وإن هذا القدر قد اختاره، وبناء على ذلك فكل سلوك له يستمد شرعيته من هذا الاختيار.
ولنا أن نعجب وندهش من تلك الآراء التي تعبر عن نفسها بوقار العلم والموضوعية وبمنطق حتمية التاريخ لتصور المرحلة على أنها مرحلة بناء الدولة وأن معاوية كان رجل دولة. وفي سبيل هذا البناء التزم سياسة واقعية بارعة، في مقابل سياسات خيالية اتبعها خصومه من أصحاب الدعوة إلى العدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية.
وكثير من هؤلاء المؤرخين يرون أن منطق التطور من الوضع القبلي إلى الدولة المركزية، هو الذي يبرر كل ما حدث من جرائم لإنشاء هذه الدولة، ومع ذلك فالدولة لم تعمر بعد ذلك إِلاَّ ستين عاماً، ولم تلبث أن انهارت انهياراً كاملاً.
قوى الثورة
كان صن يات صن الزعيم الروحي للصين الحديثة يقول عقب كل فشل لثورته الوطنية: هذا هو فشلنا الرابع أو الخامس أو العاشر، إلى آخر سلسلة الفشل التي تعرضت لها الثورة الصينية قبل أن تنتصر.
والواقع أن تاريخ البشرية جميعاً هو سلسلة من الثورات الفاشلة، حتى تتحقق ثورة ناضجة لا تلبث هي الأخرى أن تتجمد أو تغتصب؛ لتظهر ثورات أخرى تتابع فشلها حتى يتحقق النصر الحاسم.
والثورة ليست سابقة لأوانها أبداً فالشرارة الأولى هي دائماً الإعلان الحاسم بوجوب نقلة أخرى، وهذه النقلة قد تنتظر طويلاً حتى تتحقق، ولكن دون أن تظهر هذه الشرارة، فإن الثورة لا تولد، بل تصبح في حكم العدم.
والثورة ليست مجرد تغيير تنشده وتعمل له مجموعة مقهورة، لتلغي قهرها وتسترد حقوقها، بل هي أعمق من هذا، أنها طريق في سلم التطور الأخلاقي للمجموعة البشرية وهذا السلم يبدأ من السلوك الفردي في أبسط صوره، إلى السلوك الجماعي للأمة والإنسانية بشكل عام.
وكان الصراع من أجل توزيع الثروة هو ذريعة قانون التطور للوصول إلى مستوى أخلاقي أعلى للمجموعة البشرية.
وآية ذلك أن قادة الثورات لا تحركهم إلى الثورة ضغوط الحرمان أو القهر وحدها، بل قِيَم إنسانية أعلى من القيم السائدة، بل أن هؤلاء القادة غالباً ما يكونون واقعين تحت ضغوط غير مادية، بل لعلهم في الأغلب لا يعانون من أي ضغط أو حرمان مادي. أن التركيبة النفسية لقادة الثورة تتناقض مع القيم الأخلاقية السائدة في مجتمعهم، فهم يحسون بدوافع قوية للدفاع عن المثل التي أهدرت ويشعرون باختلال الطريق البشري إلى الارتقاء الروحي وأنهم منذورون لإعادة الجماعة الإنسانية إلى الطريق السوي. وكثيراً ما يكون القائد الثوري محكوماً عليه بالاندفاع في طريق الثورة بحيث لا يملك التراجع حتى ولو أراد. أن طبيعته تدفعه إلى الثورة حتى لحظات الخطر الماحق والعذاب الرهيب.
ولسنا ندري لماذا يختار البطل الثوري الجانب الخاسر في اللحظات الحاسمة حين يكون الاختيار بين أمرين: التراجع الآمن، والعذاب المحقق.
وكما ينطبق هذا على الثائر القائد ينطبق على الثائر الجندي. وعلى المشانق والمفاصل والصلبان وفي حجرات التعذيب الحديثة والقديمة يظهر هذا الجنون المصمم المنتحر. وهو جنون يقابل جنوناً من نوع آخر جنون السلطة الذي يجافي كل قيمة من القيم الإنسانية، جنون وحشي مصمم يثير من الدهشة ما يثيره ثبات الثائر وإصراره.
وأروع لحظات الاستشهاد لا تظهر إلاَّ في لحظات الانحدار الروحية الشديدة وكأن المجموعة البشرية تلقي كل إمكانياتها في هذه اللحظات الشديدة الخطورة.
عندئذٍ يصبح الصراع الطبقي مجرد ذريعة لتتخطى البشرية هوة الانحدار الأخلاقي.
وأمامنا الكثير من قصص الغدر والخيانة والتوحش في تلك الفترة لتدلنا على مدى ما وصل إليه الانهيار الأخلاقي في تلك الفترة التي عزم فيها الحسين بن علي على التصدي للنظام.
فلقد رأى الحسين كيف تخاذل الأنصار عن أبيه، ورأى ضعف الناس إزاء السلطة والإغراء. ورأى غير ذلك من الحوادث الغريبة التي تشكك الرجل في نفسه.
ومع ذلك خرج الحسين. وهو يحسب أن الناس ما زالوا يطلبون العدل الاجتماعي، وأنه من الطبيعي أن ترفض الكرامة البشرية أن يفرض عليها حاكم سكير عربيد في مجتمع يعتبر السكر والعربدة معصية تستوجب عقاب الله والمجتمع.
والحسين من اللحظة الأولى قد اختار دوره، أو على الأصح قد اختاره دوره. فطبيعته ترفض كل ما يحدث، وهي ترفضه لحد الأزمة، أن السيف والإرهاب يطالبانه بالبيعة ليزيد فلا يبايع ويأوي إلى مكة. وفي مكة يتقاطر حوله الناس يدعونه إلى الخروج وطلب البيعة. ولو لم يطلب إليه الناس ذلك لكان قد خرج أيضاً أو لمات قهراً. فإلى جانب الذين حضوه على الخروج كان هناك الذين يحضونه على إيثار السلامة. وكانوا من أخلص الناصحين له. ومع ذلك لم يقبل السلامة.
جاءته الكتب من العراق بأنه لو وفد عليهم لبايعوه، فاتخذ هذه الكتب ذريعة ليلعب دوره المقدور عليه.
أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى أصحاب هذه الكتب يستطلع الأمر، واستقبل مسلم استقبالاً حسناً ولم يملك الوالي هناك أن يتصدى له، بل كل ما فعله هو النصح. فما أن علم مستشارو الخلافة الدهاة بموقف الوالي حتى اقترحوا عزله وتعيين عبيدالله بن زياد ابن أبيه مكانه فجاء عبيدالله هذا وهو النموذج المقابل لمسلم وللثوار. رجل السلطة الذي تحكمه طبيعته أيضاً ليوغل في الإثم إلى الدرك الأسفل، ونشبت المعركة سجالاً بين الجبن والشجاعة وبين اللؤم والنبالة. فهو يفر من وجه الجماهير ويحتمي بالقصر، ثم يظهر في صورة الجبار حين تفرق الجماهير، ويخلف العهد، ويغري بالمال، ويغري بالسلطة، ويستعمل سلاح الإرهاب والتخويف، حتى يستطيع أخيراً الظفر بمسلم فيقتله قتلة شنعاء ويلقي بجثته من أعلى القصر.
وتأتي كتب مسلم إلى الحسين بأن عشرات الألوف ينتظرونه لمبايعته ويتحرَّك الحسين فيبلغه ما حدث لمسلم، وبدلاً من أن يتراجع مؤثراً السلامة يقرر المضي إلى العراق ويمضي الحسين وليس معه إِلاَّ سبعون رجلاً ونساؤه وأطفاله، محتجاً لنفسه ولأهله ونفره القليل بأنه حين يدخل العراق سيلتف الناس حوله. وكان يعني أن وجوده بينهم سيقضي على خوفهم وتخاذلهم ويردهم إلى آدميتهم. وهو بذلك يحدد دوره، أنه بعث الروح من جديد ليس أكثر.
وفي هذه اللحظة يكون الحسين قد أدرك الموقف كله فهو يعلم أن جيوش عبيدالله بن زياد قد تعترضه، بل هي تعترضه قطعاً، وعندئذٍ تكون النهاية.
ولكن الحسين كان يعلم أنه لا بد من فدية ضخمة. فدية تتوهج بالدم وكان هو الوحيد الذي يملك أن يتقدم كفدية تهز الضمير شبه الميت في قلب الأمة.
إن الأمر هنا ليس حنكة سياسية وليس غفلة سياسية، ليس واقعية أو رومانتيكية، إنه أمر واضح تماماً، يرتفع عن مستوى الغفلة أو الخيال أذكى وأشرف رجل في عصره يقدم نفسه ليوغل فيه أعداء القيم العلياء ما شاء لهم انحدارهم كآخر ما يستطيع أن يصل إليه الشر فتكون الصرخة التي توقظ ضميراً خربوه بكل الوسائل.
وهكذا مضى الحسين في طريقه إلى العراق، فتخاذل عنه من تخاذل، واختفى حوله صغار النفوس، الذين ساروا في موكبه أول الطريق حين علموا بخروجه إلى البيعة. لم يمض معه إِلاَّ هؤلاء الذين تمثَّلت فيهم الثورية بمعناها العميق، ثورية التغيير الجذري للقيم ذاتها.
وتبلورت القوى الثورية هنا في هذه الجماعة الصغيرة التي تقطع الصحراء، متحدية، مصمِّمة، ليس لها من أمل إِلاَّ في أن تعدي الناس بالثورة، وأن تعدي بالذات تلك الجيوش التي قد تقطع عليها طريقها إلى العراق.
وهذا الأمل هو الذريعة التي يتذرع بها الحسين ليحقق هدفه، وهو الشهادة في أكمل صورها.
وفي الطريق يسأل مجمعاً بن عبيد العامري فيجيبه «أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم فهم ألب واحد عليك، وأما سائر الناس فإن قلوبهم تهوي إليك، وسيوفهم غداً مشهورة عليك».
وفي هذه الجملة تلخيص ذكي للقوى القائمة، فكبراء الناس، هؤلاء الذين يملكون الثروة، لم يعد يهمهم في شيء أن يخرج حفيد النبي بل لعل خروجه يهمهم من زاوية أخرى، وهو أن هذا الحفيد يريد أن يغير مراكز القوى، وأن يعيد توزيع الثروة، وأن يمضي في نفس الطريق الذي مضى فيه أبوه، فهو من هذه الناحية عدو طبقي لا يهمل خروجه في طلب البيعة. إنه الحسين بن علي بن فاطمة الزهراء ابنة رسول الله، والسلطة قوية ولتفعل ما تشاء.
ولكن السلطة ليست بهذه البلاهة أنها لا تلقي بدم الحسين على عاتقها وحدها فمن أراد أن يدافع عن ثروته، وعن مركزه الاجتماعي فليشترك في دم الحسين.
وسنرى أن رجالاً من هذه الطبقة أهيب بهم أن يشتركوا في قتل الحسين وكانوا بين خوف من غضب السلطة والشك في ولائهم للمصلحة الطبقية الواضحة وبين أن يأثموا بدم الحسين.
على أن الأمر لم تكن له هذه الخطورة فمن قبل قُتل علي نفسه، ومن بعده قُتل الحسن مسموماً، كما قتل محمَّد بن أبي بكر. أن الإحساس بالإثم كان إحساساً هيناً يمر بالخاطر مراً سريعاً ولولا أن الحسين بالذات تربي في حجر النبي ولولا أنه رجل يمثل الصورة المثلى للإسلام، لما مر مثل هذا الخاطر بأحد.
ومن الناحية الأخرى فإن سائر طبقات الشعب قد بلغ بها القهر والشك والخوف ما يجعلها تتردَّد ألف مرَّة في الثورة. وفي العراق بالذات كان الرجل يؤخذ بمجرد الشبهة، وسيرة زياد ابن أبيه لم تنس بعد، فقد خطب فيهم خطبة خطيرة ورد فيها أنه سيأخذ البريء بالمسيء.
لاقى شعب العراق صنوفاً من الضغط لم يلقها شعب آخر جيلاً وراء جيل، فكيف كان يمكن لهذا الشعب المطحون أن يهب لمساندة الحسين. والخوف يقضي على كل كرامة وقد استطاع الحكم الأموي أن يزرع الخوف وأن يجعله القوت اليومي للشعب العراقي.
وبهذه الصورة لم يكن لخروج الحسين إلاّ معنى واحد هو الشهادة.
التراجع والشهادة
وأي سياسي آخر غير الحسين كان يستطيع تقدير الموقف، وأن يتراجع في الوقت المناسب، أو يرى طريقاً آخر للكفاح. أما التراجع فقد كانت فرصته أمامه حين شارف أرض العراق وجاءته أنباء مقتل رسوله مسلم بن عقيل وانفضاض الناس من حوله.
ومع ذلك فقد استمع باهتمام إلى واحد من صحبه يقول: «ما أنت مثل مسلم بن عقيل، ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع».
واقتنع الحسين، لم يفكر ولم يتدبر موقفه.. أكان ذاك عن سوء تدبير؟
لا يستطيع أحد أن يحكم هنا بسوء تدبير الحسين، فهو منذ تحرك من مكة كان يعلم أن الوضع قد بلغ الحد الذي يدفع إلى المواجهة إلى القتال الصريح مهما تكن القوة التي تجابهه.
وقد تأكد له الموقف بعد ذلك، حين أرسل قيساً بن مسهر الصيداوي فقتل هو الآخر، ثمن عاد فأرسل عبدالله بن بقطر فألقي من شرفات القصر. أي شيء إذن كان يتوقعه؟
إنه يلح في الاتصال بالشعب، فقد وضع أمله فيه، وإن لم يستطع الاتصال به عن طريق الكتب، إذ كان رسله يقتلون واحداً بعد الآخر فليس هناك إلاَّ أن يتصل بهم بحدث يزلزل كيانهم أهذا كان تفكير الحسين؟
ليس من الضروري أن تكون هذه الفكرة واضحة في الذهن، يكفي أن تكون هي الموجه لكل تصرف، وجميع تصرفات الحسين تؤكد أن مثل هذه الفكرة وراءها.
لم يكن أمامه إلاَّ أن يتراجع، وكان له أكثر من مبرِّر للتراجع فهؤلاء الذين كتبوا إليه يستقدمونه انفضوا عن رسوله حتى قتل. وها هوذا يرسل رسلاً آخرين فلا يكون حظهم خيراً من حظه.
فلماذا لم يتراجع؟ ألأنه كان عليه عندئذٍ أن يمنح البيعة ليزيد، وكانت هذه في رأيه أكبر الكبائر، أليعتكف في حرم الكعبة، وهل كان ليزيد أن يتحرج عن قتله في قلب الحرم.
ليس أمامه إِلاَّ أن يمضي في طريقه فهو يعلم تماماً أن ظهوره أمام الشعب سوف يجمعهم حوله. يعلم كيف يحدثهم وكيف ينزع الخوف من قلوبهم ولكن كيف يصل إلى مداخل العراق، وعبيدالله بن زياد يرصد له الجيوش الآن.
إن الموقف لا يصعب تقديره على الرجل العادي.
ومن المؤكد أن الحسين كان محيطاً به من كل جوانبه. وربما خالجه ظن بأن أي جيش سيعترض طريقه لا يلبث أن يلين له حين يخاطبه فيزيل الغشاوة عن عينيه. هذا خاطر لازمه مع خاطر آخر لم يفارقه، وهو أنه مقتول بغير شك، إذ كان يردد أن الموت كتب على ابن آدم..
كان يضع موته في كفة وثقته في الناس في كفة. فهو لم يفقد الثقة في الجوهر الكامن في النفس الإنسانية ذلك الجوهر النازع إلى الارتقاء الروحي.
ومرة أخرى لم يتراجع الحسين بل مضى في طريقه.
الصدام الأول
لم يكد الحسين يمضي إلاَّ قليلاً حتى التقى عند جبل ذي حسم بجيش من ألف فارس يقوده الحر بن يزيد، وهو أحد الأشراف الذين أشار إليهم مجمع بن عبيد العامري، بل سنرى أيضاً أن اختيار الرجال الذين سيحاربون الحسين تم بدقة حتى تتبلبل أفكار الشعب، فالقائد الذي قاتل الحسين في معركته الأخيرة كان عمر بن سعد بن أبي وقاص، ابن صحابي كبير.
ماذا يقول الشعب عندئذٍ… ابن علي بن أبي طالب، يقاتله ابن سعد بن أبي وقاص!!
وإنه لأمر مثير للدهشة أن يأتمر عمر بن سعد بن أبي وقاص، بأوامر عبيدالله بن زياد. ابن فاتح فارس وصحابي رسول الله، يأتمر بأمر ابن زياد مجهول الأب، المشكوك في نسبه!!
بل أن عمر لا يأتمر بأمر عبيدالله فحسب، بل يتملق ويدهن إليه. فحين جيء بمسلم بن عقيل بين يدي عبيدالله طلب مسلم أن يفضي بكلمة إلى عمر، وتقدم إليه عمر فهمس مسلم في أذنه مناشداً قرابته أن ينفذ وصيته التي سيفضي بها إليه، وهي أن يرد ديناً عليه قد اقترضه من رجل بالكوفة فيبيع سيفه ودرعه ويوفي دينه، وأن يرسل إلى الحسين من يمنعه من المجيء مصححاً رسالة سابقة بأن الناس معه.
إن عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يكتم السر الأخير بل بادر فأفشاه لعبيدالله بن زياد.
إلى هذا المدى فقد أعاظم الرجال كرامتهم، فإلى أي مدى فقد الشعب المقهور هذه الكرامة؟
وتقدم الحر بن يزيد فقال للحسين أنه أمر بأن يقدم به على عبيدالله بن زياد. لم يجبه الحسين بل أمر مؤذنه أن يؤذن لصلاة الظهر ثم خطب الجميع أصحابه وخصومه على السواء. أو خصومه بوجه خاص: «أيها الناس، أني لم آتكم حتى أتتني كتبكم ورسلكم أن أقدم علينا فليس علينا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق.. فقد جئتكم.. فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا أو كنتم لقدومي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه».
وكانت لحظة صمت جماعية، لا يدري أحد ما جرى في أذهانهم، ولعلهم كانوا جميعاً يودون لو يقاتلون من أجله. ولكن الخوف والمصلحة وكل عروض الدنيا كانت تقف دون ذلك.
عندئذٍ التفت الحسين وقال للمؤذن «أقم الصلاة»، ثم التفت للحر بن يزيد وسأله: هل يصلي كل فريق على حدة؟ فقال الحر: بل نصلي بصلاتك.
وانتهت الصلاة خلف الحسين وبدأ ركب الحسين يتجه وجهته، وبدأ الحر يتعقبه، وكلما اتجه وجهة أخرى حاصره ورده إلى طريق الكوفة. وأخيراً وقف الحسين مرة أخرى يعظهم:
«أيها الناس… أن رسول الله قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيِّر ما عليه بعمل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله، وحرموا حلاله. وأنا أحق من غيّر وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم وأنكم لا تسلمونني ولا تخذلونني، فإن بقيتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، وأنا الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله، نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهلكم فلكم فيَّ أسوة. وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي، وخلعتم بيعتي، فلعمري ما هي لكم بنكير والمغرور من اغتر بكم، فحظكم أخطأتم، ونصيبكم ضيعتم. ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وسيغنيني الله عنكم».
ولكن الخطبة أعقبها صمت تام، ثم تقدم الحر يحذره بأنه إذا قاتل فسيقتل، فصاح فيه الحسين «أبالموت تخوفني؟».
واصطبر الحسين ومضى والحر وراءه يمنعه كلما ابتعد عن طريق الكوفة، والحسين يرفض أن يبدأه بالقتال.
وأخيراً ظهرت طلائع جيش جديد من أربعة آلاف رجل على رأسهم عمر بن سعد بن أبي وقاص لا أحد غيره!
وانتهى الأمر بين الطرفين إلى أن حصر الحسين وصحبه في كربلاء. وبدا أن الحرب لا بد أن تقع. فبعد قليل وصل شمر بن ذي الجوشن ليكون رقيباً على عمر بن سعد بن أبي وقاص وقائد إذا تخاذل.
وهنا جمع الحسين أصحابه، وقال لهم: «لقد بررتم وعاونتم والقوم لا يريدون غيري. ولو قتلوني لم يبتغوا غيري أحداً.. فإذا جنكم الليل فتفرقوا في سواده وانجوا بأنفسكم».
ولم يقبل واحد منهم أن يترك الحسين ويهرب بحياته..
ويعود الحسين فيلح في هذا، فلا يخرج من معسكره رجل واحد.
وكانوا سبعين رجلاً بأزاء خمسة آلاف رجل.
عرض عمر بن سعد التسليم فرفض الحسين، بل طلب الاحتكام إلى الشعب.
وحصر الحسين وصحبه عند كربلاء بعيداً عن الماء حيث يحميه جيش عمر بن سعد، واشتد الظمأ بالأطفال والنساء، وحمل الحسين ولده عبدالله ليسقيه بنفسه، ظاناً أن وجوده ومعه الطفل قد يمنع محاصريه من إيذائه، ولكنهم رشقوا الطفل بسهم فسقط صريعاً بين يدي أبيه.. وتمالك الحسين أمام هذا كله نفسه، فإلى آخر لحظة كان يأمل في أن يبعث الروح في هذه الضمائر الميتة.
وتقدم الحسين يخطب الجيش وهو في رداء النبي (ص). فإذا بالجيش يحدث من الضجيج والضوضاء ما يغطي على كلامه. ولم يتراجع الحسين، بل ظل صامتاً حتى هدأت ضجتهم ثم انفجر قائلاً: انسبوني من أنا.. هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ أو لم يبلغكم ما قاله رسول الله لي ولأخي: «هذان سيدا شباب أهل الجنَّة..» ويحكم.. أتطلبونني بقتيل لكم قتلته أو مال لكم استهلكته؟».
وقد أحدثت هذه الكلمات أثرها كالسحر؟ وبدأت الرجال من جيش عمر بن سعد تنضم إلى جانب الحسين، وكان أولهم الحر بن يزيد.
وكان الموقف خطيراً فلو انتظر عمر قليلاً لانفرط الجيش كله. كما أنه خشي الرقباء أن يبلغوا يزيد بما حدث، فما كان إلاَّ أن تناول سهمه ورمى به جماعة الحسين، وهو يصيح اشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى الحسين.
وهكذا بدأ القتال في توتر وسرعة لا تتيح لكلمات الحسين أن تفعل أثرها.
وقاتل الحسين وصحبه قتالاً مجيداً حتى سقطوا جميعاً، وسقط الحسين مثقلاً بجراحه، مصاباً بمائة وعشرين طعنة.. ثم تقدم شمر بن ذي الجوشن فاحتز رأسه.. ثم وطأوا جسده الشريف بخيولهم حتى رضوا ضلوعه ومثلوا به أشنع تمثيل.. وحملوا الرؤوس ومضوا بها على أسنة الرماح إلى عبيدالله بن زياد.. ثم إلى يزيد بن معاوية!
وبذلك انتهت أول جولة للعدل مع الظلم. انتهت بأروع استشهاد وأعظم بطولة. وكانت شهادة الحسين أعظم انتصار للثورة، لأنها تغلغلت في الضمير العربي والإسلامي، وأحيت الضمائر التي خنقها الإرهاب، لتسقط بعد ذلك بستين عاماً فقط… دولة بني أمية.
أحمد عباس صالح
دراسة الثورة
لعل أصعب ما يواجه الباحث المؤرخ هو أن يضع خطاً حاسماً يفصل بين مرحلتين تاريخيتين لمجتمع ما، فإن تحوّل المجتمع من حالة إلى أُخرى بطيءٌ وتدريجي، ولذلك فمن العسير تعيين وحدة زمنية والقول بأنها خاتمة عهد وبداية عهد جديد.
وهذه هي الصعوبة التي نواجهها هنا حين نبغي وضع تحديد زماني دقيق للمرحلة التاريخية التي بدأت الأُمة المسلمة تشهد فيها الانحراف الصريح عن مبادىء الإسلام، ولكننا نستطيع أن نشهد هذا التحول واضحاً منذ بداية النصف الثاني من عهد عثمان.
ومن الطبيعي، إذن، أن تكون قد أعدت ومهدت سبيل الظهور لهذا التيار الجديد في المجتمع أحداث وأشكال جديدة في التنظيم نشأ ـ هذا التيار ـ من تفاعلها مع ذهنية الفئات التي كانت تحكم المجتمع الإسلامي آنذاك وتقوده.
وعلينا ـ لكي تستوفي هذه الدراسة شروط البحث الموضوعي ـ ألا نكتفي بالظواهر فقط، بل نمضي في البحث عن جذور هذه الظواهر في تصرفات الجماعات والرجال الذين صاغوا تاريخ هذه الفترة، منبهين إلى أننا هنا إنما نبحث عن طبيعة الأحداث وآليتها، ومدى مساهمتها في التعجيل بظهور هذا التيار الجديد في الحياة الإسلامية، دون أن نعنى بإصدار حكم أخلاقي على الرجال الذين صنعوا تاريخ هذه الفترة أو الأعمال التي كونت هذا التاريخ، بل نهدف من بحثنا اكتشاف الظروف الاجتماعية والإنسانية التي مهدت لثورة الحسين، لاعتقادنا بأن هذه الثورة، كغيرها من الأحداث الاجتماعية الهامة، لم تكن وليدة اندفاعات وقتية وإنما كانت نتاجاً للظروف الاجتماعية التي سبقتها.
ـ 1 ـ
وإذا استعرضنا جملة الأحداث التي كان لها تأثير في التمهيد للتطورات الكبرى في عهد عثمان وجدناها كثيرة، ولعل أهمها ثلاثة: منطق السقيفة، ومبدأ عمر في العطاء، وحادثة الشورى. ونظراً لما لهذه الأحداث من أهمية بالغة في تكوين هذه الفترة فإننا نخص كل واحدة منها بشيء من الحديث.
أ ـ منطق السقيفة
لا يسع الباحث أن ينكر أن وفاة النبي (ص) قد كشفت عن أن الروح القبلية كانت لا تزال متمكِّنة في نفوس كثير من المسلمين، فقد عبَّرت هذه الروح عن نفسها في أعمال الرجال الذين ظهروا على الصعيد السياسي في المدينة بعد وفاة النبي (ص) بساعات، وتحكمت في توجيه سير الأحداث التي توالت بسرعة مذهلة.
ففي سقيفة بني ساعدة اجتمع الأنصار يتداولون ـ بمعزل عن سائر المسلمين ـ في مسألة الحكم بعد النبي (ص) ويرون أنه من حقهم، بينما تكتل ضدهم فريق من القرشيين ينازعهم هذا الأمر، مع العلم بأن النبي لم يفارقهم إلاَّ بعد أن عهد بالحكم من بعده إلى علي بن أبي طالب الذي لم يشترك في أحداث السقيفة بسبب انشغاله مع الهاشميين وبعض الأنصار بجثمان النبي (ص) الذي كان لم يدفن بعد، ولكن تيار الأحداث الجارف، وتسابق الكتل السياسية، إلى اغتنام فرصة الذهول الذي أصاب أكثر المسلمين لوفاة النبي (ص) من أجل الوصول إلى الحكم، حمل الجميع على تناسي عهد النبي إلى علي بن أبي طالب، وقد تولى عمر في خلافته تبرير هذا الموقف في عدة أحاديث له مع عبدالله بن عبَّاس([543]).
وإذا فحصنا المنطق الذي استخدم في الجدل الذي دار آنذاك بين المهاجرين والأنصار نجد أن الروح القبلية ظاهرة فيه ظهوراً بيِّناً، فقد أثار كلام أبي بكر الأحقاد والإحن الكامنة بين الأوس والخزرج، وأغرى بينهما حين تحدث عما بين الحيين من القتلى، وعن الجراح التي لا تداوى، بينما نرى أن الحباب بن المنذر ـ خطيب الأنصار ـ قد تكلم بنفس جاهلي صرف حين تحدث إلى الأنصار يهيجهم ويشد من عزائمهم. ولم يخرج لسان المهاجرين عن هذه الروح حين قال:
(من ينازعنا سلطان محمَّد ونحن أولياؤه وعشيرته).
وقد سارت الأحداث في الاتجاه الذي رسمه أبو بكر، فانقسم الأنصار، بتأثير الروح القبلية التي تأججت، وانخذل سعد بن عبادة الخزرجي ـ مرشحهم للخلافة ـ حين بادرت الأوس فبايعت أبا بكر([544]).
هذه الروح القبلية التي عبَّرت عن نفسها يوم السقيفة فتحت على المسلمين باباً من أبواب الفتنة.
فقد خرجت قريش من هذه التجربة وهي ترى أن الحكم حق من حقوقها. وأن الخلافة وراثة آلت إليها بحكم كون نبي المسلمين منها. مما سبب أسوأ الآثار في فهم القرشيين لمهمة الحكم في الإسلام. وستظهر هذه الآثار واضحة في عهد عثمان.
ب ـ مبدأ عمر في العطاء
سوَّى النبي (ص) بين المسلمين في العطاء، فلم يفضل أحداً منهم على أحد، وجرى على مبدأ التسوية في العطاء أبو بكر مدة خلافته. أما عمر فقد جرى ـ حين فرض العطاء في سنة عشرين للهجرة ـ على مبدأ التفضيل:
«ففضل السابقين على غيرهم، وفضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين، وفضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة وفضل العرب على العجم، وفضل الصريح على المولى»([545]).
وفضل مضر على ربيعة، ففرض لمضر في ثلاثمائة ولربيعة في مائتين([546])، وفضل الأوس على الخزرج([547]).
وقد ولّد هذا المبدأ فيما بعد أسوأ الآثار في الحياة الإسلامية، حيث أنه وضع أساس تكون الطبقات في المجتمع الإسلامي، وجعل المزية الدينية من سبل التفوق المادي، وزوَّد الأرستقراطية القرشية التي مكَّنت لنفسها من جديد بتمكن أبي بكر من الحكم بمبرر جديد للاستعلاء والتحكم بمقدرات المسلمين، فجميع اعتبارات التفضيل تجعل القرشيين أفضل في العطاء من غير القرشيين([548]) وهذا يعني أن قريشاً هي أفضل الناس لأنها قريش، وكفى بهذا مبرراً للتحكم والاستعلاءِ.
وقد كوَّن هذا المبدأ سبباً جديداً من أسباب الصراع القبلي بين ربيعة ومضر وبين الأوس والخزرج بما تضمن من تفضيل سائر مضر على سائر ربيعة، وتفضيل الأوس على الخزرج. ونظن أن هذا المبدأ قد أرسى أول أساس من أُسس الصراع العنصري بين المسلمين العرب على العجم والصريح على المولى.
وكأن عمر قد أدرك في آخر أيامه الأخطار السياسية والاجتماعية التي يؤدي إليها مبدؤه هذا، ولعله رأى بعض الآثار الضارة التي خلفها هذا المبدأ في حياة المسلمين، ومنها هذه الظاهرة التي دلَّت على تسرب روح التحزب والانقسام إلى مجتمع المدينة، والتي لاحظها عمر وحذَّر منها بقوله:
«بلغني أنكم تتخذون مجالس، لا يجلس اثنان معاً حتى يقال: من صحابة فلان، من جلساء فلان، حتى تحوميت المجالس. وأيم الله إن هذا السريع في دينكم، سريع في شرفكم، سريع في ذات بينكم..»([549]).
ولذلك أعلن عزمه على الرجوع إلى المبدأ النبوي في العطاء فقال:
«إني كنت تألفت الناس بما صنعت في تفضيل بعض على بعض، وإن عشت هذه السنة ساويت بين الناس فلم أفضل أحمر على أسود، ولا عربياً على عجمي، وصنعت كما صنع رسول الله وأبو بكر»([550]).
ولكن عمر قتل قبل أن يرجع عن هذا المبدأ، فجاء عهد عثمان وسار عليه، فظهرت آثاره الضارة في الحياة الإسلامية، وكان من أهم العوامل التي مهَّدت للفتنة بين المسلمين.
ج ـ الشورى
وإذا كان التفضيل في العطاءِ قد خلق شعوراً بالامتياز والتفرد لدى قريش، فإن ما سمي بالشورى التي اقترحها عمر قد أثارت في نفوس كثير من الأشخاص البارزين في قريش آنذاك وفي نفوس قبائلهم وأنصارهم مطامح سياسية ما كانوا ليحلموا بها. فقد جعل عمر الشورى في ستة نفر من قريش، وكلهم مرشح للخلافة. وها نحن نثبت هنا نصاً يصوِّر لنا توزيع القوى السياسية أمام الحدث الذي يوشك أن يقع، وهو بيعة خليفة جديد للمسلمين بعد عمر بن الخطاب من بين هؤلاءِ المرشحين:
«.. فخرج عبدالرحمن ـ ابن عوف ـ فمكث ثلاثة أيام يشاور الناس ثم رجع، واجتمع الناس وكثروا على الباب، لا يشكون أنه يبايع علي بن أبي طالب([551])، وكان هوى قريش كافة ـ ما عدا بني هاشم ـ في عثمان، وهوى طائفة من الأنصار مع علي، وهوى طائفة أُخرى مع عثمان، وهي أقل الطائفتين»([552]).
فالناس يريدون علياً لأنهم يخشون سلطان بني أُمية، أما قريش فهي تخشى علياً وعدله واستقامته، ولعل كثيرين منهم كانوا على علم ببعض آرائه في المال والاجتماع والولايات، وأما الأنصار فكثرتهم مع علي وقلتهم مع عثمان، وهذا طبيعي بسبب خوفهم من تسلط قريش على جميع مقدرات الدولة.
وقد سيطر منطق السقيفة القبلي على بني أُمية في الجدل الذي دار في مسجد النبي في المدينة والذي سبق البيعة لعثمان وبدا واضحاً أن قريشاً اعتبرت الخلافة مؤسسة من مؤسساتها وشأناً من شؤونها الخاصة، وليس لأي من المسلمين أن يتقدم في الخلافة برأي يتنافى ورغباتها.
هذا عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي يقول للمقداد بن عمرو:
«يا ابن الحليف العسيف، ومتى كان مثلك يجترىء على الدخول في أمر قريش»([553]).
وقال عبدالله بن سعد بن أبي سرح الأُموي:
«أيها الملأ إن أردتم ألا تختلف قريش فيما بينها فبايعوا عثمان»([554]).
أما عمّار بن ياسر فقال:
«إن أردتم ألا يختلف المسلمون فيما بينهم فبايعوا علياً»([555]).
فعلي كان مرشح الأكثرية المسلمة، ولكن عثمان ـ مرشح الأرستقراطية القريشية ـ فاز بالبيعة دون علي بن أبي طالب.
فقد آلت الشورى، إذن في النتيجة إلى استيلاءِ الأُمويين ـ في شخص عثمان ـ على الحكم، ولكنها خلقت مواقف مختلفة من هذه النتيجة، حيث بدأ التفكير في الخلافة يتسرب إلى نفوس هؤلاءِ المرشحين من رجال الشورى، وغدا كل واحد منهم يرجوها لنفسه بعد أن رشحه لها عمر. وطمح إلى الخلافة رجال غير رجال الشورى من قريش، لأنهم رأوا أن بعض من رشحهم عمر لا يفضلونهم في شيىءِ، بل ربما امتازوا عليهم في أشياءٍ كثيرة.
وكان لنظام الشورى أسوأ الأثر في نفسيات الأنصار، هؤلاءِ الذين وعدوا في السقيفة بأن يكونوا وزراء وشركاء في الحكم وإذا بهم يحرمون من كل شيء حتى من حق المشورة، أضف إلى هذا أن النتيجة التي آلت إليها لم تكن مرضية لهم، فقد رأوا في انتصار الأمويين انتصار لأعدائهم القدماء من مشركي مكة.
وقد عبَّر علي بن أبي طالب عن عدم رضاه عن هذه النتيجة وتسليمه بالأمر الواقع قائلاً:
«لأسلمن ما سلمت أُمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلاَّ علي خاصة»([556]).
بينما أخذ الطامحون إلى الخلافة يجمعون الأنصار حولهم في الخفاء، ويستعينون على ذلك بأموالهم وقبائلهم، وإنشاءِ علاقات المصاهرة مع القبائل الأُخرى. حتى إذا تقدم العمر بخلافة عثمان قليلاً ظهرت هذه الأحزاب إلى العلن تعمل في سبيل هدفها الفريد. وكانت عاقبة الشورى أنها سبَّبت نشوء هذه الأحزاب القائمة على الولاءِ لأشخاص معينين، ذوي أهداف شخصية في الوصول إلى الحكم مستغلة أسباب الشكوى والاستياءِ من عثمان وبطانته وولاته على الأمصار. وقد روى ابن عبد ربه حديثاً لمعاوية بن أبي سفيان اعترف فيه بأنه:
«لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلاَّ الشورى التي جعلها عمر في ستة نفر… فلم يكن رجل منهم إلاَّ رجاها لفنسه، ورجاها له قومه، وتطلعت إلى ذلك نفسه»([557]).
هذه هي الأحداث التي نرى أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بالفتنة التي أصابت المسلمين في عهد عثمان، فقد تفاعلت هذه الأحداث فيما بينها، وتفاعلت مجتمعة مع أسلوب عثمان في سياسة المال والإدارة والاجتماع، فكان من ذلك جميعاً الانحراف الصريح عن مبادىءِ الإسلام الذي وصل بالمأساة إلى قمتها، فدفع بالمسلمين إلى الثورة، وانتهى بهم إلى شر ما كانوا يحذرون.
ـ 2 ـ
سار عثمان حين ولي الخلافة على سياسة في المال لم يعهدها المسلمون ممن تقدمه، ولم يألفوها. فقد راح يغدق الهبات الضخمة على آله وذويه وغيرهم من أعيان قريش، وعلى بعض أعضاءِ الشورى بصورة خاصة. ولو كانت هذه الهبات من أمواله الخاصة لما أثارت اعتراض أحد، ولكنها كانت من بيت المال الذي يشترك فيه المسلمون جميعاً. وقد سار عمال عثمان في أنحاءِ دولة الخلافة سيرته في المدينة. فانكفأوا على بيوت الأموال المحلية ينفقونها على آلهم وأنصارهم والمقربين إليهم([558]).
وقام عثمان بإجراء مالي فتح به للطبقة الثرية التي كان يخصها بهباته وعطاياه أبواباً من النشاط المالي، وأتاح لها فرص التمكين لنفسها وتنمية ثرواتها. وذلك حين اقترح أن ينقل الناس فيئهم من الأرض إلى حيث أقاموا، فلمن كان له أرض في العراق أو في الشام أو في مصر أن يبيعها ممن له أرض بالحجاز أو غيره من بلاد العرب. وقد سارع الأثرياء إلى الاستفادة من هذا الإجراءِ، فاشتروا بأموالهم المكدسة أرضين في البلاد المفتوحة، وبادلوا بأرضهم في الحجاز أرضين في البلاد المفتوحة وجلبوا لها الرقيق والأحرار يعملون فيها ويستثمرونها. وبذلك نمت هذه الثروات نمواً عظيماً، وازدادت هذه الطبقة الطامحة إلى الحكم والطامحة إلى السيادة قوة إلى قوتها.
وقد ذكر المسعودي وغيره بعض الأمثلة على هذه الثروات الضخمة في ذلك الوقت.
«فقد بلغت ثروة الزبير خمسين ألف دينار وألف فرس، وألف عبد وضياعاً وخططاً في البصرة والكوفة ومصر والإسكندرية.
وكانت غلة طلحة بن عبيدالله من العراق كل يوم ألف دينار، وقيل أكثر، وبناحية الشراة أكثر مما ذكرنا.
وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف مائة فرس، وله ألف بعير، وعشرة آلاف شاة، وبلغ رُبع ثُمن ماله بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً.
وحين مات زيد بن ثابت خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار.
ومات يعلى بن منبه وخلف خمسمائة ألف دينار، وديوناً وعقارات وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف دينار.
أما عثمان نفسه فكان له يوم قتل عند خازنه مائة وخمسون ألف دينار ومليون درهم، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار، وخلف خيلاً كثيراً وإبلاً.
ثم قال المسعودي بعد ذلك:
وهذا باب يتسع ذكره، ويكثر وصفه فيمن تملّك الأموال في أيامه»([559]).
وقد وجدت إلى جانب هذه الطبقة الثرية طبقة أُخرى فقيرة، لم تملك أرضاً ولا مالاً، وليس لها عطاءات ضخمة، تلك هي طبقة الجنود المقاتلين وأهلهم وذراريهم. وقد تكونت هذه الطبقة باستئثار عثمان وعماله بالفيءِ والغنائم لأنفسهم والمقربين منهم وحرمان المقاتلين منها. مدَّعين أن الفيء لله وليس للمحارب إِلاَّ أجر قليل يدفع إليه([560]).
أما السواد، سواد العراق، فهو ـ على حد تعبير سعيد بن العاص والي عثمان على الكوفة.
«بستان لقريش، ما شئنا أخذنا منه وما شئنا تركناه»([561]).
وأما أموال بيت المال فقد قال عثمان نفسه عنها:
«لنأخذنَّ حاجتنا من هذا الفيء، وإن رغمت أنوف أقوام»([562]).
ومضت الأيام والأحداث تزيد الهوة اتساعاً بين هاتين الطبقتين، فبينما تزداد الطبقة الأرستقراطية الثرية ثراء، وتسلطاً، وتمعن في اللهو والبطالة والعبث، بحيث يشارك بعض أولاد الخليفة نفسه في اللهو الحرام والمجون([563]) تزداد الطبقة الأُخرى فقراً، وإحساساً بهذا الفقر.
ولم يكن المسلمون بحاجة إلى وقت طويل ليتبين لهم أنهم حين بايعوا عثمان قد سلموا السلطان الفعلي على المسلمين إلى آله وذوي قرابته من بني أُميَّة وآل أَبي معيط. فقد اتضح في وقت مبكر أن عثمان ليس إِلاَّ واجهة يكمن خلفها الأُمويون. وسرعان ما عززت الأحداث هذا. وذلك أن عثمان أسند إلى آله وذويه الولايات الكبرى في دولة الخلافة، وهي البصرة والكوفة والشام ومصر وهذه الولايات الأربع هي الولايات ذات المنزلة العظيمة في الحرب والاقتصاد والاجتماع، فهي مركز الثروة المالية والزراعية لدولة الخلافة منها تحمل الأموال والأقوات، وهي مركز تجمع الجيوش الإسلامية الوافدة من شتى بقاع الدولة، وهي مركز عمليات الفتح الكبرى التي كانت إذ ذاك لا تزال في أوجها، وما عدا هذه الولايات فذو شأن ثانوي لا يؤبه له ولا يلتفت إليه.
لقد ولى عثمان على البصرة ابن خاله عبدالله بن عامر بن كريز، وعمره خمس وعشرون سنة، وولى على الكوفة أخاه الوليد بن عقبة بن أَبي معيط، ثم عزله تحت ضغط الرأي العام بعد أن ثبت عليه شرب الخمر والتهتك، وولى مكانه سعيد بن العاص وكان معاوية عاملاً لعمر على دمشق والأردن فضم إليه عثمان ولاية حمص وفلسطين والجزيرة، وبذلك مدّ له في أسباب السلطان إلى أبعد مدى مستطاع، وولى مصر أخاه من الرضاعة عبدالله بن سعد بن أبي سرح.
كان هؤلاء الولاة جميعاً من قرابة عثمان، ولم يكن سلوكهم الديني أو الإداري أو هما معاً في أمصارهم ومع رعيتهم مرضياً ومقبولاً، فقد كانوا جميعاً من قريش، وكانوا في تصرفاتهم لا يخفون قبليتهم وتعصبهم على غير قريش من قبائل العرب. ففي الكوفة تجبر سعيد بن العاص، وتعصب لقريش، وقال:
«إنما السواد بستان لقريش ما شئنا أخذنا منه وما شئنا تركناه».
فلما اعترضه المسلمون من غير قريش نفاهم إلى الشام، وإذا بمعاوية يناظرهم في فضل قريش وتقدمها على سائر المسلمين فلما أنكروا عليه ذلك نفاهم إلى الجزيرة ـ وأميرها من قبل معاوية عبدالله بن خالد بن الوليد المخزومي ـ فأذلهم، وأظهر لهم سيادة قريش بامتهانه لهم، وتحقيره لشأنهم، وحطه من مقامهم وفي مصر قسا عبدالله بن سعد في جباية الخراج فظلم وأسرف في الظلم، ثم أظهر من العصبية لقريش ما أثار غير قريش من العرب المسلمين ودفعهم إلى أن يشكوه إلى عثمان، فلما كتب إليه عثمان يأمره بالإقلاع عما هو عليه عدا على الشهود فعاقبهم، وضرب رجلاً منهم حتى قتله.
ولم يكن ولاة عثمان من ذوي السابقة في الدين والجهاد في الإسلام، وإنما كانوا متهمين في دينهم، بل كان فيهم من أمره في الفسق ورقَّة الدين معروف مشهور. كان فيهم عبدالله بن سعد الذي بالغ في إيذاءِ النبي والسخرية منه، وبالغ في الهزءِ بالقرآن حتى نزل القرآن بكفره، والوليد بن عقبة ممن أمرهم في الفسق معروف مشهور، وقد نزل فيه قرآن يعلن فسقه.
وكان المسلمون ـ أعيانهم وعامتهم ـ يراجعون عثمان في شأن هؤلاءِ الولاة من أقاربه، ويطلبون منه عزلهم فلا يعزلهم، ولا يسمع فيهم أية شكوى إِلاَّ كارهاً.
هذه السياسة التي سلكها عثمان في الولايات أثارت عليه وعلى عهده موجة عامة من السخط بين المسلمين. لما رأوه فيه من عصبية قبلية يمارسها هو وولاته من قريش.
وأثارت عليه سخط المسلمين والمعاهدين من غير العرب لما عوملوا به من امتهان وقسوة من قبل ولاته وعماله.
وأثارت عليه سخط الصحابة لأنه ولى أمور المسلمين وأموالهم وأبشارهم هؤلاء الغلمة القريشيين الذين لا يحترمون الدين ولا يأبهون له، والذين يظلمون دون أن يردوا من قبل عثمان.
وأثارت عليه سخط الأنصار لأنهم حرموا من الولايات بعد أن وُعدوا بأن يكونوا شركاء في الحكم، ولم ينس الأنصار يوماً أن سيوفهم وقتلاهم وأموالهم هي التي بوأت قريشاً هذه المنزلة.
وأثارت سخط شباب قريش والطامحين إلى الحكم من أعضاء الشورى لأنهم أهملوا ولم ينالوا ولاية من هذه الولايات.
ولقد كان سلوك عثمان إزاء معارضي سياسته في المال والإدارة من كبار الصحابة سبباً في مضاعفة النقمة عليه في قريش وفي عامة المسلمين، وعاملاً مهماً من عوامل تعقيد الأزمة التي عاناها عثمان وعاناها المسلمون في عهد عثمان.
فقد عارض سياسة عثمان في المال والإدارة عبدالله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة، وكان خازناً لبيت المال، فاعترضه عثمان بقوله: «إنما أنت خازن لنا».
ثم اشتدت معارضة ابن مسعود فأمر عثمان بضربه حتى كسر بعض أضلاعه.
وعارضه أبو ذر الغفاري فنفاه إلى الشام، فلم يكف عن المعارضة، بل أمدته أساليب معاوية في حكم الناس بمادة جديدة. فأخذ ينتقد أساليب معاوية في إنفاق الأموال العامة، وصادف كلامه هوى في نفوس رعية معاوية، فكتب بشأنه إلى عثمان، فأرسل إليه عثمان:
«أرسل إلي جندياً ـ وهذا اسم أبي ذر ـ على أغلظ مركب وأوعره».
فوصل أَبو ذر إلى المدينة وقد تآكل لحم فخذيه من عنف السير، ولكنه لم يكف عن المعارضة أيضاً، فنفاه عثمان إلى الربذة، ولبث فيها حتى مات غريباً وحيداً سنة 32هـ.
وعارضه عمار بن ياسر حليف بني مخزوم، فشتمه عثمان وضربه حتى غشي عليه سائر النهار، ولكن هذا العنف لم يثن عماراً فاستمر في معارضته، فشتمه عثمان وأمر به فطرح على الأرض، ووطئه برجليه وهما في الخف حتى أصابه الفتق.
وعارضه غير هؤلاء من الصحابة من المهاجرين والأنصار في الأحداث التي كان يقدم عليها، والسياسة التي كان ينتهجها، فلم يسمع منهم ولم يستجب لهم.
وقد كانت هذه المعارضة تشيع في المسلمين فينتظرون من عثمان أن يستجيب لها. لأنها كانت تعبيراً عن عدم رضا المسلمين عن السياسة التي كانوا يساسون بها. ولكنهم، بدل ذلك، كانوا يرون ويسمعون أن عثمان وآله قد نكلوا بالمعارضين هذا التنكيل الشديد، ومسوهم بهذا الأذى البالغ، ولم يستجيبوا إلى شيء مما دعوا إليه.
وقد أثار موقفه هذا سخط عامة المسلمين، فهؤلاء المعارضون من أعلام الصحابة وأركان الدعوة، يمتهنهم عثمان ويضطهدهم لدعائهم إياه إلى الإصلاح في الوقت الذي يسمع فيه من مروان بن الحكم وأشباهه من بني أُمية وأنصارهم من مسلمة الفتح الطلقاء الذين ليس لهم سابقة ولا مكانة في الإسلام. وهؤلاء المعارضون كانوا يعبرون بمعارضتهم هذه عن إرادة جميع المسلمين الذين آذتهم سياسة عثمان في كراماتهم وأرزاقهم ولم يفسر المسلمون موقف عثمان من المعارضين إلاَّ بأنه عازم على المضي في سياسته دون الالتفات إلى أي نصح أو تحذير.
وإلى جانب هذه المعارضة الصادقة المخلصة، الهادفة إلى خير المسلمين جميعاً كانت توجد معارضة أُخرى مدفوعة بأسباب مغايرة وتستهدف نتائج مغايرة، وقد رأى زعماء هذه المعارضة في فساد الأوضاع العامة، وشيوع التذمر والنقد فرصة يستغلونها لاستعجال نهاية عهد عثمان التي تمكنهم من الوصول إلى مآربهم، فأخذوا يساهمون في نشر روح التذمر وتعميقها.
وقد مكن عثمان بسياسته الإدارية لهذه الطائفة من معارضيه أسباب القوة والنفوذ، وذلك حين أطلق لها أن تنمي ثرواتها إلى أبعد مدى بإجرائه الذي قدمنا الحديث عنه في الأراضي وتكوين الإقطاعات الضخمة، وحين أطلق لها أن تغادر المدينة إلى البلاد المفتوحة حيث راح أفرادها يستكثرون لأنفسهم من الأموال، ويستكثرون من الأتباع ويمنون أنفسهم بالوصول إلى الخلافة. ويمنيهم بذلك أتباعهم وقبائلهم.
وقد أشار الطبري في أحداث سنة خمس وثلاثين إلى هذه الحقيقة فقال:
«كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إِلاَّ بإذن وأجل([564])… فلما ولي عثمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به عمر فانساحوا في البلاد، فما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع من لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام فكان مغموراً في الناس، وصاروا أوزاعاً إليهم، وأملوهم وتقدموا في ذلك، فقالوا يملكون فنكون قد عرفناهم، وتقدمنا في التقرب والانقطاع إليهم؛ فكان ذلك أول وهن دخل على الإِسلام وأول فتنة كانت في العامة ليس إِلاَّ ذلك»([565]).
وقال في موضع آخر:
«.. فلم ولي عثمان خلى عنهم، فاضطربوا في البلاد، وانقطع إليهم الناس..»([566]).
فإذا لاحظنا أن عثمان فتح باب الهجرة أمام قريش، فانساحوا في البلاد يستصلحون الأموال، ويكونون الثروات، ويجمعون حولهم الأنصار بالمال وبالأصهار إلى قبائل العرب وبسمعتهم الدينية التي جاءتهم من صحبتهم للنبي (ص) وسبقهم إلى الإسلام، وجهادهم في سبيله. وأن سلوك عمال عثمان على الأمصار الكبرى، وسلوك عثمان نفسه في المدينة مع ناصحيه والمشفقين عليه وعلى الناس من سلوكه كان يقدم للمسلمين أسباب التذمر والشكوى، وأن هؤلاء الصحابة من قريش كانوا يرون هذا ويسمعونه ويشاركون فيه، فإذا أضفنا إلى ذلك ما خلفه تدبير الشورى لدى هؤلاء من طموح إلى الخلافة، وسعي في سبيلها… إذا لاحظنا هذا كله اتسقت لأعيننا الخطوط البارزة، والعوامل الأساسية في ثورة المسلمين على عثمان وعلى عهده:
طبقة أرستقراطية دينية كونتها السقيفة بما بعثت من مركز قريش، غدت ـ بالإضافة إلى أرستقراطيتها الدينية ـ تتمتع بثروات طائلة بسبب مبدأ التفضيل في العطاء، وسياسة عثمان في المال والأرض والهجرة، وقد كون مبدأ الشورى في نفوس كثير من أفرادها الطموح إلى الحكم مما دفعهم إلى استغلال كل الظروف المؤاتية للوصول إلى هذا الهدف، يقابل هذه الطبقة طبقة المحاربين والمسلمين الجدد المحرومة من كافة الامتيازات، والتي كانت أسباب تذمرها متوفرة.
لقد كانت جماهير المحاربين هي مادة الثورة، أما وقودها فهو تصرفات عثمان وولاته وآل بيته، وأما الذي أججها فهم أصحاب المصلحة فيها: هم هؤلاء الزعماء الذين أُوتوا من الطموح ما جعل الخلافة هدفهم، ومن المال والمنزلة الدينية ما مكَّنهم من جمع الأنصار حولهم، ومن سوء الأوضاع ما سهل عليهم أن يعدوا الناس بخير مما هم فيه.
وقد تمخضت هذه الملابسات والظروف السيئة عن حركة عامة، إن فقدت النظام بالمعنى الحزبي الدقيق، فإنها لم تفقد وحدة الأفكار الدافعة، والأهداف المشتركة.
وقد سلك عثمان وبطانته من الأُمويين والمنتفعين تجاه هذه الحركة سلوكاً بعيداً عن الحكمة والعدل، فبدلاً من أن تجاب مطالب الثوار رُدوا بعنف، واستهين بهم، وجوبهوا بسياسة قاسية هي هذه السياسة التي تمخض عنها مؤتمر عثمان مع عماله على الأمصار، والتي قدم لنا الطبري صورة عنها:
«… فقال له عبدالله بن عامر: رأيي يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك، وأن تجمرهم في المغازي حتى يذلوا لك، فلا يكون همة أحدهم إِلاَّ نفسه، وما هو فيه من دبرة دابته وقمل فروه… فرد عثمان عماله على أعمالهم، وأمرهم بالتضييق على من قبلهم، وأمرهم بتجمير([567]) الناس في البعوث، وعزم على تحريم([568]) أُعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه»([569]).
ولكن هذه الإجراءات العنيفة زادت نار المقاومة اشتعالاً، بدل أن تخفف من شدتها، فقد رأى هؤلاء المحاربون الفقراء أنهم خدعوا، فتكتلوا من الكوفة والبصرة ومصر والحجاز، ومن هنا وهناك للقيام بمسعى جماعي لإرغام عثمان على تغيير بطانته التي اعتبروها مسؤولة عن كثير من المآسي، وتبديل عماله الذين أساؤوا السيرة، وجاروا على الرعية.. وتغيير سياسته المالية. وبينما كان علي بن أَبي طالب يسفر بين الثوار وبين الخليفة، فيهدىء من ثورة أولئك، وينبه عثمان وينصحه بالاستقامة والعدل، نرى أن الآخرين من الطامحين إلى الخلافة ينتهزون فرصة ثورة الجماهير للوصول إلى هدفهم، فيؤججون الثورة، ويزيدون النقمة اشتعالاً، ويبذلون الأموال الطائلة في تمويل الثورة، واصطناع قادتها، وتسليح أفرادها.
وبلغت المأساة قمتها بمقتل عثمان.
ـ 3 ـ
وجاء الناس إلى الإمام علي يطلبون منه أن يلي الحكم ولكنه أبى عليهم ذلك، لا لأنه لم يأنس من نفسه القوة على ولاية الحكم وتحمل تبعاته. فقد كان على تمام الأهبة لذلك، كان قد خبر المجتمع الإسلامي من أقطاره، وخالط مختلف طبقاته، وراقب حياتها عن كثب، ونفذ إلى أعماقها، وتعرف على الوجدان الطبقي الذي يشدها ويجمعها.
وقد مكنه من ذلك كله المركز الفريد الذي كان يتمتع به من النبي (ص)، فهو وزيره ونجيه، وأمين سره، وقائد جيوشه، ومنفذ خططه، ومعلن بلاغاته… هذه المنزلة الفريدة التي لم يتمتع بها أحد من الصحابة أعدته إعداداً تاماً لمهمة الحكم. وقد كان النبي يبتغي من وراء إناطة هذه المهام كلها به إعداده للمنصب الإِسلامي الأول ليصل إليه وهو على أتم ما يكون أهلية واستعداداً. ولقد غدا من نافلة القول أن يقال أنه هو الخليفة الذي كان يجب أن يلي حكومة النبي في المجتمع الإسلامي.
وإذا لم يقدر له أن يصل إلى الحكم بعد وفاة النبي فإنه لم ينقطع عن الحياة العامة، بل ساهم فيها مساهمة خصبة، فقد كان أبو بكر ثم عمر، ومن بعدهما عثمان لا يسعهم الاستغناء عن آرائه في القضاء والسياسة والحرب، وخاصة في خلافة عثمان، فقد كان على أتم الصلة بالتيارات التي تمخر المجتمع الإسلامي، لكن عثمان لم ينتفع كثيراً بالتوجيه الذي كان الإمام يقدمه، لأن بطانته المعروفة كانت تأبى عليه ذلك.
وقد رأى أن المجتمع الإسلامي قد تردى في هوة من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي زادت عمقاً وحدّة، بسبب السياسة غير الحكيمة التي اتبعها ولاة عثمان مدة خلافته ورأى أن التوجيهات الدينية العظيمة التي عمل النبي (ص) طيلة حياته على إرساءِ أصولها في المجتمع الإسلامي الناشىءِ قد فقدت فاعليتها في توجيه حياة الناس.
وإنما صار الناس إلى واقعهم هذا لأنهم فقدوا الثقة بالقوة الحاكمة التي تهيمن عليهم، فراحوا يسعون إلى إقرار حقوقهم وصيانتها بأنفسهم، وهكذا انقطعت الصلة بينهم وبين الرموز المعنوية التي يجب أن تقود حياتهم، والسبيل إلى تلافي هذا الفساد هو إشعار الناس أن حكماً صحيحاً يهيمن عليهم لتعود إلى الناس ثقتهم الزائلة بحكامهم، ولكن هذا لم يكن سهلاً قريب الجنى، فثمة طبقات ناشئة لا تسيغ مثل هذا، ولذلك فهي حَرِية بأن تقف في وجه كل منهج إصلاحي ومحاولة تطهيرية.
وإذن فقد كان علي (ع) يدرك ـ نتيجة لوعيه العميق للظروف الاجتماعية والنفسية التي كانت تجتاح المجتمع الإسلامي في ذلك الحين ـ إن المدَّ الثوري الذي انتهى بالأُمور إلى ما انتهت إليه بالنسبة إلى عثمان يقتضي عملاً ثورياً يتناول دعائم المجتمع الإسلامي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولما كانت البيعة عقداً حقيقياً يستتبع مسؤوليات وواجبات وحقوقاً لكل من الراعي والرعية([570]).
لذلك امتنع من الاستجابة الفورية لضغط الجماهير والصحابة عليه بشأن قبول بيعتهم له بالخلافة، فقد أراد أن يضعهم أمام اختبار يكتشف به مدى استعدادهم لتحمل أسلوب الثورة في العمل، لئلا يروا فيما بعد أنه استغفلهم، واستغل اندفاعهم الثوري حين يكتشفون صعوبة الشروط التي يجب أن يناضلوا الفساد الذي ثاروا عليه في ظلها.
من أجل هذا قال لهم:
«دَعُوني وَالْتَمِسُوا غَيْرِي، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، لاَ تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ، وَلاَ تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ، وَإِنَّ الآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ، وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ، وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتَكُمْ رَكَبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ، وَلَمْ أَصْغِ إِلى قَوْلِ الْقَائلِ وَعَتَبِ الْعَاتِبِ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ، وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ، وَأَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً»([571]).
ولكن الناس أبوا عليه إِلاَّ أن يلي الحكم، فاستجاب لهم.
وما أن بويع حتى عالنهم بسياسته التي قرَّر أن يتبعها من أجل تحقيق الأهداف التي قبل الحكم لأجلها. ولم تكن هذه السياسة شيئاً مرتجلاً اصطنعه لنفسه يوم ولي الخلافة، وإنما كانت منهجاً مدروساً ومنتزعاً من الواقع الذي كان يعانيه المجتمع الإسلامي آنذاك، ومعدة للسير بهذا المجتمع إلى الأمام، ومهيئة لتنيل هذا المجتمع المطامح التي كان يحلم بها ويصبو إليها.
وقد تناولت إصلاحات الإمام الثورية ثلاثة ميادين:
الإدارة.
والحقوق.
والمال.
ففيما يرجع إلى سياسة الإدارة أصر على عزل ولاة عثمان على الأمصار، هؤلاء الولاة الذين كانوا من الأسباب الهامة في الثورة على عثمان لظلمهم، وبغيهم، وعدم درايتهم بالسياسة وأُصول الحكم. وقد كلمه المغيرة بن شعبة في شأن ولاة عثمان، فأشار عليه بأن يثبت هؤلاء الولاة على أعمالهم، ولكنه أبى عليه ذلك وعزلهم. وكلمه طلحة والزبير في شأن الولاية على الكوفة والبصرة فردهما رداً رفيقاً. وولّى رجالاً من أهل الدين والعفة والحزم، فولَّى على البصرة عثمان بن حنيف، وعلى الشام سهل بن حنيف، وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة، وثبت أبا موسى الأشعري على الكوفة، وهذه هي الأمصار الكبرى في دولة الخلافة حينذاك. وقد أصاب هذا الإجراء قريشاً بضربة قاصمة في كبريائها، وسُلطانها، ونفوذها لأن هؤلاء الولاة جميعاً من غير قريش.
وقد قال في شأن ولاة عثمان ومن لف لفهم:
«… وَلَكِنِّي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَفُجَّارُهَا، فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلاً، وَعِبَادَهُ خُولاً، وَالصَّالِحِينَ حَرْباً، وَالْفَاسِقِينَ حِزْباً، فَإِنَّ مِنْهُمْ الَّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمُ الْحَرَامَ، وَجُلِدَ حَداً في الإِسْلاَمِ. وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رَضَخَتْ لَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ الرَّضَائِخُ…([572])».
وفيما يرجع إلى الحقوق نادى بأن المسلمين جميعاً سواء في الحقوق والواجبات في الإِسلام، وقد كانت هناك فروق حقوقية جاهلية قضى عليها الإسلام وأُعيدت في عهود لاحقة، فقريش ذات الماضي العريق في السيادة على القبائل العربية عادت في عهد قريش إلى إيمانها بتلك الفروق، فغدا أُناس ليس لهم ماض مشرِّف بالنسبة إلى الإسلام ونبيه يتعالون على أعظم المسلمين جهاداً وسابقة وبلاء لمجرد أنهم قرشيون.. هذه الفروق المعنوية الجاهلية قضى عليها الإمام فقال:
«أَلذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ، وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ»([573]).
وفيما يرجع إلى سياسة المال وقف موقفاً صارماً، وكانت تواجهه فيما يتعلَّق بهذه السياسة نقطتان هامتان، إحداهما الثروات التي تكوَّنت في أيام عثمان بأسباب غير مشروعة، والثانية أُسلوب توزيع العطاء.
وقد أعلن في الخطب الأُولى التي استهل بها حكمه مصادرة جميع ما أقطعه عثمان من القطائع وما وهبه من الأموال العظيمة لطبقة الأرستوقراطيين، كما أعلن أنه سيتبع مبدأ المساواة في العطاء، فقال:
«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ، لِي مَا لَكُمْ وَعَلَيَّ مَا عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي حَامِلُكُمْ عَلَى مَنْهَجِ نَبِيِّكُمْ، وَمُنَفِّذٌ فِيكُمْ مَا أَمَرَ بِهِ. أَلا وَإِنَّ كُلَّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ، وَكُلَّ مَالٍ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَهْوَ مَرْدُود فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنَّ الْحَقَّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَلَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ الإِمَاءَ وَفُرِّقَ فِي الْبُلْدَانِ لَرَدَدْتُهُ؛ فَإِنَّ في الْعَدْلِ سَعَةٌ، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ»([574]).
وقال من خطاب آخر:
«… أَلا لا يقولنَّ رجال منكم غداً قد غمرَتْهم الدُّنيا فاتَّخذوا العقار، وفجَّروا الأَنْهار، وَرَكِبُوا الخيول الفارهة، واتَّخذوا الوصائف الرُّوقة فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً، إِذا ما منعْتُهُم ما كانوا يخوضون فيه، وأَخَّرتهم إلى حقوقهم الَّتي يعلمون، فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا! أَلا وأَيُّما رجل من المهاجرين والأَنصار من أصحاب رسول الله (ص) يرى أنَّ الفضل له على سواه لصحبته فإِنَّ الفضل النَّيِّرَ غداً عند الله، وثوابه وأَجره على الله. وأَيُّما رجل استجاب لله وللرَّسول، فصدَّق ملَّتنا ودخل في ديننا، واستقبل قِبْلَتَنَا؛ فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده؛ فأنتم عباد الله، والمال مال الله، يُقسم بينكم بالسَّويَّة، لا فضل فيه لأَحد على أَحد، وللمتَّقين عند الله غداً أحسن الجزاء وأفضل الثَّواب؛ لم يجعل الله الدُّنيا للمتَّقِين أجراً ولا ثَوَاباً، وما عِند الله خيرٌ للأَبْرار. وإذا كان غد إنشاء الله فاغْدوا علينا، فإنَّ عندنا مالاً نقسمه فيكم، ولا يتخلَّفنَّ أَحدٌ منكم؛ عربيٌّ ولا عجميٌّ كان من أَهْلِ العطاء أو لم يكن؛ إِلاَّ حَضَرَ، إِذا كان مُسْلِماً حُرَّاً».
فلما كان من الغد، غدا وغدا الناس لقبض المال. فقال لعبيدالله بن أبي رافع كاتبه:
ابدأ بالمهاجرين فنادهم، وأعط كل رجل ممن حضر ثلاثة دنانير، ثم ثنِّ بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك؛ ومن حضر من الناس كلهم؛ الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك.
فقال سهل بن حنيف: يا أَمير المؤمنين، هذا غلامي بالأمس وقد أعتقته اليوم؛ فقال:
نعطيه كما نعطيك، فأعطى كل واحد منهما ثلاثة دنانير.
ولم يفضِّل أحداً على أحد. وتخلف عن هذا القسم يومئذٍ طلحة والزبير، وعبدالله بن عمر، وسعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، ورجال من قريش وغيرها»([575]).
وهكذا قضى بسرعة وحسم على شرعية التفاوت الطبقي بما له من ذيول اقتصادية ودينية، فسوَّى بين المعتقين والأحرار، والسابقين في الإسلام والمسلمين الجدد، ولم يجعل من الفضل الديني ذريعة إلى المغانم الاقتصادية. كما شل بإجراء آخر قوة هذه الطبقة التي تكونت في عهد عثمان وذلك حين صادر قطائع عثمان والأموال التي أعطاها.
وبقدر ما كانت هذه السياسة مصدر فرح وجذل للطبقة المستضعفة الفقيرة الرازحة تحت أثقال من الظلم كانت أيضاً صفعة لقريش ولغرورها وخيلائها واستعلائها على الناس، فمن أين لها بعد اليوم أن تحوز الأموال العظيمة دون أن تنفرج شفتان لتقولا لها: من أين لك هذا؟
وكيف لها بعد اليوم أن تستعلي وتستبد، وتفرض على الناس في ظل الإسلام سلطانها عليهم في الجاهلية.
ولعل قادة الطبقة الثرية وزعماءها فكروا في أن يساوموا علياً على بذل طاعتهم له على أن يغضي عما سلف منهم، ويأخذهم باللين والهوادة فيما يستقبلون، فأرسلوا إليه الوليد بن عقبة بن أبي معيط. فجاء إليه وقال:
يا أبا الحسن، إنك قد وترتنا جميعاً. ونحن أخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف. ونحن نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال أيام عثمان، وأن تقتل قتلته، وإنا إن خفناك تركناك فالتحقنا بالشام».
فقال:
أما ما ذكرتم من وتري إياكم فالحق وتركم، وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم…»([576]).
ولما أيقن زعماء هذه الطبقة أنهم لن يفلحوا عن طريق المساومة والتهديد لجأوا إلى السعي لنقض البيعة، وقد جاء من أخبر علياً بأنهم يدعون الناس إلى رفض البيعة مدفوعين إلى ذلك بالامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي فقدوها.
فخطب الناس، وكأنه أراد بذلك أن يكشف عناصر الفتنة الجديدة، ويخرج بالمسألة من حدود الهمس والعمل في الظلام إلى الصعيد العام، ويسلط عليها وعلى زعمائها النور ويفضح أهدافهم، ويطلع الأُمة على المناورة التي تريد أن تحول نتائج الثورة إلى مغانم شخصية، وتعيد الأوضاع القديمة كما كانت، فلا تحصل الأُمة من ثورتها إلاَّ على تبديل الوجوه.
وقد أكَّد في هذه الخطبة عزمه على مواصلة تطبيق المنهج الذي بدأ به، فقال:
«فأما هذا الفيء فليس لأحد على أحد فيه أثرة؛ وقد فرغ الله من قسمته، فهو مال الله، وأنتم عباد الله المسلمون؛ وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا، وعهد نبينا بين أظهرنا فمن لم يرضَ به فليتولَّ كيف شاء»([577]).
ولكن الأرستقراطية الجديدة لم تقف مكتوفة اليدين. فقامت بحركة التمرد الأُولى في البصرة تحت ستار الثأر لعثمان وما هي في واقعها إلاَّ تدبير دبَّره من لم يماش الحكم الجديد أهواءهم من المنتفعين بعهد عثمان، وقد كان القائمون بهذه الحركة يريدون أن يعطفوا أزمَّة الحكم إلى جانبهم بعد أن يئسوا من مساعدة الإمام لهم على ما يبتغون، ولكن الإمام قضى على الحركة في مهدها، وفر من بقي من أنصارها إلى الشام، حيث قامت حكومة برياسة معاوية بن أبي سفيان، انضوت إليها جميع العناصر المنتفعة بعهد عثمان، والتي رأت في الحكم الجديد خطراً عليها وعلى امتيازاتها الطبقية وبينما كانت حكومة الإمام تسير على نهج، تحقق فيه للأمة أقصى قدر مستطاع ـ في ظروفها السياسية والاقتصادية والعسكرية ـ من الرفاهية والعدالة والأمن كان معاوية يسير على نهج آخر في الحكم يقوم على شراء الضمائر بالمال، وتفضيل طائفة بحرمان طائفة أخرى، وتعطيل السبل وتعكير الأمن. ولم يكن معاوية ليبالي في أن ينزل بدافعي الضرائب من الزراع والتجار أفدح الظلم في سبيل أن يحصل منهم على مبلغ من المال يغذي به أطماع حفنة من رؤساء القبائل العربية يؤلفون جهازه العسكري المتأهب دائماً لقمع أي حركة تحررية تقوم بها جماعة من الناس.
وقد كان من الطبيعي أن تقوم حركة تمرد أُخرى وراء الواجهة نفسها بزعامة معاوية، فكانت صفين، وكان التحكيم ثم النهروان. ثم قتل (ع) بثمرة من ثمرات التحكيم بعد أن غرس في عقول الناس وقلوبهم المبادىء الإسلامية الصحيحة في الحكم وسياسة الجماعات. ثم كانت خلافة الحسن بن علي ذات الشهور العاصفة، الحبلى بالدسائس والمؤامرات عليه من قبل الانتهازيين والوصوليين. ثم اضطراره إلى التخلي عن الحكم مؤقتاً تحت ضغط الأحداث التي لم تكن صالحة تفادياً لحرب خاسرة تذهب فيها دماء أنصاره دون الحصول على نصر آني أو في المستقبل القريب أو البعيد.
وصار الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان. واتسقت له الأُمور وسيطر على العالم الإسلامي كله بعد أن أُخذت له البيعة على الناس في شوَّال سنة إحدى وأربعين للهجرة.
وقد كانت سياسة الإمام علي، وطريقته في ممارسة مهمة الحكم، وفهمه لواجبات الحاكم، كانت هذه الأُمور تشكل تحدياً مستمراً لمعاوية وبطانته؛ وتهديداً لمشاريعه في التسلط على المسلمين. والذي زاد من خطورة هذه الأفكار على معاوية ومشاريعه أنها لم تكن أفكاراً مجردة، بل طبقت على حياة الناس بأمانة وإخلاص عظيمين، لذلك عمل معاوية منذ انتهت مهزلة التحكيم على أن يحارب هذه المبادىء، وأن يطبع حياة الناس وأفكارهم بالطابع الذي يؤمن له سيطرة دائمة خالية من أي رقابة أو احتجاج. ولذلك مارس سياسة استهدف منها محق نزعة الحرية لدى الإنسان المسلم، وتحويله عن أهدافه العظيمة ونضاله من أجلها.
ولقد كانت هذه السياسة تقوم على المبادىء التالية:
أ ـ الإرهاب والتجويع.
ب ـ إحياء النزعة القبلية واستغلالها.
ج ـ التحذير باسم الدين وشل الروح الثورية.
وبهذه السياسة حاول معاوية القضاء على ما لدى الجماهير المسلمة من نزعة إنسانية تجعلها خطراً على كل حاكم يجافي مبادىء الإسلام في ممارسته لمهمة الحكم، وبذلك أمن ثورة الجماهير ونقدها.
ولنأخذ هذه المبادىء بشيء من التفصيل.
ـ 4 ـ
أ ـ الإرهاب والتجويع:
لقد اتبع معاوية سياسة الإرهاب والقتل والتجويع بالنسبة إلى الرعايا المسلمين الذين لا يتفقون معه في الهوى السياسي، وإطلالة قصيرة على تاريخ هذه الفترة من حياة المسلمين تثبت هذه الدعوى.
حدث سفيان بن عوف الغامدي، وهو أحد قواد معاوية العسكريين، قال:
«دعاني معاوية فقال: إني باعثك بجيش كثيف ذي أداة وجلادة، فالزم لي جانب الفرات حتى تمر بهيت فتقطعها؛ فإن وجدت بها جنداً فأغر عليهم، وإلاَّ فامض حتى تغير على الأنبار، فإن لم تجد جنداً فامض حتى توغل في المدائن. إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترعب قلوبهم، وتفرح كل من له هوى فينا منهم، وتدعو إلينا كل من خاف الدوائر، فاقتل كل من لقيته ممن هو ليس على مثل رأيك. وأخرب كل ما مررت به من القرى([578])، وأحرب الأموال فإن حرب الأموال شبيه بالقتل وهو أوجع للقلب»([579]).
ودعا معاوية بالضحاك بن قيس الفهري وأمره بالتوجه ناحية الكوفة، وقال له:
«من وجدته من الأعراب في طاعة علي فأغر عليه».
«فأقبل الضحاك فنهب الأموال، وقتل من لقي من الأعراب، حتى مر بالثعلبية فأغار على الحاج فأخذ أمتعتهم، ثم أقبل فلقي عمرو بن عميس بن مسعود الهذلي، وهو ابن أخي عبدالله بن مسعود فقتله في طريق الحاج عند القطقطانة وقتل معه ناساً من أصحابه»([580]).
واستدعى معاوية بسر بن أرطأة، ووجهه إلى الحجاز واليمن، وقال له:
«سر حتى تمر بالمدينة فاطرد الناس، وأخف من مررت به، وانهب أموال كل من أصبت له مالاً ممن لم يكن دخل في طاعتنا، فإذا دخلت المدينة فأرهم أنك تريد أنفسهم، وأخبرهم أن لا براءة لهم عندك ولا عذر حتى إذا ظنوا أنك موقع بهم فأكفف عنهم.. وأرهب الناس عنك فيما بين المدينة ومكة واجعلها شردات..».
وقال له:
«لا تنزل على بلد أهله على طاعة علي إلاَّ بسطت عليهم لسانك حتى يروا أنهم لا نجاء لهم، وإنك محيط بهم، ثم أكفف عنهم وأدعهم إلى البيعة لي، فمن أبى فاقتله، واقتل شيعة علي حيث كانوا»([581]).
فسار، وأغار على المدينة ومكة، فقتل ثلاثين ألفاً عدا من أحرق بالنار([582]).
بهذا المطلع القاني استهل معاوية سياسته بعد التحكيم مع المسلمين الذين يخالفونه في الهوى السياسي. وقد بلغ في ذلك شأواً بعيداً، فقتل وأرعب، واستصفى الأموال، وعاث في الأرض فساداً.
وقد استمر على هذه السياسة بعد أن قتل علي (ع) ولكنها إذ ذاك أخذت شكلاً أكثر تنظيماً وعنفاً وشمولاً.
وقد نص المؤرخون على أن هذا الإرهاب بلغ حداً جعل الرجل يفضل أن يقال عنه أنه زنديق أو كافر ولا يقال عنه أنه من شيعة علي([583])، وقد بلغ بهم الحال أنهم كانوا يخافون من النطق باسمه حتى فيما يتعلَّق بأحكام الدين التي لا ترجع إلى الفضائل التي كان الأُمويون يخشون شيوعها، فكانوا يقولون «روى أبو زينب»([584])، وقال أبو حنيفة: إن بني أُمية كانوا لا يفتون بقول علي ولا يأخذون به، وكان علي لا يذكر في ذلك باسمه.
وكانت العلامة باسمه بين المشايخ أن يقولوا: قال الشيخ([585]).
وحظر الأُمويون على الناس أن يسموا أبناءهم باسم علي([586]).
وكتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد ما سموه عام الجماعة:
أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً، ويبرؤون منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته.
«وكان أشد الناس بلاءاً حينئذٍ أهل الكوفة، لكثرة من بها من شيعة علي (ع)، فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم إليه البصرة، فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف، لأنه كان منهم أيام علي (ع)، فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم، وقطع الأيدي والأرجل، وسمل العيون. وصلبهم على جذوع النخل، وطردهم، وشردهم عن العراق، فلم يبق بها معروف منهم.
«وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق:
ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة.
ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان:
«انظروا من قامت عليه البينة إنه يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع ذلك بنسخة أُخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به وأهدموا داره.
«فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق. ولا سيما بالكوفة، حتى أن الرجل من شيعة علي (ع) ليأتيه من يثق به، فيدخل بيته، فيلقي إليه سره، ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه… فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي (ع)، فازداد البلاء والفتنة، فلم يبق أحد من هذا القبيل إلاَّ وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض»([587]).
وأجمل ذلك الإمام محمَّد بن علي بن الحسين الباقر، فقال:
«وقتلت شيعتنا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة، وكل من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله، أو هدمت داره، ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيدالله بن زياد قاتل الحسين (ع)»([588]).
وقد طبَّق ولاة معاوية على العراق ـ مهد التشيع لآل علي ـ هذه السياسة بوحشية لا توصف. فقد استعمل زياد، سمرة بن جندب على البصرة فأسرف هذا السفاح في القتل إسرافاً لا حدود له، فهذا أنس بن سيرين يقول لمن سأله:
هل كان سمرة قتل أحداً؟: «وهل يحصى من قتل سمرة بن جندب؟ استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة، فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من الناس، فقال له يعني زياداً ـ هل تخاف أن تكون قتلت أحداً بريئاً؟ فرد عليه قائلاً: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت»([589]).
وقال أبو سوار العدوي:
قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلاً قد جمع القرآن([590]).
واستقام سمرة في المدينة شهراً، فهدم دور أهلها، وجعل يستعرض الناس فلا يقال له عن أحد أنه شرك في دم عثمان إلاَّ قتله([591]) وسبى نساء همدان ـ وهمدان من شيعة علي ـ وأُقمن في الأسواق فكن أول مسلمات اشترين في الإسلام([592]) وقد فعل ما فعل لدعم ملك معاوية وقال: «لعن الله معاوية، والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذَّبني أبداً»([593]).
أما زياد بن سمية فكان يجمع الناس بباب قصره يحرضهم على لعن علي، فمن أبى عرضه على السيف([594]) وكان يعذب بغير القتل من صنوف العذاب، وتقدمت إشارات إلى ذلك في كلام المدائني، وهذا ابن الأثير يذكر لنا أنه قطع أيدي ثمانين أو ثلاثين رجلاً من أهل الكوفة([595]). وقد نوى في آخر أيامه أن يعرض أهل الكوفة أجمعين على البراءة من علي ولعنه. وأن يقتل كل من امتنع من ذلك ويخرب منزله، ولكنه مات قبل أن ينفذ هذه الفكرة([596]).
هذا كله بالإضافة إلى ـ سياسة الترحيل والتشريد التي قصد بها إلى إضعاف المعارضة في العراق ـ وتقدمت إشارة إليها في نص ابن أبي الحديد عن المدائني ـ فقد أنزل من الكوفيين وأسرهم ـ وكانوا أعظم الثوار تشيعاً ـ خمسين ألفاً في خراسان([597]) وبذلك حطم قوة المعارضة في الكوفة وخراسان معاً.
هذا عرض موجز للسياسة التي تتناول حياة الناس وأمنهم، وأما السياسة التي تتناول أرزاق الناس وموارد عيشهم فلا تقل قتامة وكلوحاً، وإيغالاً في الظلم عن سابقتها.
فإن معاوية بعد أن تمَّ له السلطان على البلاد الإسلامية في عام الجماعة عالن الناس بطبيعة الحكم الجديد في كلمته التالية:
«يا أهل الكوفة، أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وألي رقابكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون. ألا إن كل دم أُصيب في هذا مطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين».
وكان قد قال قبل ذلك، لما تمَّ الصلح: «رضينا بها ملكاً»([598]).
وكان معاوية أميناً لمنهجه هذا، فلم يحد عنه أبداً.
وشهدت الأُمة المسلمة من جوره وعسفه ما لم تعهد مثله في سالف أيامها. وكان أوفر دهاء من أن يدع للمضطهدين منفذاً للتعبير عن سخطهم واستيائهم، بل كان من البراعة بحيث حمل الكثيرين على وصفه بالحلم والكرم، والإعجاب به لذلك. وترى كتب التاريخ والأدب حافلة بالحديث عن حلم معاوية وسخائه وبذله الأموال، ولكن شيئاً من دقة الملاحظة يكشف لنا عن حقيقة الحال. فإن هذا السخاء كان مقصوراً على حفنة من الناس لا يتعداها إلى غيرها من العامة ممن هم في أمس الحاجة إلى الدرهم. لقد كان سخاء معاوية مقصوراً على هذه الطبقة الأرستقراطية التي صعد على أكتافها إلى الحكم، والتي استعان بما لها من نفوذ سياسي أو ديني في مؤامراته أو حروبه. وكانت هذه الطبقة مؤلفة من زعماء القبائل الموالين له، ومن بعض الأشخاص الذين قذفت بهم أحداث الإسلام الأُولى مرغمين إلى صحبة رسول الله، ولولا ذلك لفضلوا أن يكونوا في صفوف أعدائه، فتدفقت الثروات الضخمة، والعطايا الجزيلة على أفراد هذه الطبقة، وحرم سائر الناس من مطالبهم الأساسية، وطفق المحدثون الرسميون (القصَّاص) يذيعون في الناس سخاء معاوية وكرمه، مستشهدين بهباته الجزيلة لفلان وفلان. وتناقل الرواة هذه الأحاديث حتى سجلها المؤرخون مفاخر له.
ولا يغير من مغزى هذا شيئاً أن معاوية كان يهب بعض أعدائه القدماء أموالاً جزيلة، فإن الذي ألجأ هؤلاء الأعداء إلى مسالمته وإن كان عجزهم عن المقاومة إلاَّ أن هذا لا ينفي أنهم كانوا قادرين على أن يشغبوا عليه إذا لم يستجب لمطالبهم، ولم يكن عسيراً عليه إدراك أن من الأفضل له عدم إثارتهم بحرمانهم من الامتيازات الثابتة لهم بحكم كونهم زعماء قبليين.
ويجب علينا حين ندرس سياسة معاوية المالية أن نضع خطاً فاصلاً بين الشام وبين سائر الولايات الإسلامية، لأن الشام قد تمتعت برخاء حقيقي. والسر في ذلك هو أن جند الشام كان عماد معاوية في حروبه فلم يسعه إلاَّ أن يسترضيه بالأموال. ونلاحظ أنه كان ينفق على جيشه الذي بلغ ستين ألف جندي، ستين مليون درهم في السنة([599]). على أنه لا يفوتنا أن نلاحظ أن هذا الرخاء لم يكن من حظ عرب الشام أجمع، وإنما كان لقبائل اليمن وحدها، وأما قبائل قيس فكانت تعاني شظف العيش، لأنه لثقته بولاء اليمن له لم يأبه لقيس، فلم يفرض لها في العطاء إلاَّ في وقت متأخر بعد أن خشي على سلطانه من قوة قبائل اليمن([600]).
وأما سائر الولايات الإسلامية فقد ذاقت الطبقات الفقيرة فيها طعم البؤس، وعانت ألواناً من الاستعباد والإفقار، بلا فرق في ذلك بين المسلمين وبين الداخلين في ذمة الإسلام، فقد اهتم معاوية بجمع المال دون أن يهتم بمصادره وأساليب جبايته، واتخذ من هيمنته على مصادر الجباية وبيت المال ذريعة إلى التحكم في أعدائه المغلوبين على أمرهم والذين لا يقدرون على إزاحته عن الحكم.
وهناك بعض الشواهد على ما نقول. كتب معاوية إلى عماله بعد عام الجماعة:
«.. انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع ذلك بنسخة أُخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به وأهدموا داره»([601]).
(وكثيراً ما كان الأنصار يمكثون بلا عطاء ولا ذنب لهم إلاَّ أنهم ينصرون أهل البيت([602]).
وكانوا إذا عصاهم أحد من المسلمين قطعوا عطاءه ولو كان العاصون بلداً برمتها([603]).
وكان من جملة الأساليب التي اتبعها معاوية لحمل الحسين على بيعة يزيد حرمان جميع بني هاشم من عطائهم حتى يبايع الحسين([604]).
وكتب إلى زياد بن سمية عامله على العراق: «اصطف لي الصفراء والبيضاء».
فكتب زياد إلى عماله بذلك، وأمرهم أن لا يقسموا بين المسلمين ذهباً ولا فضة([605]).
وكتب إلى وردان عامله على مصر:
أن زد على كل امرىء من القبط قيراطاً. ولكن وردان كان أعدل من معاوية فكتب إليه «كيف أزيد عليهم؟ وفي عهدهم ألا يزاد عليهم»([606]).
وكان ذلك هو شأنه في تحريض عماله على جمع الأموال، وهم يخترعون الطرق للاستكثار منها([607]). وفرض ضريبة على الأهالي تقدم إليه يوم النيروز فكان يجبي منها عشرة ملايين درهم([608])، وهو أول من استصفى أموال الرعية([609]).
وها هو معاوية يعطي عمراً بن العاص أرض مصر وأموالها وسكانها المعاهدين ملكاً حلالاً له، وقد جاء في صك هذا العطاء! إن معاوية أعطى عمراً بن العاص مصر وأهلها هبة يتصرف كيف يشاء..!! مصر التي كتب علي بن أبي طالب للأشتر عامله عليها وثيقة تعتبر من أعظم وثائق حقوق الإنسان على مدى العصور غدت عند معاوية سلعة تباع وتشترى. وهاك نموذجاً من سلوك عمرو بن العاص في مصر: سأله صاحب أخنا بمصر أن يخبره بمقدار ما عليه من الجزية، فأجابه:
«لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك، إنما أنتم خزانة لنا، إن كثر علينا كثرنا عليكم. وإن خفف عنا خففنا عنكم»([610]).
وحين استولى معاوية على العراق نقل بيت المال من الكوفة إلى دمشق، وزاد في جرايات أهل الشام([611]) وحط من جرايات أهل العراق وقد أوضح فلسفته في جمع المال بقوله:
«الأرض لله، وأنا خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي، وما تركته كان جائزاً لي».
وكان معاوية حريصاً على أن يولي على العراق ـ موطن الولاء لآل البيت ـ أشخاصاً من أعداء آل البيت، ليضمن تنفيذ سياسة الإرهاب والإذلال والتجويع في العراق بسهولة، وليستطيع أن يمنح العراقيين امتيازات يعلم أن ولاته ـ بسبب من حقدهم ـ لا ينفذونها، فيفوز بحسن السمعة دون أن يتخلى عن مبادئه.
ونذكر نموذجاً لذلك هو أنه أمر لأهل الكوفة:
«بزيادة عشرة دنانير في أعطيتهم، وعامله يومئذ على الكوفة وأرضها النعمان بن بشير، وكان عثمانياً، وكان يبغض أهل الكوفة لرأيهم في علي (ع)، فأبى النعمان أن ينفذها لهم، فكلموه وسألوه بالله، فأبى أن يفعل.
ولما استرحمه عبدالله بن همام السلولي وطلب إليه في قطعة شعرية مؤثرة أن ينجز لهم الزيادة قال:
«والله لا أُجيزها ولا أُنفذها أبداً»([612]).
وهكذا حرم المسلمون من أموالهم لتنفق هذه الأموال على الزعماء القبليين، والقادة العسكريين، وزمر الكذابين على الله ورسوله.
وقد طبقت هذه السياسة ـ سياسة الإرهاب والتجويع ـ بالنسبة إلى المسلمين عموماً، وبالنسبة إلى كل من اتهم بحب علي وآله على الخصوص. لقد كان حب علي سرطان الحكم الأُموي فعزموا على قطعه تماماً.
ويقدم لنا يوليوس ولهاوزن صورة مُعبرة عن الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفتها هذه السياسة في المجتمع العراقي في ذلك الحين.
«لقد غُلب أهل العراق في صراعهم مع أهل الشام… وضاع منهم دخل الأراضي التي استولوا عليها، وصار عليهم أن يقبلوا بأجور هي فتات موائد أسيادهم، وكانوا مغلوبين على أمرهم، تغلبهم عليه تلك الصدقات التي هم محتاجون إليها، والتي في يد الأُمويين تخفيفها أو إلغاؤها، فلا عجب إذن في أن يروا في حكم أهل الشام نيراً ثقيلاً وأن يتأهبوا لدفعه متى سنحت الفرصة المواتية لهم بذلك.
«وازادت الضغينة على الأُمويين بسبب عدائهم للنبي والعقيدة الإسلامية بما أنظم إليها من الشكاوى على السلطان، التي أصبحت الآن شكاوى من الأُمويين وهم أصحاب السلطان وهي النقاط أنفسها تعاد وتكرر: عمال يسيئون استعمال سلطانهم، وأموال الدولة تذهب إلى جيوب عدد قليل من الناس بينما لا يحصل غيرهم على شيء.
«وكان زعماء القبائل والأسر في الكوفة يشاركون غيرهم منذ الأصل هذا الشعور، بيد أن وضعهم الذي يلقي بالمسؤولية على عاتقهم جنح بهم إلى أن يعتصموا بالحيطة والحكمة؛ فلا يشرعون في القيام بثورة لا هدف لها، بل يردون الجماهير عنها حين ينطلقون فيها وها هم أُولاء باسم السلام والنظام يضعون نفوذهم تحت تصرف الحكومة كيلا يعرضوا وضعهم للأخطار، وإذا هم يصبحون أعداء أكثر فأكثر للشيعة الحقيقيين، وأعداء لهم يشتد عداؤهم يوماً بعد يوم، تلك الشيعة التي لم ينقص من تمسكها بورثة الرسول (ص) إخفاقها في تحقيق رغباتها.. بل زاد فيه. وكانت مقاومتها للأرستقراطية القبلية تضيق الخناق عليها»([613]).
ـ 5 ـ
ب ـ إحياء النزعة القبلية واستغلالها:
دعا الإسلام إلى ترك التعصب للقبيلة والتعصب للجنس، واعتبر الناس جميعاً سواء من حيث الإنسانية المشتركة، وأقام مبادءه وتشريعاته على هذه النظرة الصائبة إلى الجنس البشري.
وفي الحديث:
«المؤمنون إخوة، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم».
ومما روي عن النبي (ص) أنه قال في خطبته في حجة الوداع:
«أَيُّها الناس، إنَّ الله تعالى أذهب عنكم نخوة الجاهليَّة وفخرها بالآباء، كلُّكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربيٍّ على عجميٍّ فضل إلاَّ بالتَّقوى».
وروي عنه (ص):
«من قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبيَّة، أو يدعو إلى عصبيَّة، أو ينصر عصبيَّة، فقتل، قُتل قتلة جاهليَّة».
وقال الله تعالى مبيناً في الكتاب الكريم المقياس الإسلامي في التفاضل:
﴿يَا أَيُّها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنَّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾([614]).
بهذه الروح الإنسانية الرحبة الآفاق دعا الإسلام العرب إلى النظر إلى اختلاف القبائل والشعوب. وبهذه الروح الإنسانية الرحبة حاول الإسلام أن يجعل من القبائل العربية المسلمة أُمة واحدة لا يمزقها التناحر القبلي الجاهلي، وإنما تربط بين أفرادها أُخوة الإسلام ورسالة الإسلام، وحاول أن يجعل من المسلمين جميعاً ـ على اختلاف أوطانهم ولغاتهم ـ أُمة واحدة متماسكة، تجمعها وحدة العقيدة، ووحدة الهدف والمصير.
وقد عمل النبي (ص) طيلة حياته بأقواله وأعماله على تركيز هذه النظرة الإسلامية في وجدان المسلمين، وجعلها حقيقة حية في تفكيرهم، وتابعه على ذلك علي (ع)، فعمل على تركيزها بأعماله وأقواله طيلة حياته، بعد أن شهد عهد عثمان انحرافاً خطيراً عن هذه النظرة الإسلامية واتجاهاً خطيراً نحو الروح الجاهلية والعصبية القبلية التي اتبعها هو وعماله([615]). ولا نزال حتى اليوم نحس بحرارة نضال علي في هذا المجال، وإنَّ ما سلم من أيدي الحوادث من آثار علي الكلامية في هذا الموضوع على قلته ليدلنا على عمق النظرة التي نظر بها علي إلى التكوين القبلي للمجتمع، ويدلنا على وعيه لمدى خطر هذا التكوين القبلي على المجتمع الإسلامي. ومن أبرز الآثار الباقية لنا من كلامه في هذا الموضوع الخطبة القاصعة، وهي وثيقة عظيمة الأهمية في الدلالة على وجهة نظره (ع)([616]).
أما معاوية فقد استغل هذه الروح في ميدانين، فقد أثار بالقول والفعل العصبية القبلية عند القبائل العربية ليضمن ولاءها عن طريق ولاء زعمائها من ناحية، وليضرب بعضها ببعض حين يخشاها على سلطانه من ناحية أُخرى. وأثار العصبية العنصرية عند العرب عموماً ضد المسلمين غير العرب، وهم الذين يطلق عليهم المؤرخون اسم الموالي.
ففي حياة علي سلك معاوية سبيل الدس والتآمر على حكم علي عن طريق إثارة الروح القبلية في سكان العراق من القبائل العربية، فتارة يلوح لزعماء هذه القبائل بالامتيازات المادية والاجتماعية التي يخص بها الزعماء القبليين في الشام، ومن هنا صارت الشام ملاذاً لمن يغضب عليه الإمام من هؤلاء الزعماء لجناية جناها، أو خيانة خانها في عمله، ومطمحاً لمن يريد الغنى والمنزلة، فيجد عند معاوية الإكرام والعطاء الجزل، والمنزلة الاجتماعية الرفيعة.
وقد كتب الإمام علي إلى سهل بن حنيف عامله على المدينة في شأن قوم من أهلها لحقوا بمعاوية:
«وإِنَّما هم أهل دنيا مقبلون عليها ومهطعون إليها، وقد عرفوا العدل ورأَوه، وسمعوه ووعوه، وعلموا أَنَّ النَّاس عندنا أُسوةٌ، فهربوا إلى الأَثرة، فبعداً لهم وسحقاً»([617]).
وقد كان معاوية يجد دائماً أشخاصاً من هذا النوع في مجتمع العراق، وكان يتخلص بولائهم له وطمعهم فيما عنده من مآزق حرجة([618])، وكان يتمتع بحس يوفق به إلى إثارة هذه الروح في الوقت المناسب، وبحيث يبدو فعله منسجماً مع ما يقتضيه الإنصاف والعدل، كقوله لشبث بن ربعي وقد سفر عنده لعلي مع زعيمين آخرين من أهل العراق في صفين:
«أول ما عرفت به سفهك، وخفة حلمك قطعك على هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقه، يعني سعيد بن العاص الهمداني»([619]).
ومن ذلك ما كان منه في شأن النزاع الذي حدث حول رياسة كندة وربيعة، فقد كانت للأشعث بن قيس الكندي، فعزله عنها علي ودفعها لحسان بن مخدوج من ربيعة، فلما بلغ ذلك معاوية أغرى شاعراً كندياً يقول شعراً يهيج به الأشعث وقومه، فقال شعراً عظَّم به شأن الأشعث وقومه، وهجا به حسان وربيعة، ولكن أهل اليمن فطنوا إلى ما يريد معاوية فقد قال شرع بن هانىء:
«يا أهل اليمن ما يريد صاحبكم إلاَّ أن يفرق بينكم وبين ربيعة»([620]).
وهكذا نراه يسعى إلى أن يؤجج العصبية القبلية بين القبائل العربية، فيلقي بينها العداوة والبغضاء، ويثير فيها إحن الجاهلية وأحقادها.
وأرسل معاوية في سنة 38 للهجرة ابن الحضرمي إلى البصرة، ليضرم الفتنة بين قبائلها بإثارة ذكريات حرب الجمل وقتل عثمان، وقال له:
«فأنزل في مضر، واحذر ربيعة، وتودد الأزد، وانع ابن عفان، وذكرهم الوقعة التي أهلكتهم، ومنِّ لمن سمع وأطاع، دنياً لا تفنى وأثرة لا يفقدها».
وقد وفق ابن الحضرمي إلى حد ما في إثارة إحن القبائل، وكأنما سرت هذه النار التي أججها ابن الحضرمي بين قبائل البصرة إلى قبائل الكوفة، للقرابة النسبية التي بين القبائل هنا وهناك، فقال علي (ع) يخاطب قبائل الكوفة بهذه المناسبة من جملة كلام له:
«وإذا رأيتم النَّاس بينهم النَّائرة، وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل فاقصدوا لهامهم ووجوههم بالسَّيف حتَّى يفزعوا إلى الله وإلى كتابه وسنَّة نبيِّه، فأَمَّا تلك الحميَّة فإنَّها من خطرات الشَّياطين، فانتهوا عنها لا أَباً لكم تفلحوا وتنجحوا»([621]).
وحينمابويع معاوية بالخلافة لم تخضع له البلاد الإسلامية كلها خضوعاً تاماً، فقد كان هنالك الشيعة الذين يوالون علياً وأهل بيته، وكان هنالك الخوارج الذين يتفقون مع الشيعة في عدائهم للأُمويين، وكان هنالك قبائل العراق التي لم تنظر بعين الارتياح إلى نقل بيت المال إلى الشام، وإلى تفضيل أهل الشام في العطاء على أهل العراق([622]). هذا مضافاً إلى أن كثيراً من المسلمين كانوا يرون في انتصار الأمويين انتصاراً للوثينية على الإسلام، لذلك كله كرهوا الأُمويين وغطرستهم، وكبريائهم، وإثارتهم للأحقاد القديمة، ونزوعهم للروح الجاهلية([623]).
ولقد واجه معاوية هذه الموجة العارمة من البغضاء التي قوبل بها حكمه بأنماط متعددة من السلوك كان منها ـ ولعله أهمها ـ ضرب القوى العقائدية المعادية للحكم الأُموي بعضها ببعض وإثارة الروح القبلية على نطاق واسع يكفل له انشقاق القبائل بتأثير أحقادها الصغيرة، ويخلق بينها حالة من التوتر تجعل من المتعذر عليها أن تتوحَّد، وأن تنظر إلى الحكم الأُموي نظرة موضوعية، وبذلك فاز معاوية بتفتيت المعارضة بعوامل داخلية تنبع من صميم المعارضة نفسها.
ولم تكن هذه السياسة هي اللون المفضل عند معاوية بالنسبة إلى سائر القبائل فحسب، بل كانت بهذه المنزلة عنده بالنسبة إلى أسرته الأموية ذاتها أيضاً، فقد كان ـ كما يقول ولهاوزن ـ يسعى إلى أن يدخل القطيعة بين مختلف فروع الأسرة الأُموية بالمدينة ليقضي بذلك على شوكتهم([624]).
وإذا كانت هذه هي خطته بالنسبة إلى أُسرته ذاتها فليس لنا أن نطمع منه بسلوك أنبل بالنسبة إلى سائر القبائل التي كان يخشاها على سلطانه لأن الدوافع المشتركة كانت توحدها في الوقوف ضده.
ولا يجد الباحث صعوبة كبيرة في اكتشاف هذا الخلق في معاوية، فتاريخه مليء بالشواهد عليه.
فبراعته في استغلال ما لشعراء عصره من تأثير عظيم في الرأي العام من أجل مصالحه الخاصة جعلته يستغل هؤلاء الشعراء في هذا الميدان، فيحرضهم على القول في موضوعات الفخر والهجاء كالذي كان بين القبائل في الجاهلية([625]).
من ذلك موقف شاعره الأخطل من الأنصار، فقد واصل شعراء الأنصار هجاء معاوية على أساس ديني، فرد عليهم الأخطل بهجاء قبلي جاهلي، ونظم فيهم قصيدته التي يقوم فيها:
ذهبت قريش بالمكارم والعلى
واللؤم تحت عمائم الأنصار([626])
ولا يصعب علينا أن نعرف الدوافع التي دفعت معاوية إلى اتخاذ هذا الموقف من الأنصار، فقد كانوا يقفون في صف المعارضة للحكم الأُموي إلى جانب الأُسر القرشية البارزة التي أحفظها أن تفوز أُمية بالحكم دونها، لأنهم لم ينظروا بعين الارتياح إلى استيلاء أعداء الإسلام ونبيه على الحكم بهذه السهولة، ولعله قدر أن إثارة الأحقاد القديمة التي خلفتها حروب الإسلام القديمة كفيلة بأن تنال من هذا الاتحاد بين الأنصار وبين المنافسين لأُمية من قريش.
ومن جهة أُخرى نراه يسعى إلى تفتيت وحدة الأَنصار بإثارة الأحقاد الجاهلية التي كانت بين الحيين: الأوس والخزرج، فيضرب إحدى القبيلتين بالأُخرى. وقد توصل إلى ذلك ببراعة، فقد كان يوعز إلى المغنين بإنشاد الشعر الجاهلي الذي تهاجت به القبائل قبل الإسلام. قال أبو الفرج الأصفهاني:
«كان طويس ولعاً بالشعر الذي قالته الأوس والخزرج في حروبهم، وكان يريد بذلك الإغراء، فكل مجلس اجتمع فيه هذان الحيان فغنى فيه طويسي إلاَّ وقع فيه شيء… فكان يبدي السرائر ويخرج الضغائن([627]).
وهذا عبدالله بن قيس الغطفاني، من قيس عيلان اعتدى على كثير بن شهاب الحارثي، فكتب ناس من اليمانية إلى معاوية: إن سيدنا ضربه خسيس من غطفان فإن رأيت أن تقيدنا من أسماء بن خارجة. فحمقهم معاوية، وقال كثير بن شهاب: والله لا أستقيدها إلاَّ من سيد مضر، فغضب معاوية، وأمن عبدالله وأطلقه، وأبطل ما فعله بابن شهاب فلم يقتص ولا أخذ له عقلاً([628]).
وحين تعرف أن أشد الناس إخلاصاً لعلي في العراق كانوا من قبائل اليمن، يتضح لنا لماذا يتعصب معاوية لمضر العراق على يمن العراق. هذا بالإضافة إلى أن السلطة حين تكف عن أن تكون حكماً بين القبائل في منازعاتها تسعى هذه القبائل إلى أن تقتص لنفسها، وتتناحر فيما بينها، وهي النتيجة التي يطمح إليها معاوية.
أما في الشام فنراه يتعصب لليمن على مصر، فقد تقرب إلى قبيلة كلب اليمانية، فتزوج ميسون أُم يزيد، وهي ابنة بجدل زعيم قبيلة كلب، وزوج ابنه يزيد من هذه القبيلة أيضاً، وقد اعتمد في حروبه ومؤامراته على هذه القبيلة وعلى قبائل اليمن الأُخرى: عك، والسكاسك، والسكون، وغسان، وغيرها. واضطهد مضر الشام، فلم يفرض عطاء لقيس، وهي من مضر، لثقته العظيمة بكفاءة أَنصاره اليمانيين. وهذا مسكين الدارمي، وهو شاعر يخشى لسانه ويرجى، طلب من معاوية أن يفرض له في العطاء فلم يجبه إلى ذلك لأنه مصري، فقال شعراً يرقق به قلب معاوية فلم يلتفت إليه. وقد سببت هذه المحاباة اعتزاز اليمن، فاشتد بأسها، واستطالت على الدولة، وتضعضعت قيس وسائر عدنان، وسمع معاوية كلمة من بعض أهل اليمن أثارت مخاوفه، فرأى أن يضرب اليمانيين بالمضريين، ففرض من وقته لأربعة آلاف من قيس وغيرها من عدنان، وبعث إلى مسكين يقول له:
«لقد فرضنا لك وأنت في بلدك فإن شئت أن تقيم بها أو عندنا فافعل، فإن عطاءك سيأتيك»([629]).
ولقد كانت سياسة عمال معاوية على أمصار الدولة هي سياسة معاوية نفسه. فيعمد الوالي إلى إثارة العصبيات القبلية فيما بين القبائل ليشغلها عن مراقبته والاتحاد ضده، بالتناحر عنده فيما بينها، وقد لاحظ ولهاوزن هذه الظاهرة وقال عنها:
«… وأجج الولاة نار هذه الخصومة ـ يعني الخصومة بين القبائل ـ ولم يكن تحت تصرف الولاة إلاَّ شرطة قليلة، وفيما سوى ذلك كانت فرقهم من مقاتلة المصر، وهي قوة الدفاع في القبائل، حتى إذا أحسنوا التصرف تهيأ لهم أن يضربوا القبائل بعضها ببعض، وأن يثبتوا مركزهم بينهم وكثيراً ما كان يحدث أن الوالي يعتمد على إحدى القبائل ضد الأُخرى، وبوجه عام على قبيلته التي أتى بها معه. حتى إذا أتى والٍ جديد أتت قبيلة أخرى إلى الحكم وينتج من ذلك أن القبيلة التي نحيت عن الحكم تصبح عدواً لدوداً للقبيلة التي تحكم، وهكذا أضحت الميزات القبلية ملطخة بالسياسة والخصام على الغنائم السياسية»([630]).
وقد كان زياد بن سمية من أبرع عمال معاوية في هذا الميدان، ومما يؤثر عنه أنه عندما هم بالقبض على حجر بن عدي الكندي أمر محمَّد بن الأشعث الكندي بالقبض عليه هادفاً من وراء ذلك إلى زرع بذور الشقاق في كندة، وهي من أقوى قبائل الكوفة، ليستريح من وحدتها، ويلهي كلاً من أنصار حجر وأَنصار محمَّد بأعدائه الجدد، ولكن يقظة حجر فوتت على زياد هذه الفرصة، فسلم نفسه إلى السلطة طوعاً([631]).
وقد قال عنه ولهاوزن:
«.. لكن الواقع أنه لم يقض في الكوفة على ثورة الشيعة بواسطة الشرطة بل بعون من القبائل نفسها.. وتمكنه الغيرة القائمة بين القبائل من أن يضرب بعضها ببعض»([632]).
وقال عنه أيضاً:
«.. وعرف زياد كيف يخضع القبائل بأن يضرب إحداها بالأُخرى، وكيف يجعلها تعمل من أجله. وأفلح في ذلك»([633]).
وقد سلك ابنه عبيدالله نفس هذا المسلك حين ولاه معاوية البصرة بعد أبيه، ومما يؤثر عنه في هذا الباب أنه أغرى بين صديقيه الشاعرين أنس بن زنيم الليثي وحارثة بن بدر الفداني، وكان يكره أحدهما على هجاء الآخر وقومه حتى وقع بينهما شر بسبب ذلك، وعبيدالله ماض في الإيقاع بينهما([634]).
وقد كان المغيرة بن شعبة والي الكوفة من قبل معاوية يتبع نفس هذا الأسلوب، فعندما ولي الكوفة جعل من همه أن يفسد ما بين الخوارج والشيعة، وبذلك استطاع أن يشغل الكوفيين عن معارضة الأُمويين معارضة فعالة([635]) وها هو يصر على أن يدفع بصفوة الشيعة في الكوفة والبصرة إلى حرب الخوارج ويجهز جيشاً منهم لهذه الغاية([636]).
وقد كانت عاقبة هذه السياسة أن عادت إلى الاشتعال من جديد تلك العداوات والأحقاد القديمة التي كانت بين القبائل وكان من نتائجها بعد ذلك ظهور الشعر السياسي الحزبي والقبلي. فقد شبت نيران الهجاء بين شعراء الشيعة والخوارج والأمويين، واشتعلت نيران الهجاء والمفاخرات القبلية بين القبائل نفسها، وعاضد الشعراء القبليون الأحزاب بدوافع قبلية، فقد انضم الأخطل إلى الأُمويين على قيس عيلان أعداء قومه التغلبيين، ثم انضم إلى الفرزدق على جرير لأن جريراً كان لسان القيسية على تغلب، وكان الفرزدق تميمياً، وجرير أخذته قيس عيلان.
وقد تقمصت هذه العصبية القبلية شكلاً دينياً حينما أخذت القبائل تسعى إلى اختراع الأحاديث في فضلها وتنسبها إلى النبي (ص) وذلك أن هذه القبائل لما كانت تتنازع الرياسة والفخر والشرف وجدت في الأحاديث باباً تدخل منه إلى المفاخرة كالذي وجدته في الشعر، فكم من الأحاديث وضعت في فضل قريش والأنصار وأسلم وغفار والأشعريين والحميريين وجهينة ومزينة([637]). وسنرى أن معاوية قد استأجر بعض تجار الدين لاختلاق الأحاديث في مديحه ومديح أُسرته، ولعل مساعيه هذه هي التي حملت الآخرين على اختلاق الأحاديث في تمجيد قبائلهم.
وهكذا بث معاوية روح البغضاء والنفرة بين القبائل العربية، فشغلت هذه القبائل بأحقادها الصغيرة عن مقارعة خصمها الحقيقي: الحكم الأُموي، وشغل زعماء هذه القبائل بالسعي عند الملوك الأُمويين للوقيعة بأعدائهم القبليين، وفاز معاوية ـ وخلفاؤه من بعده ـ بكونه حكماً بين أعداء هو الذي أشعل نيران العداء بينهم من حيث لا يشعرون، ووحدهم في طاعته من حيث لا يدرون، وقد دفعهم هذا الوضع إلى أن يقفوا دائماً مع الحاكمين ضد الثائرين ليحافظوا على الامتيازات الممنوحة لهم، فكانوا يقفون في وجه كل محاولة تهدف إلى الثورة على النظام القائم، ويخذلون عنها، بل ويتسابقون في استخدام أقصى ما يملكونه، من نفوذ ودهاء في هذا السبيل للتأكيد على ولائهم التام للسلطة القائمة، وقد لاحظ ولهاوزن:
«إن وضعهم ـ زعماء القبائل ـ جنح بهم إلى أن يعتصموا بالحيطة والحكمة فلا يشرعون في القيام بثورة لا هدف لها، بل يردون الجماهير عنها عندما ينطلقون فيها، وهاهم أُولاء باسم السلام والنظام يضعون نفوذهم تحت تصرف الحكومة كيلا يعرضوا وضعهم للأخطار»([638]).
والشواهد التي تدل على صدق هذه الملاحظة عما آل إليه أمر المسلمين بسبب استفحال الروح القبلية كثيرة جداً، وسيمر بعضها فيما يأتي من هذه الدراسة.
والعمل الآخر الذي قام به معاوية في هذا المجال هو إثارته للعصبية العنصرية عند العرب عموماً ضد المسلمين غير العرب. وقد أغرى هذا الموقف رؤساء القبائل العراقية فاندفعوا ينصحون الإمام علياً قائلين:
«يا أمير المؤمنين، أعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم، واستمل من تخاف خلافه من الناس».
ناظرين إلى ما يصنع معاوية، ولكن الإمام علياً أجابهم قائلاً:
«أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟ والله ما أطور به ما سمر سمير، وما أم نجم في السماء نجماً»([639]).
أما السياسة الأُموية فلها من الموالي موقف آخر. «تخاصم عربي ومولى بين يدي عبدالله بن عامر.
فقال المولى للعربي:
لا أكثر الله فينا مثلك.
فقال العربي: بل كثّر الله فينا مثلك.
فقيل له: يدعو عليك وتدعو له.
قال: نعم، يكسحون طرقنا، ويخرزون خفافنا، ويحوكون ثيابنا».
وقالوا: لا يصلح للقضاء إلاَّ عربي. واستدعى معاوية بن أبي سفيان الأحنف بن قيس وسمرة بن جندب، وقال لهما:
إني رأيت هذه الحمراء قد كثرت وأراها قد قطعت على السلف، وكأني أنظر إلى وثبة منهم على العرب والسلطان فقد رأيت أن أقتل شطراً وأدع شطراً لإقامة السوق، وعمارة الطريق.
وكان هذا الموقف العدائي من الموالي سبباً في امتهانهم وإرهاقهم بالضرائب، وفرض الجزية والخراج عليهم، وإسقاطهم من العطاء، فكان الجنود الموالي يقاتلون من غير عطاء. وكانوا يقولون: لا يقطع الصلاة إلاَّ ثلاثة: حمار، أو كلب، أو مولى. وكانوا لا يكنونهم بالكنى، ولا يدعونهم إلاَّ بالأسماء والألقاب، ولا يمشون في الصف معهم، ولا يقدمونهم في الموكب. وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم، وإن أطعموا المولى لسنه وفضله وعلمه أجلسوه على طريق الخباز لئلا يخفى على الناظر أنه ليس من العرب. ولا يدعونهم يصلون على الجنائز إذا حضر أحد من العرب وإن كان غريراً.
وكان الخاطب لا يخطب المرأة منهم إلى أبيها ولا إلى أخيها إنما يخطبها إلى مواليها، فإن رضي مولاها زوجت وإلاَّ فلا. وإن زوجها الأب أو الأخ بغير إذن مواليه فسخ النكاح وإن كان قد دخل بها عد ذلك سفاحاً. وإذا أقبل العربي من السوق ومعه شيء فرأى مولى دفعه إليه ليحمله عنه فلا يمتنع، ولا السلطان يغير عليه. وكان إذا لقيه راكباً وأراد أن ينزل فعل([640]).
وقد سبب هذا الموقف اللاإنساني من الموالي شق عصا المسلمين، وتراكم الأحقاد والعداوات بينهم، وكان سبباً في انعدام الرقابة الشعبية على الحاكمين.
وقد استمر هذا الداء الوبيل ينخر في جسم الأُمة الإسلامية حتى مزقها شر ممزق، وقضى على وحدتها التي أنشأها الإسلام وقذف بها في عباب حروب طاحنة أتت على روابط الأُلفة والمحبة، وزرعت بين طوائفها الإحن والبغضاء. ولقد كانت هذه السياسة التي سنّها معاوية وخلفاؤه لتدعيم سلطانهم بتحطيم وحدة الأُمة سبباً حاسماً في تحطيمهم، وتمكين أعدائهم منهم في نهاية المطاف([641]).
ـ 6 ـ
ج ـ التخدير باسم الدين وشل الروح الثورية
«المأخذ الدائم الذي يؤخذ على الأُمويين هو أنهم كانوا ـ أُصولاً وفروعاً أخطر أعداء النبي (ص)، وأنهم اعتنقوا الإسلام في آخر ساعة مرغمين، ثم أفلحوا في أن يحولوا إلى أنفسهم ثمرة حكم الدين أولاً بضعف عثمان، ثم بحسن استخدام نتائج قتله. هذا، وأصلهم يفقدهم مزية زعامة أُمة محمَّد (ص) ومن المحن التي بلي بها حكم الدين أنهم أصبحوا قائمين عليه ـ مع أنهم كانوا ـ وما فتئوا مغتصبين لسلطانه، وقوتهم في جيشهم الذي هو على قدم الاستعداد في الشام، ولكن قوتهم لا يمكن أن تصبح حقاً»([642]).
بهذه المشاعر ونظائرها واجه المسلمون الحكم الأُموي، وقد أراد معاوية أن يتغلب على هذا الشعور العام بسلاح الدين نفسه، كما أراد التوصل إلى تحطيم ما لأعدائه من سلطان روحي على المسلمين عن هذا الطريق أيضاً. وقد برع في هذا الميدان كل البراعة، وواتته الظروف عليه فبلغ منه أقصى ما يرجو.
وقد حفظ لنا التاريخ بعض الأسماء البارزة من أعوان معاوية في هذا اللون من النشاط. قال ابن أبي الحديد: «ذكر شيخنا أبو جعفر الأسكافي.
أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي (ع) تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله؛ فاختلقوا ما أرضاه منهم أبي هريرة وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير»([643]).
وقد استغل معاوية هؤلاء الأشخاص في سبيل إيجاد تبرير ديني لسلطان بني أُمية، أو على الأقل لكبح الجماهير عن الثورة برادع داخلي هو الدين نفسه، يعمل مع الروادع الخارجية: التجويع، والإرهاب، والانشقاق القبلي، هذا بالإضافة إلى مهمة أساسية أُخرى ألقاها معاوية على عاتق هؤلاء الأشخاص وهي اختلاق «الأحاديث» التي تتضمن الطعن في علي وأهل بيته ونسبتها إلى النبي (ص) ويوضح لنا النص الآتي مدى اتساع هذه الشبكة التي كونها معاوية، ومدى تجاوبها مع رغباته.
كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة:
«أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضائل أبي تراب وأهل بيته».
فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً ويبرؤون منه… وكتب إلى عماله أن لا تقبلوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم:
أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه والذين يروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم، وقرِّبوهم وأكرموهم، واكتبوا إليَّ بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته.
ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لما كان يبعثه معاوية إليهم من الصلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلاَّ كتب اسمه وقرَّبه وشفعه. فلبثوا بذلك حيناً.
«ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية. فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلاَّ وتأتوني بمناقض له في الصحابة؛ فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته.
فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجدَّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وأُلقي إلى معلمي الكتاتيب، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن وحتى علموه بناتهم ونساءهم، وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله. فظهر حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون، والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم، ويقربوا مجالسهم، ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل… فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي (ع) فازداد البلاء والفتنة»([644]).
وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه ـ وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم ـ في تاريخه ما يناسب هذا الخبر وقال:
«إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أُمية تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أُنوف بني هاشم»([645]).
وقد تجلى «سخاء» معاوية في هذا الميدان بوضوح فها هو ذا يبذل (للصحابي) سمرة بن جندب أربعمائة ألف درهم على أن يروي أن هذه الآية:
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾([646]).
قد نزلت في علي بن أَبي طالب. وإن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم وهي قوله تعالى:
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ…﴾([647]).
فروى ذلك([648]).
وأما أبو هريرة فقد كافأه معاوية بولاية المدينة لأنه روى عن النبي (ص) في شأن علي وبني أُمية ما يلائم ذوق معاوية وأهدافه السياسية([649]).
ومما يتصل بهذا ما تكشف عنه بعض النصوص أن من ملامح سياسة معاوية وجهازه إلغاء الرموز ذات المحتوى التاريخي الذي يعبِّر عن قيمة دينية معينة ذات أثر اجتماعي، وذلك بما يعكسه الرمز ويثيره في الأذهان من صور تاريخية تتصل بحياة النبي (ص) وبالكفاح من أجل انتصار الإسلام.
من هذه السياسة ما يكشف عنه النص الذي يتضمن أن معاوية وعمراً بن العاص أرادا أن يختبرا إمكانية إلغاء اسم «الأَنصار» الذي اشتهر به الأوس والخزرج منذ عهد الرسول (ص) وورد في القرآن الكريم اسماً لمسلمي المدينة كما كان اسم «المهاجرين» لمسلمي مكة قبل الهجرة([650]).
ولا بد أنّ هدف هذه المحاولة هو تجريد الأَنصار من القوة المعنوية التي يسبغها هذا اللقب عليهم.
قال عمرو لمعاوية:
«ما هذا اللقب يا أمير المؤمنين أردد القوم إلى أنسابهم، فقال معاوية: إني أخاف من ذلك الشنعة، فقال: هي كلمة تقولها، إن مضت عضتهم ونقصتهم».
ولكن الأَنصار انتبهوا للمحاولة، فردوها بحزم([651]).
وقد خلقت لنا هذه المدرسة ـ مدرسة معاوية في الرواية والحديث ـ ألواناً من «الأحاديث» النبوية.
منها ما يرجع إلى القدح في علي وآل بيته، وقد استفرغ معاوية غاية وسعه في هذا الميدان الذي قدمنا لك آنفاً تعريفاً بأسلوب معاوية في خوضه([652]).
ومنها ما يرجع إلى تمجيد بني أُمية ـ وعلى الأخص عثمان ومعاوية ـ ويجعلهم في مرتبة القديسين. كهذا الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله (ص):
«إن الله ائتمن على وحيه ثلاثاً: أنا، وجبرائيل، ومعاوية».
وإن النبي (ص) ناول معاوية سهماً فقال له:
«خذ هذا حتى تلقاني في الجنة» و«أنا مدينة العلم، وعلي بابها، ومعاوية حلقتها».
و«تلقون من بعدي اختلافاً وفتنة، فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله قال: «عليكم بالأمين وأصحابه، يشير بذلك إلى عثمان».
ومنها ما يحذر المسلمين من الثورة، ويزين لهم الرضوخ ويوهمهم أن الثورة على الظلم، والسعي نحو إقامة نظام عادل عمل مخالف للدين. وبدهي أن شيئاً من ذلك لم يصدر عن الله ولا عن رسوله. ومن هذه «الأحاديث» ما عن عبدالله بن عمر، قال:
«قال رسول الله (ص): إنكم سترون بعدي أثرة وأُموراً تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم».
و: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإن من فارق الجماعة شبراً فمات إلاَّ ميتة جاهلية».
و: «ستكون هناك وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جمع فاضربوه بالسيف كائناً ما كان»([653]).
وحديث العجاج قال: قال لي أبو هريرة:
ممن أنت؟ قال: قلت: من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتيك بقعان أهل الشام فيأخذوا صدقتك فإذا أتوك فتلقهم بها، فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخل عنهم وعنها. وإياك أن تسبهم، فإنك إن سببتهم ذهب أجرك، وأخذوا صدقتك، وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة»([654]).
وما شاكل هذا من الأحاديث التي تدعو المسلمين إلى الخضوع لأُمرائهم الظالمين، وتحرم عليهم الثورة على هؤلاء الأُمراء طلباً لحقهم.
إنَّ هذه (الأحاديث) تدعو إلى الصبر على الظلم والجوع والإرهاب لأن استنكار ذلك مخالف للدين.
وينطلق المأجورون من الوعاظ والمحدثين فينفثون هذه السموم في قلوب الجماهير المسلمة وعقولها، وبذلك يلجمونها عن التذكر والثورة بلجام ينسبونه إلى الدين والدين منه بريء ويقعدون بها عن الاحتجاج على سياسة العسف والظلم، ويحجزونها عن محاولة تحسين حياتها.
هذا لون من ألوان التضليل الديني الذي ابتدعه الأُمويون لتثبيت ملكهم. وهنا لون آخر من ألوان التضليل الديني استخدموه وبرعوا في استخدامه، وهو تأسيس الفرق الدينية السياسية التي تقدم للجماهير تفسيرات دينية تخدم سلطة الأُمويين وتبرِّر أعمالهم.
ومن الأمثلة البارزة في هذا الميدان فرقة المرجئة. فقد كان الأُمويون يواجهون الشيعة الذين يعتبرون بني أُمية قتلة غاصبين لتراث النبي (ص)، والخوارج الذين يرونهم كفرة تجب الثورة عليهم وإزاحتهم عن الحكم. وكان كل واحد من هذين الفريقين يقدم بين يدي دعواه حججاً دينية لا يملك الأُمويين ما يقابلها لذلك أنشأوا فرقة المرجئة التي قدمت أدلة مقابلة لأدلة الشيعة والخوارج، ووقفت ضدهم في ميدان النضال السياسي الديني.
ويحدِّثنا ابن أبي الحديد أن معاوية كان يتظاهر بالجبر والإرجاء وأن المعتزلة كفروه لذلك([655]).
لقد اعتبر المرجئة الإيمان عملاً قلبياً خالصاً لا يحتاج إلى التعبير عنه بفعل من الأفعال، فيكفي الإنسان أن يكون مؤمناً بقلبه ليعصمه الإسلام، ويحرم الاعتداء عليه، وهم ينادون:
«لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وقالوا:
«إن الإيمان الاعتقاد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه، وعبد الأوثان، ولزم اليهودية والنصرانية في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عزَّ وجلَّ، ولي لله عزَّ وجلَّ، من أهل الجنَّة»([656]).
والنتيجة المنطقية لهذا اللون من التفكير هي أن الأُمويين مؤمنون مهما ارتكبوا من الكبائر([657]) ومن نتائج ذلك أن المرجئة لا يوافقون الخوارج والشيعة على محاربتهم للأُمويين، وإزالة دولتهم، لأن حكومة الأُمويين حكومة شرعية لا يجوز الخروج عليها. ولم يسلم المرجئة بأن انصراف خلفاء بني أُمية عن تطبيق أحكام الشريعة كاف لحرمانهم من حقوقهم كأولياء الأمر في الإسلام([658]).
وقد كان المرجئة يبشرون بهذه الأفكار بين صفوف الأُمة المسلمة لأجل تخديرها وصرفها عن الاستجابة لدعاة الثورة على الأُمويين.
وبينما تجد الأُمويين يضطهدون كل دعوة دينية لا تلائمهم نراهم بالنسبة إلى المرجئة على العكس من ذلك، فهم يحتضنون هذه الفرقة، ويعطفون على قادتها، وما ذلك إلاَّ لأن معاوية سيدهم وهو واضع أُسسها وقد عرفت آنفاً أنه كان يقول بالجبر والإرجاء.
ومن البين أن هذا الموقف الذي اتخذه المرجئة من الأُمويين يتعارض تعارضاً مطلقاً مع إدراك أُولئك الذين يؤيدون مطالب العلويين، ويصوِّر لنا هذان البيتان من الهجاء نظرة الشيعة إلى المرجئة:
| إذا المرجي سرك أن تراه | يموت بدائه من قبل موته | |
| فجدد عنده ذكرى علي | وصل على النبي وآل بيته([659]) |
وإلى جانب ما تقدم اعتمد الأُمويون أسلوباً آخر من أساليب التضليل الديني لدعم حكمهم وصرف الناس عن الثورة عليهم.
فقد واجه الأُمويون خطرٌ ساحقاً عليهم من عقيدة القدرية القائلين بحرية الإرادة والاختيار، وإن الإنسان هو الذي يختار نوع السلوك والعمل الذي يمارسه في حياته، وإذا كان حراً فهو مسؤول عن أفعاله لأن كل حرية تستتبع حتماً المسؤولية.
هذه العقيدة كانت خطراً على الأُمويين الذين يفرقون من رقابة الأُمة عليهم وعلى تصرفاتهم، ولذلك فقد اضطهدوا هذه العقيدة ودعاتها وتمسكوا بالعقيدة المضادة لها: عقيدة الجبر([660]) فهذه هي العقيدة التي تلائمهم في الميدان السياسي لأنها توحي إلى الناس بأن وجود الأُمويين وتصرفاتهم مهما كانت شاذة وظالمة ليست سوى قدر مرسوم من الله لا يمكن تغييره ولا تبديله، فلا جدوى من الثورة عليه. وها هو معاوية يتظاهر بالجبر والإرجاء كما قدمنا لأجل تبرير أفعاله أمام الملأ بأنها مقدورة لا سبيل إلى تبديلها، مع كونها في الوقت نفسه غير قادحة فيه باعتباره حاكماً دينياً.
ولا بد أنه قد عهد بإذاعة أفكاره الخاصة حول هاتين العقيدتين ـ الجبر والإرجاء ـ بين المسلمين إلى ولاته وأجهزة الدعاية عنده، ومنها القصاص، قال الليث بن سعد:
«وأما قصص الخاصة فهو الذي أوجده معاوية، ولَّى رجلاً على القصص فإذا سلَّمَ من صلاة الصبح جلس وذكر الله عزَّ وجلَّ وحمده ومجَّده، وصلى على النبي (ص) ودعا للخليفة ولأهل بيته وحشمه وجنوده، ودعا على أهل حربه وعلى المشركين. كافة»([661]).
وأمر رجلاً يقص بعد الصبح وبعد المغرب يدعو له ولأهل الشام([662]). ولا بد أن هذا الدعاء كان استهلالاً يبتدىء به القاص ثم يأخذه بعده في قصصه.
ومثل معاوية لا يجهل الفوائد الجليلة التي يمكن أن تقدمها له عقيدة الجبر، فهو ـ وسائر الأُمويين ـ كانوا يعلمون أن أُسرتهم غير محتملة من المسلمين، ويعلمون أنهم في نظر كثير من رعاياهم مختلسون، وصلوا إلى السلطان بوسائل قهرية شديدة، وأنهم أعداء لآل النبي (ص)، وقتلة لأشخاص مقدسين لا ذنب لهم. وإن كان ثمة عقيدة تمسك الناس عن أن يثوروا عليهم وعلى ولاتهم لكانت عقيدة الجبر، هذه العقيدة التي توحي إلى الناس بأن الله قد حكم منذ الأزل أن تصل هذه الأُسرة إلى الحكم، فأعمالهم وتصرفاتهم ليست إلاَّ نتيجة لقدر إلهي محكم، من أجل ذلك كان حسناً جداً لهم ولدولتهم أن تتأصل هذه الأفكار في أذهان الأُمة([663]).
وقد استغل الشعر إلى جانب النصوص الدينية في سبيل تعزيز هذه الأفكار، فقد كان معاوية ـ كما يقول بروكلمان ـ قادراً على أن يفيد مما لشعراء عصره من تأثير عظيم في الرأي العام بسبيل مصالحه العائلية([664]).
فكان معاوية ـ وملوك بني أُمية من بعده ـ يسمعون راضين شعراءهم، بل ويحملون هؤلاء الشعراء على أن يقولوا الشعر الذي يمجدونهم فيه بنعوت تجعل سلطانهم وسيادتهم قدراً مقدوراً من الله، ومن أجل ذلك لا يمكن أن يثور المؤمن ضدهم.
فمعاوية عند الأخطل ليس ملكاً كما وصف نفسه في ساعة من ساعات سهوه، بل خليفة الله، والظفر الذي حازه ليس ناشئاً من أسبابه الطبيعية، وإنما هو من صنع الله:
| إلى امرىء لا تعدينا نوافله | أظفره الله فيهنأ له الظفر | |
| الخائض الغمر والميمون ظائره | خليفة الله يستسقى به المطر |
ولم يفضل الأمويون غيرهم ـ عند الأخطل ـ بماضيهم المجيد في الجاهلية ولا بسخائهم ولا بنجدتهم وشجاعتهم، وإنما فضلهم الله. ولم يكن رفع المصاحف في صفين خدعة تفتق عنها ذهن ابن العاص، وإنما هو إلهام من الله، وأخيراً فالله هو الذي مكنهم من الثأر لعثمان حين أوصلهم إلى سدة الحكم:
| تمت جدودهم والله فضلهم | وجد قوم سواهم خامل نكد | |
| هم الذين أجاب الله دعوتهم | لما تلاقت نواصي الخيل واجتلدوا | |
| ويوم صفين والأبصار خاشعة | يمدهم إذ دعوا من ربهم مدد | |
| على الأُلى قتلوا عثمان مظلمة | لم ينههم نشد عنه وقد نشدوا |
والأخطل ـ كسائر شعراء عصره ـ ذو روح جاهلية تعرف الفضل بالنسب وما إليه من عنعنات الجاهليين، لا بالله، وتعرف النصر بالشجاعة والقوة، والكثرة، والدهاء، لا بالله، فهذا النفس الديني الذي يشبه أن يكون صوفياً لكثرة ذكر الله فيه ليس من طبيعة الأخطل، وإنما هو موحى به من ممدوحه أو من هؤلاء الذين بثهم معاوية لصوغ أفكاره الخاصة بما يشيع بين العامة، سواء كان ذلك بالرواية عن النبي (ص) أو بالشعر.
ومسكين الدارمي يقول في شأن عقد ولاية العهد ليزيد:
| ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر | ومروان أم ماذا يقول سعيد | |
| بني خلفاء الله مهلاً فإنما | يبوئها الرحمن حيث يريد | |
| إذا المنبر الغربي خلاه ربه | فإن أمير المؤمنين يزيد |
وكما أن مذهب الجبر استخدم لتبرير حال الأسرة الأُموية على العموم، فقد استخدم أيضاً في تهدئة الشعب حين كان يبتلى أو يغرى بأن يرى في أعمال الحكام والعمال الظلم والطغيان([665]).
لقد رأينا أن سياسة الاضطهاد والتجويع خنقت نزعة الحرية في النفوس، وحملت الجماهير على أن ترضى بحياة ذليلة مضطهدة خشية أن تصير إلى لون من الحياة أقصى وأنكد. ورأينا أن الروح القبلية حوَّلت الإنسان المسلم عن أهدافه العظيمة التي وجهه إليها الإسلام وشغلته بأهداف أُخرى تتصل بأُفقه القبلي الضيق، وصنمه القبلي الجديد.
فهنا عامل نفسي وهو الخوف، وعامل اجتماعي وهو الوضع القبلي كانا يقعدان بالإنسان المسلم عن الثورة، ويحملانه على تقبل حياته على ما فيها من نكد وقسوة وحرمان، ولكنهما ما كانا ليحملا الرضى الباطني لروح القلقة المعذبة، فقد كان يشعر بالإثم لسكوته عن الحكم الأُموي وقد كان يشعر بالإثم.. لقعوده عن محاولة تطهير المجتمع من المنكرات التي يراها، وقد كان هذا الشعور بالإثم كفيلاً بأن يدفعه في النهاية إلى التغلب على الخوف في نفسه، وإلى تحطيم النطاق القبلي الذي يغله.
ولكن هذا الركن الثالث من أركان السياسة الأُموية أعني التضليل الديني، تكفل بإيجاد تبرير ديني للوضع الاجتماعي الشاذ الذي كان عليه المجتمع الإسلامي، وأُريد منه حمل الجماهير المسلمة على السكوت عن النقد والقعود عن محاولة تغيير الوضع إلى مستوى أحسن، وبذلك يختفي الشعور بالإثم من الضمير الجماهيري، هذا الشعور الذي يدفع إلى الثورة حين يبلغ درجة ضغط عالية. وعندما يضمحل الشعور بالإثم يستقر المجتمع نهائياً، فهناك عامل نفسي وديني يدفعه إلى الخضوع، وهناك عامل اجتماعي يجعله حتمياً، وحينئذٍ يطمئن الحاكمون إلى أن تصرفاتهم لن تثير أي استنكارً لدى الجماهير.
كان هذا هو الوضع النفسي لهؤلاء الذين أخذوا بأساليب الأُمويين في التخدير الديني، وأما أُولئك الذين لم يؤخذوا بهذا اللون من الدعاية ولم تنطلِ عليهم أحابيل الأُمويين وأكاذيبهم فقد كان لهم وضع آخر لا يقل إثارة للأسى عن هذا الوضع.
لقد صار الأمر بهؤلاء الآخرين إلى ازدواج الشخصية. فقد علَّمَت سياسة معاوية المالية، وأُسلوبه الوحشي في التنكيل بأعدائه العزل من السلاح، الناس على الدجل والنفاق والسكوت عن الحق، والظاهر بخلاف ما يعتقدون توصلاً إلى دنيا معاوية، تمسكاً بروحهم القبلية التي تفرض عليهم أن يتبعوا ساداتهم القبليين دون تروٍّ أو تفكير. وهذا الوضع الشاذ، الوضع الذي يفرض عليهم أن يخفوا دوماً ما يعتقدونه حقاً واقعاً، وأن يتظاهروا بما تريده السلطة منهم، ولد عندهم ازدواج الشخصية، هذا الازدواج الذي يرجع إليه سر المأساة الدامية، الطويلة الأمد التي عاشها الثائرون على حكام الجور من الأُمويين والعباسيين ومن تلاهم من الظالمين، هذا الازدواج الذي كان يعمل عمله في فض أعوان الثورة عنها بتأثير الشخصية الخارجية المنسجمة مع السلطة بعد أن كانوا قد تعاقدوا على نصرها بدافع من شخصيتهم الأُخرى، الشخصية التي تطاردها السلطة وتحاربها، هذا الازدواج الذي صوره الفرزدق للحسين حين لقيه في بعض الطريق فسأله عن أهل الكوفة:
«قلوبهم معك وسيوفهم عليك».
ولقد كانت هذه السياسة خليقة بأن تنتهي بالمجتمع الإسلامي إلى حالة تعسة من الذل والخنوع، ومن تفاهة الحياة، وأهداف تلك الحياة.
لقد كانت خليقة بأن تحول المسلم من إنسان يستبد به القلق لمصير الإنسانية كلها ويعبر عن هذا القلق بالاهتمام المباشر والعمل الإيجابي المؤدي إلى التخفيف من ويلات الإنسان في كل مكان إلى إنسان قبلي ضيق الأُفق، يعيش داخل نطاق قوقعته القبلية التي كانت قبل الإسلام تغل الإنسان العربي داخل إطارها فتعوق شخصيته عن النمو والامتداد خارج حدود كيانه القبلي، والتي عادت في عهد معاوية تعمل عملها المدمر مرة أُخرى.
ولقد كانت خليقة بأن تحوله من إنسان عقائدي، تسير حياته على خط مستقيم، خط النضال من أجل العقيدة، التي يحرر بها غيره من الناس ويرد إليهم اعتبارهم الإنساني المسلوب، إلى إنسان لا ترتكز حياته على عقيدة، ولا يحفزه مطمح عظيم، إنسان تستبد به النزوات الطارئة، والمنافع القريبة، وتجعله تارة هنا وتارة هناك.
ولقد كانت خليقة بأن تحوله من إنسان يعي وعياً عميقاً أن حياته الشخصية ليست ملكاً له بقدر ما هي ملك للجماعة الإنسانية فإذا تعرضت الجماعة لتحد يهددها بذل حياته مغتبطاً في نضال هذا التحدي إلى إنسان يحرص على هذه حرصاً شديداً مهما كانت ملفعة بالذل ومجللة بالعار، ومهما كانت مزيفة وناصلة.
ولقد كانت خليقة بأن تحوله من إنسان يحارب الظلم ويناجزه ويثور عليه أياً كان مصدره. فيكره الظلم من نفسه ويحملها على العدل، ويكره الظلم من غيره ويحمله على العدل إلى إنسان يكافح من أجل أن يكون ظالماً إذا لم تقهره قوة على أن يكون مظلوماً.
وكانت خليقة بأن تحوله من إنسان يفهم أن الدين لا يجعل من المؤمنين به عبيداً لطاغية يحكمهم باسم الدين إلى إنسان يؤيد الطغاة الحاكمين.
وكانت خليقة بأن تحوله من إنسان يرى أن الثورة على سياسة التجويع والإرهاب حق إلى إنسان يحارب الثائرين.
وتاريخ هذه الفترة من حياة المسلمين حافل بالشواهد على أن هذا التحول كان قد بدأ يظهر للعيان، ويطبع المجتمع الإسلامي بطابعه، ويمكننا أن نخرج بفكرة واضحة عن أثر هذه السياسة في المجتمع الإسلامي حين نقارن بين رد الفعل الذي واجه به المسلمون سياسة عثمان وعماله وبين موقفهم من سياسة معاوية، فقد كان رد الفعل لسياسة عثمان وعماله ثورة عارمة من معظم أقطار الأمة المسلمة: من المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر وغيرها من حواضر المسلمين وبواديهم، فهل نجد رد فعل جماعياً كهذا لتحديات معاوية في سياسته اللاإنسانية للجماهير المسلمة، مع ملاحظة أن الظلم على عهد معاوية أفدح، والاضطهاد والقتل والإرهاب أعم وأشمل، وحرمان الأُمة من حقوقها في ثرواتها وإنتاجها أظهر.
الحق أننا لا نجد شيئاً من ذلك أبداً. لقد كانت الجماهير خاضعة خضوعاً أعمى.
نعم، كانت ثمة احتجاجات تنبعث من هنا تارة ومن هناك أُخرى، تدل على أن المجتمع يتململ تحت وطأة الاضطهاد والظلم، كتلك التي عبر عنها موقف حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي وأضرابهما([666]) ولكنها لم تأخذ مداها، ولم تعبر عن نفسها في حركة فعلية عامة، بل كانت سرعان ما تهمد وتموت في مهدها حين كانت السلطة تأخذ طلائع هذه الحركات فيقتلون دون أن يحرك المجتمع ساكناً وإذا حدث وتحرك.. إنسان اشترى سكوته بالمال([667]).
ومنذ بدأ الحكام المسلمون يناوئون النزعة الإنسانية في الإسلام ليحولوه إلى مؤسسة تخدم مآرب فئة خاصة بدأ علي وأبناؤه وأصحابهم يدافعون عن الإسلام ويردون عنه شر من يريد تحريفه وتزويره.
كان هذا هو عمل علي طيلة حياته حتى إذا استشهد خلفه في الصراع ابنه الحسن، وقضت عليه ظروف المجتمع الإسلامي الاجتماعية والنفسية أن يهيىء هذا المجتمع للثورة على الحكم الأُموي. حتى استشهد.
وبقي الحسين وحيداً.
وقد عاصر الحركة التي بدأها أعداء الإسلام: الدخلاء فيه. والموتورون، والحاقدون، وطلاب المنافع العاجلة في حربهم ضد الإسلام وضد مبادئه الإنسانية. عاصر هذه الحركة منذ نشوئها: عاصرها حيناً مع أخيه والصفوة من الأصحاب. وعاصرها حيناً مع أبيه وأخيه وبقية السيف الأُموي من الأصحاب، وها هوذا الآن يقف وحيداً في ساحة الصراع. إنه يقف وحيداً ضد معاوية وجهاز حكمه الإرهابي. ويرى بعينيه كيف يراد للأُمة المسلمة أن تتحول عن الأهداف العظيمة التي كونت لأجلها، وكيف تزيف حياتها. وكيف يراد لوجودها أن يضمر ويضيق لينحصر في لقمة العيش وفي حفنة من الدراهم يبيع المسلم بها حياته وضميره وحريته وكرامته الإنسانية للحاكمين الظالمين.
وقد رأى منهج معاوية وبطانته الذي اعتمدوه للوصول بالأُمة المسلمة إلى هذا المصير الكالح، رأى كيف يطارد الناس ويجوعون ويضطهدون وينكل بهم لأنهم يخالفون السلطة في الهوى السياسي، ورأى كيف يحرف الإسلام وتزور مبادئه الإنسانية في سبيل المآرب السياسية، ورأى حملة التخدير الديني والكذب على الله ورسوله، ورصد عن كثب محاولة إفساد المجتمع بتشجيع الروح القبلية والنزعة العنصرية.
ولقد أراد الأُمويون من الحسين أن يخضع لهم لأن خضوعه يؤمن لهم انقياد الأُمة المسلمة كلها، ويمكنهم من ممارسة سياستهم دون خشية، أراد ذلك معاوية بن أَبي سفيان حين عزم على أخذ البيعة بولاية العهد ليزيد من بعده، وتوسل إلى ذلك بالشدة حيناً وباللِّين حيناً آخر فما نال بغيته([668]). وأراد ذلك يزيد حين صار إليه الأمر بعد أبيه. ولكن الحسين أبى أن يخضع لأنه كان يعي أعمق الوعي دوره التاريخي الذي يفرض عليه أن يثور لتهز ثورته ضمير الأُمة التي اعتادت الانحناء أمام جبروت السلطة الحاكمة، اعتادت ذلك حتى ليخشى ألا يصلحها شيء.
إن المجتمع الذي خضع طويلاً لتأثير السياسة الأُموية والتوجيه الأُموي لا يمكن أن يصلح بالكلام، فهو آخر شيء يمكن أن يؤثر فيه… إن الكلمة لا يمكن أن تؤثر شيئاً في النفس الميتة، والقلب الخائر، والضمير المخدر كان لا بد لهذا المجتمع المتخاذل من مثال يهزه هزاً عنيفاً، ويظل يواليه بإيحاءاته الملتهبة، ليقتلع الثقافة العفنة التي خدرته، وقعدت به عن صنع مصير وضاء.
وهذا الواقع الكالح وضع الإمام الحسين وجهاً لوجه أمام دوره التاريخي ورسالته النضالية، هذا الدور الذي يفرض عليه أن يثور، وأن يعبِّر بثورته عن شعور الملايين، وأن يهز بثورته هذه الملايين نفسها، ويضرب لها المثل والقدوة في حرب الظالمين.
وقد كان كل ذلك وكانت ثورة الحسين.
محمَّد مهدي شمس الدين
دوافع الثورة وأسبابها
كانت مبررات الثورة على الحكم الأُموي متوفرة في عهد معاوية، وقد كان الإمام الحسين يعرفها، وقد عبَّر عنها في عدة كتب وجهها إلى معاوية جواباً عن كتبه إليه، وهي كثيرة نقتبس منها قوله في كتاب:
«وهيهات هيهات يا معاوية، فضح الصبح فحمة الدجى، وبهرت الشمس أنوار السرج. ولقد فضلت حتى أفرطت واستأثرت حتى أجحفت، ومنعت حتى بخلت، وجرت حتى جاوزت، ما بذلت لذي حق من اسم حقه بنصيب حتى أخذ الشيطان حظه الأوفر، ونصيبه الأكمل…»([669]).
وقوله في كتاب آخر:
«أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عني أُمور أنت لي عنها راغب، وأنا بغيرها عندك جدير، فإن الحسنات لا يهدي إليها ولا يسدد إليها إلاَّ الله تعالى.
وأما ما ذكرت أنه رقى إليك عني فإنما رقاه إليك الملاقون، المشاؤون بالنميم، المفرقون بين الجمع، وكذب الغاوون.
وما أردت لك حرباً، ولا عليك خلافاً، وإني لأخشى الله في ترك ذلك منك، ومن الأعذار فيه إليك، وإلى أوليائك القاسطين الملحدين، حزب الظلمة وأولياء الشياطين.
«ألست القاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه المصلين العابدين، الذين كانوا ينكرون الظلم، ويستفظعون البدع، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يخافون في الله لومة لائم؟ ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً، من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظة، والمواثيق المؤكدة ألا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم، جرأة على الله واستخفافاً بعهده.
«أو لست قاتل ابن الحمق صاحب رسول الله (ص) العبد الصالح، فقتلته بعدما آمنته؟
أو لست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد من ثقيف؟ فزعمت أنه ابن أبيك، وقد قال رسول الله (ص) «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» فتركت سنة رسول الله (ص) وتبعت هواك بغير هدى من الله، ثم سلطته على أهل الإسلام، يقتلهم، ويقطع أيديهم، وأرجلهم، ويسمل عيونهم، ويصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من هذه الأُمة وليسوا منك.
«أو لست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم على دين علي صلوات الله عليه؛ فكتبت إليه أن أقتل كل من كان على دين علي فقتلهم ومثَّل بهم بأمرك، ودين علي هو دين ابن عمه (ص) الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك، وبه جلست مجلسك الذي أنت فيه.
«قلت فيما قلت: انظر لنفسك ولدينك، ولأُمة محمَّد، واتق شق عصا هذه الأُمة، وأن تردهم إلى فتنة، وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأُمة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظراً لنفسي ولديني، ولأُمة محمَّد (ص) من أن أُجاهدك…
وقلت فيما قلت: أن أنكرك تنكرني، وأن أكدك تكدني، فكد ما بدا لك، فإني أرجو ألا يضرني كيدك، وأن لا يكون على أحد أضر منه على نفسك، لأنك قد ركبت جهلك، وتحرصت على نقض عهدك، ولعمري ما وفيت بشرط، ولقد نقضت عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان، والعهود والمواثيق، ولم تفعل ذلك إلاَّ لذكرهم فضلنا، وتعظيمهم حقنا، وليس الله بناس لأخذك بالظنة، وقتلك أولياءه على التهم، ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة..»([670]).
ولذا، فإن الباحث يتساءل عن السر في قعود الحسين (ع) عن الثورة في عهد معاوية مع وجود مبررات الثورة في عهده. فلماذا لم تدفعه هذه المبررات إلى الثورة في أيام معاوية، وحملته على الثورة في أيام يزيد؟
الذي نراه في الجواب على هذا التساؤل هو أن قعود الحسين عن الثورة في عهد معاوية، كانت له أسباب موضوعية لا يمكن تجاهلها، ويمكن إجمالها فيما يلي:
ـ 1 ـ
أ ـ الوضع النفسي والاجتماعي
لقد كانت حروب الجمل وصفين والنهروان. والحروب الخاطفة التي نشبت بين القطع السورية وبين مراكز الحدود في العراق والحجاز واليمن بعد التحكيم قد ولدت عند أصحاب الإمام (ع) حنيناً إلى السلم والموادعة، فقد مرت عليهم خمس سنين وهم لا يضعون سلاحهم من حرب إلاَّ ليشهروه في حرب أُخرى، وكانوا لا يحاربون جماعات غريبة عنهم، وإنما يحاربون عشائرهم وإخوانهم بالأمس، ومن عرفهم وعرفوه.
وما نشك في أن هذا الشعور الذي بدأ يظهر بوضوح في آخر عهد علي إثر إحساسهم بالهزيمة أمام مراوغة خصمهم في يوم التحكيم أفاد خصوم الإمام من زعماء القبائل ومن إليهم ممن اكتشفوا أن سياسته لا يمكن أن تلبي مطامحهم التي تؤججها سياسة معاوية، في المال والولايات فحاولوا إذكاء هذا الشعور والتأكيد عليه، وقد ساعد على تإثير هؤلاء الزعماء ونفوذهم في أوساط المجتمع الروح القبلية التي استفحلت في عهد عثمان بعد أن أُطلقت من عقالها بعد وفاة النبي (ص). فإن الإنسان ذا الروح القبلية عالمه قبيلته، فهو ينفعل بانفعالاتها، ويطمح إلى ما تطمح إليه، ويعادي من تعادي، وينظر إلى الأُمور من الزاوية التي تنظر منها القبيلة، وذلك لأنه يخضع للقيم القبلية التي تخضع لها القبيلة وتتركز مشاعر القبيلة كلها في رئيسها، فالرئيس في المجتمع القبلي هو المهيمن والموجه للقبيلة كلها.
وقد عبَّر الناس عن رغبتهم في الدعة وكراهيتهم للقتال بتثاقلهم عن الخروج لحرب الفرق السورية التي كانت تغير على الحجاز واليمن وحدود العراق، وتثاقلهم عن الاستجابة للإمام حين دعاهم للخروج ثانية إلى صفين.
فلما استشهد الإمام علي وبويع الحسن بالخلافة برزت هذه الظاهرة على أشدها وبخاصة حين دعاهم الحسن للتجهز لحرب الشام، حيث كانت الاستجابة بطيئة جداً.
وبالرغم من أن الإمام الحسن قد استطاع بعد ذلك أن يجهز لحرب معاوية جيشاً ضخماً إلاَّ أنه كان جيشاً كتبت عليه الهزيمة قبل أن يلاقي العدو بسبب التيارات المتعددة التي كانت تتجاذبه. فقد:
«خف معه أخلاط من الناس: بعضهم شيعة له ولأبيه، وبعضهم محكمة أي خوارج يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة، وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم، وبعضهم شكاك، وأصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم»([671]).
وقد كان رؤساء القبائل هؤلاء قد باعوا أنفسهم من معاوية، الذي كتب إلى كثير منهم يغريهم بالتخلي عن الحسن والالتحاق به وأكثر أصحاب الحسن لم يستطيعوا مقاومة هذا الإغراء فكاتبوا معاوية واعدين بأن يسلموه الحسن حياً أو ميتاً. وحين خطبهم الإمام الحسن ليختبر مدى إخلاصهم وثباتهم هتفوا به من كل جانب: «البقية البقية»، بينما هاجمته طائفة منهم تريد قتله، هذا في الوقت الذي أخذ الزعماء يتسللون تحت جنح الليل إلى معاوية بعشائرهم.
ولما رأى الإمام الحسن ـ أمام هذا الواقع السيء ـ أن الظروف النفسية والاجتماعية في مجتمع العراق جعلت هذا المجتمع عاجزاً عن النهوض بتبعات القتال وانتزاع النصر، ورأى أن الحرب ستكلفه استئصال المخلصين من أتباعه بينما يتمتع معاوية بنصر حاسم، حينئذٍ جنح إلى الصلح بشروط منها ألا يعهد معاوية لأحد من بعده، وأن يكون الأمر للحسن وأن يترك الناس ويؤمنوا.
ولقد كان هذا هو الطريق الوحيد الذي يستطيع الحسن أن يسلكه باعتباره صاحب رسالة قد اكتنفته هذه الظروف السيئة الموئسة.
ونحن حين نسمح لأنفسنا أن نندفع وراء العاطفة نحسب أنه كان على الحسن أن يحارب معاوية وألاَّ يهادنه، وأن ما حدث لم يكن إلاَّ استسلاماً مذلاً مكن معاوية من أن يستولي على الحكم بسهولة ما كان يحلم بها. وقد انزلق في هذا الخطأ كثير من أصحابه المؤمنين المخلصين وقد عبَّر بعضهم عن المرارة التي يحس بها بأن خاطب الحسن بقوله: (يا مذل المؤمنين). هذا؛ ولكن علينا أن نفكر بمقاييس أُخرى إذا شئنا فهم موقف الإمام الحسن الذي يبدو محيراً لأول وهلة، فلا شك أن الإمام الحسن لم يكن مغامراً، ولا طالب ملك، ولا زعيماً قبلياً يفكر ويعمل بالعقلية القبلية، وإنما كان صاحب رسالة وحامل دعوة وكان عليه أن يتصرف على هذا الأساس. ولقد كان الموقف الذي اتخذه هو الموقف الملائم لأهدافه كصاحب رسالة وإن كان ثقيلاً على نفسه، مؤلماً لمشاعره الشخصية.
لقد كان من الممكن بالنسبة لقائد محاط بنفس الظروف السيئة التي كان الإمام الحسن (ع) محاطاً بها أن يتخذ من الأحداث أحد ثلاثة مواقف:
الأول: أن يحارب معاوية رغم الظروف السيئة، ورغم النتائج المؤلمة التي تترتب على هذا الموقف.
الثاني: أن يسلم السلطة إلى معاوية، وينفض يده من الأمر، ويتخلى عن أهدافه، ويقنع بالغنائم الشخصية.
الثالث: أن يخضع للظروف المعاكسة فيتخلى مؤقتاً عن الصراع الفعلي المسلح، لكن لا ليرقب الأحداث فقط، وإنما ليكافح على صعيد آخر، فيوجه الأحداث في صالحه وصالح أهدافه.
ما كان للحسن باعتباره صاحب رسالة أن يتخذ الموقف الأول، لأنه لو حارب معاوية في ظروفه التي عرضناها، وبقواه المفكَّكة المتخاذلة لكانت نتيجة ذلك أن يقتل ويستأصل المخلصون من أتباعه، ولا شك أنه حينئذٍ كان يحاط بهالة من الإكبار والإعجاب لبسالته وصموده، ولكن النتيجة بالنسبة إلى الدعوة الإسلامية ستكون سيئة إلى أبعد حد، فإنها كانت ستفقد فريقاً من أخلص حماتها دون أن تحصل على شيء سوى أسماء جديدة تضاف إلى قائمة شهدائها.
كذلك ما كان له باعتباره صاحب رسالة أن ينفض يده من كل شيء ويسترسل في حياة الدعة والرغد، والخلو من هموم القيادة والتنظيم.
لقد كان الموقف الثالث ـ وهو الموقف الذي اتخذه الإمام الحسن ـ هو الموقف الوحيد الصحيح بالنسبة إليه، وذلك أن يعقد مع معاوية هدنة يعد فيها المجتمع للثورة.
وذلك لأننا نسمح لأنفسنا أن نقع في خطأ كبير حين ننساق إلى الاعتقاد بأن الإمام الحسن قد اعتبر الصلح خاتمة مريحة لمتاعبه، فما صالح الإمام الحسن ليستريح، وإنما ليكافح من جديد ولكن على صعيد آخر.
فإذا كان الناس قد كرهوا الحرب لطول معاناتهم لها ورغبوا في السلم انخداعاً بحملة الدعاية التي بثها فيهم عملاء معاوية، إذ منوهم بالرخاء والأُعطيات الضخمة، والدعة والسكينة، وطاعة لرغبات زعمائهم القبليين، فإن عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم مدى الخطأ الذي وقعوا فيه حين ضعفوا عن القيام بتبعات القتال، وسمحوا للأماني بأن تخدعهم ولزعمائهم بأن يضللوهم، ولا يمكن أن يكتشفوا ذلك إلاَّ إذا عانوا هذا الحكم بأنفسهم: عليهم أن يكتشفوا طبيعة هذا الحكم وواقعه، وما يقوم عليه من اضطهاد وحرمان ومطاردة مستمرة، وخنق للحريات. وعلى الإمام الحسن وأتباعه المخلصين أن يفتحوا أعين الناس على هذا الواقع وأن يهيئوا عقولهم وقلوبهم لاكتشافه، والثورة عليه، والإطاحة به.
ولم يطل انتظار أهل العراق، فقد قال لهم معاوية حين دخل الكوفة:
«يا أهل الكوفة! أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون. ألا أن كل دم أُصيب في هذه مطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين»([672]).
ثم أتبع ذلك طائفة من الإجراءات التي صدمت العراقيين: أنقص من أُعطيات أهل العراق ليزيد في أُعطيات أهل الشام وحملهم على أن يحاربوا الخوارج فلم يتح لهم أن ينعموا بالسلم الذي كانوا يحنون إليه ثم طبق منهاجه الذي شرحناه في الفصل السابق: الإرهاب والتجويع والمطاردة، ثم أعلن بسب أمير المؤمنين (ع) على منابر المسلمين.
وبينما راح الزعماء القبليون يجنون ثمرات هذا العهد بدأ العراقيون العاديون يكشفون رويداً رويداً طبيعة هذا الحكم الظالم الشرس الذي سعوا إليه بأنفسهم، وثبتوه بأيديهم.
«وقد جعل أهل العراق يذكرون حياتهم أيام علي فيحزنون عليها، ويندمون على ما كان من تفريطهم في جنب خليفتهم ويندمون على ما كان من الصلح بينهم وبين أهل الشام، وجعلوا كلما لقي بعضهم بعضاً تلاوموا فيما كان، وأجالوا الرأي فيما يمكن أن يكون، ولم تكد تمضي أعوام قليلة حتى جعلت وفودهم تفد إلى المدينة للقاء الحسن، والقوله له والاستماع منه».
«وقد أقبل عليه ذات يوم وفد من أشراف أهل الكوفة فقال له متكلمهم سليمان بن صرد الخزاعي:
«ما ينقضي تعجبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأخذ العطاء وهم على أبواب منازلهم، ومعهم مثلهم من أبناءهم وأتباعهم، سوى شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجاز، ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العقد ولا حظاً من العطية، فلو كنت إذ فعلت ما فعلت أشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق والمغرب وكتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك بعده كان الأمر علينا أيسر، ولكنه أعطاك شيئاً بينك وبينه، ثم لم يف به، ثم لم يلبث أن قال على رؤوس الناس: إني كنت شرطت شروطاً وعدت عدات إرادة لإطفاء نار الحرب، ومداراة لقطع هذه الفتنة، فأما إذا جمع الله لنا الكلمة والألفة، وأمننا من الفرقة فإن ذلك تحت قدمي. فوالله ما اغترني بذلك إلاَّ ما كان بينك وبينه وقد نقض، فإن شئت فأعد الحرب جذعة، وأذن لي في تقدمك إلى الكوفة، فأخرج عنها عامله وأظهر خلعه، وتنبذ إليهم على سواء أن الله لا يحب الخائنين».
وقال الآخرون مثل ما قال سليمان بن صرد… فقال لهم فيما روى البلاذري:
«أنتم شيعتنا، وأهل مودتنا، فلو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل، ولسلطانها أعمل وأنصب ما كان معاوية بأبأس مني بأساً ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزيمة، ولكني أرى غير ما رأيتم، وما أردت فيما فعلت إلاَّ حقن الدماء، فارضوا بقضاء الله، وسلموا الأمر، والزموا بيوتكم، وأمسكوا، وكفوا أيديكم حتى يستريح بر ويستراح من فاجر».
«فقد أعطاهم الحسن ـ كما ترى ـ الرضى حين أعلن إليهم أنهم شيعة أهل البيت وذووا مودتهم، وإذن فمن الحق عليهم أن يستمعوا له ويأتمروا بأمره، ويكونوا عندما يريد منهم، ثمَّ طلب إليهم أن يرضوا بقضاء الله: يطيعوا السلطان، ويكفوا أيديهم عنه. وأنبأهم بأنهم لن يفعلوا ذلك آخر الدهر، ولن يستسلموا لعدوهم بغير مقاومة، وإنما انتظار إلى حين، هو انتظار إلى أن يستريح الأبرار من أهل الحق، أو يريح الله من الفجار من أهل الباطل.
«فهو إذن يهيئهم للحرب حين يأتي إبّانها، ويحين حينها، ويأمرهم بالسلم المؤقتة حتى يستريحوا ويحسنوا الاستعداد.
ومن يدري لعل معاوية أن يريح الله منه، فتستقبل الأُمة أمرها على ما يحب لها صالحوا المؤمنين»([673]).
ولم يكن سليمان بن صرد ومن معه منفردين في هذه الحركة، فكثيراً ما جاء العراقيون إلى الحسن يطلبون منه أن يثور، ولكنه كان يعدهم للمستقبل ويعدهم للثورة. وها هو يجيب حجر بن عدي الكندي بقوله:
«إني رأيت هوى معظم الناس في الصلح، وكرهوا الحرب فلم أُحب أن أحملهم على ما يكرهون، فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة من القتل، ورأيت دفع هذه الحرب إلى يوم ما، فإن الله كل يوم هو في شأن»([674]).
وإذن فهذه فترة إعداد وتهيؤ حتى يأتي اليوم الموعود، حين يكون المجتمع قادراً على الثورة مستعداً لها، أما الآن فلن يبلغ المجتمع هذا المستوى من الوعي، بل لا يزال أسير الأماني والآمال، هذه الأماني والآمال التي بثت فيه روح الهزيمة التي صورها الإمام الحسن لعلي بن محمَّد بن بشير الهمداني حين قال له:
«ما أردت بمصالحتي معاوية إلاَّ أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب، ونكولهم عن القتال، ووالله لئن سرنا إليه بالجبال والشجر ما كان بد من إفضاء هذا الأمر إليه»([675]).
وإذن فقد كان دور الحسن أن يهيىء عقول الناس وقلوبهم للثورة على حكم الأُمويين، هذا الحكم الذي كان يشكل إغراءاً قوياً للعرب في عهد أمير المؤمنين علي والذي غدا فتنة للعراقيين بعده حملتهم على التخلي عن الإمام الحسن في أحلك الساعات، وذلك بأن يدع لهم فرصة اكتشافه بأنفسهم، مع التنبيه على ما فيه من مظالم، وتعدٍّ لحدود الله.
ولم يكن الحسين (ع) أقل إدراكاً لواقع مجتمع العراق من أخيه الحسن (ع)، فقد رأى من هذا المجتمع وتخاذله مثل ما رأى أخوه، ولذلك فقد آثر أن يعد مجتمع العراق للثورة، ويعبئه لها، بدل أن يحمله على القيام بها الآن.
كان هذا رأيه في حياة أخيه الإمام الحسن (ع)، فقد قال لعلي بن محمَّد بن بشير الهمداني حين فاوضه في الثورة بعد أن يئس من استجابة الإمام الحسن:
«صدق أبو محمَّد، فليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس بيته([676]) ما دام هذا الإنسان حيّاً»([677]).
يعني معاوية بن أبي سفيان.
وكان هذا رأيه بعد وفاة الإمام الحسن، فقد كتب إليه أهل العراق يسألونه أن يجيبهم إلى الثورة على معاوية، ولكنه لم يجيبهم إلى ذلك، وكتب إليهم:
«أما أخي فأرجو أن يكون الله قد وفقه وسدَّده فيما يأتي، وأما أنا فليس رأيي اليوم ذلك، فالصقوا رحمكم الله بالأرض، واكمنوا في البيوت، واحترسوا من الظنة ما دام معاوية حياً»([678]).
وإذن فقد كان رأي الحسين ألا يثور في عهد معاوية، وهو يأمر أصحابه بأن يخلدوا إلى السكون والهدوء، وأن يبعدوا عن الشبهات. وهذا يوحي لنا بأن حركة منظمة كانت تعمل ضد الحكم الأُموي في ذلك الحين، وأن دعاتها هم هؤلاء الأتباع القليلون المخلصون الذين ضن بهم الحسن عن القتل فصالح معاوية، وأن مهمة هؤلاء كانت بعث روح الثورة في النفوس عن طريق إظهار المظالم التي حفل بها عهد معاوية، انتظاراً لليوم الموعود.
وقد رأينا أن هذه الدعوة ضد الحكم الأُموي قد بدأت بعد الصلح، وقد كانت في عهد الإمام الحسن تسير في رفق وهدوء، نظراً لأن المجتمع كان لا يزال مأخوذاً ببريق الحكم الأُموي، ولم تتمثَّل بعد طبيعة هذا الحكم الظالمة الباغية تمثلاً صحيحاً. أما في عهد الإمام الحسين فقد ازدادت الدعوة عنفاً وشدة واحتداماً، وأخذت تكسب أنصاراً كثيرين في كل مكان، بعد أن أسفر الحكم الأُموي عن وجهه تماماً، وبعد أن بدا على واقعه الذي سترته الوعود الجذابة، والألفاظ المعسولة.
ولقد كان كل حدث من أحداث معاوية يجد صدى مدوياً في المدينة حيث الإمام الحسين، ويكون مدار لاجتماعات يعقدها الإمام الحسين مع أقطاب الشيعة في العراق والحجاز وغيرهما من بلاد الإسلام. يدلنا على ذلك أنه حين قتل معاوية حجر بن عدي الكندي وأصحابه خرج نفر من أشراف الكوفة إلى الحسين فأخبروه الخبر.
ولا بد أن حركة قوية دفعت مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة إلى أن يكتب إلى معاوية:
«أما بعد فإن عمر بن عثمان ذكر أن رجالاً من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن علي، وإنه لا يؤمن وثوبه، وقد بحثت عن هذا فبلغني أنه يريد الخلاف يومه هذا، فاكتب إليّ برأيك»([679]).
ـ 2 ـ
ب ـ شخصية معاوية:
وأكبر الظن أن الحسين (ع) لو ثار في عهد معاوية لما استطاع أن يسبغ على ثورته هذا الوهج الساطع الذي خلدها في ضمائر الناس وقلوبهم، والذي ظل يدفعهم عبر القرون الطويلة إلى تمثل أبطالها، واستيحائهم في أعمال البطولة والفداء.
وسر ذلك يكمن في شخصية معاوية، وأُسلوبه الخاص في معالجة الأُمور. فإن معاوية لم يكن من الجهل بالسياسة بالمثابة التي يتيح فيها للحسين أن يقوم بثورة مدوية، بل الراجح أنه كان من الحصافة بحيث يدرك أن جهز الحسين بالثورة عليه وتحريضه الناس على ذلك كفيل بزجه في حروب تعكر عليه بهاء النصر الذي حازه بعد صلح الحسن، إن لم يكن كافياً لتفويت ثمرة هذا النصر عليه، لأنه عارف ولا ريب ـ بما للحسين من منزلة في قلوب المسلمين.
وأقرب الظنون في الأُسلوب الذي يتبعه معاوية في القضاء على ثورة الحسين ـ لو ثار في عهده ـ هو أنه كان يتخلص منه بالسم قبل أن يتمكن الحسين من الثورة، وقبل أن يكون لها ذلك الدوي الذي يموِّج الحياة الإسلامية التي يرغب معاوية في بقائها هادئة ساكنة.
والذي يجعل هذا الظن قريباً ما نعرفه من أُسلوب معاوية في القضاء على من يخشى منافستهم له في السلطان، أو تعكير صفو السلطان عليه. فإن الطريقة المثالية عنده في التخلص منهم هي القضاء عليهم بأقل ما يمكن من الضجيج. ولقد مارس معاوية هذا الأُسلوب في القضاء على الحسن بن علي (ع). وسعد بن أبي وقاص([680]). ومارسه في القضاء على الأشتر لما توجه إلى مصر، ومارسه في القضاء على عبد الرحمن بن خالد بن الوليد لما رأى افتتان أهل الشام به([681]).
وقد أوجز هو أُسلوبه هذا في كلمته المأثورة:
«إن لله جنوداً منها العسل»([682]).
والذي يرتفع بهذا الظن إلى مرتبة الاطمئنان ما نعلمه من أن معاوية كان قد وضع الأرصاد والعيون على الحسين وعلى غيره ممن يخشاهم على سلطانه، وأنهم كانوا يكتبون إليه بما يفعل هؤلاء ولا يغفلون عن إعلامه بأيسر الأُمور، وأبعدها عن إثارة الشك والريبة([683]).
فلو تحفز الحسين للثورة في عهد معاوية، ثم قضي عليه بهذه الميتة التي يفضلها معاوية لأعدائه، فماذا كانت تكون جدوى فعله هذا الذي لم يخرج عن حدود الفكرة إلى أن يكون واقعاً يحياه الناس بدمائهم وأعصابهم وما كان يعود على المجتمع الإسلامي من موته وقد قضى كما يقضي سائر الناس بهدوء وبلا ضجيج إنه لن يكون حينذاك سوى علوي مات حتف أنفه، يثير موته الأسى في قلوب أهله، ومحبيه وشيعة أبيه إلى حين ثم يطوي النسيان ذكراه كما يطوي جميع الذكريات.
وأين هذا مما صار إليه أمره وأمر مبدئه حين ثار في عهد يزيد؟
هذا بالإضافة إلى أن معاوية كان يدرك أنه ليس ينبغي له ـ وهو يحكم الناس بسلطان الدين ـ أن يرتكب من الأعمال ما يراه العامة تحدياً للدين الذي يحكم بسلطانه، بل عليه أن يسبغ على أعماله غشاءاً دينياً لتنسجم هذه الأعمال مع المنصب الذي وصل إليه، أما ما لا يمكن تمويهه من التصرفات فليرتكبه في السر([684]).
وقد أظهره سلوكه المحافظ على تعاليم الدين بمظهر لا غبار عليه من الناحية الدينية عند العامة، على الرغم من بعض الروايات التاريخية التي تؤكد أنه كان ملحداً لا يؤمن بشيء مما جعل المغيرة بن شعبة وهو في تحلله يغتم لما سمعه منه في بعض مجالسه معه، ويقول عنه أنه أخبث الناس([685]). وقد استغل ظروفه لإسباغ صفة الشرعية على منصبه، وذلك بدعواه أنه يطالب بدم عثمان، وبما موه به على الرأي العام في مؤتمر التحكيم بعد صفين من صلوحه للخلافة، وبصلحه مع الإمام الحسن (ع) وبيعة الناس له بالخلافة.
فلو أفلت من معاوية الزمام، وغفلت عيونه وأرصاده، فخرجت الفكرة إلى حيز الواقع، وتحولت إلى دوي عظيم، فهل كانت ثورة الحسين تنجح في عهد معاوية.
والذي نتساءل عنه هنا ليس النجاح العسكري، فإن ثورته ما كانت لتحوز نصراً عسكرياً آنياً يمكن الحسين من الإمساك بالسلطة، لأنه كان ضعيفاً من الناحية المادية ومعاوية أقوى ما يكون، وقد رأينا أنها أخفقت عسكرياً في عهد يزيد مع أن سلطان الأُمويين في عهده كان بالغ الضعف بسبب استنكار عامة المسلمين لسلطانه، وبسبب التناحر القبلي الذي كان قد بلغ غايته في الشام([686]).
وإنما نتساءل عن نجاح ثورته بمعنى تمكنه من التعبير بها عن أهدافه الاجتماعية والإنسانية، وإشعار الناس بواقعهم السيء، وكشف الحكم الأُموي على حقيقته لأعينهم، وبعث روح جديدة فيهم، وبث أخلاق جديدة بينهم، على النحو الذي سنرى أنه تمكن منه في عهد يزيد.
والجواب الذي لا بد منه هنا هو النفي، بل كان مصيره إلى الإخفاق على الصعيد العسكري، وعلى هذا الصعيد الآخر الذي بوأ ثورته في عهد يزيد منزلة فريدة في تاريخ الثورات:
وإذا بحثنا عن السبب في إخفاق ثورة الحسين لو ثار في عهد معاوية لوجدناه في مسحة الدين التي كان معاوية يحرص على إسباغها على سلوكه وسائر تصرفاته أمام العامة. وفي صفة الشرعية التي أفلح في أن يسبغها على منصبه لدى جانب كبير من الرأي العام الإسلامي.
فإن هذا الواقع كان يجرد ثورة الحسين ـ لو ثار ـ من مبررها الوحيد، لأن الجواب الذي كان سيقدمه معاوية وأعوانه للناس حين يتساءلون عما حمل الحسين على الثورة، أو يجيب به الناس أنفسهم، هو أن الحسين طالب ملك، ولو قتل الحسين في سبيل ما توهمه الناس هدفاً من ثورته لما أثار قتلته استنكاراً، ولما عاد قتله بشيء من مبادئه ودوافعه الحقيقية للثورة، بل ربما عده فريق من الناس مستحقاً للقتل، ولن يجدي الحسين وأنصاره أن يعلنوا للناس أن ثورتهم لحماية الدين من تحريف وتزييف معاوية، وإنقاذ الأُمة من ظلمه، فلن يصدقهم الناس لأنهم لا يرون على الدين من بأس، ولم يحدث معاوية في الدين حدثاً ولم يجاهر بمنكر، بل سيرى الناس أن مقالتهم هذه ستار يخفي مقاصدهم الحقيقية.
ـ 3 ـ
ج ـ العهد والميثاق:
ولقد كان معاوية خليقاً بأن يستغل في سبيل تشويه ثورة الحسين لو ثار في عهده ـ هذا الميثاق الذي كان نتيجة صلح الحسن مع معاوية، فلقد عرف عامة الناس أن الحسن والحسين قد عاهدا معاوية على السكوت عنه، والتسليم له ما دام حياً([687]) ولو ثار الحسين على معاوية لأمكن لمعاوية أن يصوره بصورة المنتهز، الناقض لعهده وميثاقه الذي أعطاه.
ونحن نعلم أن الحسين ما كان يرى في عهده لمعاوية عهداً حقيقاً بالرعاية والوفاء، فقد كان عهداً تم بغير رضى واختيار وقد كان عهداً تم في ظروف لا يد للمرء في تغييرها، ولقد نقض معاوية هذا العهد، ولم يعرف له حرمة، ولم يحمل نفسه مؤونة الوفاء به، فلو كان عهداً صحيحاً لكان الحسين في حل منه، لأن معاوية قد تحلل منه، ولم يأل في نقضه جهداً.
ولكن مجتمع الحسين، هذا المجتمع الذي رأينا أنه لم يكن أهلاً للقيام بالثورة، والذي كان يؤثر السلامة والعافية كان يرى أنه قد عاهد، وأن عليه أن يفي([688]) وأكبر الظن أن ثورته ـ لو قام بها في عهد معاوية ـ كانت ستفشل على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي حين ينظر إليها المجتمع الإسلامي من الزاوية التي كان معاوية سيسلط عليها الأضواء وهي هذا العهد والميثاق الذي نقضه الحسين وأنصاره من الثائرين، فيظهرها للرأي العام وكأنها تمرد غير مشروع.
ولعل هذا هو ما يفسر جواب الحسين (ع) لسليمان بن صرد الخزاعي حين فاوضه في الثورة على معاوية، والحسن (ع) حي، فقد قال له:
«ليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس بيته ما دام معاوية حياً، فإنها بيعة كنت والله لها كارهاً، فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم ورأينا ورأيتم»([689]).
وجوابه لعدي بن حاتم الطائي وقد فاوضه في الثورة أيضاً بقوله:
«إنّا قد بايعنا وعاهدنا، ولا سبيل لنقض بيعتنا»([690]).
وقد ثبت على موقفه هذا بعد وفاة الإمام الحسن (ع) فقد روى الكلبي والمدائني وغيرهما من أصحاب السير، قالوا:
«لما مات الحسن بن علي (ع) تحركت الشيعة بالعراق، وكتبوا إلى الحسين في خلع معاوية والبيعة له، فامتنع عليهم، وذكر أن بينه وبين معاوية عهداً وعقداً، ولا يجوز له نقضه حتى تمضي المدة، فإذا مات معاوية نظر في ذلك»([691]).
وقد كان معاوية يستغل هذه الحرمة التي للعهد، في نفوس الناس، فيلوح بها في مكاتباته إلى الإمام الحسين (ع) حول نشاطه في تعبئة المجتمع الإسلامي للثورة على الحكم الأُموي فقد كتب إليه.
«أما بعد، فقد انتهت إليّ أُمور عنك، إن كنت حقاً فإني أرغب بك عنها. ولعمر الله إن من أعطى عهد الله وميثاقه لجدير بالوفاء. وإن أحق الناس بالوفاء من كان مثلك في خطرك، وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بها. ونفسك فاذكر، وبعهد الله أوف، فإنك متى تنكرني أُنكرك، ومتى تكدني أكدك، فاتق شق عصا هذه الأُمة»([692]).
فها هوذا معاوية يلوح هنا بالعهد والميثاق، ويطالب بالوفاء بهما.
ولربما فهم الناس من ثورته لو ثار في عهد معاوية أنه كان على غير رأي أخيه الحسن (ع) في الصلح مع معاوية، وقد كان الحسين (ع) دائماً حريصاً على أن يظهر اتفاقه مع أخيه في القرار الذي اتخذه ومن جملة ما يدل على ذلك جوابه لعلي بن محمَّد بن بشير الهمداني حين ذكر له امتناع الحسن (ع) من إجابة من دعاه إلى الثورة بعد الصلح، مبيناً لهم عدم استعداد المجتمع الإسلامي لذلك:
«صدق أبو محمَّد، فليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس بيته ما دام هذا الإنسان حياً»([693]).
وإذن فلم يثر الحسين (ع) في عهد معاوية لأن المجتمع لم يكن مهيئاً للثورة([694]). وكان هذا هو السبب الذي دفع بالحسن إلى أن يصالح معاوية بعدما تبين له عقم محاولة المضي في الصراع، ولولا ذلك لما صالح الحسن معاوية، ولما قعد الحسين عن الثورة على معاوية. وقد أضاف هذا الصلح سبباً آخر، منع الحسين (ع) من الثورة على معاوية الذي كانت شخصيته عاملاً في جعل الثورة عليه عملاً غير مضمون بالنجاح، ولذا فقد كان لا بد للحسن والحسين (عليهما السلام) ـ وهذه هي ظروفهما في عهد معاوية ـ أن يهيئا هذا المجتمع للثورة وأن يعداه لها.
وقد مضت الدعوة إلى الثورة على الحكم الأُموي تنتشر بنجاح طيلة عهد معاوية، تجد غذاءها في ظلم معاوية وجوره وبعده عن تمثيل الحكم الإسلامي الصحيح. وانتهى الأمر بهذه الدعوة إلى هذا النجاح الكبير الذي أوجزه الدكتور طه حسين في هذه الكلمات:
«ومات معاوية حين مات، وكثير من الناس، وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بني أُمية وحب أهل البيت لأنفسهم ديناً»([695]).
ـ 4 ـ
أ ـ شخصية يزيد:
أما يزيد فقد كان على الضد مع أبيه في كل ما كان يحول بين الحسين (ع) وبين الثورة على أبيه.
لقد كان يزيد من أبعد الناس عن الحذر والحيطة والتروي.
كان إنساناً صغير العقل، متهوراً، سطحي التفكير، «لا يهم بشيء إلاَّ ركبه»([696]).
وأُسلوبه في معالجة المشاكل التي واجهته خلال حكمه يعزز وجهة النظر هذه: أُسلوبه في معالجة ثورة الحسين، وأُسلوبه في معالجة ثورة أهل المدينة، وأُسلوبه في معالجة ثورة ابن الزبير.
وتدل بعض الملاحظات التي ذكرها المؤرخون عن حياته العاطفية أن هذا النزق، والتهور، والاستجابة السريعة العنيفة للانفعال ليست أُموراً عارضة بل هي سمات أصيلة في شخصيته([697]).
ومن ثم فهو أبعد الناس عن أن يواجه ثورة الحسين بأُسلوب أبيه، بل القريب أن يواجهها بالأُسلوب الذي يتفق مع شخصيته، وهو ما حدث في النهاية بالنسبة إليها وإلى غيرها من المشاكل التي واجهته.
ونشأة يزيد المسيحية، أو القريبة من المسيحية([698]) جعلته أضعف ما يكون صلة بالعقيدة التي يريد أن يحكم الناس باسمها أعني الإسلام. وحياة التحلل التي عاشها قبل أن يلي الحكم والانسياق مع العاطفة، وتلبية كل رغباته كل ذلك جعله عاجزاً عن التظاهر بالورع والتقوى، والتلبّس بلباس الدين بعد أن حكم المسلمين، هذا بالإضافة إلى أن طبيعته النزقة جعلته يعالن الناس بارتكاب المحرمات، ويقارب من الآثام ما عرف الناس بمدى بعده عن الصلاحية لتولي منصب الخلافة.
ومن ثم فلن يكون في وسع أنصار الحكم الأُموي أن يلوثوا ثورة الحسين أمام الرأي العام بأنها ثورة في سبيل الملك لأن العامة ترى أن مبررات هذه الثورة موجودة في سلوك يزيد نفسه، هذا السلوك الذي لا يلتقي مع الدين على صعيد، وسيقبل الناس بلا تردد تبرير الحسين وأنصاره لثورتهم بحماية الدين، وإنقاذ المسلمين من جور الأُمويين.
ب ـ موقف الحسين (ع)
من يزيد في حياة معاوية
وقد حاول معاوية أن يقيد الإمام الحسين (ع) ببيعة يزيد أو يضمن ـ على الأقل ـ سكوت الإمام الحسين عن يزيد، فلم يفز بطائل.
ويروي المؤرخون عدة مواقف للحسين مع معاوية حين أخذ يعد الأمر لابنه يزيد من بعده، وكان من جملة كتبه إليه في هذا الشأن قوله في أحدها:
«… وفهمت ما ذكرت عن يزيد من اكتماله، وسياسته لأُمة محمَّد، تريد أن توهم الناس في يزيد، كأنك تصف محجوباً، أو تنعت غائباً، أو تخبر عما كان مما احتويته بعلم خاص. وقد دل يزيد من نفسه على موضع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش، والحمام السبق لأترابهن، والقيان ذوات المعازف، وضرب الملاهي، تجده باصراً. ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى الله من وزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه، فوالله ما برحت تقدح باطلاً في جور. وحنقاً في ظلم، حتى ملأت الأسقية، وما بينك وبين الموت إلاَّ غمضة…»([699]).
وقد أراد معاوية أن يحمل الحسين على البيعة ليزيد بحرمان بني هاشم جميعاً من أعطياتهم حتى يبايع الحسين([700]) فلم يتحقق له ما أراد. ومات معاوية، والحسين باق على موقفه من الإنكار لبيعة يزيد.
ـ 5 ـ
موقف الحسين من البيعة ليزيد:
«مات معاوية حين مات، وكثير من الناس، وعامة أهل العراق بنوع خاص، يرون بغض بني أُمية، وحب أهل البيت لأنفسهم ديناً»([701]).
فقد اكتشف المجتمع الإسلامي ما فيه الكفاية من عورات الحكم الأُموي، وذاق طعم عذابه وخبر ألوانه من عسفه وظلمه في الأرزاق والكرامات، وانزاحت عن بصيرته الغشاوة التي رانت عليها في أول عهد معاوية.
ولم يكن يزيد في مثل تروي أبيه، وحزمه واحتياطه للأُمور، ولم يلتزم أُسلوب أبيه في الاحتفاظ بالغشاء الديني مسدلاً على أفعاله وتصرفاته.
ولم يكن بين الحسن والحسين من جهة وبين يزيد من جهة أُخرى أي عهد أو ميثاق.
وهكذا فقد انزاحت ـ بموت معاوية ووعي المجتمع الإسلامي ـ جميع الأسباب التي كانت تحول بين الحسين وبين الثورة في عهد معاوية، وبدا الطريق إلى الثورة على الحكم الأُموي ممهداً أمام الحسين (ع).
وقد عجل تلهف يزيد على أخذ البيعة له من كبار زعماء المعارضة له ـ وعلى رأسهم الحسين ـ في تتابع الأحداث.
فقد كان أكبر همه حين آل الأمر إليه بعد موت أبيه هو بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعة يزيد، فكتب إلى الوليد بن عتبة والي المدينة كتاباً يخبره فيه بموت معاوية وكتاباً آخر جاء فيه:
«أما بعد فخذ حسيناً. وعبدالله بن عمر. وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصة، حتى يبايعوا. والسلام»([702]) ولقد آثر الحسين أن يتخلص من الوليد بالحسنى حين دعاه إلى البيعة، فقال له:
«مثلي لا يبايع سراً، ولا يجتزىء بها مني سراً، فإذا خرجت للناس ودعوتهم للبيعة، ودعوتنا معهم كان الأمر واحداً».
ولكن مروان قال للوليد:
لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه، ولكن احبسه فإن بايع وإلاَّ ضربت عنقه».
فوثب الحسين عند ذلك وقال:
«ويلي عليك يابن الزرقاء، أنت تأمر بضرب عنقي؟ كذبت ولؤمت»([703]).
ثم أقبل على الوليد. فقال:
«أيها الأمير، إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله، وبنا ختم، ويزيد فاسق، فاجر شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله»([704]).
بهذه الكلمات أعلن الحسين ثورته على الحكم الأُموي الفاسد على عظمته وجبروته وقسوته في مؤاخذة الخارجين عليه فقد مات معاوية وانقضى العهد والميثاق، وأصبح وجهاً لوجه أمام دوره التاريخي الذي يتحتم عليه أن يصنعه. وأنه لعلى يقين من أن حكم يزيد لن يأخذ صفة شرعية ما دام هو ممسكاً عن بيعته، أما إذا بايعه فإنه حينئذٍ يكون قد أكسب الغل الجديد الذي طوقت به الأُمة المسلمة صفة قانونية شرعية، وهذا شيء لا يفعله (ع).
إن ثمة فرقاً عظيماً بين أن تكون الأُمة راضخة لحكم ظالم ولكنها تعلم أنه حكم بغير حق، وأنه حكم يجب أن يزول، وبين أن تخضع الأُمة لحكم ظالم وترى أنه حكم شرعي لا بد منه ولا يجوز تغييره.
إن الأُمة في الحالة الثانية ترى أن حياتها التعسة، وأن التشريد والجوع والحرمان والذل، هو قدرها الذي لا مفر لها منه. هو مصيرها المحتوم الذي لا بد أن تصير إليه وحينئذٍ يقضي على كل أمل في تغيير الأوضاع، وحينئذٍ يضمحل كل أمل في الثورة، وحينئذٍ تدعم الأُمة جلاديها بدل أن تثور عليهم، وحينئذٍ يصار إلى الرضا بما هو كائن بحسبانه ما ينبغي أن يكون.
أما حين تخضع الأُمة وهي تعلم أن الحاكم لا حق له فحينئذٍ يبقى الأمل في التغيير حياً نابضاً، وتبقى الثورة مشتعلة في النفوس. وحينئذٍ يكون للثائرين مجال للعمل لأن التربة معدَّة للثورة.
وكان على الحسين وحده أن ينهض بهذا الدور، لقد كانت الثورة قدره المحتوم، أما الآخرون الذين أبوا البيعة ليزيد فلم يكن لهم عند المسلمين ما للحسين من المنزلة، وعلو الشأن أما ابن عمر فسرعان ما سلم قائلاً: «إذا بايع الناس بايعت»([705]). وأما ابن الزبير فقد كان الناس يكرهونه ويتهمونه في إبائه البيعة بأنه يريد الأمر لنفسه فلم تكن دوافعه دينية خالصة، وإنما كان يدفعه الطمع في الخلافة، وما كان الناس يرونه لذلك أهلاً.
ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الحسين لما خرج وابن الزبير من المدينة إلى مكة، وأقاما بها، «عكف الناس على الحسين: يفدون إليه، ويقدمون عليه، ويجلسون حواليه، ويستمعون كلامه وينتفعون بما يسمع منه، ويضبطون ما يروون عنه»([706]) ومغزى هذا الخبر بيّن فقد اتجهت أنظار الناس إلى الحسين وحده، فانقطعوا إليه، وهذا يدلك على مركزه في نفوس المسلمين إذ ذاك. قال أبو الفرج الأصفهاني.
«إن عبدالله بن الزبير لم يكن شيء أثقل عليه من مكان الحسين بالحجاز، ولا أحب إليه من خروجه إلى العراق طمعاً في الوثوب بالحجاز، وعلماً منه بأن ذلك لا يتم له إلاَّ بعد خروج الحسين»([707]).
وكان الحسين يعي هذا أيضاً، فقد قال يوماً لجلسائه:
«إن هذا ـ يعني ابن الزبير ـ ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق، وقد علم أنه ليس له من الأمر شيء معي، وأن الناس لم يعدلوه بي فود أني خرجت منها لتخلو له»([708]).
وقال عبدالله بن عباس له وهو يحاوره في الخروج إلى العراق:
«قد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه والحجاز، والخروج منها. وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك»([709]).
كل هذا يكشف عن مدى تعلق جماهير المسلمين بالحسين باعتباره رجل الساعة. ويقيناً لو أنه بايع يزيد لما كان لابن الزبير وأضرابه وزن في المعارضة لأنهم حينئذٍ ما كانوا ليجدوا أنصاراً على ما يريدون.
وإذن، فقد وجد الحسين نفسه وجهاً لوجه أمام دوره التاريخي: الحكم الأُموي بكل ما فيه من فساد، وانحطاط ورجعية وظلم، والأُمة المسلمة بذلها وجوعها وحرمانها. ومركزه العظيم في المسلمين، كل ذلك وضعه وجهاً لوجه أمام دوره التاريخي، وخطط له المصير الذي يتحتم عليه أن يصنعه لنفسه. وعند ذلك أعلن ثورته بهذه الكلمات التي مرت عليك، وقد أجمل فيها أسباب هذه الثورة: التهتك، والتطاول على الدين، والاستهتار بحقوق الشعب، هذه هي أسباب ثورة الحسين.
ويبدو أن يزيد بن معاوية أراد أن يخنق ثورة الحسين قبل اشتعالها وذلك باغتياله في المدينة. وقد وردت إشارتان إلى ذلك في كتاب أورده اليعقوبي في تاريخه([710]) من ابن عباس إلى يزيد بن معاوية صريحتان في الدلالة على أن يزيد دس رجالاً ليغتالوا الحسين في المدينة قبل مغادرته إياها إلى العراق.
ولعل هذا ما يكشف لنا عن سبب خروج الحسين من المدينة بصورة سرية.
ـ 6 ـ
بواعث الثورة عند الحسين:
إن العنصر الاجتماعي شديد البروز في ثورة الحسين، ويستطيع الباحث أن يلاحظه فيها من بدايتها حتى نهايتها، ويرى أن الحسين ثار من أجل الشعب المسلم: لقد ثار على يزيد باعتباره ممثلاً للحكم الأُموي، هذا الحكم الذي جوع الشعب المسلم، وصرف أموال هذا الشعب في اللذات، والرشا وشراء الضمائر، وقمع الحركات التحررية، هذا الحكم الذي اضطهد المسلمين غير العرب وهددهم بالإفناء، ومزَّق وحدة المسلمين العرب وبعث بينهم العداوة والبغضاء هذا الحكم الذي شرد ذوي العقيدة السياسية التي لا تنسجم مع سياسة البيت الأُموي وقتلهم تحت كل حجر ومدر، وقطع عنهم الأرزاق وصادر أموالهم. هذا الحكم الذي شجع القبلية على حساب الكيان الاجتماعي للأُمة المسلمة. هذا الحكم الذي عمل عن طريق مباشر تارة وعن طريق غير مباشر تارة أُخرى على تفويض الحس الإنساني في الشعب، وقتل كل نزعة إلى التحرر بواسطة التخدير الديني الكاذب. كل هذا الانحطاط ثار عليه الحسين، وها هو يقول لأخيه محمَّد بن الحنفية في وصيته له:
«إني لم أخرج أشراً، ولا بطراً ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أُمة جدي، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين».
فالإصلاح في أُمة جده (ص) هو هدفه من الثورة.
وهنا شيء أُريد أن أُنبه عليه في قوله:
«… فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق».
إنه لم يقل: فمن قبلني لشرفي، ومنزلتي في المسلمين، وقرابتي من رسول الله، وما إلى ذلك… لم يقل شيئاً من هذا، إن قبوله يكون بقبول الحق فهذا داع من دعاته، وحين يقبل الناس داعي الحق فإنما يقبلونه لما يحمله إليهم من الحق والخير لا لنفسه، وفي هذا تعال وتسام عن التفاخر القبلي الذي كان رأس مال كل زعيم سياسي أو ديني في عصره (ع).
وظهر العنصر الاجتماعي في ثورة الحسين أيضاً حين التقى مع الحر بن يزيد الرياحي، وقد كان ذلك بعد أن علم الحسين بتخاذل أهل العراق عنه بعد بيعتهم له، وبعد أن انتهى إليه نبأ قتل رسوله وسفيره إليهم مسلم بن عقيل، وبعد أن تبين له ولمن معه المصير الرهيب الذي ينتظرهم جميعاً، فقد خطب الجيش الذي مع الحر قائلاً:
«أيها الناس إن رسول الله (ص) قال: من رأى سلطاناً جائراً، مستحلاً لحرام الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنَّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله، ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله، وحرموا حلاله، وأنا أحق من غيَّر، وقد أتتني كتبكم، وقدمت علي رسلكم ببيعتكم، وأنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم علي بيعتكم تصيبوا رشدكم، فإني الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله (ص) نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، فلكم فيّ أُسوة. وإن لم تفعلوا، ونقضتم عهدكم، وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنكر لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم بن عقيل، والمغرور من اغتربكم، فحظكم أخطأتم، ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه»([711]).
فهو هنا يبين لهم أسباب ثورته: إنها الظلم، والاضطهاد والتجويع، وتحريف الدين، واختلاس أموال الأُمة. ثم انظر كيف لمح لهم إلى ما يخشون، لقد علم أنهم يخشون الثورة لخشيتهم الحرمان والتشريد، فهم يؤثرون حياتهم على ما فيها من انحطاط وهوان على محاولة التغيير خشية أن يفشلوا فيعانوا القسوة والضنك.
لقد علم منهم هذا فقال لهم:
«وأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله».
فبيَّن لهم مركزه أولاً، ثم قال لهم:
«نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، فلكم فيّ أسوة».
فيما قد يحدث من اضطهاد وحرمان. ويقف المتأمل وقفة أُخرى عند قوله:
«وأنا أحق من غيَّر» فيها تعبير عن شعوره بدوره التاريخي الذي يتحتم عليه أن يقوم بأدائه.
ومرة ثالثة حدث الحسين أهل العراق عن ثورته ومبرراتها وكانت خطبته هذه في الساعات الأخيرة التي سبقت اشتباك القتال بينه وبين الجيش الأُموي. قالوا إنه (ع) ركب فرسه، فاستنصتهم فلم ينصتوا، حتى قال لهم:
«ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إلي فتسمعوا قولي، وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص لأمري، غير مستمع لقولي، فقد ملئت قلوبكم من الحرام، وطبع على قلوبكم. ويلكم، ألا تنصتون؟ ألا تسمعون؟».
فتلاوم أصحاب عمر بن سعد بينهم، وقالوا:
أنصتوا له: فحمد الله وأثنى عليه وذكره بما هو أهله، وصلى على محمَّد وعلى الملائكة والأنبياء والرسل، وأبلغ في المقال.
ثم قال:
«تباً لكم أيها الجماعة وترحاً، أَحين أَستصرختمونا والهين، فأَصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفاً لنا في أَيمانكم، وحششتم علينا ناراً أَوقدناها على عدوِّنا وعدوِّكم، فأَصبحتم إِلباً على أَوليائكم، ويداً عليهم لأَعدائكم، بغير عدل أَفشوه فيكم، ولا أَمل أَصبح لكم فيهم، الاَّ الحرام من الدُّنيا أَنالوكم، وخسيس عيش طمعتم فيه، من غير حدثٍ كان منَّا، ولا رأْي تفيَّل لنا فهلا ـ لكم الويلات ـ إِذ كرهتمونا وتركتمونا، تجهتموها والسيف مشيم، والجأْش طامن، والرأْي لما يستحصف، ولكن أَسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم إليها كتداعي الفراش، فسحقاً لكم يا عبيد الأُمَّة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ونفْثة الشَّيطان، وعصبة الآثام، ومحرِّفي الكتاب، ومطفئي السُّنن، وقتلة أولاد الأَنبياء، ومبيدي عترة الأَوصياء، وملحقي العهار بالنَّسب، ومؤذي المؤمنين، وصراخ أَئمَّة المستهزئين، الذين جعلوا القرآن عضين، ولبئس ما قدّمت لهم أَنفسهم وفي العذاب هم خالدون.
«وأَنتم ابن حربٍ وأَشياعه تعضدون وعنّا تخاذلون، أجل والله الخذل فيكم معروف وشجت عليه أُصولكم، وتآزرت عليه فروعكم، وثبتت عليه قلوبكم. وغشيت صدوركم، فكنتم أَخبث ثمرةٍ: شجىً للناظر، وأَكلةً للغاصب، أَلا لعنة الله على الناكثين الَّذين ينقضون الأَيمان بعد توكيدها ـ وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ـ فأَنتم والله هم.
«أَلا وإن الدعيَّ ابن الدَّعيَّ قد ركز بين اثنتين بين السَّلَّة والذَّلَّة، وهيهات مِنَّا الذّلَّة، يأْبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طابت، وحجور طهَّرت، وأُنوف حميَّة، ونفوس أَبيَّة، لا تؤثر طاعة اللِّئام على مصارع الكرام… ألا وإنّي قد أعذرت وأنذرت، ألا وإِنِّي زاحف بهذه الأُسرة، مع قلَّة العدد وكثرة العدوِّ، وخذلان النَّاصر.
ثم قال:
| فإن نهزم فهزامون قدماً | وأن نغلب فغير مغلبينا | |
| وما أن طبنا جبن ولكن | منايانا ودولة آخرينا | |
| إذا ما الموت رفع عن أُناس | كلاكله أناخ بآخرينا | |
| فأفنى ذلكم سروات قومي | كما أفنى القرون الغابرينا | |
| فلو خلد الملوك إذن خلدنا | ولو بقي الكرام إذن بقينا | |
| فقل للشامتين بنا أفيقوا | سيلقى الشامتون كما لقينا([712]) |
في هذه الخطبة حدَّثهم الحسين عن أنفسهم، وعن واقعهم، وعن زيف حياتهم: حدثهم كيف أنهم استصرخوه على جلاديهم ثم انكفأُوا مع هؤلاء الجلادين عليه، هؤلاء الجلادين الذين لم يسيروا فيهم بالعدل، وإنما حملوهم على ارتكاب الحرام في مقابل عيش خسيس: خسيس في نفسه، قليل دون الكفاية، خسيس لأنه يعمل على مد الأجل بحياة حقيرة ذليلة، خسيس باعتباره أجراً لعمل خسيس. وحدثهم عن مواقفهم المتكررة من الحركات الإصلاحية، إنهم دائماً يظهرون العزم على الثورة، والرغبة فيها… يظهرون العزم على تطوير واقعهم السيّىء، حتى إذا جد الجد انقلبوا جلادين للثورة بدل أن يكونوا وقوداً لها. حدثهم عن أعدائه باعتبارهم أعدائهم أيضاً، ولكنهم يزيفون حياتهم بأيديهم، يحاربون محرريهم، من يعلمون أنهم المحررون، مع من؟ مع أعدائهم ومذليهم، وظالميهم.
هذه الخطبة ـ بهذا الأُسلوب الثائر، وبما فيها من تقريع، وبما فيها من فضح لهم ـ كانت ملائمة تمام الملائمة للجو النفسي السائد آنذاك على الجيش الأُموي. إن محاربي ذلك الجيش كانوا على علم بمن يحاربون، فأراد أن يشعرهم بفداحة الإثم الذي يقارفونه، وعظم الأمر الذي يحاولونه، وأراد أن يسمع المجتمع الإسلامي. هذا المجتمع الخاضع، صوته المدوي. وبهذا اللون من البيان جعل الحسين من كل مسلم بركاناً مدمراً على أهبة الانفجار.
ـ 7 ـ
بواعث الثورة لدى الرأي العام:
ولم يكن المغزى الاجتماعي للثورة مدركاً من قبل الحسين وحده، فقد كان المسلمون يحسون بضرورة العمل على تطوير واقعهم السيء إلى واقع أحسن، أدرك هذا أولئك الذين كتبوا إلى الحسين يطلبون منه القدوم إلى العراق. وأدرك هذا أولئك الذين صبروا أنفسهم على الموت معه.
والذين كتبوا إليه من العراق لم يكونوا أفراداً معدودين، وإنما كانوا كثيرين جداً. ففي المؤرخين من يقول أن كتب أهل العراق إلى الحسين زادت على مئة وخمسين كتاباً([713]) وقال مؤرخون آخرون أنه قد اجتمع عند الحسين في نوب متفرقة اثنا عشر ألف كتاب من أهل العراق. ونستطيع أن نكوِّن فكرة صحيحة عن ضخامة عدد الكتب التي دعت الحسين إلى القيام بالثورة، إذا قرأنا هذا الخبر الذي رواه أغلب المؤرخين: وهو أن الحسين لما لقي الحر بن يزيد كان من جملة ما قاله للحر ومن معه:
«أما بعد أيها الناس؛ فإنكم إن تتقوا الله، وتعرفوا الحق لأهله، يكن أرضى لله ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان وإن أنتم كرهتمونا، وجهلتم حقنا كان رأيكم غير ما أتتني به كتبكم. وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم».
فقال له الحر بن يزيد:
«إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر، فقال الحسين: يا عقبة بن سمعان أخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم إلي، فأخرج خرجين مملوئين صحفاً فنشرها بين أيديهم»([714]).
من هنا نستطيع أن نكون فكرة عن ضخامة عدد الكتب التي أُرسلت إلى الحسين، تدعوه إلى الثورة، وتعده بالنصر. ونلاحظ من ناحية أُخرى أن هذه الكتب ليست من أفراد فقد كانت كتباً من الرجل والاثنين والأربعة والعشرة([715]) فلسنا أمام حركة فردية، وإنما نحن أمام حركة جماعية قام بها المجتمع العراقي أو الكثرة الساحقة من هذا المجتمع، وهذا نموذج للكتب التي وردت إليه:
«سلام عليك، أما بعد، فالحمد لله الذي قصم عدوك وعدو أبيك من قبل. الجبار العنيد، الغشوم الظلوم، الذي انتزى على هذه الأُمة، فابتزها أمرها، واغتصبها فيئها، وتأمر عليها بغير رضىً منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها، وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وعتاتها، فبعداً له كما بعدت ثمود وأنه ليس علينا إمام غيرك، فاقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، ولسنا نجتمع معه جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا إنك أقبلت أخرجناه حتى يلحق بالشام إن شاء الله تعالى، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن رسول الله»([716]).
هذا نموذج للكتب التي أُرسلت إلى الحسين تدعوه إلى الثورة، ويبرز العامل الاجتماعي فيه بوضوح عظيم. سياسة الإرهاب والتجويع هي التي حملت هؤلاء الناس على الثورة وكان الحسين هو الشخصية الوحيدة التي يمكن أن تتزعتم ثورة كهذه إذ لم يكن في الزعماء المسلمين زعيم غيره يتجاوب مع آلام الشعب وآماله ومطامحه.
ـ 8 ـ
بواعث الثورة لدى الثائرين:
فإذا نحن تجاوزنا هؤلاء الداعين إلى الثورة ثم المتخاذلين عنها إلى أُولئك الذين ثبتوا ثائرين مع الحسين إلى اللحظة الأخيرة… اللحظة التي توجوا فيها عملهم الثوري بسقوطهم صرعى، رأيناهم يحملون نفس الفكرة، ويبررون ثورتهم ويدعون الجيش الأُموي إلى تأييدهم بنفس تلك المبررات: الظلم الاجتماعي، وسياسة الإرهاب والإذلال التي يمارسها الحاكمون.
هذا زهير بن القين، خرج على فرس له في السلاح، فخطب الجيش الأُموي قائلاً:
«يا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله نذار، أن حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن أخوة على دين واحد وملة واحدة ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا نحن أُمة وأنتم أُمة.
«إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمَّد (ص) لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبيدالله بن زياد فإنكم لا تدركون منهم إلاَّ بسوء عمر سلطانهما كله ليسملان أعينكم، ويقطعان أيديكم وأرجلكم، ويمثلان بكم، ويرفعانكم على جذوع النخل، ويقتلان أماثلكم وقرائكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه».
«فسبوه، واثنوا على ابن زياد، وقالوا: والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه، أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيدالله سلماً…».
محمَّد مهدي شمس الدين
آثار الثورة في الحياة الإسلامية
ـ 1 ـ
تمهيد
لقد درسنا فيما تقدم بعض جوانب ثورة الحسين (ع) على الحكم الأُموي، فدرسنا ظروفها الاجتماعية والنفسية، ودرسنا أسبابها وغاياتها، وفي خلال حديثنا هذا صحبنا الحسين وآله وصحبه في كثير من مراحل عملهم الثوري، ولم نتحدث عن عنصر المأساة حديثاً واسعاً، لأن ذلك ليس من همنا كما ذكرنا بين يدي هذه الفصول، واكتفينا من ذلك بالإشارة التي يقتضيها سياق البحث والاستنتاج.
ونريد الآن أن نتحدث عن نتائج هذه الثورة وعن عطائها الإنساني. فهل غيرت هذه الثورة شيئاً من واقع المجتمع الذي انفجرت فيه؟ وهل حقَّقت نصراً لصانيعها؟ وهل حطمت أعدائها؟
هذه أسئلة تثور على شفتي كل من يقرأ أو يسمع عن ثورة من الثورات، ويتوقف الحكم على الثورة بالنجاح أو الفشل على ما تقدمه الوثائق من أجوبة على هذه الأسئلة. فهل كانت ثورة الحسين ناجحة أو أنها كانت ثورة فاشلة ككثير من الثورات التي تشتعل ثم تنطفىء، ولا تخلف ورائها إلاَّ ذكريات حزينة تراود بين الحين والحين أحباء صرعاها.
قد يقال: أنها ثورة فاشلة تماماً، فهي لم تحقِّق نصراً سياسياً آنياً يطور الواقع الإسلامي إلى حال أحسن من الحال التي كان عليها قبل هذه الثورة، لقد بقي المسلمون بعد الثورة كما كانوا قبلها: قطيعاً يساق بالقوة إلى حيث يراد له لا إلى حيث يريد، ويساس بالتجويع والإرهاب. ولقد ازداد أعداء هذه الثورة قوة على قوتهم، فلم تنل منهم شيئاً. وأما صانعوها فقد أكلتهم نارها، وشملت أعقابهم مئات من السنين، فحملت إليهم الموت، والذل، والتشريد، والحرمان. فهي فاشلة على الصعيد الاجتماعي، وهي فاشلة على الصعيد الفردي.
ولكن الحق غير ذلك في عين الباحث البصير.
فإن علينا لكي نفهم ثورة الحسين أن نبحث عن أهدافها ونتائجها في غير النصر الآتي الحاسم، وفي غير الاستيلاء على مقاليد الحكم والسلطان، فإن ما بين أيدينا من النصوص دال على أن الحسين كان عالماً بالمصير الذي ينتظره وينتظر من معه.
قال لابن الزبير حين طلب منه إعلان الثورة في مكة:
«وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم، والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت»([717]).
وكان يقول:
«والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرام المرأة»([718]).
وأجمع نصحاؤه ـ حين شاع نبأ عزمه على المصير إلى العراق ـ على أنه فاشل حتماً في الوصول إلى نتيجة سريعة من ثورته، فقد كانت قوى المال والسلاح متحدة ضده، فكيف ينتصر؟ وفزعوا إليه ينصحونه بالمكوث في مكة أو الخروج عنها إلى غير العراق من بلاد الله، من هؤلاء عمر بن عبدالرحمن المخزومي، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، ومحمَّد بن الحنفية، وعبدالله بن جعفر.
ولكنه أبى عليهم ما أشاروا به فقال لعبدالرحمن بن الحرث:
«جزاك الله خيراً يا ابن عم، فقد والله علمت أنك مشيت بنصح. وتكلمت بعقل. ومهما يقض الله من أمر يكن: أخذت برأيك أو تركته. فأنت عندي أحمد مشير، وأنصح ناصح»([719]).
وقال لعبدالله بن عباس:
«يا ابن عم، إني والله لأعلم أنك ناصح مشفق، ولكني قد أزمعت وأجمعت على المسير»([720]).
وقال في موقف آخر:
«لأن أُقتل بمكان كذا أو كذا أحب إلي من أن تستحل حرمتها بي ـ يعني الحرم..»([721]).
وقال لعبدالله بن عمر وقد نصحه بالصلح والمهادنة مع يزيد:
«يا أبا عبدالرحمن أما علمت أن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أُهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل… اتق الله يا أبا عبدالرحمن ولا تدعن نصرتي»([722]).
وأجاب الفرزدق حين قال له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أُمية:
«صدقت، لله الأمر، والله يفعل ما يشاء، وكل يوم ربنا في شأن، إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته، والتقوى سريرته»([723]).
وورد إليه كتاب عمر بن سعيد بن العاص عامل المدينة يمنيه فيه الأمان والصلة، والبر وحسن الجوار، وأرسله إليه مع أخيه يحيى بن سعيد، وعبدالله بن جعفر، فجهدا أن يرجع فلم يفعل، ومضى وهو يقول:
«قد غسلت يدي من الحياة، وعزمت على تنفيذ أمر الله».
وهكذا ما نزل منزلاً إلاَّ ولقي من ينصحه بعدم الخروج إلى العراق، ويذكر له من أنباء أهله ما يكشف عن خذلانهم له وانكفائهم عليه، حتى أتاه خبر قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وهو بالثعلبية فأهاب به بعض أصحابه بالرجوع فأبى. فلما كان بزبالة([724]) أتاه خبر قتل أخيه من الرضاعة عبدالله بن بقطر([725]) فخرج حينذاك إلى من صحبه من الناس وقال:
«أما بعد فإنه قد أتاني خبر فظيع قتل مسلم بن عقيل، وهاني بن عروة، وعبدالله بن بقطر، وقد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج، ليس عليه منا ذمام. فتفرق عنه الناس تفرقاً، فأخذوا يميناً وشمالاً حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من المدينة، وإنما فعل ذلك لأنه ظن إنما اتبعه الأعراب لأنهم ظنوا أنه يأتي بلداً قد استقامت طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلاَّ وهم يعلمون علام يقدمون. وقد علم أنهم إذا بين لهم لم يصحبه إلاَّ من يريد مواساته والموت معه»([726]). وأجاب من نصحه بالرجوع إلى مأمنه من منزله ذاك بعد أن تبين له الأمر، فقال له: «يا عبدالله أنه ليس يخفى علي أن الرأي ما رأيت ولكن الله لا يغلب على أمره»([727]).
هذه النذر كلها تشير إلى أنه كان عالماً بالمصير الذي ينتظره وإذن فليس لنا أن نبحث عن أهداف ثورة الحسين ونتائجها في الاستيلاء على مقاليد الحكم والسلطان، لأنه لم يستهدف من ثورته نصراً آنياً، ولأنه كان مدركاً لاستحالة الحصول على نصر آني. وقد يبدو لنا هذا غريباً جداً. فكيف يسير إنسان إلى الموت مع طائفة من أخلص أصحابه طائعاً مختاراً، وكيف يحارب في سبيل قضية يعلم أنها خاسرة. وكيف يمكّن لعدوه من نفسه هذا التمكين، هذه علامات استفهام كثيرة نبحث عن أجوبتها.
والذي أعتقده هو أن وضع المجتمع الإسلامي إذ ذاك كان يتطلب القيام بعمل انتحاري فاجع يلهب الروح النضالية في هذا المجتمع، ويتضمن أسمى مراتب التضحية ونكران الذات في سبيل المبدأ لكي يكون مناراً لجميع الثائرين حين تلوح لهم وعورة الطريق، وتضمحل عندهم احتمالات الفوز، وترجح عندهم إمارات الفشل والخذلان.
لقد كان قادة المجتمع وعامة أفراده إذ ذاك يقعدون عن أي عمل إيجابي لتطوير واقعهم السيىء بمجرد أن يلوح لهم ما قد يعانون في سبيل ذلك من عذاب، وما قد يضطرون إلى بذله من تضحيات. وكانوا يقعدون عن القيام بأي عمل إيجابي بمجرد أن تحقق لهم السلطة الحاكمة بعض المنافع القريبة ولم يكن هذا خلق السادة وحدهم، بل كان خلق عامة الناس أيضاً، لذا رأينا تخاذل مجتمع بأسره عن نصر قضيته حين أوقع ابن زياد بمسلم بن عقيل، وكيف أخذت المرأة تخذل ابنها وزوجها وأخاها، وكيف أخذ الرجل يخذل ابنه وأخاه وأباه. لقد كان أولئك الذين قالوا للحسين: قلوب الناس معك وسيوفهم عليك صادقين في تصوير ذلك المجتمع فإن قلوب الناس كانت معه لأنَّهم يحبون أن يصيروا إلى حال أحسن من حالهم، ولكنهم حين علموا أن ذلك موقوف على بذل تضحيات قد تصل إلى بذل الحياة انكمشوا، وسلوا سيوفهم في خدمة الذين يدفعون لهم أجر قتالهم لهذا الذي جاء بدعوة منهم ليحررهم. فحين استيقن ابن زياد أن الحسين ماض فيما اعتزمه جمع الناس في مسجد الكوفة، وخطبهم ومدح يزيد وأباه، وذكر حسن سيرتهما، وجميل أثرهما ووعد الناس بتوفير العطاء لهم وزادهم في أُعطياتهم مائة مائة وأمرهم بالاستعداد والخروج لحرب الحسين([728]).
هذا هو موقف الشعب من الحركات العامة التي يتوقف نجاحها على التضحيات. وأما موقف الزعماء فقد عرفته، وهذه صورة أُخرى منها قدمها لنا عمر بن سعد أمير الجيش الأُموي، فلقد دار أمره بين أن يحارب الحسين وبين أن يفقد إمرة الري فاختار الأُولى على الثانية([729]).
ولقد حاوره الحسين في كربلاء. فقال له:
«ويلك يا ابن سعد، أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ أتقاتلني وأنا ابن عمك؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنه أقرب لك إلى الله، فقال ابن سعد: أخاف أن تهدم داري، فقال الحسين: أنا أبنيها لك، فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي، فقال الحسين: أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز، فقال: لي عيال وأخاف عليهم، وهنا اتضح للحسين أنه رجل ميت القلب، ميت الضمير فإنسان يقيس مصير مجتمعه بهذا اللون من القياس ليس إنساناً سَوي التكوين النفسي، فقال له الحسين: مالك؟ ذبحك الله على فراشك عاجلاً، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر العراق إلاَّ يسيراً.
فقال مستهزءاً:
في الشعير كفاية([730]).
هذا هو المجتمع الإسلامي في أيام الحسين: مجتمع مريض يشترى ويباع بقليل من المال وكثير من العذاب والإرهاب وما كان من الممكن أن ترد إلى هذا المجتمع إنسانيته وكرامته وما كان من الممكن أن ينبه إلى زيف وحقارة وجوده، وما كان من الممكن أن توقظ فيه روحه النضالية الهامدة إلاَّ بعمل انتحاري فاجع يتضمن أسمى آيات التضحية والكرامة، والدفاع عن المبدأ، والموت في سبيله وهكذا كان.
إن الحسين لم يكن ذا مال لينافس الأُمويين وبيدهم خزائن الأموال، ولم يكن ليتجافى عن روح الإسلام وتعاليمه فيجلب الناس إليه بالعنف والإرهاب، ولذا فليس من المعقول أن يطلب نصراً سياسياً آنياً في مجتمع لا يحارب إلاَّ في سبيل المال وبالمال. أو بالقسر والإرهاب، ولكن كان في وسعه أن يقوم بعمله الذي قام به ليهز أعماق هذا المجتمع، وليقدم له مثلاً أعلى طبع في ضمائر أفراده بدم ونار. وإذا نحن تقصينا أسماء من قتل مع الحسين في كربلاء وجدنا أصحابه ينتمون إلى معظم القبائل العربية، فقل أن توجد قبيلة عربية لم يقتل مع الحسين منها واحد أو اثنان.
ومن هنا يمكن القول بأن فاجعة كربلاء دخلت في الضمير الإسلامي آنذاك وانفعل بها المجتمع الإسلامي بصفة عامة انفعالاً عميقاً. ولقد كان هذا كفيلاً بأن يبعث في الروح النضالية الهامدة جذوة جديدة، وأن يبعث في الضمير الشلو هزة تحييه، وأن يبعث في النفس ما يدفعها إلى الدفاع عن كرامتها.
وهذه الملاحظات تجعل من المتعين علينا ألا نبحث عن نتائج ثورة الحسين فيما تعودناه في سائر الثورات، وإنما نلتمس نتائجها في الميادين التالية:
1 ـ تحطيم الإطار الديني المزيف الذي كان الأُمويون وأعوانهم يحيطون به سلطانهم، وفضح الروح اللادينية الجاهلية التي كانت توجه الحكم الأُموي.
2 ـ بث الشعور بالإثم في نفس كل فرد وهذا الشعور الذي يتحول إلى نقد ذاتي من الشخص لنفسه يقوم على ضوئه موقفه من الحياة والمجتمع.
3 ـ خلق مناقبية جديدة للإنسان العربي المسلم وفتح عيني هذا الإنسان على عوالم مضيئة باهرة.
4 ـ بعث الروح النضالية في الإنسان المسلم من أجل إرساء المجتمع على قواعد جديدة، ومن أجل رد اعتباره الإنساني إليه.
ـ 2 ـ
1 ـ تحطيم الإطار الديني:
قد رأينا في فصل سابق كيف استغل الأُمويون الدين لإيهام رعاياهم أنهم يحكمون بتفويض إلهي، وأنهم خلفاء رسول الله حقاً، هادفين من وراء ذلك إلى أن يجعلوا الثورة عليهم عملاً محظوراً وإن ظلموا وجوعوا وشردوا المؤمنين، وأن يجعلوا لأنفسهم باسم الدين الحق في قمع أي تمرد تقوم به جماعة من الناس وإن كانت محقة في طلباتها.
وقد رأينا أنهم استعانوا على ذلك بطائفة كبيرة من الأحاديث المكذوبة على النبي (ص). وقد وضعها ونسبها إلى النبي أُولئك النفر من تجار الدين الذين تقدم ذكر بعضهم والذين كانوا يؤلفون جهاز الدعاية عند معاوية بن أبي سفيان. واستعان معاوية بهؤلاء وغيرهم في عقد مجالس القصص والوعظ التي دأب القصاصون والوعاظ على أن يدسوا فيها هذه الأحاديث، ويبشروا فيها بهذه الأفكار فيؤيدون بها الحكم الأُموي عن طريق الدين.
وقد جعل معاوية القصص عملاً رسمياً تابعاً للدولة، فرتب قصاصاً يوميين في المحال والمساجد، وأنفق عليهم من مال الدولة. قال الليث بن سعد:
«وأما قصص الخاصة فهو الذي أوجده معاوية، ولى رجلاً على القصص فإذا سلَّم من صلاة الصبح جلس، وذكر الله عزَّ وجلَّ، وحمده ومجده، وصلى على النبي (ص)، ودعا للخليفة، ولأهل بيته، وحشمه وجنوده، ودعا على أهل حربه، وعلى المشركين كافةً»([731]).
وعن طريق هذه المؤسسات (الأحاديث النبوية، الشعر، الفرق الدينية، القصص) آمن الناس إيماناً غيبياً بالحكم الأُموي وبحرمة الثورة عليه، وإن خرج عن حدود الدين الذي هو المبرر الوحيد لوجوده. ولقد عملت هذه المؤسسات عملها السام، وأعطت ثمارها الخبيثة في صورة تسفيه تام، وخضوع أعمى للحكم الأُموي مهما اقترف من مظالم، وهذه بعض الشواهد على ذلك من ثورة الحسين نفسها:
فهذا ابن زياد يقول للناس في خطبته التي خذل فيها عن مسلم بن عقيل:
«اعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمتكم»([732]).
وهذا مسلم بن عمرو الباهلي ـ وهو من أصحاب ابن زياد ـ طلب منه مسلم بن عقيل، بعد أن قبض عليه، أن يسقيه من جرة بباب القصر، فقال له:
«أتراها ما أبردها..؟ والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم».
فقال له مسلم: من أنت؟
فقال: أنا من عرف الحق إذ تركته، ونصح الأُمة والإمام إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته([733]).
وهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي ـ من قادة الجيش الأُموي في كربلاء ـ صاح قائلاً حين رأى بعض أفراد جيشه ينسلون إلى الحسين، ويقاتلون دونه:
يا أهل الكوفة، الزموا طاعتكم وجماعتكم، ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين، وخالف الإمام([734]).
هذه الشواهد وغيرها كثير ـ تكشف عن أن المسؤولين الأُمويين وأعوانهم كانوا يطالبون الناس بالقيام بفرض ديني حين طلبوا منهم أن يحاربوا الحسين. ولا بد أنهم استندوا في طلبهم هذا إلى ما عهدوه من السند الديني للحكم الأُموي في نفوس المسلمين.
وقد كان حرياً بهذه العقيدة ـ إذا عمت جميع طبقات المجتمع، واستحكمت في أذهان الناس دون أن تكافح، ودون أن يظهر في الناس من يفضح زيفها، وبعدها عن الدين ـ أن تقضي تماماً على كل محاولة مقبلة يراد منها تطوير الواقع الإسلامي، وتقويض أركان الحكم الفاسد الذي يمارسه الأُمويون وأعوانهم، وكلما تقدم الزمن بهذه العقيدة دون أن تجد مناوئاً تزداد استحكاماً وتأصلاً في النفوس، وذلك كفيل في النهاية بحمل المجتمع على مناوئة كل حركة تحررية.
ويقتضينا الإنصاف للواقع أن ننبه إلى أن دعايات الأُمويين الدينية التي هدفوا منها إلى دعم حكمهم الفاسد فشلت في التأثير على الخوارج، فقد كان الخوارج يشكِّلون القوة الثورية الوحيدة في المجتمع الإسلامي، وكانوا وحدهم ـ تقريباً ـ القائمين بجميع الحركات التحررية ضد الحكم الأُموي منذ استتباب الأمر لمعاوية حتى ثورة الحسين (ع). إلاَّ أن حركات الخوارج التمردية لم تكن هي تلك الثورة التي يرجى منها بث قوى جديدة، ومفاهيم جديدة في المجتمع الإسلامي، ولم تكن هي الثورة التي يرجى منها تحطيم الإطار الديني للحكم الأُموي. ولم تكن هذه الحركات التمردية لتؤثر سوى هزات خفيفة جداً في السطح الاجتماعي، ولا تصل إلى القاع أبداً. وكانت هذه الهزات تحدث في نطاق ضيق لا يتعدى حدود المدينة أو القرية التي يحدث فيها التمرد والاشتباك المسلح بينهم وبين الفرق العسكرية الأُموية، ثم لا يلبث السطح الاجتماعي أن يعود إلى ما كان عليه دون أن يتغير من حياة الناس ومفاهيمهم ـ حتى في مركز الحركة ـ أي شيء.
والسبب في ذلك هو أن المجتمع الإسلامي لم يكن يتجاوب معهم، بل كان يحاربهم، ويقف ضدهم. ويمكن أن نقول بوثوق أن المجتمع الإسلامي لم يحارب مع حكامه الأُمويين عن رغبة واندفاع إلاَّ ضد الخوارج.
وطبيعي أنه حين لا يتجاوب المجتمع نفسياً وعقائدياً مع القائمين بالثورة، لا يمكن أن تنجح تلك الثورة مطلقاً على الصعيد الاجتماعي والفكري، فلا يمكن أن تحدث تغييراً في التركيب الاجتماعي لأن المجتمع يخذلها ويناوئها، ولا يمكن أن تحدث تغييراً في المفاهيم الثقافية والعقائدية لأن المجتمع يرفض تعاليمها ونزعتها العقائدية.
يضاف إلى هذا أن الخوارج كانوا قساة جداً، وعلى جانب كبير من الرعونة والرغبة في سفك الدم، فلم يكونوا يعفون عن قتل أي إنسان يصادفونه دون أن يلقوا بالاً إلى كونه محارباً أو مسالماً، رجلاً أو امرأة أو طفلاً. وأن تشكيلات الخوارج كانت تمتص كثيراً من المجرمين، ونهازي الفرص والطامعين في النهب([735]).
كل هذا جعل المجتمع الإسلامي يقف ضدهم ولذلك فلم تكن ثوراتهم المتكررة لتحطيم الإطار الديني الذي أحاط به الأُمويون سلطانهم.
لقد كان أضمن السبل لتحطيم هذا الإطار الديني هو أن يثور عليه رجل ذو مركز ديني مسلم به عند الأُمة المسلمة بأسرها، فثورة مثل هذا الرجل كفيلة بأن تفضح الزخرف الديني الذي يتظاهر به الحكام الأُمويون، وأن تكشف هذا الحكم على حقيقته، وجاهليته، وبعده الكبير عن مفاهيم الإسلام. ولم يكن هذا الرجل إلاَّ الحسين. فقد كان له في قلوب المسلمين جميعاً رصيد من الحب والإجلال عظيم، وقد رأيت مصداق ذلك عند الحديث عن إقامته في مكة، ثم عند الحديث عن خروجه منها إلى العراق.
كان هو الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يفضح الحكام الأُمويين ويكشف حقائقهم. وقد وضع موقف الأُمويين من ثورة الحسين خطاً فاصلاً بين الدين الإسلامي والحكم الأُموي، وأظهر هذا الحكم بمظهره الحقيقي، وكشف زيفه.
فالأُمويون الذين لم يرضوا من الحسين إلاَّ بالقتل: قتله وقتل آله: آل علي، وآل عقيل، وأبنائهم. وقتل طائفة من صفوة أصحابهم تقى وديناً وحرصاً على مصلحة المسلمين ثم منعهم الماء عنهم حتى قتلوهم عطاشى وفيهم الطفل الرضيع، والمرأة المرضع ثم ما فعلوه بعد ذلك من رض أجسادهم بحوافر الخيل، وسبي بنات النبوة على الوجه المعروف: حاسرات بلا غطاء ولا وطاء، ونقل رؤوس القتلى مع السبايا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، كل ذلك جرد الأُمويين من كل صبغة دينية وإنسانية، بل جعلهم ضد الدين والإنسانية لقد كانت الرؤوس، والسبايا، وأحاديث الجنود العائدين دلائل حية، بليغة الأداء، تعمل على تقويض كل ركيزة دينية للحكم الأُموي في نفوس المسلمين.
ولقد زاد الحسين حراجة مركزهم حين لم يصر على القتال، لقد طلب من الحر بن يزيد ـ وهو أول قائد أُموي واجه الحسين بألف محارب ـ أن يتركه ليرجع من حيث أتى فلم يجبه الحر إلى ذلك. وكانت الأوامر تقضي عليه ألا يفارق الحسين حتى يقدمه الكوفة إلى زياد، ومن نافلة القول أن نذكر أن الحسين رفض ذلك([736]).
حتى إذا قدم عمر بن سعد قائد الجيش الأُموي فاوضه الحسين طويلاً، وأقنعه بأن يمسك الطرفان عن القتال ويرجع الحسين من حيث أتى أو يذهب إلى حيث يريد من بلاد الله. وكتب عمر بن سعد بذلك إلى عبيد الله بن زياد فأبى ابن زياد ذلك، وكتب إليه:
«أما بعد، فإني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتطاوله، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتقعد له عندي شافعاً، انظر فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم، واستسلموا فابعث بهم إلي سلماً، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثِّل بهم فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتل الحسين فأوطىء الخيل صدره وظهره، فإنه عاق مشاق، قاطع ظلوم وليس في هذا أن يضر بعد الموت شيئاً، ولكن علي قول، لو قد قتلته فعلت هذا به»([737]).
لقد أعطاهم الحسين فرصة يتقون بها ارتكاب قتله وقتل آله وصحبه، ولكنهم أبوا إلاَّ القتل، وأصروا عليه، فزادهم ذلك فضيحة في المسلمين.
وأغتنم هذه المناسبة هنا فأقول: يتحدث بعض المؤرخين عن أن الحسين قال لابن سعد: اذهب بي إلى يزيد أضع يدي في يده. والذي نقطع به هو أن الحسين (ع) لم يقل هذا، ولو أراد ذلك لما صار إلى حالته التي صار إليها. إن جميع الدلائل تشير إلى أن هذا الخبر إنما هو من وضع الأُمويين وأعوانهم، أرادوا أن يوهموا به الناس أن الحسين خشع وخضع وحنى رأسه لسلطان يزيد، ليشوهوا بذلك الموقف البطولي الذي وقفه هو وأصحابه في كربلاء، وقد حرص الأُمويون وأعوانهم على إخفاء كثير من ملامح ثورة الحسين وملابساتها، وأذاعوا كثيراً من الأخبار المكذوبة عنها، ليوقفوا عملها التدميري في ملكهم وسلطانهم، ولكنهم لم يفلحوا.
والذي يدل على هذا الخبر ما رواه كثير من المؤرخين عن عقبة بن سمعان أنه قال:
«صحبت الحسين من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق، ولم أُفارقه حتى قتل، وسمعت جميع مخاطباته الناس إلى يوم مقتله، فوالله ما أعطاهم ما يتذاكر به الناس من أنه يضع يده في يد يزيد، ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال: دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه، أو دعوني أذهب في هذا الأرض العريضة حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس، فلم يفعلوا»([738]).
ولقد جعلهم موقفهم هذا من الحسين بمثابة الثائرين على الإسلام نفسه.
وقد استغل الحسين هذه النقطة ـ إصرارهم على قتله، وامتناعهم عن الاستجابة لكل حل سلمي، ومركزه في المسلمين ـ استغلالاً رائعاً، فقد دأب في كل فرصة تؤاتيه للكلام على تأكيد هذه الحقيقة للجيش الأُموي، وهذا نموذج من كلامه معهم في هذا الشأن:
«أيها الناس اسمعوا قولي، ولا تعجلوني حتى أعظكم بما يجب لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري، وصدقتم قولي، وأنصفتموني، كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر فاجمعوا أمركم وشركائكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم أفضوا إلي ولا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين».
أما بعد. فانسبوني، فانظروا من أنا، ثمَّ ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوها، وانظروا: هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيّكم (ص)، وابن وصيِّه وابن عمِّه، وأَوَّل المؤمنين بالله، والمصدِّق لرسوله بما جاء به من عند ربِّه؟ أو ليس حمزة سيِّد الشهداء عمَّ أَبي، أَو ليس جعفر الشَّهيد الطيَّار عمِّي؟ أو لم يبلغكم قول مستفيض فيكم أَنَّ رسول الله (ص) قال لي ولأَخي: «هذان سيِّدا شباب أهل الجنَّة»؟ فإن صدَّقتموني بما أقول ـ وهو الحقَّ ـ والله ما تعمَّدت كذباً مذ علمت أنَّ الله يمقت عليه أهله، ويضر به من اختلقه، وإن كذَّبتموني فإنَّ فيكم من إن سأَلتموه عن ذلك أَخبركم: سلوا جابر بن عبدالله الأنصاري، أو أبا سعيد الخدري، أو سهل بن سعد السَّاعدي، أو زيد بن أرقم، أو أَنس بن مالك يخبروكم أَنَّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله (ص) لي ولأَخي، أَفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟
«فقال له شمر بن ذي الجوشن:
هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول.
«فقال له حبيب بن مظاهر»:
والله إني لأراك تعبد الله على سبعين حرفاً وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك.
ثم قال لهم الحسين:
«فإن كنتم في شكٍ من هذا القول أَفتشكُّون في أَنِّي ابن بنت نبيِّكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبيّ غيري منكم ولا من غيركم، وأنا ابن بنت نبيَّكم خاصَّة. أَخبروني أَتطلبوني بقتيلٍ منكم قتلته؟ أو مالٍ لكم استهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟
فأخذوا لا يكلمونه. فنادى: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي: أن قد أينعت الثمار، واخضر الجناب، وطمت الجمام، وإنما تقدم على جند لك مجندة، فأقبل. قالوا له: لم نفعل، فقال: سبحان الله!، بل والله، لقد فعلتم، ثم قال: أيها الناس: إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث أَوَلا تنزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلاَّ ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه فقال له الحسين: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل([739])؟
«لا والله لا أُعطيهم بيدي إعطاء الذَّليل، ولا أُقرُّ إقرار العبيد. عباد الله: إني عذت بربِّي وربِّكم أن ترجمون. أعوذ بربِّي وربَّكم من كلِّ متكبِّر لا يؤمن بيوم الحساب»([740]).
بهذا الكلام فضح الحسين الزخرف الديني في الحكم الأُموي فليس إنساناً عادياً هذا الذي ثار على هذا الحكم، إنه ركيزة من الركائز التي قام عليها الإسلام… الدين الذي يبرر به هذا الحكم وجوده. ومن ناحية أُخرى أشعرهم أن الظلم يجب أن يقابل بالثورة. والاحتجاج.. بالعمل الانتحاري حتى ولو كان هذا الظلم صادراً من جهاز حكمٍ يحكم باسم الدين، لأن الحكم بمجرد أن يظلم يتنكر للدين.
إن بعض أدعياء البحث العلمي يرون أن الحسين وقف هذا الموقف ليستدر الرحمة، ثم يقولون ما كان أغناه عن ذلك. ولكنهم بعيدون جداً عن فهم هذا اللون من مواقف الأبطال العقائديين. لو أراد الحسين أن يستدر الرحمة وينجو بحياته لاكتفى بأدنى من هذا: لبايع يزيد، لذهب إلى أبي عبيدالله بن زياد، لكتب إلى يزيد يستأمنه ويعطيه البيعة، لكلم في ذلك عمر بن سعد سراً. لو أراد الرحمة لفعل شيئاً من ذلك، ولكنه توجه بخطابه إلى الجنود… الجنود الذين يعلم أنهم مأمورون، وأنهم لا يملكون أن يفعلوا ما يريدون، توجه إليهم ليؤكد في أذهانهم ومشاعرهم الحقيقة التي سترعبهم وسترعب المجتمع الإسلامي كله بعد قليل… الحقيقة الصارخة بأنه ومن معه أبناء رسول الله نبي الدين الذي يحكم باسمه الأُمويون. إنه ومن معه منحدرون من هذه الأصول العريقة في تاريخ الإسلام: محمَّد رسول الله، علي، فاطمة، جعفر، حمزة. إنه يقرر في أذهانهم أنهم لا يطلبونه بقتيل قتله منهم، ولا بمال احتجنه عنهم، ولا بجراحة أصاب بها أحدهم، وإنما يطلبونه لأنه ثار على الحكم الأُموي الفاسد، هذا الحكم الذي يصر على قتله باسم الدين، وهو في مركزه الديني العظيم.
على هذا النحو ينبغي أن يفهم هذا النص وغيره من النصوص.
وانتهت فاجعة كربلاء بمصرع الحسين وآله وصحبه. ولكن نضال بقية آل البيت في سبيل إشعار المسلمين بالزيف الديني الذي يقوم عليه الحكم الأُموي، وفي سبيل بث الوعي في هذه الجماهير لم ينته، ولكن النضال منذ اليوم لن يأخذ شكل الثورة المسلحة فقد صرع في كربلاء جميع الثائرين إنه منذ اليوم نضال كلامي. ولقد واصلت ثورة الحسين في هذا الاتجاه أخته زينب عقيلة آل أبي طالب.
وقد انكشف هذا الزيف الديني الذي موه الأُمويون به حكمهم سريعاً بعد مصرع الحسين وآله. فقد نشر الجنود العائدون تفاصيل الملحمة المروعة في طول البلاد الإسلامية وعرضها، فكان لذلك فعل النار بالنسبة إلى السلطان الأُموي وقد روى المؤرخون أنه لما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده، وزاده، ووصله، وسره ما فعل. ثم لم يلبث إلاَّ يسيراً حتى بلغه بغض الناس له، ولعنهم، وسبهم، فندم على قتل الحسين([741]).
لقد تحطم منذ ذلك اليوم الإطار الديني الذي أحاط به الحكام الظالمون حكمهم الفاسد، لم تعد لهذا الحكم حرمة دينية عند الجماهير المسلمة. وقد عرفت فيما سبق أن الأُمويين أنشأوا جماعة فكرية تتخذ من نشاطها الفكري وسيلة لتغطية نشاطها السياسي، ولإسباغ صفة مشروعة على هذا النشاط، وهي فرقة المرجئة التي تؤيد حكومة بني أمية، وتسبغ على تصرفاتهم صفة دينية، وتقدم للناس تفسيراً دينياً خاصاً يجعل الحاكمين بمأمن من أن ينظر المسلمون إلى أفعالهم المنافية للدين نظرة غضب واستنكار.
وقد دأب الفقهاء الرسميون، على إصدار الفتاوى التي تحرم على الجماهير الثورة على الحكم الفاسد.
قال الشربيني في كتاب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج:
«وقد عرف المصنف البغاة بقوله: هم مسلمون، مخالفوا الإمام ولو جائراً وهم عادلون، كما قال القفال، وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب، وما في الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل، وكذا هو في الأُم والمختصر مرادهم إمام أهل العدل، فلا ينافي ذلك. ويدل لذلك قول المصنف في شرح مسلم: إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين».
وقال الشيخ عمر النسفي في كتابه «العقائد النسفية»:
«ولا ينعزل الإمام بالفسق ـ أي الخروج على طاعة الله تعالى ـ والجور ـ أي الظلم على عباده تعالى ـ لأن الفاسق من أهل الولاية عند أبي حنيفة..»، وقد علل ذلك بأنه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم، ولا يرون الخروج عليهم….!!.
وقال الباجوري في حاشيته على شرح الغزي:
«فتجب طاعة الإمام ولو جائراً، وفي شرح مسلم: يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعاً»…
وهذا فقيه آخر يقول في كتاب مجمع الأنهر وملتقى الأبحر:
«والإمام يصير إماماً بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروته، فإن بويع ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماماً. فإذا صار إماماً فجار لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة وإلاَّ ينعزل»([742]).
هذه الفتاوى وأمثالها التي تحرم ثورة العادلين على الظالمين الفاسقين، والتي تجعل مبرر السيطرة على الحكم القدرة على قهر الرعية وظلمها والجور فيها، ما أنزل الله بها من سلطان وإنما هي النتاج الخبيث للنظرة الدينية إلى الحكم الأُموي وكل حكم ظالم. وهي نتيجة التبرير الديني لتصرفات الحكام الظالمين ولكن هذه الفتاوى التخديرية التي ما أنزل الله بها من سلطان بقيت في بطون الكتب، ولم تعد الجماهير المسلمة تستمع إليها إلاَّ قليلاً… لقد بدأت تتربص للثورة في كل حين.
ـ 3 ـ
2 ـ الشعور بالإثم:
وكان لثورة الحسين ونهايته في كربلاء أثر آخر، هو ما سببته هذه النهاية وهذا المصير من إثارة الشعور بالإثم في ضمير كل مسلم استطاع نصره فلم ينصره، وسمع واعيته فلم يجبها. ولقد كان هذا الشعور أقوى ما يكون في ضمائر أولئك الذين كفوا أيديهم عن نصره بعد أن وعدوه النصر، وعاهدوه على الثورة.
ولهذا الشعور بالإثم طرفان، فهو من جهة يحمل صاحبه على أن يكفِّر عن إثمه الذي ارتكبه، وجرمه الذي قارفه، وهو من جهة أخرى يثير في النفس مشاعر الحقد والكراهية لأولئك الذين دفعوه إلى ارتكاب الإثم.
وهذا ما نراه جلياً في الشعب المسلم بعد ثورة الحسين، فقد دفع الشعور بالإثم كثيراً من الجماعات الإسلامية إلى العمل للتكفير وزادهم بغضاً للأُمويين وحقداً عليهم، وكان التعبير الطبيعي للرغبة في التكفير وللحقد هو الثورة، وهكذا كان فقد استهدف الأُمويون لثورات أججها مصرع الحسين وكان باعثها التكفير عن القعود عن نصره، والرغبة في الانتقام من الأُمويين وسنرى في فصل آت نماذج من هذه الثورات.
وبسبب هذا الشعور بالإثم لم يعد موقف المسلمين من الحكم الأُموي موقفاً عقلياً نابعاً من إدراك بعد الأُمويين عن الدين وظلمهم، وإنما غدا موقفاً عاطفياً أيضاً حيث أن هذا الشعور حدا بالكثيرين إلى الثورة كعمل انتقامي يقصد به التشفي، وهذا يفسر لنا كثيراً من الثورات الفاشلة التي كان من البين فشلها قبل اشتعالها، فقد كان سببها هو الرغبة في الانتقام. هو تلبية هذا الداعي العاطفي، وعندما يقع الإنسان تحت وطأة موقف عاطفي طاغ تغيب عنه احتمالات الفشل والنجاح. ومما لا ريب فيه أن هذا العامل النفسي جعل موقف المسلمين من الحكم الأُموي أكثر إيجابية وحرارة، وأسبغ عليه صفة انتقامية، وجعله عاملاً يحسب له حساب عند الحاكمين. إن الموقف العقلي فقد تُمْكن السيطرة عليه والتشكيك فيه بأساليب كثيرة، أما حين يكون الموقف عاطفياً فإن الأمر يختلف تماماً، وذلك لأن العاطفة الصادقة تمتاز بالاشتعال، والفوران والديمومة، ورفض وجهات النظر المقابلة ولقد كان الشعور بالإثم عند هؤلاء المسلمين عميقاً، وصادقاً.
ولقد قدر لبقية آل البيت أن تلهب هذا الشعور بالإثم، وأن تزيده حدة وحرارة. هذه زينب بنت علي (عليه السلام) وقفت في أهل الكوفة، وقد احتشدوا يحدقون في موكب الرؤوس والسبايا ويبكون فأشارت إليهم أن استكتوا، فسكتوا ومضت تقول:
«أما بعد يا أهل الكوفة، أتبكون».
فلا سكنت العبرة، ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم، ألا ساء ما تزرون.
«أي والله، فابكوا كثيراً، واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، فلن ترحضوها بغسل أبداً وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة، ومعدن الرسالة ومدار حجتكم، ومنار محجتكم، وهو سيد شباب أهل الجنة…؟.
لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء. أتعجبون لو أمطرت دماً؟.
ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم، وفي العذاب أنتم خالدون.
«أتدرون أي كبد فريتم؟ وأي دم سفكتم؟ وأي كريمة أبرزتم؟ لقد جئتم شيئاً إداً، تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض، وتخر الجبال هداً».
قال من سمعها:
«فلم أر والله خفرة أنطق منها، كإنما تنزع عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فلا والله ما أتمت حديثها حتى ضج الناس بالبكاء، وذهلوا وسقط ما في أيديهم من هول تلك المحنة الدهماء».
وتكلمت فاطمة بنت الحسين فقالت في كلام لها:
«أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم، وابتلاكم بنا فكذبتمونا وكفرتمونا، ورأيتم قتالنا حلالاً، وأموالنا نهباً.
«ويلكم، أتدرون أي يد طاعنتنا منكم، وأية نفس نزعت إلى قتالنا، أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا، قست قلوبكم، وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم، وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون.
«تباً لكم يا أهل الكوفة، أي تراث لرسول الله قبلكم؟ وذحول له لديكم؟ بما غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب، وعترته الطيبين الأخيار»([743]).
وتكلم علي بن الحسين، زين العابدين، فقال:
«أيها الناس، ناشدتكم الله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة، وقاتلتموه؟ فتباً لكم لما قدمتم لأنفسكم وسوأة لرأيكم. بأي عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي، وانتهكتم حرمتي، فلستم من أُمتي»([744]).
ولما نودي بقتل الحسين في المدينة، وعلم الناس بذلك ضجت المدينة بأهلها، ولم تسمع واعية قط مثل واعية نساء بني هاشم في دورهن على الحسين. وخرجت ابنة عقيل بن أبي طالب حاسرة، ومعها نساؤها، وهي تلوي بثوبها وتقول:
| ماذا تقولون إن قال النبي لكم | ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم | |
| بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي | منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم |
فلما سمع عمرو بن سعيد ـ والي المدينة ـ أصواتهن ضحك وقال:
| عجت نساء بني زياد عجة | كعجيج نسوتنا غداة الأرنب |
ثم قال: هذه واعية كواعية عثمان([745]).
وقد عبر هذا الشعور بالإثم عن نفسه بالشعر الذي يتفجر سخطاً ونقمة على الأُمويين، وحنيناً وولاء للحسين، وانفعالاً بثورته.
وثمة نماذج معاصرة للثورة تكشف لنا بصدق وحرارة عن هذا الأثر الذي خلفته الثورة في المجتمع الإسلامي.
ولعل من أصدق النماذج التي حفظها لنا تاريخ تلك الفترة قول عبدالله بن الحر، الذي فر من الكوفة حين اتهمه عبيد الله بن زياد بعدم الولاء للسلطة، وقدم إلى كربلاء، فنظر إلى مصارع الشهداء وقال:
| يقول أمير غادر حق غادر: | ألا كنت قاتلت الشهيد بن فاطمه | |
| فيا ندمي ألا أكون نصرته | ألا كل نفس لا تسدد نادمه | |
| وإني لأني لم أكن من حماته | لذو حسرة ما إن تفارق لازمه | |
| سقى الله أرواح الذين تأزروا | على نصره سقياً من الغيث دائمه | |
| وقفت على أجداثهم ومجالهم | فكاد الحشى ينفض والعين ساجمه | |
| لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى | سراعاً إلى الهيجا حماة خضارمه | |
| تآسوا على نصر ابن بنت نبيهم | بأسيافهم آساد غيل ضراغمه | |
| فإن يقتلوا فكل نفس تقية | على الأرض قد أضحت لذلك واجمه | |
| وما إن رأى الراؤون أفضل منهم | لدى الموت سادات وزهراً قماقمه | |
| أتقتلهم ظلماً وترجو ودادنا | فدع خطة ليست لنا بملائمه | |
| لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم | فكم ناقم منا عليكم وناقمه | |
| أهم مراراً أن أسير بجحفل | إلى فئة زاغت عن الحق ظالمه | |
| فكفوا وإلاَّ زرتكم بكتائب | أشد عليكم من زحوف الديالمه([746]) |
ومن هؤلاء الذين استيقظت ضمائرهم على جريمتهم الرهيبة رضي بن منقذ العبدي، فقال:
| لو شاء ربي ما شهدت قتالهم | ولا جعل النعماء عندي ابن جابر([747]) | |
| لقد كان ذاك اليوم عاراً وسبة | تعيره الأبناء بعد المعاشر | |
| فيا ليت أني كنت من قبل قتله | ويوم حسين كنت في رمس قابر([748]) |
وقد قدر لهذا الشعور بالإثم أن يبقى مشتعل الأوار، حافزاً دائماً إلى الثورة والانتقام، وقدر له أن يدفع الناس إلى الثورات على الأُمويين كلما سنحت الفرصة ثم لا يرتوي ولا يهدأ ولا يستكين، وإنما يطلب من صاحبه ضريبة الدم باستمرار، وكان سبيل ذلك هو الثورة على الظالمين.
ـ 4 ـ
3 ـ الأخلاق الجديدة:
الثورة الصحيحة هي الاحتجاج النهائي الحاسم على الواقع المعاش. فبعد أن تخفق جميع الوسائل الأخرى في تطوير الواقع تصبح الثورة قدراً حتمياً لا بد منه.
والقائمون بالثورة هم دائماً أصح أجزاء الأُمة، هم الطليعة، هم النخبة التي لم يأسرها الواقع المعاش، وإنما بقيت في مستوى أعلى منه، وإن كانت تدركه، وتعيه، وترصده وتنفعل به، وتتعذب بسببه.
تصبح الثورة قدر هذه النخبة ومصيرها المحتوم حين تخفق جميع وسائل الإصلاح الأخرى. وإلاَّ فإن هذه النخبة إذا لم تثر تفقد مبررات وجودها، ولا يمكن أن يقال عنها أنها نخبة. أنها تكون نخبة حين يكون لها دور تاريخي، وحين تقوم بهذا الدور.
ولا بد أن تبشر الثورة بأخلاق جديدة إذا حدثت في مجتمع ليس له تراث ديني وإنساني يضمن لأفراده ـ إذا اتبع ـ حياة إنسانية متكاملة. أو تحيي المبادىء والقيم التي هجرها المجتمع أو حرفها إذا كان للمجتمع مثل هذا التراث كما هو الحال في المجتمع الإسلامي الذي كانت سياسة الأُمويين المجافية للإسلام تحمله على هجر القيم الإسلامية، واستلهام الأخلاق الجاهلية في الحياة.
وتوفر هذا الهدف في الثورة الصحيحة من جملة مقومات وجودها، لأن العلاقات الإنسانية في الواقع علاقات منحطة وفاسدة، وموقف الإنسان من الحياة موقف متخاذل وموسوم بالانحطاط والانهيار، ولذلك انتهى الواقع إلى حد من السوء بحيث غدت الثورة علاجه الوحيد.
وإذن فالدعوة إلى نموذج من الأخلاق أسمى مما يمارسه المجتمع ضرورة لازمة، لأنه لا بد أن تتغير نظرة الإنسان إلى نفسه، وإلى الآخرين، وإلى الحياة ليمكن إصلاح المجتمع.
ولقد قدم الحسين (ع)، وآله، وأصحابه ـ في ثورتهم على الحكم الأُموي ـ الأخلاق الإسلامية العالية بكل صفاتها ونقائها. ولم يقدموا إلى المجتمع الإسلامي هذا اللون من الأخلاق بألسنتهم، وإنما كتبوه بدمائهم وحياتهم.
لقد اعتاد الرجل العادي إذ ذاك أن يرى الزعيم القبلي أو الزعيم الديني يبيع ضميره بالمال، وبعرض الحياة الدنيا. لقد اعتاد أن يرى الجباه تعنو خضوعاً وخشوعاً لطاغية حقير لمجرد أنه يملك أن يحرم من العطاء. لقد خضع الزعماء الدينيون والسياسيون ليزيد على علمهم بحقارته وانحطاطه، وخضعوا لعبيد الله بن زياد على علمهم بأصله الحقير، ومنبته الوضيع، وخضعوا لغير هذا وذاك من الطغاة لأن هؤلاء الطغاة يملكون الجاه والمال والنفوذ، ولأن التقرب منهم، والتودد إليهم كفيل بأن يجعلهم ذوي نفوذ في المجتمع، وإن عليهم النعمة والرفاه. وكان هؤلاء الزعماء يرتكبون كل شيء في سبيل نيل هذه الحظوة: كانوا يخونون مجتمعهم، فيتمالئون مع هؤلاء الطغاة على إذلال هذا المجتمع، وسحقه، وحرمانه. وكانوا يخونون ضمائرهم، فيبتدعون من ألوان الكذب ما يدعم هذه العروش. وكانوا يخونون دينهم الذي يأمرهم بتحطيم الطغاة بدل عبادتهم.
كان الرجل العادي في المجتمع الإسلامي آنذاك يعرف هذا اللون من الرجال. ويعرف لوناً آخر منهم وهم أُولئك الزهاد الدجالون الذين يتظاهرون بالزهد رياء ونفاقاً، حتى إذا تقربوا من الطغاة كانوا لهم أعواناً وأنصاراً، إنهم هذا الصنف الذي وصفه الإمام علي (ع) بقوله:
«ومنهم من يطلب الدُّنيا بعمل الآخرة، ولا يطلب الآخرة بعمل الدُّنيا، قد طامن من شخصه، وقارب من خطوه، وشمَّر من ثوبه، وزخرف من نفسه للأَمانة، واتَّخذ ستر الله ذريعةً إلى المعصية([749]).
هؤلاء هم الزعماء الذين كان الرجل العادي يعرفهم، وقد اعتادهم، وألفهم، بحيث غدا يرى عملهم هذا طبيعياً لا يثير التساؤل.
ولذلك فقد كان غريباً جداً على كثير من المسلمين آنذاك أن يروا إنساناً يخير بين حياة رافهة، فيها الغنى، وفيها المتعة، وفيها النفوذ والطاعة، ولكن فيها إلى جانب ذلك كله الخضوع لطاغية، والإسهام معه في طغيانه، والمساومة على المبدأ والخيانة له، وبين الموت عطشاً، مع قتل الصفوة الخلص من أصحابه، وأولاده، وإخوته، وأهل بيته جميعاً أمامه، وحيث تنظر إليهم عينه في ساعاتهم الأخيرة وهم يلوبون ظمأ، وهم يكافحون بضراوة وإصرار عدواً هائلاً يريد لهم الموت أو هذا اللون من الحياة، ثم يرى مصارعهم واحداً بعد واحد، وإنه ليعلم أي مصير فاجع محزن ينتظر آله ونسائه من بعده: سبي، وتشريد، ونقل من بلد إلى بلد، وحرمان.. يعلم ذلك كله، ثم يختار هذا اللون الرهيب من الموت على هذا اللون الرغيد من الحياة.
لقد كان غريباً جداً على هؤلاء أن يروا إنساناً كهذا. لقد اعتادوا على زعماء يمرغون جباههم في التراب خوفاً من مصير أهون من هذا بكثير، أمثال عمر بن سعد، والأشعث بن قيس ونظائرهما. تعودوا على هؤلاء، فكان غريباً عليهم أن يشاهدوا هذا النموذج العملاق من الإنسان، هذا النموذج الذي يتعالى ويتعالى حتى ليكاد القائل أن يقول: ما هذا بشر…
ولقد هز هذا اللون من الأخلاق.. هذا اللون من السلوك الضمير المسلم هزاً متداركاً، وأيقظه من سباته المرضي الطويل ليشاهد صفحة جديدة مشرقة يكتبها الإنسان بدمه في سبيل الشرف، والمبدأ، والحياة العارية من الذل والعبودية. ولقد كشف له عن زيف الحياة التي يحياها، وعن زيف الزعماء ـ أصنام اللحم ـ الذين يعبدهم، وشق له طريقاً جديداً في العمل، وقدم له أسلوباً جديداً في ممارسة الحياة، فيه قسوة، وفيه حرمان، ولكنه طريق مضيء لا طريق غيره جدير بالإنسان.
ولقد غدا هذا اللون المشرق من الأخلاق، وهذا النموذج الباهر من السلوك خطراً رهيباً على كل حاكم يجافي روح الإسلام في حكمه.. أن ضمائر الزعماء قليلاً ما تتأثَّر بهذه المثل المضيئة، ولكن الذي يتأثّر هي الأمة، وهذا هو ما كان يريده الحسين (ع). لقد كان يريد شق الطريق للأُمة المستعبدة لتناضل عن إنسانيتها.
وفي جميع مراحل الثورة، منذ بدايتها في المدينة حتى ختامها الدامي في كربلاء نلمح التصميم على هذا النمط العالي من السلوك.
ها هو الحسين (ع) يقول لأخيه محمَّد بن الحنفية، وهما بعد في المدينة:
«يا أخي، والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى، لما بايعت يزيد بن معاوية»([750]).
وها هو يتمثل بأبيات يزيد بن مفرغ الحميري حين انسل من المدينة في جنح الليل إلى مكة:
| لا ذعرت السوام في فلق الصبح | مغيراً ولا دعيت يزيدا | |
| يوم أعطي على المهانة ضيما | والمنايا يرصدنني أحيدا([751]) |
وها هو يجيب الحر بن يزيد الرياحي حين قال له:
أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن، ولئن قوتلت لتهلكن.
فقال له الإمام الحسين (ع):
أبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لك!! ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه ـ ولقيه وهو يريد نصرة رسول الله (ص).
فقال له: أين تذهب فإنك مقتول، فقال:
| سأمضي وما بالموت عار على الفتى | إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلما | |
| وواسى رجالاً صالحين بنفسه | وخالف مثبوراً وفارق مجرما | |
| فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم | كفى بك ذلاً أن تعيش وترغما([752]) |
وها هو ـ وقد أُحيط به، وقيل له: انزل على حكم بني عمك ـ يقول:
«لا والله، لا أُعطيكم بيدي إعطاء الذَّليل، ولا أُقرُّ إقرار العبيد، ألا وإنَّ الدَّعي بن الدَّعيّ قد ركز بين اثنتين: بين السلَّة والذَّلَّة، وهيهات منَّا الذّلَّة، يأْبى الله لنا ذلك، ورسوله، والمؤمنون، وجدود طابت، وحجور طهِّرت، وأُنوف حميَّة، ونفوس أَبيَّة لا تؤثر طاعة اللِّئام على مصارع الكرام»([753]).
وها هو يخطب أصحابه، فيقول:
«أَمَّا بعد فقد نزل من الأَمر بنا ما ترون، وإنَّ الدُّنيا قد تغيَّرت وتنكَّرت، وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلاَّ صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحقِّ لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإنِّي لا أَرى الموت إلاَّ سعادة، والحياة مع الظَّالمين إلاَّ برماً([754]).
وكان يقول كثيراً:
«موت في عز خير من حياة في ذلٍّ»([755]).
كل هذا يكشف عن طبيعة السلوك الذي اختطه الحسين (ع) لنفسه ولمن معه في كربلاء، وألهب به الروح الإسلامية ـ بعد ذلك ـ وبث فيها قوة جديدة.
لقد عرفت كيف كان الزعماء الدينيون والسياسيون يمارسون حياتهم. وهنا نرسم لك صورة عن نوع الحياة التي كان يمارسها الإنسان العادي إذ ذاك. لقد كان هم الرجل العادي هو حياته الخاصة، يعمل لها، ويكدح في سبيلها، ولا يفكِّر إلاَّ فيها. فإذا اتسع أفقه كانت القبيلة محل اهتمامه. أما المجتمع وآلامه، المجتمع الكبير، فلم يكن ليستأثر من الرجل العادي بأي اهتمام. كانت القضايا العامة بعيدة عن اهتمامه، لقد كان العمل فيها وظيفة زعمائه الدينيين والسياسيين يفكرون، ويرسمون خطة العمل، وعليه أن يسير فقط. فلم تكن للرجل العادي مشاركة جدية إيجابية في قضايا المجتمع العامة.
وكان يهتم غاية الاهتمام بعطائه، فيحافظ عليه، ويطيع توجيهات زعمائه خشية أن يمحى اسمه من العطاء، ويسكت عن نقد ما يراه جوراً بسبب ذلك([756]). وكان يهم بمفاخر قبيلته ومثالب غيرها من القبائل، ويروي الأشعار في هذا وذاك.
هذا مخطط لحياة الرجل العادي إذ ذاك.
أما أصحاب الحسين (ع) فقد كان لهم شأن آخر.
لقد كانت العصبة التي رافقت الحسين (ع)، وشاركته في مصيره رجالاً عاديين، لكل منهم بيت، وزوجة، وأطفال وصداقات. ولكل منهم عطاء من بيت المال. وكان كثير منهم لا يزال في ميعة الصبا، في حياته متسع للاستمتاع بالحب وطيبات الحياة، ولكنهم جميعاً خرجوا عن ذلك كله وواجهوا مجتمعهم بعزمهم الكبير في سبيل مبدأ آمنوا به، وصمموا على الموت في سبيله.
ولا أستطيع أن أقدم هنا صورة كاملة وافية لسلوك آل الحسين وأصحابه في هذه الثورة، وعليك لكي تخرج بهذه الصورة الوافية أن تقرأ قصة كربلاء بتمامها، وغاية ما أستطيعه هنا هو أن أقدم لك لمحات من سلوكهم العالي:
ـ في زبالة (موقع) استبان للحسين مصيره حين علم بقتل رسوله إلى أهل الكوفة، مسلم بن عقيل، وأخيه من الرضاعة: عبدالله بن بقطر، فأخبر من معه بذلك وقال:
«أما بعد. فقد أتانا خبر فظيع: قتل مسلم بن عقيل، وهاني بن عروة، وعبدالله بن بقطر. وقد خذلتنا شيعتنا. فمن أحب منكم الإنصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام»([757]).
فتفرق عنه الناس يميناً وشمالاً، حتى بقي في أصحابه الذين يريدون الموت معه، واستمروا على عزمهم هذا إلى اللحظة الأخيرة لكل منهم، اللحظة التي أدى فيها ضريبة الدم كاملة.
ـ وفي كربلاء أقبل على أصحابه فقال:
«النَّاس عبيد الدُّنيا، والدِّين لعق على أَلسنتهم، يحوطونه ما درَّت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلَّ الديَّانون.
ثم قال: «أما بعد. فقد نزل بنا من الأمر ما ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلاَّ صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلاَّ سعادة والحياة مع الظالمين إلاَّ برما».
«فقال زهير بن القين:
سمعنا يا ابن رسول الله مقالتك. ولو كانت الدنيا لنا باقية، وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها».
«وقال برير بن خضير»:
يا ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك، تقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة.
«وقال نافع بن هلال»:
«سر بنا راشداً معافى، مشرّقاً إن شئت أو مغرباً، فوالله ما أشفقنا من قدر الله، ولا كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك، ونعادي من عاداك»([758]).
ومرة أخرى جمع الحسين أصحابه قرب المساء ـ مساء اليوم العاشر ـ فخطبهم قائلاً:
«.. أما بعد، فإنِّي لا أَعلم أصحاباً أَوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أَبرَّ ولا أَوصل من أَهل بيتي، فجزاكم الله عنَّي جميعاً. ألا وإِنِّ أَظنُّ أَنَّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً، وإِنِّي قد أَذنت لكم، فانطلقوا جميعاً في حلٍّ، ليس عليكم منِّي ذمام وهذا اللَّيل قد غشيكم فاتَّخذوه جملاً، وليأْخذ كلُّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعاً خيراً، وتفرَّقوا في سوادكم ومدائنكم، فإنَّ القوم إِنَّما يطلبوني، ولو أَصابوني لذهلوا عن طلب غيري…».
هذه فرصة أخيرة منحهم إياها الحسين، فماذا كان رد الفعل.
«قال له إخوته، وأبناؤه، وبنو أخيه، وأبناء عبدالله بن جعفر:
ولِمَ نفعل…
لنبقى بعدك…
«لا أرانا الله ذلك أبداً».
والتفت الحسين إلى بني عقيل، وقال:
حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا فقد أذنت لكم.
فقالوا:
«فما يقول الناس، وما نقول لهم؟ إنا تركنا شيخنا، وسيدنا، وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرم معهم بسهم، ولم نطعن برمح، ولم نضرب بسيف، ولا ندري ما صنعوا.
«لا والله لا نفعل. ولكن نفديك بأنفسنا، وأموالنا وأهلينا نقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك».
وجاء دور أصحابه، فقال مسلم بن عوسجة:
«أنحن نخلي عنك ولما نعذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله لا أفارقك حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك».
وقال سعد بن عبدالله الحنفي:
«والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله (ص) فيك، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حياً ثم أذرى، يفعل ذلك بي سبعين مرة، ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة».
وقال زهير بن القين:
والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت، حتى أقتل كذا ألف قتلة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك».
وتكلم جماعة من أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في وجه واحد، فقالوا:
«والله لا نفارقك، ولكن أنفسنا لك الفداء، نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا فإذا نحن قتلنا كنا وفينا وقضينا ما علينا»([759]).
وقال الحسين لنافع بن هلال في جوف الليل:
«ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل، وتنجو بنفسك؟ فوقع نافع على قدميه يقبلها ويقول: ثكلتني أمي، إن سيفي بألف، وفرسي بمثله فوالله الذي منَّ علي بك لا فارقتك حتى يكلأ عن فري وجري».
وصاح شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته:
أين بنو أختنا. فخرج إليه العباس وجعفر وعثمان بنو علي، فقالوا له:
ما لك وما تريد؟ قال:
أنتم يا بني أختي آمنون. فقال له الفتية:
لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له([760]).
هذا هو مستوى السلوك الذي ارتفع إليه الثائرون. وهذه هي الأخلاق الجديدة التي قدموها لمجتمعهم، هذا المجتمع الذي قدر لكثير من فئاته فيما بعد أن تأخذ نفسها بالسير على هذا المستوى العالي من الأخلاق وممارسة الحياة.
ولنا أن نتساءل هنا عن دور المرأة المسلمة في ثورة كربلاء لقد كان في الثائرين الزوج والأخ والولد، فما كان موقف المرأة من مصارع هؤلاء ويأتينا الجواب من التاريخ فنهتز لموقف المرأة في كربلاء. لقد كانت المرأة أماً وأختاً وزوجة في طليعة الثائرين المناضلين، المضحين الباذلين لضريبة الدم. ولا أتحدث هنا عن زينب وعن أخواتها فمستوى سلوكهن لم يبلغه بشر. وإنما أتحدث عن نساء عاديات جداً، كن إلى أيام قليلة قبل يوم كربلاء يشغلهن ما يشغل كل امرأة من شؤون بيتها وزينتها، وتربية أولادها، والتحدث مع جاراتها نساء لا تربطهن بالثائرين رابطة دم ولكن تربطهن بهم رابطة مبدأ، ورابطة عقيدة، فضحين بالولد والزوج مستبشرات ثم ضحين بأنفسهم في النهاية.
هذا عبدالله بن عمير قال لزوجته أنه يريد المصير إلى الحسين، فقالت له:
أصبت، أصاب الله بك أرشد أمورك، أفعل، وأخرجني معك، فخرج بها حتى أتى حسيناً فأقام معه.
ثم برز ليقاتل فأخذت امرأته عموداً ثم أقبلت نحو زوجها تقول:
فداك أَبي وأمي، قاتل دون الطيبين، ذرية محمَّد، فأقبل إليها يردها نحو النساء فأخذت تجاذب ثوبه، ثم قالت:
إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الحسين فقال: جزيتم من أهل بيت خيراً، ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهن، فانصرفت.
ثم قتل زوجها فخرجت تمشي إليه حتى جلست عند رأسه تمسح التراب عنه وتقول:
هنيئاً لك الجنة. فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام يسمى رستم:
اضرب رأسها بالعمود، فضرب رأسها فشدخه، فماتت مكانها. وهي أول امرأة قتلت من أصحاب الحسين([761]).
وهذا وهب بن حباب الكلبي، قالت له أمه:
قم يا بني فانصر ابن بنت رسول الله (ص). فقال: أفعل. فحمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل جماعة. ثم رجع وقال:
يا أماه هل رضيت؟ فقالت:
ما رضيت حتى تقتل بين يدي الحسين، فقالت له امرأته:
بالله عليك، لا تفجعني بنفسك، فقالت له أمه:
يا بني اعزب عن قولها، وارجع فقاتل بين يدي ابن بنت نبيك تنل شفاعة جده يوم القيامة. فرجع، ولم يزل يقاتل حتى قطعت يداه ثم قتل([762]).
وبرز جنادة بن الحارث السلماني ـ وكان خرج بعياله وولده إلى الحسين ـ فقاتل حتى قتل. فلما قتل أمرت زوجته ولدها عمرواً ـ وهو شاب ـ أن ينصر الحسين. فقالت له:
اخرج يا بني وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله. فخرج واستأذن الحسين، فقال الحسين:
هذا شاب قتل أبوه، ولعل أمه تكره خروجه. فقال الشاب:
أمي أمرتني بذلك، فبرز وقاتل حتى قتل، وحز رأسه، ورمى به إلى عسكر الحسين، فحملت أمه رأسه وقالت:
أحسنت يا بني، وأخذت عمود خيمة وهي تقول:
| أنا عجوز سيدي ضعيفة | خاوية بالية نحيفة | |
| أضربكم بضربة عنيفة | دون بني فاطمة الشريفة |
وضربت رجلين فقتلتهما، فأمر الحسين بصرفها، ودعا لها([763]).
هذه نماذج من سلوك الثائرين في كربلاء. ولقد أهمل التاريخ ذكر كثير من بطولات هؤلاء الثائرين، فإن المؤرخين يحرصون غالباً على تجنب ذكر التفاصيل الدقيقة، ويقصرون اهتمامهم على ما يلوح لهم أنه عمل جليل، ولا ينال الناس العاديون شيئاً من اهتمامهم بينما يقصرون هذا الاهتمام على البارزين من القادة، وإن كان الدور الحقيقي في المعركة هو ما يقوم به هؤلاء الناس العاديون. على أن أخبار ثورة كربلاء استهدفت لحملة من السلطة الحاكمة فأهمل المؤرخون الرسميون ذكر كثير من تفاصيلها الدقيقة، ذات المغزى.
ولقد عملت هذه الأخلاق الجديدة عملها في إكساب الحياة الإسلامية سمة كانت قد فقدتها قبل ثورة الحسين (ع) بوقت طويل، ذلك هو الدور الذي غدا الرجل العادي يقوم به في الحياة العامة بعد أن تأثر وجدانه بسلوك الثائرين في كربلاء وقد بدأ الحكام المجافون للإسلام يحسبون حساباً لهؤلاء الرجال العاديين، وبدأ المجتمع الإسلامي يشهد من حين لآخر ثورات عارمة يقوم بها الرجال العاديون على الحاكمين الظالمين وأعوانهم لبعدهم عن الإسلام وعدم استجابتهم لأوامر الله ونواهيه في سلوكهم، ثورات كانت روح كربلاء تلهب أكثر القائمين بها، وتدفعهم إلى الاستماتة في سبيل ما يرونه حقاً.
ولقد تحطمت دولة أمية بهذه الثورات، وقامت دولة العباسيين بوحي من الأفكار التي كانت تبشر بها هذه الثورات ولما تبين للناس أن العباسيين كمن سبقهم لم يسكنوا بل ثاروا… واستمرت الثورات التي تقودها روح كربلاء بدون انقطاع ضد كل ظلم وطغيان وفساد.
ـ 5 ـ
4 ـ انبعاث الروح النضالية:
كانت ثورة الحسين السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ولقد كانت الآفات النفسية والاجتماعية تحول بين الإنسان المسلم وبين أن يناضل عن ذاته وعن إنسانيته فجاءت ثورة الحسين وحطمت كل حاجز نفسي واجتماعي يقف في وجه الثورة.
كان الإطار الديني الذي أحاط به الأُمويون حكمهم العفن الفاسد يحول بين الشعب وبين أن يثور فجاءت ثورة الحسين وحطمت هذا الإطار، وكشفت الحكم الأُموي على حقيقته، فإذا هو حكم جاهلي لا ديني، لا إنساني تجب الثورة عليه وتحطيمه.
كانت المسلَّمات الأخلاقية تحول بين الإنسان المسلم وبين أن يثور. كانت قوانينه الأخلاقية تقول له: حافظ على ذاتك حافظ على عطائك. حافظ على منزلتك الاجتماعية. فجاءت ثورة الحسين، وقدمت للإنسان المسلم أخلاقاً جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، ضحِّ بكل شيء في سبيل مبدئك.
كان الرضا عن النفس يحول بينه وبين أن يثور، ويغريه بالقعود عن النضال، فجاءت ثورة الحسين وخلفت في أعقابها لجماهير كثيرة شعوراً بالإثم، وتأنيباً للنفس، وبرماً بها، ورغبة عارمة في التكفير.
كانت كل هذه الأسباب تحول بين الناس وبين الثورة فجاءت ثورة الحسين ونسفت هذه الأسباب كلها، وأعدت الناس إعداداً كاملاً للثورة.
وللروح النضالية شأن كبير وخطير في حياة الشعوب وحكَّامها.
فحين تكون الروح النضالية هامدة، وحين يكون الشعب مستسلماً لحكامه يشعر حكَّامه بالأمان، فيفعلون كل شيء، ويرتكبون ما يشاؤون دون أن يحسبوا حساب أحد، هذا من جهة الحاكمين وأما المحكومون فنلاحظ أنه كلما امتد الزمن بهمود الروح النضالية سهل التسلط على الشعب، واستشرت فيه روح التواكل والخنوع واستمرأ الرضا بحياته القائمة، ولم يعد بحيث يرجى منه القيام بمحاولة جديدة لتطوير واقعه، وإثبات وجوده أمام حاكميه وهذا يجعل إصلاحه وتطويره أمراً بالغ الصعوبة.
ولقد كان الإمام علي (ع) حريصاً على أن تبقى روح النضال حية نامية في الشعب، لتبقى للشعب القدرة على الثورة حين تدعو الأحوال للثورة. وتشهد لذلك هذه الكلمة التي قالها وهو على فراش الموت، من جملة وصيته:
«لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه»([764]).
معرضاً بمعاوية بن أبي سفيان.
وعلة هذا واضحة، فقد حارب هو الخوارج لأنهم تمردوا على حكم يتجاوب مع مصالح الشعب العليا انسياقاً مع أفكار خاطئة وسخيفة. ولكن هذا لم يغير موقفهم من الحكم الأُموي الذي كانوا لا يزالون يرونه حكماً بغير حق. فكان يريد ألا يتكتل المجتمع ضدهم بعده، إذ سيمكنهم سكوت المجتمع عنهم من وخز للحكم الأُموي دائماً وبذلك لا يخلو الجو تماماً لحكم الأُمويين ولكن وصيته لم تنفذ؟ فتكتل المجتمع ضدهم، وحاربهم ومع ذلك ظلوا شوكة في جنب الحكم الأُموي دائماً، ولكنهم لم يؤثروا فيه لأسباب تقدم ذكرها.
ولكي نخرج بفكرة واضحة عن مدى تأثير ثورة الحسين في بعث روح الثورة في المجتمع الإسلامي يحسن بنا أن نلاحظ أن هذا المجتمع أخلد إلى السكون عشرين عاماً كاملة قبل ثورة الحسين لم يقم خلالها بأي ثورة على توفر الدواعي إلى الثورة خلال هذه الأعوام الطوال.
فمنذ قُتل أمير المؤمنين علي (ع)، وغدا أمر الحكم للأُمويين خالصاً، إلى حين ثورة الحسين لم يقم في هذا المجتمع أي احتجاج جدي جماعي على ألوان الاضطهاد والتقتيل وسرقة أموال الأُمة التي كان يقوم بها الأُمويون وأعوانهم. بل كان موقف السادة من هذه الأفاعيل هو إيجاد المبررات الدينية والسياسية، وكان موقف الجماهير هو موقف الخضوع والتسليم، عشرون عاماً مرت على هذا المجتمع ـ من سنة أربعين إلى سنة ستين للهجرة ـ وهذه هي حالته، وتغيرت هذه الحالة بعد سنة ستين، بعد ثورة الحسين. فقد بدأ الشعب يثور، وبدأت الجماهير ترقب زعيماً يقودها وهي مستعدة للثورة، وللتمرد على الأُمويين في كل حين، ولكنها تحتاج إلى قائد، وكلما وجد القاد وجدت الثورة على حكم الأُمويين.
التمرد الوحيد الذي كان يصادفه الأُمويون طيلة هذه العشرين عاماً، وعلى فترات متعاقبة، هو تمرد الخوارج. ولكنه ـ كما قدمنا ـ لم يكن متجاوباً مع المجتمع الإسلامي فلم يكن ناجحاً، وكانت السلطة تقمعه بجيوش تؤلفها من سكان البلاد التي ينجم التمرد فيها. ولكن ما حدث بعد ثورة الحسين كان شيئاً آخر، كان تمرداً يحظى بعطف المجتمع الإسلامي كله، من شارك فيه ومن لم يشارك، وكانت أسبابه بعيدة عن تلك التي تدفع الخوارج إلى الثورة، كانت أسباباً تنبع من واقع المجتمع: من الظلم، والاضطهاد والتجويع. ولم يتمكن الحكام الأُمويون من قمع هذه الثورات بجيوش من سكان المناطق الثائرة، فقد كانوا يعرفون أن ثمة تجاوباً نفسياً بين الثائرين وبين القاعدين، فاضطروا إلى قمع هذه الثورات بجيوش أجنبية عن مناطق الثائرين، اضطروا إلى جلب جيوش سورية، وإقرار حاميات دائمة في مراكز الحكم.
هذه صورة مجملة لوضع المجتمع الإسلامي بعد ثورة الحسين فلنأخذ بشيء من التفصيل.
ـ 2 ـ
أ ـ ثورة التوابين:
كان أول رد فعل مباشر لقتل الحسين هو حركة التوابين في الكوفة.
فلما قتل الحسين، ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة تلاقت الشيعة بالتلاؤم والتندم، ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيراً بدعاء الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته، ومقتله إلى جانبهم ولم ينصروه. ورأوا أنه لا يغسل عارهم، والإثم عنهم في مقتله إلاَّ بقتل من قتله أو القتل فيه. ففزعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة:
سليمان بن صرد الخزاعي.
والمسيب بن نجبة الفزاري.
وعبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي.
وعبدالله بن وائل التميمي.
ورفاعة بن شداد البجلي. فاجتمعوا، وبدأ المسيب بن نجبة الكلام فقال:
«.. وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا، وتقريظ شيعتنا حتى بلا الله خيارنا فوجدنا كاذبين في موطنين من مواطن ابن بنت نبينا (ص). وقد بلغتنا كتبه، وقدمت علينا رسله، وأعذر إلينا يسألنا نصره عوداً وبدءاً، وعلانية وسراً. فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا، لا نحن نصرناه بأيدينا، ولا جادلنا عنه بألسنتنا، ولا قويناه بأموالنا، ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا، فما عذرنا عند ربنا، وعند لقاء نبينا..؟ لا والله لا عذر دون أن تقتلوا قاتليه والموالين عليه، أو تقتلوا في طلب ذلك، فعسى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك..».
وتكلم سليمان بن صرد الخزاعي ـ وقد جعلوه زعيماً لهم ـ فقال:
«إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا، ونمنيهم النصر، ونحثهم على القدوم. فلما قدموا ونينا، وعجزنا وأذهلنا، حتى قتل فينا ولد نبينا، وسلالته، وبضعة من لحمه ودمه… ألا انهضوا، فقد سخط ربكم، ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله، وما أظنه راضياً حتى تناجزوا من قتله أو تبيروا. ألا لا تهابوا الموت، فوالله ما هابه امرؤ قط إلاَّ ذل كونوا كالأُول من بني إسرائيل، إذ قال لهم نبيهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم، فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم..».
وكتب سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان ومن معه من الشيعة بالمدائن بأمرهم فأجابوه إلى دعوته. وكتب إلى المثنى بن محربة العبدي في البصرة والشيعة هناك فأجابوه إلى ذلك.
وكان أول ما ابتدأوا به أمرهم بعد قتل الحسين (ع) سنة إحدى وستين، فما زالوا بجمع آلة الحرب ودعاء الناس في السر إلى الطلب بدم الحسين، فكان يجيبهم القوم بعد القوم والنفر بعد النفر من الشيعة وغيرها. فلم يزالوا كذلك حتى مات يزيد، فخرجت طائفة منهم دعاة، يدعون الناس، فاستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك يزيد أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك. وخرجوا يشترون السلاح ظاهرين، ويجاهرون بجهازهم وما يصلحهم.
حتى إذا كانت ليلة الجمعة، لخمس مضين من شهر ربيع الآخر، سنة خمس وستين خرجوا، وتوجهوا إلى قبر الحسين فلما وصلوا إليه صاحوا صيحة واحدة، فما رأي يوم أكثر باكياً منه، وقالوا:
«يا رب. إنا قد خذلنا ابن بنت نبينا، فاغفر لنا ما مضى، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحم حسيناً وأصحابه الشهداء الصدِّيقين. وإنا نشهدك يا رب إنا على مثل ما قتلوا عليه، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين».
وغادروا القبر مستقتلين، فقاتلوا جيوش الأُمويين حتى أبيدوا جميعاً([765]).
ولقد اعتبر التوابون أن المسؤول الأول والأهم عن قتل الحسين (ع) هو النظام وليس الأشخاص، وكانوا مصيبين في هذا الاعتقاد، ولذا نراهم توجهوا إلى الشام ولم يلقوا بالاً إلى من في الكوفة من قتلة الحسين (ع).
ونلاحظ هنا أن هذه الثورة قد انبعثت عن شعور بالإثم والندم، وعن رغبة في التفكير. فمن يقرأ أقوالهم، وكتبهم وخطبهم يلمس فيها الشعور العميق بالإثم والندم، والرغبة الحارة في التكفير وكونها صادر عن هذه البواعث جعلها ثورة انتحارية فالثائرون هنا يريدون الانتقام والتكفير. ولا يستهدفون شيئاً آخر وراء ذلك، فلا يريدون نصراً، ولا ملكاً، ولا مغانم، وإنما يريدون انتقاماً فقط، وقد خرجوا من ديارهم وهم على مثل اليقين بأنهم لا يرجعون إليها ـ كانوا يريدون أن يموتوا، ولقد بذل لهم الأمان فلم يقبلوا([766]). وإذن، فلم تكن لهذه الثورة أهداف اجتماعية واضحة ومحددة. لقد كان الهدف الواضح منها هو الانتقام والتكفير.
وإن الفقرة التي في صدر خطاب سليمان بن صرد لتصور لنا بدقة متناهية حالة المجتمع قبل ثورة الحسين وموقفه من الحركات الإصلاحية كما عكسه موقف هذا المجتمع من ثورة الحسين نفسها. وإن الكلمات في هذه الفقرة لتكاد تختلج حياة، بما تحمل من معاني الونى والعجز، والإدهان، والتربص، والخذلان ـ كما أن بقية الخطاب، وسائر ما قيل في الحث على هذه الثورة يصور كيف كانت ثورة الحسين بركاناً عصف بكل هذا الركام من معاني العجز والانهيار والتلون. وأحل محله الرغبة العارمة في الثورة والاستشهاد. وقد رأيت فيما مر عليك من نص الطبري أن الاستجابة للثورة لم تقتصر على الشيعة وحدهم بل شاركهم فيها غيرهم ممن يأملون تغيير الأوضاع عن طريق إزالة النير الأُموي بالثورة.
وكون هذه الثورة انتقامية انتحارية لا هدف للقائمين بها إلاَّ الانتقام والموت في سبيله يفسِّر لنا قلة عدد المستجيبين لها إلى النهاية. فقد أحصى ديوان سليمان بن صرد ستة عشر ألف رجل لم يخرج معه منهم سوى أربعة آلاف([767]). ولم يستجب للدعوة من المدائن إلاَّ مائة وسبعون رجلاً، ومن البصرة إلاَّ ثلاثمائة رجل([768]). فالعمل الانتحاري لا يستهوي إلاَّ أفراداً على مستوى عال من التضحية والتشبع بالمبدأ، وهؤلاء قلة في كل زمان.
هذا، ولكن الإنصاف للواقع يقتضنا أن نسجِّل أن هذه الثورة وإن كانت ثورة انتحارية، ولم تكن لها أهداف اجتماعية واضحة، إلاَّ أنها أثرت في مجتمع الكوفة تأثيراً عميقاً. فقد عبأت خطب قادات هذه الثورة وشعاراتهم الجماهير في الكوفة للثورة على الحكم الأُموي، ولذلك فلم يكد يبلغهم خبر هلاك يزيد حتى ثاروا على العامل الأُموي عمرو بن حريث فأخرجوه من قصر الإمارة واصطلحوا على عامر بن مسعود الذي بايع لابن الزبير([769]) فكان ذلك مطلع العهد الذي زال فيه سلطان الأُمويين عن العراق إلى حين.
ـ 3 ـ
ب ـ ثورة المدينة:
وكانت ثورة المدينة رد فعل آخر لمقتل الحسين.
إلاَّ أننا هنا نشاهد لوناً آخر من الثورات، ثورة تختلف عن ثورة التوابين في الدوافع والأهداف، لقد كانت الدوافع إلى هذه الثورة شيئاً غير الانتقام، كانت ثورة تستهدف تقويض سلطان الأُمويين الظالم الجائر البعيد عن الدين.
وما نشك في أن شعلة هذه الثورة كانت متأججة، ولكنها كانت تبحث عن مبرِّر للانفجار. والذي أجج شعلة الثورة أسباب منها مقتل الحسين، ولعله كان أهمها، فإن زينب بنت علي (عليه السلام)، دأبت بعد وصولها إلى المدينة على العمل للثورة، وعلى تعبئة النفوس لها وتأليب الناس على حكم يزيد، حتى لقد خاف عمرو بن سعيد الأشدق والي يزيد على المدينة انتقاض الأمر، فكتب إلى يزيد عن نشاطها كتاباً قال فيه:
إن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر، وأنها فصيحة، عاقلة، لبيبة، وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين. فأتاه كتاب يزيد بأن يفرق بينها وبين الناس([770]).
وقد كان السبب المباشر لاشتعال الثورة هو وفد أهل المدينة إلى يزيد، فقد أوفد عثمان بن محمَّد بن أبي سفيان والي المدينة إلى يزيد وفداً من أهلها، فيهم عبدالله بن حنظلة الأنصاري غسيل الملائكة، وعبدالله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، والمنذر بين الزبير، ورجالاً من أشراف أهل المدينة، فقدموا على يزيد، فأكرمهم، وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم فلما رجعوا قدموا المدينة كلهم، إلاَّ المنذر بن الزبير، فإنه قدم العراق، فلما قدم أُولئك النفر الوفد المدينة قاموا في أهل المدينة، وأظهروا شتم يزيد وعيبه، وقالوا، قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب الخمر، ويضرب بالطنابير، ويعزف عنده القيام، ويلعب بالكلاب، ويستمر عنده الخراب ـ وهم اللصوص ـ وأنا نشهدكم أنا قد خلعناه وقام عبدالله بن حنظلة الغسيل، فقال:
«جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلاَّ بنيَّ هؤلاء لجاهدته بهم، وقد أعطاني وأكرمني، وما قبلت عطاءه إلاَّ لأتقوى به».
فخلعه الناس، وبايعوا عبدالله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد، وولوه عليهم.
وأما المنذر بن الزبير، فقدم المدينة فكان ممن يحرض الناس على يزيد، وقال:
«أنه قد أجازني بمائة ألف. ولا يمنعني ما صنع بي أن أخبركم خبره، وأصدقكم عنه: والله إنه ليشرب الخمر، والله إنه ليسكر حتى يدع الصلاة».
وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأشد.
وثارت المدينة على الحكم الأُموي وطرد الثائرون عامل يزيد والأُمويين، وقدرهم ألف رجل، ولم ينفع الوعد ولا الوعيد في ردهم عن ثورتهم. فقمعت الثورة بجيش من الشام بوحشية متناهية، ودعا القائد الأُموي مسلم بن عقبة المري، الناس للبيعة على أنهم خول ليزيد بن معاوية، يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم ما شاء([771]).
وهلك يزيد، وقد باشر جيشه بقمع ثورة ابن الزبير في مكة، بعد أن فرغ من قمع ثورة المدينة، وكان ابن الزبير قد أعلن الخلاف بعد ما بلغه مقتل الحسين، ولا يمكن أن نعتبر عبيدالله ابن الزبير امتداداً لثورة الحسين، فقد كان ابن الزبير يعد العدة للثورة قبل مقتل الحسين، وكانت أطماعه الشخصية في الحكم هي بواعثه على الثورة. وكان يرى في الحسين منافساً خطيراً كما عرفت، فلما بلغ خبر مقتل الحسين أهل مكة وثب إليه أصحابه وقالوا: «أظهر بيعتك. فإنه لم يبق أحد أذ هلك الحسين ينازعك الأمر» ولكنه قال لهم لا تعجلوا([772]). حتى إذا كانت سنة خمس وستين. بويع له في الحجاز والعراق والشام والجزيرة([773]).
وما نشك في أن استجابة الناس للثورة التي دعا إليها ابن الزبير كان مبعثها هذه الروح الجديدة التي بثتها ثورة الحسين الدامية في نفوس الجماهير، وقد مر عليك آنفاً كيف أثر التوابون في الكوفة على الحكم الأُموي، بحيث أعدوا الناس لتقبل حكم ابن الزبير، وطرد عامل بني أُمية على العراق.
ـ 4 ـ
ج ـ ثورة المختار الثقفي:
ودخلت سنة ست وستين للهجرة، فثار المختار بن أبي عبيدة الثقفي بالعراق طالباً ثأر الحسين.
ولكي نعرف السر في استجابة جماهير العراق لابن الزبير أول الأمر ثم انقلابها عليه، واستجابتها لدعوة المختار لا بد أن نلاحظ أن مجتمع العراق كان يطلب إصلاحاً اجتماعياً، وكان يطلب الثأر من الأُمويين وأعوانهم، وعلى أمل الإصلاح الاجتماعي والانتقام، استجاب مجتمع العراق لابن الزبير، فهو عدو الأُمويين، من جهة، وهو يتظاهر بالإصلاح والزهد والرغبة عن الدنيا من جهة أخرى، فلعل سلطانه أن يحقق كلا الأمرين.
ولكن سلطان ابن الزبير لم يكن خيراً من سلطان الأُمويين، لقد أخرج العراق عن سلطانهم، ولكن قاتلي الحسين كانوا مقربين إلى السلطة كما كانوا في عهد الأُمويين. أن شمر بن ذي الجوشن، وشبث بن ربعي وعمر بن سعد، وعمرو بن الحجاج، وغيرهم، كانوا سادة المجتمع في ظل سلطان ابن الزبير، كما كانوا سادته في ظل سلطان يزيد.
كما أنه لم يحقق لهم العدل الاجتماعي الذي يطلبونه. لقد كانوا يحنون إلى سيرة علي بن أبي طالب فيهم، هذه السيرة التي حققت لهم أقصى ما يمكن من رفاه وعدل، هذا عبدالله بن مطيع العدوي عامل ابن الزبير على الكوفة يقول للناس أنه أمر أن يسير بسيرة عمر وعثمان فيقول له المتكلم بلسان أهل الكوفة:
«.. أما حمل فيئنا برضانا، فإنا نشهد أنا لا نرضى أن يحمل عنا فضله، وألا يقسم إلاَّ فينا، وأن لا يسار فينا إلاَّ بسيرة علي بن أبي طالب، التي سار بها في بلادنا هذه، ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسنا، ولا في سيرة عمر بن الخطاب فينا، وإن كانت أهون السير السيرتين علينا»([774]).
كان هذا أو ذاك سبباً في انخذال الناس عن ابن الزبير، وتأييدهم لثورة المختار عليه، ولقد ربط المختار دعوته بمحمَّد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، وهذا ما جعلهم يطمئنون إلى عدل السيرة والإصلاح. ولقد جعل شعاره «يا لثارات الحسين» وهذا يحقق لهم الهدف الثاني.
ولقد حارب عبدالله بن مطيع، عامل ابن الزبير في الكوفة، الثائرين مع المختار بالرجال الذين تولوا قتل الحسين لقد حاربهم بشمر بن ذي الجوشن، وعمرو بن الحجاج، وشبث بن ربعي، وأمثالهم وكان هذا كافياً في حفز الثائرين على المضي في ثورتهم والتصميم على النصر.
وقد أنصف المختار عندما تولى الحكم طبقة في المجتمع الإسلامي كانت مضطهدة في عهد الأُمويين، واستمر اضطهادها في عهد ابن الزبير، وهي طبقة الموالي «المسلمين غير العرب» فقد كانت عليهم واجبات المسلمين ولم تكن لهم حقوقهم، فلما استتب الأمر للمختار أنصفهم فجعل لهم من الحقوق مثل ما لغيرهم من عامة المسلمين.
وقد أثار هذا العمل الأشراف وسادة القبائل فتكتلوا ضد المختار، وتآمروا عليه، وأجمعوا على حربه. وكان على رأس هؤلاء المتمردين قتلة الحسين. ولكنهم فشلوا في حركتهم([775]).
وكانت حركة التمرد هذه سبباً في حفز المختار على التعجيل بتتبع قتلة الحسين وآله في كربلاء، وقتلهم. فقتل منهم في يوم واحد مائتين وثمانين رجلاً([776]) ثم تتبعهم، فقتل كثيراً منهم، ولم يفلت من زعمائهم أحد. فقتل شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، وعمرو بن الحجاج. وشبث بن ربعي، وغيرهم([777]).
ـ 5 ـ
د ـ ثورة مطرف بن المغيرة:
وفي سنة 77 للهجرة ثار مطرف بن المغيرة بن شعبة على الحجاج بن يوسف، وخلع عبدالملك بن مروان.
كان هذا الرجل والياً للحجاج على المدائن. وكان حي الضمير، فلم يعم عينيه السلطان الذي حباه به الأُمويون عن إدراك الظلم الفادح الذي ينزلونه بالأُمة المسلمة. وقد اتصل به دعاة الخوارج فأرادوه على أن ينظم إليهم، ويسلم بأمرة المؤمنين لزعيمهم شبيب، وأرادهم على أن ينظموا إليه ليعيدوا الأمر شورى في المسلمين، فأبى وأبوا. واستشار نصحاءه في الثورة فلم ينصحه بها أحد منهم، ولكنه ثار بمن أجابه، وكلم رؤوس أصحابه، فقال:
«أما بعد. فإن الله كتب الجهاد على خلقه، وأمر بالعدل والإحسان، وقال فيما أنزل علينا ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ وإني أشهد الله أني خلعت عبدالملك بن مروان والحجاج بن يوسف، فمن أحب منكم صحبتي، وكان على مثل رأيي فليتابعني فإن له الأسوة وحسن الصحبة، ومن أبى فليذهب حيث شاء، فإني لست أحب أن يتبعني من ليست له نية في جهاد أهل الجور. أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، وإلى قتال الظلمة، فإذا جمع الله لنا أمرنا كان هذا الأمر شورى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبوا».
وكتب إلى سويد بن سرحان الثقفي وبكير بن هارون البجلي:
«أما بعد. فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، وإلى جهاد من عَنَدَ عن الحق، واستأثر بالفيء، وترك حكم الكتاب فإذا ظهر الحق، ومنع الباطل، وكانت كلمة الله هي العليا، جعلنا هذا الأمر شورى بين الأُمة، يرتضي المسلمون لأنفسهم الرضا فمن قبل هذا منّا كان أخانا في ديننا وولينا في محيانا ومماتنا، ومن رد ذلك علينا جاهدناه، واستنصرنا الله عليه»([778]).
هذا هو منهج ثورة مطرف، وفيه عبير من روح كربلاء.
ـ 6 ـ
5 ـ ثورة ابن الأَشعث:
وفي سنة 81 للهجرة ثار عبدالرحمن بن محمَّد بن الأشعث على الحجاج، وخلع عبدالملك بن مروان.
وسبب هذه الثورة التي هزَّت الحكم الأُموي على حد تعبير ولهاوزن([779]) هو الفتوح الاستعمارية التي أدرك الشعب أنها ليست في مصلحته.
فقد أرسل الحجاج عبدالرحمن إلى سجستان على رأس جيش عراقي في الوقت الذي كان جيش الشام الذي قضى على حركة الخوارج لا يزال مرابطاً في العراق([780]) وقد أبدى عبدالرحمن مهارة عسكرية فائقة، ففتح قسماً من البلاد([781])، وكتب إلى الحجاج يعرفه ذلك، وأن رأيه أن يتركوا التوغل في بلاد رتبيل حتى يعرفوا طريقها ويجبوا خراجها. فكتب إليه الحجاج يوبخه على ذلك، ويتهمه بالعجز، ويأمره بالتوغل. وكتب إليه بذلك ثانياً وثالثاً.
وعرض عبدالرحمن على جنوده أمر الحجَّاج بعد أن بين لهم رأيه الذي استقر عليه بعد أن استشار قواده وأمراء جنده، ثم قال:
«وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم، وآبي إذا أبيتم».
فثار إليه الناس وقالوا:
«بل نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع».
وقام أبو الطفيل، عامر بن واثلة الكناني، وله صحبة، فقال:
«أما بعد، فإن الحجَّاج يرى بكم ما رأى القائل الأول: أحمل عبدك على الفرس. فإن هلك هلك، وإن نجا فلك، إن الحجَّاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاداً كثيرة، ويغشي اللهوب واللصوب، فإن غنمتم وظفرتم أكل البلاد وحاز المال، وكان ذلك زيادة في سلطانه، وإن ظفر عدوكم بكم كنتم أنتم الأعداء البغضاء الذين لا يبالي عنتهم، اخلعوا عدو الله الحجَّاج وبايعوا الأمير عبدالرحمن، فإني أشهدكم أني أول خالع فنادى الناس من كل جانب: فعلنا، فعلنا، قد خلعنا عدو الله».
وقال عبدالمؤمن بن شبث بن ربعي:
«عباد الله، إنكم إن أطعتم الحجَّاج جعل هذه البلاد بلادكم، وجمركم تجمير فرعون الجنود، ولن تعاينوا الأحبة أو يموت أكثركم فيما أرى، فبايعوا أميركم، وانصرفوا إلى عدوكم الحجَّاج فانفوه عن بلادكم».
فوثب الناس إلى عبدالرحمن فبايعوه على خلع الحجَّاج ونفيه من أرض العراق. وقفلوا راجعين، حتى إذا بلغوا فارس خلعوا عبدالملك على كتاب الله وسنة نبيه، وعلى جهاد أهل الضلالة وخلعهم، وجهاد المحلين.
فلما بلغ البصرة بايعه جميع أهلها، وقرائها وكهولها مستبصرين في قتال الحجَّاج ومن معه من أهل الشام، وخلع عبدالملك. وسبب إسراع أهل البصرة إلى مساندة الثورة هو الظلم والجوع، فقد كتب عمال الحجَّاج إليه أن الخراج قد انكسر، وأن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار. فكتب إلى البصرة وغيرها من كان له أصل في قرية فليخرج إليها، فخرج الناس فعسكروا، فجعلوا يبكون وينادون: يا محمَّداه يا محمَّداه، وجعلوا لا يدرون أين يذهبون. فجعل قراء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنعين فيبكون لما يسمعون منهم ويرون. فقدم ابن الأشعث على مجتمع معبأ ينتظر قائداً فاستجاب المجتمع هذه الاستجابة السريعة، واستبصر قراء البصرة في قتال الحجَّاج مع عبدالرحمن بن الأشعث.
وقد استمرت هذه الثورة من سنة 81هـ إلى سنة 83، وأحرزت انتصارات عسكرية، ثم قضى عليها الحجَّاج بجيوش سورية([782]).
هذه هي ثورة عبدالرحمن بن الأشعث وهي ثورة قام بها العرب، ولم يقم بها الموالي. قام بها العرب العراقيون الذين ساءت حالتهم الاقتصادية إلى حد مروع، والذين استخدموا في الفتوح الاستعمارية دون أن يحصلوا على غنائمها، والذين كان عليهم أن يحاربوا مقابل جرايات ضئيلة لا تكفي بينما يفوز بالمغانم والإعطيات الكثيرة الجنود السوريون الذين تركهم الحجَّاج في العراق ليستعين بهم على قمع الثورات التي يقوم بها العراقيون([783]).
ـ 7 ـ
و ـ ثورة زيد بن علي بن الحسين:
وفي سنة 121هـ تهيأ زيد بن علي بن الحسين للثورة في الكوفة وثار في سنة 122هـ، وخنقت الثورة في مهدها بسبب الجيش الأُموي الذي كان مرابطاً في العراق.
وكانت شعارات الثائرين مع زيد «يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، وإلى الدين والدنيا»([784]).
ويبدو أن الدعوة إلى الثورة لقيت استجابة واسعة من الجماهير المسلمة في أقطار كثيرة من بلاد الإسلام فقد بويع زيد على الثورة في الكوفة، والبصرة وواسط، والموصل، وخراسان، والري، وجرجان. ولقد كان حرياً بثورته أن تنجح لولا اختلال التوقيت، فقد حدث ما دفع زيداً إلى إعلان الثورة قبل الموعد الذي بينه وبين أهل الأمصار([785]).
وقد تكون بفضل هذه الثورة جهاز ثوري دائم. على استعداد للمساهمة في كل عمل ثوري ضد السلطة. وهو طائفة الزيدية الذين يرون أن الإمام المفترض الطاعة هو كل قائم بالسيف ذوداً عن الدين ضد الظالمين.
قال ولهاوزن:
«ولئن كان عصيان زيد قد انتهى انتهاءً مفجعاً فإنه مهم. ذلك أن ثورات الشعب التي حدثت بعده والتي أدَّت إلى انهيار دولة دمشق انهياراً نهائياً كانت ذات علاقة بها، وسرعان ما ظهر أبو مسلم بعد وفاة يحيى آخذاً بثأره قاتلاً قتلته([786]).
وهذا يبرز بوضوح عظيم تأثير ثورة الحسين (ع) في تغذية الروح الثورية ومدَّها بالعطاء. فما ثورة زيد إلاَّ قبس من ثورة جده في كربلاء.
ـ 8 ـ
هذه نماذج للروح الثورية التي بثتها ثورة الحسين في الشعب المسلم، فقضت بذلك على روح التواكل والخنوع والتسليم للحاكمين، وجعلت من الشعب المسلم قوة معبأة، وعلى أهبة الانفجار دائماً.
ولقد استمرت طيلة الحكم الأُموي ضد هذا الحكم حتى قضت عليه بثورة العباسيين، هذه الثورة التي لم تكن لتنجح لو لم تعتمد على إيحاءات ثورة كربلاء، وعلى منزلة الثائرين في كربلاء في نفوس المسلمين.
ولم تبدل هذه الثورة كثيراً من واقع الشعب المسلم، بل لعلنا لا نعدوا الحق إذا قلنا أنها لم تبدل شيئاً سوى وجوه الحاكمين. ولكن هذا لم يخمد الرغبة في الثورة بقدر ما كان حافزاً عليها فاستمرت الثورات على حالتها. ومضى العباسيون وجاءت دول بعدهم، ولم تخمد الثورات، بل بقيت ناشبة أبداً، يقوم بها الإنسان المسلم دائماً، فيعبر بها عن إنسانيته التي خنقها الحاكمون وزيفوها.
ولقد كانت هذه الثورات، كما رأينا، صادرة عن وعي للواقع، وإحساس بانحطاطه وقسوته، واحتجاج عليه، ومحاولة لتطويره.
حدث هذا في ظل الحكم الأُموي وقد رأيت بعض نماذجه، وحدث في ظل الحكم العباسي أيضاً.
ونضرب مثلاً بثورة أبي السرايا مع محمَّد بن إيراهيم بن طباطبا العلوي الحسني على المأمون.
كان محمَّد بن إبراهيم هذا يمشي في بعض طرق الكوفة، إذ نظر إلى عجوز تتبع أحمال الرطب (التمر)، فتلقط ما يسقط منها فتجمعه في كساء عليها رث، فسألها عما تصنع بذلك، فقالت: إني امرأة لا رجل لي يقوم بمؤنتي، ولي بنات لا يعدن على أنفسهن بشيء، فأنا أتتبع هذا من الطريق وأتقوته أنا وولدي.
فبكى بكاء شديداً وقال:
أنت وأشباهك تخرجوني غداً حتى يسفك دمي، ونفذت بصيرته في الخروج([787]).
فلما أعلن أمره خطب الناس، ودعاهم إلى البيعة، وإلى الرضا من آل محمَّد، والدعاء إلى كتاب الله، وسنة نبيه (ص) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسيرة بحكم الكتاب، فبايعه جميع الناس حتى تكابسوا وازدحموا عليه([788]).
ومات محمَّد بن إبراهيم بعد نشوب الثورة بقليل، فلم تخمد وإنما قام عليها من بعده علي بن عبيدالله العلوي([789]).
وشملت الثورة العراق والشام والجزيرة واليمن([790]).
ونقرأ عن هذه الثورة فنعجب بأخلاق الثائرين الجياع، وبضبطهم لأنفسهم. لقد أمسك هؤلاء الثائرون عن النهب والسلب بعد أن هزموا عدوهم واستولوا على حصنه بمجرد أن أمرهم قائدهم بأن يمسكوا([791]).
وأقبل أهل بغداد ـ جنود السلطة ـ يصيحون:
يا أهل الكوفة: زينوا نساءكم وأخواتكم، وبناتكم للفجور، والله لنفعلن بهم كذا وكذا، ولا يكنون، والثائرون يذكرون الله ويقرأون القرآن، وقائدهم يقول لهم: اذكروا الله وتوبوا إليه، واستغفروه واستعينوه، صحِّحوا نياتكم، وأخلصوا لله ضمائركم واستنصروه على عدوكم، وابرأوا إليه من حولكم وقوتكم([792]).
ـ 9 ـ
وقد يقول قائل إن الروح النضالية التي بعثتها ثورة الحسين في الشعب المسلم لم تطور واقع هذا الشعب بواسطة الثورات التي أشعلتها، لقد كانت الثورات تنشب دائماً، ولكنها كانت تخفق دائماً، ولا تسوق إلى الشعب إلاَّ مزيداً من الضحايا، ومزيداً من الفقر والإرهاب.
ونقول: نعم، إنها لم تطور واقع هذا الشعب تطويراً آنياً، ولم تقدم في الغالب أية نتائج ملموسة، ولكنها حفظت للشعب إيمانه بنفسه وبشخصيته، وبحقه في الحياة والسيادة وهذا نصر عظيم.
إن أخطر ما يبتلى به شعب هو أن يقضى على روح النضال فيه، إنه حينئذٍ يفقد شخصيته، ويذوب في خضم الفاتحين كما قدر لشعوب كثيرة أن تضمحل وتذوب وتفقد كيانها لأنها فقدت روح النضال ولأنها استسلمت وفقدت شخصيتها، ومقومات وجودها المعنوي، فأذابها الفاتحون. إن هذه الشعوب التي لم يحفظ لنا التاريخ إلاَّ أسمائها لم تأت من ضعفها العسكري، أو الاقتصادي وإنما أُتِيَت من فلسفة الهزيمة والتواكل والخنوع التي وجدت سبيلها إلى النفوس بعد أن خبت روح النضال في هذه النفوس.
ولو أنها بقيت مؤمنة بشخصيتها وثقافتها ومقوماتها ولو احتفظت بروح النضال حية في أعماقها لما استطاع الغزاة إبادتها وإذابتها، ولشقت لنفسها طريقاً جديداً في التاريخ.
وهذا ما حقَّقته ثورة الحسين.
لقد أججت ثورة الحسين تلك الروح التي حاول الأُمويون إخمادها، وبقيت مستمرة تعبر عن نفسها دائماً في انفجارات ثورية عاصفة ضد الحاكمين، مرة هنا ومرة هناك، وكانت الثورات تفشل دائماً ولكنها لم تخمد أبداً لأن الروح النضالية كانت باقية، تدفع الشعب المسلم إلى الثورة دائماً، إلى التمرد، وإلى التعبير عن نفسه قائلاً للطغاة: إني هنا.
حتى جاء العصر الحديث وتعددت وسائل إخضاع الشعوب وحكم الشعب المسلم بطغمة لا تستوحي مصالحه، وإنما تخدم مصالح آخرين. ومع ذلك لم يهدأ الشعب ولم يستكن، ولم تفلح في إخضاعه وسائل القمع الحديثة، وإنما بقي ثائراً، معبراً عن إنسانيته دائماً بالثورة، بالدم المسفوح. وهكذا أثبتت الأُمة الإسلامية وجودها، ولم يجرفها التاريخ، وإنما بقيت لتصنع التاريخ.
هذا صنيع ثورة الحسين. لقد كانت هذه الثورة رأس الحربة في التطور، إن الأفكار والمشاعر، والروح التي خلقتها هذه الثورة، والتي نمتها وأثرتها الثورات التي جاءت بعدها، والتي هي امتداد لها، هي التي صنعت تاريخ الكفاح الدامي من أجل التحرر لهذه البقعة من العالم.
ولا ندري تماماً ماذا كان سيحدث لو لم يقم الحسين بثورته هذه.
غير أننا نستطيع أن نحدس ذلك الآن. لقد كان يحدث أن يستمر الحكم الأُموي، داعماً نفسه بالدجل الديني وبفلسفة التواكل والخنوع والتسليم. وكان يحدث أن تستحكم هذه الفلسفة وهذا الدجل الديني في الشعب، فيطأطىء دائماً لحاكميه ويستكين الحاكمون لموقف الشعب منه فيلهون. ويضعفون عن القيام بأعباء الحكم وصيانة الدولة، ويغرقون في اللهو والترف. وعاقبة ذلك هي الانحلال: انحلال الحاكمين والمحكومين، وكان يحدث أن يكتسح البلاد الفاتحون، فلا يجدون مقاومة ولا نضالاً، بل يجدون انحلالاً من الحاكمين والمحكومين، ثم يجرف التاريخ أولئك وهؤلاء.
ولكن ما حدث غير ذلك، لقد انحل الحاكمون حقاً، ولقد اكتسحت الدولة حقاً، ولكن المحكومين لم ينحلوا، بل ظلوا صامدين.
وكان ذلك بفضل الروح التي بثتها ثورة الثائرين في كربلاء.
خاتمة
ما نريده ونلح على أنه ضروري لنا في مرحلتنا الثورية الراهنة هو ألسنة التاريخ، هو جعله ذا صلة بحياة الإنسان ومطامحه، هو إعداده ليندمج مع الكائن الإنساني في تركيب عضوي متفاعل متكامل، وليس مجرد انعكاس خاو لحياة إنسانية سابقة.
لقد دأب مدونو التاريخ العرب على الاهتمام بالتاريخ الشخصي للملوك والقادة، فسجلوا ـ بإسهاب عظيم حروبهم وانتصاراتهم، ومجالس مجونهم ولهوهم، ولم يولوا الجانب الاجتماعي من الحياة الإسلامية ـ وهو ما يتصل بحياة الأُمة ـ اهتماماً وإن كان ضئيلاً.
ومن هنا أضحى التاريخ عندنا ـ بالنسبة إلى الجماهير ـ مجرد انعكاس لحيوات سابقة لا يسهم في تكوين الشخصية الإنسانية، إنه قد يسهم في إثارة الحماس الخلاق تارة، والغرور المدمر أخرى، ولكنه لا يسهم أبداً في تكوين شخصية إنسانية سوية متكاملة، ترتكز على أصول إنسانية عريقة، فلا تفقد محور الارتكاز حين تتعرَّض لامتحان قاس لا يجتازه إلاَّ الإنسان… الإنسان.
وإن حقبتنا الحياتية الراهنة لتحتم علينا أن نتناول التاريخ تناولاً إنسانياً، تناولاً يتيح له أن يكون عاملاً مطوراً فيما يتعلَّق بموقفنا من الحياة والكون.
إن أمتنا الإسلامية تجتاز في هذه الحقبة أدق وأخطر مرحلة من مراحل كفاحها الطويل عبر العصور.
لقد حقَّقت انتصارات باهرة يجب أن تحافظ عليها. وتعمل في الوقت نفسه لتحقيق انتصارات جديدة. وهنا تكمن الخطورة في هذه المرحلة. إنها الآن حين تقنع بالانتصارات التي حققتها وتقعد عن محاولة تحقيق غيرها تتعرض لخطر فقد هذه الانتصارات نفسها. ولذلك فيجب أن تحمي هذه الأُمة نفسها، من تطرق الوهن والاستسلام إليها. يجب ألا ترضى عن نفسها.
هذه واحدة.
وأُخرى وهي أنها إذا صممت على السير، ولم تهن، ولم تنكل، يخشى عليها أن تزيغ، وتنحرف في تطورها إذا لم يكن عندها.. في أعماقها محور ترتكز عليه وترجع إليه، محور نابع من شخصيتها التاريخية، وذاتيتها العقائدية.
وما يؤمنها من نفسها، وما يؤمنها من الزيغ والانحراف في تطورها هو أن تعي تاريخها بعد تطهيره. وتاريخها هي ـ تاريخ الأمم ـ ليس تاريخ حروب حكامها وانتصاراتهم، ومجالس لهوهم، وإنما هو تاريخ ثوراتها على هؤلاء الحكام. إن ثورات الأمم هي التي تمثل روحها، ونضالها، وإيمانها. أما الحكام الذين ثارت عليهم فليسوا منها، لو كانوا منها لما ثارت عليهم، لو كانوا منها لأحسوا بعذابها، ولما خلقوا بتصرفاتهم مبررات ثورتها.
إن تاريخ الثورات هو تاريخ الشعوب.
ولكي تبقى هذه الشعوب في يقظة دائماً لئلا تخدع عن انتصاراتها ولكي تبقى في وعي دائم لعملها التطويري الذي تمارسه يجب أن تكون في ثورة دائمة على أعدائها في الخارج والداخل لتحتفظ بانتصاراتها، وثورة دائمة على نفسها، تتناول نفسها بالنقد، وتفحص موقفها دائماً، لئلا تنحرف وتزيغ. ولكي تبقى في ثورة دائمة تصحح بها أوضاعها من الداخل والخارج يجب أن تلقن تاريخ نفسها، تاريخ ثوراتها.
ففي هذا التاريخ تجد الأساس التاريخي لشخصيتها العقائدية والنضالية، فتعصمها شخصيتها العقائدية من الزيغ والانحراف، وتعصمها شخصيتها النضالية من الوهن والنكول.
ولقد أهمل المؤرخون الأقدمون تاريخ الثورات أو زيفوه، لأنهم ـ بوحي من أنفسهم أو حكامهم ـ كانوا يعتبرون هذه الثورات حركات تمرد وعصيان ضد السلطة الشرعية.
أما الآن، فيجب أن يصحح الوضع. يجب أن يكتب التاريخ النضالي لأمتنا كتابة صحيحة. يجب أن يكشف عن العذاب، والاضطهاد، والجوع الذي كان يدفع بالناس إلاَّ الثورة، إلى الموت احتجاجاً على واقعهم. يجب أن يكشف عن الشخصية التاريخية لهذه الأُمة، ومحور ارتكازها العقائدي والنضالي عبر التاريخ. يجب أن يكشف عن مناقبية الثائرين التي كانت تعصمهم دائماً من أن ينقلبوا إلى لصوص، أو سفاحي دماء، لا هدف لهم، ولا يشعرون بمسؤوليتهم.
وتاريخ أمتنا النضالي تاريخ مضيء، فالثورات التي قامت بها أمتنا عبر العصور كانت دائماً تعبر تعبيراً تلقائياً حراً عن هذه الأُمة، وعن إنسانيتها، وعن رغبتها الحارة في أن تعيش متمتعة بكافة حقوقها الإنسانية.
وتأتي ثورة الحسين (ع) في كربلاء على رأس هذا التاريخ.
فهي رأس الحربة في التاريخ الثوري. هي الثورة الأولى التي عبأت الناس ودفعت بهم في الطريق الدامي الطويل، طريق النضال، بعد أن كادوا أن يفقدوا روحهم النضالية، بفعل سياسة الأُمويين.
وهي أغنى ثورة بالعزم والتصميم على المضي في النضال الدامي إلى نهايته أو النصر، فقد عرضت على الثائرين أمتع حياة، ولكنهم أبوا هذه الحياة التي سيسكتون معها عن الظلم والعسف وإرهاب الأُمة.
وهي ثورة امتحن أبطالها بأقسى ما امتحن به الثائرون على مدى التاريخ. فلم يهنوا، ولم ينكلوا بل ثبتوا ـ رغم كل شيء ـ ثائرين إلى اللحظة التي توجوا فيها عملهم العظيم بسقوطهم صرعى في سبيل مبدئهم الحق.
وهي أنبل ثورة قام بها جماعة من الناس، فإن الثائرين لم يستهدفوا ثورتهم مغنماً شخصياً لأنفسهم، وإنما استهدفوا من ثورتهم تحرير مجتمعهم من الطغاة الذين كانوا يسومونه العذاب ويجرعونه الصاب.
ومن هنا تأتي أهميتها التاريخية والتطويرية.
من أنها النموذج المحتذى، النموذج الذي جاء كاملاً، والذي يجب أن يستوحى.
وحيث كانت بهذه المثابة وجب أن تنال عناية خاصة من القيمين على شأن الكلمة عندنا، فعلى هؤلاء ـ وهم القوة المطورة والقائدة في الأُمة ـ أن يهتموا اهتماماً جديداً بهذه الثورة بشرح الدور الذي أسهمت به في تغذية روح النضال وإلهابها، وبالكشف عن أخلاقيتها التي بشرت بها، وبإحلالها في محلها اللائق بها من تاريخنا الثوري.
وأن أدوات الأداء الحديثة لتتيح إمكانات لا حد لها لاستخدام تاريخنا الثوري في تطوير مجتمعنا، وفي إبراز شخصيته التاريخية لعينيه، ليعمل على تركيز نضاله الحديث على الأُسس التاريخية والعقائدية لحركته النضالية الكبرى عبر العصور.
محمَّد مهدي شمس الدين
الحكم الأُموي كما
صوره خليفة أُموي
| فَدَعْ عَنْكَ ادِّكَارَكَ آل سَعْدَى | فَنَحْنُ الأَكْثَرُونَ حَصىً وَمَالا | |
| وَنَحْنُ المالِكُونَ النَّاسَ قَسْراً | نَسُومُهُمُ الْمَذَلَّةَ وَالنَّكَالا | |
| وَنُورِدُهُمْ حِيَاضَ الْخَسْفِ ذُلاًّ | وَمَا نَألُوهُمُ إِلاَّ خِبَالا |
الوليد بن يزيد الأُموي
بويع بالخلافة يوم الأربعاء/ 6 ربيع الثاني
سنة 125هـ/ 743،
وقتل بالبخراء (قرية من قرى دمشق)
يوم الخميس/ 28 جمادى الثانية سنة 126هـ 744م
البعد البشري للثورة
ـ 1 ـ
من الأبعاد التي لم تدرس في ثورة الحسين (ع) بعدها البشري ـ إذا صح التعبير ـ نعني بذلك ما يعود إلى رجالها الذين أججوا نارها، واستشهدوا فيها ـ لا من حيث إخلاصهم لها، وإيمانهم بها، فقد صدقوا ذلك بالموت ـ بل من حيث انتماؤهم القبلي، وعنصرهم البشري، وموطنهم الجغرافي، والحالة الاجتماعية، والأعمار، وغير ذلك مما يتصل بالوضع الشخصي لكل واحد منهم.
ويدخل في حقل هذه الدراسة أيضاً أولئك الذين كانوا من رجال الثورة أو من جمهورها، وفاتتهم لسبب أو لآخر فرصة المساهمة فيها حين نشبت دون أن يتبدل ولاؤهم لها.
إن دراسة هذا البعد من أبعاد الثورة الحسينية ضرورية لتحقيق هدفين:
الأول:
معرفة «الدرجة» التي بلغتها «الحالة الثورية» في المجتمع الإسلامي آنذاك، وذلك من حيث العمق والأصالة، ومن حيث الانتشار.
الثاني:
معرفة مدى مساهمة استشهاد رجال الثورة في كربلاء وغيرها في تأجيج نار الثورات التي تفجرت فيما بعد من حيث أن الانتماء القبلي أو الإقليمي المعين ـ مثلاً ـ لهذا الثائر أو ذاك قد سبَّب أن تحدث شهادته تغييراً ما في ولاء بعض الرجال والجماعات للسلطة، فنقلتهم إلى جو الثورة أو حيّدت مواقفهم على الأقل.
وقد درسنا من قبل تأثير الثورة الحسينية في تفجير ما تلاها من ثورات من حيث تأثير الثورة في ذهينة الأُمة بشكل عام كعنصر ثقافي جديد دخل في تصورات الأُمة، ولم ندرس تأثير الثورة المباشر من خلال شخصيات رجالها، وانتمائهم، ومواقعهم في حياة مجتمعاتهم القبلية ومواطنهم الجغرافية.
إن هؤلاء الرجال، حين يدرسون على هذا النحو، سيكونون نوافذ نطل منها على مجتمعهم فنعرف الكثير من خفاياه مما لا تسعفنا النصوص المباشرة في معرفة شيء منه.
ولكن المادة الأساسية لهذه الدراسة تكاد أن تكون مفقودة. فإن الإخباريين والمؤرخين لم يعنوا برواية وتسجيل أسماء الرجال والنساء والجماعات ممن شارك في هذه الثورة بشكل أو بآخر. أو حاول أن يشارك فيها وحالت الظروف بينه وبين ذلك ـ وقبائلهم ومواطنهم الجغرافية، وأعمارهم، ولا نكاد نعرف شيئاً ذا قيمة عن الأوساط الاجتماعية التي خرج منها كثير من هؤلاء الثوار أو غالبيتهم.
نعاني هذا الفقر في المعلومات بالنسبة إلى غير الهاشميين من الشهداء، أما الهاشميون فإن المؤرخين حفظوا لنا أسماء الشهداء منهم، والمؤرخون يختلفون فيما بينهم في بعض الأسماء، ولكن الأمر بالنسبة إليهم، على كل حال، أفضل مما نواجهه بالنسبة إلى الشهداء من غير الهاشميين.
ربما يكون الوهج الساطع الذي يشع من شخصية الإمام الحسين، والظل الكبير الذي تتركه هذه الشخصية العظيمة في نفس الباحث مسؤولين إلى حدٍّ ما عن إهمال المؤرخين والإخباريين لتزويدنا بالمادة الأساسية لهذه الدراسة على نحو أفضل.
ولذا فإن محاولة تجميع المادة الأساسية لهذه الدراسة تواجه صعوبات جمة تنشأ من قلة المعلومات، وتشتتها وغموضها أحياناً، وتناقضها في أحيان أخرى. ولذا فلا بد من كلمة نقولها عن المصادر.
ـ 2 ـ
إن المصادر التي من شأنها أن توفر مادة هذه الدراسة هي:
1 ـ كتب الرجال الموضوعة لمعرفة حال رواة الحديث من حيث وثاقتهم ودرجتها، أو عدمها. وقد عني علماء الرجال بذكر هؤلاء الشهداء، ربما بسبب ما يتمتعون به من مركز معنوي كبير في الذهنية الإسلامية نشأ نتيجة لشهادتهم في سبيل الحق، وإلاَّ فلم يرد لأكثرهم ذكر في سند أية رواية.
2 ـ كتب التاريخ، لما تشتمل عليه من ذكر بعض الشهداء على نحو مقصود، بسبب ما يتمتع به المذكور من مركز خاص، أو عرضاً خلال حكاية حادث أو تصوير موقف من المواقف. كما أنها مصدر رئيسي للأحداث المتصلة بهؤلاء الشهداء وخصومهم.
3 ـ كتب المقاتل، وهي كتب وضعها علماء أو متأدبون من الشيعة، وهي عادة مقصورة على رواية تاريخ الثورة الحسينية وملابساتها منذ بدايتها حتى النهاية.
4 ـ كتب الأدب القديمة، وهي ذات قيمة ثانوية في ما يبدو، على الأقل فيما يتعلَّق بهذه المرحلة من مراحل الدراسة.
من كتب الرجال سنعتمد على الكتب التالية:
1 ـ كتاب الرجال ـ لمحمَّد بن عبدالعزيز الكشي ـ توفي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ـ (منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ كربلاء العراق/ غير مؤرخة).
2 ـ كتب الرجال ـ للشيخ محمَّد بن الحسن الطوسي ـ توفي سنة 460هـ تحقيق وتعليق السيد محمَّد صادق بحر العلوم ـ المطبعة الحيدرية النجف: 1381هـ = 1961م).
4 ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة أبو القاسم الخوئي، وهو من أحدث الكتب المؤلفة في الرجال شمولاً.
ومن كتب التاريخ سنعتمد بشكل أساسي على محمَّد بن جرير الطبري في كتابه «تاريخ الرسل والملوك» ـ طبعة دار الكتب ـ تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم (الجزء الخامس المطبوع سنة 1963م) وقد آثرناه على غيره من الموسوعات لأنه يتيح للباحث فرصة معرفة سند الرواية، والتأكد من أنها رواية شاهد عيان، كما يتيح للباحث فرصة المقارنة والترجيح لما يغلب فيه من نقل عدة روايات للحادث الواحد.
ولا شك أن الحاجة ستقضي بالرجوع إلى مصادر أخرى لمقارنة بعض المعلومات، ولزيادة التوثيق. وللمقارنة والتوثيق سنرجع إلى الكتب التالية:
1 ـ الأخبار الطوال لأَبي حنيفة الدينوري ـ توفي سنة 282هـ تحقيق عبدالمنعم عامر ـ سلسلة (تراثنا) نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي، سنة 1960م.
2 ـ تاريخ اليعقوبي، لأَحمد بن أَبي يعقوب، توفي سنة 292هـ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف سنة 1384هـ = 1964م.
3 ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي، توفي سنة 346هـ تحقيق محمَّد محيي الدين عبدالحميد ـ مطبعة السعادة بمصر ـ الطبعة الثانية، سنة 1367هـ 1948م.
وربما رجعنا في حالات نادرة إلى تاريخ ابن الأثير الجزري (الكامل في التاريخ) الجزء الثالث، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية، سنة 1387هـ = 1967م. كذلك ربما دعت الحاجة أثناء البحث إلى الاستعانة ببعض كتب الأدب في شأن بعض الرجال أو الأحداث.
ومن كتب المقاتل سنعتمد على الكتب التالية:
1 ـ الإرشاد ـ للشيخ المفيد محمَّد بن محمَّد بن النعمان المتوفى سنة 413هـ منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها في النجف الأشرف، سنة 1381هـ = 1962م.
2 ـ مقتل الحسين ـ لأَبي المؤيد الموفق بن أَحمد المكي أخطب خوارزم المتوفى سنة 568هـ (الجزءان الأول والثاني) مطبعة الزهراء في النجف سنة 1367هـ = 1948م.
والخوارزمي يروي أخباره في هذا الكتاب غالباً عن تاريخ ابن أعثم، أبي محمَّد أَحمد، المتوفى سنة 314هـ، وإذن فهي في مستوى روايات الطبري. وأخباره تتسم بالموضوعية واللغة الدقيقة غالباً، كما أنها ذات محتوى عاطفي معتدل.
3 ـ مقاتل الطالبيين ـ لأَبي الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمَّد القرشي الأموي المرواني، المتوفى سنة 356هـ، شرح وتحقيق السيد أَحمد صقر ـ القاهرة ـ دار إحياء الكتب العربية.
4 ـ مناقب آل أَبي طالب ـ لمحمَّد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني المتوفى سنة 588هـ، (الجزء الرابع) المطبعة العلمية ـ بقم ـ إيران غير مؤرخة.
5 ـ مثير الأحزان ـ للشيخ نجم الدين محمَّد بن جعفر (ابن نما) الحلي المتوفى سنة 645هـ، منشورات المطبعة الحيدرية في النجف ـ 1369هـ = 1950م.
6 ـ اللهوف في قتل الطفوف ـ لعلي بن موسى بن محمَّد بن طاووس، المتوفى سنة 664هـ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف/ غير مؤرخة.
7 ـ بحار الأنوار ـ لشيخ الإسلام محمَّد باقر المجلسي، توفي سنة 1111هـ (الجزآن: 44، 45) من الطبعة الجديدة ـ المطبعة الإسلامية 1385هـ منشورات المكتبة الإسلامية بطهران ـ إيران.
وقد اعتمدنا على هذا الكتاب لأنه ينقل نصوص مؤلفين في المقاتل متقدمين عليه.
8 ـ زيارة للحسين (ع) منسوبة إلى الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تشتمل على أسماء كثير من الشهداء من الهاشميين وغيرهم. رواها المجلسي في البحار. (ج45 ص65 ـ 73) عن كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس وذكر أنَّها صدرت سنة 252هـ.
ونحن نشك في نسبتها إلى الإمام الثاني عشر (ع)، ولكنها مع ذلك نص تاريخي قديم يعتمد عليه من الناحية التاريخية، وسنشير إليها في ثنايا البحث بكلمة (الزيارة).
10 ـ زيارة للحسين ذكرها السيد ابن طاووس في كتابه الإقبال تضمنت زيارة للشهداء تشتمل على أسمائهم. وهي فيما يبدو من إنشاء السيد ابن طاووس وقد ذكرها المجلسي في بحار الأنوار (ج101 ص340 ـ 341).
وسنشير إليها في ثنايا البحث بكلمة (الرجبية) لأنها رويت ليزار بها الحسين والشهداء في أول يوم من شهر رجب. وهي أقل قيمة. كوثيقة تاريخية ـ من سابقتها لتأخر ابن طاووس عن عصر صدور الزيارة الأولى (توفي ابن طاووس سنة 664هـ) فهي متأخرة عن الزيارة الأولى أربعة قرون أو أكثر. وهما مختلفان في بعض الأسماء، وسنثبت الزيارتين في آخر هذا الكتاب مع بيان موارد اختلافها ودراسة وافية عنهما.
11 ـ أعيان الشيعة (الجزء الرابع، القسم الأول) للسيد محسن الأمين ـ الطبعة الثالثة ـ مطبعة الانصاف، بيروت، سنة 1380هـ 1960م.
وينبغي أن ننوه بأن السيد محسن الأمين هو الوحيد من بين المؤلفين في الموضوع الذي استقصى أسماء الشهداء من الهاشميين وغيرهم، وأثبت أسماءهم في الصفحات (135 ـ 138) من الجزء المذكور أعلاه، كما ذكر أسماء بعض من لم يقتل في المعركة. وسنثبت في هذا البحث ما ذكره في أعيان الشيعة.
وثمة كتب أخرى في المقتل أطلعنا عليها من خلال كتاب «بحار الأنوار» المذكور أعلاه.
ـ 3 ـ
ولا بد لنا من أن نقول هنا كلمة عن كتب «المقتل».
نحن نرى أن أكثر هذه الكتب أجدر بأن يكون مرجعاً في شأن الثورة الحسينية من كتب التاريخ العام.
فهي ـ من جهة ـ خاصة بحكاية وقائع هذه الثورة، ولذا فهي أحفل من كتب التاريخ العام بالأحداث وتفاصيلها، فإن كتب التاريخ العام تعطي، غالباً، أهمية متساوية لكل ما ترويه.
وهي، من جهة ثانية، من وضع رجال ينظرون إلى الثورة الحسينية بعاطفة الحب والتقديس، وهي جزء نابض بالحياة من تاريخهم، وهم يعتمدون في حكايتهم لأحداثها على مصادر ذات صلة حميمة بالثورة (أئمة أهل البيت، الرجال والنساء الذين رافقوا الثورة منذ بدايتها حتى نهايتها في كربلاء) هؤلاء الذين لم يتصل بهم رواة التاريخ العام الذين كانوا غالباً على اتصال وثيق بالسلطان يمنعهم من الاعتماد في رواياتهم على هؤلاء. أو كان على الأقل، يدفعهم إلى الحذر في نقل صورة الأحداث كما يعكسها نساء الثوار وأَبناؤهم وأصحابهم.
كما أن مؤلفي كتب التاريخ العام كانوا، غالباً على اتصال بالسلطان، أو أنهم يؤيدون وضعاً سياسياً يتعارض مع مضمون الثورة، وربما ينسجم بشكل أو بآخر مع وضع جلاديها، فلم يكونوا، بطبيعة الحال قادرين، أو لم يكونوا يريدون تسجيل الأحداث من وجهة نظر مصادر الثائرين أنفسهم ـ هذه المصادر قد اتصل بها رواة من الشيعة، رجال ونساء، كان تشيعهم حافزاً لهم على تقصي كل تفصيل دقيق وكل حادث كبير يتصل بالثائرين وإنجازهم في كربلاء. على أننا نبادر، مع ذلك، فنقول إنه حتى هؤلاء لم ينقلوا كل ما حدث، فلقد ضاع الكثير، وطمس الكثير.
من نماذج ذلك رواية عمار الدهني([793]) عن الإمام الباقر أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين (عليهم السلام)، وقد أوردها الطبري. فهي رواية نعتقد أن عماراً أو من بعده من الرواة قد تلاعبوا فيها، فأضافوا إليها بعض الأفكار التي ترضي السلطة (مثلاً: أن الحسين طلب أثناء مفاوضته مع عمر بن سعد أن يرسله إلى يزيد بن معاوية يضع يده في يده ويرى فيه رأيه) وحذفوا منها، واختصروا بعض المعالم الرئيسية فيها، كما لا يبعد أن يكون الطبري نفسه قد تسامح في إثبات بعض أجزائها([794]).
لهذا وذاك نعتبر كتب المقتل أجدر من كتب التاريخ العام بالاعتماد عليها فيما يتصل بالتاريخ الشخصي للثوار، بل أنها ـ لهذا وذاك أيضاً ـ أجدر من كتب التاريخ العام بالاعتماد عليها فيما يتصل بتاريخ الثورة نفسه.
نقول هذا معترفين بأن ثمة مأخذاً على كثير من كتب المقتل فيما يتصل بالأحداث، فإن الحماسة والحب قد يدفعان في بعض الحالات إلى تدوين أخبار معينة دون أن تنال حظها من التحقيق، وربما يكون بعض هذه الأخبار مجرد استنتاجات وآراء شخصية كونها لنفسه بعض الرواة والمؤلفين، فجاء كتاب متأخر عنه اعتبرها تاريخاً وأثبتها على أنها أحداث واقعة. كما أن بعض كتّاب المقتل في بعض الحالات يعمم رؤيته للموقف فيعبر عنها بإطلاق أوصاف معينة على رجال الثورة أو أعدائها، ويعبِّر عن مجموع الموقف بعبارات عاطفية. وأكثر ما توجد هذه الظاهرة في كتب المتأخرين من مؤلفي المقتل.
ومهما يكن فإن على الباحث أن يلتزم الأسلوب العلمي الصارم في النقد والاختيار.
ولكن العدل يقتضينا أن نقول إن المصادر التاريخية الأخرى ـ غير كتب المقتل ـ مما كتبه مؤلفون من غير الشيعة عن تاريخ هذه الثورة لا تسلم من مآخذ كبيرة أيضاً.
ففيما يتعلق برجال الثورة نلاحظ أن الإخباريين والمؤلفين لم يظهروا عناية خاصة بهم، ولم يذكروا لنا واحداً منهم عن قصد لذكره، وإنما ذكروا أولئك الذين تمر أسماؤهم عرضاً في سياق الأخبار التي ينقلونها.
وفيما يتعلَّق بأحداث الثورة: نلاحظ أنهم في كثير من الحالات لا يحرصون على الدقة والتفصيل فيما ينقلون من أحداثها (نستثني من ذلك أبا مخنف). وقد يقال: أنهم عاملوها كغيرها من أحداث تلك الفترة، ولعل هذا القول صحيح، ولكنهم كانوا يعلمون ويحسون أن هذه الثورة ليست كغيرها من أحداث تلك الفترة، فقد كانت مؤشراً كبيراً لتغير كبير في حياة المسلمين، وقد وضعتهم على منعطف جديد تماماً في حياتهم. وكان على هؤلاء المؤرخين ـ لهذا السبب ـ أن يحتفلوا لروايتها أكثر من غيرها، وأن لا يفوتهم تسجيل كل ما يتصل بها من قريب أو بعيد.
على أننا لا نستطيع أن نقبل القول بأنهم عاملوها كغيرها من أحداث التاريخ، بل نرى أنهم عاملوها درجة أقل من العناية، متأثرين بالاتجاه السياسي الذي كان لا يشجع على رواية أحداثها، بل يحرص على طمس تلك الأحداث، لئلا تتفاعل في المجتمع وتؤدي إلى تغيير بعض المواقف السياسية.
وهذا الأمر فيما يتصل بالأمويين واضح، ونرى أنه كذلك فيما يتصل بالعباسيين.
فإن هؤلاء وإن كانوا يعتبرون الثورة إحدى إنجازاتهم التاريخية باعتبارهم هاشميين (يلاحظ أنه لم يشترك فيها أحد من بني العباس)، وهم يعلمون أنهم مدينون للثورة بالكثير من الأوضاع والعوامل التي أوصلتهم إلى السلطة، بل قد كانت روحها وشعاراتها وذكرياتها من العوامل المباشرة في ذلك. مع هذا كله نرى أنهم كانوا يقفون منها موقفاً سلبياً، لأنهم كانوا يعلمون أن ذكرياتها وإيحاءاتها يمكن أن تكون خطراً عليهم من حيث نظرة الناس إلى شرعية توليهم للسلطة، وذلك بما تدعو إليه من إعطاء السلطة لآل علي من بني هاشم، وتتضح أسباب حذر العباسيين من الثورة الحسينية بصورة أكثر إذا لاحظنا أن تحركات الحسينيين الثورية لم تنقطع بعد استقرار دولة بني العباس.
كان لا بد من هذه الكلمة عن كتب المقتل، ليتبين الوضع الحقيقي لهذه الكتب من حيث صلاحها لتكون مصادر تاريخية لهذه الثورة. وهي كلمة لا تفي بما يجب أن تناله هذه الكتب من عناية، فكتب المقتل تصلح أن تكون موضوعاً لدراسة علمية واسعة وعميقة تشتمل على تاريخ نشوء هذا النوع من كتابة التاريخ، وتطوره، ومنهجه، ومحتوياته، ونوعيات المؤلفين، والأسلوب الذي كتب به، وتطور هذا الأسلوب خلال العصور، وعلاقة هذا الأسلوب بلغة الكتابة في المجالات الأخرى، واللغات التي كتبت بها (العربية، والفارسية، والتركية، والأردوية، وغيرها) والمحتوى الشعري لهذه الكتب التي بدأت ـ فيما نحسب ـ بأَبي مخنف ولم تنته بعد، فالكتابة في مقتل الحسين كانت ولا تزال موضوعاً يثير الرغبة لدى الكثيرين، ولذا فإن الدارس لهذا الموضوع سيجد مادة غنية وغزيرة ومتنوعة لبحثه ممتدة في جميع العصور الإسلامية ومنتشرة في جميع الأوساط والمجتمعات الإسلامية منذ القرن الهجري الأول إلى عصرنا هذا في بداية القرن الخامس عشر الهجري.
ولن تكون دراسة كهذه مقصورة على الكتب المؤلفة في مقتل الحسين، وإن كانت الكتب المؤلفة في هذا الموضوع أكثرها عدداً وأشدها تنوعاً، بل أنها تتسع لتشمل مؤلفات أخرى، فثمة مؤلفون كثيرون كتبوا في «مقتل علي» «مقتل زيد» «مقتل عثمان» «مقتل حجر بن عدي»، وغير ذلك، ويجد الباحث أسماء عشرات من كتب المقتل في موضوعات مختلفة. وربما كانت هذه الكتابات، إلى جانب الحديث والسيرة، إحدى المراحل الهامَّة التي تطورت إليها كتابة التاريخ العام عند المسلمين.
الرجال كم هم؟ ومن هم؟
كان قد اجتمع إلى الحسين «مدة مقامه بمكة نفر من أهل الحجاز ونفر من أهل البصرة انضافوا إلى أهل بيته ومواليه»([795]).
وحدد الخوارزمي عدد هؤلاء يوم خرج الحسين من مكة:
«.. وفصل من مكة يوم الثلاثاء، يوم التروية، لثمان مضين من ذي الحجة ومعه اثنان وثمانون رجلاً من شيعته، ومواليه، وأهل بيته»([796]).
وربما لا يكون هذا التقدير الذي ذكره الخوارزمي عمن رواه دقيقاً. ونحن على أي حال لا نملك تقديراً صحيحاً لعدد كل فئة من شيعته، ومواليه، عند خروجه من مكة.
وقال أَبو مخنف:
«.. لما خرج الحسين من مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص عليهم يحيى بن سعيد، فقالوا له: انصرف، أين تذهب! فأبى عليهم ومضى، وتدافع الفريقان، فاضطربوا بالسياط، ثم إن الحسين وأصحابه امتنعوا امتناعاً قوياً، ومضى الحسين (ع) على وجهه»([797]).
وقال الدينوري:
«.. ولما خرج الحسين اعترضه صاحب شرطة أميرها عمرو بن سعيد بن العاص في جماعة من الجند، فقال: إن الأمير يأمرك بالانصراف، فانصرف، وإلاَّ منعتك، فامتنع الحسين، وتدافع الفريقان، واضطربوا بالسياط. وبلغ ذلك عمرو بن سعيد، فخاف أن يتفاقم الأمر، فأرسل إلى صاحب شرطته يأمره بالانصراف»([798]).
وإذن، فقد بذلت محاولة رسمية، تتسم بالعنف، للحيلولة بين الحسين وبين «الخروج» من مكة، ولكنها باءت بالفشل([799]).
قال أبو مخنف:
«كان الحسين لا يمر بأهل ماء إلاَّ اتبعوه حتى إذا انتهى إلى زبالة سقط إليه مقتل أخيه من الرضاعة، مقتل عبدالله بن بقطر، وكان سرحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق وهو لا يدري أنه قد أُصيب.. فأتى ذلك الخبر حسيناً وهو بزبالة، فأخرج للناس كتاباً فقرأ عليهم:
«بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل، وهاني بن عروة، وعبدالله بن بقطر، وقد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الإنصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام».
«فتفرق الناس عنه تفرقاً، فأخذوا يميناً وشمالاً حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة([800]). وإنما فعل ذلك لأنه ظن إنما اتبعه الأعراب لأنهم ظنوا أنه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلاَّ وهم يعلمون علام يقدمون، وقد علم أنهم إذا بين لهم لم يصحبه إلاَّ من يريد مواساته والموت معه»([801]).
وقال الدينوري:
«قد كان صحبه قوم من منازل الطريق، فلما سمعوا خبر مسلم، وقد كانوا ظنوا أنه يقدم على أنصار وعضد، تفرقوا عنه، ولم يبق معه إلاَّ خاصته».
وإذن فقد بقي رجال الثورة الحقيقيون وحدهم بعد أن انجلى الموقف وتبين المصير.
وقد كان هذا الإعلان الذي سمعه الناس من الحسين في زبالة هو الاختبار الأول في هذه المسيرة، وقد أدَّى إلى تفرق الكثيرين الذين رافقوه عن رغبة وطمع، وبقي معه هؤلاء الرجال النادرون الذين سيعرفهم التاريخ عما قليل باسم «أنصار الحسين».
وقد مروا في اختبار ثان حين حثهم الحسين على النجاة بأنفسهم في ليلة العاشر من المحرم قائلاً لهم:
«هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً، ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما يطلبوني، ولو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري»([802]).
ولكنهم رفضوا هذه الفرصة، وآثروا البقاء معه إلى النهاية، واستشهدوا جميعاً.
وسنرى أنه لم يبق في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة، وذلك لأن عدداً قليلاً من الرجال قد انضم إليه فيما بعد، وشارك أصحابه الأولين مصيرهم المجيد.
كَم هُم؟
من المؤكد أنه لا سبيل لنا إلى معرفة العدد الحقيقي لأصحاب الحسين (ع)، من استشهد منهم ومن لم يرزق الشهادة، وذلك لأن المستندات المباشرة لهذه المسألة، وهي روايات شهود العيان، مختلفة في التقدير. وهي، بطبيعة الحال، غير مبنية على الإحصاء، بل مبنية على الرؤية البصرية والتخمين كما تقضي بذلك طبيعة الموقف، ومن هنا فإن أياً منها لا تعبر عن عدد نهائي، وإنما تعبر عن عدد تقريبي، لا بد أن يفترض فيه أنه يزيد على العدد الحقيقي قليلاً أو ينقص عنه قليلاً.
فيما يلي نعرض الروايات الرئيسة في الموضوع، ونحللها، ونناقشها.
لدينا، بالنسبة إلى من شارك في المعركة من الهاشميين وغيرهم، أربع روايات.
الرواية الأولى:
رواية المسعودي، وهي: «فلما بلغ الحسين القادسية لقيه الحر بن يزيد التميمي… فعدل إلى كربلاء، وهو في مقدار خمسمائة فارس من أهل بيته وأصحابه، ونحو مائة راجل»([803]).
إن المسعودي لم يذكر مستنده في هذه الرواية، ومع أن المسعودي يتسم بالدقة في تاريخه إلاَّ أننا لا يمكن أن نقبل العدد الوارد في هذه الرواية على أنه العدد الذي وصل مع الحسين إلى كربلاء، فهي من هذه الجهة تخالف كل الروايات المعروفة التي نعرف مستنداتها، دون أن تمتاز هذه الرواية بما يجعلها حرية بالقبول دون غيرها.
يمكن أن تكون هذه الرواية صادقة إلى حد بعيد إذا أخرجناها من إطارها الجغرافي، وتأخرنا بها في الزمان قليلاً عن لقاء الحسين للحر، واعتبرنا أنها تعبر عن العدد الذي كان قبل أن يعلن الحسين عن مقتل مسلم بن عقيل وعبدالله بن بقطر وهاني بن عروة، وأما بعد ذلك فمن المؤكد أن عدد الأصحاب ليس بالمقدار الذي ورد في رواية المسعودي.
الرواية الثانية:
رواية عمار الدهني عن أبي جعفر (محمَّد بن علي بن الحسين = الإمام الباقر) وقد جاء فيها: «… حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال لقيه الحر بن يزيد التميمي… فلما رأى ذلك عدل إلى كربلاء… فنزل وضرب ابنيته، وكان أصحابه خمسة وأربعين فارساً ومائة راجل»([804]).
وقد أورد ابن نما الحلي هذا العدد، إلاَّ أن الرواية عنده تختلف في التأقيت عن رواية عمار، فرواية عمار تؤقت العدد بساعة النزول في كربلاء، وقد كان ذلك في اليوم الثاني من المحرم([805])، وابن نما يؤقت العدد في اليوم العاشر من المحرم عند التعبئة، قال: «.. وعبىء الحسين أصحابه، وكانوا خمسة وأربعين فارساً ومائة راجل»([806])، وكذلك الحال عند ابن طاووس وقد صرح بإسناد الرواية إلى الإمام الباقر([807]).
ونحن نرجح أن ابن نما ـ كابن طاووس ـ قد استند إلى رواية عمار الدهني هذه، وليس لديه مصدر آخر غيرها، وأن اختلافهما عن رواية عمار في التأقيت ناشىء من عدم دقتهما في قراءة الرواية.
إن عمار الدهني قد تلقى الرواية من أوثق المصادر وهو الإمام الباقر، والمفروض أنه قد تلقى صورة حية ودقيقة لما حدث، فقد طلب الحديث بقوله «حدَّثني عن مقتل الحسين كأني حضرته» ولذا فإن مما يبعث على الدهشة أن نجد في الرواية تحريفاً منكراً لوقائع التاريخ، فهي تخالف، من عدة وجوه، بعض الحقائق الهامة المتصلة بمعركة كربلاء، ونرجح أن ذلك ناشئ من تلاعب الرواة بها كما ذكرنا آنفاً؛ إلاَّ أن هذا لا يمنع من قبول العدد الوارد في هذه الرواية بصورة مبدئية.
ونلاحظ أن رواية عمار تتفق من حيث الزمان والمكان مع رواية المسعودي التي طرحناها.
الرواية الثالثة:
رواية الحصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة، قال: «إن أشياخاً من أهل الكوفة لوقوف على التل يبكون ويقولون: أللهم أنزل نصرك، قال: قلت: يا أعداء الله ألا تنزلون فتنصرونه! قال: فأقبل الحسين يكلم من بعث إليه ابن زياد، قال: وإني لأنظر إليه وعليه جبة من برود، فلما كلمهم انصرف، فرماه رجل من بني تميم يقال له عمر الطهوي بسهم فإني لأنظر إلى السهم بين كتفيه متعلقاً في جبته، فلما أبوا عليه رجع إلى مصافه، وإني لأنظر إليهم، وإنهم لقريب من مائة رجل، فيهم لصلب علي بن أبي طالب (ع) خمسة، ومن بني هاشم ستة عشر، ورجل من بني سليم حليف لهم، ورجل من بني كنانة حليف لهم، وابن عمر بن زياد»([808]).
إن هذه الرواية منقولة عن شاهد عيان هو (سعد بن عبيدة)، ويبدو أنه كان مع عمر بن سعد وأنه كان مقرباً منه، فهو يقول في رواية أخرى: «إنا لمستنقعون في الماء مع عمر بن سعد»([809])، بينما تشتمل الرواية موضوع البحث عن ملاحظة تدل على أنه كان متعاطفاً مع الإمام الحسين ومع الثورة: «.. قلت يا أعداء الله ألا تنزلون فتنصرونه»([810]).
والرواية، من حيث العدد، تتفق بوجه عام مع رواية أكثر تحديداً هي رواية الخوارزمي المتقدمة عن عدد من خرج مع الحسين من مكة وأنه كان اثنين وثمانين رجلاً. وكررها الخوارزمي بصيغة التمريض: (قيل)، في حديثه عن اليوم العاشر من المحرم([811])، كما ورد هذا العدد في مصادر أخرى لم نطلع عليها بطريق مباشر.
ويبدو أن هذه الرواية، من حيث المكان والزمان، تصور الموقف في اليوم العاشر من المحرم قبيل المعركة. وربما كانت تصور الموقف بعد نشوب المعركة (بعد الحملة الأولى مثلاً)، فإن الصورة الواردة فيها عن عمر الطهوي الذي رمى الحسين بسهم بعد أن فرغ من كلامه وانصرف إلى مصافه، لم ترد في روايةً أخرى من الروايات التي نُقِلَت فيها خطب الحسين وكلماته مع الجيش الأُموي، كذلك صورة هؤلاء الذين يبكون ويدعون.
الرواية الرابعة:
رواية أَبي مخنف عن الضحاك بن عبدالله المشرقي، قال: «… فلما صلى عمر بن سعد الغداة… وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء، خرج فيمن معه من الناس… وعبأ الحسين أصحابه وصلى بهم صلاة الغداة، وكان معه اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً»([812]).
إن أبا مخنف يتمتع بسمعة جيدة من حيث دقته وصدقه في أخباره التاريخية. وقد نقل أبو مخنف هذه الرواية بواسطة واحدة عن أحد أصحاب الحسين الذين قاتلوا معه إلى أن بقي من أصحابه رجلان ـ كما سنعرض لذلك فيما يأتي ـ وهو الضحاك بن عبدالله المشرقي، وهو، فيما يبدو، رجل صارم وعملي ودقيق جداً، فحين طلب الحسين منه النصرة أجابه إلى ذلك مشترطاً أن يكون في حل من الإنصراف عنه حين لا يعود قتاله مفيداً في الدفع عن الحسين، وقد أجابه الحسين إلى شرطه فاشترك الضحاك في المعركة بصدق. إن هذه الملاحظة تبعث على الوثوق بدقته.
وهذه الرواية، من حيث العدد والتأقيت والمكان، تتفق مع روايات مؤرخين آخرين معاصرين للطبري أو متقدمين عليه.
منهم أبو حنيفة الدينوري، قال: «… وعبّأ الحسين (ع) أيضاً أصحابه، وكانوا اثنين وثلاثين فارساً وأربعين راجلاً»([813]).
والدينوري يرجع إلى مصدر آخر غير مصدر أبي مخنف في روايته هذه.
ومنهم اليعقوبي، قال: «.. وكان الحسين في اثنين وستين أو اثنين وسبعين رجلاً من أهل بيته وأصحابه([814])».
وثمة روايات لكتاب متأخرين توافق هذا العدد أهمها في نظرنا رواية الخوارزمي، قال: «ولما أصبح الحسين (ع). عبأ أصحابه، وكان معه اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً»([815]).
ومنهم الشيخ المفيد([816]).
هذه هي الروايات الرئيسة في الموضوع.
ونلاحظ، قبل أن نذكر تقديرنا الخاص في المسألة، أن عدد الأصحاب لم يكن ثابتاً في جميع المراحل، منذ الخروج من مكة إلى ما بعد ظهر اليوم العاشر من المحرم في كربلاء، وإنما كان العدد متقلباً، بدأ عند الخروج من مكة بالعدد الذي ذكره الخوارزمي (اثنين وثمانين رجلاً) ثم ازداد العدد كثيراً في الطريق، ثم تقلص حتى عاد إلى العدد الأول، وربما يكون قد نقص عنه قليلاً، ثم ازداد بنسبة صغيرة قبيل المعركة نتيجة لقدوم بعض الأنصار، وتحوّل بعض جنود الجيش الأُموي إلى معسكر الحسين.
وتقديرنا الخاص نتيجة لما انتهى بنا إليه البحث هو أن أصحاب الحسين الذين نقدر أنهم استشهدوا معه في كربلاء من العرب والموالي يقاربون مئة رجل أو يبلغونها وبما زادوا قليلاً على المئة([817]).
ولا نستطيع أن نعين عدداً بعينه، لأنه لا بد من افتراض نسبة من الخطأ تنشأ من تصحيف الأسماء، ومن عدم دقة الرواة الذين نقلوا الأحداث وأسماء رجالها، ولكن نسبة الخطأ المفترضة ليست كبيرة قطعاً.
وهذه النتيجة تتوافق إلى حد كبير مع الروايات التي تصور ما حدث في الحملة الأولى من القتال.
قال الخوارزمي في روايته عن أبي مخنف:
«.. فلما رموهم هذه الرمية قلّ أصحاب الحسين (ع)، فبقي في هؤلاء القوم الذين يذكرون في المبارزة. وقد قتل ما ينيف على خمسين رجلاً»([818]).
والذين ذكرهم ابن شهرآشوب يبلغون أربعين رجلاً([819]).
فإذا لا حظنا إلى جانب هذا أن هؤلاء الذين يذكرون في المبارزة يبلغون أربعين رجلاً تقريباً، نكون قد قربنا من النتيجة التي أدى بنا إليها البحث.
وهنا ينبغي أن نعي أن التفاوت أمر مقبول ومعقول، لأن الرواة في جميع رواياتهم عن عدد أصحاب الحسين لم يتبعوا مبدأ الإحصاء وإنما اتبعوا طريقة التقدير المستند إلى الرؤية البصرية.
وينبغي أن نعي أيضاً أن عدد هذه القوة الصغيرة كان متقلباً نتيجة لكون بعض عناصرها (الموالي خاصة) ربما كانت تظهر ثم تختفي في مهمات خاصة.
إذا أخذنا في اعتبارنا هذه الأمور نرى أن النتيجة التي تضمنها هذا البحث فيما يأتي منه عدد أصحاب الحسين من غير الهاشميين نتيجة على جانب كبير من الدقة والصواب.
وأخيراً نلاحظ، قبل أن نجاوز هذه المسألة إلى تقويم الروايات الأساسية، أننا الآن نواجه حالة مكتملة، فقد استشهد هؤلاء الرجال بأجمعهم في غالب الظن، بينما يعبر شهود العيان في رواياتهم عن حالة في طريقها إلى الاكتمال، فقد كان هؤلاء الرجال لا يزالون أحياء في الوقت الذي تحكي عنه الروايات، ولنا أن نفترض أن بعضهم، في بعض الروايات، لم يرزق الشهادة.
* * *
إذا استبعدنا رواية المسعودي للاعتبارات التي ذكرناها عند عرض الرواية، تبقى الروايات الثلاث الأخرى.
وهذه الروايات تشترك في أنها تستند إلى رواية شهود العيان الذين كانوا في ساحة المعركة، ولكنها تختلف فيما بينها في تقدير عدد أصحاب الحسين. فالتفاوت بين رواية أبي مخنف وبين رواية عمار الدهني يبلغ النصف تقريباً، والتفاوت بين رواية عمار ورواية الحصين يبلغ الثلث تقريباً.
إلاَّ أننا، مع ذلك نميل إلى قبول الروايات الثلاث لاعتبارين:
الأول: أننا نستبعد كثيراً أن يدخل الكذب في هذه الروايات من حيث العدد، مهما كانت مواقف المخبرين الذهنية والعاطفية من الثورة.
الثاني: أن هذه الروايات لا تعبر عن العدد في موقف واحد، وباعتبار واحد للرجال لينفي بعضها بعضاً، وإنما تعبر عن العدد في موقفين، وباعتبارين أو اعتبارات ثلاثة للرجال.
فرواية عمار الدهني عن أبي جعفر تعكس الموقف حين النزول في كربلاء في اليوم الثاني من المحرم، وبين هذا التاريخ والتاريخ الذي تعبر عنه روايتا الحصين وأبي مخنف تسعة أيام حدثت فيها بعض التقلبات في عدد الرجال، فقد تخلى بعضهم عن متابعة الصحبة، وانضم آخرون إلى الأصحاب، وذهب بعض إلى البصرة وغيرها برسائل من الحسين.
كما أن هذه الرواية (رواية عمار الدهني)، فيما نقدر، تعبر عن العدد الكلي للرجال الذين كانوا في هذا اليوم مع الحسين: موالي وعرباً وهاشميين، وغير هاشميين بالإضافة إلى عنصر الخدم من الرقيق وغيره ممن لا يعدون في المحاربين ـ وهم موضوع بحثنا ـ ونقدر أنه كان مع الحسين عدد من هؤلاء تقضي طبيعة الأمور بأن يكون موجوداً.
نقول هذا مع التأكيد على إمكانية وجود خطأ محدود في التقدير نتيجة لاستناد الراوي في تقديره إلى الرؤية البصرية لا إلى الإحصاء.
ورواية الحصين بن عبدالرحمن تعكس الموقف في اليوم العاشر من المحرم قبيل نشوب القتال، وتعبر عن عدد المحاربين، هاشميين وعرباً وموالي، أي أن عنصر الخدم خارج عن نطاق الصورة التي تعكسها هذه الرواية. ونقدر أنهم كانوا يزيدون على المئة قليلاً، وليسوا قريباً من مئة كما تقول الرواية، يحملنا على هذا التقدير إمكانية أن الرواية تعكس الموقف قبل تعبئة الحسين أصحابه وآله ميمنة وميسرة وقلباً، وأن بعض الرجال كان لا يزال بعيداً عن بصر الراوي، وأن الراوية يظن استناداً إلى رؤيته البصرية ولا يستند إلى الإحصاء، كما نؤكد أن ثمة من شبان الهاشميين من استشهد فيما بعد، ولم يكن، في الوقت الذي تحكي عنه الرواية، ظاهراً في الموقف عند الصباح، بسبب صغر سنه.
ورواية أبي مخنف والروايات الموافقة لها تعكس الموقف بصراحة بعد التعبئة، وهي، في تقديرنا، تعبر عن عدد أصحاب الحسين من المحاربين العرب غير الهاشميين، فهي لا تشمل الهاشميين ولا الموالي، ولا الخدم.
وثمة نص للمسعودي يحملنا على هذا الرأي بالنسبة إلى رواية أبي مخنف. فهو يقول: «… وقتل معه (مع الحسين) من الأنصار أربعة وباقي من قتل معه من أصحابه ـ على ما قدمنا من العدة ـ من سائر العرب»([820])، وكان قد قال قبل ذلك عن عدة من قتل مع الحسين: «وكان جميع من قتل مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة وثمانين منهم ابنه علي بن الحسين الأكبر»([821]). وإذن فلا بد أن يكون هذا العدد غير شامل للموالي، فهو يقول عن غير الأنصار إنهم من سائر العرب ونحن نعلم أنه قد استشهد من الموالي مع الحسين عدد كبير لم يدخلهم في عدد القتلى لاعتبارات تتصل بالعقلية العنصرية التي كانت سائدة بدرجات متفاوتة عند الناس في ذلك الحين([822]). وإذا أخرجنا الهاشميين من العدد الذي ذكره المسعودي للقتلى يبقى منهم عدد مقارب للعدد الذي ورد عند أَبي مخنف، وقلنا أنه لا يشمل الهاشميين ولا الموالي. هذا مع افتراض نسبة من الخطأ في التقدير تنشأ من الاعتماد على الرؤية، وإن كانت النسبة المفترضة ضئيلة جداً لاعتبارين.
الأول: إن الراوي هو الضحاك بن عبدالله المشرقي، أحد أصحاب الحسين، فهو في مركز من يستطيع الوصول إلى أقصى دقة في التقدير.
الثاني: أن هذا التقدير يعكس الموقف في حالة التعبئة وحالة التعبئة في عدد محدود تعطي قدرة أكثر على التحديد.
إن العدد الذي تشتمل عليه هذه الرواية هو اثنان وسبعون فرساناً ورجالة، والعدد الذي انتهى بنا البحث إليه في هذه الدراسة هو مئة تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً فإذا أخرجنا منه عشرين رجلاً من الموالي: عشرة من موالي الحسين، واثنان من موالي علي، وثمانية آخرون يبقى ثمانية وسبعون رجلاً من العرب غير الهاشميين، هذا قبل أن يتحول الحر بن يزيد الرياحي. وعلى هذا فإن نسبة الخطأ في نتيجتنا أو في رواية أبي مخنف محدودة جداً. وهذا التفاوت مألوف في مثل هذه الحالات.
* * *
تبقى ـ بالنسبة إلى عدد أصحاب الحسين ـ بعض المسائل.
من هذه المسائل مسألة تنشأ من رواية نقلها السيد بن طاووس في مقتله المسمى (اللهوف على قتل الطفوف) وهي:
«.. وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة (ليلة العاشر من المحرم) ولهم دوي كدوي النحل، ما بين راكع وساجد، وقائم وقاعد، فعبر إليهم في تلك الليلة من عسكر عمر بن سعد اثنان وثلاثون رجلاً»([823]).
إننا نقف من هذه الرواية موقف الشك:
أولاً: لأن حدثاً كهذا كان يجب أن يلفت نظر الرواة الآخرين، فهو حدث شديد الإثارة في مثل الموقف الذي نبحثه، ولهذا فقد كان لا بد أن ينقله رواة آخرون. إن عدم نقله عن رواة آخرين مباشرين يبعثنا على الشك في صدق الرواية.
وثانياً: إن هذا العدد (اثنان وثلاثون) عدد كبير جداً بالنسبة إلى أصحاب الحسين (ع) القليلين، ولذا فقد كان يجب أن يظهر لهم أثر في حجم القوة الصغيرة التي كانت مع الحسين في صبيحة اليوم العاشر من المحرم، على اعتبار أنهم انحازوا إلى معسكر الحسين في مساء اليوم التاسع، مع أننا لا نجد لهم أي أثر في التقديرات التي نقلها الرواة.
لهذا وذاك نميل إلى استبعاد هذه الرواية من دائرة بحثنا في عدد أصحاب الحسين (ع)، ونرجح أن الرواية ـ على تقدير صدقها ـ لا تعني، كما يراد لها، أن هؤلاء الرجال قد انحازوا إلى معسكر الحسين وقاتلوا معه، وإنما تعني أن هؤلاء الرجال ـ نتيجة لصراع داخلي عنيف بين نداء الضمير الذي يدعوهم إلى الانحياز نحو الحسين والقتال معه، وبين واقعهم النفسي المتخاذل الذي يدفع بهم إلى التمسك بالحياة الآمنة في ظل السلطة القائمة ـ قد «حيّدوا» أنفسهم بالنسبة إلى المعركة، فاعتزلوا معسكر السلطة، ولم ينضووا إلى الثوار.
ويبدو أنه قد حدثت حالات كثيرة من هذا القبيل، منها حالة مسروق بن وائل الحضرمي الذي كان يطمح إلى أن يصيب رأس الحسين «فأصيب به منزلة عند عبيدالله بن زياد»، ولكنه تخلى عن القتال وترك الجيش عندما رأى ما حل بابن حوزة عندما دعا عليه الحسين (ع)، وقال لمحدثه: «لقد رأيت من أهل هذا البيت شيئاً لا أقاتلهم أبداً»([824]).
وربما كان هؤلاء ـ على تقدير صدق الرواية ـ هم أولئك الرجال التافهون الذين قال الحصين بن عبدالرحمن عنهم أنهم كانوا وقوفاً على التل يبكون، ويقولون: «اللهم أنزل نصرك».
* * *
ومن المسائل المتصلة بعدد أصحاب الحسين مسألة الرؤوس وعددها:
تجمع الروايات على عدد شبه ثابت للرؤوس التي قطعت بعد نهاية المعركة، وأرسلت إلى الكوفة ثم أرسلت إلى الشام، فهذا العدد يتراوح بين سبعين رأساً وخمسة وسبعين رأساً.
فقد قال أبو مخنف في روايته عما حدث بعد قطع رأس الحسين (ع)، عن قرة بن قيس التميمي، وهو شاهد عيان من الجيش الأُموي: «.. وقُطف رؤوس الباقين، فسرح باثنين وسبعين رأساً»([825]).
وقال الدينوري:
«وحملت الرؤوس على أطراف الرماح وكانت اثنين وسبعين رأساً»([826]).
وقال الشيخ المفيد:
«.. وسرح عمر بن سعد من يومه ذلك، وهو يوم عاشوراء، برأس الحسين (ع)، مع خولي بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم إلى عبيدالله بن زياد، وأمر برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته فقطعت، وكانوا اثنين وسبعين رأساً»([827]).
وروى المجلسي في البحار عن محمَّد بن أبي طالب الموسوي:
«.. إن رؤوس أصحاب الحسين وأهل بيته كانت ثمانية وسبعين رأساً»([828]).
هذا فيما يتعلق بقطع الرؤوس. وأما فيما يتصل بتوزيع الرؤوس على القبائل:
روى أبو مخنف:
«.. فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً وصاحبهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن بعشرين رأساً وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن، وجاءت تميم بسبعة عشر رأساً، وجاءت بنو أسد بستة أرؤس، وجاءت مذحج بسبعة أرؤس، وجاء سائر الجيش بسبعة أرؤس، فذلك سبعون رأساً»([829]).
ونلاحظ على أبي مخنف أنه قال في روايته الآنفة: «فسرح باثنين وسبعين رأساً».
وروى الدينوري:
«.. وحملت الرؤوس على أطراف الرماح، وكانت اثنين وسبعين رأساً، جاءت هوازن منها باثنين وعشرين، وجاءت تميم بسبعة عشر رأساً مع الحصين بن نمير، وجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً مع قيس بن الأشعث، وجاءت بنو أسد بستة رؤوس مع هلال بن الأعور، وجاءت الأزد بخمسة رؤوس مع عيهمة بن زهير، وجاءت ثقيف باثني عشر رأساً مع الوليد بن عمرو»([830]).
ونلاحظ على الدينوري أنه قال عن مجموع الرؤوس أنه اثنان وسبعون مع أن مجموع حصص القبائل كما ذكرها يبلغ خمسة وسبعين.
وروى محمَّد بن أبي طالب الموسوي:
«.. فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً وصاحبهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن باثني عشر رأساً وصاحبهم شمر، وجاءت بنو أسد بستة عشر رأساً، وجاءت مذحج بسبعة رؤوس، وجاءت سائر الناس بثلاثة عشر رأساً»([831]).
ونلاحظ أن هذه الرواية تشتمل على أقل الأعداد في هذه المسألة فمجموع عدد الرؤوس فيها يبلغ واحداً وستين رأساً.
قد يقال بوجود دلالتين لعدد الرؤوس: إحداهما دلالته على أَصحاب الحسين، وثانيتهما دلالته على عدد القتلى.
وإذا صح هذا فإنه ينقض نظريتنا في عدد أصحاب الحسين، بل إنه ينقض كل الروايات الواردة في هذا الشأن، فمن المعلوم أن الرؤوس كانت للهاشميين وغيرهم، وعلى هذا ينبغي أن يكون عدد أَصحاب الحسين من غير الهاشميين أقل من خمسين رجلاً.
ولكننا لا نرى لعدد الرؤوس أية دلالة من هذه الجهة، فإن قطع الرؤوس وحملها إلى الكوفة والشام إجراء انتقامي ذو محتوى سياسي، أو عمل سياسي ذو صفة انتقامية، وهو خاضع لاعتبار سياسي معين سنتناوله بالدرس في فصل آت إنشاء الله تعالى.
على أننا نلفت النظر إلى الاختلاف في عدد الرؤوس بين الروايات (61 أو 70 أو 72 أو 65 أو 78) وعند الراوي الواحد (أبو مخنف: 72 و70) (الدينوري: 72 و75).
ونلفت النظر أيضاً إلى اختلاف الرواة في توزيع الرؤوس على القبائل.
إن هذه الاختلافات تدل ـ في نظرنا ـ على أن المسألة كما يعرضها الرواة، لو أردنا الأخذ بأرقامهم، ليست بسيطة كما تبدو، وإنما هي ذات تعقيدات تتصل بعلاقات القبائل بالقتلى من جهة، وتتصل بمركز القبيلة السياسي من جهة أخرى.
وعلى أي حال فسندرس هذه المسألة فيما يأتي.
* * *
ويثير الحديث عن عدد الرؤوس سؤالاً آخر هو: هل قتل الجميع أو بقيت منهم بقية؟
ذكر أبو مخنف عن محمَّد بن مسلم (وهو شاهد عيان من الجيش الأُموي).
«.. فقتل من أصحاب الحسين (ع) اثنان وسبعون رجلاً.. وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلاً سوى الجرحى..»([832]).
وهذه الرواية تعبر عن عدد الشهداء من غير الهاشميين. وهي كاذبة بلا شك فيما يتصل بتقدير عدد قتلى الجيش الأُموي، فإن أقل التقديرات بالنسبة إلى قتلى الجيش الأُموي تتجاوز العدد الذي ورد في هذه الرواية بكثير.
وقال المسعودي:
«.. وكان جميع من قتل مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة وثمانون، منهم ابنه علي بن الحسين»([833]).
وظاهر هذه الرواية أن هذا العدد يشمل الهاشميين وغيرهم بقرينة ذكر علي بن الحسين.
وفي رواية هشام بن الوليد الكلبي وأَبي مخنف عن استقبال يزيد بن معاوية لرسول عبيدالله بن زياد الذي أرسله بشيراً بالقضاء على الثورة:
«.. إذ أقبل زحر بن قيس حتى دخل على يزيد بن معاوية، فقال له يزيد: ويلك ما وراءك وما عندك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره، ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل بيته، وستين من شيعته فأحطنا بهم من كل ناحية حتى أتينا على آخرهم..»([834]).
إن قبول أي واحدة من هذه الروايات يعني أن أصحاب الحسين لم يقتلوا جميعاً، وأن بقية كبيرة منهم سلمت من القتل.
ولكننا لا يمكن أن نقبل هذه النتيجة، كما لا نستطيع أن نقبل الروايات في أنفسها وإن قبلنا النتيجة المذكورة.
لا نستطيع أن نقبل الروايات في أنفسها، بل نرجح رفضها لأن المفروض في حالة كهذه أن يكون العدد مبنياً على الإحصاء، لأن القتلى مادة ساكنة، ولأنه ـ في حالتنا ـ لا يوجد خطر من الإحصاء، لأن المنتصر قد قضى على كل مقاومة، وقد سيطر بشكل مطلق على ساحة المعركة، وإذا كانت الحالة هكذا وكان القتلى مادة ساكنة فإن عملية الإحصاء يجب أن تتم بسهولة، خاصة إذا لاحظنا أن العدد على جميع الفروض محدود للغاية.
والإحصاء يقتضي أن يكون الرواة متحدين في رواية العدد، آخذين بنظر الاعتبار أنهم شهود عيان، مع أننا نرى أنهم مختلفون في هذه المسألة اختلافاً كبيراً يبعث على الشك في دقتهم، ويحمل على الظن بأنهم بنوا تقديراتهم الظنية على استبعاد الشهداء من الموالي.
وإذا أردنا أن نحسن الظن برواياتهم فلا بد من افتراض أن بعض القتلى قد دفنوا قبل نهاية المعركة، وإن كنا نعترف بأننا لا نملك الآن بينة على هذا الافتراض.
ولا نستطيع أن نقبل النتيجة، لأن جميع المصادر من غير استثناء تنص على أن الحسين بقي ـ بعد استشهاد جميع أصحابه ـ من غير الهاشميين – مع الهاشميين وحدهم، وأنه، في النهاية، بعد استشهاد الهاشميين، بقي وحيداً، واستشهد وهو وحيد.
ولا تذكر المصادر الرئيسة والثانوية أن أحداً من أَصحابه تخلى عنه أبداً.
ولا تذكر المصادر أن أحداً من الذكور بقي حياً سوى الذين نذكرهم فيما يلي:
من الهاشميين:
1 ـ الإمام علي بن الحسين بن علي بن أَبي طالب، زين العابدين.
2 ـ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
3 ـ عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب([835]).
من غير الهاشميين:
1 ـ الضحاك بن عبدالله المشرقي:
كان قد أعطى الحسين (ع) عهداً أن يقاتل معه ما كان قتاله معه نافعاً، فإذا لم يُجْدِ مقاتلاً معه كان في حلٍ من الانصراف([836]).
2 ـ عقبة بن سمعان مولى الرباب زوجة الإمام الحسين (ع):
قال لعمر بن سعد حين أراد قتله: أنا عبد مملوك، فخلى سبيله([837]).
3 ـ المرقع بن ثمامة الأسدي:
كان قد نثر نبله، وجثا على ركبتيه، فقاتل فجاءه نفر من قومه فقالوا له أنت آمن، أخرج إلينا، فخرج إليهم([838]).
هؤلاء هم الذين ثبت أنهم سلموا من المذبحة من الذكور، ولو كان ثمة من تخلى عن الحسين قبيل المعركة أو في أثنائها أو بقي بعدها لحفظ ذكره.
وإن إجماع المصادر على ما ذكرنا، بالإضافة إلى عدم استقامة الروايات في أنفسها يحملاننا على عدم العناية بها، وتجريدها من أي دلالة مدعاة على عدد الأَصحاب، أو العدد الحقيقي للشهداء.
إن رواية عمار الدهني صادقة من هذه الجهة إلى حد بعيد:
«فقتل أَصحاب الحسين كلهم، وفيهم بضعة عشر شاباً من أهل بيته»([839]).
وثمة سؤال يتعلق بموقع الهاشميين من القوة المحاربة مع الحسين في صبيحة اليوم العاشر من المحرم.
هل كان الهاشميون صبيحة اليوم العاشر من المحرم، عند نشوب القتال، جزءً من القوة المحاربة التي عبأها الحسين (ع) فجعل زهير بن القين في الميمنة، وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وأعطى الراية أخاه العباس، أو أنهم كانوا خارج هذه القوة؟
إننا نرى أن الافتراض الأول هو الصحيح، فإننا لا نستطيع أن نقبل فكرة أن غير الهاشميين قد باشروا الحرب بينما كان هؤلاء جالسين في خيامهم. الشيء المؤكد هو أن غير الهاشميين قاتلوا وقتلوا قبل الهاشميين، ولكن هذا لا يعني أن الهاشميين كانوا خارج القوة المعبئة، وإذن فلا بد أن الجميع كانوا في حالة تهيئة للقتال في وقت واحد وفي موقف واحد.
ولدينا نص نقله الخوارزمي قال فيه:
«.. ولما أصبح الحسين (ع).. عبأ أَصحابه.. فجعل على ميمنته زهير بن القين، وعلى ميسرته حبيب بن مظاهر، ودفع اللواء إلى أخيه العباس بن علي، وثبت (ع) مع أهل بيته في القلب»([840]).
ويبدو أن موقع الراية ـ في نظام التعبئة ـ في القلب، وإذن فكل من ذكر أن الرواية كانت في يد العباس بن علي عنى أن بني هاشم كانوا في القلب مع الحسين([841]).
نستثني منهم الشبان الصغار الذين لم يكونوا في سن مناسبة للقتال، وهم بضعة أفراد استشهدوا حين لم يبق مع الحسين أحد من المقاتلين الهاشميين فاندفع هؤلاء الشبان إلى القتال، وقتلوا.
* * *
لقد كان من الممكن أن يزيد عدد أصحاب الحسين (ع) زيادة كبيرة، لم تكن لتؤثر وحدها على نتيجة المعركة بنفسها، ولكنها كانت تجعلها أطول وأشد مرارة بالنسبة إلى الجيش الأُموي، مما كان من الممكن أن يُمكّن قوات أخرى أن تتدخل إلى جانب الثورة، وعوامل مساعدة ذات طبيعة سياسية أن تحدث فتؤثِّر على نتيجة المعركة.
كان من الممكن أن يحدث هذا لولا حدوث بعض المعوقات.
فقد استأذن حبيب بن مظاهر الأسدي الإمام الحسين قبل المعركة بأيام في أن يأتي قومه من بني أسد الذين كانوا قريبين من موقع المعركة فيدعوهم إلى نصره الحسين. فأذن له.
وقد استجاب لدعوة حبيب بن مظاهر من هذا الحي من بني أسد تسعون مقاتلاً جاؤوا معه يريدون معسكر الحسين، ولكن عمر بن سعد علم بذلك فوجه إليهم قوة من أربعمائة فارس، «فبينما أولئك القوم من بني أسد قد أقبلوا في جوف الليل مع حبيب يريدون عسكر الحسين، إذ استقبلتهم خيل ابن سعد على شاطىء الفرات، وكان بينهم وبين معسكر الحسين اليسير، فتناوش الفريقان واقتتلوا، فصاح حبيب بالأزرق بن الحرث: ما لك ولنا، انصرف عنا، يا ويلك دعنا واشق بغيرنا، فأبى الأزرق، وعلمت بنو أسد ألا طاقة لهم بحيل ابن سعد، فانهزموا راجعين إلى حيّهم، ثم تحملوا في جوف الليل خوفاً من ابن سعد أن يكبسهم، ورجع حبيب إلى الحسين فأخبره»([842]).
ويبدو أن السلطة كانت تخشى أن يتسامع الناس بما يحدث في كربلاء فيؤدي ذلك إلى تدفق الأنصار على الحسين، ولذا استعجلت إنهاء المعركة والقضاء على الحسين وآله وصحبه، فرفضت المضي في المفاوضات، ووجَّهت تأنيباً إلى عمر بن سعد لأنه يحاور الحسين، واستخدمت سلاح العطش لا لمجرد التعذيب الجسدي، وإنما لغاية أخرى أيضاً هي خفض القدرة القتالية لدى الحسين وقوته الصغيرة، وإضعاف خيلهم، وخلق مشكلة موجعة تنشأ من عطش النساء والأطفال.
ويبدو أن محاولة حبيب بن مظاهر قد نبهت قيادة الجيش الأُموي إلى إمكانية تسرب قوات موالية للحسين من جانب الفرات، فعززت، أثر هذه المحاولة، حصار العطش لحماية الضفة من تسرب أي إنسان موالٍ للحسين من خلالها([843]).
ويعزز هذا الرأي ملاحظة وردت عرضاً في رواية الطبري على لسان أحد المقاتلين في الجيش الأُموي، تصور مشهداً أليماً وفاجعاً من مشاهد اليوم العاشر من المحرم، جاء فيها:
«حدَّثني من شهد الحسين في عسكره أن حسيناً حين غلب على عسكره ركب المسناة يريد الفرات، قال: فقال رجل من بني أبان بن دارم: ويلكم حولوا بينه وبين الماء، لا تتامَّ إليه شيعته»([844]).
إن ذكر هذه الملاحظة «لا تتامّ إليه شيعته» سبباً للحيلولة بين الحسين وبين الماء تدل على أن قيادة الجيش الأُموي كانت تتوقع قدوم نجدات موالية للحسين، وكانت تقوم على الشاطىء بحصار حقيقي يتجاوز الحيلولة دون الماء إلى الحيلولة دون عبور قوات موالية للحسين كانت فيما يبدو جاهزة للعبور، ولعلها كانت من الأسديين الذين فشلوا في الوصول إلى معسكر الحسين حين قادهم حبيب بن مظاهر.
منْ هُم؟
فيما يلي نستعرض أسماء الشهداء الذين حفظ التاريخ أسماءهم، باذلين كل جهد ممكن في سبيل التعرف على شخصيتهم، وقبائلهم، وأوضاعهم الاجتماعية.
هذا مع التنبيه إلى أن العدد قد لا يكون دقيقاً تماماً، فقد تكون ثمة أسماء لم تصل إلينا نتيجة لإهمال المؤرخين والرواة، وقد يكون ثمة رجال تكرر ذكرهم مرتين نتيجة لذكرهم مرة بالاسم وأخرى بالكنية أو باللقب، دون أن تكون لدينا وسيلة لمعرفة اسم صاحب اللقب أو الكنية أو كنية ولقب صاحب الاسم، ولكننا واثقون من أن إمكانية الخطأ من هذه الجهة محدودة جداً.
والتصحيف في الأسماء والألقاب والنَّسب، والخطأ في ذلك عند المؤلفين القدماء والنساخ هو أكبر الآفات التي تواجهنا في استعراض أسماء الشهداء والتحقق من شخصياتهم. ومن هنا، فإننا حرصاً منا على الدقة وضعنا جدولين أحدهما بأسماء الشهداء رضوان الله عليهم، والآخر بأسماء الرجال الذين يفترض أنهم من شهداء كربلاء. الجدول الأول أثبتنا فيه أسماء الشهداء الذين ورد ذكرهم في الزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة، لأنها أقدم وثيقة تشتمل على ما يفترض أنه جميع الشهداء ـ ونحن نعتبرها كوثيقة تاريخية فقط، لأن صفتها الدينية غير ثابتة كما ذكرنا، كما أننا أثبتنا في هذا الجدول أسماء الشهداء الذين لم يرد ذكرهم في الزيارة، ولكن ذكروا في أحد المصادر الأساسية الأخرى كرجال الشيخ أو الطبري، وكذلك الذين ذكروا في مصدرين اثنين من المصادر الثانوية بعد التأكد من عدم أخذ إحداهما عن الآخر أو في مصدرين اثنين نص أحدهما على الأقل على استشهاد المسمى، وراعينا أن يكون أحد المصدرين من المصادر الأساس في الموضوع. والجدول الثاني يشتمل على ما تفرد به مصدر واحد من المصادر المتأخرة كالزيارة الرجبية أو كتاب ابن شهرآشوب أو كتاب مثير الأحزان، أو اللهوف وأمثالها.
وسنرى أن المعلومات المتاحة قليلة جداً، وحتى هذا القليل لا يتيسر الحصول عليه بسهولة نتيجة لإهمال المؤرخين من جهة ولتصحيف النساخ من جهة أخرى، هذا التصحيف الذي يضع اسماً مكان اسم ونسباً مكان نسب.
ولكن هذه الملعومات القليلة ستكون عظيمة القيمة إذا أحسنا تبويبها وقراءة دلالاتها، فسنرى أنها تكشف لنا عن أبعاد جديدة لهذه الثورة ما كنا لنصل إليها لولا دراسة ما يمكن الوصول إليه من حياة هؤلاء الرجال الأبطال.
سنتبع في عرض الأسماء الترتيب الأبجدي، ثم نوزعها فيما بعد تبعاً للفئات الاجتماعية، والقبلية، والجغرافية، والعنصرية التي تنتمي إليها.
* * *
1 ـ أسلم التركي، مولى الحسين (ع):
ورد ذكره عند الطبري باسم «سليمان»([845]). وفي الزيارة([846]) وعند السيد الأمين. وذكره الشيخ في الرجال، فقال: «سليم، مولى الحسين (ع)، قتل معه»([847]).
نرجح أن الذي قتل في كربلاء اسمه أسلم وليس سليمان أو سليماً.
ذكره الشيخ في الرجال، ولم ينص على مقتله. وذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة في جدوله، وفي المقتل قال: «.. وخرج غلام تركي كان للحسين (ع) اسمه أسلم»([848]).
وذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث([849]).
ومن المؤكد أن هذا هو مراد الذين عبروا بـ«.. ثم خرج غلام تركي كان للحسين..»([850]) دون أن يذكروا اسمه.
وأما سليمان فقد كان مولى للحسين أيضاً. وكان رسوله إلى أهل البصرة، وسلمه أحد من أرسل إليهم من زعماء البصرة، وهو المنذر بن الجارود العبدي، إلى عبيدالله بن زياد، عامل يزيد بن معاوية على البصرة حينذاك، فقتله، وسليمان هذا يكنى أبا رزين([851]).
وصف أسلم هذا في المصادر بأنه (قارىء للقرآن، عارف بالعربية) ووصف بأنه كان كاتباً.
مولى، لا نعرف عنه شيئاً آخر.
2 ـ أنيس بن الحارث الكاهلي:
ذكره الشيخ في الرجال في عداد صحابة رسول الله (ص) ونص على أنه قتل مع الحسين.
وذكره في عدد أصحاب الحسين دون أن ينص على مقتله([852]).
وذكره السيد الخوئي([853]) ونرجح أنه متحد مع (أنس بن كاهل الأسدي) الذي ذكر في الزيارة والرجبية وعده سيدنا الأستاذ عنواناً مستقلاً([854]) فإن الكاهلي أسدي، وابن كاهل نسبة إلى العشيرة.
وذكره ابن شهرآشوب والخوارزمي مصحفاً بـ(مالك بن أنس الكاهلي)([855]).
وذكره في البحار مصحفاً بـ(مالك بن أنس المالكي) وصححه بعد ذلك عن ابن نما الحلي([856]).
الكاهلي: بنو كاهل من بني أسد بن خزيمة. من عدنان، (عرب الشمال).
شيخ كبير السن: لا بد أن يكون ذا منزلة اجتماعية عالية بحكم كونه صحابياً. يبدو أنه من الكوفة، فقد ذكر ابن سعد أن منازل بني كاهل كانت في الكوفة([857]).
3 ـ أنيس بن معقل الأصبحي:
ذكره ابن شهرآشوب([858]) والخوارزمي([859]) وذكره السيد الأمين.
الأصبحي: الأصابح، من القبائل القحطانية (يمن، عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
4 ـ أم وهب بنت عبد:
سيدة من النمر بن قاسط. زوجة عبدالله بن عمير الكلبي، من بني عُليم. أخبر زوجته أم وهب بعزمه على المصير إلى الحسين، فقالت له: «أصبت أصاب الله بك أرشد أُمورك، افعل وأخرجني معك» فخرج بها ليلاً حتى أتى حسيناً، فأقام معه.
ولما شارك زوجها في القتال وقتل رجلين من جند عمر بن سعد «أخذت أم وهب امرأته عموداً، ثم أقبلت نحو زوجها تقول له: فداك أَبي وأمي، قاتل دون الطيبين ذرية محمَّد. فأقبل إليها يردها نحو النساء، فأخذت تجاذب ثوبه، ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها حسين، فقال: جزيتم من أهل بيت خيراً، ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهن، فإنه ليس على النساء قتال، فانصرفت إليهن».
وخرجت إلى زوجها بعد أن استشهد حتى جلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقول: هنيئاً لك الجنة. فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام يسمى رستم: اضرب رأسها بالعمود، فضرب رأسها فشدخه، فماتت مكانها».
(الطبري: 5/429 ـ 430 و436 و438).
5 ـ بُرير بن خُضَيْر الهمداني:
ذكره الطبري([860]) وابن شهرآشوب([861]) وابن طاووس([862]) والمجلسي في بحار الأنوار مصحفاً بـ(بدير بن حفير)([863]) وورد ذكره في الرجبية. وقد أورد السيد الخوئي (3/289): «برير بن الحصين» وأسنده إلى الرجبية، والظاهر أن نسخة السيد مصحفة: خضير = حصين.
بذل محاولة لصرف عمر بن سعد عن ولائه للسلطة الأُموية.
وصف في المصادر بأنه «سيد القراء» وكان شيخاً، تابعياً، ناسكاً، قارئاً للقرآن، ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الهمدانيين شرف وقدر.
يبدو أنه كان مشهوراً ومحترماً في مجتمع الكوفة([864]).
همداني: من شعب كهلان، (اليمن، عرب النوب) موطنه الكوفة.
6 ـ بشير بن عمرو الحضرمي:
ذكره الطبري، أحد آخر رجلين بقيا من أصحاب الحسين قبل أن يقع القتل في بني هاشم، والآخر هو (سويد بن عمرو بن أبي المطاع)([865]). وذكر في الرجبية وذكر في الزيارة مصحفاً بـ(بشر بن عمر الحضرمي)([866]) وعند السيد الأمين (بشر بن عبدالله الحضرمي).
وذكره السيد الخوئي مردداً بين بشر وبشير([867]) ومن المؤكد أنه هو «محمَّد بن بشير الحضرمي» الذي ورد ذكره عند السيد ابن طاووس السيد بقرينة ذكره لقصة ابنه([868]) وقد وردت القصة في الزيارة مقرونة باسم بشر أو بشير ـ على اختلاف النسخ.
الحضرمي: من حضرموت، قبيلة من القحطانية، وبها عرفت مقاطعة حضرموت. أو من بني الحضرمي، فخذ من الظبي، من يافع، إحدى قبائل اليمن. وكان عداد بشير هذا في كندة وهي قبيلة يمنية أيضاً (يمن، عرب الجنوب).
لا نعرف عنه شيئاً آخر.
7 ـ جابر بن الحارث السلماني:
هكذا ورد اسمه عند الطبري([869]) وذكره الشيخ الطوسي مصحفاً (جنادة بن الحرث السلماني)([870]) وكذلك عند السيد الأمين. وعده السيد الخوئي بعنوان جنادة تبعاً للشيخ (معجم الرجال 4/166).
وذكر: «حيان بن الحارث السلماني الأزدي» بعنوان مستقل (معجم رجال الحديث: 6/308).
وذكر اسمه في الزيارة مصحفاً بـ«حباب بن الحارث السلماني الأزدي)([871]) وفي النسخة الأخرى (حيان…).
وفي الرجبية نسخة البحار (حيان بن الحارث) وفي نسخة الإقبال (حسان بن الحارث) ولعل الجميع واحد. وعند ابن شهرآشوب: (حباب بن الحارث) في عداد قتلى الحملة الأولى([872]).
من شخصيات الشيعة في الكوفة. اشترك في حركة مسلم بن عقيل، وتوجه إلى الحسين ـ بعد فشل الثورة في الكوفة ـ مع جماعة، والتقوا مع الحسين قبيل وصوله إلى عمر، فأراد الحر بن يزيد الرياحي منعهم من اللحاق بالحسين، ولم يفلح في منعهم، ويأتي ذكر بقيتهم.
السلماني: من مراد، ثم من مذحج. (يمن، عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
8 ـ جبلة بن علي الشيباني:
ذكر في الزيارة([873]) وذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([874]). ولعله متحد مع جبلة بن عبدالله، الذي ورد ذكره في الرجبية. وقد ذكرهما السيد الخوئي في عنوانين (معجم الرجال 4؛ 34) اشترك في حركة مسلم بن عقيل في الكوفة.
الشيباني: من شيبان، من العدنانية (عرب الشمال).
9 ـ جنادة بن الحارث الأنصاري:
ذكره ابن شهرآشوب([875]) والخوارزمي. (جنادة بن الحرث)([876]). وبحار الأنوار([877]).
الأنصاري: (يمن، عرب الجنوب).
لا نعرف عنه شيئاً آخر.
10 ـ جندب بن حجير الخولاني:
ذكره الشيخ دون أن ينص على مقتله([878])، وذكر في الزيارة (جندب بن حجر الخولاني)([879]).
وذكر في الرجبية (جندب بن حجير) وبهذا العنوان ورد عند السيد الخوئي (معجم الرجال 4/173) وذكره السيد الأمين.
خولان: بطن من كهلان، من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
11 ـ جون مولى أبي ذر الغفاري:
ورد ذكره في الرجبية.
وذكر في بحار الأنوار والزيارة باسم (جون بن حوي مولى أَبي ذر الغفاري)([880]) وذكره الشيخ دون أن ينص على مقتله([881]). وذكره الخوارزمي([882]) وذكره الطبري باسم (حوي)([883]). ذكره ابن شهرآشوب مصحفاً باسم (جوين أبي مالك مولى أبي ذر الغفاري)([884]).
من الموالي، أسود اللون، شيخ كبير السن.
لا نعرف عنه شيئاً آخر.
12 ـ جوين بن مالك الضبعي:
ذكره الشيخ في عداد أصحاب الحسين ولم ينص على مقتله([885]).
وذكر في الزيارة في عداد الشهداء تارة بهذا الاسم وأخرى باسم (حوي بن مالك الضبعي). وقع الخلط عند البعض بينه وبين جون مولى أبي ذر.
ذكر أيضاً في الرجبية إلاَّ أنه ورد فيها بعنوان (جوير بن مالك) ونرجح أنه جوين بن مالك الضبعي ـ وأنه صحف تارة باسم حوي، وأخرى باسم جوير.
ذكر أنه كان من جنود عمر بن سعد ثم تحول إلى الحسين وقاتل معه، وقتل في الحملة الأولى.
الضبعي: ضبع بن وبرة، بطن من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
لا نعرف عنه شيئاً آخر.
13 ـ حبيب بن مظاهر الأسدي:
ذكرته جميع المصادر. من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب، وكان من شرطة الخميس. جعله الحسين على ميسرة أصحابه عند التعبئة للقتال. تقدم أنه بذل محاولة لاستقدام أنصار من بني أسد، وحال الجيش الأُموي دون وصولهم إلى معسكر الحسين. وهو أحد الزعماء الكوفيين الذين كتبوا إلى الحسين([886]) كان معظماً عند الحسين: «لما قتل حبيب ابن مظاهر هدَّ ذلك حسيناً، وقال عند ذلك: احتسب نفسي وحماة أصحابي»([887]).
كان شخصية بارزة في مجتمع الكوفة.
الأسدي: عدنان (عرب الشمال).
14 ـ الحجاج بن زيد السعدي:
ذكر في الزيارة([888]) وذكره السيد الأمين (الحجاج بن بدر السعدي).
وفي الرجبية (حجاج بن يزيد).
وذكره السيد الخوئي بعنوان (الحجاج بن يزيد ـ 4/240) وذكر أنه ورد بهذا العنوان في الزيارة وهو مخالف ما في طبعة البحار الجديدة وموافق لنسخة الإقبال.
حمل كتاباً من مسعود بن عمرو الأزدي إلى الحسين جواباً على كتاب من الحسين إليه وإلى غيره من زعماء البصرة يدعوهم إلى نصرته.
بصري ـ من بني سعد بن تميم من عدنان (عرب الشمال).
لا نعرف عنه شيئاً آخر.
15 ـ الحجاج بن مسروق الجعفي:
ورد ذكره في الطبري([889]) وفي الزيارة وبحار الأنوار([890]) وذكره الخوارزمي([891]).
وذكر فر الرجبية.
وذكره ابن شهرآشوب([892]) وصحفه الشيخ (الحجاج بن مرزوق)([893]) وبهذا العنوان ذكره السيد الخوئي (معجم الرجال: 4/239) وذكر السيد الخوئي الحجاج بن مسروق الجعفي تحت عنوان مستقل (4/239 ـ 240) والظاهر اتحادهما. خرج من الكوفة إلى مكة فلحق بالحسين في مكة وصحبه منها إلى العراق. أمره الحسين بالأذان لصلاة الظهر عند اللقاء مع الحر بن يزيد. وصف في بعض المصادر بأنه «مؤذن الحسين».
كوفي.
الجعفي: نسبة إلى جعفي بن سعد العشيرة، من مذحج، من القحطانية.
(يمن، عرب الجنوب).
16 ـ الحر بن يزيد الرياحي اليربوعي التميمي:
ذكرته جميع المصادر. وتكرر ذكره في الرجبية فذكر في أولها وفي أواخرها.
من الشخصيات البارزة في الكوفة. أحد أمراء الجيش الأُموي في كربلاء، وكان يقود فيه ربع تميم وهمدان([894]) التقى مع الحسين عند جبل ذي حُسُم، وهو يقود ألف فارس وجهه أميراً عليهم عبيدالله بن زياد لاعتراض الحسين([895]).
تاب قبل نشوب المعركة، ولحق بمعسكر الحسين، وقاتل وقتل معه([896]).
توحي لهجة بعض كتب المقتل بأن الحر كان متعاطفاً مع الثورة منذ لقي الحسين([897]).
ونحن نشك في ذلك، ونرجح أن هذه اللهجة نتيجة لتأثر كتاب المقتل بالموقف النفسي الذي تولد نتيجة لتحول الحر في النهاية إلى جانب الثورة.
تتحدَّث بعض المراجع ذات القيمة الثانوية عن أن ولاء الحر للثورة، وتحوله إلى صفوفها أثر على موقف ابنه (علي بن الحر)، وأخيه (مصعب بن يزيد)، وغلامه (عروة)، ولم يثبت لدينا ذلك([898]).
الرياحي: بطن من يربوع، من تميم، عدنان (عرب الشمال). كوفي. يبدو أنه إلى الشباب أقرب.
17 ـ الحلاس بن عمرو الراسبي:
ذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([899]) وذكره الشيخ مصحفاً:
(الحلاش) ولم يشر إلى مقتله([900]). وفي الرجبية: (حلاس بن عمرو) وبهذا العنوان ذكره السيد الخوئي. (معجم الرجال: 4/144) وفي (ج6 ص189 من معجم الرجال) ذكر سيدنا الأستاذ: «جلاس بن عمرو الهجري» والظاهر أنه يعتبره رجلاً آخر غير جلاس بن عمرو والظاهر عندنا اتحادهما. والهجري نسبة إلى هجر في اليمن لا ينافي النسبة إلى راسب.
ذكر أنه كان على شرطة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الكوفة. وأنه وأخاه النعمان كانا مع عمر بن سعد ثم تحولا إلى معسكر الحسين. يأتي ذكر أخيه في عداد الشهداء.
الراسبي: راسب بن مالك بطن من شنوءة، من الأزد من القحطانية: كوفي (يمن، عرب الجنوب).
18 ـ حنظلة بن أسعد الشبامي:
هكذا ذكر في الزيارة والرجبية في نسخة البحار، وفي الإقبال (سعد)، وفي نسخة البحار وفي الإقبال (الشيباني) وبحار الأنوار([901]) وذكره الخوارزمي([902]) والطبري([903]) والشيخ([904]) وذكره السيد الأمين.
الشبامي: شبام بطن من همدان، من القحطانية (يمن، عرب الجنوب) كوفي.
19 ـ خالد بن عمرو بن خلد الأزدي:
ذكره ابن شهرآشوب([905]) والخوارزمي([906]) وبحار الأنوار([907]).
الأزدي: من الأزد (يمن، عرب الجنوب) من الشبان.
لا نعرف عنه شيئاً آخر.
20 ـ زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي:
ذكره الشيخ([908]) وابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([909]) وذكره في الرجبية وذكر في الزيارة في إحدى نسختيها مصحفاً: «زاهد مولى عمرو بن الحمق الخزاعي»([910]). وذكر في النسخة الأخرى (زاهر..).
ذكره السيد الخوئي (معجم رجال الحديث: 7/215) وقال نقلاً عن النجاشي في ترجمة محمَّد بن سنان أن زاهراً هذا هو جد محمَّد بن سنان. وهو من أصحاب الإمامين موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا، وهو ضعيف جداً.
وقد ذكر في المصادر خطأ باسم (زاهر بن عمرو الكندي) من الكوفة. من شخصيات الكوفة. شيخ كبير السن.
من موالي كندة.
21 ـ زهير بن بشر الخثعمي:
هكذا ذكر في الزيارة في نسخة البحار([911])، وفي نسخة الإقبال (زهير بن سليم الأزدي) وذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([912]) ونرجح اتحاده مع زهير بن سليم الأزدي الذي ذكره ابن شهرآشوب أيضاً في عداد قتلى الحملة الأولى وفي الرجبية: «زهير بن بشير».
الخثعمي: خثعم بن أنمار بن أراش، قبيلة من القحطانية، (يمن، عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
22 ـ زهير بن القين البجلي:
ذكر في جميع المصادر. في الزيارة ذكر بتكريم خاص([913]) وذكر في الرجبية. انضم إلى الحسين في الطريق من مكة إلى العراق بعد أن كان كارهاً للقائه([914]) خطب في جيش ابن زياد قبيل المعركة([915]) جعله الحسين على ميمنة أصحابه([916]).
شخصية بارزة في المجتمع الكوفي. يبدو أنه كان كبير السن.
بجلي: بجيلة هم بنو أنمار بن أراش بن كهلان، من القحطانية. (يمن، عرب الجنوب).
23 ـ زيد بن معقل الجعفي:
هكذا ذكر في الزيارة في الإقبال. وفي النسخة الأخرى من الزيارة «بدر بن معقل الجعفي» وبهذا الاسم ذكره السيد الخوئي (معجم رجال الحديث: 3/266).
وذكره الشيخ دون أن ينص على شهادته([917]) ونعتقد أنه متحد مع (منذر بن المفضل الجعفي) الذي ورد ذكره في الرجبية.
جعفي: من مذحج (يمن، عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
24 ـ سالم مولى بني المدنية الكلبي:
ذكر في الزيارة([918]).
بنو المدنية بطن من كلب بن وبرة، من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
مولى. لا نعرف عنه شيئاً.
25 ـ سالم مولى عامر بن مسلم العبدي:
ذكر في الزيارة([919]). وذكره السيد الأمين.
العبدي: من عبدالقيس، من عدنان (عرب الشمال).
مولى، من البصرة، لا نعرف عنه شيئاً آخر.
26 ـ سعد بن حنظلة التميمي:
ذكره ابن شهرآشوب([920]) وبحار الأنوار([921]).
وقد استظهر التُسْتَري في قاموس الرجال([922]) أن هذا هو حنظلة بن أسعد الشبامي المتقدم ذكره، واستدل بأن ابن شهرآشوب لم يذكر حنظلة المتفق عليه وهو الشبامي. ونرجح أن سعداً هذا غير حنظلة ذاك لأن غير ابن شهرآشوب قد ذكر سعداً وهو محمَّد بن أبي طالب الهاشمي في مقتله كما نقل ذلك المجلسي في البحار. وأن ذاك شبامي من عرب الجنوب، وهذا تميمي من عرب الشمال. والتصحيف في هذه الحالة بعيد جداً.
تميمي، من عدنان (عرب الشمال) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
27 ـ سعد بن عبدالله، مولى عمرو بن خالد:
ذكره الشيخ([923]) والطبري([924]) وذكر في الزيارة باسم (سعيد)([925]).
والظاهر أنه هو الذي ذكر في الرجبية بعنوان (السلام على عمرو بن خلف وسعيد مولاه) وخلف تصحيف خالد.
لحق بالحسين مع مولاه عمرو بن خالد الأسدي الصيداوي وآخرين فانتهوا إلى الحسين وهو بعذيب الهجانات بعد لقائه مع الحر بن يزيد الرياحي وقبيل وصوله إلى كربلاء، وقد أراد الحر منعهم من اللحاق بالحسين فلم يتمكن من ذلك.
مولى: لا نعرف عنه شيئاً آخر.
28 ـ سعيد بن عبدالله الحنفي:
ذكره الطبري([926]) والخوارزمي([927]) وابن شهرآشوب([928]) والرجبية وذكر في الزيارة باسم (سعد..)([929])، وذكره ابن طاووس([930]).
أحد الرسل الذين حملوا رسائل الكوفيين إلى الحسين([931]) من أعظم الثوار تحمساً.
الحنفي: من حنيفة بن لجيم، من بكر بن وائل. عدنان (عرب الشمال).
29 ـ سوار بن منعم بن حابس الهمداني النهمي:
ذكره الشيخ([932]) وابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى، وصحفه هكذا: (سوار بن أَبي عمير النهمي)([933]) وذكر في الزيارة باسم (سوار بن أَبي حمير النهمي)([934]). سيدنا الأستاذ: «سوار بن أَبي عمير ـ و: سوار بن المنعم: معجم رجال الحديث: 8/322) وعدَّهما رجلين، والظاهر الاتحاد، والتعدد جاء من قبل التصحيف في الأصول.
أتي به أسيراً إلى عمر بن سعد، وتوفي متأثراً بجراحه بعد ستة أشهر.
النهمي: نهم بن عمرو، بطن من همدان، من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
30 ـ سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي:
ذكره الطبري([935]) والشيخ([936]) وقال عنه في بحار الأنوار «وكان شريفاً كثير الصلاة»([937]) وذكره ابن شهرآشوب مصحفاً (عمرو بن أبي المطاع الجعفي)([938]).
هو أحد آخر رجلين بقيا مع الحسين([939]) وقتل بعد مقتل الحسين: كان بين القتلى وبه رمق، فلما سمع الناس يقولون: قتل الحسين.. «.. فوجد إفاقة فإذا معه سكين، وقد أخذ سيفه، فقاتلهم بسكينه ساعة، ثم أنه قتل.. وكان آخر قتيل»([940]).
الخثعمي: خثعم بن أنمار بن أراش، قبيلة من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
31 ـ سيف بن الحارث بن سُرَيْع الجابري:
ذكره الطبري([941]) والخوارزمي([942]) وذكره في الزيارة مصحفاً: (شبيب بن الحارث)([943]) وفي الرجبية: «سيف بن الحارث».
يأتي ذكر ابن عمه وأخيه لأمه (مالك بن عبد بن سريع).
الجابري: من بني جابر، بطن من همدان. من كهلان (يمن، عرب الجنوب).
يبدو أنه من الشبان.
32 ـ سيف بن مالك العبدي:
ذكره في الزيارة: (سيف بن مالك)([944]) وكذا في رجال الشيخ([945]) وذكره ابن شهرآشوب باسم (سيف بن مالك النميري)([946]) في عداد قتلى الحملة الأولى.
وفي الرجبية: «سفيان بن مالك».
كان سيف هذا من جملة الرجال الذين يجتمعون في بيت مارية بنت منقذ العبدية في البصرة التي كانت دارها مألفاً للشيعة([947]).
عبدي: من عبدالقيس، من العدنانية (عرب الشمال).
33 ـ حبيب بن عبدالله النهشلي:
ذكره الشيخ([948]) وذكر في الزيارة([949]) وفي الرجبية. ربما يكون متحداً مع أبي عمرو النهشلي الذي تفرد بذكره ابن نما الحلي في مثير الأحزان.
النهشلي: بنو نهشل بن دارم من تميم، من عدنان (عرب الشمال).
34 ـ شوذب مولى شاكر بن عبدالله الهمداني الشاكري:
ذكره الطبري([950]) والشيخ([951]) والخوارزمي([952]) وذكره في الزيارة([953]) وذكر في الرجبية (سويد مولى شاكر).
كان من رجال الشيعة ووجوههم، من أعظم الثوار إخلاصاً وحماساً.
شيخ كبير، مولى، يحسب في عرب الجنوب.
35 ـ ضرغامة بن مالك:
ذكره الشيخ([954]) وابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([955]) وذكره في الزيارة([956]) وفي الرجبية.
لم ينسب إلى قبيلة. لا نعرف عنه شيئاً.
36 ـ عابس بن أَبي شبيب الشاكري:
ذكره الطبري([957]) والشيخ([958]) والخوارزمي([959]) والزيارة([960]) والرجبية، وفيها: (ابن شبيب).
من رجال الشيعة، كان رئيساً، شجاعاً، خطيباً، ناسكاً متهجداً. وكان من أعظم الثوار، إخلاصاً وحماساً.
كان واعياً، لمح في كلامه مع مسلم بن عقيل، إلى أنه ليس واثقاً من الناس، ولكنه، مع ذلك، مصمم على الثورة([961]).
أرسله مسلم بن عقيل إلى الحسين بالرسالة التي أخبره فيها ببيعة أهل الكوفة، ودعاه إلى القدوم، وذلك قبل الانقلاب المضاد([962]).
الشاكري: بنو شاكر من جذام، من القحطانية (يمن، عرب الجنوب) كوفي. شخصية بارزة.
37 ـ عامر بن حسان بن شريح الطائي:
ذكره النجاشي في ترجمة حفيده (أحمد بن عامر)، وصرح بأنه «هو الذي قتل مع الحسين بن علي (ع) بكربلاء»([963]) وذكر مصحفاً باسم (عمار بن حسان بن شريح الطائي) عند الشيخ([964]) وذكر في الزيارة([965]) والرجبية وذكره ابن شهرآشوب في عداد الذين قتلوا في الحملة الأولى([966]) صحب الحسين من مكة.
طائي: (يمن، عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
38 ـ عامر بن مسلم:
هكذا ورد في الزيارة([967]) والرجبية وعند ابن شهرآشوب([968]) في عداد قتلى الحملة الأولى، والشيخ([969]) وقال عنه أنه مجهول. نسبه السيد الأمين، فقال: «العبدي» ونسبه بحر العلوم في هامش رجال الشيخ فقال: «السعدي».
السعدي، أو العبدي (من عبد القيس) كلتا النسبتين في عدنان (عرب الشمال).
من البصرة: لا نعرف عنه شيئاً آخر.
39 ـ عبدالرحمن بن عبدالله بن الكُدَر (الكدن) الأرحبي:
ذكر في الطبري (الكدن)([970]) وعند ابن شهرآشوب (الكدر) في عداد قتلى الحملة الأولى([971]) والزيارة([972])، والشيخ([973]).
من حملة رسائل أهل الكوفة إلى الحسين([974]) كان في الكوفة مع مسلم بن عقيل.
أرحب: قبيلة كبيرة من همدان، من القحطانية. (يمن، عرب الجنوب).
40 ـ عبدالرحمن بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي:
ذكره الطبري([975]) والشيخ، ونسبه إلى الخزرج([976]) وبحار الأنوار([977]) وذكره ابن طاووس (اللهوف/ ص: 40) وهو أحد الذين كانوا يأخذون البيعة للحسين في الكوفة. يبدو أنه إحدى الشخصيات البارزة.
خزرجي (يمن، عرب الجنوب) من الكوفة. لا نعرف عنه شيئاً آخر.
41 ـ عبدالرحمن بن عبدالله اليزني:
ذكره ابن شهرآشوب([978]) والخوارزمي([979]) وبحار الأنوار([980]).
نرجح أنه هو الذي ورد في الرجبية باسم «عبدالرحمن بن عبدالله الأزدي» خلافاً للسيد الخوئي الذي رأى اتحاده مع (عبدالرحمن بن عبدالله بن الكدن الأرحبي) (معجم رجال الحديث: 9/349).
اليزني: من يزن، بطن من حمير (يمن، عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
42 ـ عبدالرحمن بن عروة الغفاري:
ذكره الخوارزمي([981]) وبحار الأنوار([982]). ربما يكون أحد الأخوين الغفاريين ابني عرزة بن حراق. والذي حملنا على ترجيح كونه رجلاً آخر أن الخوارزمي ومحمَّد بن أبي طالب الموسوي الذي روى عنه المجلسي في البحار ذِكر هذا الشهيد قد ذكرا الأخوين الغفاريين بعد ذكرهما لهذا. والمصادر كلها تذكر الأخوين الغفاريين معاً، وتذكر أنهما أستأذنا في القتال معاً، وقاتلا معاً حتى قتلا، ولم تذكر المصادر كل واحد منهما على انفراد. بينما ذكر الخوارزمي والمجلسي في البحار (في موضعين) هذا الشهيد وحده، ونسب إليه رجزاً يقول فيه: «قد علمت حقاً بنو غفار».
الغفاري: من غفار بن مُلَيل، بطن من كنانة، من العدنانية (عرب الشمال).
43 ـ عبدالرحمن بن عرزة بن حراق الغفاري:
ذكره الطبري([983]) والشيخ([984]) والبحار والزيارة([985]) إلاَّ أن فيها: «ابني عروة بن حراق» والخوارزمي([986]). والرجبية.
كان جده (حراق) من أصحاب أمير المؤمنين، حارب معه في الجمل، والنهروان وصفين.
من أشراف الكوفة. شاب. (عرب الشمال).
44 ـ عبدالله بن عرزة بن حراق الغفاري:
ذكر في المصادر حيث ذكر أخوه عبدالرحمن (رقم: 43) والسِّمات واحدة.
45 ـ عبدالله بن عمير الكلبي:
ذكره الطبري([987]) وابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى: (عبدالله بن عمير)([988]) والخوارزمي([989]) وبحار الأنوار([990]) والزيارة([991]). والرجبية.
من بني عليم، توجه من الكوفة إلى الحسين مع زوجته أم وهب بنت عبد بن النمر بن قاسط، حين رأى ابن زياد يعرض الجند لإرسالهم إلى حرب الحسين. واستشهدت زوجته بعد قتله، وكان القتيل الثاني من أصحاب الحسين.
شاب، مقاتل شديد المراس من الكوفة. من أعظم الثوار حماساً.
بنو عليم بن جنَّاب: بطن من كنانة عذرة، من قضاعة، وكلب من قضاعة، من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
46 ـ عبدالله بن يزيد بن نبيط (ثبيت) العبدي:
ذكره الطبري([992]) وابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([993])، إلاَّ أنه قال عنه (ابن زيد).
في الزيارة([994]) وي الرجبية: «السلام على بدر بن رقيط وابنيه عبدالله، وعبيدالله».
خرج مع أبيه زيد بن نبيط من البصرة، حين تلقى البصريون كتاباً من الحسين يدعوهم فيه إلى نصرته([995]).
العبدي: من عبد القيس. عدنان (عرب الشمال) شاب. بصري.
47 ـ عبيدالله بن يزيد بن نبيط (ثبيت) العبدي:
أخو عبدالله المذكور أعلاه. ذكر حيث ذكر أخوه. والسِّمات واحدة.
48 ـ عمران بن كعب بن حارث الأشجعي:
ذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([996])، والشيخ «عمران بن كعب»([997]) وفي الرجبية: «عمر بن أَبي كعب» والظاهر أن الكل واحد والاختلاف نتيجة التصحيف.
أشجع، قبيلة من غطفان، من قيس عيلان (عدنان. عرب الشمال). لا نعرف عنه شيئاً آخر.
49 ـ عمار بن أبي سلامة الدالاني:
ذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([998]) والزيارة، إلاَّ أن فيها «الهمداني»([999]).
دالان: بطن من همدان من القحطانية. (يمن، عرب الجنوب) كانوا يسكنون الكوفة.
50 ـ عمار بن حسان بن شريح الطافي:
ورد ذكره في الزيارة، وفي الرجبية ورد ذكره «عمار بن حسان».
51 ـ عمرو بن جنادة بن الحارث الأنصاري:
ذكره ابن شهرآشوب([1000]) والخوارزمي([1001]) والبحار([1002]). ونعتقد أن عمرواً هذا هو الشاب الذي قتل أبوه في المعركة فأمرته أمه أن يتقدم ويقاتل وكره الحسين ذلك قائلاً: «هذا شاب قتل أبوه، ولعل أمه تكره خروجه فقال الشاب: أمي أمرتني..»([1003])، فإن ملابسات الموقفين واحدة، وليس من الطبيعي أن يكونا رجلين، ثم لا نعرف اسم الشاب ولا اسم أبيه. هل هو (عمر (عمير) ابن كناد) الذي ورد ذكره في الرجبية؟
(يمن، عرب الجنوب). شاب.
52 ـ عمر بن جندب الحضرمي:
الزيارة([1004]) وفي النسخة الأخرى: «بن الأحدوث».
من حضرموت، قبيلة من القحطانية. أو من بني الحضرمي، إحدى قبائل اليمن. (يمن، عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
53 ـ عمرو بن خالد الأزدي:
ذكره بن شهرآشوب، والبحار([1005]) والخوارزمي([1006]) وقد حكم التستري في قاموس الرجال بأن هذا متحد مع صاحب الاسم التالي «عمر بن خالد الصيداوي» ذاهباً إلى أن (الأزدي) مصحف أو محرف عن (الأسدي) وكنا قد رجحنا ذلك في أول الأمر قبل الاطلاع على كتاب التستري، ثم ترجح في نظرنا التعدد، وإن كان احتمال الاتحاد وارداً.
من الأزد: (يمن، عرب الجنوب) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
54 ـ عمر بن خالد الصيداوي:
ذكره الطبري([1007]) وذكر في الزيارة([1008]) وبحار الأنوار([1009]) والخوارزمي([1010]). وفي الرجبية «عمرو بن خلف» ويحتمل أنه تصحيف خالد([1011]).
بنو الصيداء بطن من أسد، من العدنانية (عرب الشمال).
55 ـ عمرو بن عبدالله الجندعي:
ذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1012]) والزيارة([1013]).
الجندعي: من جندع بن مالك، بطن من همدان (يمن، عرب الجنوب).
56 ـ عمرو بن ضبيعة الضبعي:
ذكره الشيخ([1014]) وابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى (عمر بن مشيعة) مصحفاً([1015]) والزيارة([1016]). وفي الرجبية، «ضبيعة بن عمر» مقلوباً.
ضبع بن وبرة، بطن من قضاعة من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
57 ـ عمرو بن قرضة بن كعب الأنصاري:
ذكره الطبري([1017]) وابن شهرآشوب([1018]) والزيارة([1019]) والبحار([1020]) والخوارزمي([1021]) وقد ورد في الزيارة (عمر بن كعب الأنصاري) وفي نسختها الأخرى (عمران..) كما ورد فيها عمرو بن قرضة الأنصاري، وكذا ورد في الرجبية. والكل واحد.
أرسله الحسين مفاوضاً إلى عمر بن سعد (يمن، عرب الجنوب).
58 ـ عمر بن عبدالله (أبو ثمامة) الصائدي:
الزيارة([1022]) والطبري([1023]) وابن شهرآشوب([1024]) الرجبية، وورد في رجال الشيخ (عمرو بن ثمامة) مصحفاً وعند الخوارزمي([1025]) (أبو ثمامة الصيداوي) مصحفاً، وكذلك في بحار الأنوار([1026]).
كان هو الذي يقبض الأموال أيام مسلم في الكوفة، ويشتري السلاح، وكان من فرسان العرب ووجوه الشيعة([1027]) عقد له مسلم على ربع تميم وهمدان حين بدأ تحركه القصير الأجل ضد عبيدالله بن زياد([1028]).
صائد: بطن من همدان (يمن، عرب الجنوب).
59 ـ عمرو بن مطاع الجعفي:
ذكره ابن شهرآشوب([1029]) وبحار الأنوار([1030]) والخوارزمي([1031]) (يمن، عرب الجنوب).
60 ـ عمير بن عبدالله المذحجي:
ذكره ابن شهرآشوب([1032]) والخوارزمي([1033]) وبحار الأنوار([1034]) مذحج، من كهلان، من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
61 ـ قارب، مولى الحسين (ع):
ذكر في الزيارة([1035]).
مولى.
62 ـ قاسط بن زهير (ظهير) التغلبي:
ذكر في الزيارة([1036]) والرجبية وذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1037]) والشيخ([1038]) إلاَّ أنه قال (قاسط بن عبدالله).
تغلب بن وائل من القبائل العدنانية (عرب الشمال).
63 ـ قاسم بن حبيب الأزدي:
ذكر في الزيارة([1039]) وذكره الشيخ([1040]) وفي الرجبية «قاسم بن حبيب» كما ورد فيها «القاسم بن الحارث الكاهلي» ويحتمل أن يكون تكراراً مصحفاً للاسم الأول.
(يمن، عرب الجنوب).
64 ـ قرة بن أبي قرة الغفاري:
ذكره ابن شهرآشوب([1041]) والخوارزمي([1042]) وبحار الأنوار([1043]) وفي الرجبية في نسخة البحار «عثمان بن فروة الغفاري» وفي نسخة الإقبال «عثمان بن عروة..».
الغفاري، من العدنانية (عرب الشمال).
65 ـ قعنب بن عمرو النمري:
ذكر في الزيارة([1044]) (التمري).
النمر بن قاسط، من العدنانية (عرب الشمال).
66 ـ كردوس (كرش) بن زهير (ظهير) التغلبي:
ذكر حيث ذكر أخوه قاسط، والسِّمات واحدة.
67 ـ كنانة بن عتيق التغلبي:
ذكر في الزيارة([1045]) والرجبية وذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1046]) والشيخ([1047]).
تغلب بن وائل من العدنانية (عرب الشمال).
68 ـ مالك بن عبد بن سريع الجابري:
ذكر حيث ذكر أخوه (سيف بن الحارث بن سريع) والسِّمات واحدة. وفي الرجبية «مالك بن عبدالله الجابري».
69 ـ مجمع بن عبدالله العائذي المذحجي:
ذكره الطبري([1048]) وابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1049]) والزيارة([1050]) والرجبية.
مذحج من كهلان من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
70 و71 ـ مسعود بن الحجاج وابنه:
ذكرا في الزيارة([1051]) وذكر الأب وحده في الرجبية، وذكر ابن شهرآشوب الأب في عداد قتلى الحملة الأولى([1052]).
72 ـ مسلم بن عوسجة الأسدي:
ذكرته جميع المصادر. هو أول قتيل من أنصار الحسين، بعد قتلى الحملة الأولى([1053]) كان صحابياً ممن رأى رسول الله (ص) وروى عنه (؟) كان يأخذ البيعة للحسين في الكوفة. عقد له مسلم بن عقيل على ربع مذحج وأسد حين بدأ تحركه القصير الأجل([1054]).
شيخ كبير السن. شخصية أسدية كبرى، إحدى شخصيات الكوفة البارزة.
أبدى شبث بن ربعي (في الجيش الأُموي) أسفه لقتله.
الأسدي: عدنان (عرب الشمال).
73 ـ مسلم بن كثير الأزدي الأعرج:
ذكره الشيخ([1055]) وابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1056]) وورد ذكره في الزيارة مصحفاً (أسلم بن كثير الأزدي)([1057]) وورد في الرجبية «سليمان بن كثير» ونرجح اتحاده مع «مسلم بن كثير الأزدي الأعرج».
أزدي: (يمن، عرب الجنوب).
74 ـ منجح مولى الحسين:
قال التستري في قاموس الرجال نقلاً عن ربيع الأبرار للزمخشري أن أمه (أم منجح) حسينية كانت جارية له (ع) اشتراها من نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب، ثم تزوجها سهم (أبو منجح) فولدت له منجحاً ـ قاموس الرجال 8/120».
ذكره الطبري([1058]) والشيخ([1059]) وذكر في الزيارة([1060]) وذكر في الرجبية.
75 ـ نافع بن هلال الجملي:
ذكره الطبري([1061]) والشيخ([1062]) وفي الزيارة (البجلي) مصحفاً([1063]) وكذا عند ابن شهرآشوب([1064]). وذكر في الرجبية بدون نسبة شارك في جلب الماء مع العباس بن علي، كوفي. شخصية بارزة جملي: النسبة إلى جمل ابن سعد العشيرة من مذحج (يمن، عرب الجنوب).
76 ـ نعمان بن عمرو الراسبي:
ذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1065]) والشيخ([1066]) وذكر في الرجبية بدون نسبة.
راسب بطن من الأزد (يمن، عرب الجنوب).
77 ـ نعيم بن عجلان الأنصاري:
ذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1067]) والشيخ([1068])، وذكر في الزيارة([1069]) وذكر في الرجبية بدون نسبة.
(يمن، عرب الجنوب).
78 ـ وهب بن عبدالله جناب الكلبي:
ذكره ابن شهرآشوب: (وهب بن عبدالله الكلبي)([1070]) والخوارزمي: (وهب بن عبدالله بن جناب الكلبي)([1071]) وذكره في بحار الأنوار([1072]).
تتحدث المصادر عن أن أمه وزوجته كانتا معه، وفي بعضها أن زوجته قتلت، وعند الخوارزمي أن التي قتلت هي أمه، وفي بعضها أن اسمه (وهب بن وهب) وأنه كان نصرانياً فأسلم، وفي بعضها أنه أسر كما عند ابن شهرآشوب، وفي بعضها الآخر أنه قتل.
نرجح أن وهباً هذا هو ابن لأم وهب زوجة عبدالله بن عمير بن جناب الكلبي الذي تقدم ذكره، فقد قتلت زوجته (أم وهب بنت عبد) وهي عند زوجها بعدما قتل، فتكون المقتولة أم وهب كما عند الخوارزمي، لا زوجته.
(يمن، عرب الجنوب) كوفي ـ شاب.
79 ـ يحيى بن سليم المازني:
ذكره ابن شهرآشوب([1073]) والخوارزمي([1074]).
80 ـ يزيد بن الحصين الهمداني المشرقي القاري:
ذكره الشيخ([1075]) وورد ذكره في الزيارة([1076]).
(يمن، عرب الجنوب).
81 ـ يزيد بن زياد بن مهاصر أبو الشعثاء الكندي:
ذكره الطبري([1077]) وابن شهرآشوب([1078]) والخوارزمي([1079]) والزيارة وفيها (ابن المظاهر)([1080]) صحفته بعض المصادر فقالت (بن مهاجر).
اضطرب فيه كلام الطبري فمرة قال عنه أنه تحول إلى الحسين من معسكر ابن زياد بعدما رفضوا عروض الحسين، ومرة قال عنه أنه خرج إلى الحسين من الكوفة قبل أن يلاقيه الحر، وكذلك اضطرب فيه كلام السيد الأمين([1081]).
كوفي. (يمن، عرب الجنوب).
82 ـ يزيد بن نبيط (ثبيت العبدي):
ذكره الطبري([1082]) وصحف في الزيارة: (يزيد بن ثبيت القيسي)([1083]).
وذكر في الرجبية باسم (بدر بن رقيط) وذكره سيدنا الأستاذ باسم (بدر بن رقيد ـ معجم رجال الحديث: 3/ 266).
قدم إلى الحسين مع ولديه عبدالله وعبيدالله من البصرة إلى مكة، بعد أن وصل كتاب الحسين إلى أشرافها.
كان منظوياً في جماعة شيعية في البصرة.
العبدي: من عبد القيس (عرب الشمال).
الجدول الثاني
1 ـ إبراهيم بن الحصين الأزدي:
ذكره ابن شهرآشوب([1084]). ونسب إليه رجزاً يغلب على الظن أنه موضوع.
وذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة.
الأسدي: من عدنان (عرب الشمال) لا نعرف عنه شيئاً آخر.
2 ـ أبو عمرو النهشلي، أو: الخثعمي:
ذكره ابن نما الحلي([1085]) وقال عنه: «وكان أبو عمروٍ هذا متهجداً كثير الصلاة».
وذكره المجلسي في البحار نقلاً عن ابن نما، كما ذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة ولكنه قال: «أبو عامر النهشلي».
هل هو متحد مع «شبيب بن عبدالله النهشلي» الذي تقدم ذكره؟
لقد ذكر ابن نما في «مثير الأحزان» أن أبا عمرو هذا قتل مبارزة، وذكر ابن شهرآشوب أن شبيب بن عبدالله قتل في الحملة الأولى. وهذا يقضي بأن يكونا رجلين. ولكن تفرد ابن نما بذكر أبي عمر النهشلي دون أن يذكر شبيباً، وإهمال بقية المصادر لذكر أبي عمرو مع إجماعها على ذكر شبيب يحمل على الظن بأنهما متحدان.
النهشلي: من بني نهشل بن دارم، من تميم، من عدنان (عرب الشمال).
3 ـ حماد بن حماد الخزاعي المرادي:
هكذا ورد اسمه في نسخة البحار من الرجبية([1086])، وليس في نسخة الإقبال «الخزاعي».
وذكر السيد الخوئي نقلاً عن الرجبية (معجم رجال الحديث: 6/205) ونحن نشك في كونه رجلاً تاريخياً من جهة شكنا في كل اسم تفردت الرجبية بذكره، ولم يرد في مصدر آخر.
4 ـ حنظلة بن عمرو الشيباني:
ذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1087])، وذكره السيد الأمين. احتمل السيد الخوئي اشتراكه مع «حنظلة بن أسعد الشبامي» (معجم رجال الحديث: 6/306 و307) كما احتمل ذلك أيضاً التستري (معجم الرجال) ويبعد هذا الاحتمال أن الشيباني ـ على تقدير كونه رجلاً تاريخياً ـ قتل في الحملة الأولى، واتفاق من ذكر «الشبامي» أنه قتل مبارزة.
الشيباني من شيبان، من العدنانية (عرب الشمال).
5 ـ رميث بن عمرو:
ذكره الشيخ دون أن ينص على مقتله. وذكر في الرجبية. ذكره السيد الخوئي دون أن ينسبه إلى الرجبية (معجم الرجال: 7/204).
6 ـ زائدة بن مهاجر:
ورد ذكره في الرجبية. هل يمكن أن يكون تصحيفاً في اسم «يزيد بن زياد بن المهاجر (المظاهر)»؟
7 ـ زهير بن سائب:
ذكر في الرجبية. وذكره السيد الخوئي نقلاً عنها (معجم رجال الحديث: 7/296) وفي نسخة الإقبال «زهير بن سيار».
8 ـ زهير بن سليمان:
ذكر في الرجبية. وفي نسخة البحار «زهير بن سليمان» وذكره نقلاً عنها (معجم رجال الحديث: 7/296).
9 ـ زهير بن سليم الأزدي:
وذكره في الزيارة، وذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1088]). رجحنا اتحاده مع «زهير بن بشر الخثعمي» بسبب اختلاف نسخة الزيارة بين البحار والإقبال. ورجحنا كون «زهير بن بشر» أقرب إلى أن يكون تاريخياً من «زهير بن سليم» لورود الأول في الرجبية أيضاً.
10 ـ سلمان بن مضارب البجلي:
ذكره الخوارزمي وقال عنه أنه ابن عم زهير بن القين وذكر أنه مال إلى معسكر الحسين مع ابن عمه زهير قبيل الوصول إلى كربلاء([1089]).
وذكره السيد الخوئي ولم يذكر له مصدراً (معجم رجال الحديث: 8/186).
البجلي. من بجيلة (يمن، عرب الجنوب).
11 ـ سليمان بن سليمان الأزدي:
ورد ذكره في الرجبية.
12 ـ سليمان بن عون الحضرمي:
ورد ذكره في الرجبية.
13 ـ سليمان بن كثير:
ورد ذكره في الرجبية. رجحنا اتحاده مع «مسلم بن كثير الأزدي الأعرج» الذي تقدم ذكره.
14 ـ عامر بن جليدة (خليدة):
ورد ذكره في الرجبية.
15 ـ عامر بن مالك:
ورد ذكره في الرجبية.
16- عبد الرحمن بن يزيد:
ورد ذكره فب الرجبية.
17 ـ عثمان بن فروة (عروة) الغفاري:
ورد ذكره في الرجبية. احتملنا اتحاده مع قرة بن أبي قرة الغفاري.
18 ـ عمر (عمير) بن كناد:
ورد ذكره في الرجبية.
19 ـ عبدالله بن أبي بكر:
قال السيد الأمين: (قال الجاحظ في كتاب الحيوان: «وهو شهيد من شهداء يوم الطف») ولا تحضرنا نسخة كتاب الحيوان للتحقق من النسبة. ويخطر في الذهن احتمال أن يكون الجاحظ عنى أحد القتلى في ثورة (إبراهيم بن عبدالله) قتيل باخمرى في عهد أبي جعفر المنصور، في البصرة.
20 ـ عبدالله بن عروة الغفاري:
ذكره ابن شهرآشوب في عداد قتلى الحملة الأولى([1090]).
وقد رجح التستري اتحاده مع «عبدالله بن عرزة بن حراق الغفاري ـ قاموس الرجال: 6/79» ونرجح نحن خلافه، فإن الأخوين الغفاريين ابني حراق ذكرا في المصادر على أنهما ممن قتل مبارزة، وصرحت المصادر أنهما قتلا معاً. ويشهد لذلك كلمة الخوارزمي «فبقي في هؤلاء القوم الذين يذكرون في المبارزة»([1091]). والأخوان ابنا حراق يذكران في المبارزة، وإذن فلم يقتل المسمى منهما «عبدالله..» في الحملة الأولى، وهو ما قاله ابن شهرآشوب بالنسبة إلى «عبدالله بن عروة» والظاهر أنهما كانا من أواخر الرجال استشهاداً (إذا اعتبرنا الترتيب الذي يذكره أرباب المقاتل بقولهم: ثم برز فلان. ثم برز فلان.. دالاً على ترتيب حقيقي حدث في التاريخ).
ومع ذلك فإننا نشك في كون هذا الاسم يدل على مسمى تاريخي بسبب تفرد ابن شهرآشوب بذكره.
21 ـ غيلان بن عبدالرحمن:
ذكر في الرجبية.
22 ـ القاسم بن الحارث الكاهلي:
ورد ذكره في الرجبية. هل يمكن أن يكون متحداً مع «قاسم بن حبيب الأزدي»؟
23 ـ قيس بن عبدالله الهمداني:
ورد ذكره في الرجبية.
24 ـ مالك بن دودان:
ذكره ابن شهرآشوب (المناقب: 4/104).
دودان بن أسد، بطن من بني أسد بن خزيمة، من العدنانية (عرب الشمال).
25 ـ مسلم بن كناد:
ورد ذكره في الرجبية.
26 ـ مسلم مولى عامر بن مسلم:
ورد ذكره في الرجبية.
27 ـ منيع بن زياد:
ورد ذكره في الرجبية.
28 ـ نعمان بن عمرو:
ورد ذكره في الرجبية.
29 ـ يزيد بن مهاجر الجعفي:
ذكره الخوارزمي (مقتل الحسين: 2/19).
نرجح اتحاده مع «يزيد بن زياد بن مهاجر أبو الشعثاء الكندي» الذي تقدم ذكره.
الجعفي: من جعفي بن سعد العشيرة، بطن من سعد العشيرة، من مذحج، من القحطانية (يمن، عرب الجنوب).
مُلحق بأسْماء الذينَ اسْتشهَدوا
في الكوفة من أصحاب الحسين
1 ـ عبدالأعلى بن يزيد الكلبي. (عرب الجنوب):
شاب كوفي. ممن بايعوا مسلم بن عقيل. لبس سلاحه حين أعلن مسلم تحركه بعد القبض على هاني بن عروة وخرج من منزله ليلحق بمسلم في محلة بني فتيان، فقبض عليه «كثير بن شهاب بن الحصين الحارثي من مذحج» ـ وكان قد استجاب لعبيدالله بن زياد حين أمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج فيخذل الناس عن مسلم بن عقيل.
فأخذ كثير بن شهاب عبد الأعلى بن يزيد الكلبي فأدخله على عبيدالله بن زياد. فقال عبد الأعلى لابن زياد: إنما أردتك، فلم يصدقه، وأمر به فحبس (الطبري: 5/369 ـ 370) ثم أن عبيدالله بن زياد لما قتل مسلم بن عقيل، وهاني بن عروة دعا بعبد الأعلى الكلبي فأتي به، فقال له: أخبرني بأمرك. فقال: أصلحك الله، خرجت لأنظر ما يصنع الناس، فأخذني كثير بن شهاب فقال له: فعليك وعليك، من الأيمان المغلظة، إن كان أخرجك إلاَّ ما زعمت! فأبى أن يحلف. فقال عبيدالله: انطلقوا بهذا إلى جبانة السبع فاضربوا عنقه بها، فانطلقوا به فضربت عنقه» (الطبري: 5/379).
2 ـ عبدالله بن بقطر: (حميري من عرب الجنوب):
كانت أمه حاضنة للحسين، ذكره ابن حجر في الإصابة، قال أنه كان صحابياً لأنه لِدَة الحسين. قبض عليه الحصين بن نمير وهو يحمل رسالة من الحسين بعد خروجه من مكة إلى مسلم بن عقيل، فأمر به عبيدالله بن زياد فألقي من فوق القصر فتكسرت عظامه وبقي فيه رمق فأجهز عليه عبدالملك بن عمير اللخمي (الطبري: 5/398).
3 ـ عمارة بن صلخب الأزدي: (عرب الجنوب):
شاب كوفي. كان قد خرج لنصر مسلم بن عقيل حين بدأ تحركه، فقبض عليه وحبس، ثم دعا به عبيدالله بن زياد ـ بعد أن قتل مسلم بن عقيل، وهاني بن عروة ـ فقال له: ممن أنت؟ قال: من الأزد. قال: انطلقوا به إلى قومه، فضربت عنقه فيهم. (الطبري: 5/379).
4 ـ قيس بن مسهر الصيداوي: (أسدي، من عدنان، عرب الشمال):
شاب كوفي. من أشراف بني أسد. أحد حملة الرسائل من قبل الكوفيين إلى الحسين بعد إعلان الحسين رفضه لبيعة يزيد، وخروجه إلى مكة. صحب مسلم بن عقيل حين قدم من مكة مبعوثاً من قبل الحسين إلى الكوفة. حمل رسالة من مسلم إلى الحسين يخبره فيها بيعة من بايع ويدعوه إلى القدوم. صحب الحسين حين خرج من مكة متوجهاً إلى العراق، حتى إذا انتهى الحسين إلى الحاجر من بطن الرمة حمل رسالة من الحسين إلى الكوفيين يخبرهم فيها بقدومه عليهم. قبض عليه الحصين بن نمير، فأتلف قيس الرسالة، وجاء به الحصين إلى عبيدالله بن زياد الذي حاول أن يعرف منه أسماء الرجال الذين أرسل إليهم كتاب الحسين ففشل، فأمر عبيدالله به فرمي من أعلى القصر «فتقطع فمات» (الطبري: 4/394 ـ 395).
5 ـ مسلم بن عقيل بن أبي طالب:
أمه أم ولد يقال لها «حلية» وكان عقيل اشتراها من الشام.
وجَّهَ به الحسين إلى الكوفة ليأخذ له البيعة على أهلها، فخرج من مكة في منتصف شهر رمضان سنة ستين للهجرة، ودخل الكوفة في اليوم السادس من شهر شوال. بايعه ثمانية عشر ألف، وقيل بايعه خمس وعشرون ألفاً.
استطاع ابن زياد أن يكتشف مقر مسلم بن عقيل بمعونة جاسوس تسلل إلى صفوف الثوار بعد أن أوهم مسلم بن عوسجة أنه من شيعة أهل البيت، فقبض ابن زياد على هاني بن عروة المرادي، واضطر مسلم إلى إعلان حركته قبل موعدها المقرر، وقد حاصر عبيدالله بن زياد في قصر الإمارة، ولكن سرعان ما تفرق الجمع وبقي مسلم وحيداً، فلجأ إلى بيت السيدة طوعة التي آوته، وحين علم ابنها بلال بذلك أخبر عبدالرحمن بن الأشعث الذي أخبر ابن زياد، فأرسل قوة هاجمت مسلماً فخاض معها، معركة قاسية أسر على أثرها، وقتله ابن زياد مع هاني بن عروة وأمر بهما فقطع رأساهما فأرسل بهما إلى يزيد بن معاوية، وشدت الحبال في أرجلهما وجرا في أسواق الكوفة.
6 ـ هاني بن عروة المرادي (من مذحج، عرب الجنوب):
من زعماء اليمن الكبار في الكوفة. أدرك النبي، وصحبه: من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شارك في حروب الجمل وصفين والنهروان من أركان حركة حجر بن عدي الكندي ضد زياد بن أبيه. اتخذ مسلم بن عقيل منزله مقراً له بعد قدوم عبيدالله بن زياد إلى الكوفة والياً عليها. انكشف أمر اشتراكه في الإعداد للثورة مع مسلم بن عقيل، فقبض عليه ابن زياد، وسجنه، ثم قتله، وبعث برأسه مع رأس مسلم بن عقيل إلى يزيد بن معاوية.
قتل في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة 60هـ وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة متوجهاً إلى العراق.
كان عمره يوم قتل تسعين سنة.
شهداء كربلاء من بني هاشم$
اختلفت الروايات في عدة من استشهد في كربلاء ـ غير الحسين (ع) ـ من أهل البيت (عليهم السلام).
فهم عند المسعودي ثلاثة عشر رجلاً (مروج الذهب: 3/71) وهو فيما أطلعنا عليه من الروايات أقل عدد روي أنه قتل منهم مع الحسين في كربلاء.
واشتملت رواية أوردها الخوارزمي عن الليث بن سعد على أسماء أربعة عشر رجلاً منهم. (مقتل الحسين: 2/47).
وذكر الخوارزمي في رواية أخرى نسبها إلى الحسن البصري، قال فيها: «قتل مع الحسين بن علي (ع) ستة عشر من أهل بيته، ما كان لهم على وجه الأرض شبيه» (مقتل الحسين: 2/46 ـ 47).
وتشتمل الزيارة المنسوبة إلى الناحية على أسماء سبعة عشر رجلاً منهم (غير الحسين بن علي) وهي، من حيث العدد، موافقة لرواية الشيخ المفيد (الإرشاد: 248 ـ 249) حيث قال: «إن عدة من قتل مع الحسين (ع) من أهل بيته بطف كربلاء هم سبعة عشر نفساً، الحسين بن علي (ع) ثامن عشر». وهاتان الروايتان موافقتان، من حيث العدد، لرواية الطبري (5؛ 468 ـ 469)، فقد عدّ الشهداء تسعة عشر رجلاً منهم «مسلم بن عقيل» ومنهم: أبو بكر بن علي بن أبي طالب. وقال عنه: «شك في قتله» فيكون الباقي عند الطبري، وهم من ثبت عنده استشهادهم في كربلاء، سبعة عشر رجلاً، ويكون بذلك متفقاً مع الزيارة والشيخ المفيد، وهذه الروايات (الزيارة المفيد، الطبري) موافقة لرواية أخرى أوردها الخوارزمي عن الحسن البصري، وفيها: «قتل مع الحسين (ع) سبعة عشر رجلاً من أهل بيته» (مقتل الحسين: 2/47).
وقال أبو الفرج الأصفهاني (مقاتل الطالبيين: 95) بعد أن عرض أسماء شهداء بني هاشم: «فجميع من قتل يوم الطف من ولد أبي طالب ـ سوى من يختلف في أمره ـ اثنان وعشرون رجلاً».
وقد عد في الشهداء الإمام الحسين ومسلم بن عقيل، وقد وَهَمَ فيه كما هو معلوم حيث أن مسلماً ليس ممن قتل يوم الطف، بل استشهد قبل ذلك في الكوفة فتكون عدة الشهداء، عند أبي الفرج الأصفهاني عشرون رجلاً.
وأكبر عدد روي أنه استشهد من أهل البيت في كربلاء فيما أطلعنا عليه من الروايات هو خمسة وعشرون رجلاً، وهذا هو ما رواه الخوارزمي (2/47 ـ 48) حيث قال: «اختلف أهل النقل في عدد المقتول يومئذٍ ما تقدم من قتل مسلم من العترة الطاهرة، والأكثرون على أنهم كانوا سبعة وعشرين..» وذكر أسمائهم بعد هذا، وفيهم اسما: «الحسين بن علي بن أبي طالب، ومسلم بن عقيل بن أبي طالب».
وذكر السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة «الجزء الرابع/ القسم الأول/ ص134» جدولاً بعنوان (أسماء من اتصلت بنا أسماؤهم من أنصار الحسين الذين قتلوا معه من بني هاشم) وذكر في الجدول ثلاثين اسماً. ولا نعرف مستند السيد في ذلك.
أسماء شهداء كربلاء من بني هاشم$
1 ـ علي بن الحسين الأكبر:
ورد ذكره في: «الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأصفهاني، الخوارزمي، المسعودي).
يكنى أبا الحسن. كان له من العمر سبع وعشرون سنة (؟) وردت رواية أنه كان متزوجاً من أم ولد.
أمه: ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي. وهو أول من قتل من بني هاشم.
قتله مرة بن منقذ بن النعمان العبدي.
2 ـ عبدالله بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
أمه: أم البنين بنت حزام. كان عمره حين قتل خمساً وعشرين سنة. لا عقب له.
قتله: هاني بن ثبيت الحضرمي.
3 ـ جعفر بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
أمه: أم البنين بنت حزام. كان عمره حين قتل تسع عشرة سنة.
قتله هاني بن ثبيت الحضرمي، أو خوليّ بن يزيد الأصبحي.
4 ـ عثمان بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
أمه: أم البنين بنت حزام. كان عمره حين قتل إحدى وعشرين سنة. رماه خولي بن يزيد الأصبحي بسهم فأضعفه، وشد عليه رجل من بني أبان بن دارم، فقتله وأخذ رأسه.
5 ـ محمَّد (الأصغر) بن علي بن أبي طالب.
ورد ذكره في: (الزيارة، الطبري، الأصفهاني، المسعودي).
أمه: أم ولد. وقيل أن أمه أسماء بنت عميس قتله رجل من تميم، من بني أبان بن دارم.
6 ـ العباس بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأَصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
أمه: أم البنين. يكنى أبا الفضل. حمل لواء الحسين. هو أكبر إخوته، وآخر من قتل من إخوته لأمه وأبيه. قتله: زيد بن رقاد الجنبي، وحكيم بن الطفيل الطائي، (وفي الطبري السَّنَبسي).
7 ـ عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأَصفهاني، الخوارزمي).
أمه: الرباب بنت امرىء القيس الكلبي. كان طفلاً رضيعاً حين قتل في حجر أبيه الحسين. رماه عقبة بن بشر بسهم فذبحه، (في الطبري أن الذي رماه: هاني بن ثبيت الحضرمي) وفي الزيارة أن الذي رماه (حرملة بن كاهل الأسدي).
8 ـ أبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأَصفهاني، المسعودي).
أمه: أم ولد. قتله عبدالله بن عقبة الغنوي، أو عقبة الغنوي.
9 ـ القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأَصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
وهو أخو أبو بكر بن الحسن المقتول قبله لأمه وأبيه. قتله عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي.
(وفي الطبري: سعد بن عمرو بن نفيل الأزدي).
10 ـ عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأَصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
كان عمره حين قتل إحدى عشرة سنة.
أمه: بنت السليل بن عبدالله أخي عبدالله بن جرير البجلي، وقيل أن أمه أم ولد (وكذلك قال الطبري) قتله: حرملة بن كاهل الأسدي، رماه بسهم فذبحه في حجر الحسين وهو صريع. وان بحر بن كعب قد قطع يد الغلام حين أهوى ليضرب الحسين فاتقى الغلام الضربة بيده فأصابته.
11 ـ عون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأَصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
أمه: زينب العقيلة بنت علي بن أبي طالب (في الطبري: أمه جمانة ابنة المسيب بن نجبة الفزاري).
قتله: عبدالله بن قطنة التيهاني (في الطبري: قطبة).
12 ـ محمَّد بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأَصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
أمه: الخوصا بنت حفصة بن ثقيف من بكر بن وائل. قتله عامر بن نهشل التميمي. (في الطبري: التيمي).
13 ـ جعفر بن عقيل بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأَصفهاني، الخوارزمي).
أمه: أم الثغر بنت عامر بن الهصان العامري، من بني كلاب (في الطبري: أم البنين ابنة الشقر بن الهضاب..) قتله عروة بن عبدالله الخثعمي (في الطبري والزيارة: بشر بن حوط الهمداني).
14 ـ عبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأَصفهاني، الخوارزمي).
أمه أم ولد. قتله عثمان بن خالد بن أسيد الجهنمي، وبشير بن حوط القايضي. في الزيارة (عمر بن خالد بن أسد الجهني).
15 ـ عبدالله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الطبري، الأَصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
أمه: رقية بنت علي بن أبي طالب. قتله عمرو بن صبيح (في الطبري: الصدائي، وقيل قتله: أسيد بن مالك الحضرمي). (في الزيارة: عامر بن صعصعة وقيل أسد بن مالك).
16 ـ عبدالله بن عقيل بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإِرشاد، الطبري، الأَصفهاني، المسعودي).
الذي ورد ذكره في الزيارة هو (أَبو عبدالله بن مسلم بن عقيل) ورجحنا أن الاسم ورد في الزيارة بهذه الصورة خطأً، لانفراد الزيارة بهذا الاسم من بين المصادر، لاتفاق الزيارة مع الطبري في أن القائل هو عمرو بن صبيح الصيداوي أو الصدائي.
أمه: أم ولد. قتله في رواية الأَصفهاني: عثمان بن خالد بن أسد الجهني، ورجل من همدان.
17 ـ محمَّد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الزيارة، الإِرشاد، الطبري، الأَصفهاني).
قتله: لقيط بن ياسر الجهني. في الزيارة (ناشر).
* * *
هؤلاء السبعة عشر هم الذين ثبت عندنا أنهم استشهدوا في كربلاء من بني هاشم، لإجماع المصادر الأساسية على ذكرهم. أما من عداهم فسنعرض أسماءهم فيما يلي، مع شكنا في كونهم ممن رزق الشهادة مع الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) في كربلاء. ونقدِّر أن بعضهم قد استشهد في مواقع أخرى متأخرة، واختلط أمره على أصحاب الأخبار والمؤرخين. مع احتمال أن يكون رأينا في عدد الشهداء السبعة عشر وأسمائهم خطأً أيضاً، وأن يكون العدد أكثر مما ذكرنا، أو أن تكون بعض الأسماء غير ما ذكرنا.
1 ـ أبو بكر بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الإرشاد، الخوارزمي، الأَصفهاني).
في الطبري قال: (شك في قتله).
قال الأَصفهاني: لم يعرف اسمه (في الخوارزمي: اسمه عبدالله).
أمه: ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك… بن دارم. قال الأَصفهاني: قتله رجل من همدان. وقيل: وجد في ساقية مقتولاً لا يدرى من قتله. وهذا التعبير من الأَصفهاني يدعونا أيضاً إلى الشك في شهادته في كربلاء.
2 ـ عبيدالله بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الأَصفهاني، الخوارزمي).
أمه: الخرصا بنت حفصة. قال الأَصفهاني: «ذكر يحيى بن الحسن العلوي، فيما حدَّثني به أَحمد بن سعيد عنه: (أنه قتل مع الحسين في الطف، رضوان الله وصلواته على الحسين وآله).
ولم يذكره غير الأَصفهاني. ولذا فنحن نشك في كونه من شهداء بني هاشم في كربلاء.
3 ـ محمَّد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب:
ورد ذكره في: (الأَصفهاني والخوارزمي) ولم يذكره غيرهما.
أمه: أم ولد. قتله أَبو مرهم الأزدي. ولقيط بن أياس الجهني.
4 ـ عبدالله بن علي بن أبي طالب:
ورد ذكره عند المفيد في الإِرشاد ولم يذكره غيره. وقال أن أمه وأم أبي بكر بن علي هي: ليلى بنت مسعود الثقفية: وينبغي أن يكون هذا غير عبدالله بن أَبي طالب الذي أمه أم البنين بنت حزام، فذاك متفق على شهادته، وقد ذكرناه في عداد السبعة عشر.
5 ـ عمر بن علي بن أبي طالب:
ذكره الخوارزمي (مقتل الحسين: 2/28 ـ 29) في عداد من برز وقاتل ويظهر منه أن أمه (ليلى بنت مسعود بن خالد بن ربعي بن مسلم بن جندل بن نهشل بن دارم التميمية) فيكون أخا أَبي بكر بن علي الذي تقدم ذكره لأبيه وأمه. وذكره في تعداد الأسماء في الرواية التي اشتملت على خمسة وعشرين اسماً (ص47 ـ 48).
6 ـ غلام في أذنيه قرطان، قتله هاني بن بعيث:
ذكره الخوارزمي (مقتل الحسين: 2/31 ـ 32) آخر الشهداء من بني هاشم في ترتيب الخوارزمي لبروز الهاشميين. وذكر بعض أرباب المقاتل أن هذا الغلام هو محمَّد بن أبي سعيد بن عقيل وأن قاتله هاني بن ثبيت الحضرمي.
7 ـ إبراهيم بن علي بن أبي طالب:
ذكره الخوارزمي ص: 47.
8 ـ عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب:
ذكره الخوارزمي. ص: 48.
9 ـ محمَّد بن عقيل بن أبي طالب:
ذكره الخوارزمي ص: 48.
10 ـ جعفر بن محمَّد بن عقيل بن أبي طالب:
ذكره الخوارزمي ص: 48.
قُبُور الشهداء الهاشميّين
وغير الهاشميِّين
جثث الشهداء أثناء معركة:
يبدو من بعض النصوص عند الطبري والشيخ المفيد أن الحسين أعد خيمة لتوضع فيها جثث الشهداء. ومن المؤكد أن جثث شهداء بني هاشم كانت توضع في مكان معين، هو الخيمة التي ذكرناها آنفاً. ولا نستطيع أن نؤكد إن كانت جثث الشهداء من غير الهاشميين كانت توضع في نفس الخيمة أو في مكان آخر، أو أنها كانت تبقى في ساحة المعركة.
ونقدِّر أنّها كانت تنقل من ساحة المعركة كما تقضي به التقاليد والأعراف. ولأن القتال كان مبارزة، وكان متقطعاً تتخلله فترات هدوء بين مبارزة ومبارزة، وكانت ساحة المعركة محدودة نسبياً بسبب قلة عدد أفراد القوة الثائرة، مما يعطِّل القدرة على المناورة في مساحة واسعة.
ولكننا لا نستطيع أن نؤكد ما إذا كانت تنقل إلى المكان الذي توضع فيه جثث شهداء الهاشميين، أو أنها كانت توضع في مكان آخر.
ولعل الذي حدث أنها كانت توضع في مكان آخر، فربما كان الإمام الحسين قدر ـ وهو يعلم نتيجة المعركة ـ أن الرؤوس ستقطع، وأن هذا سيؤدي إلى صعوبات في تمييز هوية الشهداء من أصحابه وأهل بيته، فجعل مكانين أحدهما لحفظ جثث الشهداء الهاشميين، والآخر لحفظ جثث الشهداء غير الهاشميين.
ولعل ثمة أمراً آخر يشجع على ترجيح هذا الرأي، وهو أن الشهداء الهاشميين كانوا مع أسرهم أو بعض أسرهم، بحيث لا نعرف شهيداً منهم لم يكن له بين النساء الهاشميات أم أَو أخت أَو زوجة أَو بنت، أَو هن مجتمعات؛ وهذا يؤدي إلى مراعاة الاعتبارات العاطفية والأسرية في هذه الحالة، وهي تقضي بأن يحمل الشهيد، ليتمكن النسوة، في غمرة المعركة، من مشاهدة جسده، والبكاء عليه، وهذا الاعتبار يدعو إلى إفراد الشهداء الهاشميين في مكان خاص. أما الشهداء غير الهاشميين فإن العدد الأكبر منهم لم يصحبوا معهم نساءهم.
والنصوص التي أشرنا إليها آنفاً هي ما ذكره الطبري عند ذكره استشهاد علي بن الحسين الأكبر، وهو:
«.. وأقبل الحسين إلى ابنه، وأقبل فتيانه إليه، فقال: احملوا أخاكم، فحملوه من مصرعه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه» (الطبري: 5/447).
وما ذكره في الحديث عن استشهاد القاسم بن الإِمام الحسن بن علي، وهو:
«.. ثم احتمله (الحسين) فكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض، وقد وضع حسين صدره على صدره، قال (الراوي حميد بن مسلم) فقلت في نفسي: ما يصنع به فجاء به حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين وقتلى قد قتلت حوله من أهل بيته.. » ـ (الطبري: 5/447 ـ 448).
وأورد الشيخ المفيد نصين مماثلين لما عند الطبري (الإِرشاد: 239 ـ 240).
ويؤيد هذا الرأي النص التالي الذي ذكره الشيخ المفيد (الإِرشاد: 243) في حديثه عن كيفية دفن الشهداء:
«.. وحفروا ـ بنو أسد ـ للشهداء من أهل بيته وأصحابه ـ الذين صرعوا حوله ـ مما يلي رجلي الحسين (ع) وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معاً».
فإن كلمة «جمعوهم» توحي بأنهم (الهاشميين وغير الهاشميين) كانوا متفرقين. وهذا القول يعزز الرأي بأن بني هاشم كانوا في موضع منفرد. ولكن كلمة «حوله» في هذا النص ربما توحي بأن جثث الشهداء من غير الهاشميين كانت متفرقة لم تجمع في مكان واحد، أو في مجموعات، وهو أمر بعيد جداً لما ذكرناه آنفاً. وسنرى أن كلام المفيد مضطرب في هذا الشأن.
* * *
دفن الشهداء وقبورهم:
قال المسعودي (مروج الذهب: 3/72):
«.. ودفن أهل الغاضرية ـ وهم قوم من بني عامر، من بني أسد ـ الحسين وأصحابه بعد قتلهم بيوم».
وهذا يعني أن الدفن كان بعد ظهر اليوم الحادي عشر من محرم، فإن نص الشيخ المفيد الآتي يدل على أن بني أسد دفنوا الشهداء بعد رحيل عمر بن سعد، وقد رحل عمر بن سعد بعد زوال اليوم الحادي عشر.
وقال الشيخ المفيد (الإرشاد، ص: 243):
«ولما رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد كانوا نزولاً بالغاضرية([1092]) إلى الحسين (ع) وأصحابه، فصلوا عليهم ودفنوا: الحسين (ع) حيث قبره الآن، ودفنوا ابنه عليَّ بن الحسين الأصغر عند رجليه. وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه ـ الذين صرعوا حوله ـ مما يلي رجلي الحسين (ع) وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معاً. ودفنوا العباس بن علي (ع) في موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضرية حيث قبره الآن».
وقال الشيخ المفيد في موضع آخر (الإِرشاد، ص: 249):
«.. وهم (شهداء بني هاشم) كلهم مدفونون مما يلي رجلي الحسين (ع) في مشهده، حفر لهم حفيرة وألقوا فيها جميعاً وسوّي عليهم التراب، إِلاَّ العباس بن علي (ع) فإنه دفن في موضع مقتله على المسناة([1093]) بطريق الغاضرية، وقبره ظاهر، وليس لقبور إخوته وأهله الذين سميناهم أثر، وإنما يزورهم الزائر من عند قبر الحسين (ع) ويومىء إلى الأرض التي نحو رجليه بالسلام عليهم، وعلى علي بن الحسين (ع) في جملتهم، ويقال إنه أقربهم دفناً إلى الحسين (ع).
«فأما أَصحاب الحسين (ع) رحمة الله عليهم الذين قتلوا معه، فإنهم دفنوا حوله، ولسنا نحصَّل لهم أجداثاً على التحقيق والتفصيل، إلاَّ أنا لا نشك أن الحائر محيط بهم. رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسكنهم جنات النعيم».
* * *
وهنا ملاحظتان:
الملاحظة الأولى:
إن هذا النص يخالف سابقه من حيث إن النص الأول صريح في أن جيمع الشهداء ـ من هاشميين وغير هاشميين ـ دفنوا في قبر جماعي واحد. ويبدو من النص الثاني أن الهاشميين دفنوا وحدهم في بر واحد، وغير الهاشميين من الشهداء دفنوا ـ كما يوحي به النص ـ في قبور جماعية متعددة حول الحسين (ع).
الملاحظة الثانية:
أنه يوجد قبران أحدهما قبر منسوب إلى حبيب بن مظاهر الأسدي وهو موجود في داخل الحائر من جهة رأس الحسين (ع)، والآخر قبر الحر بن يزيد الرياحي على مسافة عدة كيلومترات من مشهد الحسين حيث قبره وقبور الشهداء.
وهذا يخالف كلا النصين الآنفين عن الشيخ المفيد، فإنهما صريحان في أن جميع الشهداء دفنوا في قبر جماعي واحد مع الهاشميين، أو في قبور جماعية متعددة. ولم نر في المؤرخين المعتمدين من ذكر شيئاً يعتد به في هذا الشأن. وقال السيد محسن الأمين رضوان الله عليه (أعيان الشيعة ـ الجزء الرابع ـ القسم الأول/ 242):
«ويقال أن بني أسد دفنوا حبيب بن مظاهر في قبر وحده عند رأس الحسين (ع) حيث قبره الآن اعتناءً به لأنه أسدي. وأن بني تميم حملوا الحر بن يزيد الرياحي على نحو ميل من الحسين (ع) ودفنوه هناك حيث قبره الآن اعتناءً به أيضاً، ولم يذكر ذلك المفيد، ولكن اشتهار ذلك وعمل الناس عليه ليس بدون مستند».
والله تعالى أعلم.
محمَّد مهدي شمس الدين
كربلاء بين رؤيتين
دخلت كربلا، منذ حدوثها، في تكوين وجدان الإنسان المسلم، وشكّلت، على مدى التاريخ، في وعيه ولا وعيه مناخاً من الحزن الولود، يحثُّ على التأمّل في شؤون الحياة الدُّنيا والآخرة، ويدفع إلى اليقظة وتبيُّنِ سبل الرّشَاد؛ الأمر الذي يفضي إلى اختيار سلوكٍ تغييري يرمي إلى رضى الرّحمن وإرساء عدالته.
نلمس هذه الحقيقة في التاريخ والواقع، وطالما جسَّدها الشعراء، مجسِّدين بذلك طبيعة هذه التجربة الفريدة في التاريخ الإنساني. فنسمع، على سبيل المثال صوت الكميت بن زيد الأسدي، وهو ينشد في إحدى هاشمياته:
| ألا هل عمٍ في رأيه متأمِّل | وهل مدبرٌ، بعد الإساءة مقبل | |
| وهل أمّة مستيقظون لرشدهم | فيكشف عنه النّعسة المتزمِّل | |
| فقد طال هذا النوم، واستخرج الكرى | مساويهم، لو كان ذا الميل يعدل |
وإننا إذ ندرك هذا لا نعدم أن نجد، بين الباحثين في التاريخ الإسلامي، من يذهب إلى رؤية أخرى، فنقرأ على سبيل المثال، مقالاً للدكتور: رزق الله يقول فيه: إن العاشر من محرَّم كان حاسماً على صعيد اللاوعي الشِّيعي، إذ أدخل مفهوم الخطيئة إلى مذهب إسلاميّ، وذلك أن «مقتل الحسين بن علي يعدّ بمثابة الحدث الهلعي في تاريخ الشيعة والمولّد لشعورٍ بالذنب جماعيّ ناتج عن تخليِّ شيعة الكوفة عن تأييد إمامهم». ويرى الباحث أن الشعور بالذَّنب قاد الشيعة إلى العقاب الذاتي الذي اتخذ عندهم شكلين:
الأول: إيديولوجي يلحظ في التراث.
والثاني: جسماني يلحظ في شعائر اللطم والضرب.
ويضيف الباحث قائلاً: إن هذين النمطين سيطرا حتى أيامنا هذه على الثقافة الاجتماعيّة الشيعيَّة، وأنهما كانا صماميَّ أمان للسلطات القمعيَّة…
ويؤيِّد الباحث رأي الأستاذ أحمد أمين الوارد في فجر الإسلام الذي يصف فيه الشعر الشيعيّ بالحزن، كما يذكر، على سبيل تعزيز ما يذهب إليه، رأي كانيتي الذي يرى أن المذهب الشيعي جنائزيّ([1094]).
من عيوب البحث العلمي، الأحكام العامَّة المطلقة، والاعتماد على آراء الآخرين وعلى بعض الوقائع المجتزأة، لتقرير أحكام عامة مطلقة تتناول تاريخاً طويلاً غنياً خصباً على مختلف الأصعدة.
ونحن، وإن كنا لا نوافق الكاتب على ما يذهب إليه، فإنّنا لن نقع في ما وقع فيه من أخطاء وإنما سوف نلجأ إلى التاريخ، لنبحث على ضوئه عدّة قضايا هي: موقع كربلاء في التاريخ الإسلامي، ومنطلقها التاريخيّ، طبيعة الحزن الذي تلاها، أثرها المباشر في المجتمع الإسلامي، وأثرها الدائم على مدى التاريخ، وبخاصّة على مستوى السّلوك السياسي لنرى حقيقة ما يذهب إليه الباحث، من أنها كانت «صمام أمانٍ للسلطات القمعيَّة».
وبغية الوصول إلى اليقين في صدد هذه القضايا سوف نعمد إلى مقاربة وقائع التاريخ ونصوصه.
وصل الأُمويون إلى الخلافة بطريقة يوضحها معاوية، عندما يقول في إحدى خطبه: «… لا بمحبَّة وليتها، ولكن جالدتكم بسيفي هذا مجالدة»([1095]) وثبّتوا حكمهم مستخدمين وسائل يوضحها عتبة بن أَبي سفيان، أخو معاوية، عندما يقول: «لا تمدّوا الأعناق إلى غيرنا، فإنَّها تنقطع دوننا»([1096]).
إنها صورة السيف القاطع للأعناق غير الخاضعة، وهي صورة إرهاب يمارس بهدف تحقيق الطاعة المطلقة. ولم يكن الناس بقادرين على احتمال إرهاب القوَّة العسكريَّة، ولهذا كان لا بدّ من نظرية تكون بمثابة ملجأ للناس الراضين الراضخين، نظرية تبرر الطّاعة، فكان القدر الإلهي يبرِّر الطَّاعة ويطفىء المشاعر الرافضة ويقود إلى الطَّاعة الراضية المرضيّة، فهذا زياد بن أبيه، يخاطب الناس قائلاً:
ـ «أيها الناس، إنّا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادّة. نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء الله الذي خوَّلنا. فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا…».
ـ وفي إطار الرؤية نفسها يقول روح بن زنباع أحد قادة الأُمويين، وفي صلة مباشرة بمبايعة يزيد، وذلك لما رأى إبطاء الناس عن مبايعته: «أيُّها الناس، إنّا لا ندعوكم إلى لخم وجذام وكلب، ولكننا ندعوكم إلى قريش، ومن جعل الله له هذا الأمر واختصّه به، وهو يزيد بن معاوية. ونحن أبناء الطّعن والطّاعون وفضلات الموت. وعندنا، إن أحببتم وأطعتم من المعونة والفائدة ما شئتم».
تهدف السلطة الأُمويّة إلى الطاعة متوسّلة «أبناء فضلات الموت» و«المعونة والفائدة» جاعلةً من هذه الطاعة قدراً إلهيّاً. إنه حق إلهي يقرّر، ووعيد متبوع بترغيب، إنه السيف وكيس المال، سيف وكيس يسوسان بسلطان الله الذي أعطى…
والحقيقة أنها مفارقة تاريخيّة كبرى. أو كما يقول المستشرق فلهوزن: «.. وكان من السخرية بفكرة الحكومة الثيوقراطية أن يظهر الأُمويون ممثليها الأعلين. فهم كانوا مغتصبين. وظلّوا كذلك. ولم يكونوا يستندون إلاَّ إلى قوّتهم الخاصَّة. إلى قوّة أهل الشام. ولكنَّ قوّتهم لم تستطع قط أن تصير حقاً شرعياً».
في سبيل كشف هذه المفارقة، الزِّيف، ومنع القوة العسكرية من أن تغدو حقاً شرعياً إلهياً له حقُّ الطاعة بوصفها واجباً دينياً أو قدراً كانت كربلاء. وفي هذا الإطار من الفهم تعد كربلاء موقفاً، جهاداً في سبيل التغيير، ينطلق من الإيمان بوجوب ذلك وجوباً شرعياً يستند إلى نصِّ ديني وموقع تاريخي. وهذا ما نفيده من خطب الإِمام الحسين (ع) التي نقتطف منها ما يلي:
ـ «… إن رسول الله (ص) قال: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً بعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله (ص)، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغيِّر عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله»».
ـ «… ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غيَّر، وأنا الحسين بن علي وابن فاطمة»([1097]).
وهكذا تبدو كربلاء، في حقيقتها، حركة تاريخية تهدف إلى تغيير وجهة سير التاريخ وإعادتها إلى الاتجاه الأصوب الذي حدّده الله ورسوله (ص). وهي، وإن لم تنجح عسكرياً حين حدوثها، فقد كانت واجباً شرعياً يؤدّى من ناحيةٍ أولى، ووضعت أسس التحرك التاريخي، في الحالات المماثلة، على مرِّ العصور، من ناحية ثانية.
وفي غمرة احتدام المعركة، وكانت نتائجها واضحة منذ بدايتها، أدى الحسين (ع) وأَصحابه واجبهم، وواجهوا مصيرهم بشجاعة منقطعة النظير، وبإصرار على بذل النفس في سبيل أداء الواجب لا يكون إلاَّ من أمثالهم. وما كانوا يرتمون على الموت، وإنما كانوا يوظِّفونه في سبيل شقّ طريق التغيير أمام الأجيال التَّالية. وإن كنّا نريد إعطاء مثلٍ فلن يكون موقف الحسين (ع). وذلك لشهرة هذا الموقف وإنما سيكون موقفاً آخر، وليكن موقف مسلم بن عقيل الذي يرويه الطبري، كما يلي:
«أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت، فأخذوا يرمونه بالحجارة، ويلهبون النار في أطنان القصب، ثم يقلبونها عليه من فوق البيت. فلما رأى ذلك خرج عليهم مصلتاً سيفه، فقاتلهم. فأقبل عليه محمَّد بن الأشعث، فقال: يا فتى لك الأمان. لا تقتل نفسك، فأقبل يقاتلهم، وهو يقول:
| أقسمت لا أقتل إلاَّ حُرّا | وإن رأيت الموت شيئاً نكرا([1098]) |
وليس من شك في أن ما حدث في العاشر من محرم، في كربلاء، أورث حزناً، تواصل التعبير عنه على مرِّ العصور، والحقيقة أن عودة إلى كتب التاريخ والأدب تفيد أن حالة من الحزن العميق عمّت العالم الإِسلامي. آنذاك، رافقها شعور بالذّنب فظيع. وكانت هذه الحالة حالة شعبيّة دخلت إلى صميم وجدان المسلمين وإلى لا وعيهم، ونكتفي للاستشهاد هنا ببعض الأمثلة التي تجسد وعي المسلمين ولا وعيهم وحالتهم الوجدانيَّة التي تكوّنت على أثر كربلاء.
ـ يروي الطبري أن الناس في الحجاز مكثوا شهرين أو ثلاثة «كأنما تلطخ الحوائط بالدِّماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع». وصاروا يرون «اللون الأحمر» يلف مدينتهم ويسيل في شوارعها ويلوّن أبنيتهم، و«اللون الأصفر» يصيب الشمس بالذبول في عزّ الظهيرة، و«الغبرة» تملأ السماء في كل حين([1099])…
إن هذه المظاهر التي صار يراها الناس تعبير عن أحاسيس يعيشونها تملأ عليهم وجودهم، فتبدو وكأنها وقائع ماديَّة.
ـ ويروي الطبري أيضاً: «… قال: أصبحنا صبيحة مقتل الحسين بالمدينة، فإذا مولى لنا يحدثنا قال: سمعت البارحة منادياً ينادي:
| أيها القاتلون جهلاً حسيناً | أبشروا بالعذاب والتنكيل) | |
| كل أهل السماء يدعو عليكم | من نبيٍ ومالكٍ وقبيل([1100]) |
وقد خلّد الشعر مثل هذه الأحداث، فقال الشاعر:
| ألم تر أن الشّمس أضحت مريضةً | لفقد حسين، والبلاد اقشعرَّت | |
| وقد أعولت تبكي السماء لفقده | وأنجمها ناحت عليه وضلَّت([1101]) |
وإن لم تكن مثل هذه الحالة قد تكوّنت لدى المسلمين العاديين، فإننا لا نعدم أن نجد آثار كربلاء لدى المشتركين فيها، وممّا يدل على ذلك خبران. تهمنّا من الخبر الأوَّل دلالته، فهو وإن لم يكن قد حدث فعلاً، فإنه يوضح مدى الإحساس بالإثم والرعب اللذين كانا ينتابان أناس ذلك العصر، فيولدا لهم صوراً وأحداثاً هي ابنة للحالة التي كانوا يعيشونها ويعانون من وطأتها. والخبر يقول: «قعد الذين ذهبوا بالرّأس في أوّل مرحلة من الطّريق، وجلسوا يشربون النبيذ، فإذا قلم من حديد يخرج عليهم من حائط فيكتب بالدم:
| أترجوا أمة قتلت حسيناً | شفاعة جدِّه يوم الحساب |
وما كادت الجماعة تشهد هذا حتى فرَّت هاربة وتركت الرأس.
أما الخبر الثاني فذو دلالة على طبيعة الصراع الذي حدث في نفوس المشتركين في المعركة من نحو أوّل، وعلى نوعيَّة هؤلاء الناس وحقيقة انتمائهم وخيارهم. وهو يطرح سؤالاً حول حقيقة إتباعهم سبل الدين الإسلامي.
ـ يروي الطبري أن عمر بن سعد التقى السيدة زينب (عليها السلام) على أثر حدوث كربلاء، فخاطبته قائلة: «أيقتل أبو عبدالله وأنت تنظر إليه!؟…
فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على خديه ولحيته. وأعاد ما كان قاله عندما قرّر الاشتراك في المعركة. وهو قوله:
| أأترك ملك «الري» وهو بغية | أم أرجع مذموماً بقتل حسين | |
| وفي قتله النّار التي ليس دونها | حجاب، وملك الري قرّة عيني([1102]) |
إن فظاعة ما حدث في كربلاء جعلت الجلاد يبكي، وذلك على الرغم من أنه أقدم على ما فعله بشكل واع، وبناء على اختيار أطال التفكير فيه، ولكنها الدنيا. و«الدنيا مطلوبة، وهي في أيدي بني أميَّة»، كما كانوا يقولون.
وهكذا، كما يبدو واضحاً، عاش المسلمون بعامَّة، حالة من الحزن دخلت في التكوين الوجداني للنفس، وإن تكن من فئةٍ اختارت المشاركة في الإثم، فإنها عاشت فظاعة الجرم الذي ارتكبت، وعاشت صراعاً حسمته المصالح: «قرّة العين» التي تعمي عن الصّواب. وإن كان لنا من إضافةٍ في صدد هذه القضية فهي القول إن المذاهب الإسلامية لم تكن قد تكوّنت بعد، والحديث عن مذهب شيعي في هذه الفترة من التاريخ حديث غير دقيق.
ولم يبق المسلمون في حدود الحزن يكابدونه ويعانونه، وإنما تحرَّكوا… وأثمر الحزن في المدينة التي رأينا مظاهر من مشاعر أبنائها انتفاضة شكلت كربلاء خلفيّتها، لكنّ السيف المقنَّع بالحق الإلهي، بالخلافة كان مسرفاً هذه المرة أيضاً، وحدثت مجزرة «الحرّة» واستباحة المدينة، وقصف مكة بالمنجنيق، ثم كانت حركة التوّابين، في العراق…
يمكننا القول هنا، أن كربلاء بدأت تثمر ثورات متتالية، ولم تكن صمام أمان للسلطات القمعيَّة، ويهمّنا هنا، أن نناقش قضية «الشعور بالذنب» الذي كوَّنته كربلاء من حيث طبيعته وأثره التاريخي، وبخاصة لدى حركة التوّابين التي كانت ردة فعل مباشرة لكربلاء.
إن «الشعور بالذنب» خطير من ناحيتين: إنه إن تفجَّر ثورة أو ارتدَّ عدواناً على الذات كمهرب من القهر، وهو في كلِّ حالةٍ يخدم اتجاهاً عدوّاً للاتجاه الآخر، ففي الحالة الأولى يخدم الثوار وفي الحالة الثانية يخدم السّلطان. نعي هذه الحقيقة، ونريد أن نرى إلى الحركات التي تلت كربلاء، محاولين الإجابة عن السؤال التالي:
ـ أكانت هذه الحركات صمام أمان للسلطات القمعيَّة أم أنّها حركات تنهج نهج كربلاء؟
والحقيقة أنه لا يمكن لأي عاقل أن يرى في خروج التوابين لقتال عبيدالله بن زياد صمام أمان له. وبخاصة أن حركة التوَّابين كانت حركة واعية منظمة في منطلقها وهدفها ووسائل تحقيق هذا الهدف.
والمعروف أن هذه الحركة بدأت بوصفها ردّة فعل مباشرة لكربلاء وكان هدفها واضحاً، كما يبدو من أقوال أحد قادة التوابين، التي كان يدعو بها الناس إلى الانضمام لحركته: «إنَّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه والطلب بدماء أهل بيته وإلى جهاد المحلِّين المارقين، فإن قتلنا فما عند الله خير للأبرار، وإن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبيّنا». ويضيف قائد آخر مبدأ «الدفع عن الضعفاء وجهاد المحلّين»([1103]).
كانت دعوتهم واضحة الأهداف، فلنحاول التعرف إلى حركتهم لتحقيق هذه الدعوة لنرى إن كانت ارتداداً على الذات أم تفجراً إيجابياً يسعى للجهاد والتغيير.
يقول الطبري: «لما قتل الحسين بن علي (ع)، ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة، ودخل الكوفة تلاقت الشيعة بالتّلاوم والتندّم، ورأت أنها أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين (ع)… ورأت أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم في مقتله إلاَّ بقتلهم من قتله أو القتل فيه». ويعبر أحد قادة التوّابين عن موقفهم، آنذاك: «ألا انهضوا، وقد سخط ربّكم، ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله»([1104]).
وأعتقد أن هذا الكلام واضح الدلالة على أنهم لم يحسوا الخطيئة فحسب، وإنما أدركوها ووعوها، وشكل هذا الوعي لديهم حالة نهوض وفعل لا يهدآن حتى يرضى الله، وهنا يبدو الفرق كبيراً جداً بين الإحساس والوعي. وكلّما كانت الأمور أقل وضوحاً كان توظيفها اللاعقلاني أكثر إمكانيّة. وهذا لم يحصل لدى التوابين. ولم يحصل في تاريخ الشيعة إلاَّ في فترات موّه فيها «يزيد العصر». أما عندما تكون الأمور واضحة. فتوظيفها اللاعقلاني غير ممكن.
وكما قلنا وعى التوّابون خطأهم، ورأوا الطريق الموصلة إلى تصحيحه، وحدّدوا الهدف الذي يريدون تحقيقه، فصرخوا: «ألا انهضوا» ولم يكتفوا بهذا بل ربطوا تحركهم ـ المضحّي بكل شيء ـ بالتاريخ النضالي ضد الأُمويين. فنسمع أحد قادتهم يقول إن قتالهم سيستمر «ولو كان في ذلك حزّ الرِّقاب وقتل الأولاد واستيفاء الأموال وهلاك العشائر، ما ضرَّ أهل عذراء الذين قتلوا ألا يكونوا أحياء اليوم، وهم عند ربهم يرزقون»([1105]).
ولم يكن التوّابون فتياناً ساقتهم الحماسة بل كانوا رجالاً من ذوي المكانة الاجتماعية والدّينيّة، فعلى سبيل المثال نذكر سليمان بن صرّد الخزاعي صحابيٌّ جليل، والمسيّب بن نجبة الفزاري: «فارس مضر الحمراء كلها، وإذا عدّ من أشرافها عشرة كان أحدهم. وهو يعدّ رجل نسك ودين»([1106]).
وحركتهم لم تكن ردّة فعل فوريّة، وإنما كانت حركة واعية استمر التحضير لها من عام 61هـ حتى عام 65هـ. تولى الأمر خلالها خمسة قادة رأّسوا سليمان بن صرَّد عليهم ووزّعوا الأدوار. فعلى سبيل المثال، تولى عبدالله بن والٍ استلام الأموال وتجهيز الفقراء([1107]).
ويلاحظ في تصرّفهم انتفاء العصبيّة القبيلة، وهذا أمر نادر في ذلك العصر. وكان لديهم برنامج عمل محدّد. وكانوا يناقشون الأمور باستمرار مثل: أي عدوٍّ يواجهون في البداية، قتلة الحسين في الكوفة أم عبيدالله بن زياد؟ وإن انتهوا إلى رأي كانوا يعلِّلونه. كما فعل سليمان بن صرّد، عندما قال مبرِّراً تفضيله لمواجهة ابن زياد أولاً: «رأيت أن قتلة الحسين هم أشراف الكوفة وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه…» وأرسلوا إلى المدائن والبصرة رسلاً زيادة في الاستعداد.
وهكذا يبدو واضحاً أن هذه الحركة كانت حركةً واعيةً منظّمة، وكان ممكناً لها النجاح، في معركتها الأولى، لولا أن المختار الثقفي أتى وأحدث انقساماً في الصفوف فلم يخرج من الاثني عشر ألفاً الذين سجلهم ديوان سليمان إلاَّ أربعة آلاف.
ولعل في القليل المتبقي من شعر هذه الفترة دليلاً واضحاً على أن التعبير الأدبي لم يكن حزيناً بكائياً جنائزياً، أي «مرتدّاً إلى الذَّات» كما لم يكن السلوك العملي كذلك. ولعلنا بحاجة إلى إيراد بعض الأمثلة:
ـ كان المسيب بن نجبة الفزاري يرتجز، وهو يهجم:
| قد علمت ميّالة الذّوائب | واضحة اللبَّات والتّرائب | |
| أني غداة الوغى والتغالب | من ذي لبدٍ مواثب |
قطاع أقران مخوف النجائب([1108])
ـ أرسل المثنى بن محربة العبدي مقطوعة شعرية في أسفل الكتاب الذي أجاب به دعوة سليمان بن صرّد: تبصَّر كأني قد أتيتك…
| بكل فتىً لا يملأ الروع نحره | محسّ لعضِّ الحرب غير شؤوم | |
| أخي ثقةٍ ينوي الإله بسعيه | ضروب بنصل السَّيف غير أثيم([1109]) |
أهذا «بكائيات وجنائزيات… أم وصف لهذه القوّة الآتية، مرهب باعث للثقة في آن؟ ولنلاحظ وصف المثنى الرائع للفتى القادم: محارب جلد، أخو ثقة، ينوي الإله بسعيه. وهذه العبارة: «ضروب بنصل السيف غير أثيم» التي لا نستطيع نثرها لما فيها من جمع بين القدرة على القتل وبين الإيمان والتقوى. ولعلها «الحرب العادلة» بلغة أيَّامنا.
يصحو عبدالله بن الأحمر، ويقرّر الاشتراك في المعركة، وينشد داعياً أصحابه إلى إجابة النداء:
| صحوت، وقد أصحوا الصّبا والعواديا | وقلت لأَصحابي: أجيبوا المناديا | |
| وقولوا له: إذا قام يدعو إلى الهدى | وقبل الدعا: لبيك لبيك داعيا | |
| لبيك حسين مرمّل ذو خصاصة | عديم إماماً قد تشكى المواليا | |
| ألا وانع خير الناس جدّاً ووالداً | حسيناً لأهل الدين، إن كنت ناعيا | |
| فأضحى حسين للرماح دريئةً | وغودر مسلوباً لدى الطف ثاويا | |
| فيا ليتني إذ ذاك، كنت شهدته | فضاربت عنه الشانئين الأعاديا | |
| سقى الله قبراً ضمن المجد والتقى | بغربيّه الطفّ الغمام الغواديا | |
| فيا أمة تاهت وضلّت سفاهة | أنيبوا فارضوا الواحد المتعاليا([1110]) |
إنّها صحوة تعيد الشباب والرماح، وتلبِّي داعي الثورة وليست ردّة على الذَّات. وهي صحوة تلتفت إلى الأَصحاب تريد لهم أن يشاركوا في عودة الصّبا بحماسته وشدته واندفاعه وتعامله مع الأسنّة تلبيةً لداعي الهدى. وهذه الصحوة لأهل الدين مميزاً لهم عن الآخرين، كانت بفعل «كربلاء». وقد عبَّر الشاعر عن ذلك بنعيه «خير الناس» وبصورتين للإمام تظهر الأولى حقيقته وتظهر الثانية ما حل به، وكأنه يقابل بينهما ليكشف فظاعة ما حدث، فيأتي موقفه، الذي يتخذ شكل أمنية، وليد تطورٍ طبيعي، ثم يتطور موقفه الذاتي إلى إطلاق نداءٍ لأمة تاهت سفاهة، يطلب فيه منها العودة إلى الصواب وتلبية ندائه لأنه يحقق رضا الله المتعاليا. وهذا ما يجعلنا نضع قوله «لبيك لبيك داعياً، لبيك حسين…» في موقعه الصحيح، إذ إنه يشبه: «لبيك اللهم لبيك..» إنه تلبية ترضي الله. والملفت، في صدد القضية التي نناقش، أن عبدالله تذكّر ما حدث في كربلاء، فتمنى أن يكون شهدها ويطلب للقبر الذي ضمن المجد والتقى والسقيا. وينتهي بشكل صريح وواعٍ إلى النعي على الأمة ضلالها، ويصرخ طالباً العودة إلى إرضاء الله. وكما يبدو ليس من ردّة على الذات إطلاقاً.
وجِّهت الدعوة إلى «أهل الدِّين» كما يقول عبدالله بن الأحمر. وأثمرت فخرج الذين «أنابوا» و«أرضوا الواحد المتعاليا» والشاعر الفارس نفسه يرتجز بهم، وهو على فرس له «يتأكّل تأكلاً، كميت مربوع»:
| خرجن يلمعن بنا إرسالا | عوابساً يحملننا أبطالاً | |
| نريد أن نلقى به إلاَّ قتالا | القاسطين الغدّر الضلالا | |
| وقد رفضن الأهل والأموالا | والخفرات البيض والحجالا |
نرضي به ذا النعم المفضالا([1111])
بطال عوابس يتجهون مسرعين سيوفهم تلمع، يقصدون إلى قتال «القاسطين الغدّر الضلالا» رافضين كل ما في هذه الدنيا من مغريات ولذائذ، يطلبون بذلك رضا الله… أيكون هؤلاء «صمام أمان» للسلطات القمعيَّة؟ أيكون صنيعهم «ارتداداً على الذات»؟ نريد للباحث، أي باحث، أن يكون ملمّاً بمختلف جوانب موضوعه قبل أن يحكم. «ونودّ أن نضيف فنقول: إن الفرار من «الخطيئة»، أو من «الإحساس بالإثم» وبغضب الله، كان فراراً إلى رضا الله، وهذا الرضوان كان سرّ الرجال وعلانيتهم، وهذا ما نقرأه في كثير من تعبير ذلك العصر ولنقرأ ما كان يردِّده أحد المنيبين الذي كان يقاتل قتالاً شديداً:
| إني من الله إلى الله أفرّ | رضوانك، اللهم، أبدي وأسرّ([1112]) |
ولنسأل: أكان إحساس هذا الفارس بـ«الخطيئة» يرتد إلى نفسه عدواناً عليها، أم أن إيمانه العميق ووعيه بمعطيات عصره يدفعانه إلى صحوة ثائرة تطلب رضوان الله في قتال «القاسطين الغدّر الضلالا»!؟.
إن الإجابة واضحة، ولا تحتاج إلى عناء، فكربلاء كانت حدثاً يكشف الزيف ويدعو إلى صحوة ترى الأمور على حقيقتها، وتدفع إلى فعل ثوري مغيِّر في الاتجاه الذي يرضي الله. ولم يقتصر هذا التأثير على فترة من الزّمن محدَّدة، وإنَّما استمر طوال العصور التوالي. ففي فترةٍ ثار زيد بن علي، وكان برنامجه الديني السياسي واضحاً، إذ أنه قال في إحدى خطبه، على سبيل المثال: «… إنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه، وردّ المظالم، والدفاع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين، وقسم هذا الفيء بين أهل السّواد، وجهاد الظالمين، ونصرة أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقنا»([1113]).
ولم يكن تحرّك زيد ردّة فعل عاطفيّة تنطلق من الإحساس بالإِثم وإنما كانت ثورة برنامجها واضح، كما أسلفنا، وكان القائم بها، كما يصفه هشام بن عبدالملك، في الكتاب الذي أرسله إلى عامله يوسف بن عمر: «… رجلاً جدلاً لسناً، خليقاً بتمويه الكلام وصوغه واجترار الرِّجال بحلاوة لسانه وبكثرة مخارجه وما يدلي به عند لدد الخصام من السّطوة على الخصم بالقوّة الحادّة لنيل الفلج…»([1114]).
هذا هو زيد بن علي، على لسان خصمه، ومثله كان دعائه، وكان تعبير هؤلاء شعراً وخطابةً. وليكن مثلنا على ذلك داعيتان، وهما الشاعران الخطيبان في آن: عبدالله المرِّي والكميت بن زيد الأسدي. ومما جاء في كتب التاريخ عن المرِّي ما يلي: «ما رأيت، من هذه الأمة أحداً كان أبلغ من عبدالله المرِّي في منطق ولا عظة»، كان يخطب فيركّز على أهمية النبي، ويتساءل: هل هناك أعظم حقاً منه!؟ وهل هناك أعظم حقاً من ذرّيته!؟ ثم يصور هول الجرائم التي ارتكبت بحقِّهم مخوِّفاً القاتل والخاذل. وبعد أن يصل إلا غايته يفتح باب التوبةَ وهذا يتم بعد عرض البرنامج المحدِّد للثورة وقبوله. وكان يعيد هذا الكلام في كل يوم حتى يحفظه الجميع([1115]) والكميت بن زيد الأسدي كان يريد، من شعره إلى الناس عامة فيقبلون عليه بشوقٍ ورغبة ويتدبرونه اطلاعاً وإعادة اطلاع ودراسة حتى يحفظوه. ومن هنا كان مصدر التجديد الفني في شعر الكميت.
إن ما ينبغي الإشارة إليه، وإن كان التفصيل فيه غير متاحٍ في هذا المقام هو التطوّر الفنِّي الذي عرفه أدب الدعوة: شعراً وخطابة، إذ إن تجربة الحركة الثورية تجسدت في نصوص لغويَّة فنيّة تتوجه إلى الاهتمام بالإنسان وقضاياه، معتمدةً وسائل التأثير والإقناع، في استجابة واعية لشروط النشر في ذلك العصر، وفي استفادةٍ من مختلف علومه وثقافته.
ويلاحظ الأستاذ أَحمد نجا، في كتابه عن الكميت بن زيد الأسدي، أن الشاعر استخدم التكرار والطباق والترصيع والترتيب والمجاورة لتأكيد المعنى، والالتفاف لتأكيد فكرةٍ أو نفيها. كما يلاحظ أن شعره يتميَّز بصفاء لغة وجزالة تعابير وانتقاء مفردات. وأنه جدد من حيث القالب، فصار موضوع الأطلال ثانوياً، وانصرف إلى الجدل في بناء شعريٍّ متماسك، كما أنه جدد من حيث الموضوعات؛ إذ هجر النسيب والأوضاع البدويّة، وركَّز على الاهتمام بالإنسان وقضاياه.
ويقارن الأستاذ نجا بين الكميت وبين أَبي نواس، ويعطي أمثلة منها قول الكميت:
| فدع ذكر من لست من شأنه | ولا هو من شأنك المنصب | |
| وهات الثناء لأهل الثناء | بأصوب من قولك فالأصوب |
ويقارن بين قول الكميت:
| مالي في الدّار، بعد ساكنها | ولو تذكّرت أهلها، أرب |
وبين قول أَبي نواس:
| ما لي بدارٍ خلت من أهلها شغل | ولا شجاني لها شخص ولا طلل |
وبعدما يستنفد الباحث وجوه المقارنة بين الشاعرين، ينتهي إلى القول: «الكميت هو الحافز الحق للثورة الأدبيّة العباسيّة والسبّاق للتحرر والتجديد»([1116]).
ويتحدث الدكتور عبدالقادر القطّ عن ظاهرة التجديد في شعر الكميت، فيخلص إلى القول: «…وتؤكد هذه الظاهرة الملموسة في شعر الكميت أن التطوّر الفنِّي الذي عرف، فيما بعد باسم البديع… كان تطوّراً طبيعياً ممتداً، متأثراً بطبيعة التجربة عند الشاعر وبحسه اللغوي والموسيقي»([1117]).
ويبدو أن القدماء لاحظوا تميّز شعر الكميت، ونذكر، في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، ما يلي: سأل أبو تمام خشافاً عن الكميت بن زيد وعن شعره وعن رأيه فيه، فقال خشاف: «لقد قال كلاماً خبط فيه خبطاً من ذاك (مما لا يجوز) لا يجوز عندنا ولا نستحسنه، وهو جائز عندكم. وهو على ذاك أشبه كلام الحاضرة بكلامنا وأعربه وأجوده. ولقد تكلم في بعض أشعاره بلغة غير قومه»([1118]).
تجربة الكميت بن زيد الحياتية تختلف، غير تجربة بعض قومه، فكان تجسيدها اللغوي الفني مختلفاً، وهذا هو التجديد الحقيقي الأصيل إذ يرتبط فيه المتحوّل الشعري بالمتحوّل الحياتي، والفرق كبير جداً بين أن تفرض التجربة الشعرية الشكل وبين أن يدور الشاعر على شكل يصب فيه معانيه ولا يكون أمامه إلاَّ تزيين هذا القالب وتزويقه. وهذا الفرق نلحظه بين شعر الكميت وشعر البديع التالي له. ولعل مردُّ هذا الفرق يعود إلى شدّة اهتمام الكميت بالإنسان وإرادته أن يتجه الناس إلى معالجة مشكلاتهم الحقيقية، وليس من شك في أن هذا جميعه أفضل ردٍّ على من يتهمون الأدب الشيعي بالارتماء في أحضان الحزن، بوصفه منفِّساً للمشاكل والقضايا. إن الكميت يفتح باباً عريضاً للتطور الفني انطلاقاً من فكرة الاهتمام بالإنسان ومصيره وضرورة معالجته لمشكلاته. وهنا يكمن الفرق بين الأصالة والافتعال، وبين الحركة المغيرة مبتغية رضوان الله وبين الركون إلى الثبات في ظلِّ سلطان لا يتبع ما يقتضيه هذا الرضوان.
إن الداعية الثوري الذي يمثله الكميت في العصر الأُموي، يحدو بهذه الحركة الفاعلة في عصره، وينشد لها في العصور التوالي، قائلاً:
| فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم | فحتى م حتى م العناء المطوّل |
إن صوت الكميت يتردَّد في العصور التوالي وإن كنا نتوقف الآن، عن مواكبة هذا الصوت، فإننا نرغب في القول: ينبغي على أي حكم أن ينطلق من وقائع التاريخ وأن يكون دقيقاً، وحرصاً منا على مثل هذا الحكم نؤكد أن ما ذهب إليه د. رزق الله ومن يذهب مذهبه من الباحثين لا يصدق على الفترة الزمنية الممتدة من زمن حدوث كربلاء وحتى القضاء على الحكم الأموي وقيام الحكم العباسي. وليس من شكٍ في أنه لا يصدق تماماً على بقية العصور، ولكن تأكيد ذلك بالوقائع يحتاج إلى دراسات خاصة، وهذا ما ندعو مطلقي الأحكام إلى فعله قبل إطلاق أحكامهم.
الدكتور عبدالمجيد زراقط
التعزية([1119]*)
(أ) في الواقع التاريخي
كان المسلمون قد واجهوا الحكم الأُموي بالغضب والسخط، وأدركوا فوراً بُعد هذا الحكم عن الخط الإسلامي الصحيح، وذلك حين افتقدوا فيه الروح الإسلامية التي ألفوها في الخلفاء السابقين، إذ اكتشفوا أن الخلافة الإسلامية قد تحولت إلى ملك أُموي.
ولأضع صورة غنية ببعض التفاصيل أذكر لكم الرأي الذي تبناه الدكتور حسن إبراهيم حسن مدير جامعة أسيوط في كتابه «تاريخ الإسلام 1 ـ 278 ـ 279».
قال:
«اعتبر المسلمون انتصار بني أمية، وعلى رأسهم معاوية انتصاراً للأرستقراطية الوثنية التي ناصبت الرسول وأصحابه العداء، والتي جاهدها رسول الله حتى قضى عليها وصبر معه المسلمون.. فقضوا عليها، وأقاموا على أنقاضها دعائم الإسلام، ذلك الدين السمح الذي جعل الناس سواسية في السراء والضراء، وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون الفقراء، ويستذلون الضعفاء، ويبتزون الأموال. لذلك لا ندهش إذا كره المسلمون بني أمية، وغطرستهم، وكبرياءهم، وإثارتهم للأحقاد القديمة، ونزوعهم للروح الجاهلية، ولا سيما أن جمهور المسلمين كانوا يرون بين الأُمويين رجالاً كثيرين لم يعتنقوا الإسلام إلاَّ سعياً وراء مصالحهم الشخصية» انتهى كلام الدكتور حسن.
هذا هو التشخيص التاريخي لما حدث حينذاك.
ولكن الحكم الجديد استطاع شيئاً فشيئاً أن يقيم جهازاً محكماً ـ بوليسياً وإعلامياً ـ يعمل بإتقان تام على تبديد النظرة التي وجه بها النظام ليحل محلها نظرة جديدة، ويعطي النظام صفة الشرعية التي نزعها المسلمون عنه.
وقد استخدم هذا الجهاز في تبديد قوة الخصوم المعارضين بإثارة الصراع القبلي على أوسع نطاق، وإرهاب المعارضة بالقتل، والمطاردة، وهدم البيوت، وقطع الأرزاق من بيت المال، وكل وسيلة تجعل المعارضة في حالة رعب مستمر، حتى تهجير السكان على نطاق واسع استخدم في هذا السبيل، فقد حمل زياد بن سمية ـ والي العراق ـ خمسين ألفاً من الكوفيين وأسرهم على النزوح من الكوفة إلى خراسان، وبذلك حطم المعارضة في الكوفة وخراسان معاً.
ولعل أخطر ما حدث هو سياسة التخدير الديني التي كان الهدف منها التغلب على الشعور المعادي بسلاح الدين نفسه، والتوصل إلى تحطيم ما لأهل البيت من سلطان روحي على المسلمين عن هذا الطريق أيضاً. وقد حفظ لنا التاريخ بعض الأسماء من الصحابة والتابعين عملوا على إيجاد تبرير ديني لسلطان بني أمية، أو على الأقل كبح الجماهير عن الثورة برادع داخلي هو الدين نفسه، ليعمل مع الروادع الخارجية: التجويع والإرهاب، والانشقاق القبلي والعنصري. هذا بالإضافة إلى مهمة أخرى ألقيت على عاتق هؤلاء الأشخاص، وهي اختلاق الأحاديث التي تضمن الطعن في أهل البيت ونسبتها إلى النبي (ص).
وأذكر لكم حديث العجاج نموذجاً من أحاديث التخدير الديني التي اختلقها جهاز معاوية الإعلامي ونسبها إلى الدين. حدث العجاج قال: «قال لي أبو هريرة: ممن أنت؟ قال قلت: من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتيك بقعان أهل الشام فيأخذون صدقتك، فإذا أتوك فتلقهم بها، فإذا دخلوها فكن في أقاصيها، وخل عنهم وعنها، وإياك أن تسبهم، فإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك، وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة».
وثمة ركام من أمثال هذا الكذب الذي يدعو المسلمين إلى الخضوع لأمرائهم الظالمين، ويحرم عليهم الثورة والاحتجاج على هؤلاء الأمراء، وحتى نقدهم.
وقد دأب المأجورون من الوعاظ والمحدثين على نفث هذه السموم في قلوب الجماهير المسلمة وعقولها، هادفين إلى حجزها عن التذمر والثورة بحاجز ينسبونه إلى الدين والدين منه بريء.
عشرون عاماً تقريباً مرّت على المسلمين وهم يحكمون بهذا الأسلوب ويخضعون لهذا التوجيه حتى شلت فيهم كل قدرة على الاحتجاج والثورة، وعن هذا الطريق استطاع معاوية أن يسبغ على نظامه شرعية مزيفة، وفي ظل هذه الشرعية جاء يزيد بن معاوية خليفة لرسول الله (ص) وأميراً للمؤمنين.
وقد صوَّر لنا عبدالرحمن بن همام السلولي نظرة المسلمين إلى خلافة يزيد في الأبيات المعبرة:
| فإن تأتوا برملة أو بهند | نبايعها أميرة مؤمنينا | |
| إذا مات كسرى قام كسرى | نعد ثلاثة متناسقينا | |
| فيا لهفا لو أن لنا أنوفا | ولكن لا نعود كما عنينا | |
| إذا لضربتموا حتى تعودوا | بمكة تلعقون بها السخينا | |
| حشينا الغيط حتى لو شربنا | دماء بني أمية ما روينا | |
| لقد ضاعت رعيتكم وأنتم | تصيدون الأرانب غافلينا |
بهذا السخط المكبوت بعوامل القمع المادي والتخدير الديني واجه المسلمون خليفتهم الجديد.
وعند هذه المرحلة من التبدلات السياسية والاجتماعية والإنسانية في المجتمع وجد الحسين نفسه يواجه ـ وحيداً ـ دوره التاريخي الصعب:
الحكم الأُموي بكل ما يحفل به من فساد ورجعية وظلم، وبكل ما بعد به عهد يزيد من تحريف للإسلام، واستهتار به وتسخير له في خدمة الشهوات والمآرب، هذا من جهة، والأمة المسلمة بذلها، وتصدعها، وحرمانها، وانطفاء القدرة على التغيير فيها من جهة أخرى، ومركزه العظيم في المسلمين الذي يجعله على يقين بأن حكم يزيد لن ينال صفة الشرعية إذا وقف ضده أما إذا بايعه فإنه يكون قد أكسب الغل الجديد الذي طوقت به الأمة المسلمة صفته الشرعية.
وقد استجاب الحسين لدوره التاريخي، وبدأ ثورته في كلمات بسيطة، واضحة وحاسمة، وجهها إلى والي المدينة الوليد بن عتبة، وذلك حين قال له:
(.. أنا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق، فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله).
ولكن علينا أن نعلم أن الحسين أعلن ثورته في مجتمع خامد، متخاذل، فقد حرارته وفاعليته، واندفاعه.
لقد كان قادة المجتمع وعامة أفراده إذ ذاك يقعدون عن أي عمل إيجابي لتطوير واقعهم السيء، بمجرد أن يلوح لهم ما قد يعانون في سبيل ذلك من عذاب، وما قد يضطرون إلى بذله من تضحيات وكانوا يقعدون عن القيام بأي عمل إيجابي بمجرد أن تحقق لهم السلطة الحاكمة بعض المنافع القريبة، ولم يكن هذا خلق السادة وحدهم، بل كان خلق عامة الناس أيضاً لقد كان أولئك الذين قالوا للحسين: (قلوب الناس معك، وسيوفهم عليك) صادقين إلى حد بعيد في تصوير ذلك المجتمع، فإن قلوب الناس كانت معه لأنهم يحبون أن يصيروا إلى حال أحسن من حالهم، ولكنهم حين علموا أن ذلك موقوف على بذل تضحيات قد تصل إلى بذل الحياة انكمشوا، ووضعوا سيوفهم في خدمة السلطة التي تدفع لهم أجر قتالهم لهذا الذي جاء بدعوة منهم ليحررهم من السلطة، فحين استيقن ابن زياد أن الحسين ماض في ثورته جمع الناس في مسجد الكوفة، وخطبهم، ومدح يزيد وأباه، ووعد الناس بتوفير العطاء لهم، وزادهم في أعطياتهم مائة مائة، وأمرهم بالاستعداد والخروج لحرب الحسين.
في مجتمع كهذا ثار الحسين.
وهنا نتساءل: كيف يسير إنسان إلى الموت مع طائفة من أخلص أصحابه طائعاً مختاراً، وكيف يحارب في سبيل قضية يعلم أنها خاسرة؟ وكيف يمكّن لعدوه من نفسه هذا التمكين؟.. أن علينا لكي نفهم ثورة الحسين أن نبحث عن أهدافها ونتائجها في غير النصر الآني الحاسم، وفي غير الاستيلاء على مقاليد الحكم والسلطان، فإن النصوص المتوفرة لدينا تدل بصراحة على أن الحسين كان عالماً بالمصير الذي ينتظره. لقد كان يجيب من ينصحونه بالمهادنة والسكوت، ويخوفونه من الموت بأمثال قوله: «لقد غسلت يدي من الحياة وعزمت على تنفيذ أمر الله».
إذن، فأين نجد أهداف ثورة الحسين؟
الذي أعتقده هو أن وضع المجتمع الإسلامي إذ ذاك كان يتطلب القيام بعمل انتحاري فاجع يلهب الروح النضالية في هذا المجتمع، ويتضمن أسمى مراتب التضحية ونكران الذات في سبيل المبدأ لكي يكون مناراً لجميع الثائرين حين تلوح لهم وعورة الطريق، وتضمحل عندهم احتمالات الفوز، وترجح عندهم أمارات الفشل والخذلان.
إن المجتمع الذي خضع طويلاً لتأثير التخدير الديني، والقمع المادي لا يمكن أن يصلح بالكلام، فهو آخر شيء يمكن أن يؤثر شيئاً في النفس الميتة والقلب الخائر، والضمير المخدر، كان لا بد لهذا المجتمع من مثال يهزه هزاً عنيفاً، ويظل يواليه بإيحاءاته الملتهبة ليقتلع الثقافة العفنة التي خدرته، وقعدت به عن صنع مصير وضاء. وقد كان كل ذلك، وكانت ثورة الحسين.
لقد أراد الحسين أن يكشف لمجتمعه عن بؤس الواقع وإفلاسه، وعن أخطار المستقبل وأهواله، وأن يبرهن على صدق رؤيته للحاضر والمستقبل بتضحيته الفريدة، ليجعل من القضية شيئاً يتوهج في ضمير الأمة وقلبها، ويذيب بحرارته ونقائه كل الخبث الذي ترسب في أعماقها. فيردها إلى طهارتها، ويرد إليها شخصيتها الأصيلة الضائعة، فتواجه واقعها بالأسلوب الوحيد الصحيح: نبذ التحريفية الدينية، والثورة.
فهل تحقق هذا الهدف.
نعم. لقد تحقق، لقد حطمت ثورة الحسين الإطار الديني الذي أحاط الأُمويون به حكمهم، لقد انتزعت مرة واحدة وإلى الأبد الشرعية المزيفة التي كان الحكم الأُموي يتستر وراءها، وظهر للأعين المدهوشة على حقيقته البشعة: حكماً بربرياً، جاهلياً، بعيداً عن الإسلام، لا يتورع عن شيء في سبيل تحقيق أهدافه ومقاصده.
وقد كانت الثورة عاملاً حاسماً في تعاظم التيار الإسلامي المبرأ من الانحراف والتزوير بما كشف من تحريفية الحكم الأُموي ولا شرعيته، ومن ثم لا إسلامية الخط الذي يمثله.
وبشرت الثورة بأخلاق جديدة تمثل الأخلاق الإسلامية الإنسانية، وذلك حين دعت ـ بسلوك أبطالها وقائدها ـ إلى التلاحم المطلق مع العقيدة، وذلك بممارستها بصدق وإخلاص على صعيد الحياة العامة وعلى صعيد الناس العاديين، ومصالح الأمة.
وقد ترتب على كل ذلك، وغيره مما لم نذكره، انبعاث الروح النضالية متوهجة عنيفة.
لقد أجَّجت ثورة الحسين الروح النضالية التي حاول الأُمويون إخمادها في الأمة، وبقيت مستمرة تعبر عن نفسها دائماً في انفجارات ثورية عاصفة ضد الحاكمين الظالمين، وكانت الثورات تفشل دائماً، ولكنها لم تخمد أبداً، لأن الروح النضالية كانت باقية تدفع الأمة إلى الثورة، وإلى التمرد، وإلى التعبير عن نفسها قائلة للطغاة: إني هنا.
حتى جاء العصر الحديث، وتعددت وسائل القمع والإخضاع، وحكمت الأمة بطغمة لا تستوحي مصالحها وإنما تخدم مصالح آخرين، ومع ذلك لم تهدأ ولم تفلح في إخضاعها وسائل القمع الحديثة، وإنما بقيت ثائرة، فأثبت وجودها، ولم يجرفها التاريخ، وإنما بقيت لتصنع التاريخ.
ولا ندري تماماً ماذا كان سيحدث لو لم يقم الحسين بثورته هذه. غير أننا نستطيع أن نحدس ذلك الأن. لقد كان يحدث أن يستمر الحكم الأُموي دائماً نفسه بالدجل الديني، وبفلسفة التواكل، وبالقمع المادي، وكان يحدث أن تستحكم هذه الفلسفة وهذا الدجل الديني في الشعب، فيطأطىء الشعب دائماً لحاكميه، ويستكين الحاكمون لموقف الشعب منهم فيلهون، ويضعفون عن القيام بأعباء الحكم وصيانة الدولة ويغرقون في اللهو والترف. وعاقبة ذلك هي الانحلال: انحلال الحاكمين والمحكومين. وكان يحدث أن يكتسح البلاد الفاتحون فلا يجدون مقاومة ولا نضالاً، بل يجدون انحلالاً من الحاكمين والمحكومين، ثم يجرف التاريخ أولئك وهؤلاء. ولكن ما حدث غير ذلك، لقد انحل الحاكمون حقاً، وقد اكتسحت الدولة حقاً، ولكن المحكومين لم ينحلوا، بل ظلوا صادمين.
وكان ذلك بفضل ثورة الحسين.
(ب) في الوجدان الشعبي
علينا حين نريد أن نتقصى ثورة الحسين في الوجدان الشعبي أن نذكر أولاً المسارب التي دخلت منها هذه الثورة إلى الوجدان بهذا العمق والشمول، وثانياً العوامل التي طورتها وصعدتها في هذا الوجدان.
أما عن المسارب التي دخلت منها الثورة فيبدو لي أنه يمكن تلخيصها في الأمور التالية:
1 ـ الجانب العقيدي: فثورة الحسين ـ كما رأينا من خلال عرضنا التاريخي لها ـ إسلامية عامة، تمت بدوافع إسلامية لغاية تنبيه الأمة على واقعها السيء ودفعها إلى تحسينه عن طريق إثبات شخصيتها الإسلامية، ومن هنا فهي ليست تراثاً مذهبياً للشيعة، ولا يجوز أن تكون كذلك. وصبغتها المذهبية جاءت نتيجة لعوامل تاريخية ليس هنا مجال البحث عنها.
2 ـ دعوة أهل البيت وتشجيعهم على ذلك: فقد حرص أئمة أهل البيت على إبقاء الثورة وتفاصيلها الفاجعة حية في الذهنية العامة للأمة، وذلك عن طريق التشجيع على قول الشعر وإنشاده فيها، وعقدهم المجالس الخاصة لسماع هذا الشعر، وسنوضح أبعاد هذه الدعوة ودوافعها بصورة أكثر تفصيلاً.
3 ـ الولاء وطبيعة المأساة: لقد كانت الثورة من بدايتها حتى نهايتها فاجعة تثير الشجن والأسى العميق، وقد كان الولاء لأهل البيت والتعلق بهم يدفع إلى التعلق بذكرياتهم وإحيائها: فمن جاذبية المأساة الخارقة، ومن دفع الولاء والحب والاحترام إلى تذكرها، غدت المأساة عنصراً أساسياً في الثقافة التاريخية العامة عند الإنسان المسلم بوجه عام والشيعي بوجه خاص.
وأما عن العوامل التي صعدت ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، وطورتها في المظاهر الاحتفالية والآثار الفنية، وخاصة في الشعر فيمكن إجمالها في ثلاث أمور:
الأول: ولاء الشيعة لأهل البيت على أساس أنهم الممثلون الأكثر أمانة وإخلاصاً وفهماً للإسلام.
الثاني: نفسية الإنسان الشيعي التي تكونت بسبب ما عاناه عبر التاريخ من اضطهاد بسبب موقفه من بعض الأحداث التاريخية، وبسبب اتجاهه العقيدي والفقهي، وما أدى إليه هذا الوضع من تأجيج روح الثورة على الواقع البعيد من تعاليم أهل البيت (عليهم السلام).
الثالث: موقف السلطات الحاكمة في العصور التاريخية، ـ بعد ثورة الحسين ـ من إحياء ذكراه، وزيارة قبره.
هذه في رأيي العوامل الأساسية ذات التأثير في كينونة ثورة الحسين في الوجدان الشعبي. وسنتعرف على مدى مساهمة كل واحد منها عندما ندرس ثورة الحسين في الوجدان الشعبي عبر مظهرين:
1 ـ المظاهر الاحتفالية (مجالس التعزية).
2 ـ ظاهرة البكاء.
1 ـ مجالس التعزية:
لقد بدأت تظهر آثار ثورة الحسين في الوجدان الشعبي في شعر الرثاء لشهداء الثورة، وفي شعر الندم والتوبة من أولئك الذين قعدوا عن مناصرة الثورة أو ساهموا في الحرب ضدها. وقلة الآثار التي ترجع إلى الحقبة الأولى بعد الثورة تعود ـ في رأيي ـ إلى الخوف من اضطهاد الأُمويين الذين شنوا حملة واسعة النطاق لحصر أثر الثورة في حيز ضيق، وذلك بعد أن اكتشفوا خطر التفاعلات التي أطلقت الثورة عقالها.
ولكن نشوب الثورة في الحجاز ضد الحكم الأُموي، وامتدادها إلى العراق وغيره، وانطلاق الأعمال الانتقامية ضد الأُمويين وأعوانهم أطلق فيضاً من الشعر الرثائي لثوار كربلاء.
ويبدو لي أنه في هذه المرحلة بالذات بدأت المآتم الحسينية بشكل بسيط، ولا بد أنها بدأت على شكل اجتماعات صغيرة يعقدها نفر من المسلمين الناقمين ـ من أتباع أهل البيت وغيرهم ـ في بيت أحدهم، فيتحدَّثون عن الحسين وعما جرى عليه، وينتقدون السلطة التي حاربته، وامتدادها القانوني المتمثل في السلطة المعاصرة لهم ويتبرؤون منها، وربما تناشدوا شيئاً من شعر الرثاء الذي قيل في الثورة وفي بطلها وقتلاها.
وقد تطورت هذه المآتم عبر العصور فمرت في أدوار متميزة حتى انتهت إلى أيامنا هذه على الشكل الذي تقام به الآن، وسنعرض لهذه الأدوار فيما بعد، إنما الذي نريد أن نوضحه الآن هو العوامل التي أنشأتها، وأعطتها قوة الاستمرار إلى الآن، وهي عدة أمور:
الأول: الانفعال العفوي بالمأساة، وهذا الانفعال في رأينا هو المسبب لكثير من مظاهر الذكرى الحسينية، فقد اشتملت ثورة الحسين على أحداث تبعث على الحزن العميق، والأسى البالغ.
الثاني: انها ثورة اسلامية، وقد رأى كثير من الناس في إحياء ذكراها وتمجيد أبطالها تمجيداً للإسلام الذي جاهدوا من أجله وقتلوا في سبيله.
الثالث: أن الثورات التي انفجرت ضد الحكم القائم بعد انبعاث الروح النضالية التي أحيتها ثورة الحسين قد استعملت هذه الثورة كعامل من عوامل الإثارة وحشد الجماهير، وجعلتها مناراً وشعاراً، وقد كان هذا عاملاً هاماً في إعادة إحياء هذه الثورة في قلوب الناس وعقولهم، ولا يقتصر هذا على العصر الأموي وحده، بل حتى في العصر العباسي في ثورات بني الحسن كان يبدو للناس وكأن روح كربلاء هي التي تحرك هؤلاء الثائرين.
الرابع: تشجيع أئمة أهل البيت على إحياء هذه الذكرى، وحثهم على نظم الشعر وإنشاده في شأنها، وعقدهم لمجالس الذكرى في بيوتهم، واستقبالهم للشعراء وسماعهم، وقد تعاظم تركيز الأئمة على هذا منذ عهد الإمام الباقر والصادق (ع)، ومن الأسماء البارزة في هذا المجال الكميت بن زيد الأسدي، والسيد الحميري، وجعفر بن عفان، ودعبل الخزاعي وغيرهم.
وأعتقد أن التفسير الصحيح لحث أهل البيت على إحياء الذكرى يرجع إلى أن إحياء هذه الذكرى يكشف للناس باستمرار عن الخط الذي انتهجه أهل البيت في حماية الإسلام والدفاع عنه، وعن طبيعة القوى التي تناهضهم ومدى بعدها عن الإسلام، وتبين أن جوهر الصراع يرجع إلى العقيدة ذاتها وإلى الأمانة في تطبيق الشريعة الإسلامية بإخلاص في الحياة اليومية، فمجرد إحياء الذكرى واستعراض أحداثها يتضمن إدانة للحكم القائم المنحرف لأنه الاستمرار القانوني للحكم الذي أدَّى انحرافه إلى ثورة الحسين وقتله. وتومىء كلمة الإمام الصادق للفضيل بن يسار بصراحة إلى هذا المحتوى للذكرى قال له «يا فضيل تجلسون وتتحدثون» قال نعم سيدي. قال يا فضيل هذه المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، رحم الله امرءاً أحيا أمرنا».
هذا هو التفسير الصحيح لمحتوى دعوة أهل البيت إلى إحياء هذه الذكرى، أما المحتوى العاطفي بوجه خاص فأعالجه عند الحديث عن «البكاء».
الخامس: أن الذكرى الحسينية بحكم طبيعتها من جهة، وبحكم ما تحمله من إدانة صريحة للحكم الديني المنحرف، وبحكم توجيه أهل البيت لها في هذا السياق، قد غدت في عصور كثيرة وسيلة من وسائل المعارضة المستترة للحكم القائم. فالإنسان الشيعي ـ في ظل الحكم ـ يعاني من أمرين، الأول: أنه مضطهد ومطارد بسبب عقيدته، والثاني: أنه تعلم من منهاج أهل البيت أن الإسلام عقيدة وشريعة متكاملة، ولهذا فهو لا يقبل التزوير بحال من الأحوال. فوضعه الحياتي وخطه الفكري وضعاه في مركز المعارضة، وقد كانت الذكرى الحسينية تحقق له ممارسة المعارضة المستترة ضد الحكم في نطاق آمن نسبياً، وتحقق له أيضاً راحة نفسية بسبب ما يتاح في الذكرى من أمثلة الأسوة الحسنة بأهل البيت، وتضحياتهم.
السادس: رد الفعل ضد الطغاة من الحكام. أدرك الحكم الطغاة منذ العهد الأُموي وحتى العصر الحديث ماذا تعنيه إقامة الذكرى من إدانة لتجاوزاتهم وتصرفاتهم وظلمهم، فحاولوا الوقوف في وجهها وقمعها، نجد هذا في العصر الأُموي في موقف هشام بن عبدالملك من الكميت الأسدي وغير ذلك، ونجد هذا في العصر العباسي في شواهد كثيرة، منها موقف المتوكل الذي أراد أن يجتث عوامل الإثارة بوسيلة وحشية فظة وذلك بأمره الذي أصدره بهدم قبر الحسين وما حوله من المنازل، وحرثه وأجرى عليه الماء، ومنع الناس من إتيانه، ونادى صاحب شرطته: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة أيام بعثنا به إلى المطبق، وفي العصور التالية لاحق العثمانيون هذه المآتم ومنعوا من إقامتها في أحيان كثيرة فكانت تقام سراً، وفيما بعد عهد العثمانيين لوحقت هذه المآتم، ومنعت السلطة منها في بعض الأحيان، وقيدتها بقيود كثيرة ثقيلة في أحيان أخرى، لأجل إفراغها من محتواها النقدي للسلطة القائمة.
هذا الموقف من السلطة ضد المآتم كان دائماً ولا يزال، يولد رد فعل لدى الإنسان العادي فيدفعه إلى التشبث بها، ولعل شعور الإنسان العادي حينئذٍ هو أن السلطة تريد أن تجرده من ملاذه الوحيد الذي ينفس فيه عن عاطفته، وكبته النفسي، ومعارضته.
هذه هي في رأينا العوامل التي ساهمت في وجود المأتم الحسيني واستمراره عبر العصور.
أدوار مجالس التعزية:
وقد مر المأتم الحسيني منذ أنشىء حتى الآن في ثلاثة أدوار:
الدور الأول: من مرحلة ما بعد الثورة إلى سقوط بغداد أو قبله بقليل.
الدور الثاني: من سقوط بغداد، وطيلة العصور المظلمة إلى العصر الحديث.
الدور الثالث: بدايات العصر الحديث إلى الآن.
وفي هذه الأدوار الثلاثة يوجد عنصر ثابت في محتوى المأتم الحسيني، ويوجد عناصر متغيرة.
أما العنصر الثابت فهو استعراض المأساة، وذكر تفاصيلها، ونقد السلطة القائمة حيث تكون مبررات النقد موجودة، إما صراحة، وإما بالملازمة، وقد كانت الذكرى في الدور الأول تتم كما ذكرنا بشكل ساذج وبسيط، ثم تطورت خلال هذا الدور شكلياً وكمياً، أما من الناحية النوعية، فقد كان العنصر الأساسي فيها هو ذكر المأساة والإفاضة في تفاصيلها، وتلوينها عن طريق الأعمال الشعرية الأولى في هذا الباب، هذا بالإضافة إلى نقد السلطة القائمة (الراضية بالفعل السابق والتي تقطف ثمراته، وتسير على المنهاج الذي أدى إليه) شريكة في الإثم والجريمة.
وأظن أن الفقه السياسي يساعدنا في هذه المسألة، ليس من ناحية العقوبة وانما من ناحية عنصر الشجب، وتحمل مسؤولية تصحيح الأوضاع التي أدت إلى الجريمة.
المأساة ونقد السلطة حيث تكون مبررات النقد موجودة، هما عنصرا المأتم الثابتان منذ بدايته الأولى في القرن الهجري الأول وحتى الآن.
وأما العنصر المتغير في المأتم الحسيني، فنستطيع أن نرصده ونكتشفه من خلال تطور الشعر الحسيني الرثائي عبر العصور.
بعد أن كان محتوى المأتم الحسيني يقوم على عنصري المأساة ونقد السلطة دخل فيه منذ سقوط بغداد أو قبله وحتى فترة العصور المظلمة عنصر جديد هو عنصر الوعظ، مع التركيز على المأساة.
لقد تأثر المأتم ـ كأي ظاهرة اجتماعية ثقافية ـ بالجو العام: الانحلال السياسي، والاجتماعي، والتخلف الاقتصادي، والحروب الأهلية، ونمو تيار التصرف المرضي. ونتيجة لهذا التأثر دخل عنصر الوعظ في المأتم، الوعظ السلبي الخاطىء بوجه عام، الذي يدعو إلى الانصراف عن العمل الحياتي، ويرفض العالم، ويصور لنا البيت التالي هذه الفكرة إذ يندمج الموقف السلبي من الحياة بالمأساة الحسينية:
| أترجو الخير من دنيا أهانت | حسين السبط واستبقت يزيدا |
لقد استمر هذا الموقف ـ فيما يبدو ـ طيلة فترة القرون المظلمة، وساعد على استمراره الحكم العثماني وجوره، وفي هذه المرحلة دونت كتب المقاتل، وهي التي تتحدث عن مقتل الإمام الحسين وصحبه.
من هذا الدور انتقل المأتم إلى دوره الثالث وهو الدور الذي نعايشه الآن. وقد غدت مجالس التعزية تشتمل إلى جانب عنصر المأساة ونقد السلطة على العناصر التالية:
أولاً: لم تعد المأساة تشكل عنصراً نهائياً في مجالس التعزية وإن كانت لا تزال عنصراً رئيسياً فيها.
ثانياً: غدت مجالس التعزية تشتمل غالباً ـ على عرض تاريخ يحيط ثورة كربلاء بعواملها التاريخية في حدود سعة وعمق الثقافة التاريخية للخطيب.
ثالثاً: احتلت الدراسات الإسلامية والدعوة إلى الإسلام مركزاً مهماً جداً في مجالس التعزية بحيث غدت مقياساً تعتمد عليه الجماهير في الإقبال على المجلس وانكفائها عنه.
رابعاً: غدت مجالس التعزية مناسبة مهمة لمعالجة الأمراض الاجتماعية ومظاهر الانحطاط والدعوة إلى إصلاحها على ضوء التوجيه الديني.
أن مجالس التعزية الآن، في أفضل حالاتها وحين يقوم بها غير الجهلة المتطفلين عليها تعتبر في رأيي مؤسسة من أعظم المؤسسات خيراً وبركة بما تقوم به من دور فعال في التثقيف والتوعية، وفي الكشف عن تراثنا الفكري والحضاري وفي التوجيه الإسلامي الصحيح إزاء المشاكل الفكرية والعقيدية الغريبة عن تراثنا وعن حضارتنا.
وإذا كان من الحق أن نعترف بأن ما طرأ من تطورات اجتماعية وحضارية وثقافية في العقود الأخيرة من السنين قد ساهم في تطوير مجالس التعزية، فإن من الحق أيضاً أن نعترف أيضاً بأن جهوداً كثيرة بذلت في هذا السبيل في مجالات التأليف والتوجيه والدراسة الواعية لحلقات العصر والاستجابة لها.
فلا يسع مهتماً بدراسة هذه المسألة أن يغفل جهود السيد محسن الأمين الذي ساهم قلمه الشريف مساهمة فعالة في تطوير مجالس التعزية، ولا يسع باحثاً أن يغفل أثر كتابه «المجالس السنية» في هذا الباب، وكذلك كتابه «لواعج الأشجان» وكتابه «الدر النضيد».
2 ـ ظاهرة البكاء:
ظاهرة البكاء مثار نقد كبير. ومع أنها ليست ظاهرة منفصلة عن مجالس التعزية إلاَّ أني آثرت إفرادها من ناحية منهجية، وذلك لتسهل ملاحظتها، وفهمها.
ولعل الموضوعية تقضي علينا أن نسميها ظاهرة الحزن في المأتم الحسيني والذكرى الحسينية.
فالحزن أعم من البكاء، ومن يحزن ربما لا يبكي.
من أجل فهم هذه الظاهرة في ذاتها أولاً، ومن أجل فهم مدلولها التاريخي ثانياً، نقول:
نحن في ذكرى الحسين نواجه مسألة تاريخية نقرأها أو نسمعها، وعند هذه الحقيقة نواجه سؤالاً حاسماً كيف نكتب التاريخ وكيف نرويه؟ كيف نكتب وكيف نروي تاريخ الإنسان الذي يحب ويبغض ـ مثلنا نحن الأحياء ـ والذي يخيب وينجح ـ مثلنا ـ والذي يمتلىء قلبه بالحزن والفرح ـ مثلنا ـ والذي تواجهه التحديات العظمى فلا يفر منها، ولا يحتال عليها، بل يثبت لها، والذي تحل به الكوارث العظمى فيواجهها ببطولة أسطورية في التاريخ تاريخ الإنسان كيف نكتبه وكيف نرويه؟ هل نكتبه كما نكتب تقريراً عن الوضع الاقتصادي؟ هل نكتب تاريخ الإنسان كما نكتب تاريخ طبقات الأرض أو تاريخ المتحجرات؟ هل نحول التاريخ إلى جداول إحصائية وعمليات تحليل الأرقام ودلالاتها؟.
أم نكتب التاريخ ونرويه فنصور به حياة الإنسان المكون من لحم ودم وطموح وأمل، وحب وبغضاء وبطولة وخسة من عواطف سامية وشهوات حقيرة، وبكلمة واحدة: تاريخ الإنسان.
لا أتوهم أن باحثاً عالماً وأميناً يسمح لنفسه أن يقول: لا، وأن يزعم أن علينا أن نكتب التاريخ ونرويه بلغة الأرقام.
وإذا كان التاريخ يكتب ويروى باعتباره تاريخ الإنسان، فلنسأل: كيف نقرأ التاريخ وكيف نسمعه؟ هل نواجهه بعقل بارد وقلب بارد؟ هل نمنع أنفسنا من الفرح حين تنفعل بالفرح؟ وهل نمنع أنفسنا من الحزن حين تشعر بالحزن؟ وهل نمنع أنفسنا من الاشمئزاز حين تشعر بالاشمئزاز لا أظن أن إنساناً عالماً وأميناً يرضى لنفسه أن يقول هذا.
ونحن وجميع الناس في جميع الأزمان والأوطان يكتبون التاريخ ويروونه، ويسمعون التاريخ ويقرأونه فينفعلون بما يسمعون ويقرأون: يحزنون أو يفرحون، يعتبون أو يشمئزون، وقد يتعاظم انفعالهم فيبتسمون، أو تجري من عيونهم دموع الحزن والفخر والإعجاب.
دعونا من التاريخ. حين نقرأ أو نسمع القصة الجيدة، أو القصيدة الجيدة، أو المسرحية الجيدة ألا تنفعل قلوبنا بما نقرأ أو نسمع؟
من كل هذا يتبين لنا تفاهة كل النقد الذي يقال عن مظاهر الحزن في مجالس التعزية، وسطحية النظرة التي تعالج بها هذه المسألة إننا في هذه المجالس نسمع تصويراً تاريخياً لفاجعة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، قتل فيها أشخاص مقدسون، وارتفعوا إلى أعلى المراتب الإنسانية بذلاً وتضحية وفداء في عملية عطاء محض، وحملت رؤوسهم، وسبيت نساؤهم، كل هذا ليس من أجل أشخاصهم وإنما من أجل أمتهم وعقيدتهم، أمتهم التي نحن منها، وعقيدتهم، التي نعتنقها، فمن حقنا كبشر أسوياء أن نحزن، وأن نعتب وأن نشكر وقد يتعاظم بنا الحزن فنبكي دموع الحزن والإعجاب وعرفان الجميل.
يبقى علينا الكشف عن المدلول التاريخي لهذه الظاهرة، وهو يتجلى لنا بوضوح إذا لاحظنا أن أئمة أهل البيت كانوا هم قادة الدعوة الإسلامية والقيادة المعارضة للانحراف في فهم الإسلام وتطبيقه، وكانوا بالمرصاد دائماً لكل انحراف وتجاوز يصدر عن السلطة الحاكمة، وما أكثر انحرافها وتجاوزاتها، ومن هنا فقد كان موقفهم يضعهم دائماً في موضع المعارض الصاعد، وكان رد فعل السلطة هو العنف والملاحقة والاضطهاد على أئمة أَهل البيت وعلى أتباعهم. وقد بلغ الاضطهاد من السعة والشمول في بعض الأحيان أنه كان يتعدى أشخاص الأئمة وأسرهم ليشمل جميع العلويين وذلك كالذي فعله المتوكل ـ فيما يحدثنا به أبو الفرج الأصبهاني ـ في مقاتل الطالبيين ـ (فقد كان المتوكل لا يبلغه أن أحداً بر أحداً من آل أبي طالب بشيء وإن قل إلاَّ أنهكه عقوبة وأثقله غرماً، حتى بات القميص يكون بين جماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدة ثم يرفعنه ويجلسن على مغازلهن عواري حواسر).
وإذن فنحن أمام عقيدة مضطهدة تلاحق في أشخاص قادتها وأتباعها بشكل وحشي يضطرهم إلى إخفاء عقيدتهم حفاظاً على حياتهم. ومن الأمور الواضحة اجتماعياً ونفسياً أن القناعة الفكرية وحدها بالعقيدة لا تقدم ضمانة كافية للثبات والصمود أمام الأخطار العظيمة، والاضطهاد العنيف الذي يستمر قروناً بعد قرون، أن العسف المدروس المستمر والاضطهاد الذي لا يتورع عن شيء سرعان ما يحطم التماسك عند الجماهير حول العقيدة التي لا يتاح لهذه الجماهير أن تتصل بقادتها بحرية وأمان، ولا يتاح لها دائماً أن تظل على اتصال تام بأفكار العقيدة ومواقفها ولا يتاح لها أن تمارس حياتها علناً وفقاً لعقيدتها ـ إذا أدخلنا في حسابنا أن المسلم الشيعي العادي كان لا يبدو أمامه أمل بانفراج قريب، وعلينا أن ندخل في حسابنا أن اضطهاد الشيعة في التاريخ لم يتوقف بصورة كاملة إلاَّ في العقود الأخيرة من السنين.
ونلاحظ أن ثورة كربلاء المجيدة تمثل ذروة موقف المعارضة الذي قاده أهل البيت ضد الانحراف في فهم الإسلام وتطبيقه، فهي نتيجة سلسلة من المواقف السابقة، وفاتحة سلسلة من المواقف المقبلة، وهي بشخصيتها المتميزة تكشف بوضوح مطلق عن طبيعة الصراع بين أهل البيت وبين خصومهم، وعن أهداف هذا الصراع وهي غنية إلى درجة مطلقة بعناصر النبل الإنساني والإثارة العاطفية.
فمن أجل أن يكون لديهم ـ باستمرار ـ مثل أعلى خارق السمو للتضحية والفداء في سبيل الحق والعدل..
ومن أجل أن يضاف إلى القناعة الفكرية حرارة وقوة ومضاء في مواجهة الاضطهاد والصبر على الشدائد، ويحافظ على التماسك أمام ضربات العنف، ويحيط الموقف العقلي بوهج عاطفي يرتفع بالعقيدة من مرتبة الحالة العقلية إلى مرتبة الحالة الشعورية..
من أجل كل ذلك كله… دعا أهل البيت إلى نظم الشعر في الحسين وثورته، ودعوا إلى إحياء ذكراه.
محمَّد مهدي شمس الدين
حقيقة عظمة ثورة الحسين
منذ ولدت هذه المأساة، وهي تمون الفكر العالمي بأرفع ما وصلت إليه البطولة وأقصى ما بلغه الاستشهاد، ثم تمون العاطفة بأشجى ما وصل إليه الحزن النبيل. وبرغم القرون المتتابعة على ولادتها بقيت معانيها تتجدد في كل لحظة، وبقيت مصدراً عجيباً من مصادر الوحي الفني للأقلام السائرة في دروب الحياة إلى منتهى القمم الشوامخ.
من ذلك الزمن الذي وقعت فيه إلى هذا اليوم الذي تفصل بينه وبين يومها الأول أربعة عشر قرناً، وهي تبدو وكأنها على موعد مع التجديد الرائع في سمو المعاني وسمو الأقلام التي يسيل في لعابها نشيد الخلود.
عظمة هذه المأساة لم تكن في اختيار الموت على الحياة أو مواجهة العدد القليل للعدد الهائل الكبير أو في الصبر المذهل أمام وحوش الغابات، وإن كانت هذه المعاني فصولاً خالدة من فصولها الكثيرة، وإنما كانت في شيء آخر.. كانت في ذلك التحدي المخيف للطغيان الأحمق والظلم البليد والجبروت الغبي.. نعم كانت في هذا المعنى الذي ينتصب في تاريخ الشعوب كما ينتصب المارد الجبار، ويلوح كما يلوح العملاق أمام الزرازير الجبانة.
وفي عقيدتي أن طغاة الحكم الأُموي كانوا أجهل الناس بالأخلاق العربية العامة، كما كانوا أغبى الناس في معرفة النفس العربية البسيطة ووعي أسرارها. وقد ظن أولئك الأغبياء الحمقى أن المال وحده كاف في إماتة كل نبل وإبادة كل شرف، وأن شراء عدد من زعماء العرب في ذلك الوقت كاف في القضاء على الجوهر النبيل الذي يشع في قلوب البسطاء من الجماهير الكبيرة الواسعة، وبالتالي كاف في القضاء على الحسين ومدرسته القائمة على تحدي الطغيان والوقوف في وجهه مهما ارتفع عبابه. وفي ظلمة هذه الغباوة اشتروا عمر بن سعد الطامع بإمارة (الري)، وأمثاله من الزعماء الأذلاء الذين تهاووا على بريق الذهب كما يتهاوى الفراش على لهيب النار. وبالتالي استطاعوا أن يقتلوا الحسين وأصحابه بذلك الشكل الذي أخرج كل ما في نفوس الطغاة من نذالة وحقد وجبن وإسفاف وازدراء بالقيم. ولكن هل استطاعوا أن يقضوا على تلك المدرسة النبيلة التي أنشأها الحسين وخلق لها بتضحيته وتضحية أصحابه وأهله المثل العملية العليا؟
الجواب معروف عند كل ملم بالتاريخ وحركته. لقد ووجه الحكم الأُموي بكثير من الغضب وكثير من الصفعات، كما ووجه في كثير من الأحيان بكثير من الاحتقار. وفي ذلك الحوار المذهل الذي دار بين يزيد وزينب بنت علي ما أشعر يزيد، إن كان عنده شعور، بأن الدنيا مقبلة على عاصفة وأن قتل الحسين لم يكن سوى نذير يكاد يزعزع الأرض تحته.
لقد شمت الطاغية الأحمق بقتل الحسين أمام أخته، وظن أن زينب امرأة ذليلة هانت عليها الكرامة بعد قتل من قتل من أهلها وذويها، فراح يتحداها ويتحدى الكرامة الشامخة في تلك النفس العظيمة التي يجب أن تكون مثلاً لكل امرأة كريمة.
فماذا كان موقف زينب؟ وكيف كان ردها على شماتة الشامت الخسيس؟
«إن جرّت علي الدواهي مخاطبتك فإني لاستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك».
بهذه الكلمات القليلة أجابت زينب، ولكن أية كلمات هذه الكلمات! وأي عوالم من التحدي تحمل في كل حرف من حروفها؟ لو عض يزيد الحديد في تلك اللحظة لكان ذلك أهون عليه من أن يسمع حرفاً واحداً منها إن كان عنده إحساس!
مهما يكن شعوره فقد أدرك بالتأكيد أن مدرسة الحسين باقية وأنها ستبقى، وأن السعادة التي تخيلها حائمة عليه أو ستحوم عليه بقتل الحسين وأصحابه لن تكون سوى نعش له ولدولته.
وقبل زينب وقف رجل في الكوفة أمام عبيدالله بن زياد موقفاً لا يقل عن موقف زينب ودفع حياته ثمناً لموقفه. ثم تتابع الزمن وتتابعت المواقف الخالدة.
ومعنى ذلك أن يزيد فشل، وأن الدرس الذي ألقاه الحسين على الأجيال بقي يتنقل من جيل إلى جيل، وسيبقى على تنقله ما دام للكرامة قيمة وللأخلاق مُثُل عليا.
محمَّد شرارة
مدفن رأس الحسين
 اختلف فيه على أقوال: الأول: أنه عند أبيه أمير المؤمنين (ع) بالنجف معه إلى جهة رأسه الشريف، ذهب إليه بعض علماء الشيعة استناداً إلى أخبار وردت بذلك في الكافي، والتهذيب، وغيرهما، وفي بعضها أن الصادق (ع) قال لولده إسماعيل، أنه لما حمل إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين (ع). الثاني: أنه مدفون مع جسده رده علي بن الحسين (ع). الثالث: أنه دفن بالمدينة المنورة عند قبر أمه فاطمة (عليها السلام)، وأن يزيد أرسله إلى عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة فنصبه للناس، ثم دفن عند أمه الزهراء (عليها السلام). الرابع: أنه بدمشق. قال سبط ابن الجوزي: حكى ابن أَبي الدنيا قال: وجد رأس الحسين (ع) في خزانة يزيد بدمشق فكفنوه ودفنوه بباب الفراديس. وكذا ذكر البلاذري في تاريخه قال: هو بدمشق، وكذا ذكر الواقدي أيضاً «اهـ» المسجد الجامع. الخامس: أنه بمصر نقل إلى القاهرة من مدفنه في عسقلان، وذلك أن يزيد بعد أن نصب الرأس ثلاثة أيام في دمشق وضعه في خزائن السلاح زيادة في التشفي على عادة العرب في الجاهلية، وظل في خزائن يزيد وخلفائه من بعده حتى عهد رواية بن عبدالملك الذي غيَّر الكثير من أمور أسلافه، وكان فيما غيَّره أن أمر بدفن الرأس؛ ولكنه لم يدفنه في دمشق لأنه حدس بأن سيكون لمدفن رأس الحسين شأن يوماً ما، بل دفنه في عسقلان بفلسطين وفي العام 548هـ نقله الفاطميون إلى مدفنه الحالي في القاهرة وله فيه مشهد عظيم يُزار([1120]).
اختلف فيه على أقوال: الأول: أنه عند أبيه أمير المؤمنين (ع) بالنجف معه إلى جهة رأسه الشريف، ذهب إليه بعض علماء الشيعة استناداً إلى أخبار وردت بذلك في الكافي، والتهذيب، وغيرهما، وفي بعضها أن الصادق (ع) قال لولده إسماعيل، أنه لما حمل إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين (ع). الثاني: أنه مدفون مع جسده رده علي بن الحسين (ع). الثالث: أنه دفن بالمدينة المنورة عند قبر أمه فاطمة (عليها السلام)، وأن يزيد أرسله إلى عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة فنصبه للناس، ثم دفن عند أمه الزهراء (عليها السلام). الرابع: أنه بدمشق. قال سبط ابن الجوزي: حكى ابن أَبي الدنيا قال: وجد رأس الحسين (ع) في خزانة يزيد بدمشق فكفنوه ودفنوه بباب الفراديس. وكذا ذكر البلاذري في تاريخه قال: هو بدمشق، وكذا ذكر الواقدي أيضاً «اهـ» المسجد الجامع. الخامس: أنه بمصر نقل إلى القاهرة من مدفنه في عسقلان، وذلك أن يزيد بعد أن نصب الرأس ثلاثة أيام في دمشق وضعه في خزائن السلاح زيادة في التشفي على عادة العرب في الجاهلية، وظل في خزائن يزيد وخلفائه من بعده حتى عهد رواية بن عبدالملك الذي غيَّر الكثير من أمور أسلافه، وكان فيما غيَّره أن أمر بدفن الرأس؛ ولكنه لم يدفنه في دمشق لأنه حدس بأن سيكون لمدفن رأس الحسين شأن يوماً ما، بل دفنه في عسقلان بفلسطين وفي العام 548هـ نقله الفاطميون إلى مدفنه الحالي في القاهرة وله فيه مشهد عظيم يُزار([1120]).
مسجد الإمام الحسين (ع) في القاهرة
وهذا الرأي الأخير هو الذي يؤيده التاريخ وينتهي إليه كل تحقيق تأريخي. وهو ما أخذتُ به بعد طول بحث.
ويؤكد المؤرخ الفلسطيني مصطفى الدباغ دفن رأس الحسين في عسقلان مستشهداً برواية شعبية يتناقلها أهالي قرية (زرنوقة) القريبة من مدينة الرملة عن الآباء والأجداد، فيشيرون إلى مكان محدود من قريتهم، يذكرون باعتزاز: «أن القافلة قد استراحت هنا وهي في طريقها إلى عسقلان».
مشهد رؤوس العباس وعلي الأكبر
وحبيب بن مظاهر بدمشق
كان في المقبرة المعروفة بمقبرة باب الصغير بدمشق مشهد وضع فوق بابه صخرة كتب عليها ما صورته:
(هذا مدفن رأس العباس بن علي، ورأس علي بن الحسين الأكبر، ورأس حبيب بن مظاهر) ثم أنه بعد ذلك هدم هذا المشهد وأعيد بناؤه، وأزيلت هذه الصخرة، وبنى ضريح داخل المشهد، ونقش عليه أسماء كثيرة لشهداء كربلاء، ولكن الحقيقة أنه منسوب إلى الرؤوس الشريفة الثلاثة المقدم ذكرها بحسب ما كان موضوعاً على بابه كما مر. وهذا المشهد؛ الظن قوي بصحة نسبته لأن الرؤوس الشريفة بعد حملها إلى دمشق والطواف بها، وانتهاء غرض يزيد من إظهار الغلبة والتنكيل بأهلها والتشفي لا بد أن تدفن في إحدى المقابر، فدفنت هذه الرؤوس الثلاثة في مقبرة باب الصغير وحفظ محل دفنها والله أعلم.
البناء على قبر الحسين (ع)
أول من بنى القبر الشريف بنو أسد الذين دفنوا الحسين (ع) وأصحابه، ويدل على ذلك خبر مجيء التوابين إلى القبر الشريف، وأنه في ذلك الوقت وهو سنة هلاك يزيد (63 أو 64) كان ظاهراً معروفاً ولا يكون ذلك إلاَّ ببنائه. أما تعمير القبة عليه فقد تكرر مراراً.
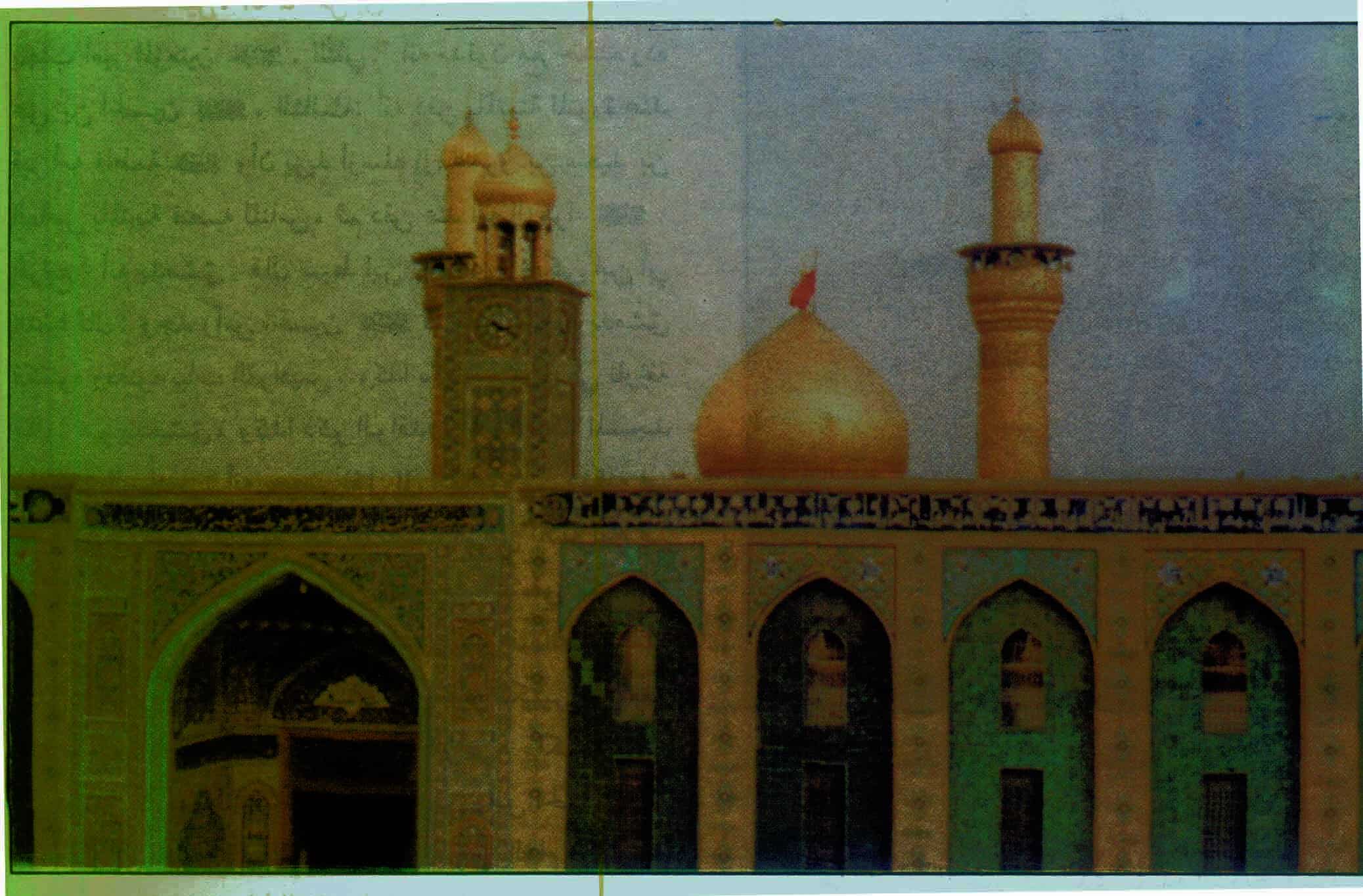 العمارة الأولى للقبة
العمارة الأولى للقبة
مقام الإمام الحسين (ع)
هي التي كانت في زمن بني أمية إذ تدل جملة من الآثار أنه كان عليه سقيفة ومسجد في زمن بني أمية، واستمر ذلك إلى زمن الرشيد من بني العباس، لكن لا يعلم أول من بنى ذلك. ويدل الخبر الذي رواه السيد علي بن طاووس في الإقبال عن الحسين بن أبي حمزة: أنه كان عليه سقيفة لها باب في آخر زمن بني أمية حيث قال فيه: خرجت في آخر زمن بني أمية وأنا أريد قبر الحسين (ع) إلى أن قال: حتى إذا كنت على باب الحائر خرج إلي رجل. ثم قال: فلما انتهيت إلى باب الحائر. ثم قال فجئت فدخلت. وقال الصادق (ع) لجابر الجعفي رواه ابن قولويه في كامل الزيارة: إذا أتيت قبر الحسين (ع) فقل… وجابر توفي على ما ذكره النجاشي سنة 128هـ، ومات مروان بن محمَّد آخر ملوك بني أمية سنة 132هـ، فتكون وفاته قبل انقضاء دولتهم بأربع سنين، وروى ابن قولويه في كامل الزيارة، عن أبي حمزة الثمالي، عن الصادق (ع) في كيفية زيارة الحسين (ع) أنه قال: فإذا أتيت الباب الذي يلي الشرق فقف على الباب وقل. ثم قال: ثم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء. وهو صريح في أن البناء كان سقيفة له باب من الشرق، وقوله: الباب الذي يلي الشرق يدل على وجود باب غيره. وفي حديث صفوان الجمال عن الصادق (ع): إذا أردت زيارة الحسين بن علي فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة وارم بطرفك نحو القبر وقل: … ثم ادخل رجلك اليمنى القبة وأخر اليسرى وقل: … ثم أدخل الحائر وقم بحذائه. وقال المفيد في مزاره عند ذكره لرواية صفوان بن مهران: فإذا أتيت باب الحائر فقف ثم تأتي باب القبة فقف من حيث يلي الرأس ثم امش حتى تأتي مشهد العباس بن علي فقف على باب السقيفة وقل: … وروى ابن قولويه بسنده عن أَبي حمزة الثمالي عن الصادق (ع): فإذا أردت زيارة العباس فقف على باب القبة وقل ثم ادخل.
هدم الرشيد قبر الحسين (ع)
وبقيت هذه القبة إلى زمن الرشيد فهدمها وكرب موضع القبر، وكان عنده سدرة فقطعها. ويوجد إلى الآن باب من أبواب الصحن الشريف يسمى: باب السدرة؛ ولعل السدرة كانت عنده أو بجنبه.
العمارة الثانية
في زمن المأمون. قال محمَّد بن أَبي طالب ـ بعدما ذكر تخريب الرشيد له ـ: ثم أعيد على زمن المأمون وغيره.
هدم المتوكل قبر الحسين (ع)
قال الطبري في تاريخه: في سنة 235هـ أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي، وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يحرث ويبذر ويسقي موضع قبره، وأن يمنع الناس من إتيانه فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجن، فهرب الناس، وامتنعوا من المصير إليه، وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه «ا.هـ» ويعلم من ذلك: أنه كان قد بني حوله دور ومساكن وسكن الناس هناك، لقوله: أنه أمر بهدمه وهدم ما حوله من المنازل والدور. وروى الشيخ الطوسي في الأمالي: بلغ المتوكل جعفر بن المعتصم أن أهل السواد يجتمعون بأرض نينوى لزيارة قبر الحسين (ع) فيصير إلى قبره منهم خلق كثير؛ فأنفذ قائداً من قواده وضم إليه عدداً كثيفاً من الجند يشعث قبر الحسين، ويمنع الناس من زيارته والاجتماع إلى قبره، فخرج القائد إلى الطف وعمل بما أمر وذلك في سنة 237هـ، فثار أهل السواد واجتمعوا. وقالوا: لو قتلنا عن آخرنا لما أمسك من بقي منا عن زيارته ورأوا من الدلائل ما حملهم على ما صنعوا فكتب بالأمر إلى الحضرة فورد كتاب المتوكل إلى القائد: بالكف عنهم والمسير إلى الكوفة مظهراً أن مسيره إليها في مصالح أهلها والانكفاء إلى المصر، فمضى على ذلك زمن حتى كانت سنة 247هـ فبلغ المتوكل أيضاً مصير الناس من أهل السواد والكوفة إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين (ع)، وأنه قد كثر جمعهم لذلك وصار لهم سوق كبير فأنفذ قائداً في جمع كثير من الجند وأمر منادياً ينادي ببراءة الذمة ممن زاره، ثم نبش القبر وحرث أرضه، وانقطع الناس عن الزيارة وعمد على تتبع آل أَبي طالب والشيعة فقتل ولم يتم له ما قدره (أقول): فيكون ابتداء أمر المتوكل بذلك سنة 236هـ ثم أعاد الكرة سنة 237هـ ثم فعل مثل ذلك سنة 247هـ وفيها قتل المتوكل فكان يمنع من زيارته فيمتنع الناس مدة أو تقل زيارتهم ويزورون خفية ثم تكر زيارتهم فيجدد المنع إلى أن قتله الله.
العمارة الثالثة
عمارة المنتصر. قال محمَّد بن أَبي طالب في تتمة كلامه السابق بعدما ذكر تخريب المتوكل القبر الشريف قال: إلى أن قتل المتوكل وقام بالأمر بعده ابنه المنتصر فعطف على آل أبي طالب وأحسن إليهم وفرق فيهم الأموال وأعاد القبور في أيامه «ا.هـ» أمر الناس بزيارة قبر الحسين (ع). وقال المجلسي في البحار: أن المنتصر لما قتل أباه وتخلف بعده أمر ببناء الحائر وبنى ميلاً على المرقد الشريف وأحسن إلى العلويين وآمنهم بعد خوفهم.
العمارة الرابعة
عمارة محمَّد بن زيد من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالداعي الصغير ملك طبرستان بعد أخيه الحسن الملقب بالداعي الكبير عشرين سنة، وبنى المشهدين الغروي والحائر أيام المعتضد. قال محمَّد بن أبي طالب في تتمة كلامه السابق بعدما ذكر إعادة القبور في أيام المنتصر قال: إلى أن خرج الداعيان الحسن ومحمَّد ابنا زيد بن الحسن فأمر محمَّد بعمارة المشهدين.
العمارة الخامسة
عمارة عضد الدولة فناخسرو بن بويه الديلمي قال محمَّد بن أَبي طالب في تتمة كلامه السابق بعدما ذكر عمارة ابن زيد: وبعد ذلك بلغ عضد الدولة بن بويه الغاية في تعظيمهما وعمارتهما والأوقاف عليهما، وكان يزورهما كل سنة «ا.هـ» وفي كتاب لبعض المعاصرين: أنه لما زار المشهد الحسيني سنة 371هـ بالغ في تشييد الأبنية حوله وأجزل العطاء لمن جاوره، وتوفي سنة 372هـ بعدما ولي العراق خمس سنين، وفي زمانه بنى عمران بن شاهين الرواق المعروف برواق عمران في مشهد الحسين.
العمارة السادسة
 عمارة الحسن بن مفضل بن سهلان أَبو محمَّد الرامهرمزي وزير سلطان الدولة بن بويه الديلمي قال ابن الأثير ـ في حوادث سنة 407هـ ـ: فيها في 14 ربيع الأول احترقت قبة الحسين والأروقة، وكان سببه أنهم أشعلوا شمعتين كبيرتين فسقطتا في الليل على التأزير فاحترق وتعدت النار «ا.هـ» فجددها الوزير المذكور وفي مجالس المؤمنين، عن تاريخ ابن كثير الشامي: أنه بنى سور الحائر الحسيني وقتل سنة 460هـ قيل: هو الذي ذكره ابن إدريس في سنة 588هـ في كتاب المواريث من السرائر «ا.هـ» وهذه العمارة هي التي رآها ابن بطوطة وذكرها في رحلته التي كانت سنة 727هـ.
عمارة الحسن بن مفضل بن سهلان أَبو محمَّد الرامهرمزي وزير سلطان الدولة بن بويه الديلمي قال ابن الأثير ـ في حوادث سنة 407هـ ـ: فيها في 14 ربيع الأول احترقت قبة الحسين والأروقة، وكان سببه أنهم أشعلوا شمعتين كبيرتين فسقطتا في الليل على التأزير فاحترق وتعدت النار «ا.هـ» فجددها الوزير المذكور وفي مجالس المؤمنين، عن تاريخ ابن كثير الشامي: أنه بنى سور الحائر الحسيني وقتل سنة 460هـ قيل: هو الذي ذكره ابن إدريس في سنة 588هـ في كتاب المواريث من السرائر «ا.هـ» وهذه العمارة هي التي رآها ابن بطوطة وذكرها في رحلته التي كانت سنة 727هـ.
ضريح الحسين (ع) بقبته ومنارتيه
العمارة السابعة
الموجودة الآن أمر بها السلطان أويس الأيلخاني سنة 767هـ ، وتاريخها هذا موجود فوق المحراب القبلي مما يلي الرأس، وأكملها ولده أَحمد بن أويس سنة 786هـ ، وقد زيد فيها وأصلحت من ملوك الشيعة وغيرهم، وفي عام 930هـ أهدى الشاه إسماعيل الصفوي صندوقاً بديع الصنع إلى القبر الشريف، وفي عام 1048هـ شيد السلطان مراد العثماني الرابع القبة وجصصها، وفي سنة 1135هـ أنفقت زوجة نادر شاه مبالغ طائلة لتعمير الروضة الحسينية، وفي سنة 1232هـ أمر فتحعلي شاه بتذهيب القبة الشريفة.
هدم الوهابية قبر الحسين (ع)
في سنة 1216هـ جهز سعود بن عبدالعزيز بن سعود الوهابي النجدي جيشاً من أعراب نجد وغزا به العراق، وحاصر مدينة كربلاء مغتنماً فرصة غياب جل الأهلين في النجف لزيارة الغدير، ثم دخلها يوم 18 ذي الحجة عنوة، وأعمل في أهلها السيف، فقتل منهم ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف، وقتل الشيوخ والأطفال والنساء، ولم ينج منهم إلاَّ من تمكن من الهرب، أو اختبأ في مخبأ ونهب البلد ونهب الحضرة الشريفة، وأخذ جميع ما فيها من فرش وقناديل وغيرها، وهدم القبر الشريف، واقتلع الشباك الذي عليه وربط خيله في الصحن المطهر، ودق القهوة وعملها في الحضرة الشريفة، ونهب من ذخائر المشهد الحسيني الشيء الكثير، ثم كر راجعاً إلى بلاده.
علي بن الحسين زين العابدين (ع)
ولد بالمدينة يوم الجمعة أو يوم الخميس أو يوم الأحد لتسع أو خمس أو سبع خلون من شعبان أو منتصف جمادى الثانية أو الأولى سنة 38 أو 37 أو 36 من الهجرة، وتوفي بالمدينة يوم السبت في 12 من المحرم أو 18 أو 19 أو 22 أو 25 منه سنة 95 أو 94 من الهجرة وله 55 سنة أو 56 أو 57 أو 58 أو 59 وأشهر وأيام بحسب اختلاف الأقوال والروايات في تاريخ المولد والوفاة، عاش منها مع جده أمير المؤمنين (ع) سنتان أو أكثر، ومع عمه الحسن 12 سنة أو 10 سنين، ومع أبيه الحسين 23 أو 24 سنة، ومع أبيه بعد عمه الحسن 10 سنين، وبعد أبيه 34 أو 33 أو 35 سنة وهي مدة إمامته، وهي بقية ملك يزيد بن معاوية، ومعاوية بن يزيد، ومروان بن الحكم، وعبدالملك بن مروان وتوفي في ملك الوليد بن عبدالملك، ودفن بالبقيع مع عمه الحسن بن علي في القبة التي فيها قبر العباس بن عبد المطلب.
أمه
قيل اسمها شهربانو أو شهربانويه بنت يزدجر آخر ملوك الفرس، وقيل غير ذلك.
هو الأكبر أم الأصغر
المشهور أن أخاه شهيد كربلاء هو الأكبر وقيل أنه الأصغر.
أولاده
تناسل ولد الحسين من زين العابدين (ع) قال المفيد في الإرشاد، وابن الصباغ في الفصول المهمة: كان له من الأولاد خمسة عشر، أحد عشر ذكراً وأربع بنات وهم: محمَّد الباقر أمه فاطمة بنت الحسن السبط تكنى أم عبدالله. عبدالله. الحسن. الحسين الأكبر لم يعقبا. زيد. عمر. الحسين الأصغر. عبيدالله. سليمان لم يعقب. محمَّد الأصغر. علي وهو أصغر ولده. فاطمة. علية. خديجة. أم كلثوم. وفي الطبقات الكبيرة لمحمَّد بن سعد عد له عشرة ذكور وسبع بنات فقال: ولد علي الأصغر ابن حسين بن علي: الحسن بن علي درج([1121]) والحسين الأكبر درج. ومحمَّد أبو جعفر الفقيه. وعبدالله وأمهم أم عبدالله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب. وعمر. وزيد المقتول بالكوفة. وعلي بن علي. وأم علي بنت علي وهي علية. وكلثم بنت علي. وسليمان لا عقب له ومليكة. والقاسم وأم الحسن وهي حسنة. وأم الحسين. وفاطمة. وفي كشف الغمة: قيل كان له تسعة أولاد ذكور ولم يكن له أنثى وقال ابن الخشاب النحوي في مواليد أهل البيت أنه ولد له ثمان بنين ولم يكن له أنثى، وهم: محمَّد الباقر، وزيد الشهيد بالكوفة وعبدالله، وعبيدالله، والحسن، والحسين، وعلي، وعمر. وقال ابن شهرآشوب في المناقب: أبناؤه ثلاثة عشر من أمهات الأولاد إلاَّ اثنين، محمَّد الباقر، وعبدالله الباهر أمهما أم عبدالله بنت الحسن بن علي وأبو الحسين زيد الشهيد بالكوفة وعمر توأم ومحمَّد الأصغر وعبدالرحمن وسليمان توأم والحسن والحسين وعبيدالله توأم ومحمَّد الأصغر فرد وعلي وهو أصغر ولده وخديجة فرد ويقال لم تكن له بنت ويقال ولدت له فاطمة وعليه وأم كلثوم وفي عمدة الطالب: أعقب منهم ستة محمَّد الباقر، وعبدالله الباهر، وزيد الشهيد، وعمر الأشرف، والحسين الأصغر، وعلي الأصغر.
أخلاقه
كان يأبى أن يواكل أمه فقيل له: يا ابن رسول الله أنت أبر الناس وأوصلهم للرحم فكيف لا تواكل أمك؟ فقال: إني أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها، وقال له رجل يا ابن رسول الله إني لأحبك في الله حباً شديداً. فقال: اللَّهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده. ومن كان منهم له عيال حمل له إلى عياله من طعامه، وكان لا يأكل طعاماً حتى يهدأ فيتصدق بمثله.
إنسانيته
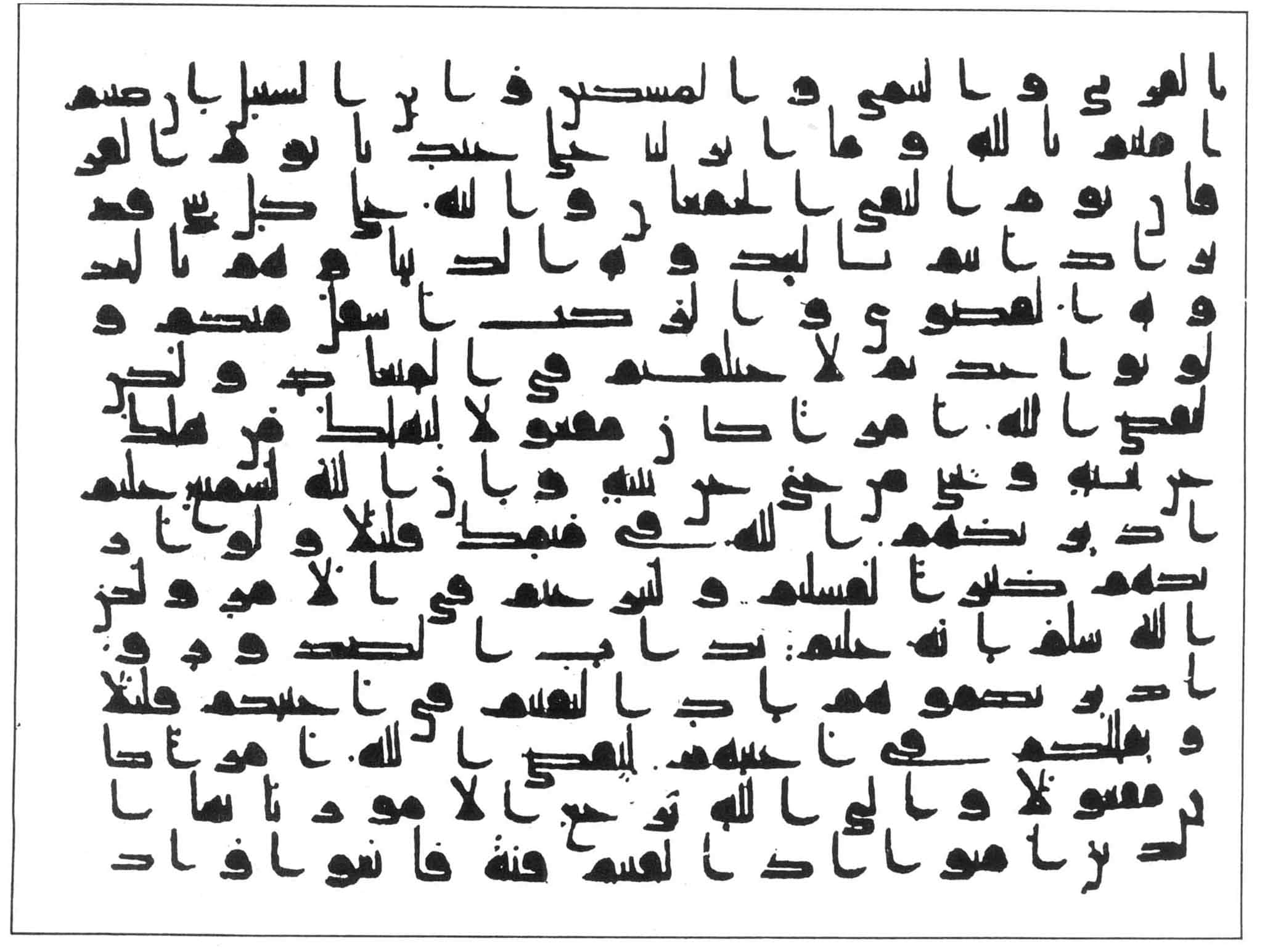 كان معظماً مهيباً عند القريب والبعيد والولي والعدو، حتى أن يزيد بن معاوية لما أمر أن يبايعه أهل المدينة بعد وقعة الحرة على أنهم عبيد رق له لم يستثن من ذلك إلاَّ علي بن الحسين. وكان يحسن إلى من يسيء إليه. كان هشام بن إسماعيل أمير المدينة يسيء إليه ويؤذيه أذى شديداً، فلما عزل أمر به الوليد أن يشهر للناس، فكان الناس يمرون به فيشتمونه فمر به علي وسلم عليه وأمر خاصته أن لا يعرض له أحد، وكان له ابن عم يؤذيه فكان يجيئه ويعطيه الدنانير ليلاً وهو مستتر، فيقول: لكن علي بن الحسين لا يصلني لا جزاه الله خيراً، فيسمع ويصبر فلما مات انقطع عنه، فعلم أنه هو الذي كان يصله، ولما طرد أهل المدينة بني أمية في وقعة الحرة، أراد مروان بن الحكم أن يستودع أهله فلم يقبل أحد أن يكونوا عنده إلاَّ علي بن الحسين، فوضعهم مع عياله وأحسن إليهم مع عداوة مروان المعروفة له ولجميع بني هاشم، وعال في وقعة الحرة أربعمائة امرأة من بني عبد مناف إلى أن تفرق جيش مسرف بن عقبة، وكان يقول لمن يشتمه: إن كنت كما قلت فاسأل الله أن يغفر لي، وإن لم أكن كما قلت فاسأل الله أن يغفر لك.
كان معظماً مهيباً عند القريب والبعيد والولي والعدو، حتى أن يزيد بن معاوية لما أمر أن يبايعه أهل المدينة بعد وقعة الحرة على أنهم عبيد رق له لم يستثن من ذلك إلاَّ علي بن الحسين. وكان يحسن إلى من يسيء إليه. كان هشام بن إسماعيل أمير المدينة يسيء إليه ويؤذيه أذى شديداً، فلما عزل أمر به الوليد أن يشهر للناس، فكان الناس يمرون به فيشتمونه فمر به علي وسلم عليه وأمر خاصته أن لا يعرض له أحد، وكان له ابن عم يؤذيه فكان يجيئه ويعطيه الدنانير ليلاً وهو مستتر، فيقول: لكن علي بن الحسين لا يصلني لا جزاه الله خيراً، فيسمع ويصبر فلما مات انقطع عنه، فعلم أنه هو الذي كان يصله، ولما طرد أهل المدينة بني أمية في وقعة الحرة، أراد مروان بن الحكم أن يستودع أهله فلم يقبل أحد أن يكونوا عنده إلاَّ علي بن الحسين، فوضعهم مع عياله وأحسن إليهم مع عداوة مروان المعروفة له ولجميع بني هاشم، وعال في وقعة الحرة أربعمائة امرأة من بني عبد مناف إلى أن تفرق جيش مسرف بن عقبة، وكان يقول لمن يشتمه: إن كنت كما قلت فاسأل الله أن يغفر لي، وإن لم أكن كما قلت فاسأل الله أن يغفر لك.
صفحة من القرآن المنسوب إلى خط زين العابدين علي بن الحسين (ع)
وكان لا يسافر إلاَّ مع رفقة لا يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجونه.
المؤسس الثاني للثقافة الإِسلامية
يعتبر علي بن الحسين المؤسس الثاني للمدرسة الإسلامية، إذ أن جده علي بن أَبي طالب هو المؤسس الأول.
وكما اتخذ جده من المسجد ومن بيته مكاناً يلتف حوله فيه طلاب العلم الوافدون من كل مكان، وكما كانت مجالس جده دروساً في شتى المعارف الإسلامية فكان بذلك المؤسس الأول للدراسات الإسلامية. كذلك كان حفيده زين العابدين علي بن الحسين، فمنذ سنة 61هـ إلى سنة 95هـ، أي طيلة خمس وثلاثين سنة كان منزله وكان المسجد مدرسته يزدحم فيها الطلاب عليه، فبينما كانت الدولة مشغولة باستبدادها واستنزاف دماء الشعب وسلب أمواله واضطهاد أحراره، كان علي بن الحسين مشغولاً بنشر العلم وبعث الثقافة وإنارة الأفكار وتهذيب الأخلاق فكثر تلاميذه والآخذون عنه في أنواع العلوم، وأصبح أولئك التلاميذ وتلاميذهم بناة الحضارة الإِسلامية ورجال الفكر الإسلامي والتشريع الإسلامي والأدب الإسلامي.
ولقد أخذ عنه علماء الحجاز ومن يأتي من البلاد البعيدة والقريبة في مواسم الحج ودونوا ما أخذوه عنه ورواه عنهم الناس.
فممن روى عنه: الزهري، وسفيان بن عيينة. ونافع والأوزاعي، ومقاتل، والواقدي، ومحمَّد بن إسحاق وغيرهم. وروى عمن روى عنه: الطبري، وابن البيع، وأحمد بن حنبل، وابن بطة، وأبو داود وصاحب الحلية، وصاحب الأغاني وصاحب قوت القلوب، وصاحب شرف المصطفى، وصاحب أسباب النزول، وصاحب الفائق، وصاحب الترغيب والترهيب، وغيرهم.
ومن رجاله من الصحابة: جابر بن عبدالله الأنصاري، وعامر بن واثلة الكناني، وسعيد بن المسيب بن حزن، وسعيد بن جهان الكناني مولى أم هانىء. ومن التابعين أبو محمَّد سعيد بن جبير مولى بني أسد، ومحمَّد بن جبير بن مطعم، والقاسم بن عوف، وإسماعيل بن عبدالله بن جعفر وإبراهيم والحسن ابنا محمَّد بن الحنفية، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو يحيى الأسدي، وأبو حازم الأعرج، وسلمة بن دينار المدني الأقرن القاص، ومن أصحابه أبو حمزة الثمالي بقي إلى أيام موسى الكاظم (ع)، وفرات بن أحنف بقي إلى أيام أبي عبدالله الصادق(ع)، وجابر بن محمَّد بن أبي بكر وأيوب بن الحسن وعلي بن رافع، وأبو محمَّد القرشي السدي الكوفي، والضحاك بن مزاحم الخراساني، وطاوس بن كيسان أبو عبدالرحمن، وحميد بن موسى الكوفي، وأبان بن تغلب بن رباح، وأبو الفضل سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي وقيس بن رمانة، وعبدالله البرقي، والفرزدق الشاعر، وأبو خالد الكابلي كنكر ويقال اسمه وردان، ويحيى بن أم الطويل وسعيد بن المسيب المخزومي، وحكيم بن جبير وغيرهم.
مؤلفاته
ومن آثاره المدونة والتي تعتبر من أوائل التأليف في صدر الإسلام:
1 ـ الصحيفة الكاملة وقد استنتسخ الناس منها نسخاً لا تعد ولا تحصى بالخطوط الجميلة النادرة المثيل والمزينة بجداول الذهب وطبعت في عصر الطباعة طبعات كثيرة وشرحها العلماء شروحاً عديدة منها شرح الشيخ البهائي المسمى حدائق المقربين وأحسن الشروح شرح السيد علي خان الشيرازي.
وقد كانت منها نسخة عند ولده زيد الشهيد ثم انتقلت إلى أولاده وإلى أَولاد عبدالله بن الحسن، مضافاً إلى ما كان عند الباقر.
وتعتبر من أعلى درجات البيان العربي بأسلوبها ومعانيها.
2 ـ رسالة الحقوق وهي من الأعمال الفكرية السامية في الإسلام تحتوي على توجيهات وتعليمات وقواعد في السلوك العام والخاص من أدق ما يعرفه الفكر الإنساني.
في كربلاء
كان عمره (ع) يوم كربلاء 24 سنة على الأكثر و22 سنة على الأقل. وقال محمَّد بن سعد في الطبقات: كان علي بن الحسين مع أبيه بطف كربلاء وعمره إذ ذاك ثلاث وعشرون سنة؛ لكنه كان مريضاً ملقى على فراشه، وقد نهكته العلة والمرض «ا.هـ» وكان قد تزوج وولد له الباقر فقد كان عمر الباقر يومئذٍ أربع سنين أو ثلاث سنين وجملة من العلماء منهم المفيد يقولون: أنه أكبر من أخيه علي شهيد كربلاء هو الأوسط وإنما قيل له الأكبر بالنسبة إلى أخيه الأصغر الذي هو أصغر منهما. وكان زين العابدين (ع) مريضاً يوم كربلاء فلذلك لم يجاهد وسلم من القتل وانحصر نسل رسول الله (ص) من فاطمة (عليها السلام) من الحسينيين فيه وفي ذريته.
ولما قتل الحسين (ع) أراد شمر قتل زين العابدين (ع) وهو مريض فدفعه عنه حميد بن مسلم. وحمله عمر بن سعد مع من حمله من أهل البيت إلى الكوفة وقد نهكته العلة.
احترام الشعب له
حج هشام بن عبدالملك فطاف بالبيت، فجهد أن يصل إلى الحجر فيستلمه فلم يقدر، لشدة الازدحام فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس، ومعه أهل الشام إذ أقبل علي بن الحسين فطاف بالبيت، فلما بلغ الحجر تنحى له الناس حتى يستلمه. فقال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وكان الشاعر الفرزدق حاضراً فقال الفرزدق: ولكني أعرفه قال الشامي: من هو يا أبا فراس؟ فقال الفرزدق قصيدته:
| هذا الذي تعرف البطحاء وطأته | والبيت يعرفه والحل والحرم | |
| هذا ابن خير عباد الله كلهم | هذا التقي النقي الطاهر العلم | |
| يكاد يمسكه عرفان راحته | ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم | |
| إذا رأته قريش قال قائلها | إلى مكارم هذا ينتهي الكرم | |
| إن عد أهل التقى كانوا ذوي عدد | أوَ قيل من خير أهل الأرض قيل هم | |
| هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله | بجده أنبياء الله قد ختموا | |
| وليس قولك من هذا بضائره | العرب تعرف من أنكرت والعجم | |
| يغضي حياء ويغضى من مهابته | فما يكلم إلاَّ حين يبتسم | |
| ينمى إلى ذروة العز التي قصرت | عنها الأكف وعن إدراكها القدم | |
| من جده دان فضل الأنبياء له | وفضل أمته دانت له الأمم | |
| ينشق نور الهدى عن صبح غرته | كالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم | |
| مشتقة من رسول الله نبعته | طابت عناصره والخيم والشيم | |
| الله شرفه قدماً وفضله | جرى بذاك له في لوحه القلم | |
| كلتا يديه غياث عم نفعهما | يستوكفان ولا يعروهما العدم | |
| سهل الخليقة لا تخشى بوادره | يزينه اثنان حسن الخلق والكرم | |
| حمال أثقال أقوام إذا فدحوا | رحب الفناء أريب حين يعتزم | |
| ما قال لاقط إلاَّ في تشهده | لولا التشهد كانت لاؤه نعم | |
| عم البرية بالإحسان فانقشعت | عنه الغياهب والإ ملاق والعدم | |
| من معشر حبهم دين وبغضهم | كفر وقربهم ملجا ومعتصم | |
| لا يستطيع جواد بعد غايتهم | ولا يدانيهم قوم وإن كرموا | |
| هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت | والأسد أسد الشرى والرأي محتدم | |
| لا ينقص العسر بسطاً من أكفهم | سيان ذلك ان أثروا وأن عدموا | |
| يستدفع السوء والبلوى بحبهم | ويُسْتَرَبُّ به الإحسان والنعم | |
| مقدم بعد ذكر الله ذكرهم | في كل بدء ومختوم به الكلم | |
| يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم | خيم كريم وأيد بالندى هضم | |
| أي الخلائق ليست في رقابهم | لأولية هذا أو له نعم | |
| من يعرف الله يعرف أولية ذا | الدين من بيت هذا ناله الأمم |
ثم قال: هذا علي بن الحسين بن علي بن أَبي طالب فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بعسفان بين مكة والمدينة فبعث إليه علي بألف دينار فردها وقال: إنما قلت ما قلت غضباً لله ولرسوله فما آخذ عليه أجراً فقال علي ابن الحسين: نحن أهل بيت لا يعود إلينا ما أعطينا فقبلها الفرزدق وهجا هشاماً فقال:
| أيحبسني بين المدينة والتي | إليها قلوب الناس يهوي منيبها | |
| يقلب رأساً لم يكن رأس سيد | وعينا له حولاء باد عيوبها |
محرر العبيد
كان زين العابدين علي بن الحسين يمثِّل الإنسانية على أعلى مستوياتها، ويطبق رسالة الإسلام كما أرادها النبي محمَّد تطبيقاً عملياً مثمراً.
فالإسلام الذي وضع الأسس لإلغاء الرقيق، فألغى أول ما ألغى معظم منابع الرقيق، وأوضح الطرق المؤدية في نهاية الأمر إلى إنهاء الرق. الإسلام هذا كان علي بن الحسين يمثله تمثيلاً كاملاً. ففي الحين الذي كانت تمتلىء فيه قصور الحكام بالأرقاء نساء ورجالاً وكانت الدولة تسيء تطبيق قواعد الإسلام. كان علي بن الحسين يقود حملة تحرير الرقيق، ويجعل من نفسه قدوة للشعب في ذلك. وكانت خطته كما يلي:
1 ـ عندما كان يصل الإرقاء إلى يده كان يعاملهم معاملة الأنداد فإذا أخطأوا لم يعاقبهم بل يسجل إخطاءهم في دفتر عنده وينتظر حتى يأتي عيد الفطر فيجمعهم ويعرض عليهم أخطاءهم ملاطفاً لهم فيعترفوا بتلك الأخطاء، فيقول لهم عفوت عنكم فهل عفوتم عني ما كان مني إليكم، فيقولون قد عفونا عنك وما أسأت. فيقول: قولوا اللهم اعف عن علي بن الحسين كما عفا عنا ثم يحررهم ويعطيهم بعض المال ليبدأوا به حياتهم الجديدة.
2 ـ لم يكن يبقي عنده عبداً سنة كاملة بل كان يشتريهم في الشهور التي تسبق رمضان ليسرع في تحريرهم وقت العيد.
3 ـ وكذلك كان يفعل في عيد الأضحى، فهو يشتري العبيد وليس له حاجة بهم فإذا جاء وقت الحج خرج بهم إلى عرفات، فإذا انتهى الحج حررهم وزودهم بالمال. ولم يكن ينقص عدد المحررين في كل عيد عن العشرين إنساناً.
والذي يزيد في تقديرنا لهذا العمل العظيم هو أن علي بن الحسين لم يكن ذا ثروة تساعده على التوسع في هذه الخطة، بل كانت موارد رزقه محدودة فكان ينفق كل ما يصل إلى يده في هذا السبيل وفي مساعدة ذوي الحاجات كما سنذكر فيما يلي:
مساعدة الفقراء
كان يخرج في الليل حاملاً معه ما استطاع جمعه من المال، وربما حمل الطعام والحطب أيضاً، حتى يأتي أبواب الفقراء فيقرعها باباً باباً، ثم يناول من يخرج إليه. ويكون مغطياً وجهه لئلا يعرفه أحد، فلما توفي انقطع عن الفقراء ما كان يأتيهم فعرفوا أنه هو الفاعل.
كتب الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) رسالة خاصة سميت بـ«رسالة الحقوق» تتضمن خمسين حقاً، تغطي معظم جوانب الحياة التي يحتاجها الإنسان بشكل تفصيلي، وتعطي قيمة للفرد في المجتمع الإنساني، وتعتبر أول مدونة حقوقية قننت وفصلت مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية. ويمكن اعتبار رسالة الحقوق مقاربة في مضامينها وفي منهجية عرضها الحقوق للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين صدرا العام 1966م من قبل الأمم المتحدة وانضمت إليهما معظم دول العالم.
وترسم رسالة الحقوق نمط العلاقات بين أفراد المجتمع والسلطة، إذ ركزت على الحقوق الفردية وخاطبت الفرد باعتباره المعني بهذه الحقوق. وتطالب الرسالة الإنسان المسلم بأن يوصل الحق إلى أصحابه قبل أن يطالب به، أي أن الرسالة تذكر «من عليه الحق» أكثر من «من له الحق». فمنظومة الحقوق هذه أسست التَرابط في ما بينها، وإمكان التمتع بأحد الحقوق أو بعضها يتوقف على توافر الحقوق الأخرى. ويمكن أن نرسم خارطة بنود رسالة الحقوق على الشكل الآتي:
1 ـ حقوق الله.
2 ـ حقوق الأفعال (العبادات).
3 ـ حقوق الأئمة (الحقوق السياسية والثقافية).
4 ـ حقوق الرعية (الحقوق الاجتماعية).
5 ـ حقوق الرحم.
ذكر الإمام علي بن الحسين الحقوق بشكل متداخل ومتفرع. ففي مقدمة الرسالة يستعرض الحقوق الخمسين بإيجاز، ثم يشرحها بالتفصيل مبتدئاً بحق الإيمان بالله، معتبراً إياه أصل الحقوق ومنه تتفرع. فحق الله كما جاء في النص: «اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقاً محيطة لك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها وآلة تصرفت بها: بعضها أكبر من بعض، وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق ومنه تَفْرع».
ثم ينتقل إلى حق النفس والجوارح السبع، وهي حق البصر والسمع واللسان واليدين والرجلين والبطن والفرج والجوارح الثلاث الأولى هي تعبير عن استعمال حق وسائل الإعلام في ذلك الوقت. يعطي الإمام للعبادات حقوقاً يفصلها، وهي حق الصلاة والصوم والصدقة والهدي. كما يورد الحقوق السياسية، وهو حق السلطان وحق الرعية، ويدخل حق الرحم في هذا السياق، وتتفرع من هذه حقوق أخرى هي، حسب تسميته «حق سائسك بالسلطان (السائس هو القائم بالأمر والمدبر له)، ثم سائسك بالعلم، ثم حق سائسك بالملك»، ليعود مرة أخرى إلى الحقوق السياسية، فيقول: «فأما حق سائسك بالسلطان فإن تعلم أنك جُعلت له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان، وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه وقد بُسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه. وتذلل وتلطف لإعطائه من الرضى ما يكفه عنه ولا يضر بدينك وتستعين عليه في ذلك بالله. ولا تعازّه ولا تُعانده فإنك إن فعلت ذلك عَققته وعققت نفسك فعرّضتها لمكروهه وعرضته للهلكة فيك، وكنت خليقاً أن تكون معيناً له على نفسك وشريكاً له فيما أتى إليك، ولا قوة إلا بالله».
تتوسع الرسالة في الحقوق الفردية (الشخصية) فتؤكد حق الملك، وحقوق الرحم متفرعة عنها حقوقاً كثيرة، هي حق الأم والأب والولد والأخ، ويربطها بالحقوق الاجتماعية، «حق مولاك المنعم عليك وحق مولاك الجاري نعمته عليك، ثم حق ذي المعروف لديك، وحق المؤذن، وحق إمام الصلاة، والجليس، والجار والصاحب».
يختتم الإمام رسالته الإنسانية بحقوق الأقليات غير المسلمة، ويقدم نموذجاً للتعايش بين الوحدات الاجتماعية غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي، ويهدف من خلالها منع مشاكل التمييز واللامساواة والقهر الديني أو القومي أو الثقافي مما حافظ على هوية الأقليات ووجودها في الشرق الإسلامي طيلة مئات السنين الماضية. ويمكن ملاحظة ذلك من قراءة الخارطة الأثنية والدينية للعالمين العربي والإسلامي، فما زالت شعوب غير عربية تعيش في منطقة الشرق، كالترك والفرس والأكراد والبلوش والبربر والهنود، وما زالت الأديان السماوية وغير السماوية تتعايش مع المسلمين، ما يدل على روح التسامح التي تسمح بالتنوع القومي والعرقي والديني، فلم يجر تعريب الشعوب المسلمة.
وعبرت الرسالة عن تلك الحقوق بحق أهل الذمة كما يأتي: «وأما حق أهل الذمة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله، وتفي بما جعل الله لهم من ذمته وعهده وتكلمهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم وأجبروا عليه، وتحكم فيهم بما حكم الله به على نفسك فيما جرى بينك (وبينهم) من معاملة، وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله والوفاء بعهده وعهد رسول الله(ص) حائل فإنه بلغنا أنه قال: «من ظلم معاهداً كنت خصمه» فاتق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله».
مُحمَّد البَاقر (ع)
مولده ووفاته ومدة عمره ومدفنه
ولد بالمدينة يوم الجمعة أو الثلاثاء، أو الاثنين غرة رجب أو ثالث صفر سنة 57 من الهجرة وقيل 56.
وتوفي بالمدينة يوم الاثنين سابع ذي الحجة، أو في ربيع الأول أو الآخر سنة 114 وعمره 57 سنة منها مع جده الحسين أربع سنين، ومع أبيه بعد جده الحسين 35 سنة، وبعد أبيه 18 سنة، وفي رواية الكافي عن الصادق(ع): 19 سنة وشهران وهي مدة أمامته وهي بقية ملك الوليد بن عبدالملك، وسليمان بن عبدالله، وعمر بن عبدالعزيز، ويزيد بن عبدالملك. وتوفي في ملك هشام بن عبدالملك. كذا في أعلام الورى وهو الصواب. وفي مناقب ابن شهرآشوب: قبض سنة 114 وله 57 سنة وأقام مع جده الحسين ثلاث سنين أو أربع سنين، ومع أبيه 34 سنة وعشرة أشهر أو 39 سنة، وبعد أبيه 19 سنة وقيل: 18 وذلك أيام أمامته وكان في سني أمامته ملك الوليد بن يزيد، وسليمان وعمر بن عبدالعزيز، ويزيد بن عبدالملك، وهشام أخيه، والوليد بن يزيد، وإبراهيم أخيه، وفي أول ملك إبراهيم قبض وقال أبو جعفر بن بابويه: سمه إبراهيم بن الوليد بن يزيد «ا.هـ» هكذا في نسختين وفيه من سهو القلم منه أو من النساخ أو منهما ما لا يخفى فالوليد بن يزيد واحد، وهو المذكور أخيراً والمذكور أولاً صوابه الوليد بن عبدالملك وقوله والوليد بن يزيد الخ صوابه الوليد بن يزيد بن عبدالملك ويزيد بن الوليد بن عبدالملك وإبراهيم أخيه ثم أن هشاماً توفي سنة 125 وإبراهيم ولي وقتل سنة 127 فإذا كان الباقر (ع) قبض سنة 114 كما ذكره هو، فوفاته في ملك هشام لا إبراهيم. وفي كشف الغمة: قال محمد بن عمرو: أما في روايتنا فإنه مات سنة 117 وقال غيره سنة 118 «ا.هـ».
ودفن بالبقيع مع أبيه علي بن الحسين وعمه الحسن بن علي (ع).
أمه
وأمه فاطمة بنت الحسن (ع).
كنيته
أبو جعفر ويقال أبو جعفر الأول.
لقبه
له ألقاب كثيرة أشهرها الباقر أو باقر العلم.
سبب تلقيبه بالباقر
في الفصول المهمة: لقب به لبقره العلم وهو تفجره وتوسعه «ا.هـ» وفي الصحاح: التبقر التوسع في العلم «ا.هـ» وفي القاموس: الباقر محمد بن علي بن الحسين لتبحره في العلم «ا.هـ» وفي لسان العرب: لقب به لأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتوسع فيه والتبقر التوسع «ا.هـ» وفي صواعق ابن حجر: سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وأثار مخبآتها ومكامنها فكذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه إلخ.
وروى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن عمرو بن شمر سألت جابر الجعفي فقلت له: لم سمي الباقر باقراً؟ قال لأنه بقر العلم بقراً أي شقه شقاً وأظهره إظهاراً. وفي مناقب ابن شهرآشوب: يقال لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) من العلوم ما ظهر منه. وتعرضت الدولة في عهد عبدالملك لتحد بيزنطي بشأن النقد المتداول فأشار على عبدالملك بأن يضرب النقود الإسلامية رداً للتحدي، كما فصله البيهقي في المحاسن والمساوىء.
ملوك عصره
الوليد بن عبدالملك، وسليمان بن عبدالملك، وعمر بن عبدالعزيز، ويزيد بن عبدالملك، وهشام بن عبدالملك، وزاد بعضهم الوليد بن يزيد بن عبدالملك، ويزيد بن الوليد بن عبدالملك، وإبراهيم بن الوليد بن عبدالملك.
أولاده
قال المفيد في الإرشاد: ولد أبي جعفر سبعة أنفس أبو عبدالله جعفر بن محمد وكان به يكنى وعبدالله بن محمد أمهما فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وإبراهيم وعبيدالله درجا، وعلي وزينب وأم سلمة وقيل: أن زينب هي أم سلمة حكاه في أعلام الورى. وقال ابن شهرآشوب في المناقب: أولاده سبعة وعدهم كالإرشاد إلا أنه قال وعبدالله الأفطح ثم قال درجوا كلهم إلا أولاد الصادق (ع).
علمه
عن أبي نعيم في الحلية: أنه سأل رجل ابن عمر عن مسألة فلم يدر ما يجيبه فقال: اذهب إلى ذلك الغلام فسله، واعلمني بما يجيبك وأشار إلى الباقر (ع) فسأله، فأجابه، فأخبر ابن عمر فقال: أنهم أهل بيت مفهمون.
وفي حلية الأولياء: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي ميمون، حدثنا أبو ملك الجهني، عن عبدالله بن عطاء ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر، لقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم بين يديه كأنه صبي بين يدي معلمه. ويكفي في ذلك تلقيبه بباقر العلم كما مر، واشتهاره بهذا اللقب بين الخاص والعام في كل عصر وزمان.
وقال المفيد: لما يظهر أحد من ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) من العلم ما ظهر عنه وسيأتي ذكر من أخذ عنه من عظماء المسلمين من الصحابة والتابعين والفقهاء والمصنفين وغيرهم. وقد أخذ العلماء عنه واقتدوا به واتبعوا أقواله. وكانت مدرسته استمراراً لمدرسة أبيه الكبرى.
احتجاجه على محمد بن المنكدر من مشاهير زهاد ذلك العصر وعباده
قال المفيد في الإرشاد: أن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أن مثل علي بن الحسين يدع خلفاً لفضل علي بن الحسين، حتى رأيت ابنه محمد بن علي، فأردت أن أعظه فوعظني، خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن علي، وكان رجلاً بديناً، وهو متكىء على غلامين له فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحالة في طلب الدنيا، والله لاعظنه، فدنوت منه فسلمت عليه، فسلم علي بنهر وقد تصبب عرقاً فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لو جاء الموت وأنت على هذه الحال؟ فخلى عن الغلامين من يده ثم تساند وقال: لو جاءني والله الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله، فقلت: يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني([1122]).
(أقول) معنى قوله «أردت أن أعظك فوعظتني» أن ابن المنكدر هذا كان من المتصوفة أمثال طاوس اليماني وإبراهيم بن أدهم وغيرهما، وكان يصرف أوقاته في العبادة ويترك الكسب، فيكون كلا على الناس، فأراد أن يعظ الباقر (ع) بأنه لا ينبغي له أن يخرج في مثل ذلك الوقت في طلب الدنيا، فأجابه: بأن خروجه في طلب المعاش ليكف نفسه عن الناس من أفضل العبادات، وكان في هذا الكلام موعظة لابن المنكدر بأنه مخطىء في ترك الكسب، وإلقاء كله على الناس واشتغاله بالعبادة فلهذا قال: أردت أن أعظك فوعظتني([1123]).
الرواة عن الباقر
قال المفيد في الإرشاد: روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين وقال ابن شهرآشوب في المناقب بعد ذكر ذلك: فمن الصحابة نحو جابر بن عبدالله الأنصاري ومن التابعين نحو جابر بن يزيد الجعفي وكيسان السختياني صاحب الصوفية. ومن الفقهاء نحو ابن المبارك والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وزياد بن المنذر النهدي. ومن المصنفين نحو الطبري والبلاذري والسلامي والخطيب في تواريخهم وفي الموطأ وشرف المصطفى والإبانة وحلية الأولياء وسنن أبي داود والألكاني ومسندي أبي حنيفة والمروزي وترغيب الأصفهاني وبسيط الواحدي وتفسير النقاش والزمخشري ومعرفة أصول الحديث ورسالة السمعاني. فيقولون: قال محمد بن علي وربما قالوا قال محمد الباقر «ا.هـ» وقال ابن شهرآشوب في موضع آخر من المناقب: ومن أصحابه حمران بن أعين الشيباني وأخوته بكير وعبدالملك وعبدالرحمن ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وعبدالله بن ميمون القداح ومحمد بن مروان الكوفي من ولد أبي الأسود وإسماعيل بن الفضل الهاشمي من ولد نوفل بن الحارث وأبو هارون المكفوف وظريف بن ناصح بياع الأكفان وسعيد بن طريف الأسكاف الدُئلي وإسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي وعقبة بن بشير الأسدي وأسلم المكي مولى ابن الحنفية وأبو بصير ليث بن البختري المرادي والكميت بن زيد الأسدي وناجية بن عمارة الصيداوي ومعاذ بن مسلم الهراء النحوي وبشير الرحال. وفي حلية الأولياء: روى عنه من التابعين عمرو بن دينار وعطاء بن رباح وجابر الجعفي وأبان بن تغلب. وروى عنه من الأئمة والأعلام ليث بن أبي سليم وابن جريح وحجاج بن أرطأة في آخرين «ا.هـ».
وقال المفيد في الاختصاص: أصحاب محمد بن علي (ع) جابر بن يزيد بن الجعفي، حمران بن أعين، زرارة، عامر بن عبدالله بن جذاعة، حجر بن زايدة، عبدالله بن شريك العامري، فضيل بن يسار البصري، سلام بن المستنير، بريد بن معاوية العجلي، الحكيم ابن أبي نعيم.
وفي الاختصاص: زياد بن المنذر الأعمى وهو أبو الجارود وزياد بن أبي رجاء وهو أبو عبيدة الحذاء وزياد بن سوقة وزياد مولى أبي جعفر وزياد بن أبي زياد المنقري وزياد الأحلام من أصحاب الباقر ومن أصحابه أبو بصير ليث بن البختري المرادي وأبو بصير يحيى بن أبي القاسم.
مؤلفاته
(1) كتاب التفسير قال ابن النديم عند ذكر الكتب المصنفة في التفسير: كتاب الباقر محمد بن علي بن الحسين (ع) رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر رئيس الجارودية الزيدية «ا.هـ» وقد روى هذا الكتاب عن أبي الجارود عند سلامة حالة أبو بصير يحيى بن القاسم (أو أبي القاسم) الأسدي وكذا أخرجه علي بن أبراهيم بن هاشم في تفسيره. (2) رسالته إلى سعد الخير من بني أمية. (3) رسالة أخرى منه إليه أوردهما الكليني في روضة الكافي. (4) قال ابن النديم: أبو جعفر محمد بن علي له من الكتب كتاب الهداية وقد روي عنه في فنون العلم الشيء الكثير وألف أصحابه في ذلك المؤلفات الكثيرة المذكورة في تراجمهم.
جعفر الصادق (ع)
ولد بالمدينة يوم الجمعة أو الاثنين عند طلوع الفجر 17 ربيع الأول. وقيل: أول رجب سنة 80 من الهجرة عام الجحاف، وقال المفيد، والكليني، والشهيد: سنة 83 قال ابن طلحة: والأول أصح. وقال ابن الخشاب قال لنا الذراع: الرواية الأولى هي الصحيحة. وتوفي يوم الاثنين في شوال وعن صاحب جنات الخلود: في 25 منه. وقيل: منتصف رجب سنة 148 وعمره 68 أو 65 سنة أقام منها مع جده علي بن الحسين 12 سنة وأياماً أو 15 سنة، ومع أبيه بعد جده 19 سنة، وبعد أبيه 34 سنة وهي مدة خلافته وإمامته وهي بقية ملك هشام بن عبدالملك، وملك الوليد بن يزيد بن عبدالملك، ويزيد بن الوليد بن عبدالملك الملقب بالناقص، وإبراهيم بن الوليد، ومروان بن محمد، والسفاح وتوفي بعد مضي عشر سنين من ملك المنصور العباسي، ودفن بالبقيع مع أبيه الباقر وجده زين العابدين وعمه الحسن بن علي (ع).
أمه
أم فروة وقيل أم القاسم واسمها قريبة أو فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر، وهذا معنى قول الصادق (ع): أن أبا بكر ولدني مرتين.
كنيته
أبو عبدالله وهي المعروفة المشهورة. وقال محمد بن طلحة: وقيل أبو إسماعيل وفي مناقب ابن شهرآشوب: يكنى أبا عبدالله وأبا إسماعيل والخاص أبو موسى.
لقبه
له ألقاب أشهرها: الصادق.
أولاده
كان له عشرة أولاد سبعة ذكور وثلاث بنات وقيل أحد عشر ولداً سبعة ذكور وأربع بنات وهم إسماعيل وعبدالله وأم فروة. قال المفيد: أمهم فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وقال الحافظ عبدالعزيز بن الأخضر الجنابذي: أمهم فاطمة بنت الحسين الأثرم بن حسن بن علي بن أبي طالب. وموسى الإمام ومحمد الديباج وإسحاق وفاطمة الكبرى أمهم حميدة البربرية والعباس وعلي العريضي وأسماء وفاطمة الصغرى لعدة أمهات، فمن عدهم عشرة ترك فاطمة الكبرى ومن عدهم أحد عشر ذكرها، ويظهر من المناقب أن أم فروة هي أسماء، وهذا غير بعيد لأن أم فروة كنية لا اسم فيكون أولاده عشرة بذكر فاطمة الكبرى وجعل أم فروة وأسماء واحدة..
مميزات القرن الثاني
عصر جعفر الصادق
ولد (ع) سنة 80 أو 83 للهجرة وتوفي سنة 148 كما مر. ومن مميزات هذا العصر انتشار العلوم الإسلامية فيه من التفسير والفقه والحديث وعلم الكلام والجدل والأنساب واللغة والشعر والأدب والكتابة والتاريخ والفلك وغيرها.
وكان الصادق أشهر أهل زمانه علماً وفضلاً، قال مالك بن أنس إمام المذهب: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد فضلاً وعلماً وعبادة وورعاً وكان كثير الحديث طيب المجالسة كثير الفوائد.
وقال الحسن بن زياد: سمعت أبا حنيفة وقد سئل عن أفقه من رأيت، قال جعفر بن محمد.
وبرز بتعليمه من الفقهاء والأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين وأخويه بكر وحمران وجميل بن صالح وجميل بن دارج ومحمد بن مسلم الطائي وبريد بن معاوية وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وأبي بصير وعبيدالله ومحمد وعمران الحلبيين وعبدالله بن سنان وأبي الصباح الكتاني وغيرهم من أعيان الفضلاء. وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل ذكرهم الحافظ بن عقدة الزيدي في كتاب رجاله وذكر مصنفاتهم، ونقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعات غير هؤلاء الأربعة الآلاف من أعيان الأئمة وأعلامهم مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريح ومالك بن أنس والثوري وابن عيينة وأبي حنيفة وشعبة وأيوب السختياني وجابر بن حيان الكوفي وإبان بن تغلب وأبو عمرو بن العلاء وعمرو بن دينار وآخرين غيرهم، وكان السبب في انتشار علومه وكثرة الأخذين عنه أن أدرك أواخر الدولة الأموي وأوائل الدولة العباسية، فأدرك الأولى في أيام ضعفها وكانت الثانية في أولها لم تنجم فيها ناجمة الحسد لآل أبي طالب وهي دولة هاشمية ترى أن مثل جعفر الصادق من مفاخرها. وقد روي عنه في التفسير الشيء الكثير وكذلك في علم الكلام ودون من أجوبة مسائله في الفقه وغيره كتب جمة وأخذت عنه مهمات علم أصول الفقه وكتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف تعرف بالأصول الأربعمائة.
وممن اشتهر بالتفسير والنسب في ذلك العصر محمد بن السائب الكلبي والسدي الكبير إسماعيل بن عبدالرحمن وأبو حمزة الثمالي. وبالفقه والحديث في ذلك العصر غير الإمام الصادق أبو حنيفة إمام المذهب وتلميذه أبو يوسف ومالك بن أنس إمام المذهب ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وغيرهم وابن جريح وعروة بن الزبير وابن سيرين والحسن البصري والشعبي وفي علوم اللغة العربية معاذ بن مسلم الهراء الكوفي واضع علم الصرف. وفي التاريخ والمغازي محمد بن إسحاق بن يسار. وفي الكتابة عبدالحميد كاتب مروان الحمار آخر ملوك بني أمية.
ومن الكتاب من أصحاب الصادق (ع) أبو حامد إسماعيل الكاتب الكوفي، وممن اشتهر من الشعراء في عصره وبعضهم كان من مادحيه السيد الحميري وأشجع السلمي والكميت وابنه المستهل وأخوه الورد وأبو هريرة الأبار وأبو هريرة العجلي والعبدي وجعفر بن عفان وسليمان بن قتة العدوي وسديف وإبراهيم بن هرمة ومنصور النمري.
أخباره مع دعاة بني العباس
في أمالي المرتضى روى أن دعاة خراسان صاروا إلى أبي عبدالله الصادق (ع) فقالوا له أردنا ولد محمد بن علي فقال أولئك بالسراة ولست بصاحبكم فقالوا لو أراد الله بنا خيراً كنت صاحبنا. فقال المنصور بعد ذلك لأبي عبدالله أردت الخروج علينا فقال نحن ندل عليكم في دولة غيركم فكيف نخرج عليكم في دولتكم.
خبره مع أبي سلمة
الخلال وعبدالله بن الحسن
في عمدة الطالب: لما قدم أبو العباس السفاح وأهله سراً على أبي سلمة الخلال الكوفي ستر أمرهم وعزم أن يجعلها شورى بين ولد علي والعباس حتى يختاروا هم من أرادوا ثم قال أخاف أن لا يتفقوا ثم عزم أن يعزل الأمر إلى ولد علي من الحسن والحسين فكتب إلى ثلاثة نفر منهم، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وعمر بن علي بن الحسين، وعبدالله بن الحسن بن الحسن فبدأ الرسول بجعفر بن محمد فلقيه ليلاً وأعلمه أن معه كتاباً إليه من أبي سلمة فقال وما أنا وأبو سلمة هو شيعة لغيري فقال: تقرأ الكتاب وتجيب عليه بما رأيت. فقال: جعفر لخادمه: قدم مني السراج فقدمه فوضع عليه كتاب أبي سلمة فأحرقه فقال: ألا تجيبه؟ فقال: فقد رأيت الجواب. فخرج من عنده وأتى عبدالله بن الحسن المثني فقبل كتابه وركب إلى جعفر بن محمد فقال جعفر: أي أمر جاء بك يا أبا محمد لو أعلمتني لجئتك؟ فقال: أمر يجل عن الوصف قال: وما هو يا أبا محمد؟ قال: هذا كتاب أبي سلمة يدعوني للأمر ويرى أني أحق الناس به وقد جاءته شيعتنا من خراسان فقال له جعفر الصادق (ع): ومتى صاروا شيعتك؟ أأنت وجهت أبا مسلم إلى خراسان وأمرته بلبس السواد؟ هل تعرف أحداً منهم باسمه ونسبه؟ كيف يكونوا من شيعتك وأنت لا تعرفهم ولا يعرفونك؟ فقال له عبدالله: إن كان هذا الكلام منك لشيء.. فقال: جعفر قد علم الله أني أوجب على نفسي النصح لكل مسلم فكيف ادخره عنك فلا تمنين نفسك الأباطيل فإن هذه الدولة ستتم لهؤلاء القوم، وقد جاءني مثل ما جاءك. فانصرف عبدالله غير راض بما قاله. وأما عمر بن علي بن الحسين فرد الكتاب. وقال: ما أعرف كاتبه فأجيبه. فهذا الذي صدر من الصادق (ع) يدل على عظم قدره وإصابة رأيه، على الأقل ولله أمر هو بالغه. وفي قوله لو أعلمتني لجئتك دليل على كرم أخلاقه ومحافظته على حق الرحم مع مزاحمة عبدالله له. وإيصاؤه إلى خمسة أحدهم المنصور والباقون محمد بن سليمان والي المدينة وولداه عبدالله وموسى وحميدة جاريته أدل على بعد نظره بتخليص وصيه الحقيقي من القتل بإشراكه في الوصية مع جماعة أحدهم المنصور.
ما فعله حين حمل المنصور
بني حسن إلى العراق
روى أبو الفرج الأصفهاني بإسناده إلى الحسين بن زيد بن علي قال: أني لواقف بين القبر والمنبر إذ رأيت بني حسن يخرج بهم من دار مروان يراد بهم الربذة، فأرسل إلي جعفر بن محمد ما وراءك؟ قلت: رأيت بني حسن يخرج بهم في محامل فقال: اجلس فدعا غلاماً ثم دعا ربه كثيراً ثم قال لغلامه: اذهب فإذا حملوا فائت فأخبرني فأتاه فقال: قد أقبل بهم فقام جعفر وراء ستر شعر أبيض فطلع بعبدالله بن حسن وإبراهيم بن حسن وجميع أهلهم فلما نظر إليهم جعفر بن محمد هملت عيناه حتى جرت دموعه على لحيته ثم أقبل علي فقال: يا أبا عبدالله، والله لا تحفظ لله حرمة بعد هذا.
الراوون عن الصادق
قال الطبرسي في أعلام الورى: أنه تضافر النقل بأن الذين رووا عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان. وقول المحقق في المعتبر: روى عنه ما يقارب أربعة آلاف رجل وبرز بتعليمه من الفقهاء الأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين وأخويه بكر وحمران وجميل بن صالح وجميل بن دراج ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية والهشامين وأبي بصير عبيدالله ومحمد وعمران الحلبيين وعبدالله بن سنان وأبي الصباح الكناني وغيرهم من أعيان الفضلاء وقول الشهيد في الذكرى: دون من رجاله المعروفين أربعة آلاف إنسان فزاد عليهم وفي مطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي: نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الأئمة وأعلامهم مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريح ومالك بن أنس والثوري وابن عيينة وأبي حنيفة وشعبة وأيوب السختياني وغيرهم وعدوا أخذهم منه منقبة شرفوا بها وفضيلة اكتسبوها، ومن تلاميذه جابر بن حيان.
وفي حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني: روى عن جعفر عدة من التابعين منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني وأبان بن تغلب وأبو عمرو بن العلاء ويزيد بن عبدالله بن الهاد وحدث عنه من الأئمة والإعلام مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وابن جريح وعبدالله بن عمرو وروح بن القاسم وسفيان بن عيينة وسلمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل وعبدالعزيز بن المختار ووهب بن خالد وإبراهيم بن طهمان في آخرين وأخرج عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه محتجاً بحديثه ثم أورد حديثاً في طريقه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ثم قال: هذا حديث صحيح ثابت أخرجه مسلم في صحيحه ثم أورد أحاديث كثيرة في طريقها جعفر بن محمد الصادق (ع).
وقال ابن شهرآشوب في المناقب: قال غير أبي نعيم روى عنه مالك والشافعي الحسن بن صالح وأبو أيوب السختياني وعمرو بن دينار وأحمد بن حنبل وكان مالك كثيراً ما يدعي سماعه وربما قال حدثني الثقة بعينه جعفر بن محمد (قال) وقال أبو عبدالله المحدث: إن أبا حنيفة من تلامذته (قال) وكان محمد بن الحسن يعني الشيباني أيضاً من تلامذته ولأجل ذلك كانت بنو العباس لا تحترمهما.
وقال ابن حجر في الصواعق: روى عنه الأئمة الأكابر كيحيى بن سعيد وابن جريح ومالك والسفيانين وأبي حنيفة وشعبة وأيوب السختياني.
وذكر الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في كتابه معالم العترة الطاهرة أنه روى عنه من أولاده موسى ومحمد وإسماعيل وإسحاق ثم ورد لكل واحد منهم حديثاً.
وفي مناقب ابن شهرآشوب: وأصحابه من التابعين مثل إسماعيل بن عبدالرحمن الكوفي. عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي (ع) ومن خواص أصحابه: معاوية بن عمار مولى بني دهن وهو حي من بجيلة. زيد الشحام. عبدالله بن أبي يعفور. أبو جعفر بن محمد بن علي. النعمان الأحول. أبو الفضل سدير بن حكيم. عبدالسلام بن عبدالرحمن. جابر بن يزيد الجعفي. أبو حمزة الثمالي. ثابت بن دينار. المفضل بن قيس بن رمانة. المفضل بن عمر الجعفي. نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب. ميسرة بن عبدالعزيز. عبدالله بن عجلان. جابر المكفوف. أبو داود المسترق. إبراهيم بن مهزم الأسدي. بسام الصيرفي سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي. أبو خالد القماط واسمه يزيد. ثعلبة بن ميمون. أبو بكر الحضرمي. الحسن بن زياد. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأنصاري. سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي. عبدالعزيز بن أبي حازم. سلمة بن دينار المدني.
مؤلفات الصادق
1 ـ رسالته إلى النجاشي والي الأهواز المعروفة برسالة عبدالله بن النجاشي وقد ذكر النجاشي صاحب الرجال أنه لم يرد لأبي عبدالله (ع) مصنف غيرها ويمكن حمله على أنه لم يجمع هو (ع) بيده غيرها والباقي مما حفظه الرواة عنه.
2 ـ رسالة له (ع) أوردها الصدوق في الخصال وأورد سنده إليها عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) تتضمن شرائع الدين.
3 ـ الكتاب المسمى بتوحيد المفضل لأنه رواية وإلا فهو من تأليف الصادق (ع) موجود بتمامه في ضمن كتاب البحار وقد طبع مستقلاً على الحجر بمصر وقرأت في مجلة المقتبس أنه طبع في استانبول ولم أره.
4 ـ كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة منسوب إلى الصادق (ع) وهو مطبوع مع جامع الأخبار ولكن المجلسي في مقدمات البحار قال أن فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمة وآثارهم. والله أعلم. وقال صاحب الوسائل في آخر كتاب الهداية الثالث: ما ثبت عندنا أنه غير معتمد فلذا لم ننقل منه فمن ذلك كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الصادق فإن سنده لم يثبت وفيه أشياء منكرة مخالفة للمتواتر وقال صاحب رياض العلماء عند ذكر الكتب المجهولة: ومن ذلك مصباح الشريعة في الأخبار والمواعظ كتاب معروف متداول إلى أن قال بل هو من مؤلفات بعض الصوفية كما لا يخفى.
5 ـ رسالته إلى أصحابه رواها الكليني في أول روضة الكافي بسنده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (ع) أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها وكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها.
6 ـ رسالته إلى أصحاب الرأي والقياس.
7 ـ رسالته (ع) في الغنائم ووجوب الخمس أوردها وما بعدها إلى السادس عشر في تحف العقول.
8 ـ وصيته لعبدالله بن جندب.
9 ـ وصيته لأبي جعفر محمد بن النعمان الأحول.
10 ـ نثر الدرر كما سماه بعض الشيعة.
11 ـ كلامه في وصف المحبة لأهل البيت والتوحيد والإيمان والإسلام والكفر والفسق.
12 ـ رسالته في وجوه معايش العباد ووجوه إخراج الأموال جواباً لسؤال من سأله كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات.
13 ـ رسالته في احتجاجه على الصوفية فيما ينهون عنه من طلب الرزق.
14 ـ كلامه في خلق الإنسان وتركيبه.
15 ـ حكمه القصيرة. وهناك كتب مروية عن الصادق (ع) جمعها أصحابه مما رووه عنه فيصح بهذا الاعتبار نسبتها إليه لأن الإملاء أحد طرق التأليف وقد ذكر خمسة منها النجاشي وذكر سنده إليها ويحتمل تداخلها مع بعض ما تقدم وهي:
16 ـ نسخة ذكرها النجاشي في ترجمة محمد بن ميمون الزعفراني.
17 ـ نسخة رواها الفضيل بن عياض عنه.
18 ـ نسخة رواها عبدالله بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.
19 ـ نسخة رواها سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي.
20 ـ نسخة يرويها إبراهيم بن الشيباني.
21 ـ كتاب يرويه جعفر بن بشير البجلي.
22 ـ كتاب رسائله رواه عنه جابر بن حيان الكوفي قال اليافعي في مرآة الجنان: له كلام نفيس في علوم التوحيد وغيرها وقد ألف تلميذه جابر بن حيان كتاباً يشتمل على ألف ورقة يتضمن رسائله وهي خمسمائة رسالة.
هذا ما عرف من الكتب التي دونت وحدها وعرفت بأسماء مخصوصة وإلا فالذي جمع مما رواه العلماء في فنون شتى ما تكفلت كتب الأخبار والأحاديث بجمعه.
علمه
في مناقب ابن شهرآشوب: نقل عنه من العلوم ما لم ينقل عن أحد، وقال أيضاً: قال نوح بن دراج لابن أبي ليلى: أكنت تاركاً قولاً قلته أو قضاء قضيته لقول أحد؟ قال: لا إلا رجلاً واحداً، قال من هو؟ قال: جعفر بن محمد. وقال المفيد في الإرشاد: لم ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبار ولا نقلوا عنه ما نقلوا عن أبي عبدالله (ع) فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقاة عن اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل. وقال المحقق في المعتبر: انتشر عن جعفر بن محمد من العلوم الجمة ما بهر به العقول.
إن التراث العلمي الذي خلفه الإمام الصادق للأجيال المتعاقبة تراث عظيم غني بالعمق والابتكار والجدة وبعد الغور، وسع المعرفة من كل جهاتها، وجلا عن عدد من العلوم خفاياها وغوامضها، فأثرى به الفكر الإنساني ثراء كبيراً، وانفتحت به أمام العقل آفاق لم يكن يدركها من قبل، ولم يسبق له التعمق فيها والاطلاع على ما تضمه من كنوز العلم والعرفان.
ولعل الميزة الكبرى والسمة البارزة لذلك التراث الخالد أنه لم يقتصر على تفسير القرآن وأحكام الفقه وشؤون الدين، بل شمل جوانب متعددة من علوم مختلفة، وأوضح خفايا كثيرة من الحقائق الكونية الغامضة، مما يدل على أن قصد الصادق كان متجهاً نحو قيام حضارة إسلامية متميزة تقوم على العلم والفكر فيما تقوم عليه من دعائم وما تتجه نحوه من أهداف.
إن الفترة الحافلة التي عاشها الإمام الصادق وبخاصة تلك الفترة التي ضعف فيها سلطان الأمويين بفعل ضربات الدعاة العباسيين، ثم انهيار الحكم الأموي. ثم فترة انشغال الحكم العباسي المنتصر بوضع التخطيط الجديد للدولة وترسيخ قواعدها في المجتمع. إن هذه الظروف التي خف فيها ضغط الحكام على الإمام وعلى من يتصل به ويأخذ عنه، قد ساعده كثيراً على إملاء العلوم، وتوضيح الغوامض، وتربية العلماء القادرين على حمل هذه الأفكار بأمانة، وتطويرها بعمق، ومن ثم جعلها المنطلق نحو بناء الحضارة الإسلامية المنشودة.
وبفضل هذه الكثرة من الروايات والأمالي والأحاديث عن الإمام الصادق لدى الناس وفي التاريخ اصطلاح المذهب الجعفري والفقيه الجعفري، في حين أن المتحري للحقيقة يعلم أن الفقه فقه أهل البيت بأجمعهم، حيث يرويه كل واحد منهم عن جدهم الأعلى محمد (ص)، ولكن كثرة الرواية وكثرة الرواة عن الصادق بالخصوص كانت السبب في هذه النسبة.
وتتجلى عظمة الإمام الصادق لنا بوضوح حينما نتصور الألوف من المسلمين وهم يفخرون بسماع علمه وحديثه حتى لقد جمع الحافظ بن عقدة في كتابه أسماء أربعة آلاف رجل من الثقات رووا عن الصادق كما مر.
وكما قال ابن حجر في كتابه الصواعق: «نقل الناس عن جعفر بن محمد من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر في جميع البلدان».
ويقول الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت: لولا السنتان لهلك النعمان. ويقول الأستاذ دونالدسن: «أن طريقة الإمام الصادق في التدريس كانت سقراطية فهو يأخذ المتلمذين بالحوار والمحادثة ويتدرج عن الموضوعات الساذجة إلى المسائل المركبة والمطالب المعقدة والأسرار الغامضة».
وإن أول جانب من جوانب المعرفة عني به الإمام الصادق كل العناية هو تفسير القرآن، وإن نظرة واحدة عجلى يلقى بها على كتب التفسير لدى المسلمين ترشدنا بوضوح إلى دور أهل البيت في تفسير القرآن، حيث لا يستغني المفسر عن نقل ما أثر عنهم في توضيح غوامض القرآن وكشف الغطاء عن حقائقه، وبخاصة ما أثر عن الصادق، بالذات من إجابات على أسئلة المستفسرين عن معاني القرآن ومراميه.
ثم كان الجانب الثاني من الجوانب التي أوضحها الإمام وبينها للناس علم الفقه والشريعة، وهو جانب كثر التحدث عنه حتى أصبح أجلى جوانب الإمام الصادق، وحسبنا في الحديث عن هذا الجانب ما يقرره الشيخ الأزهري محمد أبو زهرة في كتابه «الإمام الصادق» ص66 إذ يقول:
«ما أجمع علماء الإسلام على اختلاف طوائفهم في أمر، كما أجمعوا على فضل الإمام الصادق وعلمه، فأئمة السنة الذين عاصروه وتلقوا عنه وأخذوا، أخذ عنه مالك (رضي الله عنه)، وأخذ عنه طبقة مالك، كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم كثير، وأخذ عنه أبو حنيفة مع تقاربهما في السن واعتبره أعلم الناس لأنه أعلم الناس باختلاف الناس، وقد تلقى عليه رواية الحديث طائفة كبيرة من التابعين منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني وأبان بن تغلب وأبو عمرو بن العلاء، وغيرهم من أئمة التابعين في الفقه والحديث، وذلك فوق الذين رووا عنه من تابعي التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة والمجتهدين».
ثم كان جانب الفلسفة ثالث الجوانب التي أولاها الإمام الصادق اهتمامه، بالنظر إلى ما توارد على العقل العربي من شُبَه وشكوك فلسفية، نتيجة حركة الترجمة والاختلاط بالأمم الجديدة الداخلة في الإسلام.
وهنا نجد الصادق قائماً بتفنيد الأباطيل وإزالة الشبه وكشف القناع عن الحقائق، وتوضيح الأمر للجاهل والمضلَّل، وتوجيه عدد كبير من طلابه نحو التفرغ للعناية بهذا الجانب الفكري المهم، وقد سجل عدد من كتب الحديث والتاريخ نماذج من تلك المناقشات التي كان يشرف عليها الإمام الصادق ويقوم بها بنفسه.
وهناك جانب آخر من جوانب المعرفة الإنسانية أولاه الصادق كثيراً من عنايته، إلا وهو الكيمياء.
ويقول الدكتور محمد يحيى الهاشمي في كتابه «الإمام الصادق ملهم الكيمياء» ص28:
«إذا أردنا أن نبحث عن المنابع الحقيقية للكيمياء العربية نجد بذلك صعوبة عظيمة، لأنه لا يزال ذلك في طي الخفاء، نعم نحن نعلم أن للاسكندرية دوراً هاماً في هذا الشأن، ولكن المنبع الأصلي لهذه المدرسة لا يزال مجهولاً، فمنهم من يعزو ذلك إلى آشور وبابل، ومنهم من يعزو ذلك إلى الهند، ومنهم إلى الصين، وإلى غيرها من الممالك والبلدان ومما لا شك فيه أن شواطىء الرافدين ـ دجلة والفرات ـ كانت مركزاً هاماً لمدنيات لعبت دورها في التاريخ، وقد عرف هناك عمل الزجاج وتحضير الكلس… واستحضار المعادن من فلذاتها، كذلك عرف الآشوريون معدناً يسمونه الكبالتو، وهو نفس معدن الكوبالت المعروف اليوم والذي كانوا يستعملونه قديماً في صيغ الخزف والزجاج…
ويقول أيضاً: «إن هذا العلم السحري يرتبط مع رجال الدين والكهنة ارتباطاً وثيقاً، وبرز في الإسكندرية على يد رجال شديدي العلاقة بالإفلاطونية الحديثة التي هي بثوب يوناني وبروح شرقية، وقد حافظ هذا العلم على شكله الصوفي مدة طويلة من الزمن، ظهر لنا بعد ذلك في أرض الرافدين متعلقاً بالأئمة المجتهدين والمتصوفة علاقة شديدة، كما سوف نجد ذلك في العلاقة الروحية الشديدة بين جابر بن حيان والإمام جعفر الصادق».
ثم يقول بعد ذلك: «إن أول شبح من أشباح التاريخ الذي يظهر أمامنا في حقل الكيمياء هو جابر بن حيان، ويمكننا أن نعد رسائله أول مظهر من مظاهر الكيمياء في المدنية الإسلامية، ويغلب على الظن أن عدداً عظيماً من رسائله كان نصيبها الفناء».
إن جابر بن حيان الذي تكرر ذكره في النصوص السابقة عربي من الأزد. سافر والده إلى طوس لنشر الدعوة للعباسيين، وهنا ولد له جابر، ثم ظفر الأمويون بحيان فأعدموه الحياة، ولما انتصر العباسيون وقامت دولتهم رحل جابر إلى الكوفة، وتمكن بعد ذلك من الاتصال بالإمام الصادق وتلقى علم الكيمياء في مدرسته، وأصبح هذا الرجل بفضل تلمذته الواعية كيماوي العرب الأول، ثم اعتبر على مر القرون قمة شامخة في تطور هذا العلم، حتى قال عنه الأستاذ برتلو في كتابه الذي نشره بباريس عن الكيمياء عند العرب قال ما نصه: «أن اسم جابر ينزل في تاريخ الكيمياء منزلة اسم أرسطو في تاريخ المنطق».
لم يكن لجابر هذا أستاذ غير الإمام الصادق (ص)، وقد كرر جابر ذكر اسم أستاذه في أكثر كتبه وبتعابير مختلفة، ويقول الأستاذ هولميارد في بحثه عن جابر بن حيان:
«أن جابراً هو تلميذ جعفر الصادق وصديقه، وقد وجد في إمامه الفذ سنداً ومعيناً وراشداً أميناً، وموجهاً لا يستغنى عنه. وقد سعى جابر لأن يحرر الكيمياء بإرشاد أستاذه من أساطير الأولين التي علقت بها من الإسكندرية، فنجح في هذا السبيل إلى حد بعيد».
ويقول الدكتور زكي نجيب محمود في كتاب «جابر بن حيان ص17»:
وأما جعفر الذي كثيراً ما يرد اسمه في كتابات جابر مشاراً إليه بقوله: سيدي، فهناك من يزعم أنه جعفر بن يحيى البرمكي، لكن الشيعة تقول ـ وهو القول الراجح الصدق ـ أنه إنما عنى به جعفر الصادق، ونقول أنه مرجح الصدق لأن جابراً شيعي، فلا غرابة أن يعترف بالسيادة لإمام شيعي، هذا إلى وفرة المصادر التي لا تتردد في أن جعفراً المشار إليه في حياة جابر ونشأته هو جعفر الصادق».
وعلى الرغم من كل هذا فإن الدكتور زكي نجيب محمود يحاول أن يخلق أستاذاً آخر لجابر بن حيان، هو الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية، باعتبار أنه أول من حاول دراسة الكيمياء، ثم يحاول أن يؤكد هذا القول بنقل عن أحد الباحثين الغربيين يصرح فيه أن جابراً تلميذ خالد، ويترك ذلك بلا تعليق ليفتح باب الشك على مصراعيه، في حين أن الدكتور زكي قد صرح بكتابه بأن خالداً الأموي قد مات سنة 704 ميلادية وأن جابر بن حيان قد ولد حوالي سنة 705 ميلادية، فكيف تمت هذه التلمذة ولماذا لم يشر إليها جابر ولم يذكرها في مؤلفاته.
وإذا كان أسلوب الشك لدى المتأخرين قد حمل هذا الطابع، فإن القدماء قد حاولوا أثارة الشكوك بأسلوب آخر، هو أن تلك المؤلفات المنسوبة إلى جابر قد كتبها ونحلها له، وقد ذكر ابن النديم هذا الشك في فهرسته وأجاب عليه بقوله: «أن رجلاً فاضلاً يجلس ويتعب، فيصنف كتاباً يتعب قريحته وفكره بإخراجه، ويتعب يده وجسمه بنسخه، ثم ينحله لغيره، أما موجوداً أو معدوماً ـ ضرب من الجهل، وأن ذلك لا يدخل تحته من تحلى ساعة واحدة بالعلم، وأي فائدة في هذا وأي عائد».
وللاطلاع على مدى الكفاءة العلمية لجابر، ثم الاطلاع على مدى معرفة الإمام بهذا العلم، ننقل مقتطفات مما كتبه الدكتور محمد محمد فياض في كتابه «جابر بن حيان وخلفاؤه» ص151 إذ يقول:
«كان جابر خبيراً بالعمليات الكيميائية الشائعة كالإذابة والتقطير والتكليس والاختزال وغير ذلك، وكثيراً ما كان يصفها ويبين الغرض منها والتغيرات التي تحدث فيها، ويشرح أفضل الطرق لإجرائها وفقاً لنتائج تجاربه».
ويقول أيضاً:
«وتمكن جابر من تحضير طائفة كبيرة من المواد الكيميائية، واتبع في ذلك عمليات سهلة وشرحها في كتبه بطريقة مبسطة خالية من التعقيد والغموض، بحيث يتيسر لمن يقرؤها أن يتتبعها ويجربها بنفسه إذا أراد».
ثم يضيف الدكتور فياض:
«ولجابر بحوث أخرى في الكيمياء يعجز عنها الحصر، نذكر فيما يأتي طائفة قليلة منها للتدليل على مبلغ جهوده في هذا العلم:
1 ـ كشفه أن مركبات النحاس تكسب اللهب لوناً أزرق.
2 ـ استنباطه طرقاً صالحة لتحضير الفولاذ وتنقية المعادن وصبغ الجلود والشعر.
3 ـ توصله إلى تحضير مداد مضيء من المرقشيشا الذهبية.
4 ـ تحضيره نوعاً من الطلاء الذي يقي الثياب البلل ويمنع الحديد الصدأ.
5 ـ توصله إلى معرفة أن الشب يساعد على تثبيت الألوان في الصباغة.
6 ـ بحثه في المواد المعدنية والنباتية والحيوانية الشائعة ومعرفته لفوائدها في مداواة الأمراض.
7 ـ تمكنه من صنع ورق غير قابل للاحتراق، دعاه إلى ذلك أن الإمام جعفر الصادق وضع كتاباً في الحكمة وكان عزيزاً لديه وأراد أن ينسخه في ورق لا يتأثر بالنار وطلب من جابر أن يحاول تدبير هذا الأمر فنجح فيه».
ويقول الدكتور محمد يحيى الهاشمي في كتابه «الإمام الصادق ملهم الكيمياء» ص166 في أثناء حديث له ما نصه:
«إن شخصية جعفر الصادق لا تزال غامضة تحتاج إلى من يكشف كنهها من المؤرخين، لا لأهميتها في تاريخ الفكر الإسلامي وتاريخ تطور الفكر البشري فحسب، بل لأن تاريخ العلوم يتطلب من يجلو كنهها، لوجودها على مفترق الطرق، لمعاصرتها لعبقريات فذة أوجدت كل منها مدرسة خاصة في الإسلام.. عدا عن مناهج العلوم الكونية المستمدة في توجيهها من الروح الإسلامية والفلسفة اليونانية، وما دام يكتنف مثل هذه الشخصية الفذة، الظلام، فكثير من الحقائق ستظل في طي الخفاء، وستظل في جهل مدقع في فهم كثير من قيمة تراثنا الفكري، لأن التعصب الذميم هو الذي طمس المعالم ووضع أمامنا سداً حائلاً دون تفهم كنه الأساسات العميقة في بناء الحضارة العالمي».
مدرسة الصادق (ع)
إن مدرسة الصادق (ع) كانت امتداداً لمدرسة أبيه وجده.
وهذه المدرسة كانت من الأحداث الخطيرة فهي لم تكن بأي حال من الأحوال مدرسة خاصة يلقى فيها لون خاص من المعارف والعلوم، وإنما كانت تبني عقولاً وتنشىء أجيالاً، وتؤسس صروحاً من الثقافة ودنيا من التوجيه، وتضع دستوراً شاملاً لإصلاح الحياة وتطويرها وتقدمها في جميع الميادين.
ونقدم إلى القراء عرضاً موجزاً لبعض شؤون تلك المدرسة التي عملت على نمو الحركة الفكرية.
1 ـ سبب إنشائها:
أطل الإمام الصادق، على العالم الإسلامي وهو يموج بالاضطراب والفتن والنزاعات الخاصة التي لا يلمس فيها أي أثر محمود، فقد تحلل المجتمع وتفككت الروابط فيه إلى أبعد الحدود، ويعود السبب في ذلك إلى أن نار الحرب قد اشتعلت في معظم حواضره ونواحيه، وذلك لانهيار الإمبراطورية الأموية التي كانت أبعد ما تكون عن النظر في أمور الشعب والتحسس بإحساسه، وأشاعت ضروباً من الفساد والتحلل في جميع أنحاء البلاد، وقد قام للقضاء على تلك الدولة طائفة من المصلحين كان هدفهم إعادة الحياة الإسلامية إلى مجراها الصحيح وكانت هتافات الثوار هو الرضا من آل محمد. ولكن الثورة اغتصبها العباسيون فرأى الإمام الصادق أن لا وسيلة له لاستردادها فاعرض وطوى عنها كشحاً وأقبل على تأسيس مدرسته، وقد اغتنم الإمام تلك الفرصة التي تطلب فيها الكل رضاءه وتركه المسؤولون ينشر أهدافه وتوجيهاته لانشغالهم بتركيز أسس دولتهم وكيانهم.
لقد وجد الإمام الصادق (ع) في تلك الفترة المجال واسعاً لأداء رسالته والقيام بواجبه من نشر الثقافة الإسلامية، وإفهام المجتمع نظم الإسلام الصحيحة.
2 ـ مركزها:
واختار الإمام يثرب دار الهجرة ومهبط الوحي فجعل فيها معهده الكبير ومدرسته العظمى، أما محل التدريس وإلقاء المحاضرات فكان هو الجامع النبوي ففيه كانت تزدحم حملة الحديث ورواد العلم لاستماع دروس الإمام وتسجيل أبحاثه وربما كان في بعض الأحيان يلقي محاضراته في بهو بيته، وقد ازدهرت يثرب بهذه الحوزة العلمية واستعادت نشاطها في توجيه الركب الإسلامي نحو الخير والسعادة.
3 ـ عدد طلابها:
ولما فتح الإمام مدرسته لجميع المسلمين التحق به جمع غفير من رواد العلوم على اختلاف نزعاتهم وميولهم، فكان عددهم من أضخم ما ضمته المدارس العلمية في ذلك العهد. قد ذكر الرواة أنهم كانوا أربعة آلاف شخص، وفيهم من كبار العلماء والمحدثين الذين أصبحوا أئمة ورؤساء لبعض المذاهب الإسلامية.
4 ـ البعثات العلمية:
وأسرع إلى الانتماء لمدرسة الصادق جميع عشاق الفضيلة والعلم من شتى الأقطار الإسلامية، عرباً وغير عرب ويحدثنا الأستاذ عبدالعزيز سيد الأهل عن مدى ذلك النشاط في الالتحاق بمدرسة الإمام بقوله:
«وأرسلت الكوفة، والبصرة، وواسط، والحجاز إلى جعفر بن محمد أفلاذ أكبادها من كل قبيلة من بني أسد ومن غني، ومخارق، وطي، وسليم، وغطفان، وغفار، والأزد، وبني ضبة، ومن قريش، ولا سيما بني الحارث بن عبدالمطلب، وبني الحسن بن علي».
5 ـ تدوين العلوم:
وأقبل أصحاب الإمام (ع) على تدوين العلوم التي تلقوها وأخذوها من الإمام فألفوا في جميع الفنون والمعارف فقد ألف أبان بن تغلب (معاني القرآن)، وكتاب (القرآن) وألف المفضل بن عمر كتاب (التوحيد) وألف جابر بن حيان كتاباً في علم الكيمياء.
وهكذا ألف جمع كثير من تلاميذه في مختلف الفنون كزرارة وأبي بصير، ومحمد بن مسلم، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهم من الأعلام حتى بلغ عدد المؤلفات أربعمائة كتاب لأربعمائة مؤلف ودون الشيخ آغا بزرك الطهراني أكثر من مئتي مؤلف في علم الحديث فقط لأصحاب الإمام.
6 ـ علومها وآدابها:
وتناولت محاضرات الصادق ودروسه جميع الفنون العلمية التي لها الأثر التام في التقدم الاجتماعي، ومن أبرز العلوم التي تناولها الإمام بالبسط والتحليل الفقه الإسلامي بجميع أبوابه من العبادات والمعاملات.
ولم يقتصر الإمام في أبحاثه على الناحية العلمية، فقد توسع في محاضراتٍ إلى بيان أصول الآداب والقيم الاجتماعية، من مكارم الأخلاق، والإصلاح الشامل في جميع المجالات.
7 ـ طابعها الخاص:
ومدرسة الصادق لها طابع خاص انفردت به عن بقية المدارس والمؤسسات العلمية فقد كان طابعها هو الاستقلال وعدم خضوعها للدولة فلم يكن لولاة الأمور بأي حال من الأحوال مجال للتدخل فيه فهي منفصلة عن الهيئة الحاكمة لأن الامتزاج بها معناه تدخل السلطة في شؤونها، وهذا ما عليه جامعة النجف الأشرف حتى اليوم فإنها منذ تأسيسها لم ترتبط بالدولة، وعلى هذا المنهاج تسير جامعة (قم) في إيران.
8 ـ فروعها:
وفتحت في كثير من الأقاليم الإسلامية فروع لمدرسة الصادق أقامها كل من تخرج من تلك المدرسة ورجع إلى بلاده وأعظم الفروع التي أسست هو المعهد الكبير الذي أقيم في «جامع الكوفة» فقد التحق به من كبار تلاميذ الإمام تسعمائة عالم كما حدثنا بذلك الحسن بن علي الوشاء فقد قال: «أدركت في هذا المسجد (يعني مسجد الكوفة) تسعمائة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد».
وبذلك اتسعت الحركة العلمية اتساعاً هائلاً حتى شملت جميع المناطق الإسلامية وقال البحاثة الهندي الشهير السيد أمير علي:
«ولا مشاحة أن انتشار العلم في ذلك الحين قد ساعد على فك الفكر من عقاله، فأصبحت المناقشات الفلسفية عامة في كل حاضرة من حواضر العالم الإسلامي، ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الذي تزعم تلك الحركة هو حفيد علي بن أبي طالب المسمى بالإمام «جعفر»، والملقب «بالصادق» وهو رجل رحب أفق التفكير، بعيد أغوار العقل، ملم كل الإلمام بعلوم عصره، ويعتبر في الواقع أول من أسس المدارس الفلسفية المشهورة في الإسلام، ولم يكن يحضر حلقته العلمية أولئك الذين أصبحوا مؤسسي المذاهب فحسب بل كان يحضرها طلاب الفلسفة والمتفلسفون من الأنحاء القاصية».
9 ـ اعتزاز وافتخار:
لقد اعتز تلاميذ الإمام بالحضور في مدرسته، وافتخروا بذلك كثيراً فقد أهلتهم تلك الدراسة إلى المراكز العليا في الإسلام فهذا الإمام أبو حنيفة قد أعلن فخره واعتزازه بذلك بقوله المشهور (لولا السنتان لهلك النعمان) لقد فخر أبو حنيفة بالسنتين التين حضرهما عند الإمام وجعلهما من أفضل أدوار حياته العلمية التي سببت شهرته.
10 ـ أسباب نجاح هذه المدرسة:
وترجع الأسباب التي أدت إلى امتداد ظلال هذه المدرسة في العالم الإسلامي ونفوذها بين طبقات المسلمين إلى أمور ثلاثة:
1 ـ شخصية الصادق.
2 ـ المحتوى الفكري للمدرسة.
3 ـ جذور المدرسة الفكرية.
وهذه الجهات الثلاث هي كل ما يعني الباحث في البحث عن المدارس الفكرية.
وقد قدر لهذه المدرسة أن تضم إلى أصالة الفكر شخصية الصادق الفذة.
وأتيح لها أن تجمع بين هذه الجوانب الثلاثة، على ندرة ما يتفق ذلك لمذهب من المذاهب.
ولا أجدني بحاجة إلى أن أشير إلى تأثير شخصية الداعية في نجاح الدعوة وتوسعها. كما لا أجدني بحاجة إلى أن ألمح إلى شخصية الصادق الفذة بين معاصريه. فقد كان العلماء يقبلون على مجلسه من أقطار بعيدة ويتلقون عنه الفقه والحديث والتفسير ويلقون عليه ما يصعب عليهم من مسائل الفقه والتفسير، ثم يخرجون ليشيعوا ذلك عنه بين الناس، حتى كثر الحديث عنه.
أما فيما يختص المحتوى الفكري للمدرسة الجعفرية، فإن المحتوى الفكري لهذه المدرسة يمتاز بالتماسك الفكري الوثيق والترابط فيما بين أفكارها واتجاهاتها.
ومثل هذا التماسك يشد اتجاهات المدرسة بعضها إلى بعض، ويؤدي الالتزام بأي جزء منه إلى الالتزام بالجزء الآخر. فالمدرسة الجعفرية مثلاً فتحت باب الاجتهاد للعلماء. وقد كان لهذا العامل تأثير كبير على نمو المدرسة فيما بعد عصر الصادق، وإقبال الناس عليها لمسايرتها للأوضاع الاجتماعية المتجددة.
فعندما يغلق باب الاجتهاد على مذهب فكري، أياً كان المذهب الفكري فإن ذلك يؤدي إلى جمود المذهب عن التطور والنمو ومسايرة الأحوال والأوضاع المتجددة. ولذلك فإن هذه الميزة في المذهب الجعفري تعتبر ضماناً من الداخل لحياة المذهب وبقائه.
وقد سبقت الشيعة المذاهب الإسلامية الأخرى إلى وضع أصول الاجتهاد والاستنباط في الفقه وتحرير مباحثه، والإمام الباقر هو واضع علم الأصول وفاتح بابه، وأول من صنف فيه هو هشام بن الحكم، صنف كتاب الألفاظ ومباحثها، وهو أهم مباحث علم الأصول، ثم من بعده يونس بن عبدالرحمن، مولى آل يقطين، صنف كتاب اختلاف الحديث ومسائلة، وهو مبحث تعارض الحديثين، ومسائل التعادل والتراجيح، ثم أخذت حركة التأليف في الأصول من بعدهما بالتوسعة واشتهر منهم أئمة أعلام منهم أبو سهل النوبختي والحسن بن موسى النوبختي.
يقول العالم المصري أبو زهرة:
«تنمو المذاهب بثلاثة عوامل: أولها أن يكون باب الاجتهاد مفتوحاً، فإن ذلك يفتح باب الدراسة لكل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وعلاجها من الشريعة بما يناسبها من غير تجاوز لحدود النصوص وخروج عن المأثور.
وأننا نعتقد أن المذهب الجعفري من الناحية الفقهية قد فتح فيه هذا الباب للدراسة وهو بهذا صالح للنمو المستمر الذي لا يتخلف ما دام المجتهدون فيه ملتزمين الجادة والطريق المستقيم».
وعراقة المذهب هي الأخرى من أهم الأسباب التي أدت إلى نمو المدرسة وتوسعها فيما بعد عصر الصادق.
فليس الصادق هو الذي أنشأ هذه المدرسة وغرس فيها بذرتها الأولى، وإنما تلقاها من آبائه، ليتعهدها برعايته.
منهج الصادق
إن شخصية جعفر الصادق برزت بشكل جلي في مجالين:
أولهما: هذه القيادة الفكرية التي نصبته علماً للفكر والعلم فباشرها على نطاق واسع مكشوف مبيناً الحقائق العلمية الإسلامية والاصطلاحات الشرعية والمفاهيم والأحكام الدينية، وهو بهذا يجدد ويبعث الشريعة بعد فترة من الركود الفكري تحمل وزرها الأكبر الحكام والأمراء والملوك. وقد خرج الإمام من معركة الاصطلاحات والمفاهيم بنصر وظفر حيث هيأ للمسلمين الاطلاع على الحقائق التشريعية.
ثانيهما: اعتزاله النشاط السياسي العلني للمستلزمات الظرفية التي عاصرت عهده، في الوقت الذي لم ينفك فيه عن تعضيد الحركات السياسية التي قادها الثوار العلويون محاولة منه لإسماع الأمة صوته وإظهار سخطه على الحكام ثم كشف حقيقتهم وانحرافهم عن القواعد الإسلامية في الحكم والسياسة والتشريع.
لقد استفاد الصادق من ضعف القوى السياسية التي كانت من قبل تضيق عليه وعلى الأئمة من آبائه؛ بالنظر لأن عصره شهد ضعف وانهيار الكيان السياسي الأموي، ثم نشاط الحزب العباسي وتأسيس الدولة العباسية وسط خضم من المنازعات والفتن؛ فانشغل الحكام بأمورهم هذه عنه، مما مكنه من فتح أبوابه لطلاب العلم والحقيقة وجعله على اتصال مباشر مع الأمة يشحنها بمقومات الفكر والإصلاح والهداية.
نشأ الصادق (ع) في عهد دولة بني أمية ذلك العهد الذي فاضت جوانبه في مطاردة الأحرار؛ لا سيما شيعة علي بن أبي طالب واضطهاد آل الرسول، والاستهتار بكل القيم الإنسانية حتى جاء عهد عمر بن عبدالعزيز الملك الإنساني الذي رفع الظلم عن الشعب؛ ولكن عهده لم يطل فعادت الأمور إلى السيء والأسوأ، فكثرت الفوضى وتقلص الأمن وانتشر الخوف عندما ولي الحكم يزيد بن عبدالملك وهشام والوليد بن يزيد، ويزيد بن الوليد الذي انمحى في خلافته ظل بني أمية، حيث وقع الصراع بين الأمويين والعباسيين على طلب الخلافة.
وهنا قد لازم الصادق (ع) الصمت وعدم الانحياز إلى إحدى الفئتين غير أنه دعا الناس إلى طلب العلم والمعرفة.
وفي هذه الفترة كثر الطامعون في استعباد الأمة فخضع الضعيف ملبياً أصوات الجبابرة الطامعين وانقسم ذوو الأطماع والغايات من داع إلى حكم الأمويين ومن داع إلى بني العباس حنقاً على بني أمية لأنهم ضلوا سواء السبيل.
في تلك الساعة طولب الإمام الصادق أن يبايع إلى بعض أبناء عمه فأبى فاتهم بالحقد والحسد فاعتزل واتخذ مسجد النبي في المدينة مدرسة له ينشر منها العلم إلى جميع الآفاق.
وأعلنت الثورة العباسية وكان شعارها الإصلاح، فسالت الدماء وطاحت الرؤوس والصادق لم يتحول عن رأيه غير أنه تحول إلى جامع أبيه في الكوفة حيث وجد مجموعة خيرة من المتعلمين، فاندفع إلى نشر المعارف والعلوم فوزع طلابه، بعد أن درس نفسياتهم واتجاهاتهم وقابلياتهم، فصرف قوماً إلى الفلسفة وآخرين إلى المناظرة والمحاججة وقوماً إلى الفقه وآخرين إلى الكيمياء وهذا إلى الطب وذاك إلى رغبته من طلب العلم وإلى ما يهوى.
فقد ارتأى الصادق أن السلاح في ذلك الوقت لا يحل مشكلة اجتماعية ولا يرفع ظلامة مظلوم ولا يتقلص ظل الزمرة الحاكمة الجائرة بالسيف.
فقد كان يرى أن لا ثورة مع الجهل ولا خنوع مع العلم أنه يرتأي أن تتثقف الأمة فتطالب بحقوقها حيث لا يقضي على المتنفذين الظالمين إلا العلم، لذا وجه الناس توجيهاً علمياً.
بهذا أراد الصادق (ع) محاربة طغيان بني أمية وبني العباس حتى كان بين يديه أربعة آلاف طالب كل يقول درست على جعفر بن محمد الصادق.
وبهؤلاء عزم الصادق على أن يقضي على المتزعمين المخربين ويدك عهدهم ويقوض سلطانهم ليعيد الحق إلى نصابه والإنسان إلى حقوقه يتمتع بها كيف شاء وإني شاء.
لقد كانت الفترة التي عاشها الصادق فترة مضطربة تتميز بالغليان من ناحية سياسية واجتماعية. فإلى جنب الحركات السياسية المتضاربة المذاهب العقائدية المختلفة التي تولدت داخل الأمة من أثر الواقع الذي تعيشه آنذاك والذي كانت السلطة في انحرافها وفي ما تبنته من سياسة التجهيل مع الأمة سبباً مباشراً فيه.
فقد كثرت النظريات الفاسدة المنحرفة واندس بين المسلمين أناس كل هدفهم أن يفسدوا على المسلمين عقيدتهم وتكاثر الوضاعون من جهة والغلاة والملحدون من جهة أخرى وساهموا جميعاً في إبعاد الأمة عن الواقع الإسلامي وكادت العقيدة الإسلامية والتشريع الإسلامي أن يضيعا وسط هذه التيارات المتباينة هذا إلى جنب انحراف السلطة وطغيانها وبعدها عن الإسلام.
وقد كان على الإمام الصادق أن يواجه كل ذلك، أن يواجه أسباب الانحراف العقائدي والتشريعي، وأن يواجه أيضاً الفساد في شؤون الدولة والحكم، فماذا فعل الصادق (ع)؟
وكيف نهض بهذه المسؤولية الضخمة؟
لا شك أن امتلاك الأداة السياسية أمر مهم، وإزالة هذه الأجهزة الفاسدة المنحرفة أمر يسهل إنجاز الأهداف الإصلاحية التي يرمي إليها في جميع المجالات، ويضع حداً لكل أنواع الفساد التي ابتليت بها الأمة باعتبار أن فساد السلطة وابتعادها عن الإسلام سبب مهم في وجودها واستمرارها بشكل مباشر أو غير مباشرة.
فهل خاض الصادق المعركة السياسية في هذا السبيل؟
وهل استثمر ذلك الظرف في تحقيق هذه الغاية؟
لا لم يفعل ذلك.
فقد ذكر المؤرخون أنه رفض كل العروض التي جاءته من بعض الزعماء السياسيين رفضاً باتاً وشديداً فقد جاء رسول أبي سلمة الخلال يحمل منه كتاباً يذكر فيه الصادق استعداده للدعوة إليه، وتخليه عن بني العباس.
فقال الصادق: مالي ولأبي سلمة وهو شيعة لغيري. فقال الرجل: اقرأ الكتاب فقال (ع) ادن السراج مني فادناه. فوضع الكتاب على النار حتى احترق. فقال الرسول: إلا تجيبه قال: قد رأيت الجواب عرّف صاحبك بما رأيت ـ كما مر ـ.
ولم يستطع أصحابه أن يحولوا رأيه إلى دخول المعركة برغم رغبتهم وإلحاحهم فقد كانت الوضعية التي عليها الأمة من الانقسام السياسي المذهبي والاضطراب الفكري الذي يشملها بصورة عامة، تجعل الصادق يجزم مقدماً بأن الدخول في معركة كهذه لا يعدو أن يكون مغامرة مؤكدة الفشل وبالتالي فإنه يعرض نفسه ومن ثم البقية الباقية من المؤمنين والفكرة الإسلامية الصحيحة التي يمثلها إلى خطر لا حد له ولهذا أبى أن يخوض المعركة بنفسه.
لقد كان الأسلوب والطريقة التي سلكها الصادق من أدق وأحكم الطرائق الإصلاحية، فالصادق ليس من بغاة المغامرة والظهور وإنما هو مسؤول يحاول أن يقوم بالمسؤولية ومصلح يريد أن يصل إلى الإصلاح، ولهذا رأى ـ على ضوء الواقع الذي تحياه الأمة ـ أن يصرف جهده، بالدرجة الأولى في عملية إيجابية هامة. رأى أن ينصرف ليقيم الكيان الفكري للإسلام، وليوضح أسس العقيدة الإسلامية، وأصول التشريع الإسلامي.
لقد بلغ تلامذة الصادق أربعة آلاف بينهم أئمة المذاهب الإسلامية كمالك وسفيان الثوري وأبي حنيفةـ كما رأينا ـ.
إن الصادق وهو يبني بأحاديثه الشريعة الإسلامية في واقعها النقي الأصيل ويدلل على شمولها واستيعابها ويحملها عدداً وفيراً من العلماء لم يكتف بذلك بل حرص أيضاً على أن يجعل من شيعته في أقوالهم وأعمالهم وتفكيرهم تجسيداً للفكرة الإسلامية.
قال يخاطبهم: كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. (أي بأفعالكم).
وقال: أوصيكم بتقوى الله، واجتناب معاصيه وأداء الأمانة لمن أئتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين). فقالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا يطلع الناس منكم إلا على خير. فإذا رأوا ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا إلينا.
ومن أعظم تعاليمه تحديده للتعصب فقد قال: ليس من العصبية أن تحب أخاك ولكن العصبية أن ترى شرار قومك خيراً من خيار غيرهم.
لقد وقف الصادق موقفاً شديداً وصارماً وباشر بنفسه المعركة الفكرية وعبأ تلامذته وشيعته في هذا المجال، لقد حارب الخطابية وغيرهم من فرق الغلاة حرباً لا هوادة فيها وتبرأ منهم ومن أتباعهم الغلاة.
وقد بدأت في عصره تطغى الروح الانهزامية في المجتمع بدعوى الزهد والإيغال في التصوف والاستغراق فيه استغراقاً يخرجه عن حقيقته الخيرة. لذلك كان الصادق يحث على الجدية في الحياة، والكفاح من أجل العيش الكريم. فكان من أقواله: «أن الله يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس، فإن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثرها عليه» فقيل له كيف ذلك؟. قال: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته.
وكان يقول لأصحابه: كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا ليقول الناس: رحم الله جعفر بن محمد لنعم ما آدب أصحابه.
قال المفضل بن يزيد: قال لي الصادق وذكر أصحاب أبي الخطاب والغلاة: (يا مفضل لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا توارثوهم).
كذلك حارب الملحدين أمثال أبي العوجاء وابن طالوت وغيرهم وله معهم محاورات كثيرة أحرجهم بها. وقد كان هؤلاء يحترمون جانب الصادق ويقدرون سعة علمه وسمو شخصيته قال: ابن المقفع لابن أبي العوجاء وكانا معاً في المسجد الحرام ينظران الناس: (لا واحد من هؤلاء يستحق اسم الإنسانية إلا هذا الشيخ الجالس) (مشيراً إلى جعفر الصادق).
أما مقاومة الصادق للسلطة الحاكمة التي انحرفت عن الإسلام في سلوكها الشخصي وفي معاملتها للأمة، حيث تلاعبت بمقدراتها، وساستها بالجور والطغيان فهي مقاومة تتجلى في مقاطعته لها، وعدم تعاونه معها، ولكن هناك مقاومة كان يقوم بها الصادق بشكل غير مباشر وغير ظاهر، وذلك مثل عمله على بث الوعي الإسلامي في الأمة ونشر المفاهيم الإسلامية وإيحائه للأمة بمظلوميته، وبعدم شرعية الحكومة القائمة في كلمات كثيرة متناثرة.
وعدا ذلك فقد عمل على أن يربي جيلاً صالحاً أعده لتولي وظائف الدولة بحيث يكون منه وسيلة للتخفيف من ويلات الحكام على الشعب ودفع الظلم عن المظلومين. وخير مثل على ذلك عبدالله النجاشي المعروف بأبي بجير الأسدي الذي كان من قبل أخلص المخلصين للصادق وأصبح والياً على الأهواز من قبل المنصور. «ولما تسلم عمله أرسل إلى الصادق يطلب إليه فيها أن يضع له منهجاً يسير عليه في ولايته. فكان مما أجابه به الصادق: «أن خلاصك ونجاتك في حقن الدماء وكف الأذى والرفق بالرعية والتأني وحسن المعاشرة واتباع الحق والعدل. إياك والسعاة وأهل النمائم فلا يلتزمن بك منهم أحد ولا تقبل منهم قولاً. واعن الفقراء» إلى غير ذلك مما وضع له من التعاليم التي يسير عليها. والتي طبقها عبدالله. وقد كان الصادق يكتب إليه في شأن بعض الأشخاص المظلومين فيرفع ظلامتهم في الحال.
هذا، ومرد سلامة جعفر الصادق فيما نرى إلى منهجه البعيد عن العنف في معارضة بني العباس ـ كما رأينا ـ وإلى أخذ نفسه بالقصد والاحتياط التام يدل على ذلك رده للأموال ورفضه للرسائل التي أمر المنصور بكتابتها إليه وإلى غيره من العلويين على لسان أنصارهم وأوليائهم لتكون حجة له عليهم فالصادق من هذه الناحية منقطع النظير بين العلويين وقد يتوهم متوهم أن منهجه والحالة هذه كان منهجاً سلبياً بالنسبة إلى منهج بني عمه الحسن، والواقع غير ذلك، ومن يستبطن أسرار التاريخ ويقف على روح ذلك العصر يتضح له أن الصادق كان من رأيه عقم تلك الثورة على الدولة العباسية في مرحلة شبابها وعنفوان قوتها وغلبتها، هذا مضافاً إلى ضعف العلويين وأن ثورتهم كانت ثورة محلية في الحجاز وفي البصرة بعد ذلك وإن أيدها أهل العلم والفتوى في العراق والحجاز.
هذا وبالإضافة إلى ما تقدم من توضيح موقف الصادق وشرح منهجه وأنه لم يكن منهجاً سلبياً انقطاع الصادق لبث العلم والأثر النبوي وتأسيس مدرسة أهل البيت في هذا الشأن.
هذا ويميل بعضهم إلى تعليل تلك البادرة، بادرة المحاسنة من قبل المنصور للصادق وقلة اكتراثه بتلك السعايات بعلل لا يخلو بعضها من المبالغة، وقد يستند بعض الرواة في ذلك إلى روايات ضعيفة لا يصبر أكثرها على النقد والتمحيص.
كان الخطر محدقاً بالصادق في عهد العباسيين ما في ذلك شك، ولكنه على كل حال سلم، وكانت سلامته وسلامة كثير من أهل بيته وأصحابه أعجوبة في الواقع على أنه لم يسلم إلا بشق النفس وتوطينها على كثير من التحرز والتوقي، يدل على ذلك حديثه المشهور بل كلمته البليغة الحكيمة التي قال فيها (عزّت السلامة حتى لقد خفي مطلبها فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول، فإن طلبت في الخمول فلم توجد فيوشك أن تكون في الصمت، والسعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها).
ولما مات جعفر الصادق رثاه المنصور قائلاً لبعض أهله وقد دخل عليه: أما علمت بما نزل بأهلك؟ فقلت وماذا؟ قال: أن سيدهم وعالمهم وبقية الأخيار منهم توفاه الله، فقلت: ومن هو؟ قال: جعفر بن محمد.
من أهم إنجازات الصادق
من أهم الإنجازات التي حققها جعفر الصادق هو أنه وضع أساس التأليف في الإسلام فانطلق الناس بعده يؤلفون ويدونون تبعاً لتعليماته، ولم يكن تأليف الكتب معروفاً قبل الصادق، بل كان نادر الوقوع، فإذا بالصادق ينهض بهذا العبء ويحرض على التدوين والتأليف. ويكون هو البادىء بذلك، ثم يتداعى طلابه إلى التدوين والتأليف حتى يبلغ عدد ما ألفوه أربعمائة كتاب لأربعمائة مؤلف وتبرز دعوته إلى التدوين بمثل قوله لتلاميذه: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا، ومثل قوله للمفضل بن عمر: اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فورث كتبك بنيك.
الصادق والشعر
كان الصادق يقول الشعر أحياناً فمما روي له قوله:
| لا اليسر يطرؤنا يوماً فيبطرنا | ولا لأزمة دهر نظهر الجزعا | |
| أن سرنا الدهر لم نبهج لصحبته | أو ساءنا الدهر لم نظهر له الهلعا | |
| مثل النجوم على مضمار أولنا | إذا تغيب نجم، آخر طلعا |
ويروى له:
| لا تجزعن من المداد فإنه | عطر الرجال وحلية الآداب |
وقد مدح بشعر كثير فمن ذلك ما قاله فيه عبدالله بن المبارك:
| أنت يا جعفر فوق | المدح والمدح عناء | |
| إنما الأشراف أرض | ولهم أنت سماء | |
| جاز حد المدح من قد | ولدته الأنبياء |
ولما توفي وحمل إلى البقيع أنشد أبو هريرة العجلي:
| أقول وقد راحوا به يحملونه | على كاهل من حامليه وعاتق | |
| أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ | ثبيراً هوى من رأس علياء شاهق | |
| غداة حثا الحاثون فوق ضريحه | ترابا وأولى كان فوق المفارق |
وفاته
روى الكليني وغيره بالإسناد عن أبي أيوب الجوزي قال بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب فلما سلمت رمى الكتاب إلي وهو يبكي وقال هذا كتاب محمد بن سليمان «والي المدينة» يخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات، وأين مثل جعفر؟ قال لي: اكتب فكتبت صدر الكتاب ثم قال اكتب أن كان أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه فرجع الجواب إليه أنه أوصى إلى خمسة أحدهم أبو جعفر المنصور ومحمد بن سليمان وعبدالله وموسى ابني جعفر وحميدة فقال المنصور ليس إلى قتل هؤلاء سبيل. مروج الذهب للمسعودي: لعشر سنين خلت من خلافة المنصور توفي أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سنة 148هـ ودفن بالبقيع مع أبيه وجده وله 65 سنة وقيل أنه سُمَّ.
تراث الصادق من الوجهة الفنية
قال الدكتور عبدالكريم الأشتر:
تشغلني بعض مسائل هذا الموضوع منذ زمن طويل، فإني وجدت تاريخ الأدب العربي يكاد يُغفل ـ إذا استثنينا الشعر في جميع العصور ـ صفحات لا تحصى من الأدب الحي الذي كتبه أو أملاه رجال الحكمة والفلسفة والكلام، ورجال التاريخ والسير والتراجم والطبقات والأسمار وغيرها؛ شغلته عنها، فيما يبدو، أنواع الكتابة الأخرى التي كتبت لمقاصد أدبية صرفة، مهما تواضع حظها من جمال التصوير أو التعبير، ومهما تدنت قيمتها الفكرية أو الوجدانية، وعلى ما حفلت به، في العصور المتأخرة، من ضروب التزويق والتنميق، وطغيان النزعة اللفظية وألاعيبها التي شبهها أحد المستشرقين الفرنسيين بألعاب (الأكروبات).
فعلى هذا النحو لصق بأذهاننا أن النثر العربي تقلّبت مذاهبه، وانتهت في العصور المتأخرة إلى ما سماه أحد الباحثين «مذهب التصنيع»، بعيداً عن الكتابات الطلقة التي كانت الحياة، في هذه العصور نفسها، تمليها مثلاً على لسان ابن خلدون، ومحيي الدين بن عربي، وابن جبير، وابن بطوطة وغيرهم.
وعلى هذا النحو أيضاً عُنينا، في تاريخ هذا الأدب، بالشريف الرضي وشعره، ولكنّا لم نُعن بأخيه الشريف المرتضى وأماليه الرائق التي تشفُ عن قدرة بيانية خارقة، يغذوها علم غزير، وذوق يبلغ الغاية في الدقة والرهافة. وعنينا بأبي العميد، والصاحب بن عباد، والقاضي الفاضل، ولم نعن بالمسعودي، والطبري، وابن الجوزي وابن عساكر، فلم ننظر إليهم في تاريخ هذا الأدب إلا من حيث هم أصحاب أخبار تنفع في الدراسات والبحوث.
ثم من هذا الباب، ومن باب التضييق الذي أمليناه على أنفسنا، باسم صراع المذاهب، ونفخ في بوق أصحاب الأغراض، انطمست في تاريخ هذا الأدب صفحات متألقة من كلام رجال آل البيت وأئمتهم، في أماليهم وخطبهم، وأدعيتهم وحكمهم، فلم يكد الفريق الأكبر منا يعرف عنها شيئاً يغني.
ولو أننا كسرنا هذا الخط من تاريخ أدبنا؛ لوجب أن تتغير أو تتعدل كثير من الأحكام فيه، ولاغتنينا بنصوص أدبية عالية القيمة الفكرية والفنية، ولازددنا وعياً بخصائص جنسٍ أو نوع أدبي لم نعن به، فيما أعلم، العناية اللازمة، وهو أدب المناظرات والجدل، الذي تفرقت نصوصه في كتب التراث بمجموعه، في اللغة والأدب، والفقه والقضاء، والتاريخ والفلسفة، وعلم الكلام وغيرها، وألفت فيه كتب أغفلها تاريخ الأدب، مثل (كتاب الإهليلجة) ـ ثمرة شجر في الهند، لعله شجر الأناناس كما نسميه اليوم ـ الذي طال كلام المصادر على نسبته إلى الإمام الصادق، في مناظرة طبيب هندي لا يؤمن إلا بالمعرفة التي تحصّلها الحواس، وينكر أسباب المعرفة الأخرى، ومثل (كتاب الحيدة) الذي كتبه عبدالعزيز الكناني، في مناظرة بشر المرَيسي من المعتزلة، في حضرة المأمون، حول قضية خلْق القرآن.
إننا عنينا كثيراً بأدب الصنعة والمهارات اللفظية، فضاع على الأدب العربي تراثاً ضخماً كتبه أناس امتلؤوا بقوة العقيدة، وحرارة الحياة، وصدق الحافز، واتصف أدبهم بالقرب من الطبيعة، وبروعة الأداء ونفوذ الأثر.
لكل كلام يجمع إلى موضوعه، مهما يكن موضوعه، القدرة على بلاغ الأثر، بما يتوافر في صياغته وأسلوب تناوله، من صفات المهارات الفنية وخصائصها، فهو أدب ذلك لأنه لم يتجه في خطابه، كما يتجه أصحاب العلوم البحتة إلى العقول وحدها، وإنما اتجه إلى قوى النفس بمجموعها، بقصد التأثير فيها، عقلاً وشعوراً وخيالاً وذوقاً للجمال، وهذا كله ينطبق على كثير مما كتب هؤلاء وأمثالهم، من رجال العلم والإدارة والسياسة. وينطبق، على نحو لا يحتمل الخلاف أبداً على كلام الأئمة وغير الأئمة من أعلام مدرسة النبوة، ومنهم الإمام الصادق الذي امتلأت الكتب بأدعيته، وحكمه، ووصاياه ورسائله، وتحليلاته الفكرية الفقهية، والفلسفية، وأدلّته العقلية، وتوافر له، في التعبير عنها، ما يتوافر في كلام أئمة البيت النبوي ورجاله ونسائه، من قدرات فنية تجعل من تراثهم، في الحكمة والدعاء والمناجاة والمناظرة والحوار والخطابة وغيرها، أدباً إنسانياً ساطع الروح، عامراً بالحياة، ملتزماً تطهير النفس الإنسانية من نزعات الجشع والحسد والكِبر، وما تغري به القوة الغاشمة أصحابها من الظلم والقهر وتزوير الحقائق، وإزاحة الإنسان عن فطرته الخيّرة، وتقوية إيمانه بوحدانية الله وعدله، ودعوته إلى احكام الصلة بين قوله وعمله، مما ننصرف، في كلمتنا هذه، إلى بيانه في آداب الإمام الصادق، واستخلاص خصائصه الفنية.
عندما نرجع الآن إلى التراث الذي خلّفه الإمام الصادق، فنرى ما وصل منه موزّعاً في كتب الفقه وأصوله، وكتب التاريخ والأدب والأخبار والأمالي والتراجم وغيرها. فنتمنّى لو أنّ أناساً فكّروا في جمعه وتصنيفه، وأصدروه في مثل هذه المناسبة المباركة، في مجموعة موحدة كاملة، وفي جمع تراث الأئمة الآخرين، وتراث رجال آل البيت، على النسق نفسه.
وفي يدي من هذا التراث الذي ينفعني في هذا الموضوع بعض رسائله التي قالوا: إن تلميذه جابر بن حيَّان كان جمعها في ألف ورقة، وعدّتها خمسمائة رسالة. والكتاب الذي سمّوه توحيد المفضل، مما أملاه على تلميذه المفضّل بن عمر الجُعْفي، ومقاطع من أدعيته، وجمل من حكمه.
فأما كتاباه (مصباح الشريعة) و(كتاب الإهليلجة) ففي نسبتهما إليه كلام يصعب الآن الفصل فيه. وكنت أتمنى أن يشمل كلامي الكتاب الثاني، ليكون مثلاً من أمثلة أدب المناظرات الذي أشرت إليه.
لا مفرّ إذن من أن أكتفي ان بهذا القدر من تراث هذا الإمام العظيم وهو في كل حال، يفي، في هذه الكلمات، بما نقصد إليه من استخلاص أبرز خصائص فكره الأدبي، بما يمكن إجماله فيما يلي:
1 ـ إطالة الفكر في الأشياء ومعانيها مع دقة الملاحظة وغزارتها. وتبدو، أوضح ما تبدو، في حِكَمه وردوده على أصحاب المذاهب المادية من الدُهرية وغيرهم، وإثبات وجود الصانع الواحد، وتفسير أسباب الصنعة على هذا الوجه، والدلالة على إحكامها بما يضمن سلامة العيش وحسن التدبير، على مثاله قوله، في خلقه العينين والحواس في الإنسان، مما رواه عنه المفضل بن عمر: «انظر الآن يا مفضل إلى هذه الحواس التي خُصّ بها الإنسان في خلقه، وشُرف بها على غيره: كيف جُعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة، ليتمكن من مطالعة الأشياء. ولم تُجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين والرجلين، فتعترضها الآفات ويُعيبها من مباشرة العمل والحركة، ما يعلّلها ويؤثر فيها وينقص منها، ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن والظهر، فيعسُر تقلّبها واطّلاعها نحو الأشياء. فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع، كان الرأس أسنى المواضع للحواس، وهو بمنزلة الصومعة (المنارة) لها».
فهذا كلام من أعمل فكره طويلاً في خلق الأشياء، ووصل إلى الحكمة فيه، على الوجه الذي تمّ فيه الخلق. وكتاب التوحيد (أمالي المفضل) يجري كله على هذا النسق من عمق التأمل في الكون وكائناته، واستخلاص حقائق خلقها، في مثل هذا البيان الدقيق الواضح، البعيد عن كل تعمّل، القريب من الطبيعة، الوافي بالقصد من غير تطويل ولا حشو ولا تكرار، والقادر على استيعاب ما تولّده قوة الملاحظة ودقّتها، من تشعّب الفكرة وقوة الإحساس بها.
وفي حكمه الكثيرة التي سماها بعضهم (نثر الدرر) مثل هذا الغوص في حقائق الخلق وأسرار النفوس، لا تكتمل عدّته إلا لمن جمع مع قوة الفطرة طول النظر وحدّة الملاحظة، وتوافرت له ثقافة إنسانية منوّعة وخبرة عميقة بأحوال النفس الإنسانية وحقائقها.
يقول في بعض حِكَمه: «السريرة إذا صلُحت قوِيت العلانية» (الربط بين الظاهر والباطن).
ويقول: «من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة». (الرجوع في فهم النفس إلى قاعدة التكوين الجامع).
ويقول: ليس لإبليس جند أشدُّ من النساء والغضب».
ويقول: «إزالة الجبال أهون من إزالة قلب عن موضعه».
كيف يتيسر، إلا للممتازين الذين أطالوا النظر في الحياة والإنسان الوصول إلى مثل هذه المعرفة بالنفس الإنسانية فيما تظهر وتبطن، وما تعني قوة إحساسها بالحياة ومواقفها، وما يقرّ في أعماقها من ذهول الرؤية في مواجهة الموت؟ وما أعرف قولاً في وصف حدّة الغضب وما يقود إليه من ضلال الرشد، كقول الإمام في جمعه بينه وبين أعتى الغرائز البشرية!
2 ـ تنوّع المعرفة وتماسكها، فيما يتصل بشؤون الدين والدنيا جميعاً، وسعة الاطلاع على الثقافات المختلفة. والذي أعان الإمام على الإلمام بهذه المعارف والثقافات؛ إدراكه الحي بما تولّد المعرفة في النفس من سعادة الإحساس بقوة الحياة وخصوبة معانيها، واختلاف ألوانها وطعومها. يمثل لهذا قوله: «لا ينبغي لمن لم يكن عالماً أن يُعَدّ سعيداً»! وقوله: «الناس اثنان: عالم ومتعلم. وسائر الناس هَمج». ومن هنا تكثر دعواته إلى تنشيط العقل وتصويبه؛ بتطويل التفكير في الأشياء. يقول: «دعامة الإنسان العقل… وبالعقل يكمل، وهو دليله ومبصّره ومفتاح أمره». ويقول: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بُعداً». ويقول: «إياكم والغفْلة. فإنه من غَفَل فإنما يغفُل عن نفسه»!
3 ـ توجهه في أدبه إلى الفرد والجماعة معاً، وتقوية روح الجماعة: «لكل شيء شيئٌ يستريح إليه. وإن المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن، كما يستريح الطير إلى شكله». وتأتي دعوته إلى العمل، وإلى تقوية اللحمة بين القول والعمل، من هذه الطريق.
يقول الإمام: «الإيمان عمل كله». و«لا يثبُت الإيمان إلا بعمل». و«كونوا دعاة الناس بأعمالكم، ولا تكونوا دعاة بألسنتكم». و«إنما تفاضل القوم بالأعمال».
وفي هذه الطريق أيضاً، تقع دعوته إلى اليقظة والحذر ووضع الأشياء في مواضعها، وتحرير الإنسان من عبودية الإنسان: «من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده»! وفي إجابته من سأله عن حد اليقين: «ألا تخاف مع الله شيئاً». و«كل رياء شرك. إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله». وفي توصيته بالمساكين والضعفاء: «إن عيسى بن مريم (ع) لما أراد وداع أصحابه جمعهم وأمرهم بضعفاء الخلق، ونهاهم عن الجبابرة».
4 ـ قوة الصياغة، وإيجازها بما لا يخلّ بالقصد ويفي بالمعنى، مع حرارة الروح، وسطوع الاستجابة النفسية لدواعي الحياة، والقرب فيها من الطبيعة الجارية، وبناء الصورة، إذا احتاجها في تشخيص معانيه وتقوية أثرها في النفس، من معطيات الحواس، لتكون أنفذ وأوضح. وهذه صفات أدبه كله. بل لعلها صفات أدب المدرسة التي ينتمي إليها، مدرسة آل البيت، ابتداءً من أدب أمير المؤمنين ربيب رسول الله، وانتهاء بأدب الأئمة، ورجال آل البيت جميعاً. ينطبق ذلك على الفكر الأدبي، وينطبق أيضاً، بمقدار ما يستدعي القصد، ويستلزم التعبير من الدقة والوضوح والاتزان، على الفكر العلمي، في الفقه والسياسة والاجتماع والتفسير.
وإنما يجتمع ذلك من امتلاء النفس بالفكرة، وحرارة الإحساس بها، وبما تستلزم العقيدة، في بيان مقاصدها، من قوة التركيز، ونفي الفضول اللفظي، وما يدعو تقريبها إلى الناس، من شخوص الصورة ووضوح التمثيل.
ومن كلام الإمام الصادق أقوال عن البلاغة وصفاتها تقرّب ما انتهينا إليه. يقول: «ثلاثة فيهن البلاغة: التقرب من معنى البغية، والتبعد من حشو الكلام، والدلالة بالقليل على الكثير». ويقول: «من عرف شيئاً قلّ كلامه فيه» يريد: أن من يعرف الشيء يصل إليه في أقلّ الكلام. ويقول: «وإنما سمي البليغ بليغاً لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه». ويقول: «ليست البلاغة بحدّة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى وقصد الحجة».
فمن هنا نصل إلى فهم خصائص ما نقلنا وما ننقل في هذا الحديث، من أقواله وحكمه التي تتحقق فيها صفات البلاغة التي نص عليها. يقول مثلاً: «كثرة النظر في الحكمة تلقّح العقل». فقد جمع ما يتمثل في النفس من صدر اللقاح ومعانيه وأثره في تنشيط حركة الحياة وتوليد المعاني وإخصابها، في لفظ واحد موحٍ بهذه الدلالات كلها. ويقول: «من تعلّق قلبه بحب الدنيا، تعلّق من ضُرّها بثلاث خصال: همّ لا يُفنى وأمل لا يُدرك، ورجاء لا يُنال»، جمع حب الدنيا وأذاها معاً في لفظ واحد كرّره «التعلّق» كأنهما وجهان لحقيقة واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى. ووسع في ألفاظ قليلة مقسَّمة، معاني الخيبة كلّها. ويقول أيضاً في مثل هذا المعنى: «ما فتح الله على عبدٍ باباً من الدنيا إلا فتح عليه من الحرص مثليه». فكم يحتاج مثل هذا الكلام، في كثافة دلالاته ومعانيه، وما توحي الصورة فيه، وبيان ما طبعت عليه النفس البشرية من حب التملك، من الشرح والتفصيل؟ ويقول: «ما الدنيا؟ وما فيها؟ هل هي إلا سَدَّة فورة (يريد: سكتة الجوع)، وستر عورة»؟ فقد لجأ في تشخيص المعنى وتكثيفه إلى صورتين حسيتين، وجمع حياة الإنسان المادية كلها في أربع كلمات!
ننتهي أخيراً إلى أدب الدعاء، فهو أكثر صفحات تراثه حرارة، وأدلُّها على سعة الروح، وخصوبة النفس، وغنى اللغة وطواعيتها، والدعاء يقتضي ما لا تقتضي الحكمة من الإيجاز، إذ تسيل النفس فيه برجائها وخوفها وظمئها إلى السكينة، وتطلعها إلى الخلاص، مما لا تستريح فيه القلوب المتعبة؛ إلا باستخراج مكنونها ونثره أمام الله. فمما يلفت الناظر في أدب الإمام؛ أنه يجمع بين ما تقتضيه الحكمة والموعظة والخطاب الفقهي والأدبي، من كلف بالإيجاز، وبين ما يقتضيه الدعاء من الإفاضة والتلوين والإلحاح من الرجاء والبث، وأن يبلغ من القدرة من الحالين ما يصعب الوصول إليه؛ إلا على من يملك من رحابة الفكر والخبرة بأسرار البيان، وغنى اللغة ومرونة استجاباتها لحاجات التعبير، ما كان يملكه الإمام. ولنقرأ الآن أسطراً من دعاء دعا به في آخر شهر رمضان: «إلهي! فإني أعترف لك بذنوبي، وأذكر لك حاجتي، وأشكو إليك مسكنتي وفاقتي وقسوة قلبي، ومَيْلَ نفسي، فإنك قلت: ﴿فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾. وها آنذا قد استجرت بك، وقعدت بين يديك مسكيناً متضرعاً، راجياً لما أريد من الثواب بصيامي وصلاتي. وقد عرفت حاجتي ومسكنتي إلى رحمتك، والثبات على هداك» وقد هربت إليك هرب العبد السوء إلى المولى الكريم»… «أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك عندي تبعة أو ذنب تعذبي عليه يوم ألقاك…».
فهذا الدعاء يمثل لخصائص أدب الدعاء في تراثه كله، وهي الخصائص التي ذكرتها منذ قليل. وفيه نلمس عمق الإحساس بمكان الله من القلب، وحرارة النفس في توجهها إليه. وقد يعجب قارىء هذا الأدب أن تلوّن المعاني والإحساسات، في مواقف الدعاء المتشابهة، هذا التلوين.
لا يزيد ما قلته في هذه الكلمة، عن أن يكون نظرة طائرة في تراث الإمام الصادق، قصدت منها أن ألفت النظر إلى درسه من الجانب الفني، ففيه من الغنى والرحابة والعمق والجمال والصدق والاستجابة للطبع والبعد عن اللفظية ما تصغر إلى جانبه آلاف الصفحات التي ننكب على درسها، من أدب الصنعة في عصور الهُزل الفكري والروحي، التي ما نزال نعاني من بعض رواسبها إلى اليوم.
موسى الكاظم (ع)
ولد بالأبواء موضع بين مكة والمدينة يوم الأحد سابع صفر سنة 128 وقيل 129هـ.
مات ببغداد شهيداً بالسم في حبس الرشيد على يد السندي بن شاهك يوم الجمعة لست أو لخمس بقين من رجب. وقيل: لست أو لخمس خلون من سنة 183 على المشهور. وقيل: 181 وقيل 186 وقيل 188هـ وعمره 55 سنة أو 54 على المشهور. وقيل: 57 وقيل 60. أقام منها مع أبيه 20 سنة أو 19 سنة وبعد أبيه 35 سنة، وهي بقية ملك المنصور، وملك ابنه محمد المهدي عشر سنين وشهراً وأياماً، وملك موسى الهادي بن محمد بن المهدي سنة و15 يوماً، ثم ملك هارون الرشيد بن محمد المهدي. وتوفي بعد مضي 15 سنة من ملك هارون.
ودفن ببغداد في الجانب الغربي في المقبرة المعروفة بمقابر قريش. وكان هارون الرشيد ذهب إلى الحج، ووصل أولاً المدينة، وهناك أمر بالقبض على الكاظم وأرسله إلى عيسى بن جعفر بن المنصور وكان والياً على البصرة؛ فسلم إليه فحبسه عنده سنة. وكتب إليه الرشيد أن يقتله. فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته وثقاته، واستشارهم فيما كتب إليه الرشيد فأشار عليه خاصته بالتوقف عن ذلك، والاستعفاء منه، فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول له: لقد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي، وقد اختبرت حاله، ووضعت عليه العيون طول هذه المدة؛ فما وجدته يفتر عن العبادة، ووضعت من يسمع منه ما يقوله في دعائه؛ فما دعى عليك ولا علي ولا ذكرنا بسوء، وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة؛ فإن أنت أنفذت إلي من يتسلمه مني وإلاّ خليت سبيله فإني متحرج من حبسه، فوجه الرشيد من تسلمه من عيسى بن جعفر المنصور وصير به إلى بغداد، فسلم إلى الفضل بن الربيع، فبقي عنده مدة طويلة.
وأراد الرشيد الفضل بن الربيع على قتله، فأبى. فكتب إليه بتسليمه إلى الفضل بن يحيى البرمكي، فتسلمه منه. وجعله في بعض حجر دوره، ووضع عليه الرصد؛ ولكنه وسع عليه وأكرمه فاتصل ذلك بالرشيد وهو في الرقة؛ فكتب إليه ينكر عليه توسعته على الكاظم، ويأمر بقتله فتوقف عن ذلك ولم يقدم عليه، فاغتاظ الرشيد لذلك ثم توسط بالأمر يحيى بن خالد البرمكي والد الفضل وأرضى الرشيد، وذهب بنفسه إلى بغداد، ودعا السندي بن شاهك، وفاوضه في القضاء على الكاظم، فدس إليه السندي السم، فلبث ثلاثة أيام موعوكاً ثم مات في اليوم الثالث.
علي الرضا (ع)
ولد بالمدينة يوم الجمعة، أو يوم الخميس 11 ذي الحجة، أو ذي القعدة، أو ربيع الأول سنة 153 أو148 للهجرة سنة وفاة جده الصادق (ع)، أو بعدها بخمس سنين.
وتوفي يوم الجمعة، أو الاثنين آخر صفر، أو 17 أو 21 من شهر رمضان، أو 18 جمادى الأولى، أو 23 من ذي القعدة، أو آخره سنة 203، أو 206، أو 202 قال الصدوق في العيون: الصحيح أنه توفي في شهر رمضان لتسع بقين منه يوم الجمعة سنة 203، وكانت وفاته بطوس من أرض خراسان في قرية يقال لها سناآباد من رستاق نوقان.
وعمره 48، أو 47، أو 50، أو 51، أو 57 سنة و49، يوماً، أو 79 يوماً أو بزيادة 9 أشهر عليها، أو 6 أشهر و10 أيام على حسب الاختلاف في تاريخ المولد والوفاة وما يقال في عمره أنه 55، أو 52، أو 49 سنة لا يكاد ينطبق على شيء من الأقوال والروايات، والظاهر أن منشأ بعضه التسامح بِعَدّ السنة الناقصة سنة كاملة. ومن الغريب ما ذكره الصدوق في العيون من أن ولادته في 11 ربيع الأول سنة 153، ووفاته لتسع بقين من رمضان سن 203 وعمره 49 سنة و6 أشهر و10 أيام؛ ومنشأه عدم التدقيق في الحساب. أقام منها مع أبيه 24 سنة وأشهراً كما في مطالب السؤول و25 سنة إلا شهرين في قول ابن الخشاب، والمطابق لما مر أن يكون عمره يوم وفاة أبيه 35 سنة أو 29 سنة وشهرين وبعد أبيه 25 سنة كما في مطالب السؤول، والمطابق لما تقدم أن يكون بقاؤه بعده 20 سنة كما في الإرشاد، أو بنقيصه شهرين أو ثلاثة أو 20 سنة و4 أشهر، أو 33 سنة إلا شهراً وهي بقية ملك الرشيد عشر سنين وخمسة وعشرين يوماً، ثم خلع الأمين وأجلس عمه إبراهيم بن المهدي أربعة وعشرين يوماً، أخرج محمد ثانية وبويع له وبقي سنة وسبعة أشهر وقتله طاهر بن الحسين. ثم ملك المأمون عبدالله بن هارون بعده عشرين سنة. وتوفي بعد مضي خمس سنين أو ثمان سنين من ملك المأمون.
وفي مطالب السؤول: أمه تسمى الخيزران المرسية، وقيل: شقراء النوبية، واسمها أروى، وشقراء لقب لها.
قال الطبرسي في إعلام الورى: أمه يقال لها أم البنين واسمها نجمة، ويقال: سَكَن النوبية، ويقال: تكتم، وقال كمال الدين محمد بن طلحة في كتاب مطالب السؤول: أما أولاده فكانوا ستة: خمسة ذكور وبنت واحدة وأسماء أولاده: محمد، الحسن، جعفر، إبراهيم، الحسن، عائشة. ونحوه ذكر عبدالعزيز بن الأخضر الجنابذي في معالم العترة الطاهرة، وابن الخشاب في مواليد أهل البيت، وأبو نعيم في الحلية. وفي تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي: أولاده محمد وجعفر والحسن وإبراهيم وابنة واحدة. وقال المفيد في الإرشاد: مضى الرضا ولم يترك ولداً إلا ابنه محمد بن علي. وقال ابن شهرآشوب في المناقب: أولاده محمد فقط. وقال الطبرسي في اعلام الورى: كان للرضا من الولد ابنه محمد الجواد لا غير، وعن كتاب العدد القوية: كان له ولدان محمد وموسى لم يترك غيرهما.
جعل الرضا ولياً للعهد
كان المأمون متشيعاً لعلي، مجاهراً بذلك، مكرماً لآل أبي طالب متجاوزاً عنهم؛ ويدل على تشيعه أمور كثيرة نذكر هنا طرفاً منها:
1 ـ احتجاجه على العلماء في تفضيل علي (ع) بالحجج البالغة. كما رواه صاحب العقد الفريد، ورواه الصدوق في كتاب العيون.
2 ـ جعله الرضا (ع) ولي عهده، وتزويجه ابنته، وإحسانه إلى العلويين.
3 ـ تزويجه الجواد ابنته، وإكرامه وإجلاله.
4 ـ قوله بخلق القرآن وفقاً لقول الشيعة، حتى عد ذلك من مساوئه.
5 ـ ما ذكره سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص قال: قال أبو بكر الصولي في كتاب الأوراق، وغيره: كان المأمون يحب علياً (ع) كتب إلى الآفاق بأن علياً بن أبي طالب أفضل الخلق بعد رسول الله (ص)؛ وأن لا يذكر معاوية بخير، ومن ذكره بخير أبيح دمه وماله.
أقوال في سبب جعل المأمون
علياً الرضا ولياً لعهده
إنصافاً للحقيقة نذكر أولاً جميع ما قيل في سبب جعل المأمون علياً الرضا (ع) ولياً لعهده، ثم ندلي بعد ذلك برأينا:
قيل: أن الرشيد كان قد بايع لابنه محمد الأمين، وبعده لأخيه المأمون، وبعدهما لأخيهما القاسم المؤتمن، وجعل أمر عزله وإبقائه بيد المأمون، وكتب بذلك صحيفة وأودعها في جوف الكعبة، وقسم البلاد بين الأمين والمأمون، فجعل شرقيها للمأمون، وأمره بسكنى مرو وغربيها للأمين وأمره بسكنى بغداد، فكان المأمون في حياة أبيه في مرو. ثم أن الأمين بعد موت أبيه في خراسان خلع أخاه المأمون من ولاية العهد وبايع لولد له صغير. فوقعت الحرب بينهما. فنذر المأمون حين ضاق به الأمر إنْ أظفره الله بالأمين أن يجعل الخلافة في أفضل آل أبي طالب؛ فلما قتل أخاه الأمين واستقل بالخلافة وجرى حكمه في شرق الأرض وغربها، كتب إلى الرضا يستقدمه إلى خراسان ليفي بنذره. وهذا الوجه اختاره الصدوق في عيون الأخبار.
وقيل: أن السبب في ذلك أن الفضل بن سهل أشار عليه بهذا فاتبع رأيه. قال الصدوق في كتاب (عيون أخبار الرضا): قد ذكر قوم: أن الفضل بن سهل أشار على المأمون بأن يجعل علي بن موسى الرضا ولي عهده، ومنهم أبو علي الحسين بن أحمد السلامي ذكر ذلك في كتابه الذي صنفه في أخبار خراسان.
ثم قال الصدوق: هذا ما حكاه أبو علي الحسين أحمد السلامي في كتابه. والصحيح عندي: أن المأمون إنما ولاه العهد وبايع له للنذر الذي قد تقدم ذكره، وإن الفضل بن سهل لم يزل معادياً ومبغضاً له وكارهاً لأمره لأنه كان من صنائع آل برمك.
ويأتي في حديث أبي الفرج والمفيد: أن الحسن بن سهل لما جعل يعظم على المأمون إخراج الأمر من أهله، ويعرفه ما في ذلك عليه، قال له المأمون: إني عاهدت الله على أنّي إن ظفرت بالأمين أخرجت الخلافة إلى أفضل آل أبي طالب؛ وما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل على وجه الأرض.
وقيل: إنما بايعه لأنه نظر في الهاشميين فلم يجد أحداً أفضل ولا أحق بالخلافة منه. قال اليافعي في مرآة الجنان: إن سبب طلب المأمون الرضا (ع) إلى خراسان، وجعله ولي عهده أنه استحضر أولاد العباس الرجال منهم والنساء وهو بمدينة مرو من بلاد خراسان، وكان عددهم ثلاثة وثلاثين ألفاً بين كبير وصغير، واستدعى علياً المذكور فأنزله أحسن منزلة، وجمع خواص الأولياء وأخبرهم: أنه نظر في ولد العباس وأولاد علي بن أبي طالب فلم يجد أحداً في وقته أفضل ولا أحق بالخلافة من علي الرضا فبايعه. وقال الطبري في تاريخه: أنه ورد كتاب من الحسن بن سهل إلى بغداد: أن أمير المؤمنين المأمون جعل علي بن موسى بن جعفر بن محمد ولي عهده من بعده؛ وذلك أنه نظر في بني العباس وبني علي فلم يجد أحداً هو أفضل ولا أورع ولا أعلم منه.
وكثير من المحققين يرون: أن المأمون كان يعلم ميل الشعب إلى أبناء علي وحبه لهم، فأراد بجعل علي الرضا ولياً لعهده أن يتقرب إلى قلوب الشعب ويكسب عطفه، مع ما فيه هو نفسه من نزعة شيعية كما مر.
ولما انقضى أمر الأمين واستوى أمر المأمون كتب إلى الرضا يستدعيه إلى خراسان، وعهد بذلك إلى رجاء بن أبي الضحاك وهو عم الفضل بن سهل، وروى رجاء بن أبي الضحاك قال: بعثني المأمون في إشخاص علي الرضا من المدينة. وأمرني أن آخذ به على طريق البصرة والأهواز وفارس؛ ولا آخذ به عن طريق قم. فكنت معه من المدينة إلى مرو وذلك لأن الذاهب من العراق إلى خراسان له طريقان (أحدهما): طريق البصرة ـ الأهواز ـ فارس. الثاني: طريق بلاد الجبل وهي كرمانشاه ـ همذان ـ قم.
قال المفيد: وجلس المأمون للخاصة في يوم خميس وخرج الفضل بن سهل فاعلم الناس برأي المأمون في علي بن موسى الرضا؛ وأنه قد ولاه عهده، وسماه الرضا، وأمرهم بلبس الخضرة، والعود لبيعته في الخميس الآخر؛ فلما كان ذلك اليوم ركب الناس على طبقاتهم من القواد والحجاب والقضاة وغيرهم في الخضرة، وهي شعار العلويين وجلس المأمون وأجلس الرضا معه في الخضرة، ثم أمر ابنه العباس بن المأمون أن يبايع له أول الناس، وقام الخطباء والشعراء؛ فجعلوا يذكرون فضل الرضا؛ وما كان عليه من أمره..
رجوع المأمون لبغداد
لا بد لبيان ذلك من تقديم مقدمة تاريخية: روى الطبري في تاريخه: أنه في سنة 168هـ ولى المأمون الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن الحسن بن سهل، وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو مقيم ببغداد بتسليم ذلك إلى خلفاء الحسن بن سهل؛ وأن يشخص إلى الرقة، وولاه الموصل والجزيرة والشام والمغرب. وطاهر بن الحسين الخزاعي هذا هو الذي فتح بغداد وقتل الأمين. وفي سنة 199هـ قدم الحسن بن سهل بغداد من عند المأمون، وفرق عماله في البلدان. وكان هرثمة بن أعين من قواد بني العباس في العراق حين ورد الحسن بن سهل إليها، فسلم إلى الحسن ما كان بيده من الأعمال، وتوجه نحو خراسان مغاضباً للحسن حتى بلغ حلوان، وخرج بالكوفة أبو السراب فاستفحل أمره. فلم يلق عسكراً إلا هزمه؛ فأرسل الحسن إلى هرثمة ليرجع ويحارب أبا السرايا فأبى. فلم يزل الحسن يتلطف به حتى قبل وهُزِم أبو السرايا وقُتِل. فلما فرغ هرثمة من أمر أبي السرايا خرج حتى أتى خراسان، وقد أتته كتب المأمون أن يرجع فيلي الشام أو الحجاز فأبى، وقال: لا أرجع حتى آتي أمير المؤمنين إدلالاً منه عليه؛ لما كان يعرف من نصيحته له ولآبائه، وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفضل وما يكتم عنه من الأخبار، وأن يقنع المأمون بأن يرده هو نفسه إلى بغداد بدلاً من الشام أو الحجاز، فعلم الفضل ما يريد فأفسد قلب المأمون عليه. وقال: أنه دس أبا السرايا وهو جندي من جنده حتى عمل ما عمل. ولو شاء هرثمة أن لا يفعل ذلك أبو السرايا ما فعله، وقد كتب إليه أمير المؤمنين عدة كتب أن يرجع فأبى مشاقاً. فلما دخل على المأمون عنفه، فذهب ليعتذر، فلم يقبل ذلك منه، ووجيء أنفه وديس بطنه وحبس ثم دسوا إليه فقتلوه، وقالوا للمأمون: أنه مات. وذلك سنة 200. وكان الحسن بن سهل بالمدائن حين شخص هرثمة إلى خراسان والوالي على بغداد من قبله علي بن هشام، فلما اتصل بأهل بغداد ما صنع بهرثمة طردوا علي بن هشام من بغداد، وهرب الحسن بن سهل إلى واسط، وذلك في أوائل سنة 201. وكان عيسى بن محمد بن أبي خالد بن الهندوان عند طاهر بن الحسين بالرقة، فقدم بغداد واجتمع هو وأبوه على قتال الحسن بن سهل بأهل بغداد، فخرج أبوه في بعض الوقائع فمات. ثم رأى الحسن بن سهل أنه لا طاقة له بعيسى فصالحه. وبايع المأمون الرضا بولاية العهد في هذه السنة. فورد على عيسى بن محمد بن أبي خالد كتاب من الحسن بن سهل يعلمه فيه بأن المأمون بايع للرضا بولاية العهد، وأمر بطرح لبس الثياب السود، ولبس ثياب الخضرة، ويأمره أن يأمر من قبله من أصحابه والجند والقواد وبني هاشم بالبيعة له، وأن يأخذهم بلبس الخضرة في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم، ويأخذ أهل بغداد بذلك جميعاً. فقال بعضهم: نبايع ونلبس الخضرة. وقال بعض: لا نبايع ولا نلبس الخضرة ولا نخرج هذا الأمر من ولد العباس؛ وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل. وغضب ولد العباس من ذلك واجتمع بعضهم إلى بعض، وقالوا: نولي بعضنا ونخلع المأمون؛ فبايعوا إبراهيم بن المهدي وخلعوا المأمون وذلك يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة سنة 201. وذكر أبو علي الحسين في كتاب العيون: أن المأمون لما بايع الرضا بولاية العهد وبلغ ذلك العباسيين ببغداد ساءهم فأخرجوا إبراهيم بن المهدي عم المأمون المعروف بابن شكلة وبايعوه بالخلافة، وخلعوا المأمون. وكان إبراهيم مغنياً مشهوراً مولعاً بضرب العود منهمكاً بالشراب.
وكتب المأمون إلى الحسن بن سهل بمحاصرة بغداد ووقعت الحرب بين أصحاب إبراهيم وأصحاب الحسن بن سهل، واختل الأمر في العراق والمأمون لا يعلم بذلك، كان الفضل يخفي عنه الأخبار ولا يخبره أحد خوفاً من الفضل فأخبره الرضا بذلك، وأشار عليه بالرحيل إلى بغداد. قال الطبري: إن علي بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي أخبر المأمون بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتل أخوه، وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبار؛ وأن أهل بيته والناس قد نقموا عليه أشياء، وأنهم بايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي بالخلافة، فقال المأمون: إنهم لم يبايعوا له بالخلافة، وإنما صيروه أميراً يقوم بأمرهم على ما أخبر به الفضل، فاعلمه أن الفضل قد كذبه وغشه، وأن الحرب قائمة بين إبراهيم والحسن بن سهل، وأن الناس ينقمون عليه مكانه ومكان أخيه ومكاني ومكان بيعتك لي من بعدك، فقال: ومن يعلم هذا؟ فسمى له أناساً من وجوه أهل العسكر. فسألهم، فأبوا أن يخبروه حتى يكتب لهم أماناً بخطه إلا يعرض لهم الفضل؛ فأخبروه بما فيه الناس من الفتن، وبغضب أهل بيته ومواليه وقواده، وبما مَوّه عليه الفضل من أمر هرثمة، وأن هرثمة إنما جاء لينصحه، وأن الفضل دس إليه من قتله، وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الخلافة منه ومن أهل بيته، وأن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما أبلى حتى إذا وطىء الأمر أخرج من ذلك وصير في زاوية من الأرض بالرقة، وأن الدنيا قد تفتقت من أقطارها وسألوه الخروج إلى بغداد، فلما تحقق ذلك عنده أمر بالرحيل إلى بغداد، فلما علم الفضل بن سهل ببعض ذلك تعنتهم حتى ضرب بعضهم بالسياط، وحبس بعضاً، ونتف لحى بعض فعاوده علي بن موسى في أمرهم وأعلمه ما كان من ضمانه لهم، فاعلمه أنه يداوي ما هو فيه. وقال سبط ابن الجوزي في تذكره الخواص: قال علماء السير فلما فعل المأمون ذلك شغبت بنو العباس ببغداد عليه وخلعوه من الخلافة وولوا إبراهيم بن المهدي، والمأمون بمرو وتفرقت قلوب شيعة بني العباس عنه.  فأخبره علي الرضا بكل ذلك.
فأخبره علي الرضا بكل ذلك.
وروى الصدوق في العيون بسنده عن ياسر الخادم قال: بينما نحن عند الرضا إذ جاء المأمون ومعه كتاب طويل فقرأ ذلك الكتاب عليه؛ فإذا هو فتح لبعض قرى كابل فيه: أنا فتحنا قرية كذا وكذا، فلما فرغ قال له الرضا (ع): وسرك فتح قرية من قرى الشرك؟ فقال له المأمون: أوليس في ذلك سرور؟ فقال: يا أمير المؤمنين اتق الله في أمة محمد. وما ولاك الله هذا الأمر وخصك؛ فإنك قد ضيعت أمور المسلمين، وفوضت ذلك إلى غيرك يحكم فيها بغير حكم الله عزَّ وجلَّ، وقعدت في هذه البلاد، ويأتي على المظلوم دهر يتعب فيه نفسه ويعجز عن نفقته فلا يجد من يشكو إليه حاله، ولا يصل إليك، قال المأمون: فما ترى؟ قال أرى أن تخرج من هذه البلاد، وتتحول إلى موضع آبائك وأجدادك، وتنظر في أمور المسلمين، ولا تكلهم إلى غيرك. فقام المأمون فقال: نعم ما قلت يا سيدي. هذا هو الرأي، وبلغ ذلك الفضل بن سهل فغمه غماً شديداً، فجاء إلى المأمون وقال له: يا أمر المؤمنين ما هذا الرأي الذي أمرت به؟ فقال هو الصواب، فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا الصواب قتلت بالأمس أخاك وأزلت الخلافة عنه وبنو أبيك معادون لك وجميع أهل العراق وأهل بيتك، ثم أحدثت هذا الحدث الثاني؛ أنك جعلت ولاية العهد للرضا وأخرجتها من بني أبيك، والرأي أن تقيم بخراسان حتى تسكن قلوب الناس على هذا، ويتناسوا ما كان من أمر محمد أخيك؛ ولكن المأمون أصر على الرجوع إلى بغداد متبعاً نصيحة الرضا.
صفحة من القرآن المنسوب إلى خط الإمام الرضا (ع)
وصول المأمون والرضا إلى
سرخس وقتل الفضل بن سهل
وقال ياسر الخادم في تتمة رواية الصدوق المتقدمة:
فلما كان بعد ذلك بأيام ونحن في بعض المنازل (إلى أن قال): فإذا بالمأمون قد دخل على الرضا فنعى إليه الفضل بن سهل، وكان الفضل في الحمام فدخل عليه قوم بالسيوف فقتلوه، وأخذ من دخل عليه في الحمام، وكانوا ثلاثة نفر أحدهم ابن خالة الفضل فجيء بهم إلى المأمون فقال لهم: لم قتلتموه؟ قالوا: اتق الله يا أمير المؤمنين، قتلناه بأمرك، فلم يلتفت إلى كلامهم وقتلهم. وكان ذلك في شعبان سنة 203 قال الطبري: وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المأمون وهم أربعة: غالب المسعودي الأسود، وقسطنطين الرومي، وفرج الديلمي، وموفق الصقلبي. فقالوا للمأمون: أنت أمرتنا بقتله فأمر بهم فضربت أعناقهم وبعثت برؤوسهم إلى الحسن بن سهل.
وحكى الصدوق في العيون، عن أبي علي الحسين بن أحمد السلامي في كتابه تاريخ نيسابور أنه قال: احتال المأمون على الفضل بن سهل حتى قتله غالب خال المأمون في الحمام بسرخس.
وفاة الرضا
روايات من قالوا بوفاة الرضا بالسم:
روى الصدوق في العيون عن ياسر الخادم: قال لما كان بيننا وبين طوس سبعة منازل مرض الرضا، فدخلنا طوس وقد اشتدت به العلة، فبقينا بطوس أياماً، فكان المأمون يأتيه في كل يوم مرتين.
ويقول السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: يظهر من عدة أخبار أن علته كانت الحمى، قال المجلسي في البحار: اعلم أن أصحابنا وغيرهم اختلفوا في أن الرضا (ع) هل مات موتاً طبيعياً؟ أو مضى شهيداً بالسم؟ وهل سمه المأمون؟ أو غيره؟ والأشهر بيننا: أنه مضى شهيداً بالسم، وقد سمه المأمون. وروى الصدوق في العيون عدة روايات: في أنه سمه المأمون، وكذلك روى المفيد في الإرشاد. وفي خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال، عن سنن ابن ماجة القزويني: أنه مات مسموماً بطوس. وفي مقاتل الطالبيين: كان المأمون عقد له العهد من بعده، ودس له فيما ذكر بعد ذلك سماً فمات منه. وفي تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه قال: استشهد علي بن موسى بسناآباد. وفيه، عن أبي حاتم بن حبان: أنه (ع) مات آخر يوم من صفر، وقد سم في ماء الرمان، وسقي. وقال الطبري: أنه أكل عنباً فأكثر منه فمات فجأة.
تعليلهم سبب سم المأمون الرضا
قال المفيد في الإرشاد: كان الرضا يزري على الحسن والفضل ابن سهل عند المأمون إذا ذكرهما، ويصف له مساويهما، وينهاه عن الإصغاء إلى قولهما، وعرفا ذلك منه فجعلا يحطبان عليه عند المأمون، ويذكران له عنه ما يبعده منه ويخوفانه من حمل الناس عليه. فلم يزالا كذلك حتى قلبا رأيه وعمل على قتله. وقال أبو الفرج: اعتل الرضا علته التي مات فيها، وكان قبل ذلك يذكر ابني سهل عند المأمون فيزري عليهما، وينهي المأمون عنهما، ويذكر له مساويهما.
أما الكليني فليس في كتابه رواية تدل على أنه مات مسموماً، كما أنه لم يذكر في أبيه موسى بن جعفر أنه مات مسموماً، مع اشتهار أمره بذلك، بل اقتصر على أنه مات في حبس السندي بن شاهك. وفي كشف الغمة: بلغني ممن أثق به: أن السيد رضي الدين علي بن طاووس كان لا يوافق على أن المأمون سم الرضا، ولا يعتقده. وكان كثير المطالعة والتنقيب والتفتيش على مثل ذلك، والذي كان يظهر من المأمون من حنوه وميله إليه واختياره له، مما يؤيد ذلك ويقرره.
قال سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص: وظاهره أنه نقله عن أبي بكر الصولي في كتاب الأوراق: وزعم قوم أن المأمون سمه. وليس بصحيح، فإنه لما مات علي توجه له المأمون وأظهر الحزن عليه وبقي أياماً لا يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً وهجر الملذات. ويأتي تفصيل الحال في ذلك. قال المفيد: بعدما ذكر أن المأمون عمل على قتل الرضا (ع) فاتفق أنه أكل هو المأمون طعاماً فاعتل منه الرضا (ع)، وأظهر المأمون تمارضاً. وقال أبو الفرج: اعتل الرضا فجعل المأمون يدخل عليه فلما ثقل الرضا تمارض المأمون، وأظهر أنهما أكلا عنده طعاماً ضاراً فمرضا.
كلام المفيد يدل على: أنه كان قد سمه في ذلك الطعام فتمارض المأمون؛ ليوهم الناس أن مرض الرضا من الطعام الضار لا من السم؛ ولكن عبارة أبي الفرج تدل على: أن الطعام لم يكن مسموماً؛ وإنما كان السم في غيره مما يأتي؛ لكن المأمون أظهر أن المرض من أكل الطعام الضار؛ ولعل ذلك أقرب إلى الصواب. قال أبو الفرج: ولم يزل الرضا عليلاً حتى مات، واختلف في أمر وفاته، وكيف كان سبب السم الذي سقيه؟ ثم قال المفيد ونحوه أبو الفرج: فذكر محمد بن علي بن حمزة، عن منصور بن بشير، عن أخيه عبدالله بن بشير، قال: أمرني المأمون أن أطول أظافري على العادة، ولا أظهر لأحد ذلك ففعلت. ثم استدعاني فأخرج لي شيئاً يشبه التمر هندي، وقال لي: اعجن هذا بيديك جميعاً ففعلت. ثم قام وتركني ودخل على الرضا (ع) فقال: ما خبرك؟ قال له: أرجو أن أكون صالحاً قال له: وأنا اليوم بحمد الله صالح فهل جاءك أحد من المترفقين في هذا اليوم؟ قال: لا. فغضب المأمون وصاح على غلمانه. وقال للرضا: فخذ ماء الرمان الساعة فإنما مما لا يستغني عنه. ثم دعاني فقال: ائتنا برمان. فأتيته به. فقال لي: أعصره بيديك ففعلت وسقاه المأمون الرضا بيديه فشربه، فكان ذلك سبب وفاته، ولم يلبث إلا يومين حتى مات (ع). قال محمد بن علي بن حمزة، عن أبي الصلت الهروي قال: دخلت على الرضا (ع) وقد خرج المأمون من عنده. فقال لي: يا أبا الصلت فعلوها؛ أي سقوني السم، وجعل يوحد الله ويمجده. قال محمد بن علي وسمعت محمد بن الجهم يقول: كان الرضا (ع) يعجبه العنب فأخذ له منه شيء فجعل في مواضع إقماعه الأبر أياماً ثم نزعت منه، وجيء به إليه، فأكل منه وهو في علته التي ذكرناها فقتله وذكر أن ذلك من لطيف السموم.
قال علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة: قد ذكر المفيد شيئاً ما يقبله نقدي؛ ولعلي واهم. وهو أن الإمام (ع) كان يعيب ابني سهل عند المأمون ويقبح ذكرهما إلى غير ذلك وما كان أشغله بأمور دينه وآخرته واشتغاله بالله عن مثل ذلك. وعلى رأي المفيد أن الدولة المذكورة من أصلها فاسدة. وعلى غير قاعدة مرضية فاهتمام الرضا بالوقيعة فيهما حتى أغراهما بتغيير رأي الخليفة عليه فيه ما فيه. ثم أن نصيحته للمأمون وإشارته عليه بما ينفعه في دينه لا يوجب أن يكون سبباً لقتله، وموجباً لركوب هذا الأمر العظيم منه، وقد كان يكفي في هذا الأمر أن يمنعه عن الدخول عليه، أو يكفه عن وعظه؛ ثم إنا لا نعرف أن الأبر إذا غرست في العنب صار العنب مسموماً، ولا يشهد به القياس الطبي، والله تعالى أعلم بحال الجميع وإليه المصير وعند الله تجتمع الخصوم.
قال: ورأيت في كتاب يعرف بكتاب النديم لم يحضرني عند جمع هذا الكتاب: إن جماعة من بني العباس كتبوا إلى المأمون يسفهون رأيه في تولية الرضا (ع) العهد بعده، وإخراجه عنهم إلى بني علي (ع)، ويبالغون في تخطئته وسوء رأيه، فكتب إليهم جواباً غليظاً سبهم فيه وذكر الرضا (ع) ونبه على فضله وشرف نفسه وبيته، وهذا وأمثاله مما ينفي عن المأمون الإقدام على إزهاق تلك النفس الطاهرة، والسعي فيما يوجب خسران الدنيا والآخرة والله أعلم.
قال المجلسي في البحار: رد الأربلي في كشف الغمة ما ذكره المفيد بوجوه خفية، ثم قال بعد نقل كلامه: ولا يخفى وهنه إذا الوقيعة في ابني سهل لم تكن للدنيا؛ حتى يمنعه عنها الاشتغال بعبادة الله تعالى، بل كان ذلك لما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورفع الظلم عن المسلمين مهما أمكن، وكون خلافة المأمون فاسدة؛ لا يمنع من ذلك كما نصح غيره للمسلمين في الغزوات والحروب. ثم أنه ظاهر أن نصيحة الأشقياء ووعظهم بمحضر الناس لا سيما المدعين للفضل والخلافة مما يثير حقدهم. قال سبط بن الجوزي عن كتاب الأوراق لأبي بكر الصولي: وقيل: أنه دخل الحمام ثم خرج فقدم إليه طبق فيه عنب مسموم قد أدخل فيه الأبر المسمومة من غير أن يظهر أثرها فأكله فمات «ا.هـ» مع أن الخبر الآخر دال على سمه في الرمان.
قال المفيد: ونحوه قال أبو الفرج: لما توفي الرضا (ع) كتم المأمون موته يوماً وليلة ثم أنفذ إلى محمد بن جعفر الصادق (ع) وجماعة من آل أبي طالب الذين كانوا عنده؛ فلما حضروه نعاه إليهم وبكى وأظهر حزناً شديداً وتوجعاً وأراهم إياه صحيح البدن. وقال: يعز عليَّ يا أخي أن أراك في هذه الحال قد كنت أؤمل أن أقدم قبلك فأبى الله إلا ما أراد، ثم أمر بغسله وتكفينه وتحنيطه وخرج مع جنازته يحملها؛ حتى انتهى إلى الموضع الذي هو مدفون فيه الآن فدفنه. والموضع دار حميد بن قحطبة في قرية يقال لها سناآباد على مقربة من نوقان بأرض طوس، وفيها قبر هارون الرشيد.
رأينا فيما جرى
إن اختيار المأمون للإمام الرضا (ع) ولياً للعهد، حدث من أضخم الأحداث في التاريخ الإسلامي بعامة، وفي التاريخ الشيعي بخاصة، كانت تقتضي له دراسات معمقة وبحوث مستفيضة، تتَّفق مع ما ينطوي عليه من أهداف، وما وراءه من دوافع، وما في طياته من دلالات.
وكان أولى الناس بالعكوف على دراسة هذا الحدث دراسة بعيدة المرمى، متأصلة الجذور، هم الشيعة.
نقول هذا ونحن نعلم أن مسؤولية غير الشيعة في هذا الأمر لا تقل عن مسؤولية الشيعة، لأن الحدث كان حدثاً إسلامياً يتعلق بكيان العالم الإسلامي، وبمصير الدولة الإسلامية.
أما غير الشيعة فقد شغلوا عن ذلك، فأحداث خلق القرآن، وما جرى على يدي المأمون في هذا الموضوع، ولم يعنهم من المأمون إلا هذا الأمر.
وأما جُلّ الشيعة فكان حالهم في ذلك من أغرب الأحوال.
إن كل ما عناهم من هذا الحديث العظيم هو التفتيش عن الأدلة التي تسعفهم على إثبات سوء نية المأمون فيما فعل، والتفتيش عن أدلة أخرى يستطيعون بها اتهام المأمون بسم الإمام الرضا (ع).
لماذا وقف الشيعة هذا الموقف؟
الجواب على هذا السؤال يتلخص بكلمة واحدة: أنها عقدة الاضطهاد!. فالشيعة الذين لم يعرفوا من السلطات الحاكمة إلا الاضطهاد، فوجئوا بحاكم قوي مسيطر يرفع عنهم الاضطهاد ويكرمهم ويحميهم، ثم يفاجئهم بأن يجعل إمامهم ولياً لعهده!.
لم تتقبل عقولهم هذا الأمر، ولم يصدقوه. فراحوا يتخيلون دوافع خفية تستر الشر المراد بهم من وراء هذا التبدل الخطير من السلطات: اضطهاد متواصل، ثم فجأة: تكريم وتعظيم، ثم إعداد وسائل تسليمهم الحكم، وإعادة الحق المسلوب من أئمتهم!
كان ذلك شيئاً فوق أن تتخيله النفوس، فضلاً عن أن تقتنع به العقول!.
وبدلاً من أن يعتبروه حلماً تحقق، اعتبروه كابوساً يضغط!.. إنها عقدة الاضطهاد، اضطهاد مائتي سنة عانوا منها ما عانوا من القتل والترويع والتشريد، وكابد فيها أئمتهم ما كابدوا من الأذى والسجن والقتل بالسم.
وآخر عهدهم في ذلك، الأمس القريب، يوم سيق أمامهم موسى الكاظم (ع) إلى سجن الرشيد!.
الأب يسجن الإمام ويؤذيه، ثم يخلفه الابن فيحمي الشيعة ويرفع شأنهم، ويجعل الإمام ولياً لعهده!.
إنه لون جديد من ألوان اللعب بهم، وإن وراء ما يبدو من الخير شراً كل الشر.
فما الذي تخفي السلطات لهم من أساليب الاضطهاد بينما تتظاهر بأساليب الإكرام!
هذا ما شغلهم، وما لا يزال يشغلهم حتى اليوم!. التفتيش عما أجنت عملية المأمون من دوافع شريرة!.
إنها عقدة الاضطهاد تتحكم بهم، اضطهاد قرنين.
وجاء موت الإمام الرضا (ع) شبه الفجائي، فزادت شكوكهم، وانشغلوا بشيء جديد، هو إلصاق تهمة سم الإمام بالمأمون، وبعد أن كان شاغلهم التركيز على سوء نية المأمون بتعيين الرضا ولياً لعهده، أصبح لهم شاغل جديد هو التركيز على أن المأمون هو الذي سمم الإمام الرضا.
لماذا جعل المأمون الإمام الرضا (ع)
ولياً لعهده؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد لنا من الرجوع قليلاً إلى الوراء، إلى عهد الرشيد والد المأمون، وما كان عليه حال الدولة يومذاك.
لا ريب أن الدولة العباسية قد بلغت في عهد الرشيد ذروة تعاليها، ويشبه بعض المؤرخين عصر الرشيد في بغداد بعصر (بريكلس) في بلاد اليونان.
كان للدولة كل مظاهر العظمة، من قوة سياسية وعسكرية، واندفاع حضاري وتقدم ثقافي.
ولكن المتبصر في الأمر يدرك أن ذاك العصر حين كان له هذا المظهر البراق كان ينطوي في الوقت نفسه على عوامل التفكك والتدهور، وأنه كانت فيه أسباب القوة ودواعي الضعف معاً.
فنحن نرى مثلاً في بلاد الشام سنة 174 ثورة على الحكم لم يمكن إخمادها إلا بإرسال جعفر البرمكي، وكذلك في سنة 194.
وكذلك قامت في الجزيرة سنة 178 حركة الوليد بن طريف الخارجي التي شكلت على الدولة خطراً حقيقياً، ولم ينته الخطر إلا بإرسال يزيد بن مزيد الشيباني. كما قامت حركات خوارجية أخرى كحركة الصحصح، وحركة العطاف الأزدي، وحركة عبدالسلام، وحركة حمزة بن عبدالله الأزدي.
وفي الديلم قامت حركة يحيى بن عبدالله الحسنى واشتدت، ثم انتهت بأمان الرشيد الذي لم يف به.
إلى غير ذلك من الأحداث والثورات.
وخطا الرشيد الخطوة الأولى في تمزيق الدولة حين ولّى إبراهيم بن الأغلب بلاد أفريقيا على أن تكون ولايتها وراثية في أعقابه، مما كان مؤداه استقلال هذه البلاد وفصلها عن الدولة. ثم أتم الرشيد تقطيع الأوصال بتقسيم الدولة إلى قسمين مستقل كل منهما عن القسم الآخر، وذلك بأن جعل ابنه الأمين ولياً للعهد على أن تكون عاصمته بغداد، وجعل ابنه الآخر المأمون حاكماً على القسم الشرقي من الدولة ابتداء من مدينة همذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها وما هو منسوب إليها ـ كما جاء في كتاب البيعة ـ على أن تكون عاصمته مدينة (مرو).
وجعل المأمون مستقلاً في هذا القسم تمام الاستقلال؛ بحيث لا يستطيع الأمين أن يتدخل في شأن من شؤونه مهما صغر أو كبر هذا الشأن.
وهكذا انشطرت المملكة بعد الرشيد إلى شطرين، وعادت الدولة الواحدة دولتين.
ثم قامت الحرب بين الأمين والمأمون، وانتهت بانتصار المأمون وسيطرته الكاملة على الشطرين معاً.
وكان من الطبيعي أن يعقب ذلك شروخ في صميم الدولة، مضافاً إلى ما كانت تعانيه من شروخ.
وجد المأمون نفسه على رأس (إمبراطورية) واسعة، لها كل مقومات (الإمبراطوريات) من جيوش وولات وإدارات وخزائن أموال.
ولكنه بنظره البعيد رأى أنه ينقصها الشيء الذي إذا لم تحظ به فهي سائرة إلى الاضمحلال، ولن تفيدها كل مظاهر القوة والعظمة، وكل ما لها من اتساع الرقعة وامتداد الحدود وكثرة الأموال والجنود!.
هذا الشيء هو التماسك بين أجزائها والالتحام بين قواها. لقد كان هو بقوة شخصيته وحزمه وحسن تدبيره كفيلاً باطراد سيرها اطراداً لا يعيقه عائق، وكفيلاً كذلك بأن لا تثقف أطرافها، ولا تتمزق قواعدها، ولكن من له بمن يضمن لها ذلك بعده؟
لقد كان أحوج ما تحتاجه الدولة هو القيادة ذات الكفاءة المتعددة الجوانب: كفاءة في الإدارة، وكفاءة في الأخلاق وحسن السيرة.
لو أن رجلاً آخر غير المأمون ورث ذلك الملك العريض الذي ورثه المأمون، لما كان شغل تفكيره من يتولى الأمر بعده، فالقاعدة التي سنها معاوية بقيت قاعدة الحكام منذ عهده حتى عهد الرشيد، فالأبناء هم الذين يجب أن يرثوا الآباء في حكم المسلمين، ولو كانوا في مستوى يزيد بن معاوية.
لقد كانت المشكلة محلولة منذ البداية، أو بالأصح لم تكن هناك مشكلة، ما دام للمأمون ابن بالغ راشد لا يقل في شخصيته عمن كانوا قبله أولياء عهود منذ يزيد.
إن الأمر الطبيعي هنا أن يعهد المأمون بولاية العهد لولده العباس، ولم يكن في تفكير أحد أن الأمر سيكون غير ذلك.
ولكن المأمون كان طرازاً خاصاً بين الحكام. كانت مصلحة الدولة هي التي تهمه، ومستقبل الأمة هو الذي يشغله، كان ذلك عنده فوق مصلحته ومصلحة ولده ومصلحة أسرته.
لقد رأى بعين البعيد النظر، العميق الاستنتاج أن الدولة من أجل أن تظل دولة قوية مترابطة متقدمة، يجب أن تقودها يد حازمة صالحة رشيدة، وأن تكون على رأسها زعامة خارقة تستطيع أن تسير بها سليمة في الخضم المتلاطم الذي ينتظرها.
ولم ير في ابنه كفاءة القائد الذي يتخيله في هذا الظرف الاستثنائي الخطير.
فتجاوز ابنه إلى من هم أقرب إليه من غيره، إلى أخوته فلم ير فيهم الرجل المؤمل.
لقد كانت مصلحة الأمة هي التي تشغل بال المأمون، ومستقبل الوطن هو الذي يثير تفكيره.
من هو الرجل المنقذ؟ من هو رجل الساعة في هذا الموقف الدقيق الذي سيصير إليه أمر الإسلام والمسلمين؟
من هو الربان الذي يستطيع أن يقود السفينة سالمة في البحر العاصف المتواثب الذي ينتظرها؟
من هو الزعيم الذي يستطيع أن يموت المأمون وهو قرير العين على الشعوب الإسلامية إذا سلم إليه زعامتها؟
لم يكن المأمون بحاجة إلى تفكير طويل وتأمل كثير ليجد الزعيم المنقذ، لقد كان أشهر من أن يخفى عليه، وأعرف من أن يبحث عنه.
أنه علي بن موسى بن جعفر، أنه الذي تتجمع فيه كل صفات ما نطلق عليه في عصرنا الحاضر (رجل دولة)، إيمان وسيرة نقية، وإرادة صلبة، وعزم وحزم وعلم!
إنه بطل الإسلام المنشود، في زمن هو في أمس الحاجة إلى البطولات. إن المأمون عرف كيف يضمن للدولة سيرها التقدمي بلا تعثر ولا تعسف حين عزم على تسليم زمامها بعده إلى علي بن موسى بن جعفر، الذي كان من الرجال الذين لا يجود الزمن بأمثالهم كل يوم، والذين تعدهم الدنيا لأيامها الشداد العصيبة.
وقد كان يوم الإسلام في تلك الفترة يوماً شديداً عصيباً تقف فيه الدولة الإسلامية على مفترق طرق، فإما أن تجد من يقودها صعوداً إلى القمم العالية، وإما أن تزل بها الأقدام في المنحدرات، منحدراً بعد منحدراً! وها هو المأمون يهديه الله إلى رجل الإنقاذ.
وهنا تتجلى لنا حقيقتان طوتهما عن الأنظار، تلك السطحية التي عالجنا ولا نزال نعالج بها قضية (ولاية العهد).
الحقيقة الأولى: عظمة الإمام الرضا، عظمته لا كإمام فقط نتلقى عنه تعاليم الدين، فيفيض علماً وتقى وهداية وصلاحاً.
بل عظمته أيضاً كإنسان مجرد إنسان تتجمع فيه قوة القيادة الشعبية، وقوة القيادة السياسية، وقوة القيادة الإدارية.
عظمة الزعيم والقائد والحاكم.
الحقيقة الثانية: إخلاص المأمون للأمة الإسلامية إخلاصاً لم يسبقه به سابق.
إخلاصاً ضحى فيه المأمون تضحية لم يعرفها التاريخ من قبل، فقد عرفنا الملوك يولون ولاية العهد لأولادهم مهما كان أمر هؤلاء الأولاد هم أولياء العهود سواء كانوا أقوياء أو عاجزين، صالحين أو فاسدين؛ بل لقد عرفنا أكثر من ذلك. عرفنا أن بعض الملوك كانوا يعهدون بولاية العهد لأكثر من ولد واحد من أولادهم واحداً بعد الآخر، فيعمل من يصير إليه الملك على إزالة أخيه المعهود إليه بعده من أبيه، يعمل على إزالته ليحل ابنه محله، فعبد الملك بن مروان مثلاً عهد بولاية العهد لابنه الأكبر (الوليد) على أن يتولى الأمر بعده أخوه سليمان، وبعد سليمان بقية الأخوة.
ولكن الوليد بعد أن صار الحكم إليه قرر عزل أخيه سليمان عن ولاية عهده وجعل ابنه مكان أخيه.
وبدأ الإعداد لإعلان ذلك بعد أن مهد له مع الولاة والقواد، ولكن الأجل عاجله فمات قبل إتمام الأمر([1124]).
وقام بنفس العمل الخليفة العباسي المنصور؛ إذ كان الخليفة العباسي الأول: أبو العباس السفاح قد عهد بولاية عهده إلى أخيه المنصور على أن يكون ولي عهد المنصور ابن أخيه عيسى بن موسى. ولكن لما صار الأمر إلى المنصور أزاح عيسى عن ولاية عهده وجعلها لولده المهدي على أن يكون عيسى بعده. ثم أن المهدي خلع ابن عمه عيسى من ولاية العهد وعقدها لولده الهادي.
وكذلك فعل الأمين فقد خلع أخاه المأمون من ولاية عهده وجعلها لولده. أما المأمون فقد كان الأمر بيده، وكان ولي عهده الطبيعي ولده العباس، ولكن الدولة كانت تحتاج إلى رجل أقوى من العباس. فتجاوز المأمون ولده وضحى به من أجل مصلحة الدولة، ثم تجاوز أخوته بعد أن تجاوز ولده. تجاوز ولده وأخوته إلى من كان الكفء كل الكفء لقيادة الدولة فيما ينتظرها من زعازع!
تجاوزهم جميعاً إلى علي بن موسى بن جعفر،َ وذلك إخلاص وتلك تضحية لم يسبق المأمون إليهما سابق، وبعد أن شاءت إرادة الله أن لا يتم ما قصد إليه المأمون، فمات الإمام الرضا قبل المأمون، ظل المأمون على إخلاصه وتضحيته، فوازن بين ابنه العباس وبين أخيه المعتصم، فوجد إن أخاه مهما كان شأنه يظل أكفأ من ابنه، فنحى ابنه وجعل أخاه ولياً لعهده.
لقد شاءت مشيئة الله ـ ولا راد لمشيئته ـ أن لا يلي أمر المسلمين علي الرضا، وتحققت مخاوف المأمون وأخذت الدولة بالتدهور منذ وفاة المأمون وتولي المعتصم!
ولم يكن أحد أكثر شعوراً بالفاجعة التي حلت بالمسلمين بوفاة الرضا، من المأمون، ولم يحزن على الرضا أحد أكثر مما حزن المأمون، ولم يفض دمع أحد على علي بن موسى أكثر مما فاض دمع المأمون.
إنه لم يفجع بالرجل الذي أحبه حباً شخصياً ووالاه ولاء عقائدياً فقط، بل فجع كذلك في آماله بإنقاذ مستقبل الدولة الإسلامية، وتلك هي أكبر الفواجع!
مظاهرة مرو
ومن أعظم ما يشجي هو تحويلنا نتيجة مظاهرة مرو في اليوم الذي طلب فيه المأمون من الرضا (ع) أن يصلي بالناس صلاة العيد، تحويلنا نتيجة المظاهرة العظمى عن نتيجتها الحقيقية إلى نتيجة عكسية.
فقد قلنا ولا نزال نقول: إنه لما بلغ المأمون ما قوبل به خروج الرضا للصلاة من حماسة الناس وعواطفهم، قال الفضل بن سهل للمأمون: إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس فأنفذ إليه أن يرجع، فبعث يطلب إليه الرجوع، وأن يصلي بالناس من كان يصلي بهم، فرجع الرضا ولم يصل بالناس.
هذه هي خلاصة ما أوحته لنا (عقدة الاضطهاد) عن هذا اليوم العظيم.
فما هي الحقيقة في ذلك؟
الحقيقة هي أبعد ما تكون عن هذا الخيال العجيب.
لقد كان للمأمون معارضون في تولية عهده للإمام الرضا لأسباب نعرفها كلنا. وحاول هؤلاء المعارضون أن يثيروا معارضة شعبية على المأمون، حاولوا ذلك في بغداد وغير بغداد. فأراد المأمون أن يرد عليهم بنفس سلاحهم وأن يبرهن لهم بأن الشعب يؤيديه فيما أقدم عليه، وأن للرضا بين جماهير الشعب من المنزلة ما ليس مثلها لغيره، وإن الرضا إذا كان مرشحه لولاية العهد، فهو في الوقت نفسه مرشح الشعب.
وجاء العيد فوجد المأمون فرصته للبرهنة على ذلك، فدعا الرضا للصلاة بالناس بالعيد، وانتشر الخبر بين الناس، وتسامعوا بنبأ عزم الرضا على أن يؤم الجموع بصلاة العيد، فبكرت الجماهير كلها إلى الشوارع والطرقات والمسالك لتحية الإمام والتبرك بطلعته، وخرج الإمام بتواضعه وبساطته، وكبر مواليه معه ثم مشى حتى وقف على الباب الأكبر، فأعاد التكبير هناك.
يقول راوي الخبر: وكبر الناس معه فخيل إلينا أن السماء والحيطان تجاوبه، وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لما رأوا أبا الحسن وسمعوا تكبيره.
هذه الصورة الموجزة الرائعة التي رواها مشاهد عيان تعطينا حقيقة ما جرى.
لقد كان ظهور الإمام الرضا للجماهير، ثم هتافه: الله أكبر ـ لقد كان ذلك كافياً لأن يثير في الجماهير أقصى حماستها، ويبعث فيها أخلص عواطفها فاندفعت إليه بحبها وولائها، يحاول كل واحد فيها أن يستطيع الوصول إليه؛ فيلمس ثوبه إذا لم يستطع تقبيل يديه، أو أن يفوز عن قرب بالتطلع إلى وجهه والنظر إلى عينيه وجبينه وكل كيانه.
لقد كانت الجماهير تملأ الشوارع والميادين والدروب، وكلها تحاول الاقتراب من الإمام. ولما حاول الإمام أن يشق طريقه إلى المسجد كانت الجموع بحماستها واندفاعها تسد عليه كل طريق، فعجز عن أن يتحرك من مكانه، وخشي أن تفوت الناس صلاة العيد، فأرسل إلى المأمون من يبلغه حقيقة الواقع، وأنه لا يستطيع أن يخترق تلك الحشود الحاشدة العاكفة عليه، وأن على المأمون أن يكلف بإمامة الناس بالصلاة من كان يؤمهم من قبل.
هذا هو الصحيح فيما جرى يومذاك. لا ما أوحته عقدة الاضطهاد.
هذا ما أدى إليه بحث طويل ودراسة معمقة قمت بهما للوصول إلى الحقيقة في موضوع ولاية عهد الإمام الرضا.
وأنا أعرف حق المعرفة بأنه ليس من السهل أن أقتلع من الأذهان ما غرسته فيها قرون وقرون.
دور الكاظم والرضا (ع)
في التربية والتعليم
إن ضرورة البحث تدعو، قبل البدء في صلب الموضوع إلى أن نبين أن دور الإمامين المذكورين، رغم أهميته وخطره، لا يقارن من حيث الأهمية، بدور الإمامين الباقر وابنه الصادق في تاريخ الفكر عند الشيعة؛ وذلك لأن دور الباقر والصادق كان دور تأسيس وانتشار للفكر المذكور، كما أنه لا يقارن أيضاً بدور التوسع والانتعاش الذي بدأ بعد نهاية عصر الأئمة قبل نهاية القرن الثالث للهجرة، والذي قام به شيوخ الشيعة أمثال محمد بن مسعود العياشي (من علماء القرن الثالث) الذي أنفق، على العلم والحديث تركه أبيه كلها، وكانت ثلاثمائة ألف دينار، وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قارىء معلق مملوءة من الناس([1125]). وأمثال الشيخ الصدوق القمي (ت: 381هـ)، والشريف الرضي (ت: 406هـ)، والشيخ المفيد (ت: 413هـ)، والشريف المرتضى (ت: 436هـ) وغيرهم.
ويمكن أن نجعل الأسباب التي دعت إلى ذلك فيما يأتي:
أولاً: كانت رقابة خلفاء بني العباس المعاصرين للإمام موسى الكاظم (ع) شديدة على الشيعة بعامة، وإمامهم موسى الكاظم بخاصة؛ فضلاً عن المدة الطويلة التي قضاها موسى الكاظم في السجن. قال هشام بن سالم: «كنا بالمدينة بعد وفاة جعفر الصادق. فقعدنا في بعض أزقة المدينة.. فنحن كذلك إذ رأيت شيخاً يومىء إلي بيده، فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر المنصور، وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس على من يجتمع إليه الناس بعد الصادق فيؤخذ فيضرب عنقه([1126])، وذات مرة جاء أحدهم يسأل الإمام الكاظم كما كان يسأل أباه، قال له الإمام: «سل تخبر ولا تذع فإن أذعت فهو الذبح»([1127]).
وسأل أحدهم الإمام موسى الكاظم عن مسألة فقال: «إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل…»([1128]) وذات مرة عاتب أحد الشيعة علي الرضا وأنه فتح باب بيته للإفتاء، خلافاً لخطة أبيه موسى الكاظم، فقال: أنه ليس عليه من هارون الرشيد بأس، كما كان على أبيه.
ثانياً: انشغال علي الرضا لفترة من حياته بسياسة أمور الأمة؛ وذلك حين ولاه المأمون ولاية العهد واستقدمه لخراسان حيث توفي هناك.
ثالثاً: تجديد رقابة الخلفاء العباسيين، وخاصة المتوكل، على أئمة الشيعة المتأخرين، وحمل المتوكل الإمام العاشر من المدينة إلى سامراء، وكان هدفه أن يمنع اتصال الشيعة به([1129]).
وبالرغم من المشكلات والأحوال الشاذة القاسية التي أحاطت بحياة الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) فإنهما قاما بدور فعال في التعليم والتربية. وسنورد أمثلة على نشاطهما (عليهما السلام) في حقل التعليم خاصة.
كان إبراهيم المروزي، مؤدب أولاد السندي بن شاهك الذي أوكلت له رقابة موسى الكاظم في السجن ببغداد، يروي الحديث عن موسى الكاظم (ع) وألف كتاباً ضمنه ما سمعه من أحاديث الإمام وهو في السجن([1130]).
روى الطوسي: أن الحسن بن علي بن يقطين كان من تلامذة موسى الكاظم وله «كتاب مسائل موسى بن جعفر»([1131])، وكان علي بن جعفر شديد التمسك بأخيه موسى الكاظم (ع) والانقطاع إليه والتوفر على أخذ معالم الدين منه وله مسائل مشهورة عنه، وجوابات رواها سماعاً منه([1132]). وكان محمد بن عمير ممن «لقي موسى الكاظم وسمع منه أحاديث…»([1133]): قال الطوسي: أن «عبدالله بن موسى بن جعفر (ع) روى عن أبيه»([1134]).
وكان الحسن بن بشار المدايني قد «روى عن موسى الكاظم. لقي محمد بن عمير الأزدي موسى الكاظم وسمع منه أحاديث…»([1135]) قال النجاشي: روى بكر بن الأشعث «عن موسى بن جعفر كتاباً»([1136]). قال علي بن سويد: «كتبت إلى موسى الكاظم وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله، وعن مسائل كثيرة؛ فاحتبس الجواب عليَّ أشهراً، ثم أجابني بجواب هذه نسخته..»([1137]) روى أبو الوضاح أن أباه قال: «كان جماعة من خاصة أبي الحسن موسى الكاظم من أهل البيت وشيعته، يحضرون ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف وأميال؛ فإذا نطق أبو الحسن (ع) بكلمة وأفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا في ذلك»([1138]).
ومن الصعب تقدير الدور الذي تقوم فيه تلك الألواح من حيث هي وسيلة للتسجيل؛ لأن الألواح التي تحمل لا بد أن يكون حجمها صغيراً؛ فيصعب حينئذٍ على المسجل أن يسجل عليها مواد كثيرة، لا سيما أن ما يملى من فقه وحديث يحتاج إلى فراغ كبير.
أما الأميال([1139]) التي كانت تستعمل؛ فيبدو أنها مكونة من مادة تقوم مقام مادة الطباشير في عصرنا الحاضر.
وقد وردت أسماء طائفة كبيرة من أصحاب موسى الكاظم في كتب الرجال، ومن بينها رجال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. ورتب الشيخ الطوسي قائمة بأسماء الرجال المذكورين حسب حروف الهجاء. وبدأ الطوسي قائمة أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام بباب الهمزة الذي تضمن أربعة وثلاثين رجلاً، وتلاه بباب الباء الذي تضمن أربعة رجال، وهكذا حتى يأتي على بقية حروف الهجاء([1140]) ومن الملاحظ أن باب الميم تضمن أكبر عدد من الأسماء حيث بلغ عدد أصحاب موسى الكاظم المدرجين فيه ستة وأربعين رجلاً([1141]).
وبعد أن ينتهي الشيخ الطوسي من قائمته المرتبة حسب الحروف الأولى من أسماء أصحاب الكاظم، يلحقها بقائمة أخرى مرتبة حسب الكنى والألقاب للذين يورد أسماءهم. وكانت قائمته الأخيرة تتضمن سبعة عشر رجلاً.
ولنا ملاحظات وآراء حول قوائم الشيخ الطوسي التي أورد فيها أسماء أصحاب الكاظم:
أولاً: أن المعلومات التي أوردها الطوسي عن أصحاب الكاظم الذين ترجم لهم كانت مقتضبة إلى حد كبير. ويظهر ذلك بوضوح عندما نقارن المعلومات التي أوردها الطوسي بالمعلومات التي وردت في كتاب الرجال للنجاشي، حيث كانت المعلومات التي وردت في الكتاب الأخير أكثر اتقاناً وأغزر مادة.
ثانياً: كان الطوسي يورد أسماء عدد من الرجال دون أن يورد معلومات تساعد الباحث على دراستهم. ومن أمثلة ذلك يحيى بن عبدالرحمن، ويحيى بن عبدالله البصري، ويحيى بن سماعة الخياط، ويحيى بن الفضل النوفلي، وأبو سعيد القمَّاط، وأبو مليك وغيرهم([1142]).
ثالثاً: لقد أورد الشيخ الطوسي، أحياناً، معلومات عن بعض أصحاب الكاظم (ع) الذين ترجم لهم لها أهميتها بالنسبة لمن يدرس جهود الكاظم في التربية والتعليم.
ويبدو مما أوردناه عن جهود الكاظم في التربية والتعليم عند الشيعة، أنه رغم المشكلات التي أحاطت حياته من سجن ورقابة شديدة من خلفاء بني العباس المعاصرين له، أسهم بقسط كبير في الحقل المذكور.
أما علي الرضا فرغم انشغاله لفترة من حياته بالسياسة، أسهم هو الآخر بتبليغ رسالة العلم للشيعة إسهاماً كبيراً. قال الحسن بن موسى الوشا البغدادي: كنت بخراسان مع علي بن موسى الرضا في مجلسه وهو مقبل على قوم يلقي إليهم العلم([1143]). ويقول الحلي: إن يونس بن عبدالرحمن مولى علي بن يقطين أبو محمد… روى عن الكاظم وعن الرضا([1144]). وكان يونس هذا من تلامذة الرضا الثقاة. وذات مرة قال أحدهم للرضا (ع): إني لا ألقاك كل وقت فعن من آخذ العلم فقال: خذ من يونس بن عبدالرحمن([1145]). وكان محمد بن عمير ممن روى عن الرضا (ع)([1146]). ودخل محمد بن عيسى بن عبدالله الأشعري شيخ القميين على «علي الرضا وسمع منه»([1147]) وكان عبدالله بن سعد بن حيان من بين من لقي الرضا (ع) «وروى عنه كتاب الديات»([1148]). وروى النجاشي: أن الحسن بن الجهم الشيباني «روى عن الكاظم والرضا»([1149]): و«لعبدالله بن أحمد بن عامر الطائي نسخة رواها عن الرضا»: وكان النجاشي يقول: أنه قرأها على أستاذه أحمد بن موسى الجندي([1150]). قال الحلي: أن الحسن بن محمد بن الفضل «روى عن الرضا نسخة»([1151]). روى الصدوق: أن عبيد بن هلال قال: «سمعت الرضا يقول: إني أحب أن يكون المؤمن محدّثاً. قال قلت: وأي شيء المحدث؟ قال المُفهِّم»([1152])([1153]).
وروى الصدوق أيضاً: أن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: سمعت علي الرضا يقول رحم الله عبداً أحيا أمرنا. فقلت له: وكيف يحيى أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس.
ومن الجدير بالذكر أن إشارة وردت يستفاد منها أن الرضا كان يشير على بعض تلامذته بتلقي العلم من النابهين منهم. وكان تلميذه زكريا بن آدم الذي روى عنه الحديث من بين هؤلاء. وذات مرة قال الرضا: أنه (أي زكريا) المأمون على الدين والدنيا… وقال ابن المسبب الهمداني.. قلت للرضا: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن أتعلم؟ قال من زكريا بن آدم…([1154]).
وقد وردت أسماء طائفة كبيرة من أصحاب الرضا في كتب التراجم ومن بينها كتاب الطوسي سالف الذكر.
ورتب الطوسي قائمة بأسماء الرجال المذكورين حسب حروف الهجاء للاسم الأول للرجل دون لقبه؛ أي أنه اتبع الطريقة التي اتبعها في ترتيب سائر أصحاب الأئمة. وتضمن باب الهمزة سبعة وثلاثين رجلاً([1155])، وباب الباء ثلاثة رجال([1156])، والتاء رجلاً واحداً، بينما تضمن باب الحاء خمسة وأربعين رجلاً وتضمن باب الميم وهو أكبر الأبواب خمسة وثمانين رجلاً.
ومن الجدير بالذكر أن ملاحظاتنا التي أوردناها عند بحثنا عن المعلومات التي أوردها الطوسي عن أصحاب الكاظم (ع)، تكاد تنطبق على المعلومات التي أوردها عن أصحاب الرضا (ع)؛ من حيث قلة المعلومات التي يوردها عن الرجل المترجم له، ومن حيث فقدان المعلومات التي تساعد الباحث على دراسة أولئك الرجال.
ونختم ما قلناه عن جهود الرضا (ع) في حقل التعليم بالإشارة إلى كتاب الشيخ الصدوق القمي الموسوم بـ«عيون أخبار الرضا» والذي حوى تفصيلات وافية عن جهود الرضا (ع) في حقل التعليم والتوجيه.
الدكتور عبدالله الفياض
مُحمَّد الجواد (ع)
ولد بالمدينة ليلة الجمعة في 19 من شهر رمضان، أو للنصف منه، أو 10 من رجب يوم الجمعة.
وتوفي ببغداد في خلافة المعتصم آخر ذي القعدة يوم السبت، أو آخر ذي الحجَّة، أو لخمس، أو ست خلون منه يوم الثلاثاء سنة 220 ـ ودفن في مقابر قريش عند جده موسى الكاظم وهو ابن 25 سنة.
عاش منها مع أبيه ثماني سنين. وقيل: سبع سنين وأربعة أشهر ويومين وبعد أبيه 17 سنة. وقيل: 18 سنة إِلاَّ عشرين يوماً وهي مدة إمامته وهي بقية ملك المأمون. مات في أوائل ملك المعتصم. وقيل: في ملك الواثق وحكى الحافظ عبدالعزيز بن الأخضر الجنابذي في معالم العترة النبوية، عن محمَّد بن سعيد: أنه قتل في زمن الواثق بالله، ولعله اشتباه حصل من صلاة الواثق عليه. والصحيح: أنه توفي في خلافة المعتصم. أما الواثق فبويع له سنة 227 إلاَّ أن يكون المراد أنه سمه الواثق في خلافة المعتصم.
قال المفيد: خلف من الولد علياً ابنه وهو الإمام من بعده، وموسى وفاطمة وأمامة ابنتيه ولم يخلف ذكراً غير من سميناه. وقال ابن شهرآشوب: أولاده علي وموسى وحكيمة وخديجة وأم كلثوم وقال أبو عبدالله الحارثي: خلف فاطمة وإمامة فقط.
قال المفيد: إن المأمون كان قد شغف بالجواد لما رأى من فضله مع صغر سنه وبلوغه في الحكمة والعلم والأدب وكمال العقل؛ ما لم يساوه فيه أحد من مشائخ أهل الزمان، فزوجه ابنته وكان متوفراً على إكرامه وتعظيمه وإجلال قدره وقال الطبرسي في إعلام الورى: أنه كان (ع) قد بلغ في وقته من الفضل والعلم والحكم والآداب، مع صغر سنه منزلة لم يساوه فيها أحد من ذوي الأسنان من السادة وغيرهم؛ ولذلك كان المأمون مشغوفاً به لما رأى من علو رتبته وعظيم منزلته في جميع الفضائل، فزوجه ابنته، وكان متوفراً على إعظامه وتوقيره وتبجيله.
قال أبو الحسن البيهقي في تاريخ بيهق: أن محمَّد بن علي بن موسى الرضا عبر البحر من طريق طبس مسينا؛ لأن طريق قومس لم يكن مسلوكاً في ذلك الوقت، وهذا الطريق صار مسلوكاً من عهد قريب، فجاء من ناحية بيهق ونزل في قرية ششِتمَد، وذهب من هناك إلى زيارة أبيه في حياته سنة موته، أو قبلها بسنة، أو لزيارة قبره بعد موته للخلاف في سنة وفاته أنها سنة 202 أو 203 كما مر. ولم نر من ذكر ذلك غيره وستعرف أن المأمون استدعاه إلى بغداد بعد وفاة أبيه؛ وزوجه ابنته فإن صح ما ذكر البيهقي، فيكون قد عاد من خراسان إلى المدينة ثم منها إلى بغداد باستدعاء المأمون.
وروى ذلك المفيد في كتاب الإرشاد قال: لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمَّد بن علي بلغ ذلك العباسيين، فغلظ عليهم واستكبروه، وخافوا أن ينتهي الأمر معه إلى ما انتهى إليه مع الرضا، فخاضوا في ذلك، واجتمع إليه منهم أهل بيته الأدنون منه، وحاولوا صرفه عن ذلك ولكن المأمون أصر على ذلك. وجمع بين الجواد وبين كبار العلماء أمام العباسيين، فتبين تفوق الجواد العلمي والفكري على صغر سنه.
ولم يزل المأمون مكرماً للجواد معظماً لقدره مدة حياته يؤثره على ولده وجماعة أهل بيته. ثم أن الجواد (ع) استأذن المأمون في الحج، وخرج من بغداد متوجهاً إلى المدينة ومعه زوجته أم الفضل.
وبعد توجه الجواد إلى المدينة توفي المأمون في طرسوس وبويع أخوه المعتصم، ثم إن المعتصم طلب الجواد وأحضره إلى بغداد. قال المسعودي في إثبات الوصية: خرج أبو جعفر (ع) في السنة التي خرج فيها المأمون إلى البدندون من بلاد الروم بأم الفضل حاجاً إلى مكة، وأخرج علياً ابنه معه وهو صغير، فخلفه بالمدينة وانصرف إلى العراق ومعه أم الفضل. وتوفي المأمون بالبدندون يوم الخميس 13 رجب سنة 218، وبويع المعتصم بن هارون في شعبان سنة 218، فلما انصرف أبو جعفر إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبرون ويعملون الحيلة في قتله؛ ولكن المفيد صرح بأن ذلك كان في المحرم سنة 220 قال المفيد: فورد بغداد لليلتين بقيا من المحرم سنة 220 وتوفي بها في ذي القعدة من هذه السنة، ولكنه قال قبل ذلك: أنه لم يزل بالمدينة إلى أن أشخصه المعتصم في أول سنة 225 إلى بغداد فأقام بها حتى توفي في آخر ذي القعدة من هذه السنة.
(أقول): قوله أولاً أنه أشخصه سنة 225 مع منافاته لما ذكره، ثانياً من أن إشخاصه كان سنة 220؛ مناف لما اتفق عليه الكل، ومنهم المفيد من أن وفاته كانت سنة 220؛ فالظاهر أنه من سهو القلم، أَو من النساخ.
كيفية وفاته
في روضة الواعظين: مات ببغداد قتيلاً مسموماً، وقال ابن بابويه: سمه المعتصم. وقال ابن شهرآشوب: مات مسموماً وقال المفيد: قيل أنه مضى مسموماً، ولم يثبت عندي بذلك خبر فأشهد به.
علي الهادي (ع)
ولد سنة 214 بقرية صريا وهي قرية أسَّسها موسى بن جعفر على ثلاثة أميال من المدينة.
وتوفي بسامراء سنة 254 في خلافة المعتز، فيكون عمره أربعين سنة إلاَّ أياماً وستة أشهر. وقيل: وسبعة أشهر.. أقام منها مع أبيه ست سنين وخمسة أشهر، وبعد أبيه 33 سنة وشهوراً. ويقال: وتسعة أشهر وهي مدة إمامته وهي بقية ملك المعتصم ثم الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز، واستشهد في آخر ملك المعتمد ومدة مقامه بسامراء: عشرون سنة وأشهر ودفن بداره في سامراء.
اشتهر بالهادي وبالنقي، وعرف هو وابنه الحسن بالعسكري. قال الصدوق: إن المحلة التي يسكنها الإمامان علي بن محمَّد والحسن بن علي بسامراء كانت تسمى (عسكر)؛ فلذلك قيل لكل واحد منهما العسكري. وفي أنساب السمعاني: العسكري نسبة إلى عسكر سامراء الذي بناه المعتصم لما كثر عسكره، وضاقت عليه بغداد، وتأذَّى به الناس فانتقل إلى هذا الموضع بعسكره وسميت العسكر: لأن عسكر المعتصم نزل بها وذلك في سنة 221 وهو يدل على أن (عسكر) اسم لمجموع سامراء.
خلف من الأولاد الحسن والحسين ومحمَّداً توفي في حياة أبيه وجعفراً، وهو الذي ادعى الإمامة بعد وفاة أخيه الحسن العسكري، وعرف بجعفر الكذاب وابنة واحدة.
مجيء الهادي (ع) من المدينة إلى سامراء.
قال سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص: إنما أشخصه المتوكل من المدينة إلى بغداد؛ لأن المتوكل كان يبغض علياً وذريته، فبلغه مقام علي الهادي بالمدينة، وميل الناس إليه، فخاف منه، فدعا يحيى بن هرثمة، وقال: اذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا، قال يحيى: فذهبت إلى المدينة فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجاً عظيماً ما سمع الناس بمثله خوفاً على علي، وقامت الدنيا على ساق؛ لأنه كان محسناً، فجعلت أسكِّنهم وأحلف لهم إني لم أؤمر فيه بمكروه، وإنه لا بأس عليه ثم فتشت منزله فلم أجد فيه إلاَّ مصاحف وأدعية وكتب العلم، فعظم في عيني وتوليت خدمته بنفسي وأحسنت عشرته.
وقال سبط ابن الجوزي: قال يحيى: لما قدمت به بغداد بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري وكان والياً على بغداد فقال لي: يا يحيى إن هذا الرجل قد ولده رسول الله (ص)، والمتوكل من تعلم فإن حرضته عليه قتله، وكان رسول الله (ص) خصمك يوم القيامة فقلت له: والله ما وقفت منه إلاَّ على كل أمر جميل، ثم سرت إلى سامراء، فبدأت بوصيف التركي فأخبرته بوصوله فقال: والله لئن سقط منه شعرة لا يطالب بها سواك، فعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق. فلما دخلت على المتوكل سألني عنه فأخبرته بحسن سيرته وسلامة طريقته وورعه وزهادته، وإني فتشت داره فلم أجد فيها غير المصاحف وكتب العلم، وإن أهل المدينة خافوا عليه فأكرمه المتوكل وأحسن جائزته. قال المسعودي: لما خرج الهادي إلى سامراء تلقاه جملة أَصحاب المتوكل، حتى دخل عليه فأعظمه وأكرمه ثم انصرف عنه إلى دار قد أعدت له. قال المفيد: خرج معه يحيى بن هرثمة حتى وصل إلى سامراء، فلما وصل إليها تقدم المتوكل بأن يحجب عنه في يومه، فنزل في خان يعرف بخان الصعاليك وأقام فيه يومه، ثم تقدم المتوكل بإفراد دار له فانتقل إليها. وأقام أبو الحسن (ع) مدة مقامه بسامراء مكرماً في ظاهر حاله، فجهد المتوكل في إيقاع حيلة به فلا يتمكن من ذلك، ويروي ابن بابويه: أن المعتمد سمه.
الحسن العسكري (ع)
قال المفيد: وقال المسعودي في إثبات الوصية: ولد بالمدينة. وقيل: ولد بسامراء والصحيح: الأول، يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الآخر. وقيل: يوم اثنين رابعه. وقيل: في العاشر منه. وقيل: في ربيع الأول سنة 231 أو 232 للهجرة. وقال المسعودي في إثبات الوصية: وشخص إلى العراق بشخوص والده إليها وله أربع سنين وشهور.
وتوفي بسامراء 8 ربيع الأول. وقيل: أول يوم منه سنة 260 مرض في أوله وبقي مريضاً ثمانية أيام وتوفي. وعمره 29 أو 28 سنة أقام منها مع أبيه 23 سنة وأشهراً، وبعد أبيه خمس سنين وشهوراً، وقيل: ثمانية أشهر و13 يوماً وقيل: ست سنين وهي مدة إمامته وهي بقية ملك المعتز أشهراً، ثم ملك المهتدي 11 شهراً و28 يوماً، وتوفي بعد مضي خمس سنين من ملك المعتمد، ودفن في داره بسامراء إلى جنب قبر أبيه.
وفي مناقب ابن شهرآشوب، وإعلام الورى: كان الحسن العسكري هو وأبوه وجده يعرف كل منهم في زمانه بابن الرضا. وقال الحافظ عبدالعزيز بن الأخضر الجنابذي: يلقب بالعسكري ومر في سيرة أبيه أنه كان يعرف أيضاً بالعسكري لسكناهما في محلة تعرف بالعسكر.
يدل جملة من الأخبار على أن المتوكل كان قد حبسه ولم يذكر سبب ذلك، ولا شك أن سببه العداوة والحسد وقبول وشاية الواشين كما جرى لآبائه مع المتوكل وآبائه من التشريد عن الأوطان والحبس والقتل وأنواع الأذى.
وروي أنه مات مسموماً، سمه المعتمد.
محمَّد بن الحسن المهدي (ع)
ولد سنة 255 بسامراء في أيام المعتمد. ولم يخلف أبوه ولداً غيره. وكانت سنه عند وفاة أبيه خمس سنين. وكان سفراؤه في الغيبة الصغرى: عثمان بن سعيد، ثم ابنه محمَّد بن عثمان، ثم الحسين بن روح، ثم علي بن محمَّد السمري. وكان بين مولده وانقطاع السفارة أربع وسبعون سنة.
دور الأئمة في الحياة الإسلامية
أود أن أجعل من هذه المناسبة مجالاً للتعبير عن اتجاه معين في دراسة حياة الأئمة. ولن يتسع لحديثي في حدود هذه الفرصة أن يرسم اتجاهاً معيناً ويجسده أو يخطط له، وإنما كل ما أحاوله هو إثارة التفكير حول هذا الاتجاه، وإعطاء بعض الملامح العامة عن حياة الأئمة.
وهذا الاتجاه الذي أريد أن أتحدث عنه هو الاتجاه الي يتناول حياة كل إمام، ويدرس تاريخه على أساس النظرة الكلية بدلاً من النظرة التجزئية. أي ينظر إلى الأئمة ككل مترابط، ويدرس هذا الكل ويكتشف ملامحه العامة وأهدافه المشتركة، ومزاجه الأصيل، ويفهم الترابط بين خطواته، وبالتالي الدور الذي مارسه الأئمة جميعاً في الحياة الإسلامية.
ولا أريد بهذا أن نرفض دراسة الأئمة على أساس النظرة التجزئية؛ أي دراسة كل إمام بصورة مستقلة؛ بل أن هذه الدراسة التجزئية نفسها ضرورة؛ لإنجاز دراسة شاملة للأئمة ككل؛ إذ لا بد لنا أولاً أن ندرس الأئمة بصورة مجزأة ونستوعب إلى أوسع مدى ممكن حياة كل إمام؛ بكل ما تزخر به من ملامح وأهداف ونشاط، حتى نتمكن بعد هذا أن ندرسهم ككل، ونستخلص الدور المشترك للأئمة جميعاً، وما يعبر عنه من ملامح وأهداف وترابط.
وإذا قمنا بدراسة الأئمة على هذين المستويين فسوف نواجه على المستوى الأول اختلافاً في الحالات، وتبايناً في السلوك، وتناقضاً من الناحية الشكلية بين الأدوار التي مارسها الأئمة فالحسن (ع) هادن معاوية، بينما حارب الحسين (ع) يزيد حتى قتل، وحياة علي بن الحسين السجاد (ع) طافحة بالدعاء، بينما كانت حياة الباقر (ع) طافحة بالحديث والفقه، وأما على المستوى الثاني حين نحاول اكتشاف الخصائص العامة والدور المشترك للأئمة ككل، فسوف تزول كل تلك الاختلافات والتناقضات؛ لأنها تبدو على هذا المستوى مجرد تعابير مختلفة عن حقيقة واحدة. وإنما اختلف التعبير عنها وفقاً لاختلاف الظروف والملابسات التي مر بها كل إِمام، وعاشتها القضية الإِسلامية والشيعية في عصره، عن الظروف والملابسات التي مرت بالرسالة في عهد إمام آخر.
ويمكننا عن طريق دراسة الأئمة على أساس النظرة الكلية أن نخرج بنتائج أضخم من مجموع النتائج التي تتمخض عنها الدراسات التجزئية. لأننا سوف نكتشف الترابط بين أعمالهم. وسوف أستخدم مثالاً بسيطاً لتوضيح الفكرة: فنحن نقرأ في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه جمع الصحابة في خلافته واستشهدهم على نصوص الإمامة فشهد عدد كبير بالسماع من الرسول الأعظم، ونقرأ في حياة الإمام الحسين أنه جمع على عهد معاوية من تبقى من الصحابة والمهاجرين وعدداً كبيراً من التابعين وطلب منهم أن يحدثوا بنصوص النبي (ص) في علي وأهل البيت. ونقرأ في حياة الإمام الباقر أنه قام بنفس العملية واستشهد التابعين وتابعي التابعين. وحين ندرس الأئمة ككل ونربط بين هذه النشاطات بعضها ببعض، ونلاحظ أن العمليات الثلاث وزعت على ثلاثة أجيال نجد أنفسنا أمام تخطيط مترابط يكمل بعضه بعضاً، يستهدف الحفاظ على تواتر النصوص عبر أجيال عديدة، حتى تصبح في مستوى من الوضوح والاشتهار يتحدى كل مؤامرات الإخفاء والتحريف.
وفي عقيدتي أن وجود دور مشترك مارسه الأئمة جميعاً ليس مجرد افتراض نبحث عن مبرراته التاريخية وإنما هو مما تفرضه العقيدة نفسها وفكرة الإمامة بالذات؛ لأن الإمامة واحدة في الجميع بمسؤولياتها وشروطها، فيجب أن تنعكس انعكاساً واحداً في سلوك الأئمة وأدوارهم مهما اختلفت ألوانها الظاهرية بسبب الظروف والملابسات، ويجب أن يشكل الأئمة مجموعهم وحدة مترابطة الأجزاء يواصل كل جزء في تلك الوحدة دور الجزء الآخر ويكمله.
ما هو الدور المشترك للأئمة؟
وقد لا نحتاج إلى شيء من البحث لكي نتفق بسرعة على نوعية الدور المشترك الذي أسند إلى الأئمة في تخطيط الرسالة، فكلنا نعلم أن الرسالة الإسلامية بوصفها رسالة عقائدية قد خططت لحماية نفسها من الانحراف، وضمان نجاح التجربة خلال تطبيقها على مر الزمن، فأوكلت أمر قيادة التجربة وتنويرها تشريعياً، وتوجيهها سياسياً، إلى الأئمة بوصفهم الأشخاص العقائديين الذين بلغوا في مستواهم العقائدي أعلى الدرجات.
غير أننا حين نحاول أن نحدد الدور المشترك الذي مارسه الأئمة ككل في تاريخهم المرير، لا نعني هذا الدور القيادي في تزعم التجربة الإسلامية؛ لأننا نعلم جميعاً أن الأحداث المؤلمة التي وقعت بعد وفاة الرائد الأعظم النبي محمَّد (ص) قد أقصت الأئمة عن دورهم القيادي في تزعم التجربة، وسلمت مقاليد الرسالة ومسؤولية تطبيقها إلى أشخاص آخرين انحرف معهم التطبيق واشتد الانحراف على مر الزمن.
وإنما نريد بالدور المشترك في تاريخ الأئمة الموقف العام الذي وقفوه في خضم الأحداث والمشاكل التي اكتنفت الرسالة، بعد انحراف التجربة وإقصائهم عن مركزهم القيادي في زعامتها.
وهنا نجد تصوراً شائعاً لدى كثير من الناس الذين اعتادوا أن يفكروا في الأئمة بوصفهم أناساً مظلومين فحسب، قد أقصوا عن مركز القيادة وأقرت الأمة هذا الإقصاء، وذاقوا بسبب ذلك ألوان الاضطهاد والحرمان. فهؤلاء الناس يعتقدون أن دور الأئمة في حياتهم كان دوراً سلبياً على الأغلب. نتيجة لإقصائهم عن مجال الحكم فحالهم حال من يملك داراً فتغصب منه، وينقطع إمله في إمكان استرجاعها.
وهذا التفكير بالرغم من أنه خاطىء يعتبر خطراً من الناحية العملية؛ لأنه يحبب إلى الإنسان السلبية والانكماش والابتعاد عن مشاكل الأمة ومجالات قيادتها. ولهذا أعتقد أن من ضروراتنا الإسلامية الراهنة أن نثبت خطأ ذلك التفكير، وندرس حياة الأئمة على أساس نظرة كلية؛ لنتبين إيجابيتهم الرسالية على طول الخط ودورهم المشترك الفعال في حماية الرسالة والعقيدة.
إن الأئمة (عليهم السلام) بالرغم من التآمر على إقصائهم عن مجال الحكم، كانوا يتحملون باستمرار مسؤوليتهم في الحفاظ على الرسالة، وعلى التجربة الإسلامية وتحصينها ضد التردي إلى هاوية الانحراف، والانسلاخ من مبادئها وقيمها انسلاخاً تاماً. فكلما كان الانحراف يطغى ويشتد وينذر بخطر التردي إلى الهاوية، كان الأئمة يتخذون التدابير اللازمة ضد ذلك. وكلما وقعت التجربة الإسلامية أو العقيدة في محنة أو مشكلة، وعجزت الزعامات المنحرفة عن علاجها؛ بحكم عدم كفاءتها بادر الأئمة إلى تقديم الحل، ووقاية الأمة من الأخطار التي كانت تهددها.
وبكلمة مختصرة كان الأئمة يحافظون على المقياس العقائدي والرسالي في المجتمع الإسلامي، ويحرصون على أن لا يهبط إلى درجة تشكل خطراً ماحقاً، وهذا يعني ممارستهم جميعاً دوراً إيجابياً فعالاً في حماية العقيدة وتبنّي مصالح الرسالة والأمة.
تمثل هذا الدور الإيجابي في إيقاف الحاكم عن المزيد من الانحراف، وتمثل في تعرية الزعامة المنحرفة إذا أصبحت تشكل خطراً ماحقاً ولو عن طريق الاصطدام المسلح بها، والشهادة في سبيل كشف زيفها وشل تخطيطها كما صنع الإمام الحسين مع يزيد.
وتمثل في مجابهة المشاكل التي تهدد كرامة الدولة الإسلامية، وتعجز الزعامات المنحرفة عن حلها، كما في المشكلة التي أحدثها كتاب ملك الروم إلى عبدالملك بن مروان؛ إذ عجز عبدالملك عن الجواب على كتاب في مستواه، فملأ علي بن الحسين زين العابدين هذا الفراغ، وأجاب بالشكل الذي يحفظ للدولة كرامتها وللأمة الإسلامية هيبتها.
وتمثل في إنقاذ الدولة الإسلامية من تحد كافر يهدد سيادتها، كالتحدي الذي واجهه عبدالملك من الروم بشأن النقد وعجز عن الرد عليه. وكان محمَّد الباقر في مستوى الرد على هذا التحدي، فخطط للاستقلال النقدي.
وتمثل الدور الإيجابي للأئمة أيضاً في تلك المعارضة القوية العميقة التي كان الأئمة يواجهون بها الزعامات المنحرفة، بإرادة صلبة لا تلين، وقوة نفسية صامدة لا تتزعزع، فإن هذه المعارضة بالرغم من أنها اتخذت مظهر السلبية والمقاطعة في أكثر الأحايين. بدلاً عن مظهر الاصطدام الإيجابي والمقابلة المسلحة؛ غير أن المعارضة حتى بصيغتها السلبية كانت عملاً إيجابياً عظيماً في حماية الإسلام والحفاظ على مُثُله وقيمه؛ لأن انحراف الزعامات القائمة كان يعكس الوجه المشوه للرسالة، فكان لا بد للقادة من أهل البيت أن يعكسوا الوجه النقي المشرق لها، وأن يؤكدوا عملياً باستمرار المفارقات بين الرسالة والحكم الواقع. وهكذا خرج الإسلام على مستوى النظرية سليماً من الانحراف وإن تشوهت معالم التطبيق.
ويمكنني أن أذكر بهذا الصدد مثالاً جزئياً؛ ولكنه يعبر عن مدى الجهود التي بذلها الأئمة في سبيل الحصول على هذا المكسب: تصوروا أن موسى الكاظم سجين قد هدّ السجن صحته وأذاب جسمه، حتى أصبح حين يسجد لربه كالثوب المطروح على الأرض، فيدخل عليه رسول الزعامة المنحرفة فيقول: إن الخليفة يعتذر إليك، ويأمر بإطلاق سراحك على أن تزوره وتعتذر إليه، أو تطلب رضاه، فيشمخ الإمام وهو يجيب بالنفي بكل صراحة، ويتحمل مرارة الكأس إلى الثمالة لا لشيء إلاَّ لكي لا يحقِّق للزعامة المنحرفة هدفها في أن يبارك الإمام خطها، فتنعكس معالم التشويه نفسها.
وتمثل الدور الإيجابي للأئمة في تموين الأمة العقائدية بشخصيتها الرسالية والفكرية من ناحية، ومقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطراً على الرسالة وضربها في بدايات تكونها، من ناحية أخرى. وللإمام من علمه المحيط المستوعب ما يجعله قادراً على الإحساس بهذه البدايات، وتقدير أهميتها ومضاعفاتها، والتخطيط للقضاء عليها، وقد نفسر على هذا الضوء اهتمام الحسن العسكري وهو في المدينة بمشروع كتاب يصنفه الكندي وهو في العراق حول متناقضات القرآن؛ إذ اتصل به عن طريق بعض المنتسبين إلى مدرسته، وأحبط المحاولة، وأقنع مدرسه الكندي بأنها على خطأ.
الإيجابية تنكشف في علاقات الأئمة بالأُمَّة
وفي الواقع إن حياة الأئمة زاخرة كلها بالشواهد على إيجابية الدور المشترك الذي كانوا يمارسونه، فمن ذلك: علاقات الأئمة بالأُمَّة والزعامة الجماهيرية الواسعة النطاق التي كان إمام أهل البيت يتمتع بها على طول الخط؛ فإن هذه الزعامة لم يكن أمام أهل البيت يحصل عليها صدفة، أو على أساس مجرد الانتساب إلى الرسول ـ والمنتسبون إلى الرسول كثر ـ بل على أساس العطاء، والدور الإيجابي الذي يمارسه الإمام في الأُمَّة؛ بالرغم من إقصائه عن مركز الحكم فإن الأُمَّة لا تمنح على الأغلب الزعامة مجاناً، ولا يمتلك الفرد قيادتها ويحتل قلوبها بدون عطاء سخي منه تستشعره الأُمَّة في مختلف مجالاتها، وتستفيد منه في حل مشكلاتها والحفاظ على رسالتها.
إن تلك الزعامة الواسعة التي كانت نتيجة لإيجابية الأئمة في الحياة الإسلامية هي التي جعلت من علي (ع) المثل الأعلى للثوار الذين قضوا على حكم عثمان، وهي التي كانت تتمثل في مختلف العلاقات التي عاشها الأئمة مع الأُمَّة.
انظروا إلى موسى الكاظم كيف يقول لهارون الرشيد؟: أنت إمام الأجسام وأنا إمام القلوب.
انظروا إلى عبدالله بن الحسن، حين أراد أن يأخذ البيعة لابنه محمَّد كيف يقول لجعفر الصادق: (واعلم أنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أحد من أصحابك، ولم يختلف علي اثنان من قريش، ولا غيرهم) ولاحظوا مدى ثقة الأُمَّة بقيادة الأئمة من أهل البيت نتيجة لما يعيشونه من دور إيجابي في حماية الرسالة ومصالح الأُمَّة.
لاحظوا المناسبة الشهيرة التي أنشد فيها الفرزدق قصيدته في علي بن الحسين زين العابدين. كيف أن هيبة الحكم وجلال السلطان لم يستطع أن يشق لهشام طريقاً لاستلام الحجر بين الجموع المحتشدة من أفراد الأُمَّة في موسم الحج؟ بينما استطاعت زعامة أئمة أهل البيت أن تكهرب تلك الجماهير في لحظة وهي تحس بمقدم الإمام القائد تشق الطريق بين يديه نحو الحجر.
لاحظوا قصة الهجوم الشعبي الهائل الذي تعرض له قصر المأمون نتيجة لإغضابه علي الرضا، فلم يكن للمأمون مناص عن الالتجاء إلى الإمام لحمايته من غضب الأُمَّة فقال له الإمام: «اتق الله في أمة محمَّد وما ولاك من هذا الأمر وخصك به؛ فإنك قد ضيعت أمور المسلمين، وفوضت ذلك إلى غيرك يحكم فيها بغير حكم الله عزَّ وجلَّ».
إن كل هذه النماذج والمظاهر للزعامة الشعبية التي عاشها أئمة أَهل البيت على طول الخط تبرهن على إيجابيتهم وشعور الأُمَّة دورهم الفعال في حماية الرسالة.
الإيجابية تنكشف في علاقات الأئمة بالحكام
ويمكننا أن ننظر من زاوية جديدة لنصل إلى نفس النتيجة من زاوية علاقات الزعامات المنحرفة مع أئمة أَهل البيت على طول الخط، فإن هذه العلاقات كانت تقوم على أساس الخوف الشديد من نشاط الأئمة ودورهم في الحياة الإسلامية حتى يصل الخوف لدى الزعامات المنحرفة أحياناً إلى درجة الرعب، وكان محصول ذلك باستمرار تطويق إمام الوقت بحصار شديد، ووضع رقابة محكمة عليه، ومحاولة فصله عن قواعده الشعبية، ثم التآمر على حياته ووفاته شهيداً بقصد التخلص من خطره. فهل كان من الصدفة أو مجرد تسلية أن تتخذ الزعامات المنحرفة كل هذه الإجراءات تجاه أئمة أَهل البيت بالرغم من أنها تكلفها ثمناً باهظاً من سمعتها وكرامتها؟ أو كان كل ذلك نتيجة لشعور الحكام المنحرفين بخطورة الدور الإيجابي الذي يمارسه أئمة أهل البيت؟ وإلاَّ فلماذا كل هذا القتل والتشريد والنفي والسجن؟
هل كان الأئمة يحاولون استلام الحكم
يبقى سؤال واحد قد يتبادر إلى الأذهان وهو أن إيجابية الأئمة هل كانت تصل إلى مستوى العمل لاستلام زمام الحكم من الزعامات المنحرفة؟ أو تقتصر على حماية الرسالة ومصالح الأُمَّة من التردي إلى الهاوية وتفاقم الانحراف؟
والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى توسع في الحديث يضيق عنه هذا المجال. غير أن الفكرة الأساسية في الجواب المستخلصة من نصوص وأحاديث عديدة: أن الأئمة لم يكونوا يرون الظهور بالسيف والانتصار المسلح آنياً، كافياً لإقامة دعائم الحكم الصالح على يد الإمام. إن إقامة هذا الحكم وترسيخه لا يتوقف في نظرهم على مجرد تهيئة حملة عسكرية، بل يتوقف قبل ذلك على إعداد جيش عقائدي يؤمن إيماناً مطلقاً، ويعي أهدافه الكبيرة، ويدعم تخطيطه في مجال الحكم، ويحرس ما يحققه للأُمَّة من مكاسب.
وعلى هذا الأساس استلم علي بن أبي طالب زمام الحكم في وقت توفر فيه ذلك الجيش العقائدي الواعي متمثلاً في الصفوة من المهاجرين والأنصار والتابعين من أصحابه.
رعاية الشيعة بوصفها الكتلة المؤمنة بالإمام.
عرفنا أن الدور المشترك الذي كان الأئمة يمارسونه في الحياة الإسلامية، هو دور الوقوف في وجه المزيد من الانحراف، وإمساك المقياس عن التردي إلى الحضيض والهبوط إلى الهاوية.
غير أن هذا في الحقيقة يعبر عن بعض ملامح الدور المشترك، وهناك جانب آخر في هذا الدور المشترك لم نشر إليه حتى الآن وهو جانب الإشراف المباشر على الشيعة بوصفهم الجماعة المرتبطة بالإمام، والتخطيط لسلوكها، وحماية وجودها، وتنمية وعيها، وإمدادها بكل الأساليب التي تساعد على صمودها، وارتفاعها إلى مستوى الحاجة الإسلامية إلى جيش عقائدي وطليعة واعية.
ولدينا عدد كبير من الشواهد من حياة الأئمة على أنهم كانوا يباشرونه نشاطاً واسعاً في مجال الإشراف على الكتلة المرتبطة بهم، حتى أن الإشراف كان يصل أحياناً إلى درجة تنظيم أساليب لحل الخلافات الشخصية بين أفراد الكتلة، ورصد الأموال لها كما يحدِّث بذلك المعلى بن خنيس عن الإمام جعفر الصادق (ع).
وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفهم عدداً من نصوص الأئمة بوصفها تعليم أساليب للجماعة التي يشرفون على سلوكها، وقد تختلف الأساليب باختلاف ظروف الشيعة والملابسات التي يمرون بها.
محمد باقر الصدر
- () الذين ترجموا دائرة المعارف الإسلامية إلى اللغة العربية علقوا على ما رأوه من أباطيل تتعلق بهم، واشركوا معهم في ذلك أباضياً، ولم يشركوا شيعياً، مع أن نصيب الشيعة فيها من الأضاليل والأباطيل والافتراءات أوفى نصيب. ↑
- () يمكن أن تستثني من ذلك موسوعة (أعيان الشيعة) التي عنيت بذلك (ح). ↑
- () وكذلك (الدروز) الذين نسبوا إلى (الدرزي) وهو اسم بغيض إليهم (ح). ↑
- () لسان العرب، بولاق 1301هـ 9/54. ↑
- () لسان العرب، بولاق 1301هـ 9/54. ↑
- () لسان العرب، بولاق 1301هـ 9/54. ↑
- () لسان العرب، بولاق 1301هـ 9/54. ↑
- () لسان العرب، بولاق 1301هـ 9/54. ↑
- () لسان العرب، بولاق 1301هـ 9/54. ↑
- () لسان العرب، بولاق 1301هـ 9/54. ↑
- () القاموس المحيط، ط2، مصر 1371هـ/ 1952م، 3-49، ويلاحظ أن الكلمة المذكورة مستمدة من قول الخليل بن أحمد الفراهيدي (100 – 170هـ/ 718-781م) من معنى العبارة «أشعت الشمس» بأنها «نشرت شعاعها وهو ما ترى كالرماح ويجمع على شع وأشعة» (العين، تحقيق الدكتور عبد الله درويش، بغداد 1386هـ/1967م) «نشرت شعاعها» مهمة جداً في مجالنا هذا. ↑
- () مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، مصر 1366، 1371هـ، 3/35. ↑
- () المفردات في غريب القرآن، مصر 1324هـ، ص72. ↑
- () النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر الزاوي، ومحمد أحمد الطناحي، مصر 1963م 2/520. ↑
- () مجمع البيان في تفسير القرآن، ط. طهران، 4/388. ↑
- () تهذيب اللغة للأزهري (أبي منصور محمد بن أحمد، 282 – 370هـ/ 895-980م) تحقيق د. عبد الحليم النجار، مطابع سجل العرب بمصر، بلا تاريخ، 3/62. مجمع البيان 4/388. ↑
- () مقاييس اللغة 3/235، القاموس المحيط للفيروزآبادي، 3/47. ↑
- () الجمهرة لابن دريد (أبي بكر محمد بن الحسين الأزدي، ت 321هـ/933م، حيدر آباد 1345هـ/3/63. ↑
- () مقاييس اللغة 3/235، الحور العين لابن نشوان الحميري (أبي سعيد نشوان بن سعيد، ت573هـ: 1177م)، تحقيق كمال مصطفى، مصر 1948، وفيه نسبة البيت إلى عمر، ونسبه كذلك إليه عبد السلام هارون في هامش المقاييس وأحال إلى ديوانه، ص106. ↑
- () الحور العين ص179، مقاييس اللغة 3/535، القاموس المحيط 3/47، وقد ذكر ابن نشوان الشوع فقط وقواه الفيروزآبادي بقوله: «هذا شيع، هذا شوعة أو مثله» ودلالة المتن أمتن من هذا الرأي. ↑
- () الحور العين ص179، مقاييس اللغة 3/535، القاموس المحيط 3/47، وقد ذكر ابن نشوان الشوع فقط وقواه الفيروزآبادي بقوله: «هذا شيع، هذا شوعة أو مثله» ودلالة المتن أمتن من هذا الرأي. ↑
- () الفائق في غريب الحديث للزمخشري (جار الله محمود بن عمر بن محمد، 467 – 538هـ/1074-1144م)، حيدر آباد 1324هـ. ↑
- () مقاييس اللغة 3/235، الحور العين ص179، وقد جاء الشطر الثاني فقط من مقاييس اللغة، والنيب هي النوق المسنات. ↑
- () مقاييس اللغة 3/235، الحور العين ص179، وقد جاء الشطر الثاني فقط من مقاييس اللغة، والنيب هي النوق المسنات. ↑
- () مقاييس اللغة 3/235، الحور العين ص179، وقد جاء الشطر الثاني فقط من مقاييس اللغة، والنيب هي النوق المسنات. ↑
- () النهاية في غريب الحديث 2/520. ↑
- () الحور العين ص180. ↑
- () مجمع البيان في تفسير القرآن 4/388. ↑
- () لسان العرب 9/54. ↑
- () مجمع البيان 7/239. ↑
- () المفردات للراغب الأصفهاني ص272. ↑
- () الحور العين ص178، وانظر قول ابن منظور »والشيعة أتباع الرجل وأنصاره… ويقال شايعه كما يقال والاه من الولي» (اللسان 9/54) وقوا الفيروآبادي «وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره والفرقة على حدة» (القاموس 3/ 47). ↑
- () الحور العين ص178, وانظر قول ابن منظور »والشيعة أتباع الرجل وأنصاره… ويقال شايعه كما يقال والاه من الولي» (اللسان 9/54) وقوا الفيروآبادي «وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره والفرقة على حدة» (القاموس 3/ 47). ↑
- () الحور العين ص179. ↑
- () المفضليات للضبي (المفضل بن محمد بن يعلى الكوفي نحو 178هـ/ 794م) تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، مصر 1964م، القصيدة رقم 39، ص189، وانظر هامش المحققين. ↑
- () الجمهرة 3/63. ↑
- () الجمهرة 3/63. ↑
- () الجمهرة 3/63. ↑
- () القاموس المحيط للفيروزآبادي، شركة فن الطباعة، ط5، مصر 1333هـ/1913م، 3/847. ↑
- () تهذيب اللغة 3/36، ونقل ابن منظور هذه العبارة في اللسان (90/54). ↑
- () قال ذلك ابن أبي زينب (محمد بن إبراهيم الكاتب النعماني، تلميذ الكليني: محمد بن يعقوب، ت329هـ/939م، في كتابه: الغيبة، ط. رقم 1347هـ، ص5. وذكره إخوان الصفا في رسائلهم التي نشروها في البصرة في نحو سنة 352هـ/ 963م، القاهرة 1347هـ/1928م، 4/198-199. وانظر هذه النصوص وغيرها في كتابنا «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» بغداد 1386هـ/1966، ص429 – 430 وانظر التفصيل في الكتاب نفسه، ص57 – 62. ↑
- () كتاب الزينة في الألفاظ الإسلامية، مخطوط المتحف العراقي ببغداد في موضوع «ذكر ألقاب الفرق في الإسلام». ↑
- () كتاب الزينة في الألفاظ الإسلامية، مخطوط المتحف العراقي ببغداد في موضوع «ذكر ألقاب الفرق في الإسلام». ↑
- () سورة الأنعام، الآية: 159، وسيرد إحصاء الآيات التي تتضمن كلمة: شيعة وجَمْعَيْها في فقرة خاصة. ↑
- () تحصيل نظائر القرآن ص134. ↑
- () الأزمنة والأمكنة للمرزوقي (أبي علي أحمد بن محمد الأصبهاني، ت 421هـ/ 1030م) حيدر آباد 1332هـ، 2/ 226. ↑
- () ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس بن جندل، ت7هـ/ 628م) شرح وتعليق الدكتور م. محمد حسين، قطعة 13، البيت 22، ص139. ↑
- () أيضاًً 64، البيت: 2، ص355، والأقتار: ساعة الجدب. ↑
- () شرح القصائد السبع الطوال الجاهلية لابن الأنباري (أبي بكر محمد بن القاسم، 271 – 328ﻫ/ 884 – 939م) تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف بمصر 1963م، ص362، معلقة عنترة، البيت رقم: 74. وللأعشى بيتان يتضمنان الاستعمال الفعلي لهذه الكلمة، وذلك في قوله:
كللت مجهودها نفسي وشايعني همي عليها إذا ما آلها لمعا() وقوله:
فشايعها ما أبصرت تحت درعها على صومنا، واستعجلتها أناتُها (ديوان الأعشى الكبير، قطعة 13، البيت 24، ص139. والقطعة 64، البيت 30، ص355) وشايعني بمعنى: قواني وشجعني. والآل: السراب. والصوم: القطيعة. ↑
- () انظر: أصل الشيعة وأصولها، للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ط9، ص87 عن ابن عساكر. وينقل عن الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي حديثا نصه: «يا علي، أنت وأصحابك في الجنة» (أيضاً ص87) والأصحاب هنا تعني الشيعة كما لا يخفى. ↑
- () النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 2/520. ↑
- () النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 2/520. ↑
- () النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 2/520. ↑
- () النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 2/520. ↑
- () النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 2/520. ↑
- () النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 2/520. ↑
- () النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 2/520. ↑
- () سنن النسائي، كتاب قيام الليل، الحديث 16. ↑
- () مسند ابن حنبل، مصر 3/46 و 156، 4/124، 5/130 و248 و6/ 396. وسنن ابن ماجه، كتاب الفتن، الحديثان 9 و 35. ↑
- (10) أيضاً 5/269. ↑
- (10) أيضاً 2/219. ↑
- (11) أيضاً 5/407، سنن الدرامي سنة 16. ↑
- () أيضاً 2/67، سنن الدرامي، كتاب الصلاة، الحديث16. ↑
- () النهاية 2/519، وانظر لسان العرب مادة شيع (ط. مصر 8/189). ↑
- () دعائم الإسلام للقاضي المغربي (أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي، ت 363هـ/ 974م) تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي، دار المعارف 1383هـ/ 1963م. ↑
- () كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (الحسن بن علي بن سهل، ت 395هـ/ 1004-1005م) ط2، مطبعة محمد صبيح بمصر بلا تاريخ، ص112. ↑
- () تاريخ الأمم والملوك للطبري (محمد بن جرير، ت310هـ/ 920م)، بعناية دي غويه، ليدن 1879-1901م، 1/196م. ↑
- () الفرق بين الفرق، البغدادي (أبي منصور عبد القاهر بن طاهر، ت429هـ/ 1038م)، تحقيق محمد يحيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني بالقاهرة، بلا تاريخ، ص53. ↑
- () خزانة الأدب للبغدادي (عبد القادر بن أحمد، 1030- 1093هـ/ 1620-1682م) مصر 1651م، 4/235. والبيتان من قصيدة له أولها:
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني، وذو الشيب يلعب؟! - () خزانة الأدب للبغدادي (عبد القادر بن أحمد، 1030- 1093هـ/ 1620-1682م) مصر 1651م، 4/235. والبيتان من قصيدة له أولها:
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني، وذو الشيب يلعب؟! - () كتاب الحيوان للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر الكناني البصري، 150-255هـ/767 -869م) تحقيق عبد السلام هارون، ط2، مصر 1965م، 2/266. ↑
- () الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، ت671هـ/3-1272م) مصر 1354-1369هـ/ 1935-1950م، 3/1460. ↑
- () الديوان، تحقيق د. سامي الدهان، دمشق 1369هـ/ 1950م، ص49-50. ↑
- () الكامل للمبرد (أبي العباس محمد بن يزيد الأزدي، 210-286هـ/ 826-899م) مصر 1365هـ، 1/241. الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين بن محمد المرواني ت 356هـ/ 967م) بيروت 1959، 14/41. وفيه رواية مختلفة للبيت الثاني. ↑
- () الطبقات الكبرى لابن سعد (محمد الزهري، ت230هـ/ 844م)، بيروت 1957م، 1960م، 5/89. ↑
- () وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري (ت213هـ، 828م) تحقيق عبد السلام هارون. ↑
- () تاريخ الطبري، 1/3238. ↑
- () وقعة صفين، ص578، وانظر نصاً ثانياً لهذه الاتفاقية ص585 وراجع تاريخ الطبري في حوادث سنة 37ﮬ/657م. ↑
- () انظر مثلاً: العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (أحمد بن محمد المرواني) ت328هـ/940م، تحقيق أحمد أمين وزميله، مصر 1948-1953م، 5/11. ↑
- () شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني، ت655ﮬ/ 1258م) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، مصر 1960 – 1964م، 16/19. ↑
- () طبقات ابن سعد 5/185. ↑
- () تاريخ الطبري 2/ 469. ↑
- () طبقات ابن سعد 5/98. ↑
- () طبقات ابن سعد 5/98. ↑
- () المنتقى من أخبار أم القرى لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي (ت بعد 270ﻫ/ 885م) جوتنجن 1859م، 2/22. ↑
- () تاريخ مختصر الدول لابن العبري (أبي الفرج غريغوريوس بن أهرون الملطي، 685هـ/1286م)، بيرت 1890م، ص204. ↑
- () العقد الفريد 4/488. ↑
- () المنتظم لابن الجوزي (أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي الحنبلي، ت597هـ/1201م، حيدر آباد 1357م، 6/29. تاج العروس للزبيدي (محمد بن مرتضى الحسيني، ت 1205هـ/1790م) مصر 1306هـ/5/407. ↑
- () القاموس المحيط للفيروز آبادي (أبي طاهر محمد بن يعقوب الصديقي الشيرازي، ت 816هـ/1413م) 5/407. ↑
- () كتاب المدخل المذكور، ترجمة ثابت بن قرة، تحقيق الأب ولهلم كونسش اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية ببيروت. ↑
- () كتاب الزينة، فصل ذكر ألقاب الإسلام. ↑
- () كتاب الزينة، فصل ذكر ألقاب الإسلام. ↑
- (3) حلية الأولياء، مصر 1351ﻫ/ 1932م، 1/86. ↑
- (4) أصل الشيعة وأصولها للمرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. ط9، بيروت 1956م، ص87. ↑
- () الكامل، مصر 1303 هـ، 3/304. ↑
- () أنساب الأشراف 5/204. ↑
- () أنساب الأشراف 5/204. ↑
- () أنساب الأشراف 5/204. ↑
- () تاريخ الطبري 5/24. ↑
- () تاريخ الطبري 3/20. ↑
- () شرح النهج لابن أبي الحديد 6/42. ↑
- () تاريخ الكامل لابن الأثير وغيره. ↑
- () مسند أحمد 1/300. وصحيح مسلم ج2 في آخر الوصايا. وصحيح البخاري ج1 كتاب الصلح. ↑
- () تاريخ اليعقوبي 2/126-127. ↑
- () يقول حسن الامين: كان هؤلاء الستة من قبيلة واحدة هي قريش، وإذا افترضنا أنه لا بد ان يكون الخليفة قرشياً فهو خليفة لجميع المسلمين لا لقريش وحدها وإذا لم يكن للأنصار حق في الخلافة فإن لهم ولغيرهم حق في الاشتراك في الانتخابات على الاقل. وهكذا كان الأمر عند اصحاب الامر هو أمر إمارة قرشية لا أمر خلافة إسلامية، وإحياء للعصبية القبلية من جديد. ↑
- () طبقات ابن سعد،3/248. ↑
- () تاريخ الطبري 4/52. ↑
- () راجع نصوص يوم السقيفة في شرح النهج 6/6-9. ↑
- () سنن الدرامي 1/50. ↑
- () نفس المصدر السابق والصفحة. ↑
- () سنن الدرامي 1/56. ↑
- () عمدة القارئ 4/129. ↑
- () الوسائل كتاب الجهاد. ↑
- () السرائر لابن إدريس. ↑
- () المتحذلقون الذين يحشرون الفرس والموالي في كل شأن من هذه الشؤون ينسون أن ابن حزم مولى من الموالي مجوسي الأصل. قال في النجوم الزاهرة: «ينتهي نسبه إلى خلف بن معدان بن يزيد بن سفيان مولى يزيد بن أبي سفيان. وهو فارسي الأصل ثم أندلسي قرطبي». فلماذا لا يعتبرون أن آراء ابن حزم وآراء أشباهه سببها مجوسيتهم وشعوبيتهم وحقدهم على الإسلام. وأن النزعة الأموية والهجوم على الشيعة والانتقاص من علي وفاطمة وأبنائها أصلها من المجوسية التي أرادت أن تسيئ إلى محمد بإساتها إلى أقرب الناس إليه وأعزهم عليه، والإشادة بمن قاتلوه وقاوموه وقاتلوا من بعده أسرته وصحابته المقربين من أمثال: أبي ذر وأبي أيوب الأنصاري وحجر بن عدي وقيس بن سعد بن عبادة ومئات غيرهم. والدليل على ذلك آراء هذا المجوسي الأصل الشعوبي النسب ابن حزم. ↑
- () نورد فيما يلي ما قاله أبو بكر الخوارزمي في رسالة له إلى أهل طيرستان يتحدث فيها عما نال التشيع على أيدي غير العرب من الاضطهاد والقتل والترويع، وكيف أن التشيع كان مهجورا كاسدا في غير البلاد العربية، رائجاً منتشراً بين العرب وحدهم.. قال الخوارزمي: «..وبعث الله عليهم (على الأمويين) أباً مجرم لا أباً مسلم، فنظر – لا نظر الله إليه- إلى صلابة العلوية وإلى لين العباسية، فترك هداه واتبع هواه، وباع آخرته بدنياه، وافتتح أعماله بقتل عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وسلّط طواغيت خراسان وخوارج سجستان وأكراد أصبهان على آل أبي طالب، فداوموا قتلهم تحت كل حجر ومدر، وصلبهم على كل سهل وجبل…». ويقول الخوارزمي وفي نفس تلك الرسالة:«.. فإن كسد التشيع بخراسان، فقد نفق بالحجاز والحرمين وبالشام والعراقين والجزيرة والثغرين».
ويقول فيها أيضاً: «نسأل الله أن لا يحشرنا على نصب أصفهان ولا على بغض لأهل البيت طوسي أو شاشي».
ويقول المقدسي: «…. وفي أهل أصفهان بله وغلو في معاوية».
وإذا كان الحال قد تحول بعد ذلك في إيران، فإن العرب هم الذين نقلوا التشيع إليها: حمله الأشعريون إلى قم، ثم نشره بكل وسيلة الصفويون – وهم أشراف حسينيون- ثم أوغل في نشره علماء جبل عامل.
إن خطر تعجيم التشيع يؤدي إلى تعجيم التراث العربي وعلوم الإسلام العربية حيث الريادة العلمية للمبدعين والمفكرين والعرب الشيعة تكاد أن تسيطر على مدارس النحو واللغة والصرف والتفسير والتاريخ وعلم الكلام فضلاً عن مدارس الشعر. إن صورة الحضارة العربية ستبدو مقلوبة قومياً حين نأخذ بمشروع تعجيم التشيع ونسرف في البحث والاستقصاء وترميم مذاهب المفكرين العرب.
إن الجدول التالي عينة متواضعة توضح مدى الخسارة القومية التي ستلحق بالتاريخ حين يصبح الأعلام التالية أسماؤهم من الأعاجم لكونهم يأخذون بمذهب التشيع:
أبو الأسود الدؤلي مؤسس علم النحو.
الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم اللغة والعروض.
أبو مسلم الفراء مؤسس علم الصرف.
جابر بن عبد الله الأنصاري مؤسس علم التفسير.
سعيد بن المسيب كذلك.
هشام بن الكلبي من مؤسسي علم السِّير.
أحمد بن خالد البرقي من مؤسسي علم التاريخ.
أحمد بن يعقوب اليعقوبي المؤرخ المعروف.
المسعودي صاحب مروج الذهب كذلك.
ومن الشعراء: النابغة الجعدي، ولبيد بن أبي ربيعة، وكعب بن زهير، والفرزدق، والكميت، وكثير عزة، وقيس بن ذريح، ودعبل الخزاعي، وأبو تمام، وأبو فراس الحمداني، وابن هاني الأندلسي، وأبو بكر الخوارزمي. فضلا عن: المتنبي والمعري وأمرهما معروف. ومن مؤرخي الأدب: صاحب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني. ↑
- () قال الدكتور طه حسين في كتابه «الأدب الجاهلي»: أن أبا سفيان نظر عند فتح مكة فإذا هو بين اثنتين: أما أن يمضي في المقاومة، فتفنى مكة. وإما أن يصانع ويدخل فيما دخل فيه الناس. وينتظر لعل هذا السلطان السياسي الذي انتقل من مكة إلى المدينة ومن قريش إلى الأنصار أن يعود إلى قريش وإلى مكة مرة أخرى، وألقى الرماد على هذه النار التي كانت متأججة بين قريش والأنصار، وأصبح الناس جميعاً في ظاهر الامور أخوانا مؤتلفين في الدين. وقد طال انتظار أبي سفيان حتى قام حفيده يزيد بن معاوية، فانتقم من غزوة بدر في وقعة الحرة. ويزيد صورة صادقة لجده أبي سفيان في السخط على الإسلام وما سنّه للناس. ↑
- () اليهودي العريق المتظاهر بالإسلام (كعب الأحبار) هو الذي وقف في وجه الشيعي العريق أبي ذر الغفاري في مصادمته لفساد الحكم في عهد الخليفة الثالث وثورته على استئثار فئة محدودة من أسرة الخليفة، بخيرات الأمة وأموال الشعب.
وكان هذا اليهودي (كعب الأحبار) صفي معاوية وشبه مستشاره الخاص. وعندما جاهر أبو ذر بدعوته إلى العودة إلى الحكم السليم وحفظ حقوق الشعب ومحاربة الفساد تصدى له كعب الأحبار محاولاً تبرير الفساد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية أخذ يرددها مقابل أبي ذر. وقال لأبي ذر: ألا تتقي الله يا شيخ، تجبَه أمير المؤمنين بهذا الكلام. فصاح به أبو ذر: وما يدريك يا ابن اليهوديين! أتعلمنا ديننا! والله ما خرجت اليهودية من قلبك!. ↑
- () وللتفكه ننقل لك أقواله: قال في الصفحة 6 من الطبعة الثانية: «إن الاهتداء إلى رأي قاطع في هذه المسألة، وهي هل كان أبو ذر أو ابن سبأ هو المؤسس الحقيقي لمذهب الشيعة في الإسلام ليس من الأمور السهلة».
ثم يشجع نفسه ويخوض هذا الأمر الصعب ويطلق حكمه قائلاً: «إن ذلك لا يمنعنا من أن ندلي بالرأي الذي نراه، وهو أن ابن سبأ وهو أول من وضع عقائد مذهب الشيعة الغالية في الإسلام».
ولنوغل بك في التفكه ننقل لك طرفة أخرى من طرف هذا العلم الغزير، فهذا الدكتور لم يجد في المكتبة الإسلامية كتاباً يمكن أن يستند إليه في أبحاثه، لذلك كان اعتماده على غير المسلمين من الأوروبيين في دراسة العقائد الإسلامية!.. قال الدكتور الذي يعتبر نفسه أخصائياً في الدراسات الإسلامية ما يلي:
«وقد ذكر دي جوبينو Gobineau في كتابه (الدين والفلسفة في آسيا الوسطى: تأثير مذهب الإثني عشرية وأهميته على الفرس الذين كانوا ينظرون إلى أئمتهم كما ينظر المسيحيون إلى أقانيمهم ويعتقدون أن في أيديهم مقادير العالم الذي يحيى بوجود هؤلاء الأئمة ويهلك بدونهم. كما أن الطاعة والتوسل إلى الأئمة من الأمور الضرورية عند طائفة الإثني عشرية في فارس. وهناك صلوات خاصة بهؤلاء الأئمة: من ذلك أن يوم الأحد عندهم من أجل علي وفاطمة، والساعة الثانية من كل يوم مقدسة كذلك من أجل الحسن، والساعة الثالثة من كل يوم مقدسة كذلك من أجل الحسين، والرابعة من أجل علي زين العابدين، والخامسة من أجل محمد الباقر، والسادسة من أجل جعفر الصادق، والسابعة من أجل موسى الكاظم، والثامنة من أجل علي الرضا، والتاسعة من أجل محمد الجود، والعاشرة من أجل علي النقي، والحادية عشرة من أجل الحسن العسكري الزكي، والثانية عشر من أجل محمد المهدي الحجة».
هذا هو مبلغ علم الدكتور حسن إبراهيم حسن بالعقائد الإسلامية، ذلك العلم الذي يفاخر بأنه يستند فيه إلى غير المسلمين. وكل ما نقوله له ولأمثاله: أن هذا الهذر هو أسخف وأتفه من أن نناقشه. وأن الشيعة عرباً وفرساً وتركاً ومن أي جنس كانوا هم أسمى في عقائدهم الإسلامية الصافية مما تظن، وأن التشيع هو المرآة التي تنعكس عليها تعاليم محمد (ص) وحدها، وأن هذا الذي ذكرته في كتابك مما نقلناه ومما لم ننقله هو زور وبهتان وافتراء وجهل. ↑
- () احتفظت مراكز الفكر الإسلامي الشيعي في العراق بنوع من حرية النشر في أعقاب حملة إبادة أصحاب الرأي من فقهاء المذاهب الإسلامية التي شنها السلاجقة، وهاجر على أثرها أئمة الفقه الإسلامي الشيعي إلى النجف، واقاموا أوسع مركز للدراسات الفقهية والفلسفية والأدبية، وقد اختفت معاهد التعليم العباسي في معظم أرجاء البلاد الإسلامية، واستمرت في النجف وكربلاء والكاظمية حتى السبعينات من هذا القرن إذ بدأت حملة شبيهة بحملة السلاجقة لإبادة أصحاب الرأي الآخر، وانتهت بتعطيل الدراسات في هذه المراكز بعد ألف عام.
وبهذا خسر التراث العربي في ظل سلطة قومية، تلك الصلة التاريخية الحية التي تربطه وشريحة من الأجيال المعاصرة بنظام التعليم العباسي المعروف في عصر المأمون. حيث يتعرب «الأعاجم» من الطلبة الدارسين، وخسر العراق موقعا رياديا في حركة الفكر الإسلامي العربي، وأفسح المجال لا حبا امام إيران باعتبارها المنافس الكبير على هذا الدور. ↑
- () ينبغي أن لا ينصرف الذهن إلى أن المدرسة الأخبارية قد تخلفت عن المعارك الأساسية التي دخلها فقهاء التشيع ضد الاستعمار الغربي، حيث ساهم الأخباريون والأصوليون في حركة الجهاد وثورة العشرين والحركة الاستقلالية. ↑
- () يونس السامرائي (تاريخ مدينة سامراء) ج2 ص178 طبعة بغداد. ↑
- () وميض عمر نظمي، الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية ص111 عن وثيقة بريطانية. ↑
- () كان الراتب الشهري الذي يستلمه الشيخ فهد الهذال من الإنكليز (17) ألف باوند (عبد الله النفيسي – دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث ص 54). ↑
- () استمرت المعركة من 12 – 15 نيسان سنة 1915م. ↑
- () النفيسي ص97. ↑
- () في الأول من حزيران 1915م. ↑
- () درس الأفغاني في النجف أربع سنوات (1850م) لكن لقاءه بالحبوبي كان في الزيارة للأفغاني (1891 – 1892م). ↑
- () كان عبد الرحمن النقيب إذ ذاك رئيس بلدية بغداد، إضافة لصفته الدينية، وعمله كمشرف على الأوقاف القادرية وزعيم ديني. ↑
- () محمد حسن ياسين (مجلة الأقلام). ↑
- () لم تكن الكاظمية مركز اهتمام السلطان العثماني أو الوالي التركي قبل هذا اليوم، فيما أصبحت الكاظمية لا بغداد مركز النشاط العسكري – السياسي أثناء الحرب. ↑
- () الإمام الثائر ص43. ↑
- () ترى تفاصيلها فيما يأتي. ↑
- () الإمام الثائر ص58. ↑
- () التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق ص63. ↑
- () حسن الأسدي، ثورة النجف ص92. ↑
- () هذا الفصل ملخص عن دراسة مفصلة لحسن العلوي. ↑
- () قال ابن سعد في الطبقات: فلما أصبح «يعني النبي» يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده، ثم قال: أغز باسم الله في سبيل الله، فقاتل من كفر بالله. فخرج فعسكر في الجرف، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم: أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم. ↑
- () من أخزى ما جرى ما رواه المفيد وهو يتحدث عن دفن النبي من قوله: «لم يحضر دفنه أكثر الناس، وفات أكثرهم الصلاة عليه» لتنازعهم على الخلافة قبل أن يواروه التراب، ولم يكن مشغولا به إلاَّ علي وأهل بيته. ↑
- () راجع تفاصيل ذلك في ترجمة حجر في الطبري وابن عساكر والمرزباني وغيرهم. ↑
- () الطبري. ↑
- () قال الحسن البصري حين سمع من يصف معاوية بالحلم: وهل أغمد سيفه وفي نفسه شيء على أحد؟!. ↑
- () كان أبو العلاء المعري خلال إقامته في بغداد يتردد على هذه المكتبة وإليها يشير بقوله:
وغنت لنا في دار سابور قينة من الورق مطراب الأصائل ميهال رأت زهراً غضاً فهاجت بمزهر مثانية أحشاء لطفن وأوصال - () 6، ص: 185. ↑
- () معجم البلدان ج2. ↑
- () الكامل 10. ↑
- () يقول (بارتولد) في كتابه (تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي) في الصفحة 455: لم يكن بوسع السلاجقة أن يتشبهوا تماماً بالسامانيين والغزونويين لأنهم ظلوا حتى آخر أيامهم غريبين عن أي حزب من المدينة. هذا وقد وصلت إلينا معلومات غاية في الثقة تؤكد أنه حتى السلطان سنجر آخر السلاجقة الكبار كان أمياً، وليس هناك ما يحملنا على الافتراض بأن أسلافه كانوا أكثر ثقافة منه. ↑
- () المسعودي. ↑
- () راجع التفاصيل في الطبري، وفي طبقات ابن سعد في الجزء الرابع، الصفحة 184، طبعة دار صادر ودار بيروت سنة 1957م. ↑
- () أمالي القالي. ↑
- () راجع الصفحة 302 من الجزء الأول من السيرة الحلبية، طبعة 1949م في القاهرة. ↑
- () راجع الصفحة 302 من الجزء الأول من السيرة الحلبية، طبعة 1949م في القاهرة. ↑
- () يصف ابن قتيبة في كتابه (الإمامة والسياسة) ما حدث لعبد الرحمن ثم يقول: ومضى معاوية راجعاً من المدينة إلى الشام، فلم يلبث إلاَّ قليلاً حتى توفي عبد الرحمان بن أبي بكر في نومة نامها. ↑
- () كل النصوص من الطبري. ↑
- () عبد الرحمن بن عوف الذي رفض أن يبايع علي بن أبي طالب وصرف الخلافة عنه إلى غيره، عبد الرحمن بن عوف هذا: ذبحت سيوف الأمويين ابنه زيد في وقعة الحرة. والأمويون أيضاً قتلوا بالسم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. ↑
- () تاريخ الطبري: 3/ 161. ↑
- () الاستيعاب: 4/ 292. ونهاية الأرب: 18/ 211. وأسد الغابة: 5/ 467. ↑
- () تاريخ الطبري: 2/ 467. ونهاية الأرب: 18 / 211. ↑
- () نهاية الأرب: 18/ 211. ↑
- () طبقات ابن سعد: 8/ 24. ↑
- () تاريخ الطبري: 2/ 468. وأسد الغابة: 5/ 467. ↑
- () الاستيعاب: 4/ 292. ونهاية الأرب: 18/212. ↑
- () طبقات ابن سعد: 8/ 24. ↑
- () طبقات ابن سعد: 8/ 24. ↑
- () نهاية الأرب: 18/ 212. والإصابة 4/ 297. ↑
- () تاريخ الطبري: 2/ 230 و340 ـ الطبعة الأخيرة في مصر. ↑
- () طبقات ابن سعد: 8/ 25. ↑
- () نهاية الأرب: 18/ 212. والطبري: 2/ 468. ↑
- () نشر الدكتور محمد حسين هيكل كتابه «حياة محمد» أول ما نشره فصولاً متتابعة في جريدة السياسة الأسبوعية. ونشر هذا الحديث كاملاً كما هو. ولما اعترض عليه معترض، أجاب بأني لست أنا الذي أقول هذا القول ولكنه التاريخ. ثم ذكر الحديث في الطبعة الأولى من الكتاب، ولكن شوّهه وأفسده في الطبعة الثانية وما جاء بعدها من طبعات. ولما بحث الباحثون عن السبب وكيف أن الدكتور في جريدته دافع عن هذا الحديث وقال إن هذا ما رواه التاريخ، ثم عاد في الطبعة الثانية فشوّهه وتجنّى على التاريخ ـ عرفوا أن الدكتور هيكل طلب من جهة من الجهات أن تساهم بشراء ألف نسخة من كتابه، فأبت أن تفعل إلاَّ إذا شوّه هذا الحديث. فنزل عند رغبتها وبتره وأفسده لقاء الخمسمائة جنيه التي ستدفع ثمن الألف نسخة، والسياسة الأسبوعية موجودة والطبعة الأولى موجودة. وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم ونعيد ذكره هنا لمناسبة ذكرنا للحديث. ↑
- () هيكل. ↑
- () هيكل. ↑
- () الإرشاد للمفيد، وأسباب النزول للواحدي، ومسند أحمد بن حنبل، والمستدرك للحاكم، والذهبي، وتاريخ ابن كثير، والسيرة الحلبية لابن هشام وغيرها. ↑
- () راجع في بحث السبئية ما ينقض كل ما اخترع عن ابن سبأ والسبئية. ↑
- () من أعيان الشيعة. ↑
- () وفيق الخشاب، آسيا، المطبعة العربية، بغداد، 1964، ص 138. ↑
- () إن جغرافية العالم الإسلامي مهملة وقلَّما تجد مرجعاً يمكن الاعتماد عليه وإن وجدت بعض الإحصائيات فهي قديمة وتقريبية، وكثير منها بعيد عن الواقع، لذا لاقينا مصاعب جمة أثناء البحث. ومما يزيد الأمر تعقيداً هو صعوبة إيجاد مقياس يعتمد عليه ليحدد الدولة فيما إذا كانت إسلامية أم لا. وفي هذه الدراسة المختصرة اعتبرنا الدولة الإسلامية هي التي تزيد فيها نسبة المسلمين على 59 بالمئة من مجموع سكانها. ونتيجة لذلك فإن الأرقام الواردة في هذا البحث هي أرقام تقريبية. ↑
- () يختلف الكتاب في تقدير سكان العالم الإسلامي، ففي أطلس التاريخ الإسلامي «ص 5» يقدرون بحوالي 370 مليون مسلم وفي مجلتي المسلمون وكلية الدراسات الإسلامية يقدرون بحوالي 634 مليون مسلم. وفي أحدث إحصاء نشره اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عام 1969 أكثر من ستمائة وتسعين مليون موزعين كالآتي: 840،051،189 في أفريقيا و180،622،487 في آسيا و170،917،16 في أوروبا و1,166,000 في قارتي أميركا وأستراليا فيكون المجموع 190،757،694 مسلماً.
وفي نشرة اتحاد المسلمين في إيران أن العدد الصحيح لمسلمي العالم هو 650 مليون نسمة.
على أنه لا بد من القول أن بين من أشاروا إلى عدد المسلمين نوعين من الباحثين: نوعاً سلك سبيل توهين شأن المسلمين عن طريق التقليل من عددهم، كما فعل الدكتور (رزلر) مدير دائرة الإحصاء الألمانية (اشتوتكارت) حين أحصى عدد معتنقي الأديان فجعل عدد المسلمين لا يزيد على (175,290,000).
وكما فعل (جيمس فيشر) في كتاب له باسم دنيا العجائب، قال فيه أن عدد المسلمين 200 مليون نسمة.
ونوعاً لم تتيسر له الإحصاءات الدقيقة فمال إلى المبالغة، كما فعل كتاب (مسلمين جهان) المطبوع في إيران حيث جعل العدد 950 مليون نسمة وسيرى القارئ تفاصيل أخرى تلي هذا البحث مباشرة يمكن ضمها إليه. ↑
- () راجع: الهند. ↑
- () راجع: الصين. ↑
- () هناك إحصائيات متضاربة، فبعضها تحصر نسبة المسلمين في كل من فولتا العليا، غينيا البرتغالية، ساحل العاج، داهومي، سيراليون، غابون، توغو، نياسالاند وغيرها بين 60 و90 بالمئة من مجموع السكان، في حين أن بعضها تحصرهم بين 3 و32 بالمئة. ↑
- () تتضارب الإحصائيات حول تقدير نسبة المسلمين في أثيوبيا «الحبشة»، فبعضها تجعل النسبة 30 بالمئة وأخرى 60 بالمئة. ↑
- () (أ) د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط ص 495 وما بعدها 1989م الاسكندرية.
(ب) د. محمد عبد الحكيم وآخرون: الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده من ص 3 إلى ص 13، القاهرة، 1968م. ↑
- () الأطلس (ج. ع. ل. ش. أ). ص 5 ـ 6. ↑
- () King – L. C: The Morphology of the Earth – P. 291 (London 1967). ↑
- () د. محمد إبراهيم حسن: التكامل الاقتصادي بين المسلمين ـ مجلة كلية الدعوة الإسلامية ـ طرابلس ـ ليبيا ـ عدد خاص 1986م ص 159 إلى 164. ↑
- () المؤتمر الأول لعلوم البيئة، ج.ع.ل.ش.أ.ع: التصحر ص 168 وما بعدها (سبها 1990م). ↑
- () ج.ع.ل.ش.أ: أمانة المواصلات والنقل البحري ـ دراسة تخطيط النقل على مستوى الجماهيرية ص 157 (طرابلس 1985). ↑
- () مجلة الأكاديمية العربية للنقل البحري ـ مصر ـ المجلد 9 ـ العدد 17 يوليو 1983م ص 12. ↑
- () أعيان الشيعة. ↑
- () راجع ذلك في أخبار علي في معركة أحد من هذا الجزء. ↑
- () أي السبعة الذين اختارهم عمر. ↑
- () يقول حسن الأمين: إن عمر لم يدخل أحداً من الأنصار وغيرهم بصفة ناخب أو بصفة مستشار على الأقل. وإذا افترضنا أن من اللازم أن يكون الخليفة قرشياً، فإنه خليفة لجميع المسلمين لا للقرشيين وحدهم. وإذا لم يكن للأنصار حق في الخلافة، فإن لهم ولغيرهم من المسلمين حق الاشتراك في الانتخاب على الأقل. ↑
- () يقول حسن الأمين: كان معاوية في الأصل والياً على دمشق وحدها، ثم ضم إليه الأردن ولما مات سرخس والي حمص وقنسرين ضمهما عثمان إلى معاوية ومات والي فلسطين فضمها عثمان إلى معاوية أيضاً. وهكذا أصبح معاوية خلال سنتين من بدء خلافة ابن عمه عثمان والياً على كل ما يطلق عليه اليوم اسم سوريا الكبرى وأصبح نفوذه مطلقاً لا تهيمن عليه أية مراقبة. ولم تمض بضع سنوات حتى أصبحت سوريا دولة ضمن الدولة الإسلامية وأصبح معاوية أعظم الولاة خطراً. وفي خلال سنوات صار بإمكانه أن يضع في أي ميدان قتال يختاره نحواً من مئة ألف جندي.
وقد لقي معاوية عماراً بن ياسر يوماً في المدينة فقال له: «إن في الشام مئة ألف فارس، كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم وعبدانهم لا يعرفون علياً وقرابته ولا عمار أو سابقته ولا الزبير وصحبته».
وهكذا أصبح سلطان الإسلام في قبضة شبان من بني أمية لا يتحرجون في استعمال أي وسيلة في سبيل أهدافهم. لقد تحولت الخلافة إلى مملكة أموية بكل معانيها. ففضلاً عن معاوية كان الوليد بن عقبة في الكوفة ثم استبدل به أموي آخر هو سعيد بن العاص. وكان في البصرة عبد الله بن عامر، وفي مصر عبد الله بن أبي سرح.
ولقد كان ثقل قوة الدولة الإسلامية وثروتها في هذه الأقطار الثلاثة: سوريا والعراق ومصر. أما البقية فتابعة لها إدارياً ومالياً وفي كل شيء. ↑
- () فعل معاوية ذلك كله بعد صفين حين أرسل ابن عوف الغامدي فاقتحم مدينة الأنبار. كما فعل في الحجاز واليمن وغيرهما. ↑
- () الخوارج والشيعة ـ يوليوس فيلهوزن ـ ترجمة عبد الرحمن بدوي. ↑
- () الخوارج في الإسلام. ↑
- () قال ابن الأثير (عن الخوارج بعد النهروان): خرج أبو مريم السعدي التميمي فأتى شهرزور وأكثر من معه الموالي، لم يكن معه من العرب غير ستة هو أحدهم، واجتمع إليه مائتان وقيل أربعمائة وقال أيضاً وهو يتحدث عن الخريت الخارجي: واجتمع إليه نحو مائتين وانضاف إليه علوج من أهل الأهواز.
ثم قال عن المعركة التي حدثت بين معقل بن قيس الذي أرسله علي لقتال الخريت وجماعته: فقتل أصحاب معقل منهم (من الخوارج) سبعين رجلاً من بني ناجية ومن معهم من العرب ونحواً من ثلثمائة من العلوج والأكراد. ↑
- () يقول حسن الأمين: يجب أن لا ننسى أنه أثر وفاة النبي كانت هناك ثلاثة أحزاب تتنازع على الخلافة: حزب قريش، وحزب الأنصار، وهما حزبان قبليان تجمع أولهما رابطة قريش فقط، وتجمع الثاني رابطة الأنصار فقط.
وكان مرشح الحزب الأول: أبو بكر، ومرشح الحزب الثاني سعد بن عبادة. أما الحزب الثالث فنستطيع أن نطلق عليه اسم: (حزب الشعب) إذ لم تكن تربط بين رجاله أية رابطة قبلية، بل كان رجاله من مختلف القبائل ومن الشعوب غير العربية التي أسلمت. فكان فيه الهاشمي، والأموي (خالد بن سعيد بن العاص)، والغفاري (أبو ذر)، والكندي (المقداد بن الأسود)، والعبيد السابقون (عمار بن ياسر) إلى غير هؤلاء، ثم فريق من عيون المهاجرين والأنصار.
أما من غير العرب، فقد كان يمثل فيه الآسيويين: سلمان الفارسي، ويمثل الأفارقة: بلال الحبشي، ويمثل من أسلم من أقباط مصر: أبو رافع القبطي وغيرهم. وكان مرشح هذا الحزب علي بن أبي طالب. ↑
- () يقول حسن الأمين: لما قدر للخوارج أن تقوم لهم دولة في شمال أفريقية هي الدولة الرستمية، إذا بهم يقيمون حكماً ملكياً فردياً استبدادياً تتوارثه أسرة واحدة، ويناقض كل المناقضة دعواهم في اختيار الخليفة. وكذلك الحال في كل ما قام لهم من حكم. ↑
- () البطن ـ في اصطلاح الدراسات القبلية والعشائرية ـ هو الوحدة التالية ـ تنازلياً ـ للقبيلة، عندما تقسم القبيلة، ويليه في التنازل «الفخذ»، فالقبيلة تنقسم إلى بطون، والبطن إلى أفخاذ… إلخ.. إلخ.. ↑
- () سورة الزخرف، الآيات: 31 ـ 32. وانظر كذلك تفسير البيضاوي ص678، 679 ـ طبعة القاهرة سنة 1926م. ↑
- () سورة الشعراء، الآية: 111. ↑
- () تفسير البيضاوي ص521. ↑
- () سورة هود، الآية: 27. ↑
- () سورة القصص، الآية: 5. ↑
- () سورة قريش، الآيات: 1 ـ 4. ↑
- () انظر كتابنا (مسلمون ثوار) الفصل الخاص بأبي ذر الغفاري ـ وكان أبو ذر من حزب علي وشيعته. ↑
- () مروج الذهب ج2 ص351 ـ 352. ↑
- () الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. ص148. ↑
- () الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ج3، ص74. طبعة القاهرة سنة 1301هـ. ↑
- () مروج الذهب ج2 ص346. ↑
- () شرح نهج البلاغة ج17 ص242. ↑
- () مروج الذهب ج2 ص342. ↑
- () المصدر السابق، ج2 ص394. ↑
- () المصدر السابق، ج2 ص349. ↑
- () المصدر السابق، ج2 ص342. ↑
- () المصدر السابق، ج2 ص343. ↑
- () المصدر السابق، ج2 ص343. ↑
- () المصدر السابق، ج2 ص342. ↑
- () شرح نهج البلاغة ج9 ص6 ـ 23. ↑
- () المصدر السابق، ج9 ص16. ↑
- () مروج الذهب، ج2 ص341 ـ 342. ↑
- () المصدر السابق، ج2 ص349. ↑
- () صحيح مسلم، بشرح النووي، ج11 ص43. طبعة القاهرة. ↑
- () الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني. دراسة وتحقيق: محمد عمارة، ص421 ـ طبعة القاهرة سنة 1968م. ↑
- () السيقة ـ بفتح السين وكسر الياء المشددة وفتح القاف ـ الذي يساق من الدواب. ↑
- () (نهج البلاغة) ص186 ـ 189. طبعة «الشعب»، القاهرة. ↑
- () (شرح نهج البلاغة) ج9 ص15. ↑
- () المصدر السابق، ج9 ص16. ↑
- () (نهج البلاغة) ص66. ↑
- () المصدر السابق، ص56 ـ 57. ↑
- () المصدر السابق، ص198. ↑
- () المصدر السابق، ص60. ↑
- () التركاض ـ بفتح التاء وسكون الراء ـ الجري والإسراع. ↑
- () (نهج البلاغة) ص320 ـ 321. ↑
- () (شرح نهج البلاغة) ج12 ص9. ↑
- () (نهج البلاغة) ص401. ↑
- () المصدر السابق، ص84. ↑
- () المصدر السابق، ص41 ـ 42. ↑
- () (نهج البلاغة) ص408. ↑
- () المصدر السابق، ج7 ص37. ↑
- () المصدر السابق، ج7 ص38. ↑
- () المصدر السابق، ج7 ص40. ↑
- () المصدر السابق، ج7 ص41 ـ 42. ↑
- () نهج البلاغة، ص151. ↑
- () شرح نهج البلاغة، ص42 ـ 43. ↑
- () المصدر السابق، ج18 ص52. ↑
- () (نهج البلاغة) ص334 ـ 325. ↑
- () المصدر السابق، ص351. ↑
- () المصدر السابق، ص347. ↑
- () (شرح نهج البلاغة) ج16 ص23. ↑
- () (نهج البلاغة) ص359.. من كلماته إلى «الحارث الهمذاني». ↑
- () المصدر السابق، ص366، 373، 407، 275، 359. ↑
- () المصدر السابق، ص327. ↑
- () المصدر السابق، ص340 ـ 341. ↑
- () المصدر السابق، ص332. ↑
- () المصدر السابق، ص332. ↑
- () المصدر السابق، ص298 ـ 299. ↑
- () المصدر السابق، ص300. ↑
- () المصدر السابق، ص342. ↑
- () المصدر السابق، ص342 ـ 343. ↑
- () المصدر السابق، ص336. ↑
- () المصدر السابق، ص336. ↑
- () المصدر السابق، ص274. ↑
- () المصدر السابق، ص279. ↑
- () كان ذلك هو القانون السائد الذي على الحكام تطبيقه والعمل به (ح). ↑
- () نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد، دار الإرشاد الحديثة، م1، ج2، ص216. ↑
- () المصدر نفسه، م2 ج8، ص305. ↑
- () نهج البلاغة، مذكور سابقاً، م4، ج7، ص159. ↑
- () راجع المبرّد، الكامل، ج2، ص156. ↑
- () نهج البلاغة، مذكور سابقاً. ↑
- () نهج السعادة، ص485. ↑
- () النهج المذكور أعلاه م4، ج17، ص120. ↑
- () الطبري، ج5، ص148. ↑
- () سورة المائدة، الآية: 32. ↑
- () سورة المائدة، الآية: 33. ↑
- () نهج البلاغة، مذكور أعلاه، م4 ج7، ص151. ↑
- () فروع الكافي، مذكور أعلاه، ج7، ص354. ↑
- () الوسائل/ 341. ↑
- () أبو يوسف، الخراج، طـ مؤسسة ناضر، بيروت، ص16. ↑
- () نهج السعادة، 5/370 و371. ↑
- () فروع الكافي، 3/540. ↑
- () النهج، مذكور أعلاه، م4،ج17، ص115. ↑
- () النهج المذكور أعلاه، م3، ج15، ص434. ↑
- () المرجع نفسه، م1، ج4 ص651. ↑
- () الوسائل، م6، ج3، ص216. ↑
- () نهج البلاغة، م2، ج10، ص514. ↑
- () المرجع نفسه، ص540. ↑
- () سورة الطلاق، الآية: 7. ↑
- () الكامل، المبرد، ج2، ص156. ↑
- () نهج البلاغة، م2، ج8، ص306. ↑
- () المرجع نفسه، م4، ج20، ص470. ↑
- () المرجع نفسه، م3، ج11، ص79. ↑
- () المرجع نفسه، م4، ج17، ص111، 112. ↑
- () نهج السعادة م2، ص485. ↑
- () نهج البلاغة، م4، ج17، ص120. ↑
- () المرجع نفسه، م3 تكملة، ص513. ↑
- () مستدرك الوسائل، م18، ص25. ↑
- () المرجع نفسه، م17، ص347. ↑
- () فروع الكافي، م7، كتاب الحدود، ص188. ↑
- () وهو القانون المعمول به (ح). ↑
- () مستدرك الوسائل، ج18، ص273. ↑
- () الوسائل، م16، ص111. ↑
- () المستدرك، م18/36. ↑
- () المستدرك 17/403. ↑
- () الدينوري، الأخبار الطوال، ص130. ↑
- () الوسائل 18/217. ↑
- () الوسائل 13/416. ↑
- () الوسائل 13/431. ↑
- () الوسائل 18/181. ↑
- () مستدرك الوسائل 13/403. ↑
- () الوسائل 18/165. ↑
- () نهج البلاغة، م3، ج12، ص181. ↑
- () المصدر نفسه. ↑
- () نهج السعادة، مذكور أعلاه، ص514. ↑
- () المرجع نفسه، ص215. ↑
- () نهج البلاغة م2، ج8، ص315. ↑
- () نهج البلاغة، م1، ج1، ص181. ↑
- () المرجع نفسه، ص182. ↑
- () نهج السعادة 1/90. ↑
- () الوسائل 6/81. ↑
- () نهج البلاغة، م3، ج13، ص183. ↑
- () نهج السعادة 4/127. ↑
- () مستدرك الوسائل 11/94. ↑
- () نهج البلاغة، م1، ج2، ص181. ↑
- () المرجع نفسه. ↑
- () عبد المقصود 2/230. ↑
- () نهج السعادة، ص220. ↑
- () نهج البلاغة، م4. ج8، ص392. ↑
- () نهج البلاغة، م4، ج19، ص258. ↑
- () نهج البلاغة، م4، ج17، ص110. ↑
- () المرجع نفسه، م3، ج11، ص11. ↑
- () سورة الحجرات، الآية: 12. ↑
- () سورة النور، الآية: 27. ↑
- () سورة النحل، الآية: 80. ↑
- () النهج م3 ـ ج15، ص413. ↑
- () نهج السعادة 2/155. ↑
- () مستدرك الوسائل 11/84. ↑
- () نهج البلاغة، م4 ج17، ص122. ↑
- () المرجع نفسه. ↑
- () نهج السعادة 2/339. ↑
- () سورة الأنعام، الآية: 57. ↑
- () سورة الروم، الآية: 6. ↑
- () نهج البلاغة، م4، ج19، ص393. ↑
- () نهج السعادة، ص5. ↑
- () نهج البلاغة، م4، ج17، ص140 ـ 141. ↑
- () ابن قتيبة الإمامة والسياسة، ج1، ص95. ↑
- () ابن قتيبة الإمامة والسياسة، ج1، ص111. ↑
- () نهج البلاغة، م1، ج2، ص219. ↑
- () نهج البلاغة، مذكور سابقاً، م4، ج19، ص410. ↑
- () المرجع نفسه، ص411. ↑
- () الدينوري، الأخبار الطوال، ص844. ↑
- () الجؤجؤ: الصدر. ↑
- () ارتجال الصفة: وصف الحال بلا تأمل، فالواصف لهم بأول النظر يظنهم صرعى من السبات، أي النوم. ↑
- () الجديدان: الليل والنهار. ↑
- () سرمد: أبدي. ↑
- () الثواقب: المنيرة المشرقة. ↑
- () سراجاً مستطيراً: منتشر الضياء ويريد به الشمس. ↑
- () سورة البلد، الآية: 10. ↑
- () سورة يوسف، الآية: 87. ↑
- () عهد الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لمالك الأشتر يرسي بكل وضوح المعالم الأساسية لمهمات الحاكم وحقوق الرعية، وهي من المستمسكات التي قل التعامل معها وعرضها لجمهور المسلمين، وهذا ما يدفعنا لعرض بعض فقرات العهد.
ولّى الإمام علي مالك الأشتر النخعي مصر عام 39 هجرية، وكتب له عهداً طرح فيه النظرية الإسلامية في كيفية إدارة البلاد وحكمها مبنية على القواعد الإسلامية الأربع: الحرية والمساواة والعدل والشورى، وتضمن حوالي 94 بنداً تبين المرتكزات الأساسية للعهد، مثل واجبات الحاكم ومفهوم الأكثرية عند الأمام، والتجارة والصناعة والتنمية، وحقوق الفقراء، ومعاهدات السلام. إضافة لما تضمنه من القواعد التشريعية السياسية والإدارية والقضائية والمالية والنظريات الدستورية التي تضاهي أحدث القواعد حالياً، فقد عالج الإمام أنظمة حفظ التوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع الإسلامي التعددي خصوصاً في البلدان المفتوحة.
يحدد الإمام علي في أول العهد السلطات الرئيسية التي يجب أن يضطلع بها الحاكم وهي مالية الدولة، الشؤون العسكرية، جهاز الدولة وملاكها الوظيفي، وأخيراً عمران البلاد، فيقول في بداية العهد: «هذا ما أمر به عبدالله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها».
ثم يحدد علاقة الحاكم بالرعية عبر النص الآتي: «واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف فيهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم. فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فاعطهم من عفوك وصفحك الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم وولي الأمر عليك والله فوق من ولاك».
ولتنظيم العلاقات بين السلطات والرعية كتب الإمام في عهده «فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصباً طويلاً. ولا تنقض سُنّة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنّة تضر بشيء من ماضي تلك السنن. وأكثر مدارسة العلماء ومنافئة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك».
أما أسس النظام القضائي وطرق اختيار الحكام والقضاة واستقلالية وعدل الحكم، فقد وردت في العهد كما يلي: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نسك، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه». ويجدر بنا أن نتوقف عند مفهوم الإمام للأكثرية في الأمة (كآلية ديموقراطية) وأهمية حصول رضاها باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية. والأكثرية المقياس الذي ينبغي أن يصنع القرار السياسي، الذي هو ثمرة تفاعل بين كل قوى المجتمع، مع التزام الأقلية بالقبول وعدم التعسف ضدها. ورضا الأكثرية يعطي الشرعية للحكم، ويستمد الحاكم منه سلطته باعتباره الوكيل المؤتمن على الأمة، فهو ممثل لها في السلطة لا مالك لها، والساهر على توفير حاجات الأمة والممتنع عن إلحاق الجور والظلم بالرعية، فيذكر في العهد: «أنصف الله وأنصف الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل وأجمعها لرضى العامة، فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة».
كما يشدد الإمام علي في معاملته للرعية على الدقة في عدم ارتكاب خطأ قد يؤدي إلى إراقة الدماء في البلد، وينهي العهد بالتركيز على الابتعاد عن الغرور والعجب بالنفس والمن على الرعية والتمادي في السلطة، الذي يقود إلى الاستبداد والديكتاتورية والدمار للبلاد والعباد: «وإياك والإعجاب بنفسك، والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه». ↑
- () راجع بحث (الوعظ عند علي). ↑
- () دكتور محمد ثابت الفندي: الطبقات الاجتماعية: ص64 ـ 80. وثمة خلاف في وجهة النظر إلى مبادىء الانقسام الطبقي فقد ذكرنا هنا أنها لا تستتبع أحكاماً تقويمية ولا تسلسلاً طبقياً بخلاف ما ذهب إليه أصحابها. ↑
- () المصدر السابق، ص36 ـ 44. ↑
- () سورة البقرة، الآيات: 2 ـ 5. ↑
- () سورة البقرة، الآية: 177. ↑
- () سورة آل عمران، الآيتان: 133 ـ 134. ↑
- () سورة المائدة، الآية: 8. ↑
- () مجمع البيان في تفسير القرآن 1/37، والآية في سورة النحل: 90. ↑
- () نقول هذا في القانون الديني حين يتولى الأمر حاكم كالإمام علي، لا حين يتولاه ملوك كملوك الأمويين والعباسيين وغيرهم من الذين استعبدوا الناس باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. ↑
- () لعل مونتسكيو 1689 ـ 1755م هو أول من تكلم في مبدأ فصل السلطات، وقد عقد للحديث عنه فصلاً في كتابه روح الشرائع 1/228 ـ 242. وتابع الموضوع من الوجهة التاريخية في 234 ـ 279. ↑
- () دكتور محمد ثابت الفندي: الطبقات الاجتماعية ص: 47 ـ 51. ↑
- () راجع: (القاصعة). ↑
- () من جملة تقسيمات الواجب عند علماء أصول الفقه تقسيمه إلى واجب عيني وواجب كفائي. ويعنون بالواجب العيني ما يتعلق بكل مُكلف ولا يسقط عن أحد من المكلفين بفعل غيره. ويعنون بالواجب الكفائي ما يطلب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان، فهو يجب على المكلفين ولكن يكتفي بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين. نعم إذا تركه جميع المكلفين فالجميع مذنبون. وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها الحرف والصناعات والمهن التي يتوقف عليها انتظام شؤون حياة الناس ومنها الاجتهاد في الشريعة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ↑
- () سورة آل عمران (مدنيّة ـ 3) الآية: 104. ↑
- () سورة التوبة، الآية: 71. ↑
- () ربما يكون المراد من طاعة الله ورسوله، بعد ذكر الأمر والنهي والصلاة والزكاة ـ الطاعة في الشأن السياسي، فلا يكون من ذكر العام بعد الخاص. ↑
- () سورة آل عمران، الآية: 110. ↑
- () سورة آل عمران، الآيتان: 113 و114. ↑
- () أبور ـ على وزن أفعل ـ من البور، الفاسد، بار الشيء أي فسد، وبارت السلعة أي كسدت ولم تنفق، وهذا هو المراد هنا: أن العمل الحق بالقرآن كاسد لا يقبله الناس ولا يتعاملون معه. ↑
- () عُقر دارهم: أصل دراهم، والعُقر: الأصل، ومنه: العقار للنخل، كأنه أصل الماء. ↑
- () تواكلتم: من وكلت الأمر إليك ووكلته لي، أي لم يتوله أحد منا، ولكن أحال به كل واحد على الآخر. ↑
- () شنت الغارات: فرقت، أي نشبت الحروب الصغيرة في أماكن متعددة (حرب العصابات). ↑
- () دعاء عليهم بالخزي والسوء: القبح، والترح. ↑
- () حمارّة القيْظ: شدة حره. ويسبخ عنا الحر: بمعنى يخف، ويلطف الهواء. ↑
- () صبارة الشتاء: بتشديد الراء ـ شدة برد الشتاء. وهذه هي الأعذار التي كانوا يبررون بها تخاذلهم ويلوذون بها دون كشف موقفهم السياسي الذي بيناه. ↑
- () الحجال: جمع حجلة، وهي بيت يزين بالستور، والثياب، والاسرة. ↑
- () السدم: الحزن والغيظ. ↑
- () النغب: جمع نغبة: وهي الجرعة، والتهمام: الهمم، أنفاساً: جرعة بعد جرعة. ↑
- () ذرفت: زدت على الستين. ↑
- () الحثالة: الرديء من كل شيء. ↑
- () في المؤتمر الذي عقده الخليفة عثمان بن عفان، عن تعاظم موجة الاحتجاج والتذمر ـ وجمع الولاة والعمال والكبار لمعالجة الموقف المتفجر بالغضب والنقمة على سياسة الدولة ـ كان اقتراح عبدالله بن عامر، حاكم ولاية البصرة أن تحبس الجيوش حيث هي (تجمر) ولا يؤذن لها بالعودة ليشغل الجنود بمشاكل حياتهم اليومية عن النشاط السياسي ـ ومن المؤسف أن هذا الاقتراح هو الذي تم العمل به فأدى إلى الفتنة الكبرى. ↑
- () سورة المائدة، الآيتان: 78 ـ 79. ↑
- () ولا يعفون: أي يستحسنون ما بدا لهم استحسانه، ويستقبحون ما خطر لهم قبحه بدون رجوع إلى دليل بين، أو شريعة واضحة. يثق كل منهم بخواطر نفسه، كأنه أخذ منها بالعروة الوثقى على ما بها من جهل ونقص. ↑
- () باين: أي باعد وجانب. ↑
- () سورة يوسف، الآية: 87. ↑
- () سورة المؤمن، الآية: 51. ↑
- () سورة الأنبياء، الآية: 105. ↑
- () سورة الأعراف، الآية: 128. ↑
- () سورة يوسف، الآيات: 109 ـ 111. ↑
- () قال تعالى: ﴿قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ سورة الأنعام (مكية ـ 6) الآية: 12. ↑
- () سورة الإسراء، الآية: 9. ↑
- () سورة الزّمر (مكية ـ 39) الآيتان: 17، 18. ↑
- () سورة الأحزاب (مدنيّة ـ 3) الآية: 47. ↑
- () الهوى: الميل والرّغبة، يعني هنا الموقف السّياسي. ↑
- () يرعف بهم… يوجدون في المجتمع من غير أن يتوقَّع وجودهم لاختلافهم النّوعي الأساسي عن الأخلاقية والذهنيّة السائدة في المجتمع، فيفاجأ المجتمع بوجودهم. كما يفاجىء الرعاف صاحبه. ↑
- () يضم نشركم: يجمع شتاتكم ويوحد مواقفكم في حركة تاريخية واحدة. ↑
- () الفلذة: القطعة. والكبد في المعتقد الطّبي القديم من أشرف أعضاء الإنسان وأكثرها أهمية في بقائه وصحته، فتخرج الأرض: أفضل كنوزها وثرواتها. ↑
- () سورة الحديد، الآية: 23. ↑
- () الخشاش بالكسر ما يدخل في عظم أنف البعير من الخشب. ↑
- () الددان كسحاب من لا غناء عنده والسيف الكهام (والدثر) بالفتح الرجل البطيء الخامل النؤوم. ↑
- () يعتاص يقوى ويشتد. ↑
- () ابن فاطمة: هو علي، وأمه فاطمة بنت أسد. ↑
- () الشيخ حمدان ابن الشيخ ديب بن سعيد بن علي الخير، ولد في القرداحة في شباط سنة 1935م، نشأ نشأة عصامية ودرس لدى الكتاتيب وأكمل الدراستين الابتدائية والإعدادية، وعين معلماً، انصرف إلى القراءة منذ نعومة أظافره، وتأثر بشاعرية ابن عمه محمد حمدان الخير، كتب أول قصيدة عام 1950 وله ديوان شعر مخطوط، ومن شعره قوله:
يا رب وفّق لما ترضى به عملي ولقّني البر في سعيي وفي شغلي هذا كتابي لم أكتب به عملاً سوى ولائي أمير المؤمنين علي جعلت جوهر إيماني محبته هواه ديني وفيه منتهى أملي كرمت قلبي بنورٍ من ولايته فهل تُلمّ بقلبي ظلمة الزلل - () الغير هنا: هو الشاعر المصري حافظ إبراهيم. ↑
- () فاطمة بن أسد أم علي. ↑
- () غزوة أحد. ↑
- () حصن خيبر. ↑
- () عمرو بن العاص. ↑
- () حافظ إبراهيم. ↑
- () أعيان الشيعة. ↑
- () أعيان الشيعة. ↑
- () راجع الصفحة 302 من الجزء الأول من السيرة الحلبية طبعة 1949 في القاهرة. ↑
- () يصف ابن قتيبة ذلك في كتابه (الإمامة والسياسة) ثم يقول: ومضى معاوية راجعاً من المدينة إلى الشام، فلم يلبث إلا قليلاً حتى توفي عبدالرحمن بن أبي بكر في نومة نامها. ↑
- () ورد ذلك في غيره أيضاً. ↑
- () لم يثبت إنه كان للنبي بنت غير فاطمة (راجع سيرة النبي في الجزء الأول). ↑
- () صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 6/161 ـ 162. ↑
- () صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 9/268 ـ 270. ↑
- () صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ 7/68. ↑
- () صحيح البخاري ـ بشرح العسقلاني ـ 8/152. ↑
- () صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش إرشاد الساري ـ 9/333 ـ 335. ↑
- () صحيح الترمذي 5/698 ـ 699. ↑
- () سنن ابن ماجة 1/644. ↑
- () كذا. والصحيح: الثقفي. ↑
- () الصحيح من سنن المصطفى 1/323 ـ 324. ↑
- () كذا. وستعرف ما فيه. ↑
- () المستدرك على الصحيحين 3/158. ↑
- () المصنف 12/128. ↑
- () كذا هنا، حيث جاء «محمد بن عمرو» غير «ابن حلحلة الدؤلي». ↑
- () مسند أحمد 4/326 و328. ↑
- () مسند أحمد 4/5. ↑
- () كذا. ↑
- () فضائل الصحابة 2/754. ↑
- () مجمع الزوائد 9/203. ↑
- () المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 4/67. ↑
- () عب: رمز لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. كنز العمال 13/677. ↑
- () لسان الميزان 4/17. ↑
- () حلية الأولياء 2/40. ↑
- () فتح الباري 7/68. ↑
- () انظر ترجمته. ↑
- () تهذيب التهذيب 7/166. ↑
- () مجمع الزوائد 9/213. ↑
- () تهذيب التهذيب 8/27. ↑
- () سير أعلام النبلاء 2/124. ↑
- () إرشاد الساري 8/114، فتح الباري 9/268. ↑
- () عمدة القاري 20/211. ↑
- () تهذيب التهذيب 5/59. ↑
- () طبقات ابن سعد 8/29. ↑
- () كنز العمال 13/687. ↑
- () الإصابة 4/379. ↑
- () تهذيب التهذيب 3/385. ↑
- () تهذيب التهذيب 11/184. ↑
- () تهذيب التهذيب 11/322. ↑
- () خصائص أمير المؤمنين علي: 245. ↑
- () مر وقوعه في سند الرواية الثالثة مما رواه مسلم، فراجع. ↑
- () تهذيب التهذيب 4/307. ↑
- () تهذيب التهذيب 2/380. ↑
- () معجم البلدان 2/304. ↑
- () تهذيب التهذيب 11/131. ↑
- () تهذيب التهذيب 8/415. ↑
- () تهذيب التهذيب 10/404. ↑
- () تهذيب التهذيب 5/268. ↑
- () شرح نهج البلاغة 4/102. ↑
- () الاستيعاب ـ ترجمة زيد بن حارثة. ↑
- () الكاشف 2/311. ↑
- () تهذيب التهذيب ـ ترجمة الأعمش ـ 4/195. ↑
- () تحف العقول عن آل الرسول: 198، لابن شعبة الحراني، من أعلام الإمامية في القرن الرابع الهجري.
وقد رواه الغزالي في إحياء علوم الدين 2/143 لكنه قال: «ولما خالط الزهري السلطان كتب أخ له في الدين إليه»!! وكم له من نظير!
وبشر الحافي تاب على يد الإمام موسى الكاظم في قضية معروفة، رواها المناوي في الكواكب الدُّرِّيَّة: 208، إلا أنه لم يصرح باسم الإمام!! هكذا يريدون إخفاء فضائل آل الله وإطفاء نور الله، وهكذا يأبى الله. ↑
- () وفيات الأعيان ـ ترجمة الزهري. ↑
- () سير أعلام النبلاء 3/391 ـ 394، تهذيب التهذيب 10/137. ↑
- () فتح الباري 9/268 ـ 270. ↑
- () قد عرفت أنه وقع في صحيح البخاري أيضاً، فلماذا خصه بمسلم؟! ↑
- () تهذيب التهذيب 10/137. ↑
- () سير أعلام النبلاء 10/391. ↑
- () الكواكب الدراري 13/88. ↑
- () فتح الباري 6/61. ↑
- () عمدة القاري 15/34. ↑
- () فتح الباري 9/268. ↑
- () مسند أحمد 4/323، المستدرك 3/158، سنن البيهقي 7/64. ↑
- () ومن هنا ذكر ابن ماجة الحديث في باب الغيرة. ↑
- () ومن هنا عنون البخاري: «باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» ولم يذكر فيه إلا هذا الحديث!!. ↑
- () فتح الباري 7/68. ↑
- () عمدة القاري 16/230. ↑
- () المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ـ هامش إرشاد الساري ـ 9/333. ↑
- () عمدة القاري 15/34. ↑
- () فتح الباري 9/268. ↑
- () عمدة القاري 20/265. ↑
- () إرشاد الساري 8/152. ↑
- () هذه الأحاديث متفق عليها، وقد أخرجها أصحاب الصحاح كلهم في باب الأدب وغيره. انظر منها: سنن أبي داوود 2/288. ↑
- () فتح الباري 7/68. ↑
- () تهذيب التهذيب 12/469، الإصابة 4/378. ↑
- () الإصابة 4/378. ↑
- () فتح الباري، إرشاد الساري، عمدة القاري، المنهاج… وغيرها. ↑
- () شرح المواهب اللدنية 3/205. ↑
- () فيض القدير 4/241. ↑
- () الإصابة 4/378. ↑
- () سنن البيهقي 7/64 و10/201، مشكاة المصابيح 3/1732 وقال: متفق عليه. ↑
- () فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ـ 4/241. ↑
- () منهاج السُنَّة 2/170. ↑
- () الدلائل والمسائل لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. ↑
- () البحار. ↑
- () أعيان الشيعة. ↑
- () أعيان الشيعة. ↑
- () أعيان الشيعة. ↑
- () الطبري، ج5، ص170. ↑
- () راجع: موقف حجر بن عديّ وتحدّيه للسلطة الأُموية وهي في أشد حالات القمع والملاحقة لمعارضيها، وذلك في عهد القبضة الحديدية لهذه السلطة في العراق، زياد بن أبيه، حيث ساقه هذا الموقف إلى الإعدام مع عدد من أصحابه بالقرب من دمشق. الدينوري: الأخبار الطوال = ص223 ـ 224. ↑
- () المصدر نفسه، ص220. ↑
- () المصدر نفسه، ص221. ↑
- () المكان نفسه. ↑
- () المكان نفسه. ↑
- () ابن الأثير: الكامل، ج3، ص460. ↑
- () الطبري، ج6، ص91. ابن الأثير الكامل، ج3، ص404. ↑
- () الإمامة والسياسة، ج1 ص151، الطبري، ج6، ص92. ↑
- () الطبري، ج6، ص92. ↑
- () الأخبار الطوال، ص216. ↑
- () المصدر نفسه، ص217. ↑
- () الطبري، ج6، ص92. ↑
- () اليعقوبي: تاريخ، ج2، ص215. ↑
- () الأخبار الطوال، ص216. ↑
- () اليعقوبي: تاريخ، ج2، ص187. ↑
- () ابن الأثير: الكامل، ج3، ص340. ↑
- () الحجاج بن يوسف. ابن الأثير، ج4، ص437 ـ 443. ↑
- () الطبري، ج6، ص91. ↑
- () محب الدين أبو العباس الطبري، وهو غير الطبري الشهير المعروف بأبي جعفر بن جرير. ↑
- () ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، ص138. ↑
- () ذخائر العقبى ص139. ↑
- () المكان نفسه. ↑
- () المكان نفسه. ↑
- () Vezely: Al-Ansar, p.35. ↑
- () الطبري، ج6، ص92. ↑
- () البلاذري: أنساب الأشراف، ج1، ص57. ↑
- () أنساب الأشراف، ج1، ص116. ↑
- () الدينوري: الأخبار الطوال، ص218. ↑
- () الطبري 5 ـ 31، والكامل لابن الأثير 3 ـ 31، وابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة «بتحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم» 2 ـ 57 ـ و12 ـ 9، 20 ـ 21، 78 ـ 79 ـ 82. وفي تاريخ اليعقوبي «وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي»، وقريب منه في شرح نهج البلاغة: 2 ـ 83. ولاحظ المؤلف: «نظام الحكم والإدارة في الإسلام». ↑
- () مما لا يخلو من مغزى أن عمر حين فرض العطاء على مبدئه في تفضيل بعض المسلمين على بعض، فضل الأوس على الخزرج في ذلك، راجع: فتوح البلدان: 437.
وقد احتج سعد بن عبادة على توجيه الأَحداث السياسية بهذا الشكل فلعنه عمر وأبو بكر جهاراً، وبرءا منه، وأخرجاه من المدينة إلى الشام حيث قتل هناك، وكان مما قاله عمر: (اقتلوا سعداً، قتل الله سعداً؛ اقتلوه فإنه منافق).
ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة ج20، ص ـ 17 و21. ↑
- () ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 8/111. ↑
- () تاريخ اليعقوبي: 2/106. ↑
- () فتوح البلدان: 437. ↑
- () فهم عرب، وقرشيون، ومضريون ومهاجرون. ↑
- () الطبري 5/25 في أحداث سنة ثلاث وعشرين. ↑
- () تاريخ اليعقوبي 2/107، وشرح نهج البلاغة (بتحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم) 2/131 ـ 132، وابن الطقطقي في الفخري: 73. ↑
- () وليس هنا شيء جديد بالنسبة إلى موقف الناس من علي. فهذا هو موقفهم منه منذ السقيفة، ففي تاريخ اليعقوبي 2/83 «وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي». ↑
- () ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 9/52. ↑
- () المصدر السابق 9/52، والطبري 4/232 ـ 233. ↑
- () المصدر السابق 9/52، والطبري 4/232 ـ 233. ↑
- () المصدر السابق 9/52، والطبري 4/232 ـ 233. ↑
- () نهج البلاغة (طبع دار الأندلس ـ بيروت) 1/151. ↑
- () ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد ـ بتحقيق: محمَّد سعيد العريان ج5 ص31 ـ 32. ↑
- () المسعودي: مروج الذهب 2/341، والبلاذري: أنساب الأشراف 5/25 ـ 28 و48، 52، وغيرهما. ↑
- () المسعودي: مروج الذهب 2/341 ـ 343. ↑
- () حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 1/358. ↑
- () المسعودي: مروج الذهب 2/346. ↑
- () ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 3/49. ↑
- () «قتل عثمان وابنه الوليد ـ وكان صاحب شراب وفتوة ومجون ـ وهو مخلق الوجه، سكران، عليه مصبغات واسعة» مروج الذهب 2/341. والمعارف لابن قتيبة (دار الكتب 1960) 202. ↑
- () قال عمر لما استأذنه الزبير بن العوام في الغزو: «ها إني ممسك بباب هذا الشعب أن يتفرق أصحاب محمَّد في الناس فيضلوهم» شرح نهج البلاغة 20/20. ↑
- () الطبري 5/134. ↑
- () الطبري 5/134. ↑
- () جمر الناس: جمعهم، وجمر الجيش: حبسهم في أرض العدو، ولم يقفهم (قاموس) يريد عثمان من عماله أن يجمعوا الناس في البعوث العسكرية الطويلة الأمد، ولا يردوهم إلى أوطانهم. ↑
- () حرم: منع. ↑
- () الطبري: 3/373 ـ 374. ↑
- () وقد حدد علي هذه الحقوق في مناسبة قاسية من مناسبات حياته.
وذلك بعد صفين، في خطبة له، نهج البلاغة 1/102 ـ 105. ↑
- () نهج البلاغة 1/217. ↑
- () نهج البلاغة. ↑
- () نهج البلاغة. ↑
- () نهج البلاغة 1/59. وشرح نهج البلاغة 1/269 ـ 270. ↑
- () شرح نهج البلاغة 7/37 ـ 38. ↑
- () شرح نهج البلاغة 7/38 ـ 39. ↑
- () المصدر السابق 7/39 ـ 40. ↑
- () شرج نهج البلاغة 2/85 ـ 86. ↑
- () شرج نهج البلاغة 2/85 ـ 86. ↑
- () شرح نهج البلاغة 2/116 ـ 117. ↑
- () المصدر السابق 2/6 و7. ↑
- () المصدر السابق 2/17. وتفصيل أحداث بسر بن أرطأة في الجزء نفسه ص3 ـ 18. ↑
- () المصدر السابق 11/44. ↑
- () المصدر السابق 4/73. ↑
- () مناقب أبي حنيفة للمكي 1/117. ↑
- () شرح نهج البلاغة 1/17. ↑
- () شرح نهج البلاغة 11/44 ـ 46. ↑
- () المصدر السابق 11/43 ـ 44. وقد استمر الأمر باستمرار الزمان. يقول ابن حجر في كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) في الصفحة 125 ـ 126: كان الناس إذا أرادوا أن يكيدوا الشخص دسوا عليه من رماه بالتشيع فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقوبات والإهانات حتى يظهر التوبة من الرفض (ح). ↑
- () الطبري 6/132. ↑
- () الطبري 6/122. ↑
- () الطبري 6/80. ↑
- () الاستيعاب 1/165. ↑
- () ابن الأثير: الكامل 3/212. ↑
- () المسعودي: مروج الذهب 3/35. ↑
- () الكامل لابن الأثير 3 ـ 73. ↑
- () شرح نهج البلاغة 4 ـ 58، ومروج الذهب 3 ـ 35. ↑
- () بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية 1 ـ 128، وفيليب حتي: تاريخ العرب: 1 ـ 259 ـ 260. ↑
- () ابن الأثير: الكامل 6 ـ 220. ↑
- () تاريخ الإسلام 1 ـ 475. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 74 ـ 75. ↑
- () شرح نهج البلاغة 11 ـ 44 ـ 46. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 4 ـ 76. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 4 ـ 76. ↑
- () ابن الأثير: الكامل 3 ـ 252، والإمامة والسياسة 1 ـ 200. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 4 ـ 79. ↑
- () تاريخ الإسلام السياسي 1 ـ 474. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 2 ـ 19. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 2 ـ 19. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 2 ـ 19. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 4 ـ 79 ـ 80. ↑
- () يوليوس ولهاوزن: الدولة العربية وسقوطها: 158. ↑
- () أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني، طبعة دار الكتب ج16/29 ـ 32. ↑
- () يوليوس ولهاوزن: الدولة العربية وسقوطها: 51 ـ 52 و53 و56. ↑
- () سورة الحجرات، الآية: 13. ↑
- () قد بينا في صدر هذه الدراسة أن الروح القبلية بعثت في وقت مبكر جداً بالنسبة إلى هذا التاريخ، نعم يعتبر عهد عثمان عهد استفحالها وظهور آثارها الوبيلة في المجتمع الإسلامي وقد ظهرت هذه العصبية من عثمان حينما حكّم بني أُمية في رقاب الناس. وقد اعتبر كثير من المسلمين في هذا العمل تعصباً قبلياً مجافياً لروح الإسلام. ومن سعيد بن العاص والي الكوفة يوم قال في ملأ من رجال القبائل رداً على أحدهم «إنما السواد بستان لقريش» فرد عليه الأشتر النخعي قائلاً «أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستاناً لك ولقومك؟» فوقعت الوحشة بين قريش وسائر القبائل من ذلك الحين. زيدان: التمدن الإسلامي 4 ـ 57 ـ 58 أضف إلى هذا سلوك معاوية في الشام وعبدالله بن سعد بن أبي سرح في مصر وعبدالله بن عامر في البصرة. ↑
- () نهج البلاغة (نشر مكتبة الأندلس ـ بيروت) 3 ـ 23 ـ 48. وراجع للمؤلف: دراسات في نهج البلاغة ـ النجف 1956. في فصلي (المجتمع والطبقات الاجتماعية) و(الوعظ) ففيهما دراسة مستوفاة عن هذا الموضوع. ↑
- () نهج البلاغة 4 ـ 73 ـ 74. ↑
- () نصر بن مزاحم: كتاب صفين: 8، 108، 345، 346. ↑
- () المصدر السابق: 209 ـ 311. ↑
- () كتاب صفين: 153 ـ 156. ↑
- () الطبري: 4/ج84 ـ 86، وشرح نهج البلاغة. ↑
- () ولهاوزن، الدولة العربية: 108. ↑
- () تاريخ الإسلام السياسي 1/278 ـ 279. ↑
- () الدولة العربية: 112 نقلاً عن الطبري، وفي شرح نهج البلاغة 11/19 نقلاً عن الجاحظ: «وكان معاوية يحب أن يغري بين قريش». ↑
- () بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية 1/148، وأحمد أمين: قصة الأدب في العالم 1/372. ↑
- () أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي: 308 ـ 309. ↑
- () الأغاني (طبعة الساسي) 2/170، وتاريخ الإسلام السياسي 1/435. وفجر الإسلام: 280. ↑
- () تاريخ الشعر السياسي؛ 160/161. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 4/74 ـ 75. وقد جنى معاوية من فعله هذا ولاء مسكين الدارمي، وها هو يزين له استخلاف يزيد بقوله:
ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر ومروان أم ماذا يقول سعيد بني خلفاء الله مهلاً فإنما يبوئها الرحمن حيث يريد إذا المنبر الغربي خلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد تاريخ الشعر السياسي: 241. ولا يفوتنا أن نلاحظ أن البيت الأول يشهد لهذا التناحر الذي كان يعمل عمله في صميم الأُسرة الأُموية. ويشير إلى الأسماء البارزة في هذا الصراع: عبدالله بن عامر، ومروان بن الحكم، وسعيد العاص. ↑
- () ولهاوزن: الدولة العربية: 58. ↑
- () ونرى عند أحد رفقاء حجر، وهو قبيصة بن ربيعة العبسي، تنبهاً لهذه الأساليب، فقد قال لأَبي شريف البدري حين قدم ليقتل في مرح عذراء «إن الشر بين قومي وقومك آمن، فليقتلني سواك، فقال: برتك رحم، ثم قتله القضاعي». ↑
- () الدولة العربية 105 ـ 106. ↑
- () المصدر السابق: 207. ↑
- () الأغاني 21 ـ طبعة الساسي. ↑
- () بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية 1/146. ↑
- () الطبري. ↑
- () أحمد أمين: فجر الإسلام، 213. ↑
- () الدولة العربية: 52. ↑
- () دراسات في نهج البلاغة للمؤلف 170 ـ 174 ونهج البلاغة (دار الأندلس 2/72). ↑
- () العقد الفريد 2/260 ـ 261، وضحى الإسلام 1/18 ـ 34 والتمدن الإسلامي 4/60 ـ 64 و91 ـ 96. ↑
- () للتوسع في موضوع القبلية راجع البلاذري: أنساب الأشراف 1/18 ـ 34، وفيليب حتي: تاريخ العرب 2/352، وبروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية 1/156 ـ 157، وولهاوزن: الدولة العربية: 165 ـ 173 و403 و414 ـ 415 و418 ـ 419. وحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي 1/337 ـ 341، وسيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب: 63 ـ 67 و78 و113 ـ 114. ↑
- () ولهاوزن: الدولة العربية: 53، وراجع تاريخ الإسلام السياسي 1/278 ـ 279. ↑
- () شرح نهج البلاغة 4/61. ↑
- () شرح نهج البلاغة 11/44 ـ 6. ↑
- () المصدر السابق 11/46. ↑
- () سورة البقرة، الآيتان: 204، 205. ↑
- () سورة البقرة، الآية: 207. ↑
- () شرح نهج البلاغة: 4/73. ↑
- () المصدر السابق 4/64 وما بعدها، و67 ـ 69. ↑
- () ورد لقب الأنصار في القرآن الكريم مرتين مقروناً بلقب المهاجرين في آيتين من سورة التوبة تضمنتا مدح الله تعالى لهم وثناءه عليهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الآية: 101، «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم/118». ↑
- () أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني، طبعة دار الكتب: 16/42 ـ 43 و48. ↑
- () ويظهر أن هذا الاتجاه اعتبر سياسة ثابتة في مهمات الدولة الثقافية، فنجد أن هشام بن عبدالملك طلب من ابن شهاب الزهري أن يقول في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ إن الذي تولّى كبره هو علي بن أَبي طالب، فأبى وقال: هو عبدالله بن أبي بن سلول.
وعندما طلب خالد بن عبدالله القسري ـ والي العراق في عهد هشام بن عبدالملك ـ من ابن شهاب الزهري أن يكتب سيرة النبي يقول ابن شهاب: «فقلت له: فإنه يمر بي الشيء من سيرة علي بن أبي طالب، فأذكره؟» ولكن خالداً القسري رفض أن يأذن لابن شهاب في ذكر علي إلاَّ إذا كان ذكره يتضمن قدحاً وذماً.
الدكتور أحمد أمين: ضحى الإسلام (الطبعة الخامسة) 2/326، نقله عن الأغاني 19/59. ↑
- () تجد هذه النصوص وغيرها في البخاري وغيره من كتب الحديث. ↑
- () ابن قتيبة: عيون الأخبار 1/7. ↑
- () شرح نهج البلاغة 1/340. ↑
- () ابن حزم: الفصل في الملل والنحل 4/204. ↑
- () فيليب حتي: تاريخ العرب 2/316. ↑
- () لما استخلف يزيد بن عبدالملك بن مروان قال: سيروا بسيرة عمر بن عبدالعزيز فمكث كذلك أربعين ليلة. فأتي بأربعين شيخاً فشهدوا له أنه ما على الخلفاء من حساب ولا عذاب ابن كثير ج؟، ص232.
وفي الدولة العربية 6/593: أن قوماً من المرجئة على رأسهم رجل يقال له أبو رؤبة انضموا إلى يزيد بن المهلب بن أبي صفرة في ثورته على يزيد بن عبدالملك بن مروان ولما جاء مسلمة بن عبدالملك لقمع الثورة، وحرض يزيد بن المهلب الناس على القتال قال ابن رؤبة: «إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه، وقد زعموا أنهم قبلوا، فليس لنا أن نمكر ولا نغدر، ولا نريدهم بسوء، فقال لهم يزيد بن المهلب: ويحكم، أتصدقون بني أُمية؟ إنهم أرادوا أن يجيبوكم ليكفوكم منهم حتى يعملوا في المكر، قالوا: لا نرى أن نفعل ذلك حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم قبلوه منا». ↑
- () لاحظ في هذا الموضوع أحمد أمين: فجر الإسلام: 279 ـ 282 و291 ـ 294، وضحى الإسلام3: 316 ـ 329، وإجناس جولد تسيهر العقيدة والشريعة في الإسلام: 75 ـ 77 و295 هامش رقم 20. ↑
- () موريس غودفردا، النظم الإسلامية: 39 «في الخلاف الذي قام حول الجبرية ساند الخلفاء الأُمويون فكرة إنكار الإرادة في أفعال الإنسان». ↑
- () فجر الإسلام: 159. ↑
- () المصدر السابق: 160. ↑
- () يقول الدكتور أحمد أمين: ضحى الإسلام 3/81 «… وبنو أُمية ـ كما ظهر ـ كانوا يكرهون القول بحرية الإرادة، لا دينياً فقط، ولكن سياسياً كذلك، لأن الجبر يخدم سياستهم، فالنتيجة للجبر أن الله الذي يسير الأُمور قد فرض على الناس بني أُمية كما فرض كل شيء، ودولتهم بقضاء الله وقدره، فيجب الخضوع للقضاء والقدر». ↑
- () تاريخ الشعوب الإسلامية 1/148. ↑
- () أحمد أمين: ضحى الإسلام 3/81 ـ 82، وجولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام: 85 ـ 87. ↑
- () ابن الأثير: الكامل 3/233 ـ 243 وغيره. ↑
- () كما حدث من مالك بن هبيرة السكوني الذي بدا وكأنه سيثور بسبب قتل حجر وأصحابه، فقد أرسل إليه معاوية مائة ألف درهم «فأخذها وطابت نفسه» الكامل 3 ـ 243. ↑
- () ابن الأثير: الكامل 3: 249 ـ 252. ↑
- () الإمامة والسياسة 1 ـ 195 ـ 196. ↑
- () الإمامة والسياسة 1/189 ـ 190، وأعيان الشيعة 4: قسم أول: 143 ـ 146. ↑
- () أعيان الشيعة، قسم أول: 50 ـ 51. ↑
- () شرح نهج البلاغة 4/16. ↑
- () الدكتور طه حسين: الفتنة الكبرى: علي وبنوه 206 ـ 208. ↑
- () الدينوري الأخبار الطوال: 220. ↑
- () الأخبار الطوال 221. ↑
- () حلس بالمكان حلساً: لزمه. ↑
- () الأخبار الطوال 221. ↑
- () المصدر السابق 222. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 142 ـ 143، والأخبار الطوال 224. ↑
- () قال أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، 29: «وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد، فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر الحسن وسعد بن أبي وقاص فدس إليهما سماً، فماتا منه». وراجع: سيد أمير علي، مختصر تاريخ العرب، 72. ↑
- () زيدان: التمدن الإسلامي 4/71. ↑
- () عيون الأخبار 1/201. ↑
- () أعيان الشيعة: 4 القسم الأول: «وكان لمعاوية عين بالمدينة يكتب إليه بما يكون من أُمور الناس، فكتب إليه: أن الحسين بن علي أعتق جاريته وتزوجها…». ↑
- () حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي 1/533. ↑
- () ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 2/357. ↑
- () كان التناحر بين قيس وكلب، أو بين مضر واليمن قد بلغ غايته في عهد يزيد، ثم انفجر بموته بسبب الاختلاف فيمن يخلف معاوية الثاني الذي تنازل عن الحكم، ونشبت الحروب بين القبائل بسبب ذلك. راجع: ولهاوزن، الدولة العربية 165 ـ 173، وبروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية 1/156 ـ 157. ↑
- () ابن أبي الحديد: شرح النهج 4/8. ↑
- () يميل المرحوم الشيخ راضي آل ياسين في كتابه «صلح الحسن» ص: 242 ـ 270 ـ الطبعة الأولى ـ إلى التأكيد على أن الحسن والحسين لم يبايعا معاوية بالخلافة، استناداً إلى نصوص وردت في بعض الصيغ التي روي بها الميثاق بين الإمام الحسن ومعاوية، والتي يراها في بعض الصيغ التي روي بها الميثاق بين الإمام الحسن ومعاوية. والتي يراها دالة على إعفاء الحسن من كل التزام يشعر بأنه سلم إلى معاوية ـ بالإضافة إلى السلطان السياسي ـ الإمامة الدينية أيضاً. وهذا رأي لا نملك رفضه، فشيء آخر غير ما ذكر من النصوص، وهو شخصيتا الحسن ومعاوية، يعزز هذا الرأي. ولكن هذا الواقع لا يغير من جوهر المسألة شيئاً، فقد أظهر معاوية للرأي العام أن الحسن قد بايع بما لهذه الكلمة من دلالات زمنية ودينية. وقد كان المسلمون ينظرون إلى البيعة على أنها عهد لا يمكن نقضه ولا الفكاك منه، لاحظ كتابنا «نظام الحكم والإدارة في الإسلام» ص: 48 ففيها شواهد تاريخية، ولاحظ أيضاً «الدولة العربية وسقوطها» ولهاوزن ص115، وسمو المعنى في سمو الذات للشيخ عبدالله العلايلي ص101 ـ 105. ↑
- () الإمامة والسياسة 1/173. ↑
- () الأخبار الطوال 203. ↑
- () السيد محسن الأمين: أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 181 ـ 182: والشيخ المفيد: الإرشاد 206، وأعلام الورى 220، والسيوطي: تاريخ الخلفاء 206. وقد ذكر فيليب حتي «تاريخ العرب» 2/252 أن أهل الكوفة كانوا قد بايعوا الحسين بعد موت أخيه، وهذا غير صحيح، وما صح هو هذه المحاولة التي لم يستجب لها الإمام الحسين… ↑
- () أعيان الشيعة 4/قسم أول/ 142، والأخبار الطوال 224 ـ 225، والإمامة والسياسة 1/188. ↑
- () الأخبار الطوال 221. ↑
- () الشيخ المفيد: الإرشاد (طـ النجف 1962م) ص199. ↑
- () الفتنة الكبرى ـ علي وبنوه ـ 295. ↑
- () البلاذري: أنساب الأشراف 4/ القسم الثاني/ 1. ↑
- () نفس المصدر والصفحة. والبيت الثالث يكشف عن خلق يزيد المنحل. وفي ص4 لاحظ البيت الرابع من أبياته في زوجته أم خالد، وفي ص10 ـ 11 الأبيات الأربعة، ففيها دلالة على شذوذه الجنسي. ↑
- () فيليب حتي، تاريخ العرب 4/258 وعبدالله العلايلي: سمو المعنى في سمو الذات 59 ـ 61، وعن حياة اللهو لاحظ ولهاوزن: الدولة العربية وسقوطها 137 ـ 138، وبروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية 1/156. ↑
- () الإمامة والسياسة 1/195 ـ 196. ↑
- () المصدر السابق 1/200 والكامل في التاريخ 4/252. ↑
- () الفتنة الكبرى ـ علي وبنوه ـ 295. ↑
- () ابن الأثير: الكامل 3/263، والبلاذري 4/ قسم ثان/12. ↑
- () البلاذري كالسابق: 15. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 183 ـ 184. ↑
- () الدولة العربية 4/254، والكامل 3/265، والبلاذري: أنساب الأشراف 4/ قسم ثان/ 14. ↑
- () البداية والنهاية. ↑
- () مقاتل الطالبيين والبلاذري 4/ قسم ثان/ 13 ـ 14 والشيخ المفيد: الإرشاد (طبع النجف 1962) ص202. ↑
- () الدولة العربية 4/288، والكامل 3/276، وأنساب الأشراف 4/14. ↑
- () الدولة العربية 4/288، والكامل 3/276، وأنساب الأشراف 4/14. ↑
- () أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي، طبع النجف 1384 ـ 1964، ج2/234 ـ 236. ↑
- () الدولة العربية 4/304 ـ 305، والكامل 3/280، وأعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 228 ـ 229. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 155 ـ 160. ↑
- () الكامل 3/266 ـ 267. ↑
- () الطبري 4/303 والكامل 3/280، وأعلام الورى 229، وأعيان الشيعة نفس الجزء والصفحة، والأخبار الطوال نشرة دار الكتب: 249. ↑
- () الطبري 4/262، وجاء في أعيان الشيعة نفس الجزء والصفحة «وانفذوا قيس بن مسهر الصيداوي، وعبدالرحمن بن عبدالله بن شداد الأرحبي وعمارة بن عبدالله السلولي إلى الحسين ومعهم نحو مائة وخمسين صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة، وهو مع ذلك يتأبى ولا يجيبهم فورد عليه في يوم واحد ستون كتاباً، وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده في نوب متفرقة اثنا عشر ألف كتاب». ↑
- () الطبري 4/261 ـ 262، والكامل 3 ـ 266. ↑
- () الطبري 4/289 و296، والكامل 3/275 ـ 276، والأخبار الطوال، 223. ↑
- () الطبري 4/289 و296، والكامل 3/275 ـ 276، والأخبار الطوال، 223. ↑
- () الطبري 4/287 ـ 288 والكامل 3/275 ـ 276. ↑
- () الطبري 4/287 ـ 288 والكامل 3/275 ـ 276. ↑
- () محمَّد بن عبدالله الأزرقي: أخبار مكة (طبعة دار الثقافة في مكة المكرمة) ج2، ص1132، أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 212. ↑
- () أعيان الشيعة/ قسم أول/ 212. ↑
- () الطبري 4/290 والكامل 3/276. ↑
- () زبالة: موضع بطريق مكة. ↑
- () عبدالله بن بقطر: رضيع الحسين، كان أحد رسله إلى الكوفة. قبض عليه عبيدالله بن زياد، ورمى به من فوق القصر فتكسر، وقام إليه عمرو الأزدي فذبحه، ويقال: بل فعل ذلك عبدالملك بن عمير اللخمي. ↑
- () الطبري 4/300 ـ 301، والكامل 3/278. ↑
- () الطبري 4/300 ـ 301، والكامل 3/278. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 236. ↑
- () الطبري 4/309 ـ 310. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 143، والدولة العربية 4/2132، والكامل 3/283. ↑
- () فجر الإسلام، 158 ـ 160. ↑
- () الطبري 4/275. ↑
- () الطبري 4/281 ـ 282. ↑
- () الطبري 4/331، وراجع ولهاوزن: الدولة العربية وسقوطها ـ فقد ذكر شواهد عن تغلغل هذه الفكرة في المجتمع السوري. ↑
- () كان قسم منهم ليس خيراً من اللصوص العاديين إلاَّ بالاسم، بحيث يستحقون أن يعاملوا كاللصوص» ولهاوزن، الدولة العربية، 102.
وبروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية (الطبعة الخامسة ـ دار العلم للملايين بيروت ـ 1968، ص215). ↑
- () الطبري 4/303 ـ 304، والكامل 3/280. ↑
- () الطبري 4/ج314، والكامل 3/384. ↑
- () الطبري 4/313، والكامل 3/283 ـ 284، وأعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 244. ↑
- () محمَّد بن الأشعث ـ أخو قيس ـ هو الذي آمن مسلم بن عقيل ثم لم يف بأمانه، الدولة العربية 4/280 ـ 281. ↑
- () الطبري بتحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم 5/425 ـ 426 طبعة سنة 1964م، والكامل 3/287 ـ 288. ↑
- () الطبري 4/388 ـ 389، والكامل 3/300، وتاريخ الخلفاء، 208، وغيرها. ↑
- () راجع بحثاً مفصلاً عن هذا الموضوع في كتابنا (نظام الحكم والإدارة في الإسلام) في الصفحات 97 ـ 99 و103 ـ 104 و107 ـ 112، وغيرها. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 318 ـ 320. ↑
- () أعيان الشيعة 4/قسم أول/ 321 ـ 323. ↑
- () الطبري 4/346 ـ 357، والكامل 3/300، والشماتة في أبغض مظاهرها بينة في موقف عمرو بن سعيد الأموي. ↑
- () الطبري 5/469 ـ 470. ↑
- () كعب بن جابر: أحد جنود الجيش الأموي، قالت له زوجته أو أخته لما رجع من المعركة: «أعنت على ابن فاطمة، وقتلت سيد القراء، لقد أتيت عظيماً من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبداً» فأجابها بشعر يفتخر فيه بفعله تضمن بيتاً يذكر فيه أنه أنقذ رضي بن منفذ من القتل حين أعانة على خصمه في المعركة.
قتلت بريراً، ثم حملت نعمة أبا منقذ لما دعا: من يماصع ونلفت النظر إلى عقيدة الجبر الظاهرة عند رضي بن منقذ العبدي في البيت الأول في قوله (لو شاء ربي ما شهدت قتالهم)، الطبري 5/432 ـ 433. ↑
- () الطبري 5/433. ↑
- () نهج البلاغة 1/98. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 186. ↑
- () الطبري 4/253، والكامل 3/256. ↑
- () المصدرين السابقين على التوالي: 4/305 و3/280 ـ 281. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 258 ـ 259. ↑
- () المصدر السابق، 234. ↑
- () المصدر السابق، 135. ↑
- () قال حميد بن مسلم: قلت لشمر: أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين: تعذب بعذاب الله، وتقتل النساء والولدان، والله إن في قتلك الرجال لما ترضي به أميرك. فقال: من أنت؟ قلت لا أخبرك من أنا، قال: وخشيت والله لو عرفني أن يضرني عند السلطان. الطبري 4/334. ↑
- () الطبري 4/300 ـ 301، وأعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 223. ↑
- () المصدر السابق، 234 ـ 235. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 247 ـ 249. والطبري 4/317 ـ 318. ↑
- () الطبري 4/315 وأعيان الشيعة، 245 ـ 246. ↑
- () الطبري 4/326 ـ 327 و333 ـ 334. ↑
- () أعيان الشيعة 4/ قسم أول/ 267 ـ 268. ↑
- () المصدر السابق: 279 ـ 281. ↑
- () نهج البلاغة: 1/133. ↑
- () سجل الطبري ثورة التوابين في 4/426 ـ436 و449 ـ 473. ↑
- () الطبري 4/469. ↑
- () المصدر السابق 4/452. ↑
- () المصدر السابق 4/466. ↑
- () الطبري 4/404. ↑
- () جعفر النقدي: زينب الكبرى (طـ النجف) ص120 ـ 122 نقلاً عن النسابة العبيدي في (أخبار الزينبات) والدكتورة بنت الشاطىء في كتابها بطلة كربلاء. ↑
- () الطبري «ثورة المدينة» 4/366 ـ 381. ↑
- () المصدر السابق 4/364. ↑
- () المصدر السابق 4/408. ↑
- () أنساب الأشراف 5/220 ـ 221. ↑
- () الطبري 4/517. ↑
- () المصدر السابق 4/424. ↑
- () المصدر السابق «ثورة المختار» 4/487 ـ 577. ↑
- () الطبري: «ثورة مطرف». ↑
- () الدولة العربية، 190. ↑
- () المصدر السابق، 202. ↑
- () المصدر السابق، 190. ↑
- () الطبري: «ثورة ابن الأشعث». ↑
- () كتب ولهاوزن عن هذه الثورة بوعي وفهم. راجع الدولة العربية: 189 ـ 203. ↑
- () مقاتل الطالبيين، 139. ↑
- () المصدر السابق، 135 ـ 136. ↑
- () الدولة العربية، 271. ↑
- () مقاتل الطالبيين، 521. ↑
- () مقاتل الطالبيين، 523. ↑
- () المصدر السابق، 531 ـ 532. ↑
- () المصدر السابق، 533 ـ 534. ↑
- () المصدر السابق، 525. ↑
- () المصدر السابق، 226 ـ 227. ↑
- () عمار بن خباب، أبو معاوية، الدهن البجلي، الكوفي. عده الشيخ في الرجال من أصحاب الإمام الصادق وذكره في الفهرست (المطبعة الحيدرية ـ النجف/ الطبعة الثانية) ص144، وقال: «له كتاب ذكره ابن النديم» وصفه ابن حجر في التقريب بأنه صدوق يتشيع، توفي سنة: 133هـ. ↑
- () تتم الرواية بالتدفق والحركة وقصر الجمل، تختزل كثيراً من المواقف الهامة. وقد أثبتها الطبري في تاريخه في ثلاث قطع (5/) ومن الغريب أن ابن نما الحلي اعتمد في مقتله (مثير الأحزان) على هذه الرواية وأثبت منها الفقرة التي فيها أن الحسين طلب أن يمضي إلى يزيد ليرى فيه رأيه (مثير الأحزان، ص36) مع أن طبيعة الأشياء تكفي لتكذيب صدور هذا العرض من الحسين، هذا بالإضافة إلى نص نقله المؤرخون، ومنهم الطبري، عن عقبة بن سمعان ـ وهو شاهد عيان في موقع يتيح له الاطلاع التام على حقيقة الأحداث، فقد كان مولى للرباب زوجة الحسين ـ يكذب فيه هذه الإشاعة التي نرجح أنها من دس الأمويين والعباسيين ليشوهوا صورة الحسين الناصعة في الذهنية الإسلامية (الطبري/5). ↑
- () الشيخ المفيد، الإرشاد: 218. ↑
- () الخوارزمي، مقتل الحسين: 1/220. ذكر بعضهم هذا العدد عن الخوارزمي على أنه أحد الأقوال في عدد أصحاب الحسين في كربلاء. ونلاحظ أن هذا العدد هو لمن صحب الحسين عند خروجه من مكة، وليس من المؤكد أنه بقي ثابتاً إلى اليوم العاشر من المحرم. وذكر المجلسي (بحار الأنوار: 44/313) نقلاً عن أمالي الصدوق أن الحسين (سار في أحد وعشرين من أصحابه وأهل بيته) ولا يمكن أن نقبل هذه الرواية. لأن طبيعة الأشياء تقضي برفضها، ولأن من الثابت أن عدد بني هاشم وحدهم يبلغ هذا المقدار أو يتجاوزه. ↑
- () الطبري: 5/385. ↑
- () الأخبار الطوال: 244. ↑
- () كلمة «خرج» لا تعني مجرد المغادرة، لأنها اكتسبت منذ انشقاق (الخوارج) على الإمام علي في صفين مدلولاً رافضاً تمردياً ذا نكهة خاصة، لم يكن محبوباً في العراق بوجه خاص، وقد حاول رجال النظام إسباغ هذا المفهوم على ثورة الحسين منذ بداية المواجهة، فعبيد الله بن زياد ـ على سبيل المثال ـ في أول خطبة خطبها في الكوفة، بعد وصوله إليها من البصرة يطلب إلى موظفي الإدارة الحكومية في الكوفة أن يكتبوا له من في عشائرهم، من الحرورية وأهل الريب ـ الطبري: 5/359» والحرورية ـ كما نعلم اسم ثان للخوارج أطلق عليهم منذ معركة حروراء. ويقول ابن زياد لهاني بن عروة بعد القبض عليه وضربه، حين أراد أن يستولي على سلاح أحد الشرطة ليدافع عن نفسه: «أحروري سائر اليوم، أحللت بنفسك، قد حل لنا قتلك ـ الطبري: 5/367».
وقد عرض الدكتور أسعد علي معنى للخروج في محاضرة له، وذلك عند الحديث عن كتاب الإمام الحسين إلى أخيه محمَّد بن الحنفية، وفيه «إني لم أخرج أشراً، ولا بطراً.. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي..» قال الدكتور أسعد علي في محاضرته: (فالخروج يعني تجاوز القول إلى الفعل. عبر عن هذا التجاوز التنفيذي بفعل وصل فيه فاعله، وبصيغة التقرير الذي يؤكد ما حصل فعلاً: «خرجت»). ↑
- () في رواية الطبري عن أبي مخنف: «من المدينة» ونرجح أن هذا خطأ، فأثبتنا نص ابن الأثير: 3/278. ↑
- () الطبري: 5/398 ـ 399، وابن الأثير: 3/278. ↑
- () الطبري: 5/419، واليعقوبي: 2/231، والخوارزمي: 1/247. ↑
- () مروج الذهب: 3/70 ـ يظهر من المسعودي في مقدمة كتابه مروج الذهب أنه قد اعتمد على رصيد ضخم من المراجع التاريخية وكتب الأنساب والجغرافيا، لكنه نادراً ما يذكر في صلب كتابه مصدره الخاص لما ينقله من أحداث. بالنسبة إلى الرواية موضوع البحث: نحتمل أن المسعودي وقع ضحية التباس وتصحيف بين (خمسة) و(خمسمائة). ↑
- () الطبري: 5/389. ↑
- () الطبري: 4، والخوارزمي: 1/237. ↑
- () مثير الأحزان: 39. ↑
- () اللهوف في قتل الطفوف: 42. ↑
- () الطبري: 5/392 ـ 393. ↑
- () الطبري: 5/393. ↑
- () ويبدو أن هذه الظاهرة كانت موجودة بالنسبة إلى الكثيرين، فهم متعاطفون مع الثورة، ولكنهم يقفون عملياً ضدها، وهذه الظاهرة تصورها بدقة كلمة الفرزدق للحسين عندما لقيه: «قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية» إن هذا من مظاهر ما سنشير إليه في فصل (الدلالات) عن وجود حالة ثورية في جهاز نفسي مشلول. ↑
- () مقتل الحسين 2/4. ↑
- () الطبري: 5/422 وفي 436 كرر أبو مخنف ذكر عدد الفرسان. ↑
- () الأخبار الطوال: 256. ↑
- () تاريخ اليعقوبي: 2/230. ↑
- () مقتل الحسين: 3/4. والخوارزمي يروي غالباً عن تاريخ ابن أعثم، أبو محمَّد أحمد، المتوفى سنة 314هـ، وهذه الرواية عن هذا المؤرخ، فتكون إذن، رواية في مستوى رواية الطبري. ↑
- () الإرشاد: 233. ↑
- () إن الأسماء التي انتهى بحثنا في هذه الدراسة إلى اعتبارها دالة على رجال تاريخيين تطمئن النفس بكونهم استشهدوا مع الحسين في كربلاء تبلغ واحداً وثمانين اسماً فيهم ثلاثة موالي للإمام الحسين. وقد ذكر ابن شهرآشوب 4/113 أن ممن قتل في الحملة الأولى عشرة من موالي الحسين واثنان من موالي أمير المؤمنين علي، فيبقى منهم تسعة، ولا نستطيع الجزم بأن جميع الأسماء التسعة وعشرين التي وردت في الجدول الثاني لرجال وهميين، بل نطمئن أن في هذه الأسماء عدداً صغيراً لرجال تاريخيين وإن كنا لا نستطيع تمييز هذه الأسماء بأعيانها. ↑
- () الخوارزمي: مقتل الحسين/92. وبحار الأنوار: 45/12 نقل ذلك عن محمَّد بن أبي طالب الموسوي. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () مروج الذهب: 3/71. ↑
- () نفس المصدر. ↑
- () هذه العقلية تصورها نصوص شعرية كثيرة وحكايات حفلت بها كتب الأدب العربي القديم، ومن أدلها على هذه العقلية ما جرى مع سوار بن عبدالله بن قدامة قاضي البصرة وأميرها لأبي جعفر المنصور ـ فقد جاءه أعرابي من بني العنبر فقال: «إن أبي مات وتركني وأخاً لي ـ وخط خطين في الأرض ـ ثم قال: وهجيناً ـ (أخ أمه أمة) وخط خطاً ناحية ـ فكيف نقسم المال؟ فقال سوار: أها هنا وارث غيركم؟ قال: لا، قال: المال بينكم أثلاثاً، فقال: لا أحسبك فهمت عني؟ أنه تركني وأخي؟ وهجيناً لنا، فقال سوار: المال بينكم أثلاثاً، قال: فقال الأعرابي: يأخذ الهجين كما آخذ وكما يأخذ أخي! قال: أجل! فغضب الأعرابي قال: ثم أقبل على سوار فقال: تعلم والله أنك قليل الخالات بالدهناء..» المبرد (أبو العباس محمَّد بن يزيد): الكامل ـ تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة ـ مطبعة نهضة مصر/ ج2 ص48 ـ إن الولادة من أمه نسخت صلة الأخوة هنا ـ وإذا كانت القصة موضوعة فإنها تصور العقلية التي كانت سائدة في القرن الثاني الهجري، ولذا فليس غريباً ألا يحسب الشهداء من الموالي في كربلاء في سنة ستين للهجرة. ↑
- () مقتل الحسين = اللهوف في قتل الطفوف: … وذكرها المجلسي في بحار الأنوار: 44/394، كما ذكر السيد الأمين في أعيان الشيعة: 4/قسم أول/ 110، ونقدر أنه أخذها عن كتاب اللهوف أيضاً اما ابن نما الحلي فقال كتاب مثير الأحزان/ 38: «فجاء إليهم جماعة من أصحاب عمر بن سعد» وذكر المرحوم السيد عبد الرزَّاق المقرم (توفي سنة 1391هـ 1972م) في كتابه الموسوم (مقتل الحسين ـ الطبعة الرابعة ـ مطبعة الآداب ـ النجف/ هامش صفحة 260) أن الرواية موجودة أيضاً في مصدرين آخرين هما: سير أعلام النبلاء للذهبي ج3 ص210، ولم نتحقق من ذلك لعدم وجود الكتاب المذكور عندنا، وتاريخ اليعقوبي ج3، ص210، ومن المؤكد أن المرحوم المقرم أخطأ في هذه النسبة إلى اليعقوبي لأن هذا لم يذكر هذه الرواية في أي موضع من كتابه التاريخي. ↑
- () الطبري: 5/431، ولاحظ الحوار بين أيوب بن مشرح الخيواني وبين أبي الوداك في الطبري: 5/437. ↑
- () الطبري: 5/455 ـ 456، ومثير الأحزان: ص65، وفيه (نظفت) وكذا في اللهوف في قتلى الطفوف، ص: 60، والظاهر أن إحدى الكلمتين تصحيف عن الأخرى، وربما تكونان معاً تصحيفاً عن (قطعت). ↑
- () الأخبار الطوال: 250، وفي تعداد توزيع الرؤوس على القبائل ـ كما سيأتي ـ يبلغ العدد عند الدينوري خمسة وسبعين رأساً. ↑
- () الإرشاد: 243. ↑
- () بحار الأنوار: 45/62، واللهوف: 60. ↑
- () الطبري: 5/467 ـ 468، وقد قبل ابن شهرآشوب هذه الرواية فيما يبدو، لأنه نقلها عن أبي مخنف في كتابه (المناقب: 4/112)، دون أي اعتراض. ↑
- () الأخبار الطوال: 259. ↑
- () بحار الأنوار: 45/62. ↑
- () الطبري: 5/455. وقد وافق المسعودي على العدد الذي ذكره محمَّد بن مسلم لقتلى الجيش الأموي فقال: «وكان عدد من قتل من أصحاب عمر بن سعد في حرب الحسين ثمانية وثمانين (كذا) رجلاً ـ مروج الذهب/3/72». ↑
- () مروج الذهب/3/71. ↑
- () الطبري: 5/459 ـ 460. ↑
- () الطبري: 5/469. وغيره. ↑
- () الطبري: 5/418 و444 ـ 445. ↑
- () الطبري: 5/454: «فلم ينج منهم أحد غيره، إلاَّ أن المرقع بن ثمامة الأسدي نثر نبله.. إلخ» وعقبة بن سمعان هذا روى كثيراً من مشاهد كربلاء، وتجد رواياته في الطبري. ↑
- () الطبري: 5/454. ↑
- () الطبري: 5/389. ↑
- () مقتل الحسين: 2/4. ↑
- () من هؤلاء الدينوري في الأخبار الطوال: 356، والطبري: 5/422، والشيخ المفيد في الإرشاد: 233، ونذكر هنا بما ورد في رواية الحصين بن عبدالرحمن من التصريح بوجود بني هاشم في مجموع القوة المحاربة في صباح اليوم العاشر من المحرم ـ طبري: 5/392 ـ 393. ↑
- () الخوارزمي، مقتل الحسين: 1/243 ـ 244، وبحار الأنوار: 44/386 ـ 387. ↑
- () «.. ورجعت تلك الخيل (التي منعت الأسديين من الوصول إلى معسكر الحسين) حتى نزلت على الفرات، وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء، فأضر العطش بالحسين وبمن معه» ـ المصدران المذكوران في هامش رقم (1). ↑
- () الطبري: 5/449. وقد أورد ابن نما الحلي اسم هذا المقاتل في (مثير الأحزان ص53) وهو (زرعة بن أبان بن دارم) وأنه قال: حالوا بينه وبين الماء، ولم يذكر ابن نما عبارة (لا تتام إليه شيعته). ↑
- () الطبري: 5/469. ↑
- () بحار الأنوار: 45/69. ↑
- () الرجال: 74. ↑
- () أعيان الشيعة 4 أعيان الشيعة 126. ↑
- () معجم رجال الحديث: 3/86. ↑
- () الخوارزمي، مقتل الحسين: 3/24، وبحار الأنوار: 45/30، والمناقب: 4/104، إلاَّ أنه قال: «ثم برز غلام تركي للحر..» ومن المؤكد أنه يعني الرجل موضوع بحثنا لأن الرجز الذي نسبه إليه هو الرجز المنسوب لمن وصف بأنه غلام تركي للحسين. ↑
- () الطبري: 5/357 ـ 358، وبحار الأنوار: 44/337 ـ 339 و340، والخوارزمي: مقتل الحسين: 1/199 وقد ذكرت كنيته في بحار الأنوار. ↑
- () الرجال: 4 و71. وقد عده ابن حجر في كتاب الإصابة في معرفة..، وابن عبدالبر في الاستيعاب، والجزري في أسد الغابة ونص على مقتله مع الحسين. ↑
- () معجم رجال الحديث: 3/232. ↑
- () معجم رجال الحديث: 3/133. ↑
- () المناقب: 4/102، ومقتل الحسين: 2/18. ↑
- () بحار الأنوار: 45/24 و25. ↑
- () محمَّد بن سعد: الطبقات (طبعة ليدن ـ أوفست) 6/58. ↑
- () المناقب: 4/103. ↑
- () مقتل الحسين: 2/19. ↑
- () الطبري: 5/421 و423 وغيرهما. ↑
- () المناقب: 4/100. ↑
- () اللهوف في قتل الطفوف. ↑
- () بحار الأنوار: 45/15 وغيرها والتصحيف في: 44/320. ↑
- () الطبري: 5/432. ↑
- () الطبري: 5/444. ↑
- () بحار الأنوار: 45/70. ↑
- () معجم رجال الحديث: 3/314. ↑
- () اللهوف: 39 ـ 40. ↑
- () الطبري: 5/446. ↑
- () الرجال: 72. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () المناقب: 4/104. ↑
- () مقتل الحسين: 2/21. ↑
- () بحار الأنوار: 45/28. ↑
- () الرجال: 72. ↑
- () بحار الأنوار: 45/82. ↑
- () بحار الأنوار: 45/22 و71. ↑
- () الرجال: 72. ↑
- () مقتل الحسين: 1/237 و2/19. ↑
- () الطبري: 5/420. ↑
- () المناقب: 4/103. ↑
- () الرجال: 72. ↑
- () الطبري: 5/352 وغيره. ↑
- () الطبري: 5/440 وغيره. ↑
- () بحار الأنوار: 45/71. ↑
- () الطبري: 5/401. ↑
- () بحار الأنوار: 44/376 و45/72. ↑
- () مقتل الحسين: 2/20. ↑
- () المناقب: 4/103. ↑
- () الرجال: 73. ↑
- () الطبري: 5/422 وغيره. ↑
- () الطبري: 5/400 وما بعدها، وغيره. ↑
- () الطبري: 5/427 وما بعده، وغيره. ↑
- () اللهوف في قتلى الطفوف ص: 32، ومثير الأحزان. ↑
- () ذكر الخوارزمي في (مقتل الحسين) 2/10 أن الحر لحق بالحسين مع غلامه التركي، ولم يثبت لدينا أن هذا الغلام قاتل وقتل ليعد في الشهداء. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () الرجال: 73. ↑
- () بحار الأنوار: 45/43 و73. ↑
- () مقتل الحسين: 2/24. ↑
- () الطبري: 5/443. ↑
- () الرجال: 73. ↑
- () المناقب: 4/101. ↑
- () مقتل الحسين: 2/14. ↑
- () بحار الأنوار: 45/18. ↑
- () الرجال: 73. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/71. ↑
- () الطبري: 5/396 ـ 397. ↑
- () الطبري: 5/426 وما بعدها. ↑
- () الطبري: 5/422 وغيره. ↑
- () الرجال: 73. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () المناقب: 4/101. ↑
- () بحار الأنوار: 45/18. ↑
- () قاموس الرجال: 4/318. ↑
- () الرجال: 74. ↑
- () الطبري: 5/445. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () الطبري: 5/419. ↑
- () مقتل الحسين: 1/196 و2/20. ↑
- () المناقب: 4/103. ↑
- () بحار الأنوار: 45/21 و26 و70. ↑
- () اللهوف: 39. ↑
- () الطبري: 5/353 وغيره. ↑
- () الرجال: 74. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/73. ↑
- () الطبري: 5/444. ↑
- () الرجال: 74. ↑
- () بحار الأنوار: 45/24. ↑
- () المناقب: 4/102. ↑
- () الطبري: 5/444. ↑
- () الطبري: 5/453. ↑
- () الطبري: 5/442. ↑
- () مقتل الحسين: 2/24. ↑
- () بحار الأنوار: 45/31 و73. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 72. ↑
- () الرجال: 74. ↑
- () المناقب: 4 ـ 113. ↑
- () الطبري. ↑
- () الرجال: 74. ↑
- () بحار الأَنوار: 45 ـ 71. ↑
- () الطبري: 5 ـ 443 ـ 444. ↑
- () الرجال: 75. ↑
- () مقتل الحسين: 2 ـ 22. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 28، 29 و73. ↑
- () الرجال: 75. ↑
- () المناقب: 4 ـ 113. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 71. ↑
- () الطبري: 4 ـ 443. ↑
- () الرجال: 78. ↑
- () مقتل الحسين: 2 ـ 22. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 28، 29 و73. ↑
- () الطبري: 5 ـ 355، والخوارزمي: مقتل الحسين: 1 ـ 197. ↑
- () الطبري: 5 ـ 375 وبقية المصادر. ↑
- () رجال النجاشي: 78. ↑
- () الرجال: 77. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 72. ↑
- () المناقب: 4 ـ 113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () الرجال: 77. ↑
- () الطبري: 5/352 و354. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/73. ↑
- () الرجال: 77. ↑
- () الطبري 352، والخوارزمي: مقتل الحسين: 1/194. ↑
- () الطبري: 5/423. ↑
- () الرجال: 77. ↑
- () بحار الأنوار: 45/1. ↑
- () المناقب: 4 ـ 102. ↑
- () مقتل الحسين: 2 ـ 17. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 22. ↑
- () مقتل الحسين: 2 ـ 22. ↑
- () بحار الأنوار: 45/28، وفي 44/220 سماه (عبدالله بن أبي عروة الغفاري). ↑
- () الطبري: 5/442. ↑
- () الرجال: 77. ↑
- () بحار الأنوار: 45/29 و71. ↑
- () مقتل الحسين: 2/23. ↑
- () الطبري: 5/429 ـ 430 و436. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () مقتل الحسين: 2/8 ـ 9. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 12 ـ 13. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 71. ↑
- () الطبري: 5/353 ـ 354. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () الطبري: 5/353 ـ 354. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () الرجال: 76. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/73. ↑
- () المناقب: 4/104. ↑
- () مقتل الحسين: 2/21. ↑
- () بحار الأنوار: 45/28. ↑
- () مقتل الحسين: 2/21 ـ 22 وبحار الأنوار: 45/7، وغيرهما. ↑
- () بحار الأنوار: 45/73. ↑
- () المناقب: 4/101. ↑
- () بحار الأنوار: 45/18. ↑
- () مقتل الحسين: 2/14. ↑
- () الطبري: 5/446. ↑
- () بحار الأنوار: 45/22. ↑
- () بحار الأنوار: 45/23. ↑
- () مقتل الحسين: 2/24. ↑
- () المناقب: 4/13. ↑
- () بحار الأنوار: 45/73. ↑
- () الرجال: 77. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () الطبري: 5/413. ↑
- () المناقب: 4/105. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ج71. ↑
- () بحار الأنوار: 45/22. ↑
- () مقتل الحسين: 2/22. ↑
- () بحار الأنوار: 45/70. ↑
- () الطبري: 45/. ↑
- () المناقب: 4/104. ↑
- () مقتل الحسين: 2/17 وفي 1/240 (الصائدي). ↑
- () بحار الأنوار: 45/21. ↑
- () الطبري: 5/364. ↑
- () الطبري: 5/369. ↑
- () المناقب: 4/102. ↑
- () بحار الأنوار: 45/25. ↑
- () مقتل الحسين: 2/18. ↑
- () المناقب: 4/102. ↑
- () مقتل الحسين: 2/14. ↑
- () بحار الأنوار: 45/18. ↑
- () بحار الأنوار: 45/69. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 71. ↑
- () المناقب: 4 ـ 113. ↑
- () الرجال: 79. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 73. ↑
- () الرجال: 79. ↑
- () المناقب: 4 ـ 102. ↑
- () مقتل الحسين: 2 ـ 18. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 24. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 72. ↑
- () بحار الأنوار: 45 ـ 71. ↑
- () المناقب: 4 ـ 113. ↑
- () الرجال: 79. ↑
- () الطبري: 5/405. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/69 والطبري: 5/435. ↑
- () الطبري: 5/369 وغيره. ↑
- () الرجال: 80. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () الطبري: 5/469. ↑
- () الرجال: 80. ↑
- () بحار الأنوار: 45/69. ↑
- () الطبري: 5/404. ↑
- () الرجال: 80. ↑
- () بحار الأنوار: 45/71. ↑
- () المناقب: 4/104. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () الرجال: 80. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () الرجال: 90. ↑
- () بحار الأنوار: 45/70. ↑
- () المناقب: 4/101. ↑
- () مقتل الحسين: 2/12 ـ 13. ↑
- () بحار الأنوار: 44/320 ـ 321 و45/16 ـ 17. ↑
- () المناقب: 4/102. ↑
- () مقتل الحسين: 2/17. ↑
- () الرجال: 81. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () الطبري: 5/408 و445 ـ 446. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () مقتل الحسين: 2/25. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () الطبري (الأرقام السابقة، وأعيان الشيعة ج4 قسم أول ص10 و115 ـ 116). ↑
- () الطبري: 5/353 ـ 354. ↑
- () بحار الأنوار: 45/72. ↑
- () المناقب: 4/105. ↑
- () مثير الأحزان: 42 ـ 43. ↑
- () بحار الأنوار: 45/30. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () مقتل الحسين: 2/20. ↑
- () المناقب: 4/113. ↑
- () مقتل الحسين: 2/9. ↑
- () الغاضرية: قرية على الفرات منسوبة إلى غاضرة قبيلة من بني أسد. ↑
- () المسناة: حائط يبنى على طرف الماء، ويبدو أن المراد هنا المنبسط الرملي المحاذي لضفة النهر. ↑
- () ابن عبد ربه في العقد الفريد مطبعة الاستقامة طـ2، 1953، 4/147. ↑
- () ن.م. ↑
- () البيان والتبيين 2/244 الشركة اللبنانية للكتاب. ↑
- () ن.م 1/203 «2» الطبري الحسنية 6/229. ↑
- () ن.م 6/210. ↑
- () ن.م 6/258. ↑
- () ن.م الصفحة 259. ↑
- () أبو الفرج، مقاتل الطالبيين ص121 طبعة دار إحياء الكتب العربية. ↑
- () الشعر الأموي نقلاً عن ابن الأثير. ↑
- () الطبري 7/53 و81. ↑
- () ن.م، ص47. ↑
- () ن.م، ص50. ↑
- () ن.م، ص51. ↑
- () ن.م، ص47. ↑
- () ن.م، ص76. ↑
- () ن.م، ص51. ↑
- () مروج الذهب…، 3/38. ↑
- () نفسه والطبري، 7/71. ↑
- () الطبري، 7/81. ↑
- () المصدر نفسه، 8/267. ↑
- () المصدر نفسه، 7/172. ↑
- () المصدر نفسه، ص52. ↑
- () د. أحمد صلاح الدين نجا، الكميت بن زيد، بيروت: دار العصر، 1957، ص190. ↑
- () د. عبدالقادر القط، في الشعر الإسلامي والأموي، بيروت: دار النهضة، 1976، ص279. ↑
- () أبو عبدالله بن عمران (المرزباني)، الموشح، القاهرة: دار نهضة مصر، ص310. ↑
- (* ) يراد بالتعزية المجالس التي تقام لذكرى مقتل الحسين سواء في الأيام العشرة من المحرم أو في غيرها من الأيام. ↑
- () في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي بحاشية الصفحة 322، كلام عن تاريخ الفارقي جاء فيه: «إن الخليفة الظافر لما علم أن الإفرنج تنازل عسقلان كان نقل رأس الحسين بن علي (عليهما السلام) إلى مصر، وبنى عليه بمصر مشهداً، وغرم عليه مالاً عظيماً لا يحصى». ↑
- () درج: لم يعقب. ↑
- () أعيان الشيعة. ↑
- () أعيان الشيعة. ↑
- () وعبدالملك نفسه أراد عزل أخيه عبدالعزيز من ولاية العهد بعده، وإحلال ابنه الوليد محله، إذ كان مروان قد جعل ولاية العهد لعبد العزيز بعد عبدالملك، ولكن عبدالعزيز مات قبل ذلك. ↑
- () النجاشي، أحمد بن علي، الرجال ص271. ↑
- () المفيد، محمد بن النعمان، الإرشاد (طهران، 1377 (ص272). ↑
- () أيضاً، ص273. ↑
- () الكليني، الكافي. ↑
- () المسعودي الوصية، النجف، 1955، ص223. ↑
- () النجاشي، الرجال ص319. ↑
- () الفهرست، (النجف، 1937) ص73. ↑
- () المفيد: الإرشاد، ص266. ↑
- () الحلي، الحسن بن يوسف، الرجال (الناجف، 1961) ص68. ↑
- () الرجال (النجف، 1961) ص353. ↑
- () النجاشي، الرجال، ص250. ↑
- () الرجال، ص84. ↑
- () الكليني، الكافي، ج8، ص124. ↑
- () المجلسي، محمد الباقر، بحار الأنوار ج12 (طهران، 1915) ص278. ↑
- () يظهر أن الأميال المذكورة مكونة من مادة قابلة للكتابة على ألواح الأبنوس السود، ولعل تلك المادة شبيهة بالطباشير. ويبدو أن الطباشير كان معروفاً في بداية القرن الخامس للهجرة. وعندما حدث غلاء ببغداد سنة 439هـ بيع الطباشير درهم بدرهم فضة (ابن الجوزي، المنتظم 8: 132). ↑
- () الطوسي، الرجال، ص342 ـ 364. ↑
- () أيضاً، ص358 ـ 362. ↑
- () الطوسي، الرجال، 364 ـ 365. ↑
- () المجلسي، بحار الأنوار، ج11، ص65. ↑
- () الحلي، الرجال، ص89. ↑
- () الحلي، الرجال، ص141. ↑
- () أيضاً، ص154. ↑
- () أيضاً ، ص55. ↑
- () أيضاً، ص43. ↑
- () الرجال، ص98. ↑
- () الرجال، ص78. ↑
- () الرجال، ص43. ↑
- () جاء في عيون أخبار الرضا للصدوق (ج1: 1307 الحاشية) الفهم الذي يتعلم ويدرك علومهم ويعلمها للناس. ↑
- () عيون أخبار الرضا، ج1، ص307. ↑
- () الحلي، الرجال، ص75. ↑
- () الطوسي، الرجال، ص369. ↑
- () أيضاً، ص370. ↑